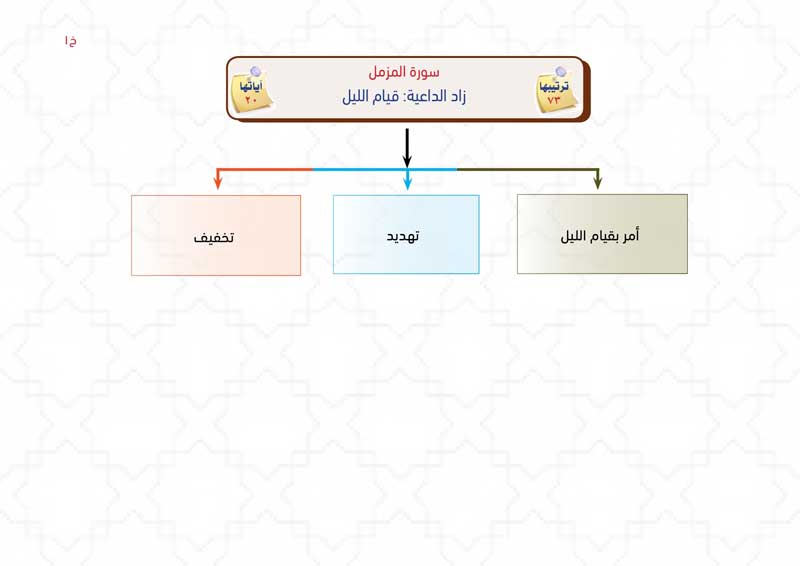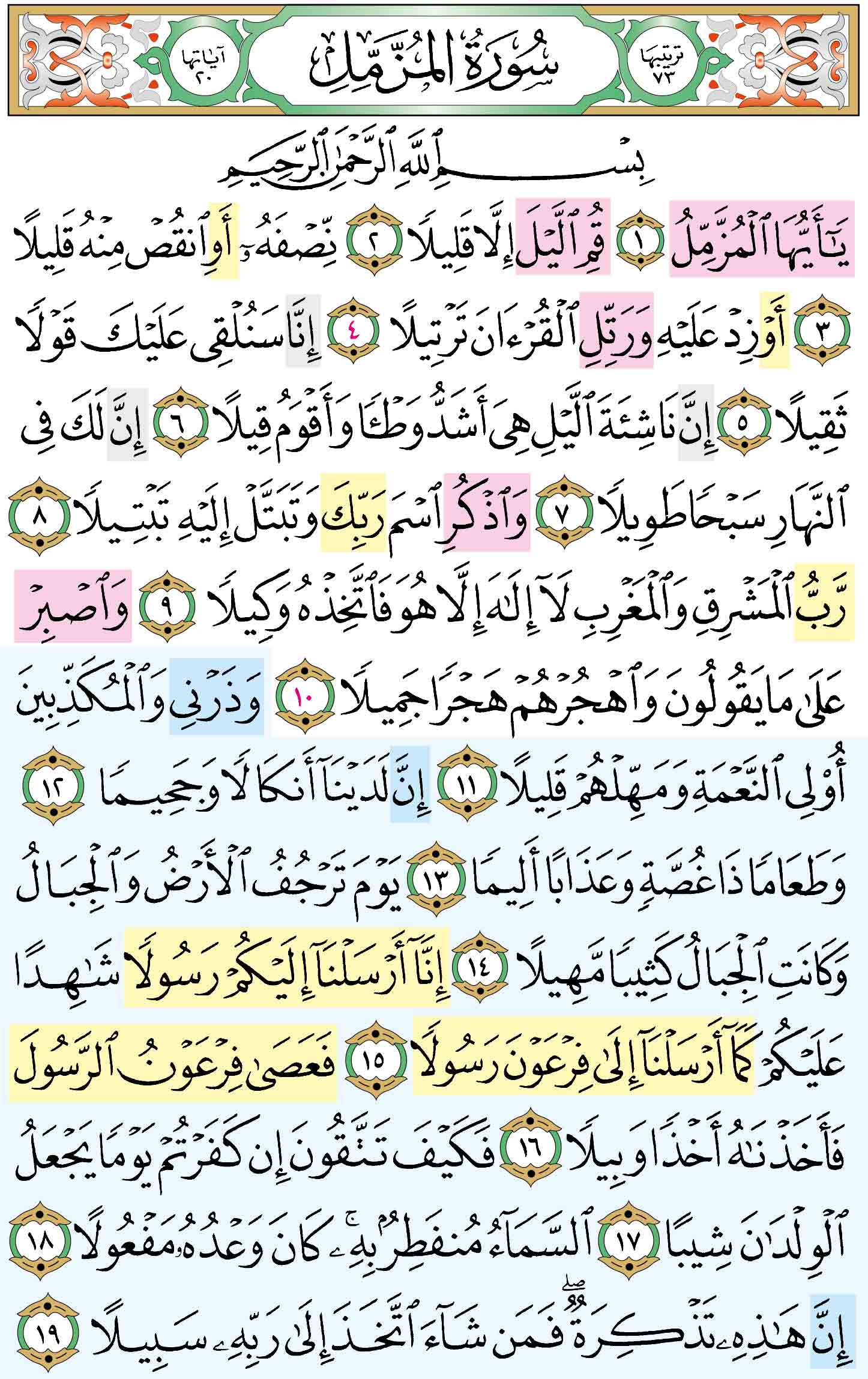
الإحصائيات
سورة المزمل
| ترتيب المصحف | 73 | ترتيب النزول | 3 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |
| عدد الآيات | 20 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |
| ترتيب الطول | 72 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 9/10 | يا أيها المزمل: 1/1 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)
إرشاداتٌ للنَّبي ﷺ بـ: قيامِ الليلِ وترتيلِ القرآنِ لتحمُّلِ أعباءِ الرِّسالةِ، وذِكْرِ اللهِ، والصَّبرِ على أذى المشركينَ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (11) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (9)
بعدَ أمرِه ﷺ بالصَّبرِ على أذى المشركينَ هدَّدَهُم اللهُ هنا بعذابِ يومِ القيامةِ، ثُمَّ هدَّدَهُم بعذابِ الدُّنيا كما حدثَ معَ فرعونَ لمَّا عَصَى موسى عليه السلام .
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة المزمل
زاد الداعية: قيام الليل
أولاً : التمهيد للسورة :
- • رسالة السورة واضحة من بدايتها:: رسالة السورة: زادك أيها الداعية: قيام الليل. الرسالة تنادينا: العبادة مع الصبر أقوى مُعين على تحمل المشاق.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «المزمل».
- • معنى الاسم :: المزمل: المتلفف بثوبه.
- • سبب التسمية :: لأنه اللَّفْظ الْوَاقِع فِي أَوَّلِهَا، ومحورها يدور حول الرسول وما كان عليه من حالة، فوصفه الله وناداه بحالته التي كان عليها .
- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن زاد الداعية إلى الله هو قيام الليل.
- • علمتني السورة :: أن قراءة القرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمّل الشدائد: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾
- • علمتني السورة :: أن أفضل أوقات الصلاة والمناجاة في الثلث الأخير من الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾
- • علمتني السورة :: أيها الداعية دربك وعْر، فتسلّح بالصبر: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة المزمل من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة المزمل من المفصل.
• سورة المزمل من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المزمل مع سورة المدثر، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًاكَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة المزمل هي السورة الوحيدة التي نسخ آخرُها أولَها، حيث جاء في أولِها وجوبُ قيامِ الليلِ، ثم جاء في آخرِها الرخصةُ في ترك قيام الليل، فعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أنه سأل أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة فقال: «أَنْبِئِينِى عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»، فَقَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾؟»، قُلْتُ: «بَلَى»، قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِى أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِى السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِى آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ».
• آخر آية من سورة المزمل هي أكثر آية تكرر فيها لفظ الجلالة (الله)، فقد تكرر فيها 7 مرات، ولا يوجد آية في القرآن تضاهيها في ذلك، حتى آية الدين من سورة البقرة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعين في الدعوة إلى الله بـ: التهجد وقيام الليل والذكر والتوكل والصبر والحلم وقراءة القرآن وصلاة الفريضة والزكاة والصدقة والاستغفار.
• أن نحرص على قيام الليل، ولا نتركه: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (2-4).
• أن نصبر على الأذى، ونحتسب ذلك عند الله: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (10).
• أن نتقي الله ونعمل لذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا * السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ (17، 18).
• أن نتذكر الآخرة، ولا نغفل عنها: ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (19).
• أن نحرص على قراءة ورد القرآن مهما كانت الظروف، من مرض وسفر وجهاد: ﴿...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ...﴾ (20).
• أن ننفق شيئًا من أموالنا ولو كان قليلًا، نقدمه لأنفسنا يوم لقاء الله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ (20).
• أن نتيقن أن كل ما نقدمه من أعمال الخير مستنسخ في كتبنا؛ فنخلص عبادتنا لله تعالى، ونكثر من الاستغفار على التقصير؛ فالله غفور رحيم: ﴿...وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (20).
تمرين حفظ الصفحة : 574
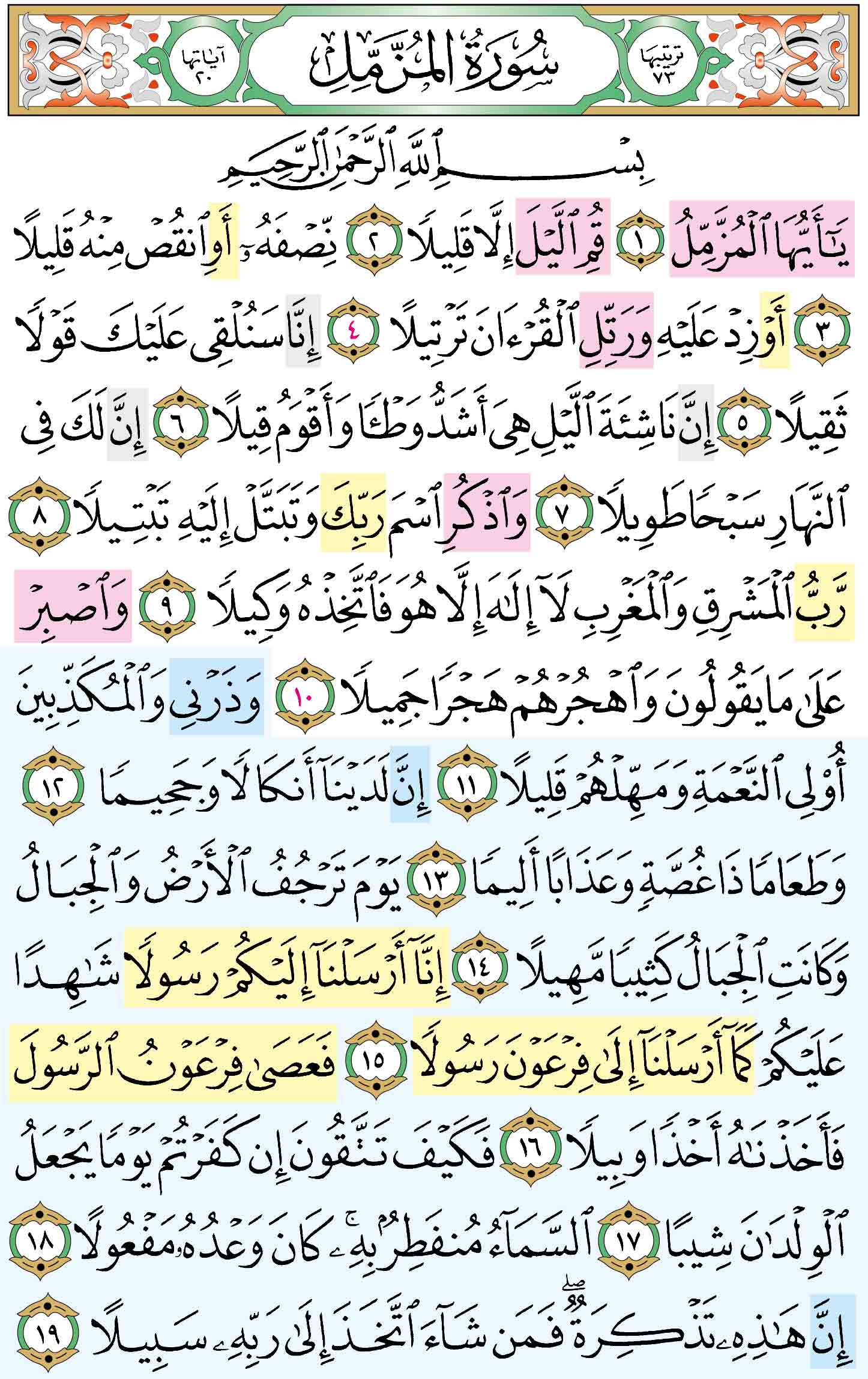
مدارسة الآية : [1] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾
التفسير :
المزمل:المتغطي بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال [وحيه بإرسال] جبريل إليه، فرأى أمرا لم ير مثله، ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون، فاعتراه في ابتداء ذلكانزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله، فقال:"زملوني زملوني "وهو ترعد فرائصه، ثم جاءه جبريل فقال:"اقرأ "فقال:"ما أنا بقارئ "فغطه حتى بلغ منه الجهد، وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات، وتابع عليه الوحي، حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين.
فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها، ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره.
فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه، ثم أمره بالصدع بأمره، وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات، وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
تفسير سورة المزمل
مقدمة وتمهيد
1- سورة «المزمل» هي السورة الثالثة والسبعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فهي السورة الثالثة أو الرابعة، إذ يرى بعضهم أنه لم يسبقها في النزول سوى سورتي العلق والمدثر، بينما يرى آخرون أنه لم يسبقها سوى سور العلق، ونون، والمدثر.
وعدد آياتها عشرون آية عند الكوفيين، وتسع عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة آية عند الحجازيين.
2- وجمهور العلماء على أن سورة «المزمل» من السور المكية الخالصة، فابن كثير- مثلا- عند تفسيره لها قال: تفسير سورة «المزمل» ، وهي مكية.
وحكى بعضهم أنها مكية سوى آيتين، فقد قال القرطبي: مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: هي مكية إلا آيتين منها، وهما قوله- تعالى-: وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ....
وقال الثعلبي: هي مكية إلا الآية الاخيرة منها وهي قوله- تعالى-: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ.... فإنها نزلت بالمدينة .
وقال الشيخ ابن عاشور ما ملخصه: وقال في الإتقان: إن استثناء قوله- تعالى-:
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ ... إلى آخر السورة، يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنها قالت: نزلت هذه الآية بعد نزول صدر السورة بسنة ...
ثم قال الشيخ ابن عاشور: وهذا يعنى أن السورة كلها مكية، والروايات تظاهرت على أن هذه الآية قد نزلت منفصلة عما قبلها، بمدة مختلف في قدرها، فعن عائشة أنها سنة ... ومن قال بأن هذه الآية مدنية، يكون نزولها بعد نزول ما قبلها بسنين ...
والظاهر أن هذه الآية مدنية، لقوله- تعالى-: ... وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ومن المعروف أن القتال لم يفرض إلا في المدينة- إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على وجه المعجزة .
3- والسورة الكريمة: زاخرة بالحديث الذي يدخل التسلية والصبر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلى من شأن القرآن الكريم، ويرشد المؤمنين إلى ما يسعدهم ويصلح بالهم، ويهدد الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم، ويذكّر الناس بأهوال يوم القيامة ...
ويسوق لهم ألوانا من يسر شريعته ورأفته- عز وجل- بعباده، وإثابتهم بأجزل الثواب على أعمالهم الصالحة.
وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه السورة الكريمة روايات منها ما رواه البزار والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل عن جابر- رضى الله عنه- قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما تصدوا الناس عنه فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر ...
فتفرق المشركون على ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل فقرأ عليه: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ....
وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم كان نائما بالليل متزملا في قطيفة ... فجاءه جبريل بقوله- تعالى- يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا....
وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، هبطت، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ... فرفعت رأسى فإذا الذي جاءني بحراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض ... فرجعت فقلت: دثروني دثروني، وفي رواية: فجئت أهلى فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله- تعالى-: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ... .
وجمهور العلماء يقولون: وعلى أثرها نزلت: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ....
والْمُزَّمِّلُ: اسم فاعل من تزمل فلان بثيابه، إذا تلفف فيها، وأصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاى والميم.
وافتتح الكلام بالنداء للتنبيه على أهمية ما يلقى على المخاطب من أوامر أو نواه.
وفي ندائه صلى الله عليه وسلم بلفظ «المزمل» تلطف معه، وإيناس لنفسه، وتحبب إليه، حتى يزداد نشاطا، وهو يبلغ رسالة ربه.
والمعنى: يا أيها المتزمل بثيابه، المتلفف فيها، رهبة مما رآه من عبدنا جبريل. أو هما وغما مما سمعه من المشركين، من وصفهم له بصفات هو برىء منها.
تفسير سورة المزمل وهي مكية
قال الحافظ أبو بكر [ أحمد ] بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي ، حدثنا معلى بن عبد الرحمن ، حدثنا شريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سموا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه ، فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهن . قالوا : مجنون . قالوا : ليس بمجنون . قالوا : ساحر . قالوا : ليس بساحر ، فتفرق المشركون على ذلك ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فتزمل في ثيابه وتدثر فيها ، فأتاه جبريل ، عليه السلام ، فقال : " يا أيها المزمل " " يا أيها المدثر " .
ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم ، واحتملوا حديثه ، لكن تفرد بأحاديث لا يتابع عليها .
يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل ، وهو : التغطي في الليل ، وينهض إلى القيام لربه عز وجل ، كما قال تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ) [ السجدة : 16 ] وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل ، وقد كان واجبا عليه وحده ، كما قال تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 79 ] وهاهنا بين له مقدار ما يقوم ، فقال تعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا )
قال ابن عباس والضحاك والسدي : ( يا أيها المزمل ) يعني : يا أيها النائم . وقال قتادة : المزمل في ثيابه ، وقال إبراهيم النخعي : نزلت وهو متزمل بقطيفة .
وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( يا أيها المزمل ) قال : يا محمد زملت القرآن .
يعني بقوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) هو الملتفّ بثيابه. وإنما عني بذلك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم.
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من التزمُّل، فقال بعضهم: وصفه بأنه مُتَزمل في ثيابه، متأهب للصلاة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) أي المتزمل في ثيابه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) هو الذي تزمل بثيابه.
وقال آخرون: وصفه بأنه متزمِّل النبوّة والرسالة.
* ذكر من قال ذلك:
التدبر :
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما: الملاطفة؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ كل ما أخافك وأحزنك استعن على ذهابه أو تخفيفه بقيام الليل، فهذا رسول الله التف بثيابه من الرعب.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أول درس يتعلمه حملة الدين هو وجوب الانتقال من وضع الاسترخاء إلى حالة التأهب والجاهزية.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قيام الليل ذهاب المخاوف.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ذهاب مخاوفك وتقوية عزائمك في قيام الليل.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الله يعلم أنك ستترك فراشك ولحافك الذي تحبه حين تقوم لتصلي، تأمل كيف ناداه بوصف التزمل.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] وظيفة الليل الشحن الإيماني، ووظيفة النهار تفريغ تلك الشحنة.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] تلك الكلمات الدعوية الهامدة الميّتة في النهار لن تبعث في قلب مستمعها ولا قائلها الحياة إلا بمدد إلهي يُروّي قلبه في الليل.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] ويسئلونك عن الفتور الحل في الآية الأولى، ويسئلونك عن موت الدعوة الحل في الآية الثانية.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] الدعوة ستبقى في قائمة الاحتضار ما لم تُحضّرك الملائكة في سجلِّ قوَّام الليل.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] لن تزول المخاوف النفسية بمثل جرعة ليلية بالسجود، ومواجهة دعوية لجماهير الناس.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] الآية الأولى تصنع توازن نفسي وتزكوي في القلب حال تسلل فيروسات شيطانية أثناء الدعوة، قد يدخلك الكبر أو العجب أو الحسد أثناء الدعوة بقيام الليل يكون هناك جدار مسلّح حول القلب تصد هذه الانقلابات الشيطانية والتقلبات النفسية.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لِمَ؟ ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [5]، ما استعين على تبليغ الدين بمثل قيامٍ في الليل وإن قلَّ.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ سورة المزمل سورة بناء روح الداعية إلى الله، توحيد وإخلاص وذكر وقيام وتبتل وصبر على الأذى.
وقفة
[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الداعية إلى الله إنسان نشيط لا يعرف التكاسل، فهو قائم بالليل لربه يصلِّي وقائم في النهار بالدعوة إلى الله تعالى.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ: ﴾
- أداة نداء. أي منادى مبني على الضم في محل نصب.و«ها» ضمير للتنبيه زائدة. المزمل: صفة- نعت- لأي لأن الكلمة مشتقة.والمنادى مرفوع بالضمة اتباعا للفظ «أي» لا لمحلها. وأصله المتزمل. أدغمت التاء في الزاي ونحوه المدثر في «المتدثر» أي أيها المتلفف بالثوب.وهو الرسول الكريم ولم يخاطب باسمه نداء إكراما له وتشريفا'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بتوجيه النداء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو في باكورة الدعوة، فتؤانسه وتلاطفه، وتنبه النُّوام إلى قيام الليل، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
المزمل:
1- بشد الزاى وكسر الميم المشددة، أصله: المتزمل، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- المتزمل، على الأصل، وهى قراءة أبى.
3- بتخفيف الزاى وكسر الميم، وهى قراءة عكرمة.
4- بتخفيف الزاى وفتح الميم، أي: الذي لف، وهى قراءة لبعض السلف.
مدارسة الآية : [2] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾
التفسير :
ومن رحمته تعالى، أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال:{ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} .
قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أى: قم الليل متعبدا لربك، إِلَّا قَلِيلًا منه، على قدر ما تأخذ من راحة لبدنك، فقوله: إِلَّا قَلِيلًا استثناء من الليل ...
يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل ، وهو : التغطي في الليل ، وينهض إلى القيام لربه عز وجل ، كما قال تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ) [ السجدة : 16 ] وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل ، وقد كان واجبا عليه وحده ، كما قال تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 79 ] وهاهنا بين له مقدار ما يقوم ، فقال تعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا )
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن عكرِمة، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) قال: زُملت هذا الأمر فقم به.
قال أبو جعفر: والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك، ما قاله قتادة؛ لأنه قد عقبه بقوله: ( قُمِ اللَّيْلَ ) فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمُّل بالثياب للصلاة، وأن ذلك هو أظهر معنييه.
وقوله: ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قُمِ اللَّيْلَ ) يا محمد كله ( إِلا قَلِيلا ) منه ( نِصْفَهُ ) يقول: قم نصف الليل ( أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) يقول: أو زد عليه؛ خَيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء فعل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما ذُكر يقومون الليل، نحو قيامهم في شهر رمضان فيما ذُكر حتى خفف ذلك عنهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أُسامة، عن مِسْعَرٍ، قال: ثنا سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عباس يقول: لما نـزل أوّل المزمل، كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في رمضان، وكان بين أوّلها وآخرها قريب من سنة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا محمد بن بشر، عن مِسْعَرٍ، قال: ثنا سماك، أنه سمع ابن عباس يقول، فذكر نحوه. إلا أنه قال: نحوا من قيامهم في شهر رمضان.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يزيد بن حيان، عن موسى بن عبيدة، قال: ثني محمد بن طَحْلاء مولى أمّ سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس، فاجتمعوا، فخرج كالمغضَب، وكان بهم رحيما، فخشي أن يُكتب عليهم قيام الليل، فقال: " يا أيُّها النَّاسُ اكْلفُوا مِنَ الأعْمالِ ما تُطِيقُونَ، فإنّ الله لا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ العَمَلِ وخَيْرُ الأعْمال ما دُمْتُمْ عَلَيْه " ونـزل القرآن: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن موسى بن عبيدة الحميري، عن محمد بن طحلاء، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كنت أشتري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا، فكان يقوم عليه من أوّل الليل، فتسمع الناس بصلاته، فاجتمعت جماعة من الناس؛ فلما رأى اجتماعهم كره ذلك، فخشي أن يكتب عليهم، فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتنحنحون ويتسعَّلون حتى خرج إليهم، فقال: " يا أيُّها النَّاس إنَّ الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا - يعنى من الثواب - فاكْلُفوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُون فإنَّ خَيَْر العَمَلِ أدْوَمُهُ وَإنْ قَلَّ" ,ونـزلت عليه: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ &; 23-679 &; اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) السورة قال: فكتبت عليهم، وأنـزلت بمنـزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به؛ فلما رأى الله ما يكلفون مما يبتغون به وجه الله ورضاه، وضع ذلك عنهم، فقال: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ... إلى عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فردّهم إلى الفريضة، ووضع عنهم النافلة، إلا ما تطوّعوا به.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[2] تأمل العلاقة الوثيقة بين الليل وبين القرآن: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾، فهل تقضي ليلك مع القرآن تاليًا متدبرًا؟
عمل
[2] ﴿قم الليل إلا قليلا﴾، ﴿قم فأنذر﴾ [المدثر: 2] المهمات العظيمة لا مكان فيها للقعود والكسل، قُم وانشَط وتحرَّك وأنجِز.
عمل
[2] ﴿قم الليل إلا قليلا﴾ من أراد سلوك الجادة النبوية؛ فليطرح الكسل والقعود والنوم والبطالة.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إذا أردتَ أمرًا واستُصعب عليك؛ قمِ الَّليلَ، وتحدث مع ربِّك سِرًّا، فهوُ يَسمعك ولن يُخيِّبَك أبدًا.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ شرع قيام الليل قبل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود؛ لأن القلب إذا زكي هانت عليه العبادات والأوامر والنواهي.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ركعة تطلب فيها ما تريد، قد تصبح غدًا وأنت تملك ما تريد.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ركعة يركعها العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الليل هو الوقت الأنسب لشحن نفسك بمعاني الإيمان، حيث تقل المشتتات، وتذبل الملهيات، ويتيقظ شيء في النفس ينظر إلى السماء.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ مع الله كل ساعة لها لذة ونشوة وحكاية.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ السجود بين يدي الله راحة للنفوس تتخللها مغفرة واستجابة.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إن الذي لا تلتهب مواجيده بأشواق التهجد؛ لا يكون من أهل سورة المزمل حقًّا.
وقفة
[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ كل مشروع للنهضة والإصلاح لا يبدأ بالصلاة فهو إلى الفشل.
وقفة
[2] إذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة تسبيحًا، فقد دل ذلك على وجوب التسبيح، كما أنه لما سماها قيامًا في قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ دل على وجوب القيام، وكذلك لما سماها قرآنًا في قوله تعالى: ﴿ﱤ ﱥ﴾ [الإسراء: 78]، دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها ركوعًا وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها.
وقفة
[2] كيف يقوم بمهمَّة قم فأنذر من لم يقم بعبء: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؟!
وقفة
[2] قال أحد الفضلاء: الداعية بين قيامين: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، و﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 2] والأول زادٌ للثاني.
الإعراب :
- ﴿ قُمِ اللَّيْلَ: ﴾
- فعل أمر مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الليل: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي أقم صلاة الليل. فحذف المفعول المضاف وحل المضاف اليه محله.
- ﴿ إِلَّا قَلِيلًا: ﴾
- أداة استثناء، قليلا: مستثنى بالإ من «الليل» منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي إلا قليلا منه. أو مستثنى من «النصف» لأن «النصف» بدل من «الليل» بمعنى: قم أقل من نصف الليل وحذفت واو «قوم» لالتقاء الساكنين وتخفيفا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كان المُزَّمِّلُ عادةً ما يكونُ جالسًا أو مُضطجِعًا؛ أمره بالقيام، فقال تعالى:
﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
قم:
1- بكسر الميم، على أصل التقاء الساكنين، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بضمها، اتباعا للحركة من القاف، وهى قراءة أبى السمال.
3- بفتحها، طلبا للتخفيف.
مدارسة الآية : [3] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾
التفسير :
ثم قدر ذلك فقال:{ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ} أي:من النصف{ قَلِيلًا} بأن يكون الثلث ونحوه.
وقوله نِصْفَهُ بدل من قَلِيلًا بدل كل من كل، على سبيل التفصيل بعد الإجمال أى: قم نصف الليل للعبادة لربك، واجعل النصف الثاني من الليل لراحتك ونومك ...
ووصف- سبحانه- هذا النصف الكائن للراحة بالقلة فقال إِلَّا قَلِيلًا للإشعار بأن النصف الآخر، العامر بالعبادة والصلاة ... هو النصف الأكثر ثوابا وقربا من الله- تعالى- بالنسبة للنصف الثاني المتخذ للراحة والنوم.
وقوله تعالى "نصفه" بدل من الليل "أو أنقص منه قليلا أو زد عليه" أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشقّ ذلك على المؤمنين، ثم خفَّف عنهم فرحمهم، وأنـزل الله بعد هذا: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ ... إلى قوله: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فوسع الله وله الحمد، ولم يضيق.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: لما أنـزل الله على نبيه: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) قال: مكث النبيّ صلى الله عليه وسلم على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنـزل الله عليه بعد عشر سنين: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ... إلى قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ فخفَّف الله عنهم بعد عشر سنين.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح عن الحسين، عن يزيد، عن عكرِمة والحسن، قالا قال في سورة المزمل ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) نسختها الآية التي فيها: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنـزل الله تخفيفا بعد في آخر السورة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن قيس بن وهب، عن أبي عبد الرحمن، قال: لما نـزلت: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) قاموا بها حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نـزلت: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فاستراح الناس.
&; 23-680 &;
قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جرير بياع المُلاء عن الحسن، قال: الحمد لله تطوّع بعد فريضة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن، قال: لما نـزلت ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ )... الآية، قام المسلمون حولا فمنهم من أطاقه، ومنهم من لم يطقه، حتى نـزلت الرخصة.
قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: لما نـزل أوّل المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أوّلها وآخرها نحو من سنة.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[3] ﴿نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ أي نصف الليل بدلًا من الليل كله، أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلث، فكان قيام الليل واجبًا على النبي ﷺ، وكان مخيَّرًا ما بين ثلث الليل إلى نصفه.
وقفة
[3، 4] ﴿نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ إن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: (أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا)، وأطلق في الزيادة فقال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾، ولم يقل: «قليلًا» فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص؛ فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا.
الإعراب :
- ﴿ نِصْفَهُ: ﴾
- بدل من «الليل» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: قم أقل من نصف الليل ويجوز أن تكون «نصف» بدلا من «قليلا» أو يحتمل أن تكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره. قم نصفه.
- ﴿ أَوِ انْقُصْ: ﴾
- معطوفة بأو للتخيير على «قم» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل السكون الظاهر على آخره وكسر واو «أو» لالتقاء الساكنين.
- ﴿ مِنْهُ قَلِيلًا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بانقص. قليلا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَه بقيامِ الليلِ إِلَّا قَلِيلًا؛ فَسَّرَ هنا هذا القليل، قال تعالى:
﴿ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ .. ﴾
التفسير :
{ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} أي:على النصف، فيكون الثلثين ونحوها.{ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له،
وقوله- سبحانه-: أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ... تخيير له صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، وإظهار لما اشتملت عليه شريعة الإسلام من يسر وسماحة ...
فكأنه- تعالى- يقول له على سبيل التلطف والإرشاد إلى ما يشرح صدره- يا أيها المتلفف بثيابه، قم الليل للعبادة والصلاة، إلا وقتا قليلا منه يكون لراحتك ونومك، وهذا الوقت القليل المتخذ للنوم والراحة قد يكون نصف الليل، أو قد يكون أقل من النصف بأن يكون في حدود ثلث الليل، ولك- أيها الرسول الكريم- أن تزيد على ذلك، بأن تجعل ثلثى الليل للعبادة، وثلثه للنوم والراحة ...
فأنت ترى أن الله- تعالى- قد رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يجعل نصف الليل أو ثلثه، أو ثلثيه للعبادة والطاعة. وأن يجعل المقدار الباقي من الليل للنوم والراحة ...
وخص- سبحانه- الليل بالقيام، لأنه وقت سكون الأصوات ... فتكون العبادة فيه أكثر خشوعا، وأدعى لصفاء النفس، وطهارة القلب، وحسن الصلة بالله- عز وجل-.
هذا، وقد استمر وجوب الليل على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد فرض الصلوات الخمس عليه وعلى أمته. تعظيما لشأنه، ومداومة له على مناجاة ربه، خصوصا في الثلث الأخير من الليل، يدل على ذلك قوله- تعالى-: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً .
وقد كان المسلمون يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وقد أثنى- سبحانه- عليهم بسبب ذلك في آيات كثيرة منها قوله- تعالى-: تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ .
وقد ذكر الإمام أحمد حديثا طويلا عن سعيد بن هشام، وفيه أنه سأل السيدة عائشة عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت له: ألست تقرأ هذه السورة، يا أيها المزمل ... ؟.
إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله ختامها في السماء اثنى عشر شهرا. ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة.. .
قال القرطبي ما ملخصه: واختلف: هل كان قيام الليل فرضا وحتما، أو كان ندبا وحضا؟ والدلائل تقوى أن قيامه كان حتما وفرضا، وذلك أن الندب والحض، لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت.
واختلف- أيضا- هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء؟ أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال ... أصحها ثالثها للحديث المتقدم الذي رواه سعيد بن هشام عن عائشة- رضى الله عنها- .
وقال بعض العلماء بعد أن ساق أقوال العلماء في هذه المسألة بشيء من التفصيل: والذي يستخلص من ذلك أن أرجح الأقوال، هو القول القائل بأن التهجد كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، إذ هو الذي يمكن أن تأتلف عليه النصوص القرآنية، ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرهما.
ويرى بعض العلماء أن وجوب التهجد باق على الناس جميعا، وأنه لم ينسخ، وإنما الذي نسخ هو وجوب قيام جزء مقدر من الليل، لا ينقص كثيرا عن النصف..
ويرد على هذا القول بما ثبت في الصحيحين، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عما يجب عليه من صلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل على غيرها؟
قال: لا إلا أن تطوع» .
ويرى فريق آخر: أن قيام الليل نسخ عن الرسول وعن أمته بآخر سورة المزمل.
واستبدل به قراءة القرآن، على ما يعطيه قوله- تعالى- عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ويدل عليه- أيضا- ظاهر ما روى عن عائشة، من قولها:
فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة، دون أن تقيد ذلك بقيد.
ويرى فريق ثالث: أن وجوب التهجد استمر على النبي وعلى الأمة، حتى نسخ بالصلوات الخمس ليلة المعراج.
ويرى فريق رابع: أن قيام الليل نسخ عن الأمة وحدها، وبقي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعطيه ظاهر آية الإسراء.
ولعل أرجح هذه الأقوال هو القول الرابع.. فإن آية سورة الإسراء وهي قوله- تعالى-: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ... تدل على أن وجوب التهجد قد بقي عليه صلى الله عليه وسلم .
وقوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إرشاد له صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى أفضل طريقة لقراءة القرآن الكريم، حتى يستمروا عليها، وهم في أول عهدهم بنزول القرآن الكريم.
والترتيل: جعل الشيء مرتلا، أى: منسقا منظما، ومنه قولهم: ثغر مرتل، أى: منظم الأسنان، لم يشذ بعضها عن بعض ...
أى: قم- أيها الرسول الكريم- الليل إلا قليلا منه ... متعبدا لربك مرتلا للقرآن ترتيلا جميلا حسنا، تستبين معه الكلمات والحروف، حتى يفهمها السامع، وحتى يكون ذلك أعون على حسن تدبره، وأثبت لمعانيه في القلب ...
قال الإمام ابن كثير: وكذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها ... وسئل أنس عن قراءته صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ...
وقال صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم» .
وقال عبد الله بن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذّ الشّعر وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب - أى لا تسرعوا في قراءته كما تسرعوا في قراءة الشعر. والهذ: سرعة القطع- هذا، وليس معنى قوله- سبحانه-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، أن يقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن، ويخل بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء، ومخارج الحروف، والغن والمد، والإدغام والإظهار ... وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم.
وإنما معنى قوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أن يقرأه بصوت جميل وبخشوع وتدبر، وبالتزام تام للقراءة الصحيحة، من حيث مخارج الحروف ومن حيث الوقف والمد والإظهار والإخفاء، وغير ذلك ...
وقد بسط القول في هذه المسألة بعض العلماء فارجع إليه إن شئت .
وقوله : ( ورتل القرآن ترتيلا ) أي : اقرأه على تمهل ، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره . وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه ، قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها ، حتى تكون أطول من أطول منها . وفي صحيح البخاري ، عن أنس : أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : كانت مدا ، ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يمد " بسم الله " ، ويمد " الرحمن " ، ويمد " الرحيم " .
وقال ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة : أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها " .
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة ، كما جاء في الحديث : " زينوا القرآن بأصواتكم " ، و " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " ، و " لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود " يعني : أبا موسى ، فقال أبو موسى : لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا .
وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . رواه البغوي .
وقال البخاري : حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا عمرو بن مرة : سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة ، فقال : هذا كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين في ركعة .
وقوله: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) يقول جلّ وعزّ: وبين القرآن إذا قرأته تبيينا، وترسل فيه ترسلا.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال. ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: ثنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: اقرأه قراءة بينة.
حدثنا ابن بشار، قال. ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فقال: بعضه على أثر بعض.
حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي، قال. ثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فقال: بعضه على أثر بعض، على تؤدة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله الله ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: ترسل فيه ترسلا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فقال: بعضه على أثر بعض.
حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: ثنا حجاج بن محمد، قال، قال ابن جريج، عن عطاء ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: الترتيل النَّبْذ: الطَّرْح.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال بينه بيانا.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: بيِّنه بيانا.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: بعضه على أثر بعض.
التدبر :
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك مُعينٌ على التفكر في معاني القرآن، بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول، وكان رسول الله ﷺ يُقَطِّع قراءته حرفًا حرفًا، ولا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمرُّ بآية عذاب إلا وقف وتعوَّذ.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ في هذه دليل على أنه لا بد للقارئ من الترتيل؛ لتقع قراءته عن حضور القلب، وذكر المعاني، فلا يكون كمن يعثر على كنز من الجواهر عن غفلة وعدم شعور.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ والحكمة في الترتيل: التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله، وبعكس هذا فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ إنما أمره بالترتيل؛ لأن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ حين توهنك الأعباء والمهمات الثقيلة رتل القران، سيعينك الله.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ كَانَتْ قِرَاءةُ الفُضَيْل بن عِيَاض حَزِيْنَةً، شَهِيَّةً، بَطِيئَةً، مُتَرسِّلَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ يُرَدِّدُ فِيْهَا.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ أمر الله نبيه ﷺ في بداية سورة المزمل بترتيل القرآن في قيام الليل، وهي دعوة لتدبر القرآن، إذ لا يخفى عظم أثر الترتيل في إحداث التدبر، خصوصًا في ظلمة الليل، حيث السكون، وحضور القلب، والاعتبار.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال ابن عباس: «لئن اقرأ سورة ارتلها أحب إليَ من أن أقرأ القرآن كله».
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال عبد الله بن مسعود: «لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ»، أي لا تسرعوا في قراءته.
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال مجاهد: «أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه».
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال الرازي: «أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف، وحينئذ يستنير القلب بنور معرفة الله، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني؛ لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية الروحانية، ومن ابتهج بشيء أحب ذكره، ومن أحب شيئًا لم يمر عليه بسرعة، فظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة».
وقفة
[4] ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا» [الترمذي 2914، قال الألباني: حسن صحيح]، قالَ ابنُ حجر الهيتمي: «الخبرُ المذكورُ خاصٌّ بمن يحفظُه عن ظهرِ قلبٍ، لا بمن يقرأُ بالمصحف»، وهل في الآخرةِ مصاحف يقرأُ منها أحدٌ؟!
وقفة
[4] ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ قال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ: «كَانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزِينَةً شَهِيَّةً بَطِيئَةً مُتَرَسِّلَةً, كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا, وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ تَرَدَّدَ فِيهَا وَسَأَلَ» [سير أعلام النبلاء 8/427].
عمل
[4] أكرِموا حفظة القرآن؛ فوالله إن الخير فيهم كثير، وإن الله يُعِز من أكرم حافظًا للقرآن، وساهم بتعليمه، وسهَّل له السُّبل ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
عمل
[4] حتى يرق قلبك؛ ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ أي: تمهل وفرِّق بين الحروف لتبين، والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر، وفهم المعاني، وبذلك يرق القلب، ويفيضت عليه النور والرحمة.
عمل
[4] رتِّل عشر آيات لهذا اليوم وذلك بإتقان التجويد، وتعلم مواطن الوقوف فيها ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
وقفة
[4] علمنا القرآن أن من سنن قراءة قيام الليل: ترتيل القرآن، تأمل قوله في سورة المزمل: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، بعد أمره بقوله قم الليل.
وقفة
[4] قراءة القرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمُّل الشدائد ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
وقفة
[4] تلاوتك للقرآن بتدبُّر تعينك على ضغوطات الحياة ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
عمل
[4] رتِّل عشر آيات لهذا اليوم، وذلك بإتقان التجويد، وتعلم مواطن الوقوف فيها ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾.
عمل
[4] أخي إمام المسجد: لا يكن همك آخر السورة، اقرأ قراءة مترسلة هادئة شهية بتدبر وتمهل ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾.
وقفة
[4] قال الحسن البصري: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقرأ آية ويبكي ويرددها، فقال: « ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾، قال: هذا الترتيل».
وقفة
[4] ما الفرق البياني بين مفردات القراءة في القرآن الكريم: وهي القراءة والتلاوة والترتيل؟ القراءة قد تكون بكلمة واحدة أو لحرف واحد، قد تقرأ هذا الحرف، التلاوة لا تكون إلا لكلمتين وصاعدًا، التلاوة شيء يتلو شيئًا، تلا يأتي خلفه، أما الترتيل فهو التبين والتحقيق، يتبين الحروف، الاستقامة في إخراجها، يتحقق في إخراجها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ يجوِّده ويحسِّنه، بصورة سليمة، يبين الكلمات والحروف يحقق مخارجها.
عمل
[2-4] احرص على قيام هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
عمل
[2-4] احرص على الصلة بالله في كل وقت ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
وقفة
[4، 5] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ حين توهنك الأعباء والمهمات الثقيلة؛ رتل القرآن، سيعينك الله.
وقفة
[4، 5] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ قد تخاف وترعب قبل بدئك بمشروع عظيم، ما عليك إلا التزود من قيام الليل والتبتل لربك، والتوكل عليه والصبر.
وقفة
[4، 5] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ لماذا هدأ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول البعثة؟ أول ما تلقى الوحي كان الأمر ثقيلًا عليه، كان بحاجة لأن يهدأ وترتاح نفسه من العبء الثقيل الذي لم يتعوده، ثم بعد ذلك وخلال هذه الفترة اشتاقت نفسه لحلاوة الوحي التي ذاقها أول الأمر، فكانت فترة التوقف تهيئة لنفسه لتلقي الوحي بعد ذلك، فجاء هينًا لينًا عليه.
الإعراب :
- ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ: ﴾
- معطوفة بأو للتخيير على «أو انقص» وتعرب اعرابها.
- ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ: ﴾
- الواو عاطفة. رتل القرآن: تعرب اعراب «قُمِ اللَّيْلَ» في الاية الثانية. أي وأحسن قراءة القرآن على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف واشباع الحركات.
- ﴿ تَرْتِيلًا: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- فيه معنى التاكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا فَسَّرَ هذا القليل؛ رَغَّبَ هنا في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل، قال تعالى:أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وبعد أن أمَرَه بقيامِ الليلِ؛ أمَرَه بترتيل القرآن، قال تعالى:
﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾
التفسير :
{ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} أي:نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي:العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف، حقيق أن يتهيأ له، ويرتل، ويتفكر فيما يشتمل عليه.
وقوله - تعالى - ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ) تعليل للأمر بقيام الليل ، وهو كلام معترض بين قوله- سبحانه- قُمِ اللَّيْلَ ... وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ.....
والمراد بالقول الثقيل: القرآن الكريم الذي أنزله- سبحانه- على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم.
ويشهد لثقل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الإمام البخاري من أن السيدة عائشة قالت: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم «ما من مرة يوحى إلى، إلا ظننت أن نفسي تفيض» - أى:
تخرج ...
ومنها قول زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن- وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي- أى: تتكسر ...
ومنها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحى عليه وهو على ناقته، وضعت جرانها- أى باطن عنقها- فما تستطيع أن تتحرك، حتى يسرّى عنه .
أى: قم- أيها الرسول الكريم- الليل إلا قليلا منه متعبدا لربك، متقربا إليه بألوان الطاعات، فإنا سنلقى عليك قولا ثقيلا، وهذا القول هو القرآن الكريم، الثقيل في وزنه وفي ميزان الحق، وفي أثره في القلوب، وفيما اشتمل عليه من تكاليف، وصدق الله إذا يقول:
لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ...
قال الجمل: قوله: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا أى: كلاما عظيما جليلا ذا خطر وعظمة، لأنه كلام رب العالمين، وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل.
أو هو ثقيل لما فيه من التكاليف، والوعد والوعيد، والحلال والحرام، والحدود والأحكام.
قال قتادة: ثقيل والله في فرائضه وحدوده ... وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين، لأنه يهتك أسرارهم ... وقال السدى: ثقيلا بمعنى كريم، مأخوذ من قولهم: فلان ثقل علىّ، أى كرم على ... وقال ابن المبارك: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا، ثقل في الميزان يوم القيامة.
وقيل: ثقيلا بمعنى أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده ومعانيه، فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته. والفقهاء بحثوا في أحكامه ... والأولى أن جميع هذه المعاني فيه.
وقيل: المراد بالقول الوحى، كما في الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحى إليه، وهو على ناقته وضعت جرانها- أى: وضعت صدرها على الأرض- فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه ....
ويبدو لنا أن وصف القرآن بالثقل وصف حقيقى، لما ثبت من ثقله على النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزوله عليه ... وهذا لا يمنع أن ثقله يشمل ما اندرج فيه من علوم نافعة، ومن هدايات سامية، ومن أحكام حكيمة، ومن آداب قويمة، ومن تكاليف جليلة الشأن.
وعبر- سبحانه- عن إيحائه بالقرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإلقاء للإشعار بأنه يلقى إليه على غير ترقب منه صلى الله عليه وسلم، بل ينزل إليه في الوقت الذي يريده- سبحانه- وللإشارة من أول الأمر إلى أن ما يوحى إليه شيء عظيم وشديد الوقع على النفس.
وقوله : ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) قال الحسن وقتادة : أي العمل به .
وقيل : ثقيل وقت نزوله ; من عظمته . كما قال زيد بن ثابت : أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي ، فكادت ترض فخذي .
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسمع صلاصيل ، ثم أسكت عند ذلك ، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض " ، تفرد به أحمد .
وفي أول صحيح البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : " أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول " . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا لفظه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ، أخبرنا عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ، فتضرب بجرانها .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته ، وضعت جرانها ، فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه .
وهذا مرسل . الجران : هو باطن العنق .
واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا ، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين .
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) فقال بعضهم: عُنى به إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) قال: العمل به، قال: إن الرجل لَيَهُذُّ (1) السورة، ولكنّ العمل به ثقيل.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) ثقيل والله فرائضه وحدوده.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( ثَقِيلا ) قال: ثقيل والله فرائضه وحدوده.
وقال آخرون: بل عني بذلك أن القول عينه ثقيل محمله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها، فما تستطيع أن تتحرّك حتى يسرَّى عنه " .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) قال: هو والله ثقيل مبارك القرآن، كما ثقل في الدنيا ثَقُل في الموازين يوم القيامة.
وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله ثقيل العمل بحدوده وفرائضه.
------------------------
الهوامش:
(1) الهذ: سرعة القراءة. وهو يهذ القرآن هذًا: إذا أسرع فيع وتابعه. وهذا الحديث سرده (التاج)
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ هذه الجملة معترضة بين الأمر بالقيام والترتيل، وبين التعليل بذكر صفة صلاة الليل، ففيها دليل على أن قيام الليل من أعظم ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة، وهذا شأن الصلاة فرضها ونفلها؛ فإنها مما أمر بالاستعانة به كما قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45].
وقفة
[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ القرآن يحتاج إلى صبر ومصابرة للقيام به والدعوة إليه.
وقفة
[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ هو القرآن، والقرآن ليس ثقيلًا في مبناه، فهو ميسَّر للذكر، لكنه ثقيل في أثره على القلب، فلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، فأنزله الله على قلب أثبت من الجبل يتلقاه.
وقفة
[5] ﴿إِنّا سَنُلقي عَلَيكَ قَولًا ثَقيلًا﴾ رغم ثقل الأمر إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يطالبه بالنوم والراحة بل بالقيام، ففيه الراحة والإعانة.
وقفة
[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ ما اللمسة البيانية في (عليك)؟ (على) للأمور الثقيلة، وهي للاستعلاء ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 216]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ومثلها ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾.
وقفة
[5] سئل مالك عن مسألة، فقال: «لا أدري»، فقال له السائل: «إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أُعلِمَ بها الأمير»، وكان السائل ذا قدر؛ فغضب مالك، وقال: «مسألة خفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾».
وقفة
[5] كلمة ثقيل جاءت بموضعين: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾، ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: 27]؛ لتنجو في اليوم الثقيل تحتاج للقول الثقيل.
وقفة
[5] لن ينجو من تبعه اليوم الثقيل ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: 27] إلا من لزم القول الثقيل ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾.
وقفة
[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً﴾ وصفَ القرآنَ بالثِّقَل، لثِقله بنزول الوحي على نبيِّه، حتى كان يعرَقُ في اليوم الشَّاتي، أو لثقل العمل بما فيه، أو لثقله في الميزان، أو لثقله على المنافقين.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّا: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
- ﴿ سَنُلْقِي عَلَيْكَ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل رفع خبر «ان» السين: حرف تسويف- استقبال- نلقي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. عليك: جار ومجرور متعلق بسنلقي.
- ﴿ قَوْلًا ثَقِيلًا: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثقيلا: صفة- نعت- لقولا منصوبة بالفتحة. و «القول الثقيل» القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي والتكاليف.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَه بقيامِ الليلِ، فكأنَّه قال: إنَّما أمَرْتُك بصلاةِ اللَّيلِ؛ لأنَّا سنُلْقي عليك قولًا ثَقِيلًا، فلا بدَّ أن تَسعى في صَيرورةِ نَفْسِك مُستَعِدَّةً لذلك القَولِ الثَّقيلِ، ولا يَحصُلُ ذلك الاستِعدادُ إلَّا بصلاةِ اللَّيلِ، فالجملةُ كالعلةِ لقيامِ الليلِ؛ فإنَّ الطاعةَ -سيَّما في اللَّيلِ- تُعينُ الرَّجلَ على نوائبِه، وتُسهِّلُ عليه المصائبَ، قال تعالى:
﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ .. ﴾
التفسير :
ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال:{ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} أي:الصلاة فيه بعد النوم{ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} أي:أقرب إلى تحصيلمقصود القرآن، يتواطأ على القرآنالقلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به هذا المقصود.
ثم بين- سبحانه- بعد ذلك الحكمة من أمره له صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة فقال: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلًا.
وقوله: ناشِئَةَ: وصف من النشء وهو الحدوث، وهو صفة لموصوف محذوف.
وقوله: وَطْئاً بمعنى مواطأة وموافقة، وأصل الوطء: وضع الرجل على الأرض بنظام وترتيب، ثم استعير للموافقة، ومنه قوله- تعالى- لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ، ومنه قولهم: وطأت فلانا على كذا، إذا وافقته عليه. وهو منصوب على التمييز. وقوله:
قِيلًا بمعنى قولا.
وقوله: أَقْوَمُ بمعنى أفضل وأنفع.
والمعنى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة. فإن العبادة الناشئة بالليل.
هي أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب، وتهذيب النفس، وأقوم قولا، وأنفع وقعا، وأفضل قراءة من عبادة النهار، لأن العبادة الناشئة بالليل يصحبها ما يصحبها من الخشوع والإخلاص، لهدوء الأصوات بالليل، وتفرغ العابد تفرغا تاما لعبادة ربه.
قال الشوكانى ما ملخصه: قوله: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ... أى: ساعاته وأوقاته، لأنها تنشأ أولا فأولا، ويقال: نشأ الشيء ينشأ، إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشئ ... قال الزجاج: ناشئة الليل، كل ما نشأ منه، أى: حدث منه ... والمراد ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف.
وقيل: إن ناشئة الليل، هي النفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة، أى: تنهض، من نشأ من مكانه، إذا نهض منه.
هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً قرأ الجمهور وَطْئاً بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة، وقرأ بعضهم وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة.
والمعنى على القراءة الأولى: أن الصلاة الناشئة في الليل، أثقل على المصلى من صلاة النهار، لأن الليل للنوم ... ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اشدد وطأتك على مضر» .
والمعنى على القراءة الثانية: أنها أشد مواطأة وموافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان، لانقطاع الأصوات والحركات، ومنه قوله- تعالى-: لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ أى:
ليوافقوا.
وَأَقْوَمُ قِيلًا أى: وأشد مقالا. وأثبت قراءة، لحضور القلب فيها، وهدوء الأصوات، وأشد استقامة واستمرارا على الصواب ... .
وقوله : ( إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ) قال أبو إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : نشأ : قام بالحبشة .
وقال عمر وابن عباس وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد وغير واحد ، يقال : نشأ : إذا قام من الليل . وفي رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر .
والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته ، وكل ساعة منه تسمى ناشئة ، وهي الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان ، وأجمع على التلاوة ; ولهذا قال : ( هي أشد وطئا وأقوم قيلا ) أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار ; لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش .
[ وقد ] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا الأعمش ، أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية : " إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا " فقال له رجل : إنما نقرؤها ( وأقوم قيلا ) فقال له : إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد .
وقوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يعني جلّ وعزّ بقوله: (إن ناشئة الليل): إن ساعات الليل، وكلّ ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل.
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة، قال: قلت لعبد الله بن أبي مليكة: ألا تحدثني أيّ الليل ناشئة ؟ قال: على الثبت سقطت، سألت عنها ابن عباس، فزعم أن الليل كله ناشئة، وسألت عنها ابن الزبير، فأخبرني مثل ذلك.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل، قالوا: نشأ.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) نشأ: قام.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي مَيْسرة ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: نشأ: قام.
قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: إذا قام الرجل من الليل، فهو ناشئة الليل.
حدثنا هناد بن السريّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرِمة، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: هو الليل كله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: إذا قمت الليل فهو ناشئة.
قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: كلّ شيء بعد العشاء فهو ناشئة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: قيام الليل؛ قال: وأيّ ساعة من الليل قام فقد نشأ.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أيّ الليل قمت فهو ناشئة.
قال: ثنا مهران، عن خارجة، عن أبي يونس حاتم بن أبى صغيرة، عن ابن أبي مُلَيكة، قال: سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل فقالا كلّ الليل ناشئة، فإذا نشأت قائما فتلك ناشئة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: أيّ ساعة تَهَجَّدَ فيها متهجد من الليل.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) يعني الليل كله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن أبي عامر الخزاز، ونافع عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: الليل كله.
قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الليل كله إذا قام يصلي فهو ناشئة.
وقال آخرون: بل ذلك ما كان بعد العشاء، فأما ما كان قبل العشاء فليس بناشئة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيميّ، عن أبي مِجْلَز، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: ما بعد العشاء ناشئة.
قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو رجاء، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: ما بعد العشاء الآخرة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: ناشئة الليل: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا أبو هلال، قال، قال قتادة في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: كلّ شيء بعد العشاء فهو ناشئة.
وقوله: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) اختلفت قرّاء الأمصار في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء مكة والمدينة والكوفة ( أَشَدُّ وَطْئًا ) بفتح الواو وسكون الطاء. وقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة ومكة والشام ( وِطاء ) بكسر الواو ومدّ الألف على أنه مصدر من قول القائل: واطأ اللسان القلب مواطأة ووِطاء.
والصواب من القول في ذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
ويعني بقوله: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. وحُكي عن العرب وَطِئنا الليل وطأ: إذا ساروا فيه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من أهل التأويل من قرأه بفتح الواو وسكون الطاء، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) أي أثبت في الخير، وأحفظ في الحفظ.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: القيام بالليل أشدّ وطئا: يقول: أثبت في الخير.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يقول: ناشئة الليل كانت صلاتهم أوّل الليل ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يقول: هو أجدر أن تُحْصُوا ما فرض الله عليكم من القيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: إن مصلي الليل القائم بالليل أشدّ وطئا: طمأنينة أفرغ له قلبا، وذلك أنه لا يَعْرِضُ له حوائج ولا شيء.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يقول: قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار، وأشدّ مواطأة بالليل منه بالنهار.
وأما الذين قرءوا( وِطاءً ) بكسر الواو ومدّ الألف، فقد ذكرت الذي عَنَوْا بقراءتهم ذلك كذلك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور عن مجاهد ( أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: أن تُوَاطئ قلبك وسمعك وبصرك.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: تواطئ سمعك وبصرك وقلبك.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: مُوَاطأة للقول، وفراغا للقلب.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: أجدر أن تواطئ لك سمعك، أن تواطئ لك بصرك.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: أجدر أن تواطئ سمعك وقلبك.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: يواطئ سَمْعُك وبصرك وقلبك بعضه بعضا.
وقوله: ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) يقول: وأصوب قراءة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يحيى بن داود الواسطي، قال: ثنا أبو أُسامة، عن الأعمش، قال: قرأ أنس هذه الآية ( إنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشَدُّ وَطْئًا وأصْوَبُ قِيلا )، فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة إنما هي ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد.
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا عبد الحميد الحماني، عن الأعمش قال: قرأ أنس ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) وأصوب قيلا؛ قيل له: يا أبا حمزة إنما هي ( وَأَقْوَمُ ) قال أنس: أصوب وأقوم وأهيأ واحد.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) يقول: أدنى من أن تفقهوا القرآن.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) : أحفظ للقراءة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس، ولغط الأصوات، وأوقات المعاش.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ إن العبادة التي تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرا في القلب, وأبين قولا; لفراغ القلب من مشاغل الدنيا.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ كان السريُّ السقطي يقول: «رأيتُ الفوائد ترد في ظلام الليل».
وقفة
[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ أي أشدّ تأثيرًا في القلب وإن كانت أثقل على النفس وأتعب للبدن، وأقوم قيلًا، أي أقرب لفهم القرآن لخلو الذهن في جوف الليل، وإقبالهم على ما يقرؤونه.
وقفة
[6] صلاة الليل أعون على تذكر القرآن، والسلامة من النسيان، وأعون على المزيد من التدبر، ولذا قال سبحانه: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾، قال ابن عباس: «﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾: أدنى أن يفقهوا القرآن»، وقال قتادة: «أحفظ للقراءة».
وقفة
[6] رمضان بإطلالته المباركة فرصة ومنحة؛ لأن يُطَهِّر المسلم نفسه بالنهار ليعدها لتلقي هدايات القرآن في قيام الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾، وناشئة الليل: ساعاته، فهي أجمع للقلب على التلاوة، فكأن الصيام في النهار تخلية، والقيام بالقرآن في الليل تحلية.
وقفة
[6] مدارسة جبريل للنبي ﷺ كانت ليلًا، فدلَّ على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلًا، فإن الليل تنقطعُ فيه الشواغلُ، وتجتمعُ فيه الهممُ، ويتواطأ فيه القلبُ واللسانُ على التدبر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾.
عمل
[6] لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك حاجة تتمنى من الله أن يحققها لك لم تسألها بعد ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾.
وقفة
[6] الليل وقت تواطئ القلب واللسان، وقت التبتل لله تعالى، ووقت التزود بالقرآن لمواجهة مصاعب اليوم الذي يليه ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطئا﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ناشئة: اسم «ان» منصوب بالفتحة. الليل: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي النفس التي تنشأ أي تنهض من مضجعها الى العبادة. وقيل هي الساعات الأولى من الليل.
- ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً: ﴾
- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر «ان» هي: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أشد: خبر «هي» مرفوع بالضمة ولم تنون لأنها ممنوعة من الصرف على وزن «أفعل» صيغة تفضيل وبوزن الفعل. وطأ: تمييز منصوب بالفتحة أي أشد ثبات قدم أو أثقل على المصلي من صلاة النهار أو أشد قياما.
- ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا: ﴾
- معطوفة بالواو على «أَشَدُّ وَطْئاً» وتعرب اعرابها. أي وأشد مقالا أو قولا.'
المتشابهات :
| النساء: 46 | ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَقْوَمَ وَلَـٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّـهُ﴾ |
|---|
| البقرة: 282 | ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ |
|---|
| الإسراء: 9 | ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ |
|---|
| المزمل: 6 | ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَ أَقْوَمُ قِيلًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد الأمرِ بقيامِ الليلِ؛ ذكرَ اللهُ هنا الحكمةَ في الأمرِ بقيامِ الليلِ؛ لأن العبادةَ التي تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرًا في القلب؛ لفراغ القلب مِن مشاغل الدنيا، قال تعالى:
﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
وطأ:
قرئ:
1- بكسر الواو وفتح الطاء ممدودا، وهى قراءة الجمهور.
2- بكسر الواو وسكون الطاء والهمزة مقصورا، وهى قراءة قتادة، وشبل، عن أهل مكة.
3- بفتح الواو، ممدودا، وهى قراءة ابن محيصن.
مدارسة الآية : [7] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا .. ﴾
التفسير :
{ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} أي:ترددا على حوائجك ومعاشك، يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام.
وقوله- سبحانه-: إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا تقرير للأمر بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة والتقرب إليه- سبحانه-.
والسبح: مصدر سبح، وأصله الذهاب في الماء والتقلب فيه ثم استعير للتقلب والتصرف المتسع، الذي يشبه حركة السابح في الماء.
أى: إنا أمرناك بقيام الليل للعبادة والطاعة، لأن لك في النهار- أيها الرسول الكريم- تقلبا وتصرفا في مهماتك، واشتغالا بأعباء الرسالة يجعلك لا تستطيع التفرغ لعبادتنا، أما في الليل فتستطيع ذلك لأنه وقت السكون والراحة والنوم.
فالمقصود من الآية الكريمة التخفيف والتيسير عليه صلى الله عليه وسلم وبيان الحكمة من أمره بقيام الليل- إلا قليلا منه- للعبادة، حيث لم يجمع- سبحانه- عليه الأمر بالتهجد في الليل والنهار، وإنما يسر عليه الأمر، فجعله بالليل فحسب، أما النهار فهو لمطالب الحياة: ولتبليغ رسالته- سبحانه- إلى الناس.
ولهذا قال : ( إن لك في النهار سبحا طويلا ) قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم : الفراغ والنوم .
وقال أبو العالية ومجاهد وابن مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري : فراغا طويلا .
وقال قتادة : فراغا وبغية ومنقلبا .
وقال السدي : ( سبحا طويلا ) تطوعا كثيرا .
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ( [ إن لك في النهار ] سبحا طويلا ) قال : لحوائجك ، فأفرغ لدينك الليل . قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها ، وقرأ : ( قم الليل إلا قليلا ) إلى آخر الآية ، ثم قال : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) حتى بلغ : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) [ الليل نصفه أو ثلثه . ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته ] فقال : قال : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 49 ] وهذا الذي قاله كما قاله .
والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا يحيى ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح ، ثم يجاهد الروم حتى يموت ، فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس لكم في أسوة ؟ " فنهاهم عن ذلك ، فأشهدهم على رجعتها ، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر ، فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك . قال : فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها ، فقال : ما أنا بقاربها ; إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا ، فأبت فيهما إلا مضيا ، فأقسمت عليه ، فجاء معي ، فدخلنا عليها فقالت : حكيم ؟ وعرفته ، قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعيد بن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر . قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : ألست تقرأ هذه السورة : ( يا أيها المزمل ) ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو [ ويستغفر ثم ينهض وما يسلم . ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو ] ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ، فتلك تسع يا بني . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض ، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان .
فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها ، فقال : صدقت ، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة .
هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه . وقد أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث قتادة بنحوه .
طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا زيد بن الحباب - وحدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران قالا جميعا ، واللفظ لابن وكيع : عن موسى بن عبيدة ، حدثني محمد بن طحلاء ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل ، فتسامع الناس به فاجتمعوا ، فخرج كالمغضب - وكان بهم رحيما ، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل - فقال : " أيها الناس ، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل ، وخير الأعمال ما ديم عليه " . ونزل القرآن : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق ، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر ، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه ، فرحمهم فردهم إلى الفريضة ، وترك قيام الليل .
ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة ، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة ، وليس كذلك ، وإنما هي مكية . وقوله في هذا السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر - غريب ; فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو أسامة ، عن مسعر ، عن سماك الحنفي ، سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل : أول المزمل ، كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان ، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة .
وهكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة به .
وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر ، عن سماك ، عن ابن عباس : كان بينهما سنة . وروى ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت : ( يا أيها المزمل ) قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ، حتى نزلت : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) قال : فاستراح الناس .
وكذا قال الحسن البصري .
وقال ابن أبي حاتم : [ حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ] عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : فقلت - يعني لعائشة - : أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : ألست تقرأ : ( يا أيها المزمل ) ؟ قلت : بلى . قالت : فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، حتى انتفخت أقدامهم ، وحبس آخرها في السماء ستة عشر شهرا ، ثم نزل .
وقال معمر عن قتادة : ( قم الليل إلا قليلا ) قاموا حولا أو حولين ، حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم ، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر عن سعيد - هو ابن جبير - قال : لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها المزمل ) قال : مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل ، كما أمره ، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه ، فأنزل الله عليه بعد عشر سنين : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) إلى قوله : ( وأقيموا الصلاة ) فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين .
ورواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن عمرو بن رافع ، عن يعقوب القمي به .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا [ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا ] فشق ذلك على المؤمنين ، ثم خفف الله عنهم ورحمهم ، فأنزل بعد هذا : ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ) إلى قوله : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) فوسع الله - وله الحمد - ولم يضيق .
قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن لك يا محمد في النهار فراغا طويلا تتسع به، وتتقلَّب فيه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( سَبْحًا طَوِيلا ) فراغا طويلا يعني النوم.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) قال: متاعا طويلا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( سَبْحًا طَوِيلا ) قال: فراغا طويلا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) قال: لحوائجك، فافُرغ لدينك الليل، قالوا: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله منّ على العباد فخفَّفها ووضعها، وقرأ: قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ... إلى آخر الآية، ثم قال: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ حتى بلغ قوله: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ الليل نصفه أو ثلثه، ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا .
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول في قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) فراغا طويلا. وكان يحيى بن يعمر يقرأ ذلك بالخاء.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد المؤمن، عن غالب الليثي، عن يحيى بن يعمر " من جذيلة قيس " أنه كان يقرأ ( سَبْخًا طَوِيلا ) قال: وهو النوم.
قال أبو جعفر: والتسبيخ: توسيع القطن والصوف وتنفيشه، يقال للمرأة: سبخي قطنك: أي نفشيه ووسعيه؛ ومنه قول الأخطل:
فأرْسَــلُوهُنَّ يُـذْرِينَ الـتَرَابَ كَمَـا
يُـذْرِي سَـبائخَ قُطْـنٍ نَـدْفُ أوْتـارُ (2)
وإنما عني بقوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) : إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك وقومك. والسبح والسبخ قريبا المعنى في هذا الموضع.
------------------------
الهوامش:
(2) البيت للأخطل يذكر الكلاب (اللسان : سبخ) قال : التسبيخ: التخفيف.ويقال : "اللهم سبخ عني الحمى" أي: خففها وسهلها، ولهذا قيل لقطع القطن إذا ندف: سبائخ، ومنه قول الأخطل يذكر الكلاب: "فأرسلوهن.." البيت. وقال الفراء في معاني القرآن (الورقة 346) وقوله: ( إن لك في النهار سبحا طويلا ) يقول: لك في النهار ما تقضي حوائجك. وقد قرأ بعضهم: سبخا، بالخاء، والتسبيخ: توسعة الصوف والقطن وما أشبهه، يقال: سبخي قطنك. قال أبو العباس (ثعلب): سمعت أبا عبد الله (ابن الأعرابي) يقول: حضر أبو زياد الكلابي مجلس الفراء في هذا اليوم، فسأله الفراء عن هذا الحرف، فقال: أهل باديتنا يقولون: اللهم سبخ عنه للمريض والملسوع ونحوه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[7] ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ لا قوة على أعباء النهار دون قيام الليل.
وقفة
[7] ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ النهار فيه شغل عظيم، لا يترك فرصة للخلوة بالنفس، وشغل النبي ﷺ في النهار بالدعوة إلى الله، وتبليغ القرآن، وتعليم الدين، ومحاجة المشركين، وتفقد المؤمنين المستضعفين.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. لك: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم. في النهار: جار ومجرور متعلق باسم «ان» أو متعلق بصفة لسبحا قدم عليه في محل نصب حال.
- ﴿ سَبْحاً طَوِيلًا: ﴾
- اسم «انّ» منصوب بالفتحة. طويلا: صفة- نعت- لسبحا منصوبة مثلها بالفتحة أي فراغا وراحة لنومك فعليك بالتهجد ليلا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن أمرَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بقيامِ الليلِ؛ بَيَّنَ له هنا أن له في النَّهار أعمالاً تشغله، فعليه أن يفرِّغ نفسَه ليلًا لعبادة ربِّه، قال تعالى:
﴿ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ .. ﴾
التفسير :
{ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ} شامل لأنواع الذكر كلها{ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} أي:انقطع إلى الله تعالى، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه، هو الانفصال بالقلب عن الخلائق، والاتصاف بمحبة الله، وكل ما يقرب إليه، ويدني من رضاه.
ثم أمره- سبحانه- بعد ذلك بالمداومة على ذكره ليلا ونهارا فقال: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا.
وقوله- سبحانه-: وَتَبَتَّلْ من التبتل، وهو الاشتغال الدائم بعبادة الله- تعالى-، والانقطاع لطاعته. ومنه قولهم بتل فلان الحبل، إذا قطعه، وامرأة بتول.
أى: منقطعة عن الزواج، ومتفرغة لعبادة الله- تعالى- والمراد به هنا: التفرغ لما يرضى الله- تعالى-، والاشتغال بذلك عن كل شيء سواه.
أى: وداوم- أيها الرسول الكريم- على ذكر الله- تعالى- عن طريق تسبيحه، وتحميده وتكبيره، وتفرغ لعبادته وطاعته تفرغا تاما، دون أن يشغلك عن ذلك شاغل.
وليس المراد بقوله- تعالى-: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا الانقطاع التام عن الأعمال، لأن هذا يتنافى مع قوله- تعالى- قبل ذلك: إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا، وإنما المراد التنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن لا يشغله السبح الطويل بالنهار، عن طاعته- عز وجل- وعن المداومة على مراقبته وذكره.
ومما لا شك فيه أن ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتغال بأمر الدعوة إلى وحدانية الله- تعالى-، ومن تعليم الناس العلم النافع، والعمل الصالح ... كل ذلك يندرج تحت المواظبة على ذكر الله- تعالى-، وعلى التفرغ لعبادته.
وقال- سبحانه- وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ولم يقل تبتلا حتى يكون الفعل موافقا لمصدره، للإشارة إلى أن التبتل والانقطاع إلى الله يحتاجان إلى عمل اختياري منه صلى الله عليه وسلم، بأن يجرد نفسه عن كل ما سوى الله- تعالى-، وبذلك يحصل التبتل الذي هو أثر للتبتيل، بمعنى:
ترويض النفس وتعويدها على العبادة والطاعة.
وقوله : ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ) أي : أكثر من ذكره ، وانقطع إليه ، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك ، وما تحتاج إليه من أمور دنياك ، كما قال : ( فإذا فرغت فانصب ) [ الشرح : 7 ] أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته ، لتكون فارغ البال . قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه .
وقال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي : ( وتبتل إليه تبتيلا ) أي : أخلص له العبادة .
وقال الحسن : اجتهد وبتل إليه نفسك .
وقال ابن جرير : يقال للعابد : متبتل ، ومنه الحديث المروي : أنه نهى عن التبتل ، يعني : الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج .
يقول تعالى ذكره: ( وَاذْكُرْ ) يا محمد ( اسْمُ رَبِّكَ ) فادعه به : ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) يقول: وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره، وهو من قولهم: تبتَّلتُ هذا الأمر؛ ومنه قيل لأمّ عيسى ابن مريم البتول، لانقطاعها إلى الله، ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله: قد تبتل؛ ومنه الخبر الذي رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن التبتُّل ".
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص له إخلاصا.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا يحيى، عن ابن أبي نجيح، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص له إخلاصا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص له إخلاصا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن مجاهد، مثله، إلا أنه قال: أخْلِصْ إليه.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص إليه إخلاصا.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي يحيى المكي، في قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص إليه إخلاصا.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص إليه المسألة والدعاء.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن الحسن، في قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: بَتِّل نفسك واجتهد.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) يقول: أخلص له العبادة والدعوة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، بنحوه.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أخلص إليه إخلاصا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) قال: أي تفرّغ لعبادته، قال: تبتل فحبذا التبتل إلى الله، وقرأ قول الله: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ قال: إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ .
التدبر :
وقفة
[8] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ جاء على التفعيل لسِرٍّ لطيف: فإن في هذا الفعل إيذانًا بالتدريج، والتكلف، والتعمل، والتكثر، والمبالغة.
وقفة
[8] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أي: انقطع له، الله يريدك كلك لأن عنده كل شيء.
وقفة
[8] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أي: انقطع إليه انقطاعًا, فقلب المؤمن يعتكف عند ربه وينقطع إليه, هذا هو التطبيق العملي للعبادة.
وقفة
[8] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ذكر الله يزيل عنك أذى الأعداء، ومن أسـباب النجاة ودفع البلاء.
وقفة
[8] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ كان يقال: «الذكر ذكران: ذكر الله باللسان، وأفضل من ذلك: أن تذكره عند المعصية إذا أشرفت عليها».
وقفة
[8] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ قال بلال بن سعد: «الذكر ذكران: ذكر باللسان حسن جميل، وذكر الله عندما أحلّ وحرّم أفضل».
وقفة
[8] ما أجمل التبتل بكثرة ذكر الله! ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾.
وقفة
[8] ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ التبتل: الانقطاع للعبادة، ومنه سُمِّيَت مريم: البتول؛ لانقطاعها عن الأزواج.
وقفة
[8] ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ قال ابن القيم: «التبتل يجمع أمرين اتصالًا وانفصالًا، لا يصحُّ إلا بهما، فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وانقطاعه عن التفات قلبه إلى ما سوى الله، خوفًا منه، أو رغبة فيه، أو مبالاة به، أو فكرًا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله، والاتصال: وهو اتصال القلب بالله، وإقباله عليه، وإقامة وجهه له، حبًّا وخوفًا ورجاء، وإنابة وتوكلًا».
عمل
[8] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: 5]، ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [النساء: 1] فى عبادة ربك ابذل غاية جهدك واستنفد غاية قدرتك.
الإعراب :
- ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ: ﴾
- الواو عاطفة. وما بعدها: يعرب اعراب «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ» الواردة في الآية الكريمة الرابعة. ربك: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا: ﴾
- معطوفة بالواو على «اذكر» وتعرب اعرابها. اليه:جار ومجرور متعلق بتبتل. تبتيلا: نائب عن المصدر المؤكد لعامله لأنه ملاقيه في الاشتقاق. أي وانقطع اليه بالعبادة والأصل «تبتلا» وقيل ان معنى «تبتل» بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل.'
المتشابهات :
| المزمل: 8 | ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ |
|---|
| الانسان: 25 | ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد ذكرِ الليلِ والنَّهارِ؛ أمرَه سبحانه بعد ذلك بالمداومة على ذكرِه ليلًا ونهارًا، والإخلاص له، قال تعالى:
﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [9] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ .. ﴾
التفسير :
{ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب [كلها]، فهو تعالى رب المشارق والمغارب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره.
{ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} أي:لا معبود إلا وجهه الأعلى، الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم، والإجلال والتكريم، ولهذا قال:{ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} أي:حافظا ومدبرا لأمورك كلها.
فربك- عز وجل- هو رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. أى: هو- سبحانه- رب جهتي الشروق والغروب للشمس.
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ مستحق للعبادة والطاعة، وما دام الأمر كذلك فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا.
أى: فاتخذه وكيلك الذي تفوض إليه أمرك، وتلجأ إليه في كل أحوالك ... إذ الوكيل هو الذي توكل إليه الأمور، ويترك له التصرف فيها.
ووصف- سبحانه- ذاته بأنه رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لمناسبة الأمر بذكره في الليل والنهار، وهما وقت ابتداء طلوع الشمس وغروبها، فكأنه- سبحانه- يقول: داوم على طاعتي لأنى أنا رب جميع جهات الأرض، التي فيها تشرق الشمس وتغرب.
والمراد بالمشرق والمغرب هنا جنسهما، فهما صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس، التي هي ثلاثمائة وستون مشرقا- كما يقول العلماء- وعلى كل مغرب من مغاربها التي هي كذلك.
والمراد بالمشرقين والمغربين كما جاء في سورة الرحمن: مشرق ومغرب الشتاء والصيف.
والمراد بالمشارق والمغارب كما جاء في سورة المعارج: مشرق ومغرب كل يوم للشمس والكواكب.
وقوله : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو ، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل ، ( فاتخذه وكيلا ) كما قال في الآية الأخرى : ( فاعبده وتوكل عليه ) [ هود : 123 ] وكقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وآيات كثيرة في هذا المعنى ، فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله ، وتخصيصه بالتوكل عليه .
وقوله: ( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة بالرفع على الابتداء، إذ كان ابتداء آية بعد أخرى تامة. وقرا ذلك عامة قرّاء الكوفة بالخفض على وجه النعت، والردّ على الهاء التي في قوله: ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ ).
والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكلّ واحدة منهما علماء من القرّاء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ومعنى الكلام: ربّ المشرق والمغرب وما بينهما من العالم.
وقوله: ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) يقول: لا ينبغي أن يُعبد إله سوى الله الذي هو ربّ المشرق والمغرب.
وقوله: ( فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا ) فيما يأمرك وفوّض إليه أسبابك.
وقوله: ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك، وعلى أذاهم، واهجرهم في الله هجرا جميلا. والهجر الجميل: هو الهجر في ذات الله، كما قال عزّ وجلّ: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... الآية، وقيل: إن ذلك نُسخ.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
عمل
[9] ﴿رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ لا تقتصر في توكلك على قضية أو هم واحد، اتخذ ربك وكيلًا دائمًا وفوض إليه كل حياتك.
وقفة
[9] ﴿رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ من قام بأمر المشرق والمغرب لن يعجزه القيام بأمرك؛ فتوكل عليه.
وقفة
[9] ﴿رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ الله معك أينما كنت، من توكَّل عليه كفاه ومن توجَّه إليه أتاه، ومن تعلَّق به هداه.
وقفة
[9] ﴿رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ التوكل الحق ليس أن تفوض وتعتمد على ربك في قضية واحدة، بل أن تتخذه وكيلًا تفوض إليه كل شؤونك دون استثناء.
وقفة
[9] ﴿رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ إن اتخذت من المخلوقين وكيلًا، أخذوا مالك وطالبوك بالأجرة، وإذا اتخذت الله وكيلاً، وفَّر عليك مالك، وأعطاك هو الثواب والأجرة.
تفاعل
[9] ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ قل: «حسبي الله ونعم الوكيل».
الإعراب :
- ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ: ﴾
- خبر مبتدأ محذوف تقديره هو مرفوع على المدح بالضمة. المشرق: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.والمغرب: معطوفة بالواو على «المشرق» وتعرب اعرابها
- ﴿ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: ﴾
- نافية للجنس. اله: اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف وجوبا تقديره موجود أو معلوم. إلا: أداة استثناء.هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل من موضع «لا إله» لأن موضع «لا» وما عملت فيه رفع بالابتداء ولو كان موضع المستثنى نصبا لكان إلا إياه.
- ﴿ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا: ﴾
- الفاء سببية. اتخذه: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. وكيلا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي كفيلا بما وعدك من النصر والإظهار.'
المتشابهات :
| الرحمن: 17 | ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ |
|---|
| المعارج: 40 | ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِـ رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ |
|---|
| الشعراء: 28 | ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ |
|---|
| المزمل: 9 | ﴿ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد الأمرِ بذِكْرِه في اللَّيلِ وذِكْرِه في النَّهارِ، وهما وَقْتَا ابتِداءِ غيابِ الشَّمسِ وطُلوعِه؛ جاء هنا وَصْفُ اللهِ بأنَّه رَبُّ المشرقِ والمغرِبِ، قال تعالى:
﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
رب:
قرئ:
1- بالخفض على البدل من «ربك» ، وهى قراءة الأخوين، وابن عامر، وأبى بكر، ويعقوب.
2- بالرفع، وهى قراءة باقى السبعة.
3- بالنصب، وهى قراءة زيد بن على.
المشرق والمغرب:
1- موحدين، وهى قراءة الجمهور.
وقرئا:
2- بجمعهما وهى قراءة عبد الله، وأصحابه، وابن عباس.
مدارسة الآية : [10] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ .. ﴾
التفسير :
فلما أمره الله بالصلاة خصوصا، وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال، وفعل الثقيلمن الأعمال، أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله، لا يصده عنه صاد، ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهمبالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.
ثم أمر الله- تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالصبر الجميل، على أذى قومه فقال:
وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا.....
أى: اجعل يا محمد اعتمادك وتوكلك على وحدي، واصبر على ما يقوله أعداؤك في حقك من أكاذيب وخرافات ... واهجرهم هجرا جميلا، أى: واعتزلهم وابتعد عنهم، وقاطعهم مقاطعة حسنة، بحيث لا تقابل السيئة يمثلها، ولا تزد على هجرهم: بأن تسبهم، أو ترميهم بالقبيح من القول ...
قال الإمام الرازي ما ملخصه: والمعنى أنك لما اتخذتني وكيلا فاصبر على ما يقولون، وفوض أمرهم إلى، فإنى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك، أحسن من قيامك بإصلاح نفسك.
واعلم أن مهمات العباد محصورة في أمرين: في كيفية معاملتهم مع الله، وقد ذكر- سبحانه- ذلك في الآيات السابقة، وفي كيفية معاملتهم مع الخلق، وقد جمع- سبحانه- كل ما يحتاج إليه في هذا الباب في هاتين الكلمتين، وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مخالطا للناس، أو مجانبا لهم.
فإن كان مخالطا لهم فعليه أن يصبر على إيذائهم ... وإما أن يكون مجانبا لهم، فعليه أن يهجرهم هجرا جميلا ... بأن يجانبهم بقلبه وهواه، ويخالفهم في أفعالهم، مع المداراة والإغضاء ....
يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه ، وأن يهجرهم هجرا جميلا ؛ وهو الذي لا عتاب معه . ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا - وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء - :
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا ) براءة نسخت ما ههنا؛ أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يقبل منهم غيرها.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ﴾ ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ﴾ [إبراهيم: 12]، ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: 24]، ﴿وَاصْبِرُوا﴾ [الأعراف: 128، الأنفال: 46، ص: 6]، ﴿اصْبِرُوا﴾ [آل عمران: 200]، ﴿وَاصْبِرْ﴾ [هود: 115، النحل: 127]، ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24]، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [البلد: 17، العصر: 3]، ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ [البقرة: 45]، وسياقات أخرى غزيرة تذكرنا بأن الصبر هو راحلة هذا الطريق.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ الصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: الأول: عدم التضجر مما يقول هؤلاء، وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه، وفيما جاء به، والثاني: أن يمضي في الدعوة إلى الله، وأن لا يتقاعس.
وقفة
[10] عَلَّمتني سورةُ المُزَّمِّلِ أنَّ الدَّاعيةَ لا بدَّ أنْ يصبرَ على الأذى: ﴿وَٱصْبِرْ﴾، وإن احتاجَ للهجرِ فليكن: ﴿هَجْرًا جَمِيلًا﴾ لا عتابَ فيه؛ لأنَّه لا ينتصرُ لنفسِه.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ فإن قولهم لا يضر الحق شيئًا، ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم .
عمل
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ لَمْ تخلُ حياةُ الأنبياءِ من أذى الناس ولم تصفُ من الكَدر، إنها حياة فانية، فلا تشغل نفسك بالحزن عليها، ولا تنشغل عن العبادة بكلام الناس عنك، مارس دورك بالطاعات والدعوة والذكر.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ لا ينفع علم بلا حلم، ولا إيمان بلا صبر، ولا توبة بلا استغفار، ولا هجر بلا احتساب.
عمل
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ أيها الداعية دربك وعْر، فتسلّح بالصبر.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ أدب وروعة وجمال؛ حتى في الهجر والعتاب.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ كل داع للخير سيسمع ما يؤذيه، لكن الصبر والهجر الجميل سيؤثر عليهم ويراجعون أنفسهم في قولهم.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ القرآن يعلمنا أن لا نقابل الإساءة بالإساءة! بالصبر والتجاهل تريح نفسك وتُؤدب خصومك.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ للمؤمن سمت حتى مع أعدائه؛ جميل في كل أحواله حتى في هجره.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ حتى تخفف آلامك من كلمات الآخرين الموجعة تذكر أخيارًا وطيبين عانوا مثلك وسمعوا، وتسل بقصصهم.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ حتى الأفعال القاسية لا بد أن يكسوها جمال، كل ذلك من جمال القرآن.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ المؤمن جميل في كل شئ حتى في هجره.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ تحمُّل التكاليف يقتضي تربية صارمة.
عمل
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ لا تشتم، لا تغضب، لا تصرخ، لا تظلم، لا تفجر بالخصومة، لا تضيع الود، فقط تأدب بآداب القرآن واتركهم بهدوء.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ هي بُشرى لكل داعية؛ ألا يبتئس لعداء قومه له، وألا يجعل في نفسه حقدًا وغلًّا، فإن الله تكفل بعقابهم والانتقام له منهم.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ وَفرة النعم بين يدَي العبد ليست دليلًا على رضا ربه عنه، ولكنَّها ابتلاءٌ وامتحان، فإن شكر أُكرم بالثواب، وإن كفر أُهين بالعقاب.
عمل
[10] اصبر على الأذى ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾.
وقفة
[10] ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ وصفه ربانية وتربية قرآنية تبعث على السكون في زمن الفتن: الصبر والهجر الجميل.
وقفة
[10] علمتني سورة المزمل أن الداعية لا بد أن يصبر على الأذى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾، وإن احتاج للهجر فليكن هجرًا جميلًا لا عتاب فيه؛ لأنه لا ينتصر لنفسه.
وقفة
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ أمر الله تعالى في كتابه بالصبر الجميل، والصفح الجميل، والهجر الجميل، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه.
وقفة
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ الله جميل يحب الجمال، حتى في الهجر والقطيعة مع الكفار، فأي عذر لمن يكدر صفو الوصل بالمن والأذى مع الأقارب والأرحام؟!
وقفة
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ هذا أدب المسلم وثبات أخلاقه حتى مع أعدائه وخصومه!
وقفة
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الهجر الجميل؟! فقال: «الهجر الجميل: هجر بلا أذى».
وقفة
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف الهجر الجميل: «خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تُكلِّموه»، لا تُكلِّموه بمعنى: لا تجرحوه.
وقفة
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾، ﴿واصبر صبرا جميلا﴾ [5] حتى الأفعال القاسية لابد أن يكسوها جمال، كل ذلك من جمال القرآن.
وقفة
[10] ﴿واهجرهُم هجرا جميلا﴾ أدب القرآن لا يعلمك أن تأخذ الصراخ بـالصراخ، ولا الشتم بـالشتم، عش جمال الحياة في الإعراض عن هذه الفئة.
عمل
[10] ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ أعرِضْ عن من يُسبب لكَ الهم والضيق؛ فإنَّه راحة لعقلك ولقلبك.
وقفة
[10] ما من عقل سوي إلا وهو يحب الشيء الجميل، لكن المفرطين في تحصيله كثيرون! ﴿فاصفح الصفح الجميل﴾ [الحجر: 85]، ﴿فاصبر صبرا جميلا﴾ [5]، ﴿واهجرهم هجرا جميلا﴾.
وقفة
[10] رُبَّ هجر جميل خيرٌ من مخالطة مؤذية! ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾.
وقفة
[10] خصومة الكرام: عتب أو عفو أو إعراض أو هجر، خصومة اللئام: غيبة ونميمة وافتراء وتشويه وكذب ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَاصْبِرْ: ﴾
- الواو عاطفة. اصبر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ عَلى ما يَقُولُونَ: ﴾
- حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى. والجار والمجرور متعلق باصبر. يقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يقولون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب، والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير: ما يقولونه. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية وجملة «يقولون» صلتها لا محل لها من الاعراب.و«ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بعلى. التقدير: على قولهم فيك وفي دينك.
- ﴿ وَاهْجُرْهُمْ: ﴾
- معطوفة بالواو علي «اصبر» وتعرب اعرابها و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.
- ﴿ هَجْراً جَمِيلًا: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- منصوب بالفتحة. جميلا: صفة- نعت لهجرا منصوبة بالفتحة أيضا.'
المتشابهات :
| طه: 130 | ﴿فَـ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُون وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ﴾ |
|---|
| ص: 17 | ﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُون وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ﴾ |
|---|
| ق: 39 | ﴿فَـ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُون وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ﴾ |
|---|
| المزمل: 10 | ﴿وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُون وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالصَّلاةِ خُصوصًا، وبالذِّكرِ عُمومًا، وبذلك يحصلُ للعبدِ مَلَكةٌ قَوِيَّةٌ في تحمُّلِ الأثقالِ، وفِعلِ الثَّقيلِ مِن الأعمالِ؛ أمَرَه بالصَّبرِ على ما يقولُ فيه المعانِدونَ له ويسُبُّونَه ويَسُبُّونَ ما جاء به، وأن يَمضيَ على أمرِ اللهِ، لا يَصُدُّه عنه صادٌّ، ولا يرُدُّه رادٌّ، وأن يَهجُرَهم هَجرًا جميلًا، قال تعالى:
﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [11] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ .. ﴾
التفسير :
{ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ} أي:اتركني وإياهم، فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم فلا أهملهم، وقوله:{ أُولِي النَّعْمَةِ} أي:أصحاب النعمة والغنى، الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه، وأمدهم من فضله كما قال تعالى:{ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} .
ثم توعدهم بما عنده من العقاب، فقال:
وقوله- سبحانه-: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا أى: ودعني وشأنى مع هؤلاء المكذبين بالحق، ولا تهتم أنت بأمرهم، فأنا خالقهم، وأنا القادر على كل شيء يتعلق بهم.
وقوله: أُولِي النَّعْمَةِ وصف لهم جيء به على سبيل التوبيخ لهم، والتهكم بهم، حيث جحدوا نعم الله، وتوهموا أن هذه النعم من مال أو ولد ستنفعهم يوم القيامة.
والنّعمة- بفتح النون مع التشديد-: تطلق على التنعم والترفه وغضارة العيش في الدنيا.
وأما النّعمة- بكسر النون- فاسم للحالات الملائمة لرغبة الإنسان من غنى أو عافية أو نحوهما.
وأما النّعمة- بالضم- فهي اسم المسرة. يقال: فلان في نعمة- بضم النون- أى: في فرح وسرور.
وقوله: وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا أى: واتركهم ودعهم في باطلهم وقتا قليلا، فسترى بعد ذلك سوء عاقبة تكذيبهم للحق.
( وذرني والمكذبين أولي النعمة ) أي : دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال ، فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم ، ( ومهلهم قليلا ) أي : رويدا ، كما قال : ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) [ لقمان : 24 ] ; ولهذا قال هاهنا :
يعني تعالى ذكره بقوله: ( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ) فدعني يا محمد والمكذّبين بآياتي ( أُولِي النَّعْمَةِ ) يعني أهل التنعم في الدنيا( وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا ) يقول: وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله.
وذُكر أن الذي كان بين نـزول هذه الآية وبين بدر يسير.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن ابن عباد، عن أبيه، عن عباد، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: لما نـزلت هذه الآية: ( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا )... الآية، قال: لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال الله: ( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا ) يقول: إن لله فيهم طَلبة وحاجة.
وقوله: ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا ) يقول تعالى ذكره: إن عندنا لهؤلاء المكذِّبين بآياتنا أنكالا يعني قيودا، واحدها: نِكْل.
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
التدبر :
وقفة
[11] ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ ووصفهم بــ ﴿أُولِي النَّعْمَةِ﴾ توبيخًا لهم بأنهم كذَّبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم، وتهديدًا لهم بأن الذي قال: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ سيزيل عنهم ذلك التنعم.
وقفة
[11] ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ النعمة التي تنعم بها تدلك على الله, فإن أعرضت فهي بوابة عذابك.
وقفة
[11] ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ الترف والتوسع في التنعم يصدُّ عن سبيل الله.
وقفة
[11] ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ هي دعوتي، وما عليك إلا البلاغ، فدعهم يكذبون، وسأتولى أنا حربهم، فأرح نفسك من عناء التفكير، ولا ترهق قلبك بكثرة التدبير، فأنا كافيك من كل ما يؤذيك.
لمسة
[11] ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ ما الفرق بين كلمتي (نَعمة) بفتح النون، و(نِعمة) بكسر النون في القرآن؟ الجواب: النَّعْمَة بالفتح هي الترف والراحة، وأما النِّعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية، وأمن ورزق، ونحو ذلك.
وقفة
[11] ﴿وَذَرني وَالمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعمَةِ﴾ يستند المكذب المكابر إلي المال والسطوة والسلطان ظانًا أنهم يحفظوه ولكن ﴿وَمَهِّلهُم قَليلًا﴾.
وقفة
[11] ﴿وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ والحياة كلها قليل، وما بقي منها أقل القليل، حتى إن الناس ليحسونها يوم القيامة ساعة من نهار، فكيف يباع نعيم الخلود بساعة؟!
الإعراب :
- ﴿ وَذَرْنِي: ﴾
- معطوفة بالواو على «اصبر» وتعرب اعرابها. النون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به.
- ﴿ وَالْمُكَذِّبِينَ: ﴾
- الواو: واو المعية. المكذبين: مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد أو تكون معطوفة بواو العطف على الضمير الياء في «ذرني» أي دعني ودع المكذبين لي فأنا كفيل بهم.
- ﴿ أُولِي النَّعْمَةِ: ﴾
- صفة- نعت- للمكذبين- منصوبة بالياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم والكلمة تكتب بواو ولا تلفظ. وهي جمع بمعنى «ذوو» لا واحد له وقيل هي اسم جمع واحده: ذو بمعنى صاحب. النعمة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي أصحاب التنعم.
- ﴿ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا: ﴾
- تعرب اعراب «وَاهْجُرْهُمْ» قليلا: صفة- نعت- لمصدر محذوف أي وامهلهم إمهالا قليلا. أو تكون صفة لظرف زمان محذوف أي وأمهلهم زمانا أو وقتا قليلا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعدَ أمرِه صلى الله عليه وسلم بالصَّبرِ على أذى المشركينَ؛ هدَّدَهُم اللهُ هنا بعذابِ يومِ القيامةِ، قال تعالى:
﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [12] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴾
التفسير :
أي:إن عندنا{ أَنْكَالًا} أي:عذابا شديدا، جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على الذنوب.{ وَجَحِيمًا} أي:نارا حامية
وقوله- سبحانه-: إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَحِيماً ... تعليل لما قبله. والأنكال: جمع نكل- بكسر النون وسكون الكاف- وهو القيد الثقيل، يوضع في الرجل لمنع الحركة. وسميت القيود بذلك لأنها تجعل صاحبها موضع عبرة وعظة، أو لأنها تجعل صاحبها ممنوعا من الحركة، والتقلب في مناكب الأرض.
أى: إن لدينا ما هو أشد من ردك عليهم ... وهو تلك القيود التي نقيد حركتهم بها، وإن لدينا «جحيما» أى: نارا شديدة الاشتعال نلقى بهم فيها،
( إن لدينا أنكالا ) وهي : القيود . قاله ابن عباس وعكرمة ، وطاوس ، ومحمد بن كعب ، وعبد الله بن بريدة ، وأبو عمران الجوني ، وأبو مجلز ، والضحاك ، وحماد بن أبي سلمان ، وقتادة ، والسدي ، وابن المبارك ، والثوري ، وغير واحد . ) وجحيما ) وهي السعير المضطرمة .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن أبي عمرو، عن عكرِمة، أن الآية التي قال: ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا ) إنها قيود.
حدثني عبيد بن أسباط بن محمد، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن أبي عمرو، عن عكرِمة ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) قال: قُيودا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى وعبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو عمرو، عن عكرمة ( أَنْكَالا ) قال: قيودا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبي عمرو، عن عكرمة ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) قال: قيودا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، قال: وبلغني عن مجاهد قال: الأنكال: القيود.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن حماد، قال: الأنكال: القيود.
حدثني محمد بن عيسى الدامغاني، قال: ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن حماد، مثله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت حمادا يقول: الأنكال: القيود.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) : أي قيودا.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن، عن سفيان، عن أبي عمرو بن العاص، عن عكرمة ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) قال: قيودا.
حدثنا أبو عبيد الوَصَّابي محمد بن حفص، قال: ثنا ابن حمير، قال: ثنا الثوريّ، عن حماد، في قوله: ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا ) قال: الأنكال: القيود.
حدثنا سعيد بن عنبسة الرازي، قال: مررت بابن السماك، وهو يَقُصّ وهو يقول: سمعت الثوري يقول: سمعت حمادا يقول في قوله الله: ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) قال: قيودا سوداء من نار جهنم.
وقوله: ( وَجَحِيمًا ) يقول: ونارا تسعر.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[12] ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا﴾ الأنكال: القيود والأغلال، قال الشعبي: «أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ لا والله، ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا أمسكت بهم».
تفاعل
[12] ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا﴾ استعذ بالله الآن من عذابه.
وقفة
[12] قرأ سليمان التيمي قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا﴾، فقال: «قيودًا والله ثقالًا لا تُفَكُّ أبدًا»، ثم بكى.
وقفة
[12، 13] ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ الطعام القبيح نكد فكيف إذا غص به؟! اللهم قنا عذابك.
وقفة
[12، 13] ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ أتى الله المكذبين أولي النَّعْمَةِ في الدنيا طعامًا طيّبًا سائغًا فما حَمِدوه ولا شكروا نعماءه، فجازاهم بطعام كريه ينشبُ في حلوقهم؛ ليذوقوا عذاب غُصَصه مع عذاب الجوع.
وقفة
[12، 13] تصور حال أهل النار وطعامهم وعذابهم وبؤسهم عياذًا بالله منهم ومن عذاب النار ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ لَدَيْنا: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. لدى: ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب متعلق بخبر «ان» المقدم وهو مضاف. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.
- ﴿ أَنْكالًا وَجَحِيماً: ﴾
- اسم «ان» منصوب بالفتحة. جحيما: معطوفة بالواو على «أنكالا» منصوبة مثلها بالفتحة. أي أن عندنا قيودا ثقيلة ونارا ملتهبة، مفردها: نكل أي قيد'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَهُم اللهُ بعذابِ يومِ القيامةِ؛ ذكرَ هنا من ألوان العذاب التي أعدها لهم أمورًا أربعة: ١- قيودًا ثقيلة. ٢- نارًا مُسْتَعِرة، قال تعالى:
﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [13] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾
التفسير :
{ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ} وذلك لمرارته وبشاعته، وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن،{ وَعَذَابًا أَلِيمًا} أي:موجعا مفظعا،
وإن لدينا كذلك «طعاما ذا غصة» أى: طعاما يلتصق في الحلوق، فلا هو خارج منها، ولا هو نازل عنها، بل هو ناشب فيها لبشاعته ومرارته.
وهذا الطعام ذو الغصّة، يشمل ما يتناولونه من الزقوم ومن الغسلين ومن الضريع، كما جاء في آيات أخرى. والغصة: ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره. وجمعه غصص.
وإن لدينا فوق كل ذلك عَذاباً أَلِيماً أى: عذابا شديد الإيلام لمن ينزل به.
فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد توعدت هؤلاء المكذبين بألوان من العقوبات الشديدة، توعدتهم بالقيود التي تشل حركتهم، وبالنار المشتعلة التي تحرق أجسادهم، وبالطعام البشع الذي ينشب في حلوقهم، وبالعذاب الأليم الذي يشقيهم ويذلهم.
( وطعاما ذا غصة ) قال ابن عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج .
( وعذابا أليما )
( وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ) يقول: وطعاما يَغَصّ به آكله، فلا هو نازل عن حلقه، ولا هو خارج منه.
كما حدثني إسحاق بن وهب وابن سنان القزّاز قالا ثنا أبو عاصم، قال: ثنا شبيب بن بشر، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: ( وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ) قال: شوك يأخذ بالحلق، فلا يدخل ولا يخرج.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ) قال: شجرة الزقوم.
وقوله: ( وَعَذَابًا أَلِيمًا ) يقول: وعذابا مؤلما موجعا.
حدثني أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن حُمْران بن أعين " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ: ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ) فصعق صلى الله عليه وسلم.
التدبر :
وقفة
[13] ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ هل شعرت يومًا بغصة من لقمة طعام كدت معها أن تختنق؟! هذا هو طعام أهل النار الدائم، يدخل إلى الحلق، فلا هو نازل ولا خارج، وأما نوعه فقال ابن عباس: «وهو الغسلين والزقوم والضريع».
تفاعل
[13] ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.
الإعراب :
- ﴿ وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً ﴾
- معطوفة على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. ذا: صفة- نعت- لطعاما منصوبة مثلها وعلامة نصبها الألف لأنها من الاسماء الخمسة وهو مضاف.غصة: مضاف إليه مجرور بالكسرة. و «أليما» صفة للموصوف «عذابا» منصوبة مثلها بالفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ٣- طعامًا كريهًا ينشَب في الحلوق لا يستساغ. ٤- عذابًا موجعًا زيادة على ما سبق، قال تعالى:
﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [14] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ .. ﴾
التفسير :
وذلك{ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ} من الهول العظيم،{ وَكَانَتِ الْجِبَالُ} الراسيات الصم الصلاب{ كَثِيبًا مَهِيلًا} أي:بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك، فتكون كالهباء المنثور.
والظرف في قوله- تعالى-: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ ... منصوب بالاستقرار العامل في «لدنيا» ، الذي هو الخبر في الحقيقة.
أى: استقر لهم ذلك العذاب الأليم لدينا، يوم القيامة، يوم تضطرب وتتزلزل الأرض والجبال.
وَكانَتِ الْجِبالُ في هذا اليوم كَثِيباً مَهِيلًا أى: رملا مجتمعا، بعد أن كانت قبل ذلك الوقت أحجارا صلبة كبيرة.
فقوله: كَثِيباً من كثب الشيء يكثبه، إذا جمعه من قرب ثم صبه، وجمعه كثب وكثبان، وهي تلال الرمال المجتمعة كالربوة.
وقوله مَهِيلًا اسم مفعول من هال الشيء هيلا، إذا نثره، وفرقه بعد اجتماعه.
والشيء المهيل: هو الذي يحرّك أسفله فينهار أعلاه ويتساقط بسرعة.
"يوم ترجف الأرض والجبال"أي : تزلزل ، ( وكانت الجبال كثيبا مهيلا ) أي : تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب ، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا ، لا ترى فيها عوجا ، أي : واديا ، ولا أمتا ، أي : رابية ، ومعناه : لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع .
القول في تأويل قوله تعالى : يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا (14)
يقول تعالى ذكره: إن لدينا لهؤلاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها في يوم ترجف الأرض والجبال؛ ورُجْفان ذلك: اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة.
وقوله: ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا ) يقول: وكانت الجبال رملا سائلا متناثرًا.
والمهيل: مفعول من قول القائل: هلت الرمل فأنا أهيله، وذلك إذا حُرِّك أسفله، فانهال عليه من أعلاه؛ وللعرب في ذلك لغتان، تقول: مهيل ومهيول، ومكيل ومكيول؛ ومنه قول الشاعر:
قـدْ كـانَ قَـوْمُكَ يَحْسَـبُونَكَ سَـيِّدا
وإخــالُ أنَّــكَ سَــيِّدٌ مَغْيُــونُ (3)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا ) يقول: الرمل السائل.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا ) قال: الكثيب المهيل: اللين الذي إذا مسسته تتابع.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( كَثِيبًا مَهِيلا ) قال: ينهال.
------------------------
الهوامش:
(3) البيت لعباس بن مرداس السلمي (شرح شواهد شافية ابن الحاجب لعبد القادر البغدادي طبع القاهرة 389). قال البغدادي: " مغيون، بالغين المعجمة: اسم مفعول من قولهم: غين على قلبه، أي غطى عليه، وفي الحديث: "إنه ليغان على قلبي" ولكن الناس ينشدونه بالباء، وهو تصحيف، وقد روى بالعين غير المعجمة أي: مصاب بالعين. والأول هو الوجه. وكلاهما مما جاء فيه التصحيح وإن كان الاعتلال فيه أكثر، كقولهم: طعام مزيوت، وبر مكيول، وثوب مخيوط؛ والقياس: مغين، ومزيت، ومكيل، ومخيط، حملا على غين، وزيت، وكيل، وخيط. قال أبو علي: ولو جاء التصحيح فيما كان من الواو لم ينكر، وقد صححوا أحرفا من ذوات الواو؛ قالوا: مسك مدوون، وثوب مصووف، وفرس مقوود. قال: وإنما صح اسم المفعول من هذا التركيب فخالف بذلك اسم الفاعل؛ لأن اسم المفعول غير جار على فعله في حركاته وسكونه، كما تجري أسماء الفاعلين على أفعالها؛ خالف اسم المفعول فعله فيما ذكرناه، خالفه في إعلاله. ا هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[14] ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ إن يومًا ترجف فيه الأرض، وتتحول الجبال فيه إلى كثبان رمال، هو يوم شديد، جدير أن تخاف منه، وتستعدّ له.
لمسة
[14] ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ كرر لفظ (الْجِبَالُ)؛ لأنه في مقام التهديد والوعيد, ثم إنه لو أضمر, فقال: (وكانت كثيباً), لكان محتملًا أن يعود الضمير على الأرض, فتكون هي التي أصبحت كثيبًا مهيلًا, وهذا غير مراد, فمنعًا لهذا الاحتمال أظهر في موضع الإضمار.
وقفة
[14] هول يوم القيامة ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾.
وقفة
[14] تأمل كم وقتٍ ومالٍ يُبذلان ﻹزالة جزء من جبل حتى تعلم حجم هول يوم واحد ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ فكيف به على بشر ضعيف.
الإعراب :
- ﴿ يَوْمَ: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية وهو متعلق بما في لدنيا الواردة في الآية الثانية عشرة.
- ﴿ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة.ترجف: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الأرض: فاعل مرفوع بالضمة.والجبال: معطوفة بالواو على «الأرض» وتعرب اعرابها. أي تضطرب أو تزلزل.
- ﴿ وَكانَتِ الْجِبالُ: ﴾
- الواو عاطفة. كانت: فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين لا محل لها من الاعراب. الجبال: اسم «كان» مرفوع بالضمة
- ﴿ كَثِيباً مَهِيلًا: ﴾
- خبر «كان» منصوب بالفتحة. مهيلا: صفة- نعت- لكثيبا منصوبة مثلها بالفتحة أي وتصير الجبال مثل رمل مجتمع هيل هيلا: أي نثر وأسيل.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَر اللهُ هذا العذابَ؛ ذكَرَ هنا ظَرْفَه، قال تعالى:
﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
ترجف:
1- بفتح التاء، مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بضمها، مبنيا للمفعول، وهى قراءة زيد بن على.
مدارسة الآية : [15] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى:احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير، الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروها.
ثم يذكر- سبحانه- بعد ذلك هؤلاء المكذبين بما حل بالمكذبين من قبلهم، فيقول:
إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ، كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا.
أى: إنا أرسلنا إليكم- أيها المكذبون- رسولا عظيم الشأن، رفيع القدر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهِداً عَلَيْكُمْ أى: سيكون يوم القيامة شاهدا عليكم، بأنه قد بلغكم رسالة الله- تعالى- دون أن يقصر في ذلك أدنى تقصير.
والكاف في قوله- تعالى-: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا للتشبيه، أى: أرسلنا إليكم- يا أهل مكة- رسولا شاهدا عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا من قبلكم إلى فرعون رسولا شاهدا عليه، هو موسى- عليه السلام- وأكد الخبر في قوله- تعالى-: إِنَّا أَرْسَلْنا ... لأن المشركين كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
ونكر رسولا، لأنهم كانوا يعرفونه حق المعرفة، وللتعظيم من شأنه صلى الله عليه وسلم أى: أرسلنا إليكم رسولا عظيم الشأن، سامى المنزلة جامعا لكل الصفات الكريمة.
ثم قال مخاطبا لكفار قريش ، والمراد سائر الناس : ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ) أي : بأعمالكم ، ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا )
يقول تعالى ذكره: ( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ) أيها الناس ( رَسُولا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ) بإجابة من أجاب منكم دعوتي، وامتناع من امتنع منكم من الإجابة، يوم تلقوني في القيامة ( كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا ) يقول: مثل إرسالنا من قبلكم إلى فرعون مصر رسولا بدعائه إلى الحقّ.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[15] ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ واختير لكفار مكة ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله، وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم.
وقفة
[15] ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ اشتراككم مع فرعون في التكذيب والعصيان، يجمعكم معه في سوء العاقبة والخذلان.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّا: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «انّ».
- ﴿ أَرْسَلْنا: ﴾
- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة «أرسلنا» في محل رفع خبر «ان».
- ﴿ إِلَيْكُمْ رَسُولًا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأرسلنا والميم علامة جمع الذكور. أو بمحذوف على أن يكون صفة لرسولا قدم عليه فصار حالا. رسولا:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ شاهِداً عَلَيْكُمْ: ﴾
- صفة- نعت- لرسولا منصوب بالفتحة. عليكم: جار ومجرور متعلق بشاهدا والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ كَما أَرْسَلْنا: ﴾
- الكاف: اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في محل نصب صفة أو نائب مفعول مطلق و «ما» مصدرية. أو تكون حرفا معناها التعليل متصلة بما الكافة وجملة «أرسلنا» أعربت. وهي هنا صلة «ما» لا محل لها من الاعراب. و «ما» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر- الكاف- والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق محذوف.
- ﴿ إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأرسلنا. وعلامة جر الاسم الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعجمة والمعرفة ولتجاوزه ثلاثة أحرف. رسولا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ونكر «رسولا» لأنه بمعنى: بعض الرسل.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَ اللهُ المشركينَ بأهوالِ القِيامةِ؛ هدَّدَهُم هنا بعذابِ الدُّنيا، فذكَّرَهم بحالِ فِرعونَ وكيفَ أخَذَه اللهُ تعالَى، إذ كَذَّب مُوسى عليه السَّلامُ، وأنَّه إنْ دامَ تَكذيبُهم أهْلَكَهم اللهُ، قال تعالى:
﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [16] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا .. ﴾
التفسير :
فتعصوا رسولكم، فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران، فدعاه إلى الله، وأمره بالتوحيد، فلم يصدقه، بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا أي:شديدا بليغا.
والفاء في قوله: فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ للتفريع. أى: أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا قبل ذلك، فكانت النتيجة أن عصى فرعون أمر الرسول الذي أرسلناه إليه، واستهزأ به، وتطاول عليه فكانت عاقبة هذا التطاول، أن أخذناه أَخْذاً وَبِيلًا.
أى أهلكنا فرعون إهلاكا شديدا، وعاقبناه عقابا ثقيلا، فوبيل بزنة فعيل- صفة مشبهة، مأخوذة من وبل المكان، إذا وخم هواؤه وكان ثقيلا رديئا. ويقال: مرعى وبيل، إذا كان وخما رديئا.
وخص- سبحانه- موسى وفرعون بالذكر، لأن أخبارهما كانت مشهورة عند أهل مكة.
وأل في قوله فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ للعهد. أى: فعصى فرعون الرسول المعهود عندكم، وهو موسى- عليه السلام-.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم نكر الرسول ثم عرف؟ قلت: لأنه أراد: أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل، فلما أعاده وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف. إشارة إلى المذكور بعينه.. .
وأظهر- سبحانه- اسم فرعون مع تقدم ذكره فقال: فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، دون أن يؤتى بضميره، للإشعار بفظاعة هذا العصيان، وبلوغه النهاية في الطغيان.
والمقصود من هاتين الآيتين، تهديد المشركين، بأنهم إذا ما استمروا في تكذيبهم لرسولهم، محمد صلى الله عليه وسلم فقد يصيبهم من العذاب ما أصاب فرعون عند ما عصى موسى- عليه السلام-.
(فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، والثوري : ( أخذا وبيلا ) أي : شديدا ، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول ، فيصيبكم ما أصاب فرعون ، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، كما قال تعالى : ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) [ النازعات : 25 ] وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم ; لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . ويروى عن ابن عباس ومجاهد .
( فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) الذي أرسلناه إليه ( فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا ) يقول: فأخذناه أخذا شديدا، فأهلكناه ومن معه جميعا، وهو من قولهم: كلأ مستوبل، إذا كان لا يستمرأ، وكذلك الطعام.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( أَخْذًا وَبِيلا ) قال: شديدا.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( أَخْذًا وَبِيلا ) قال: شديدا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا ) أي شديدًا.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( أَخْذًا وَبِيلا ) قال: شديدا.
حدثني يونس، قال: اخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا ) قال: الوبيل: الشرّ، والعرب تقول لمن تتابع عليه الشرّ: لقد أوبل عليه، وتقول: أوبلت على شرّك، قال: ولم يرض الله بأن غُرِّق وعُذّب حتى اقرّ في عذاب مستقرّ حتى يُبعث إلى النار يوم القيامة، يريد فرعون.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[16] ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ أيها الطغاة: ما غرَّكم بربكم وقد أهلك من قبلكم.
تفاعل
[16] ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ استعذ بالله الآن من انتقامه.
اسقاط
[16] ﴿فَعَصى فِرعَونُ الرَّسولَ فَأَخَذناهُ أَخذًا وَبيلًا﴾ هذا جزاء من عصى الرسول؛ فانتبه.
الإعراب :
- ﴿ فَعَصى فِرْعَوْنُ: ﴾
- الفاء: استئنافية. عصى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. فرعون: فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ الرَّسُولَ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمعرفة هنا عهدية أي معهود بالذكر اشارة الى المذكور بعينه.
- ﴿ فَأَخَذْناهُ: ﴾
- الفاء سببية. أخذ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا.و«نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل- ضمير الغائب- مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
- ﴿ أَخْذاً وَبِيلًا: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- منصوب بالفتحة. وبيلا: صفة- نعت- لأخذا منصوبة مثلها بالفتحة. أي أخذا وخيما بمعنى «ثقيلا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا عُلِمَ أنَّ اللهَ شديدُ الأخْذِ، وأنَّه لا يُغْني ذا الجَدِّ منه الجَدُّ؛ سَبَّبَ عن ذلك قَولَه محَذِّرًا لهم مِن الاقتِداءَ بفِرعَونَ، قال تعالى:
﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [17] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا .. ﴾
التفسير :
أي:فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم القيامة، اليوم المهيل أمره، العظيم قدره، الذي يشيب الولدان، وتذوب له الجمادات العظام.
ثم ذكرهم- سبحانه- بأهوال يوم القيامة، لعلهم يتعظون أو يرتدعون فقال: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً، السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
والاستفهام في قوله: فَكَيْفَ مستعمل في التوبيخ والتعجيز، وتَتَّقُونَ بمعنى تصونون أنفسكم من العذاب، ومعنى إِنْ كَفَرْتُمْ إن بقيتم على كفركم وأصررتم عليه.
وقوله يَوْماً: منصوب على أنه مفعول به لقوله: تَتَّقُونَ.
وقوله : ( فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ) يحتمل أن يكون ) يوما ) معمولا لتتقون ، كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : " فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به " ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم ، فعلى الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وكلاهما معنى حسن ، ولكن الأول أولى ، والله أعلم .
ومعنى قوله : ( يوما يجعل الولدان شيبا ) أي : من شدة أهواله وزلازله وبلابله ، وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار ، فيقول من كم ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار ، وواحد إلى الجنة .
قال الطبراني : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا نافع بن يزيد ، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : ( يوما يجعل الولدان شيبا ) قال : " ذلك يوم القيامة ، وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار . قال : من كم يا رب ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ، وينجو واحد " ، فاشتد ذلك على المسلمين ، وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم : " إن بني آدم كثير ، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه ألف رجل ، ففيهم وفي أشباههم جنة لكم " .
هذا حديث غريب ، وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث .
يقول تعالى ذكره للمشركين به: فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله، ولم تصدّقوا به. وذُكر أن ذلك كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) يقول: كيف تتقون يوما، وأنتم قد كفرتم به ولا تصدّقون به.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ ) قال: والله لا يتقي من كفر بالله ذلك اليوم.
وقوله: ( يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) يعني يوم القيامة، وإنما تشيب الولدان من شدّة هوله وكربه.
كما حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) كان ابن مسعود يقول: " إذا كان يومُ القيامة دعا رُّبنا المَلِكُ آدم، فيقول: يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول آدم: أي رب لا علم لي إلا ما علمتني، فيقول الله له: أخرج من كلّ ألف تسع مئة وتسعة وتسعين، فيُساقون إلى النار سُودا مقرّنين، زُرقا كالِحِين، فيشيب هنالك كلّ وليد ".
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) قال: تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[17] ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ما الذي جعل الطفل يقفز هذه المراحل من الزمن أما المؤمنون فهم: ﴿مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ [النمل: 89].
وقفة
[17] ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ قال الحسن: «أي: بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟».
وقفة
[17] ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ شاب طفل لم يذنب؛ فكيف بحالي وحالك؟!
وقفة
[17] ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ قال قتادة: «والله ما اتَّقى ذلك اليوم قومٌ كفروا بالله وعصوا رسوله»، وأنى لهم أن يتَّقوه؟!
عمل
[17] ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ بعض أيام دنيانا يَشيبُ لكربها المرء، فكيف بأيام الآخرة بأهوالها وفظائعها؟! فاتَّقِ الله وتعقَّل لتكون من الناجين.
وقفة
[17] ﴿فَكَيفَ تَتَّقونَ إِن كَفَرتُم يَومًا يَجعَلُ الوِلدانَ شيبًا﴾ سؤال يستحق وقفات.
الإعراب :
- ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ: ﴾
- الفاء: استئنافية. كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال والعامل فيه «تتقون» تتقون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.
- ﴿ إِنْ كَفَرْتُمْ: ﴾
- حرف شرط جازم. كفرتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك في محل جزم بإن لأنه فعل الشرط. التاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور وحذف جواب الشرط لتقدم معناه. التقدير: ان كفرتم أي أن بقيتم على الكفر فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة. وحذف مفعول «تتقون» الأول لأنه معلوم. بمعنى تتقون الله.
- ﴿ يَوْماً: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويجوز أن يكون ظرف زمان منصوبا على الظرفية. أي فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة. ان كفرتم في الدنيا. ويجوز أن يكون مفعولا لكفرتم على تأويل جحدتم. أي فكيف تتقون الله ان جحدتم يوم القيامة.
- ﴿ يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل نصب صفة- نعت- ليوما. يجعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «يوما» أو يعود على الله سبحانه. أي يجعل الولدان فيه شيبا. الولدان: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والوالدان مفعول- يجعل- الأول.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [17] لما قبلها : وبعد أن هدَّدَهُم اللهُ بعذاب الدنيا؛ عاد إلى تخويفهم بعذاب الآخرة، قال تعالى:
﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [18] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ .. ﴾
التفسير :
فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها{ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا} أي:لا بد من وقوعه، ولا حائل دونه.
وقوله: السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ صفة ثانية لهذا اليوم.
والمراد بالولدان: الأطفال الصغار، وبه بمعنى فيه..
والمقصود بهاتين الآيتين- أيضا- تأكيد التهديد للمشركين، حتى يقلعوا عن شركهم وكفرهم.. أى: إذا كان الأمر كما ذكرنا لكم من سوء عاقبة المكذبين، فكيف تصونون أنفسكم- إذا ما بقيتم على كفركم- من عذاب يوم هائل شديد، هذا اليوم من صفاته أنه يحول الشعر الشديد السواد للولدان، إلى شعر شديد البياض..
وهذا اليوم من صفاته- أيضا- أنه لشدة هوله، أن السماء- مع عظمها وصلابتها- تصير شيئا منفطرا- أى: متشققا بِهِ أى: فيه، والضمير يعود إلى اليوم..
وصدر- سبحانه- الحديث عن يوم القيامة، بلفظ الاستفهام «كيف» للإشعار بشدة هوله. وأنه أمر يعجز الواصفون عن وصفه.
ووصف- سبحانه- هذا اليوم بأنه يشيب فيه الولدان، ثم وصفه بأن السماء مع عظمها تتشقق فيه، للارتقاء في الوصف من العظيم إلى الأعظم، إذ أن تحول شعر الأطفال من السواد إلى البياض- مع شدته وعظمه- أشد منه وأعظم، انشقاق السماء في هذا اليوم.
قال صاحب الكشاف: وقوله يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً مثل في الشدة، يقال في اليوم الشديد، يوم يشيب نواصي الأطفال والأصل فيه أن الهموم والأحزان، إذا تفاقمت على الإنسان، أسرع فيه الشيب، كما قال أبو الطيب:
والهمّ يخترم الجسيم نحافة ... ويشيب ناصية الصبى ويهرم
ويجوز أن يوصف اليوم بالطول، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب.
وقوله: السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وصف لليوم بالشدة- أيضا- وأن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه فما ظنك بغيرها من الخلائق...
ووصف- سبحانه- السماء بقوله: مُنْفَطِرٌ بصيغة التذكير، حيث لم يقل منفطرة، لأن هذه الصيغة، صيغة نسب. أى: ذات انفطار، كما في قولهم: امرأة مرضع وحائض، أى: ذات إرضاع وذات حيض. أو على تأويل أن السماء بمعنى السقف، كما في قوله- تعالى-: وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً أو على أن السماء اسم جنس واحده سماوة، فيجوز وصفه بالتذكير والتأنيث..
وقوله: كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا الضمير فيه يعود إلى الخالق- عز وجل- والوعد مصدر مضاف لفاعله. أى: كان وعد ربك نافذا ومفعولا، لأنه- سبحانه- لا يخلف موعوده.
ويجوز أن تكون هذه الجملة صفة ثالثة لليوم، والضمير في وعده يعود إليه، ويكون من إضافة المصدر لمفعوله. أى: كان الوعد بوقوع يوم القيامة نافذا ومفعولا.
وقوله : ( السماء منفطر به ) قال الحسن وقتادة : أي بسببه من شدته وهوله . ومنهم من يعيد الضمير على الله عز وجل . وروي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي ; لأنه لم يجر له ذكر هاهنا .
وقوله تعالى : ( كان وعده مفعولا ) أي : كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة ، وكائنا لا محيد عنه .
وقوله: ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) يقول تعالى ذكره: السماء مثقلة بذلك اليوم متصدّعة متشققة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) يعني: تشقَّق السماء حين ينـزل الرحمن جلّ وعزّ.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: مثقلة به.
حدثنا أبو حفص الحيري، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا أبو مودود، عن الحسن، في قوله: ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: مثقلة محزونة يوم القيامة.
حدثني عليّ بن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا أبو مودود بحر بن موسى، قال: سمعت ابن أبي عليّ يقول في هذه الآية، ثم ذكر نحوه.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين، عن يزيد، عن عكرِمة ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: مثقلة به.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: موقرة مثقلة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) يقول: مثقل به ذلك اليوم.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: هذا يوم القيامة، فجعل الولدان شيبا، ويوم تنفطر السماء، وقرأ: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وقال: هذا كله يوم القيامة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: ممتلئة به، بلسان الحبشة.
حدثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن عكرِمة، ولم يسمعه عن ابن عباس ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) قال: ممتلئة به.
وذُكرت السماء في هذا الموضع لأن العرب تذكرها وتؤنثها، فمن ذكرها وجهها إلى السقف، كما يقال: هذا سماء البيت: لسقفه. وقد يجوز أن يكون تذكيرهم إياها لأنها من الأسماء التي لا فصل فيها بين مؤنثها ومذكرها؛ ومن التذكير قول الشاعر:
فَلَــوْ رَفَــعَ السَّـمَاء إلَيْـهِ قَوْمـا
لحَقْنــا بالسَّــماءِ مَــعَ السَّــحابِ (4)
وقوله: ( كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا ) يقول تعالى ذكره: كان ما وعد الله من أمر أن يفعله مفعولا لأنه لا يخلف وعده، وما وعد أن يفعله تكوينه يوم تكون الولدان شيبا يقول: فاحذروا ذلك اليوم أيها الناس، فإنه كائن لا محالة.
------------------------
الهوامش:
(4) البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن (الورقة 346) قال: وقوله: ( السماء منفطر به ) بذلك اليوم.والسماء تذكر وتؤنث، فهي هاهنا في وجه التذكير؛ قال الشاعر: "ولو رفع السماء.." البيت. وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 181) : ( السماء منفطر به ) قال أبو عمرو: ألقى الهاء؛ لأن مجازها السقف، تقول: هذا سماء البيت. وقال قوم: قد تلقى العرب من المؤنث الهاءات استغناء عنها، يقال: مهرة ضامر، وامرأة طالق، والمعنى: منفطرة.
التدبر :
وقفة
[18] ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ﴾ يا له من يومٍ تتشقق له السماوات العظمى!
وقفة
[18] ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ﴾ من الدلالات اللغوية لهذه الآية: أن السماء تُذكَّر وتؤنَّث.
وقفة
[18] ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ﴾ أرأيتَ السماء العظيمة المحكمة كيف تتصدَّع وتتشقَّق من هول القيامة، فما الظنُّ بالعبد في لُجَّة ذلك اليوم العَصيب؟!
وقفة
[18] ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ﴾ أي بذلك اليوم لشدته، وإنما لم يُؤنث صفة السماء مع أنها مؤنثة، لأنها بمعنى السقف، تقول: هذا سماءُ البيتِ أي سقفُه، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً محفوظاً﴾ [الأنبياء: 32]، أو لأنها تُذكَّرُ وتُؤنَّثُ، أو جاء (منْفَطِرٌ) على النَّسب أي ذات انفطارٍ، كامرأةٍ مرضعٍ وحائض أي ذاتُ إرضاع وٍ ذاتُ حيضٍ.
الإعراب :
- ﴿ السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ: ﴾
- الجملة الاسمية: في محل نصب صفة ثانية ليوما.السماء: مبتدأ مرفوع بالضمة. منفطر: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ولم يقل «منفطرة» لأن السماء تؤنث وتذكر أو على تأويل «السماء» بالسقف أو على السماء شيء منفطر. به: جار ومجرور متعلق بمنفطر أو بفعل من جنسه.أي تنفطر بمعنى تنشق لشدة ذلك اليوم وهوله. وفي الباء معنى الظرفية أي «فيه» يعنى يوم القيامة.
- ﴿ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا: ﴾
- فعل ماض ناقص مبني على الفتح. وعده: اسم «كان» مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. وهي من اضافة المصدر الى المفعول والضمير لليوم ويجوز أن يكون مضافا الى الفاعل وهو الله سبحانه ولم يجر له ذكر لكونه معلوما بمعنى ويتحقق وعد الله.مفعولا: خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [18] لما قبلها : وبعد إعادةِ تخويفِهم بعذابِ الآخرةِ؛ صوَّرَ اللهُ هنا بَعضَ أهوالِه؛ زيادةً في وصفِ ذلك اليوم بالشِّدَّة، قال تعالى:
﴿ السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [19] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء .. ﴾
التفسير :
{ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا}
[أي:] إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهواله، تذكرة يتذكر بها المتقون، وينزجر بها المؤمنون،{ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} أي:طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان، وأوضحه غاية الإيضاح، وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم، ومكنهم منها، لا كما يقوله الجبرية:إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل والعقل.
ثم ختم- سبحانه- هذه التهديدات بقوله: إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا.
واسم الإشارة «هذه» يعود إلى الآيات المتقدمة، المشتملة على الكثير من القوارع والزواجر.
والتذكرة: اسم مصدر بمعنى التذكير والاتعاظ والاعتبار. ومفعول «شاء» محذوف.
والمعنى: إن هذه الآيات التي سقناها لكم تذكرة وموعظة، فمن شاء النجاة من أهوال يوم القيامة، فعليه أن يؤمن بالله- تعالى- إيمانا حقا، وأن يتخذ بسبب إيمانه وعمله الصالح، طريقا وسبيلا إلى رضا ربه ورحمته ومغفرته.
والتعبير بقوله: فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ ... ليس من قبيل التخيير، وإنما المقصود به الحض والحث على سلوك الطريق الموصل إلى الله- تعالى- بدليل قوله- تعالى- قبل ذلك:
إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ أى: هذه الآيات تذكرة وموعظة، فمن ترك العمل بها ساءت عاقبته، ولم يكن من الذين سلكوا طريق النجاة.
وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ هذا، والمتأمل في هذه الآيات الكريمة، - من أول السورة إلى هنا-، يراها قد نادت الرسول صلى الله عليه وسلم نداء فيه ما فيه من الملاطفة والمؤانسة، وأمرته بأن يقوم الليل إلا قليلا متعبدا لربه، كما أمرته بالصبر على أذى المشركين، حتى يحكم الله- تعالى- بينه وبينهم.
كما يراها قد هددت المكذبين بأشد أنواع التهديد. وذكرتهم بأهوال يوم القيامة، وبما حل بالمكذبين من قبلهم، وحرضتهم على سلوك الطريق المستقيم.
وبعد هذه الإنذارات المتعددة للمكذبين، عادت السورة الكريمة إلى الحديث عن قيام الليل لعبادة الله- تعالى- وطاعته ... فقال- سبحانه-:
يقول تعالى : ( إن هذه ) أي : السورة ) تذكرة ) أي : يتذكر بها أولو الألباب ; ولهذا قال : ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أي : ممن شاء الله هدايته ، كما قيده في السورة الأخرى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ) [ الإنسان : 30 ] .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[19] ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ الهداية قرار واختيار؟ يخيِّر الله الناس بين الاهتداء بهذه الآيات المتقدمة أو الإعراض عنها، بعد أن أقام عليهم الحجة.
وقفة
[19] ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ من لم يتعظ بآيات الإنذار وما فيها من القوارع والزواجر، ويتَّخذ الطاعة والتقوى طريقًا إلى رضا مولاه، فبأيِّ شيءٍ يتَّعظ؟
عمل
[19] ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ألم يكن أبوانا في الجنة؟! إنها منازلنا الأولى؛ فلنتخذ من صالح العمل مركبًا يعيدنا إلى الوطن.
وقفة
[19] ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً﴾ إن قلتَ: إن جُعل (اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا) جوابًا فأين الشرطُ؟ قلتُ: معناه فمن شاء النَّجاة اتَّخذ إلى ربه سبيلًا، أو فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا اتَّخذ إلى ربه سبيلًا، كقوله تعالى: ﴿فمنْ شَاءَ فَلْمؤمِنْ ومَنْ شاءَ فَلْيكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، أي فمن شاء الِإيمان فلْيؤمن، ومن شاءَ الكفرَ فلْيكفرْ.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. هذه: اسم اشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم «انّ» أي انّ هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد. تذكرة: خبر «انّ» مرفوع بالضمة أي موعظة.
- ﴿ فَمَنْ شاءَ: ﴾
- الفاء: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من» شاء: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بمن. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وحذف مفعول «شاء» اختصارا. أي فمن شاء الاتعاظ.
- ﴿ اتَّخَذَ: ﴾
- الجملة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب.اتخذ: تعرب اعراب «شاء».
- ﴿ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا: ﴾
- جار ومجرور متعلق باتخذ أو بصفة محذوفة لسبيلا قدمت عليه فكان محلها حالا أي في محل نصب. سبيلا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي سبيلا الى الله بالتقوى والخشية ومعنى «اتخاذ السبيل الى الله» التقرب والتوسل بالطاعة. والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.'
المتشابهات :
| المزمل: 19 | ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |
|---|
| الانسان: 29 | ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |
|---|
| النبإ: 39 | ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [19] لما قبلها : وبعد شَرحِ أحوالِ السُّعَداءِ، ثم تهديدِ الأشقياء، ثمَّ ذكرِ أنواعًا من عذابِ الآخرةِ، ثمَّ ذكرِ عذاب الدُّنيا، ثمَّ وَصَف شِدَّة يومِ القيامةِ، فعندَ هذا تمَّ البيانُ بالكُلِّيَّةِ؛ فلا جَرَم خَتَم ذلك الكلامَ بقَولِه تعالى:
﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء