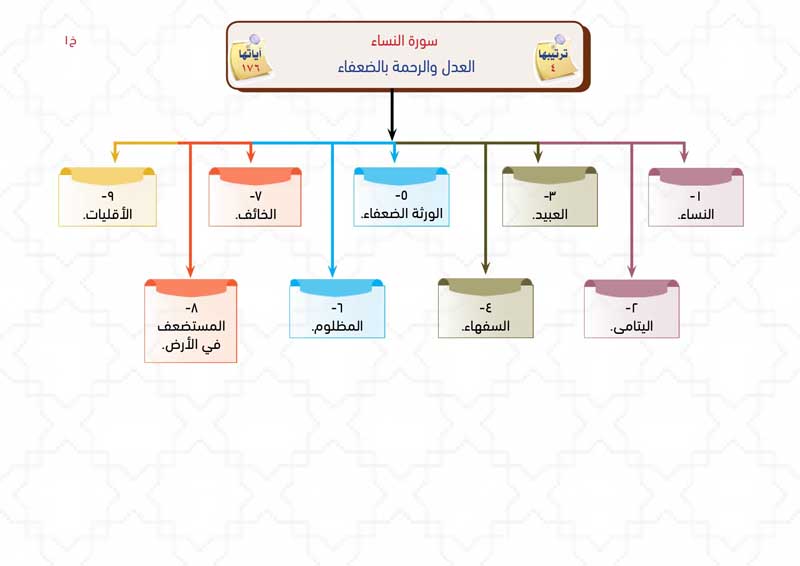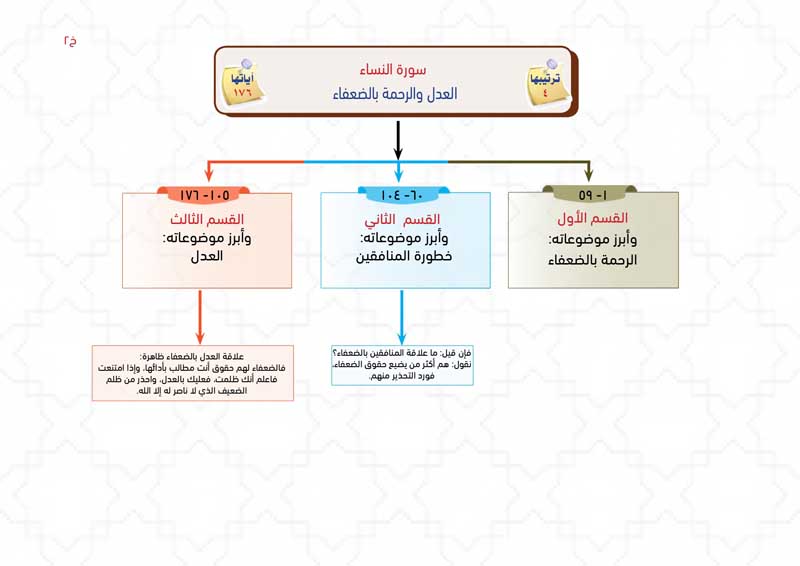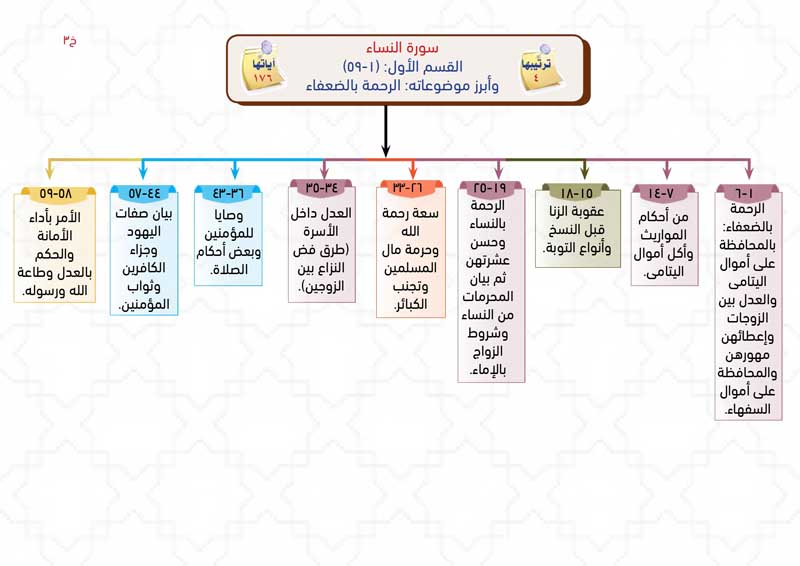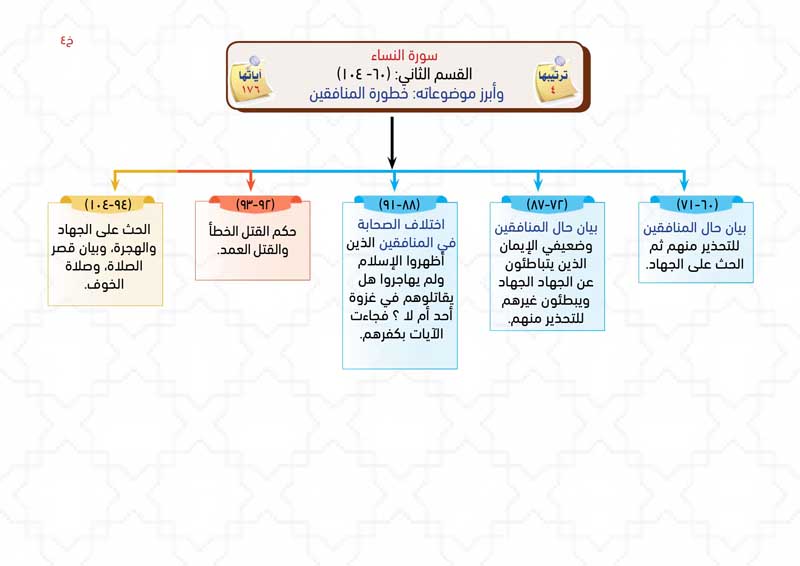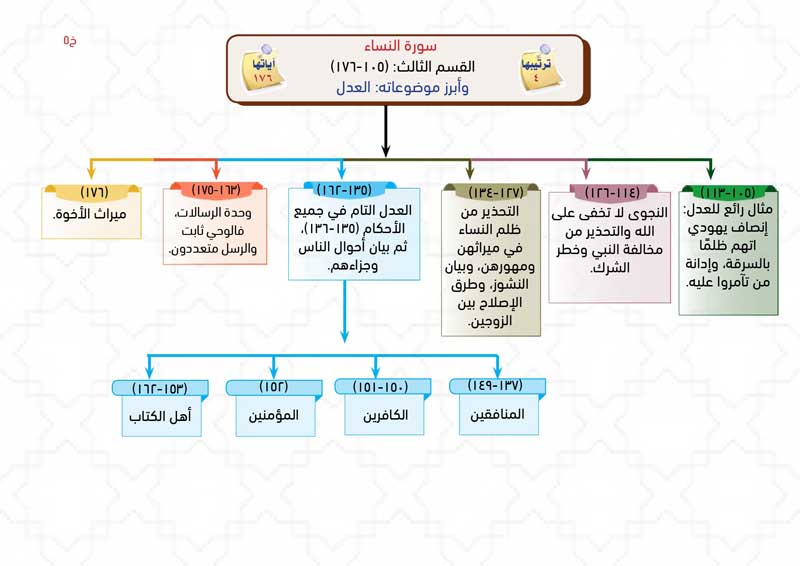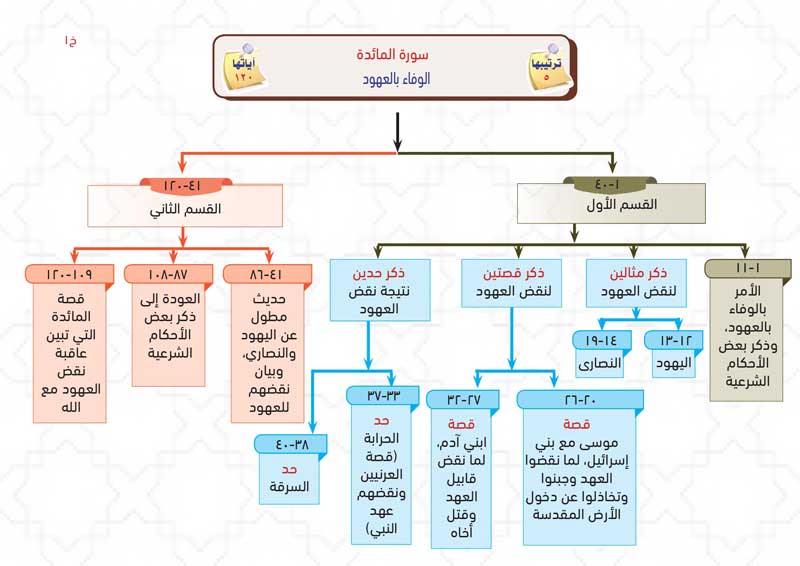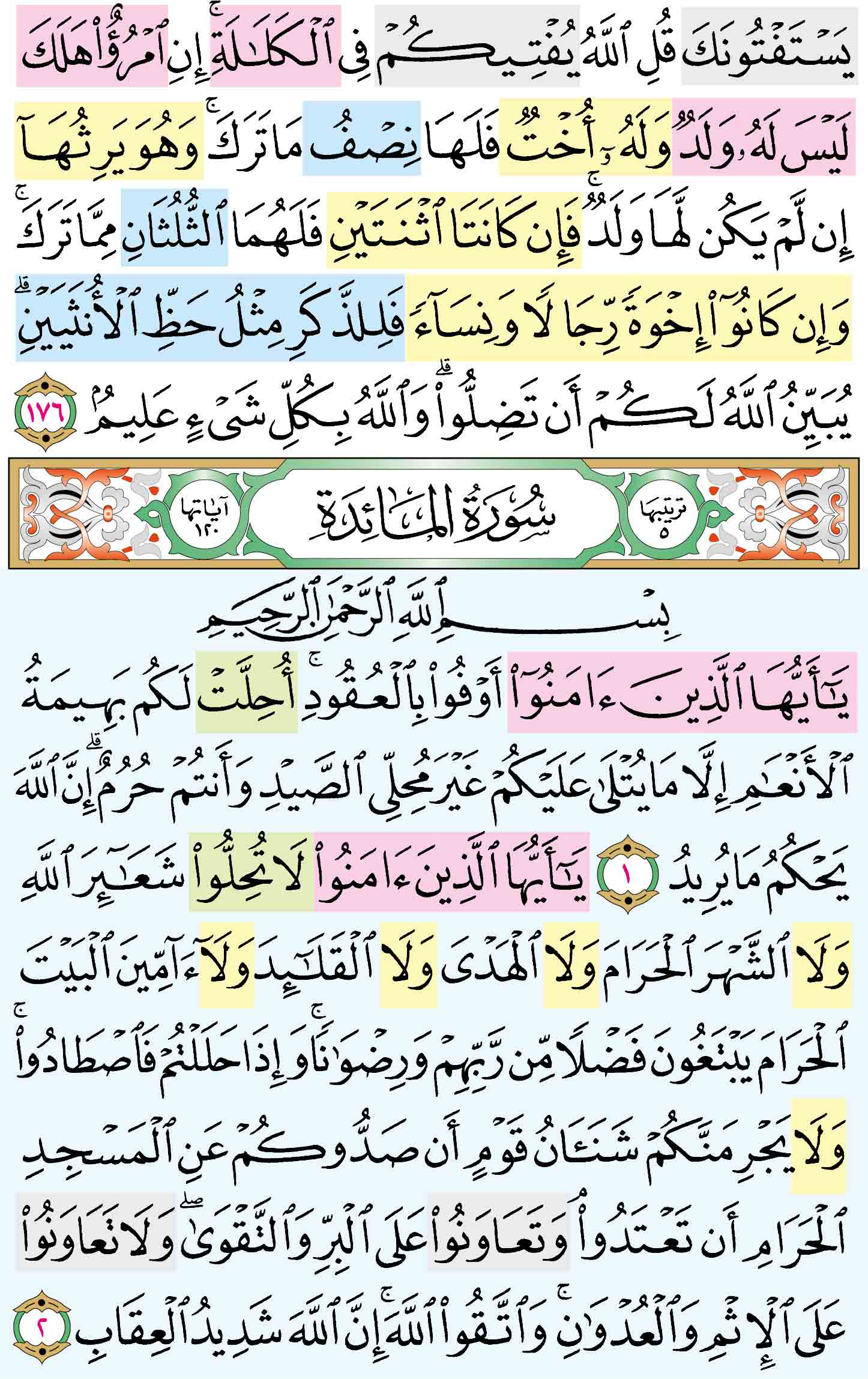
الإحصائيات
سورة النساء
| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |
| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |
| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |
| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |
| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||
سورة المائدة
| ترتيب المصحف | 5 | ترتيب النزول | 112 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 21.50 |
| عدد الآيات | 120 | عدد الأجزاء | 1.07 |
| عدد الأحزاب | 2.15 | عدد الأرباع | 8.60 |
| ترتيب الطول | 6 | تبدأ في الجزء | 6 |
| تنتهي في الجزء | 7 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 2/10 | يا أيها الذين آمنوا: 1/3 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (176) الى الآية رقم (176) عدد الآيات (1)
ختامُ السورةِ بآيةِ الكَلَالةِ، فمن ماتَ ولا ولدٌ له ولا والدٌ، وله أختٌ (شقيقةٌ أو لأبٍ) فلها النِّصفُ، فإنْ كانَ له أختانِ فلهما الثلثانِ، وإذا اجتمعَ الذكورُ معَ الإناثِ فللذكرِ مثلُ نصيبِ الأنثيينِ.
فيديو المقطع
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (2) عدد الآيات (2)
الأمرُ بالوفاءِ بالعقودِ والعهودِ، وحِلُّ بهيمةِ الأنعامِ إلا ما استثنى (في الآية 3)، وتحريمُ الصيدِ للمحرمِ، ثُمَّ النَّهيُ عن استحلالِ حرماتِ اللهِ والتي منها مناسكُ الحجِّ.
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة النساء
العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع
أولاً : التمهيد للسورة :
- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.
- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «النساء».
- • معنى الاسم :: ---
- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".
- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾
- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».
• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).
• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.
• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).
• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).
• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.
• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.
• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.
• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).
• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:
- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).
- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).
- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).
- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).
* الإسلام وحقوق النساء:
- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.
• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).
• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).
• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).
• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).
• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.
• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).
• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).
• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).
• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).
• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).
• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).
• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).
• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).
• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).
• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).
• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).
• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.
• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).
• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).
• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).
• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).
• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.
• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).
• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).
• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).
• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).
• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).
• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).
سورة المائدة
الوفاء بالعهود والمواثيق/ الحلال والحرام.
أولاً : التمهيد للسورة :
- • ما "المائدة" التي سميت بها السورة؟: الحواريون (أصحاب عيسى عليه السلام الخُلَّص) طلبوا من عيسى عليه السلام أن يدعو اللهَ أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ليأكلوا منها وتزداد قلوبهم اطمئنانًا إلى أنه صادق فيما يبلغه عن ربه: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (112-113)، فاستجاب عيسى عليه السلام لهم ودعا ربه، فوعده الله بها، وأخذ عليهم عهدًا وحذرهم من نقضه: أن من كفر بعد نزولها ولم يؤمن فسوف يعذبه عذابًا شديدًا: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (115). وهذا توجيه وتحذير للمسلمين بأن عليهم الوفاء بالعهود والمواثيق، وإلا سيكون العذاب جزاؤهم كما في قصة المائدة. السورة تنادي: - التزموا بالعقود التي ألزمكم الله بها، وأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه. - احذروا من التهاون بهذه العقود أو إضاعتها كما حصل من اليهود والنصارى.
- • هدف السورة واضح من أول نداء: لجاء في السورة: ﴿يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ أي أوفوا بعهودكم، لا تنقضوا العهود والمواثيق.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «المائدة».
- • معنى الاسم :: المائدة: الخِوَانُ الموضوع عليه طعام، والعرب تقول للخُوان إذا كان عليه طعام: مائدة، فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة.
- • سبب التسمية :: لورود قصة المائدة بها.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة العقود»؛ لافتتاحها بطلب الإيفاء بالعقود، و«المنقذة»، و«الأحبار».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الوفاء بالعقود مع الله، ومع الناس، ومع النفس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾
- • علمتني السورة :: أن الأخلاق الفاضلة هي أثر للعقيدة الصحيحة والتشريعات الحكيمة.
- • علمتني السورة :: أن الإنسان غال عند ربه، من أجل ذلك شرع الله الشرائع التي تضبط حياته، وتصون حرمته ودمه وماله (سورة المائدة أكثر سورة ذكرًا لآيات الأحكام).
- • علمتني السورة :: أنه ينبغي على الدعاة أن يبدأوا مع الناس بما أبيح أولًا، ثمّ يبينوا المحرّمات بعد ذلك، لكي يكسبوا القلوب: ﴿يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلاْنْعَامِ﴾ (1)، فلم يبدأ ربنا بما قد حُرِّم لكي لا ينفروا، فكلمة ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ توحي بأن الخطاب بعدها شديد اللهجة، فتأتي مباشرة كلمة ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾ وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة.
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا».
• عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (118)، فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا»، قَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا».
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة المائدة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.
• عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (3)؛ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا»، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ».
• قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: «الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ، وَفِيهَا ثَمَانِ عَشْرَةَ فَرِيضَةً لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا».
خامسًا : خصائص السورة :
- • هي الأكثر ذكرًا لآيات الأحكام.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تبدأ بنداء المؤمنين: ﴿يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ﴾ من أصل 3 سور افتتحت بذلك، وهي: «المائدة، والحجرات، والممتحنة».
• آخر سورة نزلت بالأحكام الشرعية.
• تمتاز بالمواجهة الشديدة مع أهل الكتاب، فهي أكثر السور تكفيرًا لليهود والنصارى.
• أكثر السور تأكيدًا على أن التشريع حق لله تعالى وحده، حيث خُتِمت ثلاث آيات بالتحذير من الحكم بغير ما أنزل الله، وهي: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (44)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (45)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (47).
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نفي بالعقود والعهود مع الله، ومع الناس، ومع النفس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾ (1).
• أن نتعاون دومًا على البر والتقوى، ففي التقوى رضى الله، وفي البر رضى الناس.
• أن ندرس بابَ الأطعمةِ من أحد كتبِ الفقه لنتعلَّمَ ما يُبَاح وما يحْرُم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ...﴾ (3).
• أن نزور أحد المرضى ونعلمه صفة التيمم: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (6).
• أن نتوخي العدل دائمًا؛ حتى في معاملة المخالفين: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (8).
• أن نفوض أمورنا إلى الله تعالى، ونعتمد عليه، ونفعل الأسباب، ولا نعتمد عليها: ﴿وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (11).
• ألا نُظهِر البلاء على ألسنتنا؛ فالبلاء موكّل بالمنطق، فاليهود لما قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (النساء 155)، أي لا تعي شيء، حلّ بهم البلاء: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ (13).
• أن نجمع بين البشارة والنذارة أثناء دعوة الناس إلى الله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (19).
• أن نعدد ثلاثًا من النعم التي اختصنا الله بها دون أقراننا، ونشكره عليها: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ﴾ (20).
• ألا يغيب عنا التفاؤل أبدًا: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ (23).
• أن نحذر الحسد؛ لأنه صفة ذميمة تؤذي صاحبها وتجره إلى معصية الله، وتجعله يسخط ويعترض على ربه، فهو أول ذنب عُصي الله به في السماء والأرض: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ ...﴾ (27).
• أن نشدد العقوبة بحق من يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق؛ حتى نمنع مجرمين آخرين من الظهور: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ ...﴾ (33).
• أن نشتغل بالإصلاح بعد التوبة؛ لأن هذا سبب لقبولها: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّـهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (39).
• أن نحدد أمورًا تتطهر بها قلوبنا، ثم نفعلها، ونتحل بها؛ مثل: حسن الظن، والعفو: ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّـهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ (41).
• أن نسبق اليوم غيرنا إلى نوع من الطاعات؛ كالصف الأول، والصدقة لمضطر محتاج، أو غيرها من أبواب الخير: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (48).
• ألا نتخذ اليهود والنصارى أولياء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ...﴾ (51).
• أن نتذكّر قول الله: ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ (54) عندما نرى من أقراننا من هو أفضل منا فهمًا أو علمًا أو مالًا أو نعمة.
• أن نحفظ ألسنتنا عن كثرة الحلِف: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (89).
• أن نتجنب الخمر والميسر والأزلام والأنصاب، ونبين للناس حرمة ذلك: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...﴾ (90).
• أن نحدد بعض المنكرات ونبلغ الناس حكم الله فيها: ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (99).
• ألا نسأل عن الأمور التي لا فائدة من وراءها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (101).
• أن نكتب الوصية قبل النوم، وننصح غيرنا بذلك، ونبين لهم أهمية كتابة الوصية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (106).
• أن نحذر أشد الحذر من كفران النعم، فإن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (115).
• أن نسأل الله كثيرًا أن يرزقنا الصدق في القول والعمل: ﴿قَالَ اللَّـهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (119).
تمرين حفظ الصفحة : 106
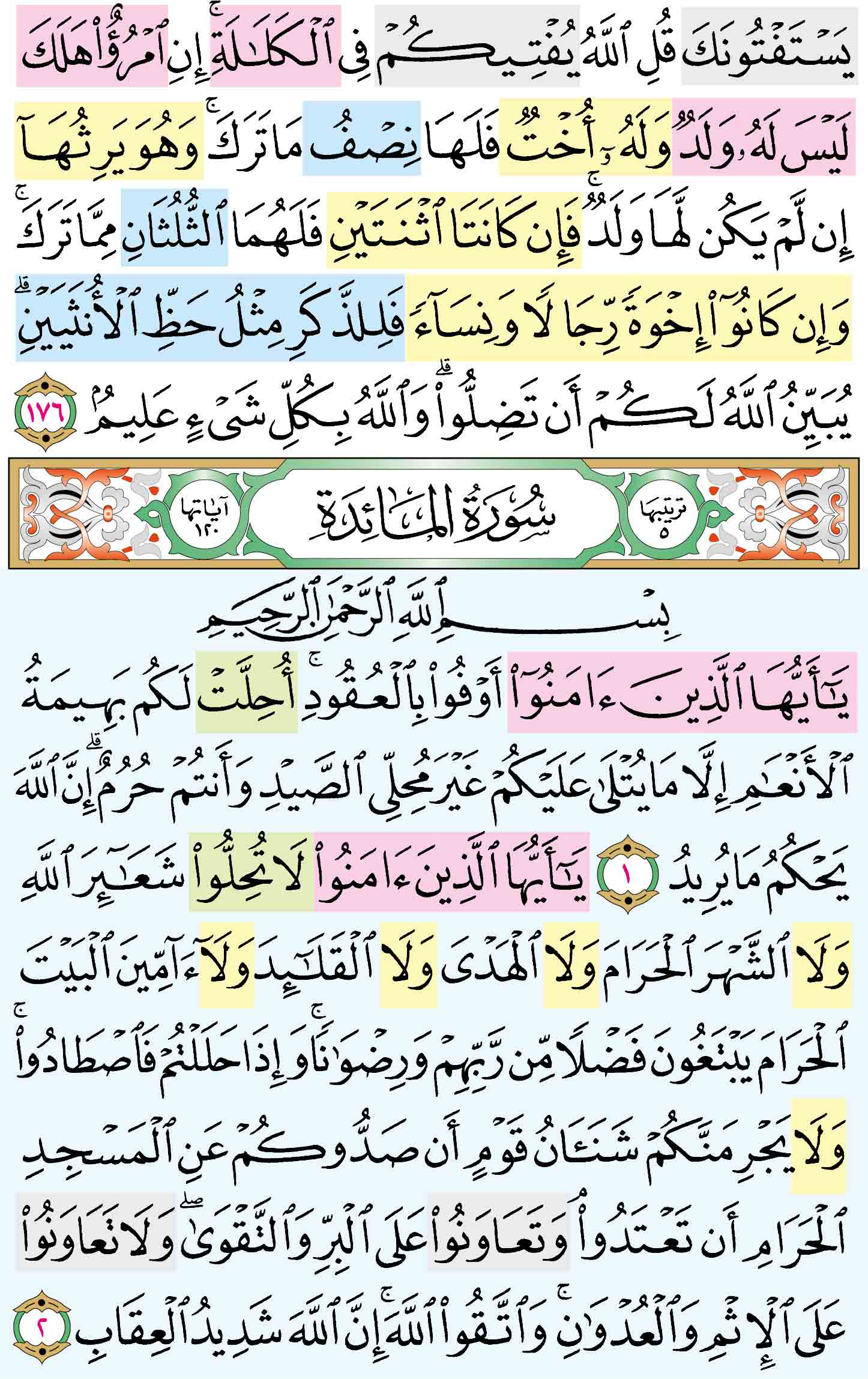
مدارسة الآية : [176] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي .. ﴾
التفسير :
أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي:في الكلالة بدليل قوله:{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ْ} وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولهذا قال:{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ْ} أي:لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد{ وَلَهُ أُخْتٌ ْ} أي:شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها.{ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ْ} أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم.{ وَهُوَ ْ} أي:أخوها الشقيق أو الذي للأب{ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ْ} ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض.{ فَإِن كَانَتَا ْ} أي:الأختان{ اثْنَتَيْنِ ْ} أي:فما فوق{ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ْ} أي:اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث{ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ} فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن.{ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ْ} أي:يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم.{ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ْ} أي:عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر.
أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ فصب على أو قال: صبوا عليه. فعقلت فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة. فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. وفى بعض الألفاظ فأنزل الله آية الميراث { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ } الآية. وفى رواية قال جابر: نزلت فى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ }.
ويبدو أن عدداً من الصحابة قد سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن ميراث الكلالة فى أزمنة متفرقة فنزلت هذه الآية للأجابة عن أسئلتهم المتعلقة بها. وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف، لأنها نزلت فى هذا الوقت.
قال القرطبى: " قال عمر: إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لى فيها، حتى طعن بإصبعه فى جنبى أو فى صدرى ثم قال: " يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء " ".
وقوله: { يَسْتَفْتُونَكَ } من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى. يقال: استفتيت العالم فى مسألة كذا. أى: سألته أن يبين حكمها. فالإِفتاء معناه: إظهار المشكل من الأحكام وتبينه.
والكلالة.. كما يقول الراغب -: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وروى " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: " من مات وليس له ولد ولا والد " ، فجعله اسما للميت. وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد ".
وقال ابن كثير ما ملخصه: وكان - رضى الله عنه - يقول: الكلالة من لا ولد له. وكان أبو بكر - رضى الله عنه - يقول: الكلالة ما عدا الولد والوالد.
ثم قال: وعن عمر أنه قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر. وهذا الذى قاله الصديق، هو الذى عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة فى قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذى يدل عليه القرآن.
وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين فى هذه السورة.
أما المرة الأولى ففى قوله - تعالى -. فى آيات المواريث:
{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ }
وقد بينا عند تفسيرنا لهذه الجملة الكريمة أن المراد بالإِخوة والأخوات فيها: الإِخوة لأم والأخوات لأم.
أما هنا فالأمر يختلف إذا المراد بالإِخوة والأخوات فى الآية التى معنا: الإِخوة والأخوات الأشقاء أو من الأب فقظ.
والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد فى كيفية ميراث الكلالة، قل الله يفتيكم فى ذلك، فاسمعوا حكمه وأطيعوه ولا تخالفوه.
وقوله { فِي ٱلْكَلاَلَةِ } متعلق بقوله { يُفْتِيكُمْ }.
وقد تولى - سبحانه - الإِجابة مع أن المسئول هو النبى صلى الله عليه وسلم، للتنويه بشأن الحكم المسئول عنه، ولتأكيد أن المواريث من الأمور التى تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده، فلا يصح لأحد أن يخالف ما شرعه الحكيم الخبير فى شأنها فهو - سبحانه - أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من آبائهم ومن أبنائهم، ومن كل مخلوق.
وقوله: { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } كلام مستأنف مبين للاجابة عما سألوا عنه فى شأن ميراث الكلالة.
والمختار الذى عليه المحققون من العلماء أن الولد هنا عام يتناول الذكر والأنثى، لأن الكلام فى الكلالة وهو من ليس له ولد أصلا ولا ذكر ولا أنثى وليس له والد - أيضا إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقة بظهور الأمر. ولأن الولد مشترك معنوى وقع نكرة فى سياق النفى فيعم الإِبن والبنت.
وقيل: المراد بالولد هنا الذكر خاصة لأنه المتبادر من معنى اللفظ.
والمراد بالأخت هنا - كما سبق أن أشرنا - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد عن توريث الكلالة فقل لهم: الله يفتيكم فى ذلك، إذا مات إنسان ولم يترك أولاداً لا من الذكور ولا من الإِناث. ولم يترك كذلك والداً، وترك أختا شقيقة أو من أبيه، فلأخته فى تلك الحالة نصف ما تركه هذا الميت بالفرض، والباقى للعصبة، أولها بالرد إن لم يترك عصبة.
وإذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم يكن لها ولد - ذكراً كان أو أنثى -، ولم يكن لها كذلك والد، فإن الأخ فى تلك الحالة يحرز جميع مالها.
وقوله: { ٱمْرُؤٌ } مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده أى: إن هلك امرؤ وقوله: { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } فى محل رفع على أنه صفة لقوله { ٱمْرُؤٌ } أى: هلك امرؤ غير ذى ولد ولا والد.
والفاء فى قوله { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } واقعة فى جواب الشرط.
وقوله { وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } جملة مستأنفة. سدت مسد جواب الشرط فى قوله: { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ }.
قال الألوسى: والآية كما أنها لم تدل على سقوط الإِخوة بغير الولد، فإنها لم تدل على عدم سقوطهم به. وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب. إذ صح عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر "
ولا ريب فى أن الأب أولى من الأخ. وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة.
ثم بين - سبحانه - صورتين أخريين من صور الكلالة فقال: { فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } أى: فإن كانتا أى: الوارثتان بالأخوة اثنتين أو أكثر، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى، وإن كان الورثة لهذا الأخ المتوفى إخوة من الرجال والنساء ففى هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإِخوة والأخوات للميت الذى لم يترك ولدا ولا والدا. أى الميت الكلالة.
1- أن يموت الميت وترثه أخت واحدة. ففى هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقى للعصبة إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد.
2- أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد. فيكون له جميع تركتها.
3- أن يكون الميت أخا وأختا والوارث أختان فصاعدا، ففى هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان.
4- أن يكون الميت أخا أو أختا، والورثة عدد من الإخوة والأخوات، ففى هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا، وظاهر الآية يفيد أن لا فرق بين الإِخوة الأشقاء والإِخوة لأب فى أنهم يشتركون فى التركة إذا اجتمعوا؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد، فقد خصصت السنة هذا العموم، فقدمت الأشقاء على الإِخوة لأب. فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإِخوة الأشقاء الإِخوة لأب.
وقد تكفلت كتب الفروع ببسط الكلام عن هذه الأحكام وأمثالها. هذا، وقوله - تعالى - { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } تذييل قصد به إظهار جانب من فضل الله - تعالى - على عباده، وتحذيرهم من مخالفة شرعه وأمره.
أى: يبين الله لكم هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث كما يبين لكم غيرها خشية أن تضلوا طريق الحق فى ذلك. بأن تعطوا من لا يستحق أو تهملوا من يستحق، والله - تعالى - عليم بكل شئ لا تخفى عليه خافية من أحوالكم، وسيحاسبكم على أعمالكم، فيجازى المتبع لشرعة بالثواب العظيم، ويجازى المخالف له بالعذاب الأليم.
والمفعول فى قوله: { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ } محذوف، والمصدر المنسبك من أن والفعل مفعول لأجله بتقدير مضاف محذوف أى: يبين الله لكم الحلال والحرام وجميع الأحكام خشية أن تضلوا.
ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول قوله { يُبَيِّنُ } أى: يبين الله لكم ضلالكم لتجتنبوه، فإن الشر يعرف ليجتنب، والخير يعرف ليفعل.
ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير (اللام ولا) فى طرفى " أن " والمعنى: يبين الله لكم ذلك لئلا تضلوا.
ثم أما بعد: فهذا تفسير وسيط لسورة النساء.
تلك السورة التى نظمت المجتمع الإِسلامى تنظيما دقيقا حكيما.
نظمته فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية، ونظمته فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية. أما فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية، فقد رأينا فيما سبق، كيف ساقت الأحكام والآداب والتوجيهات التى تكون مجتمعا فاضلا، يعرف الفرد فيه واجبة نحو خالقه، وواجبه نحو نفسه، وواجبه نحو غيره.
مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان، والمحبة والمودة والوئام.
مجتمعا رجاله يكرمون نساءه، ويعطفون عليهن، ويعاشروهن بالمعروف. ونساؤه يحترمن رجاله، ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدب، وعفة، وإخلاص، ووفاء.
مجتمعا حكامه يحكمون بالعدل، ويراقبون الله فى أقوالهم وأعمالهم. المحكومون فيه يطيعيون حكامهم فيما يأمرونهم به من حق وخير.
مجتمعا يرى أفراده أن خيراته وأمواله. هى أمانة فى أعناقهم جميعا، وأن ثمارها ومنافعها ستعود عليهم جميعا. لذا فهم يحرصون على استغلال ما يملكونه منها فيما يرضى الله، وفيما يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير والصلاح والاستغناء والفلاح.
وأما فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية، فقد رأينا - أيضا - فيما سبق، كيف كشفت النقاب عن راذائل المنافقين. وعن العقائد الفاسدة التى يتشبث بها أهل الكتاب. وعن المسالك الخبيثة، والوسائل المتعددة التى اتبعها هؤلاء جميعا لكيد الدعوة الإسلامية والإساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
كما رأينا كيف أنها قد حذرت المؤمنين من شرور أعدائهم، وبصرتهم بما يجب عليهم نحوهم. وبما يجعلهم دائما على أتم استعداد لمقاومتهم، ولتأديبهم ولرد كيدهم فى نحوهم.
ولقد ساقت السورة الكريمة من الآيات التى ترغب فى الجهاد فى سبيل الله، ما يجعل المؤمنين يقبلون عليه بقلوب منشرحة، وبعزائم ثابتة، وبأرواح غايتها الشهادة فى سبيل الله.
وباتباع المسلمين السابقين لهذا التوجيه الحكيم الذى اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، نالوا ما نالوا من مجد وسؤدد، وظفروا بما ظفروا به من عزة وسعادة، وأصابوا ما أصابوا من خير وفلاح.
وأخيرا، فإنى أحمد الله - تعالى - حمدا كثيرا على توفيقه لى لخدمة كتابه، وأضرع إليه بإخلاص أن يعيننى على إتام ما بدأته من خدمة كتابه، إنه أعظم مسئول وأكرم مأمول.
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت : " براءة " ، وآخر آية نزلت : ( يستفتونك ) .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا مريض لا أعقل ، قال : فتوضأ ، ثم صب علي - أو قال صبوا عليه - فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ قال : فنزلت آية الفرائض .
أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به . وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآية .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان وقال ابن الزبير قال - يعني جابرا - : نزلت في : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) .
وكأن معنى الكلام - والله أعلم - ( يستفتونك ) : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيها ، فدل المذكور على المتروك .
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها ، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ; ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والد ، ومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه هذه الآية : ( إن امرؤ هلك ) [ أي مات ] ( ليس له ولد ) .
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا .
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال : " يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " .
هكذا رواه مختصرا وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا .
طريق أخرى : قال [ الإمام ] أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مالك - يعني ابن مغول - سمعت الفضل بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال : " يكفيك آية الصيف " . فقال : لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر ، فإنه لم يدركه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ، فقال : " يكفيك آية الصيف " . وهذا إسناد جيد ، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش ، به . وكأن المراد بآية الصيف : أنها نزلت في فصل الصيف ، والله أعلم .
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها - فإن فيها كفاية - نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ; ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا جرير عن الشيباني ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال : " أليس قد بين الله ذلك ؟ " فنزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] ) الآية . وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق [ رضي الله عنه ] قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض ، أنزلها الله في الولد والوالد . والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم . والآية التي ختم بها " سورة النساء " أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها " سورة الأنفال " أنزلها في أولي الأرحام ، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، مما جرت الرحم من العصبة . رواه ابن جرير .
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان ، وعليه التكلان :
قوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ) أي : مات ، قال الله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ] كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله ، عز وجل ، كما قال : ( كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن : 26 ، 27 ] .
وقوله : ( ليس له ولد ) تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد ، وهو رواية عن عمر بن الخطاب ، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه من لا ولد له ولا والد ، ويدل على ذلك قوله : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) ولو كان معها أب لم ترث شيئا ; لأنه يحجبها بالإجماع ، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ، ولا والد بالنص عند التأمل أيضا ; لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد ، بل ليس لها ميراث بالكلية .
وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن مكحول وعطية وحمزة وراشد ، عن زيد بن ثابت : أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف . فكلم في ذلك ، فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك .
تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت ، وخالفهما الجمهور ، فقالوا في هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض ، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب ، بدليل غير هذه الآية وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة ، وأما وراثتها بالتعصيب ; فلما رواه البخاري من طريق سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت . ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني . فسئل ابن مسعود - وأخبر بقول أبي موسى - فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وقوله : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) أي : والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة ، وليس لها ولد ، أي : ولا والد ; لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا ، فإن فرض أن معه من له فرض ، صرف إليه فرضه ; كزوج ، أو أخ من أم ، وصرف الباقي إلى الأخ ; لما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " .
وقوله : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أي : فإن كان لمن يموت كلالة ، أختان ، فرض لهما الثلثان ، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات ، في قوله : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .
وقوله : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم ، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين .
وقوله : ( يبين الله لكم ) أي : يفرض لكم فرائضه ، ويحد لكم حدوده ، ويوضح لكم شرائعه .
وقوله : ( أن تضلوا ) أي : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان . ( والله بكل شيء عليم ) أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده ، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى .
وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب ، حدثني ابن علية ، أنبأنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين قال : كانوا في مسير ، ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة . قال : ونزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ، فلقاها حذيفة عمر ، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال : والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها ، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا . قال : فكان عمر [ رضي الله عنه ] يقول : اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي .
كذا رواه ابن جرير . ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة ، وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في : حدثنا يوسف بن حماد المعني ، ومحمد بن مرزوق قالا : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه : " نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة ، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم ، فلقاها إياه ، فنظر حذيفة فإذا عمر ، رضي الله عنه ، فلقاها إياه ، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة ، فدعا حذيفة فسأله عنها ، فقال حذيفة : لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني ، والله إني لصادق ، ووالله لا أزيد على ذلك شيئا أبدا .
ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى .
وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد - [ هو ] ابن المسيب - أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة ؟ قال : فأنزل الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] ) الآية ، قال : فكأن عمر لم يفهم . فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها ، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها ، فقال : " أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها " . قال : وكان عمر يقول : ما أراني أعلمها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال .
رواه ابن مردويه ، ثم رواه من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس : أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فأملاها عليها في كتف ، فقال : " من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها ، أوما تكفيه آية الصيف ؟ " قال سفيان : وآية الصيف التي في النساء : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء ، فألقى عمر الكتف . كذا قال في هذا الحديث ، وهو مرسل .
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : " أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن . فخرجت حينئذ حية من البيت ، فتفرقوا ، فقال : لو أراد الله ، عز وجل ، أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا إسناد صحيح .
وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، حدثنا الهيثم بن خالد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا : نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة ، عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال : سمعت سليمان الأحول يحدث ، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت : قلت : وما قلت ؟ قال : قلت : الكلالة ، من لا ولد له . ثم قال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .
وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة ، والقول ما قلت . قال : وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأب وللأم ، وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا ، وخالفه أبو بكر ، رضي الله عنهما .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا محمد بن حميد المعمري ، عن معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا ، فمكث يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه ، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ، ولم يدر أحد ما كتب فيه . فقال : إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا ، وكنت استخرت الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه .
قال ابن جرير : وقد روي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر . وكأن أبو بكر ، رضي الله عنه ، يقول : هو ما عدا الولد والوالد .
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ، في قديم الزمان وحديثه ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة . وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذي يدل عليه القرآن ، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله : ( يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) .
القول في تأويل قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
يعني تعالى ذكره بقوله: " يستفتونك "، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة. (1)
* * *
وقد بينا معنى: " الكلالة " فيما مضى بالشواهد الدالة على صحته، وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيه، فأغنى ذلك عن إعادته، وبيّنا أن " الكلالة " عندنا: ما عدا الولد والوالد. (2)
* * *
=" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، يعني بقوله: " إن امرؤ هلك "، إن إنسان من الناس مات، (3) كما:-
10864- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " إن امرؤ هلك "، يقول: مات.
* * *
=" ليس له ولد " ذكر ولا أنثى=" وله أخت "، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه=" فلها نصف ما ترك "، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة التي وَصَفنا، نصف تركته ميراثًا عنه، دون سائر عصبته. وما بقي فلعصبته.
* * *
وذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هَّمهم شأن الكلالة، فأنـزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية.
*ذكر من قال ذلك:
10865- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فسألوا عنها نبيَّ الله، فأنـزل الله في ذلك القرآن: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ"، فقرأ حتى بلغ: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . قال: وذكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنـزل الله في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها " سورة النساء "، أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها " سورة الأنفال "، أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة. (4)
10866- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بيَّن الله ذلك؟ قال: فنـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (5)
10867- حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي= أو: سبْع، أنا أشكّ (6) = فدخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت وقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ (7) قال: أحسن! قلت: الشطر؟ قال: أحسن! ثم خرج وتركني، ثم رجع إليّ فقال: &; 9-432 &; يا جابر، إنِّي لا أُرَاك ميتًا من وجعك هذا، (8) وإن الله قد أنـزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنـزلت هذه الآية فيّ: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (9)
10868- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام= يعني الدستوائي= عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (10)
10869- حدثني المثنى قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجدوني قد أغمي عليّ، (11) فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ عليّ من وَضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي= أو: كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد.
قال: فلم يجبني شيئًا حتى نـزلت آية الميراث: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " إلى آخر السورة= قال ابن المنكدر: قال جابر: إنما أنـزلت هذه الآية فيّ. (12)
* * *
وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الآية هي آخر آية نـزلت من القرآن.
*ذكر من قال ذلك:
10870- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: سمعته يقول: إن آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (13)
10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (14)
10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (15)
10873- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال، حدثنا مصعب بن المقدام قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر سورة نـزلت كاملة " براءة "، وآخر آية، نـزلت خاتمة " سورة النساء ": " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (16)
* * *
واختلف في المكان الذي نـزلت فيه الآية.
فقال جابر بن عبد الله: نـزلت في المدينة. وقد ذكرت الرواية بذلك عنه فيما مضى، بعضها في أول السورة عند فاتحة آية المواريث، وبعضها في مبتدإ الأخبار عن السبب الذي نـزلت فيه هذه الآية. (17)
* * *
وقال آخرون: بل أنـزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
*ذكر من قال ذلك:
10874- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، والنبيّ في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلَّغها النبي صلى الله عليه وسلم حُذيفة، وبلّغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه. فلما استُخلف عمر سأل عنها حذيفة، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدِّثك فيها بما لم أحدِّثك يومئذ! فقال عمر: لم أرِد هذا، رحمك الله!
10875- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين بنحوه= إلا أنه قال في حديثه: فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننتَ.
10876- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأسُ راحلة حذيفة عند رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم (18) ورأس راحلة عمر عند رِدْف راحلة حذيفة. قال: ونـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فلقَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقّاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك، سأل عمرُ عنها حذيفةَ فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَّيْتُكها كما لقَّانيها، (19) والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا! قال: وكان عمر يقول: اللهم مَن كنتَ بيّنتها له، (20) فإنها لم تُبَيَّن لي. (21)
* * *
واختلف عن عمر في الكلالة، فروي عنه أنه قال فيها عند وفاته: " هو من لا ولد له ولا والد ". وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فيما مضى في أول هذه السورة في آية الميراث. (22)
* * *
وروي عنه أنه قال قبل وفاته: هو ما خلا الأب. (23)
*ذكر من قال ذلك:
10877- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال، قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم= أو: ما نازعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صَدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنـزلت في آخر " سورة النساء ": (24) " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، هو ما خلا الأب= كذا أحسب قال ابن عرفة= قال شبابة: الشك من شعبة. (25)
* * *
وروي عنه أنه قال: " إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر "، وكان أبو بكر يقول: " هو ما خلا الولد والوالد ". وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فيما مضى في أول السورة (26)
* * *
وروي عنه أنه قال عند وفاته: " قد كنت كتبت في الكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، وقد رأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "، وأنه كان يتمنى في حياته أن يكون له بها علم.
*ذكر من قال ذلك:
10878- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: " اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه "، حتى إذا طُعِن، دعا بكتاب فَمُحي، (27) فلم يدر أحدٌ ما كتب فيه، فقال: " إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ". (28)
10879- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، بنحوه. (29)
10880- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان قال، حدثنا عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني قال، قال عمر: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنهن لنا، أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، وأبواب الربا. (30)
10881- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش قال: سمعتهم يذكرون، ولا أرى إبراهيم إلا فيهم، عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة، أحبُّ إليّ من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. (31)
10882- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتِفًا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاءً تحدَّثُ به النساء في خدورهن! فخرجت حينئذ حيَّة من البيت، فتفرَّقوا، فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمَّه. (32)
10883- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أبو حيان قال، حدثني الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة، فقال: أيها الناس، ثلاثٌ ودِدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارِقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا يُنتهى إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب الربا. (33)
10884- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر " سورة النساء ". (34)
10885- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن عمر قال: لن أدع شيئًا أهمَّ عندي من أمر الكلالة، فما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري= أو قال: في جنبي= فقال: تكفيك الآية التي أنـزلت في آخر " النساء ". (35)
10886- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنيّ والله ما أدع بعدي شيئًا هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن في نحري وقال: " تكفيك آية الصيف التي أنـزلت في آخر سورة النساء "، وإن أعِش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحدٌ قرأ القرآن. (36)
10887- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمر بن الخطاب بنحوه. (37)
10888- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، سمعت أبي يقول، أخبرنا أبو حمزة، عن جابر، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه قال: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي وَرِث كلالة، فقال: الكلالة، الكلالة، الكلالة!! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمَها أحبَّ إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. (38)
10889- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة، فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً إلى آخر الآية؟ (39)
10890- حدثني محمد بن خلف قال، حدثنا إسحاق بن عيسى قال، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير: أن رجلا سأل عُقبة عن الكلالة، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة! (40)
* * *
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله جل ثناؤه: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة= ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما= على أن الميت لو ترك ابنةً وأختًا، أن لابنته النصف، وما بقي فلأختِه، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، وقد ورَّثوها النصف مع الولد؟
قيل: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتَ إليه. إنما جعل الله جل ثناؤه بقوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى، وكان موروثًا كلالة، النصفَ من تركته فريضةً لها مسمَّاة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عصبة، يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرضَ سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميِّتهم. ولم يقل الله في كتابه: " فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه "، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجَّه إليه. وإنما بيَّن جل ثناؤه، مبلغ حقِّها إذا وُرث الميت كلالةً، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالةً في كتابه، وبيَّنه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت. وذلك معنًى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثًا كلالةً.
* * *
القول في تأويل قوله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله، إذا وُرِثت كلالة، (41) ولم يكن لها ولد ولا والد.
* * *
القول في تأويل قوله : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " فإن كانتا اثنتين "، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه=" اثنتين " فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إذا لم يكن له ولد، وورث كلالة=" وإن كانوا إخوة "، يعني: وإن كان المتروكون من إخوته=" رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته=" مثل حظ الأنثيين "، يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته. (42) وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه.
* * *
القول في تأويل قوله : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم=" أن تضلوا "، بمعنى: لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فتضلّوا عن قصد السبيل، (43) كما:-
10891- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، قال: في شأن المواريث.
10892- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري= وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق= قالا جميعًا، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا قرأ: " يبين الله لكم أن تضلوا " قال: اللهم مَنْ بَيَّنت له الكلالة، فلم تُبَيَّن لي. (44)
* * *
قال أبو جعفر: وموضع " أن " في قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، نصبٌ، في قول بعض أهل العربية، لاتصالها بالفعل.
* * *
وفي قول بعضهم: خفضٌ، بمعنى: يبين الله لكم بأن لا تضلوا، ولئلا تضلوا= وأسقطت " لا " من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، لدلالة الكلام عليها. والعرب تفعل ذلك، تقول: " جئتك أن تلومني"، بمعنى: جئتك أن لا تلومني، كما قال القطامي في صفة ناقة:
رَأَيْنَــا مَـا يَـرَى البُصَـراءُ فِيهَـا
فَآلَيْنَــــا عَلَيْهـــا أَنْ تُبَاعَـــا (45)
بمعنى: أن لا تباع.
* * *
القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " والله بكل شيء " من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها، وجميع الأشياء=" عليم "، يقول: هو بذلك كله ذو علم. (46)
* * *
(آخر تفسير سورة النساء)
والحمد الله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله وسلم
-------------------------
الهوامش :
(1) انظر تفسير"يستفتي" فيما سلف ص : 253.
(2) انظر ما سلف في"الكلالة" 8 : 53-61.
(3) انظر تفسير"المرء" فيما سلف 2 : 446.
(4) الأثر: 10865- هذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 31 ، وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 42 ، والدر المنثور 2 : 251.
(5) الأثر: 10866- ذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 42 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.
(6) في المطبوعة: "أبو جعفر الذي يشك" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(7) في المطبوعة: "بالثلث" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الموافق لرواية البيهقي ، أما رواية أبي داود في سننه ، فهي التي أثبتت في المطبوعة.
(8) "لا أراك" بالبناء للمجهول (بضم الهمزة): أي لا أظنك.
(9) الأثر: 10867-"مؤمل بن هشام اليشكري" ، هو"أبو هشام". روى عن إسمعيل بن علية ، وكان صهره. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. مترجم في التهذيب.
و"إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي" هو"ابن علية" سلف مرارًا كثيرة و"أبو الزبير" المكي ، هو: "محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي" ، مضى برقم : 2029 ، 3581 ، 8205.
وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن 3 : 164 من طريق كثير بن هشام ، عن هشام الدستوائي بلفظه.
ورواه البيهقي في السنن 6 : 231 من طرق ، مطولا مختصرًا.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 240 ، مختصرًا وفيه"الثلثين" كما في مخطوطة الطبري.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.
(10) الأثر: 10868- هو مكرر الأثر السالف ، من طريق ابن أبي عدي ، عن هشام.
وهذا الخبر رواه الواحدي في أسباب النزول : 139 ، وساق لفظه ، مع اختلاف يسير عن لفظ الأثر السالف.
(11) قوله: "فوجدوني" هكذا ثبت في المطبوعة والمخطوطة ، وهي في ألفاظ أخر"فوجدني". والذي في المخطوطة والمطبوعة صواب ، لأنه يعني أبا بكر ورسول الله ، ومن كان معهما ، أو من كان في البيت. ولو حمله على الجمع وهو مثنى ، لكان له وجه في العربية.
(12) الأثر: 10869- خبر"محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله" ، روي من طرق كثيرة ، مضى من طريق شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، مختصرًا برقم : 8730 ، ثم من طريق ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر رقم : 8731 ، بغير هذا اللفظ ، مختصرًا ، وانظر تخريجهما هناك. أما هذا ، فرواه البخاري (الفتح 12 : 2) بمثله ، مع خلاف يسير في لفظه ، وقد بين الحافظ ابن حجر في شرحه ، ما فيه من الاختلاف.
ورواه مسلم من طرق كثيرة ، منها طريق سفيان ، في صحيحه 11 : 54-56.
ورواه أبو داود في سننه 3 : 164 من طريق أحمد بن حنبل ، عن سفيان.
ورواه الترمذي في السنن (في كتاب التفسير) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح ، رواه غير واحد ، عن محمد بن المنكدر". ثم ساقه من طريق"الفضل بن صباح البغدادي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر" ، ثم قال: "وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا". وحديث الفضل بن صباح ، رواه الترمذي قبل ذلك في (كتاب الفرائض) مطولا ، وقال: "هذا حديث صحيح".
ورواه البيهقي في السنن 6 : 223 ، 224 ، ثم قال البيهقي: "وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة ، لم يكن له ولد ولا والد ، لأن أباه قتل يوم أحد. وهذه الآية نزلت بعده".
وذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 41 ، والسيوطي في الدر 2 : 249 ، وزاد نسبته لابن سعد. وابن ماجه ، وابن المنذر.
(13) الأثر: 10870- يأتي برقم: 10871 ، 10873 ، من طريق أبي إسحق ، عن البراء.
(14) الأثر: 10871- رواه مسلم في صحيحه 11 : 58 عن علي بن خشرم ، عن وكيع ، بمثله. ثم ساقه من طرق أخرى ، عن أبي إسحق عن البراء.
والبيهقي في السنن 6 : 224.
(15) الأثر: 10872-"محمد بن خلف بن عمار العسقلاني" ، شيخ الطبري ، مضى برقم : 126 ، 6534.
و"عبد الصمد بن النعمان البزاز". ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51 ، 52 وقال ، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق".
و"مالك بن مغول" ، ثقة ، مضى برقم : 5431.
و"أبو السفر" هو: "سعيد بن يحمد الثوري" أو "سعيد بن أحمد" ، مضى برقم: 3010. والخبر رواه مسلم 11 : 59 من طريق عمرو الناقد ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن مالك بن مغول.
ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق عبد بن حميد ، عن أبي نعيم ، عن مالك بن مغول ، وقال: "هذا حديث حسن".
(16) الأثر: 10873- مكرر الأثرين السالفين : 10870 ، 10871.
"هرون بن إسحق الهمداني" شيخ الطبري ، مضى برقم : 3001.
و"مصعب بن المقدام الخثعمي" ، مضى برقم : 1291 ، 3001.
وهذا الأثر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، رواه البخاري في صحيحه (الفتح 12: 22). وفي المخطوطة هنا"خاتم سورة البقرة" ، والصواب ما في المطبوعة.
(17) يعني ما سلف رقم : 8730 ، 8731 ، ثم ما سلف قريبًا من : 10867- 10869.
(18) "ردف الراحلة": كفل الدابة.
(19) في المطبوعة: "فلقنتكها" من"التلقين" ، وهو صواب في المعنى ، ولكن السياق يقتضي ما أثبته من المخطوطة ، وهي فيها منقوطة. و"لقاه الآية": علمه الآية ، ولقنه إياها.
(20) في المطبوعة وابن كثير"إن كنت" ، وأثبت ما في المخطوطة والدر المنثور ، وهي صواب محض ، وانظرها كذلك في الأثر الآتي رقم : 10892.
(21) الآثار: 10874- 10876 ، ذكر الأثر الأخير منها ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، ثم قال: "كذا رواه ابن جرير ، ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المعنى ، ومحمد بن مرزوق ، قالا ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة.." وساق الخبر ، ثم قال: "قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى". قال ابن كثير: "وكذا رواه ابن مردويه".
وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : 13 ، وقال: "رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبيدة بن حذيفة ، ووثقه ابن حبان".
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 قال: "أخرج العدني والبزار في مسنديهما ، وأبو الشيخ في الفرائض ، بسند صحيح عن حذيفة" ثم ذكر الخبر.
وعاد فخرجه في 2 : 251 ، ونسبه لابن جرير ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن ابن سيرين ، منقطعًا.
(22) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767
(23) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767.
(24) قوله: "التي أنزلت في آخر سورة النساء" غير ثابت في المخطوطة ، وهو ثابت في روايات الحديث التي ستأتي في التخريج.
(25) الأثر: 10877- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، عن عمر سيرويه أبو جعفر من أربع طرق أخرى فيما سيأتي من رقم : 10884- 10887.
وروى هذا الخبر من طريق شبابة بن سوار ، عن شعبة ، عن قتادة ، مسلم في صحيحه 11 : 57 ، إشارة.
ورواه البيهقي في السنن 6 : 224 بلفظه ، وقال: "رواه مسلم عن زهير بن حرب". وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، فقصر في نسبته. وانظر تخريج الآثار التالية التي أشرت إليها.
(26) انظر ما سلف رقم : 8745-8749.
(27) في المطبوعة: "بالكتاب فمحي"؛ بالتعريف ، وهو كذلك في الدر المنثور ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو موافق لرواية ابن كثير في تفسيره.
(28) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.
(29) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.
(30) الأثر: 10880- رواه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مع اختلاف يسير في لفظه ، مطولا.
ورواه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي 6 : 225.
ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 304 من طريق سفيان ، عن عمرو بن مرة ، بلفظ الطبري ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي.
وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 ، ولم ينسبه لغير الحاكم.
وخرجه السيوطي في الدر 2 : 251 ، 252 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، والعدني ، وابن ماجه ، والساجي.
وقوله: "أبواب الربا" ، أي: وجوه الربا وطرقه ، وهذا اللفظ ليس فيما ذكرت من المراجع ، فيها جميعًا"والربا". وانظر الأثر الآتي : 10883 ، والتعليق عليه.
(31) الأثر: 10881- خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، وفيه"قصور الشأم" ، وهما سواء في المعنى ، ولكن العجب أنه نقله عن هذا الموضع من التفسير ، وكتب مكان"الروم""الشأم".
(32) الأثر: 10882- رواه البيهقي في السنن 6 : 245 ، من طريق جرير عن الأعمش. مع اختلاف في لفظه.
وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، 45 ، ثم قال: "وهذا إسناد صحيح".
وخرجه السيوطي 2 : 250 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.
وفي المخطوطة: "النساء في خدورها" ، وهما سواء.
(33) الأثر: 10883-"أبو حيان" هو: "يحيى بن سعيد التيمي" ، مضى برقم: 5382 ، 5383 ، 6318 ، 8155.
وهذا الخبر رواه البخاري مطولا (الفتح 10 : 39-43) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان التيمي.
ورواه مسلم في صحيحه 18 : 165 من أربع طرق ، من طريق علي بن مسهر ، عن أبي حيان ، ومن طريق ابن إدريس عن أبي حيان ، ومن طريق ابن علية عن أبي حيان ، ومن طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان.
ورواه البيهقي في السنن 6 : 245/8 : 289.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 249 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن المنذر. وفي جميع المراجع: "وأبواب من أبواب الربا" ، وانظر شرح ذلك في التعليق على الأثر : 10880
(34) الأثر: 10884- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، مضى برقم : 10877 من طريق شعبة عن قتادة. وأشار إليه مسلم في صحيحه 11 : 57 من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.
ورواه أحمد في المسند رقم : 341 من طريق محمد بن جعفر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مطولا.
ورواه أيضًا مطولا رقم : 89 من طريق عفان ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة.
ورواه مختصرًا رقم : 179 من طريق إسمعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة.
وخرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 241 من هذه الأخيرة من مسند أحمد ، ولم يذكر شيئًا عن الطرق الأخرى ، بل قال: "هكذا رواه مختصرًا ، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا" ، مع أن أحمد أخرجه في مواضع مطولا كما ترى ، وكما سيأتي في التعليق على رقم : 10887.
(35) الأثر: 10885-"إبراهيم بن سعيد الجوهري" ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم: 3355 ، 3959.
و"عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي" ، ثقة صدوق مأمون ، من شيوخ أحمد. مترجم في التهذيب. ومضى في الإسناد رقم : 8284 ، وهذا طريق آخر للأثر السالف.
وفي المطبوعة: "لم أدع" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(36) الأثر: 10886- هذه طريق أخرى للأثرين السالفين ، طريق سعيد بن أبي عروبة.
(37) الأثر: 10887- رواه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 11 : 56.
ورواه أحمد مطولا في المسند برقم : 186 ، وانظر التعليق على الآثار السالفة.
(38) الأثر: 10888-"محمد بن علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى برقم : 1591 ، 2575.
وأبوه "علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى أيضًا برقم : 1591 ، 1909.
و"أبو حمزة" هو السكري: "محمد بن ميمون" ثقة إمام ، مضى برقم: 1591.
و"جابر" هو"جابر الجعفي": جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، مضى برقم: 764 ، 858 ، 2340 ، ومواضع أخرى كثيرة. وهو ضعيف جدًا ، رمي بالكذب.
أما "الحسن بن مسروق" ، فلم أجد في الرواة من يسمى بهذا الاسم ، وأما أبوه فكأنه يعني: "مسروق بن الأجدع الهمداني الوداعي". أحد المقرئين والمفتين.. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. وليس في الرواة عن مسروق من اسمه"الحسن" ، ولا وجدت له ولدًا يقال"الحسن له ابن مسروق".
ففي هذا الإسناد ما فيه من البلاء.
وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، عن الحسن بن مسروق ، عن أبيه كما هنا ، ونسبه للطبري وحده.
(39) الأثر: 10889-"أبو أسامة" هو: "حماد بن أسامة بن زيد الكوفي" ، مضى برقم : 29 ، 51 ، 223 ، 2995 ، 5265.
و"زكريا" هو: "زكريا بن أبي زائدة" مضى برقم : 112 ، 1219.
و"أبو إسحق" هو السبيعي.
و"أبو سلمة" هو: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري" ، مضى برقم : 8 ، 67 ، 3015 ، 8394.
وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 224 ، من طريق يحيى بن آدم ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال: "حديث أبي إسحق عن أبي سلمة منقطع ، وليس بمعروف".
(40) الأثر: 10890-"إسحق بن عيسى بن نجيح" هو أبو يعقوب ، ابن الطباع ، مضى برقم : 2836.
و"ابن لهيعة" مضى مرارًا.
و"يزيد بن أبي حبيب المصري" ثقة مضى برقم : 4348 ، 5493.
و"أبو الخير" هو: "مرثد بن عبد الله اليزني" الفقيه المصري ، روى عن عقبة بن عامر الجهني ، وكان لا يفارقه ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم من الصحابة. تابعي ثقة ، مترجم في التهذيب.
وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه 2 : 366 ، من طريق عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي النسخة المطبوعة من الدارمي خطأ قال فيها"عن يزيد بن عبد الله اليزني" ، والصواب"مرثد بن عبد الله" ، وهو أبو الخير ، كما سلف.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة.
"أعضل الأمر" و"أعضل به الأمر": ضاق وأشكل ، وضاق به ذرعًا لإشكاله.
(41) في المطبوعة: "إذا ورث كلالة" ، والصواب ما أثبت من المخطوطة.
(42) انظر تفسير"مثل حظ الأنثيين" فيما سلف : 8 : 30-34.
(43) انظر تفسير"الضلال" فيما سلف من فهارس اللغة.
(44) الأثر: 10892- انظر الأثر السالف رقم : 10876.
(45) ديوانه 43 ، وقد سلف من هذه القصيدة أبيات في 1 : 116/7 : 557 ، يصف ناقته لما بلغت مبلغها واستوت كما وصفها ، فيقول: لما رأينا كرمها وحسنها حلفنا عليها أن لا تباع ، لنفاستها علينا.
(46) انظر تفسير"عليم" فيما سلف من فهارس اللغة.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[176] سبب نزولها: عن جابر بن عبد الله قال: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [البخاري 194].
وقفة
[176] من رحمة الله بنا أن قطع أسباب الخصومة في الميراث بما أنزل من الآيات، المال محبب للإنسان، وجبلت النفوس على الشح، فلو لم ينص الله على تفاصيل القسمة، لدبت العداوة والبغضاء بين الورثة.
وقفة
[176] ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ عناية الله بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم.
عمل
[176] ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ اشـرح لأحـد النـاس أهمية سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم.
وقفة
[176] ﴿الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أصل الكلالة: من مات رجلًا أو امرأة ليس له والد ولا ولد، ولا جد ولا حفيد.
وقفة
[176] قد يقول قائل: كيف قال الله في الآية المتقدمة في السورة: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، ويقول هنا: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، فهذه كلالة وهذه كلالة، فما الفارق؟ والجواب: الكلالة في أول السورة هي الأخت لأم أو الأخ لأم، أما الكلالة في آخر السورة فهي للإخوة الأشقاء، وفارق بين القسمتين.
وقفة
[176] ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾، ﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: 32]، كلُّ حكمٍ خالفَ حكمَ اللهِ فهو ضلالٌ وإن استحسَنه النَّاسُ.
وقفة
[176] ﴿وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى.
وقفة
[176] من المفاتيح المعينة على تدبر القرآن: معرفة مقصد السورة، أي: موضوعها الأكبر الذي عالجته، فمثلًا: سورة النساء تحدثت عن حقوق الضعفة كالأيتام، والنساء، والمستضعفين في الأرض، وسورة المائدة في الوفاء بالعقود والعهود مع الله ومع العباد، وقس على ذلك.
الإعراب :
- ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قل: فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو وأصله «قول» لالتقاء الساكنين. والفاعل: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وحركت لام الفعل بالكسر لالتقاء الساكنين.
- ﴿ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ: ﴾
- الجملة: في محل نصب مفعول به «مقول القول». الله: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. يفتيكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة «يُفْتِيكُمْ» في محل رفع خبر. في الكلالة: جار ومجرور متعلق بيفتيكم وهو من لا ولد له ولا والد.
- ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ: ﴾
- حرف شرط جازم. وفعل الشرط «هَلَكَ» مضمره يفسره الظاهر مبني على الفتح في محل جزم بان. التقدير: إن هلك امرؤ غير ذي ولد. امرؤ: فاعل للفعل «هَلَكَ» مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة بمعنى: مات.
- ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ: ﴾
- الجملة في محل رفع صفة لامرؤ. ليس: فعل ماض ناقص. له: جار ومجرور في محل نصب خبر «لَيْسَ» مقدم. ولد: اسمها المؤخر مرفوع بالضمة. وله: الواو: استئنافية. له: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. أخت: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة ويجوز أن تعرب «الواو حالية» وجملة «لَهُ أُخْتٌ» في محل نصب حالا من الضمير.
- ﴿ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ: ﴾
- الفاء: رابطة لجواب الشرط. لها: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. نصف: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. ولم ينون لأنه مضاف. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة. ترك: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «تَرَكَ» صلة الموصول. وجملة «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير ما تركه.
- ﴿ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ: ﴾
- إن كان المتوفى امرأة ولا ولد لها ولها أخ فله كل مالها أي يرثها. الواو عاطفة هو: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. يرثها: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وجملة «يَرِثُها» في محل رفع خبر «هُوَ». إن: حرف شرط جازم. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يكن: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو تخفيفا. لها: جار ومجرور في محل نصب خبر «لَمْ يَكُنْ لأنه فعل ناقص. ولد: اسمها مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة. وجملة «لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» في محل جزم بإن لانها فعل الشرط. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه.
- ﴿ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ: ﴾
- الفاء: استئنافية. إن: حرف شرط جازم. كانتا: فعل ماض مبني على الفتح التاء تاء التأنيث والالف ضمير متصل في محل رفع اسم «كان». اثنتين: خبر «كان» منصوب بالياء لأنه مثنى والفعل الناقص «كانت» في محل جزم لأنه فعل الشرط.
- ﴿ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ: ﴾
- الفاء رابطة لجواب الشرط. لهما: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. والميم حرف عماد والالف علامة التثنية. الثلثان: مبتدأ مؤخر مرفوع بالالف لأنه مثنى وجملة «فَلَهُمَا الثُّلُثانِ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.
- ﴿ مِمَّا تَرَكَ: ﴾
- ممّا: مكونة من «من حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن. ترك: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «تَرَكَ» صلة الموصول.
- ﴿ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً: ﴾
- الواو: عاطفة. إن: حرف شرط جازم. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم بإن لأنه فعل الشرط. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. إخوة: خبر «كان» منصوب بالفتحة المنونة لأنه نكرة.
- ﴿ رِجالًا وَنِساءً: ﴾
- تمييز منصوب بالفتحة المنونة لأنه نكرة. ونساء معطوفة بالواو على «رِجالًا» وتعرب إعرابها.
- ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: ﴾
- الفاء: رابطة لجواب الشرط. للذكر: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. مثل: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه مضاف. حظ: مضاف اليه مجرور بالكسرة. الانثيين: مضاف اليه مجرور وعلامة جرّه الياء لأنه مثنى. وجملة «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.
- ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ: ﴾
- يبين: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. لكم: جار ومجرور متعلق بيبين. والميم: علامة جمع الذكور.
- ﴿ أَنْ تَضِلُّوا: ﴾
- أن: حرف نصب مصدري. تضلوا: فعل مضارع منصوب بأن. وعلامة نصبه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف: فارقة. و «إِنِ وما تلاها» بتأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله. ومعناها: كراهة أن تضلوا. وجملة «تَضِلُّوا» صلة «إِنِ» لا محل لها.
- ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: ﴾
- الواو: استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. بكل: جار ومجرور متعلق بعليم. شيء: مضاف اليه مجرور بالكسرة المنونة لأنه نكرة. عليم: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ويجوز أن يكون المصدر المؤول من «أَنْ تَضِلُّوا» بتقدير الضلالة في محل نصب مفعول به للفعل يبين، أي يبين لكم الضلالة حتى تتجنبوها. '
المتشابهات :
| النساء: 127 | ﴿وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ |
|---|
| النساء: 176 | ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسَائِي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: مرضت فجاءني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليَّ، فتوضأ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم صب وضوءه عليَّ فأفقت، فقلت: يا رسول الله، وربما قال سفيان: فقلت: أي رسولَ الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وعلى هذا جمهور المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. قال البغوينزلت في جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ثم ساق الحديث) اهـ.وقال القرطبينزلت بسبب جابر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثم ساق الحديث) اهـ.وقال ابن عاشورثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ثم ساق الحديث إلى قوله: فنزل قوله تعالىيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) اهـ.وهذا الحديث المذكور هو الصحيح في نزول آية الكلالة بخلاف قوله تعالىوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ .. ) فإن هذه الآية لا تتفق مع حديث جابر وإن قال بهذا بعض أهل العلم؛ لأن الآية المذكورة في أول السورة إنما هي في الإخوة لأم دون الأشقاء، وآية الكلالة المذكورة في آخر السورة في الإخوة الأشقاء.وقد روى الطبري عن أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال في خطبتهألا إن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم الله بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) مما جرت الرحم من العصبة) اهـ.ومما يدل على أن الآية الثانية من النساء في الإخوة لأم أن الله سوى بينهم في الميراث فقالوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) وجعل لهم عند الاجتماع رجالاً ونساءًا لثلث بينهم جميعاً فقالفَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .. ) بينما جعل للشقيقة النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك كما أنه فضل ذكرهم على أُنثاهم كالبنات تماماً فقالإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. ) وبهذا يظهر الفرق بين الكلالتين في أول السورة وآخرها. ومما يؤكد هذا أنه قد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لجابريا جابر إني لا أُراك ميتًا من وجعك هذا، فإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين .. الحديث).فلو لم يكنَّ شقيقات لما جعل لهن الثلثين والله أعلم. * النتيجة: أن سبب نزول الآية قصة جابر لصحة سندها، وصراحة لفظها، وموافقتها للفظ الآية، وقواعد الفرائض، واتفاق أكثر المفسرين على ذلك، والله أعلم.'
- المصدر لباب النقول
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [176] لما قبلها : ولَمَّا بدأت سورة النساء بالحديث عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج والمواريث؛ اختتمت السورة هنا بآية الكَلَالةِ، فمن ماتَ ولا ولدٌ له ولا والدٌ، وله أختٌ (شقيقةٌ أو لأبٍ) فلها النِّصفُ، فإنْ كانَ له أختانِ فلهما الثلثانِ، وإذا اجتمعَ الذكورُ معَ الإناثِ فللذكرِ مثلُ نصيبِ الأنثيينِ، قال تعالى:
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾
القراءات :
أن تضلوا:
وقرئ:
لأن لا تضلوا، وهى قراءة الكوفي، والفراء، والكسائي، وتبعهم الزجاج.
مدارسة الآية : [1] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ .. ﴾
التفسير :
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي:بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم. والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله:{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ْ} بالتناصر على الحق، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها ثم قال ممتنا على عباده:{ أُحِلَّتْ لَكُمْ ْ} أي:لأجلكم، رحمة بكم{ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ْ} من الإبل والبقر والغنم، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها، والظباء وحمر الوحش، ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح.{ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ْ} تحريمه منها في قوله:{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ْ} إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال:{ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ْ} أي:أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم، أي:متجرئون على قتله في حال الإحرام، وفي الحرم، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا، كالظباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش.{ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ْ} أي:فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم. وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض، من الميتة ونحوها، صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما.
تفسير سورة المائدة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدّمة
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
وبعد: فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ولينقذهم من الظلم والفجور.
قال- تعالى-: كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
ولقد كان من فضل الله علينا، أن وفقنا لخدمة كتابه، فأعاننا على كتابة تفسير سور: الفاتحة والبقرة، وآل عمران، والنساء ويسعدني أن أتبع ذلك بتفسير محرر لسورة المائدة، حاولت فيه أن أكشف عما اشتملت عليه هذه السورة من هدايات جامعة وتشريعات حكيمة، وحجج باهرة، تقذف حقها على باطل الضالين فإذا هو زاهق.
وقد رأيت من الخير قبل أن أبدأ في تفسيرها بالتفصيل والتحليل، أن أسوق كلمة بين يديها تكون بمثابة التعريف بها، وبيان فضلها، ووجه اتصالها بالسورة التي قبلها، وزمان نزولها، والمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها.
وقد كان منهجي في تفسير هذه السورة، هو المنهج الذي سلكته في تفسير السور السابقة.
وملخصه: أنى أبدأ بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا، ثم أبين المراد منها- إذا كان الأمر يقتضى ذلك.
ثم أذكر سبب النزول للآية أو الآيات- إذا وجد وكان مقبولا- ثم أذكر المعنى الإجمالى للجملة أو للآية، مستعرضا ما اشتملت عليه من وجوه البلاغة وحسن التوجيه.
ثم أتبع هذا ببيان ما يؤخذ من الآية أو الآيات من أحكام وآداب وتشريعات.
وقد حرصت كثيرا على تخريج الأحاديث التي أذكرها، وعلى بيان المصادر التي أنقل عنها.
وتعمدت- عند النقل من المصدر لأول مرة- أن أبين زمان طبعته ومكانها ثم ألتزم النقل عنه بعد ذلك إلى نهاية السورة، دون أن ألجأ إلى طبعات أخرى إلا عند الضرورة القصوى.
وقد تجنبت التوسع في وجوه الإعراب، واكتفيت بالراجح منها..
وذلك لأنى توخيت فيما أكتب إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة وتشريعات حكيمة وآداب سامية، وعظات بليغة وتوجيهات نافعة، وأقوال مأثورة.
والله أسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأنس نفوسنا، وأن يعيننا على إتمام ما بدأناه من خدمة لكتابه، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه، ونافعة لعباده.
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تمهيد بين يدي السورة
1- سورة المائدة هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف، فقد سبقتها سور: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء.
2- وهي مدنية باتفاق العلماء. بناء على القول الذي رجحه العلماء من أن القرآن المدني هو الذي نزل على رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان نزوله في غير المدينة.
3- وعدد آياتها عشرون ومائة آية عند الكوفيين ويرى الحجازيون والشاميون أن عدد آياتها اثنتان وعشرون ومائة آية، ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية.
4- ولهذه السورة الكريمة أسماء أشهرها: المائدة.
وسميت بهذا الاسم، لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التي طلب الحواريون من عيسى- عليه السلام- نزولها من السماء. وقد حكى الله- تعالى- ذلك في آخر السورة في قوله- تعالى-: إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ (الآيات من 112: 115) وتسمى أيضا بسورة العقود، لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب الإيفاء بالعقود. قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وتسمى- أيضا- المنقذة.
قال القرطبي: وروى عنه صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة. تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب » .
5- ووجه اتصالها بسورة النساء- كما يقول الآلوسى- «أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود: صريحا وضمنا. فالصريح: عقود الأنكحة وعقد الصداق. وعقد الحلف. وعقد المعاهدة والأمان. والضمنى: عقد الوصية والوديعة. والوكالة. والعارية. والإجارة. وغير ذلك مما يدخل في قوله- تعالى- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها.
فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود. فكأنه قيل: يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في السورة التي تمت، وإن كان في هذه السورة- أيضا- عقود.
ووجه تقديم النساء وتأخير المائدة. أن أول تلك يا أَيُّهَا النَّاسُ وفيها الخطاب بذلك في مواضع، وهي أشبه بتنزيل المكي. وأول هذه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بخطاب المدني. وتقديم العام وشبه المكي أنسب .
6- وقد وردت روايات تفيد أن سورة المائدة نزلت على النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعة واحدة. ومن هذه الروايات ما أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام ناقة رسول الله العضباء، إذ نزلت عليه المائدة كلها. فكادت من ثقلها تدق عنق الناقة .
وروى الإمام أحمد- أيضا- عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها .
وهناك روايات أخرى تحدثت عن زمان ومكان نزولها، ومن هذه الروايات ما أخرجه أبو عبيد عن محمد القرظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة .
وقال القرطبي: وروى أنها نزلت عند منصرف رسول الله من الحديبية .
وهناك روايات تحدثت عن زمان ومكان نزول بعض آياتها.
قال السيوطي في كتابه «الإتقان» - عند حديثه عن معرفة الحضري والسفرى-: وللسفرى أمثلة منها: قوله- تعالى- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب:
أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، عام حجة الوداع.
ومنها: آية التيمم. ففي الصحيح عن عائشة، أنها نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة- بعد انتهائهم من غزوة المريسيع كما جاء في بعض الروايات.
ومنها: قوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فقد نزلت ببطن نخل.
ومنها: قوله- تعالى- وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فقد نزلت في غزوة ذات الرقاع.
وهذه الآيات جميعها من سورة المائدة».
والذي تطمئن إليه النفس عند تلاوة سورة المائدة بتدبر وإمعان فكر، وعند مراجعة الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها، يرى أن هذه السورة الكريمة لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت متفرقة وفي أوقات مختلفة.
ومما يشهد لذلك ما جاء في كتب الحديث وفي كتب السيرة أن المقداد بن الأسود قد قال للنبي صلّى الله عليه وسلّم قبيل التحام المسلمين مع المشركين في غزوة بدر: يا رسول الله امض لما أمرك الله. فو الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به. أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يدعو على المشركين- في بدر- فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا.. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» .
فهذا النص يفيد أن الصحابة كانوا على علم قبل غزوة بدر بهذه الآيات التي وردت في سورة المائدة، والتي تحكى موقف بنى إسرائيل من نبيهم موسى عند ما دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة .
كذلك مما يشهد بأن سورة المائدة قد نزلت منجمة ولم تنزل دفعة واحدة ما نقلناه منذ قليل عن السيوطي من أن بعض آياتها قد نزلت في أزمنة وأمكنة مختلفة.
وأيضا مما يشهد لذلك، أن المتأمل في بعض آياتها يراها تحكى لنا ألوانا من تعنت اليهود مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن تحاكمهم إليه لا من أجل الوصول إلى الحق وإنما من أجل إظهاره بمظهر الجاهل بأحكام التوراة.
قال- تعالى- وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا.
وفعلهم هذا يدل على أنهم كانت لهم قوة ونفوذ في المدينة عند نزول هذه الآيات.
ومن المعروف تاريخيا أن نفوذ اليهود بالمدينة قد تلاشى بعد غزوة بنى قريظة في السنة الخامسة من الهجرة. وأن قوتهم قد زالت بعد فتح خيبر في أوائل السنة السابعة من الهجرة.
ومن كل هذا نستخلص أن بعض آيات هذه السورة يغلب على ظننا أنها نزلت على النبي صلّى الله عليه وسلّم في السنوات التي سبقت صلح الحديبية وأن الروايات التي نقلناها قبل ذلك عن بعض المفسرين، والتي يستفاد منها أن سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة، أو أنها نزلت عند منصرف
.
الرسول صلّى الله عليه وسلّم من الحديبية، أو فتح مكة أو في حجة الوداع، أو عند رجوعه منها.. كل هذه الروايات فيها مقال- لأنها بجانب- تفرد بعض المحدثين بها فإنها تخالف ما جاء في كتب السنة الصحيحة من أن بعض آياتها قد نزل في حجة الوداع، وبعضها قد نزل بعد غزوة المريسيع، وبعضها كان معروفا للصحابة قبل اشتراكهم في غزوة بدر.
ولأن بعض آيات هذه السورة تحكى لنا أحداثا ومجادلات قد حصلت بين النبي صلّى الله عليه وسلّم وبين اليهود، وهذه الأحداث وتلك المجادلات من المستبعد أن تكون قد حدثت بعد غزوة بنى قريظة في السنة الخامسة من الهجرة، لأنه- كما سبق أن أشرنا- لم يبق لليهود نفوذ في المدينة بعد غزوة بنى قريظة، حتى يستطيعوا أن يواجهوا النبي صلّى الله عليه وسلّم بما واجهوه من مجادلات ومن تحاكم اليه بقصد إحراجه- كما سنفصل ذلك عند تفسيرنا للآيات المتعلقة بهذا الموضوع.
ومع كل هذا فنحن نرجح أن جانبا كبيرا من آيات سورة المائدة قد نزل متأخرا عن صلح الحديبية، بل عن فتح مكة، لأن بعض آياتها تقرر أن المشركين قد صاروا في يأس من التغلب على المسلمين بعد أن فتح المسلمون مكة بعد أن أتم الله لهم دينهم. قال- تعالى- الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً.
ولأن هناك آثارا تشهد بأن سورة المائدة- في مجموعها- من آخر ما نزل على النبي صلّى الله عليه وسلّم من قرآن.
قال القرطبي: وروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: «يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» .
ونحوه عن عائشة- رضى الله عنها- موقوفا. قال جبير بن نفير: دخلت على عائشة فقالت:
هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: فإنها من آخر ما أنزل الله. فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه
والخلاصة، أن الذي يغلب على ظننا أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة في وقت معين أو في زمان معين، وإنما نزل بعضها في السنوات التي سبقت صلح الحديبية، ونزل معظمها بعد هذا الوقت، للأسباب التي سبق أن بيناها، وأن الروايات التي تقول بنزولها دفعة واحدة أو في وقت معين وزمان معين من الممكن أن تحمل على أن المراد بها مجموع السورة لا جميعها.
7- هذا وعند ما نستعرض سورة المائدة استعراضا إجماليا نراها في مطلعها تأمر المؤمنين بالوفاء بالعهود، وبالتزام التكاليف التي كلفهم الله بها، ثم أردفت ذلك ببيان الحلال من الذبائح والحرام منها، ثم بيان حكم طعام أهل الكتاب، وحكم الزواج بالكتابيات.
وبعد أن تكلمت عن المباحات التي يحتاج إليها الجسد أتبعت ذلك بالحديث عن الصلاة التي هي غذاء الروح، فأمرت المؤمنين بأن يدخلوها متطهرين، ووضحت لهم أنه- سبحانه- لا يريد من وراء ما يشرعه لهم الضيق أو الحرج وإنما يريد لهم الخير والطهر وإتمام النعمة:
ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
ثم أمرت المؤمنين بالتزام العدل مع الأصدقاء. ومع الأعداء، ووعدت المطيعين لله- تعالى- بالمغفرة والأجر العظيم، وتوعدت الكافرين بآيات الله بعذاب الجحيم، ثم ذكرت المؤمنين بجانب من مظاهر فضل الله عليهم ورحمته بهم، حيث كف أيدى المعتدين عنهم.
وحماهم من مكرهم. قال- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .
- ثم نراها في الربع الثاني منها تحكى لنا جانبا من رذائل أهل الكتاب. فتبين كيف أن الله- تعالى- أخذ عليهم العهد والميثاق بأن يؤمنوا به ويطيعوه ولكنهم نقضوا عهودهم، فكانت نتيجة ذلك أن لعنهم الله، وأن أدام بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
ثم وجهت نداء إلى أهل الكتاب أرشدتهم فيه إلى طريق الحق، وأمرتهم باتباعه. ووبخت الذين قالوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وحكت جانبا من الدعاوى الباطلة التي ادعاها اليهود والنصارى، حيث قالوا: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ.
ثم وجهت نداء ثانيا إلى أهل الكتاب أمرتهم فيه باتباع محمد صلّى الله عليه وسلّم لأنهم بسبب عدم اتباعه سيكون مصيرهم إلى النار، ولن يقبل الله منهم عذرا بعد أن أرسل إليهم- سبحانه- من يبشرهم وينذرهم.
قال تعالى: يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ، فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ثم حكت السورة الكريمة قصة من قصص موسى- عليه السلام- مع بنى إسرائيل.
فقد ساقت بأسلوبها البليغ إغراءه لهم بدخول الأرض المقدسة، ولكنهم جبنوا واتخذوا عصيانه سبيلهم. فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم الله- تعالى- بالتيه. قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ.
- ثم نراها بعد ذلك في الربع الثالث تحكى لنا قصة ابني آدم بأسلوب مؤثر: تحكى لنا قصة أول جريمة وقعت على ظهر الأرض بسبب الحسد. وتحكى لنا تلك المحاورات التي دارت بين الأخوين: القاتل والقتيل.
وكيف أن القاتل قد تحير في مواراة جثة أخيه، إلى أن تعلم كيفية مواراتها من غراب أخذ يبحث في الأرض ليواري جثة غراب مثله.
وإذا كان الحسد حتى في العبادات يؤدى إلى القتل وسفك الدماء، فقد شرع الله القصاص لحماية الأنفس والأموال والأعراض. فقد ذكر- سبحانه- بعد ذلك جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وجزاء السارق والسارقة. وجزاء الذين كفروا بالحق بعد أن جاءهم من عند الله.
وخلال ذلك أمر- سبحانه- عباده المؤمنين بتقوى الله. وبالتقرب إليه بالعمل الصالح، وبمداومة الجهاد في سبيل الله، حتى ينالوا الفلاح في الدنيا والآخرة.
- وبعد هذه التشريعات الحكيمة، نراها في الربع الرابع تحكى لنا بعض الوسائل الخبيثة التي اتبعها اليهود في محاربتهم للدعوة الإسلامية فذكرت بعض أقوالهم التي كانوا يقولونها عند ما يأتون إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ليتحاكموا إليه في منازعاتهم يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ووصفتهم بأنهم سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ.
وأرشدت الرسول- صلّى الله عليه وسلّم إلى طريقة التعامل معهم فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
ثم بعد أن مدحت التوراة، ووصفت الذين لم يحكموا بما أنزل الله بالكفر. والظلم. بعد كل ذلك نوهت بشأن عيسى- عليه السلام- وبشأن الإنجيل، وأمرت أهله بأن يحكموا بما أنزل الله فيه.
ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن القرآن الكريم، فوصفته بأنه هو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، وهو المهيمن عليها، وهو الذي إليه المرجع في الأحكام، وأن الذين يبغون التحاكم إلى غيره ضالون ظالمون.
قال- تعالى- أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
- ثم وجهت السورة الكريمة في مطلع الربع الخامس منها نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يجعلوا ولايتهم لله ولرسوله ولإخوانهم في العقيدة، ونهتهم عن موالاة الذين يخالفونهم في الدين. ووصفت الذين يتولون من غضب الله عليهم بالنفاق ومرض القلب، وبشرت المطيعين لله بالنصر والظفر قال- تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ.
ثم أمرت السورة الكريمة النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يوبخ أهل الكتاب بسبب كراهيتهم لأهل الحق، وأن يخبرهم بأن المستحقين للكراهية هم أولئك الذين لعنهم الله وغضب عليهم، لكفرهم، ومسارعتهم في الإثم والعدوان. ولافترائهم على الله- تعالى- الكذب، حيث وصفوه- سبحانه- بالبخل والشح.
قال- تعالى-: وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا. بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً. وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ، كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
وبعد أن بينت السورة الكريمة لأهل الكتاب أنهم لو آمنوا بالحق الذي جاءهم به محمد صلّى الله عليه وسلّم لكفر الله عنهم سيئاتهم، ولأدخلهم جنات النعيم، ولرزقهم من فضله الرزق الجزيل. بعد أن بينت كل ذلك، وجهت في مطلع الربع السادس «2» منها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم نداء أمرته فيه بتبليغ ما أمره الله بتبليغه بدون خشية أو تردد، ووعدته بعصمة الله- تعالى- له من الناس كما أمرته بمصارحة أهل الكتاب بما هم فيه من باطل وضلال.
ثم ساقت جملة من الرذائل التي انغمس فيها أهل الكتاب، فحكت نقضهم للعهود والمواثيق، وتكذيبهم للرسل تارة وقتلهم إياهم تارة أخرى، كما حكت قولهم الباطل: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وقولهم: إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ.
وقد هددتهم بالعذاب الأليم إذا ما تمادوا في ضلالهم وطغيانهم، وحثتهم على التوبة والاستغفار، وأقامت لهم الأدلة على بطلان عقائدهم، وبينت لهم القول الحق في شأن عيسى وأمه مريم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.
قال- تعالى-: مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ ثم كشفت السورة عن الأسباب التي أدت إلى طرد الكافرين من بنى إسرائيل من رحمة الله، فذكرت أنهم قد استحقوا ذلك بسبب عصيانهم، واعتدائهم وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه، وولايتهم لأهل الكفر وعداوتهم لأهل الإيمان.
قال- تعالى- تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ، وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ، وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ.
ثم وضحت السورة الكريمة في مطلع الربع السابع منها مراتب أعداء المؤمنين، فصرحت بأن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والذين أشركوا. وأن أقربهم مودة إلى المؤمنين أولئك الذين قالوا إنا نصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ.
ثم وجهت نداء المؤمنين نهتهم فيه عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم وأرشدتهم إلى ما يجب عليهم فعله إذا ما حنثوا في أيمانهم. وأمرتهم بحفظ هذه الأيمان، وعدم اللجوء إليها إلا عند وجود المقتضى لها.
ثم أخبرتهم بأنه إذا كان الله- تعالى- قد أحل لهم الطيبات، فإنه في الوقت نفسه قد حرم عليهم الخبائث، وعلى رأس هذه الخبائث: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فعليهم أن يجتنبوا هذه الأرجاس لينالوا رضا الله في عاجلتهم وآجلتهم.
ثم ساقت السورة الكريمة ألوانا من مظاهر نعم الله على عباده ورحمته بهم حيث أباح لهم أن يتمتعوا بما أحله الله لهم مع مراقبته وخشيته في كل ما يأتون وما يذرون، ومع التزامهم بتعاليم شريعة الله في الحل وفي الحرم.
وبعد هذا الحديث المستفيض عما أحله الله وعما حرمه، أخذت السورة في مطلع الربع الثامن منها في التنويه بشأن الكعبة وبشأن البيت الحرام، ووظيفة الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
ثم نهت المؤمنين عن الأسئلة التي لا منفعة من ورائها، فإن هذا يتنافى مع ما يقتضيه إيمانهم من أدب في القول، ومن تطلع إلى ما ينفع ويفيد، قال- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ.
ثم حكت السورة أنواعا من الأوهام التي تعلق بها أهل الجاهلية، حيث حرموا على أنفسهم بعض المطاعم التي أحلها الله، مستندين في تحريمهم ما حرموه إلى عادات جاهلية اعتنقوها، وهذه العادات أبعد ما تكون عن شرع الله وعما تقتضيه العقول السليمة.
وفي وسط هذا الحديث عما أحله الله وحرمه، ساقت السورة توجيها حكيما للمؤمنين، حيث بينت لهم أن الداعي إلى الله متى قام بواجبه نحو ربه، ونحو نفسه، ونحو غيره، فإنه لا يكون بعد ذلك مسئولا عن ضلال من يضل.
قال- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
وبعد أن بينت بعض الأحكام التي تتعلق بالوصية ووسائل إثباتها، نوهت السورة الكريمة في الربع الأخير منها بشأن عيسى- عليه السلام- وحكت بعض المعجزات التي أيده الله بها في رسالته، وقصت ما طلبه الحواريون منه حيث قالوا له- كما حكى القرآن عنهم:
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ وساقت ما دار بينهم وبين عيسى- عليه السلام- من محاورات في هذه المسألة.
ثم ختمت السورة حديثها عن عيسى بتلك الآيات التي تحكى براءته من كل ما افتراه المفترون عليه، وأنه- عليه السلام- لم يأمر قومه إلا بعبادة الله وحده، وأنه لم يكن إلا رسولا من رسل الله الذين أخلصوا له- سبحانه- العبادة والطاعة. استمع إلى السورة الكريمة وهي تحكى هذا المعنى بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول:
وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ: سُبْحانَكَ. ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
8- هذا عرض مجمل للتشريعات والقصص والآداب والتوجيهات التي اشتملت عليها سورة المائدة. ومن هذا العرض نستطيع أن نستخلص بعض الحقائق البارزة في هذه السورة بصورة أظهر منها في غيرها. ومن تلك الحقائق ما يأتى:
1- أن السورة الكريمة زاخرة بالأحكام الشرعية المتنوعة، فأنت تقرؤها بتدبر وخشوع فتراها قد بينت أحكاما شرعية منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي المسجد الحرام. ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من النكاح، ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة والتيمم، ومنها ما يتعلق بوجوب التزام العدل في القضاء وفي الشهادة وفي غيرهما. ومنها ما يتعلق بالحدود في السرقة وفي قطع الطريق والإفساد في الأرض. ومنها ما يتعلق بأهل الكتاب إذا ما تحاكموا إلينا. ومنها ما يتعلق بكفارات الايمان وكفارات قتل الصيد في حالة الإحرام. ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام.
ومنها ما يتعلق بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى من الأنعام. ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت.. إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي أفاضت في الحديث عنها هذه السورة الكريمة.
قال القرطبي: قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ. وفيها ثماني عشرة فريضة ليست في غيرها، وهي: الْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمَوْقُوذَةُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ، وَما أَكَلَ السَّبُعُ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، وتمام الطهور: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ أى: إتمام ما لم يذكر في سورة النساء- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قوله: عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ. ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ، وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ. وقوله- تعالى- شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الآية.
ثم قال القرطبي: قلت: وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله- تعالى-: وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إذ ليس للآذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة. وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات» .
2- إن الذي يقرأ سورة المائدة يراها قد وجهت جملة من النداءات إلى المؤمنين وقد تجاوزت هذه النداءات في كثرتها، تلك النداءات التي وردت في أطول سورة في القرآن وهي سورة البقرة.
فقد وجهت سورة المائدة إلى المؤمنين ستة عشر نداء. وقد تضمن كل نداء تشريعا من التشريعات، أو أمرا من الأوامر: أو نهيا من النواهي، أو توجيها من التوجيهات مما يدل على أن هذه السورة قد اهتمت اهتماما ملحوظا بتربية المؤمنين على المنهج الذي اختاره الله لهم.
ولا سيما بعد أن أكمل- سبحانه- لهم دينهم، وأتم عليهم نعمته.
وهذه هي النداءات التي وجهها الله- تعالى- إلى المؤمنين نسوقها مرتبة كما وردت في السورة.
1- قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الآية 1 2- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ الآية 2 3- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا الآية 6 4- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ الآية 8 5- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الآية 11 6- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الآية 35 7- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ الآية 51 8- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ الآية 54 9- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً الآية 57 10- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الآية 87 11- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ الآية 90 12- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ الآية 94 13- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ الآية 95 14- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ الآية 101 15- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ الآية 105 16- وقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الآية 106 هذه هي النداءات التي وجهها- سبحانه- إلى المؤمنين في سورة المائدة، وأنت إذا تأملت فيها ترى كل نداء منها يعتبر قانونا منظما لناحية من نواحي الحياة عند المسلمين فيما يختص بأنفسهم، أو فيما يختص بعلاقتهم بغيرهم.
وسنفصل القول في هذه الآيات المشتملة على تلك النداءات عند تفسيرنا لها- إن شاء الله-.
3- أن السورة الكريمة حافلة بالحديث عن أحوال أهل الكتاب، فقد تحدثت عن عقائدهم الفاسدة، وردت عليهم بما يبطل معتقداتهم بأسلوب منطقي رصين: ولم تكتف بهذا بل أرشدتهم في كثير من آياتها إلى طريق الحق حتى يسلكوه، وحتى لا يكون لهم عذر يوم القيامة.
وأمرت النبي صلّى الله عليه وسلّم في كثير من آياتها- أيضا- أن يكشف لهم عن ضلالهم وفسوقهم عن أمر ربهم.
ومن ذلك قوله- تعالى-: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ.
وقوله- تعالى-: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ.
وقوله- تعالى-: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، وَأَضَلُّوا كَثِيراً، وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ.
وقد ذكرت السورة الكريمة- كما سبق أن أشرنا- ألوانا من مسالك اليهود الخبيثة لكيد الدعوة الإسلامية، كتحاكمهم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لا بقصد الوصول إلى الحق، وإنما بقصد إظهاره بمظهر الجاهل بأحكام التوراة ولكن الله- تعالى- خيب سعيهم، وأبطل مكرهم، وكاستهزائهم بالدين الإسلامى وشعائره:
قال- تعالى-: وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ.
كما ذكرت- أيضا- أنواعا من رذائلهم التي من أشنعها: نقضهم للعهود والمواثيق، ومسارعتهم في الإثم والعدوان، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وتكذيبهم للرسل تارة، وقتلهم لهم تارة أخرى.
أما فيما يتعلق بالنصارى فقد تميزت سورة المائدة بالإفاضة في الحديث عنهم بصورة لا تكاد توجد في غيرها بهذه السعة.
فقد تحدثت عن عقائدهم الباطلة، وعن أقوالهم الكاذبة في شأن عيسى عليه السلام- وفي شأن أمه مريم، وردت عليهم بما يدحض حجتهم، وبما يرشدهم إلى الصراط المستقيم.
وقد أنصفت السورة من يستحق الإنصاف منهم، وبشرت أولئك الذين اتبعوا الحق منهم بالثواب الجزيل من الله- تعالى.
4- أن الذي ينظر في الأحكام والتشريعات والتوجيهات التي اشتملت عليها سورة المائدة يراها تمتاز بأنها أحكام نهائية لا تقبل النسخ.
وخذ على سبيل المثال ما ورد في هذه السورة بشأن تحريم الخمر، فإنك تراه قاطعا وحاسما في التحريم.
فلقد مر تحريم الخمر بمراحل كان أولها قوله- تعالى- في سورة البقرة: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ (الآية 219) .
وكان ثانيها قوله- تعالى- في سورة النساء: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ (الآية 43) .
وكان آخرها قوله- تعالى- هنا في سورة المائدة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
والسر في أن الأحكام الشرعية التي وردت في هذه السورة تعتبر نهائية ولا تقبل النسخ. أن معظم آياتها- كما سبق أن ذكرنا- كان من آخر ما نزل على النبي صلّى الله عليه وسلّم من قرآن، وكان نزول كثير من آياتها بعد أن انزوى الشرك في مخابئه، وصار المسلمون في قوة ومنعة، كانوا بها أصحاب السلطان في مكة وفي بيت الله الحرام، دون أن يتعرض لهم متعرض، أو ينازعهم منازع، فقد تم فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا.
ولهذا فأنت لا ترى السورة الكريمة تتحدث عن الشرك أو عن المشركين، أو عن الجهاد في سبيل الله وما يتعلق به من حض عليه ومن أحكام تختص به.
وإنما سورة المائدة تتحدث عن قضايا أخرى كان المسلمون في حاجة إليها عند نزولها. ومن أهم هذه القضايا: حث المؤمنين على التزام العهود والمواثيق وتحذيرهم من الإخلال بشيء منها، وإنزال التشريعات التي هم في حاجة إليها بعد أن تم لهم النصر على أعدائهم، وإرشادهم إلى طرق المحاجة والمناقشة التي يردون بها على ما يثيره أهل الكتاب من شبهات حول تعاليم الإسلام وآدابه وتشريعاته. وبيان وجه الحق فيما حكته السورة عن أهل الكتاب من أقوال باطلة، ومن معتقدات فاسدة.
أما فيما يتعلق بالشرك والمشركين أو بالجهاد في سبيل الله، فلم يكن مقتضى حال المسلمين يستدعى الكلام في ذلك، لأن نزول معظمها كان بعد أن تم للمسلمين النصر على أعدائهم، وبعد أن أصبحت كلمتهم هي العليا، وكلمة المشركين هي السفلى.
وقد تكفلت السور المدنية الأخرى التي نزلت قبل سورة المائدة بالحديث المستفيض عن الشرك وعن المشركين، وعن الحض على الجهاد في سبيل الله، وعن غير ذلك من القضايا التي تقتضيها حالة المسلمين.
وبعد: فهذا تمهيد بين يدي السورة الكريمة تعرضنا خلاله لمكان نزولها ولزمانه، ولوجه تسميتها بسورة المائدة. وللمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها وللأمور البارزة فيها.
وقد قصدنا بهذا التمهيد إعطاء القارئ الكريم فكرة واضحة عن هذه السورة، قبل البدء في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل. والله الهادي إلى سواء السبيل.
=======================
وقوله: أَوْفُوا من الإيفاء. ومعناه: الإتيان بالشيء وافيا تاما لا نقص فيه، ولا نقص معه. يقال وفي بالعهد وأوفى به إذا أدى ما التزم به.
قال صاحب الانتصاف: ورد في الكتاب العزيز وَفَّى بالتضعيف في قوله- تعالى-:
وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى. وورد «أوفى» كثيرا. ومنه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وأما وَفَّى ثلاثيا فلم يرد إلا في قوله- تعالى-: وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ لأنه بنى أفعل التفضيل من «وفى» : إذ لا يبنى إلا من ثلاثي» .
والعقود: جمع عقد- بفتح العين-. وهو العهد الموثق.
قال الراغب: الجمع بين أطراف الشيء. ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل، وعقد البناء. ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغير هما: فيقال: عاقدته، وعقدته، وتعاقدنا.
وهو مصدر استعمل اسما فجمع نحو. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
وقد فرق بعضهم بين العقد والعهد فقال: «والعقود جمع عقد وهو بمعنى المعقود وهو أوكد العهود. والفرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد، ولا يكون إلا بين متعاقدين. والعهد قد ينفرد به الواحد. فكل عقد عهد ولا يكون كل عهد عقدا»
والمراد بالعقود هنا: ما يشمل العقود التي عقدها الله علينا وألزمنا بها من الفرائض والواجبات والمندوبات، وما يشمل العقود التي تقع بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم المتنوعة وما يشمل العهود التي يقطعها الإنسان على نفسه، والتي لا تتنافى مع شريعة الله- تعالى-.
وبعضهم يرى أن المراد بالعقود هنا: ما يتعاقد عليه الناس فيما بينهم كعقود البيع وعقود النكاح.
وبعضهم يرى أن المراد بها هنا: العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤازرة للمظلوم حتى ينال حقه.
والأول أولى لأنه أليق بعموم اللفظ، إذ هو جمع محلى بأل المفيدة للجنس وأوفى بعموم الفائدة.
قال القرطبي: والمعنى: أوفوا بعقد الله عليكم، وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب. قال صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمنون عند شروطهم» .
وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» .
فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله: أى: دين الله. فإن ظهر فيها ما يخالف رد، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
والبهيمة: اسم لذوات الأربع من دواب البر والبحر.
قال الفخر الرازي: قالوا كل حي لا عقل له فهو بهيمة من قولهم: استبهم الأمر على فلان إذا أشكل عليه. وهذا باب مبهم أى: مسدود الطريق. ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر» .
والأنعام جمع نعم- بفتحتين- وأكثر ما يطلق على الإبل، لأنها أعظم نعمة عند العرب.
والمراد بالأنعام هنا: ما يشمل الإبل والبقر والغنم ويلحق بها كل حيوان أو طير يتغذى من النبات، ولم يرد نص بتحريمه فيدخل الظبى وحمار الوحش وغير هما من آكلات العشب، كما تدخل الطيور غير الجارحة وإضافة البهيمة إلى الأنعام إضافة بيانية من إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه كشجر الأراك، وثوب الخز.
أى: أحل الله لكم أيها المؤمنون الانتفاع ببهيمة الأنعام. وهذا الانتفاع بلحمها وجلدها وعظمها وصوفها وما أشبه ذلك مما أحله الله منها.
قال الآلوسى ما ملخصه: وقال غير واحد: البهيمة اسم لكل ذات أربع من دواب البر والبحر. وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب خز. أى: أحل لكم أكل البهيمة من الأنعام.
وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورتها.
وأفردت البهيمة لإرادة الجنس: وجمع الأنعام ليشمل أنواعها. وألحق بها الظباء وبقر الوحش. وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحو هما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب.
وإضافتها إلى الأنعام حينئذ لملابسة المشابهة بينهما.
وقيل: المراد ببهيمة الأنعام: ما يخرج من بطونها من الأجنة بعد ذكاتها وهي ميتة، فيكون مفاد الآية صريحا حل أكلها. وبه قال الشافعى .
وقوله: إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ استثناء مما أحله- سبحانه- لهم من بهيمة الأنعام. أى: أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم بعد ذلك في كتابه أو على لسان رسوله فإنه محرم عليكم.
قال القرطبي: قوله- تعالى-: إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ أى يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله- تعالى- في الآية الثالث
تفسير سورة المائدة [ وهي مدنية ] قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا أبو معاوية شيبان ، عن ليث عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ نزلت عليه المائدة كلها ، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهيل ، عن عاصم الأحول قال : حدثتني أم عمرو ، عن عمها ; أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت عليه سورة المائدة ، فاندق عنق الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضا : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة ، حدثني حيي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله ، فنزل عنها .
تفرد به أحمد وقد روى الترمذي عن قتيبة ، عن عبد الله بن وهب ، عن حيي عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال : آخر سورة أنزلت : سورة المائدة والفتح ، ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت : " إذا جاء نصر الله والفتح " [ سورة النصر : 1 ] .
وقد روى الحاكم في مستدركه ، من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وقال الحاكم أيضا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر قال : قرئ على عبد الله بن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
ورواه الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، وزاد : وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : القرآن . وراوه النسائي من حديث ابن مهدي .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا مسعر حدثني معن وعوف - أو : أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [ رضي الله عنه ] فقال : اعهد إلي . فقال : إذا سمعت الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا ) فارعها سمعك ، فإنه خير يأمر به ، أو شر ينهى عنه .
وقال : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال : إذا قال الله : ( يا أيها الذين آمنوا ) افعلوا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم .
وحدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال : كل شيء في القرآن : ( يا أيها الذين آمنوا ) فهو في التوراة : " يا أيها المساكين " .
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي ، حدثنا معاوية - يعني : ابن هشام - عن عيسى بن راشد ، عن علي بن بذيمة ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية : ( يا أيها الذين آمنوا ) إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها ، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب ، فإنه لم يعاتب في شيء منه . فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة ، وفي إسناده نظر .
قال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول ، وخبره منكر . قلت : وعلي بن بذيمة - وإن كان ثقة - إلا أنه شيعي غال ، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل . وقوله : " ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا " إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى ، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله ) الآية [ سورة المجادلة : 13 ] وفي كون هذا عتابا نظر ; فإنه قد قيل : إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل ، فلم ير من أحد منهم خلافه . وقوله عن علي : " إنه لم يعاتب في شيء من القرآن " فيه نظر أيضا ; فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فعلم بهذا ، وبما تقدم ضعف هذا الأثر ، والله أعلم .
وقال ابن جرير : حدثني المثنى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث حدثني يونس قال : قال محمد بن مسلم : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فيه : هذا بيان من الله ورسوله : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فكتب الآيات منها حتى بلغ : ( إن الله سريع الحساب ) .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ، الذي كتبه لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ، ويأخذ صدقاتهم . فكتب له كتابا وعهدا ، وأمره فيه بأمره ، فكتب : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله ورسوله : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " .
قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني بالعقود : العهود . وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال : والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره . وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) يعني بالعهود : يعني ما أحل الله وما حرم ، وما فرض وما حد في القرآن كله ، فلا تغدروا ولا تنكثوا ، ثم شدد في ذلك فقال : ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) إلى قوله : ( سوء الدار ) [ الرعد : 25 ] .
وقال الضحاك : ( أوفوا بالعقود ) قال : ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام .
وقال زيد بن أسلم : ( أوفوا بالعقود ) قال : هي ستة : عهد الله ، وعقد الحلف ، وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين .
وقال محمد بن كعب : هي خمسة منها : حلف الجاهلية ، وشركة المفاوضة .
وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية : ( أوفوا بالعقود ) قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ، فيقتضي نفي خيار المجلس ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وفي لفظ للبخاري : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع ، وليس هذا منافيا للزوم العقد ، بل هو من مقتضياته شرعا ، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد .
وقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) هي : الإبل والبقر ، والغنم . قاله الحسن وقتادة وغير واحد . قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمر وابن عباس ، وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت ، وقد ورد في ذلك حديث في السنن ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، من طريق مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف ، عن أبي سعيد ، قال : قلنا : يا رسول الله ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله؟ فقال : " كلوه إن شئتم ; فإن ذكاته ذكاة أمه " . وقال الترمذي : حديث حسن .
[ و ] قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عتاب بن بشير ، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " . تفرد به أبو داود .
وقوله : ( إلا ما يتلى عليكم ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يعني بذلك : الميتة والدم ولحم الخنزير .
وقال قتادة : يعني بذلك الميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه .
والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ) فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ; ولهذا قال : ( إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) يعني : منها . فإنه حرام لا يمكن استدراكه ، وتلاحقه ; ولهذا قال تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) أي : إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال .
وقوله : ( غير محلي الصيد وأنتم حرم ) قال بعضهم : هذا منصوب على الحال . والمراد من الأنعام : ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم ، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر ، فاستثنى من الإنسي ما تقدم ، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام .
وقيل : المراد [ أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام ، كقوله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد ، أي : كما ] أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال ، فحرموا الصيد في حال الإحرام ، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ; ولهذا قال : ( إن الله يحكم ما يريد )
القول في تأويل قوله عز ذكره يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا "، يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية الله، وأذعنوا له بالعبودية, وسلموا له الألوهة (47) وصدَّقوا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه =" أوفوا بالعقود "، يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إياه, وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضًا, فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها, ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم, ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها . (48)
* * *
واختلف أهل التأويل في" العقود " التي أمر الله جل ثناؤه بالوفاء بها بهذه الآية, بعد إجماع جميعهم على أن معنى " العقود "، العهود.
فقال بعضهم: هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضًا على النُّصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه سوءًا, وذلك هو معنى " الحلف " الذي كانوا يتعاقدونه بينهم.
ذكر من قال: معنى " العقود "، العهود.
10893- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني &; 9-450 &; معاوية بن صالح, عن علي, عن ابن عباس قوله: " أوفوا بالعقود "، يعني: بالعهود.
10894- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله جل وعز: " أوفوا بالعقود "، قال: العهود.
10895- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.
10896- حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد، مثله . (49)
10897- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرّف بن الشخِّير وعنده رجل يحدثهم, فقال: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: هي العهود . (50)
10898- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: " أوفوا بالعقود "، قال: العهود.
10899- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: هي العهود.
10900- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: " أوفوا بالعقود "، بالعهود.
10901- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة في قوله: " أوفوا بالعقود "، قال: بالعهود.
10902- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " أوفوا بالعقود "، قال: هي العهود.
10903- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، سمعت الثوري يقول: " أوفوا بالعقود "، قال: بالعهود.
10904- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.
* * *
قال أبو جعفر: و " العقود " جمع " عَقْدٍ"، وأصل " العقد "، عقد الشيء بغيره, وهو وصله به, كما يعقد الحبل بالحبلِ، إذا وصل به شدًّا. يقال منه: " عقد فلان بينه وبين فلان عقدًا، فهو يعقده ", ومنه قول الحطيئة:
قَــوْمٌ إذَا عَقَــدُوا عَقْـدًا لِجَـارِهِمُ
شَـدُّوا العِنَـاجَ وَشَـدُّوا فَوْقَـهُ الْكَرَبَا (51)
وذلك إذا وَاثقه على أمر وعاهده عليه عهدًا بالوفاء له بما عاقده عليه, من أمان وذِمَّة, أو نصرة, أو نكاح, أو بيع, أو شركة, أو غير ذلك من العقود.
* * *
ذكر من قال المعنى الذي ذكرنا عمن قاله في المراد من قوله: " أوفوا بالعقود ".
10905- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، أي: بعقد الجاهلية. ذُكر لنا أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوفوا بعقد الجاهلية, ولا تحدثوا عقدًا في الإسلام. وذكر لنا أن فرات بن حيَّان العِجلي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية, فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسأل عن حِلْف لخْمٍ وتَيْم الله؟ فقال: نعم، يا نبي الله! قال: لا يزيده الإسلام إلا شدة.
10906- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، حدثنا معمر, عن قتادة: " أوفوا بالعقود "، قال: عقود الجاهلية: الحلف.
* * *
وقال آخرون: بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإيمان به وطاعته، فيما أحل لهم وحرم عليهم.
*ذكر من قال ذلك:
10907- حدثني المثنى قال، أخبرنا عبد الله قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: " أوفوا بالعقود "، يعني: ما أحل وما حرّم, وما فرض, وما حدَّ في القرآن كله, فلا تغدِروا ولا تنكُثوا. ثم شدَّد ذلك فقال: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ إلى قوله: سُوءُ الدَّارِ [سورة الرعد: 25 ].
10908- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن &; 9-453 &; ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " أوفوا بالعقود "، ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرَّم عليهم.
* * *
وقال آخرون: بل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه.
*ذكر من قال ذلك:
10909- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثني أبي, عن موسى بن عبيدة, عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عُقدة الأيمان, وعُقدة النكاح, وعقدة العَهد, وعقدة البيع, وعقدة الحِلْف.
10910- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب القرظي = أو عن أخيه عبد الله بن عبيدة, نحوه.
10911- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: عقد العهد، وعقد اليمين وعَقد الحِلْف, وعقد الشركة, وعقد النكاح. قال: هذه العقود، خمس.
10912- حدثني المثنى قال، حدثنا عتبة بن سعيد الحمصي قال، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال، حدثنا أبي في قول الله جل وعز: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: العقود خمس: عقدة النكاح, وعقدة الشركة, وعقد اليمين, وعقدة العهد, وعقدة الحلف . (52)
* * *
وقال آخرون: بل هذه الآية أمرٌ من الله تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم، من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله.
*ذكر من قال ذلك:
10913- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " أوفوا بالعقود "، قال: العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب: أن يعملوا بما جاءهم.
10914- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس قال، قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نَجْران (53) فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم, فيه: " هذا بيان من الله ورسوله " : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ، فكتب الآيات منها حتى بلغ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ . (54)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، ما قاله ابن عباس, وأن معناه: أوفوا، يا أيها الذين آمنوا، بعقود الله التي أوجبَهَا عليكم، وعقدها فيما أحلَّ لكم وحرم عليكم, وألزمكم فرضه, وبيَّن لكم حدوده.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال, لأن الله جل وعز أتبع ذلك البيانَ عما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان معلومًا بذلك أن قوله: " أوفوا بالعقود "، أمرٌ منه عبادَه بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك, ونَهْيٌ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه, مع أن قوله: " أوفوا بالعقود "، أمرٌ منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه, فغير جائز أن يخصَّ منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لها. فإذْ كان الأمر في ذلك كما وصفنا, فلا معنى لقول من وجَّه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمرَ الله بالوفاء بها دون بعض.
* * *
وأما قوله: " أوفوا " فإن للعرب فيه لغتين:
إحداهما: " أوفوا "، من قول القائل: " أوفيت لفلان بعهده، أوفي له به ".
والأخرى من قولهم: " وفيت له بعهده أفي" . (55)
و " الإيفاء بالعهد "، إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة.
* * *
القول في تأويل قوله : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في" بهيمة الأنعام " التي ذكر الله عز ذكره في هذه الآية أنه أحلها لنا.
فقال بعضهم: هي الأنعام كلها.
*ذكر من قال ذلك:
10915- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى, عن عوف, عن الحسن قال: بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم.
10916- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، قال: الأنعام كلها.
10917- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا ابن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، قال: الأنعام كلها.
10918- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، قال: الأنعام كلها. (56)
10920- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " بهيمة الأنعام "، هي الأنعام.
* * *
وقال آخرون: بل عنى بقوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها -إذا نحرت أو ذبحت- ميتةً.
*ذكر من قال ذلك:
10921- حدثني الحارث بن محمد قال، حدثنا عبد العزيز قال، أخبرنا أبو عبد الرحمن الفزاري, عن عطية العوفي, عن ابن عمر في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام ". قال: ما في بطونها. قال قلت: إن خرج ميتًا آكله؟ قال: نعم.
10922- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا يحيى بن زكريا, عن إدريس الأودي, عن عطية, عن ابن عمر نحوه = وزاد فيه قال: نعم, هو بمنـزلة رئتها وكبدها.
10923- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير, عن قابوس, عن أبيه, عن ابن عباس قال: الجنين من بهيمة الأنعام، فكلوه.
10924- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن مسعر = وسفيان, عن قابوس = عن أبيه, عن ابن عباس: أن بقرة نحرت فوُجد في بطنها جنين, فأخذ ابن عباس بذنَب الجنين فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلّت لكم.
10925- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن قابوس, عن أبيه, عن ابن عباس قال: هو من بهيمة الأنعام.
10926- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم ومؤمل قالا حدثنا سفيان, عن قابوس, عن أبيه قال: ذبحنا بقرة, فإذا في بطنها جنين, فسألنا ابن عباس فقال: هذه بهيمة الأنعام.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول من قال: عنى بقوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، الأنعام كلها: أجنَّتها وسِخَالها وكبارها . (57) لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك " بهيمة وبهائم ", ولم يخصص الله منها شيئًا دون شيء. فذلك على عمومه وظاهره، حتى تأتى حجة بخصوصه يجب التسليم لها.
* * *
وأما " النعم " فإنها عند العرب، اسم للإبل والبقر والغنم خاصة, كما قال جل ثناؤه: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ، [سورة النحل: 5]، ثم قال: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [سورة النحل: 8]، ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان . (58)
وأما " بهائمها "، فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم الكبار منها اسم " بهيمة "، كما يلزم الصغار, لأن معنى قول القائل: " بهيمة الأنعام ", نظير قوله: " ولد الأنعام ". فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر, فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر.
* * *
وقد قال قوم: " بهيمة الأنعام "، وحشيُّها، كالظباء وبقر الوحش والحُمُر . (59)
* * *
القول في تأويل قوله : إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في الذي عناه الله بقوله: " إلا ما يتلى عليكم ". فقال بعضهم: عنى الله بذلك: أحلت لكم أولاد الإبل والبقر والغنم, إلا ما بيَّن الله لكم فيما يتلى عليكم بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ، الآية [سورة المائدة: 3].
*ذكر من قال ذلك:
10927- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا &; 9-458 &; عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، إلا الميتة وما ذكر معها.
10928- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، أي: من الميتة التي نهى الله عنها، وقدَّم فيها.
10929- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة: " إلا ما يتلى عليكم "، قال: إلا الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه.
10930- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " إلا ما يتلى عليكم "، الميتة والدم ولحم الخنـزير.
10931- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، الميتة ولحم الخنـزير.
10932- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، هي الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أُهِلَّ لغير الله به.
* * *
وقال آخرون: بل الذي استثنى الله بقوله: " إلا ما يتلى عليكم "، الخنـزير.
ذكر من قال ذلك.
10933- حدثني عبد الله بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس: " إلا ما يتلى عليكم "، قال: الخنـزير.
10934- حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " إلا ما يتلى عليكم "، يعني: الخنـزير.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من قال: عنى بذلك: إلا ما يتلى عليكم من تحريم الله ما حرّم عليكم بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، الآية. لأن الله عز وجل استثنى مما أباح لعباده من بهيمة الأنعام، ما حرَّم عليهم منها. والذي حرّم عليهم منها، ما بيّنه في قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ [سورة المائدة: 3]. وإن كان حرَّمه الله علينا، فليس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستثناء ما حرَّم علينا مما دخل في جملة ما قبل الاستثناء، أشبهُ من استثناء ما حرَّم مما لم يدخل في جملة ما قبل الاستثناء.
* * *
القول في تأويل قوله : غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معنى ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ =" غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" = أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ فذلك، على قولهم، من المؤخر الذي معناه التقديم. فـ" غير " منصوب = على قول قائلي هذه المقالة = على الحال مما في قوله: " أوفوا " من ذكر " الذين آمنوا ".
وتأويل الكلام على مذهبهم: أوفوا، أيها المؤمنون، بعقود الله التي عقدها عليكم في كتابه, لا محلّين الصيد وأنتم حرم.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية من الظباء والبقر والحمر =" غير محلي الصيد "، غير مستحلِّي اصطيادها, وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم ". فـ" غير "، على قول هؤلاء، منصوب على الحال من " الكاف والميم " اللتين في قوله: لَكُمْ ، بتأويل: أحلت لكم، أيها الذين آمنوا، بهيمة الأنعام, لا مستحلِّي اصطيادها في حال إحرامكم . (60)
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها = إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ , إلا ما كان منها وحشيًّا, فإنه صيد، فلا يحل لكم وأنتم حرم. فكأن من قال ذلك, وجَّه الكلام إلى معنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها = إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، إلا ما يبين لكم من وحشيها, غيرَ مستحلي اصطيادها في حال إحرامكم. فتكون " غير " منصوبة، على قولهم، على الحال من " الكاف والميم " في قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ .
*ذكر من قال ذلك:
10935- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرِّف بن الشخير، وعنده رجل, فحدّثهم فقال: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " صيدًا =" غير محلي الصيد وأنتم حرم ", فهو عليكم حرام. يعني: بقر الوحش والظباءَ وأشباهه. (61)
10936- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم "، قال: الأنعام كلها حِلٌّ، إلا ما كان منها وحشيًّا, فإنه صيد, فلا يحل إذا كان مُحْرِمًا.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب = على ما تظاهر به تأويل أهل التأويل في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ، من أنها الأنعام وأجنَّتها وسخالها, وعلى دلالة ظاهر التنـزيل = قولُ من قال: معنى ذلك: أوفوا بالعقود، غيرَ محلي الصيد وأنتم حرم, فقد أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال إحرامكم أو غيرها من أحوالكم, إلا ما يتلى عليكم تحريمه من الميتة منها والدم، وما أهل لغير الله به.
وذلك أن قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، لو كان معناه: " إلا الصيد ", لقيل: " إلا ما يتلى عليكم من الصيد غير محليه ". وفي ترك الله وَصْلَ قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ بما ذكرت, وإظهار ذكر الصيد في قوله: " غير محلي الصيد "، أوضحُ الدليل على أن قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، خَبَرٌ متناهية قصته, وأن معنى قوله: " غير محلي الصيد "، منفصل منه.
وكذلك لو كان قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ، مقصودًا به قصد الوحش, لم يكن أيضًا لإعادة ذكر الصيد في قوله: " غير محلي الصيد " وَجْهٌ، وقد مضى ذكره قبل, ولقيل: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلِّيه وأنتم حرم ". وفي إظهاره ذكر الصيد في قوله: " غير محلي الصيد "، أبينُ الدلالة على صحة ما قلنا في معنى ذلك.
* * *
فإن قال قائل: فإن العرب ربما أظهرت ذكر الشيء باسمه وقد جرى ذكره باسمه؟ قيل: ذلك من فعلها ضرورة شعر, وليس ذلك بالفصيح المستعمل من كلامهم. وتوجيه كلام الله إلى الأفصح من لغات من نـزل كلامه بلغته، أولى = ما وُجد إلى ذلك سبيل = من صرفه إلى غير ذلك.
* * *
قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذًا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرّم وأحلّ, لا محلين الصيد في حرمكم, ففيما أحلَّ لكم من بهيمة الأنعام المذكَّاة دون ميتتها، متَّسع لكم ومستغنًى عن الصيد في حال إحرامكم.
* * *
القول في تأويل قوله : إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله يقضي في خلقه ما يشاء (62) من تحليل ما أراد تحليله, وتحريم ما أراد تحريمه, وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم, وغير ذلك من أحكامه وقضاياه = فأوفوا، أيها المؤمنون، له بما عقدَ عليكم من تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حرّم عليكم, وغير ذلك من عقوده، فلا تنكثوها ولا تنقضوها. كما:-
10937- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " إن الله يحكم ما يريد "، إن الله يحكم ما أراد في خلقه, وبيّن لعباده, وفرض فرائضه, وحدَّ حدوده, وأمر بطاعته, ونهى عن معصيته.
------------------
الهوامش :
(47) في المطبوعة: "الألوهية" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(48) انظر تفسير"أوفى" فيما سلف 1: 557/3: 348/6: 526.
(49) الأثر: 10896- في المخطوطة: "حدثنا سفيان قال ، حدثنا ابن أبي سفيان ، عن رجل..." وهو خطأ وسهو ، وهو إسناد دائر في التفسير: سفيان بن وكيع ، عن أبيه وكيع ، عن سفيان الثوري.
(50) الأثر: 10897-"عبيد الله" ، هو"عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي""باذام" ، مضت ترجمته برقم: 2092 ، 2219 ، 5796 ، 7758. وكان في المطبوعة هنا: "عبيد الله عن ابن أبي جعفر الرازي" ، وهو خطأ سيأتي على الصواب في الأسانيد التالية رقم: 10935 ، 10957 ، 10963.
(51) ديوانه: 6 ، مجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 145 ، اللسان (كرب) (عنج) ، من قصيدته التي قالها في الزبرقان بن بدر ، وبغيض بن عامر من بني أنف الناقة ، فمدح بغيضًا وقومه فقال:
قَـوْمٌ هُـمُ الأَنْـفُ، وَالأَذْنَـابُ غَيْرهُمُ،
وَمَـنْ يُسَـوِّي بِـأَنْفِ النَّاقَـةِ الذَّنَبَـا!
قَــوْمٌ يَبِيـتُ قَرِيـرَ العَيْـنِ جَـارُهُمُ
إذَا لَــوَى بقُــوَى أَطْنَـابِهِمْ طُنُبَـا
قَـــــوْمٌ إذَا عَقَــــدُوا........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا مثل ضربه يقول: إذا عقدوا للجار عقدًا وذمامًا ، أحكموا على أنفسهم العقد ، حتى يكون أقر عينًا بنصرتهم له ، وحمايتهم لعرضه وماله. وضرب المثل بالدلو ، التي يستقي بها وينتفع. و"العناج": خيط يشد في أسفل الدلو ، ثم يشد في عروتها ، أو في أحد آذانها ، فإذا انقطع حبل الدلو ، أمسك العناج الدلو أن تقع في البئر. و"الكرب" الحبل الذي يشد على الدلو بعد"المنين" وهو الحبل الأول ، فإذا انقطع المنين بقي الكرب. فهذا هو المثل ، استوثقوا له بالعهد ، كما استوثقوا لدلوه بالحبل بعد الحبل حتى تكون بمأمن من القطع.
(52) الأثر 10912-"عتبة بن سعيد الحمصي" مضى برقم: 8966.
(53) في المطبوعة: "بعثه إلى نجران" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(54) الأثر: 10914- روى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو جعفر في التاريخ 3: 157 ، وهو في سيرة ابن هشام 4: 241 ، وفتوح البلدان للبلاذري: 77 ، وغيرها.
(55) انظر تفسير"أوفى" فيما سلف 1: 557-559/3: 348/6: 526.
(56) سقط من الترقيم ، رقم: 10919.
(57) "السخال" جمع"سخلة" (بفتح فسكون): وهي ولد الشاة من المعز والضأن ، ذكرًا كان أو أنثى.
(58) انظر تفسير"الأنعام" فيما سلف 6: 254.
(59) هي مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 298.
(60) انظر معاني القرآن للفراء 1: 298.
(61) انظر الإسناد السالف رقم: 10897 ، وكان هناك عن"ابن أبي جعفر الرازي" ، وهذا هو الإسناد الصحيح ، صححت ذلك عليه. وسيأتي برقم: 10957 ، 10963.
(62) انظر تفسير"حكم" فيما سلف: ص 324: تعليق: 3.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] لما أخبر تعالى في آخر سورة النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها عليهم حَرَّمَ عليهم طيبات أُحِلَّتْ لهُم، ناسب افتتاح هذه السورة بأمر المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جلُّ مبناه القلب.
وقفة
[1] سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي.
لمسة
[1] تأمل -أيها المؤمن- في سطرين فقط، وفي آية واحدة: نداء وتنبيه، أمر ونهي، تحليل وتحريم، إطلاق وتقييد، تعميم واستثناء، وثناء وخبر، فسبحان من هذا كلامه!
لمسة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لماذا أمرنا الله تعالى بالوفاء بالعقود ولم يقل لنا إلتزموا أمر الله؟ الإيفاء أن تعطي وتؤدي ما عليك كاملًا من غير نقص، ولا شك أن ذلك لا يتحقق إلا إذا أدَّيت زيادة على القدر الواجب، فالوفاء بالعقد يتطلب منك حرصًا ومبالغة في أداء ما تعهدت به، والعقد هو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل ما.
وقفة
[1] جاءت عقود كثيرة في سورة النساء منها: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: 33]، ﴿وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]، ثم قال جلَّ شأنه في مستهل سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ تناسب بديع.
وقفة
[1] لو تتبَّعنا النِّداء في القرآن الكريم كاملًا لوجدنا أنَّه ورد النِّداء بوصف الإيمان ثمانية وثمانين مرَّة، ورد في سورة المائدة فقط ستةَ عَشَرَ مرَّة، ومنه هذه الآية التّي في أوَّل السُّورة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 16 نداء بوصف الإيمان؛ فلنتأمل هذه النداءات، ونعرض أنفسنا عليها، فهي إما أوامر ينبغي أن نأتمر بها، أو نواهٍ ينبغي أن ننتهي عنها؛ فهل نحن نأتمر وننتهي بها؟!
وقفة
[1] ﴿أوفوا بالعقود﴾ مِن الخَطأ أن يُقال إنَّ العَقد شريعةُ المتعاقدين، وإنَّما العقد الَّذي هو شريعةُ المتعاقدين هو ما كان موافقاً للكِتَاب والسُّنة، وما خالفهما فليس بمشروع.
وقفة
[1] ﴿أوفوا بالعقود﴾ يجب الوفاء بالعقود، ويحرم إغراء العامل وتخبيبه على كفيله بما يخالف مقتضى العقد: «فالمسلمون على شروطهم».
وقفة
[1] ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ الأصل هو حِلُّ الأكل من كل بهيمة الأنعام، سوى ما خصه الدليل بالتحريم، أو ما كان صيدًا يعرض للمحرم في حجه أو عمرته.
عمل
[1] راجع الأطعمة التي تأكلها، واحذر الأطعمة المشتبهة والمحرمة؛ فإنها ضرر على الدين والعقل والجسم ﴿أحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾.
وقفة
[1] ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ فيه تحريم الصيد في الإحرام.
وقفة
[1] من الإيمان أن يُسَلِّم المرء بالأحكام الشرعية، ولا يعارضها، ولا يجعل عقله حاكمًا في التحليل والتحريم ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.
وقفة
[1] ﴿يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ أي: من تحليل وتحريم وغيرهما، فما فهمتم حكمته فذاك, وما لا فَكِلُوه إليه, وارغبوا في أن يُلْهِمَكُم حِكمَتَه.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾
- يا: أداة نداء. أي: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» للتنبيه. الذين: اسم موصول مبني على الفتح بدل من «أي». آمنوا: صلة الموصول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف فارقة.
- ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ﴾
- أوفوا: فعل أمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف: فارقة. بالعقود: جار ومجرور متعلق بأوفوا.
- ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: ﴾
- أحلت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة. لكم: جار ومجرور متعلق بأحلت والميم علامة جمع الذكور. بهيمة: نائب فاعل مرفوع بالضمة. الانعام: مضاف اليه مجرور بالكسرة. والمعنى: من الانعام. واضافة «بَهِيمَةُ» للانعام للبيان.
- ﴿ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ: ﴾
- أي إلا محرم ما يتلى عليكم. أو إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه. إلا: اداة استثناء. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى بإلّا وهو استثناء منقطع. يتلى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. عليكم: جار ومجرور متعلق بيتلى والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ: ﴾
- غير: حال منصوب بالفتحة من الضمير في «لَكُمْ» أي أحلت لكم هذه الاشياء لا محلين للصيد. ويجوز أن يكون انتصابه عن قوله: أوفوا بالعقود. محلي: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وحذفت النون للاضافة. الصيد: مضاف اليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة.
- ﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ: ﴾
- الواو: حالية. أنتم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. حرم: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة والجملة الاسمية في محل نصب حال.
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ: ﴾
- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «إِنَّ» منصوب للتعظيم بالفتحة. يحكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديرة هو سبحانه. وجملة «يَحْكُمُ» في محل رفع خبر «إِنَّ» ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يريد: صلة الموصول تعرب إعراب «يَحْكُمُ» لا محل لها من الاعراب والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: ما يريده. '
المتشابهات :
| المائدة: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ |
|---|
| الحجرات: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾ |
|---|
| الممتحنة: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بداية السورة بالأمر بالوفاءِ بالعقودِ والعهودِ، وحِل بهيمةِ الأنعامِ -إلا ما استثنى في الآية الثالثة-، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾
القراءات :
غير:
وقرئ:
بالرفع، على أن يكون صفة لقوله «بهيمة الأنعام» ، وهى قراءة ابن أبى عبلة.
مدارسة الآية : [2] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى{ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ْ} أي:محرماته التي أمركم بتعظيمها، وعدم فعلها، والنهي يشمل النهي عن فعلها، والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي، عن فعل القبيح، وعن اعتقاده. ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، ومحرمات الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله:{ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ْ} أي:لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما قال تعالى:{ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ْ} والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى:{ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ْ} وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون:إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها، مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا:المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال:لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها، فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في "حنين"في "شوال". وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال، فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله:{ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ْ} أي:ولا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة، أو غيرهما، من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به، أو تحملوه ما لا يطيق، خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به.{ وَلَا الْقَلَائِدَ ْ} هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى، فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله، وحملا للناس على الاقتداء، وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة.{ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ْ} أي:قاصدين له{ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ْ} أي:من قصد هذا البيت الحرام، وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به، والصلاة، وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء، ولا تهينوه، بل أكرموه، وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمرُ الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين، غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى:{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ْ} فالمشرك لا يُمَكَّن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه -يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى:{ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ْ} ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال:{ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ْ} أي:إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة، وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.{ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ْ} أي:لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم، حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله، ويسلك طريق العدل، ولو جُنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه.{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ْ} أي:ليعن بعضكم بعضا على البر. وهو:اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع:اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك.{ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ْ} وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ويحرج.{ وَالْعُدْوَانِ ْ} وهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.{ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ْ} على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل.
وقوله: لا تُحِلُّوا من الإحلال الذي هو ضد التحريم. ومعنى عدم إحلالهم لشعائر الله:
تقرير حرمتها عملا واعتقادا، والالتزام بها بالطريقة التي قررتها شريعة الله.
والشعائر: جمع شعيرة- على وزن فعيلة- وهي في الأصل ما جعلت شعارا على الشيء وعلامة عليه من الإشعار بمعنى الإعلام. وكل شيء اشتهر فقد علم. يقال: شعرت بكذا.
أى علمته.
والمراد بشعائر الله هنا: حدوده التي حدها، وفرائضه التي فرضها وأحكامه التي أوجبها على عباده.
ويرى بعضهم أن المراد بشعائر الله هنا: مناسك الحج وما حرمه فيه من لبس للثياب في أثناء الإحرام. ومن غير ذلك من الأفعال التي نهى الله عن فعلها في ذلك الوقت فيكون المعنى.
لا تحلوا ما حرم عليكم حال إحرامكم.
والقول الأول أولى لشموله جميع التكاليف التي كلف الله بها عباده. وقد رجحه ابن جرير بقوله: وأولى التأويلات بقوله: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ قول من قال: لا تحلوا حرمات الله، ولا تضيعوا فرائضه. فيدخل في ذلك مناسك الحج وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه.
وإنما قلنا ذلك القول أولى، لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها، نهيا عاما من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء. فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها ولا حجة بذلك».
وأضاف- سبحانه- الشعائر إليه. تشريفا لها، وتهويلا للعقوبة التي تترتب على التهاون بحرمتها. وعلى مخالفة ما أمر الله به في شأنها.
وقوله. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ معطوف على شعائر الله. والمراد به الجنس. فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم. وهي أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة والمحرم، ورجب.
وسمى الشهر حراما: باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام.
أى: لا تحلوا- أيها المؤمنون- القتال في الشهر الحرام، ولا تبدأوا أعداءكم فيه بقتال.
قال ابن كثير: يعنى بقوله: وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ تحريمه، والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه، من الابتداء بالقتال كما قال- تعالى- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ. قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. وقال- تعالى- إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً وفي صحيح البخاري عن أبى بكرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض والسنة اثنا عشر شهرا. منها أربعة حرم» . وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت. كما هو مذهب طائفة من السلف.
وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ. وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم. واحتجوا بقوله- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره.
والمقصود بالهدى في قوله وَلَا الْهَدْيَ ما يتقرب به الإنسان إلى الله من النعم ليذبح في الحرم، وهو جمع هدية- بتسكين الدال-، أى: ولا تحلوا حرمة ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام تقربا إلى الله- تعالى- بأن تتعرضوا له بنحو غصب وسرقة أو حبس عن بلوغه إلى محله.
وخص ذلك بالذكر مع دخوله في الشعائر، لأن فيه نفعا للناس، لأنه قد يتساهل فيه أكثر من غيره، ولأن في ذكره تعظيما لشأنه.
وقوله: وَلَا الْقَلائِدَ جمع قلادة، وهي ما يقلد به الهدى ليعلم أنه مهدى إلى البيت الحرام فلا يتعرض له أحد بسوء. وقد كانوا يضعون في أعناق الهدى ضفائر من صوف، ويربط بعنقها نعلان أو قطعة من لحاء الشجر أو غيرهما ليعلم أنه هدى فلا يعتدى عليه.
والمراد: ولا تحلوا ذوات القلائد من الهدى بأن تتعرضوا لها بسوء.
وخصت بالذكر مع أنها من الهدى تشريفا لها واعتناء بشأنها، لأن الثواب فيها أكثر، وبهاء الحج بها أظهر. فكأنه قيل: لا تحلوا الهدى وخصوصا ذوات القلائد منه.
ويجوز أن يراد النهى عن التعرض لنفس القلائد مبالغة في النهى عن التعرض لذواتها أى:
لا تتعرضوا لقلائد الهدى فضلا عن ذاته.
وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذين الوجهين بقوله: وأما القلائد ففيها وجهان:
أحدهما: أن يراد بها ذوات القلائد من الهدى وهي البدن. وتعطف على الهدى للاختصاص وزيادة التوصية بها لأنها أشرف الهدى كقوله وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ كأنه قيل: والقلائد منها خصوصا.
والثاني: أن ينهى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة في النهى عن التعرض للهدى. على معنى: ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها. كما قال وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهى عن إبداء مواقعها».
وقوله: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً معطوف على قوله:
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ.
وقوله: آمِّينَ جمع آم من الأم وهو القصد المستقيم. يقال: أممت كذا أى: قصدته أى:
ولا تحلوا أذى قوم قاصدين زيارة البيت الحرام بأن تصدوهم عن دخوله حال كونهم يطلبون من ربهم ثوابا. ورضوانا لتعبدهم في بيته المحرم.
ولكن ما المراد بهؤلاء الآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟
قال بعضهم: المراد بهم المسلمون الذين يقصدون بيت الله للحج والزيارة. فلا يجوز لأحد أن يمنعهم من ذلك بسبب نزاع أو خصام لأن بيت الله- تعالى- مفتوح للجميع وعلى هذا يكون التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم في قوله مِنْ رَبِّهِمْ للتشريف والتكريم وجملة يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً حال من الضمير المستكن في قوله آمِّينَ. وقد جيء بها لبيان مقصدهم الشريف، ومسعاهم الجليل.
أى: قصدوا البيت الحرام يبتغون رزقا أو ثوابا من ربهم، ويبتغون ما هو أكبر من كل ذلك وهو رضاه- سبحانه- عنهم وعلى هذا القول تكون الآية الكريمة محكمة ولا نسخ فيها، وتكون توجيها عاما من الله- تعالى- لعباده بعدم التعرض بأذى لمن يقصد زيارة المسجد الحرام من إخوانهم المؤمنين، مهما حدث بينهم من نزاع أو محلاف.
وقال آخرون: المراد بهم المشركون. واستدلوا بما رواه ابن جرير عن السدى من أن الآية نزلت في رجل من بنى ربيعة يقال له الحطيم بن هند، وذلك أنه أتى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فسأله إلام تدعو؟ فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فقال له: حسن ما تدعو إليه إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلى أسلّم وآتى بهم. فلما خرج مر بسرح من سرح المدينة فساقه وانطلق به.
ثم أقبل من العام القادم حاجا ومعه تجارة عظيمة. فسأل المسلمون النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يأذن لهم في التعرض له. فأبى النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم نزلت الآية».
وعلى هذا القول يفسر ابتغاء الفضل بمطلق الرزق عن طريق التجارة. وابتغاء الرضوان بأنهم كانوا يزعمون أنهم على سداد من دينهم، وأن الحج يقربهم من الله، فوصفهم- سبحانه- على حسب ظنهم وزعمهم. ثم نسخ ذلك بقوله- تعالى- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.
وعليه يكون ابتغاء الفضل والرضوان عاما الدنيوي والأخروى ولو في زعم المشركين.
والذي نراه أولى هو القول الأول، لأن الآية الكريمة مسوقة لبيان ما يجب على المؤمنين أن يفعلوه نحو شعائر الله التي هي حدوده وفرائضه ومعالم دينه، ولأن قوله- تعالى-: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً هذا الوصف إنما يليق بالمسلّم دون الكافر، إذ المسلمون وحدهم الذين يقصدون بحجهم وزيارتهم لبيت الله الثواب والرضوان منه- سبحانه-.
قال الفخر الرازي: «أمرنا الله في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين، وحرم علينا أخذ الهدى من المهدين إذا كانوا مسلمين. والدليل عليه أول الآية وآخرها.
أما أول الآية فهو: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وشعائر الله إنما تليق بنسك المسلمين وطاعتهم لا بنسك الكفار.
وأما آخر الآية فهو قوله: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر».
وبذلك نرى الآية الكريمة قد نهت المؤمنين عن استحلال اى شيء من الشعائر التي حرم الله- تعالى- استحلالها، وخصت بالذكر هذه الأمور الأربعة التي عطفت عليها اهتماما بشأنها وزجرا للنفوس عن انتهاك حرمتها، لأن هذه الأمور الأربعة منها ما ترغب فيه النفوس بدافع
شهوة الانتقام، ومنها ما ترغب فيه النفوس بدافع المتعة والميل القلبي، ومنها ما ترغب فيه النفوس بدافع الطمع وحب التملك.
ثم أتبع- سبحانه- هذا النهى ببيان جانب من مظاهر فضله. حيث أباح لهم الصيد بعد الانتهاء من إحرامهم فقال: وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا.
أى: وإذا خرجتم من إحرامكم أبيح لكم الصيد، وأبيح لكم أيضا كل ما كان مباحا لكم قبل الإحرام.
وإنما خص الصيد بالذكر، لأنهم كانوا يرغبون فيه كثيرا. كبيرهم وصغيرهم، وغنيهم وفقيرهم. والإشارة إلى أن الذي ينبغي الحرص عليه هو ما يعد قوتا تندفع به الحاجة فقط لا ما يكون من الكماليات ولا ما يكون إرضاء للشهوات.
والأمر في قوله: فَاصْطادُوا للإباحة، لأنه ليس من الواجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد. بل يباح له ذلك كما كان الشأن قبل الإحرام ومثله قوله- تعالى- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ أى: أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
ثم نهى- سبحانه- المؤمنين على أن يحملهم البغض السابق لقوم لأنهم صدوهم عن المسجد الحرام على أن يمنعوهم من دخوله كما منعهم من دخوله أولئك القوم فقال- تعالى-:
وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا.
والجملة الكريمة معطوفة على قوله: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ لزيادة تقرير مضمونه.
ومعنى وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ ولا يحملنكم مأخوذ من جرمه على كذا إذا حمله عليه، أو معناه:
ولا يكسبنكم من جرم بمعنى كسب، غير أنه في كسب ما لا خير فيه ومنه الجريمة.
وأصل الجرم: قطع الثمرة من الشجرة، أطلق على الكسب، لأن الكاسب ينقطع لكسبه.
قال صاحب الكشاف: جرم يجرى مجرى «كسب» في تعديه إلى مفعول واحد واثنين.
تقول: جرم ذنبا نحو كسبه وجرمته ذنبا، نحو كسبته إياه. ويقال: أجرمته ذنبا، على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين. كقولهم: أكسبته ذنبا».
والشنآن: البغض الشديد. يقال: شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة وشنآنا إذا أبغضته بغضا شديدا.
والمعنى: ولا يحملنكم- أيها المؤمنون- بغضكم الشديد لقوم بسبب أنهم منعوكم من دخول المسجد الحرام، لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم، فإن الشرك إذا كان يبرر هذا العمل، فإن الإسلام- وهو دين العدل والتسامح- لا يبرره ولا يقبله، ولكن الذي يقبله الإسلام هو احترام المسجد الحرام، وفتح الطريق إليه أمام الناس حتى يزداد المؤمن إيمانا، ويفيء العاصي إلى رشده وصوابه.
قال ابن كثير: وقوله: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أى: ولا يحملنكم بغض قوم، «قد كانوا صدوكم عن المسجد الحرام- وذلك عام الحديبية-، على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد.. فإن العدل واجب على كل أحد. في كل أحد، وفي كل حال. والعدل، به قامت السموات والأرض.
وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.
وعن زيد بن أسلّم، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه بالحديبية، حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة. فقال الصحابة. نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فنزلت هذه الآية».
وقوله: شَنَآنُ قَوْمٍ مصدر مضاف لمفعوله. أى: لا يحملنكم بغضكم قوما.
وقوله: أَنْ صَدُّوكُمْ- بفتح همزة أن- مفعول لأجله بتقدير اللام. أى: لأن صدوكم.
فهو متعلق بالشنآن.
وقوله أَنْ تَعْتَدُوا في موضع نصب على أنه مفعول به.
أى: لا يحملنكم بغضكم قوما لصدهم إياكم عن المسجد الحرام الاعتداء عليهم.
وقراءة أَنْ صَدُّوكُمْ بفتح الهمزة- هي قراءة الجمهور، وهي تشير إلى أن الصد كان في الماضي، وهي واضحة ولا إشكال عليها.
قال الجمل: وفي قراءة لأبى عمرو وابن كثير بكسر همزة أن على أنها شرطية وجواب الشرط دل عليه ما قبله. وفيها إشكال من حيث إن الشرط يقتضى أن الأمر المشروط لم يقع. مع أن الصد كان قد وقع. لأنه كان في عام الحديبية وهي سنة ست. والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكانت مكة عام الفتح في أيدى المسلمين فكيف يصدون عنه؟ وأجيب بوجهين:
أو لهما: لا نسلّم أن الصد كان قبل نزول الآية فإن نزولها عام الفتح غير مجمع عليه.
والثاني: أنه وإن سلمنا أن الصد كان متقدما على نزولها فيكون المعنى: إن وقع صد مثل ذلك الصد الذي وقع عام الحديبية- فلا تعتدوا-.
قال بعضهم: وهذا لا يمنع من الجزاء على الاعتداء بالمثل، لأن النهى عن استئناف الاعتداء على سبيل الانتقام، فإن من يحمله البغض والعداوة على الاعتداء على من يبغضه يكون منتصرا لنفسه لا للحق. وحينئذ لا يراعى المماثلة ولا يقف عند حدود العدل».
ثم أمر الله- تعالى- عباده بالتعاون على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات فقال:
وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ.
والبر معناه: التوسع في فعل الخير، وإسداء المعروف إلى الناس.
والتقوى تصفية النفس وتطهيرها وإبعادها عن كل ما نهى الله عنه.
قال القرطبي: قال الماوردي: ندب الله- تعالى- إلى التعاون بالبر، وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله، وفي البر رضا الناس. ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته.
والإثم- كما يقول الراغب- اسم للأفعال المبطئة عن الثواب وجمعه آثام، والآثم هو المتحمل للإثم. ثم أطلق على كل ذنب ومعصية.
والعدوان: تجاوز الحدود التي أمر الشارع الناس بالوقوف عندها.
أى: وتعاونوا- أيها المؤمنون- على كل ما هو خير وبر وطاعة لله- تعالى-، ولا تتعاونوا على ارتكاب الآثام ولا على الاعتداء على حدوده، فإن التعاون على الطاعات والخيرات يؤدى إلى السعادة، أما التعاون على ما يغضب الله- تعالى- فيؤدى إلى الشقاء.
قال الآلوسى: والجملة عطف على قوله وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ من حيث المعنى، فكأنه قيل:
لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل أن صدوكم عنه، وتعاونوا على العفو والإغضاء.
وقال بعضهم: هو استئناف، والوقف على أَنْ تَعْتَدُوا لازم.
هذا، وفي معنى هذه الجملة الكريمة وردت أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلّم عن أبى مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إنى أبدع بي- أى: هلكت دابتي التي أركبها- فاحملني فقال: «ما عندي» . فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وروى الإمام مسلّم- أيضا- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا».
وقوله- تعالى- وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ تذييل قصد به إنذار الذين يتعاونون على الإثم والعدوان. أى: اتقوا الله- أيها الناس- واخشوه فيما أمركم ونهاكم، فإنه- سبحانه شديد العقاب لمن خالف أمره، وانحرف عن طريقه القويم.
وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد نهت المؤمنين عن استحلال ما حرمه الله عليهم من محارم، وعن الإخلال بشيء من أحكامها، كما نهتهم عن أن يحملهم بغضهم لغيرهم على الاعتداء عليه وأمرتهم بأن يتعاونوا على فعل الخير الذي ينفعهم وينفع غيرهم من الناس وعلى ما يوصلهم إلى طاعته- سبحانه- وحسن مثوبته، ولا يتعاونوا على الأفعال التي يأثم فاعلها، وعلى مجاوزة حدود الله بالاعتداء على غيرهم. ثم حذرتهم في نهايتها من العقاب الشديد الذي ينزله سبحانه- بكل من عصاه، وانحرف عن هداه.
ثم شرع- سبحانه- في بيان المحرمات التي أشار إليها قبل ذلك بقوله: إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فبين ما يحرم أكله من الحيوان لأسباب معينة فقال- تعالى-:
ثم قال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج .
وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله .
وقيل : شعائر الله محارمه [ التي حرمها ] أي : لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ; ولهذا قال [ تعالى ] ( ولا الشهر الحرام ) يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه ، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال ، وتأكيد اجتناب المحارم ، كما قال تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) [ البقرة : 217 ] ، وقال تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا [ في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ] ) الآية . [ التوبة : 36 ] .
وفي صحيح البخاري : عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان " .
وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت ، كما هو مذهب طائفة من السلف .
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ولا الشهر الحرام ) يعني : لا تستحلوا قتالا فيه . وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري ، واختاره ابن جرير أيضا ، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم ، واحتجوا بقوله : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] قالوا : والمراد أشهر التسيير الأربعة ، [ ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ] قالوا : فلم يستثن شهرا حراما من غيره .
وقد حكى الإمام أبو جعفر [ رحمه الله ] الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة ، قال : وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم ، لم يكن ذلك له أمانا من القتل ، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر ، له موضع أبسط من هذا .
[ و ] قوله : ( ولا الهدي ولا القلائد ) يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت ; فإن فيه تعظيما لشعائر الله ، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء ، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها ، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ; ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة ، وهو وادي العقيق ، فلما أصبح طاف على نسائه ، وكن تسعا ، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ، ثم أشعر هديه وقلده ، وأهل بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين ، من أحسن الأشكال والألوان ، كما قال تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) [ الحج : 32 ] .
قال بعض السلف : إعظامها : استحسانها واستسمانها .
وقال علي بن أبي طالب : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن . رواه أهل السنن
وقال مقاتل بن حيان : ( ولا القلائد ) فلا تستحلوا وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر ، وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجر الحرم ، فيأمنون به .
رواه ابن أبي حاتم ، ثم قال : حدثنا محمد بن عمار ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : نسخ من هذه السورة آيتان : آية القلائد ، وقوله : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] .
وحدثنا المنذر بن شاذان ، حدثنا زكريا بن عدي ، حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء ؟ قال : لا .
وقال عطاء : كانوا يتقلدون من شجر الحرم ، فيأمنون ، فنهى الله عن قطع شجره . وكذا قال مطرف بن عبد الله .
وقوله : ( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام ، الذي من دخله كان آمنا ، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه ، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه .
قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان في قوله : ( يبتغون فضلا من ربهم ) يعني بذلك : التجارة .
وهذا كما تقدم في قوله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [ البقرة : 198 ]
وقوله : ( ورضوانا ) قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم .
وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج : أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري ، كان قد أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت ، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت ، فأنزل الله عز وجل ( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) .
وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله ، إذا لم يكن له أمان ، وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس ; فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم ، والله أعلم . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به ، فهذا يمنع كما قال [ تعالى ] ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28 ] ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع - لما أمر الصديق على الحجيج - عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة ، وألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان .
وقال [ علي ] بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني من توجه قبل البيت الحرام ، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام ، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله بعدها : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28 ] وقال تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) [ التوبة : 17 ] وقال [ تعالى ] : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) [ التوبة : 18 ] فنفى المشركين من المسجد الحرام .
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة في قوله : ( ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ) قال : منسوخ ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر ، فلم يعرض له أحد ، وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد . وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت ، فنسخها قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] . .
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ( ولا القلائد ) يعني : إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه ، قال : ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك ، قال الشاعر :
ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم يمران الأيدي اللحاء المصفرا
وقوله : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه ، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد . وهذا أمر بعد الحظر ، والصحيح الذي يثبت على السبر : أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي ، فإن كان واجبا رده واجبا ، وإن كان مستحبا فمستحب ، أو مباحا فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب ، ينتقض عليه بآيات كثيرة ، ومن قال : إنه للإباحة ، يرد عليه آيات أخر ، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه ، كما اختاره بعض علماء الأصول ، والله أعلم .
وقوله : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) ومن القراء من قرأ : " أن صدوكم " بفتح الألف من " أن " ومعناها ظاهر ، أي : لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام ، وذلك عام الحديبية ، على أن تعتدوا [ في ] حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا ، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد . وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) [ المائدة : 8 ] أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل ، فإن العدل واجب على كل أحد ، في كل أحد ، في كل حال .
وقال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ، والعدل به قامت السموات والأرض .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت ، وقد اشتد ذلك عليهم ، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق ، يريدون العمرة ، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية .
والشنآن هو : البغض . قاله ابن عباس وغيره ، وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا ، بالتحريك ، مثل قولهم : جمزان ، ودرجان ورفلان ، من جمز ، ودرج ، ورفل . قال ابن جرير : من العرب من يسقط التحريك في شنآن ، فيقول : شنان . قال : ولم أعلم أحدا قرأ بها ، ومنه قول الشاعر :
وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإن لام فيه ذو الشنان وفندا
وقوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات ، وهو البر ، وترك المنكرات وهو التقوى ، وينهاهم عن التناصر على الباطل . والتعاون على المآثم والمحارم .
قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعله ، والعدوان : مجاوزة ما حد الله في دينكم ، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم .
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن جده أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " . قيل : يا رسول الله ، هذا نصرته مظلوما ، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال : " تحجزه تمنعه فإن ذلك نصره " .
انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه ، وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " . قيل : يا رسول الله ، هذا نصرته مظلوما ، فكيف أنصره ظالما؟ قال : " تمنعه من الظلم ، فذاك نصرك إياه " .
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد ، عن يحيى بن وثاب ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " .
وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر : حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب ، عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، [ قال الأعمش : هو ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم " .
وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف ، كلاهما عن الأعمش به .
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي ، حدثنا بكر بن عبد الرحمن ، حدثنا عيسى بن المختار ، عن ابن أبي ليلى ، عن فضيل بن عمرو ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدال على الخير كفاعله " . ثم قال : لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد .
قلت : وله شاهد في الصحيح : " من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا " .
وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي ، حدثنا أبي ، حدثنا عمرو بن الحارث ، عن عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مشى مع ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج من الإسلام " .
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر
القول في تأويل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } اختلف أهل التأويل في معنى قول الله : { لا تحلوا شعائر الله } فقال بعضهم : معناه : لا تحلوا حرمات الله , ولا تتعدوا حدوده . كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم , وتأولوا لا تحلوا شعائر الله : معالم حدود الله , وأمره , ونهيه , وفرائضه . ذكر من قال ذلك : 8594 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي , قال : ثنا حبيب المعلم , عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله , فقال : حرمات الله : اجتناب سخط الله , واتباع طاعته , فذلك شعائر الله . وقال آخرون : معنى قوله : { لا تحلوا } حرم الله . فكأنهم وجهوا معنى قوله : { شعائر الله } أي معالم حرم الله من البلاد . ذكر من قال ذلك : 8595 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } قال : أما شعائر الله : فحرم الله . وقال آخرون : معنى ذلك : لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها . وكأنهم وجهوا تأويل ذلك إلى : لا تحلوا معالم حدود الله التي حدها لكم في حجكم . ذكر من قال ذلك : 8596 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , قال : قال ابن جريج , قال ابن عباس : { لا تحلوا شعائر الله } قال : مناسك الحج . 8597 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثنا معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام , ويهدون الهدايا , ويعظمون حرمة المشاعر , ويتجرون في حجهم , فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم , فقال الله عز وجل : { لا تحلوا شعائر الله } . 8598 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : { شعائر الله } الصفا والمروة , والهدي , والبدن , كل هذا من شعائر الله . * - حدثني المثنى , قال : ثني أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . وقال آخرون : معنى ذلك : لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم . ذكر من قال ذلك : 8599 - حدثنا محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { لا تحلوا شعائر الله } قال : شعائر الله : ما نهى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم . وكأن الذين قالوا هذه المقالة , وجهوا تأويل ذلك إلى : لا تحلوا معالم حدود الله التي حرمها عليكم في إحرامكم . وأولى التأويلات بقوله : { لا تحلوا شعائر الله } قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى : لا تحلوا حرمات الله , ولا تضيعوا فرائضه ; لأن الشعائر جمع شعيرة , والشعيرة : فعيلة من قول القائل : قد شعر فلان بهذا الأمر : إذا علم به , فالشعائر : المعالم من ذلك . وإذا كان ذلك كذلك , كان معنى الكلام : لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله , فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج , من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم , وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها , وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه , وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه ; لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل , يعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه . وإنما قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى : { لا تحلوا شعائر الله } لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده , وإحلالها نهيا عاما من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء , فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها , ولا حجة بذلك كذلك .الله ولا الشهر
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا الشهر الحرام } يعني جل ثناؤه بقوله : { ولا الشهر الحرام } ولا تستحلوا الشهر الحرام بقتالكم به أعداءكم من المشركين , وهو كقوله : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير } وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن عباس وغيره . ذكر من قال ذلك : 8600 - حدثني المثنى قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { ولا الشهر الحرام } يعني : لا تستحلوا قتالا فيه . 8601 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , قال : كان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت , فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت . وأما الشهر الحرام الذي عناه الله بقوله : { ولا الشهر الحرام } فرجب مضر , وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال . وقد قيل : هو في هذا الموضع ذو القعدة . ذكر من قال ذلك : 8602 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , عن عكرمة , قال : هو ذو القعدة . وقد بينا الدلالة على صحة ما قلنا في ذلك فيما مضى , وذلك في تأويل قوله : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه }الحرام ولا الهدي ولا
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا الهدي ولا القلائد } أما الهدي : فهو ما أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك إلى بيت الله , تقربا به إلى الله وطلب ثوابه . يقول الله عز وجل : فلا تستحلوا ذلك فتغضبوا أهله عليه , ولا تحولوا بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلغوا به المحل الذي جعله الله محله من كعبته . وقد روي عن ابن عباس أن الهدي إنما يكون هديا ما لم يقلد . 8603 - حدثني بذلك محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { ولا الهدي } قال : الهدي ما لم يقلد , وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلده . وأما قوله : { ولا القلائد } فإنه يعني : ولا تحلوا أيضا القلائد . ثم اختلف أهل التأويل في القلائد التي نهى الله عز وجل عن إحلالها , فقال بعضهم : عنى بالقلائد : قلائد الهدي ; وقالوا : إنما أراد الله بقوله : { ولا الهدي ولا القلائد } ولا تحلوا الهدايا المقلدات منها وغير المقلدات ; فقوله : { ولا الهدي } ما لم يقلد من الهدايا , { ولا القلائد } المقلد منها . قالوا : ودل بقوله : { ولا القلائد } على معنى ما أراد من النهي عن استحلال الهدايا المقلدة . ذكر من قال ذلك : 8604 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : { ولا القلائد } القلائد : مقلدات الهدي , وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم , فإن فعل ذلك وعليه قميصه فليخلعه . وقال آخرون : يعني بذلك : القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكة من لحاء السمر , وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها , من الشعر . ذكر من قال ذلك : 8605 - حدثني الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام } قال : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد , فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد . وقال آخرون : بل كان الرجل منهم يتقلد إذا أراد الخروج من الحرم أو خرج من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك من سائر قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء . ذكر من قال ذلك : 8606 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن مالك بن مغول , عن عطاء : { ولا القلائد } قال : كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم , يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم , فنزلت : { لا تحلوا شعائر الله } الآية , { ولا الهدي ولا القلائد } . 8607 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ولا القلائد } قال : القلائد : اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمن لهم . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 8608 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي , قوله : { ولا الهدي ولا القلائد } قال : إن العرب كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة , فيقيم الرجل بمكانه , حتى إذا انقضت الأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر , فيأمن حتى يأتي أهله . 8609 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال ابن زيد في قوله : { ولا القلائد } قال : القلائد : كان الرجل يأخذ لحاء شجرة من شجر الحرم فيتقلدها , ثم يذهب حيث شاء , فيأمن بذلك , فذلك القلائد . وقال آخرون : إنما نهى الله المؤمنين بقوله : { ولا القلائد } أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم فيتقلدوه كما كان المشركون يفعلون في جاهليتهم . ذكر من قال ذلك : 8610 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن عبد الملك , عن عطاء في قوله : { ولا الهدي ولا القلائد } كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السمر , فيتقلدونها , فيأمنون بها من الناس , فنهى الله أن ينزع شجرها فيتقلد . 8611 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبيد الله , عن أبي جعفر الرازي , عن الربيع بن أنس , قال : جلسنا إلى مطرف بن الشخير , وعنده رجل , فحدثهم في قوله : { ولا القلائد } قال : كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السمر فيتقلدون , فيأمنون بها في الناس , فنهى الله عز ذكره أن ينزع شجرها فيتقلد . والذي هو أولى بتأويل قوله : { ولا القلائد } إذ كانت معطوفة على أول الكلام , ولم يكن في الكلام ما يدل على انقطاعها عن أوله , ولا أنه عنى بها النهي عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شيء ; أن يكون معناه : ولا تحلوا القلائد . فإذا كان ذلك بتأويله أولى , فمعلوم أنه نهي من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلد هديا كان ذلك أو إنسانا , دون حرمة القلادة ; وأن الله عز ذكره إنما دل بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلد , فاجتزأ بذكره القلائد من ذكر المقلد , إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به . فمعنى الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله , ولا الشهر الحرام , ولا الهدي , ولا المقلد بقسميه بقلائد الحرم . وقد ذكر بعض الشعراء في شعره , ما ذكرنا عمن تأول القلائد أنها قلائد لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه , فقال وهو يعيب رجلين قتلا رجلين كانا تقلدا ذلك : ألم تقتلا الحرجين إذ أعوراكما يمران بالأيدي اللحاء المضفرا والحرجان : المقتولان كذلك . ومعنى قوله : أعوراكما : أمكناكما من عورتهما .القلائد ولا آمين البيت
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا آمين البيت الحرام } يعني بقوله عز ذكره { ولا آمين البيت الحرام } ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام العامدية , تقول منه : أممت كذا : إذا قصدته وعمدته , وبعضهم يقول : يممته , كما قال الشاعر : إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا والبيت الحرام : بيت الله الذي بمكة ; وقد بينت فيما مضى لم قيل له الحرام . { يبتغون فضلا من ربهم } يعني : يلتمسون أرباحا في تجارتهم من الله . { ورضوانا } يقول : وأن يرضى الله عنهم بنسكهم . وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم . ذكر من قال ذلك : 8612 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي , قال : أقبل الحطم بن هند البكري , ثم أحد بني قيس بن ثعلبة , حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحده , وخلف خيله خارجة من المدينة , فدعاه فقال : إلام تدعو ؟ فأخبره , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : " يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة , يتكلم بلسان شيطان " . فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال : انظروا لعلي أسلم , ولي من أشاوره . فخرج من عنده , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد دخل بوجه كافر , وخرج بعقب غادر " . فمر بسرح من سرح المدينة , فساقه , فانطلق به وهو يرتجز : قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر الوضم باتوا نياما وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد وأهدى , فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه , فنزلت هذه الآية , حتى بلغ : { ولا آمين البيت الحرام } قال له ناس من أصحابه : يا رسول الله خل بيننا وبينه , فإنه صاحبنا ! قال : " إنه قد قلد " . قالوا : إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية . فأبى عليهم , فنزلت هذه الآية 8613 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن عكرمة , قال : قدم الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري المدينة في عير له يحمل طعاما , فباعه . ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم , فبايعه , وأسلم . فلما ولى خارجا نظر إليه , فقال لمن عنده : " لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر " . فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام , وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي القعدة , يريد مكة ; فلما سمع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره , فأنزل الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } الآية , فانتهى القوم . قال ابن جريج : قوله : { ولا آمين البيت الحرام } قال : ينهى عن الحجاج أن تقطع سبلهم . قال : وذلك أن الحطم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليرتاد وينظر , فقال : إني داعية قومي , فاعرض علي ما تقول ! قال له : " أدعوك إلى الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا , وتقيم الصلاة , وتؤتي الزكاة , وتصوم شهر رمضان , وتحج البيت " . قال الحطم : في أمرك هذا غلظة , أرجع إلى قومي فأذكر لهم ما ذكرت , فإن قبلوه أقبلت معهم , وإن أدبروا كنت معهم . قال له : " ارجع ! " فلما خرج , قال : " لقد دخل علي بوجه كافر وخرج من عندي بعقبى غادر , وما الرجل بمسلم " . فمر على سرح لأهل المدينة , فانطلق به فطلبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ففاتهم . وقدم اليمامة , وحضر الحج , فجهز خارجا , وكان عظيم التجارة , فاستأذنوا أن يتلقوه ويأخذوا ما معه , فأنزل الله عز وجل : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام } 8614 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا آمين البيت الحرام } 000 الآية , قال : هذا يوم الفتح جاء ناس يؤمون البيت من المشركين , يهلون بعمرة , فقال المسلمون : يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون , فمثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ! فنزل القرآن : { ولا آمين البيت الحرام } 8615 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { ولا آمين البيت الحرام } يقول : من توجه حاجا . 8616 - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن جويبر , عن الضحاك في قوله : { ولا آمين البيت الحرام } يعني : الحاج . 8617 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبيد الله بن موسى , عن أبي جعفر الرازي , عن الربيع بن أنس , قال : جلسنا إلى مطرف بن الشخير وعنده رجل , فحدثهم فقال : { ولا آمين البيت الحرام } قال : الذين يريدون البيت . ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخا , فقال بعضهم : نسخ جميعها . ذكر من قال ذلك : 8618 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن بيان , عن عامر , قال : لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد } . 8619 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا يزيد بن هارون , عن سفيان بن حسين , عن الحكم , عن مجاهد : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } نسختها : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } . * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن بيان , عن الشعبي , قال : لم ينسخ من سورة المائدة غير هذه الآية : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } . 8620 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام } الآية , قال : منسوخ . قال : كان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت , فأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحرم ولا عند البيت , فنسخها قوله : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } . 8621 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو معاوية , عن جويبر , عن الضحاك : { لا تحلوا شعائر الله } إلى قوله : { ولا آمين البيت الحرام } قال : نسختها براءة : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } . * - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : ثنا هشيم , عن الضحاك , مثله . * - حدثنا ابن حميد وابن وكيع , قالا : ثنا جرير , عن منصور , عن حبيب بن أبي ثابت : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد } قال : هذا شيء نهي عنه , فترك كما هو . 8622 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام } قال : هذا كله منسوخ , نسخ هذا أمره بجهادهم كافة . وقال آخرون : الذي نسخ من هذه الآية , قوله : { ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام } ذكر من قال ذلك : 8623 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبدة بن سليمان , قال : قرأت على ابن أبي عروبة , فقال : هكذا سمعته من قتادة نسخ من المائدة : { آمين البيت الحرام } نسختها براءة , قال الله : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } , وقال : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر } , وقال : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } وهو العام الذي حج فيه أبو بكر , فنادى فيه بالأذان . * - حدثني المثنى , قال : ثنا الحجاج بن المنهال , قال : ثنا همام بن يحيى , عن قتادة , قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } الآية , قال : فنسخ منها : { آمين البيت الحرام } نسختها براءة , فقال : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } , فذكر نحو حديث عبدة . 8624 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي , قال : نزل في شأن الحطم : { ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام } ثم نسخه الله فقال : { اقتلوهم حيث ثقفتموهم } . 8625 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { لا تحلوا شعائر الله } إلى قوله : { ولا آمين البيت } جميعا , فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر , ثم أنزل الله بعد هذا : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } , وقال : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله } , وقال : { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } فنفى المشركين من المسجد الحرام . 8626 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام } الآية , قال : منسوخ , كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج , تقلد من السمر فلم يعرض له أحد , وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد , وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت , وأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحرم ولا عند البيت , فنسخها قوله : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } . وقال آخرون : لم ينسخ من ذلك شيء إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء الشجر . ذكر من قال ذلك : 8627 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام } الآية , قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : هذا كله من عمل الجاهلية , فعله وإقامته , فحرم الله ذلك كله بالإسلام , إلا لحاء القلائد , فترك ذلك . { ولا آمين البيت الحرام } فحرم الله على كل أحد إخافتهم . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . وأولى الأقوال في ذلك بالصحة , قول من قال : نسخ الله من هذه الآية قوله : { ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام } لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها , وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان . وقد بينا فيما مضى معنى القلائد في غير هذا الموضع . وأما قوله : { ولا آمين البيت الحرام } فإنه محتمل ظاهره : ولا تحلوا حرمة آمين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام , لعموم جميع من أم البيت . وإذا احتمل ذلك , فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم , فلا شك أن قوله : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ناسخ له ; لأنه غير جائز اجتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال واحدة ووقت واحد . وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم , أموا البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم وغيرها , ما يعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيت الحرام منسوخ , ومحتمل أيضا : ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك , وأكثر أهل التأويل على ذلك . وإن كان عني بذلك المشركون من أهل الحرب , فهو أيضا لا شك منسوخ . وإذ كان ذلك كذلك وكان لا اختلاف في ذلك بينهم ظاهر , وكان ما كان مستفيضا فيهم ظاهر الحجة , فالواجب وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا , التسليم لما استفاض بصحته نقلهم .الحرام يبتغون فضلا من ربهم
القول في تأويل قوله تعالى : { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } يعني بقوله : { يبتغون } يطلبون ويلتمسون . والفضل : الإرباح في التجارة ; والرضوان : رضا الله عنهم , فلا يحل بهم من العقوبة في الدنيا ما أحل بغيرهم من الأمم في عاجل دنياهم بحجهم بيته . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 8628 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : ثنا معمر , عن قتادة في قوله : { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } قال : هم المشركون يلتمسون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبدة بن سليمان , قال : قرأت على ابن أبي عروبة , فقال : هكذا سمعته من قتادة في قوله : { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } والفضل والرضوان : اللذان يبتغون أن يصلح معايشهم في الدنيا , وأن لا يعجل لهم العقوبة فيها . 8629 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس . { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } يعني : أنهم يترضون الله بحجهم . 8630 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبيد الله , عن أبي جعفر الرازي , عن الربيع بن أنس , قال : جلسنا إلى مطرف بن الشخير , وعنده رجل , فحدثهم في قوله : { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } قال : التجارة في الحج , والرضوان في الحج . 8631 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن أبي أميمة , قال : قال ابن عمر في الرجل يحج , ويحمل معه متاعا , قال : لا بأس به . وتلا هذه الآية : { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } . 8632 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } قال : يبتغون الأجر والتجارة .ورضوانا وإذا حللتم
القول في تأويل قوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } يعني بذلك جل ثناؤه : { وإذا حللتم فاصطادوا } الصيد الذي نهيتكم أن تحلوه وأنتم حرم , يقول : فلا حرج عليكم في اصطياده واصطادوا إن شئتم حينئذ ; لأن المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد زال . وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 8633 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : ثنا حصين , عن مجاهد , أنه قال : هي رخصة . يعني قوله : { وإذا حللتم فاصطادوا } . 8634 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد الأحمر , عن حجاج , عن القاسم , عن مجاهد , قال : خمس في كتاب الله رخصة , وليست بعزمة , فذكر : { وإذا حللتم فاصطادوا } قال : من شاء فعل , ومن شاء لم يفعل . 8635 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد , عن حجاج , عن عطاء , مثله . 8636 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن حصين , عن مجاهد : { وإذا حللتم فاصطادوا } قال : إذا حل , فإن شاء صاد , وإن شاء لم يصطد . 8637 - حدثنا ابن وكيع , قال : حدثنا ابن إدريس , عن ابن جريج , عن رجل , عن مجاهد : أنه كان لا يرى الأكل من هدي المتعة واجبا , وكان يتأول هذه الآية : { وإذا حللتم فاصطادوا } { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } .فاصطادوا ولا
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا يجرمنكم } يعني جل ثناؤه بقوله : { ولا يجرمنكم } ولا يحملنكم . كما : 8638 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } يقول : لا يحملنكم شنآن قوم . 8639 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } أي لا يحملنكم . وأما أهل المعرفة باللغة , فإنهم اختلفوا في تأويلها , فقال بعض البصريين : معنى قوله : { ولا يجرمنكم } لا يحقن لكم ; لأن قوله : { لا جرم أن لهم النار } هو حق أن لهم النار . وقال بعض الكوفيين معناه : لا يحملنكم . وقال : يقال : جرمني فلان على أن صنعت كذا وكذا : أي حملني عليه . واحتج جميعهم ببيت الشاعر : ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا فتأول ذلك كل فريق منهم على المعنى الذي تأوله من القرآن , فقال الذين قالوا : { لا يجرمنكم } لا يحقن لكم معنى قول الشاعر : جرمت فزارة : أحقت الطعنة لفزارة الغضب . وقال الذين قالوا معناه : لا يحملنكم : معناه في البيت : " جرمت فزارة أن يغضبوا " : حملت فزارة على أن يغضبوا . وقال آخر من الكوفيين : معنى قوله : { لا يجرمنكم } لا يكسبنكم شنآن قوم . وتأويل قائل هذا القول قول الشاعر في البيت : " جرمت فزارة " : كسبت فزارة أن يغضبوا . قال : وسمعت العرب تقول : فلان جريمة أهله , بمعنى : كاسبهم , وخرج يجرمهم : يكسبهم . وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه متقاربة المعنى ; وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل فقد أكسبه بغضه , ومن أكسبه بغضه فقد أحقه له . فإذا كان ذلك كذلك , فالذي هو أحسن في الإبانة عن معنى الحرف , ما قاله ابن عباس وقتادة , وذلك توجيههما معنى قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } ولا يحملنكم شنآن قوم على العدوان . واختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأته عامة قراء الأمصار : { ولا يجرمنكم } بفتح الياء من : جرمته أجرمه . وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين , وهو يحيى بن وثاب والأعمش , ما : 8640 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع , قالا : ثنا جرير , عن الأعمش , أنه قرأ : "ولا يجرمنكم " مرتفعة الياء من أجرمته أجرمه وهو يجرمني . والذي هو أولى بالصواب من القراءتين , قراءة من قرأ ذلك : { ولا يجرمنكم } بفتح الياء , لاستفاضة القراءة بذلك في قراء الأمصار وشذوذ ما خالفها , وأنها اللغة المعروفة السائرة في العرب , وإن كان مسموعا من بعضها : أجرم يجرم , على شذوذه , وقراءة القرآن بأفصح اللغات أولى وأحق منها بغير ذلك ومن لغة من قال : جرمت , قول الشاعر : يا أيها المشتكي عكلا وما جرمت إلى القبائل من قتل وإبآسيجرمنكم شنآن
القول في تأويل قوله تعالى : { شنآن قوم } اختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأه بعضهم : { شنآن } بتحريك الشين والنون إلى الفتح , بمعنى : بغض قوم توجيها منهم ذلك إلى المصدر الذي يأتي على فعلان نظير الطيران , والنسلان , والعسلان , والرملان . وقرأ ذلك آخرون : { شنآن قوم } بتسكين النون وفتح الشين , بمعنى الاسم ; توجيها منهم معناه إلى : لا يحملنكم بغض قوم , فيخرج شنآن على تقدير فعلان ; لأن فعل منه على فعل , كما يقال : سكران من سكر , وعطشان من عطش , وما أشبه ذلك من الأسماء . والذي هو أولى القراءتين في ذلك بالصواب , قراءة من قرأ : { شنآن } بفتح النون محركة , لشائع تأويل أهل التأويل على أن معناه : بغض قوم , وتوجيههم ذلك إلى معنى المصدر دون معنى الاسم . وإذ كان ذلك موجها إلى معنى المصدر , فالفصيح من كلام العرب فيما جاء من المصادر على الفعلان بفتح الفاء تحريك ثانيه دون تسكينه , كما وصفت من قولهم : الدرجان , والرملان من درج ورمل , فكذلك الشنآن من شنئته أشنؤه شنآنا . ومن العرب من يقول : شنآن على تقدير فعال , ولا أعلم قارئا قرأ ذلك كذلك , ومن ذلك قول الشاعر : وما العيش إلا ما يلذ ويشتهى وإن لام فيه ذو الشنان وفندا وهذا في لغة من ترك الهمز من الشنآن , فصار على تقدير فعال وهو في الأصل فعلان . ذكر من قال من أهل التأويل : { شنآن قوم } بغض قوم . 8641 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } لا يحملنكم بغض قوم . * - وحدثني به المثنى مرة أخرى بإسناده , عن ابن عباس , فقال : لا يحملنكم عداوة قوم أن تعتدوا . 8642 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } لا يجرمنكم بغض قوم . 8643 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } قال : بغضاؤهم أن تعتدوا .قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن
القول في تأويل قوله تعالى : { أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا } اختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأه بعض أهل المدينة وعامة قراء الكوفيين : { أن صدوكم } بفتح الألف من " أن " بمعنى : لا يجرمنكم بغض قوم بصدهم إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وكان بعض قراء الحجاز والبصرة يقرأ ذلك : " ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم " بكسر الألف من " إن "بمعنى : ولا يجرمنكم شنآن قوم إن هم أحدثوا لكم صدا عن المسجد الحرام , أن تعتدوا . فزعموا أنها في قراءة ابن مسعود : " إن يصدكم "فقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءته . والصواب من القول في ذلك عندي , أنهما قراءتان معروفتان مشهورتان في قراءة الأمصار , صحيح معنى كل واحدة منهما . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت هو وأصحابه يوم الحديبية , وأنزلت عليه سورة المائدة بعد ذلك . فمن قرأ : { أن صدوكم } بفتح الألف من " أن " فمعناه : لا يحملنكم بغض قوم أيها الناس من أجل أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام , أن تعتدوا عليهم . ومن قرأ : " إن صدوكم " بكسر الألف , فمعناه : لا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام إذا أردتم دخوله ; لأن الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش يوم فتح مكة قد حاولوا صدهم عن المسجد الحرام قبل أن يكون ذلك من الصادين . غير أن الأمر وإن كان كما وصفت , فإن قراءة ذلك بفتح الألف أبين معنى ; لأن هذه السورة لا تدافع بين أهل العلم في أنها نزلت بعد يوم الحديبية . وإذ كان ذلك كذلك , فالصد قد كان تقدم من المشركين , فنهى الله المؤمنين عن الاعتداء على الصادين من أجل صدهم إياهم عن المسجد الحرام , وأما قوله : { أن تعتدوا } فإنه يعني : أن تجاوزوا الحد الذي حده الله لكم في أمرهم . فتأويل الآية إذن : ولا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أيها المؤمنون أن تعتدوا حكم الله فيهم فتجاوزوه إلى ما نهاكم عنه , ولكن الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . وذكر أنها نزلت في النهي عن الطلب بذحول الجاهلية . ذكر من قال ذلك : 8644 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : { أن تعتدوا } رجل مؤمن من حلفاء محمد , قتل حليفا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة ; لأنه كان يقتل حلفاء محمد , فقال محمد صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من قتل بذحل الجاهلية " * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . وقال آخرون : هذا منسوخ . ذكر من قال ذلك : 8645 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا } قال : بغضاؤهم , حتى تأتوا ما لا يحل لكم . وقرأ { أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا } وتعاونوا , قال : هذا كله قد نسخ , نسخه الجهاد . وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد : إنه غير منسوخ لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به . وإذا احتمل ذلك , لم يجز أن يقال : هو منسوخ , إلا بحجة يجب التسليم لها .تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
القول في تأويل قوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } يعني جل ثناؤه بقوله : { وتعاونوا على البر والتقوى } وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر , وهو العمل بما أمر الله بالعمل به { والتقوى } هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه . وقوله : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } يعني : ولا يعن بعضكم بعضا على الإثم , يعني : على ترك ما أمركم الله بفعله . { والعدوان } يقول : ولا على أن تتجاوزوا ما حد الله لكم في دينكم , وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم . وإنما معنى الكلام : ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا , ولكن ليعن بعضكم بعضا بالأمر بالانتهاء إلى ما حده الله لكم في القوم الذين صدوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم , والانتهاء عما نهاكم الله أن تأتوا فيهم وفي غيرهم وفي سائر ما نهاكم عنه , ولا يعن بعضكم بعضا على خلاف ذلك . وبما قلنا في البر والتقوى قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 8646 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { وتعاونوا على البر والتقوى } البر : ما أمرت به , والتقوى : ما نهيت عنه . 8647 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع , عن أبي العالية في قوله : { وتعاونوا على البر والتقوى } قال : البر : ما أمرت به , والتقوى : ما نهيت عنه .والعدوان واتقوا الله إن الله شديد
القول في تأويل قوله تعالى : { واتقوا الله إن الله شديد العقاب } وهذا وعيد من الله جل ثناؤه وتهديد لمن اعتدى حده وتجاوز أمره . يقول عز ذكره : { واتقوا الله } يعني : واحذروا الله أيها المؤمنون أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حده فيما حد لكم وخالفتم أمره فيما أمركم به أو نهيه فيما نهاكم عنه , فتستوجبوا عقابه وتستحقوا أليم عذابه ثم وصف عقابه بالشدة , فقال عز ذكره : إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من خلقه ; لأنها نار لا يطفأ حرها , ولا يخمد جمرها , ولا يسكن لهبها . نعوذ بالله منها ومن عمل يقربنا منها .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّـهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ النهي عن استحلال المحرَّمات، ومنها: محظورات الإحرام، والصيد في الحرم، والقتال في الأشهر الحُرُم، واستحلال الهَدْي بغصب ونحوه، أو مَنْع وصوله إلى محله.
وقفة
[2] ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ معطوف على شعائر الله، والمراد به الجنس، فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، وسمي الشهر حرامًا باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام.
لمسة
[2] لم يأتِ التعبير بالأشمل: (ولا قاصدين مكة) بدلًا من: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ أي قاصدين الحرم؛ وذلك لأن قصد مكة قد يكون للعبادة، وقد يكون للتجارة ونحوها، والحرمة لا تخصُّ إلا المُحرِم للعبادة، أما البيت الحرام فلا يُقصد إلا للعبادة.
وقفة
[2] ﴿ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً﴾ قال ابن جرير: «هم قاصدو البيت الحرام، يبتغون أن يرضى الله عنهم بنسكهم».
عمل
[2] ما أحسن العبد -وهو ذاهب لأداء نسكه- أن يستشعر هذه الآية: ﴿ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً﴾ لعل ذلك يحدوه إلى امتثالها، ودعاء الله بتحقيقها.
عمل
[2] ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ حذار أن تدفعكم كراهية أحد إلى الجور عليه والعدوان، قال ابن كثير: «لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد، في كل حال».
وقفة
[2] ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ عن زيد بن أسلم قال: «كان رسول الله r وأصحابه بالحديبية، حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال الصحابة: نصد هؤلاء کما صدنا أصحابهم، فنزلت هذه الآية».
وقفة
[2] قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾.
لمسة
[2] ﴿شَنَآنُ﴾ الشنآن هو شدة البُغض، وهو مصدر دالٌ على الاضطراب والتقلّب؛ لأن الشنآن فيه اضطراب النفس، فهو مثل الغليان.
لمسة
[2] ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ المسجد الحرام اسم جُعِل علَمًا للغلبة على المكان المحيط بالكعبة المحصور ذي الأبواب، وهو اسم إسلامي، ولم يكن يُدعى بذلك في الجاهلية؛ لأن المسجد مكان السجود، ولم يكن لأهل الجاهلية سجود عند الكعبة.
وقفة
[2] ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ لا فرق في أصل طلب التعاون بين أن يكون الخير من مصالح الحياة الدنيا التي أذنت الشريعة بإقامتها، وأن يكون من وسائل السعادة في الأخرى.
وقفة
[2] ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته.
وقفة
[2] ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ وصية عامة، والفرق بين البرِّ والتقوى: أن البرَّ عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات، وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبرُّ أعمُّ من التقوى.
وقفة
[2] ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى، ورضا الناس؛ فقد تمت سعادته، وعمت نعمته.
عمل
[2] ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ اعرض خدماتك اليوم على مؤسسة إسلامية، أو جهة تساعد المحتاجين.
وقفة
[2] قال جمهور الأئمة: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم: لا لحمًا ولا ثوبًا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
وقفة
[2] الاشتغال بالمحاماة لإحقاق الحق وإبطال الباطل على الوجه المشروع، ورد الحقوق لأهلها ورفع الظلم أمر محمود، وأخذ الأجر على ذلك جائز، أما إن كان للإعانة على الإثم والعدوان فيحرم عليه عمله وأجره، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
عمل
[2] حقِّق التقوى بشقَّيها: اتباع أوامر ربك: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾، واجتناب نواهيه: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.
عمل
[2] عود نفسك ألا تعين أحدًا على معصية الله تعالى، ولا تمنع خيرك عن أحد في طاعة الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
وقفة
[2] ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ قال ابن تيمية: «المسلم لا يحل له أن يعين أحدًا على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك؛ فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟!».
وقفة
[2] ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ النَّاس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان؛ أبغض بعضهم بعضًا.
وقفة
[2] ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ الإثم هو التجرؤ على معصية الله التي يأثم صاحبها، والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل إثم وعدوان يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.
وقفة
[2] ما أقرب العاصي مِن رحمة الله! وما أقرب الشامِت مِن مقت الله! تجاوز واستر ولا تكن سببًا في شماتة مسلم بمسلم ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا: ﴾
- سبق إعرابها في الآية الكريمة السابقة. لا: ناهية جازمة. تحلوا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف: فارقة.
- ﴿ شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا: ﴾
- مفعول به منصوب بالفتحة. الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. الواو: عاطفة و «لا» زائدة للتأكيد.
- ﴿ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا: ﴾
- الشهر: معطوفة على «شَعائِرَ» منصوب بالفتحة الحرام: صفة للشهر منصوب بالفتحة. الواو عاطفة. لا: زائدة للتأكيد.
- ﴿ الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ: ﴾
- الكلمتان: معطوفتان على «شَعائِرَ» منصوبتان مثلها بالفتحة.
- ﴿ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ: ﴾
- ولا آمين: معطوفة بالواو على «شَعائِرَ» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. أي ولا تحلوا قوما آمين البيت الحرام و «الْبَيْتَ» مفعول به لاسم الفاعل «آمِّينَ» الذي عمل عمل فعله منصوب بالفتحة الحرام: صفة للبيت منصوب بالفتحة.
- ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. فضلا: مفعول به منصوب بالفتحة. وجملة «يَبْتَغُونَ» في محل نصب صفة. لآمين. أو حال على قوم آمين يتقدير وهم مبتغون. من ربّ: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «فَضْلًا» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. ورضوانا: معطوفة بالواو على «فَضْلًا» منصوبة مثلها.
- ﴿ وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا: ﴾
- الواو: استئنافية. إذا: ظرف زمان خافض لشرطه أداة شرط غير جازمة. حللتم: في محل جر بالاضافة: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطبين. التاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور الفاء رابطة لجواب الشرط. اصطادوا: فعل أمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «فَاصْطادُوا» جواب شرط غير جازم لا محل لها.
- ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ: ﴾
- الواو عاطفة. لا: ناهية جازمة. يجرمنكم: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا. والكاف: ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. شنآن: فاعل مرفوع بالضمة. قوم: مضاف اليه مجرور بالكسرة بمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم لهم.
- ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ: ﴾
- أن: حرف مصدري. صدوكم: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «صَدُّوكُمْ» صلة «أَنْ» لا محل لها. و «أَنْ» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل رفع بدل من «شَنَآنُ» أي صدهم إياكم أو يجوز أن يكون في محل نصب مفعولا له.
- ﴿ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصدوكم. الحرام: صفة- نعت- للمسجد مجرور مثله بالكسرة.
- ﴿ أَنْ تَعْتَدُوا: ﴾
- أن: حرف مصدري ناصب. تعتدوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف فارقة. و «أن وما تلاها» بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان للفعل «يجرمن» وجملة «تَعْتَدُوا» صلة «أَنْ» لا محل لها.
- ﴿ وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى: ﴾
- الواو: استئنافية. تعاونوا: فعل أمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف فارقة. على البر: جار ومجرور متعلق بتعاونوا. والتقوى: معطوفة بالواو على «الْبِرِّ» مجرورة بالكسرة المقدرة على الالف للتعذر.
- ﴿ وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ: ﴾
- الواو: عاطفة. لا تعاونوا: تعرب إعراب «لا تُحِلُّوا». على الإثم: جار ومجرور متعلق. بتعاونوا. والعدوان: معطوفة بالواو على «الْإِثْمِ» مجرورة مثلها بالكسرة. وأصل تعاونوا: تتعاونوا حذفت أحدى التاءين اختصارا.
- ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ: ﴾
- تعرب أعراب «تَعاوَنُوا». الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة.
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: ﴾
- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسمها منصوب للتعظيم بالفتحة. شديد: خبر «أَنْ» مرفوع بالضمة. العقاب: مضاف اليه مجرور بالكسرة. '
المتشابهات :
| المائدة: 2 | ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ |
|---|
| الفتح: 29 | ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ |
|---|
| الحشر: 8 | ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}؛ قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يَغِيرُوا عليهم؛ فقال الله -عزّ وجلّ-: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} . [حسن] عن قتادة في قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}؛ قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السمر فلم يعرض له أحد، وإذا تقلد قلادة من شعر لم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يُصدّ عن البيت؛ فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت؛ فنسخها قوله -تعالى-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] . [ضعيف]عن السدي؛ قال: أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بني قيس بن ثعلبة، حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه، فقال: إلام تدعو فأخبره، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان"، فلما أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: انظروا لعلِّي أُسلم ولي من أشاوره، فخرج من عنده؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر"، فمر بسرح من سرح المدينة فساقه فانطلق به وهو يرتجز:قد لفها الليل بسوّاق حطم ... ليس براعي إبل ولا غنمولا بجزار على ظهر الوضم ... باتوا نياماً وابن هند لم ينمبات يقاسيها غلام كالزلم ... خدلج الساقين ممسوح القدم ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلّد وأهدى، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث إليه؛ فنزلت هذه الآية حتى بلغ: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}، قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله! خلّ بينا وبينه؛ فإنه صاحبنا، قال: "إنه قد قلد"، قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأبى عليهم؛ فنزلت هذه الآية . [ضعيف جداً] عن جُبير بن نُفير؛ قال: دخلت على عائشة، فقالت لي: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال؛ فاستحلوه، ومما وجدتم فيها من حرام؛ فحرموه، وسَألتها عن خُلُقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قالت: القرآن . [حسن]'
- المصدر الاستيعاب في بيان الأسباب
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : لمَّا حرَّمَ اللهُ عز وجل الصيدَ على المُحرِم؛ أكَّدَ ذلك هنا بالنهيِ عن مخالفَةِ تكاليفِ الله، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾
القراءات :
آمين:
وقرئ:
آمى، بحذف النون للإضافة، وهى قراءة عبد الله، وأصحابه.
يبتغون:
قرئ:
1- بالياء، وهى قراءة الجمهور، فيكون صفة ل «آمين» .
2- بالتاء، خطابا للمؤمنين، وهى قراءة حميد بن قيس، والأعرج.
ورضوانا:
وقرئ:
1- بضم الراء، وهى قراءة الأعمش (وانظر 3: 15) .
حللتم:
وقرئ:
أحللتم، وهى لغة، يقال: حل من إحرامه، وأحل.
فاصطادوا:
وقرئ:
بكسر الفاء، على البدل من كسر الهمزة عند الابتداء، وهى قراءة أبى واقد، والجراح، ونبيح، والحسن بن عمران.
يجرمنكم:
وقرئ:
بسكون النون، على أنها نون التوكيد الخفيفة، وهى قراءة الحسن، وإبراهيم وابن وثاب، والوليد، عن يعقوب.
شنآن:
قرئ:
1- بفتح النون، وهى قراءة النحويين، وابن كثير، وحمزة، وحفص، ونافع.
2- بسكون النون، وهى قراءة ابن عامر، وأبى بكر.
أن صدوكم:
وقرئ:
بكسر الهمزة على أنها شرطية، وهى قراءة أبى عمرو، وابن كثير.