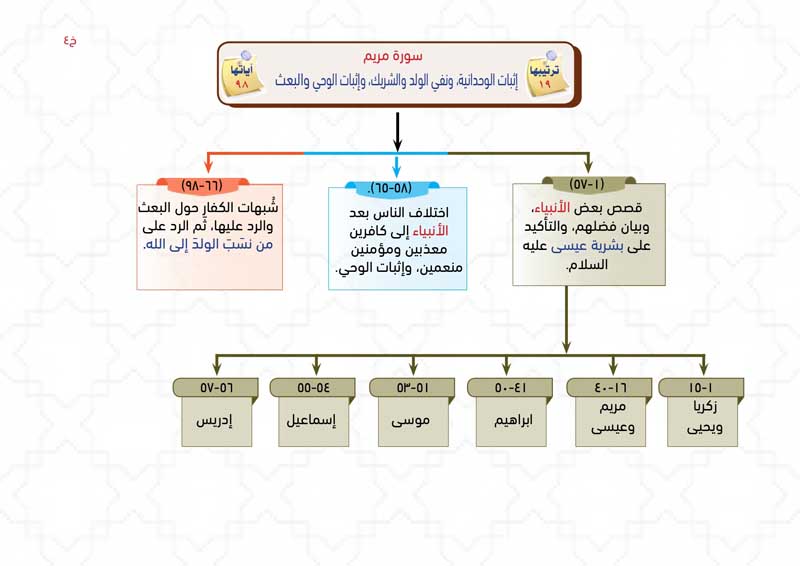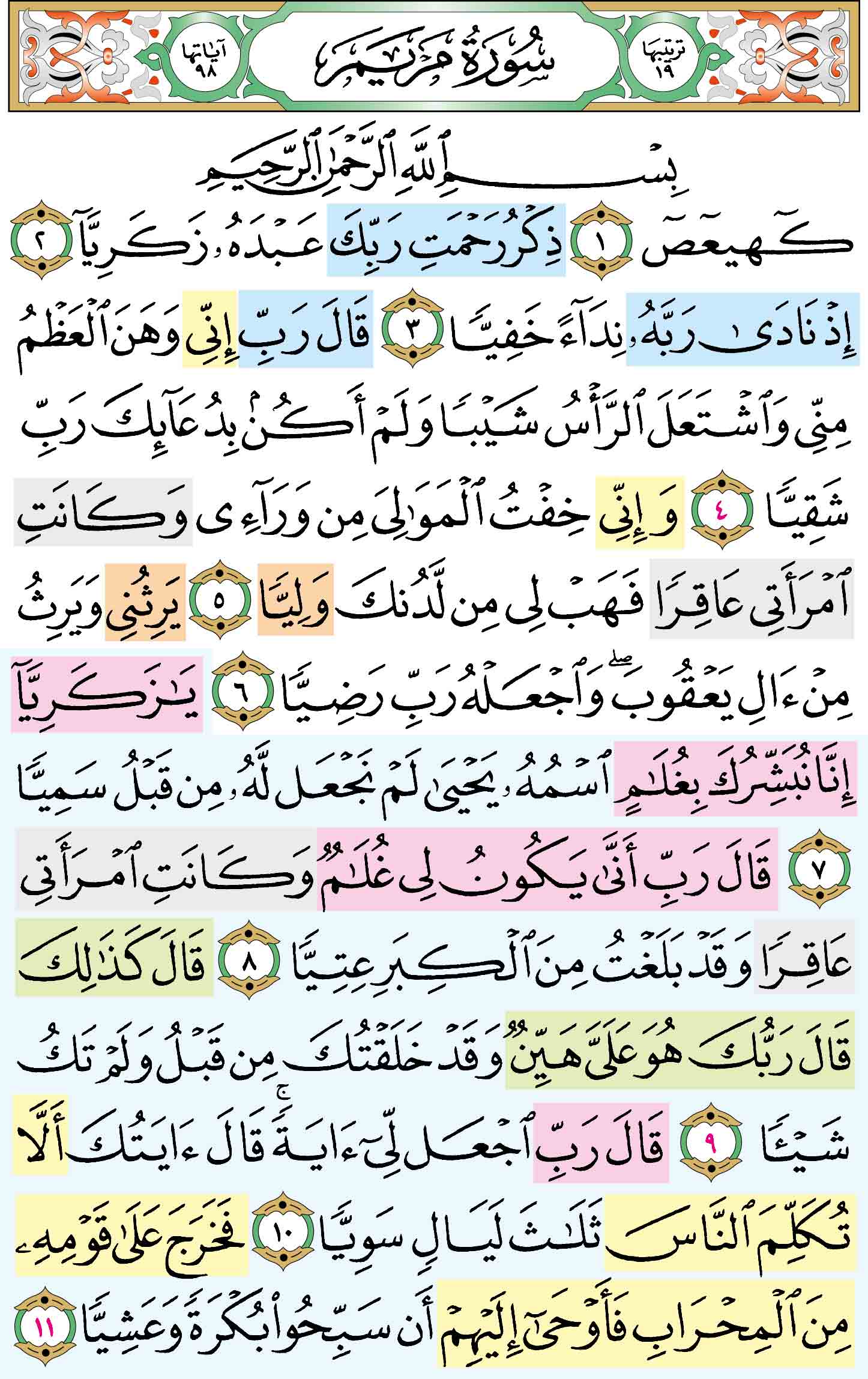
الإحصائيات
سورة مريم
| ترتيب المصحف | 19 | ترتيب النزول | 44 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 7.30 |
| عدد الآيات | 98 | عدد الأجزاء | 0.30 |
| عدد الأحزاب | 0.65 | عدد الأرباع | 2.60 |
| ترتيب الطول | 27 | تبدأ في الجزء | 16 |
| تنتهي في الجزء | 16 | عدد السجدات | 1 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 10/29 | كهيعص: 1/1 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)
القصَّةُ الأولى في هذه السورةِ: قصَّةُ زكريا عليه السلام لمَّا نادى ربَه رغمَ الشيخوخةِ وعُقرِ الزوجِ أن يهبَ له الولدَ، ليرثَ ميراثَ آلِ يعقوبَ: النبوةَ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (7) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (5)
استجابَ اللهُ دعاءَ زكريا عليه السلام ، وبشَّرَه بيحيى عليه السلام ، فتعجَّبَ وطلبَ علامةً يطمئنُّ بها، فكانت العلامةُ: أن لا تقدرَ على كلامِ النَّاسِ مدَّةَ ثلاثِ ليالٍ وأيَّامِها من غيرِ خَرَسٍ ولا مرضٍ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة مريم
رحمة الله بعباده/ توريث الدين للأبناء/ إثبات الوحدانية ونفي الولد والشريك وإثبات الوحي والبعث/ سورة المواهب
أولاً : التمهيد للسورة :
- • من هي مريم؟: مريم هي أم نبي الله عيسى. وهي أفضل نساء العالمين (من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة) بالقرآن والسنة. في القرآن: قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 42[، فقوله تعالى: «اصطفاك» أي: اختارك واجتباك وفضلك. وفي السنة: • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» . • عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيِّداتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانَ: فَاطِمَةُ، وَخَدِيجَةُ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» . • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ» . • فترتيب أفضل النساء: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية.
- • لماذا مريم هنا؟: السورة مليئة بالأنبياء الرجال، فقد ذُكر فيها: إبراهيم وزكريا ويحيي وموسى وعيسى وغيرهم، فلماذا سميت باسم المرأة الوحيدة التي ذُكرت فيها؟ وكأن الله يقول لنا: إن المرأة قد تصل مثل الرجل، وأن المرأة تستطيع أن تقدم بطولات مثل الرجال تمامًا، ولكي يعرف الجميع دور المرأة الخطير، وقدرة المرأة علي الوصول إلي الله والسبق إلي الله سبحانه وتعالي.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «مريم».
- • معنى الاسم :: هي مريم بنت عمران عليها السلام أم نبي الله عيسى عليه السلام.
- • سبب التسمية :: لأنه بسطت فيها قصة مريم وولادتها عيسى من غير أب، ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت بعد ذلك في المدينة.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: ل«سورة كهيعص»؛ لافتتاح السورة بها، وتقرأ هكذا: (كاف ها يا عين صاد).
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك وإثبات وحدانيته تعالى.
- • علمتني السورة :: أن المرأة تستطيع أن تقدم بطولات مثل الرجال تمامًا.
- • علمتني السورة :: على قدر البلاء يكون العطاء، مريم ابتلاها الله بأمر شديد، ولكن العاقبة أنها أصبحت أم نبي، ومن سيدات أهل الجنة.
- • علمتني السورة :: أن الصمت علاج ودواء، إذا كنتَ مُحاطًا بأهل القيل والقال: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالْأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي»، قال ابن حجر: «وَمُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّل مَا تُعُلِّمَ مِنْ الْقُرْآن، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاء وَالْأُمَم».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة مريم من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • أكثر سورة تكرر فيها اسم (الرحمن)، تكرر 16 مرة.
• احتوت السورة على السجدة الخامسة -بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة في القرآن الكريم.
• هي أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- يُذكَر فيها لفظ (كلا) في آيتين منها (79، 82)، وذكر هذا اللفظ في السورة يدل على أنها مكية.
• سورة مريم هي السورة التي قرأ جعفر بن أبي طالب صدرها على النجاشي فأسلم، وهذا أثناء الهجرة للحبشة.
• جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة (وهي: 29 سورة) أن يأتي الحديث عن القرآن الكريم بعد الأحرف المقطعة مباشرة؛ إلا أربع سور، وهي: مريم والعنكبوت والروم والقلم.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نرحم كل من حولنا: الكبير والصغير، القريب والبعيد، الذكر والأنثى.
• أن نورث أبناءنا حب الدين، وأهمية العمل للدين.
• ألا نيأس؛ فالسورة بدأت بقصة زكريا عليه السلام وقدرة الله في إعطائه الولد بعد أن شاب رأسه وعقمت امرأته، فلا نيأس بعد ذلك أبدًا.
• أن نلجأ إلى الله بالدعاء دائمًا: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ... فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ (2-5).
• ألا نعلّق قلوبنا بالأسباب ونغفل عن المسبِّب؛ فقد يجعل الله من المستحيل ممكنًا، ومن الممكن مستحيلًا: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ (9).
• أن نكثِر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (11).
• أن نأخذ بالأسباب، مع علمنا بأن الرزق من عند الله وحده: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ (25).
• ألا نتعجلَ في إصدارِ الأحكامِ على النَّاسِ، فلعلَّ هناك ما يَخفَى علينا: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ (27).
• ألا نقنط أبدًا، ففي الوقت المناسب يُنزل الله على عبده الصابر أنوار الفرَج شريطة أن يُديم الثناء على الله: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (30).
• ألا نأنف من أخذ العلم عمن صغر سِنُّه، أو قلت درجته عنا: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ (43).
• أن نعتزل أماكن الفساد والشر، ولا نتساهل في ذلك: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ﴾ (48).
• أن نحرص على الصدق في أقوالنا، وأفعالنا، ومواعيدنا، وعهودنا؛ فهذا من أخلاق الأنبياء: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (54).
• أن نأمر إخواننا وأهل بيتنا بالصلاة والصدقة، ونذكرهم بأدائها في وقتها: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ (55).
• أن نسارع بالتوبة وعمل الصالحات إذا وقعنا في معصية الله: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ (59-60).
• أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم؛ فقد ثبت ورودنا لها، لكن لم يثبت لنا النجاة منها: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ (71).
• أن نكثر من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ فهي من الباقيات الصالحات: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ (76).
• ألا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه، ونتذكر قول الله تعالى: ﴿كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ (79).
• أن ندعو الله تعالى أن يحشرنا في زمرة المتقين: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا﴾ (85).
• أن نتذكر أننا سنأتي الله يوم القيامة فرادى؛ ونعمل لذلك اليوم: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (95).
• أن نحمد الله على الأول، ونجتهد بالثاني، لنكسب الثالث: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَـٰنُ وُدًّا﴾ (96).
تمرين حفظ الصفحة : 305
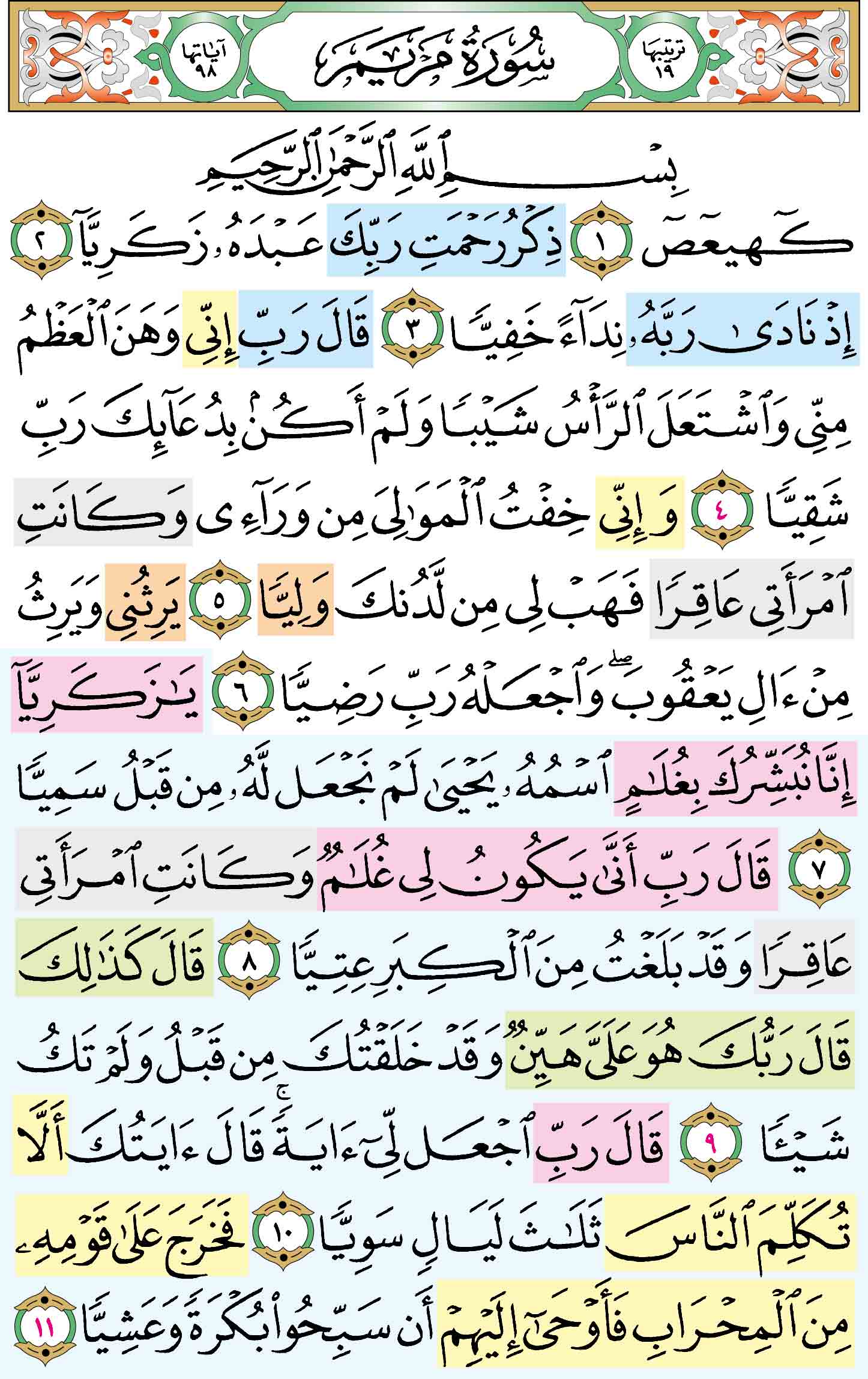
مدارسة الآية : [1] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كهيعص ﴾
التفسير :
تقدم الكلام عن الحروف المقطعة
تعريف بسورة مريم
1- سورة مريم من السور المكية.
قال القرطبي: وهي مكية بالإجماع. وهي تسعون وثماني آيات .
وقال ابن كثير: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة، من حديث أم سلمة، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة، أن جعفر بن أبى طالب- رضى الله عنه- قرأ صدر هذه السورة على النجاشيّ .
وكان نزولها بعد سورة فاطر .
2- ويبدو أن تسميتها بهذا الاسم كان بتوقيف من النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد أخرج الطبراني والديلمي، من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساني عن أبيه عن جده، قال:
أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ولدت لي الليلة جارية. فقال: والليلة أنزلت على سورة مريم.
وجاء فيما روى عن ابن عباس، تسميتها بسورة كهيعص .
وقد تكرر اسم مريم في القرآن ثلاثين مرة، ولم تذكر امرأة سواها باسمها الصريح.
3- والذي يقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل، يراها زاخرة بالحديث عن عدد من الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام-.
فقد افتتحت بالحديث عن تلك الدعوات التي تضرع بها زكريا إلى ربه، لكي يهب له وليا، يرثه ويرث من آل يعقوب.
وقد استجاب الله- تعالى- دعاء زكريا، فوهبه يحيى كما قال- تعالى-: يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.
ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن قصة مريم، بصورة فيها شيء من التفصيل، فذكرت اعتزالها لقومها ومجيء جبريل إليها وما دار بينه وبينها من محاورات، ومولدها لعيسى وإتيانها
به قومها، وما دار بينها وبينهم في شأنه. ثم ختمت هذه القصة بالقول الحق في شأن عيسى، قال- تعالى-: ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ، إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ.
5- ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن طرف من قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس، وختمت حديثها عن الرسل الكرام بقوله- تعالى-: أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ. وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا، إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا.
6- ثم حكت السورة الكريمة أنماطا من الشبهات التي تفوه بها الضالون، ومن هذه الشبهات ما يتعلق بالبعث والنشور، ومنها ما يتعلق بموقفهم من القرآن الكريم ومنها ما يتعلق بزعمهم أن لله ولدا ... وقد ردت على كل شبهة من هذه الشبهات بما يبطلها، ويخرس ألسنة قائليها.
ومن ذلك قوله- تعالى-: وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً.
وقوله- سبحانه-: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً. كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً.
وقوله- عز وجل-: وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا. تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً. وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً.
7- ومن هذا العرض الإجمالى لآيات السورة الكريمة، يتبين لنا أن سورة مريم قد اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى نفى الشريك والولد عن ذاته- سبحانه-، كما اهتمت- أيضا- بإقامة الأدلة على أن البعث حق، وعلى أن الناس سيحاسبون على أعمالهم يوم القيامة.
كما زخرت السورة بالحديث عن قصص بعض الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- تارة بشيء من التفصيل كما في قصة زكريا وعيسى ابن مريم، وتارة بشيء من الاختصار والتركيز كما في قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس.
كما نراها بوضوح تحكى شبهات المشركين. ثم ترد عليها بما يبطلها ...
وقد ساقت السورة ما ساقت من قضايا، بأسلوب عاطفى بديع، يهيج المشاعر نحو الخير والحق والفضيلة، وينفر من الشر والباطل والرذيلة، ويطلع العقول على نماذج شتى من مظاهر رحمة الله- تعالى- بعباده الصالحين ترى ذلك في مثل قوله- تعالى-: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا.
وفي مثل قوله- سبحانه-: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا.
8- قال بعض العلماء ما ملخصه: والظل الغالب في جو السورة هو ظل الرحمة والرضا والاتصال. فهي تبدأ بذكر رحمة ربك لعبده زكريا. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة كثيرا. ويكثر فيها اسم الرَّحْمنِ.
وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية. ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال، كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته ...
كذلك تحس أن للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا، فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء، وفيه عمق كألفاظ: رضيا، سريا، حفيا، نجيا ...
فأما المواضع التي تقتضي الشدة والعنف، فتجيء فيها الفاصلة مشددة في الغالب، كألفاظ: ضدّا، هدّا، إدّا، أزّا .
وبعد فهذا تعريف لسورة مريم، نرجو أن يكون القارئ له، قد أخذ صورة مركزة عن أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
سورة ( مريم ) من السور القرآنية التى افتتحت ببعض حروف التهجى .
وقد سبق أن تكلمنا بشىء من التفصيل ، عن آراء العلماء فى المراد بهذه الحروف التى افتتحت بها بعض السور ، وذلك عند تفسيرنا لسور : البقرة ، وآل عمران ، والأعراف ، ويونس . . .
ورجحنا أن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت فى افتتاح بعض سور القرآن ، على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن .
فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله - تعالى - ، هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلامهو من جنس ما تؤلفون به كلامكم ، ومنظوماً من حروف هى من جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم فى شك من كونه منزلاً من عند الله فهاتوا مثله . أو عشر سور من مثله ، بل بسورة واحدة من مثله ، وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك . . .
فلما عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت أن غيرهم أعجز ، وأن هذا القرآن من عند الله ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً ).
سورة مريم: وهي مكية .
وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه.
قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.
ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.
قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.
فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.
وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.
هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذانى قال: قال عبدالله فذكر نحوه.
وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.
وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.
قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.
قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.
هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.
هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.
ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.
وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لايـ نقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.
قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.
قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.
وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.
قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.
وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شىء حكمته.
وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدىء بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.
وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري فى كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.
قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حمعسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.
فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.
هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.
فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.
ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى ذكره: كاف من (كهيعص) فقال بعضهم: تأويل ذلك أنها حرف من اسمه الذي هو كبير، دلّ به عليه، واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية (كهيعص) قال: كبير، يعني بالكبير: الكاف من (كهيعص).
حدثنا هناد بن السريّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، كان يقول (كهيعص) قال: كاف: كبير.
حدثني أبو السائب، قال: أخبرنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير في (كهيعص) قال: كاف: كبير.
حدثنا ابن بشار، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه.
وقال آخرون: بل الكاف من ذلك حرف من حروفه اسمه الذي هو كاف.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: أخبرنا شريك، عن سالم، عن سعيد، في قوله (كهيعص) قال: كاف: كافٍ.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم في قوله: (كهيعص) قال: كاف: كافٍ.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام عن عنبسة، عن الكلبي مثله.
وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو كريم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال : ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبير (كهيعص) قال: كاف من كريم.
وقال الذين فسروا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص: حرف من حروف اسمه الذي هو هاد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أبو حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان يقول في الهاء من (كهيعص) : هاد.
حدثنا أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل، عن سعيد، مثله.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير نحوه.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثني يحيى بن طلحة، قال: ثنا جابر بن نوح ، قال : أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم في قوله (كهيعص) ، قال: ها: هاد.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن الكلبي، مثله.
واختلفوا في تأويل الياء من ذلك، فقال بعضهم: هو حرف من حروف اسمه الذي هو يمين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: " يا " من (كهيعص) ياء يمين.
حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: " يا " من (كهيعص) ياء يمين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس ، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد ، عن سعيد بن جبير ياء: يمين.
وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو حكيم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبير (كهيعص) قال: يا: من حكيم.
وقال آخرون: بل هي حروف من قول القائل: يا من يجير.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا إبراهيم بن الضريس، قال: سمعت الربيع بن أنس في قوله (كهيعص) قال: يا من يجير ولا يجار عليه.
واختلف متأوّلو ذلك كذلك في معنى العين، فقال بعضهم: هي حرف من حروف اسمه الذي هو عالم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد (كهيعص) قال: عين من عالم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن الكلبي، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثنا عمرو، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن العلاء بن المسيب بن رافع، عن أبيه، في قوله (كهيعص) قال: عين: من عالم.
وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز.
ذكر من قال ذلك:
* حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (كهيعص) عين: عزيز.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.
حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، في قوله (كهيعص) قال: عين عزيز.
وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم، في قوله (كهيعص) قال: عين: عدل.
وقال الذين تأولوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله (كهيعص) : حرف من حروف اسمه الذي هو صادق.
* ذكر الرواية بذلك: حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان يقول في (كهيعص) صاد : صادق.
حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين ، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم، قال: صاد: صادق.
حدثني يحيى بن طلحة، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، قال: صادق، يعني الصاد من (كهيعص)
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد (كهيعص) قال: صاد صادق.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن الكلبي، قال: صادق.
وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تعالى.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن خالد بن خداش، قال: ثني سالم بن قتيبة، عن أبي بكر الهُذَليّ، عن عاتكة، عن فاطمة ابنة عليّ قالت: كان عليّ يقول: يا(كهيعص) : اغفر لي.
حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: (كهيعص) قال: فإنه قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله.
وقال آخرون: كلّ حرف من ذلك اسم من أسماء الله عزّ وجل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني مطر بن محمد الضبي، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: (كهيعص) ليس منها حرف إلا وهو اسم.
وقال آخرون: هذه الكلمة اسم من أسماء القرآن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله (كهيعص) قال: اسم من أسماء القرآن.
قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندنا نظير القول في الم وسائر فواتح سور القرآن التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[1] ﴿كهيعص﴾ يجب تعظيم هذا المقطع القرآني مع أننا لا نفهمه، وهذه رسالة لعقولنا أن تسلم بما جاء به الشرع مما تقصر عن إدراكه عقولنا .
وقفة
[1] ﴿كهيعص﴾ قال ابن عباس: «إن الكاف من كافٍ، والهاء من هادٍ، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق».
وقفة
[1] ﴿كهيعص﴾ قيل في الحروف المقطعة أوائل السور: 1- إنها مما استأثر الله بعلمه. 2- إنها أسماء للسور المذكورة فيها. 3- إنها رموز تدل على بعض أسماء الله وصفاته. 4- إنها بيان لإعجاز القرآن؛ فالقرآن مركب منها، والخلق عاجزون عن الإتيان بمثله.
الإعراب :
- ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كهيعص ﴾
- هذه الأحرف التي تبدأ بها بعض سور القرآن شرحت في السور الكريمة السابقة. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:
﴿ كهيعص ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
كهيعص:
قرئ:
1- بكسر الهاء والياء، وهى قراءة على، ويحيى.
2- بين الفتح والكسر، وإلى الفتح أقرب، وهى قراءة نافع.
3- بكسر الهاء وفتح الياء، وهى قراءة أبى عمرو.
4- بفتح الهاء وكسر الياء، وهى قراءة حمزة.
5- بضمهما، وهى قراءة الحسن.
6- بفتحهما، وهى قراءة غيرهم.
مدارسة الآية : [2] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾
التفسير :
تفسير الآيتين 2و 3:ـ
أي:هذا{ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ْ} سنقصه عليك، ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه، وبأي:سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا.
وقوله- تعالى-: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا خبر لمبتدأ محذوف. أى: المتلو عليك ذكر رحمة ربك عبده ذكريا.
ولفظ ذِكْرُ مصدر مضاف لمفعوله. ولفظ رَحْمَتِ مصدر مضاف لفاعله وهو ربك، وعَبْدَهُ مفعول به للمصدر الذي هو رحمة.
وزَكَرِيَّا هو واحد من أنبياء الله الكرام، وينتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- عليهم السلام-.
والمعنى: هذا الذي نذكره لك يا محمد، هو جانب من قصة عبدنا زكريا، وطرف من مظاهر الرحمة التي اختصصناه بها، ومنحناه إياها.
وقوله : ( ذكر رحمة ربك ) أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا .
وقرأ يحيى بن يعمر " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " .
و ) زكريا ) : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل . وفي صحيح البخاري : أنه كان نجارا ، أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة .
اختلف أهل العربية في الرافع للذكر، والناصب للعبد، فقال بعض نحويي البصرة في معنى ذلك كأنه قال: مما نقصّ عليك ذكر رحمة ربك عبده، وانتصب العبد بالرحمة كما تقول: ذكر ضرب زيد عمرا. وقال بعض نحويي الكوفة: رفعت الذكر بكهيعص، وإن شئت أضمرت هذا ذكر رحمة ربك، قال: والمعنى ذكر ربك عبده برحمته تقديم وتأخير.
قال أبو جعفر: والقول الذي هو الصواب عندي في ذلك أن يقال: الذكر مرفوع بمضمر محذوف، وهو هذا كما فعل ذلك في غيرها من السور، وذلك كقول الله: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وكقوله: سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا ونحو ذلك. والعبد منصوب بالرحمة، وزكريا في موضع نصب، لأنه بيان عن العبد، فتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ أعظم ما تُستنزل به رحمات الله: العبودية الحقة له سبحانه.
وقفة
[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ لا يأس ولا مستحيل إن كان ظنك بالله جميل، وأملك به كبير، وحتى لو انعدمت الأسباب، فربك على كل شيء قدير سبحانه.
وقفة
[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا» [مسلم 2379]، ليس مهمًا ما مهنتك أو منصبك أو نسبك أو مستواك؟ رحمة الله تصلك بقدر عبوديتك لربك.
وقفة
[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ كلما زادت العبودية زادت الرحمات.
وقفة
[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ وصفه بالعبودية تشريفًا له، وإعلامًا له بتخصيصه وتقريبه.
وقفة
[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع.
عمل
[2] ﴿ذِكرُ رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَهُ زَكَرِيّا﴾ كن عبدًا لله بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ تشملك رحمته.
لمسة
[2] ﴿ذِكرُ رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَهُ زَكَرِيّا﴾ قَدَّمَ ذكرَ الرحمة تحفيزًا للذهن؛ ليعرف أن تضرعه هو سبب رحمة الله له.
وقفة
[2] ﴿ذِكرُ رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَهُ زَكَرِيّا﴾ ترد (رحمت) هكذا، وفي مواضع بالمربوطة (رحمة)، فما سبب الاختلاف؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: هذا مكتوب كما وجده العلماء في رسم المصحف العثماني المكتوب في عهد عثمان بن عفان، ولا يوجد تعليل دقيق لهذه الظاهرة في القرآن، والفرق بينها وبين المكتوبة بالتاء المربوطة هو في نطقها عند الوقف عليها، فتنطق بالتاء.
وقفة
[2] سورة مريم سورة رحمة الله، تكرر فيها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آية، وهذا ما لم يقع في سورة أخرى، ويكفي مطلعها ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾.
وقفة
[2، 3] ﴿ذكر (رحمت) ربك عبده زكريا * إذ (نادى)﴾ لحظة النداء لحظة غشيان الرحمات.
وقفة
[2، 3] ﴿ذكر (رحمت) ربك عبده زكريا * إذ (نادى)﴾ نصيبك من الرحمة بقدر النداء، اشتك همومك، قل بالتفصيل كل شيء لربك، هو يعلمه لكنه يحب سماعه منك.
الإعراب :
- ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ: ﴾
- خبر مبتدأ محذوف بتقدير: هذا المتلو ذكر رحمة. وهو مضاف ومرفوع بالضمة. رحمة: مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف.
- ﴿ رَبِّكَ عَبْدَهُ: ﴾
- مضاف إليه مجرور للتعظيم بالكسرة وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب في محل جر بالاضافة. عبده: مفعول به بالمصدر «رحمة» منصوب بالفتحة وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة.
- ﴿ زَكَرِيّا: ﴾
- بدل من «عبده» منصوب مثله بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر. وهو اسم اعجمي ينون في النكرة ويجوز أن يكون عربيا فيه ألف تأنيث ولا يجوز تنوينه في معرفة ولا نكرة. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : بعد الحُروفِ المُقطَّعة؛ بدأت القصَّةُ الأولى في هذه السورةِ: قصَّةُ زكريا عليه السلام، قال تعالى:
﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا ﴾
التفسير :
تفسير الآيتين 2و 3:ـ
أي:هذا{ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ْ} سنقصه عليك، ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه، وبأي:سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا.
وقوله: إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا ظرف لرحمة ربك. والمراد بالنداء: الدعاء الذي تضرع به زكريا إلى ربه- عز وجل-.
أى: هذا الذي قرأناه عليك يا محمد في أول هذه السورة. وذكرناه لك، هو جانب من رحمتنا لعبدنا زكريا. وقت أن نادانا وتضرع إلينا في خفاء وستر، ملتمسا منا الذرية الصالحة.
وإنما أخفى زكريا دعاءه، لأن هذا الإخفاء فيه بعد عن الرياء، وقرب من الإخلاص، وقد أمر الله- تعالى- به في قوله: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
ويبدو أن هذا الدعاء قد تضرع به زكريا إلى ربه في أوقات تردده على مريم، واطلاعه على ما أعطاها الله- تعالى- من رزق وفير.
ويشهد لذلك قوله- تعالى-: فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا، كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً، قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ. هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ .
وقوله : ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) : قال بعض المفسرين : إنما أخفى دعاءه ، لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردي .
وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) : إن الله يعلم القلب التقي ، ويسمع الصوت الخفي .
وقال بعض السلف : قام من الليل ، عليه السلام ، وقد نام أصحابه ، فجعل يهتف بربه يقول خفية : يا رب ، يا رب ، يا رب فقال الله : لبيك ، لبيك ، لبيك .
وقوله: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) يقول حين دعا ربه، وسأله بنداء خفي، يعنى: وهو مستسرّ بدعائه ومسألته إياه ما سأل ، كراهة منه للرياء.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) أي سرّا، وإن الله يعلم القلب النقيّ، ويسمع الصوت الخفيّ.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) قال: لا يريد رياء.
التدبر :
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ أفلح كل وجه جعل وجهته (لله) وأنزل به حاجته، فهذا اليقين هو الذي يحقق لك المستحيل وما على الله مستحيل.
وقفة
[3] ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ﴾ [الأنبياء: 76]، ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنبياء: 87]، وزكريا: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾؛ نجاتك في مُناجاتك.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ لعل من أسباب اقتران إجابة الدعاء بإخفائه أنه لا يكون إلا ممن اشتد إيمانه بعلم الله، فكان ذلك توسلًا بإيمان.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ الله يسمع كل همسة تهمسها له، وكل شكوى تشكوها له، حتى لو لم تنطقها بفمك، وتأكد أن رجاءك بالله لن يخيب.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ كل من نناديهم نرفع أصواتنا لندائهم، إلا الله، فإنّهُ قريبٌ منّا فلا حاجة لرفع الصوت.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ما كلفنا الله حتى أن نرفع أصواتنا حين ندعوه، همسات وجعك تسمع في السماء.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أخفى تضرعه ونداءه فصدحت به المحاريب، وترنمت به حناجر العباد، وبقى النداء خالدًا.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ حين تتمتم بدعواتك، تشعر بالقرب الإلهي منك، فلا حاجة لرفع الصوت وهو يسمعك.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ قيل في سبب إخفائه: حياؤه من ربه أن يسأله ما لم يره في الحياة (حياء الجنان وخفض الصوت من فنون الدعاء).
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أخفاهُ عن البشر لأنه يعلم أنه مسموعٌ من ربّ البشر؛ خاطِب ربّك بالدعاء، أسمِعه نجواك وأبشر بما يسّرك منه.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ (خفيًا): همسة صادقة (كافية) لفتح باب السماء.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ هذا النداء الخفي لربك خير من جهرك بشكواك لكل أحد!
عمل
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ لا تقلل من شأن دعائك، هذا الصوت الخفي فُتحت له أبواب السماء!
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ إخفاء الدعاء يدل على أن صاحبه قريب من الله، وأنه لإقترابه منه وشدة حضوره يسأله بخفض الصوت.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ يعني: دعاه، ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ فيه استحباب الإسرار بالدعاء.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ فيه فضل الدعاء الخفي، وأنه أفضل من الدعاء الجهري، وهذا عام في جميع العبادات، كالقراءة والصدقة والقيام، فما كان سرًا فهو أفضل، إلا إذا كان في الإعلان مصلحة
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ إخفاء الدعاء، والإسرار بالمسألة: مناجاة للرب، وإيمان بأن الله سميع، وذل واستكانة، وسنة من سنن المرسلين.
وقفة
[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أنتَ لا تحتاج لرفع صوتك أثناء الدعاء، فهمسةٌ منك يسمعها سبحانه!
عمل
[3] حدد أمرًا صعب عليك، ثم نادِ ربك به نداء خفيًا؛ محسنًا الظن به ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ بدعائك الخفي تتنزل عليك الرحمات، وترزق بما تمنيت وسألت.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ ربك قريب فلا ضرورة ولا حاجة لرفع صوتك ﴿وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريدِ﴾ [ق: 16].
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ تأملوا كلمة: (ربه)، ليس لنا سواه ندعوه فيتقبل دعاءنا، وتأملوا كلمة: (نادى) بها مناجاة وابتهال وتذلل، اللهم تقبل دعاءنا.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ كان خفيًا؛ لأنه يعلم أن أسبابه الدنيوية لا تصلح للإنجاب، فهو كبير وامرأته عاقر، فلذلك كان دعاؤه خفيًا، يأمل في شيء من الله يغلب هذه الأسباب.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ من آداب الدعاء: التذلل لله عند الدعاء.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ إذ دعا ربه سرًا؛ ليكون أكمل وأتم إخلاصًا لله، وأرجى للإجابة.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ همساتُ وجعكَ التي تُخفيها عن عيونِ البشر وآذانهم، يسمعُ أنينها ربُ الأرض والسماء.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ خاطِبْ ربّك بالدعاء، بُثّ لهُ شكواك، أسمِعه نجواك، وأبشر بما يسّرك منه.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ صوت خفي يسري في حنايا الروح؛ فهنالك رب قريب يسمع همسات النفس، وإن أخفيت عن العالم أجمع، لكنها لا تخفى عليه، فذلك الكسر يجبره كأن لم يرهقك ألمه يومًا.
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ قال قتادة: «وإن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي».
وقفة
[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ كلما خفي الدعاء؛ كانت الإجابة أقرب.
وقفة
[3] من آداب الدعاء: أن تدعو الله تضرعًا وخفية، فأنت تدعو السميع الذي يعلم السر وأخفى ﴿إذ نادى ربه نداء خفيا﴾.
وقفة
[3] ﴿فإني قَريبٌ﴾ [البقرة: 186]، ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ هو قريب؛ فلا حاجة لأن ترفع صوتك بالنداء.
وقفة
[3] همسات التضرع الصادقة تهز أبواب السماء ﴿نداءً خفيًا﴾، سبحان من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء!
الإعراب :
- ﴿ إِذْ: ﴾
- ظرف للزمن بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب. والجملة الفعلية بعده: في محل جر بالاضافة.
- ﴿ نادى رَبَّهُ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ربه: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة.
- ﴿ نِداءً خَفِيًّا: ﴾
- مفعول مطلق-مصدر مؤكد-منصوب بالفتحة. خفيا: صفة -نعت-لنداء منصوب مثله بالفتحة. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا وصفَ اللهُ عز و جل زكريا عليه السلام بصفة العبودية؛ ذكرَ هنا حاجةَ العبد إلى ربه، فناداه، قال تعالى:
﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ .. ﴾
التفسير :
{ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ْ}
أي:وهى وضعف، وإذا ضعف العظم، الذي هو عماد البدن، ضعف غيره،{ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ْ} لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده، ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.
{ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ْ} أي:لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي، وإحسانك واصلا إلي، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقا، أن يتمم إحسانه لاحقا.
ثم بين- سبحانه- ما نادى به زكريا ربه فقال: قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ...
والوهن: الضعف. يقال: وهن الجسم يهن- من باب وعد- إذا ضعف.
وخص العظم بالذكر، لأنه دعامة البدن، وعماد الجسم، وبه قوامه، فإذ ضعف كان غيره من أجزاء الجسم أضعف. وإفراد لفظ العظم لإرادة الجنس.
وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً والمراد باشتعال الرأس شيبا: انتشار بياض الشيب فيه.
والألف واللام في لفظ الرَّأْسُ قاما مقام المضاف إليه.
والمراد: واشتعل رأسى شيبا، وهذا يدل على تقدم السن، كما يشهد له قوله- تعالى- وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا وقوله- عز وجل-: وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ....
قال صاحب الكشاف: «شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر..
باشتعال النار، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس، وأخرج الشيب مميزا ولم يضف إلى الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا، فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة ... » .
وقوله: وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا أى: ولم أكن فيما مضى من عمرى مخيب الدعاء وإنما تعودت منك يا إلهى إجابة دعائي، وما دام الأمر كذلك فأجب دعائي في الزمان الآتي من عمرى، كما أجبته في الزمان الماضي منه.
فأنت ترى أن زكريا- عليه السلام- قد أظهر في دعائه أسمى ألوان الأدب مع خالقه، حيث توسل إليه- سبحانه- بضعف بدنه، وبتقدم سنه، وبما عوده إياه من إجابة دعائه في الماضي.
( قال رب إني وهن العظم مني ) أي : ضعفت وخارت القوى ، ( واشتعل الرأس شيبا ) أي اضطرم المشيب في السواد ، كما قال ابن دريد في مقصورته :
إما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده
مثل اشتعال النار في جمر الغضا
والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر ، ودلائله الظاهرة والباطنة .
وقوله : ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) أي : ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ، ولم تردني قط فيما سألتك .
حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: رغب زكريا في الولد، فقام فصلى، ثم دعا ربه سرّا ، فقال: ( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ).... إلى وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا وقوله: ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) يقول تعالى ذكره، فكان نداؤه الخفي الذي نادى به ربه أن قال: ( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) يعني بقوله (وَهَنَ) ضعف ورقّ من الكبر.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) أي ضعف العظم مني.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) قال: نحل العظم. قال عبد الرزاق، قال: الثوري: وبلغني أن زكريا كان ابن سبعين سنة.
وقد اختلف أهل العربية في وجه النصب في الشَّيْب، فقال بعض نحويي البصرة: نصب على المصدر من معنى الكلام، كأنه حين قال: اشتعل، قال: شاب، فقال: شَيْبا على المصدر. قال: وليس هو في معنى: تفقأت شحما وامتلأت ماء، لأن ذلك ليس بمصدر. وقال غيره : نصب الشيب على التفسير، لأنه يقال: اشتعل شيب رأسي، واشتعل رأسي شيبا، كما يقال: تفقأت شحما، وتفقأ شحمي.
وقوله: ( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) يقول: ولم أشق يا رب بدعائك، لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك، بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك.
كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج عن ابن جريج، قوله: ( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) يقول: قد كنت تعرّفني الإجابة فيما مضى.
التدبر :
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ فيه استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ الصوت المنكسر، هناك جبره الكلام المتلجلج بالصدر، هناك المكان اﻵمن لبوحه، هناك ستندمل كل جراحك.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ ليس أجمل من أن تحتفظ بهمومك لنفسك، وﻻ تبوح بها إﻻ لخالقك، فلا أحد يطبب الجروح مثل الله!
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ ستأتيك لحظات ترفع راية الاستسلام لربك، فنفسك تعبت ولم تعد تقوى، فهل تظن أنه يتركك؟ ﻻ والله وأبشر بسعدك.
عمل
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ عبر عن شكواك، اسكب فيها المسكنة والضعف والانكسار، اشرح بأسى ألمك وحزنك، قُل كل شيء لربك.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ انكسارك لله هو عزك الحقيقي، وافتقارك إليه هو الغنى وانطراحك بين يديه هو القوة.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله؛ لأنه يدل على التَّبَرُؤِ من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.
عمل
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ توسل إلى الله بإظهار قلة حيلتك، فهذه من أسباب استجابة دعوتك.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.
وقفة
[4] ﴿قالَ رَبِّ إِنّي وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ بقياسات البشر مستحيل، لكن الله عنده فقط (كن فيكون).
لمسة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أي: أسرع فيه الشيب إسراع النار في الحطب، وهو من أبلغ الاستعارات، ولم يكتفِ بالاستعارة حتى أسند الاشتعال إلى الرأس، وأخرج الشيب تمييزًا؛ مبالغةً في ذلك، والأصل: اشتعل شيبُ الرأس.
عمل
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ادع الله بيقين فهو القادر على تحقيق ما تريد.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ كل العزة والقوة والمعية في انكسارك لله جل جلاله.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾كان واهنًا إلى أبعد حد، عجوزًا تمكن منه الشيب، لكنه توسل بصدق إلى الله الذي لا يعجزه شيء فمنحه ما تمنى، ضعفك ليس بعائق إن أراد الله عطاءك.
وقفة
[4] ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ لكبار السن رحمة خاصة في السماء، ودعوتهم تخترق الحجب، تأمل كيف توسل زكريا بشيبه!
وقفة
[4] ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ الخضوع والانكسار بين يديّ رب السموات، من أعظم أسباب إجابة الدعوات!
وقفة
[4] ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ إظهار الضعف والتذلل لرب السماء، سبب لنزول الرحـمة وإجـابة الدعاء.
وقفة
[4] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ [القمر: 10]، ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ من كشف ضعفه لله ليس كمن كشفه للناس، فالأول أصبح قويًا مستورًا، والثاني ازداد فوق ضعفه ضعفًا.
عمل
[4] ﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ تملّق إلى الله في دعائك بذكر حاجتك وشدة بلائك وضعفك وانحنائك.
وقفة
[4] ﴿إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا﴾ العظام الواهنة والرؤوس البيضاء لا تسلب المؤمن سعادته ولا تشقيه أبدًا.
وقفة
[4] ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾، ﴿أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: 37]، ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي﴾ [يوسف: 86]، دعوات الأنبياء تفطر القلوب.
عمل
[4] ﴿وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ توسل إلى الله بضعفك، وعجزك وتبرأ من حولك وقوتك.
وقفة
[4] ﴿وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ هنا إشارة لآداب الدعاء وطلب الحاجة من الله عز وجل، والتي منها: إظهار الافتقار إلى الله، والخضوع بين يديه، وانكسار القلب والجوارح، وإظهار حاجة العبد الأزلية لخالقه وسيده.
وقفة
[4] قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ إظهار للخضوع، وقوله: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي: لم أكن بدعائي إياك شقيًا؛ أي: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي: إنك عودتني الإجابة فيما مضى.
وقفة
[4] ﴿وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ مفاجئ وسريع الانتشار.
وقفة
[4] ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أقوى الرجاء ما كان في زمن الفوات .
وقفة
[4] الشيب أبيض كالثلج، والله وصفه بصفة النار بقوله: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾، (فالأمور بحقائقها لا ألوانها).
وقفة
[4] من بلاغة ألفاظ القرآن أنها تجمع المعنى الكثير في المبنى اليسير، انظر إلى: ﴿واشتعل الرأس شيبًا﴾؛ تجد كلمة (اشتعل) قد أغنتْ عن كلامٍ كثير، كأن زكريا قال: شاب شعر رأسي دفعة واحدة، ولم يترك الشيب منه شيئًا، كالنار إذا التهبت في الحطب، (اشتعل) أفادت ذلك كله.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ معترفًا بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه, فلم يشق مع دعائه لربه, وهو في فتوته وقوته، فما أحوجه الآن في هرمه وكبره أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ الدعاء والشقاء، ضدان لا يجتمعان.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ ما شقي أحد قط يقول: «يا رب، يا رب»!
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ إذا هداك إلى دعائه ورجائه؛ فأنت السعيد بمناجاته وسابق إحسانه، وإن طال زمن الإجابة.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ اعترافُك بإجابته سبحانه لدعواتِ الأمس؛ بابٌ لإجابته لدعواتِ اليوم.
وقفة
[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ كل لحظة ضعف تمر بك فى جسدك، فى مالك، فى نفسيتك، هى ساعة استجابة، أنت أقوى ما يكون ضعيفًا.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا تيأسْ مِن فرج الله حينما يشتدُّ عليك المرضُ والهمُّ، فزكريَّا برغم ما حدث له مِن وهن عظمِه، واشتَعل رأسه شيبًا، وامرأتُه عاقر، لكنَّه ظل يدعو ربه حتى أتاه الفَرج.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ قال ابن عيينة أي: «سعدت بدعائك وإن لم تعطني».
عمل
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ يقين يجب أن يسكننا، فإن تعسر أمر ما؛ فأكثر من الدعاء، لتدخل باب رجاء الله وتغلق ما دونه من أبواب.
عمل
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لاَ تستعجل أمرًا رجوت الله به، خير لله آتيك فلا تيأس، ألح بالدعاء، فلا يشقى عبد دعا ربّه.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يشقى عبد دعا ربّه، اللهُمَ سعادة القلب، وقرار العين، وجميل البشائر، وسجدة الفرح العميقة.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ قال ابن كثير: «أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة».
عمل
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ في ساعة استجابة قل: «يا رب»، وانتظر: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ [7].
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ فيه التوسل إلي الله بنعمه وعوائده الجميلة.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي: لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردّني قط فيما سألتك.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ اذا ابطأت حاجة تطلبها من الله فتودد إليه واعترف بألطافه السابقة، واطلب منه أن لا يردك خائبًا هذه المرة.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ اعترافك بإجابته لدعوات الأمس باب لإجابته لدعوات اليوم.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يمكن لمن جنح إلى كنفِ الرحمن؛ أن يحزن أو يشقىٰ.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يمكن أبدًا أن يجتمع الشقاء مع الدعاء، إنّ الدعاء رياض السعداء.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لن تشقى طالما كنت مستمسكًا بحبل الدعاء .
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ وَهَنَ الْعَظْمُ، اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، امْرَأَتِي عَاقِرًا، أبوابٌ مؤصدةٌ وما انقطعَ الأملُ.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي أنك عودتني إجابتك، قال القرطبي: «وهذه وسيلة حسنة، أن يتشفع إليه بنعمه، ويستدر فضله بفضله، يروى أن حاتم لقيه رجل فسأله، فقال له حاتم: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول (أي العام السابق)، فقال: مرحبًا بمن تشفع إلينا بنا».
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يمكن أبدًا أن يجتمع الشقاء مع الدعاء، إنّ الدعاء رياض السعداء.
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ من آداب الدعاء: ذكر نعم الله عليك وقديم إحسانه فإنما تُستدرّ النعم بالحمد: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.
وقفة
[4] من جميل ما دعا زكريا: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾؛ أي يا رب لم تضيعني من قبل حينما دعوتك ،فرجائي بك أكبر، ورحمتك بي أعظم في ضعفي.
وقفة
[4] وهِن العظم، واشتعل الرأس شيبًا، وزوجة عاقر، ثم قال: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ رغم كلّ الأبواب المؤصدة لم ينقطع الأمل.
عمل
[4] أحسن الظن بالله تعالى؛ فالله سبحانه عند حسن ظن عبده به ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.
وقفة
[4] والله لن يشقى عبد وهو يدعو ربه ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ .
وقفة
[4] قال زكريا عن الدعاء: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾؛ لأن المؤمن يعيش لذة عبودية دعائه قبل لذة حصول مطلوبه.
وقفة
[4] زكريا عليه السلام ورغم أسباب اليأس الثلاثة: وهن العظم، واشتعال الرأس شيبًا، وكانت امرأته عاقرًا، ومع ذلك لم ينتهي الأمل، وقال: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.
وقفة
[4] من جميل ما دعا زكريا: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾؛ أي يا رب لم تضيّعني من قبل حينما دعوتك؛ فرجائي بك أكبر ورحمتك بي أعظم في ضعفي.
وقفة
[4] الشقاء لا يجتمع بثلاث: لا يجتمع الشقاء مع الدعاء: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، ﴿وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً﴾ [48]، ولا يجتمع الشقاء مع القرآن: ﴿طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ [طه: 1، 2]، ولا يجتمع الشقاء مع البِر: ﴿وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا﴾ [32].
وقفة
[4، 5] ﴿إني وهن العظم مني﴾، ﴿امرأتي عاقرا﴾ إقرارك بانتفاء الأسباب ثقة منك وإيمان بعظيم قدرة رب الأسباب.
وقفة
[4، 5] قال ربِّ: ﴿وهن العظم ﴾، ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾، ﴿امرأتي عاقرا﴾ انقطعت أسباب الأرض، ولكنها لا ولن تنقطع أسباب رب السموات والأرض.
وقفة
[4، 5] من أدب الدعاء: تقرّب إلى ربك بفقرك إليه: ﴿إني وهن العظم مني﴾، ثم قدّم حاجتك بين يديه: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾.
وقفة
[4، 5] لم ييأس زكريا بالرغم من دواعي اليأس: وهن عظمه، واشتعل رأسه شيبًا، وكانت امرأته عاقرًا؛ لكنه ظل يحسن الظن بربه.
وقفة
[4، 5] كان قادرًا أن يقول: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ بلا مقدمات طويلة: ﴿وَهَنَ، وَاشْتَعَلَ، خِفْتُ، وَكَانَتِ امْرَأَتِي﴾، تلذذ بدعائك وأخبره بآلامك؛ فإنه يحب أن يسمع شكواك.
وقفة
[4، 5] طرق مؤصدة؛ فوهن العظم، واشتعال الرأس، والمرأة عاقر، الأسباب المادية مقفلة، ولا يحل قفلها إلا من أوجدها ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾.
وقفة
[4، 5] قال الرازي: «تعليم آداب الدعاء وهي من جهات: أحدها: قوله: ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [3]، وهو يدل على أن أفضل الدعاء أخفاه، ولأن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة، وإخفاء الصوت مشعر بالضعف والانكسار، وعمدة الدعاء الانكسار والتبري عن حول النفس وقوتها، والاعتماد على فضل الله تعالى وإحسانه. وثانيها: أن يذكر في مقدمة الدعاء عجز النفس وضعفها كما في قوله تعالى عنه: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾. وثالثها: أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلِّق بالدين لا لمحض الدنيا كما قال: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾. ورابعها: أن يكون الدعاء بلفظ يا رب».
الإعراب :
- ﴿ قالَ رَبِّ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. رب: منادى بأداة نداء محذوفة اختصارا ولكثرة الاستعمال أو لأن المنادى سبحانه معلوم وقيل حذفت أداة النداء اكتفاء بالمنادى وهو مضاف ومنصوب للتعظيم بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء المحذوفة من الخط ولدلالة الكسرة عليها ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
- ﴿ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي: ﴾
- الجملة في محل نصب مفعول به-مقول القول- أو المصدر المؤول منها. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير المتكلم في محل نصب اسم «إنّ».وهن: فعل ماض مبني على الفتح. العظم: فاعل مرفوع بالضمة. مني: جار ومجرور متعلق بوهن والجملة الفعلية «وهن العظم مني» في محل رفع خبر «إنّ» بمعنى: ضعف عظمي.
- ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً: ﴾
- معطوفة بالواو على «وهن العظم» وتعرب إعرابها. شيبا: تمييز منصوب بالفتحة. وأصل هذا التمييز مقلوب عن الفاعل اذ أصله واشتعل شيب الرأس ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا بتقدير وشاب الرأس شيبا. وفي التعبير فصاحة ظاهرة واستعارة بديعة وبلاغة مشهودة لأنه لم يقل واشتعل رأسي شيبا اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا. وشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانارته وانتشاره في الشعر.
- ﴿ وَلَمْ أَكُنْ: ﴾
- الواو عاطفة. لم: حرف نفي وجزم وقلب. أكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو لأن أصله «أكون» لالتقاء الساكنين واسم «كان» ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا.
- ﴿ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بشقيا والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي ولم أكن بدعائي إياك أو بسبب دعائك. رب: أعربت. شقيا: خبر «أكن» منصوب بالفتحة بمعنى لم أكن شقيا قط بل كلما دعوتك استجبت لي. '
المتشابهات :
| مريم: 4 | ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ |
|---|
| مريم: 48 | ﴿وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن نادى زكريا عليه السلام ربَّه؛ جاء هنا بيان ما نادى به زكريا عليه السلام ربَّه، فقد ذكرَ ضعفَ بدنِه، وتقدُّم عُمرِه، وما عوَّده إياه من إجابة دعائه في الماضي، قال تعالى:
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي .. ﴾
التفسير :
{ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ْ} أي:وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، أن لا يقوموا بدينك حق القيام، ولا يدعوا عبادك إليك، وظاهر هذا، أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد، ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين، والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين، ومعدن الرسالة، ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا، يقوم بالدين من بعده، واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي:عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد.{ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ْ} وهذه الولاية، ولاية الدين، وميراث النبوة والعلم والعمل
ثم حكى- سبحانه- بعض الأسباب الأخرى لإلحاح زكريا في الدعاء فقال: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي، وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ...
والموالي: جمع مولى، والمراد بهم هنا: عصبته وأبناء عمومته الذين يلون أمره بعد موته، وكان لا يثق فيهم لسوء سلوكهم.
والعاقر: العقيم الذي لا يلد، ويطلق على الرجل والمرأة، يقال: امرأة عاقر، ورجل عاقر.
أى: وإنى- يا إلهى- قد خفت ما يفعله أقاربى مِنْ وَرائِي أى: من بعد موتى، من تضييع لأمور الدين، ومن عدم القيام بحقه وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً لا تلد قط في شبابها ولا في غير شبابها، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ أى: من عندك وَلِيًّا أى: ولدا من صلبي،هذا الولد يَرِثُنِي في العلم والنبوة وَيَرِثُ أيضا مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ابن إسحاق بن إبراهيم العلم والنبوة والصفات الحميدة وَاجْعَلْهُ يا رب رَضِيًّا أى:
مرضيا عندك في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته.
ففي هاتين الآيتين نرى زكريا يجتهد في الدعاء بأن يرزقه الله الولد، لا من أجل شهوة دنيوية، وإنما من أجل مصلحة الدين والخوف من تضييعه وتبديله والحرص على من يرثه في علمه ونبوته، ويكون مرضيا عنده- عز وجل-.
قال الآلوسى ما ملخصه: «وقوله مِنْ وَرائِي المراد به من بعد موتى، والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أى: خفت فعل الموالي من ورائي أو جور الموالي. وهم عصبة الرجل.. وكانوا على سائر الأقوال شرار بنى إسرائيل، فخاف أن لا يحسنوا خلافته في أمته» .
وفي قوله فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اعتراف عميق بقدرة الله- تعالى- لأن مثل هذا العطاء لا يرجى إلا منه- عز وجل-، بعد أن تقدمت بزكريا السن، وبعد أن عهد من زوجه العقم وعدم الولادة.
وقد أشار- سبحانه- في آية أخرى إلى أنه أزال عنها العقم وأصلحها للولادة فقال:
وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ ... أى: وجعلناها صالحة للولادة بعد أن كانت عقيما من حين شبابها إلى شيبها..
وقوله : ( وإني خفت الموالي من ورائي ) : قرأ الأكثرون بنصب " الياء " من ( الموالي ) على أنه مفعول ، وعن الكسائي أنه سكن الياء ، كما قال الشاعر :
كأن أيديهن في القاع الفرق أيدي جوار يتعاطين الورق
وقال الآخر :
فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا
ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي :
تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل
وقال مجاهد ، وقتادة ، والسدي : أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة .
وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان يقرؤها : " وإني خفت الموالي من ورائي " بتشديد الفاء بمعنى : قلت عصباتي من بعدي .
وعلى القراءة الأولى ، وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا ، فسأل الله ولدا ، يكون نبيا من بعده ، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه . فأجيب في ذلك ، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله ، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ، ويسأل أن يكون له ولد ، فيحوز ميراثه دونه دونهم . هذا وجه .
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال ، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ، ومثل هذا لا يجمع مالا ، ولا سيما الأنبياء ، عليهم السلام ، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا .
الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة " وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح : " نحن معشر الأنبياء لا نورث " وعلى هذا فتعين حمل قوله : ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ) على ميراث النبوة; ولهذا قال : ( ويرث من آل يعقوب ) ، كما قال تعالى : ( وورث سليمان داود ) [ النمل : 16 ] أي : في النبوة; إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة ، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه ، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها ، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة " .
يقول: وإني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي: يقول: من بعدى أن يرثوني، وقيل: عنى بقوله (مِنْ وَرَائِي) من قدّامي ومن بين يديّ ؛ وقد بيَّنت جواز ذلك فيما مضى قبل.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) يعني بالموالي: الكلالة الأولياء أن يرثوه، فوهب الله له يحيى.
حدثنا يحيى بن داود الواسطي، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي صالح في قوله: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: العصبة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح في قوله (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: خاف موالي الكلالة.
حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح بنحوه.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: يعني الكلالة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث، قال : ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله (خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: العصبة.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قوله (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: العصبة.
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) والموالي: هنّ العصبة ، والموالي: جمع مولى، والمولى والوليّ في كلام العرب واحد. وقرأت قراء الأمصار (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ) بمعنى: الخوف الذي هو خوف الأمن. وروي عن عثمان بن عفان أنه قرأه : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ) بتشديد الفاء وفتح الخاء من الخفة، كأنه وجه تأويل الكلام: وإني ذهبت عصبتي ومن يرثني من بني أعمامي. وإذا قرئ ذلك كذلك كانت الياء من الموالي مسكنة غير متحركة، لأنها تكون في موضع رفع بخفت.
وقوله (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) يقول: وكانت زوجتي لا تلد، يقال منه: رجل عاقر، وامرأة عاقر بلفظ واحد، كما قال الشاعر:
لَبِئـسَ الفَتـى أنْ كُـنْتُ أعْوَرَ عاقِرً ا
جبَانـا فَمَـا عُـذْرِي لَدَى كُلّ مَحْضَرِ (1)
وقوله (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) يقول: فارزقني من عندك ولدا وارثا ومعينا.
------------------------
الهوامش:
(1) البيت في ديوان عامر بن الطفيل ، طبعة ليدن سنة 1913 . والرواية فيه " فبئس " في مكان : " لبئس " وفي اللسان : العاقر التي لا تحمل ، ورجل عاقر : لا يولد له ، ونساء عقر ، بضم العين وتشديد القاف المفتوحة . وقد استشهد به المؤلف على معنى العاقر ، في سورة آل عمران ( 3 : 257 ) وأعاده في هذا الموضع ، ومحل الاستشهاد في الموضعين واحد .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾ كان زكريا يخاف مما سيفعله أقاربه بعد موته من تضييع أمر الدين، وعدم القيام بحقه، فدعا الله بالولد، انظروا نيته في الإنجاب، وهمته العالية التي تناطح السحاب.
وقفة
[5] ﴿وَإِنّي خِفتُ المَوالِيَ مِن وَرائي وَكانَتِ امرَأَتي عاقِرًا﴾ لم يكن همه عليه السلام عصبته وبنوا عمومته أن يرثوا ماله، إنما كل همه من يرث العلم والنبوة ﴿فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا﴾، كما كان كل ما يشغل يعقوب عليه السلام حين حضره الموت: ﴿إِذ قالَ لِبَنيهِ ما تَعبُدونَ مِن بَعدي﴾ [البقرة: 133]، ولنا فى أنبياء الله قدوة حسنة.
وقفة
[5] ﴿وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا﴾ اقهر الموانع نفسها بالدعاء، ثم انسفه بحرارة مناجاتك، من عاقر ظروفك يولد أمل.
عمل
[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ ادع الله بيقين، فانقطاع أسباب الوصول للهدف لا تعني أبدًا عدم تحققه.
وقفة
[5] ﴿هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي﴾ [ص: 35]، ﴿لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: 23]، ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ كلما كان الدعاء أغرب كانت إجابته أقرب.
وقفة
[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ بلغا من الكبر عتيًا، ولا زالت علاقتهما الزوجية، ما المانع من استمرار الزواج بلا أبناء؟! لا كما يفعله بعضهم.
وقفة
[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ إذا سدت كل المنافذ ونفضت حتى يدك من حيلتك لنفسك، وتعلق الرجاء بالله وحده؛ هنا سترى عجائبه.
لمسة
[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ما الفرق بين العقيم والعاقر؟ كلاهما امتناع الحمل أو الإنجاب لكن: (العقر) قد يعقبه حمل عند العرب، عاقر يمكن أن تحمل، فهو دعا الله عز وجل وكان يتوقع أن يستجيب الله تعالى له. (العقم) هو الداء الذي لا يُبرأ منه، ورحمٌ معقومة أي مسدودة، في اللغة لا تنفتح ولا تلد، وكلمة العقم تطلق على ما لا نتيجة من ورائه، ويقال ريح عقيم لا تلقح سحابًا ولا شجرًا، ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده، ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: 50] أى ليس هناك مجال للإنجاب.
عمل
[5] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ إذا اشتدت حاجتك وتقطعت دونها الأسباب، فأكثر من (لدنك) فإن العطاءات المدهشة تحضر معها.
عمل
[5] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ قبل أن تذكر حاجتك اعترف في دعائك أنها لن تصلك تلك الحاجة إلا من قبله سبحانه، فهذا تملق تستنزل به الإجابة.
تفاعل
[5] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ كان يقينه بالله جليًا، ارفع يدين لا ترتجفان بهواجس من شك، وقل: «ربً هب لي من لدنك خيرًا».
عمل
[5] سل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة, وأن يجعل ذريتك من أولياء الله تعالى ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾.
وقفة
[3-5] طريقة النداء: ﴿نِدَاءً خَفيًا﴾، الحال: ﴿إنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ منِّي واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيبًا﴾، المطلب: ﴿فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا﴾، بعض الحاجات تحتاج منك مزيدًا من الذل والإنكسار، تحتاج مزيدًا من الافتقار ووصف الحال كأضعف ما يكون.
عمل
[5، 6] ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك ولياً ... وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ استبدئ صلاح ذريتك بدعاء مبكّرٍ، مبكّرٍ جدًا.
وقفة
[5، 6] ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفًا سيئًا، فسأل الله ولدًا يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حَدُّهُ.
وقفة
[5، 6] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ سأله نسلًا يورِّثه علمَه، لا من يورِّثه مالَه، فأعراض الدنيا أهون عند الأنبياء من أن يشفقوا عليها!
عمل
[5، 6] ليكن من دعائك لابنك أن ينال مقامًا في الدين والأمة، تأمل دعاء زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، أي النبوة بعده.
وقفة
[5، 6] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَاالِيَ: ﴾
- الواو عاطفة. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير المتكلم في محل نصب اسمها. خفت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. الموالي: مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية «خفت الموالي» في محل رفع خبر «إنّ» وهي جمع مولى.
- ﴿ مِنْ وَرائِي: ﴾
- جار ومجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ومعنى مِنْ وَرائِي»: بعد موتي. أي خفت الولاية في الموالي: بمعنى خفت فعلهم وهو سوء خلافتهم من ورائي. وورائي: بمعنى خلفي وبعدي وهو متعلق بالموالي. أو بمعنى «قدامي» فيتعلق بخفت.
- ﴿ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً: ﴾
- الواو: عاطفة. كانت: فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. امرأتي: اسم «كان» مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة و «عاقرا» خبر «كان» منصوب بالفتحة. وكسرت تاء «كانت» لالتقاء الساكنين.
- ﴿ فَهَبْ لِي: ﴾
- بمعنى: فامنحني من فضلك. الفاء استئنافية. هب: فعل دعاء وتضرع بصيغة-طلب-.والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. لي: جار ومجرور متعلق بهب بمقام المفعول الأول.
- ﴿ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بهب. أي من فضلك. لدن: اسم مبني على السكون في محل جر بمن. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. وليا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة. بمعنى: وليا من صلبي يلي أمري. ويجوز أن يكون «من لدنك» في محل نصب حالا من «وليا» لأنه متعلق بصفة له قدمت عليه '
المتشابهات :
| آل عمران: 40 | ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ |
|---|
| مريم: 5 | ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ |
|---|
| مريم: 8 | ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد التمهيد السابق؛ أضاف زكريا عليه السلام هنا سببين آخرين للإلحاح في الدعاء، ثم ذكرَ حاجته، وهي: أن يرزقه اللهُ الولدَ الصالح، قال تعالى:
﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
من ورائي:
وقرئ:
من وراى، بالقصر، وهى قراءة ابن كثير.
مدارسة الآية : [6] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ .. ﴾
التفسير :
{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ْ}
أي:عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك، والحاصل أنه سأل الله ولدا، ذكرا، صالحا، يبق بعد موته، ويكون وليا من بعده، ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده، أن يرزقه ولدا صالحا، جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته
والمراد بالوراثة في قوله يَرِثُنِي وراثة العلم والنبوة والصفات الحميدة.
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: «وقوله: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء..
ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا. فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته.. لا أنه خشي من وراثتهم له ماله. فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى هذا الحد، وأن يأنف من وراثة عصبته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم.
وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» .
وعلى هذا فتعين حمل قوله فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي على ميراث النبوة ولهذا قال: وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ كقوله: وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ أى: في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل، أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» .
وقال بعض العلماء ما ملخصه: ومعنى يَرِثُنِي أى: إرث علم ونبوة، ودعوة إلى الله والقيام بدينه، لا إرث مال، ويدل لذلك أمران:
أحدهما قوله: وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين.
والأمر الثاني ما جاء من الأدلة أن الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والدين، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبى بكر الصديق أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» .
ثم بين القرآن الكريم أن الله- تعالى- قد أجاب بفضله وكرمه دعاء عبده زكريا. كما بين ما قاله زكريا عند ما بشره ربه بغلام اسمه يحيى فقال- تعالى-:
قال مجاهد في قوله : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال : كان وراثته علما وكان زكريا من ذرية يعقوب .
وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال : قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن : يرث نبوته وعلمه .
وقال السدي : يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب .
وعن مالك ، عن زيد بن أسلم : ( ويرث من آل يعقوب ) قال : نبوتهم .
وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون ، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال : يرث مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة .
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يرحم الله زكريا ، وما كان عليه من ورثة ، ويرحم الله لوطا ، إن كان ليأوي إلى ركن شديد "
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا جابر بن نوح ، عن مبارك - هو ابن فضالة - عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رحم الله أخي زكريا ، ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول : ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب )
وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح ، والله أعلم .
وقوله : ( واجعله رب رضيا ) أي مرضيا عندك وعند خلقك ، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه .
وقوله: ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) يقول: يرثني من بعد وفاتي مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) يقول: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة.
حدثنا مجاهد، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن أبي صالح في قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: وكان وراثته علما، وكان زكريا من ذرّية يعقوب.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال : كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، في قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: نبوّته وعلمه.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن مبارك، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ أخِي زَكَرِيَّا، ما كانَ عَلَيْهِ مِنْ وَرَثَةِ مالِهِ حِينَ يَقُولُ فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: كان الحسن يقول: يرث نبوّته وعلمه. قال قتادة: ذُكر لنا " أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية، وأتى على ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته ".
حدثنا الحسن، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يَرْحَمُ اللهُ زكَرِيَّا ومَا عَلَيْهِ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطا إنْ كانَ لَيَأْوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ".
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ(فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: يرث نبوّتي ونبوّة آل يعقوب.
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) فقرأت ذلك عامَّة قرّاء المدينة ومكة وجماعة من أهل الكوفة:
( يَرِثُنِي وَيَرِثُ ) برفع الحرفين كليهما، بمعنى فهب الذي يرثني ويرث من آل يعقوب، على أن يرثني ويرث من آل يعقوب، من صله الوليّ. وقرأ ذلك جماعة من قرّاء أهل الكوفة والبصرة: ( يَرِثُنِي وَيَرِثْ ) بجزم الحرفين على الجزاء والشرط، بمعنى: فهب لي من لدنك وليا فإنه يرثني إذا وهبته لي. وقال الذين قرءوا ذلك كذلك: إنما حسن ذلك في هذا الموضع، لأن يرثني من آية غير التي قيلها. قالوا وإنما يحسنُ أن يكون مثل هذا صلة، إذا كان غير منقطع عما هو له صلة، كقوله: رِدْءًا يُصَدِّقُنِي .
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأه برفع الحرفين على الصلة للوليّ، لأنّ الوليّ نكرة، وأن زكريا إنما سأل ربه أن يهب له وليا يكون بهذه الصفة، كما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه سأله وليا، ثم أخبر أنه إذا وهب له ذلك كانت هذه صفته، لأن ذلك لو كان كذلك، كان ذلك من زكريا دخولا في علم الغيب الذي قد حجبه الله عن خلقه.
وقوله ( وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) يقول: واجعل يا ربّ الولي الذي تهبه لي مرضيا ترضاه أنت ويرضاه عبادك دينا وخُلُقا وخَلْقا. والرضي: فعيل صرف من مفعول إليه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ دعا لابنه -الذي يستحيل في العادة أن يأتي- بالنبوة! الذين يؤمن بقدرته يُغرِب في دعوته.
عمل
[6] ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ عندما تكون حاجاتنا موصولة بمصالح الآخرة تكون أقرب للإجابة، انو نية صادقة، ثم ادع واذكر ذلك في دعائك.
وقفة
[6] ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ الوراثة دينية يرث العلم والنبوة؛ لأن الأنبياء لا يرثون ولا يُورثون، فهم لا ينتفع منهم أحد، بشيء من أموال الدنيا.
عمل
[6] ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ اجعل من سعيك للوصول لهدفك حكمة.
عمل
[6] اترك علمًا نافعًا تورثه من بعدك، فإرث العلم ينفع ويدوم، وإرث المال قد يزول ﴿يرثني ويرث من آل يعقوب﴾.
وقفة
[6] ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ كل الأسباب كانت ضد إنجابها الولد، ومع ذلك حين دعا ذكر الصفات التى يتمناها فيه! إنه حسن الظن بالله، إنه اليقين برب مجيب الدعاء، إنه التلذذ بمناجاة الله بما يتمناه القلب.
اسقاط
[6] ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ إن الدعاء للأبناء من هدي الأنبياء، فهذا زكريا عليه السلام يدعو لابنه الذي لم يولد، فكيف بمن أبناؤه بين يده وهو يقصر!
وقفة
[6] ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ كم من ذرية كانت وبالًا على والديهم فعذبوا نفوسهم وكسروا قلوبهم قبل ظهورهم، فالذرية الصالحة رزق فاطلبه من الرزاق.
وقفة
[6] ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ من صور الرضا التي تشملها الآية: رضا الإنسان عن نفسه.
وقفة
[6] ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أمنية الأنبياء أن يكون أبناؤهم مرضيين في أقوالهم وأفعالهم، وصالحين يرضى الله عنهم، ما أجملها من دعوة.
وقفة
[6] ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ دعاءً جامعًا أي ترضاه أنت يا رب، ويرضاه عبادك دينًا وخلقًا ويرضي هو بقضائك.
عمل
[6] ﴿وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ ادعوا لأبنائكم بخيري الدنيا والآخرة.
وقفة
[6] ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران: 38]، ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة، وخرج مِن حدِّ العداوة والفتنة إلى حد المسرَّة والنِّعمة.
وقفة
[6] الذرية الصالحة نعمة عظيمة من الله، والذرية الفاسدة ابتلاء وألم وامتحان؛ لذلك دعا ربه: ﴿واجعله ربِّ رضيًّا﴾.
وقفة
[6] لا تأتي الهموم والأحزان إلا من قلة الرضا عن الله، وأشرف شيء للعبد أن يرزقه الله الرضا والتسليم، ولذا دعا زكريا لولده فقال: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾.
الإعراب :
- ﴿ يَرِثُنِي: ﴾
- الجملة: في محل نصب صفة-نعت-لوليا. يرث: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. النون: للوقاية لا عمل لها. والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به.
- ﴿ وَيَرِثُ: ﴾
- معطوفة بالواو على «يرثني» وتعرب إعرابها. والمراد بالإرث إرث الشرع والعلم لأن الأنبياء لا تورث المال.
- ﴿ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيرث. يعقوب: مضاف إليه مجرور بالفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف-التنوين-للعجمة والعلمية.
- ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا: ﴾
- معطوفة بالواو على «هب لي وليا» وتعرب إعرابها. ربّ: أعربت في الآية الرابعة. رضيا: مرضيا مفعول «اجعل» الثاني منصوب بالفتحة المنونة أما مفعولها الأول فهو الهاء-ضمير الغائب-في جملة «اجعله». '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا دعا زكريا عليه السلام ربَّه أن يرزقه الولدَ الصالح؛ ذكرَ هنا السببَ الذي لأجله سأل الولد، قال تعالى:
﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ .. ﴾
التفسير :
أي:بشره الله تعالى على يد الملائكة بــ "يحيى "وسماه الله له "يحيى "وكان اسما موافقا لمسماه:يحيا حياة حسية، فتتم به المنة، ويحيا حياة معنوية، وهي حياة القلب والروح، بالوحي والعلم والدين.{ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ْ} أي:لم يسم هذا الاسم قبله أحد، ويحتمل أن المعنى:لم نجعل له من قبل مثيلا ومساميا، فيكون ذلك بشارة بكماله، واتصافه بالصفات الحميدة، وأنه فاق من قبله، ولكن على هذا الاحتمال، هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام، ونحوهم، ممن هو أفضل من يحيى قطعا
قال القرطبي: قوله- تعالى- يا زَكَرِيَّا في الكلام حذف، أى: فاستجاب الله دعاءه فقال: يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى ... فتضمنت هذه البشارة ثلاثة أشياء: أحدها: إجابة دعائه وهي كرامة. الثاني: إعطاؤه الولد وهو قوة. الثالث: أن يفرد بتسميته ... » .
وقد بين- سبحانه- في آيات أخرى أن الذي بشر زكريا هو بعض الملائكة، وأن ذلك كان وهو قائم يصلى في المحراب، قال- تعالى-: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى، مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ .
وقوله- سبحانه-: اسْمُهُ يَحْيى يدل على أن هذه التسمية قد سماها الله- تعالى- ليحيى، ولم يكل تسميته لزكريا أو لغيره، وهذا لون من التشريف والتكريم.
وقوله- تعالى-: لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا أى لم نجعل أحدا من قبل مشاركا له في هذا الاسم، بل هو أول من تسمى بهذا الاسم الجميل.
قال بعض العلماء: «وقول من قال: إن معناه: لم نجعل له من قبل سميا، أى: نظيرا يساويه في السمو والرفعة غير صواب، لأنه ليس بأفضل من إبراهيم ونوح وموسى فالقول الأول هو الصواب، وممن قال به: ابن عباس، وقتادة، والسدى، وابن أسلم وغيرهم ... » .
هذا الكلام يتضمن محذوفا ، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له : ( يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ) ، كما قال تعالى : ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) [ آل عمران : 38 ، 39
وقوله : ( لم نجعل له من قبل سميا ) قال قتادة ، وابن جريج ، وابن زيد : أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم ، واختاره ابن جرير ، رحمه الله .
وقال مجاهد : ( لم نجعل له من قبل سميا ) أي : شبيها .
أخذه من معنى قوله : ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) [ مريم : 65 ] أي : شبيها .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله .
وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام ، كان لا يولد له ، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها ، بخلاف إبراهيم وسارة ، عليهما السلام ، فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما ; ولهذا قال : ( أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ) [ الحجر : 54 ] مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة . وقالت امرأته : ( ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ) [ هود : 72 ] ، 73 .
يقول تعالى ذكره: فاستجاب له ربه، فقال له: يا زكريا إنا نبشرك بهبتنا لك غلاما اسمه يحيى.
كان قتادة يقول: إنما سماه الله يحيى لإحيائه إياه بالإيمان.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى ) عبد أحياه الله للإيمان.
وقوله ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه لم تلد مثله عاقر قط.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ليحيى ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) يقول: لم تلد العواقر مثله ولدا قط.
وقال آخرون: بل معناه: لم نجعل له من قبله مثلا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو الربيع ، قالا ثنا سالم بن قتيبة، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، في قوله ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) قال: شبيها.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) قال: مثلا.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
وقال آخرون: معنى ذلك، أنه لم يسمّ باسمه أحد قبله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) لم يسمّ به أحد قبله.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) قال: لم يسمّ يحيى أحد قبله.
- حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، مثله.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ( لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) قال: لم يسمّ أحد قبله بهذا الاسم.
حدثنا موسى، قال : ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ( إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) لم يسمّ أحد قبله يحيى.
قال أبو جعفر: وهذا القول أعني قول من قال: لم يكن ليحيى قبل يحيى أحد سمي باسمه أشبه بتأويل ذلك، وإنما معنى الكلام: لم نجعل للغلام الذي نهب لك الذي اسمه يحيى من قبله أحدا مسمى باسمه، والسميّ: فعيل صرف من مفعول إليه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[7] ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾ ما أجمل عطاء الله عندما تمد يدك له وأنت تعلم أن الأمر أقرب للمستحيل، لكن الكريم لم يخيب ظنك!
وقفة
[7] خمسة سُموا قبل أن يولدوا: 1- ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [45] .2- ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: 6]. 3- ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾. 4، 5- ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: 71].
وقفة
[7] ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: أحدها: إجابة دعائه، وهي كرامة. الثاني: إعطاؤه الولد؛ وهو قوة، الثالث: أن يفرد بتسميته.
وقفة
[7] تقدم ذكر هبة يحيى لزكريا قبل ذكر خلق عيسى في آل عمران ومريم؛ مما يظهر براعة المقدمة، وحسن التوطأة، وأهمية التمهيد، وحاجة النفوس إليها.
وقفة
[7] ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ إن المشاركة في التهنئة وزف البشرى تزيد من السرور على قلبي الوالدين.
وقفة
[7] تأمل في إجابة الله تعالى لدعاء من دعاه، يدفعك ذلك للإكثار من التضرع إليه ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾.
وقفة
[7] ﴿لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ له اسم لم يسبق لأحد مثله، اسم يرسم به طريقه في الدنيا والآخرة، ففي اختيار اسم المولود توفيق وبشارة وتميز عن الآخرين.
وقفة
[7] ﴿بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾ من إكرام الله عز وجل لزكريا، أن الله هو الذي سمى له ابنه يحيى، ولهذا الاسم دلالة على مسماه، فيحيى معناه الذي لا يموت، ولم يمت ذكر يحيى عليه السلام، فقد مات شهيدًا، والشهداء أحياء عند ربهم تبارك وتعالى.
وقفة
[7] ﴿اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾ تستحب الأسماء ذات المعاني الطيبة.
وقفة
[7] ﴿لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ فيه إشارة إلى مشروعية حرص بعض الناس على ابتكار أسماء أبنائهم، ولكن ينبغي عدم إغفال معنى الاسم.
وقفة
[7] ﴿لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ أي لم نسم أحدًا قبل يحيى بهذا الاسم، ومن تشريف الله له أنه لم يكل تسميته إلى أبويه، بل كانت تسميته من الله وحده.
عمل
[4-7] زكريا عليه السلام شكى لله: ﴿قال رب ٳني وهن العظم﴾، ثم سلم أمره لله ودعاه: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾ ثم أحسن الظن بالله: ﴿واجعله ربي رضيا﴾؛ فأجاب الله سؤله وأعطاه ما طلب: ﴿إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى﴾، ادعو ربك وأحسن الظن به؛ سيجيب لك سؤلك.
الإعراب :
- ﴿ يا زَكَرِيّا: ﴾
- أي فاستجاب الله سبحانه له وقال له: يا زكريا: يا: أداة نداء. زكريا: اسم منادى مبني على الضم المقدر على الألف للتعذر لأنه منادى علم مفرد في محل نصب وما بعده في محل نصب مفعول به-مقول القول-.
- ﴿ إِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ: ﴾
- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «إنّ».نبشر: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. بغلام: جار ومجرور متعلق بنبشر. والجملة الاسمية بعده في محل جر صفة-نعت-لغلام.
- ﴿ اسْمُهُ يَحْيى: ﴾
- مبتدأ مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. يحيى: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للتعذر ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ولأنه بوزن الفعل وقيل: بل انّ أصله فعل مضارع وكتب بالألف المقصورة تفريقا بين الاسم والفعل.
- ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر صفة ثانية لغلام أو في محل نصب حال من «يحيى».لم: حرف نفي وجزم وقلب. نجعل: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. له: جار ومجرور متعلق بنجعل.
- ﴿ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا: ﴾
- من: حرف جر. قبل: اسم مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة في محل جر بمن. سميا: مفعول به منصوب بالفتحة. بمعنى: لم يسم أحد بيحيى قبله والجار والمجرور «من قبل» متعلق بنجعل أو بحال محذوفة من «سميا». '
المتشابهات :
| الحجر: 53 | ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ |
|---|
| مريم: 7 | ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن دعا زكريا عليه السلام ربَّه؛ استجابَ اللهُ عز و جل هنا دعاءَ زكريا عليه السلام، وبشَّرَه بيحيى عليه السلام، قال تعالى:
﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي .. ﴾
التفسير :
، فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وقال:{ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ْ} والحال أن المانع من وجود الولد، موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه، لم يستحضر هذا المانع لقوة الوارد في قلبه، وشدة الحرص العظيم على الولد، وفي هذه الحال، حين قبلت دعوته، تعجب من ذلك
ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك ما قاله زكريا بعد هذه البشارة السارة. فقال- تعالى-: قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ، وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا.
فالجملة الكريمة استئناف مبنى على سؤال تقديره: فماذا قال زكريا عند ما بشره الله- تعالى- بيحيى؟
ولفظ أَنَّى بمعنى: كيف. أو بمعنى: من أين.
أى: قال زكريا مخاطبا ربه بعد أن بشره بابنه يحيى: يا رب كيف يكون لي غلام، وحال امرأتى أنها كانت عاقرا في شبابها وفي شيخوختها، وحالي أنا أننى قد بلغت من الكبر عتيا، أى. قد تقدمت في السن تقدما كبيرا.
يقال: عتى الشيخ يعتو عتيا- بكسر العين وضمها- إذا بلغ النهاية في الكبر.
قال ابن جرير: «قوله: وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا يقول: وقد عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها، يقال منه للعود اليابس: عات وعاس. وقد عتا يعتو عتوا وعتيا ... وكل متناه في كبر أو فساد أو كفر فهو عات ... ».
فإن قيل: «ما المراد باستفهام زكريا- عليه السلام- مع علمه بقدرة الله- تعالى- على كل شيء؟
فالجواب أن استفهامه إنما هو على سبيل الاستعلام والاستخبار، لأنه لم يكن يعلم أن الله- تعالى- سيرزقه بيحيى عن طريق زوجته العاقر، أو عن طريق الزواج بامرأة أخرى، فاستفهم عن الحقيقة ليعرفها.
ويصح أن يكون المقصود بالاستفهام التعجب والسرور بهذا الأمر العجيب حيث رزقه الله الولد مع تقدم سنه وسن زوجته.
ويجوز أن يكون المقصود بالاستفهام الاستبعاد لما جرت به العادة من أن يأتى الغلام مع تقدم سنه وسن زوجته. وليس المقصود به استحالة ذلك على قدرة الله- تعالى- لأنه- سبحانه- لا يعجزه شيء.
هذا تعجب من زكريا ، عليه السلام ، حين أجيب إلى ما سأل ، وبشر بالولد ، ففرح فرحا شديدا ، وسأل عن كيفية ما يولد له ، والوجه الذي يأتيه منه الولد ، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها ، ومع أنه قد كبر وعتا ، أي عسا عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع .
تقول العرب للعود إذا يبس : " عتا يعتو عتيا وعتوا ، وعسا يعسو عسوا وعسيا " .
وقال مجاهد : ( عتيا ) بمعنى : نحول العظم .
وقال ابن عباس وغيره : ( عتيا ) يعني : الكبر .
والظاهر أنه أخص من الكبر .
وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لقد علمت السنة كلها ، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا ؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف : ( وقد بلغت من الكبر عتيا ) أو " عسيا " .
يقول تعالى ذكره: قال زكريا لما بشره الله بيحيى: ( رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ ) ومن أيّ وجه يكون لي ذلك، وامرأتي عاقر لا تحبل، وقد ضعُفت من الكبر عن مباضعة النساء بأن تقوّيني على ما ضعفت عنه من ذلك، وتجعل زوجتي ولودا، فإنك القادر على ذلك وعلى ما تشاء، أم بأن أن أنكح زوجة غير زوجتي العاقر، يستثبت ربه الخبر، عن الوجه الذي يكون من قبله له الولد، الذي بشره الله به، لا إنكارا منه صلى الله عليه وسلم حقيقة كون ما وعده الله من الولد، وكيف يكون ذلك منه إنكارا لأن يرزقه الولد الذي بشَّره به، وهو المبتدئ مسألة ربه ذلك بقوله فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ بعد قوله إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا .
وقال السديّ في ذلك: ما حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قال: نادى جبرائيل زكريا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا فلما سمع النداء، جاءه الشيطان فقال: يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس من الله، إنما هو من الشيطان يسخر بك، ولو كان من الله أوحاه إليك كما يوحي إليك غيره من الأمر، فشك وقال ( أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ ) يقول: من أين يكون وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ .
وقوله ( وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ) يقول: وقد عتوت من الكبر فصرت نحل العظام يابسها، يقال منه للعود اليابس، عوت عاتٍ وعاسٍ، وقد عتا يعتو عَتِيًّا وعُتُوّا، وعسى يعسو عِسِيا وعسوّا، وكلّ متناه إلى غايته في كبر أو فساد، أو كفر، فهو عات وعاس.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب ، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قد علمتُ السنة كلها، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف ( وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ) أو (عِسِيًّا).
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ) قال: يعني بالعِتيّ: الكبر. .
حدثني محمد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله (عِتِيًّا) قال: نحول العظم.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله ( مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ) قال: سنًّا، وكان ابن بضع وسبعين سنة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ) قال: العتيّ: الذي قد عتا عن الولد فيما يرى نفسه لا يولد له.
- حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ) قال: هو الكبر.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[8] ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ بعض العطاءات الربانية تبلغ في إدهاشها وإبهارها حدًا، تنسى معه أنك أنت من دعوت بها.
وقفة
[8] ﴿قال رب أنى يكون لي غلام﴾ ما وجه قوله ذلك مع أنه قال: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾ [5]، فسؤاله مؤذن بإمكانه عنده، وقوله: ﴿أنى يكون لي﴾ مؤذن بإحالته عادة؟ الجواب: كان بين سؤاله وبشارته بالولد أربعين سنة.
عمل
[8] ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ في عالم قدرة الله دع عنك الغير ممكن والمستحيل، وسلم بأن الله على كل شيء قدير.
وقفة
[8] ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ قيل: إن المراد باستفهام زكريا مع علمه بقدرة الله الاستعلام والاستخبار؛ لأنه لم يكن يعلم أن الله سيرزقه بيحيى عن طريق زوجته العاقر، أو عن طريق الزواج بامرأة أخرى.
لمسة
[8] ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته؛ فسأل ذلك أولًا لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة، وقيل: سأله وهو في سِنّ من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ.
عمل
[8] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾، ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: 72]، زكريا وإبراهيم لم تتكرر عبثًا نفس الفكرة، لعلها إشارة لكل من تأخر مطلبه وانقطعت أسبابه؛ لا تيأس. [8] ﴿وقت بلغت من الكبر عتيا﴾ لا تيأس مهما طال بك العمر؛ فرج الله آتي لا محالة.
عمل
[8، 9] لا تقس رغباتك بقدرتك، وإنما قسها بقدرة الله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ قالَ رَبِّ: ﴾
- قال: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ربّ: أعربت في الآية الكريمة الرابعة.
- ﴿ أَنّى يَكُونُ لِي غُلامٌ: ﴾
- أنى: اسم استفهام بمعنى «كيف» أو «من أين» مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر «يكون» مقدم محذوف. يكون: فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة. لي: جار ومجرور متعلق بخبر «يكون» غلام: اسم «يكون» مؤخر مرفوع بالضمة.
- ﴿ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة الخامسة. الواو حالية. والجملة بعدها: في محل نصب حال. قد: حرف تحقيق.
- ﴿ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا: ﴾
- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك-ضمير المتكلم-والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. من الكبر: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من مفعول «بلغت».عتيا: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى: بلغت حدا أو سنا كبيرا وقد حذف الموصوف المفعول «حدا» وحلت الصفة «عتيا» محله. '
المتشابهات :
| آل عمران: 47 | ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ |
|---|
| آل عمران: 40 | ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ |
|---|
| مريم: 8 | ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ |
|---|
| مريم: 20 | ﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا بَشَّرَ اللهُ عز و جل زكريا عليه السلام بهذه البشرى؛ تعجبَ زكريا عليه السلام، فالزوجة عاقر، وهو شيخ كبير، قال تعالى:
﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
عتيا:
قرئ:
1- بكسر العين، وهى قراءة ابن وثاب، وحمزة، والكسائي.
2- بفتحها، وهى قراءة ابن مسعود.
3- عسيا، وهى قراءة أبى، ومجاهد.
مدارسة الآية : [9] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ .. ﴾
التفسير :
فأجابه الله بقوله:{ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ْ}
أي:الأمر مستغرب في العادة، وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين عليه، ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا.
ثم حكى- سبحانه- ما رد به على استفهام زكريا فقال: قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً.
وقوله: كَذلِكَ خبر لمبتدأ محذوف، أى: الأمر كذلك.
قال الآلوسى: وذلك إشارة إلى قول زكريا- عليه السلام- وجملة هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ مفعول قالَ الثاني وجملة «الأمر كذلك» مع جملة قالَ رَبُّكَ إلخ مفعول قالَ الأول ... ».
والمعنى: قال الله- تعالى- مجيبا على استفهام زكريا، الأمر كما ذكرت يا زكريا من كون امرأتك عاقرا، وأنت قد بلغت من الكبر عتيا، ولكن ذلك لا يحول بيننا وبين تنفيذ إرادتنا في منحك هذا الغلام، فإن قدرتنا لا يعجزها شيء، ولا تخضع لما جرت به العادات.
وهذا الأمر وهو إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ أى:
يسير سهل.
ثم ذكر له- سبحانه- ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً.
أى: لا تعجب يا زكريا من أن يأتيك غلام وأنت وزوجك بتلك الحالة، فإنى أنا الله الذي أوجدتك من العدم، ومن أوجدك من العدم، فهو قادر على أن يرزقك بهذا الغلام المذكور.
فالآية الكريمة قد ساقت بطريق منطقي برهاني، ما يدل على كمال قدرة الله- تعالى- وما يزيد في اطمئنان قلب زكريا- عليه السلام-.
ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان ، وأبو داود ، عن زياد بن أيوب ، كلاهما عن هشيم ، به .
( قال ) أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه : ( كذلك قال ربك هو علي هين ) أي : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها ) هين ) أي : يسير سهل على الله .
ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه ، فقال : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) كما قال تعالى : ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) الإنسان : 1
يقول تعالى ذكره: قال الله لزكريا مجيبا له (قَالَ كَذَلِكَ) يقول: هكذا الأمر كما تقول من أنّ امرأتك عاقر، وإنك قد بلغت من الكبر العتيّ، ولكن ربك يقول: خلْق ما بشَّرتك به من الغلام الذي ذكرت لك أن اسمه يحيى عليّ هين، فهو إذن من قوله (قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) كناية عن الخلق.
وقوله (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا) يقول تعالى ذكره وليس خلق ما وعدتك أن أهبه لك من الغلام الذي ذكرت لك أمره منك مع كبر سنك، وعقم زوجتك بأعجب من خلقك، فإني قد خلقتك، فأنشأتك بشرا سويا من قبل خلقي ما بشرتك بأني واهب لك من الولد، ولم تك شيئا، فكذلك أخلق لك الولد الذي بشرتك به من زوجتك العاقر، مع عِتيك ووهن عظامك، واشتعال شيب رأسك.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
عمل
[9] ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ إن استحالت عليك أمنية، فأحلها إلى من أمره بعد الكاف والنون، فكل المستحيلات عنده هينة، فقط كن فيكون.
عمل
[9] ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ علينا ألا نفكر في صعوبة ظروفنا، بل في قوة الرب الذي ندعوه.
عمل
[9] ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ لا تفكر في صعوبة الظروف، فإنها هيّنة عند ربـك الرؤوف.
وقفة
[9] ﴿قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ لا تدع غيرك في حيرة، إذا كنت قادر على إزالة الغموض عنه.
عمل
[9] كلما استعظمت أمرًا تذكر: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾.
وقفة
[9] ﴿كذلك قال ربك هو علي هين﴾ كل الأحلام والأمنيات والدعوات التي قالوا لك عنها محال أن تتحق؛ هي على الله هينة يسيرة.
وقفة
[9] ﴿كذلك قال ربك هو علي هين﴾ علينا أن لا نفكر في صعوبة ظروفنا، بل في قوة الرب الذي ندعوه، فاسألوه كل شيء، فإنه لا يعجزه شيء.
تفاعل
[9] ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ اللهم يسر علينا كل عسير من أمرنا، واكتب لنا السعادة فيما بقي من عمرنا.
وقفة
[9] ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ لَا تُفَكر في صعوبةِ أمرك واستحالتِه؛ لكِن تذكر قدرة اللهِ عزَّ وجلَّ.
وقفة
[9] ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ تؤكد لك أنه مهما تعاظم مطلبك فقدرة الله أعظم، فإن كان في داخلك أمل فارجو الله، فربك لا شيء عليه عسير، بين الكاف والنون، كن فيكون.
عمل
[9] ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ لا تستصعب حل مشاكلك وأزماتك، فالذي خلقك من العدم قادر على تفريج كربك، قادر على شفاءك بعد أن عجز الأطباء عن مُداواتك.
عمل
[9] ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ إن أحرقت نيران اليأس قلبك؛ استدعِ فِرق الإطفاء بهذه الآية.
عمل
[9] ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ رسالة إلى كل عقيم: أمرك صعب جدًا على أطباء الدنيا، ولكنه على رب الأطباء هين، فاذكر في دعائك أن مطلوبك هين عليه.
وقفة
[9] ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ إذا كان على الله سهلًا هينًا أن يخلق طفلًا من شيخ طاعن وامرأة عاقر؛ فشفاؤه لمريض أسهل، وكشفه لكربة أهون.
عمل
[9] ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ علينا ألَّا نفكِّرَ في صعوبةِ ظروفِنا، بل نفكَّرُ في قوَّةِ الربِّ الذي ندعُوه.
وقفة
[9] قالت نفسك صعب، و﴿قال ربك هو علي هين﴾، قالت غير ممكن، و﴿قال ربك هو علي هين﴾، مهما كبر الهم؛ فالله تعالى أجل وأكبر وأعظم.
عمل
[9] لا تُعلِّق قلبك بالأسباب وتغفل عن المسبِّب فقد يجعل من المستحيل ممكنًا، ومن الممكن مستحيلًا، فلا تيأس ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾.
اسقاط
[9] ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفًا﴾ [طه: 105]، ﴿وألنَّا له الحديد﴾ [سبأ: 10]، ﴿قال ربك هو عليَّ هيِّن﴾، وبعد هذا تظن أن همومك وأحزانك لن تزول؟!
وقفة
[9] داوِ مراقبة الناس بـ: ﴿ولا تُسألون عما كانوا يعملون﴾ [البقرة: 134]، واليأس بـ: ﴿قال ربك هو عليَّ هيِّن﴾، وألم فوت الفرصة بـ: ﴿عسى ربنا أن يبدلنا خيرًا منها﴾ [القلم: 32].
عمل
[9] إنْ أحْرَق قلبك اليأس أطفئ لهيبه بهذه الآية: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾.
وقفة
[9] ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ ما كان عليك عسيرًا فهو على الله يسير، ولن يعجزه أن يعطيك أمانيك، فأبشر بالخير الكثير.
عمل
[9] ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ إن استصعبت عليك الأمور وما من طريق لإنفراجها، فأحلها لمن كل أمر عليه هين، فربك ﻻ يعجزه شيء، والمستحيل عندك فعنده ممكن!
عمل
9] ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ اطلب ما خطر (ببالك)، ولو استصعبته في (خيالك).
وقفة
[9] ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ لا يموت أمل في قلب وعي هذه الآية.
عمل
[9] ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ عند دعائك لا تطلب على قدر حاجتك، بل على قدر من تدعوه.
عمل
[9] يقول الله عز وجل: ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾، تمتِم بها إن ماتَ لك أمل!
وقفة
[9] اختصر الله جوابه على حاجات زكريا عليه السلام من ولد وصحّة بقوله: ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾؛ ليعلم ونعلم أن الله لا راد لفضله، ولا ممسك لرحمته.
وقفة
[9] مَهما بَـدَت لك الأمور كبيرة كثيرة مستحيلة! ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾.
وقفة
[9] كل العقبات تذوب وتتلاشى وتضمحل بعد قراءة هذه الآية: ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾.
وقفة
[9] من عظمة الله: أنه يأتيك بما تحب من وراء ما لا تحتسب! فيفرّج على قلبك من ذات الأمر الذي يأست منه، ويأتيك بالفرح خلف أمر كان أشد ما يكون على قلبك، ويأتيك بأمنيتك خلف باب صددت عنه يأسًا منك أنه لن يُفتح؛ ليوصل لك رسالة نزلت من السماء في قوله: ﴿هو عليّ هين﴾.
وقفة
[9] ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ﴾ الذي أعطاك نعمةَ الحياةِ دونَ أن تسألَه؛ لن يمنَعَكَ خيرًا حين تسألُه.
وقفة
[9] ﴿وَقَد خَلَقتُكَ مِن قَبلُ وَلَم تَكُ شَیـٔا﴾ (تَكُ) أصلها (تكون) فأصبحت (تكن) فصارت (تَكُ)؛ لتدل على أن الإنسان قبل خلقه عدم، ليس بشيء، فناسب تقليل حروف (تَكُ).
الإعراب :
- ﴿ قالَ كَذلِكَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. كذلك: الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدإ محذوف تقديره: الأمر كذلك. ويجوز أن يكون الكاف في محل نصب مفعولا به بقال. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اللام للبعد والكاف للخطاب. والاشارة إلى مبهم يفسره ما بعدها وهو قوله هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ».
- ﴿ قالَ رَبُّكَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح. ربك: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة والكاف ضمير المخاطب في محل جر بالاضافة.
- ﴿ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ: ﴾
- ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. علي: جار ومجرور متعلق بهين. هين: خبر «هو» مرفوع بالضمة. بمعنى: وهو أي الأمر أو خلقه علي هين: أي سهل. والجملة: في محل نصب مفعول به -مقول القول-.
- ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ: ﴾
- الواو: استئنافية. قد: حرف تحقيق. خلقت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم سبحانه. التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. من: حرف جر. قبل: اسم مبني على الضم في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بخلقت. وبني الاسم «قبل» على الضم لانقطاعه عن الاضافة.
- ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً: ﴾
- الواو: عاطفة. لم: حرف نفي وجزم وقلب. تك: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف جوازا وحذفت الواو وجوبا لالتقاء الساكنين واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. شيئا: خبر «تكن» منصوب بالفتحة. '
المتشابهات :
| مريم: 9 | ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ |
|---|
| مريم: 21 | ﴿ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا تعجبَ زكريا عليه السلام؛ ردَّ اللهُ عز و جل عليه هنا بأن الأمر يسير، ثم ذَكَّرَه بخلقِه من العدم، قال تعالى:
﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
خلقتك:
وقرئ:
خلقناك، وهى قراءة الأعمش، والكسائي، وابن وثاب.
مدارسة الآية : [10] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً .. ﴾
التفسير :
{ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ْ} أي:يطمئن بها قلبي، وليس هذا شكا في خبر الله، وإنما هو، كما قال الخليل عليه السلام:{ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ْ} فطلب زيادة العلم، والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طلبته رحمة به، فـ{ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ْ} وفي الآية الأخرى{ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ْ} والمعنى واحد، لأنه تارة يعبر بالليالي، وتارة بالأيام ومؤداها واحد، وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام، وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة، بل كان سويا، لا نقص فيه، من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد، ومع هذا، ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم،. وأما التسبيح والتهليل، والذكر ونحوه، فغير ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى:{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ْ} فاطمأن قلبه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه،
ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك ما التمسه زكريا- عليه السلام- من خالقه فقال:
قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً....
أى: اجعل لي علامة أستدل بها على وقوع ما بشرتني به، لأزداد سرورا واطمئنانا.
ولأعرف الوقت الذي تحمل فيه امرأتى بهذا الغلام فأكثر من شكرك وذكرك.
فأجابه الله- تعالى- بقوله: قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا.
أى: قال الله- تعالى- لعبده زكريا: يا زكريا. علامة وقوع ما بشرتك به، أنك تجد نفسك عاجزا عن أن تكلم الناس بلسانك، لمدة ثلاث ليال بأيامهن حال كونك سوى الخلق، سليم الحواس ليس بك من خرس، أو بكم، ولكنك ممنوع من الكلام بأمرنا وقدرتنا على سبيل خرق العادة.
يقول تعالى مخبرا عن زكريا ، عليه السلام ، أنه ( قال رب اجعل لي آية ) أي : علامة ودليلا على وجود ما وعدتني ، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم ، عليه السلام : ( رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) الآية [ البقرة : 260 ] . ) قال آيتك ) أي : علامتك ( ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) أي : أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة .
قال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، والسدي وقتادة وغير واحد : اعتقل لسانه من غير مرض .
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( ثلاث ليال سويا ) أي : متتابعات .
والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح كما قال تعالى في أول [ آل عمران : ( قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ) [ آل عمران : 41 ]
وقال مالك ، عن زيد بن أسلم : ( ثلاث ليال سويا ) من غير خرس .
وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها ) إلا رمزا ) أي : إشارة
وقوله: ( قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ) يقول تعالى ذكره: قال زكريا: يا ربّ اجعل لي علما ودليلا على ما بشَّرَتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك ورسالتك، ليطمئنّ إلى ذلك قلبي.
كما حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ) قال: قال ربّ اجعل لي آية أن هذا منك.
حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: قال رب، فإن كان هذا الصوت منك فاجعل لي آية (قال) الله (آيَتُكَ) لذلك ( أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) يقول جلّ ثناؤه: علامتك لذلك، ودليلك عليه أن لا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سويّ صحيح، لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس ( ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) قال: اعتقل لسانه من غير مرض.
حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) يقول: من غير خرس.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) قال: لا يمنعك من الكلام مرض.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ( أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) قال: صحيحا لا يمنعك من الكلام مرض.
حدثنا بشر ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) من غير بأس ولا خرس، وإنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعد ما شافهته الملائكة مشافهة، أخذ بلسانه حتى ما كان يفيض الكلام إلا أومأ إيماء.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن عكرمة، في قوله ( ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) قال: سويا من غير خرس.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) وأنت صحيح، قال: فحبس لسانه، فكان لا يستطيع أن يكلم أحدا، وهو في ذلك يسبح، ويقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل، فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمن لا يتهم، عن وهب بن منبه اليماني، قال: أخذ الله بلسانه من غير سوء، فجعل لا يطيق الكلام، وإنما كلامه لقومه بالإشارة، حتى مضت الثلاثة الأيام التي جعلها الله آية لمصداق ما وعده من هبته له.
حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدّي ( قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) يقول: من غير خرس إلا رمزا، فاعتقل لسانه ثلاثة أيام وثلاث ليال.
وقال آخرون: السويّ من صفة الأيام، قالوا: ومعنى الكلام: قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال متتابعات.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال : ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) قال: ثلاث ليال متتابعات.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[10] ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لي آيةً﴾ أي علامة، فإن قلتَ: كيف طلب العلامة على وجود الولد، بعدما بشَّره اللَّهُ تعالى؟ قلتُ: ليبادر إلى الشكر، ويتعجل السرور، إذِ الحملُ لا يظهر في أول العلوق، فأراد معرفته أول وجوده، فجعل الله آية وجوده عجزَه عن كلام الناس.
وقفة
[10] ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ قال بعض أهل العلم: طلب الآية على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به، ونظيره على هذا القول قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260].
لمسة
[10] ﴿اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ بتقديم الجار والمجرور؛ لأنها خاصة به تحديدًا، مثل: ﴿هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً﴾ [الأعراف: 73] خاصة بقوم صالح فقط.
وقفة
[10] هنا فى سورة مريم كلم زكريا عليه السلام الناس ليلًا: ﴿قالَ آيَتُكَ أَلّا تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا﴾، بينما فى سورة آل عمران كلم زكريا عليه السلام الناس نهارًا: ﴿قالَ رَبِّ اجعَل لي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلّا تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِلّا رَمزًا وَاذكُر رَبَّكَ كَثيرًا وَسَبِّح بِالعَشِيِّ وَالإِبكارِ﴾ [آل عمران: ٤١]، مهما شغلتك أمورك الخاصة لا تتوقف عن الدعوة ليلًا ونهارًا.
وقفة
[10] ﴿ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا﴾ أي سوي التكوين بلا نقصٍ، أو مرضٍ فيك.
لمسة
[10] ﴿لَيَالٍ﴾ ما الفرق بين ليال وأيام؟ اليوم في اللغة هو من طلوع الشمس إلى غروبها (باختلاف المفهوم المستحدث السائد أن اليوم يشكل الليل والنهار)، أما الليل هو من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر، وقد فرّق بينها القرآن: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7].
الإعراب :
- ﴿ قالَ رَبِّ: ﴾
- قال: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ربّ: أعربت في الآية الكريمة الرابعة.
- ﴿ اجْعَلْ لِي آيَةً: ﴾
- فعل دعاء وتضرع بصيغة-طلب-والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. لي: جار ومجرور متعلق باجعل. آية: أي علامة: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به والجملة الفعلية-اجعل لي آية» في محل نصب مفعول به-مقول القول-.
- ﴿ قالَ آيَتُكَ: ﴾
- قال أعربت. والجملة الاسمية بعدها: في محل نصب مفعول به -مقول القول-آية: مبتدأ مرفوع بالضمة والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. بمعنى: قال علامتك.
- ﴿ أَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ: ﴾
- ألاّ: أصلها: أن: حرف مصدري ناصب. و «لا» نافية لا عمل لها. تكلم: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الناس: مفعول به منصوب بالفتحة. وجملة تُكَلِّمَ النّاسَ» صلة «أن» لا محل لها من الاعراب. و «أن» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل رفع خبر المبتدأ «آيتك».
- ﴿ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا: ﴾
- بمعنى: ثلاثة أيام بلياليها وأنت سويّ الخلق ليس بك خرس ولا بكم. ثلاث: ظرف زمان متعلق بتكلم منصوب على الظرفية بالفتحة وهو مضاف. ليال: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة المنونة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص اسم نكرة وبقي التنوين دالا على الياء المحذوفة و «سويا» حال منصوب بالفتحة. '
المتشابهات :
| آل عمران: 41 | ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ |
|---|
| مريم: 10 | ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد أن ردَّ اللهُ عز و جل على زكريا عليه السلام؛ طلبَ زكريا عليه السلام علامةً يستدل بها على بدء حمل زوجته؛ ليزداد سرورًا واطمئنانًا، فكانت العلامةُ: أن لا يقدر على كلامِ النَّاسِ مدَّةَ ثلاثِ ليالٍ وأيَّامِها من غيرِ خَرَسٍ ولا مرضٍ، قال تعالى:
﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [11] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ .. ﴾
التفسير :
وخرج على قومه منه فأوحى إليهم، أي:بالإشارة والرمز{ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ْ} لأن البشارة بـ "يحيى "في حق الجميع، مصلحة دينية.
فقوله: سَوِيًّا حال من فاعل «تكلم» وهو زكريا أى: حال كونك يا زكريا سوى الخلق، سليم الجوارح، لا علة تمنعك من ذلك سوى قدرتنا. ثم بين- سبحانه- ما كان من زكريا بعد ذلك فقال: فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.
والمحراب: المصلى، أو الغرفة التي كان يجلس فيها في بيت المقدس، أو هو المسجد، فقد كانت مساجدهم تسمى المحاريب. لأنها الأماكن التي تحارب فيها الشياطين.
أى: فخرج زكريا- عليه السلام- على قومه من المكان الذي كان يصلى فيه، فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أى: فأشار إليهم أو كتب لهم دون أن ينطق بلسانه أَنْ سَبِّحُوا الله- تعالى- وقدسوه بُكْرَةً أى: في أوائل النهار وَعَشِيًّا أى: في أواخره.
وقد ذكر- سبحانه- في آية أخرى، ما يشير إلى أن هذا المحراب الذي خرج منه زكريا- عليه السلام- على قومه. هو ذلك المكان الذي بشره الله- تعالى- فيه بيحيى.
قال- تعالى-: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى،مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
وبذلك نرى الآيات الكريمة قد حكت لنا بأسلوبها البليغ جانبا من رحمة الله- تعالى- بعبده زكريا، ومن الدعوات التي تضرع بها إلى خالقه- عز وجل-، وأن الله- تعالى- قد أجاب له دعاءه، وبشره بيحيى، وعرفه بالعلامة التي بها يعرف وقوع ما بشره به، زيادة في اطمئنانه وسروره.
ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن يحيى، فبينت ما أمره الله- تعالى- به، وما منحه من صفات فاضلة. فقال- تعالى-:
ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : ( فخرج على قومه من المحراب ) أي : الذي بشر فيه بالولد ، ( فأوحى إليهم ) أي : أشار إشارة خفية سريعة : ( أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي : موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله ، وشكرا لله على ما أولاه .
قال مجاهد : ( فأوحى إليهم ) أي : أشار . وبه قال وهب ، وقتادة .
وقال مجاهد في رواية عنه : ( فأوحى إليهم ) أي : كتب لهم في الأرض ، كذا قال السدي .
يقول تعالى ذكره: فخرج زكريا على قومه من مصلاه حين حُبس لسانه عن كلام الناس، آية من الله له على حقيقة وعده إياه ما وعد. فكان ابن جريج يقول في معنى خروجه من محرابه، ما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج ، عن ابن جريج ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ) قال: أشرف على قومه من المحراب.
قال أبو جعفر: وقد بيَّنا معنى المحراب فيما مضى قبل، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ) قال: المحراب: مصلاه، وقرأ: فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
وقوله: ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ) يقول: أشار إليهم، وقد تكون تلك الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك، مما يفهم به عنه ما يريد. وللعرب في ذلك لغتان: وَحَى، وأوحى فمن قال: وَحَى، قال في يفعل: يَحِي; ومن قال: أوحى، قال : يُوحي، وكذلك أوَمَى وَوَمَى، فمن قال: وَمَى، قال في يفعل يَمِي; ومن قال أوَمَى، قال يُومِي.
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي به أوحى إلى قومه، فقال بعضهم: أوحى إليهم إشارة باليد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (فَأَوْحَى) : فأشار زكريا.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمن لا يتهم، عن وهب بن منبه ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ) قال: الوحي: الإشارة.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ) قال: أومى إليهم.
وقال آخرون: معنى أوحى: كتب.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمود بن خداش، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، في قول الله تعالى ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) قال: كتب لهم في الأرض.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ) قال: كتب لهم.
حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدّي ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ) فكتب لهم في كتاب ( أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) ، وذلك قوله ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ )
وقال آخرون: معنى ذلك: أمرهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) قال: ما أدري كتابا كتبه لهم، أو إشارة أشارها، والله أعلم، قال: أمرهم أن سَبِّحوا بكرة وعشيا، وهو لا يكلمهم.
وقوله ( أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) قد بيَّنت فيما مضى الوجوه التي ينصرف فيها التسبيح، وقد يجوز في هذا الموضع أن يكون عنى به التسبيح الذي هو ذكر الله، فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح، ويجوز أن يكون عنى به الصلاة، فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين.
وكان قتادة يقول في قوله ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) قال: أومى إليهم أن صلوا بكرة وعشيا.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[11] ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ حُبِس زكريا عن الكلام، فدعا بالإشارة؛ الداعية لا يتوقف، إن أُغلقَ في وجههِ بابٌ، فَتَحَ بابًا آخر!
وقفة
[11] ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ علاقتك بالله تظهر في الأماكن التي تكثر المكث فيها.
وقفة
[11] ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾، ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ [آل عمران: 37]، ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ [آل عمران: 39] هل عرفت مكان الهِبات.
وقفة
[11] ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا﴾ حتى لو مُنع من الكلام؛ يدعو إلى الله بالإشارة.
وقفة
[11] ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب.
وقفة
[11] ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ لطالما كانت دعوة المحراب سببًا في الإجابة السريعة.
وقفة
[11] حتى في حالة عدم كلامه لم يترك الدعوة إلى الله ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.
وقفة
[11] ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا﴾ مُنِعَ مِنَ الكلامِ فدَعَا إلى اللهِ بالإشَارةِ، يا لها مِن هِمَمٍ!
وقفة
[11] ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا﴾ لو لم تستطع أن تدعو إلى الله إلا بالإيماء والإشارة، فافعل.
وقفة
[11] ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ صام عن الكلام، فأذن الله له بالرمز والإشارة، فدعاهم للتسبيح, ذكر الله لا يحتمل التأخير ثلاثة أيام.
وقفة
[11] ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ أهم شئ هو أن تحرص على ربط أهلك بالله تعالى.
عمل
[11] أكثِر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.
وقفة
[11] ﴿أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ أمره الله تعالى بالتسبيح ولا يفتر عن ذلك، ولا يتوقف حتى تتم الولادة، فكان الصمت علامة على بدء الحمل.
تفاعل
[11] ﴿أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ سَبِّح الله الآن.
عمل
[11] ﴿أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ حافظ على أذكار الصباح والمساء.
الإعراب :
- ﴿ فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ: ﴾
- الفاء: استئنافية ويجوز أن تكون سببية. خرج: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. على قومه: جار ومجرور متعلق بخرج والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة.
- ﴿ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخرج أي من المصلى أو الغرفة وقيل من المسجد. الفاء: عاطفة. أوحى: أي أشار اليهم: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.
- ﴿ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأوحى و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بإلى. أن: حرف تفسير. سبحوا: أي صلّوا لله أو بمعنى صلّوا ونزهوا الله وقدسوه وقد حذف المفعول به ولم يذكر اسم لفظ الجلالة لأنه معلوم من سياق القول. و «سبّحوا» فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «سبّحوا» تفسيرية لا محل لها. ويجوز أن تكون «أن» التفسيرية مصدرية اذا قدّر قبلها حرف جر فيكون القول بتقدير: فأشار اليهم بأن سبّحوا أو إلى أن سبّحوا.
- ﴿ بُكْرَةً وَعَشِيًّا: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية بالفتحة. بمعنى أول النهار وآخره. وعشيا: معطوفة بالواو على «بكرة» وتعرب إعرابها والظرفان متعلقان بسبّحوا. '
المتشابهات :
| مريم: 11 | ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ |
|---|
| القصص: 79 | ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد مدة من تحديد العلامة؛ خرج زكريا عليه السلام على قومه من مصلَّاه، فأشار إليهم من غير كلام، قال تعالى:
﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء