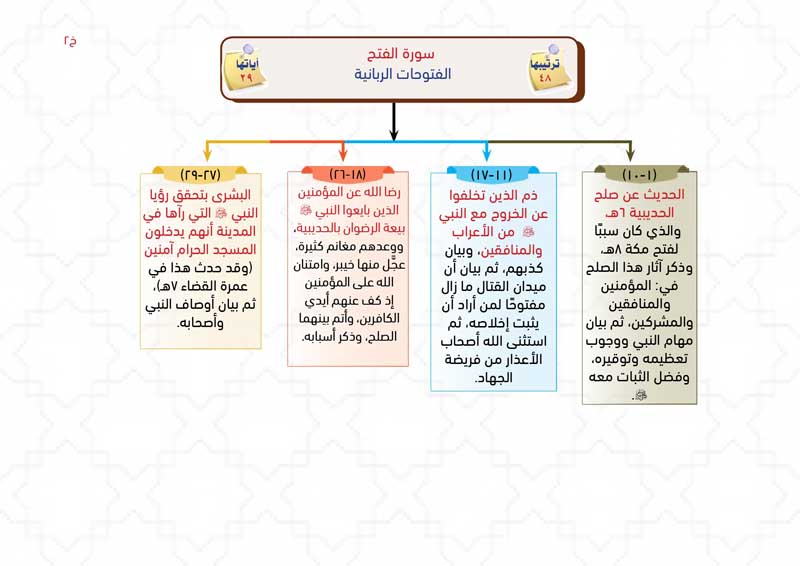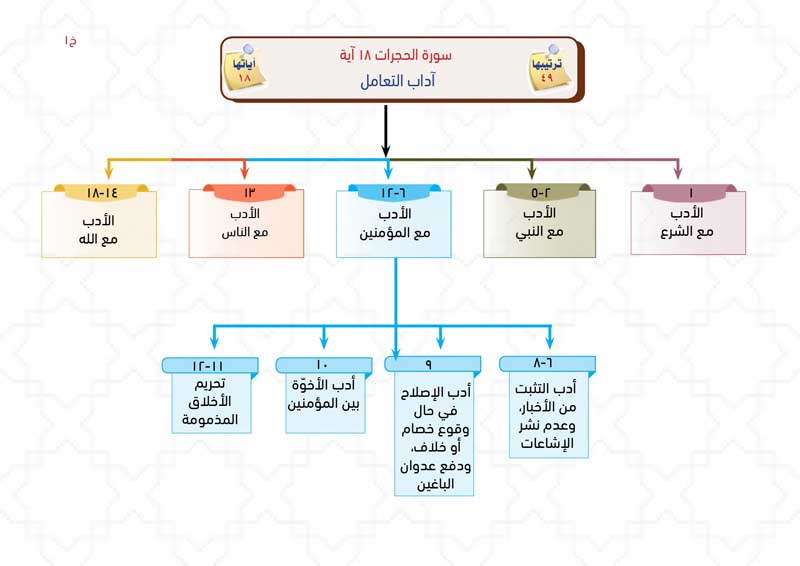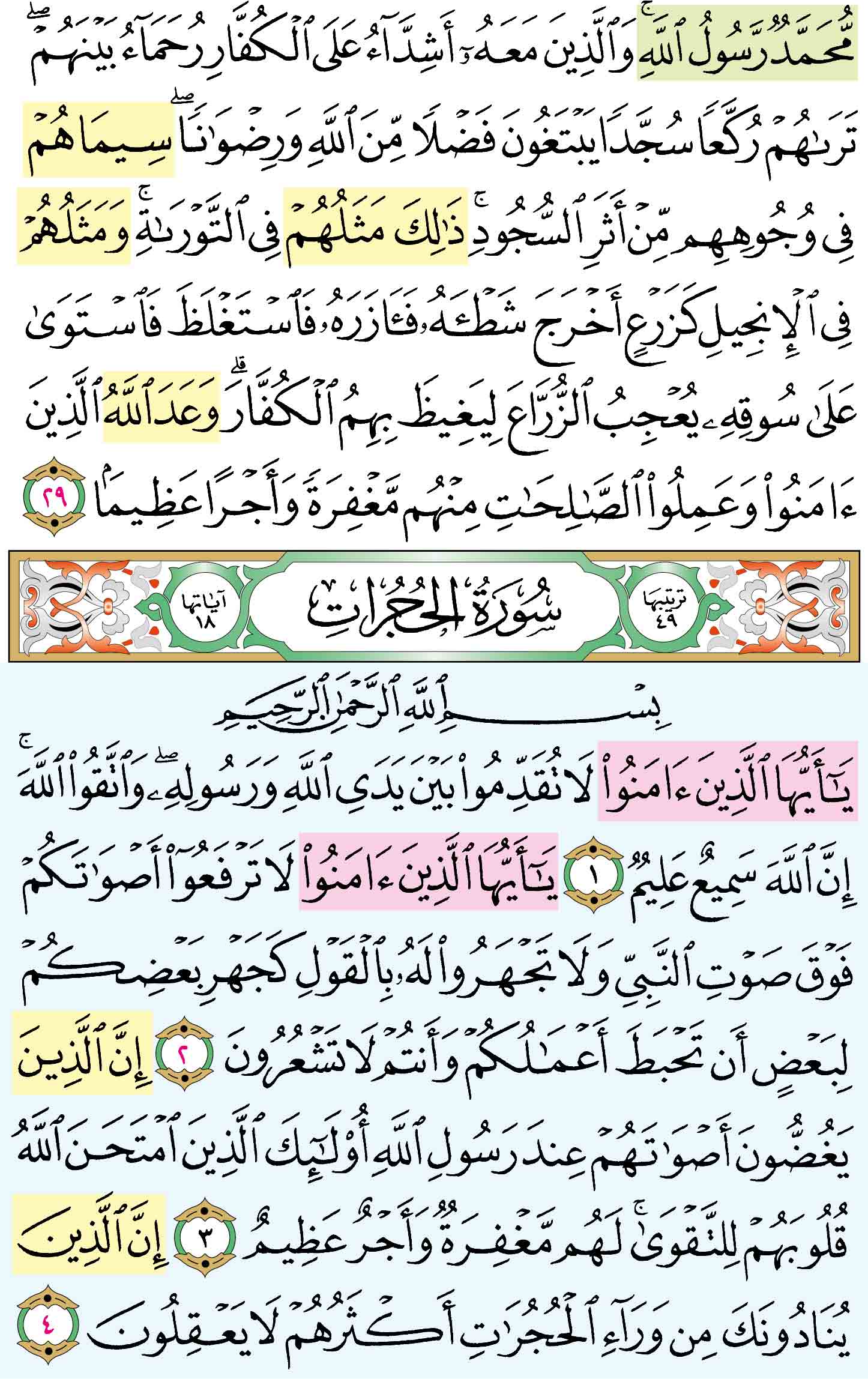
الإحصائيات
سورة الفتح
| ترتيب المصحف | 48 | ترتيب النزول | 111 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 4.50 |
| عدد الآيات | 29 | عدد الأجزاء | 0.22 |
| عدد الأحزاب | 0.45 | عدد الأرباع | 1.80 |
| ترتيب الطول | 43 | تبدأ في الجزء | 26 |
| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الجمل الخبرية: 9/21 | _ | ||
سورة الحجرات
| ترتيب المصحف | 49 | ترتيب النزول | 106 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.50 |
| عدد الآيات | 18 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.30 |
| ترتيب الطول | 54 | تبدأ في الجزء | 26 |
| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 5/10 | يا أيها الذين آمنوا: 2/3 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (29) الى الآية رقم (29) عدد الآيات (1)
= ووصفُ النَّبي ﷺ والمؤمنينَ بالشِّدةِ على الكُفَّارِ والرَّحمةِ فيما بينَهُم، ووعدُ المؤمنينَ بالمَغفرةِ والأجرِ العظيمِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)
من الأدبِ معَ النَّبي ﷺ: 1- عدمُ تقديمِ قولٍ أو فعلٍ قبلَ قولِه وفعلِه، 2- خَفْضُ الصَّوتِ أمامَه وعدمُ الجَهرِ، ثُمَّ مَدَحَ اللهُ من غضَّ صَوتَه عنده ﷺ، وذَمَّ الذينَ ينَادُونَه من خَلفِ حُجُرَاتِ نسائِه.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الفتح
الفتوحات الربانية
أولاً : التمهيد للسورة :
- • سورة الفتوحات الربانية والكرم الرباني:: نزلت بعد صلح الحديبية في ظروف إحباط شديد للصحابة، نزلت والنفوس جريحة.في السنة السابعة -وبعد غزوة الأحزاب- كان الصراع على أشده بين المسلمين والمشركين، ورأى النبي ﷺ في الرؤيا أنه يدخل المسجد الحرام، فتجهّز مع الصحابة للذهاب إلى مكة معتمرين غير مقاتلين، لكنهم لما وصلوا إلى الحديبية رفض المشركون السماح لهم بالدخول إلى مكة، فقرر النبي ﷺ عقد صلح مع مشركي مكة، والذي عرف فيما بعد بـ (صلح الحديبية). لكن بنود هذا الصلح كانت مجحفة بحق المسلمين، فحزن الصحابة حزنًا شديدًا لقبول النبي ﷺ بها، وزاد من حزنهم أنهم منعوا من دخول البيت الحرام لأداء العمرة، ومنعوا من قتال المشركين، وشعروا أنهم يعطون الدنية في دينهم. تخيّل نفسك الآن مكان الصحابة! في هذا الوقت العصيب نزلت سورة الفتح، وسمت هذا الصلح «فَتْحًا مُّبِينًا»، نعم كان فتحًا مبينًا، ألم تكن هذه الفترة من أهم الفترات التي انتشر فيها الإسلام؟! بلا شك، فبعد إبرام هذا الصلح بعامين فقط كان فتح مكة. فالسورة تقول لنا: افهموا عن الله، افهموا سنن الله، عليكم طاعة النبي ﷺ والامتثال له، وانتظروا الفتح من الله.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الفتح».
- • معنى الاسم :: أصل الفتح: إزالة الإغلاق، وفتح البلد: دخله عنوة أو صلحًا.
- • سبب التسمية :: لأنها بدأت ببشرى الفتح، وتكرر فيها لفظ (فتحًا) 3 مرات.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: طاعة النبي ﷺ والامتثال له مهما كانت الظروف، ففيها الخير العظيم.
- • علمتني السورة :: أن صلح الحديبية كان بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين.
- • علمتني السورة :: وجوب تعظيم وتوقير رسول الله ﷺ: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾
- • علمتني السورة :: أن مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة، وأن أهلها من خير الناس على وجه الأرض: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّـهَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾.
• عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِـ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الفتح من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • أكثر سورة تكرر فيها لفظ (السكينة)، حيث تكرر فيها 3 مرات.
• أكثر سورة في القرآن فيها ثناء على الصحابة.
• سورة تجعلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحظات فتح مكة، ونستبشر بنصر الله لنا إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفاتهم التي ذُكرت في الآية الأخيرة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نلزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره مهما كانت الظروف.
• أن نحسن الظن بالله؛ فرب الخير لا يأتي منه إلا كل خير، ومن أحسن ظنه به فلن يخيب ظنه، وسيعطيه فوق ما يتمنى: ﴿... الظَّانِّينَ بِاللَّـهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ (6).
• أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (9).
• أن نجعل لنا وردًا من التسبيح والأذكار في الصباح والمساء: ﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (9).
• أن نتذكَّر مواثيقَنا وعهودَنا مع اللهِ أو مع النَّاسِ، ونعمل على الوفاءِ بها: ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ (10).
• أن نتعاون مع أهلنا على عبادة من العبادات: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ (11).
• ألا نتملق للناس بل نتملق لمن ملكه السماوات والأرض، الذي إن رضى عنا أسعدنا، وجعل هذا الكون كله يسير لصالحنا: ﴿وَلِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (14).
• ألا نهتم بالمظاهر، فإن أعظم البيعات كانت مراسمها تُعقد تحت شجرة: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (18).
• ألا نحكم على أحَدٍ بفعلِه الظَّاهرِ، فلسنا نحن من يُقسِم رحمةَ اللهِ: ﴿لِّيُدْخِلَ اللَّـهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (25).
• أن نلزم قول: «إن شاء الله تعالى» فيما تخبر به للمستقبل: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ﴾ (27).
سورة الحجرات
آداب التعامل
أولاً : التمهيد للسورة :
- • سورة الحجرات تبين لنا:: سؤال: كم ستأخذ فى المائة فى أدبك مع الله؟ مع سنة النبي ﷺ ؟ مع أهلك؟ مع عائلتك؟ مع أصحابك؟ مع جيرانك؟ مع إخوانك المسلمين؟ مع كل الناس؟
- • تضمّنت السورة العديد من الآداب:: كيف تتعامل مع الشرع؟ مع النبي ﷺ ؟ مع المؤمنين؟ مع كل الناس؟ مع الله؟ اليهود فى التوراة المحرفة: «إذا أقرضت أخاك فلا تقرضه بربا، وإذا أقرضت أحدًا من غير إخوانك فأقرضه بربا». الأخلاق عندهم مع اليهود فقط، أما مع غير اليهود فلا توجد أخلاق.وعند المؤمنين فالأخلاق مع الجميع، الكرم، الصدق، الأمانة، أداء الحقوق، الوفاء بالعهد مع الجميع.اثنان من المؤمنين في الهجرة وعدا المشركين بأن يسمحوا لهم أن يذهبوا للمدينة، بشرط ألا يقاتلوا مع النبي ﷺ ، فأمرهم النبي ﷺ أن يوفوا بوعدهم.سورة الحجرات هي سورة الأدب والأخلاق، أدب التعامل وأدب العلاقات.أدب التعامل مع الشرع، ومع النبي ﷺ ، ومع المؤمنين، ومع الناس عامة، ومع الله.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الحُجُرات».
- • معنى الاسم :: الحُجُرات: جمع حُجرة، وهي الغرفة في الدار، والمقصود بها هنا: بيوت أزواج النبي ﷺ.
- • سبب التسمية :: سميت بهذا؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ فيها حرمة بيوت النبي ﷺ ، وذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ الْحُجُرَاتِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ... ﴾ آية (4).
- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن الأخلاق أساس بناء المجتمع.
- • علمتني السورة :: تعظيم النبي ﷺ ، وتوقيره، والتزام توجيهاته وأوامره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾
- • علمتني السورة :: عدم نشر الإِشاعات، والتثبت من الأخبار، لاسيما إن كان القائل غير عدل، فكم من كلمةٍ نقلها فاجر فاسق سبَّبت كارثةً من الكوارث: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...﴾
- • علمتني السورة :: أنه إذا تقاتل طائفتان من المسلمين فعلينا: الدعوة إلى الصلح وهو تحكيم كتاب الله، فإذا لم تقبل إحداهما الصلح وجب على المسلمين قتالها؛ لأنها هي الباغية، فإذا رجعت الباغية وقبلت تحكيم كتاب الله فيجب تطبيق العدل بينهما: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الحُجُرات من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الحجرات افتتحت بالنداء، واحتوت على 6 نداءات: 5 نداءات للمؤمنين، والنداء السادس للناس كافة.
• سورة الحجرات احتوت على 8 آيات تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت بعض الأوامر والنواهي للمحافظة على قوة المسلمين وتماسكهم.
• سورة الحجرات آخر سورة من سور المثاني البالغة 30 سورة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتأدب مع الشرع ومع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي منا الخضوع لشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزهما.
• أن نحذر أن نقدم الآراء والأهواء على القرآن والسنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ (1).
• أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ونوقره، ونلتزم توجيهاته وأوامره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (2).
• أن نتثبت من الأخبار، ولا ننشر الإِشاعات، لاسيما إن كان القائل غير عدل، فكم من كلمةٍ نقلها فاجر فاسق سبَّبت كارثةً من الكوارث: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...﴾ (6).
• أن نلزم العدل مع كل الناس: ﴿وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (9).
• أن نصلح بين اثنين كانا على خلاف: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (10).
• أن نتجنب هذه الأفعال: السخرية والاستهزاء بالآخرين، واحتقار الناس، ومنادتهم بالألقاب التي تغضبهم، ووجوب التوبة من هذه الأفعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ...﴾ (11).
• أن ننادي الناس بأحب الأوصاف إليهم: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ (11).
• أن نمتنع عن الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب ...﴾ (12).
• أن نحسن علانيتنا وسريرتنا؛ فالله بصير بما نعمل: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّـهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (18).
تمرين حفظ الصفحة : 515
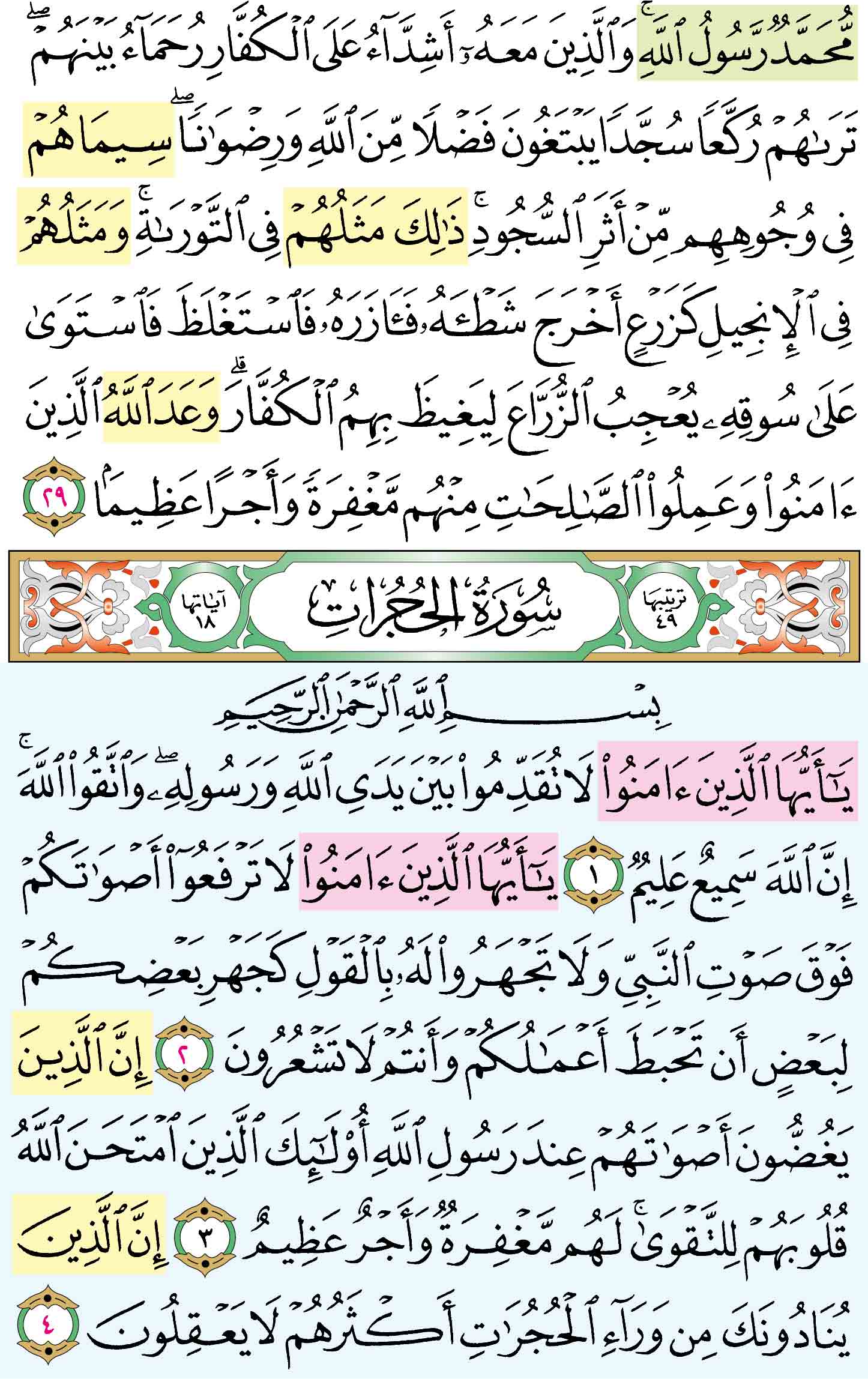
مدارسة الآية : [29] :الفتح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ .. ﴾
التفسير :
يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، أنهم بأكمل الصفات، وأجل الأحوال، وأنهم{ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} أي:جادون ومجتهدون في عداوتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم، وانكسروا، وقهرهم المسلمون،{ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} أي:متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك{ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا} أي:وصفهم كثرة الصلاة، التي أجل أركانها الركوع والسجود.
{ يَبْتَغُونَ} بتلك العبادة{ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} أي:هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم، والوصول إلى ثوابه.
{ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} أي:قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههم، حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم، استنارت [بالجلال] ظواهرهم.
{ ذَلِكَ} المذكور{ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ} أي:هذا وصفهم الذي وصفهم الله به، مذكور بالتوراة هكذا.
وأما مثلهم في الإنجيل، فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم{ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ} أي:أخرج فراخه، فوازرته فراخه في الشباب والاستواء.
{ فَاسْتَغْلَظَ} ذلك الزرع أي:قوي وغلظ{ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} جمع ساق،{ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ} من كماله واستوائه، وحسنه واعتداله، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه، قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه، من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه، فآزره فاستغلظ، ولهذا قال:{ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال، ومعامع القتال.
{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} فالصحابة رضي الله عنهم، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة، التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة.
ولنسق قصة الحديبية بطولها، كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في{ الهدي النبوي} فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة، وتكلم على معانيها وأسرارها، قال -رحمه الله تعالى:-
فصل في قصة الحديبية
قال نافع:كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري، وقتادة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق وغيرهم.
وقال هشام بن عروة، عن أبيه:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة:إنها كانت في ذي القعدة على الصواب.
وفي الصحيحين عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه ألف وخمسمائة، هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما:كانوا ألفا وأربعمائة، وفيهما، عن عبد الله بن أبي أوفى:كنا ألفا وثلاثمائة، قال قتادة:قلت لسعيد بن المسيب:كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال:خمس عشرة مائة، قال:قلت:فإن جابر بن عبد الله قال:كانوا أربع عشرة مائة، قال:يرحمه الله وهم، وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة، قلت:وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقيل له:كم كنتم؟ قال:ألفا وأربعمائة، بخيلنا ورجلنا، يعني:فارسهم وراجلهم.
والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حزن، قال شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه:كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ألفا وأربعمائة، وغلط غلطا بينا من قال:كانوا سبعمائة، وعذرهأنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة أو عشرة، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة، فلو كانت السبعون عن جميعهم، لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا، وقد قال بتمام الحديث بعينه، أنهم كانوا ألفا وأربعمائة.
فصل
فلما كانوا بذي الحليفة، قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له بين يديه من خزاعة، يخبره عن قريش، حتى إذا كانوا قريبا من عسفان، أتاه عينه، فقال:إني قد تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت.
واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه:أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر:الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فروحوا إذا"فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين"، فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هو بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش.
وسار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت راحلته، فقال الناس:حل حل، فألحت، فقالوا:خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"ثم قال:"والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها"ثم زجرها، فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش.
فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوها فيه، قال:فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها، وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال:يا رسول الله، ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي، إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان، فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت.
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فأرسله إلى قريش، وقال:"أخبرهم أنا لم نأت لقتال، إنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام"
وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين، ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة، حتى لا يستخفى فيها بالإيمان، فانطلق عثمان، فمر على قريش ببلدح، فقالوا:أين تريد؟ فقال:بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ونخبركم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمارا، قالوا:قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك.
وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحب به، وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة، وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان:خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون"فقالوا:وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال:"ذاك ظني به، أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه"واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة.
فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه، وقال:"هذه عن عثمان"ولما تمت البيعة، رجع عثمان، فقال له المسلمون:اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت، فقال:بئسما ظننتم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيم بالحديبية، ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت، فقال المسلمون:رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعلمنا بالله، وأحسننا ظنا.
وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد ابن قيس، وكان معقل بن يسار، أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه، أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات، في أول الناس، وأوسطهم، وآخرهم.
فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل تهامة، فقال:إني تركت كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره"قال بديل:سأبلغهم ما تقول.
فانطلق حتى أتى قريشا، فقال:إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم، فقال سفهاؤهم:لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي:منهم:هات ما سمعته، قال:سمعته يقول كذا وكذا، فقال عروة بن مسعود الثقفي:إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها، ودعوني آته، فقالوا:ائته، فأتاه، فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك:أي:محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فوالله إني لأرى وجوها، وأرى أوباشا من الناس، خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر:امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال:من ذا؟ قال:أبو بكر، قال:أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، لأجبتك.
وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب يده بنعل السيف، وقال:أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه، وقال:من ذا؟ قال:المغيرة بن شعبة، فقال:أي:غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء"
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه.
وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ، كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم، خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر، تعظيما له.
فرجع عروة إلى أصحابه، فقال:أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى، وقيصر، والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه، ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم، خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
فقال رجل من بني كنانة:دعوني آته، فقالوا:ائته.
فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له"فبعثوها فاستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك، قال:سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.
فرجع إلى أصحابه، فقال:رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت فقام مكرز بن حفص، وقال:دعوني آته، فقالوا:ائته، فلما أشرف عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر"فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يكلمه، إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد سهل لكم من أمركم"فقال:هات، اكتب بيننا وبينك كتابا، فدعا الكاتب، فقال:"اكتب:بسم الله الرحمن الرحيم"فقال سهيل:أما الرحمن، فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب:"باسمك اللهم"كما كنت تكتب، فقال المسلمون:والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اكتب باسمك اللهم"
ثم قال:"اكتب:هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله "فقال سهيل:فوالله لو نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب:محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني رسول الله وإن كذبتموني، اكتب:محمد بن عبد الله "فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به"فقال سهيل:والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل، فكتب.
فقال سهيل:على أن لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك، إلا رددته علينا.
فقال المسلمون:سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟
فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل:هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه، أن ترده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنا لم نقض الكتاب بعد"فقال:فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فأجزه لي"فقال:ما أنا بمجيزه، فقال:"بلى فافعل"قال:ما أنا بفاعل، قال مكرز:قد أجزناه.
فقال أبو جندل:يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا.
قال عمر بن الخطاب:والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت:يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال:"بلى"قلت:ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال:"بلى"فقلت:علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال:"إني رسول الله، وهو ناصري، ولست أعصيه"قلت:أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال:"بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟"قلت:لا، قال:"فإنك آتيه ومطوف به"
قال:فأتيت أبا بكر، فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد:فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، قال عمر:فعملت لذلك أعمالا.
فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قوموا وانحروا، ثم احلقوا"فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت:يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلق لك، فقام فخرج، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل:{ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حتى بلغ{ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية، والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة.
وفي مرجعه أنزل الله عليه:{ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} إلى آخرها، فقال عمر:أفتح هو يا رسول الله؟ فقال:"نعم"فقال الصحابة:هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟
فأنزل الله عز وجل:{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ}
الآية. انتهى.
وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة
[وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفا عنه، وكان الفراغ من كتابته في 13 ذي الحجة 1345 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين.
بقلم الفقير إلى ربه سليمان بن حمد العبد الله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات]
وقوله- تعالى-: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مبتدأ وخبر، أو مُحَمَّدٌ خبر لمبتدأ محذوف، ورَسُولُ اللَّهِ بدل أو عطف بيان من الاسم الشريف. أى: هذا الرسول الذي أرسله الله- تعالى- بالهدى ودين الحق، هو محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وَالَّذِينَ مَعَهُ وهم أصحابه- وعلى رأسهم من شهد معه صلح الحديبية، وبايعه تحت الشجرة- من صفاتهم أنهم أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ أى: غلاظ عليهم، وأنهم رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.
أى: أنهم مع إخوانهم المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتعاونون على البر والتقوى ...
وقوله- تعالى- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فيه أسمى التكريم للرسول صلّى الله عليه وسلّم حيث شهد له- سبحانه- بهذه الصفة، وكفى بشهادته- عز وجل- شهادة، وحيث قدم الحديث عنه بأنه أرسله بالهدى ودين الحق، ثم أخر اسمه الشريف على سبيل التنويه بفضله، والتشويق إلى اسمه.
وفي وصف أصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، مدح عظيم لهم، وجمع بين الوصفين على سبيل الاحتراس، فهم ليسوا أشداء مطلقا، ولا رحماء مطلقا، وإنما شدتهم على أعدائهم، ورحمتهم لإخوانهم في العقيدة، وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ، يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ... .
قال صاحب الكشاف: «وعن الحسن أنه قال: «بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، وبلغ من تراحمهم فيما بينهم، أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه..» .
وأسمى من هذا كله في بيان تراحمهم قوله- تعالى-: وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ...
ثم وصفهم بوصف آخر فقال: تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً.
أى: تراهم وتشاهدهم- أيها العاقل- راكعين ساجدين محافظين على الصلاة ولا يريدون من وراء ذلك إلا التقرب إلى الله- تعالى- والظفر برضاه وثوابه..
ثم وصفهم بوصف ثالث فقال: سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.. أى: علامتهم وهو نور يجعله الله- تعالى- في وجوههم يوم القيامة، وحسن سمت يعلو وجوههم وجباههم في الدنيا، من أثر كثرة سجودهم وطاعتهم لله رب العالمين.
فالمقصود بهذه الجملة بيان أن الوضاءة والإشراق والصفاء.. يعلو وجوههم من كثرة الصلاة والعبادة لله، وليس المقصود أن هناك علامة معينة- كالنكتة التي تكون في الوجه- كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان.
واختار- سبحانه- لفظ السجود، لأنه يمثل أعلى درجات العبودية والإخلاص لله- تعالى-.
قال الآلوسى: «أخرج ابن مردويه بسند حسن عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «في قوله- تعالى-: سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ النور يوم القيامة» .
ثم قال الآلوسى: ولا يبعد أن يكون النور علامة على وجوههم في الدنيا والآخرة- للآثار السابقة- لكنه لما كان في الآخرة أظهر وأتم خصه النبي صلّى الله عليه وسلّم بالذكر ... » .
واسم الإشارة في قوله- تعالى-: ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ يعود إلى جميع أوصافهم الجليلة السابقة. والمثل هو الصفة العجيبة والقصة ذات الشأن. أى: ذلك الذي ذكرناه عن هؤلاء المؤمنين الصادقين من صفات كريمة تجرى مجرى الأمثال، صفتهم في التوراة التي أنزلها الله- تعالى- على نبيه موسى- عليه السلام-.
ثم بين- سبحانه- صفتهم في الإنجيل فقال: وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ...
وقوله: وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ معطوف على ما قبله وهو مثلهم في التوراة، والإنجيل:
هو الكتاب الذي أنزله الله- تعالى- على نبيه عيسى- عليه السلام-.
والشط: فروع الزرع، وهو ما خرج منه وتفرع على شاطئيه. أى: جانبيه. وجمعه:
أشطاء، وشطوء، يقال: شطأ الزرع وأشطأ، إذا أخرج فروعه التي تتولد عن الأصل.
وقوله فَآزَرَهُ أى: فقوت تلك الفروع أصولها، وآزرتها، وجعلتها مكينة ثابتة في الأرض. وأصله من شد الإزار. تقول: أزّرت فلانا، إذا شددت إزاره عليه. وتقول آزرت البناء- بالمد والقصر- إذا قويت أساسه وقواعده.
ومنه قوله- تعالى- حكاية عن موسى- عليه السلام-: وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.
وقوله: فَاسْتَغْلَظَ أى: فصار الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا.
وقوله: فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ أى: فاستقام وتكامل على سيقانه التي يعلو عليها.
وقوله: يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ أى: يعجب الخبراء بالزراعة لقوته وحسن هيئته.
والمعنى: أن صفة المؤمنين في الإنجيل، أنهم كالزرع، يظهر في أول أمره رقيقا ضعيفا متفرقا، ثم ينبت بعضه حول بعض، ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد، وتعجب جودته أصحاب الزراعة، العارفين بها.
فكذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، كانوا في أول الأمر في قلة وضعف، ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة، حتى بلغوا ما بلغوا في ذلك.
وصدق الله إذ يقول: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
قال صاحب الكشاف: «وهذا مثل ضربه الله- تعالى- لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى واستحكم. لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قام وحده، ثم قواه الله- تعالى- بمن معه. كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها، حتى يعجب الزراع» .
وعلى هذا التفسير الذي سرنا عليه يكون وصفهم في التوراة، هو المعبر عنه بقوله- تعالى-: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.. ويكون وصفهم في الإنجيل هو المعبر عنه بقوله- سبحانه-: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ....
ولا شك أن هذه الأوصاف كانت موجودة في الكتابين قبل أن يحرفا ويبدلا، بل بعض هذه الأوصاف موجودة في الكتابين، حتى بعد تحريفهما.
فقد أخرج بن جرير وعبد بن حميد عن قتادة قال: «مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..» .
ويرى بعض المفسرين أن المذكور في التوراة والإنجيل شيء واحد، وهو الوصف المذكور إلى نهاية قوله: وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاما على هذه الجملة، وما بعدها وهو قوله: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ.. كلام مستأنف.
قال القرطبي: «قوله- تعالى-: ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ.. قال الفراء: فيه وجهان: إن شئت قلت: المعنى: ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضا، كمثلهم في القرآن، فيكون الوقف على «الإنجيل» .
وإن شئت قلت: تمام الكلام: ذلك مثلهم في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومثلهم في الإنجيل.
وكذا قال ابن عباس وغيره: هما مثلان، أحدهما في التوراة، والآخر في الإنجيل ... » .
والذي نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كونهما مثلين، أحدهما مذكور في التوراة والآخر في الإنجيل، هو الرأى الراجح، لأن ظاهر الآية يشهد له.
وفي هذه الصفات ما فيها من رسم صورة مشرقة مضيئة لهؤلاء المؤمنين الصادقين.
وقوله- تعالى-: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ تعليل لما يعرب عنه الكلام، من إيجاده- تعالى- لهم على هذه الصفات الكريمة.
أى: جعلهم- سبحانه- كذلك بأن وفقهم لأن يكونوا أشداء على الكفار، ولأن يكونوا رحماء فيما بينهم، ولأن يكونوا مواظبين على أداء الطاعات.. لكي يغيظ بهم الكفار، فيعيشوا وفي قلوبهم حسرة مما يرونه من صفات سامية للمؤمنين.
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بهذا الوعد الجميل، فقال: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.
و «من» في قوله مِنْهُمْ الراجح أنها للبيان والتفسير، كما في قوله- تعالى- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ...
أى: وعد الله- تعالى- بفضله وإحسانه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهم أهل بيعة الرضوان، ومن كان على شاكلتهم في قوة الإيمان.. وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم، وأجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا هو- سبحانه-.
ويجوز أن تكون من هنا للتبعيض، لكي يخرج من هؤلاء الموعودين بالمغفرة والأجر العظيم أولئك الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، وهم المنافقون الذين أبوا مبايعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأبوا الخروج معه للجهاد، والذين من صفاتهم أنهم كانوا إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ...
هذا، وقد أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها: وجوب احترام الصحابة وتوقيرهم، والثناء عليهم، لأن الله- تعالى- قد مدحهم ووعدهم بالمغفرة وبالأجر العظيم.
قال القرطبي: «روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير أنه قال: كنا عند مالك بن أنس، فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقرأ مالك هذه الآية: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ... فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقد أصابته هذه الآية. ثم قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته، فقد رد على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين» .. .
وبعد: فهذا تفسير لسورة «الفتح» تلك السورة التي بشرت الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه
يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه ، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب ، فقال : ( محمد رسول الله ) ، وهذا مبتدأ وخبر ، وهو مشتمل على كل وصف جميل ، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال : ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) ، كما قال تعالى : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) [ المائدة : 54 ] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار ، رحيما برا بالأخيار ، غضوبا عبوسا في وجه الكافر ، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن ، كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) [ التوبة : 123 ] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر " ، وقال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح .
وقوله : ( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة ، وهي خير الأعمال ، ووصفهم بالإخلاص فيها لله - عز وجل - والاحتساب عند الله جزيل الثواب ، وهو الجنة المشتملة على فضل الله ، وهو سعة الرزق عليهم ، ورضاه تعالى ، عنهم وهو أكبر من الأول ، كما قال : ( ورضوان من الله أكبر ) [ التوبة : 72 ] .
وقوله : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) : قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( سيماهم في وجوههم ) يعني : السمت الحسن .
وقال مجاهد وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد الطنافسي ، حدثنا حسين الجعفي ، عن زائدة ، عن منصور عن مجاهد : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) قال : الخشوع ، قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه ، فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون .
وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم .
وقال بعض السلف : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار .
وقد أسنده ابن ماجه في سننه ، عن إسماعيل بن محمد الطلحي ، عن ثابت بن موسى ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " والصحيح أنه موقوف .
وقال بعضهم : إن للحسنة نورا في القلب ، وضياء في الوجه ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الناس .
وقال أمير المؤمنين عثمان : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه ، وفلتات لسانه .
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه ، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس ، كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته .
وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمود بن محمد المروزي ، حدثنا حامد بن آدم المروزي ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن جندب بن سفيان البجلي قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر " ، العرزمي متروك .
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة ، لخرج عمله للناس كائنا ما كان " .
وقال الإمام أحمد [ أيضا ] : حدثنا حسن ، حدثنا زهير ، حدثنا قابوس بن أبي ظبيان : أن أباه حدثه عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الهدي الصالح ، والسمت الصالح ، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة " ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي ، عن زهير ، به .
فالصحابة [ رضي الله عنهم ] خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم ، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم .
وقال مالك ، رحمه الله : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون : " والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا " . وصدقوا في ذلك ، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة ، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة ; ولهذا قال هاهنا : ( ذلك مثلهم في التوراة ) ، ثم قال : ( ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه [ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ) : ( أخرج شطأه ] ) أي : فراخه ، ( فآزره ) أي : شده ( فاستغلظ ) أي : شب وطال ، ( فاستوى على سوقه يعجب الزراع ) أي : فكذلك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ، ( ليغيظ بهم الكفار ) .
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله ، في رواية عنه - بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ، قال : لأنهم يغيظونهم ، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ، ويكفيهم ثناء الله عليهم ، ورضاه عنهم .
ثم قال : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ) من " هذه لبيان الجنس ، ( مغفرة ) أي : لذنوبهم . ( وأجرا عظيما ) أي : ثوابا جزيلا ورزقا كريما ، ووعد الله حق وصدق ، لا يخلف ولا يبدل ، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم ، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ، وجعل جنات الفردوس مأواهم ، وقد فعل .
قال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه " .
آخر تفسير سورة الفتح ، ولله الحمد والمنة .
القول في تأويل قوله تعالى : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)
وقوله ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) يقول تعالى ذكره: محمد رسول الله وأتباعه من أصحابه الذين هم معه على دينه,( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ) , غليظة عليهم قلوبهم, قليلة بهم رحمتهم ( رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) يقول: رقيقة قلوب بعضهم لبعض, لينة أنفسهم لهم, هينة عليهم لهم.
كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ألقى الله في قلوبهم الرحمة, بعضهم لبعض ( تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ) يقول: تراهم ركعا أحيانا لله في صلاتهم سجدا أحيانا( يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ ) يقول: يلتمسون بركوعهم وسجودهم وشدّتهم على الكفار ورحمة بعضهم بعضا, فضلا من الله, وذلك رحمته إياهم, بأن يتفضل عليهم, فيُدخلهم جنته ( وَرِضْوَانًا )يقول: وأن يرضى عنهم ربهم.
وقوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) يقول: علامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم.
ثم اختلف أهل التأويل في السيما الذي عناه الله في هذا الموضع, فقال بعضهم: ذلك علامة يجعلها الله في وجوه المؤمنين يوم القيامة, يعرفون بها لما كان من سجودهم له في الدنيا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة.
حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا عبيد الله العتكي, عن خالد الحنفي, قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: يعرف ذلك يوم القيامة في وجوههم من أثر سجودهم في الدنيا, وهو كقوله تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ .
حدثني عبيد بن أسباط بن محمد, قال: ثنا أبي, عن فضيل بن مروزق, عن عطية, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: مواضع السجود من وجوههم يوم القيامة أشد وجوههم بياضا.
حدثنا محمد بن عمارة, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا ابن فضيل, عن فضيل, عن عطية, بنحوه.
حدثني أبو السائب, قال: ثنا ابن فضيل, عن فضيل, عن عطية, بنحوه.
حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد, قال: أخبرنا فضيل, عن عطية, مثله.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر, قال: سمعت شبيبا يقول عن مقاتل بن حيان, قال : ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: النور يوم القيامة.
حدثنا ابن سنان القزاز, قال: ثنا هارون بن إسماعيل, قال: قال عليّ بن المبارك: سمعت غير واحد عن الحسن, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: بياضا في وجوههم يوم القيامة.
وقال آخرون: بل ذلك سيما الإسلام وَسمْته وخشوعه, وعنى بذلك أنه يرى من ذلك عليهم في الدنيا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ) قال: السَّمْت الحَسَن.
قال: ثنا مجاهد, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا الحسن بن معاوية, عن الحكم, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: أما إنه ليس بالذي ترون, ولكنه سيما الإسلام وسَحْنته وسَمته وخشوعه.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عامر, قال: ثنا سفيان, عن حميد الأعرج, عن مجاهد ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: الخشوع والتواضع.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن حميد الأعرج, عن مجاهد, مثله.
قال: ثنا أبو عامر, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: الخشوع.
حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, عن شعبة, عن الحكم, عن مجاهد, في هذه الآية ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: السَّحْنة.
حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: هو الخشوع, فقلت: هو أثر السجود, فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنـز وهو كما شاء الله.
وقال آخرون: ذلك أثر يكون في وجوه المصلين, مثل أثر السهر, الذي يظهر في الوجه مثل الكلف والتهيج والصفرة, وأشبه ذلك مما يظهره السهر والتعب في الوجه, ووجهوا التأويل في ذلك إلى أنه سيما في الدنيا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن رجل, عن الحسن ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: الصفرة.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر, عن أبيه, قال: زعم الشيخ الذي كان يقصّ في عُسر, وقرأ ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) فزعم أنه السهر يرى في وجوههم.
حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يعقوب القمِّيُّ, عن حفص, عن شَمِر بن عَطية, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ) قال: تهيج في الوجه من سهر الليل.
وقال آخرون: ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرض, أو نَدَى الطَّهُور.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا حوثرة بن محمد المنقري, قال: ثنا حماد بن مسعدة; وحدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا حرير جميعا عن ثعلبة بن سهيل, عن جعفر بن أبي المُغيرة, عن سعيد بن جُبير, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: ثرى الأرض, وندى الطَّهُور.
حدثنا ابن سنان القزّاز, قال: ثنا هارون بن إسماعيل, قال: ثنا عليّ بن المبارك, قال: ثنا مالك بن دينار, قال: سمعت عكرِمة يقول ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: هو أثر التراب.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في وجوههم من أثر السجود, ولم يخصّ ذلك على وقت دون وقت. وإذ كان ذلك كذلك, فذلك على كلّ الأوقات, فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الإسلام, وذلك خشوعه وهديه وزهده وسمته, وآثار أداء فرائضه وتطوّعِه, وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به, وذلك الغرّة في الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء, وبياض الوجوه من أثر السجود.
وبنحو الذي قلنا في معنى السيما قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) يقول: علامتهم أو أعلمتهم الصلاة.
وقوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) يقول: هذه الصفة التي وصفت لكم من صفة أتباع محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الذين معه صفتهم في التوراة.
وقوله ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) يقول: وصفتهم في إنجيل عيسى صفة زرع أخرج شطأه, وهو فراخه, يقال منه: قد أشطأ الزرع: إذا فرَّخ فهو يشطّي إشطاء, وإنما مثلهم بالزرع المشطئ, لأنهم ابتدءوا في الدخول في الإسلام, وهم عدد قليلون, ثم جعلوا يتزايدون, ويدخل فيه الجماعة بعدهم, ثم الجماعة بعد الجماعة, حتى كثر عددهم, كما يحدث في أصل الزرع الفرخ منه, ثم الفرخ بعده حتى يكثر وينمي.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثنا معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ) أصحابه مثلهم, يعني نعتهم مكتوبا في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق السموات والأرض.
حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قالة: ثنا عبيد, عن الضحاك ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ )... إلى قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) ثم قال ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ )... الآية.
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ذلك ( مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) : أي هذا المثل في التوراة ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) فهذا مثل أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الإنجيل.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ).
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) يعني السيما في الوجوه مثلهم في التوراة, وليس بمثلهم في الإنجيل, ثم قال عزّ وجلّ : ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ )... الآية, هذا مثلهم في الإنجيل.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ).
حدثني عمرو بن عبد الحميد, قال: ثنا مروان بن معاوية, عن جُويبر, عن الضحاك في قول الله : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ )... الآية, قال: هذا مثلهم في التوراة, ومثل آخر في الإنجيل ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ) الآية.
وقال آخرون: هذان المَثَلان في التوراة والإنجيل مثلهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) والإنجيل واحد.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: مثلهم في التوراة, غير مثَلهم في الإنجيل, وإن الخبر عن مثلهم في التوراة متناه عند قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) وذلك أن القول لو كان كما قال مجاهد من أن مثلهم في التوراة والإنجيل واحد, لكان التنـزيل: ومثلهم في الإنجيل, وكزرع أخرج شطأه, فكان تمثيلهم بالزرع معطوفا على قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) حتى يكون ذلك خبرا عن أن ذلك مَثلهم في التوراة والإنجيل, وفي مجيء الكلام بغير واو في قوله ( كَزَرْعٍ ) دليل بَيِّن على صحة ما قُلْنا, وأن قولهم ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ ) خبر مبتدأ عن صفتهم التي هي في الإنجيل دون ما في التوراة منها.
وبنحو الذي قلنا في قوله ( أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ, قال: ثنا أبي, عن أبيه, عن جدّه, عن الأعمش, عن خيثمة, قال: بينا عبد الله يقرئ رجلا عند غروب الشمس, إذ مرّ بهذه الآية ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: أنتم الزرع, وقد دنا حصادكم.
قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن حُمَيد الطويل, قال: قرأ أنس بن مالك : ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ) قال: تدرون ما شطأه ؟ قال: نباته.
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: سنبله حين يتسلع نباته عن حباته.
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: هذا مثل أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الإنجيل, قيل لهم: إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع, منهم قوم يأمرون بالمعروف, وينهوْن عن المنكر.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة والزهريّ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قالا أخرج نباته.
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) يعني: أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويستغلظون.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) أولاده, ثم كثرت أولاده.
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: ما يخرج بجنب الحقلة فيتمّ وينمي.
وقوله ( فَآزَرَهُ ) يقول: فقوّاه: أي قوى الزرعَ شطأه وأعانه, وهو من الموازرة التي بمعنى المعاونة ( فَاسْتَغْلَظَ ) يقول: فغلظ الزرع ( فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ) والسوق: جمع ساق, وساق الزرع والشجر: حاملته.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( فآزَرَهُ ) يقول: نباته مع التفافه حين يسنبل ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ ) فهو مثل ضربه لأهل الكتاب إذا خرج قوم ينبتون كما ينبت الزرع فيبلغ فيهم رجال يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر, ثم يغلظون, فهم أولئك الذين كانوا معهم. وهو مَثل ضربه الله لمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: بعث الله النبيّ وحده, ثم اجتمع إليه ناس قليل يؤمنون به, ثم يكون القليل كثيرا, ويستغلظون, ويغيظ الله بهم الكفار.
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( فَآزَرَهُ ) قال: فشدّه وأعانه.
وقوله ( عَلَى سُوقِهِ ) قال: أصوله.
حدثني ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة والزهري ( فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ) يقول: فتلاحق.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( فَآزَرَهُ ) اجتمع ذلك فالتفتّ; قال: وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء, فلم يزل الله يزيد فيهم, ويؤيدهم بالإسلام, كما أيَّد هذا الزرع بأولاده, فآزره, فكان مثلا للمؤمنين.
حدثني عمرو بن عبد الحميد, قال: ثنا مروان بن معاوية, عن جُوَيبر, عن الضحاك ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ) يقول: حبّ برّ نثر متفرّقا, فتنبت كلّ حبة واحدة, ثم أنبتت كل واحدة منها, حتى استغلظ فاستوى على سوقه; قال: يقول: كان أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قليلا ثم كثروا, ثم استغلظوا( لِيَغِيظَ ) الله ( بِهِمُ الْكُفَّارَ ).
وقوله ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) يقول تعالى ذكره: يعجب هذا الزرعُ الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحُسن نباته, وبلوغه وانتهائه الذين زرعوه ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) يقول: فكذلك مثل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه, واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا, وغلظ أمرهم كهذا الزرع الذي وصف جلّ ثناؤه صفته, ثم قال ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) فدلّ ذلك على متروك من الكلام, وهو أن الله تعالى فعل ذلك بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه ليغيظ بهم الكفار.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) يقول الله: مثلهم كمثل زرع أخرج شطأه فآزَره, فاستغلظ, فاستوى على سوقه, حتى بلغ أحسن النبات, يُعْجِب الزرّاع من كثرته, وحُسن نباته.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ) قال: يعجب الزرّاع حُسنه ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) بالمؤمنين, لكثرتهم, فهذا مثلهم في الإنجيل.
وقوله ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) يقول تعالى ذكره: وعد الله الذين صدّقوا الله ورسوله ( وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) يقول: وعملوا بما أمرهم الله به من فرائضه التي أوجبها عليهم.
وقوله ( مِنْهُمْ ) يعني: من الشطء الذي أخرجه الزرع, وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذي وصف ربنا تبارك وتعالى صفته. والهاء والميم في قوله ( مِنْهُمْ ) عائد على معنى الشطء لا على لفظه, ولذلك جمع فقيل: " منهم ", ولم يقل " منه ". وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصف الله صفتهم بقوله ( وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ).
وقوله ( وَمَغْفِرَةً ) يعني: عفوا عما مضى من ذنوبهم, وسيئ أعمالهم بحسنها. وقوله ( وَأَجْرًا عَظِيمًا ) يعني: وثوابا جزيلا وذلك الجنة.
آخر تفسير سورة الفتح
المعاني :
التدبر :
وقفة
[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ﴾ هذه هي الحقيقة الأزلية التي لا يزال البعض يجادل ويشكك بها، فإن تيقنوها فهم المفلحون وإن صدوا عنها فهم الخاسرون.
وقفة
[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ﴾ نزلت بعد رفض قريش كتابة ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ﴾ في الصلح فمحاها النبي ﷺ من ورقة، وأثبتها الله في كتابه تتلى إلى يوم القيامة.
وقفة
[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ معه وليس وراءه، القائد الموفق هو الذي يُشعر من حوله بأنهم معه، شركاء في النجاح، ليسوا أتباع فقط.
وقفة
[29] ﴿مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ﴾ لم تُذكر أسماؤهم ولا كنيتهم، فقط يكيفهم شرفًا معية المصطفى ﷺ.
وقفة
[29] ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ كراهية الكفار ليس تشهيًا ولا بغيًا، وإنما هو دين واتباع لسيد الأنام.
وقفة
[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ قال أبو عروة: كنا عند مالك، فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله، فقرأ مالك هذه الآية حتى بلغ: ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾، فقال مالك: «من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ فقد أصابته الآية».
وقفة
[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ رقة قلوبنا على بعضنا تعلمناها من مدرسة محمد.
وقفة
[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ تشرع الرحمة مع المؤمن، والشدة مع الكافر المحارب.
وقفة
[29] ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ لا خير في أخوَّةٍ لا تكون الرحمة جوهرها، ولا خير في أخوَّةٍ لا تكون الرحمة أساس التعامل فيما بينهم.
وقفة
[29] أمران لا تقوى شوكة دولةٍ إلا بهما، إدراك العدو الخارجي، ونزع الخلاف الداخلي ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.
وقفة
[29] أتباع الرسول ﷺ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.
وقفة
[29] من علامة أهل الأهواء: الشدَّة مع المخالفين المؤمنين، واللين مع المخالفين الكافرين ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾.
عمل
[29] ابتسم لزملائك وإخوانك وألق السلام عليهم؛ فهذا من التراحم ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.
وقفة
[29] في الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين -الشدَّةِ والرحمة- إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد؛ فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية.
وقفة
[29] ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ الركب الراكعة والجباه الساجدة بعقيدة صافية تغلب الجيوش الكافرة ولو كانت زاحفة.
وقفة
[29] أول وصف وصف الله به نبيه وأصحابه في هذه الآية: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾، فهل اتصفنا بهذه الصفة ونحن نرى الإساءة إليه منهم.
وقفة
[29] ﴿أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ﴾ تأملوا، تلك أول صفاتهم: الشدة بالعدد والقوة والعدة والكلمة والتصرف، بل هو سمتهم وديدنهم مع الكفار، لذا استحقوا معيته ﷺ.
اسقاط
[29] ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ هكذا يجبُ أن تكونَ، رحيمًا رفيقًا بإخوانِك، وأمَّا الغِلظةُ فلغيرِهم.
وقفة
[29] ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ الجمع بين الشدة والرحمة والبغض والمحبة ووضع كل صفة في موضعها.
وقفة
[29] ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ المجاهدون أرحم الناس بالأمة.
وقفة
[29] ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ أي: جادون ومجتهدون في عداوتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم، ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد؛ يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾.
وقفة
[29] ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً﴾ هكذا بلاغة القرآن فقد بيَّن في جمل يسيرة منهج التعامل مع الخلق مؤمنهم وكافرهم، والتعامل مع الخالق بإخلاص وعلوِّ غاية.
وقفة
[29] ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ المؤمن مهما تكدر صفو علاقته بأخيه؛ يبقى قلبه رحيمًا عليه متمنيًا له الخير.
وقفة
[29] من أحب رسول الله ﷺ وأحب صحابته؛ فليقتدِ بهم في كل شيء، وليس في العقائد فحسب، بل وحتى في السلوك ﴿رحماء بينهم﴾.
وقفة
[29] ﴿رُحماء بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ تأمل: بدأ بالثناء عليهم بأخلاقهم قبل عبادتهم، وهذا تأكيد على أهمية الرحمة وحسن الخلق.
تفاعل
[29] ﴿رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا﴾ قل: «اللهم ارزقنا حسن الخلق».
وقفة
[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ هناك لذة في رؤية: انحناء الراكعين؛ وخضوع الساجدين؛ لأن الروح ترى غذاءها في الركوع والسجود.
وقفة
[29] ﴿تراهم ركعا سجدا﴾ مدحهم الله بأحب مشهد يراهم فيه.
وقفة
[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ الهامات العزيزة لم يخفضوها إلا لله ليرضى عنهم، ومن يبحث عن رضا ربه فسيرضيه الله.
وقفة
[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ الركوع والسجود مغاريف الفضائل والرضوان.
وقفة
[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ الفضل: فضائل الدنيا كل ما تعسر فإنه مع الصلاة يتيسر.
وقفة
[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ فضل الإله الودود تناله بكثرة السجود.
وقفة
[29] ﴿تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا﴾ ما أكرم الوصف، وما أعظم الغاية! ويا سَعد من اقتدى! اللهم ارض عن الصحابة أجمعين.
وقفة
[29] ﴿تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ الركوع والسجود مفاتيح الفضل ورضا الرحمن.
وقفة
[29] ﴿تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ فحياتهم عبادة وسؤالهم زيادة، فلم يبتغوا الأجر فحسب بل سألوا الفضل والرضوان.
وقفة
[29] أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبَّد خوفًا من العذاب: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37]، وأثنى الله تعالى على من تعبد طلبًا: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾.
لمسة
[29] وصف الله الصحابة بقوله: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ولم يقل: (يبتغون أجرًا) ففيه اعتراف منهم بالتقصير، وطمع بالفضل الإلهي الذي لا منتهى ولا حد له، والذي هو أعظم من الأجرة التي يستحقونها على عملهم.
وقفة
[29] طوبى لمن تشبه بما نعت الله به نبيه ﷺ وأصحابه فقال: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ «قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههم حتى استنارت، فلما استنارت بالصلاة بواطنهم، استنارت بالجلال ظواهرهم».
وقفة
[29] الملك يستقبل الوفود، يحبهم ويحبونه ومن عظمته يخشونه ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾، ينير لهم بصائرهم، ويقضي حوائجهم، لنكن من عباد الله الخاشعين ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 11].
عمل
[29] أطل اليوم في الركوع والسجود ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.
وقفة
[29] ﴿ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا﴾ ما عند الله تناله بالطاعة والعبادة.
اسقاط
[29] ﴿يَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا﴾ هذا ما يبتغيه صحبُ محمد ﷺ: رضوان الله عليهم؛ فماذا تبتغى أنت؟
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ القسمات الوسيمة تصنعها الأخلاق الكريمة.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ السيما: العلامة، فأثر الخشوع واضح في نور الوجه وحسن السمت، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص والمداومة والكثرة.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ متى تطيل السجود؟ قال أبو سليمان الداراني: «إذا لذت لك القراءة، فلا تركع ولا تسجد، وإذا لذ لك السجود فلا تركع ولا تقرأ، الأمر الذي يُفتح لك فيه فالزمه».
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ عن بعض السلف: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار».
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الأثر لا يكون إلا إذا كان للشيء تتابع وطول، وكذلك السجود المطمئن الطويل.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الطوية الطاهرة والأفعال الطاهرة لابد وأن تظهر على صفحات وجه صاحبها، فللطاعة نور لا يخفى.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الأثر: أثر الخشوع والهدي والسمت، لا يكون الأثر إلا مع الكثرة والمداومة.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ بقي الأثر مع أن السجود انتهى؛ لأن قلوبهم لا تزال ساجدة.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ» [البخاري 136] بعد هذا أيخيب عبدٌ قضى حياته ما بين وضوء وسجود.
وقفة
[29] ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ قال بعض السلف: «من كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار».
وقفة
[29] ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ يقول ابن القيم: «العبد إذا رُزق حظًّا من صلاة الليل؛ فإنها تُنَوَّرُ الوجه وتُحَسِّنُهُ».
وقفة
[29] ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، ثم استنارت بواطنهم وظواهرهم.
وقفة
[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ أما إنه ليس بالذي ترون, ولكنه سيما الإسلام وسحنته وسمته وخشوعه، إنه شيء لا يمكن وصفه.
وقفة
[29] أثر الأعمال يظهر على الوجوه: ﴿تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر﴾ [الحج: 72]، ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾.
وقفة
[29] من أكثر الأعمال تأثيرًا في نضارة الوجه ونوره: قيام الليل وقراءة القرآن ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.
عمل
[29] إذا رأيت متكبرًا فاعلم أنه قليل الصلاة أو عديمها، لا يجتمع كبر مع كثرة سجود ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾، صح عن مجاهد أنه قال: هو التواضع.
وقفة
[29] ﴿أَثَرِ﴾ الأثر لا يكون إلا إذا كان للشئ تتابع وطول, وكذلك السجود المطمئن الطويل يسبب الأثر في نور الوجه.
وقفة
[29] ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ﴾ الركب المبارك الذي آمن بمحمد وسار بدربه له علامات مميزة، استحقت أن تذكر بكل الكتب السماوية.
وقفة
[29] ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ﴾ مدح الله الصحابة في ثلاثة كتب سماوية، ولم يمنع ذلك أهل البدع من سبهم.
وقفة
[29] ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ قال قتادة: «هذا مثل أصحاب محمد في الإنجيل، قيل لهم: إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، منهم قوم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر».
وقفة
[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ﴾ توحيد الاعتماد والتوكل على الله لا يعني إهدار ما أعطانا سبحانه من دعم إخواننا ومؤازرتهم لنا في المحن.
وقفة
[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ بشارة إلهية، قال ابن عاشور: «وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة مائة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة».
وقفة
[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ نبقى فروعًا نحيلة ذابلة، حتى يمن الله علينا بمؤازرة أحبتنا، فننهض ونستقيم ونستوي.
وقفة
[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه ﷺ.
وقفة
[29] ليس المزارع الحاذق من ينثر الحب في الفلاة؛ ليسقيه المطر أو تذروه الرياح! وإنما هو من يحسن اختيار الحب والتربة والماء، ويتعاهده حتى يؤتي أكله بإذن ربه: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾.
وقفة
[29] ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ إذا أردت تعيش دون أن تغضب أحدًا، وأوقفت حياتك لترضي الكل؛ فأنت مجرد شبح إنسان ليس إلا.
وقفة
[29] ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ﴾ تعليلٌ لما دلَّ عليه تشبيههم بالزرع، من نمائهم وقوَّتهم، كأنه قيل: إنما قوَّاهم وكثَّرهم ليغيظ بهم الكفار.
وقفة
[29] ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: «لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر».
وقفة
[29] ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ من يجد في قلبه كرهًا للصحابة الكرام يُخْشى عليه من الكفر.
وقفة
[29] ﴿وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ وعد بالخير لك على كل عمل صالح تفعله، وكل مسلك رديء تتركه، أن الله لن يجعله يمر دون جائزة.
تفاعل
[29] ﴿وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.
وقفة
[29] لما بُشر النبي ﷺ في أول السورة؛ بشر أصحابه رضي الله عنهم في آخرها ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما﴾.
وقفة
[29] آيتان جمعت حروف المعجم ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم﴾ [آل عمران: 154]، وآخر آية في الفتح، وهناك ثالثة ينقصها حرف الشين، آخر آية في المزمل.
الإعراب :
- ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ: ﴾
- محمد: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو محمد. لتقدم قوله تعالى-هو الذي ارسل رسوله مرفوع بالضمة و «رسول» عطف بيان لمحمد مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. أو يكون «محمد» مبتدأ و رَسُولُ اللهِ» خبره.
- ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ: ﴾
- الواو عاطفة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. معه: ظرف مكان منصوب متعلق بصلة الموصول المحذوفة وهو ظرف يدل على الاجتماع والمصاحبة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. بمعنى: وأصحاب محمد.
- ﴿ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ: ﴾
- خبر «الذين» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن-أفعلاء-على الكفار: جار ومجرور متعلق بأشداء.
- ﴿ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ: ﴾
- خبر ثان للمبتدإ «الذين» يعرب اعراب «أشداء» وهو على وزن «فعلاء» بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق برحماء و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.
- ﴿ تَراهُمْ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل رفع خبر آخر للمبتدإ. أو في محل نصب حال.ترى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.
- ﴿ رُكَّعاً سُجَّداً: ﴾
- حالان منصوبان وعلامة نصبهما الفتحة. أي راكعين ساجدين أي كثيري الركوع والسجود.
- ﴿ يَبْتَغُونَ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى يطلبون.
- ﴿ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بصفة محذوفة من فضلا. ورضوانا:معطوفة بالواو على «فضلا» وتعرب إعرابها
- ﴿ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ: ﴾
- مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. في وجوه: جار ومجرور متعلق بخبر «سيماهم» و «هم» أعربت في «سيماهم» بمعنى: علامتهم والمراد بها: السمة التي تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود.
- ﴿ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بسيماهم أو بحال منه أي حالة كونها من أثر السجود أي من التأثير الذي يؤثره السجود أو تفسير لسيماهم.السجود: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.
- ﴿ ذلِكَ: ﴾
- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. أي ذلك الوصف.
- ﴿ مَثَلُهُمْ: ﴾
- خبر «ذلك» مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.
- ﴿ فِي التَّوْراةِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «مثلهم».
- ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ: ﴾
- معطوفة بالواو على مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ» وتعرب إعرابها بمعنى وصفهم العجيب في الكتابين جميعا.
- ﴿ كَزَرْعٍ: ﴾
- الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم كزرع و «زرع» مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. واذا كان فِي التَّوْراةِ» تمام الكلام تكون الواو في وَمَثَلُهُمْ» استئنافية و «مثلهم» مبتدأ وخبره «كزرع» ويجوز أن تكون «ذلك» اشارة مبهمة أوضحت بقوله كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ» أو تكون الكاف حرف جر للتشبيه والجار والمجرور «كزرع» متعلقا بخبر مبتدأ تقديره: هم كزرع أو في محل رفع خبر مثلهم.
- ﴿ أَخْرَجَ شَطْأَهُ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر صفة-نعت-لزرع: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. شطأه:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: فراخه. وقيل سنابله.
- ﴿ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ: ﴾
- الفاء: حرف عطف للتراخي وما بعدها معطوفان على «أخرج» ويعربان اعرابها والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به بمعنى فقواه من الدقة الى الغلظة.
- ﴿ فَاسْتَوى: ﴾
- معطوفة بالفاء على «استغلظ» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الألف للتعذر.
- ﴿ عَلى سُوقِهِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق باستوى والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. أي فاستقام على قصبه.
- ﴿ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر صفة ثانية لزرع أو في محل نصب حال من الضمير في «سوقه» وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الزراع: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي يعجب الزراع به.
- ﴿ لِيَغِيظَ: ﴾
- اللام حرف جر للتعليل. يغيظ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.وجملة «يغيظ» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب و «ان» المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة ويجوز أن يعلل به وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا» لأن الكفار اذا سمعوا بما أعد لهم في الآخرة غاظهم ذلك
- ﴿ بِهِمُ الْكُفّارَ: ﴾
- الباء حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بيغيظ.الكفار: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة
- ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ آمَنُوا: ﴾
- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
- ﴿ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «آمنوا» وتعرب إعرابها.الصالحات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم وهي صفة لموصوف محذوف التقدير: الأعمال الصالحات فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.
- ﴿ مِنْهُمْ: ﴾
- تعرب اعراب «بهم» والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من «الذين» و «من» حرف جر بياني. أي لبيان جنس المبهم الاسم الموصول بتقدير:حالة كونهم منهم أي الذين هم منهم.
- ﴿ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً: ﴾
- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.وأجرا: معطوفة بالواو على «مغفرة» وتعرب إعرابها. عظيما: صفة-نعت- لأجرا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.'
المتشابهات :
| المائدة: 2 | ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ |
|---|
| الفتح: 29 | ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ |
|---|
| الحشر: 8 | ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [29] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ صِدقَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رُؤياه، واطمَأَنَّت نُفوسُ المُؤمِنينَ؛ أثنى هنا على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى أصحابِه، قال تعالى:
﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
رسول الله:
وقرئ:
1- بالنصب، على المدح، وهى قراءة ابن عامر.
أشداء رحماء:
وقرئا:
ينصبهما، وهى قراءة الحسن.
ورضوان:
وقرئ:
بضم الراء، وهى قراءة عمرو بن عبيد.
سيماهم:
وقرئا:
سيمياهم، بزيادة ياء، والمد، وهى لغة فصيحة.
أثر:
1- بفتح الهمزة والثاء، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بكسر الهمزة وسكون التاء، وهى قراءة ابن هرمز.
شطأه:
1- بإسكان الطاء وهمزة مفتوحة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بفتحهما، وهى قراءة ابن كثير، وابن ذكوان.
3- بفتحهما، وبالمد، وهى قراءة أبى حيوة، وابن أبى عبلة، وعيسى الكوفي.
4- بألف بدل الهمزة، وهى قراءة زيد بن على.
5- شطه، بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء، وهى قراءة أبى جعفر.
6- شطوه، بإسكان الطاء وواوا بعدها، ورويت عن الجحدري أيضا.
فآزره:
وقرئ:
1- فأزره، ثلاثيا، وهى قراءة ابن ذكوان.
2- فآزره، على «أفعله» ، وهى قراءة باقى السبعة.
3- فأزره، بتشديد الزاى.
سوقه:
وقرئ:
سؤقه، بالهمز، وهى قراءة ابن كثير."
مدارسة الآية : [1] :الحجرات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا .. ﴾
التفسير :
هذا متضمن للأدب، مع الله تعالى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له ، واحترامه، وإكرامه، فأمر [الله] عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان، بالله وبرسوله، من امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين، خلف أوامر الله، متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جميع أمورهم، و [أن] لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا، حتى يقول، ولا يأمروا، حتى يأمر، فإن هذا، حقيقة الأدب الواجب، مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته، تفوته السعادة الأبدية، والنعيم السرمدي، وفي هذا، النهي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم، على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب اتباعها، وتقديمها على غيرها، كائنا ما كان
ثم أمر الله بتقواه عمومًا، وهي كما قال طلق بن حبيب:أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله.
وقوله:{ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} أي:لجميع الأصوات في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات،{ عَلِيمٌ} بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحيلات والممكنات
وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والأمر بتقواه- حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة، والآداب المستحسنة، وترهيب عن عدم الامتثال
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدمة وتمهيد
1- سورة «الحجرات» من السور المدنية الخالصة، وعدد آياتها ثماني عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «المجادلة» .
2- والذي يتدبر هذه السورة الكريمة، يراها قد اشتملت على أسمى الآداب، وأبلغ العظات، وأحكم الهدايات، فهي تبدأ بنداء للمؤمنين، تعلمهم فيه ما يجب عليهم نحو خالقهم- سبحانه-، ونحو نبيهم صلّى الله عليه وسلّم من أدب.
قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ..
3- ثم وجهت إليهم نداء ثالثا أمرتهم من خلاله بالتثبت من صحة الأخبار التي تصل إلى مسامعهم، وبينت لهم جانبا من مظاهر فضل الله عليهم.
قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
4- ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عما يجب على المؤمنين نحو إخوانهم في العقيدة، إذا ما دب بينهم نزاع أو قتال، فأمرت بالإصلاح بينهم، وبمقاتلة الفئة الباغية إذا ما أبت الصلح، وأصرت على بغيها..
قال- سبحانه-: وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
5- ثم وجهت بعد ذلك إلى المؤمنين نداء رابعا نهتهم فيه عن أن يسخر بعضهم من بعض،أو أن يلمز بعضهم بعضا. ونداء خامسا أمرتهم فيه باجتناب الظن السيئ بالغير، دون أن يكون هناك مبرر لذلك، ونهتهم عن التجسس وعن الغيبة.
قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ، وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ، وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ، وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.
6- وبعد هذه النداءات المتكررة للمؤمنين، وجهت نداء إلى الناس جميعا، بينت لهم فيه أنهم جميعا قد خلقوا من ذكر وأنثى، وأن أكرمهم عند الله هو أتقاهم وأخشاهم لله- تعالى-.
ثم ردت على الأعراب الذين قالوا آمنا دون أن يستقر الإيمان في قلوبهم ووضحت صفات المؤمنين الصادقين، وأمرت كل مؤمن أن يشكر الله- تعالى- على نعمة الإيمان.
قال- سبحانه-: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ.
7- وهكذا نجد السورة الكريمة قد رسمت للمؤمنين طريق الحياة السعيدة، حيث عرفتهم بما يجب عليهم نحو خالقهم- سبحانه- وبما يجب عليهم نحو نبيهم صلّى الله عليه وسلّم وبما يجب عليهم نحو أنفسهم، وربما يجب عليهم نحو إخوانهم في العقيدة، وبما يجب عليهم نحو أفراد المجتمع الإسلامى بصفة عامة.
وقد وضحت لهم كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر، من شأنه أن يغرس في النفوس الخشوع والطاعة لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
افتتحت سورة «الحجرات» بهذا النداء المحبب إلى القلوب، ألا وهو الوصف بالإيمان، الذي من شأن المتصفين به، أن يمتثلوا لما يأمرهم الله- تعالى- به، ويجتنبوا ما ينهاهم عنه.
افتتحت بقوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
وقوله تُقَدِّمُوا مضارع قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب- بكسر الدال فيهما- وهو اسم فاعل فيهما بمعنى تقدم.
ويصح أن يكون مضارع قدّم المتعدى، تقول: قدمت فلانا على فلان، إذا جعلته متقدما عليه، وحذف المفعول لقصد التعميم.
وقوله: بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تشبيه لمن يتعجل في إصدار حكم من أحكام الدين بغير استناد إلى حكم الله ورسوله، بحالة من يتقدم بين يدي سيده أو رئيسه، بأن يسير أمامه في الطريق، أو على يمينه أو شماله. وحقيقة الجلوس بين يدي الشخص: أن يجلس بين الجهتين المقابلتين ليمينه أو شماله قريبا منه أو أمامه.
قال الجمل قوله: بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جرت هذه العبارة هنا على سنن من المجاز، وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلا، أى: استعارة تمثيلية، شبّه تعجل الصحابة في إقدامهم على قطع الحكم في أمر من أمور الدين، بغير إذن الله ورسوله، بحالة من تقدم بين يدي متبوعه إذا سار في طريق، فإنه في العادة مستهجن.. والغرض تصوير كمال الهجنة، وتقبيح قطع الحكم بغير إذن الله ورسوله.
أو المراد: بين يدي رسول الله، وذكر لفظ الجلالة على سبيل التعظيم للرسول صلّى الله عليه وسلّم وإشعار بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله .
والمعنى: يا من آمنتم بالله- تعالى- حق الإيمان: احذروا أن تتسرعوا في الأحكام، فتقولوا قولا، أو تفعلوا فعلا يتعلق بأمر ديني، دون أن تستندوا في ذلك إلى الله- تعالى- وحكم رسوله صلّى الله عليه وسلّم وَاتَّقُوا اللَّهَ- تعالى- في كل ما تأتون وتذرون، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بجميع أحوالكم.
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: هذه آداب أدب الله- تعالى- بها عباده المؤمنين، فيما يعاملون به الرسول صلّى الله عليه وسلّم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام.
فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
أى: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه. أى: قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي، حديث معاذ، إذ قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى» .
فالغرض منه أنه أخّر رأيه ونظره واجتهاده، إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله .
وقال الإمام القرطبي ما ملخصه: قوله: لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أى:
لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله، وقول رسوله وفعله، فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا..
واختلف في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال منها:
ما ذكره الواحدي من حديث ابن جريج قال: حدثني ابن أبى مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بنى تميم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمّر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر: يا رسول الله، أمّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر ما أردت خلافك، فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه الآية.
وقال قتادة: إن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فيّ كذا، فنزلت هذه الآية.
وقال الحسن: نزلت في قوم ذبحوا أضحيتهم قبل أن يصلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأمرهم أن يعيدوا الذبح . وعلى أية حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمقصود من الآية الكريمة نهى المؤمنين في كل زمان ومكان عن أن يقولوا قولا أو يفعلوا فعلا يتعلق بأمر شرعي، دون أن يعودوا فيه إلى حكم الله ورسوله.
تفسير سورة الحجرات وهي مدنية .
هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام ، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [ واتقوا الله ] ) ، أي : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه ، أي : قبله ، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور ، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ ، [ إذ ] قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه إلى اليمن : " بم تحكم ؟ " قال : بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد ؟ " قال : بسنة رسول الله . قال : " فإن لم تجد ؟ " قال : أجتهد رأيي ، فضرب في صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ، لما يرضي رسول الله " .
وقد رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه . فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله .
قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة .
وقال العوفي عنه : نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه .
وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء ، حتى يقضي الله على لسانه .
وقال الضحاك : لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم .
وقال سفيان الثوري : ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) بقول ولا فعل .
وقال الحسن البصري : ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) قال : لا تدعوا قبل الإمام .
وقال قتادة : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا كذا ، وكذا لو صنع كذا ، فكره الله ذلك ، وتقدم فيه .
( واتقوا الله ) أي : فيما أمركم به ، ( إن الله سميع ) أي : لأقوالكم ) عليم ) بنياتكم .
القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)
يعني تعالى ذكره بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) : يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية الله, وبنبوّة نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم, قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله, فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله, محكيّ عن العرب فلان يقدّم بين يدي إمامه, بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله ( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) يقول: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, في قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )... الآية قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه.
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) قال: لا تفتاتوا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه.
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) ذُكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنـزل في كذا لوضع كذا وكذا, قال: فكره الله عزّ وجلّ ذلك, وقدم فيه.
وقال الحسن: أناس من المسلمين ذبحوا قبل صلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يوم النحر, فأمرهم نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يعيدوا ذبحا آخر.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) قال: إن أُناسا كانوا يقولون: لو أنـزل في كذا, لو أنـزل في كذا, وقال الحسن: هم قوم نحروا قبل أن يصلي النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فأمرهم النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يعيدوا الذبح.
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) يعني بذلك في القتال, وكان (1) من أمورهم لا يصلح أن يقضى إلا بأمره ما كان من شرائع دينهم.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله جلّ ثناؤه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) قال: لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله.
وحدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن سفيان ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) قال: لا تقضوا أمرا دون رسول الله, وبضم التاء من قوله ( لا تُقَدِّمُوا ) قرأ قرّاء الأمصار, وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها, لإجماع الحجة من القرّاء عليها, وقد حكي عن العرب قدّمت في كذا, وتقدّمت في كذا, فعلى هذه اللغة لو كان قيل: ( لا تَقَدَّمُوا ) بفتح التاء (2) كان جائزا.
وقوله ( وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) يقول: وخافوا الله أيها الذين آمنوا في قولكم, أن تقولوا ما لم يأذن لكم به الله ولا رسوله, وفي غير ذلك من أموركم, وراقبوه, إن الله سميع لما تقولون, عليم بما تريدون بقولكم إذا قلتم, لا يخفى عليه شيء من ضمائر صدوركم, وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم.
------------------------
الهوامش:
(1) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : وكل ما كان ... الخ .
(2) والدال مشددة وهي قراءة مشهورة ليعقوب الحضرمي .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] سورة الحجرات وليس لها اسم غيره، ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الحجرات، ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صل الله عليه وسلم من وراء حجراته.
وقفة
[1] افتتحت سورة الحجرات بالنداء للمؤمنين، واختتمت بنداء الناس، فالمؤمن الذي تربَّى في مدرسة سورة الحجرات يتقي الله في تعامله مع كل الناس.
وقفة
[1] سورة الحجرات إحدى 3 سور افتتحت بنداء المؤمنين في القرآن، مع سورة المائدة والممتحنة، وكلها في أخلاقيات المؤمن.
وقفة
[1] ﴿يا أيها الذينَ آمنوا﴾ ذُكِر في السورة خمس مرات، والمخاطبون فيها المؤمنون، والمخاطَبُ به أمرٌ، أو نهيٌ، وذُكر فيها: ﴿يا أيُّها النَّاسُ﴾ مرَّة، والمخاطبون فيها يعمُّ المؤمنين والكافرين.
وقفة
[1] ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ تصدير السورة بنداء الإيمان يشعرك بدفئ الخطاب مع من أخطأ في حضرة المصطفى.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ لما أثنى الله على أصحاب رسوله في خاتمة سورة الفتح؛ جعل سورة الحجرات في تكميل إيمانهم وتأديبهم، فبدأ بالأدب مع الله، ثم مع رسوله، ثم مع المؤمنين، سواء من حضر منهم، ومن غاب، ومن تلبس بفسق.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ ابن القيم: «وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟!».
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ ﺃﺻﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﻬﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
عمل
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ اتبع الشرع في كل شئ.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ من أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله؛ ففيه نوعٌ من التقدم بين يدي الله ورسوله.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ يحتج بهذه الآية في تقديم النص على القياس.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ يحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء.
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال السعدي: «وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول ﷺ على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله ﷺ وجب اتباعها، وتقديمها على غيرها، كائنًا ما كان».
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال الرازي: «واعلم أن بقدر تقديمك للنبي ﷺ على نفسك في الدنيا، يكون تقديم النبي ﷺ إياك في العقبى».
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ والبدع من التقدم بين يدي الله ورسوله بجميع أنواعها العقدية القولية والفعلية، بل هي أشد التقدم، فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات، مما يدعي أنه شرع، كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل، وأنه كملها بما أتى به من البدعة، ويدخل في ذلك دخولًا أوليًّا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
وقفة
[1] ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ نداء الإيمان فيه إشارة أن الالتزام بما خوطب به المكلف هو من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان بحسب المخالفة.
وقفة
[1] ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ ﺃﺻﻞﻛﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
وقفة
[1] المؤمن لا يُقدم على حكم حتى يعلم حكم الله ورسوله ﷺ فيه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾.
وقفة
[1] ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ والتقدم حقيقته: المشي قبل الغير، قال تعالى عن فرعون: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: 98].
وقفة
[1] ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ قال ابن كثير: «هذه آداب، أدَّب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ﷺ من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام».
وقفة
[1] ﴿واتقوا الله﴾ هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته، ومعنى (واتقوا الله) أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي تقربًا إلى الله.
وقفة
[1] ﴿إن الله سميع عليم﴾ لا يخفى عليه شيء، وإن تحيل الناس لإبطال الحقوق بوجوه الحيل، وجاروا بأنواع الجور فالله سميع، عيلم بفعلهم.
وقفة
[1] ﴿إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ﴾ خاتمة الآية الكريمة باسمى الله عز وجل: السميع والعليم، فلهما دلالة قوية، فهو سبحانه سميع بكل ما تتلفظون به فى سركم وجهركم، وعليم أيضًا جل شأنه بنواياكم.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ: ﴾
- اداة نداء. أي: منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب. و «ها» زائدة للتنبيه. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع عطف بيان لاي او بدل منها على اللفظ وفي محل نصب على الموضع
- ﴿ آمَنُوا: ﴾
- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.
- ﴿ لا تُقَدِّمُوا: ﴾
- ناهية جازمة. تقدموا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة وحذف المفعول اي امرا او على معنى لا تقدموا على التلبس بهذا الفعل.
- ﴿ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ: ﴾
- ظرف مكان منصوب متعلق بتقدموا وهو مضاف. يدي:مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لأنه مثنى وحذفت النون للاضافة. الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة.والتعبير من ضروب المجاز يقال جلس فلان بين يدي فلان اي جلس من جهتي يمينه وشماله اي قريبا منه
- ﴿ وَرَسُولِهِ: ﴾
- الواو عاطفة. رسوله: مجرور بالاضافة أي بين يدي رسوله والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
- ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ: ﴾
- الواو عاطفة. اتقوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة.
- ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «إنّ» منصوب للتعظيم بالفتحة. سميع عليم: خبرا «إنّ» مرفوعان بالضمة او يكون «عليم» صفة لسميع أي سميع لما تقولون عليم بما تعملون.'
المتشابهات :
| المائدة: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ |
|---|
| الحجرات: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ |
|---|
| الممتحنة: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إبْراهِيمَ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ العُكْبَرِيُّ بِها، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، قالَ: حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أخْبَرَهُ، أنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ أبُو بَكْرٍ: أمِّرِ القَعْقاعَ بْنَ مَعْبَدٍ. وقالَ عُمَرُ: بَلْ أمِّرِ الأقْرَعَ بْنَ حابِسٍ. فَقالَ أبُو بَكْرٍ: ما أرَدْتَ إلّا خِلافِي. وقالَ عُمَرُ: ما أرَدْتُ خِلافَكَ. فَتَمارَيا حَتّى ارْتَفَعَتْ أصْواتُهُما، فَنَزَلَتْ في ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورَسُولِهِ﴾ . إلى قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ولَوْ أنَّهم صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [الحجرات: ٥] .رَواهُ البُخارِيُّ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بنهي المؤمنينَ أنْ يَتقدَّموا بيْنَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه بقولٍ أو فِعلٍ (النداء الأول)، قال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ولَمَّا نَهَى؛ أمَرَ بالتَّقْوى؛ لأنَّ مِن التَّقوى اجتِنابَ المنْهيِّ عنه، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لا تقدموا:
1- وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بشد التاء، على إدغام تاء المضارعة فى التاء بعدها، وهى قراءة بعض المكيين.
3- مضارع «قدم» ، بكسر الدال، من «القدوم» .
مدارسة الآية : [2] :الحجرات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا .. ﴾
التفسير :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ} وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خطابه، أي:لا يرفع المخاطب له، صوته معه، فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت، ويخاطبه بأدب ولين، وتعظيم وتكريم، وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزوه في خطابهم، كما تميز عن غيره، في وجوب حقه على الأمة، ووجوب الإيمان به، والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك، محذورًا، وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه، من أسباب [حصول الثواب و] قبول الأعمال.
ثم وجه- سبحانه- نداء ثانيا إلى المؤمنين، أكد فيه وجوب احترامهم للرسول صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.
قال الآلوسى: هذه الآية شروع في النهى عن التجاوز في كيفية القول عند النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد النهى عن التجاوز في نفس القول والفعل. وإعادة النداء مع قرب العهد به، للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه، والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه .
أى: يا من آمنتم بالله واليوم الآخر.. واظبوا على توقيركم واحترامكم لرسولكم صلّى الله عليه وسلّم ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته عند مخاطبتكم له. ولا تجعلوا أصواتكم مساوية لصوته صلّى الله عليه وسلّم حين الكلام معه، ولا تنادوه باسمه مجردا بأن تقولوا له يا محمد، ولكن قولوا له: يا رسول الله، أو يا نبي الله.
والكاف في قوله: كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ في محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف أى: ولا تجهروا له بالقول جهرا مثل جهر بعضكم لبعض.
قال القرطبي: وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا، حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفته، أعنى الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم، وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة، وجلالة مقدارها، وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها .
وقوله- سبحانه-: أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ بيان لما يترتب على رفع الصوت عند مخاطبته صلّى الله عليه وسلّم من خسران.
والجملة تعليل لما قبلها، وهي في محل نصب على أنها مفعول لأجله. أى: نهاكم الله- تعالى- عن رفع أصواتكم فوق صوت النبي، وعن أن تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كراهة أو خشية أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك، وأنتم لا تشعرون بهذا البطلان.
قال ابن كثير: وقوله: أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده صلّى الله عليه وسلّم خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره، كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره .
ولقد امتثل الصحابة لهذه الإرشادات امتثالا تاما، فهذا أبو بكر يروى عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخى السرار- أى: كالذي يتكلم همسا. وهذا ثابت بن قيس، كان رفيع الصوت، فلما نزلت هذه الآية قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنا من أهل النار، حبط عملي، وجلس في أهل بيته حزبنا ... فلما بلغ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما قاله ثابت، قال لأصحابه: «لا. بل هو من أهل الجنة» .
قال بعض العلماء: وما تضمنته هذه الآية من لزوم توقير النبي صلّى الله عليه وسلّم جاء مبينا في آيات أخرى، منها قوله تعالى-: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً.
وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله- تعالى- لم يخاطبه في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم كقوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ. يا أَيُّهَا الرَّسُولُ. يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.
مع أنه- سبحانه- قد نادى غيره من الأنبياء بأسمائهم، كقوله- تعالى-: وَقُلْنا يا آدَمُ. وقوله- عز وجل-: وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا.
أما النبي صلّى الله عليه وسلّم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما ذكر في غير ذلك، كقوله- تعالى- وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .
وقوله : ( ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - [ فوق صوته ] . وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما .
وقال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي ، حدثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا ، أبو بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، رفعا أصواتهما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم عليه ركب بني تميم ، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع ، وأشار الآخر برجل آخر - قال نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي . قال : ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك ، فأنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) الآية ، قال ابن الزبير : فما كان عمر يسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية حتى يستفهمه ، ولم يذكر ذلك عن أبيه : يعني أبا بكر رضي الله عنه . انفرد به دون مسلم .
ثم قال البخاري : حدثنا حسن بن محمد ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، حدثني ابن أبي مليكة : أن عبد الله بن الزبير أخبره : أنه قدم ركب من بني تميم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلى - أو : إلا - خلافي . فقال عمر : ما أردت خلافك ، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ، فنزلت في ذلك : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) ، حتى انقضت الآية ، ( ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ) الآية [ الحجرات : 5 ] .
وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا .
وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا الفضل بن سهل ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا حصين بن عمر ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي بكر الصديق قال : لما نزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) ، قلت : يا رسول الله ، والله لا أكلمك إلا كأخي السرار .
حصين بن عمر هذا - وإن كان ضعيفا - لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف ، وأبي هريرة [ رضي الله عنه ] بنحو ذلك ، والله أعلم .
وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا أزهر بن سعد ، أخبرنا ابن عون ، أنبأني موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتقد ثابت بن قيس ، فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أعلم لك علمه . فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه ، فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد حبط عمله ، فهو من أهل النار . فأتى الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه قال كذا وكذا ، قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : " اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار ، ولكنك من أهل الجنة " تفرد به البخاري من هذا الوجه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) إلى : ( وأنتم لا تشعرون ) ، وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبط عملي ، أنا من أهل النار ، وجلس في أهله حزينا ، ففقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجهر له بالقول حبط عملي ، أنا من أهل النار . فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه بما قال ، فقال : " لا بل هو من أهل الجنة " . قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ، ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف ، فجاء ثابت بن قيس بن شماس ، وقد تحنط ولبس كفنه ، فقال : بئسما تعودون أقرانكم . فقاتلهم حتى قتل .
وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : لما نزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) إلى آخر الآية ، جلس ثابت في بيته ، قال : أنا من أهل النار . واحتبس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاذ : " يا أبا عمرو ، ما شأن ثابت ؟ أشتكى ؟ " فقال سعد : إنه لجاري ، وما علمت له بشكوى . قال : فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ثابت : أنزلت هذه الآية ، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا من أهل النار . فذكر ذلك سعد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بل هو من أهل الجنة " .
ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي ، عن حيان بن هلال ، عن سليمان بن المغيرة ، به ، قال : ولم يذكر سعد بن معاذ . وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس بنحوه . وقال : ليس فيه ذكر سعد بن معاذ .
حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، سمعت أبي يذكر عن ثابت ، عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية ، واقتص الحديث ، ولم يذكر سعد بن معاذ ، وزاد : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة . .
فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة ، فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ . والصحيح : أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا ; لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس ، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم ، والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة ، والله أعلم .
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس ، حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس ، عن أبيه قال : لما نزلت هذه الآية : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ) قال : قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي ، قال : فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان ، فقال : ما يبكيك يا ثابت ؟ قال : هذه الآية ، أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت ، رفيع الصوت . قال : فمضى عاصم بن عدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وغلبه البكاء ، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي ابن سلول فقال لها : إذا دخلت بيت فرسي فشدي علي الضبة بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه ، وقال : لا أخرج حتى يتوفاني الله عز وجل ، أو يرضى عني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : وأتى عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبره ، فقال : " اذهب فادعه لي " . فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده ، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس ، فقال له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوك . فقال : اكسر الضبة . قال : فخرجا فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما يبكيك يا ثابت ؟ " . فقال : أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ) . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما ترضى أن تعيش حميدا ، وتقتل شهيدا ، وتدخل الجنة ؟ " . فقال : رضيت ببشرى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا أرفع صوتي أبدا على صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره ، كما كان يكره في حياته ; لأنه محترم حيا وفي قبره ، صلوات الله وسلامه عليه ، دائما . ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه ، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ; ولهذا قال : ( ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) ، كما قال : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) [ النور : 63 ] .
وقوله : ( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) أي : إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك ، فيغضب الله لغضبه ، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري ، كما جاء في الصحيح : " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض " .
ثم ندب الله عز وجل ، إلى خفض الصوت عنده ، وحث على ذلك ، وأرشد إليه ، ورغب فيه ، فقال : ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أي : أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) .
وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين ، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها ، أفضل ، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها ؟ فكتب عمر ، رضي الله عنه : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ) . قال : وأنزل الله : ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) .
وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك ، فقد نهى الله عز وجل ، عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ارتفعت أصواتهما ، فجاء ، فقال : أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا . وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره ، كما كان يكره في حياته ; لأنه محترم حيا وفي قبره ، صلوات الله وسلامه عليه ، دائما . ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه ، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ; ولهذا قال : ( ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) ، كما قال : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) [ النور : 63 ] .
وقوله : ( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) أي : إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك ، فيغضب الله لغضبه ، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري ، كما جاء في الصحيح : " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض " .
القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2)
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله تتجهموه بالكلام, وتغلظون له في الخطاب ( وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ) يقول: ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا: يا محمد, يا محمد, يا نبيّ الله, يا نبيّ الله, يا رسول الله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ) , قال لا تنادُوه نداء, ولكن قولا لينًا يا رسول الله.
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ) كانوا يجهرون له بالكلام, ويرفعون أصواتهم, فوعظهم الله, ونهاهم عن ذلك.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, كانوا يرفعون, ويجهرون عند النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فوعظوا, ونهوا عن ذلك.
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ )... الآية, هو كقوله : لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا وأمرهم أن يشرّفوه ويعظِّموه, ويدعوه إذا دعوه باسم النبوّة.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا زيد بن حباب, قال: ثنا أبو ثابت بن ثابت قيس بن الشماس, قال: ثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن شماس, عن أبيه, قال: لما نـزلت هذه الآية ( لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ) قال: قعد ثابت في الطريق يبكي, قال: فمرّ به عاصم بن عديّ من بني العَجلان, فقال: ما يُبكيك يا ثابت؟ قال: لهذه الآية, أتخوّف أن تكون نـزلت فيّ, وأنا صيت رفيع الصوت قال: فمضى عاصم بن عديّ إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, قال: وغلبه البكاء, قال: فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أَبيّ ابن سلول, فقال لها: إذا دخلتُ بيت فرسي, فشدّي على الضبة بمسمار, فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله, أو يرضى عني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم; قال: وأتى عاصم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخبره خبره, فقال: اذْهَبْ فادْعُهُ لي، فجاء عاصم إلى المكان, فلم يجده, فجاء إلى أهله, فوجده في بيت الفرس, فقال له: إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يدعوك, فقال: اكسر الضَّبة, قال: فخرجا فأتيا نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما يُبكِيكَ يا ثابِتُ ؟ فقال: أنا صيت, وأتخوّف أن تكون هذه الآية نـزلت فيّ( لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ) فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أما تَرْضَى أنْ تَعيش حَمِيدًا, وَتُقْتَلَ شَهِيدًا, وَتَدْخُلَ الجَنَّةَ ؟ فقال: رضيت ببُشرى الله ورسوله, لا أرفع صوتي أبدا على رسول الله, فأنـزل الله إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ... الآية.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يعقوب, عن حفص, عن شمر بن عطية, قال: جاء ثابت بن قيس بن الشماس إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو محزون, فقال: يا ثابت ما الذي أرى بك ؟ فقال: آية قرأتها الليلة, فأخشى أن يكون قد حَبِط عملي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) وكان في أُذنه صمم, فقال: يا نبيّ الله أخشى أن أكون قد رفعت صوتي, وجهرت لك بالقول, وأن أكون قد حبط عملي, وأنا لا أشعر: فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " امْشِ على الأرْضِ نَشِيطا فإنَّكَ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ ".
حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, قال: ثنا أيوب, عن عكرِمة, قال: لما نـزلت ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ )... الآية, قال ثابت بن قيس: فأنا كنت أرفع صوتي فوق صوت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, وأجهر له بالقول, فأنا من أهل النار, فقعد في بيته, فتفقده رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, وسأل عنه, فقال رجل: إنه لجاري, ولئن شئت لأعلمنّ لك علمه, فقال: نعم, فأتاه فقال: إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد تفقدك, وسأل عنك, فقال: نـزلت هذه الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ )... الآية وأنا كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, وأجهر له بالقول, فأنا من أهل النار, فرجع إلى رسول الله فأخبره, فقال: بَلْ هُوَ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ; فلما كان يوم اليمامة انهزم الناس, فقال: أفّ لهؤلاء وما يعبدون, وأفّ لهؤلاء وما يصنعون, يا معشر الأنصار خلوا لي بشيء لعلي أصلى بحرّها ساعة قال: ورجل قائم على ثلمة, فقَتل وقُتل.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزُّهريّ, أن ثابت بن قيس بن شماس, قال: لما نـزلت ( لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) قال: يا نبيّ الله, لقد خشيت أن أكون قد هلكت, نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك, وإني امرؤ جهير الصوت, ونهى الله المرء أن يحبّ أن يُحمد بما لم يفعل, فأجدني أحبّ أن أُحمد; ونهى الله عن الخُيَلاء وأجدني أحبّ الجمال; قال: فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا ثابت أما تَرْضَى أنْ تَعِيشَ حَمِيدًا, وَتُقْتَلَ شَهِيدًا, وَتَدْخُلَ الجَنَّةَ ؟ فعاش حميدا, وقُتل شهيدا يوم مُسَيلمة.
حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي, قال: ثني ابن أَبي مليكة, عن الزبير, قال: " قدم وفد أراه قال تميم, على النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, منهم الأقرع بن حابس, فكلم أبو بكر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يستعمله على قومه, قال: فقال عمر: لا تفعل يا رسول الله, قال: فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما عند النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, قال: فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي, قال: ما أردت خلافك. قال: ونـزل القرآن ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ )... إلى قوله وَأَجْرٌ عَظِيمٌ قال: فما حدّث عمر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد ذلك, فَيُسْمِعَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, قال: وما ذكر ابن الزبير جدّه, يعني أبا بكر.
وقوله ( أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ) يقول: أن لا تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا ثواب لكم عليها, ولا جزاء برفعكم أصواتكم فوق صوت نبيكم, وجهركم له بالقول كجهر بعضكم لبعض.
وقد اختلف أهل العربية في معنى ذلك, فقال بعض نحويي الكوفة: معناه: لا تحبط أعمالكم. قال: وفيه الجزم والرفع إذا وضعت " لا " مكان " أن ". قال: وهي في قراءة عبد الله ( فَتَحْبَطْ أَعْمَالُكُمْ ) وهو دليل على جواز الجزم, وقال بعض نحويي البصرة: قال: أن تحبط أعمالكم: أي مخافة أن تحبط أعمالكم وقد يقال: أسند الحائط أن يميل.
وقوله ( وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ) يقول: وأنتم لا تعلمون ولا تدرون.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا، أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ، قَالَ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُ اسْمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلاَفِي، قَالَ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الآيَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ» [البخاري 4845]، حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ أي: حتى يستفهمه رسولُ الله عدة مرات.
وقفة
[2] تأمل انقياد الصحابة بعدما نزل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾.
وقفة
[2] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ: «أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ اشْتَكَى؟»، قَالَ سَعْدٌ: «إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى»، فَأَتَاهُ سَعْدٌ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ثَابِتٌ: «أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» [مسلم 119].
وقفة
[2] لنا في ثَابِت بن قَيْس قدوة، حين نزلت الآيات أدرك أنه المقصود بالنهي، وذلك لتدبره الآيات، إما خيرًا تؤمر به، أو شرًّا تنهى عنه.
اسقاط
[2] كيف حالي وحالك بعد توجيه القرآن لسلوكياتنا الخاطئة؟!
وقفة
[2] فائدةُ ذكرِ: ﴿وَلَا تَجْهرُوا لهُ بالقَوْلِ﴾ بعد قوله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أصواتكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَبِيِّ﴾ النهيُ عن الجهرِ في مخاطبتِهِ، وإنْ لم يتضمَّنْ رفع أصواتِهم على صوته، وقيلَ: المراد النهيُ عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه.
وقفة
[2] قد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام، وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفًا لهم؛ إذ هم ورثة الأنبياء.
وقفة
[2] للنبي ﷺ منزلة عظيمة، فيجب على المسلم أن يتأدب حين يذكر اسمه، فيصلي عليه.
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفتهم على ما جاء به ورفعها عليه؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطًا لأعمالهم؟!
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر.
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ إن كلمة واحدة من سوء الأدب مع الله، أو مع رسوله ﷺ، قد تحرق رصيد العبد الإيماني كله.
وقفة
[2] ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ فيها أن الأدب مع أهل الفضل من العلماء والأتقياء والمربين والحكماء الذين وقفوا حياتهم لخدمة الدين -تعليمًا ودعوة- يقتضي التوقير والاحترام، سواء في معاملتهم أو في طرق أبوابهم، ومراعاة أوقاتهم؛ لما في ذلك من مصلحة عامة للمسلمين.
وقفة
[2] ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ وجوب التأدب مع رسول الله ﷺ، ومع سُنَّته، ومع ورثته العلماء.
وقفة
[2] ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ وحرمة النبي ﷺ ميتًا كحرمته حيًّا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه، وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به.
وقفة
[2] ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ ويدخل في ذلك: احترام وتوقير أهل العلم والديانة اتباع النبي ﷺ، من وقفوا حياتهم خدمة للسنة وأهلها.
وقفة
[2] ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ ومن رفع الأصوات فوق صوت النبي أن نُذكَّر بسنة من سنن النبي ﷺ، فنقول: «هذه لا تصلح لعصرنا»، هذا ونردُّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول برأينا وأهوائنا.
وقفة
[2] قال ابن عقيل الحنبلي: «ما أخوفني أن أساكن معصية، فتكون سببًا في حبوط عملي وسقوط منزلتي -إن كانت لي- عند الله تعالى، بعدما سمعت قوله تعالى: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، فإن هذا يدل على أن في بعض التسبب وسوء الأدب على الشريعة ما يحبط الأعمال، ولا يشعر العامل إلا أنه عصيان ينتهي إلى رتبة الإحباط»، وقد علق ابن مفلح قائلًا: «وهذا يجعل الفطن خائفًا وجلًا من الإقدام على المآثم، وخوفًا أن يكون تحتها من العقوبة ما يماثل هذه».
وقفة
[2] أركان الأخلاق: 1- حفظ المراتب: كحفظ مرتبة النبي ﷺ: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾. 2- مراعاة العواقب: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [5]. 3- تحري المناقب وتجنب المثالب: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [11].
وقفة
[2] خاف كبار الصحابة من حبوط العمل حين نزلت: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، وتجد اﻵن من يرفع صوته فوق صوت السنة كلها، وهو متكئ على أريكته، بل وكيف بمن يسخر من هديه وسنته مباشرة؟!
وقفة
[2] كان السلف إذا قرأ حديث النبي ﷺ أمرهم بالسكوت وقال: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، وينصت لسماع قوله.
وقفة
[2] الاعتراض بالرأي على السنة المحكمة داخل في قوله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾.
وقفة
[2] ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ ذكر العلماء بكراهية رفع الصوت عند قبره؛ فوجوب احترامه في حياته وبعد مماته.
وقفة
[2] ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ بعد هذه الآية لا أشك في حنينك الجارف إذا طافت بمسمعك همسات الصحابة المؤدبة: «يا رسول الله» بصوتهم المنخفض، وحبهم الصادق له، مجتمع تربيته الوحي، ما أحلاه!
وقفة
[2] ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم﴾ عبادات سنين بصيامها وقيامها وصدقاتها تتلاشى لرفع صوت، فكيف بترفُّع قلب؟!
وقفة
[2] ﴿ولا تجهروا له بالقول ... أن تحبط أعمالكم﴾ رفع الصوت عند النبي محبط للعمل؛ فكيف بالتفجير والقتل.
تفاعل
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ ادعُ الله الآن أن يتقبل منك أعمالك.
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ آيةٌ تهزُّ كيانَ المؤمنِ، محبطاتُ الأعمالِ قد لا يعلمُها الإنسانُ.
عمل
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ احذروا تسريبات الأعمال الخفية، الفحص المبكر -للنية والمتابعة- خير أمان وضمان لاستبقائها.
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ كم من مسرور بعمله، وهو عند الله هباءً منثورًا!
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ وهم صحابة ﻻ يشعرون بها؛ مخيف! محبطات الأعمال قد لا يعلمها الإنسان.
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ نزلت في أبي بكر وعمر وهما المبشران بالجنة، فكيف بمن سواهما؟!
وقفة
[2] ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي هذا إثم يخشى أن يحبط العمل، فكلمة واحدة من سوء الأدب مع الله أو مع رسوله قد تحرق إيمان العبد كله.
عمل
[2] ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون﴾ رب معصية لا تلقي لها بالًا يكون فيها هلاكك وأنت لا تشعر؛ فاحذر.
عمل
[2] ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ كن دقيقًا في كلماتك، وحركاتك، وسكناتك، ثمة أعمال لا تشعر بها قد تفني حسنات تعبت في تحصيلها.
عمل
[2] ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ انتبه، احفظ إيمانك وعملك من الضياع والحبوط، فقد كثرت أسبابه، وتنوعت مسوغاته؛ أخطرها الاعتداء على الشعائر، واستنقاص الشرائع، والنيل من كليات الدين، والتكبر على أصوله.
وقفة
[2] آية تهز كيان المؤمن، ويلجأ إلى الله أن يعصمه، ويحفظ عمله ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا: ﴾
- اعربت في الآية الكريمة السابقة.
- ﴿ أَصْواتَكُمْ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور اي اخفضوها وانتم في حضرته تأدبا.
- ﴿ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ: ﴾
- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بترفعوا وهو مضاف. صوت: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. النبي: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة
- ﴿ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ: ﴾
- معطوفة بالواو على لا تَرْفَعُوا» وتعرب اعرابها. له: جار ومجرور متعلق بتجهروا بمعنى عليه. بالقول: جار ومجرور في مقام مفعول «تجهروا» الذي تعدى اليه بالباء بمعنى ولا تظهروا له القول او بمعنى لا تقولوا له يا محمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة.
- ﴿ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ: ﴾
- الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب بمعنى «مثل» او حرف جر للتشبيه والجار والمجرور متعلق بصفة لمفعول مطلق-مصدر-محذوف بتقدير جهرا مثل جهر بعضكم لبعض او جهرا كجهر بعضكم. بعض: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والكاف والميم اعربتا في «اصواتكم»، لبعض: جار ومجرور متعلق بالمصدر «جهر» بمعنى لا تخاطبوه مخاطبة مثل مخاطبة بعضكم لبعض.
- ﴿ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ: ﴾
- حرف مصدري ناصب. تحبط: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة أي بمعنى «لئلا تحبط اعمالكم» اعمال:فاعل مرفوع بالضمة. و «كم» اعربت في «اصواتكم» وجملة تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «أن» المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول له-لاجله-على تقدير حذف مضاف اي كراهة حبوط اعمالكم بمعنى: بطلانها. وهو متعلق بمعنى النهي اي انتهوا عما نهيتم عنه لحبوط اعمالكم اي كراهة حبوطها لخشية حبوطها او يتعلق بنفس الفعل بمعنى انهم نهوا عن الفعل لاجل الحبوط.
- ﴿ وَأَنْتُمْ: ﴾
- الواو حالية والجملة الاسمية بعدها في محل نصب حال. أنتم: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
- ﴿ لا تَشْعُرُونَ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «أنتم».لا: نافية لا عمل لها. تشعرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وحذف مفعولها اختصارا لأنه معلوم أي وأنتم لا تشعرون أن أعمالكم قد بطلت.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ نَزَلَتْ في ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، كانَ في أُذُنِهِ وقْرٌ، وكانَ جَهْوَرِيَّ الصَّوْتِ، فَكانَ إذا كَلَّمَ إنْسانًا جَهَرَ بِصَوْتِهِ، فَرُبَّما كانَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَتَأذّى بِصَوْتِهِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ.أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المُزَكِّي، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو القاسِمِ البَغَوِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا ثابِتٌ، عَنْ أنَسٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لا تَرْفَعُوا أصْواتَكم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ . قالَ ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ: أنا الَّذِي كُنْتُ أرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وأنا مِن أهْلِ النّارِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: ”هو مِن أهْلِ الجَنَّةِ“ .رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ قَطَنِ بْنِ نُسَيْرٍ. وقالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: كادَ الخَيِّرانِ أنْ يَهْلِكا؛ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، رَفَعا أصْواتَهُما عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأشارَ أحَدُهُما بِالأقْرَعِ بْنِ حابِسٍ، وأشارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ، فَقالَ أبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: ما أرَدْتَ إلّا خِلافِي. وقالَ عُمَرُ: ما أرَدْتُ خِلافَكَ. وارْتَفَعَتْ أصْواتُهُما في ذَلِكَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى في ذَلِكَ: ﴿لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ﴾ .وقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَما كانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَلامَهُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ حَتّى يَسْتَفْهِمَهُ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن نهى اللهُ المؤمنينَ عن التقدُّمِ بَيَّنَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه؛ نهاهم هنا عن أنْ يُعْلوا أصْواتَهم فوقَ صَوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعن أنْ تكونَ مُناداتُهم له باسمِه كما يكونُ النِّداءُ بيْنَهم بَعضِهم لبعضٍ (النداء الثاني)، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :الحجرات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ .. ﴾
التفسير :
ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي:ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك، بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم، المتضمنة لزوال الشر والمكروه، والأجر العظيم، الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفي الأجر العظيم وجود المحبوبوفي هذا، دليل على أن الله يمتحن القلوب، بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله، واتبع رضاه، وسارع إلى ذلك، وقدمه على هواه، تمحض وتمحص للتقوى، وصار قلبه صالحًا لها ومن لم يكن كذلك، علم أنه لا يصلح للتقوى.
ثم مدح- سبحانه- الذين يغضون أصواتهم في حضرة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
وقوله: يَغُضُّونَ بمعنى يخفضون. يقال: غض فلان من صوته ومن طرفه إذا خفضه. وكل شيء كففته عن غيره فقد غضضته.
وقوله: امْتَحَنَ أى: اختبر وأخلص، وأصله من امتحان الذهب وإذابته ليخلص جيده من خبيثة، والمراد به هنا: إخلاص القلوب لمراقبة الله وتقواه.
أى: إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعند مخاطبتهم له.
أولئك الذين يفعلون ذلك، هم الذين أخلص الله- تعالى- قلوبهم لتقواه وطاعته، وجعلها خالصة من أى شيء سوى هذه الخشية والطاعة.
قال صاحب الكشاف: «امتحن الله قلوبهم للتقوى» من قولك: امتحن فلان لأمر كذا وجرب له، ودرب للنهوض به، فهو مضطلع به غير وان عنه، والمعنى: أنهم صبروا على التقوى، أقوياء على احتمال مشاقها. أو وضع الامتحان موضع المعرفة، لأن تحقق الشيء باختباره، كما يوضع الخبر موضعها، فكأنه قيل: عرف الله قلوبهم للتقوى .
وقوله: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بشارة عظيمة من الله- تعالى- لهم. أى: لهؤلاء الغاضين أصواتهم عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مغفرة لذنوبهم، وأجر كبير لا يعرف مقداره أحد سوى الله- تعالى-.
ولقد التزم المسلمون بهذا الأدب في حياة النبي صلّى الله عليه وسلّم وبعد مماته، فقد سمع عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- رجلا يرفع صوته في المسجد النبوي: فقال له: من أين أنت- أيها الرجل-؟ فقال: من الطائف، فقال له: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا.
ثم ندب الله عز وجل ، إلى خفض الصوت عنده ، وحث على ذلك ، وأرشد إليه ، ورغب فيه ، فقال : ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أي : أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) .
وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين ، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها ، أفضل ، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها ؟ فكتب عمر ، رضي الله عنه : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ) .
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3)
يقول تعالى ذكره: إن الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول الله, وأصل الغضّ: الكفّ في لين. ومنه: غضّ البصر, وهو كفه عن النظر, كما قال جرير:
فَغُــضَّ الطَّـرْفَ إنَّـكَ مِـنْ نُمَـيْر
فَــلا كَعْبــا بَلَغــتَ وَلا كِلابــا (3)
وقوله ( أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله, هم الذين اختبر الله قلوبهم بامتحانه إياها, فاصطفاها وأخلصها للتقوى, يعني لاتقائه بأداء طاعته, واجتناب معاصيه, كما يمتحن الذهب بالنار, فيخلص جيدها, ويبطل خبثها (4) .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ) قال: أخلص.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ) قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ.
وقوله ( لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ) يقول: لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة, وصفح منه عنها لهم ( وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ) يقول: وثواب جزيل, وهو الجنة.
------------------------
الهوامش:
(3) البيت لجرير بن الخطفي ، من قصيدة يهجو بها الراعي النميري الشاعر . ( ديوانه 64 ) يقول له . غض نظرك أي كف بصرك ذلا ومهانة . وهذا موضع الشاهد عند قوله تعالى " يغضون أصواتهم عند رسول الله " وهو من ذلك . قال في " اللسان : غض " : وغض طرفه وبصره ، يغضه غضا وغضاضا ( ككتاب ) وغضاضة ( كسحابة ) فهو مغضوض وغضيض " كفه وخفضه وكسره ، وقيل : هو إذا دانى بين جفونه ونظر . وقيل : الغضيض : الطرف المسترخي الأجفان . وفي الحديث " كان إذا فرح غض طرفه " ، أي كسره وأطرق ، ولم يفتح عينيه . وإنما كان يفعل ذلك ، ليكون أبعد من الأشر والمرح . أ هـ . وكعب وكلاب : حيان من تميم .
(4) الضمير في جيدها وخبثها : راجع إلى الذهب ، لأنها مؤنثة ، وقد تذكر .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم﴾ الغض حقيقته: خفض العين، أي أن لا يُحدق بها إلى الشخص، وهو هنا مستعار لِخفض الصوت والميلِ به إلى الإسرار.
وقفة
[3] ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّـهِ﴾ جاء الغض للبصر وللصوت وهو القصر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور، واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور، هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه، وهذا ترجمانه».
وقفة
[3] ما في القلب من الإيمان والتقوى له أثر حتى على حبال الصوت، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّـهِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾.
وقفة
[3] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّـهِ ... لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ مغفرة وأجر عظيم لمن غض صوته، كيف بمن اتبعه وذبَّ عنه.
وقفة
[3] تعظيم النبي سبب لغفران الذنوب وعلامة للتقوى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّـهِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.
وقفة
[3] هل تخيلتم يومًا أن يكون اختباركم فى مدى انخفاض صوتكم؟ وهل تعرضتم لهكذا اختبار من قبل؟ ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلوبَهُم لِلتَّقوى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيمٌ﴾.
وقفة
[3] غضك لصوتك واتهامك لرأيك في معارضة النص الشرعي دليل نجاحك في امتحان تسليم قلبك لوحي ربك، تأمل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أولئك الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ للتقوى ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.
وقفة
[3] ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ الامتحان: التجربة والاختبار، أي مرَّن الله قلوبهم للتقوى، وهي كناية عن صبرهم على التقوى وثباتهم عليها.
وقفة
[3] امتحان الإيمان أن يتمكَّن الإنسان من حرام يشتهيه فيتركه لله، قال الله: ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.
وقفة
[3] قال ابن رجب: «إنَّ الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾، وما أقلّهم في هذا الزمان!».
وقفة
[3] ﴿امْتَحَنَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ تمر على قلبك امتحانات، هل يصلح لنور التقوى أم لا؟
وقفة
[3] ﴿امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ ستمر على قلبك امتحانات؛ لأن نور التقوى عزيز.
وقفة
[3] ﴿امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ إيمانك وتقواك تهذيب لك.
وقفة
[3] ﴿امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ ابحث عن تقواك فى قلبك.
وقفة
[3] ﴿امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ كم مرة امتحن الله قلبي وقلبك؟ ليست العبرة بكم، ولكن العبرة بكيف اجتزنا الامتحان؟!
وقفة
[3] ﴿امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ لا تنزل التقوى في القلب إلا بعد امتحانه، فعلى قدر نجاحه تكون عمارته.
تفاعل
[3] ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ادعُ الله الآن أن يغفر لك.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «إنّ».
- ﴿ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ: ﴾
- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. اصوات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى يخفضون أصواتهم.
- ﴿ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ: ﴾
- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيغضون وهو مضاف. رسول: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.
- ﴿ أُولئِكَ الَّذِينَ: ﴾
- اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر والجملة الاسمية أُولئِكَ الَّذِينَ» في محل رفع خبر «ان» او تكون «الذين» خبر مبتدأ محذوف تقديره «هم» والجملة الاسمية «هم الذين» في محل رفع خبر «أولئك» او تكون «الذين» بدلا من «اولئك» والخبر. الجملة الاسمية لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ».
- ﴿ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ: ﴾
- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. امتحن: فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. قلوب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.و«هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة
- ﴿ لِلتَّقْوى: ﴾
- جار ومجرور متعلق بمحذوف بتقدير: عرف الله ان قلوبهم اهل للتقوى او متعلق بمبتدإ محذوف خبره بتقدير هم صبر على التقوى او هم للتقوى اي كائنين لها ومختصين بها وهي ومعمولها في محل نصب حال او يتعلق الجار والمجرور بمفعول له-لاجله-بمعنى ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لاجل التقوى اي لتثبت وتظهر تقواها ويعلم انهم متقون لان حقيقة التقوى لا تعلم الا عند المحن والشدائد. وقيل على معنى هم اخلصهم للتقوى وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة على الالف للتعذر.
- ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ: ﴾
- اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. مغفرة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة والجملة متضمنة جواب-جزاء-الشرط لان «الذين» تتضمنه.
- ﴿ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ: ﴾
- معطوفة بالواو على «مغفرة» وتعرب مثلها. عظيم: صفة -نعت-لاجر مرفوعة بالضمة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أصْواتَهم عِندَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ قالَ عَطاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ﴾ [الحجرات: ٢] . تَألّى أبُو بَكْرٍ ألّا يُكَلِّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلّا كَأخِي السِّرارِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى في أبِي بَكْرٍ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أصْواتَهم عِندَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ .أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ القاضِي، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، قالَ: حَدَّثَنا حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ الأحْمَسِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا مُخارِقٌ، عَنْ طارِقٍ، عَنْ أبِي بَكْرٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ عَلى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أصْواتَهم عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهم لِلتَّقْوى﴾ . قالَ أبُو بَكْرٍ: فَآلَيْتُ عَلى نَفْسِي ألّا أُكَلِّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلّا كَأخِي السِّرارِ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا نهى اللهُ عن رفعِ الصَّوتِ أمامَه صلى الله عليه وسلم، وعدم الجَهرِ؛ مَدَحَ هنا من خفضَ صَوتَه عنده صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الحجرات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء .. ﴾
التفسير :
نزلت هذه الآيات الكريمة، في أناس من الأعراب، الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه:يا محمد يا محمد، [أي:اخرج إلينا]، فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب.
ثم أشار- سبحانه- إلى ما فعله بعض الناس من رفع أصواتهم عند ندائهم للنبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ، أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
وقد ذكروا في سبب نزول هاتين الآيتين أن جماعة من بنى تميم أتوا إلى المدينة في عام الوفود في السنة التاسعة، فوقفوا بالقرب من منزل النبي صلّى الله عليه وسلّم في ساعة القيلولة وأخذوا يقولون: يا محمد اخرج إلينا.. فكره النبي صلّى الله عليه وسلّم منهم ذلك.
والمراد بالحجرات: حجرات نسائه صلّى الله عليه وسلّم جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة، أى: المحددة بحدود لا يجوز تخطيها، ويمنع الدخول فيها إلا بإذن.
أى: إن الذين ينادونك- أيها الرسول الكريم- مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ.
أى: خلف حجرات أزواجك وخارجها، أكثرهم لا يجرون على ما تقتضيه العقول السليمة، والآداب القويمة من مراعاة الاحترام والتوقير لمن يخاطبونه من الناس، فضلا عن أفضلهم، وأشرفهم، وذلك لأنهم من الأعراب الذين لم يحسنوا مخاطبة الناس، لجفائهم وغلظ طباعهم.
وقال- سبحانه- أَكْثَرُهُمْ للإشعار بأن قلة منهم لم تشارك هذه الكثرة في هذا النداء الخارج عن حدود الأدب واللياقة.
قال صاحب الكشاف ما ملخصه: وورود الآية على النمط الذي وردت عليه، فيه ما لا يخفى على الناظر من إكبار للنبي صلّى الله عليه وسلّم وإجلال لمقامه.
ومن ذلك: مجيئها على النظم سجل على الصائحين به السفه والجهل بسبب ما أقدموا عليه. ومن ذلك: التعبير بلفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه، والمرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي يظهر به موضع الاستنكار عليهم.
ومن ذلك: شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم، وقلة ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات، تهوينا للخطب، وتسلية له صلّى الله عليه وسلّم
ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات ، وهي بيوت نسائه ، كما يصنع أجلاف الأعراب ، فقال : ( أكثرهم لا يعقلون )
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إن الذين ينادونك يا محمد من وراء حجراتك, والحجرات: جمع حجرة, والثلاث: حُجَر, ثم تجمع الحجر فيقال: حجرات وحُجْرات, وقد تجمع بعض العرب الحجر: حجَرات بفتح الجيم, وكذلك كلّ جمع كان من ثلاثة إلى عشرة على فُعَلٍ يجمعونه على فعَلات بفتح ثانيه, والرفع أفصح وأجود; ومنه قول الشاعر:
أمــا كــانَ عَبَّــادٌ كَفِيئـا لِـدَارِم
بَــلى, وَلأبْيــاتٍ بِهـا الحُجُـرَات (5)
يقول: بلى ولبني هاشم.
وذُكر أن هذه الآية والتي بعدها نـزلت في قوم من الأعراب جاءوا ينادون رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا.
* ذكر الرواية بذلك:
حدثنا أبو عمار المروزي, والحسن بن الحارث, قالا ثنا الفضل بن موسى, عن الحسين بن واقد, عن أبي إسحاق, عن البرّاء في قوله ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ) قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فقال: يا محمد إنّ حمدي زين, وإن ذمِّي شين, فقال: " ذَاكَ اللّهُ تَباركَ وتَعَالى ".
حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا الحسين, عن أبي إسحاق, عن البراء بمثله, إلا أنه قال: ذاكم الله عزّ وجلّ.
حدثنا الحسن بن عرفة, قال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي, قال: سمعت داود الطُّفاوي يقول: سمعت أبا مسلم البجلي يحدث عن زيد بن أرقم, قال: جاء أناس من العرب إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل, فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به, وإن يكن ملِكا نعش في جناحه; قال: فأتيت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فأخبرته بذلك, قال: ثم جاءوا إلى حجر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فجعلوا ينادونه. يا محمد, فأنـزل الله على نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) قال: فأخذ نبيّ الله بأذني فمدّها, فجعل يقول: " قَدْ صَدَّقَ اللّهُ قَوْلَكَ يا زَيْدُ, قَدْ صَدَّقَ اللّهُ قَوْلَكَ يا زَيْدُ".
حدثنا الحسن بن أبي يحيى المقدمي, قال: ثنا عفان, قال: ثنا وُهَيب, قال: ثنا موسى بن عقبة, عن أبي سَلَمة, قال: ثني الأقرع بن حابس التميميّ أنه أتى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فناداه, فقال: يا محمد إن مدحي زين, وإن شتمي شين; فخرج إليه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: وَيْلَكَ ذَلِكَ اللّهُ، فأنـزل الله ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ )... الآية.
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ) : أعراب بني تميم.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة " أن رجلا جاء إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فناداه من وراء الحُجَر, فقال: يا محمد إنّ مدحي زين, وإنّ شتمي شَيْن; فخرج إليه النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فقال: وَيْلَكَ ذلكَ اللّهُ، فأنـزل الله ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ).
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة قوله ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ )... الآية, ذُكر لنا أن رجلا جعل ينادي يا نبيّ الله يا محمد, فخرج إليه النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فقال: ما شأنُكَ ؟ فقال: والله إنّ حمده لزين, وإنّ ذمَّه لَشَيْن, فقال نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ذَاكُمُ اللّهُ , فأدبر الرجل, وذُكر لنا أن الرجل كان شاعرا.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن حبيب بن أبي عمرة, قال: كان بشر بن غالب ولَبيد بن عُطارد, أو بشر بن عُطارد ولبيد بن غالب, وهما عند الحجاج جالسان, يقول بشر بن غالب للبيد بن عطارد نـزلت في قومك بني تميم ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ) فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير, فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية, أجابه يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قالوا: أسلمنا, ولم يقاتلك بنو أسد.
حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن المبارك بن فضالة, عن الحسن, قال: " أتى أعرابيّ إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من وراء حجراته, فقال: يا محمد, يا محمد; فخرج إليه النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: مالك ؟ مالك؟, فقال: تعلم إنّ مدحي لزين, وإن ذمِّي لشين, فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ذَاكُمُ اللّهُ, فنـزلت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ .
واختلفت القرّاء في قراءة قوله ( مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ) فقرأته قرّاء الأمصار بضمّ الحاء والجيم من الحُجُرات, سوى أبي جعفر القارئ, فإنه قرأ بضم الحاء وفتح الجيم على ما وصفت من جمع الحُجرة حُجَر, ثم جمع الحُجْر: حُجُرات ".
والصواب من القراءة عندنا الضم في الحرفين كليهما لما وصفت قبل.
وقوله ( أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) يقول: أكثرهم جهال بدين الله, واللازم لهم من حقك وتعظيمك.
------------------------
الهوامش:
(5) في كتاب الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي 85 ) : يقال : فلان كفاء فلان ، وكفيء فلان ، وكفء فلان ؛ أي : عديله. ويروى أن الفرزدق بلغه أن رجلا من الحبطات بن عمرو بن تميم خطب امرأة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، فقال الفرزدق :
بَنُــو دَارِمٍ أكْفــاؤُهُمْ آلُ مِسْــمَعٍ
وتنكــح فــي أكفائهـا الحَبِطـاتُ
( آل مسمع بيت بكر بن وائل في الإسلام ، وهم من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة ) قال : فقال رجل من الحبطات : " أما كان عباد كفيئا ... " البيت . يعني بني هاشم ( يريد أبيات بني هاشم ) من قول الله عز وجل : " إن الذين ينادونك من وراء الحجرات " . والشاهد في البيت قوله " الحجرات " بضم الحاء والجيم ، وهي جمع حجرة ، وتجمع الحجرة وما شابهها على حجرات بضمتين ، وبضم ففتح ، وبضم فسكون . ويرى المؤلف أن الجمع الأول أفصح وأجود . أ هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ العقل قرين الأدب.
وقفة
[4] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أدبُ العبدِ عنوانُ عقلِه، وأن الله مريد به خيرًا، فمن العقل وعلامته استعمال الأدب.
وقفة
[4] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ذو الأدب الجم صاحب عقل وافر، وقلة الأدب دليل نقص العقل.
وقفة
[4] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير.
تفاعل
[4] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ قل: «اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني سيئها لا يجنبني سيئها إلا أنت».
وقفة
[4] ﴿إِنَّ الَّذينَ يُنادونَكَ مِن وَراءِ الحُجُراتِ أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ﴾ ختمت الآية الكريمة بوصفهم بأنهم لا يعقلون، فالعاقل هو الذى يراعى اللياقة فى تصرفه مع الآخرين وبالأخص الأعلى منه مكانة، أما السفيه الغير مقدر للأمر وكيف يتعامل مع غيره يعد من غير العاقلين، والله أعلم.
وقفة
[4] درس في الإنصاف: ﴿إنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾، تأمل كلهم نادى، لكن ليس كلهم: ﴿لا يعقلون﴾.
وقفة
[4] ﴿ينادونك من وراء الحجرات﴾ الحجرات بخلاف الغرف، (الحجرة): مكان محجور في سفل وليس في علو، و(الغرفة) ما كانت في عُليَّة البناء، ولذلك فمنازل الجنة غرف: ﴿لهم غرف من فوقها غرف مبنية﴾ [الزمر: 20].
وقفة
[4] ﴿ينادونك من وراء الحجرات﴾ هذه حجرات النبي، وليست قصورًا، وليست بنايات، وظاهر اللفظ مع نقل السنة يدل على صغرها، فأين المتهالكون في توسعة البيوت في غير حاجة، وأين من يفني ماله بين الفينة والفينة في تجديد الأثاث؟!
وقفة
[2-4] لاحظ التدرج في مجلس واحد في ٣ آيات: أدَّب ووجه: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾، مدح: ﴿إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله﴾، ذم: ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ: ﴾
- اعربت في الآية الكريمة السابقة وضمير المخاطب الكاف في محل نصب مفعول به.
- ﴿ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بينادون. الحجرات: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة و «من» حرف جر لابتداء الغاية وان المناداة نشأت من وراء حجرات الرسول الكريم.
- ﴿ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ: ﴾
- الجملة الاسمية في محل رفع خبر «إن».أكثر: مبتدأ مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. لا: نافية لا عمل لها. يعقلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة لا يَعْقِلُونَ» في محل رفع خبر «أكثرهم» وحذف مفعولها اختصارا بمعنى لا يدركون قبح عملهم هذا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ المَخْلَدِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ الدَّقّاقُ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى العَتَكِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ، قالَ: حَدَّثَنا داوُدُ الطُّفاوِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو مُسْلِمٍ البَجَلِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أرْقَمَ يَقُولُ: أتى ناسٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَجَعَلُوا يُنادُونَهُ وهو في حُجْرَةٍ: يا مُحَمَّدُ، يا مُحَمَّدُ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِن وراءِ الحُجُراتِ أكْثَرُهم لا يَعْقِلُونَ﴾ .وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ وغَيْرُهُ: نَزَلَتْ في جُفاةِ بَنِي تَمِيمٍ، قَدِمَ وفْدٌ مِنهم عَلى النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلُوا المَسْجِدَ فَنادَوُا النَّبِيَّ ﷺ مِن وراءِ حُجْرَتِهِ أنِ اخْرُجْ إلَيْنا يا مُحَمَّدُ؛ فَإنَّ مَدْحَنا زَيْنٌ، وإنَّ ذَمَّنا شَيْنٌ. فَآذى ذَلِكَ مِن صِياحِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ، فَقالُوا: إنّا جِئْناكَ يا مُحَمَّدُ نُفاخِرُكَ. ونَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِن وراءِ الحُجُراتِ أكْثَرُهم لا يَعْقِلُونَ﴾ . وكانَ فِيهِمُ الأقْرَعُ بْنُ حابِسٍ، وعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، والزِّبْرِقانُ بْنُ بَدْرٍ، وقَيْسُ بْنُ عاصِمٍ.وكانَتْ قِصَّةُ هَذِهِ المُفاخَرَةِ عَلى ما أخْبَرَناهُ أبُو إسْحاقَ أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، قالَ: أخْبَرَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ السَّدُوسِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ صالِحِ بْنِ هانِئٍ، قالَ: حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قالَ: حَدَّثَنا القاسِمُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنا مُعَلّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: جاءَ بَنُو تَمِيمٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَنادَوْا عَلى البابِ: يا مُحَمَّدُ، اخْرُجْ إلَيْنا فَإنَّ مَدْحَنا زَيْنٌ، وإنَّ ذَمَّنا شَيْنٌ. فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ وهو يَقُولُ: ”إنَّما ذَلِكُمُ اللَّهُ الَّذِي مَدْحُهُ زَيْنٌ، وذَمُّهُ شَيْنٌ“ . فَقالُوا: نَحْنُ ناسٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ، جِئْنا بِشاعِرِنا وخَطِيبِنا نُشاعِرُكَ ونُفاخِرُكَ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”ما بِالشِّعْرِ بُعِثْتُ، ولا بِالفَخارِ أُمِرْتُ، ولَكِنْ هاتُوا“ . فَقالَ الزِّبْرِقانُ بْنُ بَدْرٍ لِشابٍّ مِن شُبّانِهِمْ: قُمْ فاذْكُرْ فَضْلَكَ وفَضْلَ قَوْمِكَ. فَقامَ فَقالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنا خَيْرَ خَلْقِهِ، وآتانا أمْوالًا نَفْعَلُ فِيها ما نَشاءُ، فَنَحْنُ مِن خَيْرِ أهْلِ الأرْضِ، ومِن أكْثَرِهِمْ عُدَّةً ومالًا وسِلاحًا، فَمَن أنْكَرَ عَلَيْنا قَوْلَنا فَلْيَأْتِ بِقَوْلٍ هو أحْسَنُ مِن قَوْلِنا، وفِعالٍ هو خَيْرٌ مِن فِعالِنا. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ: ”قُمْ فَأجِبْهُ“ . فَقامَ فَقالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ أحْمَدُهُ وأسْتَعِينُهُ، وأُومِنُ بِهِ وأتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وأشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، دَعا المُهاجِرِينَ مِن بَنِي عَمِّهِ - أحْسَنِ النّاسِ وُجُوهًا، وأعْظَمِهِمْ أحْلامًا - فَأجابُوهُ، فالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنا أنْصارَهُ، ووُزَراءَ رَسُولِهِ، وعِزًّا لِدِينِهِ، فَنَحْنُ نُقاتِلُ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فَمَن قالَها مَنَعَ مِنّا نَفْسَهُ ومالَهُ، ومَن أباها قَتَلْناهُ، وكانَ رُغْمُهُ مِنَ اللَّهِ تَعالى عَلَيْنا هَيِّنًا، أقُولُ قَوْلِي هَذا وأسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ. فَقالَ الزِّبْرِقانُ بْنُ بَدْرٍ لِشابٍّ مِن شُبّانِهِمْ: قُمْ يا فُلانُ فَقُلْ أبْياتًا تَذْكُرُ فِيها فَضْلَكَ وفَضْلَ قَوْمِكَ. فَقامَ الشّابُّ فَقالَ:نَحْنُ الكِرامُ فَلا حَيٌّ يُعادِلُنافِينا الرُّءُوسُ وفِينا يُقْسَمُ الرُّبُعُونُطْعِمُ النّاسَ عِنْدَ القَحْطِ كُلَّهُمُمِنَ السَّدِيفِ إذا لَمْ يُؤْنَسِ القَزَعُإذا أبَيْنا فَلا يَأْبى لَنا أحَدٌإنّا كَذَلِكَ عِنْدَ الفَخْرِ نَرْتَفِعُقالَ: فَأرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى حَسّانَ بْنِ ثابِتٍ، فانْطَلَقَ إلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقالَ: وما يُرِيدُ مِنِّي وقَدْ كُنْتُ عِنْدَهُ ؟ قالَ: جاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ بِشاعِرِهِمْ وخَطِيبِهِمْ، فَأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَأجابَهم، وتَكَلَّمَ شاعِرُهم فَأرْسَلَ إلَيْكَ تُجِيبُهُ. فَجاءَ حَسّانُ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُجِيبَهُ، فَقالَ حَسّانُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْهُ فَلْيُسْمِعْنِي ما قالَ. فَأنْشَدَهُ ما قالَ، فَقالَ حَسّانُ عِنْدَ ذَلِكَ:نَصَرْنا رَسُولَ اللَّهِ والدِّينَ عَنْوَةًعَلى رَغْمِ بادٍ مِن مَعَدٍّ وحاضِرِألَسْنا نَخُوضُ المَوْتَ في حَوْمَةِ الوَغىإذا طابَ وِرْدُ المَوْتِ بَيْنَ العَساكِرِونَضْرِبُ هامَ الدّارِعِينَ ونَنْتَمِيإلى حَسَبٍ مِن جِذْمِ غَسّانَ قاهِرِفَلَوْلا حَياءُ اللَّهِ قُلْنا تَكَرُّمًاعَلى النّاسِ بِالخَيْفَيْنِ: هَلْ مِن مُنافِرِفَأحْياؤُنا مِن خَيْرِ مَن وطِئَ الحَصىوأمْواتُنا مِن خَيْرِ أهْلِ المَقابِرِقالَ: فَقامَ الأقْرَعُ بْنُ حابِسٍ فَقالَ: إنِّي واللَّهِ لَقَدْ جِئْتُ لِأمْرٍ ما جاءَ لَهُ هَؤُلاءِ، وقَدْ قُلْتُ شِعْرًا فاسْمَعْهُ. فَقالَ: ”هاتِ“ . فَقالَ:أتَيْناكَ كَيْما يَعْرِفُ النّاسُ فَضْلَناإذا فاخَرُونا عِنْدَ ذِكْرِ المَكارِمِوإنّا رُءُوسُ النّاسِ مِن كُلِّ مَعْشَرٍوأنْ لَيْسَ في أرْضِ الحِجازِ كَدارِمِوإنَّ لَنا المِرْباعَ في كُلِّ غارَةٍتَكُونُ بِنَجْدٍ أوْ بِأرْضِ التَّهائِمِفَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”قُمْ يا حَسّانُ فَأجِبْهُ“ . فَقامَ حَسّانُ فَقالَ:بَنِي دارِمٍ لا تَفْخَرُوا إنَّ فَخْرَكُمْيَعُودُ وبالًا عِنْدَ ذِكْرِ المَكارِمِهَبِلْتُمْ، عَلَيْنا تَفْخَرُونَ وأنْتُمُلَنا خَوَلٌ مِن بَيْنِ ظِئْرٍ وخادِمِوأفْضَلُ ما نِلْتُمْ مِنَ المَجْدِ والعُلىرِدافَتُنا مِن بَعْدِ ذِكْرِ الأكارِمِفَإنْ كُنْتُمُ جِئْتُمْ لِحَقْنِ دِمائِكُمْوأمْوالِكم أنْ تُقْسَمُوا في المَقاسِمِفَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا وأسْلِمُواولا تَفْخَرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ بِدارِمِوإلّا ورَبِّ البَيْتِ مالَتْ أكُفُّناعَلى هامِكم بِالمُرَهَفاتِ الصَّوارِمِقالَ: فَقامَ الأقْرَعُ بْنُ حابِسٍ فَقالَ: إنَّ مُحَمَّدًا لَمُؤْتًى لَهُ، واللَّهِ ما أدْرِي ما هَذا الأمْرُ، تَكَلَّمَ خَطِيبُنا فَكانَ خَطِيبُهم أحْسَنَ قَوْلًا، وتَكَلَّمَ شاعِرُنا فَكانَ شاعِرُهم أشْعَرَ. ثُمَّ دَنا مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وأنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”ما يَضُرُّكَ ما كانَ قَبْلَ هَذا“ . ثُمَّ أعْطاهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وكَساهم، وارْتَفَعَتِ الأصْواتُ، وكَثُرَ اللَّغَطُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآياتِ: ﴿لا تَرْفَعُوا أصْواتَكم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢] . إلى قَوْلِهِ: ﴿وأجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٣] . '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن نهى اللهُ عن رفعِ الصَّوتِ أمامَه صلى الله عليه وسلم، وذكَرَ وصْفَ المُطيعِ؛ أتْبَعَ ذلك -على سَبيلِ النَّتيجةِ- وصْفَ مَن أخَلَّ بذلك، قال تعالى:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
الحجرات:
1- بضم الجيم، اتباعا للضمة قبلها، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بفتحها، وهى قراءة أبى جعفر، وشيبة.
3- بإسكانها، وهى قراءة ابن أبى عبلة.