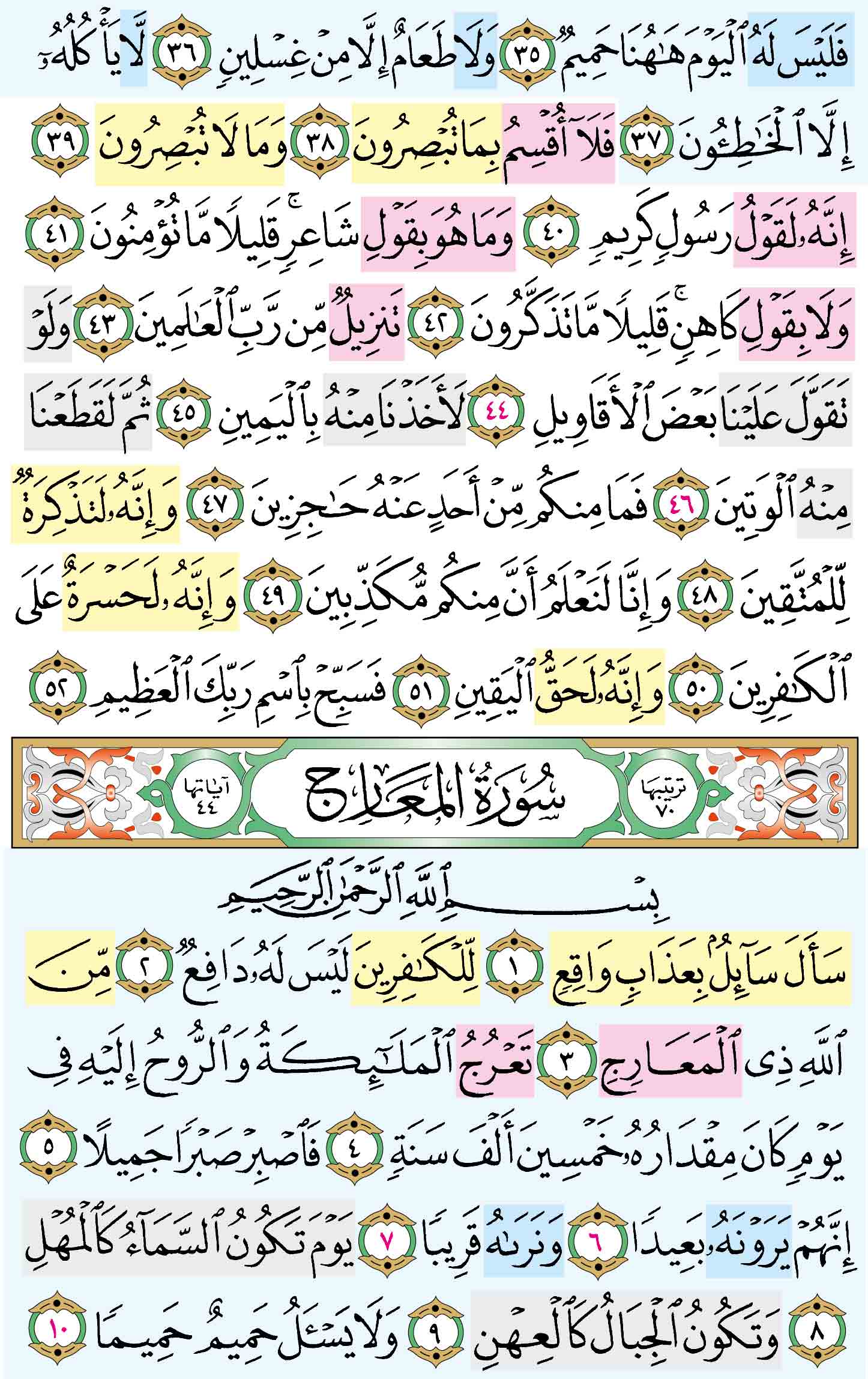
الإحصائيات
سورة الحاقة
| ترتيب المصحف | 69 | ترتيب النزول | 78 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.00 |
| عدد الآيات | 52 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.75 |
| ترتيب الطول | 63 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الجمل الخبرية: 13/21 | _ | ||
سورة المعارج
| ترتيب المصحف | 70 | ترتيب النزول | 79 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.70 |
| عدد الآيات | 44 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.65 |
| ترتيب الطول | 70 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الجمل الخبرية: 14/21 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (38) الى الآية رقم (52) عدد الآيات (15)
ختامُ السُّورةِ بالقَسَمِ على صِدقِ القرآنِ، وأنَّه كلامُ اللهِ المُنزَلُ على رسولِه ﷺ، وأنَّهُ ليس بقولِ شاعرٍ ولا كاهِنٍ، ولو أنَّ مُحَمَّدًا ﷺ تَقَوَّلَ على اللهِ لانْتَقَمَ منه، وأنَّ القرآنَ موعظةٌ للمتقينَ وحسرةٌ على الكافرين.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)
طلبُ كُفَّارِ مَكَّةَ تعجيلَ العذابِ استهزاءً، وهو واقعٌ بهم لا محالةَ، ثُمَّ عرضُ مشاهدَ من يومِ القيامةِ، =
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الحاقة
التذكير بيوم القيامة
أولاً : التمهيد للسورة :
- • الحاقة: • اسم من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيه يظهر الحق الكامل، وتُحَقُّ الأمور، أي تُعَرف فيه الأمور على حقيقتها، ويصير كل إنسان حقيقًا بجزاء عمله، فيها يتخاصم الناس ويدَّعي كل إنسانٍ الحق لنفسه، كما أن القيامة أحقت لأقوامٍ الجنة وأحقت لأقوامٍ النار. • استشعر هول العرض على الجبار: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (18). • استشعر موقف تطاير الصحف: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ ٱقْرَؤُاْ كِتَـٰبيَهْ * إِنّى ظَنَنتُ أَنّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ * فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ...﴾ (19-22). • أرأيت فرحته؟! أسمعت نداء الفوز والفلاح منه؟! فلماذا لا تكون مثله؟! • وفي المقابل: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَـٰبِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ * يٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَىٰ عَنّى مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنّى سُلْطَـٰنِيَهْ * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاْسْلُكُوهُ﴾ (25-32). ولاحظ أن السورة ابتدأت بأهل الجنة قبل أهل النار، وكأن المعنى: حبّب الناس بالجنة قبل تخويفهم من النار، لأن الترغيب يؤثر في النفوس بشكل أقوى بكثير من الترهيب.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الحاقة».
- • معنى الاسم :: الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة، فهو يوم متحقق الوقوع، ويتحقق فيه الوعد والوعيد.
- • سبب التسمية :: وُقُوعُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي أَوَّلِهَا وَلَمْ تَقَعْ فِي غَيْرِهَا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ السِّلْسِلَةِ»؛ لذكره في الآية (32)، و«سُورَةُ الواعية»؛ لذكره في الآية (12).
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: حتمية وقوع القيامة، وأنها حق.
- • علمتني السورة :: حال الأمم السابقة وما أنزل الله عليهم من العقوبات: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾
- • علمتني السورة :: أن ثمار الجنة قريبة يتناولها أهل الجنة قعودًا وعلى جنوبهم: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾
- • علمتني السورة :: أن المال والسلطان ابتلاء وتكليف لا تشريف؛ فإذا العبد ما أدى فيها حق ربه وعباده كانت حسرة يوم القيامة: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الحاقة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الحاقة من المفصل.
• سورة الحاقة من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الحاقة مع سورة القمر، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • افتتحت سورة الحاقة بأسلوب التكرار والاستفهام: ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ (1-3)، وهذا الأسلوب يفيد التهويل والتعظيم، وهو مناسب لموضوع السورة الذي يتحدث عن يوم القيامة وأهوالها.
• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتيقن بوقوع القيامة، ونستشعر أحداثها، مثل: العرض على الله، والحساب، وتطاير الصحف.
• أن نعتبر بما حدث للأمم السابقة، وما أنزل الله عليهم من عقوبات لما كذبوا الرسل: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ (5، 6).
• أن نعرف حقارة الدنيا؛ دكة واحدة تُذهب كل ما نراه: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ (14).
• أن نستعد الآن ليوم القيامة بالأعمال الصالحة؛ لنكون ممن يأخذ كتابه بيمينه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ * إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ (19، 20).
• أن نطعم الفقراء، ولا نكتفي بذلك؛ بل نحُضّ الآخرينَ على ذلك: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (34).
• أن نحذر من التَّقَوُّل على الله والافتراء عليه سبحانه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ (44).
• أن نتدبر القرآن، ونعمل بما فيه: ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (48).
• أن نكثر من قول: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (52).
سورة المعارج
أهمية حسن عبادة الله إلى جانب الأخلاق/ بيان طول يوم القيامة
أولاً : التمهيد للسورة :
- • سورة المعارج تعرض لبعض أهوال القيامة، فأين المتدبرون؟: سورة المعارج تتحدث عن طبيعة الإنسان: الجزع عند الشدة، والمنع عند النعمة، ثم تستثنى السورة من ذلك المؤمنين، وتصفهم بتسع صفات، وهي: 1- المداومة على الصلاة. 2- إخراج الزكاة. 3- الإيمان بيوم القيامة. 4- الخوف من الله. 5- حفظ الفرج. 6- أداء الأمانة. 7- الوفاء بالعهد. 8- عدم كتمان الشهادة. 9- المحافظة على الصلاة. ونلاحظ فيما سبق: 1- جمعت صفات المؤمنين السابقة بين: العبادات وأعمال القلوب والأخلاق، للدلالة على تكامل شخصية المؤمن. 2- أول صفة ذَكَرَتها: الصلاة، وآخر صفة كذلك، للدلالة على أن من حافظ على صلاته سهل الله له باقي هذه العبادات والأخلاق.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «المعَارج».
- • معنى الاسم :: عرج: ارتقى وارتفع وعلا، والمعَارِجُ جمع مِعراج، والمِعْرَاجُ: المِصْعَدُ والسُّلَّمُ، والمعارج: المصاعد والدرجات، ومنه ليلة الإسراء والمعراج، وذو المعارج اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الذي يُعْرج إليه بالأرواح والأعمال.
- • سبب التسمية :: لذكر هذا اللفظ في الآية (3).
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ سَأَلَ سَائِلٌ»، و«سُورَةُ سَأَلَ»؛ لافتتاحها بهذا اللفظ، و«سورة الواقع».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أهمية حسن عبادة الله إلى جانب الأخلاق.
- • علمتني السورة :: طول يوم القيامة، وغفلة الكافرين عنه، واستعداد المؤمنين له.
- • علمتني السورة :: أن دعوات الأنبياء قائمة على الصبر والعفو والحب والإحسان، أما التربية التي تقتات على الحقد فلا تمت لدعوتهم بصلة: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾
- • علمتني السورة :: أن اليقين باليومِ الآخرِ وشدَّةِ قربِه يدعو أهلَ الإيمانِ للعملِ: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة المعَارج من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة المعَارج من المفصل.
• سورة المعَارج من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المعَارج مع سورة النازعات، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّاكَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة المعارج احتوت على 17 آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وبينت جزاءهم، وقارنت بين حال الإنسان العادي والإنسان المؤمن عند وقوع المصائب وحصول النعم، وهي الآيات: (19-35).
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتيقن من وقوع العذاب على الكافرين، وحصول النعيم للمصدقين بيوم الدين.
• أن نحرص على الترقي في درجات الإيمان.
• أن نحذر من الانسياق خلف خطرات النفس؛ إذ يغلب عليها الانفعال والهلع والشح والبخل والاضطراب.
• أن نحذر أن نكون ممن تطلبهم النار يوم القيامة، وهم: من أعرض عن دين الله تعالى، ومن جمع المال ولم ينفق في سبيل الله: ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ * وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ﴾ (16-18).
• أن نحافظ على الصَّلاةِ؛ فإنها من أعظم أسبابِ الاستقرارِ النَّفسي: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ...إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ (19-22).
• أن نتصدق من أموالنا على الفقراء والمحتاجين: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (24، 25).
• أن نتحلى بصفة الوفاء بالعهد وعدم خيانة الأمانة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (32).
• أن نحذر أن تغرنا الحياة الدنيا: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (42).
تمرين حفظ الصفحة : 568
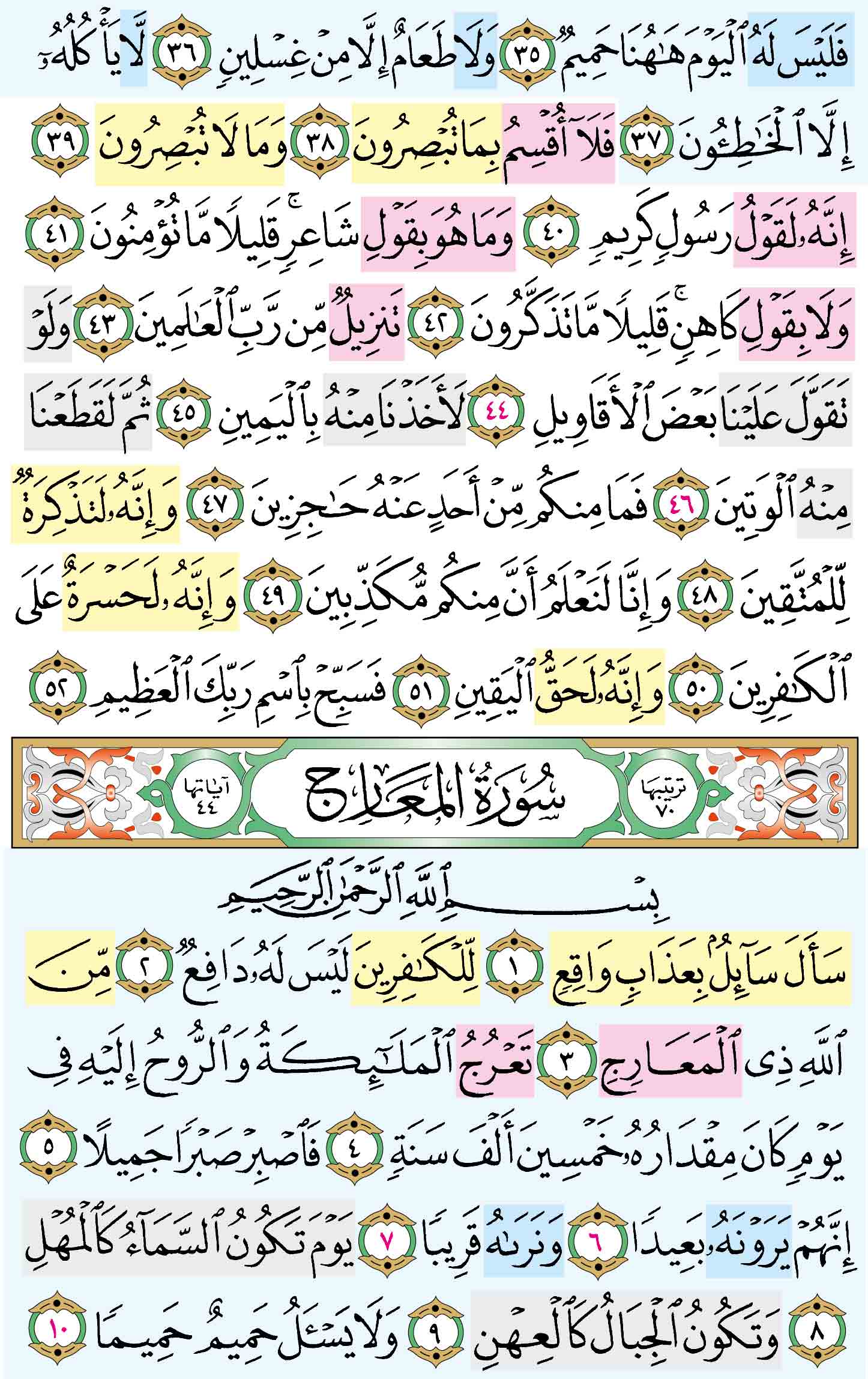
مدارسة الآية : [36] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾
التفسير :
وليس له طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار، الذي هو في غاية الحرارة، ونتن الريح،
(( وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ) أى : وليس له فى جهنم من طعام سوى الغسلين وهو صديد أهل النار . . أو شجر يأكله أهل النار ، فيغسل بطونهم ، أى : يخرج أحشاءهم منها ، أو ليس لهم إلا شر الطعام وأخبثه .
وقوله : ( فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ) أي : ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله ، لا حميم - وهو القريب - ولا شفيع يطاع ، ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين .
قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع والضحاك : هو شجرة في جهنم .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا منصور بن مزاحم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : ما أدري ما الغسلين ، ولكني أظنه الزقوم .
وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل النار .
(وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ ) يقول جلّ ثناؤه: ولا له طعام كما كان لا يحضّ في الدنيا على طعام المسكين، إلا طعام من غسلين، وذلك ما يسيل من صديد أهل النار.
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: كلّ جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجراح والدَّبر، وزيد فيه الياء والنون بمنـزلة عفرين.
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ ): صديد أهل النار.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ ) قال: ما يخرج من لحومهم.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ ): شرّ الطعام وأخبثه وأبشعه.
وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ ) قال: الغسلين والزقوم لا يعلم أحد ما هو.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[36] ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾ منعَ المساكين الطعامَ في الدنيا؛ فمنعهُ الله الطعام في الآخرة، وجعله يتجرع غصص الغسلين، جزاءً وفاقًا.
وقفة
[36] ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾ قال تعالى في موضع آخر: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ [الغاشية: 6]، وقال هنا: ﴿إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾، فكيف الجمع بين الآيتين؟ والجواب: أن النار دركات، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد.
وقفة
[36] أحيانًا لا تحتاج أن تكشف عن معنى كلمة رغم صعوبة معرفة معناها، فمن وقع الكلمة تعرف: ﴿غِسلينٍ﴾ يقينًا هو طعام سيئ كريه غير مستساغ.
الإعراب :
- ﴿ وَلا طَعامٌ: ﴾
- الواو عاطفة لا عمل لها. طعام: معطوفة على «حميم» وتعرب إعرابها.
- ﴿ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ: ﴾
- حرف تحقيق بعد النفي. مِنْ غِسْلِينٍ: جار ومجرور متعلق بصفة لطعام ويجوز أن تكون «إلا» أداة استثناء. و «من» حرف جر زائدا و «غسلين» اسم مجرر لفظا منصوب محلا على أنه مستثنى من «طعام» و «غسلين» أي غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [36] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ أن هذا الكافر ليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب؛ بَيَّنَ هنا أنه ليس له طعام إلا مِن صديد أهل النَّار، قال تعالى:
﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [37] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ ﴾
التفسير :
وقبح الطعم ومرارته لا يأكل هذا الطعام الذميم{ إِلَّا الْخَاطِئُونَ} الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا سبل الجحيم فلذلك استحقوا العذاب الأليم.
لاَّ يَأْكُلُهُ ) أى : الغسلين ( إِلاَّ الخاطئون ) أى : إلا الكافرون الذين تعمدوا ارتكاب الذنوب ، وأصروا عليها ، من خَطِئَ الرجل : إذا تعمد ارتكاب الذنب .
فالخاطئ هو من يرتكب الذنب عن تعمد وإصرار . والمخطئ : هو من يرتكب الذنب عن غير إصرار وتعمد .
وهكذا . نجد الآيات الكريمة قد ساقت أشد ألوان الوعيد والعذاب . . للكافرين ، بعد أن ساقت قبل ذلك ، أعظم أنواع النعيم المقيم للمؤمنين .
وقوله : ( فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ) أي : ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله ، لا حميم - وهو القريب - ولا شفيع يطاع ، ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين .
قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع والضحاك : هو شجرة في جهنم .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا منصور بن مزاحم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : ما أدري ما الغسلين ، ولكني أظنه الزقوم .
وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل النار .
وقوله: (لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ ) يقول: لا يأكل الطعام الذي من غسلين إلا الخاطئون، وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[37] ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ الخاطئ هو من يرتكب الذنب عن تعمد وإصرار، والمخطئ: هو من يرتكب الذنب عن غير إصرار وتعمد.
الإعراب :
- ﴿ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل رفع صفة- نعت- لطعام. لا: نافية لا عمل لها. يأكله: فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. إلا: أداة حصر لا عمل لها. الخاطئون: فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [37] لما قبلها : ولَمَّا حَصَرَ اللهُ طَعامَهم فِيما لا يَقْرَبُهُ أحَدٌ بِاخْتِيارِهِ؛ حَصَرَ مَن يَتَناوَلُهُ مُعَبِّرًا عَنْهم بِالوَصْفِ الَّذِي أوْجَبَ لَهم أكْلَهُ، قال تعالى:
﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
الخاطئون:
1- بالهمز، اسم فاعل من «خطئ» ، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بياء مضمومة بدلا من الهمزة، وهى قراءة الحسن، والزهري، والعتكي، وطلحة، فى نقل.
3- بضم الطاء دون همز، وهى قراءة أبى جعفر، وشيبة، وطلحة، ونافع، بخلاف عنه.
مدارسة الآية : [38] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾
التفسير :
أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة، على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى.
والفاء في قوله: فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ للتفريع على ما فهم مما تقدم، من إنكار المشركين ليوم القيامة، ولكون القرآن من عند الله.
وفَلا في مثل هذا التركيب يرى بعضهم أنها مزيدة، فيكون المعنى: أقسم بما تبصرون من مخلوقاتنا كالسماء والأرض والجبال والبحار ... وبما لا تبصرون منها، كالملائكة والجن.
يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته ، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله ، الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ، فقال : ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون)
القول في تأويل قوله تعالى : فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ
يقول تعالى ذكره: فلا ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورسله، أقسم بالأشياء كلها التي تبصرون منها، والتي لا تبصرون.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
التدبر :
وقفة
[38، 39] ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ هذا أعمُّ قسمٍ وقع في القرآن، فإنه يعمُّ العُلويَّات والسُفليَّات، والدنيا والآخرة، وما يُرى وما لا يُرى!
الإعراب :
- ﴿ فَلا أُقْسِمُ: ﴾
- الفاء: استئنافية. لا: مزيدة مؤكدة. أقسم: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنا وجملة «لا أقسم» شرحت في الآية الأولى من سورة القيامة.
- ﴿ بِما تُبْصِرُونَ: ﴾
- الباء حرف جر. ما: اسم موصول- مقسم به- مبني على السكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بأقسم. تبصرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «تبصرون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: بما تبصرونه من الأشياء والعوالم المتطورة وغير المنظورة'
المتشابهات :
| الواقعة: 75 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ |
|---|
| الحاقة: 38 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ |
|---|
| المعارج: 40 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ |
|---|
| التكوير: 15 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴾ |
|---|
| الإنشقاق: 16 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ |
|---|
| القيامة: 1 | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ *﴾ |
|---|
| القيامة: 2 | ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ |
|---|
| البلد: 1 | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [38] لما قبلها : ولَمَّا أقامَ اللهُ الدَّلالةَ على إمكانِ القِيامةِ، ثمَّ على وُقوعِها، ثمَّ ذَكَرَ أحوالَ السُّعداءِ وأحوالَ الأشقياءِ؛ أَقْسَمَ هنا أنَّ القرآنَ كلامُ الله، يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل، وليس بقول شاعر كما يزعم المشركون، قال تعالى:
﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [39] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴾
التفسير :
أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة، على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى.
وبما لا تبصرون منها ، كالملائكة والجن .
يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته ، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله ، الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ، فقال : ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون)
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله: (فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا تُبْصِرُونَ ) قال: أقسم بالأشياء، حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: (فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا تُبْصِرُونَ ) يقول: بما ترون وبما لا ترون.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ وَما لا تُبْصِرُونَ ﴾
- الآية الكريمة معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [39] لما قبلها : وبعد أن أَقْسَم اللهُ بما يُشاهَد؛ أقسم بما لا يُشاهَد، ليدخل فيه كل الخلق، بل يدخل في ذلك نفسُه المقدَّسةُ، قال تعالى:
﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [40] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾
التفسير :
أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة، على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى.
وقوله: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ جواب القسم، وهو المحلوف عليه أى: أقسم إن هذا القرآن لقول رسول كريم، هو محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف- سبحانه- القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو الذي تلقاه عن الله- تعالى- وهو الذي بلغه عنه بأمره وإذنه.
أى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا القرآن، وينطق به، على وجه التبليغ عن الله- تعالى-.
قال الإمام ابن كثير: قوله إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي فقال: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وهو جبريل- عليه السلام- .
وبعضهم يرى أن «لا» في مثل هذا التركيب ليست مزيدة، وإنما هي أصلية، ويكون المقصود من الآية الكريمة، بيان أن الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم، إذ كل عاقل عند ما يقرأ القرآن، يعتقد أنه من عند الله.
ويكون المعنى: فلا أقسم بما تبصرونه من مخلوقات، وبما لا تبصرونه.. لظهور الأمر واستغنائه عن القسم.
قال الشوكانى: قوله: فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ هذا رد لكلام المشركين، كأنه قال: ليس الأمر كما تقولون. و «لا» زائدة والتقدير: فأقسم بما تشاهدونه وبما لا تشاهدونه.
وقيل إن «لا» ليست زائدة، بل هي لنفى القسم، أى: لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحق في ذلك. والأول أولى.
وتأكيد قوله: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بإنّ وباللام، للرد على المشركين الذين قالوا عن القرآن الكريم: أساطير الأولين.
يعني : محمدا أضافه إليه على معنى التبليغ ; لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ; ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي : ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ) وهذا جبريل ، عليه السلام .
ثم قال : ( وما صاحبكم بمجنون ) يعني : محمدا صلى الله عليه وسلم ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يعني : أن محمدا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ، ( وما هو على الغيب بضنين ) أي : بمتهم ( وما هو بقول شيطان رجيم ) [ التكوير : 19 - 25 ] ، وهكذا قال هاهنا :
وقوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن لقول رسول كريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم.
التدبر :
وقفة
[40] ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هذا هو المقسم عليه، أي إن القرآن تبليغ رسول كريم، ومقول قاله جبريل عليه السلام الشريف الكريم العزيز عند الله، ونزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله ﷺ، فليس القرآن من كلام البشر، وإنما وصل إلى النبي ﷺ من جبريل الذي تلقاه عن ربِّه عزَّ وجلَّ.
وقفة
[40] ﴿إِنَّهُ لَقَولُ رَسولٍ كَريمٍ﴾ رغم أنه كلام الله المُنزل إلا أنه سبحانه نَسَبه للرسول ﷺ لإنه من يُبلغه، ولهذا يجب أن نُراعى كل حرفٍ نتفوه به أيًّا كان، لأنه سيُنسب إلينا.
وقفة
[40] ﴿إِنَّهُ لَقَولُ رَسولٍ كَريمٍ﴾ ولما كان من شأن الرسول ﷺ أن لا يبلغ إلا ما أرسله به مرسله، أخبر أن له ﷺ من الوصف ما يحفظه فقال: ﴿كَريمٍ﴾ أي هو ﷺ في غاية الكرم الذي هو البعد عن مساوىء الأخلاق بإظهار معاليها لشرف النفس وشرف الآباء فهو لا يزيد ولا ينقص، وكرم الشيء اجتماع الكمالات اللائقة به.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» أي ان هذا القرآن. اللام لام التوكيد- المزحلقة- قول: خبر «إن» مرفوع بالضمة.
- ﴿ رَسُولٍ كَرِيمٍ: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. كريم:صفة- نعت- لرسول مجرور بالكسرة. أي قول محمد يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله.'
المتشابهات :
| الحاقة: 40 | ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ |
|---|
| التكوير: 19 | ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [40] لما قبلها : وبعد القسم؛ جاء جوابُ القسم، قال تعالى:
﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [41] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا .. ﴾
التفسير :
ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه، من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا، لعلموا ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك، أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم، ويرمقوا أوصافه وأخلاقه، لرأوا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا.
ثم أضاف- سبحانه- إلى هذا التأكيد تأكيدات أخرى فقال: وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ، قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ. وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ.
والشاعر: هو من يقول الشعر. والكاهن: هو من يتعاطى الكهانة عن طريق الزعم بأنه يعلم الغيب.
وانتصب «قليلا» في الموضعين على أنه صفة لمصدر محذوف، و «ما» مزيدة لتأكيد القلة.
والمراد بالقلة في الموضعين انتفاء الإيمان منهم أصلا أو أن المراد بالقلة: إيمانهم اليسير، كإيمانهم بأن الله هو الذي خلقهم، مع إشراكهم معه آلهة أخرى في العبادة.
أى: ليس القرآن الكريم بقول شاعر، ولا بقول كاهن، وإنما هو تنزيل من رب العالمين، على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبلغه إليكم، ولكي يخرجكم بواسطته من ظلمات الكفر، إلى نور الإيمان.
ولكنكم- أيها الكافرون- لا إيمان عندكم أصلا، أو قليلا ما تؤمنون بالحق، وقليلا ما تتذكرونه وتتعظون به.
ففي الآيتين رد على الجاحدين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن.
وخص هذين الوصفين بالذكر هنا لأن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه رَسُولٍ كَرِيمٍ كاف لنفى الجنون أو الكذب عنه صلى الله عليه وسلم أما وصفه بالشعر والكهانة فلا ينافي عندهم وصفه بأنه كريم، لأن الشعر والكهانة كان معدودين عندهم من صفات الشرف، لذا نفى- سبحانه- عنه صلى الله عليه وسلم أنه شاعر أو كاهن، وأثبت له أنه رسول كريم.
( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) ، فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي ، وتارة إلى الرسول البشري ; لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه
وقوله: (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ ) يقول جلّ ثناؤه: ما هذا القرآن بقول شاعر؛ لأن محمدًا لا يُحسن قيل الشعر، فتقولوا هو شعر، (قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ ) يقول: تصدّقون قليلا به أنتم، وذلك خطاب من الله لمشركي قريش، (وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) يقول: ولا هو بقول كاهن، لأن محمدًا ليس بكاهن، فتقولوا: هو من سجع الكهان، (قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) يقول : تتعظون به أنتم، قليلا ما تعتبرون به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ ): طهَّره الله من ذلك وعصمه،
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[41، 42] ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة.
الإعراب :
- ﴿ وَما هُوَ: ﴾
- الواو استئنافية. ما: نافية بمنزلة «ليس» عند الحجازيين. ونافية لا عمل لها عند بني تميم. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «ما» على اللغة الأولى ومبتدأ على اللغة الثانية. أي وليس هذا القرآن.
- ﴿ بِقَوْلِ شاعِرٍ: ﴾
- الباء حرف جر زائد. قول: اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر «ما» ومرفوع محلا على أنه خبر «هو» وعلامة نصبه أو رفعه فتحة أو ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. شاعر: مضاف اليه مجرور بالكسرة.
- ﴿ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ: ﴾
- نعت للمصدر- المفعول المطلق- أو صفة نائبة عنه.التقدير: ايمانا قليلا تؤمنون. تؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و «ما» زائدة مهملة لتوكيد القلة والقلة في معنى العدم. أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. والمعنى: ما أكفركم وما أغفلكم. أو تكون «ما» مصدرية والجملة بعدها صلتها لا محل لها و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل رفع فاعل لاسم الفاعل الصفة المشبهة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [41] لما قبلها : ولَمَّا أثبت أنه قولُه سبحانه وتعالى؛ لأنه قولُ رسولِه صلى الله عليه وسلم لنا، وهو لا ينطقُ عن الهوى؛ نفى عنه ما يتقوَّلونه عليه، وبدأ بالشعر، فقال تعالى:
﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تؤمنون:
قرئ:
1- بالياء، وهى قراءة ابن كثير، وابن عامر، وأبى عمرو بخلاف عنهما، والجحدري، والحسن.
2- بتاء الخطاب، وهى قراءة باقى السبعة.
مدارسة الآية : [42] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا .. ﴾
التفسير :
ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه، من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا، لعلموا ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك، أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم، ويرمقوا أوصافه وأخلاقه، لرأوا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا.
ثم أضاف- سبحانه- إلى هذا التأكيد تأكيدات أخرى فقال: وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ، قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ. وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ.
والشاعر: هو من يقول الشعر. والكاهن: هو من يتعاطى الكهانة عن طريق الزعم بأنه يعلم الغيب.
وانتصب «قليلا» في الموضعين على أنه صفة لمصدر محذوف، و «ما» مزيدة لتأكيد القلة.
والمراد بالقلة في الموضعين انتفاء الإيمان منهم أصلا أو أن المراد بالقلة: إيمانهم اليسير، كإيمانهم بأن الله هو الذي خلقهم، مع إشراكهم معه آلهة أخرى في العبادة.
أى: ليس القرآن الكريم بقول شاعر، ولا بقول كاهن، وإنما هو تنزيل من رب العالمين، على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبلغه إليكم، ولكي يخرجكم بواسطته من ظلمات الكفر، إلى نور الإيمان.
ولكنكم- أيها الكافرون- لا إيمان عندكم أصلا، أو قليلا ما تؤمنون بالحق، وقليلا ما تتذكرونه وتتعظون به.
ففي الآيتين رد على الجاحدين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن.
وخص هذين الوصفين بالذكر هنا لأن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه رَسُولٍ كَرِيمٍ كاف لنفى الجنون أو الكذب عنه صلى الله عليه وسلم أما وصفه بالشعر والكهانة فلا ينافي عندهم وصفه بأنه كريم، لأن الشعر والكهانة كان معدودين عندهم من صفات الشرف، لذا نفى- سبحانه- عنه صلى الله عليه وسلم أنه شاعر أو كاهن، وأثبت له أنه رسول كريم.
فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي ، وتارة إلى الرسول البشري ; لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ; ولهذا قال :
(وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ )، طهَّره الله من الكهانة، وعصمه منها.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعراب. أي ولا كاهن كما تدعون و «لا» زائدة لتاكيد معنى النفي. تذكرون: أصلها تتذكرون.فحذفت احدى التاءين تخفيفا'
المتشابهات :
| الأعراف: 3 | ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ |
|---|
| النمل: 62 | ﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ |
|---|
| الحاقة: 42 | ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [42] لما قبلها : وبعد أن نفى أن يكون قولَ شاعر؛ نفى هنا أن يكون قولَ كاهن، قال تعالى:
﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تذكرون:
قرئ:
1- بالياء، وهى قراءة ابن كثير، وابن عامر، وأبى عمرو، بخلاف عنهما، والجحدري، والحسن.
2- بتاء الخطاب، وهى قراءة باقى السبعة.
مدارسة الآية : [43] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
التفسير :
وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين، لا يليق أن يكون قول البشر بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به، وجلالة أوصافه، وكمال تربيته لعباده، وعلوه فوق عباده، .
وقوله: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ تأكيد لكون القرآن من عند الله- تعالى- وأنه ليس بقول شاعر أو كاهن.
أى: هذا القرآن ليس كما زعمتم- أيها الكافرون- وإنما هو منزل من رب العالمين، لا من أحد سواه- عز وجل-.
( تنزيل من رب العالمين )
قال الإمام أحمد : حدثنا ابن المغيرة ، حدثنا صفوان ، حدثنا شريح بن عبيد الله قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقني إلى المسجد ، فقمت خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أعجب من تأليف القرآن ، قال : فقلت : هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال : فقرأ : ( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) قال : فقلت : كاهن . قال فقرأ : ( ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) إلى آخر السورة . قال : فوقع الإسلام في قلبي كل موقع .
فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب ، كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة ، ولله الحمد .
القول في تأويل قوله تعالى : تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43)
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[43] ما تضمنه قوله: ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى؛ لا يأمرهم، ولا ينهاهم، ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم، ويحذرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملًا بمنْزلة الأنعام السائمة؛ فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره، ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى.
الإعراب :
- ﴿ تَنْزِيلٌ: ﴾
- خبر مبتدأ محذوف تقديره هو تنزيل، مرفوع بالضمة.
- ﴿ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لتنزيل. أو متعلق بفعل من جنس المصدر «تنزيل» أي لأنه قول رسول نزل عليه من رب العالمين. العالمين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'
المتشابهات :
| الواقعة: 80 | ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ |
|---|
| الحاقة: 43 | ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [43] لما قبلها : وبعد أن نفى أن يكون قولَ شاعر أو قولَ كاهن؛ ترقَّبَ السامعُ معرفة كنهه، فبَيَّنَ بأنه منزلٌ من ربِّ العالمين على الرسول الكريم، قال تعالى:
﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تنزيل:
1- بالرفع، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- تنزيلا، بالنصب، وهى قراءة أبى السمال.
مدارسة الآية : [44] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾
التفسير :
فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو تقول عليه وافترى{ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ} الكاذبة.
ثم بين- سبحانه- ما يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه- على سبيل الفرض- غيّر أو بدل شيئا من القرآن فقال: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ.
والتقول: افتراء القول، ونسبته إلى من لم يقله، فهو تفعل من القول يدل على التكلف والتصنع والاختلاق.
والأقاويل: جمع أقوال، الذي هو جمع قول، فهو جمع الجمع.
أى: ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى علينا بعض الأقوال، أو نسب إلينا قولا لم نقله، أو لم نأذن له في قوله.. لو أنه فعل شيئا من ذلك على سبيل الفرض.
يقول تعالى : ( ولو تقول علينا ) أي : محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا ، فزاد في الرسالة أو نقص منها ، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا ، وليس كذلك ، لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا قال
يقول تعالى ذكره: ولكنه (تَنـزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) نـزل عليه، (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا ) محمد، (بَعْضَ الأقَاوِيلِ ) الباطلة، وتكذب علينا، (لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب، وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة، ولا يؤخره بها.
التدبر :
تفاعل
[44] ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ قل: «اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورًا، أو أغشى فجورًا».
وقفة
[44] ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ إذا كان النَّبي خُوطِبَ بالتَّهديدِ إذا تَقَوَّلَ على اللهِ؛ فكيف بغيره؟!، فكيف بمن يُفتِي على اللهِ بغير علمٍ؟!
وقفة
[44] ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ خطر التَّقَوُّل على الله والافتراء عليه سبحانه.
وقفة
[44] ما أعظم الافتراء على الله! تأمل وتدبر قول الله عن نبيه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ: ﴾
- الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم. تقول:فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي لو ادعى علينا شيئا لم نقله أي لو افترى.
- ﴿ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ: ﴾
- حرف جر و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بتقول و «بعض» مفعول مطلق- مصدر- أو نائب عنه فيه معنى التوكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الأقاويل: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [44] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن القرآنَ منزلٌ من ربِّ العالمين على الرسول الكريم؛ بَيَّنَ هنا ما يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه- على سبيل الفرض- غيَّرَ أو بَدَّل شيئًا من القرآن، قال تعالى:
﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تقول:
1- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- مبنيا للمفعول.
مدارسة الآية : [45] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾
التفسير :
{ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسان، فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على الله لعاجله بالعقوبة، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم، على كل شيء قدير، فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه، الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة، ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات، وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات، ونصره على أعدائه، ومكنه من نواصيهم، فهو أكبر شهادة منه على رسالته.
لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ أى: لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، وهو كناية عن إذلاله وإهانته.
أو: لأخذناه بالقوة والقدرة، وعبر عنهما باليمين، لأن قوة كل شيء في ميامنه.
والمقصود بالجملة الكريمة: التهويل من شأن الأخذ، وأنه أخذ شديد سريع لا يملك معه تصرفا أو هربا.
( لأخذنا منه باليمين ) قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ; لأنها أشد في البطش ، وقيل : لأخذنا منه بيمينه .
وقد قيل: إن معنى قوله: (لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) : لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه؛ قالوا: وإنما ذلك مثل، ومعناه: إنا كنا نذله ونهينه، ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين، قالوا: وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه، خذ بيده فأقمه، وافعل به كذا وكذا، قالوا: وكذلك معنى قوله: (لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) أي لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله.
وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: (الْوَتِينَ ) قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
التدبر :
وقفة
[45] ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ من العلماء من قال: (باليمين) أي: الجارحة، ومنهم من قال: (اليمين): القوة، وقوله: (اليمين)؛ لكون اليمين عند العرب أقوى من اليسار، وإن كانت كلتا يدي ربي يمين مباركة، لكن لتقريب المعنى للناس، إذا قلت -ولله المثل الأعلى-: فلان يضربك باليمين، فالضرب باليمين غير الضرب باليسار، فالضرب باليسار ضربٌ ضعيف، بينما الضرب باليمين ضربٌ قوي.
وقفة
[45] ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ في هذه الآية التحذير الشديد من الزيادة أو النقصان في كتابه العزيز، وفيها بيان حفظ الله لهذا الكتاب.
الإعراب :
- ﴿ لَأَخَذْنا: ﴾
- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. اللام واقعة في جواب «لو» أخذ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
- ﴿ مِنْهُ بِالْيَمِينِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأخذنا. باليمين: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة للمصدر المقدر أي أخذا باليمين. أي بمعنى لأخذناه بيمينه أي لقتلناه بأخذ يده وضرب عنقه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [45] لما قبلها : ولَمَّا قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾؛ ذكرَ هنا جوابَ «لو»، قال تعالى:
﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [46] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾
التفسير :
{ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسان، فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على الله لعاجله بالعقوبة، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم، على كل شيء قدير، فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه، الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة، ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات، وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات، ونصره على أعدائه، ومكنه من نواصيهم، فهو أكبر شهادة منه على رسالته.
ثم أضاف- سبحانه- إلى هذا التهويل ما هو أشد منه في هذا المعنى فقال: ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ.
أى: ثم بعد هذا الأخذ بقوة وسرعة، لقطعنا وتينه. وهو عرق يتصل بالقلب. متى قطع مات صاحبه.
وهذا التعبير من مبتكرات القرآن الكريم، ومن أساليبه البديعة، إذ لم يسمع عن العرب أنهم عبروا عن الإهلاك بقطع الوتين.
( ثم لقطعنا منه الوتين ) قال ابن عباس : وهو نياط القلب ، وهو العرق الذي القلب معلق فيه . وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد .
وقال محمد بن كعب : هو القلب ومراقه وما يليه .
حدثني سليمان بن عبد الجبار، قال: ثنا محمد بن الصلت، قال: ثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: (لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) قال: نياط القلب.
حدثني ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بمثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بمثله.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال، قال ابن عباس (الْوَتِينَ ) : نِياط القلب.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير بنحوه.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سفيان، عن سعيد بن جبير بمثله.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) يقول: عرق القلب.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) يعني: عرقا في القلب، ويقال: هو حبل في القلب.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (الْوَتِينَ ) قال: حبل القلب الذي في الظهر.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) قال: حبل القلب.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) وتين القلب، وهو عرق يكون في القلب، فإذا قطع مات الإنسان.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) قال: الوتين: نياط القلب الذي القلب متعلق به، وإياه عنى الشماخ بن ضرار التغلبي بقوله:
إذَا بَلَّغْتِنـــي وَحَـــمَلْتِ رَحْــلِي
عَرَابَــةَ فاشْــرَقي بــدَمِ الــوَتينَ (1)
المعاني :
التدبر :
وقفة
[46] الوتين هو عرق في قلب الإنسان إذا قطع مات صاحبه لا يمكن الحياة بدونه ومنه قول الله ﷻ: ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ سأل سائل بعذاب واقع السؤال يُعدّى بعن، لكن المعنى: سأل سائل مهتمًا بعذاب واقع، فُضمِّن السؤال معنى الاهتمام.
وقفة
[44-46] ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ إذا كان هذا التهديد لخير خلقه ﷺ لو تقوَّل عليه، فكيف بمن يتجرأ بالفتاوى الباطلة الشاذة، ويتقوَّل على الله بلا علم!
وقفة
[44-46] لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخفي من القرآن شيئًا؛ لأخفى هذا الوعيد والتهديد، ولكنها مخافة الله، والأمانة في تبليغ الرسالة.
وقفة
[44-46] سوء خاتمة مدَّعي النبوة.
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾
- معطوفة بثم على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. أي لقطعنا وتينه والوتين نياط القلب وهو حبل الوريد اذا قطع مات صاحبه. الوتين: مفعول به منصوب بالفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [46] لما قبلها : ولَمَّا صوَّر مبدأَ الإهلاكِ بأفظعِ صورةِ؛ أتمَّه مُشِيرًا إلى شِدَّةِ بشاعتِه بحرفِ التَّراخي فقال تعالى:
﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [47] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ .. ﴾
التفسير :
{ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} أي:لو أهلكه، ما امتنع هو بنفسه، ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله.
ثم بين- سبحانه- أن أحدا لن يستطيع منع عقابه فقال: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ.
أى: فما منكم من أحد- أيها المشركون- يستطيع أن يدفع عقابنا عنه، أو يحول بيننا وبين ما نريده، فالضمير في «عنه» يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات: التقول: افتعال القول، كأن فيه تكلفا من المفتعل، وسمى الأقوال المتقولة «أقاويل» ، تصغيرا بها وتحقيرا، كقولك: الأعاجيب والأضاحيك، كأنها جمع أفعولة من القول.
والمعنى: ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم.
معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده، وتضرب رقبته.
وخص اليمين عن اليسار، لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف- وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف- أخذ بيمينه.
ومعنى: لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ: لأخذنا بيمينه. كما أن قوله: ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ: لقطعنا وتينه، والوتين: نياط القلب، وهو حبل الوريد، إذا قطع مات صاحبه .
وفي هذه الآيات الكريمة أقوى الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله- تعالى- لأنه لو كان- كما زعم الزاعمون أنه من تأليف الرسول صلى الله عليه وسلم لما نطق بهذه الألفاظ التي فيها ما فيها من تهديده ووعيده.
كما أنها كذلك فيها إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يتقول شيئا.. وإنما بلّغ هذا القرآن عن ربه- عز وجل- دون أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا.. لأن حكمة الله- تعالى- قد اقتضت أن يهلك كل من يفترى عليه الكذب، ومن يزعم أن الله- تعالى- أوحى إليه، مع أنه- سبحانه- لم يوح إليه.
وقوله : ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) أي : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك . والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد ; لأن الله ، عز وجل ، مقرر له ما يبلغه عنه ، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات .
القول في تأويل قوله تعالى : فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)
يقول تعالى ذكره: فما منكم أيها الناس من أحد عن محمد لو تقوّل علينا بعض الأقاويل، فأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، حاجزين يحجزوننا عن عقوبته، وما نفعله به. وقيل: حاجزين، فجمع، وهو فعل لأحد، وأحد في لفظ واحد ردّا على معناه، لأن معناه الجمع، والعرب تجعل أحدا للواحد والاثنين والجمع، كما قيل لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وبين: لا تقع إلا على اثنين فصاعدا.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[47] ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ هذا القرآن مَصُون أعظم درجات الصيانة، ومحفوظ من قِبَل الله، فلا يجرأ أحد أن يزيد فيه حرفًا أو ينقص حرفًا، وهذا وعد الله بحفظه، وتهديد بعقاب من أراد أن يمسه بسوء.
الإعراب :
- ﴿ فَما مِنْكُمْ: ﴾
- الفاء: استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. منكم: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم والميم علامة الجمع.
- ﴿ مِنْ أَحَدٍ: ﴾
- حرف جر زائد لتوكيد النفي. أحد: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ نكرة مسبوق بنفي.
- ﴿ عَنْهُ حاجِزِينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بحاجزين. والضمير في «عنه» للقتل:أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه. أو لرسول الله.أي لا تقدرون أن تحجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه. حاجزين: صفة- نعت- لأحد على المعنى لأن الخطاب للناس ولهذا جاء بصيغة الجمع أي لأنه في معنى الجماعة و «أحد» يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وهو اسم لمن يعقل و «حاجزين» مجرورة على لفظ «أحد» لا الموقع. وعلامة جرها الياء لأنها جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [47] لما قبلها : ولَمَّا أتمَّ تصويرَ ما يفعلُه الملوكُ بمن يغضبون عليه، من أن يأخذَ السَّيَّافُ بيمينِه، يضربَ عُنُقَه بالسَّيفِ؛ بَيَّنَ هنا أنه لا يقدر أحد أن يحجز عنه عقابنا، قال تعالى:
﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [48] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾
التفسير :
{ وَإِنَّهُ} أي:القرآن الكريم{ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم، فيعرفونها، ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية، والأخلاق المرضية، والأحكام الشرعية، فيكونون من العلماء الربانيين، والعباد العارفين، والأئمة المهديين.
وقوله - سبحانه - ( وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ) معطوف على قوله : ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) .
أى : إن هذا القرآن لقول رسول كريم بلغه عن الله - تعالى - وإنه لتذكير وإرشاد لأهل التقوى ، لأنهم هم المنتفعون بهداياته .
ثم قال : ( وإنه لتذكرة للمتقين ) يعني : القرآن كما قال : ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) [ فصلت : 44 ] .
وقوله: ( وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ) يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لتذكرة، يعني عظة يتذكر به، ويتعظ به للمتقين، وهم الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ) قال: القرآن.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[48] ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي من العالمين؛ لأنهم المنتفعون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد.
وقفة
[48] ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ كل من لم يذكِّره القرآن أو تؤثر فيه معانيه، فليتهم تقواه.
تفاعل
[48] ﴿وَإِنَّهُ لَتَذكِرَةٌ لِلمُتَّقينَ﴾ تأملوا من المستفيد؟ قل: «اللهم اجعلنا من المتقين».
الإعراب :
- ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ: ﴾
- الواو: استئنافية. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء يعود على القرآن ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» اللام لام التوكيد- المزحلقة- تذكرة: خبر «إن» مرفوع بالضمة أي لموعظة.
- ﴿ لِلْمُتَّقِينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لتذكرة. وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [48] لما قبلها : ولَمَّا أُبطِلَ طَعْنُهم في القرآنِ بأنَّه قولُ شاعرٍ، أو قولُ كاهنٍ؛ أُعقِبَ ببَيانِ شَرَفِه ونفْعِه؛ إمعانًا في إبطالِ كَلامِهم بإظهارِ الفرْقِ البَيِّنِ بيْنه وبيْن شِعرِ الشُّعراءِ وزَمزمةِ الكُهَّانِ؛ إذ هو تَذكرةٌ، وليس ما ألْحَقوه به مِن أقوالِ أولئك مِن التَّذكيرِ في شَيءٍ، قال تعالى:
﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [49] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴾
التفسير :
{ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ} به، وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين، فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة.
وقوله- تعالى-: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ تبكيت وتوبيخ لهؤلاء الكافرين، الذين جحدوا الحق بعد أن تبين لهم أنه حق.
أى: وإنا لا يخفى علينا أن منكم- أيها الكافرون- من هو مكذب للحق عن جحود وعناد، ولكن هذا لن يمنعنا من إرسال رسولنا بهذا الدين لكي يبلغه إليكم، ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر، وسنجازى كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب.
ثم قال ( وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) أي : مع هذا البيان والوضوح ، سيوجد منكم من يكذب بالقرآن .
قوله: ( وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ) يقول تعالى ذكره: وإنا لنعلم أن منكم مكذّبين أيها الناس بهذا القرآن،
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[49] ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾ سيظل التكذيب بالدين قائمًا، في زمن النبوة، وفي كل زمان بعد زمن النبوة، فهي سُنَّة ماضية، لكن هيهات أن يؤثِّر التكذيب، فأمركم أيها المكذِّبون معلوم، وعقابكم قادم.
وقفة
[49] ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾ علم الله أنَ مِن عباده من سيكذب به، لم يمنعه من توجيه التذكرة إليهم وإعادتها عليهم، وذلك لتقوم عليهم الحجة: ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42].
الإعراب :
- ﴿ وَإِنَّا: ﴾
- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» المدغمة ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرها.
- ﴿ لَنَعْلَمُ: ﴾
- اللام لام التوكيد- المزحلقة- نعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
- ﴿ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ: ﴾
- أعربت. منكم: جار ومجرور متعلق بخبر «أن» المقدم. مكذبين: اسم «أنّ» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. و «أنّ» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي «نعلم» وهو ايعاد على التكذيب. وقيل الخطاب للمسلمين. والمعنى: أنّ منهم ناسا سيكفرون بالقرآن. والميم في- منكم- علامة جمع الذكور.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [49] لما قبلها : وبعد بيان أن القرآن موعظة للمتقين؛ وَبَّخَ هنا الكافرين الذين كذبوا به، قال تعالى:
﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [50] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾
التفسير :
{ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ} فإنهم لما كفروا به، ورأوا ما وعدهم به، تحسروا إذ لم يهتدوا به، ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم الثواب، وحصلوا على أشد العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.
وقوله- سبحانه-: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ بيان لما يكون عليه الكافرون من ندم شديد، عند ما يرون حسن مصير المؤمنين، وسوء مصير المكذبين.
والحسرة: هي الندم الشديد المتكرر، على أمر نافع قد مضى ولا يمكن تداركه.
أى: وإن هذا القرآن الكريم، ليكون يوم القيامة، سبب حسرة شديدة وندامة عظيمة، على الكافرين، لأنهم يرون المؤمنين به في هذا اليوم في نعيم مقيم، أما هم فيجدون أنفسهم في عذاب أليم.
ثم قال : ( وإنه لحسرة على الكافرين ) قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتادة بمثله .
وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي ، عن أبي مالك : ( وإنه لحسرة على الكافرين ) يقول : لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن ، أي : وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين ، كما قال : ( كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به ) [ الشعراء : 200 ، 201 ] ، وقال تعالى : ( وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) [ سبأ : 54 ] ولهذا قال هاهنا :
( وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ) يقول جلّ ثناؤه: وأن التكذيب به لحسرة وندامة على الكافرين بالقرآن يوم القيامة
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ): ذاكم يوم القيامة.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[50] ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ القرآن حسرة على الكافرين، إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين، أو في الدنيا إذا رأوا إقرار الحق وإزهاق الباطل، فالحسرة إما هنا وإما هناك.
وقفة
[50] ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ سيغدو القرآن حسرة علي المكذبين به، تفري قلوبهم فريًا لما يرون من ثواب من آمن به واهتدي بهداه.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الثامنة والأربعين وتعرب اعرابها. أي على الكافرين به المكذبين له اذا رأوا ثواب المصدقين به.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [50] لما قبلها : وبعد توبيخ الكافرين الذين كذبوا بالقرآن؛ بَيَّنَ هنا ما يكون عليه الكافرون من ندم شديد، عندما يرون حسن مصير المؤمنين، وسوء مصير المكذبين، قال تعالى:
﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [51] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾
التفسير :
{ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} أي:أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين وهو العلم الثابت، الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها:أولها:علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن الكريم، بهذا الوصف، فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية، وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية، يحصل به لمن ذاقه حق اليقين.
وقوله: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ معطوف على ما قبله، أى: وإن هذا القرآن لهو الحق الثابت الذي لا شك في كونه من عند الله- تعالى- وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغه إلى الناس دون أن يزيد فيه حرفا، أو ينقص منه حرفا.
وإضافة الحق إلى اليقين، من إضافة الصفة إلى الموصوف. أى: لهو اليقين الحق، أو هو من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، كما في قوله: حَبْلِ الْوَرِيدِ، إذ الحبل هو الوريد.
والمقصود من مثل هذا التركيب: التأكيد.
وقد قالوا: إن مراتب العلم ثلاثة: أعلاها: حق اليقين، ويليها: عين اليقين، ويليها:
علم اليقين.
فحق اليقين: كعلم الإنسان بالموت عند نزوله به، وبلوغ الروح الحلقوم. وعين اليقين:
كعلمه به عند حلول أماراته وعلاماته الدالة على قربه.. وعلم اليقين: كعلمه بأن الموت سينزل به لا محالة مهما طال الأجل..
( وإنه لحق اليقين ) أي : الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب .
( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) يقول: وإنه للحقّ اليقين الذين لا شكّ فيه أنه من عند الله، لم يتقوّله محمد صلى الله عليه وسلم.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[51] ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ في الآية إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يسعي دائمًا للارتقاء في معرفة الحق ورعاية الإيمان حتى يكون مشاهِدًا للغيب كمشاهدة المرئيات.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾
- تعرب اعراب الآية الكريمة السابقة. أي اليقين الذي لا شك فيه. أو ان القرآن لليقين حق اليقين. والمعنى: لعين اليقين ومحض اليقين. واليقين:مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [51] لما قبلها : وبعد بيان أن القرآن موعظة للمتقين؛ زاد هنا أن القرآن هو الحقُّ الثابت الذي لا شك في كونه من عند الله، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد بلغه إلى النَّاس دون أن يزيد فيه حرفًا، أو ينقص منه حرفًا، قال تعالى:
﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [52] :الحاقة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾
التفسير :
{ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} أي:نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. تم تفسير سورة الحاقة، والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، على كماله وأفضاله وعدله.
والفاء في قوله- تعالى- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
للإفصاح. أى: إذا كان الأمر كما ذكرنا لك من أن هذا الدين حق، وأن البعث حق، وأن القرآن حق، فنزه اسم ربك العظيم عما لا يليق به، من النقائص، في الاعتقاد، أو في العبادة، أو في القول، أو في الفعل.
والباء في قوله: بِاسْمِ رَبِّكَ للمصاحبة. أى: نزه ربك تنزيها مصحوبا بكل ما يليق به من طاعة وإخلاص ومواظبة على مراقبته وتقواه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم قال : ( فسبح باسم ربك العظيم ) أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . [ آخر تفسير سورة " الحاقة " ، ولله الحمد ]
( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) بذكر ربك وتسميته العظيم، الذي كلّ شيء في عظمته صغير.
التدبر :
تفاعل
[52] ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قل: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» 100 مرة.
وقفة
[52] ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ داوم على ذكره، وادأب على الدعوة إليه، وبلغ ما أوحي إليك، ولا تفتر عن عبادته، وهذا الأمر لنبيه، ويسري على أمته.
وقفة
[52] ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال الرازي عن هدف التسبيح: «إما شكرًا على ما جعلك أهلًا لإيحائه إليك، وإما تنزيهًا له عن الرضا بأن يُنسب إليه الكاذب من الوحي ما هو بريء عنه».
عمل
[52] ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ سئل علي عن كلمة التسبيح (سبحان الله)، قال: «كلمةٌ رضيها اللهُ لنفسه، فأوصى بها خَلقه»؛ فأكثر من التسبيح عملًا بوصية الرب الكريم.
الإعراب :
- ﴿ فَسَبِّحْ: ﴾
- الفاء: استئنافية. سبح: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ بِاسْمِ رَبِّكَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بسبح. ربك: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ الْعَظِيمِ: ﴾
- صفة- نعت- للرب أو اسمه مجرور وعلامة جره الكسرة. أي فسبح الله أي نزهه عن النقص وقدسه بذكر اسمه العظيم وهو قولك سبحان الله واعبده واشكره شكرا على ما أهلك له من ايحائه اليك'
المتشابهات :
| الواقعة: 74 | ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ |
|---|
| الواقعة: 96 | ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ |
|---|
| الحاقة: 52 | ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [52] لما قبلها : وبعد ما تقدم من وصف القرآن، وتنزيهه على المطاعن، وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عما افتراه عليه المشركون؛ أمَرَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بأن يسبح الله تسبيح ثناء وتعظيم؛ شكرًا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة، وإنزال هذا القرآن عليه، قال تعالى:
﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾
التفسير :
يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين، واستعجالهم لعذاب الله، استهزاء وتعنتا وتعجيزا:
{ سَأَلَ سَائِلٌ} أي:دعا داع، واستفتح مستفتح{ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ}
تفسير سورة المعارج
مقدمة وتمهيد
1- سورة (المعارج) هي السورة السبعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثامنة والسبعون، وكان نزولها بعد سورة (الحاقة) وقبل سورة (النبأ) .
وتسمى- أيضا- بسورة (سأل سائل) ، وذكر السيوطي في كتابه (الإتقان) أنها تسمى كذلك بسورة (الواقع) .
وهذه الأسماء الثلاثة قد وردت ألفاظها في السورة الكريمة. قال- تعالى- سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ. لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ.
وهي من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها أربع وأربعون آية في عامة المصاحف، وفي المصحف الشامي ثلاث وأربعون آية.
والسورة الكريمة نراها في مطلعها، تحكى لنا جانبا من استهزاء المشركين بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من بعث وثواب وعقاب.. وترد عليهم بما يكبتهم، حيث تؤكد أن يوم القيامة حق، وأنه واقع، وأن أهواله شديدة.
قال- تعالى- سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ. لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ. تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً. وَنَراهُ قَرِيباً. يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ. وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً.
3- ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى تصوير طبيعة الإنسان، وتمدح المحافظين على صلاتهم، وعلى أداء حقوق الله- تعالى- في أموالهم، كما تمدح الذين يؤمنون بأن البعث حق،ويستعدون لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح.
قال- تعالى- إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ.
4- ثم أخذت السورة الكريمة في أواخرها في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي توبيخ الكافرين على مسالكهم الخبيثة بإزاء الدعوة الإسلامية، وفي بيان أن يوم القيامة الذي يكذبون به آت لا ريب فيه.
قال- تعالى-: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ.
5- هذا والمتدبر في هذه السورة الكريمة، يرى أن على رأس القضايا التي اهتمت بالحديث عنها: التذكير بيوم القيامة، وبأهواله وشدائده، وببيان ما فيه من حساب، وجزاء، وثواب وعقاب.
والحديث عن النفس الإنسانية بصفة عامة في حال عسرها ويسرها، وصحتها ومرضها، وأملها ويأسها ... واستثناء المؤمنين الصادقين، من كل صفة لا يحبها الله- تعالى- وأنهم بسبب إيمانهم الصادق، وعملهم الصالح، سيكونون يوم القيامة. في جنات مكرمين.
كما أن السورة الكريمة اهتمت بالرد على الكافرين، وبتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما لحقه منهم، وببيان مظاهر قدرة الله- تعالى- التي لا يعجزها شيء.
وقوله- تعالى- سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ قرأه الجمهور بإظهار الهمزة في سَأَلَ.
وقرأه نافع وابن عامر سَأَلَ بتخفيف الهمزة.
قال الجمل: قرأ نافع وابن عامر بألف محضة، والباقون، بهمزة محققة وهي الأصل.
فأما القراءة بالألف ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بمعنى قراءة الهمزة، وإنما خففت بقلبها ألفا. والثاني: أنها من سال يسال، مثل خاف يخاف، والألف منقلبة عن واو، والواو منقلبة عن الهمزة.
والثالث: من السيلان، والمعنى: سال واد في جهنم بعذاب، فالألف منقلبة عن ياء .
وقد حكى القرآن الكريم عن كفار مكة، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم والاستهزاء عن موعد العذاب الذي يتوعدهم به إذا ما استمروا على كفرهم، ويستعجلون وقوعه.
قال- تعالى-: وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وقال- سبحانه- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ.
وعلى هذا يكون السؤال على حقيقته، وأن المقصود به الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين.
ومنهم من يرى أن سأل هنا بمعنى دعا. أى: دعا داع على نفسه بعذاب واقع.
قال الآلوسى ما ملخصه: سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ أى: دعا داع به، فالسؤال بمعنى الدعاء، ولذا عدى بالباء تعديته بها في قوله يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ. والمراد:
استدعاء العذاب وطلبه.. وقيل إنها بمعنى «عن» كما في قوله: فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً.
والسائل هو النضر بن الحارث- كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم- حيث قال إنكارا واستهزاء «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم» . وقيل السائل: أبو جهل، حيث قال: «فأسقط علينا كسفا من السماء» .
وعلى أية حال فسؤالهم عن العذاب، يتضمن معنى الإنكار والتهكم، كما يتضمن معنى الاستعجال، كما حكته بعض الآيات الكريمة..
ومن بلاغة القرآن، تعدية هذا الفعل هنا بالباء، ليصلح لمعنى الاستفهام الإنكارى، ولمعنى الدعاء والاستعجال.
أى: سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تهكم، عن العذاب الذي توعد به الكافرين إذا ما استمروا على كفرهم. وتعجّله في وقوعه بل أضاف إلى ذلك- لتجاوزه الحد في عناده وطغيانه- أن قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» .
وقال- سبحانه- بِعَذابٍ واقِعٍ ولم يقل بعذاب سيقع، للإشارة إلى تحقق وقوع هذا العذاب في الدنيا والآخرة.
أما الدنيا فمن هؤلاء السائلين من قتل في غزوة بدر وهو النضر بن الحارث، وأبو جهل وغيرهما، وأما في الآخرة فالعذاب النازل بهم أشد وأبقى.
تفسير سورة سأل سائل وهي مكية .
( سأل سائل بعذاب واقع ) فيه تضمين دل عليه حرف " الباء " ، كأنه مقدر : يستعجل سائل بعذاب واقع . كقوله : ( ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ) أي : وعذابه واقع لا محالة .
قال النسائي : حدثنا بشر بن خالد ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ( سأل سائل بعذاب واقع ) قال : النضر بن الحارث بن كلدة .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( سأل سائل بعذاب واقع ) قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : تعالى ) سأل سائل ) دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة ، قال : وهو قولهم : ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) [ الأنفال : 32 ] .
وقال ابن زيد وغيره : ( سأل سائل بعذاب واقع ) أي : واد في جهنم ، يسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف ، بعيد عن المراد . والصحيح الأول لدلالة السياق عليه .
القول في تأويل قوله تعالى : سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1)
قال أبو جعفر: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( سَأَلَ سَائِلٌ )، فقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة: ( سَأَلَ سَائِلٌ ) بهمز سأل سائل، بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب الله، بمن هو واقع، وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة ( سالَ سَائِلٌ ) فلم يهمز سأل، ووجهه إلى أنه فعل من السيل.
والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه بالهمز؛ لإجماع الحجة من القرّاء على ذلك، وأن عامة أهل التأويل من السلف بمعنى الهمز تأوّلوه.
* ذكر من تأوّل ذلك كذلك، وقال تأويله نحو قولنا فيه:
حدثني محمد بن سعيد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) قال: ذاك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، عن مجاهد إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ... الآية، قال ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ).
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( سَأَلَ سَائِلٌ ) قال: دعا داع، ( بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) قال: يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) قال: سأل عذاب الله أقوام، فبين الله على من يقع؛ على الكافرين.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( سَأَلَ سَائِلٌ ) قال: سأل عن عذاب واقع، فقال الله: ( لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ).
وأما الذين قرءوا ذلك بغير همز، فإنهم قالوا: السائل واد من أودية جهنم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله الله: ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) قال: قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنم يقال له سائل.
وقوله: ( بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرينَ ) يقول: سأل بعذاب للكافرين واجب لهم يوم القيامة واقع بهم، ومعنى ( لِلْكَافِرِينَ ) على الكافرين، كالذي حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت
التدبر :
وقفة
[1] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ قد يكون من الحكمة عدم ذكر اسم مثير الشبهة عند ذكر شبهته؛ تجاهلًا له، وصرفًا لأنظار الناس عنه!
وقفة
[1] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ سؤال المشركين عن العذاب يتضمن ثلاثة معاني: الإنكار، والتهكم، والاستعجال، فهو سؤال الجهال لا سؤال استفهام واستعلام.
تفاعل
[1] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.
لمسة
[1] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ في الآية تضمين دل عليه حرف (الباء) كأنه مقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع كقوله: ﴿ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده﴾ [الحج: 47] أي: وعذابه واقع لا محالة.
الإعراب :
- ﴿ سَأَلَ سائِلٌ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح. سائل: فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ بِعَذابٍ واقِعٍ: ﴾
- عدي الفعل بالباء الزائدة للتوكيد. و «عذاب» مفعول الفعل لأنه على معنى دعا فعدي تعديته أي في «سأل» معنى «دعا» أي استدعاه وطلبه وقيل: الباء للسببية لأنه بعد سؤال أو بمعنى «عن» وهي باء المجاوزة أي عن عذاب. واقع: صفة- نعت- لعذاب مجرورة وعلامة جرها الكسرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿سَألَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ﴾ نَزَلَتْ في النَّضْرِ بْنِ الحارِثِ حِينَ قالَ: اللَّهُمَّ إنْ كانَ هَذا هو الحَقَّ مِن عِنْدِكَ. فَدَعا عَلى نَفْسِهِ وسَألَ العَذابَ، فَنَزَلَ بِهِ ما سَألَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقُتِلَ صَبْرًا، ونَزَلَ فِيهِ: ﴿سَألَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ﴾ . الآيَةَ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بطلبِ كُفَّارِ مَكَّةَ تعجيلَ العذابِ استهزاءً، وهو واقعٌ بهم لا محالةَ، قال تعالى:
﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
سأل:
1- بالهمز، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- سال، بألف، وهى قراءة نافع، وابن عامر.
مدارسة الآية : [2] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾
التفسير :
[لِلْكَافِرينَ} لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم{ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ} أي:ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل، من متمردي المشركين، أحد يدفعه قبل نزوله، أو يرفعه بعد نزوله، وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المشركينفقال:{ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم} إلى آخر الآيات.
ثم وصف- سبحانه- العذاب بصفات أخرى، غير الوقوع فقال: لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ. واللام في قوله لِلْكافِرينَ بمعنى على. أو للتعليل.
أى: سأل سائل عن عذاب واقع على الكافرين، هذا العذاب ليس له دافع يدفعه عنهم، لأنه واقع من الله- تعالى- ذِي الْمَعارِجِ.
وقوله : ( واقع للكافرين ) أي : مرصد معد للكافرين .
وقال ابن عباس : ( واقع ) جاء ) ليس له دافع ) أي : لا دافع له إذا أراد الله كونه ; ولهذا قال
الضحاك يقول في قوله: ( بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرينَ ) يقول: واقع على الكافرين، واللام في قوله: ( لِلْكَافِرِينَ ) من صلة الواقع.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[2] ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ السورة تحكي أن هناك سائلًا سأل وقوع العذاب واستعجله، وتُقرِّر أن هذا العذاب واقع فعلًا، لأنه كائن في تقدير الله من جهة، ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى، وأن أحدًا لا يمكنه دفعه ولا منعه، فالسؤال عنه واستعجاله -وهو واقع ليس له من دافع- يبدو تعاسة من السائل المستعجل، فردًا كان أو مجموعة.
تفاعل
[2] ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ لِلْكافِرينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة ثانية لعذاب. أي كائن للكافرين أو متعلق بالفعل أي دعا للكافرين بعذاب واقع. أو بواقع: أي بعذاب نازل لاجلهم جاء في التفسير: السائل هو نصر بن الحارث فانه قال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم وقيل بل هو أبو جهل، قال: فأسقط علينا كسفا من السماء. وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين الحركة في المفرد.
- ﴿ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر صفة أخرى لعذاب. ليس: فعل ماض ناقص مبني على الفتح من أخوات كان» له: جار ومجرور متعلق بخبرها المقدم. دافع: اسم «ليس» مرفوع بالضمة. أي اذا جاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن العذابَ واقعٌ؛ ذكرَ هنا مَن يختصُّ بهذا العذابِ الواقعِ، قال تعالى:
﴿ لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾
التفسير :
فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا، وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة، فلو عرفوا الله تعالى، وعرفوا عظمته، وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته، لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبوا، ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال:{ ذِي الْمَعَارِجِ}
والمعارج جمع معرج، وهو المصعد، ومنه قوله- تعالى- وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً، لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ .
وقد ذكر المفسرون في المراد بالمعارج وجوها منها: أن المراد بها السموات، فعن ابن عباس أنه قال أى: ذي السموات، وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها.
ومنها: أن المراد بها: النعم والمنن. فعن قتادة أنه قال: ذي المعارج، أى: ذي الفواضل والنعم. وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب، وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة.
ومنها: أن المراد بها الدرجات التي يعطيها لأوليائه في الجنة.
وفي وصفه- سبحانه- ذاته ب ذِي الْمَعارِجِ: استحضار لصورة عظمة جلاله، وإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه، فإن المعارج من خصائص منازل العظماء.
فأنت ترى أن الله- تعالى- قد وصف هذا العذاب الواقع على الكافرين. بجملة من الصفات، لتكون ردا فيه ما فيه من التهديد والوعيد للجاحدين، الذين استهزءوا به وأنكروه.
(من الله ذي المعارج ) قال الثوري ، عن الأعمش عن رجل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ( ذي المعارج ) قال : ذو الدرجات .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( ذي المعارج ) يعني : العلو والفواضل .
وقال مجاهد : ( ذي المعارج ) معارج السماء . وقال قتادة : ذي الفواضل والنعم .
وقوله: ( لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ) يقول تعالى ذكره: ليس للعذاب الواقع على الكافرين من الله دافع يدفعه عنهم.
وقوله: ( ذِي الْمَعَارِجِ ) يعني: ذا العلوّ والدرجات والفواضل والنعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( ذِي الْمَعَارِجِ ) يقول: العلوّ والفواضل.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ): ذي الفواضل والنِّعم.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ) قال: معارج السماء.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( ذِي الْمَعَارِجِ ) قال: الله ذو المعارج.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( ذِي الْمَعَارِجِ ) قال: ذي الدرجات.
التدبر :
وقفة
[3] ﴿مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ صفة لله ﷻ، أي من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، وفي الصحيح لبيك ذَا المعارج.
وقفة
[3] ﴿الْمَعَارِجِ﴾ ثلاثة معانِ! المراد بها: 1- السموات، وسماها معارج؛ لأن الملائكة يعرجون فيها. 2- النَّعَم والمنن؛ لأن وجوه إنعامه مراتب، وتصل إلى الناس على مراتب مختلفة. 3- الدرجات التي يعطيها الله لأوليائه في الجنة.
الإعراب :
- ﴿ مِنَ اللَّهِ: ﴾
- جار ومجرور للتعظيم متعلق بواقع أو بدافع. بمعنى ليس له دافع من جهته.
- ﴿ ذِي الْمَعارِجِ: ﴾
- صفة- نعت- للفظ الجلالة مجرورة وعلامة جرها الياء لأنها من الاسماء الخمسة وهي مضافة. المعارج: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا كأنَّ قائلًا قالَ: مِمَّن هذا العذابُ الواقعُ؟؛ قيل:
﴿ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي .. ﴾
التفسير :
[ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} أي:ذو العلو والجلال والعظمة، والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرهاعلى تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها، برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة، فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لها من سماء إلى سماء، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه، وتحظى بقربه، وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام.
وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها، وأعيدت إلى الأرض.
ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة والأرواحوأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب، وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها، وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى، فهذا الملك العظيم، والعالم الكبير، علويه وسفليه، جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه، ما عمهم وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري، وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي.
فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته، ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان، وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم.
هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية [الكريمة] فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا، لأن السياق الأول يدل على هذا.
ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه، ما هو أكبر دليل على معرفته، مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة، بالتدابير الإلهية، والشئون في الخليقة
في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن.
والمراد بالروح في قوله: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ: جبريل- عليه السلام- وأفرد بالذكر لتمييزه وفضله، فهو من باب عطف الخاص على العام.
والضمير في «إليه» يعود إلى الله- تعالى-.
أى: تصعد الملائكة وجبريل- عليه السلام- معهم، إليه- تعالى-.
والسلف على أن هذا التعبير وأمثاله، من المتشابه الذي استأثر- سبحانه- بعلمه. مع تنزيهه- عز وجل- عن المكان والجسمية. ولوازم الحدوث، التي لا تليق بجلاله.
وقيل: «إليه» أى: إلى عرشه- تعالى- أو إلى محل بره وكرامته.
قال القرطبي ما ملخصه: قوله: فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ أى: عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد، خمسين ألف سنة.
وعن مجاهد: هذا اليوم هو مدة عمر الدنيا، من أول ما خلقت إلى آخر ما بقي منها، خمسون ألف سنة.
وقال ابن عباس: هو يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة.
ثم قال القرطبي: «وهذا القول أحسن ما قيل في الآية- إن شاء الله- بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ، فقلت: ما أطول هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده، إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» .
وفي رواية عن ابن عباس- أيضا- أنه سئل عن هذه الآية فقال: أيام سماها الله- عز وجل-، وهو أعلم بها كيف تكون وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم.
وقيل: ذكر خمسين ألف سنة تمثيل- لما يلقاه الناس في موقف الحساب من شدائد، والعرب تصف أيام الشدة بالطول، وأيام الفرح بالقصر .
وقال بعض العلماء: وقد ذكر- سبحانه- في سورة السجدة أنه يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.
وقال في سورة الحج: وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وذكر هنا فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.
والجمع بين هذه الآيات من وجهين: أولهما: ما جاء عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج، هو أحد الأيام الستة التي خلق الله- تعالى- فيها السموات والأرض.
ويوم الألف في سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه- تعالى-.
ويوم الخمسين ألفا هنا: هو يوم القيامة.
وثانيهما: أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر.
ويدل لهذا الوجه قوله- تعالى-: فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ .
وقوله : ( تعرج الملائكة والروح إليه ) قال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( تعرج ) تصعد .
وأما الروح ، فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس ، وليسوا أناسا .
قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ، ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم ، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء ، كما دل عليه حديث البراء . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المنهال ، عن زاذان ، عن البراء مرفوعا - الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة - قال فيه : " فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة " . والله أعلم بصحته ، فقد تكلم في بعض رواته ، ولكنه مشهور ، وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن يسار عنه ، وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة ، وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) [ إبراهيم : 27 ] .
وقوله : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) فيه أربعة أقوال :
أحدهما : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين ، وهو قرار الأرض السابعة ، وذلك مسيرة خمسين ألف سنة ، هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة ، وأنه من ياقوتة حمراء ، كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية :
حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا حكام ، عن عمر بن معروف ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قوله : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقدار خمسين ألف سنة ، ويوم كان مقداره ألف سنة : يعني بذلك : تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ، ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة ; لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة .
وقد رواه ابن جرير ، عن ابن حميد ، عن حكام بن سلم ، عن عمر بن معروف ، عن ليث ، عن مجاهد قوله ، لم يذكر ابن عباس .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد الطنافسي ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا نوح المؤدب ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض خمسمائة عام ، وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام ، فذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء خمسمائة عام ، وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام ، فذلك أربعة عشر ألف عام ، وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام ، فذلك قوله : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )
القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة ، قال ابن أبي حاتم :
حدثنا أبو زرعة ، أخبرنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة . وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم ، ( تعرج الملائكة والروح إليه في يوم ) قال : اليوم : الدنيا .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد - وعن الحكم بن أبان ، عن عكرمة : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة ، لا يدري أحد كم مضى ، ولا كم بقي إلا الله ، عز وجل .
القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة ، وهو قول غريب جدا . قال ابن أبي حاتم :
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا بهلول بن المورق ، حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني محمد بن كعب : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة .
القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة ، قال ابن أبي حاتم :
حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : يوم القيامة . هذا وإسناده صحيح . ورواه الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) يوم القيامة . وكذا قال الضحاك وابن زيد .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : فهذا يوم القيامة ، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .
وقد وردت أحاديث في معنى ذلك ، قال الإمام أحمد :
حدثنا الحسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا " .
ورواه ابن جرير ، عن يونس ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج به ، إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان ، والله أعلم .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة عن أبي عمرو الغداني قال : كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له : هذا أكثر عامري مالا ، فقال أبو هريرة : ردوه فقال : نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامري : إي والله ، إن لي لمائة حمرا ومائة أدما ، حتى عد من ألوان الإبل ، وأفنان الرقيق ، ورباط الخيل ، فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم - يردد ذلك عليه ، حتى جعل لون العامري يتغير - فقال : ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها - قلنا : يا رسول الله : ما نجدتها ورسلها ؟ قال : " في عسرها ويسرها - " فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ، حتى يبطح لها بقاع قرقر ، فتطؤه بأخفافها ، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ، وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها ، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ، حتى يبطح لها بقاع قرقر ، فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها ، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره ، حتى يبطح لها بقاع قرقر ، فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ، ليس فيها عقصاء ولا عضباء ، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين الناس ، فيرى سبيله " . قال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة ، وتفقر الظهر ، وتسقي اللبن وتطرق الفحل .
وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به .
طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره ، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " . وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم ، وفيه : " الخيل لثلاثة ; لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر " إلى آخره .
ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه ، عن أبي هريرة وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة في " الأحكام " ، والغرض من إيراده هاهنا قوله : " حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " .
وقد روى ابن جرير ، عن يعقوب ، عن ابن علية وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة قال : سأل رجل ابن عباس عن قوله : ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : فاتهمه ، فقيل له فيه ، فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال : إنما سألتك لتحدثني . قال : هما يومان ذكرهما الله ، الله أعلم بهما ، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم .
وقوله: ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح، وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله جلّ وعزّ، والهاء في قوله: ( إِلَيْهِ ) عائدة على اسم الله، ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) يقول: كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره، من فوق السموات السبع.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عمرو بن معروف، عن ليث، عن مجاهد ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) قال: منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة؛ ويوم كان مقداره ألف سنة، يعني بذلك نـزول الأمر من السماء إلى الأرض، ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره ألف سنة، لأن ما بين السماء إلى الأرض، مسيرة خمس مئة عام.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه، كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين ألف سنة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرِمة ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) قال: في يوم واحد يفرغ في ذلك اليوم من القضاء كقدر خمسين ألف سنة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) قال: يوم القيامة.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن عكرمة في هذه الآية ( خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) قال: يوم القيامة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) : ذاكم يوم القيامة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال معمر: وبلغني أيضا، عن عكرِمة، في قوله: ( مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ): لا يدري أحدٌ كم مضى، ولا كم بقي إلا الله.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) فهذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ): يعني يوم القيامة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) قال: هذا يوم القيامة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن درّاجا حدّثه عن أبي الهيثم عن سعيد، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) ما أطول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلى المُؤْمِنِ حتى يَكُونَ أخَفَّ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ يُصَلِّيها فِي الدُّنْيا ".
وقد رُوي عن ابن عباس في ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه، وذلك ما:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن رجلا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال: إنما سألتك لتخبرني، قال: هما يومان ذكرهما الله في القرآن، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، قال: فاتهمه، فقيل له فيه، فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال: إنما سألتك لتخبرني، فقال: هما يومان ذكرهما الله جلّ وعزّ، الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم؛ وقرأت عامة قرّاء الأمصار قوله: ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ ) بالتاء خلا الكسائي، فإنه كان يقرأ ذلك بالياء بخبر كان يرويه عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك كذلك.
والصواب من قراءة ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار، وهو بالتاء لإجماع الحجة من القرّاء عليه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿في يَومٍ كانَ مِقدارُهُ خَمسينَ أَلفَ سَنَةٍ﴾ رقم يصيب المرء بالدوار.
وقفة
[4] ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ سبحان من خلق الزمان وأفلاكه، والمكان وأبعاده!
وقفة
[4] ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ قال ابن عباس: «هو يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة»، فما أطول ذلك اليوم على الخلق! وما أقصره على المؤمنين!
الإعراب :
- ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل نصب حال من «المعارج» أي المصاعد وقيل السماء. تعرج فعل مضارع مرفوع بالضمة. الملائكة: فاعل مرفوع بالضمة أي تصعد.
- ﴿ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «الملائكة» مرفوعة مثلها بالضمة. والروح هو حبريل عليه السلام وقد أفرد لتميزه بفضله. وقيل الروح خلق هم حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على الناس. إليه: جار ومجرور متعلق بتعرج. أي الى عرشه سبحانه.
- ﴿ فِي يَوْمٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بواقع أي يقع في يوم طويل وهو يوم القيامة.
- ﴿ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر صفة- نعت- ليوم: كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح مقداره اسم «كان» مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. خمسين: خبر «كان» منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من تنوين المفرد. أي كان مقداره كمقدار مدة خمسين ألف سنة مما يعد الناس.
- ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ: ﴾
- تمييز منصوب بالفتحة. سنة: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.'
المتشابهات :
| السجدة: 5 | ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ |
|---|
| المعارج: 4 | ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد ذكرِ اللهِ ذي العلو والدرجات؛ بَيَّنَ هنا مقدارَ ارتفاعِ تلك الدرجات، قال تعالى:
﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تعرج:
1- بالتاء، على التأنيث، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بالياء، وهى قراءة عبد الله، والكسائي، وابن مقسم، وزائدة، عن الأعمش.
مدارسة الآية : [5] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾
التفسير :
{ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا} أي:اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا، لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله، وادع عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم، وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا.
أى: أن يوم القيامة يتفاوت طوله بحسب اختلاف الشدة، فهو يعادل في حالة ألف سنة من سنى الدنيا، ويعادل في حالة أخرى خمسين ألف سنة.
وقوله- تعالى-: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً. وَنَراهُ قَرِيباً.. متفرع على قوله- سبحانه- سَأَلَ سائِلٌ لأن السؤال كان سؤال استهزاء، يضيق به الصدر، وتغتم له النفس.
والصبر الجميل: هو الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله- عز وجل- ولا يخالطه شيء من الجزع، أو التبرم بقضاء الله وقدره.
أى: لقد سألوك- أيها الرسول الكريم- عن يوم القيامة، وعن العذاب الذي تهددهم به ... سؤال تهكم واستعجال.. فاصبر صبرا جميلا على غرورهم وجحودهم وجهالاتهم.
إنهم يرون هذا اليوم وما يصحبه من عذاب.. يرونه «بعيدا» من الإمكان أو من الوقوع، ولذلك كذبوا بما جئتهم به من عندنا، واستهزؤا بك.. ونحن نراه قريبا من الإمكان، بل هو كائن لا محالة في الوقت الذي تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.
وقوله : ( فاصبر صبرا جميلا ) أي : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك ، واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه ، كقوله : ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ) [ الشورى : 18 ]
وقوله: ( فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا )يقول تعالى ذكره: ( فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا )يعني: صبرا لا جزع فيه. يقول له: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك، ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة.
وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا ) قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم، فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدّة والقتل حتى يتركوا، ونسخ هذا، وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الآية، ثم نسخ ذلك قول لا وجه له، لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصحّ منها الدعاوى، وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا منه له به في بعض الأحوال؛ بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوال، لأنه لم يزل صلى الله عليه وسلم من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم، وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم، وبعد إذنه له بذلك.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ﴾ أي: على أذاهم، ولا ينفك ذلك عن تبليغهم؛ فإنك شارفت وقت الانتقام منهم أيها الفاتح الخاتم الذي لم أبين لأحد ما بينت على لسانه، والصبر: حبس النفس على المكروه.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ لا يصاحبه تشكِّي للمخلوقين، ولا شكوى -لغير الله- من أذى المكذِّبين، والداعية لا يُحمِّل الخلق سبب تقصيره، فلم يُكلَّف بهدايتهم!
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ يعني: صبرًا لا جزع فيه.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ دعوات الأنبياء قائمة على الصبر والعفو والحب والإحسان، التربية التي تقتات على الحقد لا تمت لدعوتهم بصلة.
عمل
[5] ﴿فَاصبِر صَبرًا جَميلًا﴾ ابحث كيف يكون الصبر جميلًا، وطبق على نفسك.
عمل
[5] ﴿فَاصبِر صَبرًا جَميلًا﴾ ليكن صبرك جميلًا، مليئًا بالرضا، قانعًا بما رزقكِ الله من ابتلاء.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ حتى الأفعال القاسية لابد أن يكسوها جمال، كل ذلك من جمال القرآن.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ اﻟﺼﺒﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﺃﺣﺪ بأﻧّﻪ ﻣُﺼﺎﺏ.
تفاعل
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ قل: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت».
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ الصبر الجميل هو الصبر المطمئن، الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد، صبر الواثق من العاقبة، الراضي بقدر الله، الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء، الموصول بالله المحتسب كل شيء عنده مما يقع به، وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ ما من عقل سوي إلا وهو يحب الشيء الجميل.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ الصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى مخلوق، ولهذا قُرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: إن طاووسًا -طاووس بن كيسان علم من أعلام التابعين- كان يكره أنين المريض، ويقول: إنه شكو ، فما أنَّ أحمد حتى مات، وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: ﴿فصبر جميل﴾ [يوسف: 18]، وقال: ﴿إنما أشكو بثي وحزني إلى الله﴾ [يوسف: 86].
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ بسمتك جميلة في الأفراح، وأعذب وأجمل منها بسمتك عندما تهب العواصف.
وقفة
[5] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ خير ما يتسلَّح به المسلم سلاحُ الصبر؛ لثقل العِبء، ومشقة الطريق، وضرورة الثبات لبلوغ الهدف البعيد، يتجلَّى جمال الصبر بسكون الظاهر؛ بالثبات ورباطة الجأش، وبسكون الباطن؛ بالرضا والتسليم، وبرد اليقين.
وقفة
[5] فى أصعب اللحظات يريدك الله أن تكون جميلًا: ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾، ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾، ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾.
وقفة
[5] في أصعب اللحظات وأثقلها يريدك الله أن تكون جميلًا ﴿فاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَاصْبِرْ: ﴾
- الفاء سببية. لأن سؤال السائل كان على وجه الاستهزاء بالرسول الكريم والتكذيب بالوحي. اصبر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ صَبْراً جَمِيلًا: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- منصوب بالفتحة. جميلا: صفة- نعت- لصبرا منصوبة بالفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا كان الكفَّارُ قد سألوا استِعجالَ العذابِ، وكان السُّؤالُ على سبيلِ الاستهزاءِ والتَّكذيبِ، وكانوا قد وُعِدوا به؛ أمَرَ اللهُ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ، قال تعالى:
﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾
التفسير :
{ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا} الضمير يعود إلى البعث الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب أي:إن حالهم حال المنكر له، أو الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة، حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبا، لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب.
وقوله- تعالى-: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً. وَنَراهُ قَرِيباً.. متفرع على قوله- سبحانه- سَأَلَ سائِلٌ لأن السؤال كان سؤال استهزاء، يضيق به الصدر، وتغتم له النفس.
والصبر الجميل: هو الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله- عز وجل- ولا يخالطه شيء من الجزع، أو التبرم بقضاء الله وقدره.
أى: لقد سألوك- أيها الرسول الكريم- عن يوم القيامة، وعن العذاب الذي تهددهم به ... سؤال تهكم واستعجال.. فاصبر صبرا جميلا على غرورهم وجحودهم وجهالاتهم.
إنهم يرون هذا اليوم وما يصحبه من عذاب.. يرونه «بعيدا» من الإمكان أو من الوقوع، ولذلك كذبوا بما جئتهم به من عندنا، واستهزؤا بك.. ونحن نراه قريبا من الإمكان، بل هو كائن لا محالة في الوقت الذي تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.
قال : ( إنهم يرونه بعيدا ) أي : وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع ، بمعنى مستحيل الوقوع
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6)
يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين يرون العذاب الذي سألوا عنه، الواقع عليهم، بعيدا وقوعه، وإنما أخبر جلّ ثناؤه أنهم يرون ذلك بعيدا، لأنهم كانوا لا يصدّقون به، وينكرون البعث بعد الممات، والثواب والعقاب
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[6، 7] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ والله يراه قريبًا؛ لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب.
وقفة
[6، 7] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ كلما زاد الإيمان في قلبك، أيقنت بقرب الفرج من ربك.
وقفة
[6، 7] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ اليقينُ باليومِ الآخرِ وشدَّةِ قربِه يدعو أهلَ الإيمانِ للعملِ.
وقفة
[6، 7] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ أهل الغفلة لا يفتؤون يستبعدون الموت والحساب، وكأنَّ حياتهم سرمديةٌ لا نهاية لها، ولكن ما أسرعَ الموت في طيِّهم، وجعلهم خبرًا من الأخبار!
وقفة
[6، 7] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ المسافة واحدة والرؤية مختلفة، وعلى قدر الرؤية يكون العمل أو الأمل.
وقفة
[6: 7] ﴿إِنَّهُم يَرَونَهُ بَعيدًا * وَنَراهُ قَريبًا﴾ التقدير الشخصى لأى أمر يختلف من شخص لآخر، وإرجاع الأمر للعالم به أولى وأضمن.
وقفة
[6، 7] الحق هو ما يراه الخالق، وليس ما يراه المخلوقون ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾.
وقفة
[6، 7] النظرة البشرية والتقديرات الدنيوية إذا لم تضبط بالشريعة فهي بعيدة عن الصواب ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّهُمْ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسمها والجملة بعدها في محل رفع خبرها.
- ﴿ يَرَوْنَهُ بَعِيداً: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول لأن «يرى» من أفعال القلوب والضمير يعود على العذاب الواقع أو ليوم القيامة في حال تعليق «في يوم» بواقع. بعيدا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي يستبعدونه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا سألوا استِعجالَ العذابِ استهزاءً وتكذيبًا؛ بَيَّنَ اللهُ هنا سبب ذلك، فهم يرون هذا العذاب بعيدًا مستحيل الوقوع، قال تعالى:
﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾
التفسير :
{ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا} الضمير يعود إلى البعث الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب أي:إن حالهم حال المنكر له، أو الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة، حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبا، لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب.
وقوله- تعالى-: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً. وَنَراهُ قَرِيباً.. متفرع على قوله- سبحانه- سَأَلَ سائِلٌ لأن السؤال كان سؤال استهزاء، يضيق به الصدر، وتغتم له النفس.
والصبر الجميل: هو الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله- عز وجل- ولا يخالطه شيء من الجزع، أو التبرم بقضاء الله وقدره.
أى: لقد سألوك- أيها الرسول الكريم- عن يوم القيامة، وعن العذاب الذي تهددهم به ... سؤال تهكم واستعجال.. فاصبر صبرا جميلا على غرورهم وجحودهم وجهالاتهم.
إنهم يرون هذا اليوم وما يصحبه من عذاب.. يرونه «بعيدا» من الإمكان أو من الوقوع، ولذلك كذبوا بما جئتهم به من عندنا، واستهزؤا بك.. ونحن نراه قريبا من الإمكان، بل هو كائن لا محالة في الوقت الذي تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.
( ونراه قريبا ) أي : المؤمنون يعتقدون كونه قريبا ، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله ، عز وجل ، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة .
.
فقال: إنهم يرونه غير واقع، ونحن نراه قريبا، لأنه كائن، وكلّ ما هو آت قريب.
والهاء والميم من قوله: ( إِنَّهُمْ ) من ذكر الكافرين، والهاء من قوله: (يَرَوْنَهُ ) من ذكر العذاب.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[5-7] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ الصبر وصية الله وأمره لأوليائه، وذلك لأنه جعل العقبى لهم في جميع المآلات.
وقفة
[5-7] ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ الحقيقة واحدة، ولكن بقدر صفاء النفوس وخلوصها تكون قدرتها على التعامل الإيجابي مع الأحداث مهما عظمت، وبمقدار ما فيها من غبش تعمي عن رؤية الواقع والمستقبل على وجهه الصحيح!
الإعراب :
- ﴿ وَنَراهُ قَرِيباً ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. بتقدير: ونحن نراه قريبا لأن موضع «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ» الرفع على الابتداء على تقدير: هم يرونه بعيدا ونحن نراه قريبا بمعنى: هينا في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنهم يرون هذا العذاب بعيدًا مستحيل الوقوع؛ أَكَّدَ هنا أنه قريب واقع لا محالة، قال تعالى:
﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ ﴾
التفسير :
أي:{ يَوْمِ} القيامة، تقع فيه هذه الأمور العظيمة فـ{ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ} وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ.
ثم بين- سبحانه- جانبا من أهوال هذا اليوم فقال: يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ. وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً.
ولفظ «يوم» متعلق بقوله: «قريبا» أو بمحذوف يدل عليه قوله: واقِعٍ أى: هو واقع هذا العذاب يوم تكون السماء في هيئتها ومظهرها «كالمهل» أى: تكون واهية مسترخية.. كالزيت الذي يتبقى في قعر الإناء.
يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين ( يوم تكون السماء كالمهل ) قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد ، كدردي الزيت
وقوله: (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ )
يقول تعالى ذكره: يوم تكون السماء كالشيء المذاب، وقد بينت معنى المهل فيما مضى بشواهده، واختلاف المختلفين فيه، وذكرنا ما قال فيه السلف، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.
التدبر :
وقفة
[8، 9] ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار.
وقفة
[8، 9] ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ السماء كالرصاص المذاب، والجبال كالصوف المنفوش، فما حال العبد الضعيف الذي أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟!
الإعراب :
- ﴿ يَوْمَ: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بقريبا أي يمكن ولا يتعذر في ذلك اليوم. أو متعلق بفعل مضمر تقديره: يقع لدلالة «واقع» عليه
- ﴿ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة. وتكون: فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفع الضمة. السماء: اسم «تكون» مرفوع بالضمة. كالمهل: جار ومجرور متعلق بخبر «تكون» والكاف حرف جر للتشبيه. أو تكون اسما بمعنى «مثل» مبنيا على الفتح في محل نصب خبر «تكون» و «المهل» مضافا إليه مجرورا بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي كدردي الزيت بمعنى عكره أو كالفضة المذابة في تلونها.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا أَكَّدَ اللهُ أن العذاب قريب، واقع لا محالة؛ ذكرَ هنا وقتَ حدوثه، قال تعالى:
﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [9] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾
التفسير :
{ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ} وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذاك هباء منثورا فتضمحل، فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟
وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ أى: كالصوف المصبوغ ألوانا، لاختلاف ألوان الجبال، فإن الجبال إذا فتتت وتمزقت في الجو، أشبهت الصوف المنفوش إذا طيرته الرياح، قيل: أول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منبثا.
ووجه الشبه أن السماء في هذا اليوم تكون في انحلال أجزائها، كالشىء الباقي في قعر الإناء من الزيت، وتكون الجبال في تفرق أجزائها كالصوف المصبوغ الذي تطاير في الجو.
( وتكون الجبال كالعهن ) أي : كالصوف المنفوش ، قاله مجاهد وقتادة والسدي . وهذه الآية كقوله تعالى : ( وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) [ القارعة : 5 ] .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ) قال: كَعَكَرِ الزيت.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ): تتحوّل يومئذ لونا آخر إلى الحمرة.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[9] ﴿يَومَ تَكونُ السَّماءُ كَالمُهلِ * وَتَكونُ الجِبالُ كَالعِهنِ﴾ دوام الحال من المحال.
وقفة
[9] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ العِهن هو الصوف، شبّه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه.
الإعراب :
- ﴿ وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. بمعنى كالصوف المصبوغ ألوانا.'
المتشابهات :
| المعارج: 9 | ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ |
|---|
| القارعة: 5 | ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ العالمَ العُلويَّ؛ ذكرَ العالمَ السُّفليَّ، قال تعالى:
﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [10] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾
التفسير :
أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه، ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال:{ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا}
وفي هذا اليوم- أيضا- لا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً أى: لا يسأل صديق صديقه النصرة أو المعونة، ولا يسأل قريب قريبه المساعدة والمؤازرة.. لأن كل واحد منهما مشغول بهموم نفسه من شدة هول الموقف، كما قال- تعالى-: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
والحميم: هو الصديق الوفي القريب من نفس صديقه.
وقوله : ( ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم ) أي : لا يسأل القريب عن حاله ، وهو يراه في أسوأ الأحوال ، فتشغله نفسه عن غيره .
قال العوفي ، عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا ، ويتعارفون بينهم ، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك ، يقول : ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه )
وهذه الآية الكريمة كقوله : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ) [ لقمان : 33 ] . وكقوله : ( وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ) [ فاطر : 18 ] . وكقوله : ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) [ المؤمنون : 101 ] . وكقوله : ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) [ عبس : 34 - 37 ] .
وقوله: (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ) يقول: وتكون الجبال كالصوف.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (كَالْعِهْنِ ) قال: كالصوف.
حدثني ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (كَالْعِهْنِ ) قال: كالصوف.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[10] ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ لا يسألُ قريبٌ قريبَه عن شأنِه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مشغولٌ بنفسِه.
وقفة
[10] ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ السؤال عن الأحبة هو آخر بقية من الشعور بهم.
وقفة
[10] ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ يفترض أن لا تنقطع علائق الأحماء الأقارب إلا في أهوال القيامة الكبرى.
وقفة
[10] ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ في هذا اليوم لا يسأل صديق صديقه النصرة أو المعونة؛ لأن كل واحد منهما مشغول بهموم نفسه من شدة الموقف وهول الحساب، ولأنه قد كُشِف لهم أنه لا تُغني نفس عن نفس شيئًا، وأنه قد تقطعت الأسباب، وتلاشت الأنساب، وعرف الجميع ألا عز إلا بالتقوى.
وقفة
[10] ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ مشاهد الرعب التي يرونها، ألهتهم عن روابط الود التي يعرفونها.
وقفة
[8-10] ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ أليس حقًّا أن ينخلع قلبه، وينزعج لبه، ويذهل عن كل أحد.
الإعراب :
- ﴿ وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ: ﴾
- الواو عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. يسأل: فعل مضارع مرفوع بالضمة. حميم فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ حَمِيماً: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي يسأل صاحب وقريب صاحبه عن حاله لأن كل واحد مشغول عن المساءلة بما هو فيه'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا كان ذلك سببًا في انخلاع القلبِ، والذُّهولِ عن كلِّ أحدٍ؛ فلا يسأل قريب قريبًا عن حاله، قال تعالى:
﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لا يسأل:
1- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- مبنيا للمفعول، أي: لا يسأل إحضاره، وهى قراءة أبى حيوة، وشيبة، وأبى جعفر، والبزي، بخلاف عن ثلاثتهم.

