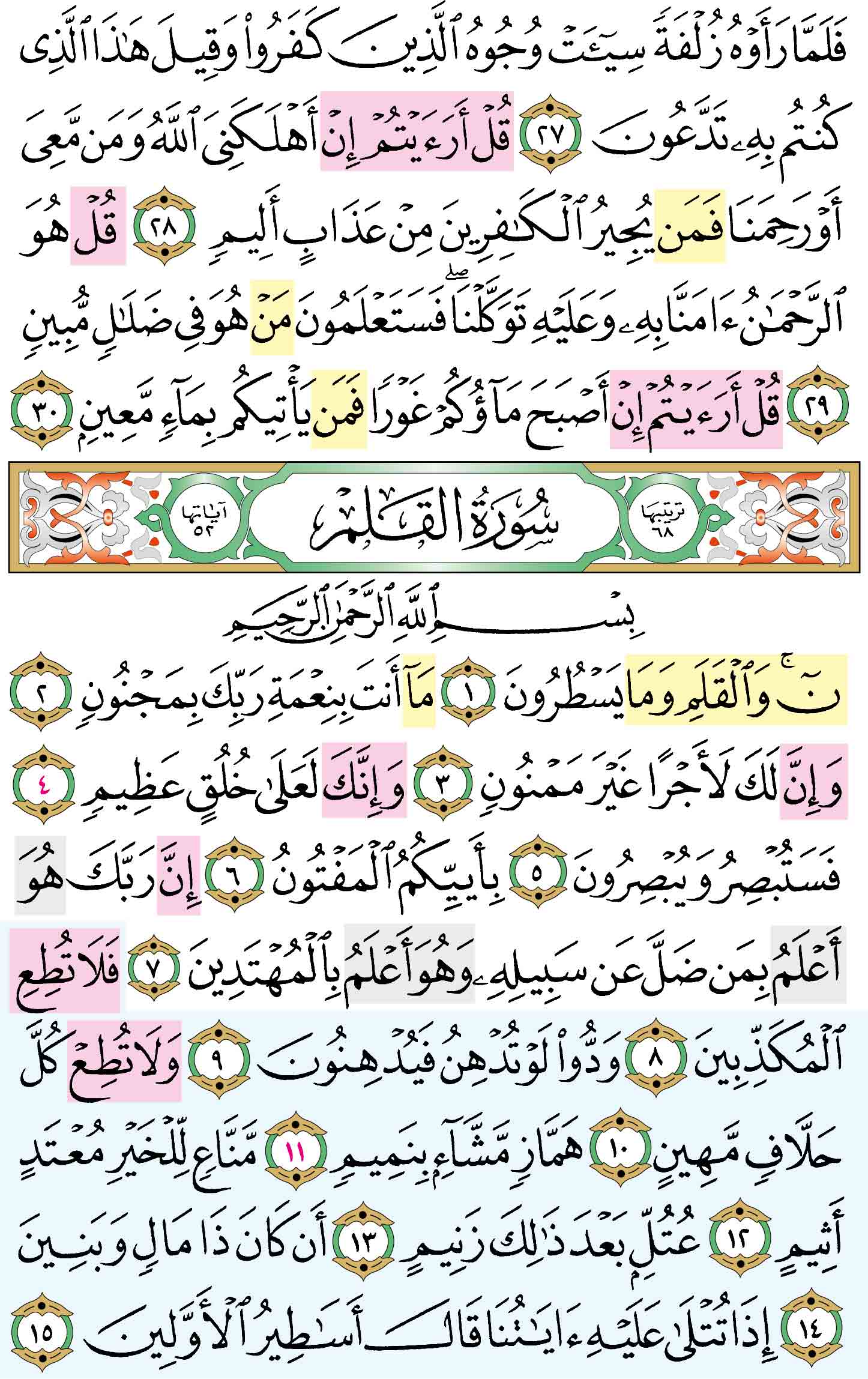
الإحصائيات
سورة الملك
| ترتيب المصحف | 67 | ترتيب النزول | 77 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.40 |
| عدد الآيات | 30 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.00 |
| ترتيب الطول | 59 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الثناء على الله: 13/14 | تبارك: 2/2 | ||
سورة القلم
| ترتيب المصحف | 68 | ترتيب النزول | 2 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.20 |
| عدد الآيات | 52 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.00 |
| ترتيب الطول | 61 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 29/29 | ن: 1/1 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (27) الى الآية رقم (30) عدد الآيات (4)
ختامُ السُّورةِ ببيانِ حالِ الكافرينَ وتَغيُّرِ وجوهِهم عندَ رؤيتِهم العذابَ، وحثِّهُم على طلبِ النَّجاةِ والإنقاذِ بالتَّوبةِ والرَّجوعِ إلى اللهِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (7) عدد الآيات (7)
القَسَمُ على رِفعةِ النَّبي ﷺ وبراءتِه ممَّا اتَّهمَهُ به المشركونَ من الجُنونِ، ووصفُه بالخُلُقِ العَظيمِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثالث
من الآية رقم (8) الى الآية رقم (16) عدد الآيات (9)
بعدَ بيانِ ما عليه النَّبي ﷺ من الأخلاقِ العَظيمةِ، بَيَّنَ هنا ما عليه الكفارُ من الأخلاقِ الذَّميمةِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الملك
الدعوة للتفكر في ملك الله
أولاً : التمهيد للسورة :
- • السورة دعوة للتأمل والتفكر في:: مقصود السور: المُلك يدل على صاحب المُلك (المَلك المالك المليك) سبحانه وتعالى، ولذا نجد فيها: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ (3، 4). فالمُلك ناطق بأنَّ له ربًا ملكًا يصرف أموره. السورة تدعونا للنظر فيما حولنا: ننظر إلى الطيور، إلى الماء، ونسأل أنفسنا: من الذي يتحكم كل هذا؟
- • على العبد أن لا يقف عند النعم :: 1. ملك الله وعظمته: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَىْء قَدِيرٌ﴾ (1). 2. الحكمة من خَلْق الخَلْق: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (2). 3. إتقان الله في كونه: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ (3). 4. نعم الله على عباده، مثل الخلق والرزق وتذليل الأرض للعيش، وحفظ السماء.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة الْمُلك»، و«سُورَةُ تَبَارَكَ».
- • معنى الاسم :: الْمُلْكُ :ما يُمَلك ويُتصرّف فيه، وتبارك: فعل لا يُستعمل إلا ماضيًا، ولا يسند إلا لله تعالى، وتبارك اللهُ: أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته.
- • سبب التسمية :: سميت «سورة الْمُلك»؛ لورود اللفظ في الآية الأولى، و«سُورَةُ تَبَارَكَ»، لافتتاحها بهذا اللفظ.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»، و«تَبَارَكَ الْمُلْكُ»، و«المانعة»، و«المنجية»، و«الواقية»، و«المجادلة»؛ لأنها تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: التأمل والتفكر في ملك الله.
- • علمتني السورة :: أن العبرة بأحسن العمل، لا بأكثره، فالله قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (2)، ولم يقل: (أكثر عملًا).
- • علمتني السورة :: أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدًا إلا بعد أن ينذره في الدنيا: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾
- • علمتني السورة :: أن النهايات السيئة تبدأ بتسليم الإنسان عقله لغيره بلا تفكير: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».
• عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».
• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الْمُلك من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الْمُلك من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الملك آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالثناء على الله بالمدح، والسور التي افتتحت بذلك سبع، وهي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، والفرقان، وسبأ، وفاطر، والملك، وكلها سور مكية، وكلها افتتح بـ(الحمد)، ما عدا الفرقان والملك افتتحتا بـ(تبارك).
• سورة الملك أُولَى سور الجزء الـ 29، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة الملك: (جزء تبارك)، وهذا الجزء يحتوي على 11 سورة: تبدأ بالملك وتنتهي بالمرسلات، وكلها سور مكية، وهي تهتم بالجانب العقائدي؛ كما هو شأن القرآن المكي.
• سورتان في القرآن بدأتا بـ (تبارك): الفرقان، والمُلك.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتأمل ونتفكر في ملك الله.
• أن نتق الله ونعمل لآخرتنا، فالدنيا دار ابتلاء واختبار: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (2).
• أن نعظم الله جل وعلا في كل أمر من الأمور: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ (3).
• أن نراقب الله؛ فهو يعلم سرنا وعلانيتنا: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (13).
• أن نسعي ونأخذ بأسباب تحصيل الرزق: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (15).
• أن نتأمل كيف جعل الله هذه الأرض مذللة نمشي عليها، ثم نشكر الله تعالى على هذه النعم: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ...﴾ (15).
• أن نعلم ونتيقن أن رزقنا بيد الله تعالى، ولن يستطيع أحد أن يمنع رزقنا: ﴿أَمَّنْ هَـٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ (21).
• أن نشكر الله تعالى على نعمه علينا: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (23).
أن نحرِص على قراءةِ سورةِ المُلكِ كلَّ ليلةٍ قبل النَّومِ، لحديث جابر السابق.
سورة القلم
الثناء على النبي ﷺ بأخلاقه العظيمة
أولاً : التمهيد للسورة :
- • سورة القلم تعرض نموذجين من الأخلاق:: النبي ﷺ وخلقه العظيم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (4). وبالمقابل: نرى المكذبين أصحاب الأخلاق السيئة: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ...﴾ (10-15). فالرسالة هنا: لا تكذب، ولا تحلف كذبًا، ولا تشتم، ولا تهمز.ثم تذكر السورة عقوبة أصحاب الأخلاق السيئة: فذكرت قصة أصحاب الجنة، الذين أدى بخلهم الشديد إلى حرمانهم من الرزق، وكأنها تقول لنا: إياكم والبخل؛ فإنه من أسوأ الأخلاق. ثم أمر الله نبيه ﷺ بالصبر، وعدم التبرم والتضجر مما يلقاه من المكذبين في سبيل تبليغ الدعوة، كما حدث من نبي الله يونس حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (48).
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «القلم».
- • معنى الاسم :: القلم: هو ما يُكتب به.
- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالقلم.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ ن»، و«سُورَةُ ن وَالْقَلَمِ».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: محبة النبي ﷺ.
- • علمتني السورة :: أهمية الأخلاق في الإسلام، وعقوبة أصحاب الأخلاق السيئة.
- • علمتني السورة :: فضل العلم، وأهمية القراءة والكتابة.
- • علمتني السورة :: فلان ضالّ، فلان مهتد، ليس هذا شأنك: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة القلم من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة القلم من المفصل.
• سورة القلم من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القلم مع سورة الواقعة، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة القلم من أوائل السور القرآنية نزولًا.
• سورة القلم آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بحرف واحد من حروف التهجي، فقد سبقتها سورتا (ص)، (ق).
• سورة القلم آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- من السور التي افتتحت بحروف التهجي أو الحروف المقطعة، وهي 29 سورة.
• جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة (وهي: 29 سورة) أن يأتي الحديث عن القرآن الكريم بعد الأحرف المقطعة مباشرة؛ إلا أربع سور، وهي: مريم والعنكبوت والروم والقلم.
• احتوت سورة القلم على أكثر آية أثنت على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (4).
• احتوت سورة القلم على أكثر صفات مذمومة تذكر متتالية لبعض كفار قريش، وقد بلغت 9 صفات، وهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ (10-13).
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نحذر من عاقبة كفر النعمة والتكبر عن شكرها.
• أن نهتم بالعلم، والقراءة والكتابة؛ فأوّل سورة نزلت من القرآن الكريم: العلق، وبدأت بالقراءة: ﴿اقْرَأْ﴾ (العلق 1)، وثاني سورة نزلت من القرآن الكريم: القلم، وبدأت بالكتابة: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (1).
• أن نتقي الله فيما نكتب، ونعلم أننا محاسبون عليه، فالقلم وسيلةٌ هامةٌ في نصر الدين، وكذلك في هدمه.
• ألا نطيع: الكذاب، الكثير الحلف، من يستهزئ بالناس، من يمشي بين الناس بالنميمة، من يمنع الخير، من يعتدي على الناس، السيء الخلق: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ * وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ (8-13).
• أن نتصدق على الفقراء والمحتاجين، ولا نبخل: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ...﴾ (17).
• أن ننوي بالمساكينَ خيرًا، فنِيَّةُ سُوءٍ بالمساكينَ جَعَلتْ البُستانَ كاللَّيْلِ المُظْلِمِ، وتثمرُ حياتُنا بقدرِ حبِّنا لهم: ﴿أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾ (24).
• أن نكون أكثر تفاؤلًا: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ (32).
• أن نصلي ركعتين ونطل فيهما السجود، وندعو الله أن يحسن وقوفنا بين يديه: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (42).
• أن نستمر في نصح مسلم مصر على معصية؛ ولا نيأس: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (48).
• ألا نستعجل في انتظارِ نتائجِ الدَّعوةِ إلى اللهِ: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (48).
تمرين حفظ الصفحة : 564
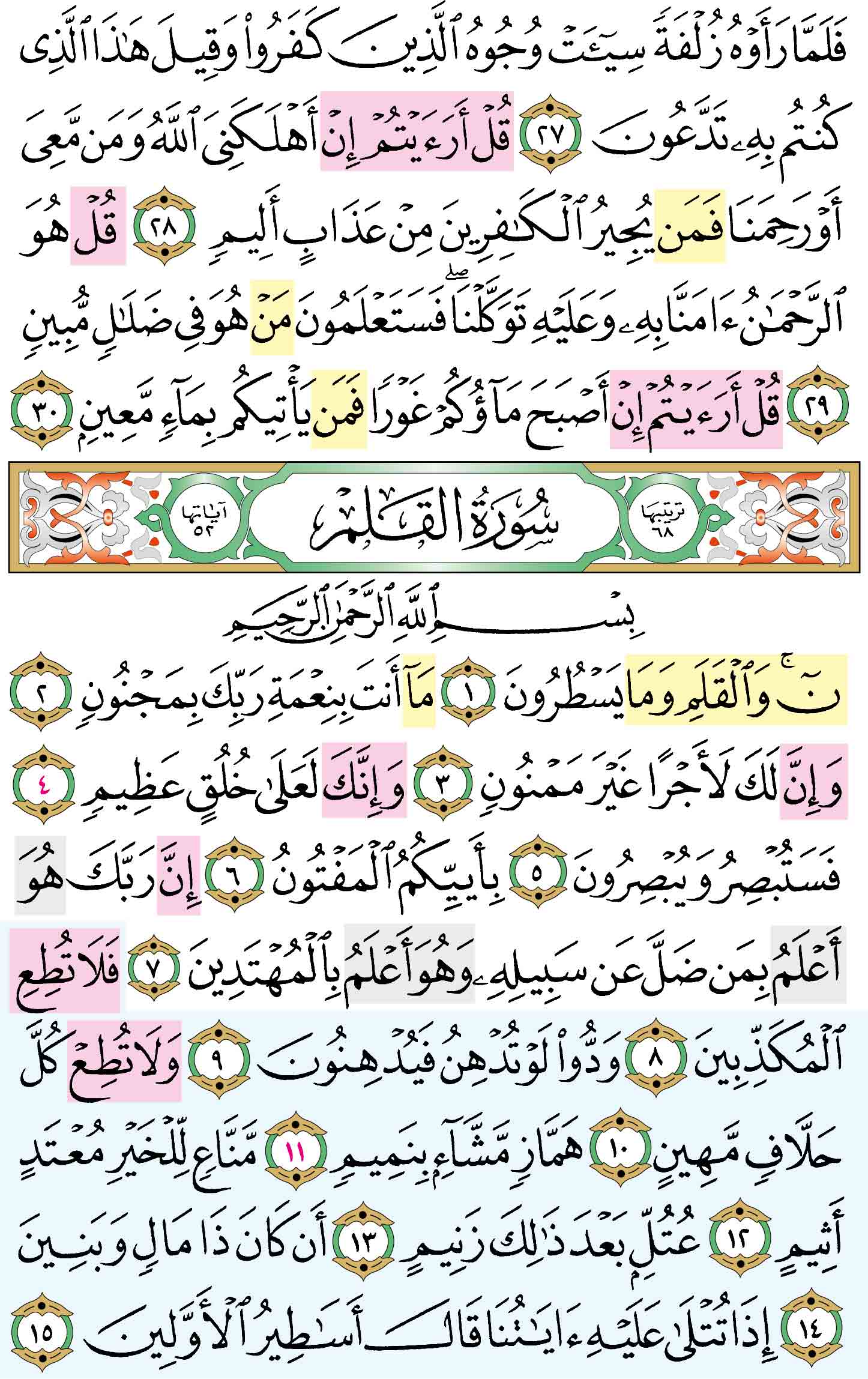
مدارسة الآية : [27] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ .. ﴾
التفسير :
يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء، ورأوا العذاب منهم{ زُلْفَةً} أي:قريبًا، ساءهم ذلك وأفظعهم، وقلقل أفئدتهم، فتغيرت لذلك وجوههم، ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، فاليوم رأيتموه عيانًا، وانجلى لكم الأمر، وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب.
ثم حكى- سبحانه- حالهم عند ما يرون العذاب الذي استعجلوه فقال: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ.
والفاء في قوله: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ... هي الفصيحة. وفَلَمَّا ظرف بمعنى حين.
ورَأَوْهُ مستعمل في المستقبل وجيء به بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، كما في قوله- تعالى-: أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ...
وزُلْفَةً اسم مصدر لأزلف إزلافا، بمعنى القرب. ومنه قوله- تعالى-: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ... أى: قربت للمتقين، وهو حال من مفعول رَأَوْهُ.
والمعنى: لقد حل بالكافرين العذاب الذي كانوا يستعجلونه، ويقولون: متى هذا الوعد.
فحين رأوه نازلا بهم، وقريبا منهم سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أى: ساءت رؤيته وجوههم، وحلت عليها غبرة ترهقها قترة.
وَقِيلَ لهم على سبيل التوبيخ والتأنيب هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ أى: هذا هو العذاب الذي كنتم تتعجلون وقوعه في الدنيا، وتستهزءون بمن يحذركم منه.
فقوله تَدَّعُونَ من الدعاء بمعنى الطلب، أو من الدعوى.
وسِيئَتْ فعل مبنى للمجهول. وأسند- سبحانه- حصول السوء إلى الوجوه، لتضمينه معنى كلحت وقبحت واسودت، لأن الخوف من العذاب قد ظهرت آثاره على وجوههم.
وقال- سبحانه- سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بالإظهار، ولم يقل وجوههم، لذمهم بصفة الكفر، التي كانت السبب في هلاكهم.
ومفعول تَدَّعُونَ محذوف. والتقدير: وقيل لهم هذا الذي كنتم تدعون عدم وقوعه.
قد وقع، وها أنتم تشاهدونه أمام أعينكم.
والجار والمجرور في قوله بِهِ متعلق بتدعون لأنه مضمن معنى تكذبون.
والقائل لهم هذا القول: هم خزنة النار، على سبيل التبكيت لهم.
قال الله تعالى : ( فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ) أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ، ورأوا أن الأمر كان قريبا ; لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه ، فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك ، لما يعلمون ما لهم هناك من الشر ، أي : فأحاط بهم ذلك ، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب ، ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) [ الزمر : 47 ، 48 ] ; ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : ( هذا الذي كنتم به تدعون ) أي : تستعجلون .
القول في تأويل قوله تعالى : فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27)
وقوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول تعالى ذكره: فلما رأى هؤلاء المشركون عذاب الله زلفة، يقول: قريبا، وعاينوه، ( سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول: ساء الله بذلك وجوه الكافرين.
وبنحو الذي قلنا في قوله: ( زُلْفَةً ) قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ ) قال: لما عاينوه.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا شعبة، عن أبي رجاء، قال: سألت الحسن، عن قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) قال: معاينة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) قال: قد اقترب.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) لما عاينت من عذاب الله.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) قال: لما رأوا عذاب الله زلفة، يقول: سيئت وجوههم حين عاينوا من عذاب الله وخزيه ما عاينوا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ ) قيل: الزلفة حاضر قد حضرهم عذاب الله عزّ وجلّ.
: ( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ )يقول: وقال الله لهم: هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) قال: استعجالهم بالعذاب.
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) بتشديد الدال بمعنى تفتعلون من الدعاء.
وذكر عن قتادة والضحاك أنهما قرءا ذلك ( تَدَّعُونَ ) بمعنى تفعلون في الدنيا.
حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن هارون، قال: أخبرنا أبان العطار وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أنه قرأها( الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) خفيفة ؛ ويقول: كانوا يدعون بالعذاب، ثم قرأ: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .
والصواب من القراءة في ذلك، ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القرّاء عليه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[27] ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أول ما تظهر آثار الاستياء والانكسار على الوجه، كما في وجه من يُساق إلى القتل، وليس هذا عند نزول العذاب، بل قبله، بمجرد اقترابه، مما يدل على هول العذاب مع شدة الخوف والفزع في من نزل به.
لمسة
[27] ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولم يقل: (وجوههم)؛ لإفادة ذمِّهم والتصريح بصفة الكفر، التي كانت سبب هلاكهم.
عمل
[27] ﴿فَلَمّا رَأَوهُ زُلفَةً سيئَت وُجوهُ الَّذينَ كَفَروا﴾ ولكن الوقت قد فات، وأنت الآن ما زلت حيًّا؛ فاعمل لهذا اليوم.
تفاعل
[27] ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ استعذ بالله من خزي يوم القيامة.
وقفة
[27] ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾ هذا تقريع ملائكة العذاب، وتبكيت أهل النار وهو على أعتابها.
الإعراب :
- ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً: ﴾
- الفاء: استئنافية. لما: اسم شرط غير جازم بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالجواب. رأوه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الألف المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة ولالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دالة عليه. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل يعود على الوعد وهو العذاب الموعود مبني على الضم في محل نصب مفعول به.وجملة «رأوه» في محل جر بالاضافة. زلفة: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي القرب. أو منصوب على الظرفية بتقدير: ذا زلفة أو مكانا ذا زلفة.
- ﴿ سِيئَتْ وُجُوهُ: ﴾
- الجملة: جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب. وجوه: نائب فاعل مرفوع بالضمة. أي ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن علتها الكآبة وكلحوا.
- ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾
- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. كفروا:فعل ماض يعرب اعراب «رأوا» وجملة «كفروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ وَقِيلَ هذَا: ﴾
- الواو: عاطفة. قيل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. أي وقال الزبانية لهم. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة الاسمية من اسم الاشارة وخبره في محل رفع نائب فاعل.
- ﴿ الَّذِي: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر «هذا» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو والجملة الاسمية «هو الذي» في محل رفع خبر «هذا» والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ كُنْتُمْ بِهِ: ﴾
- فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. به: جار ومجرور متعلق بكنتم أو بخبرها.
- ﴿ تَدَّعُونَ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل نصب خبر «كنتم» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى:تفتعلون من الدعاء: أي تطلبون وتستعجلون به وقيل هو من الدعوى:أي كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [27] لما قبلها : ولَمَّا استعجلوا العذاب؛ حكى اللهُ حالَهم عندما يرون العذاب الذي استعجلوه، قال تعالى:
﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
سيئت:
وقرئ:
1- بإخلاص كسرة السين، وهى قراءة الجمهور.
2- بإشمامها الضم، وهى قراءة أبى جعفر، والحسن، وأبى رجاء، وشيبة، وابن وثاب، وطلحة، وابن عامر، ونافع، والكسائي.
تدعون:
1- بشد الدال مفتوحة، من «الدعوى» ، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بسكون الدال، من الدعاء، وهى قراءة أبى رجاء، والضحاك، والحسن، وقتادة، وابن يسار، وسلام، ويعقوب، وابن أبى عبلة، وأبى زيد، وعصمة عن أبى بكر، والأصمعى، عن نافع.
مدارسة الآية : [28] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ .. ﴾
التفسير :
ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، [الذين] يردون دعوته، ينتظرون هلاكه، ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم:أنتموإن حصلت لكم أمانيكموأهلكني الله ومن معي، فليس ذلك بنافع لكم شيئًا، لأنكم كفرتم بآيات الله، واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم؟ فإذًا، تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيدة، ولا مجد لكم شيئًا.
ثم أمر- سبحانه- رسوله صلى الله عليه وسلم للمرة الرابعة، أن يرد على ما كانوا يتمنونه بالنسبة له ولأصحابه فقال: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا، فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ.
ولقد كان المشركون يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرددون ذلك في مجالسهم، وقد حكى القرآن عنهم ذلك في آيات منها قوله- تعالى-: أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
أى: قل لهم- أيها الرسول الكريم- أَرَأَيْتُمْ أى: أخبرونى إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ. - تعالى- وأهلك مَنْ مَعِيَ من أصحابى وأتباعى أَوْ رَحِمَنا بفضله وإحسانه بأن رزقنا الحياة الطويلة، ورزقنا النصر عليكم.
فأخبرونى في تلك الحالة فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ أى: من يستطيع أن يمنع عنكم عذاب الله الأليم، إذا أراد أن ينزله بكم؟ مما لا شك فيه أنه لن يستطيع أحد أن يمنع ذلك عنكم.
قال صاحب الكشاف: كان كفار مكة يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالهلاك، فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين: إما أن نهلك كما تتمنون، فننقلب إلى الجنة، أو نرحم بالنصرة عليكم، أما أنتم فماذا تصنعون؟ من يجيركم- وأنتم كافرون- من عذاب أليم لا مفر لكم منه.
يعنى: إنكم تطلبون لنا الهلاك الذي هو استعجال للفوز والسعادة، وأنتم في أمر هو الهلاك الذي لا هلاك بعده.. .
والمراد بالهلاك: الموت، وبالرحمة: الحياة والنصر بدليل المقابلة، وقد منح الله- تعالى- نبيه العمر المبارك النافع، فلم يفارق صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت كلمته هي العليا.
والاستفهام في قوله أَرَأَيْتُمْ للإنكار والتعجيب من سوء تفكيرهم.
والرؤية علمية، والجملة الشرطية بعدها سدت مسد المفعولين.
وقال- سبحانه- فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ للإشارة إلى أن كفرهم هو السبب في بوارهم وفي نزول العذاب الأليم بهم.
يقول تعالى : ( قل ) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه : ( أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ) أي : خلصوا أنفسكم ، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة ، والرجوع إلى دينه ، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال ، فسواء عذبنا الله أو رحمنا ، فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم .
القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قُلْ ) يا محمد للمشركين من قومك، (أَرَأَيْتُمْ ) أيها الناس (إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ) فأماتني (وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ) فأخَّر في آجالنا(فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ ) بالله (مِنْ عَذَابِ ) موجع مؤلم، وذلك عذاب النار. يقول: ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتُنا وحياتنا، فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا قيام الساعة، ونـزول العذاب، فإن ذلك غير نافعكم، بل ذلك بلاء عليكم عظيم.
التدبر :
وقفة
[28] قال الزمخشري: «كان كفار مكة يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك، فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنين: إما أن نهلك كما تتمنون فننقلب إلى الجنة، أو نُرحَم بالنصرة عليكم، أما أنتم فماذا تصنعون؟ من يجيركم -وأنتم كافرون- من عذاب النار؟!».
وقفة
[28] لم يذكر المصطفى ﷺ المشركين والكفار فى خطابه مباشرة بخطاب الحاضر المخاطب، بل ذكرهم غيبًا، وهذا أسلوب تربوى، فقط لمِّح من بعيد، وسيفهم من عنده عقل.
تفاعل
[28] ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ سَبِّح الله الآن.
الإعراب :
- ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والعشرين. الألف ألف تعجب بلفظ استفهام. رأيتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور بمعنى: أخبروني.
- ﴿ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ: ﴾
- حرف شرط جازم. أهلكني: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن. النون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون الذي حرك بالفتح لالتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به مقدم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.
- ﴿ وَمَنْ مَعِيَ: ﴾
- الواو عاطفة. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب لأنه معطوف على منصوب وهو ياء المتكلم في «أهلكني» مع: ظرف مكان يدل على الاجتماع والمصاحبة منصوب على الظرفية متعلق بصلة الموصول المحذوفة وكسر آخره مراعاة للياء فهو اسم بمعنى الظرف وهو مضاف والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل جر بالاضافة.
- ﴿ أَوْ رَحِمَنا: ﴾
- معطوفة بأو للتخيير على «أهلكني» وتعرب اعرابها. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.
- ﴿ فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ: ﴾
- الجملة: جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بإن اهكلني. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يجير: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الكافرين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد وجملة «يجير الكافرين» في محل رفع خبر «من».
- ﴿ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيجير. أليم: صفة- نعت- لعذاب مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة أي فمن ينقذهم من عذاب أليم.'
المتشابهات :
| الأنعام: 40 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّـهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ﴾ |
|---|
| الأنعام: 47 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّـهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [28] لما قبلها : ولَمَّا كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم يردون دعوته ينتظرون هلاكه؛ لقن اللهُ نبيَّه الرَدَّ، وهذا هو التلقينُ الرابع: لا مفرَّ للكافرِ من عذاب الله، قال تعالى:
﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [29] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ .. ﴾
التفسير :
ومن قولهم، إنهم على هدى، والرسول على ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه، ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا:{ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا} والإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال، وجودها وكمالها، متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان، ومن جملة لوازمه كما قال تعالى:{ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح، وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان [لهم] ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى، ومن هو في ضلال مبين.
ثم أمره- سبحانه- للمرة الخامسة، أن يبين لهم أنه هو وأصحابه معتمدون على الله- تعالى- وحده، ومخلصون له العبادة والطاعة، فقال: قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا ...
أى: وقل يا محمد لهؤلاء الجاحدين: إذا كنتم قد أشركتم مع الله- تعالى- آلهة أخرى في العبادة، فنحن على النقيض منكم، لأننا أخلصنا عبادتنا للرحمن الذي أوجدنا برحمته، وآمنا به إيمانا حقا، وعليه وحده توكلنا وفوضنا أمورنا.
وأخر- سبحانه- مفعول آمَنَّا وقدم مفعول تَوَكَّلْنا، للتعريض بالكافرين، الذين أصروا على ضلالهم، فكأنه يقول: نحن آمنا ولم نكفر كما كفرتم، وتوكلنا عليه وحده، ولم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من أصنامكم وأموالكم وأولادكم..
وقوله فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ مسوق مساق التهديد والوعيد أى:
فستعلمون في عاجل أمرنا وآجله، أنحن الذين على الحق أم أنتم؟ ونحن الذين على الباطل أم أنتم؟ ..
فالمقصود بالآية الكريمة التهديد والإنذار، مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف، الذي يحملهم على التدبر والتفكر لو كانوا يعقلون.
ثم قال : ( قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ) أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم ، وعليه توكلنا في جميع أمورنا ، كما قال : ( فاعبده وتوكل عليه ) [ هود : 123 ] . ولهذا قال : ( فستعلمون من هو في ضلال مبين ) ؟ أي : منا ومنكم ، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة ؟ .
القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد: ربنا(الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ ) يقول: صدّقنا به (وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ) يقول: وعليه اعتمدنا في أمورنا، وبه وثقنا فيها(فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) يقول: فستعلمون أيها المشركون بالله الذي هو في ذهاب عن الحقّ، والذي هو على غير طريق مستقيم منا ومنكم إذا صرنا إليه، وحشرنا جميعا.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[29] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ عليه وحده توكلنا؛ لأنه لا شيء في يد غيره، وإلا لرحم من يريد عذابه، أو عذب من يريد رحمته؛ فكل ما جرى على أيدي خلقه من رحمة أو نقمة فهو الذي أجراه.
وقفة
[29] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لما كانت الأعمال -وجودها وكمالها- متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان، ومن جملة لوازمه.
وقفة
[29] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ من أعظم أسباب قوة التوكل على الله: يقيننا أننا نفوِّض أمرنا للرحمن، والرحمن أرحم بعباده من كل أحد.
وقفة
[29] ﴿آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ الإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفةً على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه.
الإعراب :
- ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والعشرين. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الرحمن: خبر «هو» مرفوع بالضمة. أي قل لهم يا محمد هو الله. والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به- مقول القول-.
- ﴿ آمَنَّا بِهِ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل نصب حال وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بآمنا.
- ﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا: ﴾
- معطوفة بالواو على «آمنا به» وتعرب اعرابها.
- ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة السابعة عشرة. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وجملة «هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» في محل رفع خبر «من» بمعنى: من منا في ضلال أي في باطل واضح بين هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
- ﴿ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: ﴾
- جار ومجرور- شبة جملة- في محل رفع خبر «هو» ويجوز أن يكون «من» اسما موصولا بمعنى «الذي» في محل نصب مفعولا به وجملة «هو في ضلال مبين» صلة الموصول لا محل لها. و «مبين» صفة- نعت- لضلال مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.'
المتشابهات :
| القصص: 85 | ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ |
|---|
| الملك: 29 | ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [29] لما قبلها : التلقينُ الخامس: المؤمنُ قريب من رحمة الله، قال تعالى:
﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
فستعلمون:
1- بتاء الخطاب، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بياء الغيبة، وهى قراءة الكسائي.
مدارسة الآية : [30] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ .. ﴾
التفسير :
ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصًا، بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فقال:{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} أي:غائرًا{ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} تشربون منه، وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي:لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.
تمت ولله الحمد.
ثم أمر- سبحانه- نبيه صلى الله عليه وسلم للمرة السادسة، أن يذكرهم بنعمة الماء الذي يشربونه فقال: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ.
وقوله غَوْراً مصدر غارت البئر، إذا نضب ماؤها وجف. يقال: غار الماء يغور غورا، إذا ذهب وزال..
والمعين: هو الماء الظاهر الذي تراه العيون، ويسهل الحصول عليه، وهو فعيل من معن إذا قرب وظهر.
أى: وقل لهم- أيها الرسول الكريم- على سبيل التوبيخ وإلزام الحجة: أخبرونى إن أصبح ماؤكم غائرا في الأرض، بحيث لا يبقى له وجود أصلا.
فمن يستطيع أن يأتيكم بماء ظاهر على وجه الأرض، تراه عيونكم، وتستعملونه في شئونكم ومنافعكم.
إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله- تعالى- وحده، فعليكم أن تشكروه على نعمه، لكي يزيدكم منها.
وبعد: فهذا تفسير لسورة «الملك» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
ثم قال : ( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ) أي : ذاهبا في الأرض إلى أسفل ، فلا ينال بالفئوس الحداد ، ولا السواعد الشداد ، والغائر : عكس النابع ; ولهذا قال : ( فمن يأتيكم بماء معين ) أي : نابع سائح جار على وجه الأرض ، لا يقدر على ذلك إلا الله ، عز وجل ، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض ، بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة ، فلله الحمد والمنة .
[ آخر تفسير سورة " تبارك " ولله الحمد ] .
القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين: (أَرَأَيْتُمْ ) أيها القوم العادلون بالله (إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) يقول: غائرا لا تناله الدلاء (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) يقول: فمن يجيئكم بماء معين، يعني بالمعين: الذي تراه العيون ظاهرا
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) يقول: بماء عذب.
حدثنا ابن عبد الأعلى بن واصل، قال: ثني عبيد بن قاسم البزاز، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جُبير في قوله: (إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) لا تناله الدلاء (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) قال: الظاهر.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) : أي ذاهبا(فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) قال: الماء المعين: الجاري.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: (مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) ذاهبا(فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) جار.
وقيل غورا فوصف الماء بالمصدر، كما يقال: ليلة عم، يراد: ليلة عامة.
التدبر :
وقفة
[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ لكثرة ما نراه فًوْرًا، نستبعِدُ أنْ نراه غَوْرًا، ورُبَّ أرخصِ موجودٍ صار أعلى مفقود!
تفاعل
[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ سَل الله أن ينزل الغيث.
وقفة
[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ استعظموا قدر نعمة الماء، وقيَّدوها بالشكر، وخافوا إن لم تُشكَّر أن تزول.
تفاعل
[29] ﴿قُل أَرَأَيتُم إِن أَصبَحَ ماؤُكُم غَورًا فَمَن يَأتيكُم بِماءٍ مَعينٍ﴾ قل: «لا أحد».
وقفة
[30] قال الإمام الزمخشري: «وعن بعض الشطار أنها تُلِيَت عنده، فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه، نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته».
وقفة
[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ بعض المسائل لا تحتاج إلا إلي سؤال يدفع العقل إلي التفكر في حقائق لا مناص من الإقرار بها والتسليم لها.
وقفة
[30] قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا خرجت الدلو ملأى، قال: «الحمد لله»، قلت: «يا أبت، أي شيء الفائدة في هذا؟»، فقال: «يا بني، أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾؟».
تفاعل
[30] ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ سَبِّح الله الآن.
الإعراب :
- ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ﴾
- تعرب اعراب الآية الكريمة الثامنة والعشرين. أصبح: فعل ماض ناقص من أخوات «كان» ماؤكم اسمها مرفوع بالضمة. الكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكورغورا: خبر «أصبح» منصوب بالفتحة أي غائرا ذاهبا في الأرض وهو وصف بالمصدر.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [30] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ العَذابَ، وهو مُطلَقٌ؛ ذكَرَ فَقْدَ ما به حياةُ النُّفوسِ، وهو الماءُ، وهو عذابٌ مَخصوصٌ، وهذا هو التلقينُ السادس: التهديد بالحرمان من نعمة الماء، قال تعالى:
﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾
التفسير :
يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام، التي تكتب بها [أنواع] العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم.
تفسير سورة القلم
مقدمة وتمهيد
1- سورة «ن» أو «القلم» تعتبر من أوائل السور القرآنية، التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر السيوطي في كتابه «الإتقان» أنها السورة الثانية في النزول، بعد سورة «العلق» .
ويرى بعض العلماء أنها السورة الرابعة في النزول، فقد سبقتها سور: العلق، والمدثر، والمزمل، وعدد آياتها اثنتان وخمسون آية.
2- والمحققون على أنها من السور المكية الخالصة، فقد ذكر الزمخشري وابن كثير.. أنها مكية، دون أن يذكرا في ذلك خلافا.
وقال الآلوسى: هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة، فقد نزلت- على ما روى عن ابن عباس- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ... ثم هذه، ثم المزمل، ثم المدثر، وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها، بين أهل التأويل.
وفي الإتقان: استثنى منها: إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا ... إلى قوله- تعالى-: لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ .
3- والذي تطمئن إليه النفس، أن سورة ن من السور المكية الخالصة، لأنه لم يقم دليل مقنع. على أن فيها آيات مدنية، بجانب أن أسلوبها وموضوعاتها تشير إلى أنها من السور المكية الخالصة.
كذلك نميل إلى أن بعض آياتها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جهر بدعوته.
4- وقد فصل هذا المعنى بعض العلماء فقال ما ملخصه: لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة، سواء مطلعها أو جملتها.
والروايات التي تقول: إن هذه السورة هي الثانية في النزول بعد سورة العلق كثيرة، ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها، يجعلنا نرجح غير هذا، حتى ليكاد يتعين أنها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة، التي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة الفردية، في الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها، وتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو برىء منه، كذلك ذكرت بعض الروايات في السورة آيات مدنية، ونحن نستبعد هذا كذلك، ونعتقد أن السورة كلها مكية، لأن طابع آياتها عميق في مكيته.
والذي نرجحه بشأن السورة كلها، أنها ليست الثانية في ترتيب النزول وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبوية، بل بعد الجهر بالدعوة، وبعد أن أخذت قريش في محاربتها بصورة عنيفة.
والسورة قد أشارت إلى شيء من عروض المشركين: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وظاهر أن مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية، إنما تكون بعد ظهورها، وشعور المشركين بخطرها.. .
5- والذي يتدبر هذه السورة الكريمة، يراها قد اشتملت على مقاصد من أبرزها: تحدى المشركين بهذا القرآن الكريم، والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل أنواع الثناء ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
والتسلية الجميلة له صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن مهادنة المشركين أو ملاينتهم أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة، قال- تعالى-: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
ثم نراها تضرب الأمثال لأهل مكة، لعلهم يتعظون ويعتبرون، ويتركون الجحود والبطر.. إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ، إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ. وَلا يَسْتَثْنُونَ. فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.
ثم نرى من مقاصدها كذلك: المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.
وتسفيه أفكار المشركين وعقولهم، بأسلوب مؤثر خلاب: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ..
وتهديدهم بأقصى ألوان التهديد: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ...
ثم تختتم بتكرار التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره بالصبر على أذى أعدائه: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ، إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ، لَوْلا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ.
وبعد: فهذه كلمة مجملة عن سورة «القلم» تكشف عن زمان ومكان نزولها. وعن أهم المقاصد والأهداف، التي اشتملت عليها.
ونسأل الله- تعالى- أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأنس نفوسنا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
افتتحت سورة " القلم " بأحد الحروف المقطعة ، وهى آخر سورة فى ترتيب المصحف ، افتتحت بواحد من هذه الحروف . أما بالنسبة لترتيب النزول ، فقد تكون أول سورة نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى السور المفتتحة بالحروف المقطعة .
وقد قلنا عند تفسيرنا لسورة البقرة : وردت هذه الحروف المقطعة تارة مفردة بحرف واحد ، وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة ، أو أربعة ، أو خمسة .
فالسور التى تدئت بحرف واحد ثلاث سور وهى : ص ، ق ، ن .
والسور التى بدئت بحرفين تسع سور وهى : طه ، يس ، طس ، وحم ، فى ست سور ، وهى : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف .
والسور التى بدئت بثلاثة أحرف ، ثلاث عشرة سورة وهى : " ألم " فى ست سور ، وهى : البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة .
و ( الر ) فى خمس سور : وهى : يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر .
و ( طسم ) فى سورتين وهما : الشعراء ، والقصص .
وهناك سورتان بدئتا بأربعة أحرف وهما : الرعد ، " الر " والأعراف " المص " .
وهناك سورتان - أيضا - بدأنا بخمسة أحرف ، وهما : " مريم " " كهيعص " والشورى : " حم عسق " فيكون مجموع السور التى افتتحت بالحروف المقطعة : تسعا وعشرين سورة .
هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء فى المعنى المقصود بتلك الحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجال خلافهم فى رأيين رئيسيين :
الرأى الأول يرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهى من المتشابه الذى استأثر الله - تعالى - بعلمه .
وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - فى بعض الروايات عنه - كما ذهب إليه الشعبى ، وسفيان الثورى وغيرهم من العلماء .
فقد أخرج ابن المنذر عن الشعبى أنه سئل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سرا ، وإن سر هذا القرآن فى فواتح السور .
ويروى عن ابن عباس أنه قال : عجزت العلماء عن إدراكها .
وعن على بن أبى طالب أنه قال : " إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة الكتاب حروف التهجى " .
وفى رواية أخرى عن الشعبى أنه قال : " سر الله فلا تطلبوه "
ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى ، أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه ، فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثل ذلك كمثل المتكلم بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها .
وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ ، لم ينتف الإِفهام عنها عند كل أحد ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين ، ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس جميعا فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور .
وهناك مناقشات أخرى للعلماء حول هذا الرأى ، يضيق المجال عن ذكرها .
أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذى استأثر الله - تعالى - بعلمه .
وأصحاب هذا الرأى قد اختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتى :
أ - أن هذه الحروف أسماء للسور ، بدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة " ص " وسورة " يس " .
ولايخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، والغرض من التسمية رفع الاشتباه .
ب - وقيل : إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة ، للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .
ج - وقيل : إنها حروف مقطعة ، بعهضا من أسماء الله - تعالى - ، وبعضها من صفاته ، فمثلا : ( ألم ) أصلها : أنا الله أعلم .
د - وقيل : إنها اسم الله الأعظم . إلى غير ذلك من الأقوال التى لا تخلوا من مقال ، والتى أوصلها الإمام السيوطى فى كتابه " الإتقان " إلى أكثر من عشرين قولا .
ه - ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت فى افتتاح بعض السور ، للإِشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى الله به المشركين ، هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التى يعرفونها ، ويقدرون على تأليف الكلام منها ، فإذا عجزوا عن الإِتيان بسورة من مثله ، فذلك لبلوغه فى الفصاحة والبلاغة ، مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة .
وفضلا عن ذلك ، فإن تصدير هذه السور بمثل هذه الحروف المقطعة ، يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم ، إلى الإِنصات والتدبر ، لأنه يطرق أسماعهم فى أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة فى مجارى كلامهم . وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ، فيسمعوا حكما وحججا قد تكون سببا فى هدايتهم واستجابتهم للحق .
هذه خلاصة لآراء العلماء فى الحروف المقطعة ، التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع - مثلا - إلى كتاب " البرهان " للزركشى . وكتاب " الإتقان " للسيوطى ، وتفسير " الآلوسى " .
ولفظ " ن " على الرأى الذى رجحناه ، يكون إشارة إلى إعجاز القرآن . . .
وقيل : هو من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه . .
وقد ذكر بعض المفسرين أقوالا أخرى ، لا يعتمد عليها لضعفها ، ومن ذلك قولهم : إن " نون " اسم لحوت عظيم . . أو اسم للدواة . . . وقيل : " نون " لوح من نور . .
والواو فى قوله : ( والقلم ) للقسم ، والمراد بالقلم : جنسه ، فهو يشمل كل قلم يكتب به و " ما " فى قوله ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) موصولة أو مصدرية .
و ( يَسْطُرُونَ ) مضارع سطر - من باب نصر - ، يقال : سطر الكتاب سطرا ، إذا كتبه ، والسطر : الصف من الشجر وغيره ، وأصله من السطر بمعنى القطع ، لأن صفوف الكتابة تبدو وكأنها قطع متراصة .
تفسير سورة " ن " وهي مدنية .
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول " سورة البقرة " ، وأن قوله : ( ن ) كقوله : ( ص ) ) ق ) ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور ، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته .
وقيل : المراد بقوله : ( ن ) حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط ، وهو حامل للأرضين السبع ، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير :
حدثنا ابن بشار ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان - هو الثوري - حدثنا سليمان - هو الأعمش - عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر . فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق " النون " ورفع بخار الماء ، ففتقت منه السماء ، وبسطت الأرض على ظهر النون ، فاضطرب النون فمادت الأرض ، فأثبتت بالجبال ، فإنها لتفخر على الأرض .
وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن أحمد بن سنان ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش به . وهكذا رواه شعبة ، ومحمد بن فضيل ، ووكيع ، عن الأعمش ، به . وزاد شعبة في روايته : ثم قرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) وقد رواه شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان - أو مجاهد ، - عن ابن عباس فذكر نحوه . ورواه معمر ، عن الأعمش : أن ابن عباس قال . . . فذكره ، ثم قرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم ، ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . ثم خلق " النون " فوق الماء ، ثم كبس الأرض عليه .
وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذي ، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أول ما خلق الله القلم والحوت ، قال للقلم : اكتب ، قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيء كائن إلى يوم القيامة " . ثم قرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) فالنون : الحوت . والقلم : القلم .
حديث آخر في ذلك : رواه ابن عساكر ، عن أبي عبد الله مولى بني أمية ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن أول شيء خلقه الله القلم ، ثم خلق " النون " وهي : الدواة . ثم قال له : اكتب . قال وما أكتب ؟ قال : اكتب ما يكون - أو : ما هو كائن - من عمل ، أو رزق ، أو أثر ، أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة ، فذلك قوله : ( ن والقلم وما يسطرون ) ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ، ثم خلق العقل وقال : وعزتي لأكملنك فيمن أحببت ، ولأنقصنك ممن أبغضت " .
وقال ابن أبي نجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون : الحوت العظيم الذي تحت الأرض السابعة .
وذكر البغوي وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السماوات والأرض ، وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن ، وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فالله أعلم . ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد :
حدثنا إسماعيل ، حدثنا حميد ، عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، فأتاه فسأله عن أشياء ، قال : إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي ، قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : " أخبرني بهن جبريل آنفا " . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : " أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت " .
ورواه البخاري من طرق عن حميد ، ورواه مسلم أيضا ، وله من حديث ثوبان - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا . وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان : أن حبرا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مسائل ، فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ - يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة - قال : " زيادة كبد الحوت " . قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : " ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها " . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : " من عين فيها تسمى سلسبيلا " .
وقيل : المراد بقوله : ( ن ) لوح من نور .
قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب ، حدثنا محمد بن زياد الجزري ، عن فرات بن أبي الفرات ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ( ن والقلم وما يسطرون ) لوح من نور ، وقلم من نور ، يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة " وهذا مرسل غريب .
وقال ابن جريج أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام .
وقيل : المراد بقوله : ( ن ) دواة ، والقلم : القلم . قال ابن جرير :
حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، وقتادة في قوله : ( ن ) قالا هي الدواة .
وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جدا ، فقال ابن أبي حاتم :
حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " خلق الله النون ، وهي الدواة " .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أخي عيسى بن عبد الله ، حدثنا ثابت الثمالي ، عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون - وهي الدواة - وخلق القلم ، فقال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر ، أو فجور ، أو رزق مقسوم ، حلال ، أو حرام . ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه : دخوله في الدنيا ، ومقامه فيها كم ؟ وخروجه منها كيف ؟ ثم جعل على العباد حفظة ، وللكتاب خزانا ، فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم ، فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم ، فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا فترجع الحفظة ، فيجدونهم قد ماتوا . قال : فقال ابن عباس : ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون : ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) [ الجاثية : 29 ] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل .
وقوله : ( والقلم ) الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله ( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) [ العلق : 3 - 5 ] . فهو قسم منه تعالى ، وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ; ولهذا قال : ( وما يسطرون ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة : يعني : وما يكتبون .
وقال أبو الضحى ، عن ابن عباس : ( وما يسطرون ) أي : وما يعملون .
وقال السدي : ( وما يسطرون ) يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد .
وقال آخرون : بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم ، فقال ابن أبي حاتم :
حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي ، عن عطاء - هو ابن أبي رباح - حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعاني أبي حين حضره الموت فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب . قال : يا رب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ ما كان ] وما هو كائن إلى الأبد " .
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق ، عن الوليد بن عبادة ، عن أبيه به . وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به . ، وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو داود في كتاب " السنة " من سننه ، عن جعفر بن مسافر ، عن يحيى بن حسان ، عن ابن رباح ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أبي حفصة - واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشامي - عن عبادة فذكره .
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي ، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا رباح بن زيد ، عن عمر بن حبيب ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أول شيء خلقه الله القلم ، فأمره ، فكتب كل شيء " . غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجوه
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( والقلم ) يعني : الذي كتب به الذكر . .
وقوله : ( وما يسطرون ) أي : يكتبون كما تقدم .
القول في تأويل قوله تعالى : ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1)
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( ن ) فقال بعضهم: هو الحوت الذي عليه الأرَضُون.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبى عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عباس، قال: أوّل ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء، فخلقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون، فتحرّكت الأرض فمادت، فأثبت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض، قال: وقرأ: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ).
حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، أو مجاهد عن ابن عباس، بنحوه، إلا أنه قال: فَفُتِقَتْ مِنْهُ السموات.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: ثني سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أوّل ما خلق الله القلم، قال: اكتب، &; 23-524 &; قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال: فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم خلق النون، ورفع بخار الماء، ففُتِقت منه السماء و بُسِطت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون، فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال، فإنها لتفخر على الأرض.
حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: " أوّل ما خلق الله من شيء القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات، ثم خلق النون فدُحيت الأرض على ظهره، فاضطرب النون، فمادت الأرض، فأُثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض ".
حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس نحوه.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، أن إبراهيم بن أبي بكر، أخبره عن مجاهد، قال: كان يقال النون: الحوت الذي تحت الأرض السابعة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، قال: قال معمر، ثنا الأعمش، أن ابن عباس قال: إنّ أوّل شيء خُلق القلم، ثم ذكر نحو حديث واصل عن ابن فضيل، وزاد فيه: ثم قرأ ابن عباس: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ).
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن ابن عباس، قال: إن أوّل شيء خلق ربي القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كبس الأرض عليه.
وقال آخرون: ( ن ) حرف من حروف الرحمن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عبد الله بن أحمد المروزي، قال: ثنا عليّ بن الحسين، قال: ثنا أبي، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس الر و حم و ( ن ) حروف الرحمن مقطعة.
حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا عباس بن زياد الباهلي، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قوله: الر و حم و ( ن ) قال: اسم مقطع.
وقال آخرون: ( ن ) : الدواة، والقلم: القلم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أخي عيسى بن عبد الله، عن ثابت البناني، عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون وهي الدواة، وخلق القلم، فقال: &; 23-525 &; اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، من عمل معمول، برّ أو فجور، أو رزق مقسوم حلال أو حرام، ثم ألزم كلّ شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم، وخروجه منها كيف؛ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا، فالحفظة ينسخون كلّ يوم عمل ذلك اليوم، فإذا فني الرزق وانقطع الأثر، وانقضى الأجل، أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا؛ قال: فقال ابن عباس: ألستم قوما عربا تسمعون الحَفَظة يقولون: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في قوله: ( ن ) قال: هو الدواة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمرو، عن قتادة، قال: النون: الدواة.
وقال آخرون: ( ن ) : لوح من نور.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا الحسن بن شبيب المكتّب، قال: ثنا محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن أبي الفرات، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ )" لوح من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة لوح &;
وقال آخرون: ( ن ) : قَسَم أقسم الله به.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) يُقْسِم الله بما شاء.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله الله: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: هذا قسم أقسم الله به.
وقال آخرون: هي اسم من أسماء السورة.
وقال آخرون: هي حرف من حروف المعجم؛ وقد ذكرنا القول فيما جانس ذلك من حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور، والقول في قوله نظير القول في ذلك.
واختلفت القرّاء في قراءة: ( ن ) فأظهر النون فيها وفي يس عامة قرّاء الكوفة خلا الكسائيّ، وعامة قرّاء البصرة، لأنها حرف هجاء، والهجاء مبني على الوقوف عليه وإن اتصل، وكان الكسائيّ يُدغم النون الآخرة منهما ويخفيها بناء على الاتصال.
والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب، غير أن إظهار النون أفصح وأشهر، فهو أعجب إلىّ.وأما القلم فهو القلم المعروف، غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام: القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره، فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة.
حدثني محمد بن صالح الأنماطي، قال ثنا عباد بن العوّام، قال: ثنا عبد الواحد بن سليم، قال: سمعت عطاء، قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حشره الموت؟ فقال: دعاني فقال: أي بنيّ اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده، والقدر خيره وشرّه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ خَلَقَ القَلَمَ، فَقالَ لَهُ: اكْتُبْ، قالَ: يَا رَبّ وَما أكْتُبُ؟ قال: اكْتُبَ القَدَرَ، قالَ فَجَرَى القَلَمُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كانَ وَما هُوَ كائِنٌ إلى الأبَدِ".
حدثني محمد بن عبد الله الطوسي، قال: ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا رباح بن زيد، عن عمرو بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوَّلُ شَيْء خَلَق اللهُ القَلَمَ وأمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْء ".
حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا ابن المبارك بإسناده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نحوه.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: إن ناسا يكذّبون بالقدر، فقال: إنهم يكذّبون بكتاب الله، لآخذّن بشَعْر أحدهم، فلا يقصَّن به، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فكان أوّل ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فُرغ منه.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو هاشم، أنه سمع مجاهدًا، قال: سمعت عبد الله - لا ندري ابن عمر أو ابن عباس قال -: إن أوّل ما خلق الله القلم، فجرى القلم بما هو كائن؛ وإنما يعمل الناس اليوم فيما قد فُرِغ منه.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني معاوية بن صالح؛ وحدثني عبد الله بن آدم، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح، عن أيوب بن زياد، قال: ثني عباد بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، قال: أخبرني أبي، قال: قال أبي عُبادة بن الصامت: يا بنيّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ"
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( ن وَالْقَلَمِ ) قال: الذي كُتِبَ به الذكر.
حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، أخبره عن إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، في قوله: ( ن وَالْقَلَمِ ) قال: الذي كتب به الذكر.
وقوله: ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) يقول: والذي يخُطُّون ويكتبون. وإذا وُجِّهَ التأويل إلى هذا الوجه كان القسم بالخلق وأفعالهم. وقد يحتمل الكلام معنى آخر، وهو أن يكون معناه: وسطرهم ما يسطرون، فتكون " ما " بمعنى المصدر. واذا وُجه التأويل إلى هذا الوجه، كان القسم بالكتاب، كأنه قيل: ن والقلم والكتاب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: وما يَخُطُّون.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) يقول: يكتبون.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: وما يكتبون.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) : وما يكتبون، يقال منه: سطر فلان الكتاب فهو يَسْطُر سَطْرا: إذا كتبه؛ ومنه قول رُؤبة بن العجَّاج:
إنّي وأسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرَا (1)
------------------
الهوامش :
(1) البيت في ديوان رؤبة بن العجاج الراجز (ديوانه طبع ليبسج 174). وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن عند قوله تعالى: ( والقلم وما يسطرون ) قال: وما يكتبون قال رؤبة: "إني وأسطار..." البيت. والأسطار: جمع سطر، وهو الصف من النخل أو من حروف الكتابة المنسوقة.
التدبر :
وقفة
[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أقسم ربنا ﷻ بالقلم لعظمته؛ فلا يكن قلمك عندك هيِّـنًا.
وقفة
[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ القلم نعمة من الله عظيمة، لولا القلم ما قام دين، ولم يصلح عيش، والله أعلم بما يصلح خلقه.
وقفة
[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ القسم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب به القرآن، وكتبت به الكتب المقدسة، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق، والعلوم؛ وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى.
وقفة
[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أقسم الله سبحانه بالقلم، وهو واقع على كل قلم يكتب به من في السماء ومن في الأرض، وقلم اليوم يشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وما أعظم أثرها على حياتنا.
وقفة
[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ فضل القلم، قال ابن القيم: «القلم من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم، وتثبت الحقوق، وتُعلّم الوصايا، وتحفَظ الشهادات، ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تُقيَّد أخبار الماضين للباقين اللاحقين، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن، وتخبَّطت الأحكام».
وقفة
[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ قيل لابن المبارك: «إلى كم تكتب الحديث؟»، قال: «لعل الكلمة التي أنتفع بها، لم أسمعها بعد».
وقفة
[1] ﴿ن وَالقَلَمِ وَما يَسطُرونَ﴾ لا حاجة للقلم بدون استخدامه فيما يفيد.
وقفة
[1] لقد عظم الله القلم، وأقسم به فقال: ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾، فيا سفاهة ويا ويل من كتب به تنقصًا واستهزاءً وسخريةً بالله ورسوله وبشريعته وأوليائه.
الإعراب :
- ﴿ ن: ﴾
- شأنها شأن الأحرف التي تبدأ بها بعض السور وقد شرحت في سور سابقة وقيل عن «ن» اضافة لما قيل عن حروف بقية السور فيها قراءات ومعان كثيرة. قال الزمخشري: قرئ ن والقلم وبالبيان والادغام وبسكون النون وفتحها وكسرها كما في ص، والمراد هذا الحرف من حروف المعجم واما قولهم هو الداوة فما ادري أهو وضع لغوي ام شرعي، ولا يخلو اذا كان اسما للدواة من ان يكون جنسا او علما، فان كان جنسا فأين الاعراب والتنوين، وان كان علما فأين الاعراب؟ وايهما كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام. فان قلت: هو مقسم به وجب ان كان جنسا ان تجره وتنونه ويكون القسم بداوة منكرة مجهولة كأنه قيل وداوة والقلم، وان كان علما ان تصرفه وتجره اولا تصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث وكذلك التفسير بالحوت اما ان يراد نون من النينان او يجعل علما للبهموت الذي يزعمون والتفسير باللوح من نور او ذهب والنهر في الجنة نحو ذلك وقيل نون: من الرحمن.
- ﴿ وَالْقَلَمِ: ﴾
- الواو واو القسم حرف جر. القلم: مقسم به مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وعلامة جر الاسم الكسرة.
- ﴿ وَما يَسْطُرُونَ: ﴾
- الواو عاطفة. ما: اسم موصول بمعنى الذي او مصدرية. يسطرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يسطرون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: وما يسطرونه او تكون صلة «ما» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر معطوف على «القلم» بمعنى وما يكتب من كتب وقيل ما يسطره الحفظة. وجواب القسم في الآية الكريمة الثانية «ما انت بنعمة ربك بمجنون».'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالقَسَمِ على رِفعةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وبراءتِه ممَّا اتَّهمَهُ به المشركونَ من الجُنونِ، ووصفه بالخُلُقِ العَظيمِ، قال تعالى:
﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
ن:
1- بسكونها وإدغامها فى «واو» و «القلم» ، بغنة أو بغير غنة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بإظهارها، وهى قراءة حمزة، وأبى عمرو، وابن كثير، وقالون، وحفص.
3- بكسرها، لالتقاء الساكنين، وهى قراءة ابن عباس وابن أبى إسحاق، والحسن، وأبى السمال.
4- بفتحها، وهى قراءة سعيد بن جبير، وعيسى بخلاف عنه.
مدارسة الآية : [2] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾
التفسير :
وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام، من آيات الله العظيمة، التي تستحق أن يقسم الله بها، على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنونبنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا، ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال:{ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا} .
وجواب القسم قوله : ( مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) .
أى : وحق القلم الذى يكتب به الكاتبون من مخلوقاتنا المتعددة ، إنك - أيها الرسول الكريم - لمبرأ مما اتهمك به أعداؤك من الجنون ، وكيف تكون مجنونا وقد أنعم الله - تعالى - عليك بالنبوة والحكمة .
فالمقصود بالآيات الكريمة تسلية النبى صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المشركين ، ودفع تهمهم الباطلة دفعا يأتى عليها من القواعد فيهدمها ، وإثبات أنه رسول من عنده - تعالى - .
وأقسم - سبحانه - بالقلم ، لعظيم شرفه ، وكثرة منافعه ، فبه كتبت الكتب السماوية ، وبه تكتب العلوم المفيدة . . وبه يحصل التعارف بين الناس . .
وصدق الله إذ يقول : ( اقرأ وَرَبُّكَ الأكرم . الذى عَلَّمَ بالقلم . عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ ) قال القرطبى : أقسم - سبحانه - بالقلم . لما فيه من البيان كاللسان . وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من السماء من فى الأرض ، ومنه قول أبى الفتح البستى :
إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم ... وعدُّوه مما يُكْسِبُ المجد والكرَمْ
كفى قلم الكتاب عزا ورفعة ... مدى الدهر أن الله أقسم بالقلَمْ
والضمير فى قوله : ( يَسْطُرُونَ ) راجع إلى غير مذكور فى الكلام ، إلا أنه معلوم للسامعين ، لأن ذكر القلم يدل على أن هناك من يكتب به .
ونفى - سبحانه - عنه صلى الله عليه وسلم الجنون بأبلغ أسلوب ، لأن المشركين كانوا يصفونه بذلك ، قال - تعالى - . ( وَإِن يَكَادُ الذين كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ) قال الآلوسى : قوله : ( مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) . جواب القسم ، والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفى . ومجنون خبر ما ، والباء الأولى للملابسة ، والجار والمجرور فى موضع الحال من الضمير فى الخبر ، والعامل فيها معنى النفى .
والمعنى : انتفى عنك الجنون فى حال كونك ملتبسا بنعمة ربك أى : منعما عليك بما أنعم من حصافة الرأى ، والنبوة . .
وفى إضافته صلى الله عليه وسلم إلى الرب - عز وجل - مزيد إشعار بالتسلية والقرب والمحبة . ومزيد إشعار - أيضا - بنفى ما افتراه الجاهلون من كونه صلى الله عليه وسلم مجنونا ، لأن هذه الصفة لا تجتمع فى عبد أنعم الله - تعالى - عليه ، وقربه ، واصطفاه لحمل رسالته وتبليغ دعوته .
أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون.
وقوله: ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مكذِّبا بذلك مشركي قريش الذين قالوا له: إنك مجنون.
المعاني :
التدبر :
عمل
[2] ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ يتقلب في النعمة ويتهم بالجنون، كن كما أنت فالحقيقة والوهم ﻻ يجتمعان.
وقفة
[2] ﴿ما أَنتَ بِنِعمَةِ رَبِّكَ بِمَجنونٍ﴾ يهون على المرء كل سوء يُرمى به؛ فلقد وُصف المصطفى ﷺ بما هو أسوأ.
وقفة
[2] ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ كل الصفات المحمودة إنما حصلت، وكل الصفات المذمومة إنما زالت، بسبب إنعام الله ولطفه وإكرامه.
وقفة
[2] ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ حسب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة علية، أن الله سبحانه تولى الذب عن عرضه الشريف، ودفع افتراء المبطلين عنه.
وقفة
[2] ما تفسير الباء في قوله تعالى: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾، وقوله: ﴿بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ [6]؟ الجواب: الباء في قوله: (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) سببية، أي: بسبب إنعام الله عليكم فلست بمجنون، والباء في قوله: (بِأَيِّكُمُ) ظرفية بمعنى (في)، وقيل: زائدة، والله أعلم.
تفاعل
[2] احمد الله على ثلاث نعم أنعم بها عليك ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾.
الإعراب :
- ﴿ ما أَنْتَ: ﴾
- نافية بمنزلة «ليس» عند اهل الحجاز ولا عمل لها عند بني تميم. نت: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «ما» على اللغة الاولى ومبتدأ على اللغة الثانية. والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لها.
- ﴿ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بمجنون في محل نصب حال بمعنى: ما انت بمجنون منعما عليك بالنبوة والفهم ولم تمنع الباء في «بمجنون» ان يعمل مجنون فيما قبله لانها زائدة لتأكيد النفي اي استبعاد ما كان ينسبه اليك كفار مكة عداوة وحسدا. ربك: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ بِمَجْنُونٍ: ﴾
- الباء حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي. مجنون: اسم مجرور لفظا منصوب محلا على انه خبر «ما» ومرفوع محلا على انه خبر «أنت».'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد القسم؛ جاء هنا جوابُ القسم، فنفى اللهُ عن نبيِّه صلى الله عليه وسلم الجنون بأبلغ أسلوب؛ لأن المشركين كانوا يصفونه بذلك، قال تعالى:
﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾
التفسير :
أي:لأجرا عظيمًا، كما يفيده التنكير،{ غير ممنون} أي:[غير] مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، والأخلاق الكاملة.
ثم بشره - سبحانه - ببشارة ثانية فقال : ( وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ) .
وقوله : ( مَمْنُونٍ ) مأخوذ من المن بمعنى القطع ، تقول : مننت الحبل ، إذا قطعته ، ويصح أن يكون من المن ، بمعنى أن يعطى الإِنسان غيره عطية ثم يفتخر بها عليه ، ومنه قوله - تعالى - : ( ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بالمن والأذى . . . )
أى : وإن لك - أيها الرسول الكريم - عندنا ، لأجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا نحن ، وهذا الأجر غير مقطوع بل هو متصل ودائم وغير مجنون .
وهذه الجملة الكريمة وما بعدها ، معطوفة على جملة جواب القسم ، لأنهما من جملة المقسم عليه . .
( وإن لك لأجرا غير ممنون ) أي : بل لك الأجر العظيم ، والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد ، على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق ، وصبرك على أذاهم . ومعنى ) غير ممنون ) أي : غير مقطوع كقوله : ( عطاء غير مجذوذ ) [ هود : 108 ] ( فلهم أجر غير ممنون ) [ التين : 6 ] أي : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : ( غير ممنون ) أي : غير محسوب ، وهو يرجع إلى ما قلناه .
وقوله: ( وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ) يقول تعالى ذكره: وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين إياك غير منقوص ولا مقطوع، من قولهم: حبل متين، إذا كان ضعيفا، وقد ضعفت منَّته: إذا ضعفت قوّته.
وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني به محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: محسوب.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ كل أذى نالك في سبيل دعوتك، وطعن نالك من المعاندين، فاصبر عليه صبر الموقنين بحسن جزاء العاملين.
وقفة
[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ قال الآلوسي: «أو غير ممنون عليك من جهة الناس، فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة؛ لأنك حبيب الله تعالى، وهو عز وجل أكرم الأكرمين، ومن شيمة الأكارم أن لا يمنوا بإنعامهم، لا سيَّما إذا كان على أحبابهم».
وقفة
[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ كل داعية بعد النبي ﷺ يسير على منهجه ويحمل رسالته للناس، له نصيب من هذا الأجر.
تفاعل
[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ سَل الله من فضله الآن.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً: ﴾
- الواو استئنافية. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. لك: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم واللام لام التوكيد- المزحلقة-. أجرا: اسم «ان» مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي لثوابا.
- ﴿ غَيْرَ مَمْنُونٍ: ﴾
- صفة- نعت- لاجرا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة. ممنون: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي غير مقطوع او غير منقوص'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ثبَّتَ اللهُ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدفَعَ بُهتانَ أعدائِه؛ أعقَبَه بإكرامِه بأجْرٍ عظيمٍ على ما لَقِيَه مِن المشرِكينَ مِن أذًى، قال تعالى:
﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾
التفسير :
{ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} أي:عاليًا به، مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به، وحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، [عائشة -رضي الله عنها-] لمن سألها عنه، فقالت:"كان خلقه القرآن"، وذلك نحو قوله تعالى له:{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}{ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [الآية]،{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيُصُ عَلَيْكُم بِالمْؤُمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، [والآيات] الحاثات على الخلق العظيمفكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلًا لينا، قريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من دعاه، قاضيًا لحاجة من استقضاه، جابرًا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبًا، وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلي عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم.
ثم أثنى - سبحانه - عليه بأجمل ثناء وأطيبه فقال : ( وَإِنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) .
والخلق - كما يقول الإِمام الرازى - ملكه نفسانية ، يسهل على المتصف بها الإِتيان بالأفعال الجميلة . . . و . . .
والعظيم : الرفيع القدر ، الجليل الشأن ، السامى المنزلة .
أى : وإنك - أيها الرسول الكريم - لعل دين عظيم ، وعلى خلق كريم ، وعلى سلوك قويم ، فى كل ما تأتيه وما تتركه من أقوال وأفعال . .
والتعبير بلفظ " على " يشعر بتمكنه صلى الله عليه وسلم ورسوخه فى كل خلق كريم . وهذا أبلغ رد على أولئك الجاهلين الذين وصفوه بالجنون ، لأن الجنون سفه لا يحسن معه التصرف . أما الخلق العظيم ، فهو أرقى منازل الكمال ، فى عظماء الرجال .
والتعبير بلفظ " على " يشعر بتمكنه صلى الله عليه وسلم ورسوخه فى كل خلق كريم . وهذا أبلغ رد على أولئك الجاهلين الذين وصفوه بالجنون ، لأن الجنون سفه لا يحسن معه التصرف . أما الخلق العظيم ، فهو أرقى منازل الكمال ، فى عظماء الرجال .
وإن القلم ليعجز عن بيان ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة ، من ثناء من الله - تعالى - على نبيه صلى الله عليه وسلم .
قال الإِمام ابن كثير عند تفسيره ، لهذه الآية ما ملخصه : قال قتادة : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل السيدة عائشة عن معنى هذه الآية فقالت : ألست تقرأ القرآن؟ قال : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن . .
ومعنى هذا ، أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا ، سجية له وخلقا وطبعا ، فمهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه ، هذا ما جبله الله عليه من الخلق الكريم ، كالحكمة ، والعفة ، والشجاعة ، والعدالة . .
وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم جماع كل خلق عظيم وهو القائل : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " .
وقوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) قال العوفي ، عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم ، وهو الإسلام . وكذلك قال مجاهد ، وأبو مالك ، والسدي ، والربيع بن أنس ، والضحاك ، وابن زيد .
وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر ، عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : كان خلقه القرآن ، تقول كما هو في القرآن .
وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان القرآن .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبريني يا أم المؤمنين - عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : أتقرأ القرآن ؟ فقلت : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن .
هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه ، من حديث قتادة بطوله ، وسيأتي في سورة " المزمل " إن شاء الله تعالى .
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن رجل من بني سواد قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : أما تقرأ القرآن : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ؟ قال : قلت : حدثيني عن ذاك . قالت : صنعت له طعاما ، وصنعت له حفصة طعاما ، فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . قالت : فألقت الجارية ، فوقعت القصعة فانكسرت - وكان نطعا - قالت : فجمعه رسول الله وقال : " اقتضوا - أو : اقتضي - شك أسود - ظرفا مكان ظرفك " . قالت : فما قال شيئا .
وقال ابن جرير : حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس ، حدثنا أبي ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن سعد بن هشام : قال : أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : أخبريني بخلق النبي صلى لله عليه وسلم . فقالت : كان خلقه القرآن . أما تقرأ : ( وإنك لعلى خلق عظيم )
وقد روى أبو داود ، والنسائي من حديث الحسن ، نحوه
وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب ، وأخبرني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير قال : حججت ، فدخلت على عائشة رضي الله عنها ، فسألتها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن .
وهكذا رواه أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي . ورواه النسائي في التفسير ، عن إسحاق بن منصور ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح به
ومعنى هذا أنه ، عليه السلام ، صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له ، وخلقا تطبعه ، وترك طبعه الجبلي ، فمهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم ، من الحياء ، والكرم والشجاعة ، والصفح ، والحلم ، وكل خلق جميل . كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين فما قال لي : " أف " قط ، ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقا ، ولا مسست خزا ، ولا حريرا ، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وقال البخاري : حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس وجها ، وأحسن الناس خلقا ، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير
والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب " الشمائل " .
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده خادما له قط ، ولا امرأة ، ولا ضرب بيده شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله . ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله ، فيكون هو ينتقم لله ، عز وجل
وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق " . تفرد به
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)
يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك.
حدثني على قال ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) يقول: دين عظيم.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن بن عباس، قوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) يقول: إنك على دين عظيم، وهو الإسلام.
حدثني محمد بن عمرو، قال. ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن. قال. ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قال: الدين.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: سألتُ عائشة عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، تقول: كما هو في القرآن.
حدثنا بشر، قال. ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) ذُكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
حدثنا عُبيد بن آدم بن أبي إياس، قال: ثني أبي، قال: ثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن سعيد بن هشام، قال: أتيت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: أخبريني عن خُلُق رسول الله، فقالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ).
أخبرنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن أبى الزهرية، عن جُبير بن نُفَير قال: حججبت فدخلت على عائشة، فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن.
حدثنا عبيد بن أسباط، قال: ثني أبي، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، في قوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قال: أدب القرآن.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قال: على دين عظيم.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: (لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) يعني دينه، وأمره الذي كان عليه، مما أمره الله به، ووكله إليه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ أي: دين وهدي عظيم؛ وذلك أنه ﷺ كان خلقه القرآن، تلاوة وتدبُّرًا، وعملًا بأوامره، وتركًا لنواهيه، وترغيبًا في طاعة الله ورسوله، ودعوة إلى الخير، ونصيحة لله ولعباده، إلى غير ذلك من وجوه الخير.
لمسة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ حرف الجر (على) يفيد أن الخلق هو مركوبك الذي تستعلي عليه لتسير به بين الناس، فاختر مركبك.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وصفت الآية الكريمة خلق النبي ﷺ بالعظمة, والله هو قاسم الأرزاق والأخلاق؛ فأعطي النبي ﷺ من الرزق كفافًا, ومن الأخلاق تمامًا.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ فسبحان الله ما أعظم شأنه، وأتم امتنانه! انظر إلى عميم لطفه، وعظيم فضله، كيف أعطى ثم أثنى، فهو الذي زينه بالخلق الكريم، ثم أضاف إليه ذلك فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ومن عظمة خُلقه: سماحة نفسه، وعدم تكلفه، مهما اختلفت الأحوال والأزمان والأماكن.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ أكد ﷻ أنه ﷺ على خلق عظيم في آية واحدة مرتين: فأكده بـ (إنّ)، وأكده بـ (اللام)، اللهم املأ قلوبنا بحب نبيِّنا.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ تعاظمت أخلاقه فتصاغر أعداؤه.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ لم يمدحه الله بسبب نسبه أو شكله أو ماله، بل مدح فيه حُسن الخلق؛ الإسلام دين مبادئ.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ نواجه أزمات عديدة متفاوتة في حدتها وانتشارها، لكن كلها تزول إذا عالجنا الأزمة الأخلاقية.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ القائل: الله سبحانه وتعالى.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ اتصاف الرسول ﷺ بأخلاق القرآن.
لمسة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ قل: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق».
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ قال ابن عاشور: «واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين، ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتاعب، والاعتراف للمحسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والعفو، والجمود، والحياء، والشجاعة، وحسن الصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمة، وحسن المعاملة والمعاشرة».
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ما مدحه الله بمال ولا كثرة عيال، ولا لعقل أو عراقة نسب، وإنما أثنى عليه الله بسبب خُلُقه، فقيمتك عند ربك بحسب أخلاقك.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ قال ابن القيم: «الدِّينُ كلُّه خُلق، فَمن فاقكَ في الخُلق فَقد فاقكَ في الدِّين»، وقال عبد الله بن المبارك: «كادَ الأدبُ أن يكون ثُلثي الدِّين».
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ أفاد حرف الجر معنى الاستعلاء، فهو ﷺ مستعلٍ على كل خلق، متمكن منه.
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ شهادة ووسام من فوق سبع سموات للرسول صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فهل أدرك أعداء الإسلام من هو رسولنا الكريم؟!
وقفة
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ أثنى الله على خُلقه ﷺ، وليس حسبه أو نسبه، أخلاقك هي التي تميزك؛ فجَمِّلْها تكن أجمل الناس.
عمل
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ لا تندم على حسن خلقك مع الناس، حتى وإن قابلوك بالإساءة، فإن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقًا.
تفاعل
[4] ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ قل: «اللهم إنا نسألك حسن الخلق».
وقفة
[4] من المعلوم أن أحب خلق الله إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانًا أحسنهم خلقًا؛ كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقًا، والخلق الدين كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
وقفة
[4] حينما أراد الله وصف نبيه لم يصف شكله أو نسبه أو ماله، ولكن قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ قيمتُك بأخلاقِك.
وقفة
[4] تغنى به الشعراء ومدحه المادحون وأحبه أتباعه واحترمه أعداؤه، وما بلغ أحد فيه قول ربه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
وقفة
[4] سبحان من أعطى ثم أثنى، أعطى الله نبيه ﷺ الخلق العظيم، ثم أثنى عليه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فهو الذي زينه بالخلق الكريم، ثم أضاف ذلك إليه.
وقفة
[4] اعلم أنك لست أكمل عقلًا ولا أشرف نسبًا من النبي ﷺ، ومع ذلك لم يمدحه ربه لعقله ولا لنسبه، وإنما أثنى عليه ومدحه لخُلُقِه ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
وقفة
[4] لا يوجد وصف للنبي ﷺ أفضل مما وصَفهُ به ربُّه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ إرتقى ﷺ بأخلاقه فارتقى ذِكره حتى نالَ الوسيلة من الجنة.
وقفة
[4] أعظم من كملت أخلاقه نبينا ﷺ بشهادة الله له ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، وسبيل الكمال الخُلقي أن نتشبه به.
وقفة
[4] يكفيك أن ربك بشر بك وامتن على عباده بك وكمل تمام خلقك: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، وأمر بالصلاة عليك وتوقيرك ونصرتك.
وقفة
[4] قال ابن تيمية: «سورة ن هي سورة الخُلُق، الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به محمدًا ﷺ، قال ﷻ في مطلعها: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾».
وقفة
[4] من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يُعامل الآخرين بأخلاقه هو، فلا يرد الإساءة بالإساءة ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
وقفة
[4] الحث على مكارم الأخلاق ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
وقفة
[4] عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرِينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾» [أحمد 24601، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين].
وقفة
[4] من أعظم أسباب قبول الناس لما يقوله الداعية: (حسن الخلق سلوكاً ومنطقاً)، وقد يُعذر بترك القيام ببعض وسائل العلم والدعوة لقيام العارض، ولا يُعذر بسوء الخلق، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، وزكاه ربه فقال: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾.
وقفة
[4] الأخلاق مثل الأرزاق تمامًا، هي قسمة من الله، فيها غني وفيها فقير ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى: ﴾
- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب اسم «ان» واللام لام التوكيد- المزحلقة- لا عمل لها. على: حرف جر.
- ﴿ خُلُقٍ عَظِيمٍ: ﴾
- اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بخبر «ان». عظيم: صفة- نعت- لخلق مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ الحارِثِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيّانَ، قالَ: حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَصْرٍ الجَمّالُ، قالَ: حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ يَحْيى، قالَ: حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عُلْوانَ الكُوفِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: ما كانَ أحَدٌ أحْسَنَ خُلُقًا مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ما دَعاهُ أحَدٌ مِن أصْحابِهِ ولا مِن أهْلِ بَيْتِهِ إلّا قالَ: ”لَبَّيْكَ“ . ولِذَلِكَ أنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ . '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أنْ آنَسَ اللهُ نفْسَ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوعْدِ؛ عاد إلى تَسفيهِ قولِ الأعداءِ، فحقَّقَ أنَّه مُتلبِّسٌ بخُلقٍ عَظيمٍ، وذلك ضِدُّ الجُنونِ، قال تعالى:
﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾
التفسير :
فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال:{ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} وقد تبين أنه أهدى الناس، وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس، [وشر الناس]للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي.
ثم بشره - سبحانه - ببشارات أخرى فقال : ( فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ . بِأَيِّكُمُ المفتون . إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين ) .
والفاء فى قوله : ( فَسَتُبْصِرُ . . . ) للتفريع على ما تقدم من قوله : ( مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ )
والفعل " تبصر ويبصرون " من الإبصار الذى هو الرؤية بالعينين ، وقيل : بمعنى العلم . . والسين فى ( فَسَتُبْصِرُ . . . ) للتأكيد .
وقوله : ( فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ) أي : فستعلم يا محمد ، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك : من المفتون الضال منك ومنهم . وهذا كقوله تعالى : ( سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ) [ القمر : 26 ] ، وكقوله : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) [ سبإ : 24 ] .
قال ابن جريج : قال ابن عباس في هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة .
وقوله: (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) يقول تعالى ذكره: فسترى يا محمد، ويرى مشركو قومك الذين يدعونك مجنونا(بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ).
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ) يقول: ترى ويرون.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لمسة
[5، 6] ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ وعيد وتهديد، وحذف المفعول للتهويل.
الإعراب :
- ﴿ فَسَتُبْصِرُ: ﴾
- الفاء استئنافية. السين: حرف تسويف- استقبال- للقريب. تبصر: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.
- ﴿ وَيُبْصِرُونَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «تبصر» مرفوعة مثلها وعلامة رفعها ثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وفي القول الكريم وعيد للكفار وتسلية لرسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم).'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد هذا الثناء الحسن من اللهِ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ طمأنه اللهُ هنا على مستقبل الدعوة، وبشره بانكشاف الباطل وثبات الحقِّ، قال تعالى:
﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾
التفسير :
فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال:{ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} وقد تبين أنه أهدى الناس، وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس، [وشر الناس]للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي.
والباء فى قوله ( بِأَيِّكُمُ . . ) يرى بعضهم أنها بمعنى فى . والمفتون : اسم مفعول ، وهو الذى أصابته فتنة . أدت إلى جنونه ، والعرب كانوا يقولون للمجنون : فتنته الجن . أو هو الذى اضطرب أمره واختل تكوينه وضعف تفكيره .
. كأولئك المشركين الذين قالوا فى النبى صلى الله عليه وسلم أقوالا لا يقولها عاقل . .
أى : لقد ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - أنك بعيد عما اتهمك به الكافرون ، وأن لك عندنا المنزلة التى ليس بعدها منزلة . . وما دام الأمر كذلك فسترى وسنعلم ، وسيرى وسيلعم هؤلاء المشركون ، فى أي قريق منكم الإِصابة بالجنون؟ أفى فريق المؤمنين أم بفريق الكافرين . .
قال الجمل فى حاشيته ما ملخصه : قوله : ( فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ) قال ابن عباس : فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتميز الحق من الباطل ، وقيل فى الدنيا بظهور عاقبة أمرك . .
( بِأَيِّكُمُ المفتون ) الباء مزيدة فى المبتدأ ، والتقدير : أيكم المفتون ، فزيدت الباء كزيادتها فى نحو : بحسبك درهم . .
وقيل : الباء بمعنى " فى " الظرفية ، كقولك : زيد بالبصرة . أى : فيها . والمعنى : فى أى فرقة منكم المفتون .
وقيل : المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور . أى ، بأيكم الفتون . .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( بأيكم المفتون ) أي : الجنون . وكذا قال مجاهد وغيره . وقال قتادة وغيره : ( بأيكم المفتون ) أي : أولى بالشيطان .
ومعنى المفتون ظاهر ، أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه ، وإنما دخلت الباء في قوله : ( بأيكم المفتون ) لتدل على تضمين الفعل في قوله : ( فستبصر ويبصرون ) وتقديره : فستعلم ويعلمون ، أو : فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون . والله أعلم .
وقوله: (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله بأيكم المجنون، كأنه وجَّه معنى الباء في قوله: (بِأَيِّيكُمُ ) إلى معنى في. وإذا وجهت الباء إلى معنى في كان تأويل الكلام: ويبصرون في أيّ الفريقين المجنون في فريقك يا محمد أو فريقهم، ويكون المجنون اسما مرفوعا بالباء.
* ذكر من قال معنى ذلك: بأيكم المجنون.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: { بأيكم المفتون } قال: المجنون.
قال ثنا مهران، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) قال: بأيكم المجنون.
وقال آخرون: بل تأويل ذلك: بأيكم الجنون؛ وكأن الذين قالوا هذا القول وجهوا المفتون إلى معنى الفتنة أو المفتون، كما قيل: ليس له معقول ولا معقود: أي بمعنى ليس له عقل ولا عقد رأى فكذلك وضع المفتون موضع الفُتُون.
* ذكر من قال: المفتون: بمعنى المصدر، وبمعنى الجنون:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) قال: الشيطان.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) يعني الجنون.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس يقول: بأيكم الجنون.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أيكم أولى بالشيطان؛ فالباء على قول هؤلاء زيادة دخولها وخروجها سواء، ومثَّل هؤلاء ذلك بقول الراجز:
نَحْـنُ بنُـو جَـعْدَةَ أصحَـابُ الفَلَـجْ
نَضْـرِبُ بالسَّـيْفِ وَنَرْجُـو بـالفَرَجْ (2)
بمعنى: نرجو الفرج، فدخول الباء في ذلك عندهم في هذا الموضع وخروجها سواء.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) يقول: بأيكم أولى بالشيطان.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) قال: أيكم أولى بالشيطان.
واختلف أهل العربية في ذلك نحو اختلاف أهل التأويل، فقال بعض نحوِّيي البصرة: معنى ذلك: فستبصر ويبصرون أيُّكم المفتون. وقال بعض نحوِّيي الكوفة: بأيكم المفتون ها هنا، بمعنى الجنون، وهو في مذهب الفُتُون، كما قالوا: ليس له معقول ولا معقود؛ قال: وإن شئت جعلت بأيكم في أيكم في أيّ الفريقين المجنون؛ قال: وهو حينئذ اسم ليس بمصدر.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: بأيكم الجنون، ووجه المفتون إلى الفتون بمعنى المصدر، لأن ذلك أظهر معاني الكلام، إذا لم ينو إسقاط الباء، وجعلنا لدخولها وجها مفهوما.
وقد بيَّنا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له.
-----------------
الهوامش :
(2) البيتان من مشطور الرجز، وهما من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 179) من مصورة الجامعة عن نسخة "مراد مثلا" بالآستانة قال عند قوله تعالى: ( بأيكم المفتون ) مجازها: أيكم المفتون، كما قال الأول: "نحن بنو جعدة..." والشاهد فيه أن الباء في قوله بالفرج، أي نرجو الفرج، كما زيدت في الآية. والبيتان للنابغة الجعدي. وقد سبق الاستشهاد بهما على مثل هذا الموضع في الجزء (18: 14) فراجعه.
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ بِأَيِّكُمُ: ﴾
- الباء حرف جر زائد. اي: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدأ والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور اي أيكم المفتون.
- ﴿ الْمَفْتُونُ: ﴾
- خبر المبتدأ مرفوع بالضمة مثل قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. والمفتون: مصدر بمعنى الفتنة لان حكم مصدر الفعل حكم اسم مفعوله في التقدير لا في اللفظ او يكون «المفتون» مبتدأ وما قبله خبره كقولهم بمن مرورك وعلى أيهم نزولك لان الاول في معنى الظرف او تكون الباء بمعنى «في» والجار والمجرور متعلقا بخبر مقدم والمفتون مبتدأ مؤخر بمعنى في اي الفريقين يوجد من يستحق هذا الاسم اي الجنون. أبفريق المؤمنين ام بفريق الكافرين؟ والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها من الاعراب ويجوز ان تكون في محل نصب مفعولا به للفعل «تبصر» وقيل «المفتون» بمعنى المجنون لانه فتن: اي محن بمعنى اختبر وامتحن بالجنون.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا كانَ ﷺ هو ومَن مَعَهُ فَرِيقًا والأعْداءُ فَرِيقًا، وقَدْ أبْهَمَ آخِرَ «المُلْكِ» الضَّالَّ في الفَرِيقَيْنِ؛ قالَ:
﴿ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
بأيكم:
وقرئ:
فى أيكم، وهى قراءة ابن أبى عبلة.
مدارسة الآية : [7] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن .. ﴾
التفسير :
و{ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} وهذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية، دون غيره.
وجملة : ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ . . . ) تعليل لما ينبئ عنه ما قبله من ظهور جنونهم بحيث لا يخفى على أحد ، وتأكيد لوعده صلى الله عليه وسلم بالنصر ، ولوعيدهم بالخيبة والخسران .
أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - الذى خلقك فسواك فعدلك ، هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وبمن أعرض عن طريق الحق والصواب . . وهو - سبحانه - أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا إلى ما ينفعهم ويسعدهم فى دنياهم وآخرتهم . .
وما دام الأمر كذلك : فذرهم فى طغيانهم يعمهون ، وسر فى طريقك ، فستكون العاقبة لك ولأتباعك .
أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق.
وقوله: (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ) يقول تعالى ذكره: إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله، كضلال كفار قريش عن دين الله، وطريق الهدى (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) يقول: وهو أعلم بمن اهتدى، فاتبع الحقّ، وأقرّ به، كما اهتديت أنت فاتبعت الحقّ، وهذا من معاريض الكلام. وإنما معنى الكلام: إن ربك هو أعلم يا محمد بك، وأنت المهتدي وبقومك من كفار قريش وانهم الضالون عن سبيل الحقّ.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[7] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ هذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمهتدين.
وقفة
[7] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ لو بلغ زعيق المنافقين عنان السماء في وصم المهتدين وعيب المتقين ما ضرهم شيئًا؛ فإن الله أعلم بالصالح والطالح وبالمصلح والمفسد.
عمل
[7] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ لا تتعب نفسك بتصنيف الناس، عليك بنفسك فلن تُسأل عنهم.
وقفة
[7] فلان ضالٌّ، فلان مهتد، ليس هذا شأنك ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.
وقفة
[7] ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ الهداية شئ وقر بالقلب وصدقه العمل، فالهداية الحقة هي تنظيم البيت الداخلي للنفس قبل مظهرها الخارجي.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾
- هذه الآية الكريمة سبق اعرابها في سورة «النحل» في الآية الكريمة الخامسة والعشرين بعد المائة.'
المتشابهات :
| الأنعام: 117 | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ |
|---|
| النحل: 125 | ﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ |
|---|
| النجم: 30 | ﴿ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ |
|---|
| القلم: 7 | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد وعده صلى الله عليه وسلم بالنصر؛ أتبعَ ذلك بتهديد للضالين، ووعد للمهتدين، قال تعالى:
﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴾
التفسير :
يقول الله تعالى، لنبيه صلى الله عليه وسلم:{ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ} الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلًا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب، وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم، ويسكتوا عنه.
ثم أرشده - سبحانه - إلى جانب من مسالكهم الخبيثة ، وصفاتهم القبيحة ، وحذره من الاستجابة إلى شئ من مقترحاتهم ، فقال : ( فَلاَ تُطِعِ المكذبين . وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ )
يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم "فلا تطع المكذبين ".
القول في تأويل قوله تعالى : فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( فَلا تُطِعِ ) يا محمد ( الْمُكَذِّبِينَ ) بآيات الله ورسوله ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: ودّ المكذّبون بآيات الله لو تكفر بالله يا محمد فيكفرون.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) يقول: ودّوا لو تكفر فيكفرون.
حُدثت عن الحسين، فقال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) قال: تكفر فيكفرون.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[8] ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ النهي عن طاعة المرء نهيٌ عن التشبه به بالأولى؛ فلا يُطاع المكذب والحلاف، ولا يعمل بمثل عملهما.
وقفة
[8] ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ كانت الملاينة والمصانعة منهم لا من رسول الله ﷺ، فكانوا يحبون منه أن يستجيب لمقترحاتهم، فيقابلوا ذلك بالتظاهر باستجابتهم لدعوته.
وقفة
[8] قوله تعالى لنبيه: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام، فإن قوله: لا تكذب، ولا تحلف، ولا تشتم، ولا تهمز، ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متلبسًا بهذه الأخلاق؛ لما فيه من الدلالة على تشريفه وبراءته من تلك الأخلاق.
وقفة
[8] الوعيد لكل مكذب معرض مستهزئ ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَلا تُطِعِ: ﴾
- الفاء استئنافية او للتسبيب. لا: ناهية جازمة. تطع: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.
- ﴿ الْمُكَذِّبِينَ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد وحذفت ياء «تطع» تخفيفا ولالتقاء الساكنين.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعدَ بيانِ ما عليه النَّبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاقِ العَظيمةِ، بَيَّنَ هنا ما عليه الكفارُ من الأخلاقِ الذَّميمةِ، قال تعالى:
﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [9] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾
التفسير :
{ وَدُّوا} أي:المشركون{ لَوْ تُدْهِنُ} أي:توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه،{ فَيُدْهِنُونَ} ولكن اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره، بنقض ما يضاده، وعيب ما يناقضه.
وقوله : ( وَدُّواْ ) من الود بمعنى المحبة . وقوله : ( تُدْهِنُ ) من الإدهان وهى المسايرة والمصانعة والملاينة للغير . وأصله أن يجعل على الشئ دهنا لكى يلين أو لكى يحسن شكله ، ثم استعير للملاينة والمساهلة مع الغير .
أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - لا يخفى عليه شئ من أحوالك وأحوالهم ، وما دام الأمر كذلك ، فاحذر أن تطيع هؤلاء المكذبين فى شئ مما يقترحونه عليك ، فإنهم أحبوا وودوا أن تقبل بعض مقترحاتهم ، وأن تلاينهم وتطاوعهم فيما يريدون منك . . وهم حينئذ يظهرون لك من جانبهم الملاينة والمصانعة . . حتى لكأنهم يميلون نحو الاستجابة لك ، وترك إيذائك وإيذاء أصحابك .
فالآية الكريمة تشير إلى بعض المساومات التى عرضها المشركون على النبى صلى الله عليه وسلم وما أكثرها ، ومنها : ما ذكره ابن إسحاق فى سيرته من أن بعض زعماء المشركين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : يا محمد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت فى الأمر ، فإن كان الذى تعبد خيرا مما نعبد ، كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد ، كنت قد أخذت بحظك منه ، فنزلت سورة " الكافرون " .
ومنها ما دار بينه صلى الله عليه وسلم وبين الوليد بن المغيرة تارة ، وبينه وبين عتبة بن ربيعة تارة أخرى . . مما هو معروف فى كتب السيرة .
ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لعمه أبى طالب عندما نصحه بأن يترك المشركين وشأنهم ، وقال له : يا ابن أخى أشفق على نفسك وعلى ، ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق .
وقال له صلى الله عليه وسلم : يا عماه ، والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى . على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله أو أهلك فيه . . " .
والتعبير بقوله : ( وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) يشير إلى أن الملاينة والمصانعة كانت منهم ، لا منه صلى الله عليه وسلم ، فهم الذين كانوا يحبون منه أن يستجيب لمقترحاتهم ، لكى يقابلوا ذلك بالتظاهر بأنهم على صلة طيبة به وبأصحابه .
قال صاحب الكشاف : قوله : ( فَلاَ تُطِعِ المكذبين ) تهييج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم ، وكانوا قد أرادوا على أن يعدب الله مدة ، وآلهتهم مدة ، ويكفوا عن غوائلهم ، .
وقوله : ( لَوْ تُدْهِنُ ) لو تلين وتصانع ( فَيُدْهِنُونَ ) .
فإن : قلت : لماذا رفع " فيدهنون " ولم ينصب بإضمار " أن " وهو جواب التمنى؟ قلت : قد عدل إلى طريق آخر ، وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف . أى : فهم يدهنون ، كقوله : ( فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَقاً ) على معنى : ودوا لو تدهن فهم يدهنون . .
"ودوا لو تدهن فيدهنون" قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون.
وقال مجاهد: "ودوا لو تدهن" تركن إلى آلهتم وتترك ما أنت عليه من الحق.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) قال: تكفر فيكفرون.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ودّوا لو تُرخِّص لهم فُيرخِّصون، أو تلين في دينك فيلينون في دينهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) يقول: لو ترخص لهم فيرخِّصون.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) قال: لو تَرْكَن إلى آلهتهم، وتترك ما أنت عليه من الحقّ فيمالئونك.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) يقول: ودّوا يا محمد لو أدهنت عن هذا الأمر، فأدهنوا معك.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) قال: ودّوا لو يُدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُدْهنون.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ودّ هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جلّ ثناؤه: وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا * إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ وإنما هو مأخوذ من الدُّهن شبه التليين في القول بتليين الدُّهن.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ طلبوا المداهنة ﻷن النبي عليه السلام كان صريحًا، ﻻ يطلب المداهنة إﻻ من تؤلمه المصارحة.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ وكفار زماننا ودوا لو نُدهن ولا يُدهنون.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ ليس لأهل الباطل حق يغارون عليه، أو دين يغضبون من أجله، هم مستعدون للتنازل عن أي شيء المهم عندهم إضعاف الحق وتلبيسه.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ لا مداهنة على حساب العقيدة، ولا التقاء في منتصف الطرق، وكان وضوح النبي ﷺ وصراحته يؤذيان الكفار، فيطلبان منه التخفيف، فحذره الله من المداهنة.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ المداراة أن تضحي بالدنيا لأجل الدين، وتكون باستعمال الألفاظ الليِّنة مع عدم قبول المنكر أو إقرار صاحبه عليه، وأما المداهنة فأن تضحي بالدين لأجل الدنيا.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أولى خطوات النكوص عن الحق: مداهنة أهل الباطل، والرضا بالتنازل عن بعض الثوابت.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ ليس لديهم مشكلة في تقديم أية تنازلات، فكل ما معهم هراء, المهم أن تتنازل أنت.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ في الصراع مع الباطل يكفيهم منك أن تجاملهم على حساب دينك، ثم تنفرط سلسلة التنازلات.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ زلَّة الصالحين ينتظرها المغرضون بفارغ الصبر.
وقفة
[9] ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أولى خطوات التنازل خطيرة ومصيريَّة.
عمل
[9] احذر المداهنة في دين الله تعالى ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.
وقفة
[9] قد يتنازل المبطل عن بعض باطله؛ ليأخذ جزءًا من الحق الذي معك؛ فهو لم يخسر إلا باطلًا، أما أنت فستخسر الحق كله؛ لأنه لا يتجزأ ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَدُّوا: ﴾
- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.
- ﴿ لَوْ تُدْهِنُ: ﴾
- حرف مصدري لا عمل له. تدهن: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت بمعنى لو تلين وتصانع اي تداهن وتلاين. وجملة «تدهن» صلة «لو» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «لو» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «ود» التقدير: ودوا ادهانك.
- ﴿ فَيُدْهِنُونَ: ﴾
- الفاء عاطفة. يدهنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجاء الفعل «يدهنون» مرفوعا لانه ليس جوابا للتمني لان «لو» مصدرية ولو كانت للتمني لكانت الفاء سببية وحذفت نون «يدهنون» او تكون جواب التمني ولم ينصب الفعل «يدهنون» باضمار «ان» بعد «الفاء» لانه عدا به الى طريق آخر وهو ان جعل خبر مبتدأ محذوف. التقدير: فهم يدهنون على معنى: ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ، او ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد النهي عن طاعةِ المكذبين؛ حَذَّرَه هنا من الاستجابة إلى شيء من مقترحاتهم، قال تعالى:
﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
فيدهنون:
1- بالنون، وعلى هذا جمهور المصاحف.
2- فيدهنوا، بحذفها، وكذا فى بعض المصاحف.
قال هارون: ولنصبه وجهان:
أحدهما: أنه جواب «ود» .
والثاني: أنه على توهم النطق ب «أن» .
مدارسة الآية : [10] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾
التفسير :
{ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ} أي:كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابًا إلا وهو{ مُهِينٌ} أي:خسيس النفس، ناقص الهمة، ليس له همةفي الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.
ثم يكرر - سبحانه - النهى للنبى صلى الله عليه وسلم عن طاعة كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . .
فيقول : ( وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ . مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) .
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكريمة ، نزلت فى الوليد بن المغيرة . . وقيل : إنها نزلت فى الأخنس بن شريق . .
والآيات الكريمة يشمل النهى فيها كل من هذه صفاته ، ويدخل فيها الوليد بن المغيرة ، والأخنس بن شريف . . دخولا أوليا .
أى : ولا تطع - أيها الرسول الكريم - كل من كان كثير الحلف بالباطل ، وكل من كان مهينا ، أى : حقير ذليلا وضيعا . من المهانة ، وهى القلة فى الرأى والتمييز .
ثم قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين ) وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى ، واستعمالها في كل وقت في غير محلها .
قال ابن عباس : المهين الكاذب . وقال مجاهد : هو الضعيف القلب . قال الحسن : كل حلاف : مكابر ، مهين : ضعيف .
وقوله: ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) ولا تطع يا محمد كلّ ذي إكثار للحلف بالباطل؛( مَهِين ) : وهو الضعيف.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
غير أن بعضهم وجَّه معنى المهين إلى الكذّاب، وأحسبه فعل ذلك لأنه رأى أنه إذا وصف بالمهانة فإنما وصف بها لمهانة نفسه كانت عليه، وكذلك صفة الكذوب، إنما يكذب لمهانة نفسه عليه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) والمهين: الكذاب.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( حَلافٍ مَهِينٍ ) قال: ضعيف.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) وهو المكثار في الشرّ.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، في قوله: ( كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) يقول: كلّ مكثار في الحلف مهين ضعيف.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سعيد، عن الحسن وقتادة: ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) قال: هو المكثار في الشرّ.
التدبر :
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ كثير الحلف بالله ومع ذلك مهين القلوب ﻻ تقبله.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ لسانه يحلف وقلوب الناس تستهينه، من لم يكتب له القبول فلا تنفعه أيمانه.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ وذلك أن الكاذب -لضعفه ومهانته- إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى، واستعمالها في كل وقت في غير محلها.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ من أكثر الحلف هان على الرحمن، ونزلت مرتبته عند الناس.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ كثرة الحلف علامة بارزة من علامات الكذب.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ وكفى بهذه الآية زاجرة لمن اعتاد الحلف.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ لسانه (يحلف) وقلوب الناس (تستهين به)، فمن حرم القبول، لم تنفعه أيمانه في الوصول.
وقفة
[10] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ كثرة الحلف بالحق والباطل أمارة على عدم استشعار عظمة الله، ومن هان الله في نفسه؛ جعله الله مهينًا في الدنيا والآخرة.
وقفة
[10] امتهان الحلف والإكثار منه مذموم، فقد وصف الله بها أقوامًا مقبوحين فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾، وبين في مواطن كثيرة أن ذلك من أبرز صفات المنافقين: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: 2]، ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّـهِ﴾ [التوبة: 56]، وما يزالون على ذلك إلى يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّـهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ [المجادلة: 18]، فعظم ربك، واحفظ يمينك.
وقفة
[10] كثرة اعتياد الإنسان على الكذب تفقد الثقة به وتوهن من قيمته، تأمل: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾.
وقفة
[8-10] ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾، ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ من فوائدها: أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى، فلا يطاع المكذب والحلاف، ولا يعمل بمثل عملهما.
الإعراب :
- ﴿ وَلا تُطِعْ كُلَّ: ﴾
- اعربت في الآية الكريمة الثامنة وعلامة جزم «تطع» السكون الظاهر وعلامة نصب «كل» الفتحة.
- ﴿ حَلَّافٍ مَهِينٍ: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي كثير الحلف في الكذب والباطل وهو من صيغ المبالغة: فعال بمعنى فاعل. مهين: صفة- نعت- لحلاف مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة وهو من المهانة وهي الحقارة او اراد الكذب لانه مهان- حقير- عند الناس.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا نهَى اللهُ رَسولَه عن طاعةِ المكذبين، وكان مِن النَّاسِ مَن يُخفي تكذيبَه؛ أظهَرَ هنا علاماتِ المكَذِّبِ -وهي تِسْع صِفات ساقَها اللهُ لذَمِّ الوَليد بن المُغِيرَة ولأمثالِه في الكفرِ والفجورِ-، وهي: ١- كثير الحلف بالله كَذِبًا. ٢- حقير ذليل، قال تعالى:
﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [11] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾
التفسير :
{ هَمَّازٍ} أي:كثير العيب [للناس] والطعن فيهمبالغيبة والاستهزاء، وغير ذلك.
{ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} أي:يمشي بين الناس بالنميمة، وهي:نقل كلام بعض الناس لبعض، لقصد الإفساد بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء.
( هَمَّازٍ ) أى : عياب للناس ، أو كثير الناس الاغتياب لهم ، من الهمز ، وأصله : الطعن فى الشئ بعود أو نحوه ، ثم استعير للذى يؤذى الناس بلسانه وبعينه وبإرشاته ، ويقع فيهم بالسوء ، ومنه قوله - تعالى - : ( ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ) ( مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ) أى : يقال للحديثي السَّيَّئ لكى يفسد بين الناس . . والنميم والنميمة مصدران بمعى السعاية والإِفساد . يقال : نَمَّ فلان الحديث - من بابى قتل وضرب - إذا سار بين الناس بالفتنة .
وأصل النم : الهمس والحركة الخفيفة ثم استعملت فى السعى بين الناس بالفساد على سبيل المجاز .
وقوله ) هماز ) قال ابن عباس ، وقتادة : يعني الاغتياب .
( مشاء بنميم ) يعني : الذي يمشي بين الناس ، ويحرش بينهم ، وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " الحديث . وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم ، من طرق عن مجاهد به .
وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام أن حذيفة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يدخل الجنة قتات " .
رواه الجماعة - إلا ابن ماجه - من طرق ، عن إبراهيم به .
وحدثنا عبد الرزاق ، حدثنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن حذيفة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يدخل الجنة قتات " يعني : نماما .
وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول ، عن الأعمش حدثني إبراهيم - منذ نحو ستين سنة - عن همام بن الحارث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء . فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - أو : قال - : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يدخل الجنة قتات " .
وقال أحمد : حدثنا هاشم ، حدثنا مهدي ، عن واصل الأحدب ، عن أبي وائل قال : بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يدخل الجنة نمام " .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن ابن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ألا أخبركم بخياركم ؟ " . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " الذين إذا رءوا ذكر الله ، عز وجل " . ثم قال : " ألا أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة ، المفسدون بين الأحبة ، والباغون للبرآء العنت " .
ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد ، عن يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم به .
وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي حسين ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم - يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - : " خيار عباد الله الذين إذا رءوا ذكر الله ، وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبرآء العنت "
وقوله: ( هَمَّازٍ ) يعني: مغتاب للناس يأكل لحومهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( هَمَّازٍ ) يعني الاغتياب.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( هَمَّازٍ ) يأكل لحوم المسلمين.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( هَمَّازٍ ) قال: الهماز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، وليس باللسان وقرأ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي يلمز الناس بلسانه، والهمز أصله الغمز فقيل للمغتاب: هماز، لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون، وذلك غمز عليهم.
وقوله: ( مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) يقول: مشاء بحديث الناس بعضهم في بعض، ينقل حديث بعضهم إلى بعض.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( هَمَّازٍ ) يأكل لحوم المسلمين ( مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) : ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض.
حدثني محمد بن سعد، قال ثني أبي، قال ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) : يمشي بالكذب.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر عن الكلبي، في قوله: ( مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) قال: هو الأخنس بن شريق، وأصله من ثقيف، وعداده في بني زُهْرة.
القول في تأويل قوله تعالى : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13)
التدبر :
وقفة
[11] ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ لمَّا تكلَّمَ اللسانُ بالهمز جاوبَتْه القَدَمُ بالمَشي بالنَّميمةِ؛ صلاحُك يبدأُ من لسانِك.
وقفة
[11] ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ صلاح الجوارح متعلِّق بصلاح اللسان, فإن استقام استقامت، وإن اعوج اعوججت.
وقفة
[11] ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ يوصيك القرآن: لا تصدِّق أهل النميمة، ولا تستمع لنصحهم.
وقفة
[11] ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» [البخاري ۱۳6۱].
وقفة
[11] ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ استعمال كلمة المشي مع النميمة لتشويه حال النام، بأنه يتجسّم المشاق لتمرير نميمته، والهدف: تبغيض الناس في النميمة.
الإعراب :
- ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ: ﴾
- صفة ثانية لحلاف اي عياب طعان بمعنى كثير الهمز وهو الطعن. مشاء: صفة اخرى لحلاف اي كثير المشي بالنميمة اي مضرب نقال للحديث من قوم الى قوم على وجه السعاية اي الوشاية. بنميم: جار ومجرور متعلق بمشاء والصفتان معطوفتان بدون حرفي عطف.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ٣- كثير الطعن في أعراض النَّاس. ٤- ينقل الكلام بين النَّاس على وجه الإفساد بينهم، قال تعالى:
﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [12] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾
التفسير :
{ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ} الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك،{ مُعْتَدٍ} على الخلق في ظلمهم، في الدماء والأموال والأعراض{ أَثِيمٍ} أي:كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى
( مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ) أى : هو شديد المنع لكل ما فيه خير ، ولكل من يستحقه ، خصوصا إذا كان من يستحقه من المؤمنين .
ثم هو بعد ذلك ( مُعْتَدٍ ) أى : كثير العدوان على الناس ( أَثِيمٍ ) أى : مبالغ فى ارتكابه للآثام ، لا يترك سيئة دون أن يرتكبها .
وقد جاءت صفات الذم السابقة بصيغة المبالغة ، للإِشعار برسوخه فيها ، وباقترافه لها بسرعة وشدة .
أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير "معتد" في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع "أثيم" أي يتناول المحرمات.
وقوله: (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ). يقول تعالى ذكره: بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق.
وقوله: (مُعْتَدٍ ) يقول: معتد على الناس (أَثِيمٍ ) : ذي إثم بربه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: (مُعْتَدٍ ) في عمله (أَثِيمٍ ) بربه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[12] ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ مناع وأثيم صيغتا مبالغة، والخير هنا يراد به العموم في كل ما يُطلق عليه خير، وصيغة المبالغة للإشعار برسوخه في النفس، واقترافها له بسرعة وقوة.
وقفة
[12] ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ ذكر الرازي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان له عشرة من البنين، وكان يقول لهم: لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدًا، فمنعهم من الإسلام.
وقفة
[12] منع الخير من صفات الكفار ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾، فهل يليق بنا كمسلمين؟!
عمل
[10-12] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ من منع الخير لم يكن أهلًا أن يطاع؛ فاحذره.
عمل
[10-12] ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ لا تصدق أهل الغيبة والنميمة، ولا تستمع لنصائحهم، هذه وصية القرآن.
عمل
[12، 13] ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ فطر الله الناس على حب المهذب المتواضع الحسن الخلق، وعلى بغض اللئيم الغليظ السيئ الخلق، فاحرص على كسب ود الناس، واحذر نفورهم.
الإعراب :
- ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة. بمعنى: بخيل وهي من صيغ المبالغة فعال بمعنى فاعل. و «الخير» المال او مناع اهله الخير وهو الاسلام فذكر الممنوع منه دون الممنوع بتقدير: مناع من الخير و «معتد» مجاوز في الظلم حده وحذفت ياؤه لأنه اسم نكرة منقوص وتخلصا من التقاء الساكنين و «أثيم» فعيل بمعنى فاعل اي كثير الآثام.'
المتشابهات :
| ق: 25 | ﴿ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ |
|---|
| القلم: 12 | ﴿ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ٥- بخيل بالمال وبكل ما هو خير. ٦- يتجاوز الحد في المحرمات والعدوان على النَّاس. ٧- كثير الآثام، قال تعالى:
﴿ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [13] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾
التفسير :
{ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ} أي:غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق{ زَنِيمٍ} أي:دعي، ليس له أصل و [لا] مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي:علامة في الشر، يعرف بها.
وحاصل هذا، أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب، خسيس النفس، سيئ الأخلاق، خصوصًا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس، والتكبر على الحق وعلى الخلق، والاحتقار للناس، كالغيبة والنميمة، والطعن فيهم، وكثرة المعاصي.
( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) والعتل : هو الجاف الغليظ ، القاسى القلب : الفظ الطبع ، الأكول الشروب . . بدون تمييز بين حلال وحرام . مأخوذ من عتلة يعتُلِه - بكسر التاء وضمها - إذا جره بعنف وغلظة . .
( والزنيم ) هو اللصيق بالقوم دون أن يكون منهم ، وإنما هو دعى فيهم ، حتى لكأنه فيهم كالزنمة ، وهى ما يتدلى من الجلد فى حلق المعز أو الشأة . .
وقيل : الزنيم ، هو الشخص الذى يعرف بالشر واللؤم بين الناس ، كما تعرف الشاة بزنمتها . أى : بعلامتها .
ومعنى : " بعد ذلك " : كمعنى " ثم " أى : ثم هو بعد كل تلك الصفات القبيحة السابقة : جاف غليظ ، ملصق بالقوم ، دعى فيهم . . .
فهذه تسع صفات ، كل صفة منها قد بلغت النهاية فى القبح والسوء ، ساقها - سبحانه - لذم الوليد بن المغيرة وأشباهه فى الكفر والفجور .
وقوله : ( عتل بعد ذلك زنيم ) أما العتل : فهو الفظ الغليظ الصحيح ، الجموع المنوع .
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، وعبد الرحمن ، عن سفيان ، عن معبد بن خالد ، عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ، ألا أنبئكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر " . وقال وكيع : " كل جواظ جعظري مستكبر " .
أخرجاه في الصحيحين ، وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري ، وشعبة ، كلاهما عن معبد بن خالد به .
وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا موسى بن علي ، قال : سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عند ذكر أهل النار : " كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع " . تفرد به أحمد .
قال أهل اللغة : الجعظري : الفظ الغليظ ، والجواظ : الجموع المنوع .
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا عبد الحميد ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العتل الزنيم ، فقال : " هو الشديد الخلق ، المصحح ، الأكول ، الشروب ، الواجد للطعام والشراب ، الظلوم للناس ، رحيب الجوف " .
وبهذا الإسناد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري ، العتل الزنيم " وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه ، وأرحب جوفه ، وأعطاه من الدنيا مقضما ، فكان للناس ظلوما . قال : فذلك العتل الزنيم " .
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين ، ونص عليه غير واحد من السلف ، منهم مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، وغيرهم : أن العتل هو : المصحح الخلق ، الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح ، وغير ذلك ، وأما الزنيم فقال البخاري :
حدثنا محمود ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : ( عتل بعد ذلك زنيم ) قال : رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة .
ومعنى هذا : أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها . وإنما الزنيم في لغة العرب : هو الدعي في القوم . قاله ابن جرير ، وغير واحد من الأئمة ، قال : ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفار قريش :
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
وقال آخر :
زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطي ، حدثنا أسباط ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ( زنيم ) قال : الدعي الفاحش اللئيم . ثم قال ابن عباس :
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع
وقال العوفي ، عن ابن عباس : الزنيم : الدعي . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة يعرف بها . ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة . وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب .
وقال ابن أبي حاتم : حدثني يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثني سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه سمعه يقول في هذه الآية : ( عتل بعد ذلك زنيم ) قال سعيد : هو الملصق بالقوم ، ليس منهم .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عقبة بن خالد ، عن عامر بن قدامة ، قال : سئل عكرمة ، عن الزنيم ، قال : هو ولد الزنا .
وقال الحكم بن أبان ، عن عكرمة في قوله تعالى : ( عتل بعد ذلك زنيم ) قال : يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه : التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها . وقال الثوري ، عن جابر ، عن الحسن ، عن سعيد بن جبير قال : الزنيم : الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملصق ، رواه ابن جرير .
وروى أيضا من طريق داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : قال : نعت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال : وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها . وقال آخرون : كان دعيا .
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن أصحاب التفسير قالوا هو الذي تكون له زنمة مثل زنمة الشاة .
وقال الضحاك : كانت له زنمة في أصل أذنه ، ويقال : هو اللئيم الملصق في النسب .
وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : هو المريب الذي يعرف بالشر .
وقال مجاهد : الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رزين : الزنيم علامة الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها .
والأقوال في هذا كثيرة ، وترجع إلى ما قلناه ، وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر ، الذي يعرف به من بين الناس ، وغالبا يكون دعيا ولد زنا ، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره ، كما جاء في الحديث : " لا يدخل الجنة ولد زنا " وفي الحديث الآخر : " ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه " .
وقوله: (عُتُلٍّ ) يقول: وهو عُتُلّ، والعتلّ: الجافي الشديد في كفره، وكلّ شديد قويّ فالعرب تسميه عُتُلا؛ ومنه قول ذي الإصبع العَْوانّي:
والدَّهْرُ يَغْدُو مِعْتَلا جَذَعا (3)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (عُتُلٍّ ) العتلّ: العاتل الشديد المنافق.
حدثني إسحاق بن وهب الواسطي، قال: ثنا أبو عامر العَقْدِيُّ، قال: ثنا زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن وهب الذَّمارِيّ، قال: تبكي السماء والأرض من رجل أتمّ الله خلقه، وأرحب جوفه، وأعطاه مقضما من الدنيا، ثم يكون ظلوما للناس، فذلك العتلّ الزنيم .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: العتلّ: الأكول الشروب القويّ الشديد، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع المَلَكُ من أولئك سبعين ألفا دفعة في جهنم.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، في قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: العتلّ: الشديد.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي رزين، في قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: العتلّ: الصحيح.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم، مولى معاوية قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العُتُلّ الزنيم، قال: " الفَاحِشُ اللَّئيمُ ".
قال معاوية، وثني عياض بن عبد الله الفهريّ، عن موسى بن عقبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: فاحش الخُلق، لئيم الضريبة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: الحسن وقتادة: هو الفاحش اللئيم الضريبة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، في قوله: (عُتُلٍّ ) قال: هو الفاحش اللئيم الضريبة.
قال ثنا ابن ثور، عن معمر، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تَبْكي السَّماءُ مِنْ عَبْدٍ أصَحَّ اللهُ جِسْمَهُ، وأرْحَبَ جَوْفَهُ، وأعْطاهُ مِنَ الدُّنْيا مِقْضَما فَكانَ للنَّاس، ظَلُوما، فَذلكَ العُتلُّ الزَّنِيمُ".
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، قال: العتل: الصحيح الشديد.
حدثني جعفر بن محمد البزوري، قال: ثنا أبو زكريا، وهو يحيى بن مصعب، عن عمر بن نافع، قال: سُئل عكرمة، عن (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) فقال: ذلك الكافر اللئيم.
حدثني عليّ بن الحسن الأزديّ، قال: ثنا يحيى، يعنى: ابن يمان، عن أبي الأشهب، عن الحسن في قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: الفاحش اللئيم الضريبة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، قال: العتلّ، الزنيم: الفاحش اللئيم الضريبة.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (عُتُلٍّ ) قال: شديد الأشَر.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: (عُتُلٍّ ) قال: العتلّ: الشديد (بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) ومعنى " بعد " في هذا الموضع معنى مع، وتأويل الكلام: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) : أي مع العتلّ زنيم.
وقوله: (زَنِيمٍ ) والزنيم في كلام العرب: الملصق بالقوم وليس منهم؛ ومنه قول حسان بن ثابت:
وأنْــتَ زَنِيـمٌ نِيـطَ فِـي آلِ هاشِـمٍ
كمَـا نِيـطَ خَـلْفَ الرَّاكِب القَدَحُ الفَرْدُ (4)
وقال آخر:
زَنِيــمٌ لَيْسَ يَعْــرِفُ مَــن أبُـوهُ
بَغِـــيُّ الأمّ ذُو حَسَـــبٍ لَئِــيمِ (5)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (زَنِيمٍ ) قال: والزنيم: الدعيّ، ويقال: الزنيم: رجل كانت به زنمة يُعرف بها، ويقال: هو الأخنس بن شَرِيق الثَّقَفِيّ حلِيف بني زُهْرة. وزعم ناس من بني زُهره أن الزنيم هو: الأسود بن عبد يغوث الزُّهريّ، وليس به.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: أخبرنا ابن إدريس، قال: ثنا هشام، عن عكرمة، قال: هو الدعيّ.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه يقول في هذه الآية: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن الحسن، عن سعيد بن جبير، قال: الزنيم الذي يعرف بالشرّ، كما تعرف الشاة بزنمتها؛ الملصق.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، وقال آخرون: هو الذي له زَنَمة كزنمة الشاة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في الزنيم قال: نعت، فلم يعرف حتى قيل زنيم. قال: وكانت له زنمة في عنقه يُعرف بها.
وقال آخرون: كان دعيًّا.
حدثني الحسين بن على الصدائي، قال: ثنا عليّ بن عاصم، قال ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: (بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: نـزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ قال: فلم نعرفه حتى نـزل على النبي صلى الله عليه وسلم (بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن إدريس، عن أصحاب التفسير، قالوا: هو الذي يكون له زنمة كزنمة الشاة.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: زنيم: يقول: كانت له زنمة في أصل أذنه، يقال: هو اللئيم الملصق في النسب.
وقال آخرون: هو المريب
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: زنيم: المُرِيب الذي يعرف بالشرّ.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن الحسن بن مسلم، عن سعيد بن جبير قال: الزنيم: الذي يعرف بالشرّ.
وقال آخرون: هو الظلوم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: (زَنِيمٍ ) قال: ظلوم.
وقال آخرون: هو الذي يُعرف بأُبنة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: الذي يُعرف بأبنة، قال أبو إسحاق: وسمعت الناس في إمرة زياد يقولون: العتلّ: الدعيّ.
وقال آخرون: هو الجِلْف الجافي.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثنا داود بن أبي هند، قال: سمعت شهر بن حَوْشب يقول: هو الجلف الجافي الأكول الشروب من الحرام.
وقال آخرون: هو علامة الكفر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، قال: الزنيم: علامة الكفر.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، قال: الزنيم: علامة الكافر.
حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه كان يقول الزنيم يُعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة.
وقال آخرون: هو الذي يعرف باللؤم.
* ذكر من قال ذلك
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة، قال: الزّنيم: الذي يعرف باللؤم، كما تُعرف الشاة بزنمتها.
وقال آخرون: هو الفاجر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي رزين، في قوله: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) قال: الزنيم: الفاجر.
-----------------
الهوامش :
(3) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 179) أنشده عند قوله تعالى: ( عتل ) قال: العتل: الفظ الكافر في هذا الموضع، وهو الشديد من كل شيء بعد ذلك؛ قال ذو الإصبع العدواني: " والدهر يغدو معتلا جذعا" أي شديدا ا هـ. وفي (اللسان: عتل) العتل: هو الشديد الجافي، والفظ الغليظ. قيل: هو الجافي الخلق، اللئيم الضريبة. وقيل هو الشديد من الرجال والدواب. وفي التنزيل: ( عتل بعد ذلك زنيم ) قيل: هو الشديد الخصومة. ا هـ. وفي (اللسان: عتل) ورجل معتل (بوزن منبر) بالكسر: قوي. والجذع: الصغير السن.
(4) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 179 من مصورة الجامعة 26390 عن مخطوطة "مراد مثلا" بالآستانة) أنشده عند قول الله تعالى: ( زنيم ) قال: الزنيم: المعلق في القوم ليس منهم، قال حسان بن ثابت: "وأنت زنيم..." البيت. ويقال للتيس: زنيم، له زنمتان. ا هـ
(5) ليس هذا البيت من شواهد الفراء ولا من شواهد أبي عبيدة، ولم ينسبه المؤلف إلى قائله. وفي اللسان: الزنيم: المستحلق في قوم ليس منهم، لا يحتاج إليه، فكأنه فيهم زنمة (أي: زنمة العنز المعلقة عند حلقها). يقول: هو فيهم زنيم، لا يعرفون أباه؛ لأنه دخيل. وأمه بغي، وحسبه لئيم. وهو في معنى الشاهد الذي قبله على معنى "الزنيم".
التدبر :
وقفة
[13] ﴿عُتُلٍّ﴾ العتل هو الجاف الغليظ قاسي القلب، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» [البخاري 6071].
وقفة
[13] ﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ له زنمة من الشر، أي علامة يُعرَّف بها، والزنمة: شيء يُقطع من أذن الشاة ويُترك معلَّقًا بها، والزنيم هو الشخص المعروف بالشر واللؤم بين الناس، كما تُعرَّف الشاة بزنمتها.
عمل
[8-13] الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة، ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاق الناس بالمخالطة لهم؛ فليأخذ الداعية حذره؛ فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى.
عمل
[10-13] صفات الكفار صفات ذميمة؛ يجب على المؤمن الابتعاد عنها، وعن طاعة أهلها.
لمسة
[10-13] صفات كثيرة، جاء على أبنية المبالغة، تُرك العطف بالواو فيما بينها؛ لأنها مجتمعة كلُّها في شخص واحد، قيل أنه الوليد بن المغيرة.
وقفة
[10-13] هى صفات من السوء بمكان، وُصم بها من نزلت فيه حتى يوم القيامة، اللهم استرنا.
وقفة
[10-13] هذه أوصاف تسعة ولم يدخل بينها واو العطف، ولا بعد السابع، فدل على ضعف القول بواو الثمانية.
الإعراب :
- ﴿ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة الحادية عشرة. و «عتل» اي غليظ جاف من عتله اذا قاده بعنف وغلظة. وقال عكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه. بعد: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بعتل بمعنى مع. وهو مضاف. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة واللام للبعد والكاف حرف خطاب اي بعد ما عدله من المثالب والنقائص. و «زنيم» اي دعي منسوب لغير قومه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ٨- غليظ فظ الأخلاق. ٩- يُعرف بالشَّرِّ بين النَّاس، قال تعالى:
﴿ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
عتل:
1- بالجر، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بالرفع، وهى قراءة الحسن.
مدارسة الآية : [14] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾
التفسير :
وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين، كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه:{ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} أي:لأجل كثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق، ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين، التي يمكن صدقها وكذبها- فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة.
وقوله : ( أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ . . . ) متعلق بقوله قبل ذلك ( وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ . . )
أى : ولا تطع من كانت هذه صفاته لكونه ذا مال وبنين ، فإن ماله وولده لن يغنى عنه من الله - تعالى - شيئا .
يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين.
القول في تأويل قوله تعالى : أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (15)
اختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( أَنْ كَانَ ) فقرأ ذلك أبو جعفر المدني وحمزة: (أأنْ كَانَ ذَا مالٍ ) بالاستفهام بهمزتين، وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين:
أحدهما أن يكون مرادًا به تقريع هذا الحلاف المهين، فقيل: ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين ( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ) وهذا أظهر وجهيه.
والآخر أن يكون مرادًا به: ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه، على وجه التوبيخ لمن أطاعه. وقرأ ذلك بعد سائر قراء المدينة والكوفة والبصرة: ( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ ) على وجه الخبر بغير استفهام بهمزة واحدة، ومعناه إذا قُرئ كذلك: ولا تطع كلّ حلاف مهين ( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ) كأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو مال وبنين.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[14] ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ إنهما زينة ولكنهما ليستا قيمة، فهما فتنة لا يجوز أن يوزن بهما الناس ولا تقعدهم عن التضحيات والجهاد.
وقفة
[14] ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ كثرة المال والبنين سببان يدفعان الكثيرين للعصيان والتمرد.
الإعراب :
- ﴿ أَنْ كانَ ذا: ﴾
- حرف مصدري. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة من «كان وما بعدها» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الإعراب و «ان» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول من اجله اي لان كان او متعلق بقوله لا تطع بمعنى ولا تطعه مع هذه المثالب ويجوز ان يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا. ذا: خبر «كان» منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف.
- ﴿ مالٍ وَبَنِينَ: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. وبنين: معطوفة بالواو على «مال» مجرورة مثلها وعلامة جرها الياء لانها ملحقة بجمع المذكر السالم والنون عوض من تنوين المفرد.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا نهَى اللهُ رَسولَه عن طاعةِ المكذبين؛ بَيَّنَ هنا ما حملهم على التكذيب بآيات الله، وهو الشعور بالغنى -إن كان ذا مال وبنين-، قال تعالى:
﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
أن كان:
1- على الخبر، وهى قراءة النحويين، والحرميين، وحفص، وأهل المدينة.
وقرئ:
2- على الاستفهام، وهى قراءة باقى السبعة، والحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى جعفر.
3- بتحقيق الهمزتين، وهى قراءة حمزة.
4- بتسهيل الثانية.
مدارسة الآية : [15] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ .. ﴾
التفسير :
وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين، كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه:{ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} أي:لأجل كثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق، ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين، التي يمكن صدقها وكذبها- فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة.
وقوله : ( إِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأولين ) كلام مستأنف جار مجرى التعليل للنهى عن طاعته ، والأساطير جمع أسطورة بمعنى أكذوبة .
أى : لا تطعه - لأنه فضلا عما اتسم به من صفات قبيحة - تراه إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا . . وعلى صدقك يا محمد فيما تبلغه عنا ، قال هذا العتل الزنيم ، هذه الآيات أكاذيب الأولين وترهاتهم .
كفر بآيات الله وأعرض عنها ، وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين ، كقوله : ( ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ) قال الله تعالى : ( سأصليه سقر ) [ المدثر : 11 - 26 ] .
وقوله: ( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ) يقول: إذا تقرأ عليه آيات كتابنا، قال: هذا مما كتبه الأوّلون استهزاء به وإنكارًا منه أن يكون ذلك من عند الله.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[15] ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الشر يُعدي، الذي قال عن القرآن أنه أساطير الأولين هو الوليد بن المغيرة، فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان، وأخذوا يقولونه أسند الله إليهم هذا القول في آية: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الفرقان: 5].
وقفة
[15] صاحب الهوى غايته أن يرد الحق، وحججه أعذار، أقوام ترد الحق لأنه قديم: ﴿أساطير الأولين﴾، وأخرى ترده لأنه جديد: ﴿ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين﴾ [المؤمنون: 24].
وقفة
[15] وصفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلُّف القديم، فقالوا: ﴿أساطير الأولين﴾، وقالوا: ستموت دعوته بموته، ووصفوه بـالأبتر، فماتوا ومات دينهم، وبقي ذكر محمد ودينه.
الإعراب :
- ﴿ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾
- اعربت في الآية الكريمة السابعة من سورة «لقمان» وعلامة بناء الفعل «قال» الفتحة الظاهرة.
- ﴿ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: ﴾
- خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أساطير. الأولين: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'
المتشابهات :
| لقمان: 7 | ﴿وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ |
|---|
| القلم: 15 | ﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ |
|---|
| المطففين: 13 | ﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا أعطاه اللهُ المال والبنين؛ طغى واستكبر عن الحقِّ، فإذا قرأ عليه أحدٌ آيات القرآن؛ كذَّب به، ووصفه بأنه خُرافات الأولين، قال تعالى:
﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
إذا:
وقرئ:
أئذا، على الاستفهام، وهى قراءة الحسن.
مدارسة الآية : [16] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾
التفسير :
ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله، بأن الله سيسمه على خرطومهفي العذاب، وليعذبه عذابًا ظاهرًا، يكون عليه سمة وعلامة، في أشق الأشياء عليه، وهو وجهه.
ثم ختم هذه الآيات بأشد أنواع الوعيد لمن هذه صفاته فقال - تعالى - ( سَنَسِمُهُ عَلَى الخرطوم ) .
أى : سنبين أمره ونوضحه توضيحا يجعل الناس يعرفونه معرفة تامة لإخفاء معها ولا لبس ولا غموض ، كما لا تخفى العلامة الكائنة على الخرطوم ، الذى يراد به هنا الأنف . والوسم عليه يكون بالنار .
أو سنلحق به عارا لا يفارقه ، بلا يلازمه مدى الحياة ، وكان العرب إذا أرادوا أن يسبوا رجلا سبة قبيحة . . قد وُسِمَ فلان مِيسَمَ سوء . . أى : التصق به عار لا يفارقه ، كالسمة التى هى العلامة التى لا يمحى أثرها . .
وذكر الوسم والخرطوم فيه ما فيه من الذم ، لأن فيه جمعا بين التشويه الذى يترتب على الوسم السَّيِّئ ، وبين الإِهانة ، لأن كون الوسم فى الوجه بل فى أعلى جزء من الوجه وهو الأنف .
. دليل على الإِذلال والتحقير .
ومما لا شك فيه أن وقع هذه الآيات على الوليد بن المغيرة وأمثاله ، كان قاصما لظهورهم ، ممزقا لكيانهم ، هادما لما كانوا يتفاخرون به من أمجاد زائفة ، لأنه ذم لهم من رب الأرض والسماء ، الذى لا يقول إلا حقا وصدقا .
كذلك كانت هذه الآيات تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ، عما أصابهم من أذى ، من هؤلاء الحلافين بالباطل والزور ، المشائين بين الناس بالنميمة ، المناعين لكل خير وبر .
قال تعالى ها هنا : ( سنسمه على الخرطوم )
قال ابن جرير : سنبين أمره بيانا واضحا ، حتى يعرفوه ، ولا يخفى عليهم ، كما لا تخفى السمة على الخراطيم ، وهكذا قال قتادة : ( سنسمه على الخرطوم ) شين لا يفارقه آخر ما عليه . وفي رواية عنه : سيما على أنفه . وكذا قال السدي .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( سنسمه على الخرطوم ) يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال . وقال آخرون : ( سنسمه ) سمة أهل النار ، يعني نسود وجهه يوم القيامة ، وعبر عن الوجه بالخرطوم . حكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة ، وهو متجه .
وقد قال ابن أبي حاتم في سورة ( عم يتساءلون ) حدثنا أبي ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني الليث ، حدثني خالد ، عن سعيد ، عن عبد الملك بن عبد الله ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ، ثم أحقابا ، ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ، ثم أحقابا ، ثم يموت والله عليه راض . ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس ، كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم ، من كلا الشفتين " .
القول في تأويل قوله تعالى : سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16)
وقوله: ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: سنخطمه بالسيف، فنجعل ذلك علامة باقية، وسمة ثابتة فيه ما عاش.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) فقاتل يوم بدر، فخُطِم بالسيف في القتال.
وقال آخرون: بل معنى ذلك سنشينه شينا باقيا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) شَيْن لا يفارقه آخر ما عليه.
وقال آخرون: سيمَى على أنفه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) قال: سنسم على أنفه.
وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه، فلا يخفى عليهم، كما لا تخفي السمة على الخرطوم.
وقال قتادة: معنى ذلك: شين لا يفارقه آخر ما عليه، وقد يحتمل أيضا أن يكون خطم بالسيف، فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطم بالسيف.
ويعني بقوله: ( سَنَسِمُهُ ) سنكويه. وقال بعضهم: معنى ذلك: سنسمه سِمَة أهل النار: أي سنسوِّد وجهه.
وقال: إن الخرطوم وإن كان خصّ بالسمة، فإنه في مذهب الوجه؛ لأن بعض الوجه يؤديّ عن بعض، والعرب تقول: والله لأسمنك وسما &; 23-542 &; لا يفارقك، يريدون الأنف. قال: وأنشدني بعضهم:
لأعَلطَنَّـــهُ وَسْـــمًا لا يُفارِقــهُ
كمــا يُحَـزُّ بِحَـمْى المِيسَـمِ النَّجِـرُ (1)
والنجر: داء يأخذ الإبل فتُكوى على أنفها.
------------
الهوامش :
(1) البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن (الورقة 339) قال عند قوله تعالى: ( سنسمه على الخرطوم ) أي: سنسمه سمة أهل النار، أي: سنسود وجهه؛ فهو وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة، فإنه في مذهب الوجه؛ لأن بعض الوجه يؤدى عن بعض، والعرب تقول: أما والله لأسمنك وسما لا يفارقك، يريدون الأنف، وأنشدني بعضهم: "لأعلطنه وسما." البيت فقال: الميسم ولم يذكر الأنف؛ لأنه موضع السمة. والبحر: البعير إذا أصابه البحر، وهو داء يأخذ البعير فيوسم لذلك. أ.هـ . قلت: وأنشد صاحب اللسان البيت "في بحر" وقال قال الفراء: البحر أن يلغي البعير بالماء، فيكثر منه، حتى يصيبه منه داء، يقال: بحر يبحر بحرا، فهو بحر، وأنشد: بيت الشاهد. قال: وإذا أصابه الداء كوي في مواضع فيبرأ. ا هـ كلام الفراء كما في اللسان.
وقال الأزهري معقبا عليه: الداء الذي يصيب البعير فلا يروى من الماء، هو النجر، بالنون والجيم، والبجر بالباء والجيم. وأما البحر: فهو داء يورث السل. وأبحر الرجل: إذا أخذه السل. ورجل بحير وبحر: مسلول ذاهب اللحم. عن ابن الأعرابي . ا هـ. قلت : ويؤيد هذا ما جاء في (اللسان: نجر) قال الجوهري: النجر بالتحريك، عطش يصيب الإبل والغنم عن أكل الحبة، فلا تكاد تروى من الماء. يقال: نجرت الإبل ومجرت أيضا. ا هـ . وفي التهذيب: نجر ينجر نجرا: إذا أكثرت من شرب الماء، ولم يكد يروى قال يعقوب: وقد يصيب الإنسان. ا هـ . وحمى الميسم: حره . والميسم حديدة يكوى بها.
التدبر :
وقفة
[16] ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ عبر بالوسم على الخرطوم -وهو الأنف- عن غاية الإذلال والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإذالة، فكيف بها على أكرم موضع منه؟!
تفاعل
[16] ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ ادعُ الله الآن أن يسترك في الدنيا والآخرة.
وقفة
[16] ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ قيل: إن معنى وسم الوليد بن المغيرة أن يصير مشهورًا بالذكر الرديء، والعار الذي لا يفارقه أبد الدهر، فقد ذكر الله في سورة القلم من أوصافه القبيحة ما التصق به، فعُرف بالمهانة كما تُعرَّف الشاة بزنمتها، وكون الوسم في أعلى جزء من الوجه وهو الأنف دليل على الإذلال والتحقير.
وقفة
[16] ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ أعظم الإهانة إهانة الوجه، ومن بذل وجهه في طاعة الله، جعل الله هذا سببًا لتحريمه على النار، فإن الله حرَّم على النار أن تأكل آثار السجود.
وقفة
[16] ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ فائدة فقهية تربوية، قال القرطبي: «ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور، علامة على قبح المعصية، وتشديدًا لمن يتعاطاها ممن يُرجي تجنبه لها، بما رأى من عقوبة شاهد الزور وشهرته، فقد كان عزيزًا بقول الحق، وقد صار مهينًا بالمعصية».
عمل
[16] ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ من نازع الله في كبريائه وعظمته؛ أذله الله ذل لا يخفى، وأهانه إهانة لا تمحى، فإياك والكبرياء بغير حق.
وقفة
[16] كان الوليد بن المغيرة سيِّدًا من سادات قومه ومن أكابر رجالات قريش، ولا يستطيع المسلمون يومها أن يدفعوا عن أنفسهم عذابه وإيذاءه، وفي هذه الظروف توعده الله بقوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾، فخُطم أنفه بالسيف يوم بدر، فلم يزل مخطومًا إلى أن مات، لينفذ فيه وعد الله.
الإعراب :
- ﴿ سَنَسِمُهُ: ﴾
- السين حرف- تسويف- استقبال. نسمه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به بمعنى سنجعل له علامة.
- ﴿ عَلَى الْخُرْطُومِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بنسم اي على الانف وعبر بذلك عن الاذلال والاهانة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ قَبائحَ أفعالِ المُكذِّب وأقوالِه؛ ذَكَرَ هنا ما يُفعَلُ به على سَبيلِ التَّوعُّدِ، قال تعالى:
﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء

