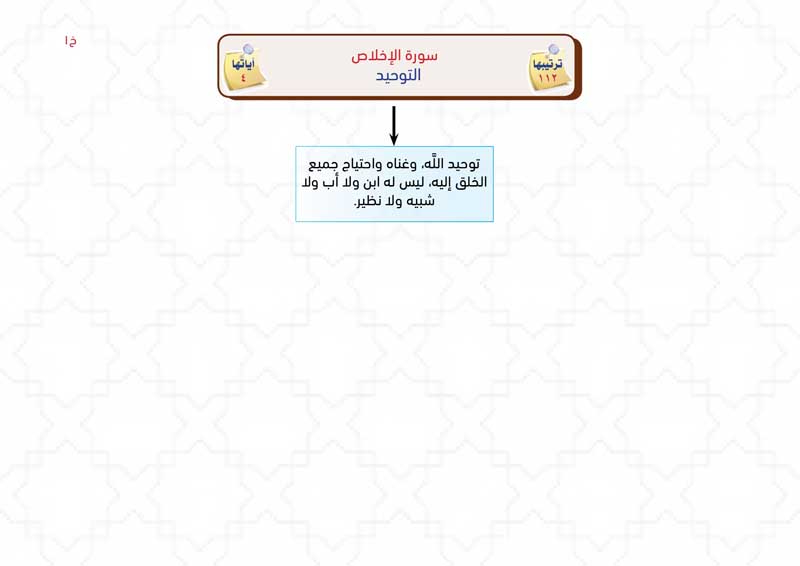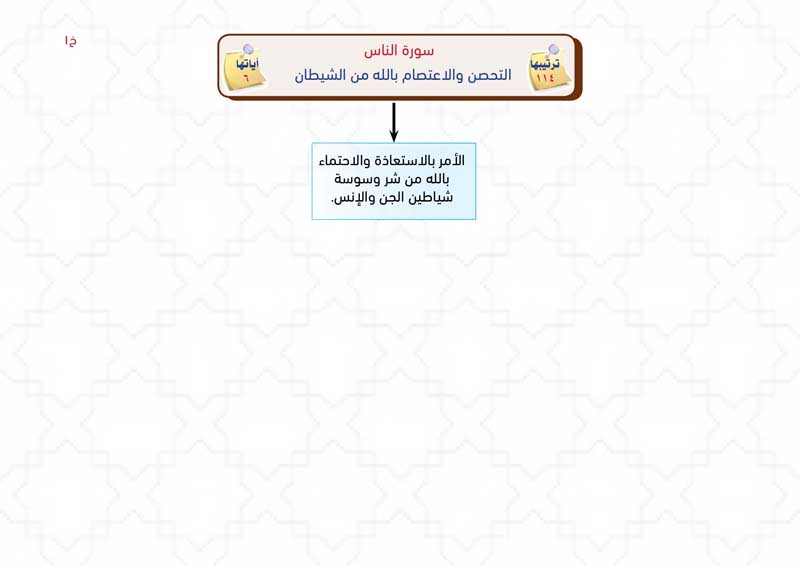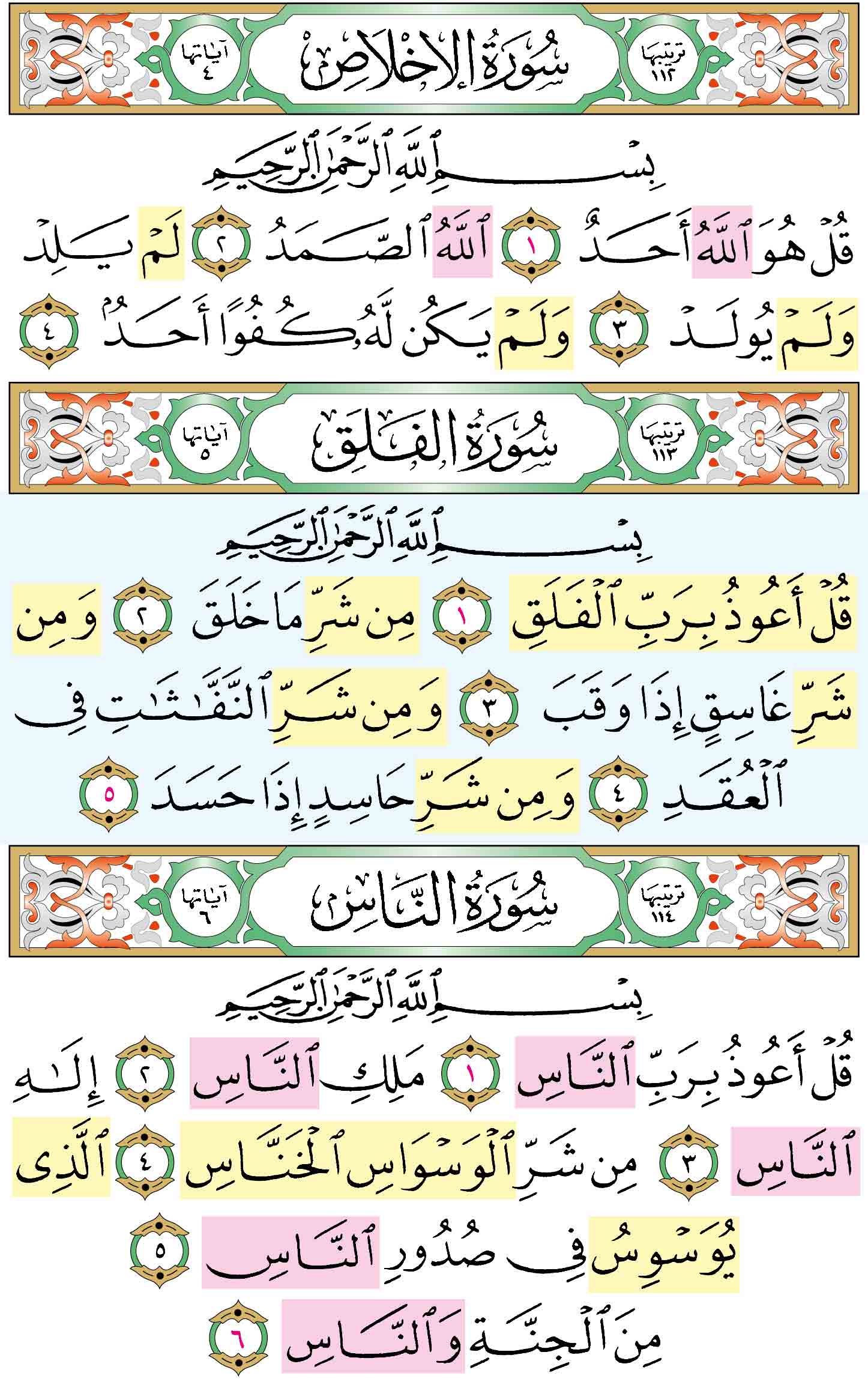
الإحصائيات
سورة الإخلاص
| ترتيب المصحف | 112 | ترتيب النزول | 22 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.26 |
| عدد الآيات | 4 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |
| ترتيب الطول | 113 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الأمر: 4/6 | _ | ||
سورة الفلق
| ترتيب المصحف | 113 | ترتيب النزول | 20 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.36 |
| عدد الآيات | 5 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |
| ترتيب الطول | 111 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الأمر: 5/6 | _ | ||
سورة الناس
| ترتيب المصحف | 114 | ترتيب النزول | 21 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.38 |
| عدد الآيات | 6 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |
| ترتيب الطول | 108 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الأمر: 6/6 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)
توحيدُ اللَّهِ وغِنَاه واحتياجُ جميعِ الخَلقِ إليه، ليسَ له ابنٌ ولا أبٌ ولا شبيهٌ ولا نظيرٌ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)
الأمرُ بالاستعاذةِ والاحتماءِ باللهِ من شرِّ جميعِ المخلوقاتِ، ثُمَّ تخصيصُ ثلاثةٍ بالذِّكرِ لخطرِها.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثالث
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)
الأمرُ بالاستعاذةِ والاحتماءِ باللهِ من شرِّ وسوسةِ شياطينِ الجنِّ والإنسِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الإخلاص
التوحيد
أولاً : التمهيد للسورة :
- • رسالة السورة:: • السورة بكاملها تقرر وحدانية الله، فهو سبحانه ليس له أب ولا ولد لاستغنائه عن ذلك، فهو الأول والآخر، كل مخلوق محتاج له، وهو مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى، إله بهذه الصفات الجليلة ألا يستحق العبادة وحده؟ وقصده في جميع أمورنا؟
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة الإخلاص»، و«سُورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».
- • معنى الاسم :: --
- • سبب التسمية :: اشْتُهِرَ هَذَا الِاسْمُ لِاخْتِصَارِهِ وَجَمْعِهِ مَعَانِي هَذِهِ السُّورَةِ لِأَنَّ فِيهَا تَعْلِيمَ النَّاسِ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، أَيْ سَلَامَةَ الِاعْتِقَادِ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ غَيْرَهُ فِي الْإِلَهِيَّةِ.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ الأَسَاسِ»، و«سُورَةُ التوحيد»، و«سُورَةُ المقشقشة»، و«سُورَةُ الصمد».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن الله واحد لا شريك له ولا شبيه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾
- • علمتني السورة :: غنى الله واحتياج جميع الخلق إليه
- • علمتني السورة :: أن الله لا ولد له ولا والد، فهو مستغن عن ذلك
- • علمتني السورة :: أن الله ليس له مماثل أو مشابه من خلقه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ».
• عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: «لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا»، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ».
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ».
• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».
• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».
• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».
• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
• عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ».
• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».
والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الإخلاص من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الإخلاص من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، (لحديث ابن عباس الذي مر قبل قليل).
• يستحب قرن سورة الإخلاص مع سورة الكافرون في صلاة: سنة الفجر، وسنة المغرب، والوتر والطواف.
• يحرص المسلم على قراءة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) عند النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد الصلاة.
• يوجد في القرآن 3 سور لم يرد اسمها المشهور في آياتها، وهي: الفاتحة والأنبياء والإخلاص.
• اختصت سورة الإخلاص بذكر اسمين لله تعالى لم يذكرا في سواها: الأحد والصمد.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نجتهد في توحيد الله وأن نحذر الشرك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ (1).
• أن ندعو الناس لتوحيد الله ونحذرهم من الشرك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ (1).
• أن نعلق قلوبنا به وحده، فهو المقصود بجلب كل خير ودفع كل شر: ﴿ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ (2).
• أن ننفي عن الله كل نقص وسوء، فهو سبحانه الكامل من كل وجه: ﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ﴾ (3).
• أن ننزه الله عن المثل والند: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (4).
• أن نقرأ المعوذات: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ قبل النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد كل صلاة مرة واحدة.
أن نرقي أنفسنا بالمعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.
سورة الفلق
التحصن والاعتصام بالله من كل الشرور (الاستعاذة بالله من أسباب الشر)
أولاً : التمهيد للسورة :
- • نقاط السورة: • هذه السورة ترشدنا إلى الاعتصام بالله من الشرور جميعها، ومن أعظم تلك الشرور التي يجب للعبد أن يستجير بالله منها شر الحسد والعين والسحر، فكيف الوقاية من كل تلك الشرور؟ هل عرض لك شيء من ذلك؟ ماذا كان موقفك، وكيف عالجت نفسك؟
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة الفلق»، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»، و«االمعوذتين» مع سورة الناس.
- • معنى الاسم :: الفلق: هو الصُبح.
- • سبب التسمية :: لوروده في أول آية.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: 1- «المُقَشْقِشَتين» أي الفلق والناس، وسميتا بذلك لأنهما تبرئان من النفاق، فيكون اسم (المُقَشْقِشَة) مشتركًا بين خمس سور: براءة والكافرون والإخلاص والفلق والناس. 2- «المُشَقْشِقَتَيْن» -بتقديم الشينين على القافين- أي الفلق والناس أيضًا.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الالتجاء والاعتصام بالله وحده: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾
- • علمتني السورة :: أن من استجار بربّه سبحانه أجاره، ومن اعتصم به وقاه وكشف ما به؛ كما يكشف ظلمة الليل بضوء الفجر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾
- • علمتني السورة :: أن الله سبحانه خالق كل شيء، وبيده كل شيء، فلا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾
- • علمتني السورة :: الفلق أن الظلمة مظنة للشرور من هوام وغيرها، وكذلك ظلمة القلب عن الوحي مظنة لانتشار الأذى فيه: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا».
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا».
• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عُقْبَة بْنُ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق} فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ».
• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».
• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
• عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ».
• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».
• والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الإخلاص من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الفلق من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • يحرص المسلم على قراءة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) عند النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد الصلاة.
• جاءت المعوذتان في آخر المصحف لنتعلم كيف نتحصن بالله تعالى من شرور كثيرة؛ لأن الحياة حافلة بما يسوء.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتعلق بالله وحده رب كل شيء ومليكه، الذي يخرج الخير والنور من ظلمة البلاء والضيق: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (1).
• أن نلتجئ ونعتصم بالله تعالى وحده من جميع الشرور الظاهرة والباطنة: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (2).
• أن نجتهد في اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنسلم من الظلمة والشرور: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (3).
• أن نُذَكِّر الناسَ بخطورة السحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وعدَّه من السبع الموبقات: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (4).
• أن نحذر من حسد الناس على ما أعطاهم الله من النعم، فإنها من الله وبتقديره: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (5).
• أن نقرأ المعوذات: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ قبل النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد كل صلاة مرة واحدة.
• أن نرقي أنفسنا بالمعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.
سورة الناس
التحصن والاعتصام بالله من الشيطان (الاستعاذة بالله من شر الشيطان)
أولاً : التمهيد للسورة :
- • نقاط السورة: • هذه السورة كسابقتها إرشاد من الله تعالى لنا بالاعتصام به من شر شياطين الإنس والجن ووسوستهم، حتى يكون العبد • في حرز من الله تعالى من شر الشياطين وأعوانهم من الإنس.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة الناس»، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»، و«االمعوذتين» مع سورة الفلق.
- • معنى الاسم :: --
- • سبب التسمية :: لوروده في أول آية، وتكرار اللفظ فيها خمس مرات.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: 1- «المُقَشْقِشَتين»: أي الفلق والناس، وسميتا بذلك لأنهما تبرئان من النفاق، فيكون اسم (المُقَشْقِشَة) مشتركًا بين خمس سور: براءة والكافرون والإخلاص والفلق والناس. 2- «المُشَقْشِقَتَيْن»: -بتقديم الشينين على القافين- أي الفلق والناس أيضًا.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الالتجاء والاعتصام بالله تعالى، فهو رب الناس كلهم، وهو مالكهم ومعبودهم، فلِمَ اللجوء إلى غيره؟: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَـٰهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾
- • علمتني السورة :: أهمية الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾
- • علمتني السورة :: أن كيد الشيطان ضعيف فهو يوسوس للإنسان عند الغفلة، فإذا ذكرَ اللهَ خنس واختفى، فليس له سلطان على عباد الله الصالحين: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾
- • علمتني السورة :: أن من الناس شياطين؛ فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا.
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا».
• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».
• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
• عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ».
• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».
والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الإخلاص من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الناس من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • يحرص المسلم على قراءة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) عند النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد الصلاة.
• جاءت المعوذتان في آخر المصحف لنتعلم كيف نتحصن بالله تعالى من شرور كثيرة؛ لأن الحياة حافلة بما يسوء.
• سورة الناس آخر سور القرآن الكريم البالغة 114 سورة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعيذ بالله وحده ونعلق القلوب به وحده، فهو سبحانه مالك النفع والضر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَـٰهِ النَّاسِ﴾ (1-3).
• أن نشتغل بذكر الله ونحافظ على الأذكار لنطرد وساوس الشيطان عنا: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (4).
• أن نجدد الالتجاء إلى الله في كل وقت وحين، فعدونا متربص لا يمل ولا يكل: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (5).
• أن نستعيذ بالله ونلجأ إليه من شر مفسدي الإنس أعوان الشياطين: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (6).
• أن نبيِّن للناس شدة ضرر الشيطان عليهم، وأنه يجري منهم مجرى الدم، وأن معركة الشيطان مع الإنسان قديمة باقية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ...﴾ (فاطر 6).
• أن نقرأ المعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ قبل النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد كل صلاة مرة واحدة.
• أن نرقي أنفسنا بالمعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.
تمرين حفظ الصفحة : 604
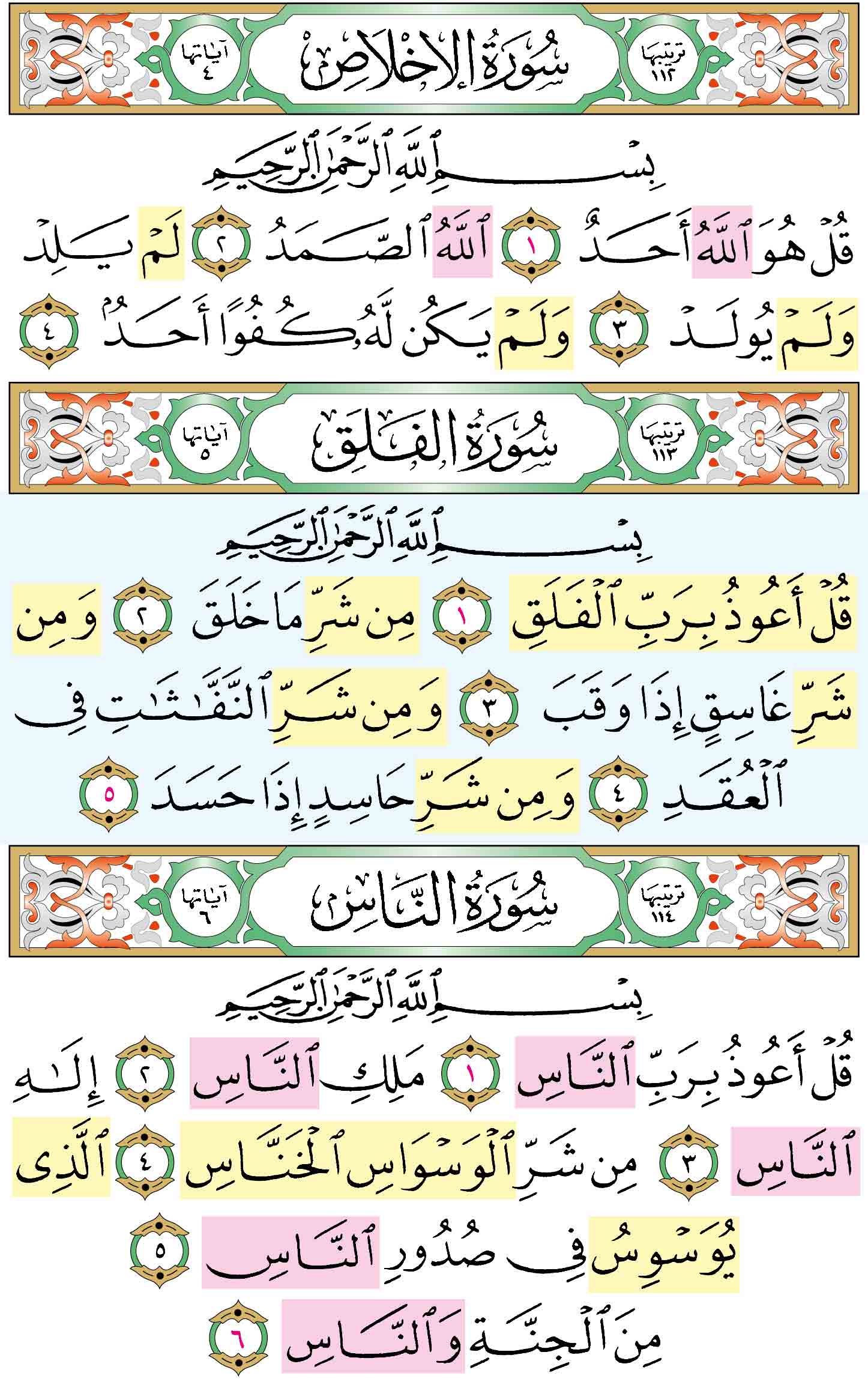
مدارسة الآية : [1] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾
التفسير :
أي{ قُلْ} قولًا جازمًا به، معتقدًا له، عارفًا بمعناه،{ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أي:قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل.
تفسير سورة الإخلاص
مقدمة وتمهيد
1- سورة «الإخلاص» من السور ذات الأسماء المتعددة، وقد ذكر لها الجمل في حاشيته عشرين اسما، منها أنها تسمى سورة التفريد، والتجريد، والتوحيد، والنجاة، والولاية، والمعرفة، والصمد، والأساس، والمانعة، والبراءة ... .
2- وقد ورد في فضلها أحاديث متعددة، منها ما أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري، أن رجلا سمع رجلا يقرأ هذه السورة، ويرددها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» .
قال بعض العلماء ومعنى هذا الحديث: أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات.
3- وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها: أن المشركين قالوا: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله- تعالى- هذه السورة الكريمة ... .
وجمهور العلماء على أنها السورة الثانية والعشرون في ترتيب النزول. ويرى بعضهم أنها مدنية، والأول أرجح، لأنها جمعت أصل التوحيد، وهذا المعنى غالب في السور المكية.
وعدد آياتها خمس آيات في المصحف الحجازي والشامي، وأربع آيات في الكوفي والبصري.
وقد افتتحت بفعل الأمر «قل» لإظهار العناية بما بعد هذا الأمر من توجيهات حكيمة، ولتلقينه صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين الذين سألوه أن ينسب لهم ربه.
وهُوَ ضمير الشأن مبتدأ، والجملة التي بعده خبر عنه.
والأحد: هو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وفي كل شأن من شئونه، فهو منزه عن التركيب من جواهر متعددة، أو من مادة معينة، كما أنه- عز وجل- منزه عن الجسمية والتحيز، ومشابهة غيره.
وفي الإتيان بضمير الشأن هنا: إشارة إلى فخامة مضمون الجملة، مع ما في ذلك من زيادة التحقيق والتقرير، لأن الضمير يشير إلى شيء مبهم تترقبه النفس، فإذا جاء الكلام من بعده زال الإبهام، وتمكن الكلام من النفس فضل تمكن.
وجيء بالخبر نكرة وهو لفظ «أحد» لأن المقصود الإخبار عن الله- تعالى- بأنه واحد، ولو قيل: الله الأحد، لأفاد أنه لا واحد سواه، وليس هذا المعنى مقصودا هنا، وإنما المقصود إثبات أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ... ونفى ما زعمه المشركون وغيرهم، من أنه- تعالى- مركب من أصول مادية أو غير مادية، أو من أنه له شريك في ملكه.
تفسير سورة الإخلاص وهي مكية .
ذكر سبب نزولها وفضيلتها
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، حدثنا الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب : أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ، انسب لنا ربك . فأنزل الله : " قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " .
وكذا رواه الترمذي وابن جرير ، عن أحمد بن منيع - زاد ابن جرير : ومحمود بن خداش - عن أبي سعد محمد بن ميسر به - زاد ابن جرير والترمذي - قال : " الصمد " الذي لم يلد ولم يولد ، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث ، " ولم يكن له كفوا أحد " ولم يكن له شبه ولا عدل ، وليس كمثله شيء .
ورواه ابن أبي حاتم ، من حديث أبي سعد محمد بن ميسر به . ثم رواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، فذكره مرسلا ولم يذكر " أخبرنا " . ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد .
حديث آخر في معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا إسماعيل بن مجالد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : انسب لنا ربك . فأنزل الله عز وجل : " قل هو الله أحد " إلى آخرها . إسناده مقارب .
وقد رواه ابن جرير ، عن محمد بن عوف ، عن سريج فذكره . وقد أرسله غير واحد من السلف .
وروى عبيد بن إسحاق العطار ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انسب لنا ربك ، فنزلت هذه السورة : " قل هو الله أحد "
قال الطبراني : رواه الفريابي وغيره ، عن قيس ، عن أبي عاصم ، عن أبي وائل ، مرسلا .
ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي ، عن الوازع بن نافع ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل شيء نسبة ، ونسبة الله : " قل هو الله أحد الله الصمد " والصمد ليس بأجوف ] .
حديث آخر في فضلها : قال البخاري : حدثنا محمد - هو الذهلي - ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو ، عن ابن أبي هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم ب " قل هو الله أحد " فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " سلوه : لأي شيء يصنع ذلك ؟ " . فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أخبروه أن الله تعالى يحبه " .
هكذا رواه في كتاب " التوحيد " . ومنهم من يسقط ذكر " محمد الذهلي " . ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال به .
حديث آخر : قال البخاري في كتاب الصلاة : " وقال عبيد الله ، عن ثابت عن أنس قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء ، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب " قل هو الله أحد " حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى ، فإما أن تقرأ بها ، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت ، وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم ، وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر ، فقال : " يا فلان ، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ " . قال : إني أحبها . قال : " حبك إياها أدخلك الجنة " .
هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به . وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه ، عن البخاري ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، فذكر بإسناده مثله سواء . ثم قال الترمذي : غريب من حديث عبيد الله ، عن ثابت . قال : وروى مبارك بن فضالة ، عن ثابت عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني أحب هذه السورة : " قل هو الله أحد " قال : " إن حبك إياها أدخلك الجنة " .
وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا فقال :
حدثنا أبو النضر ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن ثابت ، عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أحب هذه السورة : " قل هو الله أحد " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حبك إياها أدخلك الجنة " .
حديث في كونها تعدل ثلث القرآن : قال البخاري : حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . أن رجلا سمع رجلا يقرأ : " قل هو الله أحد " يرددها ، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، وكأن الرجل يتقالها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن " . زاد إسماعيل بن جعفر ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : أخبرني أخي قتادة بن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف والقعنبي . ورواه أبو داود ، عن القعنبي . والنسائي ، عن قتيبة ، كلهم عن مالك به . وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن مالك به .
حديث آخر : قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ، حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ " . فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : " الله الواحد الصمد ثلث القرآن " .
تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن شرحبيل الهمداني المشرقي ، كلاهما عن أبي سعيد ، قال القربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله البخاري : عن إبراهيم مرسل ، وعن الضحاك مسند .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب " قل هو الله أحد " فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " والذي نفسي بيده ، لتعدل نصف القرآن ، أو ثلثه " .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا حيي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو : أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : فإن " قل هو الله أحد " ثلث القرآن . قال : فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب ، فقال : " صدق أبو أيوب " .
حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا يزيد بن كيسان ، أخبرني أبو حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احشدوا ، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن " . فحشد من حشد ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ : " قل هو الله أحد " ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن " . إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إني قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن " .
وهكذا رواه مسلم في صحيحه ، عن محمد بن بشار به ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ، واسم أبي حازم سلمان .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن الربيع بن خثيم ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن امرأة من الأنصار ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ : " قل هو الله أحد الله الصمد " في ليلة ، فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن " .
هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد . ورواه الترمذي والنسائي ، كلاهما عن محمد بن بشار بندار - زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به . فصار لهما عشاريا . وفي رواية الترمذي : " عن امرأة أبى أيوب ، عن أبي أيوب " ، به [ وحسنه ] . ثم قال : وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود . وهذا حديث حسن ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية " زائدة " . وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض . وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه .
حديث آخر : قال أحمد : حدثنا هشيم ، عن حصين ، عن هلال بن يساف ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب - أو : رجل من الأنصار - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ ب " قل هو الله أحد " فكأنما قرأ بثلث القرآن " .
ورواه النسائي في " اليوم والليلة " ، من حديث هشيم ، عن حصين ، عن ابن أبي ليلى به . ولم يقع في روايته : هلال بن يساف .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن " .
وهكذا رواه ابن ماجه ، عن علي بن محمد الطنافسي ، عن وكيع به . ورواه النسائي في " اليوم والليلة " من طرق أخر ، عن عمرو بن ميمون ، مرفوعا وموقوفا .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا بهز ، حدثنا بكير بن أبي السميط ، حدثنا قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ " . قالوا : نعم يا رسول الله ، نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : " فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء ، ف " قل هو الله أحد " ثلث القرآن " .
ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد ، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم - ابن أخي ابن شهاب - عن عمه الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن - هو ابن عوف - عن أمه - وهي : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن " .
وكذا رواه النسائي في " اليوم والليلة " ، عن عمرو بن علي ، عن أمية بن خالد به . ثم رواه من طريق مالك ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، قوله . ورواه النسائي أيضا في " اليوم والليلة " من حديث محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل الأنصاري ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن : أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها " .
حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن حنين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع رجلا يقرأ " قل هو الله أحد " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجبت " . قلت : وما وجبت ؟ قال : " الجنة " .
ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث مالك .
وتقدم حديث : " حبك إياها أدخلك الجنة " .
حديث في تكرار قراءتها : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا قطن بن نسير ، حدثنا عيسى بن ميمون القرشي ، حدثنا يزيد الرقاشي ، عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أما يستطيع أحدكم أن يقرأ : " قل هو الله أحد " ثلاث مرات في ليلة ، فإنها تعدل ثلث القرآن ؟ "
هذا إسناد ضعيف ، وأجود منه حديث آخر ، قال عبد الله بن الإمام أحمد :
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمة ، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ، فخرج فأخذ بيدي ، فقال : " قل " . فسكت . قال : " قل " . قلت : ما أقول ؟ قال : " " قل هو الله أحد " والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا ، تكفك كل يوم مرتين " .
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي ذئب به . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائي من طريق أخرى ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، فذكره [ ولفظه : " يكفك كل شيء " ] .
حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا ليث بن سعد ، حدثني الخليل بن مرة ، عن الأزهر بن عبد الله ، عن تميم الداري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال : لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له كفوا أحد ، عشر مرات ، كتب له أربعون ألف ألف حسنة " .
تفرد به أحمد والخليل بن مرة : ضعفه البخاري وغيره بمرة .
حديث آخر : قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ " قل هو الله أحد " حتى يختمها ، عشر مرات ، بنى الله له قصرا في الجنة " . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : " الله أكثر وأطيب " . تفرد به أحمد .
ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال : حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد - قال الدارمي : وكان من الأبدال - أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ " قل هو الله أحد " عشر مرات ، بنى الله له قصرا في الجنة ، ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة ، ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة " . فقال عمر بن الخطاب : إذا لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله أوسع من ذلك " . وهذا مرسل جيد .
حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي ، حدثني نوح بن قيس ، أخبرني محمد العطار ، أخبرتني أم كثير الأنصارية ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ " قل هو الله أحد " خمسين مرة غفرت له ذنوب خمسين سنة " إسناده ضعيف .
حديث آخر : قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حاتم بن ميمون ، حدثنا ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ في يوم : " قل هو الله أحد " مائتي مرة ، كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين " . إسناده ضعيف حاتم بن ميمون : ضعفه البخاري وغيره . ورواه الترمذي ، عن محمد بن مرزوق البصري ، عن حاتم بن ميمون به . ولفظه : " من قرأ كل يوم ، مائتي مرة : " قل هو الله أحد " محي عنه ذنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين " .
قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن ينام على فراشه ، فنام على يمينه ، ثم قرأ : " قل هو الله أحد " مائة مرة ، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل : يا عبدي ، ادخل على يمينك الجنة " . ثم قال : غريب من حديث ثابت وقد روي من غير هذا الوجه ، عنه .
وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر ، حدثنا حبان بن أغلب ، حدثنا أبي ، حدثنا ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ : " قل هو الله أحد " مائتي مرة ، حط الله عنه ذنوب مائتي سنة " . ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم ، وهما متقاربان في سوء الحفظ .
حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائي عند تفسيرها : حدثنا عبد الرحمن بن خالد ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني مالك بن مغول ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي ، يدعو يقول : اللهم ، إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد . قال : " والذي نفسي بيده ، لقد سأله باسمه الأعظم ، الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعي به أجاب " .
وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق ، عن مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، به . وقال الترمذي : حسن غريب .
حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة : قال الحافظ أبو يعلى [ الموصلي ] : حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا بشر بن منصور ، عن عمر بن نبهان ، عن أبي شداد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء ، وزوج من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله ، وأدى دينا خفيا ، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات : " قل هو الله أحد " . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال : " أو إحداهن "
حديث في قراءتها عند دخول المنزل : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري ، حدثنا محمد بن الفرج ، حدثنا محمد بن الزبرقان ، عن مروان بن سالم ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ : " قل هو الله أحد " حين يدخل منزله ، نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران " . إسناده ضعيف .
حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن العلاء بن محمد الثقفي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله ، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا جبريل ، ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟ " . قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي ، مات بالمدينة اليوم ، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال : " وفيم ذلك ؟ " قال : كان يكثر قراءة : " قل هو الله أحد " في الليل وفي النهار ، وفي ممشاه وقيامه وقعوده ، فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : " نعم " . فصلى عليه .
وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في [ كتاب ] دلائل النبوة " من طريق يزيد بن هارون ، عن العلاء أبي محمد - وهو متهم بالوضع - فالله أعلم .
طريق أخرى : قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله ، حدثنا عثمان بن الهيثم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي - عن محمود أبي عبد الله ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مات معاوية بن معاوية الليثي ، فتحب أن تصلي عليه ؟ قال : " نعم " . فضرب بجناحه الأرض ، فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت ، فرفع سريره فنظر إليه ، فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة ، في كل صف سبعون ألف ملك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا جبريل ، بم نال هذه المنزلة من الله تعالى ؟ " . قال بحبه : " قل هو الله أحد " وقراءته إياها ذاهبا وجائيا قائما وقاعدا ، وعلى كل حال .
ورواه البيهقي من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن ، عن محبوب بن هلال ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس فذكره . وهذا هو الصواب ، ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي : " ليس بالمشهور " . وقد روي هذا من طرق أخر ، تركناها اختصارا ، وكلها ضعيفة .
حديث آخر في فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا معاذ بن رفاعة ، حدثني علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابتدأته فأخذت بيده ، فقلت : يا رسول الله ، بم نجاة المؤمن ؟ قال : " يا عقبة ، احرس لسانك وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك " . قال : ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابتدأني فأخذ بيدي ، فقال : " يا عقبة بن عامر ، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة ، والإنجيل والزبور ، والقرآن العظيم ؟ " . قال : قلت : بلى ، جعلني الله فداك . قال : فأقرأني : " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " ثم قال : " يا عقبة ، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن " . قال : فما نسيتهن منذ قال : " لا تنسهن " ، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن . قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته ، فأخذت بيده ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني بفواضل الأعمال . فقال : " يا عقبة ، صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، وأعرض عمن ظلمك "
روى الترمذي بعضه في " الزهد " ، من حديث عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد وقال : هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد من طريق آخر :
حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا ابن عياش ، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي ، عن فروة بن مجاهد اللخمي ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد .
حديث آخر في الاستشفاء بهن : قال البخاري : حدثنا قتيبة ، حدثنا المفضل ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : "قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات .
وهكذا رواه أهل السنن ، من حديث عقيل به .
قد تقدم ذكر سبب نزولها . وقال عكرمة : لما قالت اليهود : نحن نعبد عزيرا ابن الله . وقالت النصارى : نحن نعبد المسيح ابن الله . وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر . وقالت المشركون : نحن نعبد الأوثان - أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ( قل هو الله أحد )
يعني : هو الواحد الأحد ، الذي لا نظير له ولا وزير ، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل ; لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله .
ذُكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب ربّ العزّة, فأنـزل الله هذه السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نـزلت من أجل أن اليهود سألوه, فقالوا له: هذا الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟ فأُنـزلت جوابا لهم.
ذكر من قال: أنـزلت جوابا للمشركين الذين سألوه أن ينسب لهم الربّ تبارك وتعالى.
حدثنا أحمد بن منيع المَرْوَزِي ومحمود بن خداش الطالَقاني, قالا ثنا أبو سعيد الصنعاني, قال: ثنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية, عن أبي بن كعب, قال: قال المشركون للنبيّ صلى الله عليه وسلم: انسُب لنا ربك, فأنـزل الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) .
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا الحسين, عن يزيد, عن عكرمة, قال: إن المشركين قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن ربك, صف لنا ربك ما هو, ومن أي شيء هو؟ فأنـزل الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إلى آخر السورة .
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) قال: قال ذلك قتادة الأحزاب: انسُب لنا ربك, فأتاه جبريل بهذه .
حدثني محمد بن عوف, قال: ثنا شريح, قال: ثنا إسماعيل بن مجالد, عن مجالد, عن الشعبي, عن جابر قال: قال المشركون: انسُب لنا ربك, فأنـزل الله ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
* ذكر من قال: نـزل ذلك من أجل مسألة اليهود:
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, قال: ثني ابن إسحاق, عن محمد, عن سعيد, قال: أتى رهط من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق, فمن خلقه؟ فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى انتُقِع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه, فجاءه جبريل عليه السلام فسكنه, وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد, وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه. قال: " يقول الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) " فلما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: صف لنا ربك كيف خلقه, وكيف عضده, وكيف ذراعه, فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم أشدّ من غضبه الأول, وساورهم غضبا, فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته, وأتاه بجواب ما سألوه عنه: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: أنسب لنا ربك, فنـزلت: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) حتى ختم السورة .
فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا: قل يا محمد لهؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفته, ومَن خَلقه: الربّ الذي سألتموني عنه, هو الله الذي له عبادة كل شيء, لا تنبغي العبادة إلا له, ولا تصلح لشيء سواه.
واختلف أهل العربية في الرافع ( أَحَدٌ ) فقال بعضهم: الرافع له " الله ", وهو عماد (1) بمنـزلة الهاء في قوله: إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وقال آخر منهم: بل هو مرفوع, وإن كان نكرة بالاستئناف, كقوله: هذا بعلي شيخ, وقال: هو الله جواب لكلام قوم قالوا له: ما الذي تعبد؟ فقال: " هو الله ", ثم قيل له: فما هو؟ قال: هو أحد.
وقال آخرون ( أَحَدٌ ) بمعنى: واحد, وأنكر أن يكون العماد مستأنفا به, حتى يكون قبله حرف من حروف الشكّ, كظنّ وأخواتها, وكان وذواتها, أو إنّ وما أشبهها, وهذا القول الثاني هو أشبه بمذاهب العربية.
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) بتنوين " أحدٌ ", سوى نصر بن عاصم, وعبد الله بن أبي إسحاق, فإنه رُوي عنهما ترك التنوين: " أحَدُ اللهُ "; وكأن من قرأ ذلك كذلك, قال: نون الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام أو ساكن من الحروف حذفت أحيانا, كما قال الشاعر:
كَـيْفَ نَـوْمي عـلى الفِـرَاشِ وَلَمَّـا
تَشْــمَلِ الشَّــامَ غَــارَةٌ شَـعْوَاءُ
تُــذْهِلُ الشَّـيْخَ عَـنْ بَنِيـهِ وَتُبْـدِي
عَــنْ خِــدَامِ العَقِيلَــةِ العَــذْراءُ (2)
يريد: عن خدام العقيلة.
والصواب في ذلك عندنا: التنوين, لمعنيين: أحدهما أفصح اللغتين, وأشهر الكلامين, وأجودهما عند العرب. والثاني: إجماع الحجة من قرّاء الأمصار على اختيار التنوين فيه, ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وقد بيَّنا معنى قوله " أحد " فيما مضى, بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
التدبر :
وقفة
[1] عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ». [أحمد 15648، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6472].
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. [البخاري 7375].
وقفة
[1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ». [الترمذي 2894، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [النسائي 992، وحسنه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [الترمذي 869، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [ابن ماجه 1173، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [البخاري 5017].
وقفة
[1] عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: « قُلْ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ». [الترمذي 3575، وحسنه الألباني].
وقفة
[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ من عظمة الآية أنه ما من دين باطل أو فرقة مخالفة إلا وهذه الآية ترد عليها، فعليها يقوم علم الردود.
وقفة
[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ لم يخبر أنه أحد في أي شيء؟ فدل على العموم: فهو أحد في ربوبيته، فلا أحد يخلق ويرزق ويملك غيره، وأحد في ألوهيته، فلا يجوز أن يُعبَد أحد غيره، وأحد في صفاته، المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة.
وقفة
[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ (قل) تدل على أن القرآن قولي، وليس كما يقول بعضهم أنه كلام معنوي، أو كلام نفسي.
وقفة
[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا.
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ ربما ظن بعضهم أن السياق أن يقول: (هو الله الأحد الصمد)، ولكنها فُصلت عن التي قبلها؛ لأن هذه الجملة مسوقة لتستقر في النفوس ولتعظم، فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها.
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ هل تحفظ سور الإخلاص والمعوذات حقًّا؟ إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص، ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع، ولا يتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء رغبًا ورهبًا؛ فليس بحافظ حقًّا لسورة الإخلاص! وإن الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حمى المعوذتين، لا يكون قد اكتسب سورتي الفلق والناس!
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ لماذا حُذِفت ال التعريف من أحد؟ نكَّر أحد وعرَّف الصمد، الله أحد هذا إخبار للمخاطبين كانوا يجهلونه وينكرونه بالنسبة لقريش لا يعتقدون بالتوحيد لأنهم مشركون فهذا إخبار لهم أما الله الصمد فكلهم يعلمون هذا الشيء، الصمد أي الكافي الذي يرجعون إليه إذا احتاجوه هو الذي يكفيهم ويسد حاجاتهم وأسئلتهم الذي يصمدون إليه عند الحاجة، هذا معنى الصمد في اللغة صمد إليه أي توجه إليه وطلب منه الحاجة المصمود إليه هو السيد المتوجَّه إليه.
الإعراب :
- ﴿ قُلْ: ﴾
- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: ﴾
- ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الله لفظ الجلالة: خبره مرفوع للتعظيم بالضمة. أحد: بدل من لفظ الجلالة وان كان نكرة لأن النكرة قد تبدل من المعرفة والأصل في «أحد» وحد أي واحد فقلبت الواو ألفا ويجوز أن يكون «هو» ضمير الشأن في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الاسمية «اللَّهُ أَحَدٌ» وهو الشأن على تقدير: الشأن هذا وهو أن الله واحد لا شريك له أي لا ثاني له. و «أحد» بدل من قوله «الله» مرفوع بالضمة أو على «هو أحد» والجملة بعد «قل» في محل نصب مفعول به- مقول القول-.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بإثباتِ وَحدانيَّةِ الله تعالى، قال تعالى:
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
أحد الله:
وقرئ:
بحذف التنوين من «أحد» ، لالتقائه مع لام التعريف، وهى قراءة أبان بن عثمان، وزيد بن على، ونصر بن عاصم، وابن سيرين، والحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى عمرو، فى رواية يونس ومحبوب، والأصمعى، واللؤلئى، وعبيد، وهارون.
مدارسة الآية : [2] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾
التفسير :
{ اللَّهُ الصَّمَدُ} أي:المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي [كمل في رحمته الذي] وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه،
وقوله- سبحانه- اللَّهُ الصَّمَدُ أى: الله- تعالى- هو الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، ويقصدونه وحده بالسؤال والطلب ... مأخوذ من قولهم صمد فلان إلى فلان. بمعنى توجه إليه بطلب العون والمساعدة.
قال صاحب الكشاف: والصمد فعل بمعنى مفعول، من صمد إليه إذا قصده، وهو- سبحانه- المصمود إليه في الحوائج، والمعنى: هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض، وخالقكم، وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها، وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه، وهو الغنى عنهم ... .
وجاء لفظ «الصمد» محلى بأل، لإفادة الحصر في الواقع ونفس الأمر، فإن قصد الخلق إليه- سبحانه- في الحوائج، أعم من القصد الإرادى، والقصد الطبيعي، والقصد بحسب الاستعداد الأصلى، الثابت لجميع المخلوقات إذ الكل متجه إليه- تعالى- طوعا وكرها.
وقوله : ( الله الصمد ) قال عكرمة ، عن ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم .
قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والعليم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله سبحانه ، هذه صفته لا تنبغي إلا له ، ليس له كفء ، وليس كمثله شيء ، سبحان الله الواحد القهار .
وقال الأعمش ، عن شقيق عن أبي وائل : ( الصمد ) السيد الذي قد انتهى سؤدده ورواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود مثله .
وقال مالك عن زيد بن أسلم : ( الصمد ) السيد . وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضا : ( الصمد ) الحي القيوم الذي لا زوال له . وقال عكرمة : ( الصمد ) الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم .
وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلد ولم يولد . كأنه جعل ما بعده تفسيرا له ، وهو قوله : ( لم يلد ولم يولد ) وهو تفسير جيد . وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير ، عن أبي بن كعب في ذلك ، وهو صريح فيه .
وقال ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعبد الله بن بريدة ، وعكرمة أيضا ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطية العوفي ، والضحاك ، والسدي : ( الصمد ) الذي لا جوف له .
قال سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : ( الصمد ) المصمت الذي لا جوف له .
وقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام ، ولا يشرب الشراب .
وقال عبد الله بن بريدة أيضا : ( الصمد ) نور يتلألأ .
روى ذلك كله وحكاه : ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني ، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده ، وقال :
حدثني العباس بن أبي طالب ، حدثنا محمد بن عمرو بن رومي ، عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش ، حدثني صالح بن حيان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال - لا أعلم إلا قد رفعه - قال : ( الصمد ) الذي لا جوف له .
وهذا غريب جدا ، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة .
وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له ، بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير " الصمد " : وكل هذه صحيحة ، وهي صفات ربنا عز وجل ، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج ، وهو الذي قد انتهى سؤدده ، وهو الصمد الذي لا جوف له ، ولا يأكل ولا يشرب ، وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقي نحو ذلك [ أيضا ] .
وقوله: ( اللَّهُ الصَّمَدُ ) يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد.
واختلف أهل التأويل في معنى الصمد, فقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوف, ولا يأكل ولا يشرب.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود, قال: ثنا محمد بن ربيعة, عن سلمة بن سابور, عن عطية, عن ابن عباس, قال: ( الصمد ): الذي ليس بأجوف .
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد, قال: ( الصمد ): المُصْمَت الذي لا جوف له .
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, مثلَه سواء.
حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: ( الصمد ): المصمت الذي ليس له جوف .
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن ووكيع, قالا ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: ( الصَّمَد ): الذي لا جوف له .
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع; وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران جميعا, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثلَه.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا الربيع بن مسلم, عن الحسن, قال: ( الصمد ): الذي لا جوف له .
قال: ثنا الربيع بن مسلم, عن إبراهيم بن ميسرة, قال: أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير أساله عن ( الصمد ), فقال: الذي لا جوف له .
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا يحيى, قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, قال: ( الصمد ) الذي لا يطعم الطعام .
حدثنا يعقوب, قال: ثنا هشيم, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي أنه قال: ( الصمد ): الذي لا يأكل الطعام, ولا يشرب الشراب .
حدثنا أبو كُرَيب وابن بشار, قالا ثنا وكيع, عن سلمة بن نبيط, عن الضحاك, قال: ( الصمد ): الذي لا جوف له .
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن أبي زائدة, عن إسماعيل, عن عامر, قال: ( الصمد ): الذي لا يأكل الطعام .
حدثنا ابن بشار وزيد بن أخزم, قالا ثنا ابن داود, عن المستقيم بن عبد الملك, عن سعيد بن المسيب قال: ( الصمد ): الذي لا حِشوة له .
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( الصمدُ ): الذي لا جوف له .
حدثني العباس بن أبي طالب, قال: ثنا محمد بن عمر بن رومي, عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش, قال: ثني صالح بن حيان, عن عبد الله بن بريدة, عن أبيه, قال: لا أعلمه إلا قد رفعه, قال: ( الصَّمَد ) الذي لا جوف له .
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا بشر بن المفضل, عن الربيع بن مسلم, قال: سمعت الحسن يقول: ( الصَّمَد ): الذي لا جوف له .
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن عكرمة, قال: ( الصمد ): الذي لا جوف له .
وقال آخرون: هو الذي لا يخرج منه شيء.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن أبي رجاء قال: سمعت عكرمة, قال في قوله: ( الصمد ): الذي لم يخرج منه شيء, ولم يلد, ولم يولد .
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن أبي رجاء محمد بن يوسف, عن عكرمة قال: ( الصمد ): الذي لا يخرج منه شيء .
وقال آخرون: هو الذي لم يَلِد ولم يُولَد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية, قال: ( الصمد ): الذي لم يلد ولم يولد, لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث, ولا شيء يولد إلا سيموت, فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت .
حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قالا ثنا أبو سعيد الصنعاني, قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنـزل الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت, وليس شيء يموت إلا سيورث, وإن الله جلّ ثناؤه لا يموت ولا يورث ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) : ولم يكن لَه شبيه ولا عِدل, وليس كمثله شيء .
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن أبي معشر, عن محمد بن كعب: الصمد: الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد .
وقال آخرون: قد انتهى سُؤدده.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو السائب, قال: ثني أبو معاوية, عن الأعمش, عن شقيق, قال: الصمد: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده.
حدثنا أبو كُرَيب وابن بشار وابن عبد الأعلى, قالوا: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن أبي وائل, قال: ( الصَّمَد ): السيد الذي قد انتهى سؤدده; ولم يقل أبو كُرَيب وابن عبد الأعلى سؤدده.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي وائل مثله.
حدثنا علي, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, في قوله: ( الصَّمَدُ ) يقول: السيد الذي قد كمُل في سُؤدَده, والشريف الذي قد كمل في شرفه, والعظيم الذي قد عظم في عظمته, والحليم الذي قد كمل في حلمه, والغني الذي قد كمل في غناه, والجبَّار الذي قد كمل في جبروته, والعالم الذي قد كمل في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته, وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد, وهو الله سبحانه هذه صفته, لا تنبغي إلا له .
وقال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنَى.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) قال: كان الحسن وقتادة يقولان: الباقي بعد خلقه, قال: هذه سورة خالصة, ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة .
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: ( الصمد ): الدائم .
قال أبو جعفر: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يُصمد إليه, الذي لا أحد فوقه, وكذلك تسمى أشرافها; ومنه قول الشاعر:
ألا بَكَـرَ النَّـاعي بِخَـيْرَيْ بَنِـي أسَدْ
بِعَمْرِو بْـنِ مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدْ (3)
وقال الزبرقان:
وَلا رَهِينَةً إلا سَيِّدٌ صَمَدُ (4)
فإذا كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل الكلمة, المعنى المعروف من كلام من نـزل القرآن بلسانه; ولو كان حديث ابن بُريدة, عن أبيه صحيحا, كان أولى الأقوال بالصحة, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما عنى الله جل ثناؤه, وبما أنـزل عليه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ تقصده وحده كل الخلائق في حاجاتها، هتاف الصبح في قلوب الموحدين.
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ أجمع ما قيل في معناه: أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته.
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ السيد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم، لا يأكل ولا يشرب جل وعز، وهو باقٍ بعد خلقه.
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ هو الذي تصمد إليه الخلائق فتنزل حاجتها به, ومن لطائف هذا: فيه الدلالة عل غنى الله غنى ذايتًا, وفقر المخلوق فقرًا ذاتيًّا, فلا يليق بالله إلا أن يعبد, ولا يليق بالمخلوق إلا العبودية.
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ قال ابن عباس: «الصَّمَدُ: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبّار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه هذه صفته، لا تنبغي إلا له».
وقفة
[2] ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أَى الَّذِي يُصْمَدُ إلَيْهِ في الحَوائِجِ، ويُقْصَدُ إلَيْهِ في الرَّغائِبِ.
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ لست وحدك، لديك سيِّد قد كَمُل في سؤدده، ركنك الشديد، فما تجد نفسك في وحشة ومعك من تركن إليه، من تتكل عليه، من تطمئن وتستأنس بقربه.
وقفة
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ ما لبعض القلوب تتعلق بما سوى الخالق؛ وهي تعلم أن الله هو الصمد؛ الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجها!
عمل
[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ اطلب حوائجك من الله، والجأ إليه قبل أي أحد؛ لأنه الصمد.
وقفة
[2] تحل بك نازلة، تنزل بك حاجة، يصيبك هم أو حزن؛ فإلى من تلجأ؟! اجعل أول ما يخطر ببالك: ﴿الله الصمد﴾ الذي تتوجه إليه الخلائق لقضاء حوائجها.
وقفة
[2] من أعظم دلائل الألوهية: صمود الخلائق إليه عند البَلِيَّة ﴿الله الصَّمَدُ﴾.
وقفة
[2] ﴿الصَّمَدُ﴾ قال ابن الأنباري: «لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم»، وقال الزجاج: «هو الذي ينتهي إليه السؤدد، ويصمد إليه -أي يقصده- كل شيء».
وقفة
[2] ﴿الصَّمَدُ﴾ عن أبي هريرة: «هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد».
وقفة
[2] ﴿الصَّمَدُ﴾ الصمد: أن تستغني بالله عن كل أحد.
الإعراب :
- ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ: ﴾
- لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. الصمد: خبره مرفوع بالضمة. وهو فعل بمعنى مفعول من صمد اليه اذا قصده وهو المقصود أي المصمود اليه في الحوائج. أو الباقي بعد فناء الخلق ويجوز أن يكون «الصمد» صفة للفظ الجلالة والخبر الآية الكريمة الثالثة أي الجملة الفعلية.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن نفى اللهُ عن ذاتِه التعدد؛ نفى عن ذاته النقص والاحتياج، فبَيَّنَ غِنَاه واحتياج جميعِ الخَلقِ إليه، قال تعالى:
﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
أحد الله:
وقرئ:
بحذف التنوين من «أحد» ، لالتقائه مع لام التعريف، وهى قراءة أبان بن عثمان، وزيد بن على، ونصر بن عاصم، وابن سيرين، والحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى عمرو، فى رواية يونس ومحبوب، والأصمعى، واللؤلئى، وعبيد، وهارون.
مدارسة الآية : [3] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾
التفسير :
ومن كماله أنه{ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} لكمال غناه
وقوله- سبحانه-: لَمْ يَلِدْ تنزيه له- تعالى- عن أن يكون له ولد أو بنت، لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه، وذلك يقتضى التركيب المنافى للأحدية والصمدية، أو لأن الولد من جنس أبيه، وهو- تعالى- منزه عن مجانسة أحد.
وقوله: وَلَمْ يُولَدْ تنزيه له- تعالى- عن أن يكون له أب أو أم، لأن المولودية تقتضي- أيضا- التركيب المنافى للأحدية والصمدية، أو لاقتضائها سبق العدم، أو المجانسة، وكل ذلك مستحيل عليه- تعالى- فهو- سبحانه-: الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
وقوله : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة .
وقوله: ( لَمْ يَلِدْ ) يقول: ليس بفانٍ, لأنه لا شيء يلد إلا هو فانٍ بائد
( وَلَمْ يُولَدْ ) يقول: وليس بمحدث لم يكن فكان, لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن, وحدث بعد أن كان غير موجود, ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل, ودائم لم يبد, ولا يزول ولا يفنى.
التدبر :
وقفة
[3] ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ فيها رد على أكثر فرق الضلالة، وعلى رأسهم اليهود الذين يقولون: عزير ابن الله، والنصارى الذين يقولون: المسيح ابن الله، وغيرهم من فرق الضلال.
الإعراب :
- ﴿ لَمْ يَلِدْ: ﴾
- حرف نفي وجزم وقلب. يلد: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والأصل «يولد» فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة.
- ﴿ وَلَمْ يُولَدْ: ﴾
- الواو عاطفة. لم: أعربت. يولد: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وثبتت الواو لأنها واقعة بين ياء وفتحة والجملة الفعلية: في محل رفع خبر ثان للفظ الجلالة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن أثبتَ اللهُ غِنَاه واحتياج جميعِ الخَلقِ إليه؛ نفى عن ذاته: ١- أن يكون له ولد أو بنت. ٢- أن يكون له أب أو أم، قال تعالى:
﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾
التفسير :
{ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى.
فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.
وقوله- عز وجل-: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ تنزيه له- تعالى- عن الشبيه والنظير والمماثل.
والكفؤ: هو المكافئ والمماثل والمشابه لغيره في العمل أو في القدرة.
أى: ولم يكن أحد من خلقه مكافئا ولا مشاكلا ولا مناظرا له- تعالى- في ذاته، أو صفاته، أو أفعاله، فهو كما قال- تعالى-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
وبذلك نرى أن هذه السورة الكريمة قد تضمنت نفى الشرك بجميع ألوانه.
فقد نفى- سبحانه- عن ذاته التعدد بقوله: اللَّهُ أَحَدٌ ونفى عن ذاته النقص والاحتياج بقوله: اللَّهُ الصَّمَدُ، ونفى عن ذاته أن يكون والدا أو مولودا بقوله: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.
كما نراها قد تضمنت الرد على المشركين وأهل الكتاب، وغيرهم من أصحاب الفرق الضالة، الذين يقولون، بالتثليث، وبأن هناك آلهة أخرى تشارك الله- تعالى- في ملكه.
وبغير ذلك من الأقاويل الفاسدة والعقائد الزائفة ... - سبحانه وتعالى- عما يقولون علوا كبيرا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ال مجاهد : ( ولم يكن له كفوا أحد ) يعني : لا صاحبة له .
وهذا كما قال تعالى : ( بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ) [ الأنعام : 101 ] أي : هو مالك كل شيء وخالقه ، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه ، أو قريب يدانيه ، تعالى وتقدس وتنزه . قال الله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [ مريم : 88 - 95 ] وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) [ الأنبياء : 26 ، 27 ] وقال تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ) [ الصافات : 158 ، 159 ] وفي الصحيح - صحيح البخاري - : " لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولدا ، وهو يرزقهم ويعافيهم " .
وقال البخاري : حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " .
ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين .
آخر تفسير سورة " الإخلاص "
وقوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ )
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: ولم يكن له شبيه ولا مِثْل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية قوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) : لم يكن له شبيه, ولا عِدْل, وليس كمثله شيء .
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, عن عمرو بن غيلان الثقفي, وكان أميرَ البصرة (5) عن كعب, قال: إن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع, والأرضين السبع, على هذه السورة ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه .
حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: ليس كمثله شيء, فسبحان الله الواحد القهار .
حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن جريج ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ) : مثل.
وقال آخرون: معنى ذلك, أنه لم يكن له صاحبة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن عبد الملك بن أبجر, عن طلحة, عن مجاهد, قوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: صاحبة .
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا يحيى, عن سفيان, عن ابن أيجر, عن طلحة, عن مجاهد, مثله.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن إدريس, عن عبد الملك, عن طلحة, عن مجاهد, مثله.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبجر, عن رجل عن مجاهد ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: صاحبة .
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن عبد الملك بن أبجر, عن طلحة بن مصرف, عن مجاهد ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: صاحبة .
حدثنا أبو السائب, قال: ثنا ابن إدريس, عن عبد الملك, عن طلحة, عن مجاهد مثله.
والكُفُؤُ والكُفَى والكِفَاء في كلام العرب واحد, وهو المِثْل والشِّبْه; ومنه قول نابغة بني ذُبيان:
لا تَقْــذِفَنِّي بِــرُكْن لا كِفَــاء لَـهُ
وَلَــوْ تَــأَثَّفَكَ الأعْــدَاءُ بـالرِّفَدِ (6)
يعني: لا كِفَاء له: لا مثل له.
واختلف القرّاء في قراءة قوله: (كُفُوا) . فقرأ ذلك عامة قرّاء البصرة: (كُفُوا) بضم الكاف والفاء. وقرأه بعض قرّاء الكوفة بتسكين الفاء وهمزها " كُفْئًا ".
والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان, ولغتان مشهورتان, فبأيَّتِهِما قرأ القارئ فمصيب.
آخر تفسير سورة الإخلاص
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة: «كما أن لا شبيه له في ذاته؛ فلا شبيه له في صفاته».
وقفة
[1] سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ قالوا: لأن علوم القرآن ثلاثة: توحيد، وأحكام، وقصص، وقد اشتملت هذه السورة على تقرير التوحيد تمام التقرير، فهي ثلث القرآن.
وقفة
[1] سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ أي في الجزاء لا الإجزاء؛ تعدل الثلث في الفضل والثواب لكنها لا تُجزئ عن قراءة ثلث القرآن.
وقفة
[1] سورة الإخلاص مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيد، فعُلِمَ أن آيات التوحيد أفضل من غيرها.
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [البخاري 5016]، والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.
عمل
[1] اقرأ المعوذاتِ (الإخلاص والفلق والنَّاس) مرةً واحدةً بعد كل صلاةٍ، وعند النومِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ومع أذكارِ الصَّباحِ والمساءِ ثلاثَ مرَّاتٍ.
عمل
[1] ارق نفسك بالمعوذات.
وقفة
[1] لا تأتي الإستعاذة إلا بعد أن تعظم من استعذت به، ولذلك أتت المعوذتين بعد الإخلاص.
الإعراب :
- ﴿ وَلَمْ يَكُنْ: ﴾
- أعربتا. يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو لالتقاء الساكنين: سكونها وسكون النون والأصل «يكون» فنقلت الضمة الى الكاف لثقلها على الواو.
- ﴿ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بالخبر. كفوا: خبر «يكن» مقدم.أحد: اسم «يكن» مرفوع بالضمة وعلامة نصب خبرها «كفوا» الفتحة المنونة. أي لم يكافئه أحد: أي لم يماثله.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٣- أن يكون له شبيه أو نظير أو مماثل، قال تعالى:
﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
كفوا:
قرئ:
1- بضم الكاف وإسكان الفاء والهمز، وهى قراءة حمزة.
2- بضم الكاف وإسكان الفاء وإبدال الهمزة واوا، وهى قراءة حفص.
3- بضمهما، والهمز، وهى قراءة باقى السبعة.
4- بضمهما وتسهيل الهمزة، وهى قراءة الأعرج، وأبى جعفر، وشيبة، ونافع.
5- كفاء، بكسر الكاف وفتح الفاء والمد، وهى قراءة سليمان بن على بن عبد الله بن عباس.
مدارسة الآية : [1] :الفلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾
التفسير :
أي:{ قل} متعوذًا{ أَعُوذُ} أي:ألجأ وألوذ، وأعتصم{ بِرَبِّ الْفَلَقِ} أي:فالق الحب والنوى، وفالق الإصباح.
تفسير سورة الفلق
مقدمة وتمهيد
1- سورة «الفلق» تسمى- أيضا- سورة «قل أعوذ برب الفلق» وتسمى هي والتي بعدها بالمعوّذتين، وكان نزولهما على الترتيب الموجود في المصحف.
ويرى الحسن وعطاء وعكرمة أنهما مكيتان، ويرى قتادة وجماعة أنهما مدنيتان ...
قال الآلوسى عند تفسيره لهذه السورة: هي مكية في قول الحسن ... ومدنية في رواية عن ابن عباس. وفي قول قتادة وجماعة، وهو الصحيح، لأن سبب نزولها سحر اليهود ... .
وقد سار السيوطي في إتقانه على أنهما مكيتان، وأن نزول سورة الفلق كان بعد نزول سورة «الفيل» وقبل سورة «الناس» ، وأن نزول سورة «الناس» كان بعد سورة «الفلق» وقبل سورة «الصمد» .
2- وعدد آياتها خمس آيات، والغرض الأكبر منها: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعيذ بالله- تعالى- من شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر ربهم ...
والفلق: أصله شق الشيء عن الشيء، وفصل بعض عن بعض، والمراد به هنا:
الصبح، وسمى فلقا لانفلاق الليل وانشقاقه عنه، كما في قوله- تعالى-: فالِقُ الْإِصْباحِ أى: شاقّ ظلمة آخر الليل عن بياض الفجر ...
ويصح أن يكون المراد به، كل ما يفلقه الله- تعالى- من مخلوقات كالأرض التي تنفلق عن النبات، والجبال التي تنفلق عن عيون الماء ...
أى: قل- أيها الرسول الكريم- أعوذ وأستجير وأعتصم، بالله- تعالى- الذي فلق الليل، فانشق عنه الصباح، والذي هو رب جميع الكائنات، ومبدع كل المخلوقات ...
تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان .
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، قال : قلت لأبي بن كعب : إن ابن مسعود [ كان ] لا يكتب المعوذتين في مصحفه ؟ فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام ، قال له : " قل أعوذ برب الفلق " فقلتها ، قال : " قل أعوذ برب الناس " فقلتها . فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده ، عن سفيان بن عيينة ، حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة ، أنهما سمعا زر بن حبيش قال : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين ، فقلت : يا أبا المنذر ، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف . فقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " قيل لي : قل ، فقلت " . فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر قال : سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال : " قيل لي ، فقلت لكم ، فقولوا " . قال أبي : فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول .
وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبدة بن أبي لبابة ، عن زر بن حبيش - وحدثنا عاصم ، عن زر - قال : سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر ، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال : إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " قيل لي ، فقلت " . فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ورواه البخاري أيضا والنسائي ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبدة وعاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب به .
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الأزرق بن علي ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا الصلت بن بهرام ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ، ويقول : إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما ، ولم يكن عبد الله يقرأ بهما
ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ، ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله - قال الأعمش : وحدثنا عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " قيل لي ، فقلت " .
وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء : أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه ، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتواتر عنده ، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة ، فإن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كتبوهما في المصاحف الأئمة ، ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك ، ولله الحمد والمنة .
وقد قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " .
ورواه أحمد ومسلم أيضا ، والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة به . وقال الترمذي : حسن صحيح .
طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا ابن جابر ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن عقبة بن عامر قال : بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب ، إذ قال لي : " يا عقبة ، ألا تركب ؟ " . قال : [ فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه . ثم قال : " يا عقيب ، ألا تركب ؟ " . قال ] فأشفقت أن تكون معصية ، قال : فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة ، ثم ركب ، ثم قال : " يا عقيب ، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ " . قلت : بلى يا رسول الله . فأقرأني : " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " ثم أقيمت الصلاة ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ، ثم مر بي فقال : " كيف رأيت يا عقيب ، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت " .
ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك ، كلاهما عن ابن جابر به .
ورواه أبو داود والنسائي أيضا ، من حديث ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عقبة به .
طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم ، عن يزيد بن محمد القرشي ، عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة .
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق ، عن علي بن أبي رباح . وقال الترمذي : غريب .
طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ بالمعوذتين ، فإنك لن تقرأ بمثلهما " . تفرد به أحمد .
طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا حيوة بن شريح ، حدثنا بقية ، حدثنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء ، فركبها فأخذ عقبة يقودها له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ " قل أعوذ برب الفلق " . فأعادها له حتى قرأها ، فعرف أني لم أفرح بها جدا ، فقال : " لعلك تهاونت بها ؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها " .
ورواه النسائي ، عن عمرو بن عثمان ، عن بقية به . ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين ، فذكر نحوه .
طريق أخرى : قال النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا المعتمر ، سمعت النعمان ، عن زياد أبي الأسد ، عن عقبة بن عامر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " .
طريق أخرى : قال النسائي : أخبرنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عقبة ، قل " . فقلت : ماذا أقول ؟ فسكت عني ، ثم قال : " قل " . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ فسكت عني ، فقلت : اللهم اردده علي . فقال : " يا عقبة ، قل " . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ فقال : " " قل أعوذ برب الفلق " ، فقرأتها حتى أتيت على آخرها ، ثم قال : " قل " . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ قال : " " قل أعوذ برب الناس " ، فقرأتها حتى أتيت على آخرها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " ما سأل سائل بمثلهما ، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما " .
طريق أخرى : قال النسائي : أخبرنا محمد بن يسار ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا معاوية ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح .
طريق أخرى : قال النسائي : أخبرنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي عمران أسلم ، عن عقبة بن عامر قال : اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ، فوضعت يدي على قدمه فقلت : أقرئني سورة هود أو سورة يوسف . فقال : " لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من " قل أعوذ برب الفلق " .
حديث آخر : قال النسائي : أخبرنا محمود بن خالد ، حدثنا الوليد ، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبي عبد الله ، عن ابن عائش الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " يا ابن عائش ، ألا أدلك - أو : ألا أخبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون ؟ " . قال : بلى ، يا رسول الله . قال : " " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " هاتان السورتان " .
فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه ، تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث .
وقد تقدم في رواية صدي بن عجلان وفروة بن مجاهد ، عنه : " ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن ؟ " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا الجريري ، عن أبي العلاء قال : قال رجل : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، والناس يعتقبون ، وفي الظهر قلة ، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي ، فلحقني فضرب [ من بعدي ] منكبي ، فقال : " " قل أعوذ برب الفلق " ، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ، ثم قال : " " قل أعوذ برب الناس " ، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ، فقال : " إذا صليت فاقرأ بهما " .
الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر ، والله أعلم .
ورواه النسائي ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية به .
حديث آخر : قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سعيد ، حدثني يزيد بن رومان ، عن عقبة بن عامر ، عن عبد الله الأسلمي - هو ابن أنيس - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال : " قل " . فلم أدر ما أقول ، ثم قال لي : " قل " . قلت : " قل هو الله أحد " ثم قال لي : " قل " . قلت : " أعوذ برب الفلق من شر ما خلق " حتى فرغت منها ، ثم قال لي : " قل " . قلت : " قل أعوذ برب الناس " حتى فرغت منها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هكذا فتعوذ ، ما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط " .
حديث آخر : قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص ، حدثنا بدل ، حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة ، عن سعيد الجريري ، حدثنا أبو نضرة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ يا جابر " . قلت : وما أقرأ بأبي أنت وأمي ؟ قال : " اقرأ : " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " . فقرأتهما ، فقال : " اقرأ بهما ، ولن تقرأ بمثلهما " .
وتقدم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن ، وينفث في كفيه ، ويمسح بهما رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده .
وقال الإمام مالك : عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح بيده عليه ، رجاء بركتها .
ورواه البخاري ، عن عبد الله بن يوسف . ومسلم ، عن يحيى بن يحيى . وأبو داود ، عن القعنبي . والنسائي ، عن قتيبة - ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر ، ثمانيتهم عن مالك به .
وتقدم في آخر سورة : " ن " من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان ، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما ، وترك ما سواهما . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا حسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : الفلق : الصبح .
وقال العوفي عن ابن عباس : ( الفلق ) الصبح . وروي عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، والحسن ، وقتادة ، ومحمد بن كعب القرظي ، وابن زيد ، ومالك ، عن زيد بن أسلم ، مثل هذا .
قال القرظي وابن زيد وابن جرير : وهي كقوله تعالى : ( فالق الإصباح ) [ الأنعام : 96 ] .
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( الفلق ) الخلق . وكذا قال الضحاك : أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله .
وقال كعب الأحبار : ( الفلق ) بيت في جهنم ، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره ، ورواه ابن أبي حاتم ، ثم قال :
حدثنا أبي ، حدثنا سهيل بن عثمان ، عن رجل سماه ، عن السدي عن زيد بن علي ، عن آبائه أنهم قالوا : ( الفلق ) جب في قعر جهنم ، عليه غطاء ، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم ، من شدة حر ما يخرج منه .
وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر ، فقال ابن جرير :
حدثني إسحاق بن وهب الواسطي ، حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي ، حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني ، عن شعيب بن صفوان ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ( الفلق ) جب في جهنم مغطى " إسناده غريب ولا يصح رفعه .
وقال أبو عبد الرحمن الحبلي : ( الفلق ) من أسماء جهنم .
قال ابن جرير : والصواب القول الأول ، أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار البخاري رحمه الله ، في صحيحه .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، أستجير بربّ الفلق من شرّ ما خلق من الخلق.
واختلف أهل التأويل في معنى ( الفلق ) فقال بعضهم: هو سجن في جهنم يسمى هذا الاسم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني الحسين بن يزيد الطحان، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله، عمن حدثه عن ابن عباس قال: ( الفلق ): سجن في جهنم .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن رجل، عن ابن عباس، في قوله: ( الفَلَقِ ) : سجن في جهنم .
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا العوّام بن عبد الجبار الجولاني، قال: قَدم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشأم، قال: فنظر إلى دور أهل الذمة، وما هم فيه من العيش والنضارة، وما وُسِّع عليهم في دنياهم، قال: فقال: لا أبا لك أليس من ورائهم الفلق؟ قال: قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذ فُتح هَرّ أهْلُ النار .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت السديّ يقول: ( الفَلَق ) : جُب في جهنم .
حدثني عليّ بن حسن الأزدي، قال: ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن السديّ، مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن السديّ، مثله.
حدثني إسحاق بن وهب الواسطيُّ، قال: ثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطيُّ، قال: ثنا نصر بن خُزَيمة الخراساني، عن شعيب بن صفوان، عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " الفَلَق: جبّ في جهنم مغطًّى " .
حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا نافع بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي أسيد عن ابن عجلان، عن أبي عبيد، عن كعب، أنه دخل كنيسة فأعجبه حُسنها، فقال: أحسن عمل وأضلّ قوم، رضيت لكم الفلق، قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فُتح صاح جميع أهل النار من شدّة حرّه .
وقال آخرون: هو اسم من أسماء جهنم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت خيثم بن عبد الله يقول: سألت أبا عبد الرحمن الحبلي، عن ( الفلق ) ، قال: هي جهنم .
وقال آخرون: الفلق: الصبح.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) قال: ( الفلق ): الصبح .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، قال: أنبأنا عوف، عن الحسن، في هذه الآية ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) قال: ( الفلق ): الصبح .
قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبير، قال: ( الفلق ) : الصبح .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع؛ وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران جميعا، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبير، مثله.
حدثني عليّ بن الحسن الأزدي، قال: ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جُبير، مثله.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: ( الفَلَق ): الصبح .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، مثله.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا أبو صخر، عن القُرَظِيّ أنه كان يقول في هذه الآية: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) يقول: فالق الحبّ والنوى، قال: فالق الإصباح .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) قال: الصبح .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) قال: ( الفَلَق ): فَلق النهار .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: ( الفلق ): فلق الصبح .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) قيل له: فلق الصبح؟ قال: نعم، وقرأ: فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا .
وقال آخرون: ( الفلَق ): الخلق، ومعنى الكلام: قل أعوذ بربّ الخلق.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: لنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( الفلق ) : يعني: الخلق .
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جلّ ثناؤه أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقول: ( أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) والفلق في كلام العرب: فلق الصبح، تقول العرب: هو أبين من فَلَق الصُّبح، ومن فرق الصبح. وجائز أن يكون في جهنم سجن &; 24-702 &; اسمه فَلَق. وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن جلّ ثناؤه وضعَ دلالة على أنه عُنِي بقوله: ( بِرَبِّ الْفَلَقِ ) بعض ما يُدْعَى الفلق دون بعض، وكان الله تعالى ذكره ربّ كل ما خلق من شيء، وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفَلَق، إذ كان ربّ جميع ذلك.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا». [أحمد 17360، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1160].
وقفة
[1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. [الترمذي 2058، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عُقْبَة بْنُ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق} فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ». [ابن حبان 1839، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [ابن ماجه 1173، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [البخاري 5017].
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [البخاري 5016]، والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.
وقفة
[1] اشتملت سورتا الفلق والناس على ثلاثة أصول للاستعاذة: 1- نفس الاستعاذة. 2- المستعاذ به. 3- المستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدة الضرورة إلى هاتين السورتين، وأن حاجة العبد إليهما أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس.
عمل
[1] اقرأ المعوذاتِ (الإخلاص والفلق والنَّاس) مرةً واحدةً بعد كل صلاةٍ، وعند النومِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ومع أذكارِ الصَّباحِ والمساءِ ثلاثَ مرَّاتٍ.
عمل
[1] ارق نفسك بالمعوذات.
وقفة
[1] سورة الفلق جاءت في الاستعاذة بالله من الشرور التي هي خارج إرادتنا وقدرتنا، فهذه هي المصائب، وعلمنا في السورتين كيف نستعيذ به عز وجل من هذه الشرور.
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ في الاستعاذة بهذه الصفة تفاؤل، وتذكير بالنور بعد الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفرج بعد الانغلاق، والفلق كل ما يفلقه الله تعالى، كالنبات من الأرض، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك، وكله مما يوحي بالفرج المشرق العجيب.
عمل
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اقرأ سورة الفلق وتفاءل؛ أليس الذي أزاح ظلمة الليل بانفلاق الصباح بقادر على تفريج كربك وتيسير أمرك!
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ والفلق هو: النور الذي يزيل الظلام، ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: 96]، فهذا المطلع القوي يفيد التفاؤل عند مواجهة الأمور العظيمة، كهذه الشرور المذكورة في السورة، كما أنها تضمنت شرورًا تقع غالبًا في الليل، فقابلها بالنور الذي يفلقها ويزيل أثرها كما يزيل الصبح أثر الظلام.
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ حينما يستعيذ المرء بسورة الفلق، يستجلب التفاؤل ويستذكر النور بعد الظلمة والسعة بعد الضيق والفرج بعد الانغلاق.
تفاعل
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ استعذ الآن.
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ما أعظم الاستعاذة بهذه الصفة العظيمة (رب الفلق)! وما تشتمل عليه من قوة وغلبة وسلطان على ظلمات الشرور والسحرة والحاسدين، وتأمل لفظة الفلق وما يقابلها من انغلاق الليل، وانغلاق عقد السحرة، وانغلاق قلوب الحاسدين.
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ قال الرازي: «في سورة الفلق المستعاذ به مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، أما سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث: وهي الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، فما الفرق بين الموضعين؟ أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في سورة الفلق سلامة النفس والبدن، والمطلوب في سورة الناس سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت، أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت».
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ تأمين شامل على الحياة كل صباح ومساء، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: « قُلْ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ». [الترمذي 3575، وحسنه الألباني].
وقفة
[1] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ قال الشاعر عبد الله السعيدي:
ليلٌ ويعْقبُهُ فَلَقْ ... فلِمَ التشاؤمُ والقلَقْ؟!
أُنظر لرحمةِ والِدَيْكَ ... فكيفَ رحْمةُ مَن خلقْ؟!
وقفة
[1] نستعيذ بـ ﴿رب الفلق﴾ من أربع أعداء، ونستعيذ بـ ﴿رب الناس * ملك الناس * اله الناس﴾ [الناس: 1-3] من عدو واحد، هل عرفت من عدوك؟!
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ كثيًا ما نستعيذ من الشرور الخارجية، لكن غالبًا ما نغفل عن الاستعاذة من عدونا الداخلي: أنفسنا الأمارة بالسوء.
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ كثيرون يقرؤونها وهم يستحضرون في أذهانهم شرور غيرهم، بينما الواجب أن يستحضروا التعوذ من شرور أنفسهم ابتداءً، كما في خطلبة الحاجة: «وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا» [أحمد ٤/٢٦٤، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح]، وحديث: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» [الترمذي 3392، وصححه الألباني]؛ فقدم شر نفسه على شر الشيطان.
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ هذا هو التأمين الشامل والذي نفسي بيده، ضد كل شيء.
وقفة
[1، 2] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ هل فكرت يومًا في شر نفسك؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا.
وقفة
[1-2 ] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ هل رأيت شيئًا يبعث الطمأنينة والأمن من الشرور مثل هذا؟ إنك لا تستعيذ من شيء بشيء أعظم ممن خلقه.
الإعراب :
- ﴿ قُلْ أَعُوذُ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة السابقة. أعوذ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا.
- ﴿ بِرَبِّ الْفَلَقِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأعوذ. الفلق: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة أي قل التجيء برب الصبح أو الفجر أو برب الخلق كله. والجملة الفعلية أعوذ وما بعدها في محل نصب مفعول به مقول القول.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالأمرِ بالاستعاذةِ والاحتماءِ باللهِ من شرِّ جميعِ المخلوقاتِ، قال تعالى:
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :الفلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾
التفسير :
{ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} وهذا يشمل جميع ما خلق الله، من إنس، وجن، وحيوانات، فيستعاذ بخالقها، من الشر الذي فيها،
قل أعوذ بهذا الرب العظيم مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ أى: من شر كل ذي شر من المخلوقات، لأنه لا عاصم من شرها إلا خالقها- عز وجل- إذ هو المالك لها، والمتصرف في أمرها، والقابض على ناصيتها، والقادر على تبديل أحوالها، وتغيير شئونها.
وقوله تعالى "من شر ما خلق" أي من شر جميع المخلوقات وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق.
وقال جلّ ثناؤه: ( مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ) لأنه أمر نبيه أن يستعيذ (من شرّ كل شيء)، إذ كان كلّ ما سواه، فهو ما خَلَق.
التدبر :
وقفة
[2] ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ الله أرحم بخلقه: العبد يسعى لتحصيل مراده، ولا يعلم ما به من شر، وربه يعيذه.
وقفة
[2] ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ نم هانئًا لم يعد هناك شيء يقلقك.
وقفة
[2] ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ الله تعالى لا يخلق شرًّا محضًا، كما قال ﷺ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» [مسلم 771]، بل كل ما يخلقه تعالى فهو لحكمة، وإن كان فيه شر لبعض الناس فهو شر جزئي إضافي، وهو باعتبار ما فيه من الحكمة خير.
وقفة
[2] ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ أي: من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسك؛ لأن النفس أمارة بالسوء.
وقفة
[2] ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ كم فيها من الشمول؟! فهي تشمل كل من فيه شر أنس وجن وجماد ... إلخ، بل نفسي يا رب إن كان فيها شر؛ فاحمني منها.
وقفة
[2] الشر لا يضاف إلى الله، بل إما أن يدخل فيه عموم الخلق وخلق كل شيء، أو يضاف إلى السبب: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، أو يحذف فاعله: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْض﴾ [الجن: 10].
وقفة
[2، 3] ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إذَا وَقَبَ﴾ (مِنْ شرِّ) كرَّره أربع مراتٍ، لأن شرَّ كلٍ منهما غير شرِّ البقيةِ عنهاـ فإن قلتَ: أَوَّلُها يشمل البقيَّة، فما فائدةُ إعادتها؟ قلتُ: فائدتُها تعظيم شرِّها، ودفعُ توهم أنه لا شرَّ لها لخفائه فيها.
الإعراب :
- ﴿ مِنْ شَرِّ ما: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأعوذ. ما: اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل جر بالاضافة.
- ﴿ خَلَقَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «خلق» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف المحل لأنه مفعول به التقدير: الذي خلقه أو تكون «ما» مصدرية وجملة «خلق» صلتها لا محل لها من الاعراب و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة التقدير من شر خلقه.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ المُستعاذ به؛ ذكرَ المُستعاذ منه، قال تعالى:
﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
شر ما خلق:
1- بإضافة «شر» إلى «ما» ، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بتنوين «شر» ، وهى قراءة عمرو بن فائد.
مدارسة الآية : [3] :الفلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾
التفسير :
ثم خص بعد ما عم، فقال:{ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ} أي:من شر ما يكون في الليل، حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة، والحيوانات المؤذية.
ثم قال- تعالى-: وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ والغاسق: الليل عند ما يشتد ظلامه، ومنه قوله- تعالى-: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ.... أى: إلى ظلامه.
وقوله: وَقَبَ من الوقوب، وهو الدخول، يقال: وقبت الشمس إذا غابت وتوارت في الأفق. أى: وقل أعوذ به- تعالى- من شر الليل إذا اشتد ظلامه، وأسدل ستاره على كل شيء واختفى تحت جنحه ما كان ظاهرا.
ومن شأن الليل عند ما يكون كذلك، أن يكون مخيفا مرعبا، لأن الإنسان لا يتبين ما استتر تحته من أعداء.
( ومن شر غاسق إذا وقب ) قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب : غروب الشمس . حكاه البخاري عنه . ورواه ابن أبي نجيح ، عنه . وكذا قال ابن عباس ، ومحمد بن كعب القرظي ، والضحاك ، وخصيف ، والحسن ، وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه .
وقال الزهري : ( ومن شر غاسق إذا وقب ) الشمس إذا غربت . وعن عطية وقتادة : إذا وقب الليل : إذا ذهب . وقال أبو المهزم : عن أبي هريرة : ( ومن شر غاسق إذا وقب ) كوكب . وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق : سقوط الثريا ، وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها ، وترتفع عند طلوعها .
قال ابن جرير : ولهؤلاء من الأثر ما حدثني : نصر بن علي ، حدثني بكار بن عبد الله - ابن أخي همام - ، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ( ومن شر غاسق إذا وقب ) قال : النجم الغاسق " .
قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن جرير : وقال آخرون : هو القمر .
قلت : وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد :
حدثنا أبو داود الحفري ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث ، عن أبي سلمة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، فأراني القمر حين يطلع ، وقال : " تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب " .
ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما ، من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به . وقال الترمذي : حسن صحيح . ولفظه : " تعوذي بالله من شر هذا ، فإن هذا الغاسق إذا وقب " . ولفظ النسائي : " تعوذي بالله من شر هذا ، هذا الغاسق إذا وقب " .
قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج - : هذا لا ينافي قولنا ; لأن القمر آية الليل ، ولا يوجد له سلطان إلا فيه ، وكذلك النجوم لا تضيء ، إلا في الليل ، فهو يرجع إلى ما قلناه ، والله أعلم .
وقوله: ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) يقول: ومن شرّ مظلم إذا دخل، وهجم علينا بظلامه.
ثم اختلف أهل التأويل في المظلم الذي عُنِي في هذه الآية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه، فقال بعضهم: هو الليل إذا أظلم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: الليل .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، قال: أنبأنا عوف، عن الحسن، في قوله: ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: أوّل الليل إذا أظلم .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا أبو صخر، عن القرظي أنه كان يقول في: ( غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) يقول: النهار إذا دخل في الليل .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد بن كعب ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: هو غروب الشمس إذا جاء الليل، إذا وقب .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( غَاسِقٍ ) قال: الليل ( إِذَا وَقَبَ ) قال: إذا دخل .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: الليل إذا أقبل .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: إذا جاء .
&; 24-703 &;
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( إِذَا وَقَبَ ) يقول: إذا أقبل. وقال بعضهم: هو النهار إذا دخل في الليل، وقد ذكرناه قبلُ.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد بن كعب القُرَظِيّ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: هو غروب الشمس إذا جاء الليل، إذا وجب .
وقال آخرون: هو كوكب. وكان بعضهم يقول: ذلك الكوكب هو الثُّريا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان بن حِبان، عن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة في قوله: ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: كوكب .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: كانت العرب تقول: الغاسق: سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها .
ولقائلي هذا القول عِلة من أثر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وهو ما حدثنا به نصر بن عليّ، قال: ثنا بكار بن عبد الله بن أخي همام، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: " النجم الغاسق " .
وقال آخرون: بل الغاسق إذا وقب: القمر، ورووا بذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خبرا.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع؛ وحدثنا ابن سفيان، قال: ثنا أبي ويزيد بن هارون، به.
وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم نظر إلى القمر، ثم قال: " يا عائِشَةُ تَعَوَّذِي باللهِ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَا وَقَب، وَهَذَا غاسِقٌ إذَا وَقَبَ"، وهذا لفظ حديث أبي كُرَيب، وابن وكيع. وأما ابن حُمَيد، فإنه قال في حديثه: قالت: أخَذَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال: " أتَدْرِينَ أيَّ شَيءٍ هَذَا؟ تَعَوَّذِي باللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا؛ فإنَّ هَذَا الْغاسِقُ إذَا وَقَبَ" .
حدثنا محمد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر. فقال: " يا عائِشَةُ اسْتَعِيذِي باللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، فإنَّ هَذَا الْغاسِقُ إذَا وَقَبَ" .
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، أن يقال: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ ) وهو الذي يُظْلم، يقال: قد غَسَق الليل يَغُسْق غسوقا: إذا أظلم ( إِذَا وَقَبَ ) يعني: إذا دخل في ظلامه؛ والليل إذا دخل في ظلامه غاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب، ولم يخصص بعض ذلك بل عمّ الأمر بذلك، فكلّ غاسق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يُؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب. وكان يقول في معنى وقب: ذهب.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) قال: إذا ذهب، ولست أعرف ما قال قتادة في ذلك في كلام العرب، بل المعروف من كلامها من معنى وقب: دخل.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ الغاسق هو: المظلم, وأشهر مظلم يغطي الأرض كلها هو: الليل حتي أصبح الغاسق يفسر بالليل, ووقب: أي دخل, ومن فوائد ذلك: الليل إذا دخل تحركت الشرور، حتى الأفكار السيئة تتحرك ليلًا أكثر منها نهارًا, وهذا مستمر حتي مع تطور الحياة المدنية اليوم.
وقفة
[3] ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ أي: الليل إذا دخل، ومن تأمل أنواع الشرور وجد أكثرها في الليل، وفيه انتشار الشياطين، وأهل الغفلة والبطالة، فحريٌّ بالمسلم اغتنامه بالعبادة، وتجنب السهر فيما لا ينفع، وخصوصًا في الأسواق ونحوها.
وقفة
[3] ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ غاسق هو الليل، وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما خلق، وإنما خص الليل؛ لأن أكثر المعاصي تقع في الليل، وأكثر السرقات في الليل، والهوام تخرج في الليل، والشياطين تنتشر في الليل، وهنا معنى لطيف ذكره العلماء: أن السحر أكثر ما يكون تأثيره على الإنسان في الليل.
وقفة
[3] ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ الليل إذا دخل تحركت الشرور، حتى الأفكار السيئة تتحرك ليلًا أكثر منها نهارًا.
وقفة
[3] ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ دخول الليل مظنة انتشار الشياطين والهوام والسراق؛ لاستتارهم بالظلام، فيستعاذ بالله من شره.
الإعراب :
- ﴿ وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ: ﴾
- معطوفة بالواو على «من شر» الأولى وتعرب مثلها. غاسق: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي من شر الليل وقيل: من شر القمر.
- ﴿ إِذا وَقَبَ: ﴾
- ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب بمعنى حين متعلق بفعل أعوذ وهو مضاف الى ما بعده. وقب: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «وقب» في محل جر بالاضافة. أي اذا دخل بظلمته الشديدة على الناس.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد الأمرِ بالاستعاذةِ باللهِ من شرِّ جميعِ المخلوقاتِ؛ خَصَّصَ ثلاثةً بالذِّكرِ لخطرِها، قال تعالى:
﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الفلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾
التفسير :
{ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} أي:ومن شر السواحر، اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد، التي يعقدنها على السحر.
ثم قال- سبحانه-: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ وأصل النفاثات جمع نفّاثة، وهذا اللفظ صيغة مبالغة من النّفث، وهو النفخ مع ريق قليل يخرج من الفم.
والعقد: جمع عقدة من العقد الذي هو ضد الحل، وهي اسم لكل ما ربط وأحكم ربطه.
والمراد بالنفاثات في العقد: النساء السواحر، اللائي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها من أجل السحر.
وجيء بصيغة التأنيث في لفظ «النفاثات» لأن معظم السحرة كن من النساء.
ويصح أن يكون النفاثات صفة للنفوس التي تفعل ذلك، فيكون هذا اللفظ شاملا للذكور والإناث.
وقيل المراد بالنفاثات في العقد: النمامون الذين يسعون بين الناس بالفساد، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ... وعلى ذلك تكون التاء في «النفاثة» للمبالغة كعلامة وفهامة، وليست للتأنيث.
أى: وقل- أيضا- أستجير بالله- تعالى- من شرور السحرة والنمامين، ومن كل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
وقوله : ( ومن شر النفاثات في العقد ) قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك : يعني : السواحر - قال مجاهد : إذا رقين ونفثن في العقد .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين .
وفي الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : " نعم " . فقال : بسم الله أرقيك ، من كل داء يؤذيك ، ومن شر كل حاسد وعين ، الله يشفيك .
ولعل هذا كان من شكواه ، عليه السلام ، حين سحر ، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ، ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رءوسهم ، وجعل تدميرهم في تدبيرهم ، وفضحهم ، ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ، بل كفى الله وشفى وعافى .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم قال : سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما ، قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود سحرك ، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا ، فأرسل إليها من يجيء بها . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عليا رضي الله تعالى عنه ] فاستخرجها ، فجاء بها فحللها قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال ، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه [ قط ] حتى مات .
ورواه النسائي ، عن هناد ، عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير .
وقال البخاري في " كتاب الطب " من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريج ، يقول : حدثني آل عروة ، عن عروة فسألت هشاما عنه ، فحدثنا عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن - قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر ، إذا كان كذا - فقال : " يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا - وقال : وفيم ؟ قال : في مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان " . قالت : فأتى [ النبي صلى الله عليه وسلم ] البئر حتى استخرجه فقال : " هذه البئر التي أريتها ، وكأن ماءها نقاعة الحناء ، وكأن نخلها رءوس الشياطين " . قال : فاستخرج . [ قالت ] . فقلت : أفلا ؟ أي : تنشرت ؟ فقال : " أما الله فقد شفاني ، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا " .
وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان وفيه : " قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله " . وعنده : " فأمر بالبئر فدفنت " . وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد .
وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير . ورواه أحمد عن عفان ، عن وهيب ، عن هشام به .
ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد ، عن رباح ، عن معمر ، عن هشام عن أبيه ، عن عائشة قالت : لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي ، فأتاه ملكان ، فجلس أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم وذكر تمام الحديث .
وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره : قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه ، فأعطاها اليهود فسحروه فيها . وكان الذي تولى ذلك رجل منهم - يقال له : [ لبيد ] بن أعصم - ثم دسها في بئر لبني زريق ، ويقال لها : ذروان ، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه ، ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه . فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما بال الرجل ؟ قال : طب . قال : وما طب ؟ قال : سحر . قال : ومن سحره ؟ قال : لبيد بن أعصم اليهودي . قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟ قال : في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان - والجف : قشر الطلع ، والراعوفة : حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح - فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا ، وقال : " يا عائشة ، أما شعرت أن الله أخبرني بدائي ؟ " . ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر ، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء ، ثم رفعوا الصخرة ، وأخرجوا الجف ، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه ، وإذا فيه وتر معقود ، فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتين ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة ، فقام كأنما نشط من عقال ، وجعل جبريل عليه السلام ، يقول : باسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من حاسد وعين الله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله ، أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أنا فقد شفاني الله ، وأكره أن يثير على الناس شرا " .
هكذا أورده بلا إسناد ، وفيه غرابة ، وفي بعضه نكارة شديدة ، ولبعضه شواهد مما تقدم ، والله أعلم .
وقوله: ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) يقول: ومن شرّ السواحر الّلاتي ينفُثن في عُقَد الخيط، حين يَرْقِين عليها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (7) ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) قال: ما خالط السِّحر من الرُّقَي .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن عوف، عن الحسن ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) قال: السواحر والسَّحرَة .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: تلا قتادة: ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) قال: إياكم وما خالط السِّحر من هذه الرُّقَى .
قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ما من شيء أقرب إلى الشرك من رُقْية المجانين .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان الحسن يقول إذا جاز ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) قال: إياكم وما خالط السحر .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد وعكرِمة ( النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) قال: قال مجاهد: الرُّقَى في عقد الخيط، وقال عكرِمة: الأخذ في عقد الخيط .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) قال: النفاثات: السواحر في العقد.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
وقفة
[4، 5] ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ اقترن الحاسد والساحر في السورة؛ لأن مقصدهما الشر للناس، والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه؛ فلهذا -والله أعلم- قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر هذين نعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن، فالحسد من شياطين الإنس والجن، والسحر من النوعين، وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب، فذكره في سورة الناس.
وقفة
[4، 5] ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ اقتران الحسد بالسحر هنا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد، وأقل ما يكون هو التأثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحر، ومن الحاسد بالحسد، مع الاشتراك في عموم الضرر، فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء، وكلاهما منهيٌّ عنه.
وقفة
[4، 5] أهمية الاستعاذة بالله من خطر العين والسحر ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة- الثالثة-. في العقد: جار ومجرور متعلق بالنفاثات أي بفعل اسم الفاعل أي من شر النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها. و «النفث» النفخ مع ريق.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد الاستعاذة من شَرِّ اللَّيلِ؛ جاءت الاستعاذة من شَرِّ الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عُقَد؛ لأنَّ اللَّيلَ وقْتٌ يَتحيَّنُ فيه السَّحَرةُ إجراءَ شَعوذتِهم؛ لئلَّا يَطَّلِعَ عليهم أحَدٌ، قال تعالى:
﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
النفاثات:
1- بالفتح، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بضم النون، وهى قراءة الحسن.
3- النفاثات، وهى قراءة أبى عمرو، والحسن أيضا، وعبد الله بن القاسم، ويعقوب، فى رواية.
4- النفاثات، بغير ألف، وهى قراءة الحسن أيضا، وأبى الربيع.
مدارسة الآية : [5] :الفلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾
التفسير :
{ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} والحاسد، هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره، وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس، فهذه السورة، تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور، عمومًا وخصوصًا.
ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره، ويستعاذ بالله منه [ومن أهله].
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله: وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ. والحاسد:
هو الإنسان الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره. والحسد: حقيقة واقعة. وأثره لا شك فيه، وإلا لما أمر الله- تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شرور الحاسدين.
قال الآلوسى: وقوله: وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ أى إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر، ومبادي الاضرار بالمحسود قولا وفعلا ... .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد في أحاديث كثيرة منها قوله: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ... » .
ومنها قوله: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب» .
هذا، وقد تكلم العلماء كلاما طويلا عند تفسيرهم لقوله- تعالى-: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ عن السحر، فمنهم من ذهب إلى أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل وتمويه ...
وجمهورهم على إثباته، وأن له آثارا حقيقية، وأن الساحر قد يأتى بأشياء غير عادية، إلا أن الفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله- تعالى- ...
وقد بسطنا القول في هذه المسألة عند تفسيرنا لقوله- تعالى- في سورة البقرة:
وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ، وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ....
نسأل الله- تعالى- أن يعيذنا من شرار خلقه ...
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...
وقوله : ( ومن شر النفاثات في العقد ) قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك : يعني : السواحر - قال مجاهد : إذا رقين ونفثن في العقد .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين .
وفي الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : " نعم " . فقال : بسم الله أرقيك ، من كل داء يؤذيك ، ومن شر كل حاسد وعين ، الله يشفيك .
ولعل هذا كان من شكواه ، عليه السلام ، حين سحر ، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ، ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رءوسهم ، وجعل تدميرهم في تدبيرهم ، وفضحهم ، ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ، بل كفى الله وشفى وعافى .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم قال : سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما ، قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود سحرك ، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا ، فأرسل إليها من يجيء بها . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عليا رضي الله تعالى عنه ] فاستخرجها ، فجاء بها فحللها قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال ، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه [ قط ] حتى مات .
ورواه النسائي ، عن هناد ، عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير .
وقال البخاري في " كتاب الطب " من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريج ، يقول : حدثني آل عروة ، عن عروة فسألت هشاما عنه ، فحدثنا عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن - قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر ، إذا كان كذا - فقال : " يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا - وقال : وفيم ؟ قال : في مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان " . قالت : فأتى [ النبي صلى الله عليه وسلم ] البئر حتى استخرجه فقال : " هذه البئر التي أريتها ، وكأن ماءها نقاعة الحناء ، وكأن نخلها رءوس الشياطين " . قال : فاستخرج . [ قالت ] . فقلت : أفلا ؟ أي : تنشرت ؟ فقال : " أما الله فقد شفاني ، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا " .
وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان وفيه : " قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله " . وعنده : " فأمر بالبئر فدفنت " . وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد .
وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير . ورواه أحمد عن عفان ، عن وهيب ، عن هشام به .
ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد ، عن رباح ، عن معمر ، عن هشام عن أبيه ، عن عائشة قالت : لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي ، فأتاه ملكان ، فجلس أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم وذكر تمام الحديث .
وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره : قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه ، فأعطاها اليهود فسحروه فيها . وكان الذي تولى ذلك رجل منهم - يقال له : [ لبيد ] بن أعصم - ثم دسها في بئر لبني زريق ، ويقال لها : ذروان ، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه ، ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه . فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما بال الرجل ؟ قال : طب . قال : وما طب ؟ قال : سحر . قال : ومن سحره ؟ قال : لبيد بن أعصم اليهودي . قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟ قال : في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان - والجف : قشر الطلع ، والراعوفة : حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح - فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا ، وقال : " يا عائشة ، أما شعرت أن الله أخبرني بدائي ؟ " . ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر ، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء ، ثم رفعوا الصخرة ، وأخرجوا الجف ، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه ، وإذا فيه وتر معقود ، فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتين ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة ، فقام كأنما نشط من عقال ، وجعل جبريل عليه السلام ، يقول : باسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من حاسد وعين الله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله ، أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أنا فقد شفاني الله ، وأكره أن يثير على الناس شرا " .
هكذا أورده بلا إسناد ، وفيه غرابة ، وفي بعضه نكارة شديدة ، ولبعضه شواهد مما تقدم ، والله أعلم .
وقوله: ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شرّ حسده به، فقال بعضهم: ذلك كلّ حاسد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شرّ عينه ونفسه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) قال: من شرّ عينه ونفسه، وعن عطاء الخراساني مثل ذلك. قال معمر: وسمعت ابن طاوس يحدّث عن أبيه، قال: العَينُ حَقٌّ، وَلَو كانَ شَيءٌ سابق القَدرِ، سَبَقَتْهُ العَينُ، وإذا اسْتُغْسِل (8) أحدكم فَلْيَغْتَسِل .
وقال آخرون: بل أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يستعيذ من شرّ اليهود الذين حسدوه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) قال: يهود، لم يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم .
وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول من قال: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شرّ كلّ حاسد إذا حسد، فعابه أو سحره، أو بغاه سوءًا.
وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله عزّ وجلّ لم يخصص من قوله ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) حاسدا دون حاسد، بل عمّ أمره إياه بالاستعاذة من شرّ كلّ حاسد، فذلك على عمومه.
آخر تفسير سورة الفلق
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ العائن حاسد خاص، وهو أضر من الحاسد؛ ولهذا جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولابد، وليس كل حاسد عائنًا، فإذا استعاذ العبد من شر الحسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته.
عمل
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ لا تحسِدْ.
وقفة
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ يدخل في الحاسد: العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس.
وقفة
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ قال الحسين بن الفضل: «إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد؛ ليعلم أنه أخس الطبائع».
وقفة
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ قال معاوية بن أبي سفيان: «كلُّ الناسِ أستطيعُ أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها».
وقفة
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ لا يحسدك إلا من استحكم الشر قلبه.
وقفة
[5] ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ قد لا يخلو قلب إنسان من شيء من الحسد، فهي فطرة بشرية، لكنه لا يضر إلا إذا حسد غيره.
الإعراب :
- ﴿ وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة الثالثة. أي من شر حاسد إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا كان أعظَمُ حاملٍ على السِّحرِ وغَيرِه مِن أذى النَّاسِ: الحسَدَ، مع اشتِراكِهما في التَّأثيرِ الخَفيِّ للحالِ -بإذْنِ الله تعالى-؛ عُطِفَ شَرُّ الحاسدِ على شَرِّ السَّاحرِ، قال تعالى:
﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :الناس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾
التفسير :
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن [لهم] الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي:يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال:{ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} .
تفسير سورة الناس
مقدمة وتمهيد
1- سورة «الناس» كان نزولها بعد سورة «الفلق» ، وتسمى سورة المعوذة الثانية، والسورتان معا تسميان بالمعوذتين، كما سبق أن أشرنا، وعدد آياتها ست آيات ...
أى : قل - أيها الرسول الكريم - أعوذ وألتجئ وأعتصم " برب الناس " أى : بمربيهم ومصلح أمورهم ، وراعى شئونهم . . إذ الرب هو الذى يقوم بتدبير أمر غيره ، وإصلاح حاله . .
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل : الربوبية ، والملك ، والإلهية ؛ فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ، فجميع الأشياء مخلوقة له ، مملوكة عبيد له ، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ، من شر الوسواس الخناس ، وهو الشيطان الموكل بالإنسان ، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ، ولا يألوه جهدا في الخبال . والمعصوم من عصم الله ، وقد ثبت في الصحيح أنه : " ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة " . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، إلا أن الله أعانني عليه ، فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير " وثبت في الصحيح ، عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها ، فلقيه رجلان من الأنصار ، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال رسول الله : " على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي " . فقالا سبحان الله يا رسول الله . فقال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ، أو قال : شرا " .
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن بحر ، حدثنا عدي بن أبي عمارة ، حدثنا زياد النميري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر خنس ، وإن نسي التقم قلبه ، فذلك الوسواس الخناس " غريب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره ، فقلت : تعس الشيطان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقل : تعس الشيطان ; فإنك إذا قلت : تعس الشيطان ، تعاظم ، وقال : بقوتي صرعته ، وإذا قلت : بسم الله ، تصاغر حتى يصير مثل الذباب " .
تفرد به أحمد إسناده جيد قوي ، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب ، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم إذا كان في المسجد ، جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته ، فإذا سكن له زنقه - أو : ألجمه " . قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك ، أما المزنوق فتراه مائلا - كذا - لا يذكر الله ، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل . تفرد به أحمد .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أستجير ( بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ ) وهو ملك جميع الخلق: إنسهم وجنهم، وغير ذلك، إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه، وأن ذلك في مُلكه وسلطانه، تجري عليه قُدرته، وأنه أولى بالتعظيم، وأحقّ بالتعبد له ممن يعظمه، ويُتعبد له، من غيره من الناس.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا. [أحمد 17360، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1160].
وقفة
[1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. [الترمذي 2058، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [ابن ماجه 1173، وصححه الألباني].
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [البخاري 5017].
وقفة
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [البخاري 5016]، والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.
وقفة
[1] اشتملت سورتا الفلق والناس على ثلاثة أصول للاستعاذة: 1- نفس الاستعاذة. 2- المستعاذ به. 3- المستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدة الضرورة إلى هاتين السورتين، وأن حاجة العبد إليهما أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس.
عمل
[1] اقرأ المعوذاتِ (الإخلاص والفلق والنَّاس) مرةً واحدةً بعد كل صلاةٍ، وعند النومِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ومع أذكارِ الصَّباحِ والمساءِ ثلاثَ مرَّاتٍ.
عمل
[1] ارق نفسك بالمعوذات.
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ قال الرازي: «في سورة الفلق المستعاذ به مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، أما سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث: وهي الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، فما الفرق بين الموضعين؟ أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في سورة الفلق سلامة النفس والبدن، والمطلوب في سورة الناس سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت، أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت».
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ تأمين شامل على الحياة كل صباح ومساء، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ». [الترمذي 3575، وحسنه الألباني].
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ من المعلوم أن الله رب جميع الخلائق، وإنما قال رب الناس مع أنه رب جميع مخلوقاته للدلالة على شرفهم؛ ولكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم.
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ لِمَ قال: (أعوذ) دون (أستعيذ)؟ السين والتاء دالة على الطلب، فقوله: أستعيذ بالله، أي أطلب العياذ به، أما من قال: أعوذ بالله، فقد امتثل بالفعل لما طلب منه؛ لأن الله طلب منه الاعتصام والالتجاء إليه، وفرق بين نفس الاعتصام والالتجاء، وبين طلب ذلك. فالأول: مخبر عن حاله وعياذه بربه، وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني: طالب سائل من ربه أن يعيذه، كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني. فحال الأول أكمل.
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ بدأ برب الناس، وقدَّم الربوبية على غيرها لعمومها وشمولها لكل الخلق، وأخر صفة الألوهية لاختصاصها بمن عبده ووحده فحسب.
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ قال القرطبي: «وإنما ذكر أنه رب الناس، وإن كان ربًّا لجميع الخلق لأمرين: أحدهما: لأن الناس معظمون، فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهم، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم».
تفاعل
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ استعذ الآن.
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ تكرار كلمة الناس في آخر سورة في المصحف 5 مرات، هذا كتاب الإنسانية وكتاب الناس أجمعين إلى يوم الدين.
وقفة
[1] ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ [الفلق: 1]، ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ تأمين شامل على حياتك كل صباح ومساء.
وقفة
[1] قوله تعالى: ﴿برب الناس﴾ وهو رب كل شيء، فما وجه تخصيص الناس؟ الجواب: أن المستعاذ منه الوسوسة وهي مخصوصة بالناس، فناسب استغاثتهم لسيدهم، وتسميتهم لذلك.
الإعراب :
- ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة الأولى من سورة «الفلق» وأصل «الناس» الأناس فتركوا الهمزة تخفيفا وأدغموا اللام في النون.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالأمرِ بالاستعاذةِ والاحتماءِ باللهِ، وذلك بصفات ثلاث، وهي: ١- رب النَّاس، قال تعالى:
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :الناس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾
التفسير :
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن [لهم] الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي:يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال:{ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} .
( مَلِكِ الناس ) أى المالك لأمرهم ملكا تاما . والمتصرف فى شئونهم تصرفا كاملا . .
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل : الربوبية ، والملك ، والإلهية ؛ فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ، فجميع الأشياء مخلوقة له ، مملوكة عبيد له ، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ، من شر الوسواس الخناس ، وهو الشيطان الموكل بالإنسان ، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ، ولا يألوه جهدا في الخبال . والمعصوم من عصم الله ، وقد ثبت في الصحيح أنه : " ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة " . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، إلا أن الله أعانني عليه ، فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير " وثبت في الصحيح ، عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها ، فلقيه رجلان من الأنصار ، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال رسول الله : " على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي " . فقالا سبحان الله يا رسول الله . فقال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ، أو قال : شرا " .
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن بحر ، حدثنا عدي بن أبي عمارة ، حدثنا زياد النميري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر خنس ، وإن نسي التقم قلبه ، فذلك الوسواس الخناس " غريب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره ، فقلت : تعس الشيطان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقل : تعس الشيطان ; فإنك إذا قلت : تعس الشيطان ، تعاظم ، وقال : بقوتي صرعته ، وإذا قلت : بسم الله ، تصاغر حتى يصير مثل الذباب " .
تفرد به أحمد إسناده جيد قوي ، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب ، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم إذا كان في المسجد ، جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته ، فإذا سكن له زنقه - أو : ألجمه " . قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك ، أما المزنوق فتراه مائلا - كذا - لا يذكر الله ، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل . تفرد به أحمد .
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أستجير ( بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ ) وهو ملك جميع الخلق: إنسهم وجنهم، وغير ذلك، إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه، وأن ذلك في مُلكه وسلطانه، تجري عليه قُدرته، وأنه أولى بالتعظيم، وأحقّ بالتعبد له ممن يعظمه، ويُتعبد له، من غيره من الناس.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ جرت عادة الناس إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إلي أكابرهم وذوي السطوة فيهم؛ طلبًا للحماية والمعونة, أفلا نتوجه إلي ملك الملوك بطلب العود والملجأ؟!
الإعراب :
- ﴿ مَلِكِ النَّاسِ: ﴾
- بدل من «رب الناس» ويعرب مثله. أو عطف بيان له. أي بين «رب الناس بملك الناس.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- مَلِك النَّاس، قال تعالى:
﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :الناس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴾
التفسير :
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن [لهم] الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي:يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال:{ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} .
إِلهِ النَّاسِ أى: الذي يدين له الناس بالعبودية والخضوع والطاعة لأنه هو وحده الذي خلقهم وأوجدهم في هذه الحياة، وأسبغ عليهم من النعم ما لا يحصى ...
وبدأ- سبحانه- بإضافة الناس إلى ربهم، لأن الربوبية من أوائل نعم الله- تعالى- على عباده، وثنى بذكر المالك، لأنه إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مدركا، وختم بالإضافة إلى الألوهية، لأن الإنسان بعد أن يدرك ويتعلم، يدرك أن المستحق للعبادة هو الله رب العالمين.
قال الجمل: وقد وقع ترتيب هذه الإضافات على الوجه الأكمل، الدال على الوحدانية، لأن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة، علم أن له مربيا، فإذا درج في العروج ...
علم أنه- تعالى- غنى عن الكل، والكل راجع إليه، وعن أمره تجرى أمورهم، فيعلم أنه ملكهم، ثم يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إبداعهم، أنه المستحق للألوهية بلا مشارك فيها ... .
وإنما خصت هذه الصفات بالإضافة إلى الناس- مع أنه- سبحانه- رب كل شيء- على سبيل التشريف لجنس الإنسان، ولأن الناس هم الذين أخطئوا في حقه- تعالى-، إذ منهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد الشمس إلى غير ذلك من المعبودات الباطلة التي هي مخلوقة له- تعالى-.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم قيل: «برب الناس» مضافا إليهم خاصة؟ قلت:
لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس. فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم، الذي يملك عليهم أمورهم، كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم.
فإن قلت: «ملك الناس. إله الناس» ما هما من رب الناس؟ قلت: هما عطفا بيان، كقولك: سيرة أبى حفص عمر الفاروق. بين بملك الناس، ثم زيد بيانا بإله الناس ...
فإن قلت: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة؟ قلت: أظهر المضاف إليه الذي هو الناس لأن عطف البيان للبيان، فكان مظنة للإظهار دون الإضمار ... .
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل : الربوبية ، والملك ، والإلهية ؛ فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ، فجميع الأشياء مخلوقة له ، مملوكة عبيد له ، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ، من شر الوسواس الخناس ، وهو الشيطان الموكل بالإنسان ، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ، ولا يألوه جهدا في الخبال . والمعصوم من عصم الله ، وقد ثبت في الصحيح أنه : " ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة " . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، إلا أن الله أعانني عليه ، فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير " وثبت في الصحيح ، عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها ، فلقيه رجلان من الأنصار ، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال رسول الله : " على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي " . فقالا سبحان الله يا رسول الله . فقال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ، أو قال : شرا " .
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن بحر ، حدثنا عدي بن أبي عمارة ، حدثنا زياد النميري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر خنس ، وإن نسي التقم قلبه ، فذلك الوسواس الخناس " غريب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره ، فقلت : تعس الشيطان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقل : تعس الشيطان ; فإنك إذا قلت : تعس الشيطان ، تعاظم ، وقال : بقوتي صرعته ، وإذا قلت : بسم الله ، تصاغر حتى يصير مثل الذباب " .
تفرد به أحمد إسناده جيد قوي ، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب ، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم إذا كان في المسجد ، جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته ، فإذا سكن له زنقه - أو : ألجمه " . قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك ، أما المزنوق فتراه مائلا - كذا - لا يذكر الله ، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل . تفرد به أحمد .
وقوله: ( إِلَهِ النَّاسِ ) يقول: معبود الناس، الذي له العبادة دون كل شيء سواه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ تكرار كلمة الناس في آخر سورة في المصحف 5 مرات؛ هذا كتاب الإنسانية وكتاب الناس أجمعين إلى يوم الدين.
الإعراب :
- ﴿ إِلهِ النَّاسِ ﴾
- تعرب إعراب الآية السابقة، أي عطف بيان لرب الناس. أي زيد بيانا بإله الناس.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٣- إله النَّاس، قال تعالى:
﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الناس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾
التفسير :
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن [لهم] الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي:يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال:{ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} .
وقوله- سبحانه-: مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ متعلق بقوله أَعُوذُ.
والوسواس: اسم للوسوسة وهي الصوت الخفى، والمصدر الوسواس- بالكسر-، والمراد به هنا: الوصف. من باب إطلاق اسم المصدر على الفاعل، أو هو وصف مثل:
الثرثار.
و «الخناس» صيغة مبالغة من الخنوس، وهو الرجوع والتأخر، والمراد به: الذي يلقى في نفس الإنسان أحاديث السوء.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : ( الوسواس الخناس ) قال : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد وقتادة .
وقال المعتمر بن سليمان ، عن أبيه : ذكر لي أن الشيطان ، أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح ، فإذا ذكر الله خنس .
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : ( الوسواس ) قال : هو الشيطان يأمر ، فإذا أطيع خنس .
وقوله: ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ) يعني: من شرّ الشيطان ( الْخَنَّاسِ ) الذي يخنِس مرّة ويوسوس أخرى، وإنما يخنِس فيما ذُكر عند ذكر العبد ربه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن حكيم بن جُبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما من مولود إلا على قلبه الوَسواس، فإذا عقل فذكر الله خَنَس، وإذا غَفَل وسوس، قال: فذلك قوله: ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن سفيان، عن ابن عباس، في قوله ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس .
قال: ثنا مهران، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) قال: ينبسط فإذا ذكر الله خَنَس وانقبض، فإذا غفل انبسط .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) قال: الشيطان يكون على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خَنَس .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( الْوَسْوَاسِ ) قال: قال هو الشيطان، وهو الخَنَّاس أيضا، إذا ذكر العبد ربه خنس، وهو يوسوس وَيخْنِس .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) يعني: الشيطان، يوسوس في صدر ابن آدم، ويخنس إذا ذُكر الله .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن أبيه، قال: ذُكر لي أن الشيطان، أو قال الوسواس، ينفث في قلب الإنسان عند الحزن وعند الفرح، وإذا ذُكر الله خنس .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( الْخَنَّاسِ ) قال: الخناس الذي يوسوس مرّة، ويخنس مرّة من الجنّ والإنس، وكان يقال: شيطان الإنس أشدّ على الناس من شيطان الجنّ، شيطان الجنّ يوسوس ولا تراه، وهذا يُعاينك معاينة .
ورُوي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول في ذلك ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ) الذي يوسوس بالدعاء إلى طاعته في صدور الناس، حتى يُستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته، فإذا استجيب له إلى ذلك خَنَس.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله ( الْوَسْوَاسِ ) قال: هو الشيطان يأمره، فإذا أطيع خنس .
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شرّ شيطان يوسوس مرّة ويخنس أخرى، ولم يخصَّ وسوسته على نوع من أنواعها، ولا خنوسه على وجه دون وجه، وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله، &; 24-711 &; فإذا أطيع فيها خَنَس، وقد يوسوس بالنَّهْي عن طاعة الله فإذا ذكر العبدُ أمر ربه فأطاعه فيه، وعصى الشيطان خنس، فهو في كلّ حالتيه وَسْواس خَناس، وهذه الصفة صفته.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ إذا غفل الإنسان وسوس، وإذا ذكر الله خنس، فكم نظلم أنفسنا بترك الذكر فندع للشيطان مجالًا للتسلط علينا!
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ هو إبليس إذا ذكرت الله خنس، وإذا تركت الذكر وسوس، الذكر حياة.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة، منها: إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد، فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي، فإن لم يقدر على ذلك ثبَّطه عن الطاعات، فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها، فإن سلم من ذلك أدخل عليه العُجْب بنفسه واستكثار عمله، ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ من دلائل اللفظ: كشف حقيقة الشيطان التي لا يعلمها إلا خالقها وهي: أنه يخنس ويختفي إذا ذكر الله, أن طبيعة الشيطان ظهور ثم اختفاء, فلا هو يريح المؤمن من أذاه, ولا ييأس من الإصابة من المؤمن, أنه ينال من المؤمن حين يغفل عن ذكر الله, فعلى قدر نسيانه للذكر تكون إنالة الشيطان منه.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ قال ابن عباس: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل، فذكر الله خنس، وإذا غفل، وَسَوَسَ، قال: فذلك الوسواس الخنّاس».
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ لا يستهينن أحدكم بوساوس النفس, فكم من وسوسة انتهت بالمرء إلي أبعد الضلال! وذلك يقتضي الاستعاذة منها؛ تحصنًا بالله واعتصامًا به.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ إن من مكائد الشيطان أن يشغلك بالمفضول من العمل عن الفاضل، وأمثلة ذلك كثيرة: منها كمن يشغله بقيام الليل عن صلاة الفجر، أو يشغله بحضور المحاضرات وله والد في حاجته، أو يشغله بأجهزة التقنية بحجة الدعوة إلى الخير ويفوته الكثير من الغنائم في رمضان، ولنفقه أن الأعمال الصالحة ليست كلها بدرجة واحدة، فيها فاضل ومفضول وسيد ومسود، فالأعمال تتفاضل، وقد كان السلف حريصين على معرفة تفاضل الأعمال وحريصون على التفقه فيه.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ لم يذكر الشيطان باسمه؛ بل عرَّفه بوصفه الوظيفي، ومهمته الرئيسة: الوسواس، وثنى بنقطة ضعفه: الخناس، فإذا ذُكِرَ الله خنس.
عمل
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ إذا ذكرت اللهَ خنس الشييطان، وإذا غفلت وسوس؛ فالزم الذكر باللسان والجنان.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الوَسواسِ الخَنّاسِ﴾ اعلم يقيناً أن سبب الوسواس إنما هو غفلة عن ذكر خالقك فنال منك الشيطان وقتها…
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ إن الشيطان لا يمل ولا يسأم من الوسوسة والافساد, فوجب علي العبد ألا يفتر لسانه عن ذكر الله؛ وقاية لنفسه من شروره.
وقفة
[4] ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ قال ابن عباس: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس».
وقفة
[4] أهمية الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان، فهي من أوسع أبواب الشر على الناس ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾.
الإعراب :
- ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأعوذ. الوسواس: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. و «الوسواس» هو ابليس.
- ﴿ الْخَنَّاسِ: ﴾
- صفة- نعت- للوسواس مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. وهو اسم فاعل للمبالغة لأنه يخنس اذا سمع الانسان يذكر ربه أي ينقبض.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ المُستعاذ به؛ ذكرَ المُستعاذ منه، فقال تعالى:
﴿ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :الناس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾
التفسير :
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن [لهم] الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي:يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال:{ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} .
وقوله : ( الذى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس ) صفة لهذا الوسواس الخناس وزيادة توضيح له . .
هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا وقال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم.
وقوله: ( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) يعني بذلك: الشيطان الوسواس، الذي يوسوس في صدور الناس: جنهم وإنسهم.
فإن قال قائل: فالجنّ ناس، فيقال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قيل: قد سماهم الله في هذا الموضع ناسا، كما سماهم في موضع آخر رجالا فقال: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فجعل الجنّ رجالا وكذلك جعل منهم ناسا.
وقد ذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث، إذ جاء قوم من الجنّ فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجنّ، فجعل منهم ناسا، فكذلك ما في التنـزيل من ذلك.
التدبر :
وقفة
[5] ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ علَّق الوسوسة هنا بالصدر، الذي هو موضع القلب، وهو محل العقل والتقوى والصلاح والفساد، فحري بالعبد أن يطهر قلبه، وما تطهرت القلوب بمثل ذكر الله، وتدبر كتابه، والإخلاص له، والتوبة إليه.
وقفة
[5] ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
وقفة
[5] ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ قال ابن تيمية: «فالذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم وشياطين الجن وشياطين الإنس، والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن».
اسقاط
[5] ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ هو يوسوس؛ ليخرجك عن منهج الله الذي أراده لك، فإذا طاوعته فإن تكون قد جلبته لنفسك.
وقفة
[5] ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ الشيطان يحرص علي إغواء الإنسان عن طريق إفساد قلبه أولًا؛ لأن قوة الإنسان في قلبه، فهو مركز الهوي والضلال، وهو محل نظر الله وحسابه.
وقفة
[5] قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾، ولم يقل في (قلوب الناس)، قال العلامة ابن باديس: «والسر في التعبير بـ ﴿يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ بدلًا من (قلوب الناس)؛ لأن القلب مجلى العقل، ومقر الإيمان، وقد يكون محصنًا بالإيمان فلا يستطيع الوسواس أن يَظْهَره، ولا يستطيع له نقبًا».
وقفة
[5، 6] ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ بين الله تعالى نوع الموسوس، بأنهم من الجنة والناس؛ لأن ربما غاب عن الباب أن من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين، وهو وسوسة الناس، وهو أشد خطرًا، وهم بالتعوذ منهم أجدر؛ لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطر، وأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر.
الإعراب :
- ﴿ الَّذِي: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية للوسواس أو في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. أو في محل نصب على الشتم- الذم- أي مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعني.
- ﴿ يُوَسْوِسُ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ فِي صُدُورِ النَّاسِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيوسوس. الناس: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَر صِفةَ المُستعاذِ منه؛ ذكَرَ إبرازَه لصِفتِه بالفِعلِ، فقال تعالى:
﴿ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :الناس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾
التفسير :
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن [لهم] الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي:يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.
فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال:{ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} .
والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.
ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالتبيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته.
ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون.
وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلامًا دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه، على يد جامعه وكاتبه، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلثمائة وألف من هجرة محمدً صلى الله عليه وسلم
تم بحمد الله
لاتنسونا من دعوه بظهر الغيب
وقوله: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ زيادة بيان للذي يوسوس في صدور الناس، وأن الوسوسة بالسوء تأتى من نوعين من المخلوقات: تأتى من الشياطين المعبر عنهم بالجنّة ... وتأتى من الناس.
ثم بينهم فقال : ( من الجنة والناس ) وهذا يقوي القول الثاني . وقيل قوله : ( من الجنة والناس ) تفسير للذي يوسوس في صدور الناس ، من شياطين الإنس والجن ، كما قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) [ الأنعام : 112 ] ، وكما قال الإمام أحمد :
حدثنا وكيع ، حدثنا المسعودي ، حدثنا أبو عمر الدمشقي ، حدثنا عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فجلست ، فقال : " يا أبا ذر ، هل صليت ؟ " . قلت : لا . قال : " قم فصل " . قال : فقمت فصليت ، ثم جلست فقال : " يا أبا ذر ، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " .
قال : قلت : يا رسول الله ، وللإنس شياطين ؟ قال : " نعم " . قال : قلت : يا رسول الله ، الصلاة ؟ قال : " خير موضوع ، من شاء أقل ، ومن شاء أكثر " . قلت : يا رسول الله فما الصوم ؟ قال : " فرض يجزئ ، وعند الله مزيد " . قلت : يا رسول الله ، فالصدقة ؟ قال : " أضعاف مضاعفة " . قلت : يا رسول الله ، أيها أفضل ؟ قال : " جهد من مقل ، أو سر إلى فقير " . قلت : يا رسول الله ، أي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " . قلت : يا رسول الله ، ونبي كان ؟ قال : " نعم ، نبي مكلم " . قلت : يا رسول الله ، كم المرسلون ؟ قال : " ثلثمائة وبضعة عشر ، جما غفيرا " . وقال مرة : " خمسة عشر " . قلت : يا رسول الله ، أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال : " آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم )
ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به . وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه ، بطريق آخر ، ولفظ آخر مطول جدا ، فالله أعلم .
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ذر بن عبد الله الهمداني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به . قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الله أكبر الله أكبر ، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " .
ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور - زاد النسائي ، والأعمش - كلاهما عن ذر به .
آخر التفسير ، ولله الحمد والمنة ، والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . ورضي الله عن الصحابة أجمعين . حسبنا الله ونعم الوكيل .
وكان الفراغ منه في العاشر من جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وثمانين . والحمد له وحده .
وقوله: ( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) يعني بذلك: الشيطان الوسواس، الذي يوسوس في صدور الناس: جنهم وإنسهم.
فإن قال قائل: فالجنّ ناس، فيقال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قيل: قد سماهم الله في هذا الموضع ناسا، كما سماهم في موضع آخر رجالا فقال: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فجعل الجنّ رجالا وكذلك جعل منهم ناسا.
وقد ذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث، إذ جاء قوم من الجنّ فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجنّ، فجعل منهم ناسا، فكذلك ما في التنـزيل من ذلك.
.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس.
وقفة
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ قال قتادة: «إن من الناس شياطين فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن».
وقفة
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ بعضُ النَّاسِ شياطين، يشجِّعون غيرَهم على فعلِ المُنكراتِ ويقُودونهم إلى طريقِ الفسادِ.
وقفة
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ قال الحسن: «هما شيطانان: أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية».
وقفة
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ يتسلط على الإنسان شيطانين: شيطان من الجن: يوسوس ويزين ويلبس، وشيطان من الإنس: يغري ويقنع، ويدلس، والاستعاذة منهما نجاة.
وقفة
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ مواطن تقديم الجن على الإنس: جاء تقديم الجن في القرآن الكريم، وحيث قدم الجن فإن السياق يتحدث عن خصوصية لهم تميزوا بها أكثر من غيرهم، ومنه: ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا ...﴾ [الرحمن: 33]، هذا الأمر الأقرب له الجن للخوارق التي تميزوا بها، فقدمهم القرآن عناية بهم.
عمل
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ من أبناء جنسنا من البشر من هم شر مكانًا ووسوسة من شياطين الجن, ألا فاحذروا رفاق السوء، فإنهم أسُّ البلاء.
عمل
[6] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ قال قتادة: «إن من الجن شياطين, وإن من الإنس شياطين, فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن».
الإعراب :
- ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيوسوس أو «من» حرف جر بياني. والجار والمجرور على هذا متعلق بحال محذوفة من «الناس» التقدير حال كونهم من الجنة. أي من الجن.
- ﴿ وَالنَّاسِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «الجنة» وتعرب اعرابها.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا كان الَّذي يُعَلِّمُ الإنسانَ الشَّرَّ تارةً مِنَ الجِنِّ، وأُخرَى مِنَ الإنسِ؛ قال تعالى مُبَيِّنًا للوَسواسِ؛ تحذيرًا مِن شياطينِ الإنسِ كالتَّحذيرِ مِن شياطينِ الجِنِّ، مُقَدِّمًا الأهَمَّ الأضَرَّ:
﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء