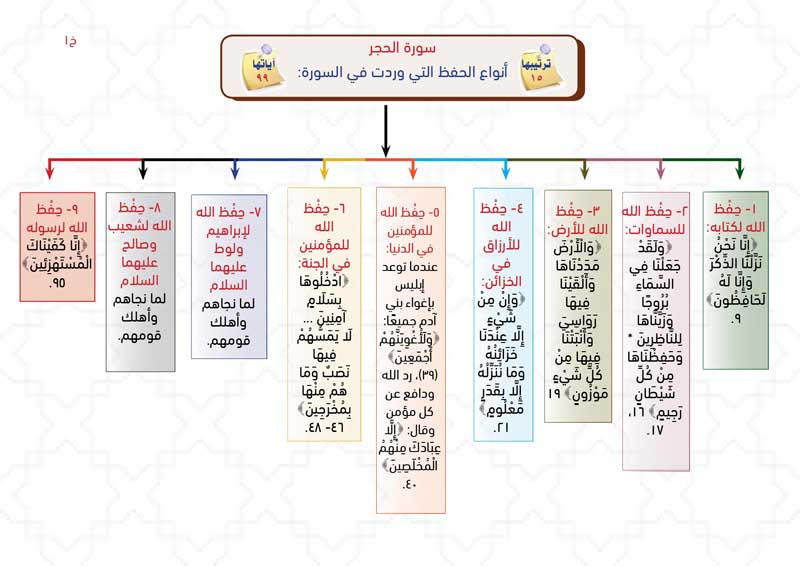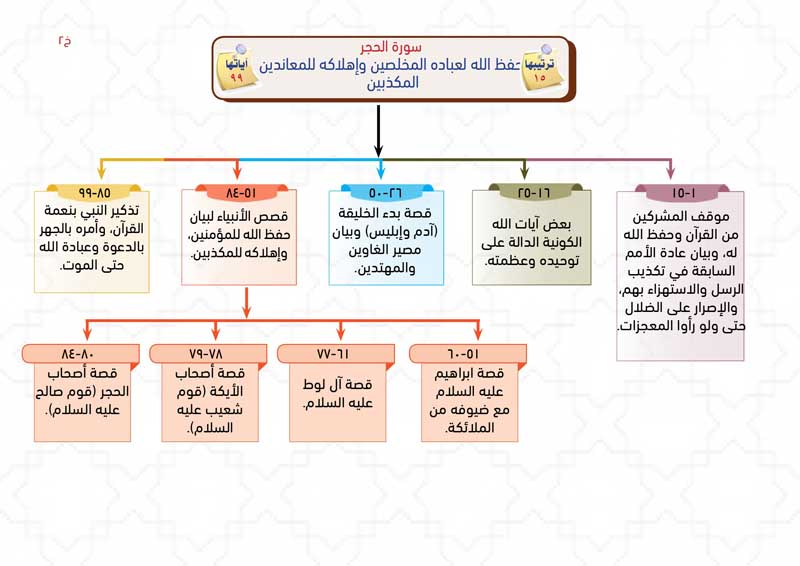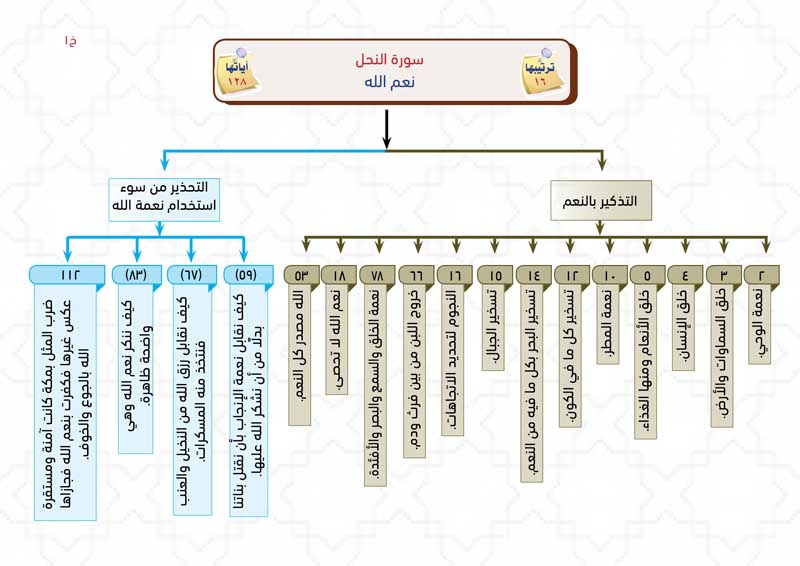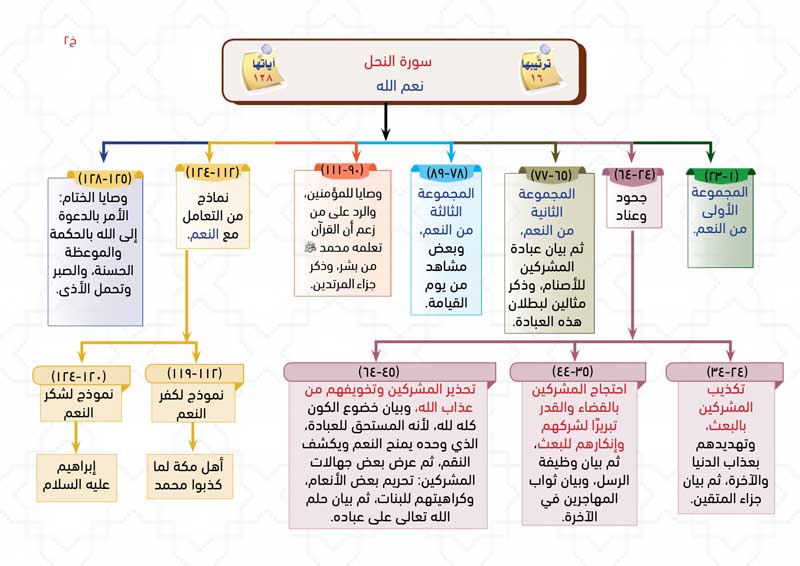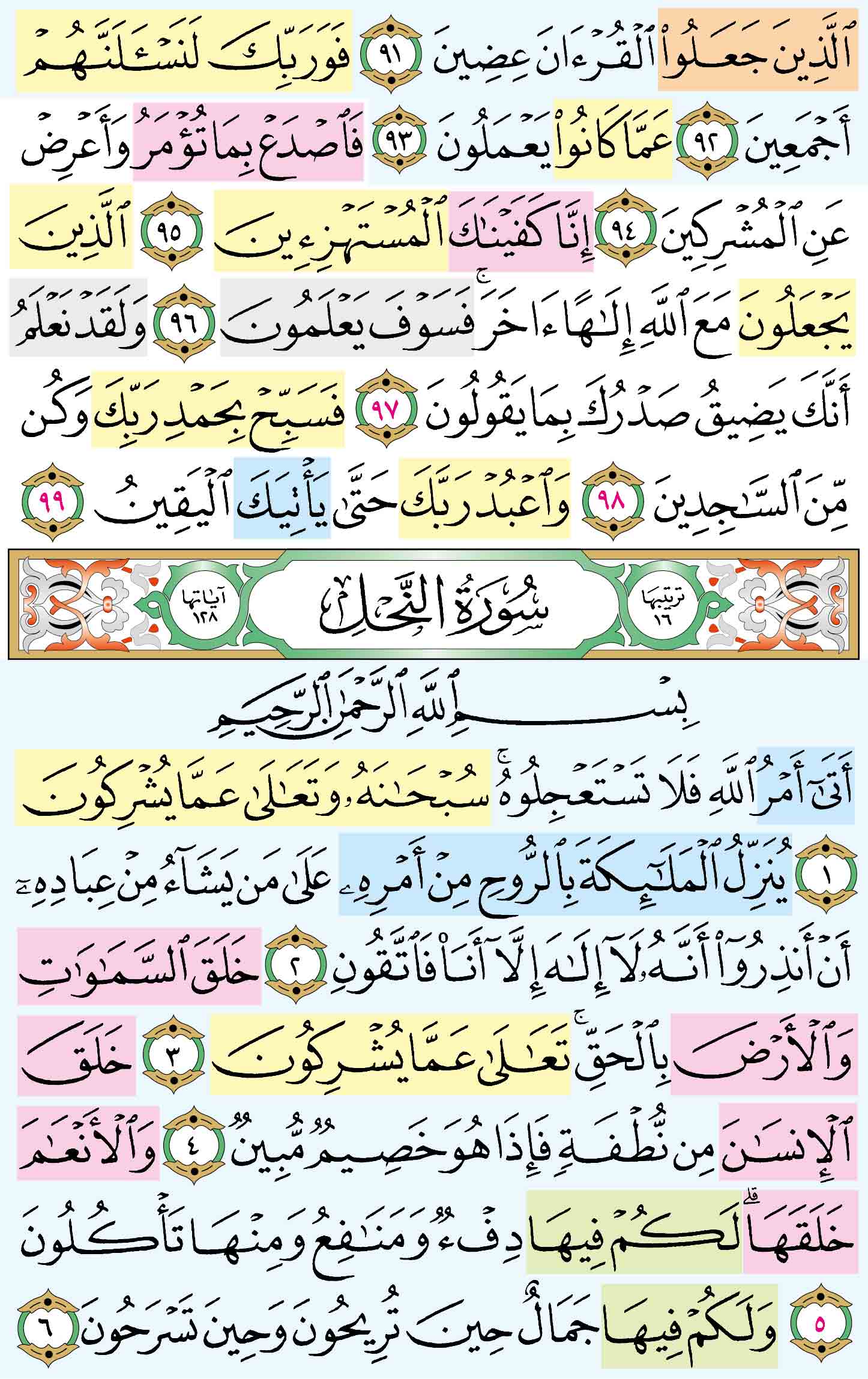
الإحصائيات
سورة الحجر
| ترتيب المصحف | 15 | ترتيب النزول | 54 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.50 |
| عدد الآيات | 99 | عدد الأجزاء | 0.25 |
| عدد الأحزاب | 0.50 | عدد الأرباع | 2.00 |
| ترتيب الطول | 40 | تبدأ في الجزء | 14 |
| تنتهي في الجزء | 14 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 9/29 | آلر: 5/5 | ||
سورة النحل
| ترتيب المصحف | 16 | ترتيب النزول | 70 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 14.50 |
| عدد الآيات | 128 | عدد الأجزاء | 0.75 |
| عدد الأحزاب | 1.50 | عدد الأرباع | 6.00 |
| ترتيب الطول | 9 | تبدأ في الجزء | 14 |
| تنتهي في الجزء | 14 | عدد السجدات | 1 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الجمل الخبرية: 3/21 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (94) الى الآية رقم (99) عدد الآيات (6)
بعدَ بيانِ إكرامِه ﷺ بالفاتِحةِ والقرآنِ وأنَّ مُهمَّتَه إنْذارُ النَّاسِ، أَمَرَه هنا بالجَهْرِ بالدَّعوةِ والتسبيحِ والصَّلاةِ وعبادةِ اللهِ حتَّى الموتِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)
لمَّا هدَّدَ النَّبيُ ﷺ الكفَّارَ بعذابِ الدُّنيا والآخرةِ ولم يَرَوا شيئًا نسَبُوه إلى الكذبِ، فرَدَّ اللهُ هنا بتحقُّقِ نزولِ العذابِ، ثُمَّ ذَكَّرَهم بالأدلَّةِ على وحْدَانيتِهِ تعالى وقدرتِه: خلقِ السماواتِ والأرضِ، وخلقِ الإنسانِ، وخلقِ الأنعامِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الحجر
حفظ الله لعباده المخلصين وإهلاكه للمعاندين المكذبين
أولاً : التمهيد للسورة :
- • اسم السورة: يشير إلى أصحاب الحِجْر (قوم ثمود)، وهم نموذج الطغيان والاستكبار الذين ركنوا إلى حصونهم القوية وقلاعهم الحصينة، وظنوا أن فيها الأمن والأمان والحفظ فلم تغن عنهم شيئًا، فجاءتهم الصيحة لتهلكهم، لنعلم نحن أنَّه لا حافظ إلا الله، وأن الحفظ لا يكون بالوسائل المادية، وإنما بطاعة الله.
- • سورة الحفظ والعناية الربانية:: سورة الحجر سورة بمجرد قرائتها تشعر بالأمان، إنها سورة الحفظ والعناية الربانية، مع كل آية من آياتها تجد قلبك يطمئن على رزقك، على دينك، على قرآنك، فكيف ذلك؟! لأن رسالتها ببساطة: الله هو حافظ هذا الدين وهذا الكتاب وليس البشر فقط، ادع إلى ربك واعبده ولا تلتفت لاستهزاء حاقد أو كاره للدين، احفظ الله يحفظك.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الحِجْرُ».
- • معنى الاسم :: الحِجْرُ: اسم ديار ثمود قوم صالح عليه السلام بوادي القرى بين المدينة والشام.
- • سبب التسمية :: لأن الله ذكر فيها ما حدث لقوم صالح وهم قبيلة ثمود وديارهم بالحِجْر.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: كانت تسمى هذه السورة عند حفاظ أهل تونس بسورة «رُبَمَا»، لأن كلمة (رُبَمَا) لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: حفظ الله لعباده المخلصين وإهلاكه للمعاندين المكذبين.
- • علمتني السورة :: أن حياة المعرضين عن الله في التلذذ بالمأكل، والتمتع بالشهوات، وطول اﻷمل: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾
- • علمتني السورة :: أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾
- • علمتني السورة :: الحجر أن هلاك الأمم مُقَدَّر بتاريخ معين، لا تأخير فيه ولا تقديم: ﴿مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الحجر من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • هي آخر السور الخمس -بحسب ترتيب المصحف- التي افتتحت بحروف التهجي: ﴿الر﴾، وهذه السور هي: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر.
• احتوت سورة الحجر على أطول كلمة في القرآن، وهي: ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (22)، وحروفها 11 حرفًا.
• احتوت سورة الحجر على آية تعتبر الدليل الأصلي والعمدة في حفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (9).
• احتوت سورة الحجر على الموضع الوحيد الذي أقسم الله فيه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (72)، ولم يقسم الله تعالى بحياة غير نبيه صلى الله عليه وسلم.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستشعر بقلوبنا أن الكون كله بيد الله الحافظ العليم، الدين محفوظ، القرآن محفوظ، الرزق محفوظ.
• أن نحمد الله أن هدانا للإسلام، وندعو الله أن يثبّتنا عليه حتى نلقاه: ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (2).
• أن نستعد للآخرة ونتأهب لها، لا أن يكون أكبر همنا: أن نأكل ونشرب ونتمتع: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (3).
• ألا نحزن على قلة أرزاقنا؛ فإن الله أعلم بمصلحتنا منا، فنرضى بما قدره الله لنا: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (21).
• أن نحذر من الكبر؛ فإنه معصية الشيطان: ﴿قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ ...﴾ (32-35).
• ألا يمنعنا من الدعاء ما نعلم من أنفسنا، فإن الله أجاب دعاء شر الخلق: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ *قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (36، 37).
• أن نحدد حيلة غلبنا بها الشيطان؛ ثم نفكر في طريقة التخلص منها: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (39).
• أن نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان، وأن يجعلنا من عباده المخلصين: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (39، 40).
• أن نسامح من ظلمنا، ونعفو عنه لله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (47).
• أن نكون مع الله بين الخوف والرجاء: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (49-50).
• أن نبتدئ بالسلام عند دخولنا المنزل، أو عند إقبالنا على مسلم: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ (52).
• ألا نقنط من رحمة الله تعالى مهما أصابنا في هذه الدنيا: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (56).
• ألا نجعل المعارك الجانبية تستهلك أعمارنا، بل نركز على أهدافنا: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (65).
• أن نعامل إخواننا -وخاصة العمال والخدم- بلطف وبشاشة: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (88).
• أن نستمر في طاعة الله، فلا تتوقف الطاعات بانتهاء المواسم: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (99).
سورة النحل
التعرف على نعم الله وشكره عليها
أولاً : التمهيد للسورة :
- • هي سورة النعم تخاطب قارئها قائلة:: فسورة النحل هي أَكْثَرُ سُورَةٍ نُوِّهَ فِيهَا بِالنِّعَمِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سُورَةٍ تَكَرَّرَتْ فِيهَا مُفْرَدَةُ (نِعْمَة) وَمُشْتَقَّاتُهَا.
- • سورة إبراهيم وسورة النحل:: انظر لنعم الله تعالى في الكون، من النعم الأساسيّة (ضروريّات الحياة) إلى النعم الخفيّة التي يغفل عنها الكثير وينساها، وحتى التي يجهلها، كل أنواع النعم. ثم تعرض السورة النعم وتناديك وتذكرك وتنبهك: المنعم هو الله، احذر من سوء استخدام النعم، اشكر الله عليها ووظفها فيما خلقت له.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «النحل».
- • معنى الاسم :: النحل: حشرة صغيرة تربى للحصول على العسل.
- • سبب التسمية :: قال البعض: لذكر لفظ النحل فيها في الآية (68)، ولم يذكر في سورة أخرى غيرها
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النِّعَم»؛ لكثرة ذكر النعم فيها.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: التفكر في نعم الله الكثيرة علينا.
- • علمتني السورة :: أنّ الوحي قرآنًا وسنة هو الرُّوح الذي تحيا به النفوس: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾
- • علمتني السورة :: أنّ نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ما نعرف منها وما لا نعرف: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (18)، فلو أننا قضينا حياتنا في عدّها ما أحصيناها، فكيف بشكرها؟
- • علمتني السورة :: أن العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين، كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النحل من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.
• عن عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلاَلٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ...﴾».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة النحل احتوت على السجدة الثالثة -بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة في القرآن الكريم، في الآية (49).
• سورة النحل وسورة هود تعتبر من أطول سور المئين، فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطِّوَال.
• سورة النحل تشبه سورة إبراهيم في التركيز على موضوع تعدد نعم الله على عباده، ولكن سورة النحل أكثر تفصيلًا للموضوع لطولها.
• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نقرأ سورة النحل، ثم نتبّع النعم المذكورة فيها، ونكتبها بالقلم في ورقة.
• أن نتفكّر في نعم الله، وفي كيفية توظيف كل هذه النعم في طاعة الله.
• أن نتذكر من فقد أحد هذه النعم، ونحن نردد: (الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة).
• أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام الشاكر لأنعم الله عليه.
• ألا ننسى قول: "الحمد لله" عندما نرتدي ملابسنا الشتوية: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (5).
• أن نتأمل وسائل النقل الحديثة كالسيارات والطائرات، وندرك سعة معاني كلام الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (8).
• أن نحذر السخـرية، أو الاستـهزاء بالدعاة إلى الله، والعلماء المصلحين: ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (34).
• أن نبلِّغ الناس مسألة نافعة اقتداء بالأنبياء، وسيرًا على نهجهم: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (35).
• ألا نحمل أنفسنا ما لا تطيق, علينا النصح فقط, والله أعلم بقلوب عباده ومن يستحق القرب منه: ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ (37).
• ألا تيأس؛ ليس بين الضيق والفرج إلا كلمة (كن) فيكون الفرج ويزول الضيق: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (40).
• أن نتذكر نعمة أنعم الله بها علينا، ثم ننسب الفضل فيها لله وحده: " الحمد لله، الله أنعم علينا بكذا": ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ﴾ (53).
• أن نحسن معاملة بناتنا وأخواتنا، ونظهر البشر لمقدمهن: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (58).
• أن نتفكر -ونحن نشرب اللبن- كيف تدرج اللبن من برسيم في المزرعة إلى مصنع في بطن الحيوان، حتى صار مشروبًا لذيذًا على المائدة، ثم نحمد الله على نعمه: ﴿لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾ (66).
• أن نحذر الحسد؛ فإن الله تعالى هو الذي فاضل بين الناس في أرزاقهم وعقولهم: ﴿وَاللَّـهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (71).
• أن نستخدم ضرب المثل في نصحنا ودعوتنا؛ لتقريب الأمور: ﴿وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا ...﴾ (76).
• أن نتخَيل لو تعطَّلَت إحدَى النِّعَمِ، ثُمَّ نشْكُر اللهَ عليها: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (78).
• أن نشكر نعمة الله علينا بالسكن، ونتصدق بصدقة نساعد بها فقيرًا في دفع إيجار مسكنه: ﴿وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ (80). • أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لنقرأ القرآن بقلب حاضر وبتدبر وتفكر: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (98).
• أن نهتم كثيرًا بتعـلم اللـغة العـربية؛ لأنـها تـوصل إلى فــهم القرآن: ﴿وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (103).
• أن نحرص على اتباع المنهج لا اتباع الأشخاص: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (123).
تمرين حفظ الصفحة : 267
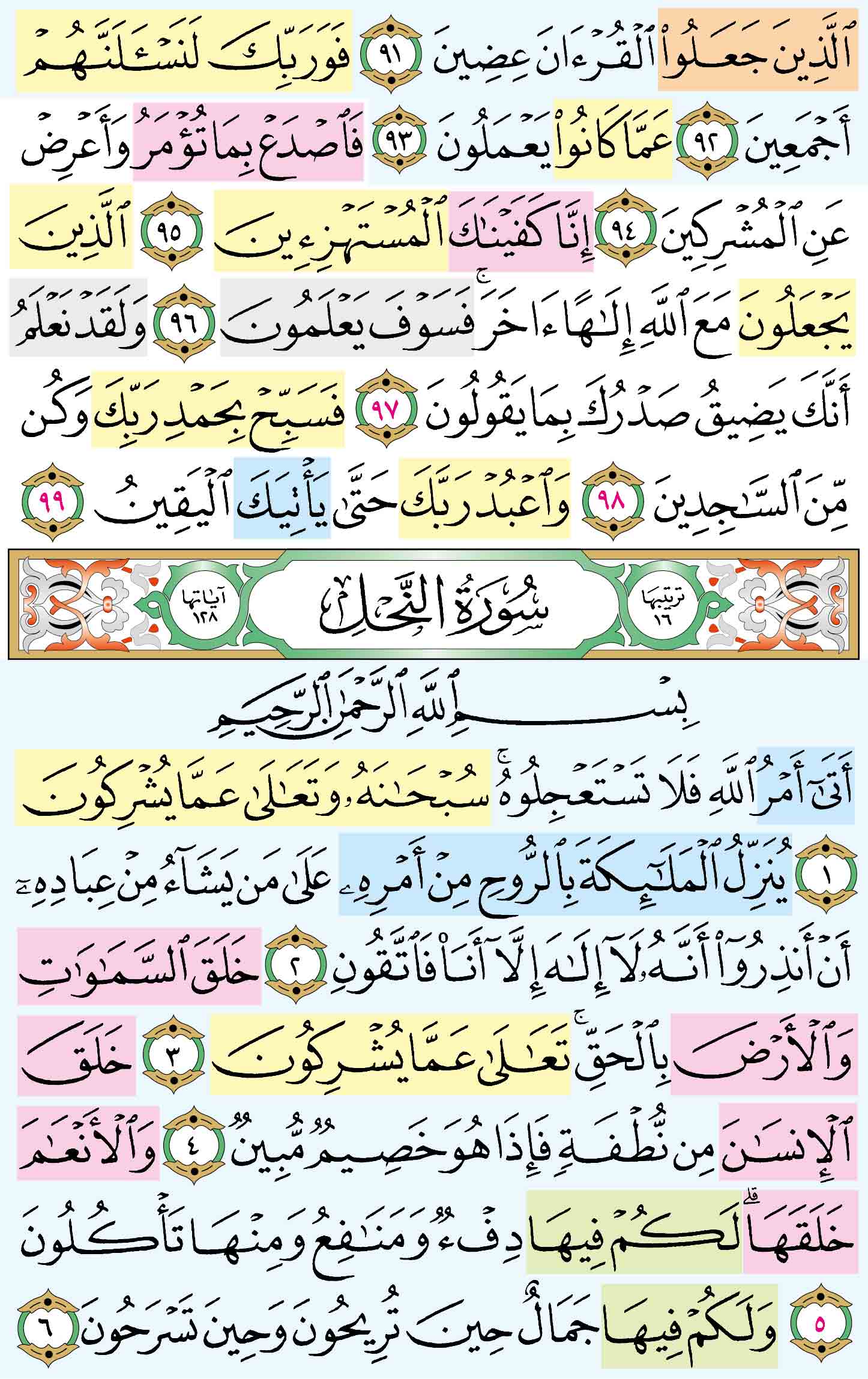
مدارسة الآية : [91] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾
التفسير :
{ الذين جعلوا القرآن عضين} أي:أصنافا وأعضاء وأجزاء، يصرفونه بحسب ما يهوونه، فمنهم من يقول:سحر ومنهم من يقول:كهانة ومنهم من يقول:مفترى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به، الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى.
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ أى قسموه إلى حق وباطل..
وقيل: هو متعلق بقوله- تعالى-: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.. وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة من قريش ... أرسلهم الوليد بن المغيرة، أيام موسم الحج، ليقفوا على مداخل طرق مكة، لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فانقسموا على هاتيك المداخل، يقول بعضهم لا تغتروا بالخارج فإنه ساحر..أى: وقل إنى أنا النذير عذابا مثل العذاب الذي أنزلناه على المقتسمين.
وقيل المراد بالمقتسمين، الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحا- أى يقتلوه ليلا- فأهلكهم الله ...
ثم قال- رحمه الله-: والأقرب من الأقوال المذكورة أن قوله كَما أَنْزَلْنا.. متعلق بقوله- تعالى- وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً ... وأن المراد بالمقتسمين أهل الكتابين، وأن الموصول مع صلته، صفة مبينة لكيفية اقتسامهم ...
والمعنى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إيتاء مماثلا لإنزال الكتابين على أهلهما ... .
ويبدو لنا أن من الأفضل أن يكون المراد بالمقتسمين، ما يشمل أهل الكتابين وغيرهم من المشركين المتحالفين على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم- كما قال ابن كثير- وقد ذهب إلى ذلك الإمام ابن جرير، فقد قال- رحمه الله- بعد سرده للأقوال في ذلك ما ملخصه:
«والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله- تعالى- أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم قومه الذين عضوا القرآن ففرقوه، أنه نذير لهم من سخط الله وعقوبته، أن يحل بهم ما حل بالمقتسمين من قبلهم ومنهم ...
وجائز أن يكون عنى بالمقتسمين: أهل الكتابين.. وجائز أن يكون عنى بذلك: المشركين من قريش، لأنهم اقتسموا القرآن، فسماه بعضهم شعرا، وسماه بعضهم كهانة ...
وجائز أن يكون عنى به الفريقين ... وممكن أن يكون عنى به المقتسمين على صالح من قومه. لأنه ليس في التنزيل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في فطرة العقل، ما يدل على أنه عنى به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين، وإذا فكل من اقتسم كتابا لله بتكذيب بعض وتصديق بعض، كان داخلا في هذا التهديد والوعيد ... .
وقوله : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) أي : جزءوا كتبهم المنزلة عليهم ، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض .
قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم ، أنبأنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( جعلوا القرآن عضين ) قال : هم أهل الكتاب ، جزءوه أجزاء ، فآمنوا ببعضه ، وكفروا ببعضه
حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : ( كما أنزلنا على المقتسمين ) قال : آمنوا ببعض ، وكفروا ببعض : اليهود والنصارى
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك مثل ذلك .
وقال الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( جعلوا القرآن عضين ) قال : السحر . وقال عكرمة : العضه : السحر بلسان قريش ، تقول للساحرة : إنها العاضهة
وقال مجاهد : عضوه أعضاء ، قالوا : سحر ، وقالوا : كهانة ، وقالوا : أساطير الأولين .
وقال عطاء : قال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون . وقال بعضهم كاهن . فذلك العضين ، وكذا روي عن الضحاك وغيره .
وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن سعيد أو عكرمة ، عن ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا شرف فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه بعضا . فقالوا : وأنت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأيا نقول به . قال : بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا : نقول كاهن " . قال : ما هو بكاهن . قالوا : فنقول : " مجنون " . قال : ما هو بمجنون ! قالوا فنقول : " شاعر " . قال : ما هو بشاعر . قالوا : فنقول : " ساحر " . قال : ما هو بساحر . قالوا : فماذا نقول ؟ قال : والله إن لقوله حلاوة ، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول أن تقولوا : هو ساحر . فتفرقوا عنه بذلك ، وأنزل الله فيهم : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) أصنافا
واختلف أهل التأويل في معنى قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) فقال بعضهم: معناه: الذين جعلوا القرآن فِرَقا مفترقة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: فرقا.
حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جزّءوه فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: جزّءوه فجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور.
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا طلحة، عن عطاء ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: المشركون من قريش، عضُّوا القرآن فجعلوه أجزاء، فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: مجنون ، فذلك العِضُون.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: في قوله ( جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) : جعلوا كتابهم أعضاء كأعضاء الجزور، وذلك أنهم تقطعوه زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وهو قوله فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .
حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) عضهوا كتاب الله ، زعم بعضهم أنه سِحْر، وزعم بعضهم أنه شِعْر، وزعم بعضهم أنه كاهن .
قال أبو جعفر: هكذا قال كاهن، وإنما هو كهانة ، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: آمنوا ببعض، وكفروا ببعض.
حدثني يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: جعلوه أعضاء كما تُعَضَّى الشاة. قال بعضهم: كَهانة، وقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: شعر، وقال بعضهم أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا .. الآية ، جعلوه أعضاء كما تُعَضَّى الشاة فوجه قائلو هذه المقالة قوله ( عِضِينَ) إلى أن واحدها: عُضْو، وأن عِضِينَ جمعه، وأنه مأخوذ من قولهم عَضَّيت الشيء تعضية: إذا فرقته، كما قال رؤبة:
وليس دينُ اللَّهِ بالمُعَضَّى (1)
يعني بالمفرّق ، وكما قال الآخر:
وعَضَّـى بَنِـي عَـوْف فأمَّـا عَدُوَّهُمْ
فـأرْضَى وأمَّـا الْعِـزُّ منهُـمُ فغـيَّرا (2)
يعني بقوله: وعَضَّى: سَبَّاهُمْ ، وقَطَّعاهُمْ بألسنتهما (3) . وقال آخرون: بل هي جمع عِضَة، جمعت عِضين ، كما جمعت البُرّة بُرِين، والعِزة عِزِين ، فإذا وُجِّه ذلك إلى هذا التأويل كان أصل الكلام عِضَهَة، ذهبت هاؤها الأصلية، كما نقصوا الهاء من الشَّفَة وأصلها شَفَهَة، ومن الشاة ، وأصلها شاهة ، يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة: شُفَيْهة، والشاة: شُوَيْهة، فيردّون الهاءَ التي تسقط في غير حال التصغير ، إليها في حال التصغير، يقال منه: عَضَهْتُ الرجل أعضَهُه عَضْهًا. إذا بَهَتَّه ، وقذفته ببُهتان ، وكأن تأويل من تأوّل ذلك كذلك: الذين عَضَهوا القرآن، فقالوا: هو سِحْر، أو هو شعر، نحو القول الذي ذكرناه عن قتادة.
وقد قال جماعة من أهل التأويل: إنه إنما عَنَى بالعَضْه في هذا الموضع، نسبتهم إياه إلى أنه سِحْر خاصة دون غيره من معاني الذمّ، كما قال الشاعر:
للماءِ مِنْ عِضَاتهنَّ زَمْزَمهْ (4)
يعني: من سِحْرهنْ.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: سحرا.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (عِضِينَ) قال: عَضَهوه وبَهَتُوه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: كان عكرمة يقول: العَضْه: السحر بلسان قريش، تقول للساحرة: إنها العاضهة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء ، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل ، وحدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: سِحْرا أعضاء الكتب كلها وقريش فرقوا القرآن ، قالوا: هو سحر.
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُعْلِم قوما عَضَهُوا القرآن أنه لهم نذير من عقوبة تنـزل بهم بِعضْهِهِمْ إياه مثل ما أنـزل بالمقتسمين، وكان عَضْهُهُم إياه: قذفهموه بالباطل، وقيلهم إنه شعر وسحر، وما أشبه ذلك.
وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده، وذلك قوله إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ على صحة ما قلنا، وإنه إنما عُنِيَ بقوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) مشركي قومه ، وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه، وإما كافر بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك، فالصحيح من القول في معنى قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) الذين زعموا أنهم عَضَهوه، فقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: هو شعر، وقال بعضهم: هو كهانة ، وما أشبه ذلك من القول، أو عَضَّهُوه ففرقوه، بنحو ذلك من القول ، وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله عِضِين، أن يكون جمع: عِضة، واحتمل أن يكون جمع عُضْو، لأن معنى التعضية: التفريق، كما تُعَضى الجَزُور والشاة، فتفرق أعضاء. والعَضْه: البَهْت ، ورميه بالباطل من القول ، فهما متقاربان في المعنى.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[91] ﴿الَّذِين َجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ قال ابن عباس: «آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهذه تسلية لرسول الله ﷺ عن صنيع قومه بالقرآن، وتكذيبهم له بقولهم: سحر، وشعر، وأساطير، بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب مثل فعل كفار مكة».
الإعراب :
- ﴿ الَّذِينَ: ﴾
- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة-نعت-للمقتسمين. والجملة بعده: صلة الموصول لا محل لها.
- ﴿ جَعَلُوا الْقُرْآنَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. القرآن: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ عِضِينَ: ﴾
- مفعول به ثان منصوب بالياء لأن ملحق بجمع المذكر السالم. وهي جمع «عضة» وأصلها: عضوة على وزن «فعلة» وعن عكرمة: العضة: بمعنى السحر بلغة قريش يقولون للساحر عاضهة ومعنى «عضين هو» أجزاء. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [91] لما قبلها : ولَمَّا أجملَ اللهُ عز وجل المُقْتَسِمِين؛ بَيَّنَهم هنا بأنهم الذين قَسَّموا كتابَ الله، فقالوا عنه: شعر، وقالوا: سحر، وقالوا: كهانة، وقالوا: أساطير الأولين، قال تعالى:
﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [92] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾
التفسير :
تفسير الآيتين 92 و93:ـ
{ فوربك لنسألنهم أجمعين} أي:جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله{ عما كانوا يعملون} وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه
ثم أكد- سبحانه- هذا التهديد والوعيد فقال: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ.
والفاء هنا متفرعة على ما سبق تأكيده في قوله وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ... إذ في هذا اليوم يكون سؤالهم.
والواو للقسم، أى: فوحق ربك- أيها الرسول الكريم- الذي خلقك فسواك فعدلك، لنسألن هؤلاء المكذبين جميعا، سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت، عما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال قبيحة: وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة، ثم لننزلن بهم جميعا العقوبة المناسبة لهم.
فالمقصود من هذه الآية الكريمة زيادة التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد التهديد للمشركين.
" فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون " أولئك النفر الذين قالوا لرسول الله.
وقال عبد الله هو ابن مسعود والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول: ابن آدم ماذا غرك منى بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فوربك يا محمد لنسألنّ هؤلاء الذين جعلوا القرآن في الدنيا عِضين في الآخرة عما كانوا يعملون في الدنيا، فيما أمرناهم به ، وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنـزلته إليهم ، وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان.
.
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا، عن بشير، عن أنس، في قوله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قال: عن شهادة أن لا اله إلا الله.
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن بشير بن نهيك، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قال: " عن لا إله إلا الله ".
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن ليث، عن بشير، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[92] هنا قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، وفي القصص: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: 78]، وفى الرحمن: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 39] كيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب: قيل: في القيامة مواقف عدة، ففي بعضها يسأل، وفى بعضها لا يسأل، وقيل: (لَنَسْأَلَنَّهُمْ) لما عملوا، ولا يسألون ماذا عملوا لأنه أعلم بذلك، وقيل: (لَنَسْأَلَنَّهُمْ) سؤال توبيخ، و(لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ) سؤال استعلام.
وقفة
[92، 93] ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هذا قسم من الله يشيب له الشعر ويرتجف منه الفؤاد.
وقفة
[92، 93] ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ قسمٌ ترتعد له القلوب، وسؤالٌ لا بدّ سيطرح عليك، وبعد الجواب إما نجاة أو هلاك.
وقفة
[92، 93] قال عدة من أهل العلم في قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: عن لا إله إلا الله.
وقفة
[92، 93] قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين، اعلموا أنَّ عندَ الله مسألةً فاضحةً :﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَوَ رَبِّكَ: ﴾
- الفاء: استئنافية. الواو: واو القسم: حرف جر. ربّ: اسم مقسم به مجرور للتعظيم بواو القسم. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة وعلامة جر الاسم الكسرة الظاهرة.
- ﴿ لَنَسْئَلَنَّهُمْ: ﴾
- اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. والجملة بعدها: جواب القسم لا محل لها. نسألن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والثقيلة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.
- ﴿ أَجْمَعِينَ: ﴾
- توكيد للضمير «هم» منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. بمعنى: لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي السؤال تقريع ووعيد لهم. '
المتشابهات :
| الحجر: 92 | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ |
|---|
| مريم: 68 | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [92] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل المراد بالمُقْتَسِمِين؛ هَدَّدَهم هنا وتوعدهم، قال تعالى:
﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [93] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
التفسير :
تفسير الآيتين 92 و93:ـ
{ فوربك لنسألنهم أجمعين} أي:جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله{ عما كانوا يعملون} وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه
عما كانوا يعملونه فى الدنيا من أعمال قبيحة : وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة ، ثم لننزلن بهم جميعًا العقوبة المناسبة لهم .
فالمقصود من هذه الآية الكريمة زيادة التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد التهديد للمشركين .
وقال عطية العوفي ، عن ابن عمر في قوله : ( لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) قال : عن لا إله إلا الله .
وقال عبد الرزاق ، أنبأنا الثوري ، عن ليث - هو ابن أبي سليم - عن مجاهد في قوله : ( لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) قال : عن لا إله إلا الله
وقد روى الترمذي ، وأبو يعلى الموصلي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن بشير بن نهيك ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) [ قال ] عن لا إله إلا الله
ورواه ابن إدريس ، عن ليث ، عن بشير عن أنس موقوفا
وقال ابن جرير : حدثنا أحمد ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا شريك ، عن هلال ، عن عبد الله بن عكيم قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود - : والذي لا إله غيره ، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ، فيقول : ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدم ، ماذا أجبت المرسلين ؟
وقال أبو جعفر : عن الربيع ، عن أبي العالية : قال : يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة ، عما كانوا يعبدون ، وماذا أجابوا المرسلين .
وقال ابن عيينة عن عملك ، وعن مالك .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن أبي الحواري ، حدثنا يونس الحذاء ، عن أبي حمزة الشيباني ، عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معاذ إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه ، حتى كحل عينيه ، وعن فتات الطينة بأصبعيه ، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد أسعد بما آتى الله منك "
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) ثم قال ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) [ الرحمن : 39 ] قال : لا يسألهم : هل عملتم كذا ؛ لأنه أعلم بذلك منهم ، ولكن يقول : لم عملتم كذا وكذا ؟
حدثنا الحسن بن يحيى. قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) قال: عن لا إله إلا الله.
حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن هلال، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما منكم أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ، ماذا غرّك مني بي ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين؟
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) قال: يُسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون، وعما أجابوا المرسلين.
حدثنا المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا الحسين الجعفي، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن عمر: (لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قال: عن لا إله إله الله.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس قوله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) . ثم قال: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم: لِمَ عملتم كذا وكذا؟
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[93] ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ قال ابن عباس: «لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام: هل عملتم كذا وكذا؟ لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ».
الإعراب :
- ﴿ عَمّا كانُوا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بنسأل و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعن. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة وجملة كانُوا يَعْمَلُونَ» صلة الموصول لا محل لها.
- ﴿ يَعْمَلُونَ: ﴾
- الجملة: في محل نصب خبر «كان» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والعائد الى الموصول محذوف وهو منصوب المحل أي يعملونه. '
المتشابهات :
| البقرة: 134 | ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |
|---|
| البقرة: 141 | ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |
|---|
| الحجر: 93 | ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [93] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَهم اللهُ عز وجل بالسؤال؛ بَيَّنَ هنا أنه سوف يسألهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا، قال تعالى:
﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [94] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ .. ﴾
التفسير :
ثم أمر الله رسوله ان لا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين،{ وأعرض عن المشركين} أي:لا تبال بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك
ثم أمر- سبحانه- رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يمضى في طريقه، وأن يجهر بدعوته وأن يعرض عن المشركين، فقد كفاه- سبحانه- شرهم فقال- تعالى-: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
وقوله فَاصْدَعْ.. من الصدع بمعنى الإظهار والإعلان. ومنه قولهم: انصدع الصبح، إذا ظهر بعد ظلام الليل والصديع الفجر لانصداعه أى ظهوره. ويقال: صدع فلان بحجته، إذا تكلم بها جهارا.
أى: فاجهر- أيها الرسول الكريم- بدعوتك، وبلغ ما أمرناك بتبليغه علانية، وأعرض عن سفاهات المشركين وسوء أدبهم.
قال عبد الله بن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا بدعوته حتى نزلت هذه الآية.
فخرج هو وأصحابه،
يقول تعالى آمرا رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به ، وهو مواجهة المشركين به ، كما قال ابن عباس : ( فاصدع بما تؤمر ) أي : أمضه . وفي رواية : افعل ما تؤمر .
وقال مجاهد : هو الجهر بالقرآن في الصلاة .
وقال أبو عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود : ما زال النبي - صلى الله عليه وسلم - مستخفيا ، حتى نزلت : ( فاصدع بما تؤمر ) فخرج هو وأصحابه
وقوله : ( وأعرض عن المشركين)
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس، قال: أنـزل الله تعالى ذكره: ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) فإنه أمر من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالته قومه ، وجميع من أرسل إليه ، ويعني بقوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) : فامض وافرُق، كما قال أبو ذؤَيب:
وكــــأنَّهُنَّ رَبابَـــةٌ وكأنَّـــهُ
يُسـرٌ يُفيـضُ عـلى القِـداح ويَصْدَعُ (5)
يعني بقوله: يَصْدَع : يُفَرِّق بالقداح.
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) يقول: فأمضه.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) يقول: افعل ما تؤمر.
حدثني الحسين بن يزيد الطحان، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن.
حدثني نصر بن عبد الرحمن الأَوْديّ، قال: ثنا يحيى بن إبراهيم، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: هو القرآن.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: الجهر بالقرآن في الصلاة.
حدثنا أحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن في الصلاة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء ، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: اجهر بالقرآن في الصلاة.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال : ثنا أبو أسامة، قال: ثنا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: مازال النبيّ مستخفيا حتى نـزلت ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) فخرج هو وأصحابه.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن الذي يوحى إليه أن يبلغهم إياه ، وقال تعالى ذكره: ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) ولم يقل: بما تؤمر به، والأمر يقتضي الباء ، لأن معنى الكلام: فاصدع بأمرنا، فقد أمرناك أن تدعو إلى ما بعثناك به من الدين خلقي وأذنَّا لك في إظهاره.
ومعنى " ما " التي في قوله ( بِمَا تُؤْمَرُ ) معنى المصدر، كما قال تعالى ذكره يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ معناه: افعل الأمر الذي تؤمر به ، وكان بعض نحويِّي أهل الكوفة يقول في ذلك: حذفت الباء التي يوصل بها تؤمر من قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) على لغة الذين يقولون: أمرتك أمرا ، وكان يقول: للعرب في ذلك لغتان: إحداهما أمرتك أمرا، والأخرى أمرتك بأمر، فكان يقول: إدخال الباء في ذلك وإسقاطها سواء. واستشهد لقوله ذلك بقول حصين بن المنذر الرقاشي ليزيد بن المهلَّب:
أمَــرْتُكَ أمْــرًا جازِمـا فَعَصَيْتَنـي
فـأصْبَحْتَ مَسـلُوبَ الإمـارَةِ نادِمـا (6)
فقال أمرتك أمرا، ولم يقل: أمرتك بأمر، وذلك كما قال تعالى: ذكره: أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ولم يقل: بربهم، وكما قالوا: مددت الزمام، ومددت بالزمام، وما أشبه ذلك من الكلام .
وأما قوله ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) ويقول تعالى ذكره لنبييه صلى الله عليه وسلم: بلغ قومك ما أرسلتَ به، واكفف عن حرب المشركين بالله وقتالهم. وذلك قبل أن يفرض عليه جهادهم، ثم نَسَخَ ذلك بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .
كما حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) وهو من المنسوخ.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) و قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ وهذا النحو كله في القرآن أمر الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك منه، ثم أمره بالقتال، فنَسَخَ ذلك كله، فقال: ( خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ) ...الآية.
التدبر :
عمل
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر﴾ اصدع؛ ﻷنه ليس من أمور اﻹسلام (محرج ومخجل).
وقفة
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ الحقيقة لابد أن تشقق جدرانًا كنت تستظل بها.
وقفة
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ دين بلا أسرار.
وقفة
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ افلق به وجه الظلام، أيقظ به الحياة، مزق به أستار الجاهلية، حطم به جدران الزيف.
وقفة
[94] عندما تختل الموازيين لا يكون قول الحق مُجديًا حتى ترجع الموازين إلى نصابها؛ حينئذٍ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾.
وقفة
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ جاء في تفسير الألوسي أن أعرابيًا لما سمع هذه الآية، سجد وقال: «سجدت لبلاغة هذا الكلام».
وقفة
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أهمية الجهر بالحق وبيانه لاسيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على مصلحة قول الحق.
عمل
[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ شارك مع بعض زملائك أو أحد أقاربك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر.
وقفة
[94] إذا صدع المسلم بأمر ربه على الوجه المشروع، فلن يضره المستهزؤون؛ فلقد تكفل الله بكفايته إياهم، تأمل قول ربك: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.
وقفة
[94 ،95] من ترك الدعوة خشية المنافقين والمستهزئين والمثبطين فقد خالف منهج النبوة ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ فقد كفاك الله شرهم؛ فلا تترك الدعوة لأجلهم.
الإعراب :
- ﴿ فَاصْدَعْ: ﴾
- الفاء: استئنافية. اصدع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أي فاجهر من صدع بالحجة: جهر بها.
- ﴿ بِما تُؤْمَرُ: ﴾
- جار ومجرور متعلق باصدع. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. تؤمر: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. أي: تؤمر به. والجملة: صلة الموصول لا محل لها ويجوز أن تعرب «ما» مصدرية فتكون «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بالباء. التقدير: أو المعنى: بأمرك-على المصدر-من المبني للمجهول. أو بأمرنا. وعلى ذلك تكون الجملة «تؤمر» صلة «ما» المصدرية لا محل لها أما على الوجه الأول فعلى معنى: بما تؤمر به من الشرائع فحذف الجار كقوله: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به.
- ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «اصدع» وتعرب اعرابها. عن المشركين: جار ومجرور متعلق با عرض وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم النون عوض من التنوين والحركة في المفرد. وكسرت نون «عن» لالتقاء الساكنين والمعنى: وأعرض عن اجابتهم. '
المتشابهات :
| الأعراف: 199 | ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ |
|---|
| الأنعام: 106 | ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ |
|---|
| الحجر: 94 | ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [94] لما قبلها : وبعد بيانِ إكرامِه صلى الله عليه وسلم بالفاتِحةِ والقرآنِ، وأنَّ مُهمَّتَه إنْذارُ النَّاسِ؛ أَمَرَه اللهُ عز وجل هنا بالجَهْرِ بالدَّعوةِ والتسبيحِ والصَّلاةِ وعبادةِ اللهِ حتَّى الموتِ، قال تعالى:
﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [95] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾
التفسير :
{ إنا كفيناك المستهزئين} بك وبما جئت به وهذا وعد من الله لرسوله، أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.
وقوله إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ تعليل للأمر بالجهر بالدعوة، بعد أن مكث صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام سرا ثلاث سنين أو أكثر.
وقوله كَفَيْناكَ.. من الكفاية. تقول: كفيت فلانا المؤنة إذا توليتها عنه، ولم تحوجه إليها. وتقول: كفيتك عدوك أى: كفيتك بأسه وشره.
والمراد بالمستهزئين: أكابر المشركين في الكفر والعداوة والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أى: إنا كفيناك الانتقام من المستهزئين بك وبدعوتك، وأرحناك منهم، بإهلاكهم. وذكر بعضهم أن المراد بهم خمسة من كبرائهم، وهم: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطل، والعاص بن وائل: وقد أهلكهم الله جميعا بمكة، وكان هلاكهم العجيب من أهم الصوارف لأتباعهم عن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الرازي: واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين، وفي أسمائهم، وفي كيفية طريق استهزائهم، ولا حاجة إلى شيء منها.
والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورئاسة، لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على إظهار مثل هذه السفاهة، مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو قدره، وعظم منصبه، ودل القرآن على أن الله- تعالى- أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم» .
وقوله : ( وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ) أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك ، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) [ القلم : 9 ] ولا تخفهم ; فإن الله كافيك إياهم ، وحافظك منهم ، كما قال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) [ المائدة : 67 ]
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، حدثنا إسحاق بن إدريس ، حدثنا عون بن كهمس ، عن يزيد بن درهم قال : سمعت أنسا يقول في هذه الآية : ( إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ) قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغمزه بعضهم ، فجاء جبريل أحسبه قال : فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا
وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير - خمسة نفر ، كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم ، من بني أسد بن عبد العزى بن قصي : الأسود بن المطلب أبو زمعة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - قد دعا عليه ؛ لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه [ به ] فقال : اللهم ، أعم بصره ، وأثكله ولده . ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة . ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد . ومن خزاعة : الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستهزاء ، أنزل الله تعالى : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ) إلى قوله : ( فسوف يعلمون )
وقال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، أو غيره من العلماء ، أن جبريل أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف بالبيت ، فقام وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه ، فمر به الأسود [ ابن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء ، فعمي . ومر به الأسود ] بن عبد يغوث ، فأشار إلى بطنه ، فاستسقى بطنه ، فمات منه حبنا . ومر به الوليد بن المغيرة ، فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله - كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره - وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له ، فتعلق سهم من نبله بإزاره ، فخدش رجله ذلك الخدش ، وليس بشيء - فانتقض به فقتله . ومر به العاص بن وائل ، فأشار إلى أخمص قدمه ، فخرج على حمار له يريد الطائف ، فربض على شبرقة فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته . ومر به الحارث بن الطلاطلة ، فأشار إلى رأسه ، فامتخط قيحا ، فقتله
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن رجل ، عن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد بن المغيرة ، وهو الذي جمعهم .
وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق ، عن يزيد ، عن عروة بطوله ، إلا أن سعيدا يقول : الحارث بن غيطلة . وعكرمة يقول : الحارث بن قيس .
قال الزهري : وصدقا ، هو الحارث بن قيس ، وأمه غيطلة .
وكذا روي عن مجاهد ، ومقسم ، وقتادة ، وغير واحد ، أنهم كانوا خمسة .
وقال الشعبي : كانوا سبعة .
والمشهور الأول .
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله، ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك كما كفاك المستهزئين. وكان رؤساء المستهزئين قوما من قريش معروفين.
* ذكر أسمائهم حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثني محمد، قال: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عُروة بن الزُّبير خمسة نَفَر من قومِه، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم ، من بني أسد بن عبد العُزَّى بن قصيّ: الأسود بن المطلب أبو زَمْعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: اللهمّ أعم بصره، وأثكله ولده ، ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة ، ومن بني مخزوم: الوليدُ بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ، ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤيّ: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سَهْم ، ومن خُزاعة: الحارث بن الطُّلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن مَلْكان ، فلما تمادوْا في الشرّ وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنـزل اللَّه تعالى ذكره فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ... إلى قوله ( فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) قال محمد بن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان، عن عُروة بن الزبير أو غيره من العلماء ، أن جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمرّ به الأسود بن المطلب، فرَمى في وجهه بورقة خضراء، فعَمِي ، ومرّ به الأسود بن عبد يغوث، فأشار إلى بطنه فاسْتَسْقَى بطنه ، فمات منه حبنا ، ومرّ به الوليد بن المُغيرة، فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين، وهو يجرّ سِبله، يعني إزاره ، وذلك أنه مرّ برجل من خزاعة يَريش نبلا له، فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فانتقَض به فقتله ، ومرّ به العاص بن وائل السَّهميّ، فأشار إلى أخمص رجله، فخرج على حمار له يريد الطائف ، فوقِصَ على شِبْرِقة، فدخل في أخمص رجله منها شوكة، فقتلته .
قال أبو جعفر : الشِّبرقة: المعروف بالحَسَك، منه حَبَنا (7) والحَبَن: الماء الأصفر ، ومرّ به الحارث بن الطُّلاطلة، فأشار إلى رأسه، فامتخط قيحا فقتله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد القرشيّ، عن رجل، عن ابن عباس، قال : كان رأسهم الوليد بن المُغيرة، وهو الذي جمعهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن زياد، عن سعيد بن جبير، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: كان المستهزئين: الوليدُ بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو زمعة والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن عيطلة. فأتاه جبرئيل، فأومأ بأصبعه إلى رأس الوليد، فقال: ما صنعت شيئا، قال: كُفِيت ، وأومأ بيده إلى أخمص العاص، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما صَنَعْتَ شَيْئا ، فقال: كُفيت ، وأومأ بيده إلى عين أبي زمعة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما صَنَعْتَ شَيْئا، قال: كُفيت. وأومأ بأصبعه إلى رأس الأسود، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: دَعْ لي خالي . فقال: كُفِيت ، وأومأ بأصبعه إلى بطن الحارث، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما صَنَعْتَ شَيْئا ، فقال كُفِيت. قال: فمرّ الوليد على قين لخزاعة وهو يجر ثيابه، فتعلقت بثوبه بروة أو شررة (8) وبين يديه نساء، فجعل يستحي أن يطأ من ينتزعها، وجعلت تضرب ساقه فخدشته، فلم يزل مريضا حتى مات ، وركب العاص بن وائل بغلة له بيضاء إلى حاجة له بأسفل مكة، فذهب ينـزل، فوضع أخمص قدمه على شبرقة ، فحكت رجله، فلم يزل يحكها حتى مات ، وعمي أبو زمعة ، وأخذت الأكلة في رأس الأسود ، وأخذ الحارث الماء في بطنه.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: هم خمسة رهط من قريش: الوليدُ بن المغيرة، والعاصُ بن وائل، وأبو زمعة، والحارث بن عيطلة، والأسود بن قيس.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: الوليد بن المغيرة، والعاصُ بن وائل السَّهْمِيّ، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطلة.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: هم خمسة كلهم هلك قبل بَدْر: العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة بن عبد الأسود، والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن عيطلة.
حدثنا المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بكر الهذلي، قال: قلت للزُّهريّ: إن سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين، فقال سعيد: هو الحارث بن عيطلة، وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس؟ فقال: صدقا، كانت أمه تسمى عيطلة وأبوه قيس.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم ، عن حصين، عن الشعبيّ، قال: المستهزئين سبعة ، وسَمَّى منهم أربعة.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: كانوا من قريش خمسة نفر: العاصُ بن وائل السهمي، كُفِي بصداع أخذه في رأسه، فسال دماغه حتى كان يتكلم من أنفه ، والوليد بن المغيرة المخزومي، كفي برجل من خزاعة أصلح سهما له، فندرت منه شظية، فوطئ عليها فمات ، وهبار بن الأسود، وعبد يغوث بن وهب، والحارث بن عيطلة.
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: كلهم من قريش : العاص بن وائل، فكفي بأنه أصابه صداع في رأسه، فسال دماغه حتى لا يتكلم إلا من تحت أنفه ، والحارث بن عيطلة بصفر في بطنه ، وابن الأسود فكفي بالجدري ، والوليد بأن رجلا ذهب ليصلح سهما له، فوقعت شظية فوطئ عليها ، وعبد يغوث فكفي بالعمى، ذهب بصره.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، وعن مِقْسم ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ) قال: هم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وعديّ بن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، مرّوا رجلا رجلا على النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه جبرئيل، فإذا مرّ به رجل منهم قال جبرئيل: كيف تجد هذا؟ فيقول: بئس عدوّ الله ، فيقول جبرئيل: كفاكه ، فأما الوليد بن المغيرة ، فتردّى، فتعلق سهم بردائه، فذهب يجلس فقطع أكحله فنـزف فمات ، وأما الأسود بن عبد يغوث، فأُتِي بغصن فيه شوك، فضرب به وجهه، فسالت حدقتاه على وجهه، فكان يقول: دعوت على محمد دعوة، ودعا عليّ دعوة، فاستجيب لي، واستجيب له ، دعا عليّ أن أَعمَى فعميت : ودعوت عليه أن يكون وحيدا فريدا في أهل يثرب فكان كذلك ، وأما العاص بن وائل، فوطئ على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك ، وأما الأسود بن المطلب وعديّ بن قيس، فإن أحدهما قام من الليل وهو ظمآن، فشرب ماء من جَرّة، فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه فمات ، وأما الآخر فلدغته حية فمات.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزاق، قال: أخبرنا معمر. عن قتادة وعثمان، عن مِقْسم مولى ابن عباس، في قوله ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ) ثم ذكر نحو حديث ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: كَمَا أَنْـزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ هم رهط خمسة من قريش عضهوا القرآن، زعم بعضهم أنه سحر وزعم بعضهم أنه شعر وزعم بعضهم أنه أساطير الأوّلين: أما أحدهم: فالأسود بن عبد يغوث، أتى على نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وهو عند البيت، فقال له الملَك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ على أنَّهُ خالي ، قال: كفيناك ، ثم أتى عليه الوليد بن المغيرة، فقال له الملَك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كَفيناك ، ثم أتى عليه عدي بن قيس أخو بني سهم، فقال الملك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كفيناك ، ثم أتى عليه الأسود بن المطلب، فقال له الملك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كفيناك ، ثم أتى عليه العاص بن وائل، فقال له الملك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كفيناك ، فأما الأسود بن عبد يغوث، فأُتي بغصن من شوك فضرب به وجهه حتى سالت حدقتاه على وجهه، فكان بعد ذلك يقول: دعا عليّ محمد بدعوة ودعوت عليه بأخرى، فاستجاب الله له في واستجاب الله لي فيه ، دعا عليّ أن أثكل وأن أعمى، فكان كذلك ، ودعوت عليه أن يصير شريدا طريدا، فطردناه مع يهود يثرب وسرّاق الحجيج، وكان كذلك ، وأما الوليد بن المغيرة، فذهب يرتدي، فتعلق بردائه سهم غرب (9) فأصاب أكحله أو أبجله، فأتي في كلّ ذلك، فمات ، وأما العاص بن وائل، فوطئ على شوكة، فأتي في ذلك، جعل يتساقط لحمه عضوا عضوا فمات وهو كذلك ، وأما الأسود بن المطلب وعديّ بن قيس، فلا أدري ما أصابهما.
ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، نهى أصحابه عن قتل أبي البختري، وقال: خذوه أخذا، فإنه قد كان له بلاء ، فقال له أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: يا أبا البختري إنا قد نهينا عن قتلك فهلمّ إلى الأمنة والأمان ، فقال أبو البختري: وابن أخي معي؟ فقالوا: لم نؤمر إلا بك ، فراودوه ثلاث مرّات، فأبى إلا وابن أخيه معه، قال: فأغلظ للنبيّ صلى الله عليه وسلم الكلام، فحمل عليه رجل من القوم فطعنه فقتله، فجاء قاتله وكأنما على ظهره جبل أوثقه مخافة أن يلومه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبر بقوله: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أبْعَدَهُ اللَّهُ وأسْحَقَهُ ، وهم المستهزِئُونَ الذين قال الله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) وهم الخمسة الذين قيل فيهم (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) استهزءوا بكتاب الله، ونبيه صلى الله عليه وسلم.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفة، قال : ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) هم من قريش.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، وزعم ابن أبي بَزَّة أنهم العاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة الوحيد، والحارث بن عديّ بن سهم بن العيطلة، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصيّ، وهو أبو زمعة، والأسود بن عبد يغوث وهو ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن عباس، نحو حديث محمد بن عبد الأعلى ، عن محمد بن ثور، غير أنه قال: كانوا ثمانية ، ثم عدّهم وقال: كلهم مات قبل بدر.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله لرسوله، ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ﷺ وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ وفي وصفهم بالشرك تسلية لرسول الله ﷺ، وتهوين للخطب عليه ﷺ, بالإشارة إلى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به ﷺ، بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه.
لمسة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ لم يقل: (سنكفيك) بل جاءت بصيغة الماضي؛ لزيادة توكيدها، فهو مكفي حتمًا بالله وحده.
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ عناية الله ورعايته بصَوْن النبي ﷺ وحمايته من أذى المشركين.
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ فدفاع الرب سبحانه عن نبيه يكفيه عن دفاعنا، ولكن احرص على أن تكون ممن يستعملهم الله للدفاع عن نبيه.
وقفة
[95] من سنة الله فيمن يؤذي رسوله ﷺ أنه إن لم يجاز بيد الخلق، فإن الله ينتقم منه ويكفيه إياه، والتاريخ شاهد، فتدبر: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾.
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ هل جربت أن تقف عند ضمائر الجلال الإلهي: (كَفَيْنَاكَ، أَعْطَيْنَاكَ، إِنَّا، نَحْنُ ...) تلك الضمائر الباهرة التي لا تكاد تخلو منها آية تعود إلى رب العزة.
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ مزَّق كِسرى رسالة النبي ﷺ فمزّق الله مُلكه!
وقفة
[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ذكر ابن القيم في كتاب (الصارم المسلول): أن المسلمين كانوا يحاصرون الحصن أو المدينة الشهر وهو ممتنع عليهم حتی كادوا ييأسون، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله ﷺ والوقيعة في عرضه، تعجل فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر.
وقفة
[95] من رب العالمين إلى الصادق الأمين ﷺ: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنّا كَفَيْناكَ: ﴾
- انّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «إنّ».كفي: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» في محل رفع خبر «انّ».
- ﴿ الْمُسْتَهْزِئِينَ: ﴾
- مفعول به ثان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. أي كفيناك المستهزئين بإهلاكهم. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [95] لما قبلها : ولَمَّا كان الصَّدعُ في غايةِ الشِّدَّةِ عليه صلى الله عليه وسلم لكثرةِ ما يَلقَى مِن الأذَى؛ خَفَّف اللهُ عز وجل عنه هنا، فقال تعالى:
﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [96] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـهًا .. ﴾
التفسير :
ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله، فإنهم أيضا يؤذون الله ويجعلون معه{ إلها آخر} وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم{ فسوف يعلمون} غب أفعالهم إذا وردوا القيامة
ثم بين- سبحانه- أن هؤلاء المستهزئين قد أضافوا إلى ذلك الشرك والكفر فقال:
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ في عباداتهم وفي عقيدتهم.
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ما يترتب على ذلك في الآخرة من عذاب شديد لهم، بعد أن أهلكناهم في الدنيا وقطعنا دابرهم.
وقوله : ( الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ) تهديد شديد ، ووعيد أكيد ، لمن جعل مع الله معبودا آخر .
وقوله ( الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ) وعيد من الله تعالى ذكره، وتهديد للمستهزئين الذين أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد كفاه أمرهم بقوله تعالى ذكره: إنا كفيناك يا محمد الساخرين منك، الجاعلين مع الله شريكا في عبادته، فسوف يعلمون ما يلقون من عذاب الله عند مصيرهم إليه في القيامة، وما يَحُلّ بهم من البلاء.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[96] ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أشد تهديد ما أخفى الله فيه نوع الوعيد! فهذا تهديد شديد لمن جعل مع الله معبودًا آخر.
الإعراب :
- ﴿ الَّذِينَ: ﴾
- اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة-نعت- للمستهزئين. ويجوز أن يكون في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين. والوجه الأول من الإعراب أوجه وأصوب والجملة بعده: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ: ﴾
- أي يتخذون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. مع: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيجعلون وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.
- ﴿ إِلهاً آخَرَ: ﴾
- مفعول به منصوب بالفتحة. آخر: صفة-نعت-لإلها منصوب مثله بالفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف-التنوين-على وزن «أفعل».
- ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: ﴾
- بمعنى: فسوف يعلمون أنهم كانوا ضالين. الفاء: استئنافية أو سببية. ويجوز أن تكون واقعة في جواب شرط جزاء-مقدر. سوف: حرف استقبال-تسويف-للمستقبل. يعلمون: تعرب اعراب «يجعلون» وحذف مفعول «يعلمون» اختصارا. '
المتشابهات :
| الفرقان: 42 | ﴿لَوۡلَآ أَن صَبَرۡنَا عَلَيۡهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ مَنۡ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ |
|---|
| الحجر: 3 | ﴿ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |
|---|
| الحجر: 96 | ﴿ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |
|---|
| العنكبوت: 66 | ﴿لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |
|---|
| الصافات: 170 | ﴿فَكَفَرُواْ بِهِۦۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |
|---|
| غافر: 70 | ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلۡكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرۡسَلۡنَا بِهِۦ رُسُلَنَاۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |
|---|
| الزخرف: 89 | ﴿فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [96] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل لنبيِّه صلى الله عليه وسلم أنه كفاه كيد المستهزئين؛ وصف هؤلاء المستهزئين هنا بالشرك، ثم توعدهم على ما كانوا يصنعون، قال تعالى:
﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [97] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ .. ﴾
التفسير :
{ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون} لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب، والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم.
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بتسلية أخرى له صلى الله عليه وسلم، وبإرشاده إلى ما يزيل همه. ويشرح صدره، فقال- تعالى-: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
وضيق الصدر: كناية عن كدر النفس، وتعرضها للهموم والأحزان.
أى: ولقد نعلم- أيها الرسول الكريم- أن أقوال المشركين الباطلة فيك وفيما جئت به من عندنا، تحزن نفسك، وتكدر خاطرك.
وقال- سبحانه- وَلَقَدْ نَعْلَمُ.. بلام القسم وحرف التحقيق، لتأكيد الخبر، وإظهار مزيد الاهتمام والعناية بالمخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الحال والاستقبال.
وقوله : ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ) أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر ، فلا يهيدنك ذلك ، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله ، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم ، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ; ولهذا قال : ( وكن من الساجدين ) كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد :
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " قال الله : يا ابن آدم ، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره . .
ورواه أبو داود من حديث مكحول ، عن كثير بن مرة ، بنحوه
ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر صلى .
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بما يقول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك وبما جئتهم به، وأن ذلك يُحْرِجك .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[97] يحزن على فوات مرغوب وحُق له، أرأيت هذا الحزن؟ وهذا الهم؟ فإنه في ذاته تكفير للخطايا، وحسبك أن الرحيم مطلع؛ لا تحزن ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾.
وقفة
[97] هل يجوز أن يسلي المؤمن قلبه بالآيات الخاصة بنبينا محمد، كقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ [الضحى: 5]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾؟ الجواب: من أحبّ الرسول حقًا تسلى بما كان يسليه، وفرح بما كان يفرحه، وحزن مما كان يحزنه صلى الله عليه وسلم.
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ التسبيح والسجود يشرحان الصدر، ويزيلان الضيق والكَدَر عن النفس.
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ما ألطف تخفيف الله على رسولهَ! فلنقدر كون اﻹنسان يضيق بما يسمع.
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ لا تصدق أن هناك نفسًا لا تؤلمها الكلمات.
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ إن ضاق صدرك فالتمس في جنة التسبيح راحة، واسجد لربك واقترب، يجد الفؤاد به انشراحه.
عمل
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ لا تكن سببًا لضيق صدر مؤمن بكلماتك الجارحة.
عمل
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ لا تستهين بـ (وزر) كلمة تلقيها؛ فبعض الكلام أثقل من الأفعال.
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ جميلة هي (العلاقة) مع الله! لا تحتاج للشرح هو يعلم أدق تفاصيل حزنك دون كلام أليس هو الأحق لتهبه قلبك؟
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ في البوح راحة لكن ما يمنعك عنه أنك قد تجرح بعدم الاستماع لك من الناس يكفيك أن رب الناس يعلم بضيقتك رب اشرح صدورنا.
وقفة
[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ كلام أحزن النبي ﷺ وضيق صدره فما بالك بالناس?! اختر مفرداتك؛ كلمة قد تكون أشد إيذاء من طعنة.
وقفة
[97] الصلاة وذكر الله سعة للصدر والبال عند ضيقه وهمّه من كلام الناس ونقدهم ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾.
وقفة
[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ من يشتغل بنقض شبهات المبطلين يسمع كثيرًا من الأذى والأكاذيب التي يضيق بها الصدر، فعليه بالإكثار من الصلاة والذكر؛ ليذهب ما به، ويثبت فؤاده كما أرشدت إليه الآيات.
وقفة
[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ التسبيح والصلاة من أهم الأدوية في علاج الضيقة وإزالة الهموم.
وقفة
[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان، وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب.
عمل
[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة؛ فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك.
اسقاط
[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ إذا أصيب الإنسان بضيق وهَمٍّ في صدره، ثم سبح الله وأكثر من الصلاة ومن الذكر؛ أزال الله همه وشرح صدره.
وقفة
[97، 98] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ جمعت الآية علاج ضيقة الصدر بسبب ما يقول الأعداء وهو: التسبيح, وكثرة السجود.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ علاج ضيقة الصدر.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ذكر ضيق الصدر مما يرى أو يسمع، وأمره بالوصفة المحققة: التسبيح والسجود.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ لا تحتمل صدورنا كلام الناس فينا؛ فهو أثقل على نفوسنا من الجبال الراسيات، ولا يزحزح هذه الضيقة ويوسع الصدر ويشرحه كاللهج بالتسبيح بحمد الله، مع كثرة السجود بين يديه جل وعز.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ تأمل كيف جعلت الآية التسبيح ترياقًا تستطب به النفوس وتداوى به الغموم.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ التسبيح والسجود يوسع الصدور.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أعظم علاج لضيق الصدر: ذكر الله والصلاة، وأي ضيق سيبقى بعد ذلك؟!
عمل
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ قم واسجد وسبح بحمد ربك؛ فما ضاق أمر بصدورنا إلا وفرجه.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ علاج الضِيق العمل، قال ديل كارنيجي: «انشغل عن القلق بالاستغراق في العمل؛ فإن العمل خير علاج للقلق أُخرج للناس».
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ لمن يعاني من ضيق الصدر: هذا هو الدواء، سبّح واسجد إذا ضاق صدرك، سبِّح الله؛ حتى يتَّسع، واسجُد؛ حتى ترتفع، فاللهُ يكفيك ويعلم ما فيك.
وقفة
[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، ﴿رب انصرني بما كذبون * فأوحينا إليه أن اصنع الفلك﴾ [المؤمنون: 26، 27] علاج الهَم العمل، الشكوى لا تفيد كثيرًا.
عمل
[97، 98] طريق الحق محفوف بالابتلاء وتسلط السفهاء، فإن أحزنك ما يقولون فتذكر قول الله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
وقفة
[97، 98] قد يضيق صدرك إذا سمعت ما يؤلمك، وقد تحزن لذلك، وقد تهتم كثيرًا، فنحتاج لمن يرأف على قلبك، ويذهب ما أهمك، تدبرت أواخر سورة الحجر: ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ فوجدت العلاج الشافي الكافي، فيا عظمة هذا القرآن وجميل لذاته!
عمل
[97، 98] هل ضايقك أحد بكلمة جارحة يا صديقي؟ سبح بحمد ربك ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
وقفة
[97، 98] هل تشعر بضيق في صدرك؟ تأمل هذه الآية جيدًا وستجد الحل بإذن الله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾.
عمل
[97، 98] علم الله بمكرهم يخفف عنك ظلمهم؛ ما عليك إلا أن تسبح ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
وقفة
[97، 98] أين الأطباء النفسانيون من العلاج الرباني لمرض العصر المتفاقم: (الاكتئاب)؟ قال تعالى مبينًا هذا الداء: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾، ثم أوضح علاجه بقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، فوجّهوا مرضاكم لهذا العلاج أولًا، قبل صرف العقاقير، فليست نفسية المسلم كنفسية غيره.
وقفة
[97، 98] لكل من ضاق صدره بسبب مكر المنافقين وسخريتهم؛ عليك بوصية الله لنبيه ﷺ ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
عمل
[97، 98] ادفع همومك بالسجود ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
عمل
[97، 98] إذا ضاق صدرك اسجد، إذا تشتت فكرك اسجد، إذا تغيّر قلبك اسجد ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
عمل
[97، 98] قد تصيبك هموم وينتابك ضيق وقلق؛ فافزع إلى الصلاة بخشوع، وصية الله لنبيه: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
وقفة
[97، 98] يا من أغرقك الضيق؛ أمامك أطواق النجاة فاستمسك بها: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
وقفة
[97، 98] لا شيء كالذِّكر تزيل به أثر أذى الأعداء، ﴿يضيق صدرك بما يقولون * فسبِّح﴾، وفي طه: ﴿فاصبر على ما يقولون وسبِّح﴾ [طه: 130]، وفي ق: ﴿فاصبر على ما يقولون وسبِّح﴾ [ق: 39]، جاءك خبر الداء والدواء.
عمل
[97، 98] إذا حزبك أمر في دنياك، أو ضاق صدرك من أذى غيرك، فافزع إلى ذكر الله والصلاة ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
وقفة
[97، 98] المخرج من الهموم وضيق الصدر: كثرة الثناء على لله والإنكسار بين يديه ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ: ﴾
- الواو: استئنافية. اللام: للابتداء والتوكيد. قد: حرف تحقيق. نعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
- ﴿ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ: ﴾
- أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «أنّ».يضيق: فعل مضارع مرفوع بالضمة. صدرك: فاعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة وجملة يَضِيقُ صَدْرُكَ» في محل رفع خبر «أنّ» و «أنّ» مع اسمها وخبرها: بتأويل مصدر سدّ مسدّ مفعولي «نعلم».
- ﴿ بِما يَقُولُونَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيضيق. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. يقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يقولون» صلة الموصول لا محل لها والعائد ضمير منصوب لأنه مفعول به. التقدير: بما يقولونه من الشرك والطعن في الاسلام. أو بما يقولونه من أقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن. '
المتشابهات :
| الأنعام: 33 | ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ |
|---|
| الحجر: 97 | ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ |
|---|
| النحل: 103 | ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [97] لما قبلها : ولَمَّا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل داعية يتأثر بالمستهزئين والمكذبين؛ طَمْأنَ اللهُ عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم هنا بأنَّه مُطَّلِعٌ على تحرُّجِه مِن أذاهم، قال تعالى:
﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [98] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ .. ﴾
التفسير :
فأنت يا محمد{ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين} أي:أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك.
والفاء في قوله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... واقعة في جواب شرط.
والتسبيح لله- تعالى- معناه: تنزيهه- عز وجل- عن كل ما لا يليق به.
والتحميد له- تعالى- معناه: الثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال والجلال.
أى: إن ضاق صدرك- أيها الرسول الكريم- بسبب أقوال المشركين القبيحة، فافزع إلينا بالتسبيح والتحميد، بأن تكثر من قول سبحان الله، والحمد لله.
قال بعض العلماء: فهذه الجملة الكريمة قد اشتملت على الثناء على الله بكل كمال لأن الكمال يكون بأمرين:
أحدهما: التخلي عن الرذائل، والتنزه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح.
والثاني: التحلي بالفضائل، والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد.
فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ... » .
والمراد بالسجود في قوله- تعالى- وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ الصلاة. وعبر عنها بذلك من باب التعبير بالجزء عن الكل، لأهمّيّة هذا الجزء وفضله، ففي صحيح مسلم عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» .
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة، أن ترتيب الأمر بالتسبيح والتحميد والصلاة على ضيق الصدر دليل على أن هذه العبادات، بسببها يزول المكروه بإذنه- تعالى-، وتنقشع الهموم ... ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم بن عمار- رضى الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله- تعالى-: «يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخره» .
فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله- تعالى- بأنواع الطاعات من صلاة وتسبيح وتحميد وغير ذلك من ألوان العبادات.
وقوله : ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ) أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر ، فلا يهيدنك ذلك ، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله ، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم ، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ; ولهذا قال : ( وكن من الساجدين ) كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد :
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " قال الله : يا ابن آدم ، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره . .
ورواه أبو داود من حديث مكحول ، عن كثير بن مرة ، بنحوه
ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر صلى .
( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ) يقول: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفك الله من ذلك ما أهمّك ، وهذا نحو الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا حَزَبَه أمر فَزِع إلى الصلاة.
المعاني :
التدبر :
تفاعل
[98] ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ سَبِّح الله الآن.
وقفة
[98] ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ يغْشَاكَ بردُ متاعبِكْ؟ لا ترتجفْ! (سَبِّحْ) من النّعمَىٰ اغْترف، لا تنعطف، للسّابقاتِ من الذنُوب أطِـلْ سُجُودك واعْترف.
الإعراب :
- ﴿ فَسَبِّحْ: ﴾
- الفاء: سببية. سبح: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والتسبيح: هو التنزيه.
- ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بسبح. ربّك: مضاف اليه للتعظيم بالكسرة والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة. أي فافزع إلى ربك بالتسبيح والتحميد.
- ﴿ وَكُنْ: ﴾
- الواو: عاطفة. كن: فعل أمر ناقص مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. واسمه: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ مِنَ السّاجِدِينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخبر «كن» وعلامة جر الاسم: الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد ويجوز أن يتعلق الجار والمجرور «بحمد» بحال محذوفة من ضمير «سبّح» التقدير: حامدا. '
المتشابهات :
| الحجر: 98 | ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ |
|---|
| الأعراف: 144 | ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ |
|---|
| الزمر: 66 | ﴿بَلِ اللَّـهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [98] لما قبلها : ولَمَّا ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أقوال المشركين القبيحة، واستهزاء المستهزئين؛ أمره اللهُ عز وجل بأربعة أمور تزيل ضيق صدره وحزنه، وهي: 1- التسبيح. 2- التحميد. 3- السجود، قال تعالى:
﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [99] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾
التفسير :
{ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} أي:الموت أي:استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة، حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
تم تفسير سورة الحجر
والمراد بالأمر بالعبادة في قوله تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ المداومة عليها وعدم التقصير فيها.
والمراد باليقين: الموت، سمى بذلك لأنه أمر متيقن لحوقه بكل مخلوق.
أى: ودم- أيها الرسول الكريم- على عبادة ربك وطاعته ما دمت حيا، حتى يأتيك الموت الذي لا مفر من مجيئه في الوقت الذي يريده الله- تعالى-.
ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله- تعالى- حكاية عن المجرمين: قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ أى: الموت.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على
عثمان بن مظعون وقد مات، قالت: قلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما يدريك أن الله قد أكرمه ... أما هو فقد جاءه اليقين- أى الموت- وإنى لأرجو له الخير» .
قال الإمام ابن كثير: ويستدل بهذه الآية الكريمة، على أن العبادة كالصلاة ونحوها، واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلى بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» .
ويستدل بها أيضا على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة، سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل ... » .
وبعد: فهذه سورة الحجر، وهذا تفسير لها. نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقوله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قال البخاري : قال سالم : الموت
وسالم هذا هو : سالم بن عبد الله بن عمر ، كما قال ابن جرير :
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني طارق بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قال : الموت
وهكذا قال مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيره
والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا : ( لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) [ المدثر : 43 - 47 ]
وفي الصحيح من حديث الزهري ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أم العلاء - امرأة من الأنصار - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل على عثمان بن مظعون - وقد مات - قلت : رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وما يدريك أن الله أكرمه ؟ " فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله ، فمن ؟ فقال : " أما هو فقد جاءه اليقين ، وإني لأرجو له الخير "
ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) - على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله ، كما ثبت في صحيح البخاري ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب "
ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة ، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل ، فإن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته ، وما يستحق من التعظيم ، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة . وإنما المراد باليقين هاهنا الموت ، كما قدمناه . ولله الحمد والمنة ، والحمد لله على الهداية ، وعليه الاستعانة والتوكل ، وهو المسئول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [ فإنه جواد كريم ]
[ وحسبنا الله ونعم الوكيل ]
يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك الموت، الذي هو مُوقَن به. وقيل: يقين، وهو موقَن به، كما قيل: خمر عتيق، وهي معتَّقَة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال : ثني طارق بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) قال : الموت .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شبل ، وحدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثني عباس بن محمد ، قال : ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول : ( حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) قال : الموت .
حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) قال : يعني الموت .
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) قال : اليقين : الموت .
حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرّزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله .
حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، في قوله ( حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) قال : الموت .
حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا أبي ، عن سفيان عن طارق ، عن سالم ، مثله .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) قال : الموت ، إذا جاءه الموت ، جاءه تصديق ما قال الله له ، وحدّثه من أمر الآخرة .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب " أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن أمّ العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قُرْعة قالت : وطار لنا عثمان بن مظعون ، فأنـزلناه في أبياتنا ، فوَجع وجعه الذي مات فيه ، فلما تُوُفِّي وغسِّل وكُفِّن في أثوابه ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا عثمان بن مظعون رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك ، لقد أكرمك الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَّا هُوَ فَقَدْ جاءَهُ اليَقِينُ ، وَوَاللَّهِ إنّي لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ " .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مالك بن إسماعيل ، قال : ثنا إسماعيل ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، قال / ثنا ابن شهاب ، عن خارجة بن زيد ، عن أمّ العلاء امرأة من نسائهم ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه .
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن محمد بن شهاب ، أن خارجة بن زيد ، حدثه عن أمّ العلاء امرأة منهم ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، بنحوه ، إلا أنه قال في حديثه : فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " أمَّا هُوَ فَقَدْ عايَنَ اليَقِينَ ".
التدبر :
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ كان عمر بن عبد العزيز يقول: «ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ثم لا يستعدون له»؛ يعني كأنهم فيه شاكون.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أي الموت، والمراد: استقم ولازم العبادة ولا تخل لحظة من الحياة إلا بتعبدٍ لله.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ فلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر الصيام أن يحل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية، ولا يسوغ له إذا أرغم عدوه في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ليس المقصود بـ(اليقين) المعرفة التي يسقط معها التكليف، بل المقصود هو الموت.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ العبادة مستمرة حتى يأتي الأجل.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ليس للعبادة نهاية عند المؤمن دون الموت.
عمل
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ لا تتوقف عن الطاعات بانتهاء المواسم.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت، ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله.
وقفة
[99] ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ عبادة الله تعالى ليست موسمية؛ إنما هي وظيفتك أيها الإنسان ما دمت حيًّا؛ فأحسن أداءها.
وقفة
[99] كلما ازداد قرب العبد من الله وعلا مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه، ولا فتور لقصده، بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أحزم، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.
وقفة
[99] الصوم لا ينتهي، والقرآن لا يهجر، والمسجد لا يترك: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾؛ كن ربانيًّا ولا تكن رمضانيًّا.
وقفة
[99] سَدِّد وقَارِب، لن تَصِلَ إلى الغَاية، تَتَشَوَّف نَفسُكَ إلى الغَاية، ولَن تَصِل إلى الكَمَال؛ لِأَنَّك مَجبُول على النَّقص؛ لَكِن مع ذلك: سَدِّد وقَارِب، احرِص أن يكُون عَمَلُك سَدَادًا على وِفقِ مَا جَاءَ عَن نَبِيِّ الله جَلَّ وعَلا، وقَارِب الكَمَال وإن لَم تَستَطِعهُ، سَدِّد وقَارِب وأَبشِر واستَعِن بِغُدُوٍّ والرَّواح وأَدلِج قَاصِدًا ودُمِ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» [البخاري 39]، المَقصُود أنَّكَ تَستَغِلّ آناءَ اللِّيل وأطرَاف النَّهار، وأدلِج قَاصِدًا ودُمِ، ما تقول: (أنا والله بتعبَّد يُوم يومين في الشَّهر، أو شهر في السنة ويكفي) لا، دُم على ذلك: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، هذهِ هي الغاية.
وقفة
[99] ﴿الْيَقِينُ﴾ هو: الموت في تفاسير السلف الصالح, لأنه موقن به, فلم يجعل الله للمؤمن نهاية لعبادته إلا الموت, فمن استشعر ذلك زادت عبادته على قدر استشعاره.
وقفة
[97-99] التسبيح وذكر الله هي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك، وفي القرآن نلاحظ أن الله تعالى يأمر بالإكثار من التسبيح والذكر في المواطن التي تحتاج إلى صبر وفي الأزمات: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، فهو ترتيب منطقي جدًا، بعدما تضيق الصدور والقلوب نذكر اسم ربنا، وأمره بالتسبيح في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]، ومداومة التسبيح تفرِّج الكروب، فالذي نجَّى يونس من بطن الحوت هو مداومته على التسبيح: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: 143، ١٤٤].
وقفة
[97-99] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ النبي ﷺ يسوؤه تكذيب قومه مع علمهم بصدقه ووضوح أدلته، فأرشده الله إلى ما يطرد الهم، فأمره بخصوص، ثم عموم، ثم أعم: إذ أرشده إلى تسبيح الله، ثم إلى أمر أعم من الذكر المجرد وهو الصلاة، ثم إلى الإقبال على العبادة بمفهومها الشامل، فيا لها من هداية عظيمة لو تدبرناها، وأخذنا بها!
وقفة
[97-99] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾ أسباب انشراح الصدور: التسبيح: ﴿فَسَبِّحْ﴾، والحمد: ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، والسجود: ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، والعبادة: ﴿واعبد ربك﴾.
وقفة
[97-99] ﴿ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك﴾ إذا ضاق صدرك: اعبد ربك.
وقفة
[97-99] ﴿ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك﴾ عبادة الله موطن الراحة.
وقفة
[97-99] إذا وجدت في نفسك ضيقًا وهمًا بسبب واقع تعيشه، فتوجه إلى ربِّك وقم بعمل إيجابي مثمر؛ ليزول عنك همك، وينشرح صدرك، وتتقي شرَّ هذا الهم والغم: ﴿ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «سبح» وتعرب إعرابها. ربك: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة. والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. أي: ودم على عبادة ربّك. أو فاعبده ما دمت حيا.
- ﴿ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ: ﴾
- حتى: حرف غاية وجر بمعنى «إلى أن».يأتيك: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد «حتى» وعلامة نصبه: الفتحة والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. اليقين: فاعل مرفوع بالضمة. بمعنى: حتى يأتيك اليقين أي الموت فلا تخل بالعبادة لأنه حتم يقين. وجملة يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ» صلة «أن» المصدرية المضمرة لا محل لها من الإعراب. و «أن» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بحتى. والجار والمجرور متعلق باعبد. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [99] لما قبلها : 4- المدوامة على عبادة الله حتى يأتي الموت، قال تعالى:
﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :النحل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى -مقربا لما وعد به محققا لوقوعه-{ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ} فإنه آت، وما هو آت، فإنه قريب،{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله،
تعريف بسورة النحل
1- سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب المصحف، فقد سبقتها سور:
الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر.
أما في ترتيب النزول، فكان ترتيبها التاسعة والستين، وكان نزولها بعد سورة الكهف .
2- وعدد آياتها ثمان وعشرون ومائة آية.
3- وسميت بسورة النحل، لقوله- تعالى- فيها وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً ... .
وتسمى- أيضا- بسورة النعم، لأن الله- تعالى- عدد فيها أنواعا من النعم التي أنعم بها على عباده.
4- وسورة النحل من السور المكية: أى التي كان نزولها قبل الهجرة النبوية الشريفة.
قال القرطبي: «وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. وقيل: هي مكية إلا قوله- تعالى- وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ.. الآية. نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد..» «3» .
وقال الآلوسى: وأطلق جمع القول بأنها مكية، وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس، وابن الزبير- رضى الله عنهم- وأخرجه النحاس من طريق مجاهد عن الحبر أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها، فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف النبي- صلى الله عليه وسلم- من غزوة أحد .
والذي تطمئن إليه النفس، أن سورة النحل كلها مكية، وذلك لأن الروايات التي ذكروها في سبب نزول قوله- تعالى-، وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ.. إلخ السورة، فيها مقال. فقد ذكر الإمام ابن كثير عند سردها، أن بعضها مرسل وفيه مبهم، وبعضها في إسناده ضعف.. .
5- (أ) وإذا ما قرأنا سورة النحل بتدبر وتفكر، نراها في مطلعها تؤكد أن يوم القيامة حق، وأنه آت لا ريب فيه، وأن المستحق للعبادة والطاعة إنما هو الله الخالق لكل شيء.
قال- تعالى-: أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ، سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ، يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ.
(ب) تم تسوق ألوانا من الأدلة على وحدانية الله وقدرته، عن طريق خلق السموات والأرض وخلق الإنسان والحيوان، وعن طريق إنزال الماء من السماء، وتسخير الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم.. وغير ذلك من النعم التي لا تحصى.
استمع إلى بعض هذه الآيات التي تحكى جانبا من هذه النعم فتقول: خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ.
ثم تقول: وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
(ج) وبعد أن توبخ السورة المشركين لتسويتهم بين من يخلق ومن لا يخلق تحكى جانبا من أقاويلهم الباطلة التي وصفوا بها القرآن الكريم، وتصور استسلامهم لقضاء الله العادل فيهم يوم الحساب، فتقول: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا: أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ.
إلى أن تقول: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.
(د) وكعادة القرآن الكريم في قرنه الترهيب بالترغيب، وفي عقده المقارنات بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين، جاءت الآيات بعد ذلك لتبشر المتقين بحسن العاقبة.
جاء قوله- تعالى-: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ، وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ.
(هـ) ثم تعود السورة الكريمة مرة أخرى إلى حكاية أقوال المشركين حول مسألتين من أخطر المسائل، وهما مسألة الهداية والإضلال، ومسألة البعث بعد الموت بعد أن حكت ما قالوه في شأن القرآن الكريم.
استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى أقوالهم ثم يرد عليها بما يبطلها فيقول: وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ، كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ. وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ، بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ.
(و) ثم تهدد السورة الكريمة أولئك الجاحدين لنعم الله، الماكرين للسيئات، بأسلوب يستثير النفوس ويبعث الرعب في القلوب، وتدعوهم إلى التأمل والتفكر في ملكوت السموات والأرض، لعل هذا التفكر يكون سببا في هدايتهم، وتخبرهم بأن الله- تعالى- هو الذي نهاهم عن الشرك، وهو الذي أمرهم بإخلاص العبادة له.
استمع إلى القرآن وهو يصور هذه المعاني بأسلوبه البديع فيقول: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ. وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ.
(ز) ثم انتقلت السورة إلى سرد أنواع من جهالات المشركين، ومن سوء تفكيرهم، حتى يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، ويشكروا الله- تعالى- على توفيقه إياهم إلى الدخول في الإسلام.
لقد ذكرت السورة الكريمة ألوانا متعددة من جهالات الكافرين، ومن ذلك قوله- تعالى-: وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ، تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ.
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
(ح) هكذا تصور سورة النحل ما كان عليه المشركون من غباء وغفلة وسوء تفكير، ثم تعود- سورة النعم- مرة أخرى إلى الحديث عن نعم الله- تعالى- على عباده، فتتحدث عن نعمة الكتاب، وعن نعمة الماء، وعن نعمة الأنعام، وعن نعمة الثمار والفواكه، وعن نعمة العسل المتخذ من بطون النحل وعن نعمة التفاضل في الأرزاق، وعن نعمة الأزواج والبنين والحفدة.
قال- تعالى-: وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها، إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ.
إلى أن يقول- سبحانه-: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ، أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.
(ط) ثم تسوق السورة الكريمة مثلين مشتملين على الفرق الشاسع، بين المؤمن والكافر، وبين الإله الحق والآلهة الباطلة، فتقول: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً، هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
(ى) وبعد إيراد هذين المثلين البليغين، تعود سورة النعم إلى الحديث عن أنواع أخرى من نعم الله على خلقه، لكي يشكروه عليها، ويستعملوها فيما خلقت له فتتحدث عن نعمة إخراج الإنسان من بطن أمه، وعن نعمة البيوت التي هي محل سكن الإنسان، وعن نعمة الظلال، وعن نعمة الجبال، وعن نعمة الثياب.
قال- تعالى-: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ، وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها، أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.
(ك) ثم بعد أن تصور السورة الكريمة أحوال المشركين يوم القيامة عند ما يرون العذاب، وتحكى ما يقولون عند ما يرون شركاءهم، وتقرر أن الله يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- سيكون شهيدا على من بعث إليهم.
بعد كل ذلك تسوق السورة الكريمة عددا من الآيات الآمرة بمكارم الأخلاق والناهية عن منكراتها فتقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ، وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ.
(ل) وبعد هذه التوجيهات السامية المشتملة على الترغيب والترهيب، وعلى الأوامر والنواهي. تتحدث آيات السورة عن آداب تلاوة القرآن وعن الشبهات التي أثارها المشركون حوله مع الرد عليها بما يدحضها، وعن حكم من تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فتقول: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ.
ثم تقول: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
ثم تقول: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
(م) ثم تعود السورة الكريمة لضرب الأمثال، فتسوق مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم بالنعم فلم يقابلوها بالشكر، فانتقم الله- تعالى- منهم. كما تسوق جانبا من حياة سيدنا إبراهيم كمثال للشاكرين الذين استعملوا نعم الله فيما خلقت له.
استمع إلى قوله- تعالى-: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ.
ثم إلى قوله- تعالى-: إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
(ن) وأخيرا تختتم السورة الكريمة بتلك الآيات الجامعة لأحكم الأساليب وأكملها وأجملها وأ نجمعها في الدعوة إلى الله- تعالى- وفي معاملة الناس فتقول: ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
6- وبعد، فهذا عرض إجمالى لأهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة، ومنه نرى:
(أ) عنايتها الفائقة بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته، وعلى أن يوم القيامة حق، وعلى أن القرآن من عند الله- عز وجل.
(ب) كما نرى تفصيلها القول في بيان آلاء الله- تعالى- على خلقه، وقد سبحت السورة في هذا الجانب سبحا عظيما، فذكّرت الإنسان بنعمة خلقه، وبنعمة تسخير الأنعام والشمس، والقمر، والنجوم، والماء، والجبال، والأشجار.. كل ذلك وغيره لمنفعته ومصلحته.
(ج) كما نلمس اهتمامها بضرب الأمثال للمؤمن والكافر، والشاكر والجاحد والإله الحق والآلهة الباطلة.. وذلك لأن في ضرب الأمثال تقريبا للبعيد وتوضيحا للخفى، بأسلوب من شأنه أن يكون أوقع في القلوب، وأثبت في النفوس وأدعى إلى التدبر والتفكر.
(د) كما ندرك حرصها على إيراد أقوال المشركين وشبههم! ثم الرد عليها بطريقة تقنع العقول، وترضى العواطف، بأن الإسلام هو الدين الحق، وبذلك يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم.
(هـ) كما نحس- عند قراءتها- بعنايتها بتوجيه المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وأمهات الفضائل، كالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والوفاء، والصبر، والشكر ... وبنهيهم عن الرذائل كالغدر والجحود، ونقض العهود، والاستكبار، والظلم.
وأخيرا فإن المتأمل في هذه السورة- أيضا- يراها حافلة بأسلوب الترغيب والترهيب، والتبشير والإنذار، والوعد والوعيد.
الوعيد للكافرين بسوء المصير إذا ما لجوا في ضلالهم وطغيانهم كما في قوله- تعالى-:
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ.
والوعد للمؤمنين بالحياة الطيبة في الدارين، كما في قوله- تعالى-: مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.
والآن فلنبدأ في التفسير التحليلى لسورة النعم، ونسأل الله- تعالى- أن يرزقنا التوفيق والسداد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
افتتحت السورة الكريمة، بتهديد الكافرين الذين كانوا ينكرون البعث، وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب، ويستبعدون نصر الله- تعالى- لأوليائه، فقال- تعالى-: أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ والفعل «أتى» هنا، بمعنى قرب ودنا بدليل «فلا تستعجلوه» ، لأن المنهي عن الاستعجال يقتضى أن الأمر الذي استعجل حصوله لم يحدث بعد.
والمراد بأمر الله: ما اقتضته سنته وحكمته- سبحانه- من إثابة المؤمنين ونصرهم، وتعذيب الكافرين ودحرهم.
والفاء في قوله «فلا تستعجلوه» للتفريع. والاستعجال: طلب حصول الشيء قبل وقته.
والضمير المنصوب في «تستعجلوه» يعود على «أمر الله» ، لأنه هو المتحدث عنه، أو على «الله» - تعالى-، فلا تستعجلوا الله فيما قضاه وقدره.
والمعنى: قرب ودنا مجيء أمر الله- تعالى- وهو إكرام المؤمنين بالنصر والثواب، وإهانة الكافرين بالخسران والعقاب، فلا تستعجلوا- أيها المشركون- هذا الأمر، فإنه آت لا ريب فيه، ولكن في الوقت الذي يحدده الله تعالى- ويشاؤه.
وعبر عن قرب إتيان أمر الله- تعالى- بالفعل الماضي «أتى» للإشعار بتحقق هذا الإتيان، وللتنويه بصدق المخبر به، حتى لكأن ما هو واقع عن قريب، قد صار في حكم الواقع فعلا. وفي إبهام أمر الله، إشارة إلى تهويله وتعظيمه، لإضافته إلى من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
قوله «فلا تستعجلوه» زيادة في الإنذار والتهديد، أى: فلا جدوى من استعجالكم، فإنه نازل بكم سواء استعجلتم أم لم تستعجلوا.
والظاهر أن الخطاب هنا للمشركين، لأنهم هم الذين كانوا يستعجلون قيام الساعة، ويستعجلون نزول العذاب بهم، وقد حكى القرآن عنهم ذلك في آيات:
منها قوله- تعالى-: يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ .
ومنها قوله- سبحانه-: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .
وقال بعض العلماء: و «يجوز أن يكون الخطاب هنا شاملا للمؤمنين، لأن عذاب الله- تعالى- وإن كان الكافرون يستعجلونه، تهكما به، لظنهم أنه غير آت، فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه، ويحبون تعجيله للكافرين» .
وقوله: «سبحانه وتعالى عما يشركون» جملة مستأنفة، قصد بها إبطال إشراكهم، وزيادة توبيخهم وتهديدهم:
أى: تنزه الله- تعالى- وتعاظم بذاته وصفاته، عن إشراك المشركين، المؤدى بهم إلى الأقوال الفاسدة، والأفعال السيئة، والعاقبة الوخيمة. والعذاب المهين. وقوله:
«يشركون» : قراءة الجمهور، وفيها التفات من الخطاب في قوله «فلا تستعجلوه» إلى الغيبة، تحقيرا لشأن المشركين، وحطا من درجتهم عن رتبة الخطاب، وحكاية لشنائعهم التي يتبرأ منها العقلاء.
وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» تبعا لقوله- تعالى- فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ وعلى قراءتهما لا التفات في الآية.
تفسير سورة النحل وهي مكية .
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة [ كما قال تعالى ] : ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) [ الأنبياء : 1 ] وقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) [ القمر : 1 ] .
وقوله : ( فلا تستعجلوه ) أي : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه .
يحتمل أن يعود الضمير على الله ، ويحتمل أن يعود على العذاب ، وكلاهما متلازم ، كما قال تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) [ العنكبوت : 53 ، 54 ] .
وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب ، فقال في قوله : ( أتى أمر الله ) أي : فرائضه وحدوده .
وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب فإنهم استعجلوه قبل كونه ، استبعادا وتكذيبا .
قلت : كما قال تعالى : ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ) [ الشورى : 18 ] .
وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن يحيى بن آدم ، عن أبي بكر بن عياش ، عن محمد بن عبد الله - مولى المغيرة بن شعبة - عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن حجيرة ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس ، فما تزال ترتفع في السماء ، ثم ينادي مناد فيها : يا أيها الناس ، فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم ؟ فمنهم من يقول : نعم ، ومنهم من يشك ، ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس ، فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم ؟ فيقولون : نعم ، ثم ينادي الثالثة : يا أيها الناس ، أتى أمر الله فلا تستعجلوه . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فوالذي نفسي بيده ، إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا ، وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا ، وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا - قال - ويشتغل الناس .
ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره ، وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد ، تعالى وتقدس علوا كبيرا ، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة ، فقال : ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) .
يقول تعالى ذكره: أتى أمر الله فقرُب منكم أيها الناس ودنا، فلا تستعجلوا وقوعه.
ثم اختلف أهل التأويل في الأمر الذي أعلم الله عباده مجيئه وقُربه منهم ما هو، وأيّ شيء هو؟ فقال بعضهم: هو فرائضه وأحكامه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله ( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ) قال: الأحكام والحدود والفرائض.
وقال آخرون: بل ذلك وعيد من الله لأهل الشرك به، أخبرهم أن الساعة قد قَرُبت وأن عذابهم قد حضر أجله فدنا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا القاسم، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: لما نـزلت هذه الآية، يعني ( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ) قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله أتى، فأمسِكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن ، فلما رأوا أنه لا ينـزل شيء، قالوا: ما نراه نـزل شيء فنـزلت اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضا ، فلما رأوا أنه لا ينـزل شيء، قالوا: ما نراه نـزل شيء فنـزلت وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .
حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى بن يمان، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن أبي بكر بن حفص، قال: لما نـزلت ( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ) رفعوا رءوسهم، فنـزلت ( فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ) .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا أبو بكر بن شعيب، قال: سمعت أبا صادق يقرأ (يا عِبادِي أتّى أمْرُ اللَّهِ فلا تستعجلوه) .
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: هو تهديد من الله أهل الكفر به وبرسوله، وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك وذلك أنه عقَّب ذلك بقوله سبحانه وتعالى ( عَمَّا يُشْرِكُونَ ) فدلّ بذلك على تقريعه المشركين ووعيده لهم. وبعد، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تُفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين، فقد كانوا كثيرا.
وقوله سبحانه وتعالى ( عَمَّا يُشْرِكُونَ ) يقول تعالى تنـزيها لله وعلوّا له عن الشرك الذي كانت قريش ومن كان من العرب على مثل ما هم عليه يَدِين به.
واختلفت القراء في قراءة قوله تعالى ( عَمَّا يُشْرِكُونَ ) فقرأ ذلك أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين ( عَمَّا يُشْرِكُونَ ) بالياء على الخبر عن أهل الكفر بالله وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قرءوا الثانية بالياء . وقرأ ذلك عامَّة قرّاء الكوفة بالتاء على توجيه الخطاب بقوله ( فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ) إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى " عما يشركون " إلى المشركين ، والقراءة بالتاء في الحرفين جميعا على وجه الخطاب للمشركين أولى بالصواب لما بيَّنت من التأويل ، أن ذلك إنما هو وعيد من الله للمشركين ، ابتدأ أوّل الآية بتهديدهم ، وختم آخرها بنكير فعلهم واستعظام كفرهم على وجه الخطاب لهم.
التدبر :
وقفة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ﴾ أمر الله هو القيامة، والاتيان: مجيء بسهولة، فهو يُعبِّر عن المستقبل لقربه وتحقق وقوعه، وقد ناسب أن تأتي فاتحة السورة بهذا المعنى بعد: ﴿حتى يأتيك اليقين﴾ [الحجر: 99] في السورة التي قبلها، واليقين: الموت، ومن مات فقد قامت قيامته.
لمسة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ﴾ (أتى) وليس: (جاء)؛ فمن الناحية اللغوية: (جاء) تستعمل لما فيه مشقة، أما (أتى) فتستعمل للمجيء بسهولة ويسر.
لمسة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ﴾ جاء فعل الاتيان ماضيًا مع أن أمر القيامة لم يحصل، وذلك لتنزيل ما لم يقع منزلة الذي وقع، فكأن أمر الله قد وقع وفرغ منه وانتهى، لتقرير حقيقة وقوع القيامة وأنها مما فرغ منها.
لمسة
[1] استعمال صيغة الفعل الماضي في قوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ﴾ للدلالة على التيقن من وقوع الحدث سواء كان المقصود يوم القيامة أو النصر في الدنيا، فالفعل الماضي في اللغة قد يكون لما قد حصل أو لما شارف الوقوع، كما نقول: (قد قامت الصلاة) أو للمستقبل كذكر أحداث يوم القيامة في القرآن للدلالة على التيقن من وقوعها.
وقفة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر: 1]، ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: 1]؛ مخيف جدًّا أن تذكر أن هذه الآيات نزلت قبل قرابة 1440 سنة، حتى قبل الهجرة.
وقفة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ المؤمن لا يستعجل شيئًا باختياره؛ رضًا باختيار الله له.
وقفة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ سنة الله تمضي وفق مشيئته، لا يقدمها استعجال، ولا يؤخرها رجاء.
اسقاط
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ كل آتٍ في القرآن فهو قريب، فما الذي أعددته ليوم الوعيد؟!
عمل
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ واعلم أنَّ كل ما هو آتٍ فهو قريب؛ ألا فاستعد.
عمل
[1] افتتحت سورة النحل بالنهي عن الاستعجال: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، وختمت بالأمر بالصبر: ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله﴾ [127]، وما بين التروي والصبر يكمن خير لا يعلم به إلا الله سبحانه؛ فثق بالله، ولا تجزع.
لمسة
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، مُعَبِّرًا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة.
عمل
[1] ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ اقرأ عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى.
تفاعل
[1] ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ سَبِّح الله الآن.
الإعراب :
- ﴿ أَتى أَمْرُ اللهِ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. أمر:فاعل مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة والجملة واقعة جوابا للذين كانوا يكذبون بالوعد أي العذاب الذي هددهم به رسول الله.
- ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ: ﴾
- الفاء: استئنافية. لا: ناهية جازمة بلهجة تهديد.تستعجلوه: فعل أمر مبني على حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أي الأمر -أمر الله-.
- ﴿ سُبْحانَهُ وَتَعالى: ﴾
- سبحان: مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره: أسبح «وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.وتعالى: الواو عاطفة. تعالى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي تبرأ عز وجل وتنزه.
- ﴿ عَمّا يُشْرِكُونَ: ﴾
- عما: مركبة من «عن» حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعن. يشركون: صلة الموصول لا محل لها. وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل أو هي «ما» المصدرية فتكون «ما» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلق بسبحانه. التقدير: سبحانه عن اشراكهم.وجملة «يشركون» صلة «ما» المصدرية لا محل لها. '
المتشابهات :
| الإسراء: 1 | ﴿ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ |
|---|
| غافر: 20 | ﴿وَٱللَّهُ يَقۡضِي بِٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقۡضُونَ بِشَيۡءٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ |
|---|
| غافر: 56 | ﴿إِن فِي صُدُورِهِمۡ إِلَّا كِبۡرٞ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِۚ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ |
|---|
| الشورى: 11 | ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أتى أمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَمّا أنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وانشَقَّ القَمَرُ﴾ [القمر: ١] . قالَ الكُفّارُ بَعْضُهم لِبَعْضٍ: إنَّ هَذا يَزْعُمُ أنَّ القِيامَةَ قَدْ قَرُبَتْ، فَأمْسِكُوا عَنْ بَعْضِ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حَتّى نَنْظُرَ ما هو كائِنٌ. فَلَمّا رَأوْا أنَّهُ لا يَنْزِلُ شَيْءٌ قالُوا: ما نَرى شَيْئًا. فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهم وهم في غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١] . فَأشْفَقُوا وانْتَظَرُوا قُرْبَ السّاعَةِ، فَلَمّا امْتَدَّتِ الأيّامُ قالُوا: يا مُحَمَّدُ، ما نَرى شَيْئًا مِمّا تُخَوِّفُنا بِهِ. فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أتى أمْرُ اللَّهِ﴾ . فَوَثَبَ النَّبِيُّ ﷺ، ورَفَعَ النّاسُ رُءُوسَهم، فَنَزَلَ: ﴿فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ . فاطْمَأنُّوا، فَلَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”بُعِثْتُ أنا والسّاعَةُ كَهاتَيْنِ - وأشارَ بِأُصْبُعِهِ - إنْ كادَتْ لَتَسْبِقُنِي“ .وقالَ الآخَرُونَ: الأمْرُ هَهُنا العَذابُ بِالسَّيْفِ، وهَذا جَوابٌ لِلنَّضْرِ بْنِ الحارِثِ حِينَ قالَ: ﴿اللَّهُمَّ إن كانَ هَذا هو الحَقَّ مِن عِندِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِّنَ السَّماءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] . يَسْتَعْجِلُ العَذابَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : سورة النحل هي «سورة النِّعَم»؛ لكثرة ذكر النعم فيها، ومقصدها: التعرف على نعم الله عز وجل، وشكره عليها، وبدأت بالرد على استعجال الكفَّار للعذاب الذي توعدهم به النَّبيُّ r؛ فرَدَّ اللهُ عليهم: قَرُبَ قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب قبل أوانه، قال تعالى:
﴿ أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تستعجلوه:
قرئ:
1- بالتاء، على الخطاب، وهى قراءة الجمهور.
2- بالياء، نهيا للكفار، وهى قراءة ابن جبير.
يشركون:
قرئ:
1- بتاء الخطاب، وهى قراءة حمزة، والكسائي.
2- بالياء، وهى قراءة باقى السبعة.
مدارسة الآية : [2] :النحل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ .. ﴾
التفسير :
ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه، مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله، من صفات الكمال فقال:{ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ} أي:بالوحي الذي به حياة الأرواح{ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} ممن يعلمه صالحا، لتحمل رسالته.وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله:{ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاتقون} أي:على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل الله بها كتبه وأرسل رسله، وجعل الشرائع كلها تدعو إليها، وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها
ثم بين- سبحانه- لونا من ألوان قدرته، ورحمته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، فقال تعالى-: يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ...
والمراد بالملائكة هنا: جبريل- عليه السلام- ومن معه من حفظة الوحى. أو المراد بهم جبريل خاصة، ولا مانع من ذلك، لأن الواحد قد يسمى باسم الجمع إذا كان رئيسا عظيما.
والمراد بالروح: كلام الله- تعالى- ووحيه الذي ينزل به جبريل، ليبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه.
وقد جاء ذكر الروح بمعنى الوحى في آيات منها قوله- تعالى-: وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ، وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا ... .
والمعنى: ينزل- سبحانه- الملائكة بكلامه ووحيه، على من يشاء إنزالهم إليه من عباده المصطفين الأخبار.
وأطلق- سبحانه- على وحيه اسم الروح، على سبيل التشبيه، ووجه الشبه: أن بسببهما تكون الحياة الحقة.
فكما أن بالروح تحيا الأبدان والأجساد، فكذلك بالوحي تحيا القلوب والنفوس وتؤدى رسالتها في هذه الحياة.
وفي قوله- سبحانه-: «من أمره» إشارة إلى أن نزول الملائكة بالوحي، لا يكون إلا بسبب أمر الله لهم بذلك، كما قال- تعالى- حكاية عنهم: وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ، وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .
وقوله: «على من يشاء من عباده» رد على مطالب المشركين المتعنتة، والتي من بينها ما حكاه الله تعالى- عنهم في قوله: وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ... .
فالآية الكريمة تبين أن نزول الملائكة بالوحي، إنما هو على من يختاره الله- تعالى- لنزول الوحى عليه، لا على من يختارونه هم، وأن النبوة هبة من الله- تعالى- لمن يصطفيه من عباده. قال- تعالى-: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ .
وقوله: «أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» بيان للمقصود من نزول الملائكة بالوحي على الأنبياء.
أى: أنزل- سبحانه- ملائكته بوحيه على أنبيائه، لكي ينذر هؤلاء الأنبياء الناس، ويخوفوهم من سوء عاقبة الإشراك بالله، ويدعوهم إلى أن يخلصوا العبادة لله- تعالى- وحده، ويبينوا لهم أن الألوهية لا يصح أن تكون لغيره- سبحانه-.
قال الآلوسى ما ملخصه: وقوله: أَنْ أَنْذِرُوا بدل من «الروح» على أن «أن» هي التي من شأنها أن تنصب المضارع، وصلت بالأمر كما وصلت به في قولهم: كتبت إليه بأن قم.
وجوز بعضهم كون «أن» هنا مفسرة، فلا موضع لها من الإعراب، وذلك لما في «ينزل الملائكة بالوحي، من معنى القول، كأنه قيل: يقول- سبحانه- بواسطة الملائكة لمن يشاء من عباده أن أنذروا ... » .
واقتصر هنا على الإنذار الذي هو بمعنى التخويف، لأن الحديث مع المشركين، الذين استعجلوا العذاب، واتخذوا مع الله- تعالى- آلهة أخرى.
والفاء في قوله «فاتقون» فصيجة: أى، إذا كان الأمر كذلك، من أن الألوهية لا تكون لغير الله، فعليكم أن تتقوا عقوبتي لمن خالف أمرى، وعبد غيرى.
قال الجمل: «وفي قوله «فاتقون» تنبيه على الأحكام الفرعية بعد التنبيه على الأحكام العلمية بقوله، «أنه لا إله إلا أنا» ، فقد جمعت الآية بين الأحكام الأصلية والفرعية» .
يقول تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح ) أي : الوحي كما قال تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) [ الشورى : 52 ] .
وقوله : ( على من يشاء من عباده ) وهم الأنبياء ، كما قال : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [ الأنعام : 124 ] وقال : ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) [ الحج : 75 ] وقال : ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) [ غافر : 15 ، 16 ] .
وقوله : ( أن أنذروا ) أي : لينذروا أنه لا إله إلا أنا ) [ كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ) ] فاعبدون ) [ الأنبياء : 25 ] وقال في هذه [ الآية ] : ( فاتقون ) أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري .
اختلفت القرّاء في قراءة قوله ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ ) فقرأ ذلك عامَّة قرّاء المدينة والكوفة ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ ) بالياء وتشديد الزاي ونصب الملائكة، بمعنى ينـزل الله الملائكة بالروح. وقرأ ذلك بعض البصريين وبعض المكيين: " يُنـزلُ المَلائِكَةَ " بالياء وتخفيف الزاي ونصب الملائكة. وحُكي عن بعض الكوفيين أنه كان يقرؤه: " تَنـزلُ المَلائكَةُ" بالتاء وتشديد الزاي والملائكة بالرفع، على اختلاف عنه في ذلك ، وقد رُوي عنه موافقة سائر قرّاء بلده.
وأولى القراءات بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ ) بمعنى: ينـزل الله ملائكة. وإنما اخترت ذلك، لأن الله هو المنـزل ملائكته بوحيه إلى رسله، فإضافة فعل ذلك إليه أولى وأحقّ واخترت ينـزل بالتشديد على التخفيف، لأنه تعالى ذكره كان ينـزل من الوحي على من نـزله شيئا بعد شيء، والتشديد به إذ كان ذلك معناه ، أولى من التخفيف.
فتأويل الكلام: ينـزل الله ملائكته بما يحيا به الحقّ ويضمحلّ به الباطل من أمره ( عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) يعني على من يشاء من رسله ( أَنْ أَنْذِرُوا ) فإن الأولى في موضع خفض، ردًا على الروح، والثانية في موضع نصب بأنذروا. ومعنى الكلام: ينـزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، بأن أنذروا عبادي سطوتي على كُفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي الآلهة والأوثان، فإنه لا إله إلا أنا ، يقول: لا تنبغي الألوهة إلا لي، ولا يصلح أن يُعبد شيء سواي، فاتقون : يقول: فاحذروني بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي، فإن ذلك نجاتكم من الهلكة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ ) يقول: بالوحي.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) يقول: ينـزل الملائكة (10) .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفة، قال: ثنا شبل وحدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله، عن ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله ( بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ) إنه لا ينـزل ملك إلا ومعه روح.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، قال مجاهد: قوله ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ) قال: لا ينـزل ملك إلا معه روح ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) قال: بالنبوّة. قال ابن جريج: وسمعت أن الروح خلق من الملائكة نـزل به الروح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، في قوله ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاتَّقُونِ ) قال: كل كلِم تكلم به ربنا فهو روح منه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ... إلى قوله أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ) يقول: ينـزل بالرحمة والوحي من أمره، ( عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) فيصطفي منهم رسلا.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ( يُنـزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) قال: بالوحي والرحمة.
وأما قوله ( أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاتَّقُونِ ) فقد بيَّنا معناه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاتَّقُونِ ) إنما بعث الله المرسلين أن يوحد الله وحده، ويطاع أمره، ويجتنب سخطه.
------------------------
الهوامش:
(10) أي بنحو ما قبله ، من حديث المثنى عن ابن عباس ، كما جرت به عادة المؤلف في مواضع كثيرة .
التدبر :
وقفة
[2] ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن المراد بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح، كما أن الغذاء به حياة الأجسام، اللهم أحي قلوبنا بالقرآن.
وقفة
[2] ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ سمى الله الوحي روحًا؛ لأنه تحيا به النفوس.
وقفة
[2] ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ الروح التي تمد روحك الأولى بالحياة، بالضياء، بالاتساع، اللهم اسكب روح القرآن في أرواحنا.
لمسة
[2] ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ سماه روحًا؛ لأنه يحيي به القلوب، سمى الله الوحي روحًا؛ لأنه تحيا به النفوس.
وقفة
[2] من تدبر القرآن تبين له أن أعظم نعم الرب على العبد: تعليمه القرآن والتوحيد، تأمل: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1، 2]، فبدأ بها قبل نعمة الخلق، وهنا في سورة النحل التي هي سورة النعم: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، فهذه الآية أول نعمة عددها الله على عباده؛ لذا قال ابن عيينة: «ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله».
وقفة
[2] ﴿أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ من أشد ما يوقظ القلوب ويبعث فيها التقوى: كلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر كما في الحديث: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». [الترمذى 3383، وحسنه الألباني].
وقفة
[2] ﴿أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ فبَيَّنَ سبحانه الهدف الأسمى من إرسال الرسل.
الإعراب :
- ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي الله سبحانه. الملائكة: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ: ﴾
- أي بالوحي أو بالقرآن: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «الملائكة».من أمره: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «الروح» والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
- ﴿ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: ﴾
- حرف جر. من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى. يشاء: صلة الموصول لا محل لها تعرب اعراب «ينزل» و عَلى مَنْ» متعلق بينزل. من عباده: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الموصول «من» و «من» بيانية والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
- ﴿ أَنْ أَنْذِرُوا: ﴾
- أي بأن أنذروا الناس أو أهل الكفر وتقديره بأنه أنذروا: أي بأيّ شأن أقول لكم أنذروا. أنذروا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. و «أن» وما تلاها» بتأويل مصدر في محل جر بدل من الروح. وجملة «أنذروا» صلة «أن» لا محل لها. ويجوز أن تكون «أن» تفسيرية لأن تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول. ومعنى أنذروا أنه لا إله إلاّ أنا: اعلموا بأن الأمر ذلك من نذرت بكذا إذا علمته. والمعنى: اعلموا الناس قولي لا إله إلاّ أنا.
- ﴿ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا: ﴾
- أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «أنّ» وخبرها الجملة التالية من «لا» مع اسمها وخبرها في محل رفع. لا: أداة نافية للجنس تعمل عمل «إن» اله: اسم«لا» مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف وجوبا. الاّ: أداة استثناء. أنا: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع بدل من موضع لا إِلهَ» لأن موضع «لا» وما عملت فيه رفع بالأبتداء ولو كان موضع المستثنى منصوبا لكان إلاّ إياه.
- ﴿ فَاتَّقُونِ: ﴾
- الفاء: سببية. اتقون: تعرب اعراب «أنذروا» النون نون الوقاية والكسرة دالة على الياء المحذوفة اختصارا أو لأنها رأس آية. في محل نصب مفعول به. بمعنى: فخافوني. '
المتشابهات :
| النحل: 2 | ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِـ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا﴾ |
|---|
| غافر: 15 | ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كان استِعجالُ المُشرِكينَ للعذابِ استهزاءً بالنبي r وتكذيبًا له؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا صدقَ النبي r، فهو سبحانه ينزلُ الملائكةَ بالوحي إلى من يشاء من عباده، وهذه هي النعمة الأولى في هذه السورة التي تتحدث عن نعم الله: 1- نعمة الوحي، قال تعالى:
﴿ يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
ينزل:
قرئ:
1- مخففا، وهى قراءة ابن كثير، وأبى عمرو.
2- بالتشديد، وهى قراءة باقى السبعة، وزيد بن على، والأعمش.
3- تنزل، مشددا مبنيا للمفعول، و «الملائكة» بالرفع، وهى قراءة أبى بكر.
4- تنزل، بالتخفيف، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجحدري.
5- ننزل، بالنون والتشديد، وهى قراءة ابن أبى عبلة.
6- ننزل، بالنون والتخفيف، وهى قراءة قتادة.
قال ابن عطية، وفى هاتين الأخيرتين شذوذ كثير.
مدارسة الآية : [3] :النحل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى .. ﴾
التفسير :
هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق، ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما، وما له من نعوت الكمال ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه، بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به فقال:{ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} أي:تنزه وتعاظم عن شركهم فإنه الإله حقا، الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى، ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]ذكر خلق ما فيهما.
وبعد أن بين- سبحانه- أنه منزه عن أن يكون له شريك، وأنه قد أنزل الملائكة بوحيه على من يشاء من عباده، وأنه لا إله يستحق العبادة سواه.
بعد كل ذلك، بين الأدلة الدالة على قدرته ووحدانيته، بأسلوب بديع، جمع فيه بين دلالة المخلوق على الخالق، ودلالة النعمة على منعمها، ووبخ المشركين على شركهم، تارة عن طريق خلقه وحده- سبحانه- للسموات والأرض، وتارة عن طريق خلقه للإنسان، وتارة عن طريق خلقه للحيوان وللنبات، ولغير ذلك من المخلوقات التي لا تحصى.
قال- تعالى-: خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
والباء في قوله «بالحق» للملابسة. والحق: ضد الباطل، وهو هنا بمعنى الحكمة والجد الذي لا هزل فيه ولا عبث معه، كما قال- تعالى-: وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ. ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ... .
أى: خلق- سبحانه- بقدرته النافذة السموات وما أظلت، والأرض وما أقلت، خلقا ملتبسا بالحكمة الحكيمة، وبالجدية التي لا يحوم حولها لهو أو عبث.
وقوله: «تعالى عما يشركون» تنزيه وتقدير لذاته وصفاته، عما قاله المشركون في شأنه- عز وجل- من أن له ولدا أو شريكا.
قال- تعالى-: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ، إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ، وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ، سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ .
وقد صدر- سبحانه- هذه الأدلة الدالة على وحدانيته وقدرته، بخلق السموات والأرض، لأن خلقهما أعظم من خلق غيرهما، ولأنهما حاويتان لما لا يحصى من مخلوقاته- سبحانه-.
قال- تعالى-: لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات ، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت ، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث ، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) [ النجم : 31 ] .
ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره [ من الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون فكيف ناسب أن يعبد معه غيره ] وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له ، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له .
يقول تعالى ذكره معرّفا خلقه حجته عليهم في توحيده، وأنه لا تصلح الألوهة إلا له: خلق ربكم أيها الناس السموات والأرض بالعدل وهو الحقّ منفردا بخلقها لم يشركه في إنشائها وإحداثها شريك ولم يعنه عليه معين، فأنى يكون له شريك ( تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) يقول جلّ ثناؤه: علا ربكم أيها القوم عن شرككم ودعواكم إلها دونه، فارتفع عن أن يكون له مثل أو شريك أو ظهير، لأنه لا يكون إلها إلا من يخلق وينشئ بقدرته مثل السموات والأرض ويبتدع الأجسام فيحدثها من غير شيء، وليس ذلك في قُدرة أحد سوى الله الواحد القَّهار الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح الألوهة لشيء سواه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[3] ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ خصَّ الله السموات والأرض بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات، وهما أوضح ما يكون للناظرين؛ ولأنهما تشتملان على أصناف لا تُحصى من الخلق.
تفاعل
[3] ﴿تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ سَبِّح الله الآن.
الإعراب :
- ﴿ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ: : ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي الله سبحانه. السموات: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. والأرض:معطوفة بالواو على «السموات» منصوبة بالفتحة.
- ﴿ بِالْحَقِّ: ﴾
- جار ومجرور في محل نصب متعلق بصفة للمصدر. التقدير:خلقهما خلقا ملتبسا بالحق. أو في محل نصب حال.
- ﴿ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة الاولى. وفي هذه الآية الكريمة دليل على توحيده سبحانه. '
المتشابهات :
| الأنعام: 73 | ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوۡمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُۚ﴾ |
|---|
| ابراهيم: 19 | ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ وَيَأۡتِ بِخَلۡقٖ جَدِيدٖ﴾ |
|---|
| النحل: 3 | ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ |
|---|
| الزمر: 5 | ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِۖ﴾ |
|---|
| التغابن: 3 | ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : 2- النعمة الثانية: خلق السماواتِ والأرضِ، قال تعالى: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ/ ولَمَّا ذكَرَ اللهُ عز وجل أنَّه المُستقِلُّ بالخَلقِ وَحدَه لا شريكَ له، وكان لذلك يستحِقُّ أن يُعبَدَ وَحدَه لا شريكَ له، ولا يصِحُّ أن يُعبَدَ معه مَن لا يَقدِرُ على شَيءٍ؛ قال هنا: /تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3)
﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :النحل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا .. ﴾
التفسير :
{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ} لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة، حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها{ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ} يحتمل أن المراد:فإذا هو خصيم لربه، يكفر به، ويجادل رسله، ويكذب بآياته. ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به، من النعم فاستعان بها على معاصيه، ويحتمل أن المعنى:أن الله أنشأ الآدمي من نطفة، ثم لم يزل ينقله من طور، إلى طور حتى صار عاقلا متكلما، ذا ذهن ورأي:يخاصم ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها.
ثم ساق- سبحانه- دليلا آخر على انفراده بالألوهية عن طريق خلق الإنسان فقال:
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ، فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.
والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان.
وأصل النطفة: الماء الصافي. أو الماء القليل الذي يبقى في الدلو أو القربة، وجمعها: نطف ونطاف. يقال: نطفت القربة إذا قطرت، أى سال منها الماء وتقاطر.
والمراد بالنطفة هنا: المنى الذي هو مادة التلقيح من الرجل للمرأة.
والخصيم: الكثير الخصام لغيره، فهو صيغة مبالغة. يقال: خصم الرجل يخصم- من باب تعب- إذا أحكم الخصومة، فهو خصم وخصيم.
والمبين. المظهر للحجة، المفصح عما يريده بألوان من طريق البيان.
أى: خلق- سبحانه- الإنسان. من منىّ يمنى، أو من ماء مهين خلقا عجيبا في أطوار مختلفة، لا يجهلها عاقل، ثم أخرجه بقدرته من بطن أمه إلى ضياء الدنيا، ثم رعاه برعايته ولطفه إلى أن استقل وعقل.
حتى إذا ما وصل هذا الإنسان إلى تلك المرحلة التي يجب معها الشكر لله- تعالى- الذي رباه ورعاه، إذا به ينسى خالقه، ويجحد نعمه، وينكر شريعته، ويكذب رسله ويخاصم ويجادل بلسان فصيح من بعثه الله- تعالى- لهدايته وإرشاده، ويقول- كما حكى القرآن عنه-: مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ...
وإذا في قوله- سبحانه- فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. هي التي تسمى بإذا الفجائية التي يؤتى بها لمعنى ترتب الشيء، على غير ما يظن أن يترتب عليه.
وجيء بها هنا لزيادة التعجيب من حال الإنسان، لأنه كان المنتظر منه بعد أن خلقه الله- تعالى- بقدرته، ورباه برحمته ورعايته، أن يشكر خالقه على ذلك، وأن يخلص العبادة له، لكنه لم يفعل ما كان منتظرا منه، بل فعل ما يناقض ذلك من الإشراك والمجادلة في أمر البعث وغيره.
وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله- تعالى-: وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .
وقوله- تعالى-: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ، وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً .
ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة ) أي : ضعيفة مهينة ، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ، ويحارب رسله ، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا ، كما قال تعالى : وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ) [ الفرقان : 54 ، 55 ] وقال : ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) [ يس : 77 ، 79 ] .
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال : بصق رسول الله في كفه ، ثم قال : يقول الله : ابن آدم ، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد ، فجمعت ومنعت ، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق . وأنى أوان الصدقة ؟ .
يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم أيضا أيها الناس، أنه خلق الإنسان من نطفة، فأحدث من ماء مهين خلقا عجيبا، قلبه تارات خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما تمّ خلقه ونفخ فيه الروح، فغذاه ورزقه القوت ونماه، حتى إذا استوى على سوقه كفر بنعمة ربه وجحد مدبره وعبد من لا يضرّ ولا ينفع ، وخاصم إلهه ، فقال مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ونسِي الذي خلقه فسوّاه خلقا سويا من ماء مهين ، ويعني بالمبين: أنه يبين عن خصومته بمنطقه ، ويجادل بلسانه، فذلك إبانته ، وعنى بالإنسان: جميع الناس، أخرج بلفظ الواحد ، وهو في معنى الجميع.
التدبر :
وقفة
[4] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ كان نطفة لو سقطت في غير محلها لغُسلت، حتى إذا أمد الله في عمره اعترض على ربه!
وقفة
[4] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ خُلقتَ لِتكونَ عَبْدًا لا خَصْمًا!
وقفة
[4] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ يا ليت هذا المجادل في الله يتذكر أصله فقط!
وقفة
[4] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ لفتة للعقل البشري ليفكر في بعدين بينهما بعد كبير.
وقفة
[4] من نطفة مهينة قذرة إلى عاقل متكلم مجادل مخاصم ﴿مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾.
وقفة
[4] ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ بيان لنعمة عظيمة، وهي أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم ويبين عن ما في نفسه من سائر المخلوقات المحسوسة على وجه الأرض.
الإعراب :
- ﴿ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة السابقة. من نطفة:جار ومجرور متعلق بخلق أي من ماء قليل ليس به شعور ولا إدراك.
- ﴿ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ: ﴾
- الفاء: استئنافية. اذا: حرف فجاءة لا محل له من الإعراب ولا عمل لها. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. خصيم: خبر «هو» مرفوع بالضمة. مبين: صفة-نعت- لخصيم مرفوعة مثلها بالضمة. والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها من الاعراب. '
المتشابهات :
| النحل: 4 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ |
|---|
| الرحمن: 14 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ |
|---|
| العلق: 2 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿خَلَقَ الإنسانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإذا هو خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ نَزَلَتِ الآيَةُ في أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ الجُمَحِيِّ حِينَ جاءَ بِعَظْمٍ رَمِيمٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، أتَرى اللَّهَ يُحْيِي هَذا بَعْدَما قَدْ رَمَّ ؟نَظِيرُ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلُهُ تَعالى في سُورَةِ يس: ﴿أوَلَمْ يَرَ الإنسانُ أنّا خَلَقْناهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإذا هو خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: ٧٧] . إلى آخِرِ السُّورَةِ نازِلَةٌ في هَذِهِ القِصَّةِ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : 3- النعمة الثالثة: خلق الإنسانِ، قال تعالى:
﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :النحل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ .. ﴾
التفسير :
{ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ} أي:لأجلكم، ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها العظيمة أن لكم{ فِيهَا دِفْءٌ} مما تتخذون من أصوافها وأوبارها، وأشعارها، وجلودها، من الثياب والفرش والبيوت.{ وَ} لكم فيها{ مَنَافِعُ} غير ذلك{ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}
وبعد أن بين- سبحانه- ما يدل على وحدانيته وقدرته عن طريق خلقه للسموات وللأرض وللإنسان، أتبع ذلك ببيان أدلة وحدانيته وقدرته عن طريق خلق الحيوان فقال- تعالى-: وَالْأَنْعامَ خَلَقَها، لَكُمْ فِيها دِفْءٌ، وَمَنافِعُ، وَمِنْها تَأْكُلُونَ.
والأنعام: جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وقد تطلق على الإبل خاصة،.
وانتصب الأنعام عطفا على الإنسان في قوله: خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ، أو هو منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور بعده. أى: وخلق الأنعام خلقها.
والدفء: السخونة. ويقابله شدة البرد، يقال: دفئ الرجل- من باب طرب- فهو دفأ- كتعب- ودفآن، إذا لبس ما يدفئه، ويبعد عنه البرد.
والمراد بالدفء هنا: ما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها لهذا الغرض.
وعطف «منافع» على «دفء» من باب عطف العام على الخاص، إذ المنافع تشمل ما يستدفأ به منها وغيره.
وخص الدفء بالذكر من عموم المنافع، للعناية به وللتنويه بأهميته في حياة الناس.
أى: ومن مظاهر نعم الله- تعالى- عليكم- أيها الناس-، أن الله- تعالى- خلق الأنعام، وجعل لكم فيها ما تستدفئون به، من الثياب المأخوذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، فتقيكم برودة الجو وجعل لكم فيها منافع متعددة، حيث تتخذون من ألبانها شرابا سائغا للشاربين، ومن لحومها أكلا نافعا للآكلين.
وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها، وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ .
يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ، كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج ، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع ، من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون ، ومن ألبانها يشربون ، ويأكلون من أولادها ،
يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم أيها الناس ما خلق لكم من الأنعام، فسخَّرها لكم، وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس تدفئون بها ، ومنافع من ألبانها ، وظهورها تركبونها( وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) يقول: ومن الأنعام ما تأكلون لحمه كالإبل والبقر والغنم ، وسائر ما يؤكل لحمه ، وحذفت ما من الكلام لدلالة من عليها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، وعليّ بن داود، قال: المثنى أخبرنا، وقال ابن داود: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ) يقول: الثياب.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله.( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) يعني بالدفء: الثياب، والمنافع: ما ينفعون به من الأطعمة والأشربة.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء وحدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله، عن ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تعالى ( لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ) قال: لباس ينسج، ومنها مركب ولبن ولحم.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ) لباس ينسج ومنافع، مركب ولحم ولبن.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله ( لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ) قال: نسل كلّ دابة.
حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل بإسناده ، عن ابن عباس، مثله.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ) يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، قال: قال ابن عباس ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) قال: هو منافع ومآكل.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ) قال: دفء اللحف (11) التي جعلها الله منها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: بلغني، عن مجاهد ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ) قال: نتاجها وركوبها وألبانها ولحومها.
------------------------
الهوامش:
(11) اللحف : جمع لحاف ، وهو كل ما يلتحف به الإنسان للدفء ، من عباءة ، وكساء ، ونحوهما.
التدبر :
عمل
[5] ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ عندما ترتدي ملابسك الشتوية قل: الحمد لله .
عمل
[5] ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ اجمع النعم الواردة في سورة النحل، ثم تأمل فيها حتى تدرك مقصد هذه السورة؛ وهو تعداد النعم.
وقفة
[5] ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ مَلَّكَنا الله تعالى الأنعام والدواب وذَلَّلها لنا، وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها؛ رحمة منه تعالى بنا.
وقفة
[5] ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها.
لمسة
[5] ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (دفء) و(منافع)، ثم جاء التعبير بالمضارع في (تأكلون)؛ لأن الأكل عادة متكررة يوميًا، بينما الدفء موسمي، والمنافع الأخرى قد لا تتكرر، وقد تكون المنافع يومية لكن ليست لكل الناس.
وقفة
[5] ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، ﴿هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب﴾ [10]، ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ [14]، رزقنا الله من فضله وكرمه، نِّعم لا تعد ولا تحصى، من غير أن نسأله؛ فكيف إذا سألناه؟!
وقفة
[5] المؤمن إذا عاش البرد، أو سمع أخباره تذكر قوله تعالى في أول النحل: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، فهذه نعمته بالدفء، وأما نعمته بالوقاية من الحر فذكرها في أواخر النحل: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: 81]، إذ لما كانت الوقاية من البرد من أصول النعم ذكرت في أول السورة، ولما كانت الوقاية من الحر من مكملات النعم ذكرت بعد ذلك.
وقفة
[5]كل ما جاء في القرآن: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فهو في الدنيا، أي: ومنها تبيعون ومنها تدخرون، ومنها تأكلون، وذلك في: (النحل)، (المؤمنون)، (غافر)، أما قوله: ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [الزخرف: 73] فهذا في جنة الآخرة، والجنة ليس فيها بيع ولا ادخار ولا إهداء، وإنما يأكلون منها فحسب، وذلك في سورة الزخرف.
الإعراب :
- ﴿ وَالْأَنْعامَ خَلَقَها: ﴾
- الواو: عاطفة. الأنعام: مفعول به لفعل محذوف أي مضمر يفسره الظاهر أو ما بعده ويجوز أن يعطف على الانسان بتقدير: خلق الانسان والأنعام ثم قال ما خلقها لكم أي ما خلقها إلاّ لكم. خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها لأنها مفسرة. أو بتقدير وخلق الانعام خلقها.
- ﴿ لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة مقدمة من دفء ومنافع. فيها: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. دفء: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة والدفء: نتاج الابل. ومنافع: معطوفة بالواو على «دفء» مرفوعة مثلها بالضمة ولم تنون لأنها على وزن «مفاعل».
- ﴿ وَمِنْها تَأْكُلُونَ: ﴾
- الواو: عاطفة. منها: جار ومجرور متعلق بتأكلون. تأكلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وانّ تقديم معمول الفعل يوجب حصره فيه فالتقدير: وإنّما تأكلون منها. '
المتشابهات :
| النحل: 5 | ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ |
|---|
| المؤمنون: 21 | ﴿نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : 4- النعمة الرابعة: خلق الأنعامِ (فلَمَّا ذكَرَ اللهُ عز وجل خلْقَ الإنسانِ؛ ذكرَ هنا ما امتَنَّ به عليه في قِوامِ مَعيشتِه، فذكرَ أوَّلًا أكثَرَها منافِعَ، وألزَمَ لِمَن أُنزِلَ القرآنُ بلُغتِهم، وهي الأنعامُ)، قال تعالى: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا/ ولَمَّا امتنَّ اللهُ عز وجل بخلق الأنعامِ؛ ذكرَ هنا منافعها: 1) الدفء بالفُرْش المصنوعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها. 2) منافع كاللبن والجلود وغير ذلك. 3) الأكل من لحومها، قال تعالى: /لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5)
﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
دفء:
وقرئ:
1- بضم الفاء وشدها وتنوينها، وهذا بنقل الحركة من الهمزة إلى الفاء وحذفها ثم تشديد الفاء، إجراء للوصل مجرى الوقف، وهى قراءة الزهري، وأبى جعفر.
2- بنقل الحركة وحذف الهمزة دون تشديد التاء، وهى قراءة زيد بن على.
مدارسة الآية : [6] :النحل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ .. ﴾
التفسير :
{ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} أي:في وقت راحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون بها، كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم، وتعجبون بذلك
وقوله- سبحانه-: وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ بيان لنوع آخر من أنواع منافع الحيوان للإنسان.
قال أبو حيان في البحر والجمال مصدر جمل- بضم الميم-، يقال رجل جميل وامرأة جميلة وجملاء، قال الشاعر:
فهي جملاء كبدر طالع ... بذت الخلق جميعا بالجمال
والجمال يكون في الصورة بحسن التركيب، بحيث يدركه البصر فتتعلق به النفس.
ويكون في الأخلاق، باشتمالها على الصفات المحمودة، كالعلم والعفة والحلم.
ويكون في الأفعال، بوجودها ملائمة لمصالح الخلق. وجلب المنفعة لهم وصرف الشر عنهم..» .
وجمال الأنعام من النوع الأول، ومن جمالها- أيضا- كثرتها ودلالتها على أن صاحبها من أهل السعة واليسار.
وقوله «تريحون» من الإراحة، يقال: أراح فلان ماشيته إراحة، إذا ردها إلى المراح، وهو منزلها الذي تأوى إليه، وتبيت فيه.
و «تسرحون» من السروح، وهو الخروج بها غدوة من حظائرها إلى مسارحها ومراعيها.
يقال: سرحت الماشية أسرحها سرحا وسروحا، إذا أخرجتها إلى المرعى.
ومفعول الفعلين «تريحون وتسرحون» محذوف للعلم به.
والمعنى: ولكم- أيها الناس- في هذه الأنعام جمال وزينة، حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى معاطنها التي تأوى إليها، وحين تخرجونها بالغداة من معاطنها إلى مسارحها ومراعيها.
وخص- سبحانه- هذين الوقتين بالذكر، لأنهما الوقتان اللذان تتراءى الأنعام فيهما، وتتجاوب أصواتها ذهابا وجيئة، ويعظم أصحابها في أعين الناظرين إليها.
وقدم- سبحانه- الإراحة على التسريح، لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج، حيث تقبل من مسارحها وقد امتلأت بطونها، وحفلت ضروعها، وازدانت مشيتها.
وقال- سبحانه-: حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. بالفعل المضارع، لإفادة التجديد والتكرار، وفي ذلك ما يزيد السرور بها، ويحمل على شكر الله- تعالى- على وافر نعمه.
قال صاحب الكشاف: «منّ الله بالتجمل بها، كما منّ بالانتفاع بها لأنه من أغراض أصحاب المواشي. بل هو من معاظمها لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي، وسرحوها بالغداة فزينت إراحتها وتسريحها الأفنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء، آنست أهلها، وفرحت أربابها. وأجلتهم في عيون الناظرين إليها، وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس.
فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسريح- مع تأخر الإراحة في الوجود؟.
قلت: لأن الجمال في الإراحة أظهر، إذا أقبلت ملأى البطون، حافلة الضروع، ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها» .
وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ولهذا قال : ( ولكم فيها جمال حين تريحون ) وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى فإنها تكون أمده خواصر ، وأعظمه ضروعا ، وأعلاه أسنمة ، وحين تسرحون ) أي : غدوة حين تبعثونها إلى المرعى .
يقول تعالى ذكره: ولكم في هذه الأنعام والمواشي التي خلقها لكم (جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ) يعني: تردّونها بالعشيّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التي تأوي إليها ولذلك سمي المكان المراح، لأنها تراح إليه عشيا فتأوي إليه، يقال منه: أراح فلان ماشيته فهو يريحها إراحة ، وقوله (وَحِينَ تَسْرَحُونَ) يقول: وفي وقت إخراجكموها غدوة من مُراحها إلى مسارحها، يقال منه: سرح فلان ماشيته يسرحها تسريحا، إذا أخرجها للرعي غدوة، وسَرحت الماشية: إذا خرجت للمرعى تسرح سرحا وسروحا، فالسرح بالغداة ، والإراحة بالعشيّ ، ومنه قول الشاعر:
كــأنَّ بَقايــا الأتْـنِ فَـوْقَ مُتُونِـهِ
مـدَّبُّ الـدَّبىّ فَـوْقَ النَّقا وَهْوَ سارِحُ (12)
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاما ضروعها ، طوالا أسنمتها، وحين تسرحون إذا سرحت لرعيها.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) قال: إذا راحت كأعظم ما تكون أسنمة، وأحسن ما تكون ضروعا.
------------------------
الهوامش:
(12) لعل الشاعر يصف حمارًا وحشيًا . يقول : إن الأتن قد عضضنه ، فتركن فوق متونة آثارًا ، كانت كأنها طريق للدبى ، وهو صغار الجراد . فوق النقا ، وهو الكثيب الأبيض من الرمل . ولم أعثر على البيت ولا قائله .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ولكم في هذه الأنعام زينة حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى منازلها التي تأوي إليها، وحين إخراجها من منازلها إلى مسارحها، وخصص هذين الوقتين بالذكر، حيث يتجاوب ثغاؤها ورغاؤها حين الذهاب والإياب فتعظم في أعين الناظرين.
وقفة
[6] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ فإن قال قائل: لم قدَّم الرواح، والسراح هو المقدَّم؟ الرواح: رجوعها بالعشيِّ من المراعي، والسراح: مسيرها إلى مراعيها بالغداة، وقدَّم الإراحة على التسريح؛ لأن منظرها عند الإراحة أجمل، وذواتها أحسن لكونها في تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب، فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها، وخصَّ هذين الوقتين؛ لأنهما وقت نظر الناظرين إليها، لأنها عند استقرارها في الحظائر لا يراها أحد، وعند كونها في مراعيها هي متفرِّقة غير مجتمعة كل واحد منها يرعى في جانب.
وقفة
[6] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ قسوة الصحراء وتعب الرعي ونفوس تواقة للجمال أيضًا.
وقفة
[6] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ فيه أن التجمل ببهائم الأنعام وإظهار النعمة بذلك، من الأمور الجائزة، وفيه أن من مقاصد اتخاذ بهائم الأنعام جمالها في غدوها ورواحها، وفيه جواز شرائها وبيعها لأجل جمالها؛ لظاهر الآية.
وقفة
[6] إذا أردت أن تستمتع بالجمال المشروع؛ فانظر إلى الأنعام وهي تغدو وتروح ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ: ﴾
- الواو عاطفة. لكم: جار ومجرور والميم علامة جمع الذكور. فيها: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. جمال: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. حين: مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة بمعنى «المدة» أو الوقت عموما.
- ﴿ تُرِيحُونَ: ﴾
- الجملة في محل جر بالاضافة بمعنى حين تريحون فيه: وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.
- ﴿ وَحِينَ تَسْرَحُونَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «تريحون» وتعرب إعرابها. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : 4) الجمال والزينة، قال تعالى:
﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء