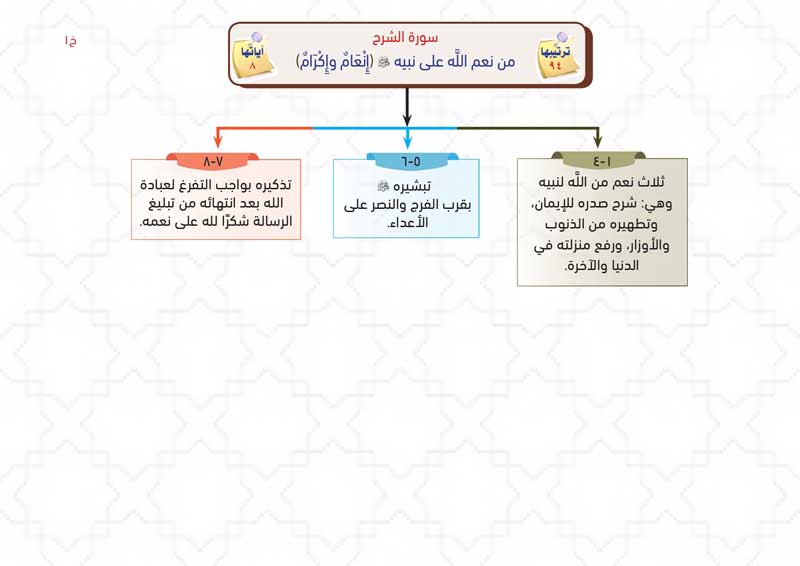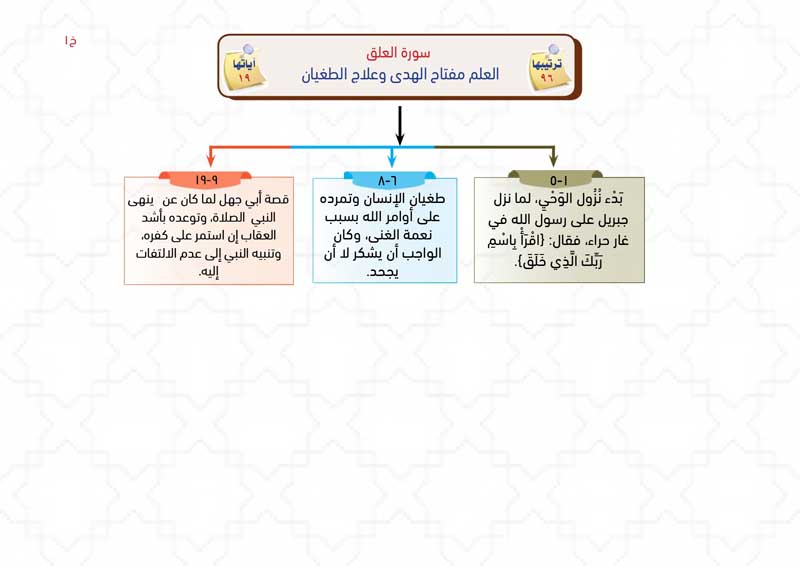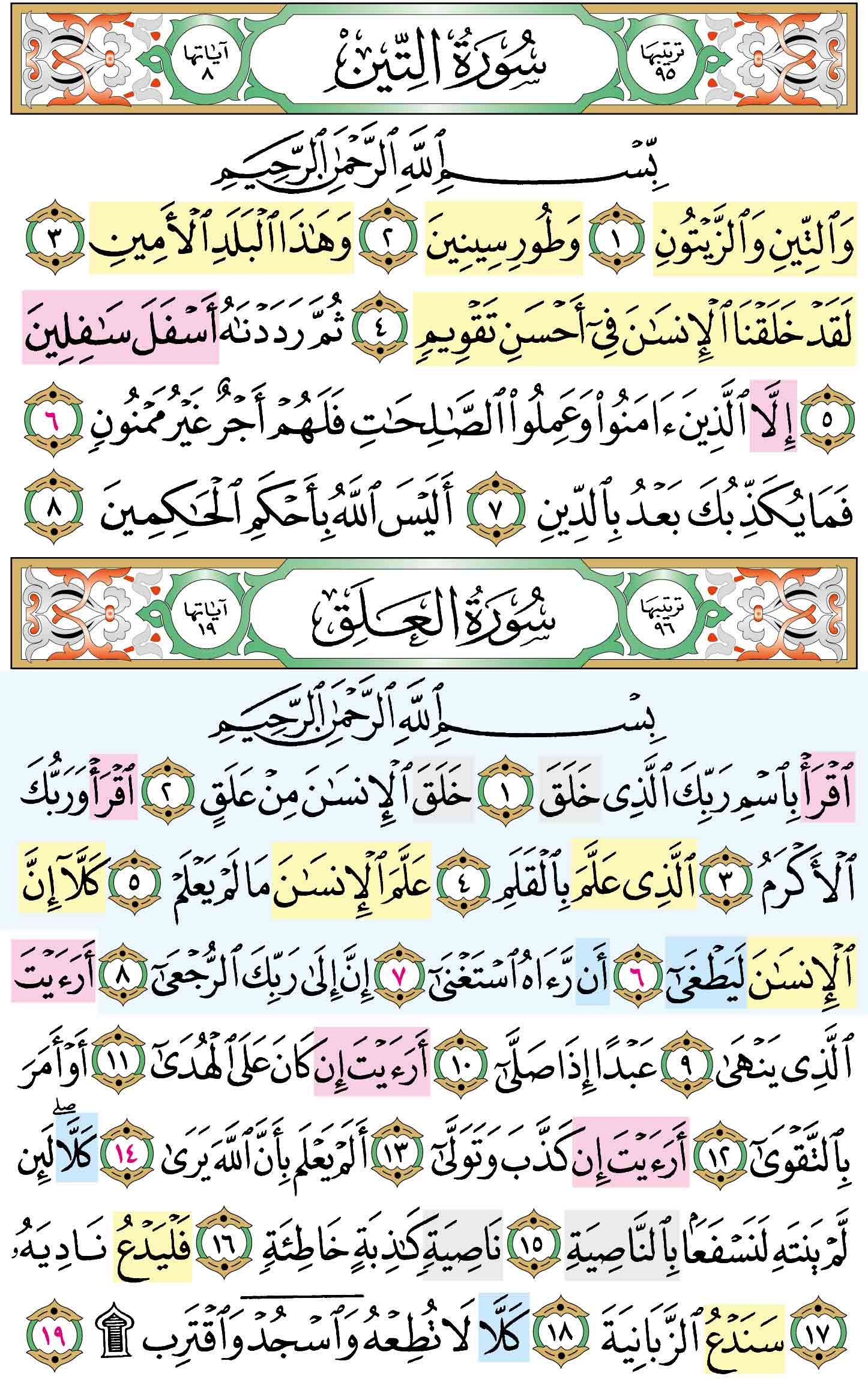
الإحصائيات
سورة الشرح
| ترتيب المصحف | 94 | ترتيب النزول | 12 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.30 |
| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |
| ترتيب الطول | 104 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الاستفهام: 4/6 | _ | ||
سورة التين
| ترتيب المصحف | 95 | ترتيب النزول | 28 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.40 |
| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |
| ترتيب الطول | 97 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| القسم: 15/17 | _ | ||
سورة العلق
| ترتيب المصحف | 96 | ترتيب النزول | 1 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.60 |
| عدد الآيات | 19 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |
| ترتيب الطول | 91 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 1 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الأمر: 2/6 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)
تكريمُ الإنسانِ وخلقُه في أحسنِ صورةٍ، ثُمَّ زجُّه في جهنَّمَ بسببِ كفرِه، واستثناءُ الذينَ آمنُوا، ثُمَّ توبيخُ الكُفَّارِ لتكذيبِهم بالجَزاءِ بعدَ البعثِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)
(أَوَّلُ ما نَزَلَ من الْقُرْآنِ) بيانُ بعضِ نِعمِ اللهِ: خلقُ الإنسانِ وتعليمُه القراءةَ والكتابةَ، ثم طغيانُ الإنسانِ بسببِ نعمةِ الغِنَى.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثالث
من الآية رقم (9) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (11)
مثالٌ لِمَنْ طَغَى: أبو جهلٍ الذي كانَ يَنْهى النَّبي ﷺ عن الصَّلاةِ، وتوعُّدُه بأشدِّ العِقابِ إن استمرَّ على كفرِه، وتنبيهُ النَّبي ﷺ إلى عدمِ الالتفاتِ إليه.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الشرح
من نعم اللَّه على نبيه ﷺ (إِنْعَامٌ وإِكْرَامٌ)
أولاً : التمهيد للسورة :
- • نقاط السورة: السورة تدور حول : سورة الضحى وسورة الشرح وسورة الكوثر سور مليئة بمحبة الله تعالى لرسوله الكريم وكأنها تعويض عن عتاب الله الرقيق لرسوله في سورة عبس، وهي تتناول شخصية الرسول وما أنعم الله تعالى عليه من النعم في الدنيا والآخرة.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الشرح».
- • معنى الاسم :: الشرح: البسط والتوسعة، وشرح الله صدره: وسعه لقبول الحق.
- • سبب التسمية :: لأنه مصدر الفعل الواقع في أولها.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الِانْشِرَاحِ»، و«سورة أَلَمْ نَشْرَحْ».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: منة الله على نبيه ﷺ بشرح صدره: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾
- • علمتني السورة :: إذا كان وزره -وهو المعصوم ﷺ- قد أثقل ظهره، فكيف بذنوبنا؟! وتعظم مصيبةُ مَن لا يحس بثقل ذنوبه وهي كالجبال!
- • علمتني السورة :: أن الأوزار تتعب الظهر, فاللهم خفف عن ظهورنا: ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾
- • علمتني السورة :: إذا رفع الله ذكرك فلا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من قدرك أو تخدش سمعتك: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الشرح من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الشرح من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الشرح شديدة الاتصال بسورة الضحى السابقة، حيث إن السورتين خاصتان بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيهما تعداد نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، مع تطمينه وحثه على العمل والشكر.
• افتتحت سورة البقرة وغيرها بـ (الم)، وافتتحت سورة الشرح بـ (ألم)، إلا أن قراءتهما مختلفة، وهذا يدل على أهمية تلقي القرآن مشافهة وعدم الاكتفاء بقراءته من المصحف مباشرة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نسعى إلى تحصيل نعمة شرح الصدر بالإقبال على كتاب الله تعلُّمًا وتعليمًا: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (1).
• أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي؛ لأن ذلك من أسباب ضيق الصدر، ونكد العيش: ﴿ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (2) ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ﴾ (2، 3).
• أن نداوم على ذكر الله سبحانه علمًا وعملًا لننال الرفعة من الله، ونلحق بنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (4).
• أن نثق بالله تعالى ونتوكل عليه، ولا نيأس من روحه وفرَجه، بل لنوقن أن الله سبحانه جاعل لأمتنا فرجًا ومخرجًا مما هي فيه: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (5، 6).
• أن نحرص على استغلال الأوقات؛ بأن نشغل الفراغ بكل ما يعود بالنفع علينا في الدنيا والآخرة: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ (7).
• أن نخلص لله في كل عباداتنا، ونطلب وجهه فقط ونرجو ما عنده من الثواب: ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (8).
سورة التين
تكريم الله تعالى للإنسان (قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله بتخلّيه عنه)
أولاً : التمهيد للسورة :
- • رسالة السورة:: السورة تدور حول: سورة التين تدور حول رفعة الإنسان بإيمانه وعمله الصالح، وسفوله وهوانه بتركهما.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «التين».
- • معنى الاسم :: --
- • سبب التسمية :: لأن الله أقسم في مطلعها بالتين.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن الله قد شرَّف بقاعًا فأنزل فيها وحيه: التوراة والإنجيل والقرآن: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾
- • علمتني السورة :: أن اللهَ كَرَّمَ ابن آدم فخلقه على أكمل ما يكون من الخلقة الظاهرة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
- • علمتني السورة :: ليكن من دعائك: اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي؛ فَحَسِّنْ خُلُقِي
- • علمتني السورة :: أن هذا الإنسان الذي خلقه الله وجمل صورته؛ إن لم يهده الله فهو في مرتبة أسفل من مرتبة الأنعام: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة التين من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة التين من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة التين، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (8) وما شابهه من القرآن، أن يقول: (بلى)، فعن عبد الرحمن بن القاسم قال: قال أبو هريرة: «...ومن قرأ: ﴿وَٱلتّينِ وَٱلزَّيْتُونِ﴾ فانتهى إلى آخرها، أو بلغ آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ فليقل: بلى».
و(بلى) حرف يجاب به النفي، وهي تنفي النفي، فيصير ما بعده مثبتًا، فصار الكلام بعد الإثبات: «الله أحكم الحاكمين».
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نعمرَ قلوبنا بالوحي؛ لننال كل الخير والبركة، والشرف والرفعة: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾ (1-3).
• أن لا نكتفي بالحفاظ على أجسادنا وصورنا ظاهرًا، وإنما نحافظ على فطرتنا السليمة التي فطرنا الله عليها باطنًا ولا نلوِّثها بالاعتقادات الباطلة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (4).
• أن نطلب أسباب الهداية لنخرج من الظلمات إلى النور، ولنرتقي من الدرك الأسفل إلى المنزلة العليا، منزلة العبودية لله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (5).
• أن نجتهد في عمل الصالحات لنفوز بالجنة ونعيمها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (6).
• أن نتفكّر بعقولنا التي ميزنا الله بها في علامات قدرته الدالة على عظمة الخالق المبدع، فإنّ هذا التفكير سيقودنا إلى الإيمان بيوم الحساب والجزاء: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ (7).
• أن نؤمن بعدل الله وحكمته بجعل يوم القيامة يومًا للجزاء؛ فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (8).
سورة العلق
العلم مفتاح الهدى وعلاج الطغيان
أولاً : التمهيد للسورة :
- • نقاط السورة: أسئلة قد تقفز إلى الذهن: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين أصير؟ من أوجدني؟ ولماذا أوجدني؟ سورة العلق تجيبك.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة العلق»، و«سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».
- • معنى الاسم :: العلق: جمع علقة، وهي: قطعة دم غليظ أحمر.
- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لَفْظِ «الْعَلَقِ» فِي أَوَائِلِهَا.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة اقْرَأْ»، و«القلم».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أهمية القراءة والكتابة في الإسلام
- • علمتني السورة :: أن اللهَ خلقَ الإنسانَ من ضعف ثم رَفَعَه بقراءة الوحي والعلم وهَدَاهُ إلى أدوات التعلم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾
- • علمتني السورة :: تعلّم العلم وتعليمه وضبط شوارده بأدوات العلم، فإن ربك الأكرم، إن أخلصت له زادك علمًا وأجرًا: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾
- • علمتني السورة :: أن العلم من الله، وهو العليم، فالموحد يطلب العلم منه سبحانه، بالتوكل عليه واستمداد العلم من كتابه وسنة نبيه: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ آخِرَ كَلَامٍ كَلَّمَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ: خَفِّفْ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى وَقَّتَ لِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُرْآنِ.
• عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة العلق من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة العلق من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • صدر سورة العلق هو أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق.
• احتوت سورة العلق على السجدة الخامسة عشرة من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف-، وجاءت في آخر السورة في الآية (19)، وهي آخر سجدات التلاوة في ترتيب المصحف.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتعلم العلم من الكتاب والسنة لنخرج من الظلمات إلى النور، ولنرقى من الضعف إلى القوة: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (1، 2).
• أن نقرأ القرآن مع استشعار معية الله وتوفيقه، وأن نأخذ بأسباب العلم لاستجلاب المكرمات الإلهية: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (3، 4).
• ألا نفخر بما لدينا من علم، ولا نكتمه عن متعلم؛ لأنه نعمة من الله تفضل علينا بها بلا حول منا ولا قوة: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (5).
• أن نتفكر في مآلنا ومصيرنا؛ فإن ذلك أدعى ألا نتجاوز حدود الله ولا نغتر بما أنعم الله علينا من مال: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ * إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (6-8).
• أن نسلك سبيل الرسل، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونُبصر الناس بدينهم: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (9، 10).
• أن نراقب الله في أفعالنا وأقوالنا؛ فإنّ من راقب الله امتثل لأمره وابتعد عن معصيته، فهو سبحانه يرى أفعالنا ويسمع كلامنا: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ (14).
• أن نجتهد في القرب من مرضاة الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه؛ فهو سبحانه سينتقم لنا ممن يحاول منعنا من إقامة شعائر ديننا: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩﴾ (19).
تمرين حفظ الصفحة : 597
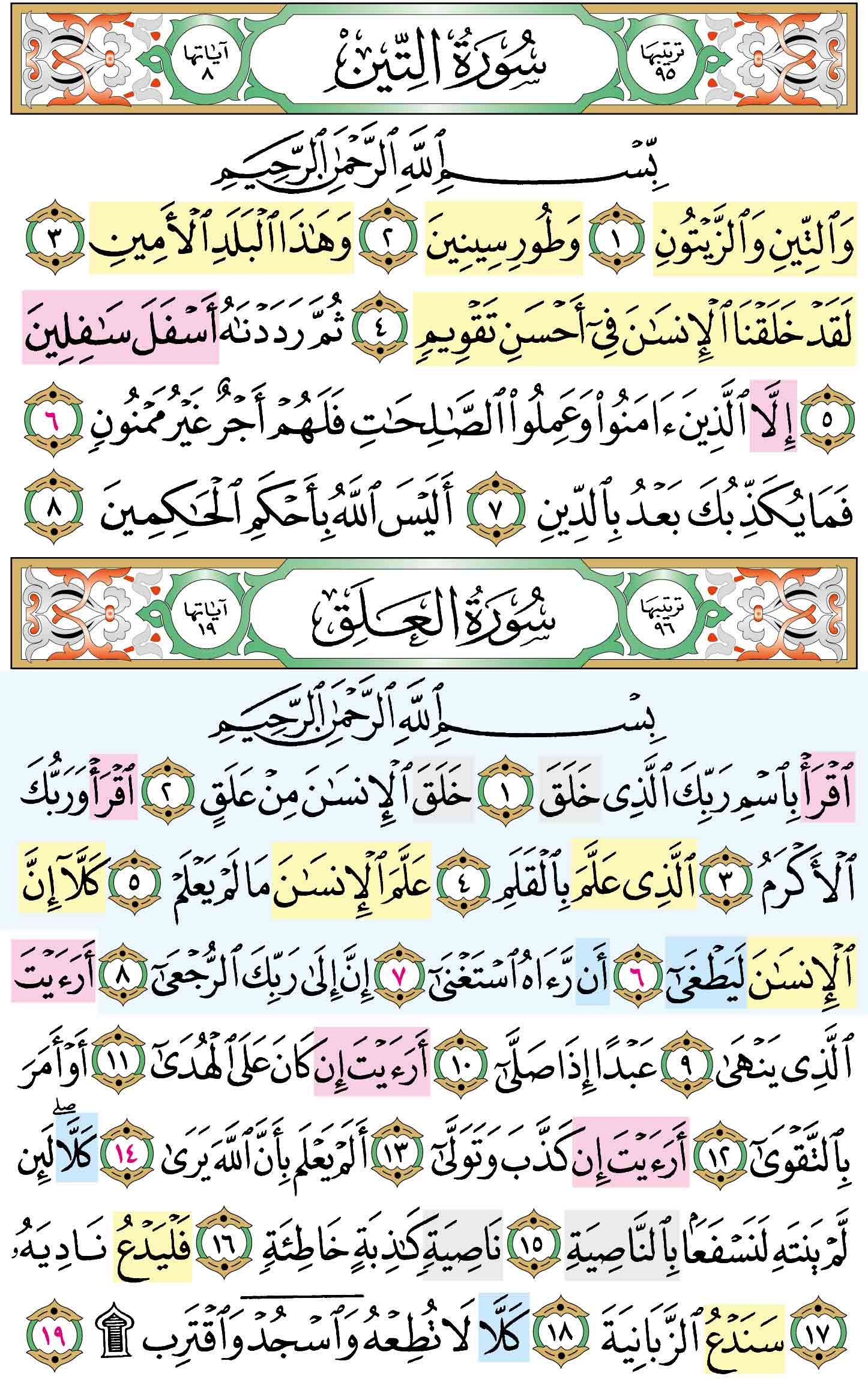
مدارسة الآية : [3] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾
التفسير :
{ الَّذِي أَنْقَضَ} أي:أثقل{ ظَهْرَكَ} كما قال تعالى:{ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} .
وأَنْقَضَ ظَهْرَكَ أى: أثقله وأوهنه وأتعبه، حتى سمع له نقيض، وهو الصوت الخفى الذي يسمع من الرّحل الكائن فوق ظهر البعير، إذا كان هذا الرحل ثقيلا، ولا يكاد البعير يحمله إلا بمشقة وعسر.
والمعنى: لقد شرحنا لك- أيها الرسول الكريم- صدرك، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة، وعصمناك من الذنوب والآثام، وطهرناك من الأدناس، فصرت- بفضلنا وإحساننا- جديرا بحمل هذه الرسالة، بتبليغها على أكمل وجه وأتمه.
فالمراد بوضع وزره عنه صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنوبه، وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله: قوله- تعالى-: وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ بمعنى لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ.
وقال غير واحد من السلف في قوله: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ أى: أثقلك حمله ... .
ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه صلى الله عليه وسلم: إزالة العقبات التي وضعها المشركون في طريق دعوته، وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه، ورفع الحيرة التي كانت تعتريه قبل النبوة.
قال بعض العلماء: وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر في هذه الآية: الذنب، ثم راحوا يتأولون الكلام، ويتمحلون الأعذار، ويختلفون في جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصي، وكل هذا كلام، ولا داعي إليه، ولا يلزم حمل الآية عليه.
والمراد- والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم- بالوزر: الحيرة التي اعترته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حين فكر فيما عليه قومه من عبادة الأوثان. وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو الجدير بالعبادة، ثم تحير في الطريق الذي يسلكه لعبادة هذا الخالق، وما زال كذلك حتى أوحى الله إليه بالرسالة فزالت حيرته. ولما دعا قومه إلى عبادة الله، وقابلوا دعوته بالإعراض ...
ثقل ذلك عليه، وغاظه من قومه أن يكذبوه ... وكان ذلك حملا ثقيلا ... شق عليه القيام به.
فليس الوزر الذي كان ينقض ظهره، ذنبا من الذنوب ... ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه، ألم ذلك الثقل الحسى ... فلما هداه الله- تعالى- إلى إنقاذ أمته من أوهامها الفاسدة ... كان ذلك بمثابة رفع الحمل الثقيل، الذي كان ينوء بحمله. لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل التمثيل، واقرأ إن شئت قوله- تعالى-: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
ويبدو لنا أن هذا القول الثاني، هو الأقرب إلى الصواب. لأن الكلام هنا ليس عن الذنوب التي ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة- كما يرى بعض المفسرين- وإنما الكلام هنا عن النعم التي أنعم بها- سبحانه- عليه والتي من مظاهرها توفيقه للقيام بأعباء الرسالة، وبإقناع كثير من الناس بأنه على الحق، واستجابتهم له صلى الله عليه وسلم.
( الذي أنقض ظهرك ) الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف في قوله : ( الذي أنقض ظهرك ) أي : أثقلك حمله .
( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) قال: أثقل ظهرك.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) : كانت للنبيّ صلى الله عليه وسلم &; 24-494 &; ذنوب قد أثقلته، فغفرها الله له.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) قال: كانت للنبي: ذنوب قد أثقلته، فغفرها الله له.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ) يعني: الشرك الذي كان فيه.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ) قال: شرح له صدرَه، وغفر له ذنبَه الذي كان قبل أن يُنَبأ، فوضعه.
وفي قوله: ( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) قال: أثقله وجهده، كما يُنْقِضُ البعيرَ حِمْلُه الثقيل، حتى يصير نِقضا بعد أن كان سمينا( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ) قال: ذنبك الذي أنقض ظهرَك، أثقل ظهرك، ووضعناه عنك، وخفَّفنا عنك ما أثقل ظهرَك.
التدبر :
اسقاط
[3] ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ إذا كان وزره قد أثقلَ ظهرَه، فكيف بذنوبنا؟!
وقفة
[3] ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ أي: أثقل ظهرك, ففي الآية دلالة على أن الأوزار تتعب الظهر, فاللهم خفف عن ظهورنا.
وقفة
[3] ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ ثقل الظهر يمنع من قطع مسافة السفر، وكذلك الأوزار تمنع القلب من السير إلى الله، وتثقل الجوارح من النهوض للطاعة.
وقفة
[3] ﴿الَّذي أَنقَضَ ظَهرَكَ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: «هُوَ أنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلام شُقَّ صَدْرُهُ فَأخْرَجَ مِنهُ قَلْبَهُ فَشَرَحَهُ وأخْرَجَ مِنهُ عَلَقَةً سَوْداءَ فَأنْقاهُ وغَسَلَهُ ثُمَّ مَلَأهُ عِلْمًا وإيمانًا وحِكْمَةً»، يَعْنِي فَصارَ يَحْتَمِلُ ما لا يَحْتَمِلُهُ غَيْرُهُ.
وقفة
[3] سر قوله: ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ يفيد عظم ما كان يحمله ﷺ من الهم والحرص الشديد.
وقفة
[1-3] عن حفص بن حميد قال: قال لي زياد بن حدير: اقرأ علي، فقرأت عليه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾، فقال: «يا ابن أم زياد، أنقض ظهر رسول الله؟!»، أي: إذا كان الوزر أنقض ظهر الرسول فكيف بك؟! فجعل يبكي كما يبكي الصبي.
الإعراب :
- ﴿ الَّذِي: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة- نعت- للوزر أي حملك الثقيل الذي.
- ﴿ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ: ﴾
- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الفتح. ظهرك: تعرب إعراب «صدرك» اي أثقل ظهرك اي أثقلك وفاعل «أنقض» ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ الوزرَ؛ وَصَفَه هنا، قال تعالى:
﴿ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾
التفسير :
{ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} أي:أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره، بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.
وقوله- سبحانه-: وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ بيان لنعمة ثالثة من نعمه- تعالى- على نبيه صلى الله عليه وسلم. أى: لقد شرحنا لك- أيها الرسول الكريم- صدرك، وأزلنا عن قلبك الحيرة التي كانت تعتريك قبل تبليغ الرسالة وبعد تبليغها، بأن يسرنا لك كل صعب.
وفوق ذلك فقد رفعنا لك ذكرك، بأن جعلناك رفيع الشأن، سامى المنزلة، عظيم القدر، ومن مظاهر ذلك: أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين.
وفي الأذان، وفي الإقامة، وفي التشهد، وفي غير ذلك من العبادات، وأننا فضلناك على جميع رسلنا، بل على جميع الخلق على الإطلاق، وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى، وجعلنا طاعتك من طاعتنا.
قال الآلوسى: أخرج أبو يعلى، وابن جرير ... عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتانى جبريل فقال لي: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟
قلت: الله- تعالى- أعلم. قال: «إذا ذكرت ذكرت معى» .
وقوله : ( ورفعنا لك ذكرك ) قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .
وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .
قال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال : إذا ذكرت ذكرت معي " ، وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن يونس بن عبد الأعلى به ، ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة ، عن دراج .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته ، قلت : قد كانت قبلي أنبياء ، منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى . قال : يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا رب . قال : ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب " .
وقال أبو نعيم في " دلائل النبوة " : حدثنا أبو أحمد الغطريفي ، حدثنا موسى بن سهل الجوني ، حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي ، حدثنا نصر بن حماد ، عن عثمان بن عطاء ، عن الزهري ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت : يا رب ، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته ، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما ، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين ، وأحييت لعيسى الموتى ، فما جعلت لي ؟ قال : أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله ، أني لا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرءون القرآن ظاهرا ، ولم أعطها أمة ، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " .
وحكى البغوي ، عن ابن عباس ومجاهد : أن المراد بذلك : الأذان . يعني : ذكره فيه ، وأورد من شعر حسان بن ثابت :
أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه
إذا قال في الخمس المؤذن : أشهد وشق له من اسمه ليجله
فذو العرش محمود وهذا محمد
وقال آخرون : رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ، ونوه به ، حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به ، وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه .
وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله :
لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي
وقال أيضا :
[ ألم تر أنا لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما ]
وقوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) يقول: ورفعنا لك ذكرك، فلا أُذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ معي، وذلك قول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب وعمرو بن مالك، قالا ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) قال: لا أُذْكَرُ إلا ذُكْرِتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " ابْدَءُوا بالعُبُودَةِ، وَثَنُّوا بالرسالة " فقلت لمعمر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده، فهو العبودة، ورسوله أن تقول: عبده ورسوله.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب، ولا متشهد، ولا صاحب صلاة، إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن درّاج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أتانِي جِبْرِيلُ فَقالَ إنَّ رَبِّي وَرَبكَ يَقُولُ: كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ ؟ قال: الله أعْلَمُ، قال: إذَا ذُكِرْتُ ذُكرتَ مَعِي".
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ما صور رفع ذكره؟ في الشهادتين، في الأذان، في المقام المحمود، في الشفاعة، ذكره الحسن على الألسن، في الصلاة عليه.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ما سر قوله (ورفعنا) دون (ونشرنا)؟ يفيد أنه أرفع الخلق ذكرًا، ولذلك قرن الله اسمه باسمه.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ إذا كان الله ﷻ رفع مقام نبيِّه إلى أعلى مقام فنحن من باب أولى أن نعظِّمه ونوقِّره ونصلي عليه ﷺ.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ إذا رفع الله ذكرك فلا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من قدرك أو تخدش سمعتك.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ مهما علا نِباحهم وسخروا؛ فلن يخفضوا من رفع الله ذكره.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ لا يرجم أحدٌ الثريا إلا عاد رجمه عليه ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الكوثر: 3].
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ إذا كان الله هو الذي رفع مقام نبيه إلى أعلى مقام؛ فلا تستطيع أي قوة أن تسقطه ﷺ.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمهِ...إذا قَالَ في الخَمْسِ المُؤذِّنُ أشْهَدُ
وشقّ لهُ منِ اسمهِ ليجلهُ ... فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ كل من أحب سنة النبي ﷺ ونشرها؛ فله نصيب من رفعة الذكر وعلو الشأن، فأكثروا عليه من الصلاة والسلام ﷺ.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ من اعتنى بجناب الله؛ اعتنى الله بجنابه، ومن عظم الله في قلبه؛ عظمه الله بقلوب عباده، ومن رفعه الله؛ فلا خافض له.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ رفع الله ذكر نبيه بالشهادتين، وفي الأذان، وبالمقام المحمود، وبصلاته وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين عليه، وأنه اختصه بالشفاعة.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ يدل على رفعة ذكر أتباعه؛ لأن الله يرفع بهم ذكر نبيه عليه السلام.
وقفة
[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملًا دون تحوير سوى القرآن الذي نقله محمد صلى الله عليه وسلم.
وقفة
[4] أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول؛ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، وأهل البدعة شنئوا ما جاء به الرسول؛ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3].
وقفة
[4] المؤمن يرفع الله ذكره؛ تكريمًا له ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.
وقفة
[4] كما أن الشانئ والشاتم هو الأنقص والأبتر، فإن من حمى جناب النبي ﷺ، ودافع عنه، له نصيب وافر من الرفعة وعلو المكانة، نظرا لعلو ورفعة منزلة من دافع عنه، تدبر: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.
وقفة
[4] قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، قال قتادة: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله».
وقفة
[4] معنى قولك: (اللهم صل على محمد): اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى، أي: اذكره بصفات الكمال في الملأ الأعلى، وهذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله به في قوله: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾.
وقفة
[4] قال تعالى مخاطبًا الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، اليوم لو وزعت مواقيت الصلاة في العالم على دقائق اليوم، وتأملت في اختلاف المواقيت على وجه الأرض لوجدت أن في كل لحظة هناك من ينادي: (أشهد أن محمدًا رسول الله)، سبحان من صدق وعده ورفع ذكر حبيبه!
وقفة
[2-4] من القواعد العامة" (التخلية قبل التحلية)، وقد وردت في القرآن كثيرًا في مثل قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وهذا مقام التخلية، فلما خلاَّه بوضع الوزر عنه حلاَّه برفع الذكر: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، واعتبر هذا في القرآن في كلمة التوحيد وغيرها تجده كثير الوقوع في القرآن.
الإعراب :
- ﴿ وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾
- تعرب اعراب الآية الكريمة الثانية ورفع ذكره أي قرن بذكر الله في كلمة الشهادة والاذان وفي مواضع من القرآن وفي تسميته رسول الله.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٣- رفعُ منزلتِه في الدُّنيا والآخرةِ، قال تعالى:
﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾
التفسير :
{ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى:{ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا ".
وتعريف "العسر "في الآيتين، يدل على أنه واحد، وتنكير "اليسر "يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.
وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له.
ثم أضاف- سبحانه- إلى هذه النعم الجليلة، ما يدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم وما يبعث الأمل في نفسه وفي نفوس أصحابه، بأن بين لهم سنة من سننه التي لا تتخلف فقال:
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.
والفاء للإفصاح، ومع بمعنى بعد، وأل في العسر لاستغراق أنواع العسر المعروفة للمخاطبين. من فقر، وضعف، وقلة في الوسائل التي تؤدى إلى إدراك المطلوب. والجملة الثانية مؤكدة ومقررة للجملة الأولى. والتنكير في قوله يُسْراً للتفخيم.
والمعنى: إذا تقرر عندك ما أخبرناك به، من شرح الصدر، ووضع الوزر. ورفع الذكر ...
فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر، وما من شدة إلا ويأتى بعدها الفرج، وما من غم أو هم، إلا وينكشف، وتحل محله المسرة ... وما دام الأمر كذلك، فتذرع أنت وأصحابك بالصبر، واعتصموا بالتوكل على الله، فإن العاقبة لكم.
ففي هاتين الآيتين ما فيهما من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، ومن وعد صادق بأن كل صعب يلين، وكل شديد يهون، وكل عسير يتيسر. متى صبر الإنسان الصبر الجميل، وتسلح بالعزيمة القوية، وبالإيمان العميق بقضاء الله- تعالى- وقدره.
وأكد- سبحانه- هاتين الآيتين، لأن هذه القضية قد تكون موضع شك، خصوصا بالنسبة لمن تكاثرت عليهم الهموم وألوان المتاعب، فأراد- سبحانه- أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان، أن اليسر يعقب العسر لا محالة، والفرج يأتى بعد الضيق، فعلى المؤمن أن يقابل المصائب بصبر جميل، وبأمل كبير في تيسير الله وفرجه ونصره.
وقال- سبحانه- مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ولم يقل بعد العسر يسرا، للإشعار بأن هذا اليسر، ليس بعد العسر بزمن طويل، وإنما هو سيأتى في أعقابه بدون مهلة طويلة، متى وطن الإنسان نفسه على الصبر والأمل في فرج الله- تعالى-.
وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين بعض الآثار، منها ما رواه ابن أبى حاتم، عن عائد بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الجحر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» .
وعن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين.
وعن قتادة: ذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه فقال: «لن يغلب عسر يسرين» . ومعنى هذا أن العسر معرّف في الحالين، فهو مفرد، واليسر منكّر فمتعدد، ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين» فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد ....
وقال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف تعلق قوله: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً بما قبله؟
قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالفقر فذكّره الله- تعالى- بما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله، فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسرا.
فإن قلت «إن مع» للصحبة، فما معنى اصطحاب اليسر للعسر؟ قلت: أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر، زيادة في التسلية، وتقوية القلوب.
فإن قلت: فما المراد باليسرين؟ قلت: يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما تيسر لهم في أيام الخلفاء ... وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة.
فإن قلت: فما معنى هذا التنكير؟ قلت التفخيم، كأنه قال: إن مع العسر يسرا عظيما وأى يسر ....
وقوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ، ثم أكد هذا الخبر .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم ، حدثنا عائذ بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر ، فقال : " لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه " ، فأنزل الله عز وجل : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) .
ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر ، عن حميد بن حماد به ، ولفظه : " لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه " ثم قال : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح .
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف ، ولكن رواه شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود موقوفا .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ، وهو يقول : " لن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا " .
وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد ، عن الحسن مرسلا .
وقال سعيد ، عن قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : " لن يغلب عسر يسرين " .
ومعنى هذا : أن العسر معرف في الحالين ، فهو مفرد ، واليسر منكر فتعدد ; ولهذا قال : " لن يغلب عسر يسرين " ، يعني قوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد .
وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح ، حدثنا خارجة ، عن عباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ، ونزل الصبر على قدر المصيبة " .
ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه ، أنه قال :
صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا
من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا
وقال ابن دريد : أنشدني أبو حاتم السجستاني :
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب
وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب
ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب
أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب
وقال آخر :
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج
كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج
وقوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإنّ مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين، ومن أوّله ما أنت بسبيله رجاء وفرجا بأن يُظْفِرَكَ بهم، حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعا وكَرها.
ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نـزلت، بَشَّر بها أصحابه وقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت يونس، قال: قال الحسن: لما نـزلت هذه الآية ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبْشِرُوا أتاكُمُ اليُسْرُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، مثله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فَرِحا وهو يضحك، وهو يقول: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) ".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّر أصحابه بهذه الآية، فقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن معاوية بن قرة أبي إياس، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود، قال: لو دخل العسر في جُحْر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن رجل، عن عبد الله، بنحوه.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم: قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال: يتبع اليسرُ العُسَر.
التدبر :
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ سنة ربانية ثابتة يؤكدها ويفسرها قوله: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ مَـعَه، ليتَ اليائس يدرك ذلك! قال عبد الله بن مسعود: «لو أن العسر دخل في جُحر لجاء اليسر حتى يدخل معه».
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ نَعم مَعه، لكن اليائس لا يُدرك ذلك.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ كلَّما تعسّرَ عليك الأمر، فانتظر التيسِــير للجنة.
عمل
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لتكن لك نفس واثقة بالله وأنت تستمتع بأنوار الصباح بعد ليل حالك أن عسرك ﻻبد وأن ينبلج صباحه باليسر.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أصبح اليسر هو الأصل، والعسر استثنائي.
عمل
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ اطمئن يا من ضاقت عليه الأرض؛ لن يغلب عسر يسرين، سوف تفرج.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أفضل مزايا العُسر أنه لا يدوم.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قال رسول الله: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا» [الحاكم 3/624، وصححه الألباني].
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قال ابن رجب: «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتدَّ وعظم وتناهي، حصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلَّق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل عليه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه﴾ [الطلاق: ۳].
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ اشتداد الشدة من أسباب الفرج؛ ولذا فالشدة نوع من النِّعَم لما يترتب عليها، كانت العرب تقول: «الشدة إذا تناهت انفرجت».
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» [أحمد 1/307، وصححه شعيب الأرنؤوط].
عمل
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ الكلام خبر من الله سبحانه، وخبره أكمل الأخبار صدقًا ووعده لا يخلف، فكلما تعسر عليك الأمر؛ فانتظر التيسير.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ الذي يحدث في غالب الأحيان أن ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ابحث دومًا عن المنح المخفية في تلافيف المحن, واستخلص من العقبات العسيرة دروسًا في التفاؤل والأمل, فما كان عسر إلا صاحبه يسر.
وقفة
[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ من وثق بوعد ربه كان شجاعًا مقدامًا, لا يتهيب الصعاب ولا يخشي الشدائد, فما أصابهم هم ولا غم إلا أعقبه فرج مضاعف.
لمسة
[5] فائدة التكرار في قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ التكرار يفيد تأكيدًا وترسيخًا للمعنى في النفوس خاصة في حال العسر والشدة.
لمسة
[5] فائدة الفاء قي قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي إذا علمت ذلك فاعلم أن مع العسر يسرًا.
لمسة
[5] سر تنكير: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ للتعظيم، أي مع العسر العارض يسر عظيم.
عمل
[5] مهما كثرت الهموم ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، سيأتيك فرج ينسيك آلام الماضي، اطمئن ﴿سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].
وقفة
[5] ما من عبد مؤمن أصابه همٌّ وقرأ هذه الآية إلا شرح الله صدره ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[5] إذا ضاقت بك الدنيا فـتذكر: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ نعم معه، مع الضيق الفرج، مع الفقر الغنىٰ، مع المرض الصحة.
وقفة
[5] مهما تراكمت الصعاب إلَّا أنها لا تدوم؛ لأن الله وعد بالفرج والتيسير ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾؛ لا تحزن ولا تجزع وتعلّق بمن بيده مقاليد كل شيء.
وقفة
[5] الابتلاءات هي المقياس الحقيقي لقوَّة الإيمان؛ لا يدوم البلاء قط، وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلًا؛ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[5] مهما تراكمت الصعاب إلَّا أنها لا تدوم: لأن الله حق والله وعد بالفرج والتيسير ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[5] نعم بعد ذلك فرج وأي فرج، يقول من بيده الفرج: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، ليس بعده ولكنه معه.
وقفة
[5] ما يُصيب المرء من أوجاع وابتلاءات ما هي إلا خير له سواء أدركه أم لم يُدركه، وما غلب عُسر يُسرَين ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
عمل
[5] تأكد أن ورآء كل ضيق ينتظرك فرجًا من الله ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[5] القرآن علمني أنه مهما تراكمت الصعاب إلَّا أنها لا تدوم؛ لأن وعد الله حق والله وعد بالفرج والتيسير ﴿فإن مع العسر يُسراً﴾.
وقفة
[5] خلف هذا الليل يقبع الكثيرون ممن أغراهم الهَم حتى صاحبوه، وقد نسوا أن خلف الليل نورًا ساطعًا، وبعد الهم وعدًا صادقًا: ﴿فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾.
وقفة
[5] هو اللطيف حسبُك؛ فابتسم سيُطبِّبُ الرحمن ما قد أوجعك ﴿فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾.
وقفة
[5] تأكد أنه خلف كل تعب سيكون هناك راحة بلا حدود، ووراء كل حزن سينتظرك فرح كبير، ألم تقرأ قول الله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا﴾.
عمل
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ تفاءلوا والله ما ضاقت إلا وفرجت، وما تعسرت إلا تيسرت، وما أغلق باب إلا فتح ألف باب، وعد من الكريم الوهاب.
الإعراب :
- ﴿ فَإِنَّ: ﴾
- الفاء سببية او عاطفة على مضمر للتعليل اي فلا تيأس من فضل الله فإن .... ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل.
- ﴿ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً: ﴾
- ظرف مكان يدل على الاجتماع والمصاحبة متعلق بخبر «ان» منصوب على الظرفية وهو مضاف. العسر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. يسرا: اسم «ان» مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعسر: ضد اليسر وهما لا يجتمعان فيكون التقدير ان مع انقضاء العسر يسرا فحذف المضاف او ان الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب او تكون «مع» حرف جر والجار والمجرور في محل رفع خبر «ان» المقدم.
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ بعض نعمه على رسوله من شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر، بعد استحكام الكرب، وضيق الأمر؛ ذكرَ هنا أن ذلك قد وقع على ما جرت به سنته في خلقه، من إحداث اليسر بعد العسر، قال تعالى:
﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾
التفسير :
{ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى:{ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا ".
وتعريف "العسر "في الآيتين، يدل على أنه واحد، وتنكير "اليسر "يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.
وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له
فإن قلت " إن مع " للصحبة ، فما معى اصطحاب اليسر للعسر؟ قلت : أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذى كانوا فيه بزمان قريب ، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر ، زيادة فى التسلية ، وتقوية القلوب .
فإن قلت : فما المراد باليسرين؟ قلت : يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ، وما تيسر لهم فى أيام الخلفاء . . وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة .
فإن قلت : فما معنى هذا التنكير؟ قلت التفخيم ، كأنه قال : إن مع العسر يسرا عظيما وأى يسر . .
وقوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ، ثم أكد هذا الخبر .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم ، حدثنا عائذ بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر ، فقال : " لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه " ، فأنزل الله عز وجل : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) .
ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر ، عن حميد بن حماد به ، ولفظه : " لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه " ثم قال : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح .
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف ، ولكن رواه شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود موقوفا .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ، وهو يقول : " لن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا " .
وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد ، عن الحسن مرسلا .
وقال سعيد ، عن قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : " لن يغلب عسر يسرين " .
ومعنى هذا : أن العسر معرف في الحالين ، فهو مفرد ، واليسر منكر فتعدد ; ولهذا قال : " لن يغلب عسر يسرين " ، يعني قوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد .
وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح ، حدثنا خارجة ، عن عباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ، ونزل الصبر على قدر المصيبة " .
ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه ، أنه قال :
صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا
من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا
وقال ابن دريد : أنشدني أبو حاتم السجستاني :
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب
وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب
ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب
أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب
وقال آخر :
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج
كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج
وقوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإنّ مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين، ومن أوّله ما أنت بسبيله رجاء وفرجا بأن يُظْفِرَكَ بهم، حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعا وكَرها.
ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نـزلت، بَشَّر بها أصحابه وقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت يونس، قال: قال الحسن: لما نـزلت هذه الآية ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبْشِرُوا أتاكُمُ اليُسْرُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، مثله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فَرِحا وهو يضحك، وهو يقول: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) ".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّر أصحابه بهذه الآية، فقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن معاوية بن قرة أبي إياس، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود، قال: لو دخل العسر في جُحْر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن رجل، عن عبد الله، بنحوه.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم: قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال: يتبع اليسرُ العُسَر.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ إن اليسر قريب قريب، ولن يغلب عسر يُسرين.
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾، ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ [الطلاق: 7]، ما الفرق بين (مع وبعد)؟ الجواب: (مع) تفيد اقتران اليسر بالعسر، و(بعد) تفيد التعقيب، والمعنى: أن كل عسر معه يسر يعقبه.
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ رسالة إلى قلبك، (مع) وليس (بعد)، طمّن قلبك، فالله أرحم مِن أن يجعل الأحزان فوق قلبك مُتتابعة، الفرج قادم بإذن الله، تأهب لاستقباله.
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ أشد عسر واجهة النبي ﷺ كان عناد قومه وعدم استجابتهم له، فوعده الله بيسرين مقابل عسر واحد، فجاء السر الأول متدرجًا بإسلامهم آحادًا، ثم اكتمل اليسر الثاني بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجًا؛ فلا تيأس مهما واجهك من عسر وشدة، فهي محنة في طياتها منح.
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ قال ابن القيم: «فالعسر وإن تكرّر مرتين فتكرّر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرّر بلفظ النكرة فهو يُسران، فالعُسر محفوف بيسرين: يُسر قبله، ويُسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين».
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ ليس بتكرار؛ لأن المعنى إن مع العسر الذي أنت فيه من مقاساة الكفار يسرًا في العاجل، وإن مع العسر الذي أنت فيه من الكفار يسرًا في الآجل، فالعسر واحد واليسر اثنان، وعن عمر رضي الله عنه: «لن يغلب عسر يسرين».
عمل
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ عرف العسر في الآيتين، ونكر اليسر؛ ليدل على أن العسر واحد واليسر كثير، ولن يغلب عسر يسرين؛ فتفاءل.
وقفة
[5، 6] المتدبر لمناسبة مجيء سورة الشرح بعد سورة الضحى ينكشف له كثير من المعاني المقررة في السورة، ومنها ما في قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾، فمجموع السورتين يعطيان مثالًا حيًّا لتقرير هذه السنة، فسورة الضحى تمثل جوانب العسر التي عاناها نبينا عليه السلام؛ ليعقبها جوانب اليسر في سورة الشرح، حتى إذا انتهى المثل يأتي التعقيب بأن مجيء اليسر بعد العسر سنة لا تتخلف.
وقفة
[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ اليسر أوسع من العسر، العسر تكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، أما اليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، واحد قبله وآخر بعده، فلن يغلب عسر بيسرين.
تفاعل
[5، 6] ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ * ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ قل: «اللهم يسر لنا كل أمر عسير، فتيسير العسير عليك يسير».
عمل
[5، 6] وإن أصابك حزنٌ؛ تفاءل بأن من جعل للحزن سببًا جعل للفرح أسبابًا ﴿فإن مع العسر يُسْرًا * إن مع العسر يسراً﴾.
وقفة
[5، 6] من يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف، حدثوه عن قوله تعالى: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾، حدثوه عن محن صارت منح ربانية، حدثوه عن الأمل والثقة بالله، حدثوه عن: ﴿فإن مَع الْعُسْرِ يُسْرًا * إن مع الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[5، 6] لو أعلن العالم كله كل كلمات العسر واليأس؛ فسيطمئنك إيمانك بهذه الآيات: قال الله ﷻ: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾.
وقفة
[5، 6] ربما تقلق إذا وعدك مخلوق مشيئته تحت مشيئة الله، لكنك ستنام قرير العين بوعد الذي بيده ملكوت كل شىء إذ قال: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔَﺮَﺝَ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻀﻴﻖ، ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﺃﺟﻠﻪ.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إن لم تثق بوعد ربك فبمن؟ سيأتي الفرج وإن طال الوجع، ستخرج من حزنك أكتر قربًا لربك، وبأجر الصبر والدعاء.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أيها المبتلى تصبَّر يقول القائل:
أَلاَ فَاصْبِرْ على الحَدَثِ الجَلِيْلِ ... وَدَاوِ جِوَاكَ بالصَّبْرِ الجَميلِ
ولا تَيْأَسْ فإِنَّ اليَأْسَ كُفْرٌ ... لَعَلَّ اللَه يُغنِي مِنْ قليلِ
وأن العسر يتبعه يسارٌ ... وقول الله أصدق كل قيل
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ما بين عسر وعسر؛ يزهر اليسر.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ معه، معه، معه.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ريٌّ، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، سوف يصل الغائب، ويهتدي الضال.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ليس (بعده)؛ بل (معه).
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إنَّ مع العسر الذي أنت فيه بذور الفَرَج.
لمسة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لو قال ﷻ: (بعد)؛ لاستبشرنا، كيف وقد قال (مع)؟!
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ وظِّف حروفك في بث الأمل ولا تُبالي بالعواقب، إذا ضيَّقتَ أمرًا زادَ ضيقـًا وإنْ هَوَّنتَ صعبَ الأمرِ هانا.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فلسفتها: ﻻ عسر يدوم.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ الأمل الذي كان في نفوس الصحابة حيث رأوا في تكرار الآية توكيدًا لوعود الله ﷻ بتحسن الأحوال.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ هي طب للقلوب، ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قالها علام الغيوب.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ما ضاقت واستعسرت إلا وفرجت من فوق سابع سماء.
وقفة
[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أيامك التي تراها حالكة السواد معتمة موحشة ثق تمامًا أن الله سيخلق لها فجرًا باسمًا، ﻻ شيء يدوم على ما هو إﻻ هو.
وقفة
[6] ﻫﺬﺍ ﻭﻋﺪُ ﺍﻟﻠﻪِ: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إنَّه يأتي معه لا بعده، لكنَّنا نَعجَل.
وقفة
[6] حسن الظن بالله سبحانه وإنتظار الفرج من أجلِّ العبادات؛ من حفظ يونس في بطن الحوت لن يعجزه حفظك وتدبير أمرك ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
لمسة
[6] قال الله عن اشتداد المحن: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قال: (مع)، ولم يقل: (بعد)؛ ﻷنه دليل على السرعة والمزامنة.
وقفة
[6] أبشركم ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﺪﺓ ﺇلَّا ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺧﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[6] يا أيها المهموم المحزون المكروب: تأمل هاتين الآيتين: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: 9].
وقفة
[6] يَا ضجيجَ الكُربات ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وقفة
[6] مهما أصابنا من شدة وضيق، فبلا شك يوجد مخرج من هذا الضيق، فالله يقول: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾
وقفة
[6] لم يكون عمرك كله ربيعًا! ستتناوب عليك الفصول الأربعة، تلفحك الحرارة، تتجمد في سقيع الوحدة، تتساقط أحلامك اليابسة؛ لكن ستزهر حياتك من جديد ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة. وتكرير «ان» في الآيتين لزيادة التأكيد والآية الثانية مؤكدة للاولى لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب و «نكرت» يسرا للتفخيم اي يسرا عظيما.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا كان العُسرُ مَكروهًا إلى النُّفوسِ، وكان لله فيه حِكَمٌ عظيمةٌ، وكانت الحِكَمُ لا تتراءى إلَّا للأفرادِ مِنَ العِبادِ؛ كَرَّره سُبحانَه على طريقِ الاستِئنافِ؛ لجوابِ مَن يقولُ: وهل بَعْدَه مِن عُسْرٍ؟ مؤكِّدًا له؛ ترغيبًا في أمرِه، وترَقُّبًا لِما يتسَبَّبُ عنه، مُبَشِّرًا بتكريرِه مع وَحْدةِ العُسْرِ، قال تعالى:
﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾
التفسير :
ثم أمر الله رسوله أصلًا، والمؤمنين تبعًا، بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال:{ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} أي:إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء.
بعد هذا التعديد لتلك النعم العظيمة، أمر الله- تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في العبادة فقال- تعالى-: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
وأصل الفراغ خلو الإناء مما بداخله من طعام أو غيره، والمراد به هنا الخلو من الأعمال التي تشغل الإنسان، والنصب: التعب والاجتهاد في تحصيل المطلوب.
أى: فإذا فرغت- أيها الرسول الكريم- من عمل من الأعمال، فاجتهد في مزاولة عمل آخر من الأعمال التي تقربك من الله- تعالى-، كالصلاة، والتهجد، وقراءة القرآن الكريم.
وقوله : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها ، فانصب في العبادة ، وقم إليها نشيطا فارغ البال ، وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : " لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان " وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء ، فابدءوا بالعشاء " .
قال مجاهد في هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة ، فانصب لربك . وفي رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك ، وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفي رواية عن ابن مسعود : ( فانصب وإلى ربك فارغب ) بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس .
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( فإذا فرغت فانصب ) يعني : في الدعاء .
وقال زيد بن أسلم والضحاك : ( فإذا فرغت ) أي : من الجهاد ( فانصب ) أي : في العبادة .
وقوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: فإذا فَرغت من صلاتك، فانصب إلى ربك في الدعاء، وسله حاجاتك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) يقول: في الدعاء.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) يقول: فإذا فرغت مما فُرض عليك من الصلاة فسل الله، وارغب إليه، وانصب له.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) يقول: من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلِّم، فانصَب.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ) قال: أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) من صلاتك ( فَانْصَبْ ) في الدعاء.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) من جهاد عدوّك ( فَانْصَبْ ) في عبادة ربك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال الحسن في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: أمره إذا فرغ من غزوه، أن يجتهد في الدعاء والعبادة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال عن أبيه: فإذا فرغت من الجهاد، جهاد العرب، وانقطع جهادهم، فانصب لعبادة الله ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) .
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دنياك، فانصب في عبادة ربك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب، قال: فصّل.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب، فصّل.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) قال: إذا فرغت من أمر الدنيا، وقمت إلى الصلاة، فاجعل رغبتك ونيتك له.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: إن الله تعالى ذكره، أمر نبيه أن يجعل فراغه من كلّ ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته، مما أدّى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته، والاشتغال فيما قرّبه إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كلّ أحوال فراغه، من صلاة كان فراغه، أو جهاد، أو أمر دنيا كان به مشتغلا لعموم الشرط في ذلك، من غير خصوص حال فراغ، دون حال أخرى.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ لم يذكر متعلق فرغت؛ فما السر؟ ليعم كل فراغ، أي إذا فرغت من عمل فانصب لعمل آخر، جدد عملك في الدعوة ولا تتوقف.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ الأعمال كلها يُفرغ منها، والذكر لا فراغ له، ولا انقضاء، تنقطع الأعمال بانقطاع الدنيا ويبقى الذكر.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ الفراغ فيه سُمٌّ قاتل؛ ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللًا، لا في عمل دنيا، ولا في عمل آخرة.
لمسة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ لم يذكر في الآية متعلِّق (فَرَغْتَ)، أي فرغت من ماذا؟ ليعمُّ كل فراغ، قلبي أو وقتي أو عقلي أو عاطفي.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ الفراغ نعمة حُرم منها الكثيرون، فاغتنمها للتقرب من الله.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ سكين الفراغ بوسعه أن يذبح إيمان أتقي الأتقياء، والعاقل من ملأ فراغه بالطاعات، ولم يدع فُرجة يتسلل منها الشيطان.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ مرَّ شريح القاضي على قوم يلعبون يوم عيد، فقال: «ما لكم؟» قالوا: «فرغنا يا أبا أمامة»، قال: «ما بهذا أمر الفارغ».
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ من إشارات سورة الشرح: أن من أسباب ضيق الصدر (الفراغ)، فإذا استغلَّ المسلم وقته بما ينفعه من طلب العلم والدعوة؛ انشرح صدره.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ كلما وجدت فسحة من الوقت؛ مد يدك للمصحف، تجبر ما فات من وردك.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (فرغت): تدل على أنه كان ممتلئ الوقت قبل ذلك؛ ممتلئ الوقت يحسن استغلال الفراغ.
وقفة
[7] ﴿فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب﴾ وهكذا حياة المؤمن، عملٌ وعبادة.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ من سمات الموفقين: أنهم إذا تفرغوا من الأعمال ومشاغل الحياة؛ انشغلوا بالعبادة.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ إذا فرغت من عمل من الأعمال؛ فاجتهد في مزاولة عمل آخر من الأعمال التي تقربك من الله ﷻ، كالصلاة والتهجد وتلاوة القرآن وغيرها.
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ هي دعوة لاستثمار الوقت؛ فلا تركن إلي الدعة والكسل, وإذا فرغت من عمل نافع مفيد فأتبعه بمثله, فإنك يوم القيامة مسؤول عن عمرك فيما أفنيته؟
عمل
[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ اجعل رغبتك في جميع أعمالك إرضاء ربك، ولا تجعل لك هدفًا آخر، فتقديم (وَإِلَىٰ رَبِّكَ) لإفادة الحصر؛ فالإخلاص فيه الخلاص.
لمسة
[7] سر تقديم ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ على ﴿فَانصَبْ﴾ للتأكيد على شغل وقت الفراغ لتتعاقب الأعمال.
وقفة
[7] مناسبة قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ فيها تذكير بلطف وعناية بمواصلة الدعوة دون ملل.
لمسة
[7] سر التعبير بـ ﴿فَانصَبْ﴾ دون (اعمل النصب) يفيد العمل بحزم وقوة وثبات وصبر.
وقفة
[7] أفضل طريقة لاستغلال الوقت هي ألا تدع للفراغ فرصة في حياتك، وهو ما قررته هذه الآية الجامعة المانعة: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾.
وقفة
[7] من التأويلات الباطلة في قوله: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾ قرأ الرافضة (فانصِب) أي انصب عليًّا بعدك للإمامة، ما أجرأهم على كتاب الله وتحريفه!
عمل
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ لا تنس شرف زمانك الذي تعيشه الآن؛ فاعمره بكل ما تستطيع من القربات، فإن ضعفت نفسك فتدبر، وإن تكاسلت فتأمل.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ تخلل الفترات للعابدين أمر لازم لابد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رُجي له أن يعود خيرًا مما كان.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ هذه خطة لحياة المسلم وضعت للنبي ﷺ، وهي: فإذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي، وإذا فرغت من عمل دنيوي فانصب لعمل ديني أخروي، فالمسلم يحيا حياة الجد والتعب، فلا يعرف وقتًا للهو والبطالة قط.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ قعودُ الرَّجُلِ فارغًا من غير شُغل، أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفهِ الرأي، وسخافة العقل، واستيلاء الغفلة!
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ لا عطلة للمؤمن عن طاعة الله؛ بل يتنقل من طاعة إلى طاعة.
وقفة
[7، 8]﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ليس أجمل من وقت تدع به أشغال الدنيا وهمومها خلف ظهرك، لتخلو بين يدي ربك، فمن تمسك بركن قوي فكيف له أن يضعف.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ العبادة تورث هدوءًا واستقرارًا نفسيًا وعقليًا يحرم منه المضطربون الذين يظنون أن مقاليد الأمور بيد غير الله.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ هذه القاعدة القرآنية أبلغ وأعظم حادٍ إلى العمل، والجد في استثمار الزمن قبل الندم.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء.
وقفة
[7،8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ قال الضحاك: «فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء».
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ اجعل رغبتك إلي الله تعالي وحده في جميع مطالبك الدنيوية والأخروية, وترفع ما استطعت عما في أيدي الناس, واستغن عن غير ربك.
وقفة
[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ما يسمى بفن إدارة الوقت؛ هنا في ست كلمات.
وقفة
[7، 8] هل تجد فراغًا في وقتك ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾، الفراغ فرصة للقرب من الله.
لمسة
[7، 8] دلالة الفاء في ﴿فَانصَبْ﴾، ﴿فَارْغَب﴾ تأكيد الأمر ووجوبه.
وقفة
[7، 8] الفراغ فرصة للقرب إلى الله ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾.
عمل
[7، 8] اشغل أحد أوقات فراغك بعبادة ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب﴾.
وقفة
[7، 8] أحسن ما تكون عبادة النوافل بعد أدائك واجب النفس والأهل، ولن تشعر بلذة النافلة إلا باجتماع جهدك ورغبتك إلى ربك ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾.
وقفة
[7، 8] هل تريد أن يشرح الله لك صدرك؟ ويضع عنك وزرك؟ وهل تريد أن يرفع لك ذكرك؟ ويبدلك الله بعسرك يسرين ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾.
وقفة
[7، 8] عجبًا لمن يشكي الفراغ ويضيعه فيما لا يفيده وهو يقرأ ويسمع قول ربه: ﴿فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب * وَإِلى رَبِّكَ فَارغَب﴾.
وقفة
[7، 8] الجلوس بعد السلام من الصلاة من أعظم الأوقات التي تنزل فيها رحمة الله عز وجل، لا تنس بأنك في ضيافته ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾.
وقفة
[7، 8] ينبغي للمؤمن أن يشغل وقت فراغه بعبادة ربه، ويجعل هاتين الآيتين نصب عينيه ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾.
عمل
[7، 8] احذر الفتور في وقت الغنائم ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾، إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب إلى العبادة، وقم نشيطًا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة.
الإعراب :
- ﴿ فَإِذا: ﴾
- الفاء استئنافية. إذا: ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط.
- ﴿ فَرَغْتَ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.
- ﴿ فَانْصَبْ: ﴾
- الفاء واقعة في جواب «اذا» والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. انصب: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت اي فاذا فرغت من التبليغ او العبادة او الصلاة فاتعب في العبادة او فاجتهد فيها. وقيل فاذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا عَدَّد اللهُ عليه نِعَمَه السَّالِفةَ، ووعَدَه بالنِّعَمِ الآتيةِ؛ لا جَرَمَ بَعَثَه على الشُّكرِ والاجتِهادِ في العِبادةِ؛ فقال تعالى:
﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
فرغت:
1- بفتح الراء، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بكسرها، وهى لغة، وبها قرأ أبو السمال.
وقال الزمخشري: ليست بفصيحة.
فانصب:
1- بسكون الباء خفيفة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بشدها مفتوحة.
3- بكسر الصاد، أي: إذا فرغت من الرسالة فانصب خليفة، وهى قراءة فرقة من الإمامية.
قال ابن عطية، وهى قراءة شاذة، ضعيفة المعنى، لم تثبت عن عالم.
مدارسة الآية : [8] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾
التفسير :
{ وَإِلَى رَبِّكَ} وحده{ فَارْغَبْ} أي:أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك.
ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين.
وقد قيل:إن معنى قوله:فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها، فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك.
واستدل من قال بهذا القول، على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك تمت ولله الحمد.
واجعل رغبتك في جميع أعمالك وعباداتك، من أجل إرضاء ربك، لا من أجل شيء آخر، فهو وحده القادر على إبلاغك ما تريد، وتحقيق آمالك.
فالمقصود بهاتين الآيتين حثه صلى الله عليه وسلم وحث أتباعه في شخصه على استدامة العمل الصالح، وعدم الانقطاع عنه، مع إخلاص النية لله- تعالى- فإن المواظبة على الأعمال الصالحة مع الإخلاص فيها، تؤدى إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة.
ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لهذا الإرشاد الحكيم، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه، وعند ما سئل لم كل هذه العبادة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» .
وسار أصحابه من بعده على هذا الهدى القويم: فعمروا حياتهم بالباقيات الصالحات من الأعمال، دون أن يكون للفراغ السيئ، مكان في حياتهم، بل واصلوا الجهاد بالجهاد، وأعمال البر بمثلها.
ومن أقوال عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-: «إنى لأكره لأحدكم أن يكون خاليا، لا في عمل دنيا ولا دين» .
وفي رواية أنه قال: «إنى لأنظر إلى الرجل فيعجبني، فإذا قيل: إنه لا عمل له سقط من عيني» .
نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا ممن يعمرون أوقاتهم بالأعمال الصالحة، والخالصة لوجهه الكريم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
( وإلى ربك فارغب ) قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل .
آخر تفسير سورة " ألم نشرح " ولله الحمد .
وقوله: ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) يقول تعالى ذكره: وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك، دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) قال: اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) قال: إذا قمت إلى الصلاة.
آخر تفسير سورة ألم نشرح
المعاني :
التدبر :
وقفة
[8] ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ماذا ترغب؟ ارغب فيما عند الله يحبّك الله، وارغب فيما في أيدي الناس يُبْغضك الناس.
عمل
[8] ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ الجأ إلى الله في تحقيق مطلوبك، إنا إلى الله راغبون، وتقديم الجار والمجرور إلى ربك يفيد الحصر، لأن الرغبة لا تكون إلا لله.
عمل
[8] ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ كل طريق إن خطوته لله انتظر فلاحه، وكل نية إن جعلتها لله فانتظر بركتها، فمن جعل وجهته لله وجه الله له الخير.
لمسة
[8] سر حذف مفعول ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾؛ ليعم كل ما يرغبه النبي ﷺ، وهل يرغب إلا الكمال النفسي والكمال لأمته.
لمسة
[8] سر التعبير بالرغبة ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ دون (أقبل) ليفيد معنى التوجه مع إقبال النقس ورغبتها لربها.
لمسة
[8] سر تقديم الظرف ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ للاختصاص، أي إليه لا إلى غيره تكون رغبتك.
وقفة
[8] ﴿وَإِلى رَبِّكَ فَارغَب﴾ فعنده جل شأنه الملاذ والملجأ والأمان والمُبتغى والعوْد والمرجع والسرور والحبور والراحة والهداية والنجاة والفوز و... فكيف تجد نَصَبًا بعد ذلك؟!
وقفة
[8] ﴿وَإِلَى رَبِّكَ﴾ وحده ﴿فَارْغَبْ﴾ أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك.
وقفة
[8] ﴿وَإِلى رَبِّكَ فَارغَب﴾ ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا، لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين.
عمل
[8] دع عنك الخلق، واقصد الخالق؛ ينشرح صدرك، وييسر أمرك، ويساق لك من الخير ما لم يكن في الحسبان ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَإِلى رَبِّكَ: ﴾
- الواو عاطفة. الى ربك: جار ومجرور متعلق بارغب والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ فَارْغَبْ: ﴾
- تعرب اعراب «فانصب» اي واجعل رغبتك الى الله خصوصا ولا تسأل إلا فضله سبحانه متوكلا عليه.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن أمَرَه بالاجتهاد في العبادة؛ أمَرَه أن يجعل رغبته وقصده إلى الله وحده، قال تعالى:
﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
فأرغب:
1- أمرا من الثلاثي، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- فرغب، أمرا من «رغب» ، بشد الغين.
مدارسة الآية : [1] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾
التفسير :
(التين) هو التين المعروف، وكذلك{ الزَّيْتُونَ} أقسم بهاتين الشجرتين، لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام، محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام.
تفسير سورة التين
مقدمة وتمهيد
1- وتسمى- أيضا- سورة «والتين» وعدد آياتها ثماني آيات، والصحيح أنها مكية.
وقد روى ذلك عن ابن عباس وغيره، ويؤيد كونها مكية، القسم بمكة في قوله- تعالى-: وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وعن قتادة أنها مدنية، وهو قول لا دليل عليه.
وكان نزولها بعد سورة «البروج» ، وقبل سورة «لإيلاف قريش» .
2- وقد اشتملت هذه السورة الكريمة، على التنبيه بأن الله- تعالى- قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فعليه أن يكون شاكرا لخالقه، مخلصا له العبادة والطاعة.
اختلف المفسرون في المراد بقوله- تعالى-: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وقد ذكر الإمام القرطبي هذا الخلاف فقال ما ملخصه: قوله: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: قال ابن عباس وغيره: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. قال- تعالى-:
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وهي شجرة الزيتون.
وقال أبو ذر: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم سلة تين، فقال: «كلوا» وأكل منها. ثم قال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة، لقلت هذه ... » .
وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتون، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» ...
وهذا هو الرأى الذي تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها.
ثم قال الإمام القرطبي: وهذا القول هو أصح الأقوال، لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة، لقوله- تعالى-: يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وكان ورق التين، ولأنه كثير المنافع.
وأقسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة، قال- تعالى-: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ... وفيه منافع كثيرة ... .
وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال في المقصود بالتين والزيتون:
والصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: التين: هو التين الذي يؤكل. والزيتون:
هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون. إلا أن يقول قائل: المراد من الكلام القسم بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبا، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك، دلالة في ظاهر التنزيل ...
وما ذهب إليه الإمامان: ابن جرير والقرطبي، من أن المراد بالتين والزيتون، حقيقتهما، هو الذي نميل إليه، لأنه هو الظاهر من معنى اللفظ، ولأنه ليس هناك من ضرورة تحمل على مخالفته، ولله- تعالى- أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو صاحب الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية .
قال مالك وشعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون ، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم .
اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي نفسها . وقيل : الجبل الذي عندها .
وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف .
وروى العوفي ، عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي .
وقال مجاهد : هو تينكم هذا .
( والزيتون ) قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد ، وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس .
وقال مجاهد وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون .
القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) فقال بعضهم: عُنِي بالتين: التين الذي يؤكل، والزيتون: الزيتون الذي يُعْصر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قول الله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: تينكم هذا الذي يؤكل، وزيتونكم هذا الذي يُعْصر.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة، قال: التين: هو التين، والزيتون: الذي تأكلون.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين، عن يزيد، عن عكرِمة ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: تينكم وزيتونكم.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَيَّة، عن أبي رجاء، قال: سُئِل عكرِمة عن قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين تينكم هذا، والزيتون: زيتونكم هذا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين الذي يؤكل، والزيتون: الذي يعصر.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران؛ وحدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، جميعا عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: الفاكهة التي تأكل الناس.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سلام بن سليم، عن خصيف، عن مجاهد ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: هو تينكم وزيتونكم.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يُعصر.
حدثنا بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الكلبيّ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) هو الذي ترون.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتَادة، قال: قال الحسن، فى قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) : التين تينكم، والزيتون زيتونكم هذا.
وقال آخرون: التين: مسجد دمشق، والزيتون: بيت المقدس.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا رَوْح، قال: ثنا عوف، عن يزيد أبي عبد الله، عن كعب أنه قال في قول الله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين: مسجد دمشق، والزيتون: بيت المقدس.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَالتِّينِ ) قال: الجبل الذي عليه دمشق ( وَالزَّيْتُونَ ) : الذي عليه بيت المقدس.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) ذُكر لنا أن التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون: الذي عليه بيت المقدس.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، وسألته عن قول الله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين: مسجد دمشق، والزيتون، مسجد إيلياء.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبي بكر، عن عكرِمة ( وَالتِّينِ &; 24-503 &; وَالزَّيْتُونِ ) قال: هما جبلان.
وقال آخرون: التين: مسجد نوح، والزيتون: مسجد بيت المقدس.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) يعني مسجد نوح الذي بني على الجوديّ، والزيتون: بيت المقدس؛ قال: ويقال: التين والزيتون وطور سينين: ثلاثة مساجد بالشام.
والصواب من القول في ذلك عندنا: قول من قال: التين: هو التين الذي يُؤكل، والزيتون: هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يُعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام: القسم بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبا، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنـزيل، ولا من قول من لا يجوّز خلافه، لأن دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون.
التدبر :
وقفة
[1] ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ التين هو الثمرة المعروفة التي لا عجم لها ولا قشرة، والزيتون هو كذلك الثمرة التي منها الزيت.
وقفة
[1] ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ التين والزيتون في الأرض المباركة أرض الشام، طور سينين في أرض مصر، البلد الأمين مكة، وهي أماكن دعوة الأنبياء.
وقفة
[1] ﴿وَالتّينِ وَالزَّيتونِ﴾ أقسم رب العزة بهما لكثرة منافعهما وفوائدهما.
الإعراب :
- ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: ﴾
- الواو حرف جر «واو القسم». التين: اسم مقسم به مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف التقدير:وحق التين ... او أقسم برب التين. والزيتون: معطوفة بالواو على «التين» مجرورة مثلها بالكسرة اي ورب التين والزيتون. أقسم بهما لانهما عجيبان من بين اصناف الاشجار المثمرة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ على أنَّ اللهَ خَلَق الإنسانَ في أحسَنِ تقويمٍ، فـ: ١، ٢- أقسمَ اللهُ بالتين والزيتون، وهما يكثران في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام، قال تعالى:
﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾
التفسير :
{ وَطُورِ سِينِينَ} أي:طور سيناء، محل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم.
اتفق المفسرون على أن المراد بطور سينين: الجبل الذي كلم الله- تعالى- عليه موسى- عليه السلام- وسينين، وسيناء، وسينا، اسم للبقعة التي فيها هذا الجبل، بإضافة «طور» إلى ما بعده، من إضافة الموصوف إلى الصفة.
قال الإمام الشوكانى: «وطور سينين» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، اسمه الطور. ومعنى سينين: المبارك الحسن.. وقال مجاهد: سينين كل جبل فيه شجر مثمر، فهو سينين وسيناء. وقال الأخفش: طور: جبل. وسينين شجر، واحدته سينه، ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء، لأنه جعل اسما للبقعة.. .
وأقسم- سبحانه- به، لأنه من البقاع المباركة، وأعظم بركة حلت به ووقعت فيه، تكليم الله- تعالى-، لنبيه موسى- عليه السلام-.
قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام.
وقوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: هو جبل موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه ومسجده.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، عن قزعة، قال: قلت لابن عمر: إني أريد أن آتي بيت المقدس ( وَطُورِ سِينِينَ ) فقال: لا تأت طور سينين، ما تريدون أن تدعوا أثر نبيّ إلا وطئتموه. قال قتادة ( وَطُورِ سِينِينَ ) : مسجد موسى صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله.
( طُورِ سِينِينَ ) قال: جبل موسى.
قال: ثنا عوف، عن يزيد أبي عبد الله، عن كعب، في قوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: جبل موسى صلى الله عليه وسلم.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: هو الطُّور.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: مسجد الطور.
وقال آخرون: الطور: هو كلّ جبل يُنْبِتُ. وقوله ( سِينِينَ ) : حسن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا عمارة، عن عكرِمة، في قوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: هو الحسن، وهي لغة الحبشة، يقولون للشيء الحسن: سِينا سِينا.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، قال: سُئل عكرِمة، عن قوله ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: طُور: جبل، وسِينين: حَسَنٌ بالحبشية.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الصباح بن محارب، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب، فقرأ في أوّل ركعة ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ ) قال: هو جبل.
حدثني يعقوب، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: سواء علي نبات السهل والجبل.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: الجبل.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَطُورِ سِينِينَ ) : جبل.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَطُورِ سِينِينَ ) الجبل.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن النضر، عن عكرِمة، قال: الطور: الجبل، والسينين: الحسن، كما ينبت في السهل، كذلك ينبت في الجبل.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الكلبيّ، أما( طُورِ سِينِينَ ) فهو الجبل ذو الشجر.
وقال آخرون: هو الجبل، وقالوا: سينين: مبارك حسن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَطُورِ ) : الجبل و ( سِينِينَ ) قال: المبارك.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: جبل مبارك بالشام.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: جبل بالشام، مُبارك حسن.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: طور سينين: جبل معروف، لأن الطور هو الجبل ذو النبات، فإضافته إلى سينين تعريف له، ولو كان نعتا للطور، كما قال من قال معناه حسن أو مبارك، لكان الطور منّونا، وذلك أن الشيء لا يُضاف إلى نعته، لغير علة تدعو إلى ذلك.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ هناك جبال إذا نزل عليها المطر أنبتت، وجبال إذا نزل عليها المطر لا تنبت، فكل جبلٍ ينبت يطلق عليه (طور)، والمراد بـ (سينين): سيناء، و(طور سينين): هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام.
وقفة
[2] ﴿وَطورِ سينينَ﴾ أقسم سبحانه بجبل الطور، كيف لا وهو جل شأنه كلم نبيه موسى عليه السلام عنده!
الإعراب :
- ﴿ وَطُورِ سِينِينَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «التين» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. سينين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتعريف وهو اسم بقعة ويجوز اعرابها بالحروف والحركات مثل «سنين وسنون» اي بالياء لانها ملحقة بجمع المذكر السالم واضيف «الطور» وهو الجبل الى «سينين» وهي البقعة التي تضم الجبل الذي كلم الله موسى عليه. وقيل «سينين» شجر.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٣- أقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيَّه موسى عليه السلام، قال تعالى:
﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
سينين:
1- وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بفتح السين، وهى لغة بكر وتميم، وهى قراءة ابن أبى إسحاق، وعمرو بن ميمون، وأبى رجاء.
3- سيناء، بكسر السين والمد، وهى قراءة عمر بن الخطاب، وعبد الله، وطلحة، والحسن.
4- سيناء، بفتح السين والملد، وهى قراءة عمر أيضا، وزيد بن على.
مدارسة الآية : [3] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾
التفسير :
{ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} وهي:مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة، التي اختارها وابتعث منها أفضل النبواتوأشرفها.
كما اتفقوا- أيضا- على أن المراد بالبلد الأمين: مكة المكرمة، وسمى بالأمين لأن من دخله كان آمنا، وقد حرمها- تعالى- على جميع خلقه، وحرم شجرها وحيوانها، وفي الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتحها: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فلا يعضد- أى: يقطع- شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ... » .
( وهذا البلد الأمين ) يعني : مكة . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار . ولا خلاف في ذلك .
وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة ، بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار ، فالأول : محلة التين والزيتون ، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . والثاني : طور سينين ، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث : مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا ، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم .
قالوا : وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه موسى [ بن عمران ] - وأشرق من ساعير - يعني بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني : جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا - فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ، ولهذا أقسم بالأشرف ، ثم الأشرف منه ، ثم بالأشرف منهما .
وقوله: ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) يقول: وهذا البلد الآمن من أعدائه أن يحاربوا أهله، أو يغزوهم. وقيل: الأمين، ومعناه: الآمن، كما قال الشاعر:
ألـمْ تَعْلَمـي يـا أسْـمَ وَيحَـكِ أنَّنِـي
حَــلَفْتُ يمِينــا لا أخُــونُ أمِينـي (1)
يريد: آمني، وهذا كما قال جلّ ثناؤه: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ .
وإنما عني بقوله: ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) : مكة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) قال: مكة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن يزيد أبي عبد الله، عن كعب، في قول الله ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) قال: البلد الحرام.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) قال: البلد الحرام.
قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان؛ وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان؛ وحدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) قال مكة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سَلام بن سليم، عن خَصيف، عن مجاهد: ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) : مكة.
حدثنى يعقوب، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم يحدّث عن عكرِمة ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) : قال: البلد الحرام.
قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، قال: سُئل عكرِمة، عن قوله ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) قال: مكة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) يعني: مكة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) قال: المسجد الحرام.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) : مكة.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿وَهَـٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ ودع أطفالك ولا تخف أبدًا، أنت قادم إلى البلد الأمين.
وقفة
[3] ﴿وَهَـٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ كن على يقين، فأنت آمن على نفسك ومالك في بلد أُرسل فيه سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم.
وقفة
[1-3] ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المواطن الثلاثة التي نزلت فيها أشهر كتبه على أفضل خلقه عليهم الصلاة والسلام، فالتين والزيتون المراد بهما: منابت التين ومنابت الزيتون، وهي بلاد الشام التي كان فيها عيسى ﷺ، وطور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى ﷺ، والبلد الأمين وهو مكة التي بعث فيها رسول الله محمد ﷺ.
الإعراب :
- ﴿ وَهذَا: ﴾
- الواو عاطفة. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر لانه معطوف على مجرور.
- ﴿ الْبَلَدِ الْأَمِينِ: ﴾
- بدل من اسم الاشارة او صفة- نعت- مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة و «البلد» مكة المكرمة حماها الله. والأمين: الآمن او فعيل بمعنى مفعول اي المأمون. الأمين: صفة- نعت- للبلد مجرورة مثلها بالكسرة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٤- أقسم بمكة البلد الحرام الذي بعث فيه محمد ﷺ، قال تعالى:
﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ .. ﴾
التفسير :
والمقسم عليه قوله:{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} أي:تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًا، ومع هذه النعم العظيمة، التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور، وسفساف الأخلاق.
وجملة: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.... وما عطف عليه جواب القسم.
أى: وحق التين الذي هو أحسن الثمار، صورة وطعما وفائدة، وحق الزيتون الذي يكفى الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم، وحق هذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة، وحق طور سنين الذي كلم الله- تعالى- عليه نبيه موسى تكليما ... وحق هذه الأشياء ... لقد خلقنا الإنسان في أعدل قامة، وأجمل صورة، وأحسن هيئة، ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره، من بيان فصيح، ومن عقل راجح، ومن علم واسع، ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه في هذه الحياة، بإذننا ومشيئتنا.
والتقويم في الأصل: تصيير الشيء على الصورة التي ينبغي أن يكون عليها في التعديل والتركيب. تقول: قومت الشيء تقويما، إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغي أن يكون عليها ... في التعديل والتركيب. تقول: قومت الشيء تقويما، إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغي أن يكون عليها ... وهذا الحسن يشمل الظاهر والباطن للإنسان ...
والمراد بالإنسان هنا: جنسه. أى: لقد خلقنا- بقدرتنا وحكمتنا- جنس الإنسان في أكمل صورة، وأحكم عقل ...
هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوى الأعضاء حسنها.
وقوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) وهذا جواب القسم، يقول تعالى ذكره: والتين والزيتون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: وقع القسم ها هنا( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( لَقَدْ خَلَقْنَا &; 24-507 &; الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) فقال بعضهم: معناه: في أعدل خلق، وأحسن صورة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عاصم، عن أبي رَزِين، عن ابن عباس ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: في أعدل خلق.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: في أحسن صورة.
قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: خَلْقٍ.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: في أحسن صورة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) يقول: في أحسن صورة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) : في أحسن صورة.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: أحسن خَلْقٍ.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: في أحسن خلق.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) يقول: في أحسن صورة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، هو والكلبيّ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قالا في أحسن صورة.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان، فبلغنا به استواء شبابه وجلده وقوّته، وهو أحسن ما يكون، وأعدل ما يكون وأقومه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة، في قوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: الشاب القويّ الجَلْد.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: شبابه أوّل ما نشأ.
وقال آخرون: قيل ذلك لأنه ليس شيء من الحيوان إلا وهو منكبّ على وجهه غير الإنسان.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: خلق كلّ شيء منكبا على وجهه، إلا الإنسان.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدلها؛ لأن قوله: ( أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) إنما هو نعت لمحذوف، وهو في تقويم أحسن تقويم، فكأنه قيل: لقد خلقناه في تقويم أحسن تقويم.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ هو اعتداله واستواء شبابه، قال أبو بكر بن طاهر: «مزينًا بالعقل، مؤديًا للأمر، مهديًا بالتمييز، مديد القامة، يتناول مأكوله بيده» أحسن خلق الله باطنًا وظاهرًا: جمال هيئة، وبديع تركيب الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج بما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه.
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ انتبه: هنا نعمةٌ منسية تستحق الشكر.
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ كل مولود يولد على الفطرة. قال عبد الرحمن بن كيسان: «أحسن تقويم: أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان»، وقال الطاهر بن عاشور: «وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير، وأن في جبلته جلب النفع والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنه باطلًا أو هلاكًا، ومحبة الخير والحسن من الأفعال؛ لذلك تراه يُسَر بالعدل والإنصاف، وينصح بما يراه مجلبة لخير غيره، ويغيث الملهوف، ويعامل بالحسنى، ويغار على المستضعفين، ويشمئز من الظلم».
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ كان بعض الصالحين يقول: «إلهنا، أعطيتنا في الأولى أحسن الأشكال، فأعطنا في الآخرة أحسن الفعال، وهو العفو عن الذنوب، والتجاوز عن العيوب».
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ من أحسن التقويم أن خلق الله لنا عقولًا وقلوبًا حتى نتلقى القرآن الذي بدأ الوحي به: اقرأ.
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ خلقك الله في أحسن هيئة وخير حال، أليست بنعمة تستوجب الشكر؟
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ انظر إلى حسن تقويم عينك، وسمعك، وفمك، ويدك، وقدمك ما أعظم هذا التقويم ولذا قال: (أحسن).
وقفة
[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ سُّورَة التِّين نعمة على كل إنسان، المؤمن والكافر، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، شملت الإنسانية كلها، نعمة يعجز الإنسان عن شكرها.
وقفة
[4] من تدبر قول الحكيم جلَّ وعلا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾؛ لم يتجرأ أن يسخر من إنسان خلقه الله، ولا أن يحتقر خلقة مدحها الله.
الإعراب :
- ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا: ﴾
- اللام واقعة في جواب القسم والجملة بعدها لا محل لها من الاعراب لانها جواب القسم. قد: حرف توقع او تحقيق. خلق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
- ﴿ الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في أحسن: جار ومجرور متعلق بخلقنا وصرف «أحسن» وهو أفعل التفضيل لانه اضيف.
- ﴿ تَقْوِيمٍ: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. اي في احسن تعديل لشكله وصورته.
المتشابهات :
| الحجر: 26 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ﴾ |
|---|
| المؤمنون: 12 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾ |
|---|
| ق: 16 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ نَفۡسُهُۥۖ﴾ |
|---|
| البلد: 4 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ |
|---|
| التين: 4 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد القَسَمِ؛ جاء هنا جوابُ القَسَمِ، قال تعالى:
﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾
التفسير :
فردهم الله في أسفل سافلين، أي:أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم.
وقوله- تعالى-: ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ معطوف على ما قبله وداخل في حيز القسم. وضمير الغائب يعود إلى الإنسان ...
وحقيقة الرد: إرجاع الشيء إلى مكانه السابق، والمراد به هنا: تصيير الإنسان على حالة غير الحالة التي كان عليها، وأسفل: أفعل تفضيل، أى: أشد سفالة مما كان يتوقع.
وللمفسرين في هذه الآية الكريمة اتجاهات منها: أن المراد بالرد هنا: الرد إلى الكبر والضعف، كما قال- تعالى-: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ ما يَشاءُ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.
وعلى هذا الرأى يكون المردودون إلى أسفل سافلين، أى: إلى أرذل العمر، هم بعض أفراد جنس الإنسان، لأنه من المشاهد أن بعض الناس هم الذين يعيشون تلك الفترة الطويلة ن العمر، كما قال- تعالى-: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة، وأشبهها بتأويل الآية، قول من قال معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمر. إلى عمر الخرفى الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر، وذهاب العقل ... ».
ومنها: أن المراد بالرد هنا: الرد إلى النار، والمعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه إلى أقبح صورة، وأخس هيئة ... حيث ألقينا به في أسفل سافلين، أى: في النار، بسبب استحبابه العمى على الهدى، والكفر على الإيمان ...
وقد رجح هذا الرأى ابن كثير فقال: قوله: ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ أى: إلى النار ... أى: ثم بعد هذا الحسن والنضارة، مصيره إلى النار، إن لم يطع الله- تعالى- ويتبع الرسل. ولهذا قال: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ....
وعلى هذا الرأى- أيضا-، يكون المردودون إلى «أسفل سافلين» أى: إلى النار، هم بعض أفراد جنس الإنسان، وهم الكفار، والفاسقون عن أمره- تعالى-.
ومنها: أن المراد بالرد إلى أسفل سافلين هنا: الانحراف والارتداد عن الفطرة التي فطر الله- تعالى- الناس عليها، بأن يعبد الإنسان مخلوقا مثله، ويترك عبادة خالقه، ويطيع نفسه وشهواته وهواه ... ويترك طاعة ربه- عز وجل-.
وقد فصل الأستاذ الإمام هذا المعنى فقال ما ملخصه: «أقسم- سبحانه- أنه قوم الإنسان أحسن تقويم، وركبه أحسن تركيب، وأكد- سبحانه- ذلك بالقسم، لأن الناس بسبب غفلتهم عما كرمهم الله به، صاروا كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجماوات، يفعلون كما تفعل، لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة. فانحطت بذلك نفوسهم عن مقامها، الذي كان لها بمقتضى الفطرة ... فهذا قوله: ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ، أى: صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات التي كانت أسفل منه، لأن الحيوان المفترس- مثلا- إنما يصدر في عمله عن فطرته التي فطر عليها، لم ينزل عن مقامه، ولم ينحط عن منزلته في الوجود.
أما الإنسان فإنه بإهماله عقله، وجهله بما ينبغي أن يعمله لتوفير سعادته وسعادة إخوانه،ينقلب أرذل من سائر أنواع الحيوان، ولطالما قلت: «إذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان».
والذي يتأمل الرأى الثاني والثالث يرى أن بينهما تلازما، لأن الانحراف عن الفطرة السوية يؤدى إلى الدخول في النار وبئس القرار، وهذان الرأيان أولى بالقبول، لأن الاستثناء في قوله- تعالى- بعد ذلك: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ يؤيد ذلك، إذ المعنى عليها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه إلى النار بسبب انحرافه عن الفطرة، وإيثاره الغي على الرشد، والكفر على الإيمان ...
( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي : إلى النار . قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد ، وغيرهم . ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ; ولهذا قال :
وقوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ثم رددناه إلى أرذل العمر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: إلى أرذل العمر.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عمرو، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: إلى أرذل العمر.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) يقول: يرّد إلى أرذل العمر، كبر حتى ذهب عقله، وهم نفر رُدّوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سفهت عقولهم، فأنـزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، قال: سُئل عكرِمة، عن قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: ردّوا إلى أرذل العمر.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل وعبد الرحمن، قالا ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: إلى أرذل العمر.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، مثله.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، مثله.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: رددناه إلى الهِرَم.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: الهِرَم.
حدثني يعقوب، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: الشيخ الهَرِم، لم يضرّه كبرُه إن ختم الله له بأحسن ما كان يعمل.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة.
* ذكر من قال ذلك .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبي جعفر الرازيّ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: في شرّ صورة في صورة خنـزير.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: النار.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: إلى النار.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: في النار.
قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: إلى النار.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: قال الحسن: جهنم مأواه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: &; 24-510 &; قال الحسن، في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: في النار.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: إلى النار.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة، وأشبهها بتأويل الآية، قول من قال: معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمر، إلى عمر الخَرْفَى، الذين ذهبت عقولهم من الهِرَم والكِبر، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر وذهاب العقل.
وإنما قلنا: هذا القول أولى بالصواب في ذلك؛ لأن الله تعالى ذكره، أخبر عن خلقه ابن آدم، وتصريفه في الأحوال، احتجاجا بذلك على مُنكري قُدرته على البعث بعد الموت، ألا ترى أنه يقول: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) يعني: بعد هذه الحُجَج.
ومحال أن يحتجّ على قوم كانوا مُنكرين معنى من المعاني بما كانوا له مُنكرين. وإنما الحجة على كلّ قوم بما لا يقدرون على دفعه، مما يعاينونه ويحسُّونه، أو يقرّون به، وإن لم يكونوا له مُحسين.
وإذْ كان ذلك كذلك، وكان القوم للنار- التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة- مُنكرين، وكانوا لأهل الهِرَم والخَرَف من بعد الشباب والجَلَد شاهدين، علم أنه إنما احتجّ عليهم بما كانوا له مُعاينين، من تصريفه خلقه، ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد، إلى الهِرَم والضعف وفناء العمر، وحدوث الخَرَف.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة.
وقفة
[5] ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة، وأشبهها بتأويل الآية، قول من قال معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمر، إلى عمر الخرفى الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكِبر، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر، وذهاب العقل».
وقفة
[5] ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ تدل على أنه ما من سفل إلا وهناك ما هو أسفل منه؛ العلو يوصل لله؛ والسفل يوصل لسجين.
وقفة
[5، 6] ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الهوان اختيار، والسمو اختيار، ولك القرار.
وقفة
[5، 6] ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ رجَّح ابن كثير أن أسفل سافلين هو النار، أي: ثم بعد هذا الحسن والنضارة، مصيره إلى النار؛ إن لم يطع الله تعالى ويتبع الرسل؛ ولهذا قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ رَدَدْناهُ: ﴾
- حرف عطف. رددنا: تعرب اعراب «خلقنا» والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
- ﴿ أَسْفَلَ سافِلِينَ: ﴾
- ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة بمعنى في اسفل. سافلين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من حركة المفرد اي ثم كان عاقبة امره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية ان رددناه اسفل من سفل خلقا وتركيبا وهم اصحاب النار. أي رددناه الى الانحطاط بمعنى الى أرذل العمر.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد هذا الحُسن والنضارة؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أن مصيرَه إلى النَّار، إن لم يطع الله ويتبع الرسل، قال تعالى:
﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
سافلين:
1- منكرا، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- السافلين، معرفا بالألف واللام، وهى قراءة عبد الله.
مدارسة الآية : [6] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾
التفسير :
إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، والأخلاق الفاضلة العالية،{ فَلَهُمْ} بذلك المنازل العالية، و{ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} أي:غير مقطوع، بل لذات متوافرة، وأفراح متواترة، ونعم متكاثرة، في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وساروا على مقتضى فطرتهم، فأخلصوا لله- تعالى- العبادة والطاعة ... فلهم أجر غير مقطوع عنهم أو غير ممنون به عليهم، بل هم قد اكتسبوا هذا الأجر الدائم العظيم، بسبب إيمانهم وعملهم الصالح.
قال الآلوسى ما ملخصه: قوله: ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ، «ثم» هنا للتراخي الزمانى أو الرتبى، والرد يجوز أن يكون بمعنى الجعل، فينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.
فأسفل مفعول ثان، والمعنى: ثم جعلناه من أهل النار، الذين هم أقبح، وأسفل من كل سافل ... ويجوز أن يكون الرد بمعناه المعروف، وأسفل منصوب بنزع الخافض.
أى: رددناه إلى أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم ...
وقوله: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ استثناء متصل من ضمير «رددناه» العائد على الإنسان، فإنه في معنى الجمع، فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم القيامة، بل يزدادون بهجة إلى بهجتهم. وحسنا على حسنهم ... ».
"إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات"
وقال بعضهم : ( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي : إلى أرذل العمر . روي هذا عن ابن عباس وعكرمة - حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . واختار ذلك ابن جرير . ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك ; لأن الهرم قد يصيب بعضهم ، وإنما المراد ما ذكرناه ، كقوله : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) [ العصر : 1 - 3 ] .
وقوله : ( فلهم أجر غير ممنون ) أي : غير مقطوع ، كما تقدم .
وقوله: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) اختلف أهل التأويل في معنى هذا الاستثناء، فقال بعضهم: هو استثناء صحيح من قوله ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قالوا: وإنما جاز استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم جمع، من الهاء في قوله ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ ) وهي كناية الإنسان، والإنسان في لفظ واحد، لأن الإنسان وإن كان في لفظ واحد، فإنه في معنى الجمع، لأنه بمعنى الجنس، كما قيل: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ قالوا: وكذلك جاز أن يقال: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) فيضاف أفعل إلى جماعة، وقالوا: ولو كان مقصودا به قصد واحد بعينه، لم يجز ذلك، كما لا يُقال: هذا أفضل قائمين، ولكن يقال: هذا أفضل قائم
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن سعيد بن سابق، عن عاصم الأحول، &; 24-511 &; عن عكرِمة، قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، ثم قرأ: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قال: لا يكون حتى لا يعلم من بعد علم شيئا، فعلى هذا التأويل قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) لخاصّ من الناس، غير داخل فيهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه مستثنى منهم.
وقال آخرون: بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يدخلون في الذين ردّوا إلى أسفل سافلين، لأن أرذل العمر قد يردّ إليه المؤمن والكافر. قالوا: وإنما استثنى قوله: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) من معنى مضمر في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قالوا: ومعناه: ثم رددناه أسفل سافلين، فذهبت عقولهم وخرفوا، وانقطعت أعمالهم، فلم تثبت لهم بعد ذلك حسنة ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) فإن الذي كانوا يعملونه من الخير، في حال صحة عقولهم، وسلامة أبدانهم، جار لهم بعد هرمهم وخَرَفهَم.
وقد يُحتمل أن يكون قوله: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) استثناء منقطعا، لأنه يحسن أن يقال: ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم أجر غير ممنون، بعد أن يردّ أسفل سافلين.
* ذكر من قال معنى هذا القول:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: فأيما رجل كان يعمل عملا صالحا وهو قوي شاب، فعجز عنه، جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثني عمى، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) يقول: إذا كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها، ثم كبر حتى ذهب عقله، كُتب له مثل عمله الصالح، الذي كان يعمل في شبيبته، ولم يُؤاخذ بشيء مما عمل في كبره، وذهاب عقله، من أجل أنه مؤمن، وكان يطيع الله في شبيبته.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال: إلى أرذل العمر، فإذا بلغ المؤمن إلى أرذل العمر، كُتِبَ له كأحسن ما كان يعمل في شبابه وصحته، فهو قوله: ( فَلَهُمْ &; 24-512 &; أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فإنه يكتب له من الأجر، مثل ما كان يعمل في الصحة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، مثله.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) قال: إذا بلغ من الكبر ما يعجز عن العمل، كُتِب له ما كان يعمل.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) فإنه يُكتب لهم حسناتهم ويُتجاوز لهم عن سيئاتهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عاصم، عن أبي رَزين عن ابن عباس (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قال: هم الذين أدركهم الكبر، لا يؤاخذون بعمل عملوه في كبرهم، وهم هَرْمَى لا يعقلون.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، قال: سُئل عكرمة، عن قوله: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: يوفيه الله أجره أو عمله، ولا يؤاخذه إذا رُدّ إلى أرذل العمر.
حدثني يعقوب، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قال: الشيخ الهرم لم يضرّه كبره إن ختم الله له بأحسن ما كان يعمل.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) قال: من أدركه الهرم، وكان يعمل صالحا، كان له مثل أجره إذا كان يعمل.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين في جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون، فعلى هذا التأويل: إلا الذين آمنوا &; 24-513 &; وعملوا الصالحات مستثنون من الهاء في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ ) ، وجاز استثناؤهم منها إذ كانت كناية للإنسان، وهو بمعنى الجمع، كما قال: إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا) : إلا من آمن.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن، في قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) : في النار ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) قال الحسن: هي كقوله: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة، قول من قال: معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم، فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم، كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم، في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة لما وصفنا من الدلالة على صحة القول بأن تأويل قوله: ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) إلى أرذل العمر.
اختلفوا في تأويل قوله: ( غَيْرُ مَمْنُونٍ ) فقال بعضهم: معناه: لهم أجر غير منقوص.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) يقول: غير منقوص.
وقال آخرون: بل معناه: غير محسوب.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) : غير محسوب.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
دثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: غير محسوب.
قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: غير محسوب.
وقد قيل: إن معنى ذلك: فلهم أجر غير مقطوع.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: فلهم أجر غير منقوص، كما كان له أيام صحته وشبابه، وهو عندي من قولهم: جبل مَنِين: إذا كان ضعيفا؛ ومنه قول الشاعر:
أعْطَــوْا هُنَيْــدَة يَحْدُوهـا ثَمَانِيَـة
مـا فِـي عَطـائِهمُ مَـنٌّ وَلا سَـرَف (2)
يعني: أنه ليس فيه نقص، ولا خطأ.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ الإيمانُ والعملُ الصَّالحُ سببٌ في المحافظةِ على كرامةِ العبدِ عندَ اللهِ.
وقفة
[6] ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ يقولون: قيمة المرء ما يُحسن, نعم هذا في الدنيا, أما الآخرة فقيمة المرء بإيمانه وصدق يقينه, وبإخلاصه في الطاعات, وإكثاره من الصالحات.
وقفة
[6] الإيمان والعمل الصالح حفظ للعبد في الدنيا والآخرة ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾.
وقفة
[6] ﴿إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمنونٍ﴾ لا ينفعك مركزك، لا تنفعك سلطاتك، لا ينفعك أين تسكن، لا تنفعك صحة وقوة وشباب وخلقة حسنة، لا ينفعك من تعرفهم من علية القوم، فقط لا ينفعك إلا إيمانك وعملك.
وقفة
[6] ﴿فلهم أجر غير ممنون﴾ قال السعدي: «غير مقطوع، لذات متوافرة، وأفراح متواترة، ونعم متكاثرة، في أبدٍ لا يزول، ونعيم لا يحول».
تفاعل
[6] ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ سَل الله الجنة الآن.
الإعراب :
- ﴿ إِلَّا الَّذِينَ: ﴾
- اداة استثناء. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى بإلا استثناء متصلا ظاهر الاتصال على المذهب الاول اي من الهاء- الضمير- في «رددناه» العائد الى «الانسان» لانه بمعنى «الجماعة» وان كان لفظه لفظ مفرد وعلى المذهب الثاني يكون استثناء منقطعا بمعنى ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمى.
- ﴿ آمَنُوا: ﴾
- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة وجملة «آمنوا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «آمنوا» وتعرب اعرابها.الصالحات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم وهو في الاصل صفة لموصوف محذوف. التقدير: الاعمال الصالحات.
- ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ: ﴾
- الفاء استئنافية تفيد التعليل او تكون واقعة في جواب «الذين» المتضمنة معنى الشرط واللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. اجر: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.
- ﴿ غَيْرُ مَمْنُونٍ: ﴾
- صفة- نعت- لاجر مرفوع مثلها بالضمة. ممنون: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. اي فلهم ثواب دائم غير منقطع ولا يمن عليهم لطاعتهم وصبرهم
المتشابهات :
| فصلت: 8 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ |
|---|
| الإنشقاق: 25 | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ |
|---|
| التين: 6 | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا حَكَم بذلك الرَّدِّ على جميعِ النَّوعِ إشارةً إلى كثرةِ المتَّصِفِ به منهم، وكان الصَّالحُ قليلًا جِدًّا؛ جعَلَه محَطَّ الاستثناءِ، فقال تعالى:
﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾
التفسير :
{ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ} أي:أي:شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيء مما أخبرك به.
و «ما» في قوله- سبحانه-: فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اسم استفهام مبتدأ، وخبره جملة «يكذبك» . والخطاب للإنسان الذين خلقه الله- تعالى- في أحسن تقويم، ففي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب. والاستفهام للإنكار والتعجيب من هذا الإنسان ...
والمعنى: فأى شيء يحملك- أيها الإنسان- على التكذيب بالدين وبالبعث وبالجزاء، بعد أن خلقناك في أحسن تقويم، وبعد أن أقمنا لك الأدلة على أن دين الإسلام هو الدين الحق، وعلى أن رسولنا صادق فيما يبلغك عن ربه- عز وجل-؟
فالمقصود بقوله- تعالى-: يُكَذِّبُكَ: يجعلك مكذبا، أى: لا عذر لك في التكذيب بالحق، وقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون «ما» بمعنى «من» ، ويكون الاستفهام بها عن ذوات المخاطبين، أى: فمن ذا الذي يكذبك- أيها الرسول الكريم- ويكذب بيوم الدين والجزاء، بعد أن ظهرت الدلائل على صدقك ... ؟
إن كل عاقل يجب عليه أن يصدقك ولا يكذبك، ولا يعرض عنك.
ثم قال : ( فما يكذبك ) يعني : يا ابن آدم ( بعد بالدين ) ؟ أي : بالجزاء في المعاد ، وقد علمت البدأة ، وعرفت أن من قدر على البدأة ، فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى ، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان عن منصور قال : قلت لمجاهد : ( فما يكذبك بعد بالدين ) عنى به النبي صلى الله عليه وسلم قال : معاذ الله! عنى به الإنسان . وهكذا قال عكرمة وغيره .
القول في تأويل قوله تعالى : فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7)
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ ) فقال بعضهم معناه: فمن يكذّبك يا محمد بعد هذه الحجج التي احتججنا بها، بالدين، يعني: بطاعة الله، وما بعثك به من الحقّ، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: " ما " في معنى " مَنْ"، لأنه عُنِيَ به ابن آدم، ومن بعث إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما يكذّبك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، قال: قلت لمجاهد: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) عني به النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله! عُني به الإنسان.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عمن سمع مجاهدا يقول: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) قلت: يعني به: النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله! إنما يعني به الإنسان.
دثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) أعني به النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله! إنما عُنِيَ به الإنسان.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الكلبيّ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) ؟ إنما يعني الإنسان، يقول: خلقتك في أحسن تقويم، فما يكذّبك أيها الإنسان بعد بالدين.
وقال آخرون: إنما عني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له: استيقن مع ما جاءك من الله من البيان، أن الله أحكم الحاكمين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) أي استيقن بعد ما جاءك من الله البيان ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) .
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى " ما " معنى " مَنْ", ووجه تأويل الكلام إلى: فمن يكذبك يا محمد بعد الذي جاءك من هذا البيان من الله بالدين؟ يعني: بطاعة الله، ومجازاته العباد على أعمالهم. وقد تأوّل ذلك بعض أهل العربية بمعنى: فما الذي يكذّبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ وكأنه قال: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب، بعد ما تبين له خلقنا الإنسان على ما وصفنا.
واختلفوا في معنى قوله: ( بِالدِّينِ ) فقال بعضهم: بالحساب.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود الطُّفاوي، قال: ثنا محمد بن ربيعة، عن النضر بن عربيّ، عن عكرِمة، في قوله: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) قال: الحساب.
وقال آخرون: معناه: بحكم الله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) يقول: ما يكذّبك بحكم الله.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الدين في هذا الموضع: الجزاء والحساب، وذلك أن أحد معانى الدين في كلام العرب: الجزاء والحساب؛ ومنه قولهم: &; 24-516 &; كما تدين تُدان. ولا أعرف من معاني الدين " الحكم " في كلامهم، إلا أن يكون مرادا بذلك: فما يكذّبك بعد بأمر الله الذي حكم به عليك أن تطيعه فيه؟ فيكون ذلك.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[7] الدين في القرآن يأتي بمعنيين: 1- الحساب والجزاء نحو: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]. 2- الملة والشريعة نحو: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5]. وقوله تعالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ يحتمل الوجهين، أي ما يكذبك بالملة التي جاء بها الرسول ﷺ، أو ما يكذبك بالجزاء يوم القيامة.
الإعراب :
- ﴿ فَما يُكَذِّبُكَ: ﴾
- الفاء استئنافية. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يفيد التقرير. يكذب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وهو خطاب للانسان على طريقة الالتفات. اي فما يجعلك كاذبا بسبب الدين وانكاره بعد هذا الدليل او فما سبب تكذيبك ايها الانسان بعد هذا الدليل القاطع بالجزاء.
- ﴿ بَعْدُ بِالدِّينِ: ﴾
- ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة في محل نصب ولانه غاية بمعنى يعد هذا الدليل القاطع. بالدين: جار ومجرور متعلق بيكذبك اي بالجزاء.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد ذكرِ خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ وَبَّخَ اللهُ هذا الإنسان على التكذيب بالدين وبالبعث وبالجزاء، قال تعالى:
﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾
التفسير :
{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون؟
أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار، وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه، ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم، التي إليها يقصدون، ونحوها يؤمون. تمت ولله الحمد.
والاستفهام في قوله- تعالى-: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ للتقرير: إذ الجملة الكريمة تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رده إلى أسفل سافلين.
فكأنه- تعالى- يقول: إن الذي فعل ذلك كله هو أحكم الحاكمين خلقا وإيجادا. وصنعا وتدبيرا، وقضاء وتقديرا، فيجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة، وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند ربه- عز وجل-.
وقد روى الإمام الترمذي عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من قرأ منكم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ... ثم انتهى إلى قوله- تعالى- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين» .
نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقوله : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) أي : أما هو أحكم الحاكمين ، الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا : " فإذا قرأ أحدكم ( والتين والزيتون ) فأتى على آخرها : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) فليقل : بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين " .
آخر تفسير [ سورة ] " والتين والزيتون " ولله الحمد .
وقوله: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول تعالى ذكره: أليس الله يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه، وفصل قضائه بين عباده؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك فيما بلغنا قال: بَلى.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: " بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين " .
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، قال: كان ابن عباس إذا قرأ: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) قال: سبحانك اللهمّ، و بلى.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: كان قتادة إذا تلا( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، أحسبه كان يرفع ذلك؛ وإذا قرأ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ؟ قال: بلى، وإذا تلا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قال: آمنت بالله، وبما أنـزل.
آخر تفسير سـورة والتين
التدبر :
وقفة
[8] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ أي: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا، ومن عدله أن يقيم القيامة، فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه.
وقفة
[8] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: «لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [مسلم 82].
تفاعل
[8] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ سَبِّح الله الآن.
وقفة
[8] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ وهذا تقريرٌ لمضمون السورة؛ من إثبات النبوَّة، والتوحيد، والمعاد، وحُكمه بتضمن نصره لرسوله على من كذَّبه بالحجة والقدرة والظهور عليه.
عمل
[8] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ فإن أحكم الحاكمين أدرى بما يصلحك وما فيه خيرك, فلا تحِد عنه فتهلك.
وقفة
[8] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ الإيمان بأن الله أحكم الحاكمين هو أعظم مثبت للمؤمنين عندما يرون من الأحداث ما يسوؤهم ويحزنهم.
عمل
[8] احرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ: ﴾
- الالف ألف تقرير بلفظ استفهام اي استفهام انكار للنفي مبالغة في الاثبات او همزة انكار دخلت على المنفي فرجع الى معنى التقرير. الله لفظ الجلالة: اسم «ليس» مرفوع للتعظيم بالضمة. و «ليس» فعل ماض ناقص من اخوات «كان».
- ﴿ بِأَحْكَمِ: ﴾
- الباء حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي الانكاري. أحكم: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه خبر «ليس» وهو من «أفعل» التفضيل صرف لانه أضيف.
- ﴿ الْحاكِمِينَ: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. والقول الكريم فيه وعيد للكفار وانه سبحانه يحكم عليهم بما هو اهله. والجواب: بلى.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا صَحَّ أنَّ تارِكَ الظَّالِمِ بغيرِ انتِقامٍ، والمحسِنِ بلا إكرامٍ: ليس على مِنهاجِ العَدْلِ الَّذي شَرَعه اللهُ تعالى؛ حَسُنَ جِدًّا تكريرُ الإنكارِ بقَولِه سُبحانه وتعالى:
﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾
التفسير :
هذه السورة أول السور القرآنية نزولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة، إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأمره أن يقرأ، فامتنع، وقال:{ ما أنا بقارئ} فلم يزل به حتى قرأ. فأنزل الله عليه:{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} عموم الخلق، ثم خص الإنسان.
تفسير سورة العلق
مقدمة وتمهيد
1- هذه السورة الكريمة تسمى سورة «العلق» ، وتسمى سورة «اقرأ» وعدد آياتها تسع عشرة آية في المصحف الكوفي، وفي الشامي ثماني عشرة آية، وفي الحجازي عشرون آية.
وصدر هذه السورة الكريمة يعتبر أول ما نزل من قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم.
2- ومن أغراضها: التنويه بشأن القراءة والكتابة، والعلم والتعلم، والتهديد لكل من يقف في وجه دعوة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه- عز وجل- وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله- تعالى- مطلع على ما يبيته له أعداؤه من مكر وحقد، وأنه- سبحانه- قامعهم وناصره عليهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يمضى في طريقه، دون أن يلتفت إلى مكرهم أو سفاهاتهم.
وقد أجمع المحققون من العلماء ، على ن هذه الآيات الكريمة ، أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن على الإطلاق ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى ، الرؤيا الصالحة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث - أى : فيتعبد - فيه الليالى ذوات العدد ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك ، حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . فجاءه الملك فقال له : ( اقرأ ) قال : ما أنا بقارئ ، قال صلى الله عليه وسلم فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : ( اقرأ ) فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : ( اقرأ ) فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : ( اقرأ باسم رَبِّكَ الذي خَلَقَ . خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ . . ) .
وما ورد من أحاديث تفيد أن أول سورة نزلت هى " سورة الفاتحة " فمحمول على أن أول سورة نزلت كاملة هى سورة الفاتحة .
كذلك ما ورد من أحاديث فى أن أول ما نزل سورة المدثر ، محمول على أن أول ما نزل بعد فترة الوحى . أما صدر سورة العلق فكان نزوله قبل ذلك .
قال الآلوسى - بعد أن ساق الأحاديث التى وردت فى ذلك - : " وبالجملة فالصحيح - كما قال بعض وهو الذى أختاره - أن صدر هذه السورة الكريمة ، هو أول ما نزل من القرآن على الإِطلاق . وفى شرح مسلم : الصواب أن أول ما نزل " اقرأ " أى : مطلقاً ، وأول ما نزل بعد فترة الوحى ، " يأيها المدثر " ، وأما قول من قال من المفسرين ، أول ما نزل الفاتحة ، فبطلانه أظهر من أن يذكر " .
والذى نرجحه ونميل إليه أن أول من قرآن على الإطلاق ، هو صدر هذه السورة لكريمة إلى قوله ( مَا لَمْ يَعْلَمْ ) ، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك . أما بقيتها فكان نزوله متأخراً .
قال الأستاذ الإِمام " أما بقية السورة فهو متأخر النزول قطعاً ، وما فيه من ذكر أحوال المكذبين ، يدل على أنه إنما نزل بعد شيوع خبر البعثة ، وظهور أمر النبوة ، وتحرش قريش لإيذائه صلى الله عليه وسلم " .
وقد افتتحت السورة الكريمة بطلب القراءة من النبى صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أميا لتهيئة ذهنه لما سيلقى عليه صلى الله عليه وسلم من وحى . . فقال - سبحانه - : ( اقرأ باسم رَبِّكَ الذي خَلَقَ ) . أى : اقرأ - أيها الرسول الكريم - ما سنوحيه إليك من قرآن الكريم- ما سنوحيه إليك من قرآن كريم - ولتكن قراءتك ملتبسة باسم ربك ، وبقدرته وإرادته ، لا باسم غيره ، فهو - سبحانه - الذى خلق الأشياء جميعها ، والذى لا يعجزه أن يجعلك قارئاً ، بعد كونك لم تكن كذلك .
وقال - سبحانه - ذاته بقوله : ( الذي خَلَقَ ) للتذكير بهذه النعمة ، لأن الخلق هو أعظم النعم ، وعليه تترتب جميعها .
تفسير سورة اقرأ وهي أول شيء نزل من القرآن .
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء ، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو : التعبد - الليالي ذوات العدد ، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فقلت : ما أنا بقارئ " . قال : " فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ، فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ . فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ . فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) حتى بلغ : ( ما لم يعلم ) قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : " زملوني زملوني " . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال : يا خديجة ، ما لي : فأخبرها الخبر وقال : " قد خشيت علي " . فقالت له : كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا ; إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن قصي - وهو ابن عم خديجة أخو أبيها ، وكان امرأ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي ، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد عمي - فقالت خديجة : أي ابن عم ، اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخي ، ما ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أومخرجي هم ؟ " . فقالورقة : نعم ، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا . [ ثم ] لم ينشب ورقة أن توفي ، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رءوس شواهق الجبال ، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه ، تبدى له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا . فيسكن بذلك جأشه ، وتقر نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك .
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى ، فمن أراده فهو هناك محرر ، ولله الحمد والمنة .
فأول شيء [ نزل ] من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن أول رحمة رحم الله بها العباد ، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم .
القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)
يعني جل ثناؤه بقوله: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ يا محمد بذكر ربك ( الَّذِي خَلَقَ ) .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ﴾ أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ﴾ أول كلمة نزلت، تأمل في دلالتها، وحروفها: قراءة، ورقي، ورقية، فالقراءة: بوابة العلم. وهو رقي ورفعة: ﴿يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، ويوم القيامة يقال: «اقْرَأْ وَارْقَ» [الترمذي 2914، وحسنه الألباني]، وهو أيضًا: رقية وشفاء، فما أعجب هذا القرآن؟ أربعة أحرف حوت سعادة الدارين.
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ﴾ أول كلمة صافحت أذن النبي الأمي؛ لتوحي بأهمية العلم، وأنه أولى خطوات اتصال المخلوق بخالقه.
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ﴾ أشرف الأفعال، ولا شرف للإنسان يحمله كشرف العلم! وبه امتاز آدم عليه السلام على غيره من الخلق.
وقفة
[1] إذا جهل القلب عظمة الرب؛ تَجرَّأ فخاض ثم انغمس؛ فافتح لقلبك أبواب المعرفة بربك من خلال: إدامة النظر في كونه، وإطالة التدبر في آي كتابه، بهذا افتتح العليم كتابه في سورة العلم ﴿اقْرَأْ﴾.
وقفة
[1] العلم النافع إنما هو العلم المقرِّب إلى الله، الباعث على مراقبة الله، أما ترى سورة العلم (سورة العلق) بدأت بالوسيلة: ﴿اقْرَأْ﴾، وختمت بالغاية: ﴿وَاقْتَرِب﴾ [19]، وبينهما جاء الدواء لكل أنواع الجهل: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ ﴾ [14].
وقفة
[1] أول ما نزل من القرآن ﴿اقرأ﴾، واليوم أُمَّة محمد ﷺ لديها عُقدة ونفور من القراءة، لن يصلح حال الأمة إلَّا إذا عادت لما قام عليه أول أجيالها.
وقفة
[1] سورة العلق أولها: ﴿اقرأ﴾، وآخرها: ﴿واسجد واقترب﴾ [19]؛ العلم النافع ثمرته العمل.
وقفة
[1] أول كلمة نزلت على رسول الله ﴿اقرأ﴾؛ لتبين أن من أعظم النعم القراءة، فكانت معجزة له ومنحة لك، فكم تقرأ في يومك مما ينفعك؟!
وقفة
[1] بين ﴿اقْرَأْ﴾ و﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3] رحلة ٢٣عامًا مليئة بالبذل والصبر والدعوة والإحسان، فكان النصر: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: 1].
وقفة
[1] ثلاثية النجاة -وتأمل في ترتيب نزولها-: العلم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، والعبادة: ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: 2]، والدعوة: ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 2].
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ خص خلق الإنسان لأوجه منها: لأنه أوضح الأدلة، إذ هو دليل ملازم للإنسان ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾، ولأن تنزيل القرآن إليه دون سائر المخلوقات من الحيوانات والجمادات.
اسقاط
[1] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ باعتبارك فردًا من أمة (اقرأ)، كم كتابًا تقرأ كل عام؟
عمل
[1] ﴿اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ﴾ استعن بالله عند البدء بأى عمل.
لمسة
[1] ﴿اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ﴾ تركت كلمة خلق فى نهاية الآية بدون توضيح لما خلق؛ لأنه وببساطة خالق كل شئ.
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ بحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن اليونسكو، فإن كل ۸۰ عربيًّا يقرؤون كتابًا واحدًا، بينما المواطن الأوربي يقرأ 35 كتابًا كل عام، والمواطن اليهودي في فلسطين المحتلة يقرأ 40 كتابًا.
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ لتعلم أن من أول واجبات الداعي والمعلم والمربي: القراءة.
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ الصلة بين الدين والعلم وثيقة جدًا, كيف لا وأول آية أنزلت علي سيد الأنام تدعو إلي القراءة والعلم؟!
وقفة
[1] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ افتتحت السورة بالأمر بالقراءة باسم الله, وستختم بالأمر بالسجود؛ لأن القراءة مفتاح الوصول إلي حقيقة الخالق عبادته.
عمل
[1] اقرأ في التاريخ، الأدب، الطبيعة، شتى العلوم ولكن: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، اقرأ وفق المنهـج القرآني.
عمل
[1] اقرأ، ليس كل شيء تقرؤه، ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، اقرأ كل ما يدلّك إلى الله.
وقفة
[1] في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ إشارة إلى أن مركز القوة والحضارة والتقدم انتقل -من خلال الرؤية الإسلامية- من القوة المالية والبدنية إلى العلم والمعرفة.
وقفة
[1] من أسرار التنصيص على صفة الخلق في قوله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ أن ينبه الإنسان إلى أنه بهذا العلم (وهو القرآن) تكتمل في سرك وباطنك، كما كمل الله صورتك، فالذي كمَّل صورتك بخلقه، هو الذي أنزل القرآن لتكتمل به سيرتك، فما أسعد من جمع الله له بين: كمال الصورة، وجمال السيرة!
وقفة
[1] من لطائف اسم الربوبية (رب): أنه يظهر في بداية الوحي؛ لمحمد ﷺ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، ولموسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه: 12].
وقفة
[1] أهمية القراءة في حياة المسلم ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.
وقفة
[1] إن الله لا يعبد عن جهل، والكتاب الذي بدأ بـ (اقرأ) لا متسع فيه للجهلاء وأصحاب الأهواء ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.
وقفة
[1، 2] ﴿اقْرَأْ﴾ لتوسع مداركك، ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ اقرأ ما يرضي ربك، ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ لا تتكبر بعد قراءتك، ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ [19] لتكن القاءة تزيدك قربًا من مولاك.
وقفة
[1، 2] من تدبر القرآن تبين له أن الرب العظيم يذكر عباده كثيرًا بنعمة الخلق والإيجاد، وأن تذكر هذه النعمة يثمر ثمرات جليلة، منها: استحقاق الخالق عز وجل للعبادة بجميع أنواعها، والإيمان بالبعث والنشأة الآخرة، وإثبات حكمة الله وعلمه في شرعه وقدره، ولزوم التواضع وترك الكبر؛ ولعل هذا من أسرار بدء الوحي بقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾.
الإعراب :
- ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ: ﴾
- فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. باسم: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة اي مفتتحا باسم ربك قل بسم الله ثم اقرأ او تكون الباء زائدة غير معلقة بشيء وهي باء الصفة بمعنى اقرأ اسم ربك مثل قوله تعالى «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ».
- ﴿ رَبِّكَ الَّذِي: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة- نعت- للرب والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.
- ﴿ خَلَقَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف مفعولها اختصارا اي بتقدير خلق كل شيء اي تناول سبحانه كل مخلوق لانه مطلق وقوله- خلق الانسان- تخصيص للانسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق او يراد الذي خلق الانسان فقيل «الَّذِي خَلَقَ» مبهما ثم فسره بقوله تعالى «خَلَقَ الْإِنْسانَ» تفخيما لخلق الانسان ودلالة على عجيب فطرته.وقيل يجوز ان لا يقدر له مفعول وان يراد انه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه: او تكون «خلق» في الآية الكريمة الثانية بدلا من «خلق» الاولى.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ ببيان أَوَّل ما نَزَلَ من الْقُرْآنِ، قال تعالى:
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
اقرأ:
1- بهمزة ساكنة، وهى قراءة الجمهور.
قرئ:
2- بحذفها، وهى قراءة الأعمش، عن أبى بكر، عن عاصم.
مدارسة الآية : [2] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾
التفسير :
وذكر ابتداء خلقه{ مِنْ عَلَقٍ} فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره، لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتب عليهم، ولهذا ذكربعد الأمر بالقراءة، خلقهللإنسان.
وجملة خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ بدل من قوله الَّذِي خَلَقَ بدل بعض من كل، إذ خلق الإنسان يمثل جزءا من خلق المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله.
و «العلق» الدم الجامد، وهو الطور الثاني من أطوار خلق الإنسان.
وقيل: العلق: مجموعة من الخلايا التي نشأت بطريقة الانقسام عن البويضة الملقحة، وسمى «علقا» لتعلقه بجدار الرحم .
والمقصود من هذه الجملة الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته- تعالى- فكأنه- سبحانه- يقول: إن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا يسمع ويرى ويعقل ... قادر- أيضا- على أن يجعل منك- أيها الرسول الكريم- قارئا، وإن لم تسبق لك القراءة.
وخص- سبحانه- خلق الإنسان بالذكر، لأنه أشرف المخلوقات ولأن فيه من بدائع الصنع والتدبير ما فيه.
التنبيه على خلق الإنسان من علقة.
ثم بين الذي خلق فقال: ( خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ) يعني: من الدم، وقال: من علق؛ والمراد به من علقة، لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال: شجرة وشجر، وقصَبة وَقصَب، وكذلك علقة وعَلَق. وإنما قال: من علق والإنسان في لفظ واحد، لأنه في معنى جمع، وإن كان في لفظ واحد، فلذلك قيل: من عَلَق.
التدبر :
وقفة
[2] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ خلقك من قطعة يسيرة من الدم وتتكبر! عجبًا لأمرك يا ابن آدم! يكرمك ربك، وتبخل بالطاعة.
وقفة
[2] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ إن الذي خلقك من علقة صغيرة, ثم كملك صورة وخلقة, هو الذي يأمرك أن تقرأ لتكتمل عقلًا وعلمًا.
عمل
[2] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ معرفتك ﻷصلك تمنعك من التكبر والتباهي، فالله سبحانه له الفضل فيما أنت عليه الآن؛ فاحمد لله.
وقفة
[2، 3] ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ انظر لمهين خلقك، والتمس علوًّا، ولن يكون إلا بـ ﴿إقرأ﴾، نتاجها علم وإيمان وعمل.
الإعراب :
- ﴿ خَلَقَ الْإِنْسانَ: ﴾
- اعربت في الآية الكريمة الاولى. الانسان: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ مِنْ عَلَقٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخلق. ولم يقل «مِنْ عَلَقَةٍ» كقوله تعالى «مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ» وقالها على الجمع لان «الانسان» في معنى الجمع او مراعاة لرأس الآية الاولى.
المتشابهات :
| النحل: 4 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ |
|---|
| الرحمن: 3 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾ |
|---|
| الرحمن: 14 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ |
|---|
| العلق: 2 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد الامتنان بخلق جميع الخلائق؛ خَصَّ اللهُ هنا خلقَ الإِنسانِ بالذِّكرِ من بين بقية المخلوقات، قال تعالى:
﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾
التفسير :
{ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} أي:كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود.
وقوله- تعالى-: اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ أى: امض لما أمرتك به من القراءة، فإن ربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم، والأعظم من كل عظيم.
قالوا: وإنما كرر- سبحانه- الأمر بالقراءة، لأنه من الملكات التي لا ترسخ في النفس إلا بالتكرار والإعادة مرة فمرة.
وجملة وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ مستأنفة لقصد بيان أنه- تعالى- أكرم من كل من يلتمس منه العطاء، وأنه- سبحانه- قادر على أن يمنح نبيه نعمة القراءة، بعد أن كان يجهلها.
وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم ، فشرفه وكرمه بالعلم ، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة والعلم تارة يكون في الأذهان ، وتارة يكون في اللسان ، وتارة يكون في الكتابة بالبنان ، ذهني ولفظي ورسمي ، والرسمي يستلزمهما من غير عكس ، فلهذا قال : ( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) وفي الأثر : قيدوا العلم بالكتابة . وفيه أيضا : " من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن [ يعلم ] .
وقوله: ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ ) يقول: اقرأ يا محمد وربك الأكرم .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[3] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا.
وقفة
[3] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ عليك القراءة، ومنه جل جلاله الكرم.
وقفة
[3] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ العلم من أعلى درجات الكرم الإلهي للإنسان.
وقفة
[3] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ تلاوة القرآن سبب لنيل المكارم في الدنيا والآخرة.
وقفة
[3] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ أحد تفسيراتها: اقرأ القرآن وربك سيكرمك، الإكرام الرباني بالارتباط بالقرآن.
وقفة
[3] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ وربك الأكرم أكرمك بالخلق والفكر والعلم والرزق وحمل الرسالة؛ فهل أديت واجبك نحوه؟ كن كريمًا كما أكرمك.
وقفة
[3] هنا الكرم الحقيقي: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، الرسالة هنا: اقرأ لتُكْرَم، وإذا كان المُكْرِم هو الله، فما ظنك بالثمرة؟
وقفة
[3] إن الله كريم، أكرم من كل توقعاتك وطموحاتك وآمالك وأحلامك، أما مرَّ بك: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾.
وقفة
[3، 4] القراءة: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، والكتابة: ﴿الذي علم بالقلم﴾ من أهم وسائل العلم قديمًا وحديثًا، لا تنتظر أن تنهي أعمالك لتجد وقتًا للقرآن! بل ابدأ به، يكرمك الله ببركة في أوقاتك وأعمالك وجهدك وطاقتك.
عمل
[3] ﴿اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ﴾ اعمل مستعينًا بالله، وأحسن الظن به.
وقفة
[3، 4] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ جعل الله من أعظم براهين كرمه: تعليم عباده، أن تتعلم أنت تحظى بكرم الله.
وقفة
[3، 4] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ ذكر الكرم الرباني إشارة لطالب العلم أن الله سيعينه، ويذلل له العقبات في طريق التعلم, وما عليه إلا أن ينطلق, وسيفاجأ بعد ذلك بروعة النتائج.
الإعراب :
- ﴿ اقْرَأْ: ﴾
- اعربت في الآية الكريمة الاولى وحذف مفعولها اختصارا اي اقرأ ما يوحى اليك.
- ﴿ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ: ﴾
- الواو استئنافية. ربك: مبتدأ مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.الاكرم: صفة- نعت- للرب سبحانه مرفوع بالضمة وحذف الخبر اختصارا أي وربك الاكرم سيجزيك على طاعتك وقراءتك.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا كانَتِ القِراءَةُ مِنَ المَلَكاتِ الَّتِي لا تَكْسَبُها النَّفْسُ إلّا بِالتَّكْرارِ، والتَّعَوُّدِ عَلى ما جَرَتْ بِهِ العادَةُ في النَّاسِ؛ لِهَذا كَرَّرَ الأمْرَ بقوله تعالى:
﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾
التفسير :
الذي من كرمه أن علم بالعلم و{ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ}
وقوله- تعالى-: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ أى: علم الإنسان الكتابة بالقلم، ولم يكن له علم بها، فاستطاع عن طريقها أن يتفاهم مع غيره، وأن يضبط العلوم والمعارف، وأن يعرف أخبار الماضين وأحوالهم، وأن يتخاطب بها مع الذين بينه وبينهم المسافات الطويلة.
ومفعولا «علّم» محذوفان، دل عليهما قوله بِالْقَلَمِ أى: علم ناسا الكتابة بالقلم.
وتخصيص هذه الصفة بالذكر، للإيماء إلى إزالة ما قد يخطر بباله صلى الله عليه وسلم من تعذر القراءة بالنسبة له، لجهله بالكتابة، فكأنه- تعالى- يقول له: إن من علم غيرك القراءة والكتابة بالقلم، قادر على تعليمك القراءة وأنت لا تعرف الكتابة، ليكون ذلك من معجزاتك الدالة على صدقك، وكفاك بالعلم في الأمى معجزة.
وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة وفيه أيضا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم.
( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) خَلْقَهُ للكتابة والخط.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) قرأ حتى بلغ ( عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) قال: القلم: نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم، ولم يصلح عيش. وقيل: إن هذه أوّل سورة نـزلت في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني أحمد بن عثمان البصري، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، &; 24-520 &; قال: سمعت النعمان بن راشد يقول عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة أنها قالت كان أوّل ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة؛ كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء، فكان بغار حراء يتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى أهله فيتزوّد لمثلها، حتى فجأه الحق، فأتاه، فقال: يا محمد أنت رسول الله، قال رسول الله: " فَجَثَوْتُ لِرُكْبَتيَّ وأنا قائِمٌ، ثُمَّ رَجَعْتُ تَرْجُفُ بَوَادِرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، حتى ذَهَبَ عنِّي الرَّوْعُ، ثُمَّ أتانِي فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، أنا جِبْرِيُل وأنْتَ رَسُولُ اللهِ، قال: فَلَقَدْ هَمَمْت أنْ أطْرَحَ نَفسِي مِنْ حالِقٍ [مِنْ جَبَلٍ ] ، فَتَمَثَّل إليَّ حِينَ هَمَمْتُ بذلكَ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، أنا جِبْرِيلُ، وأنْتَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قالَ: اقْرأ، قُلْتُ: ما أقْرأ؟ قال: فأخَذَنِي فَغطَّنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ، حتى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدُ، ثُمَّ قالَ: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) فَقَرأتُ، فأتَيْتُ خَدِيجَةَ، فَقَلْتُ: لَقَدْ أشْفَقْتُ عَلى نَفْسِي، فأخْبَرْتُها خَبرِي، فَقالَتْ: أبْشِرْ، فَوَاللهِ لا يُخْزِيكَ الله أبدًا، وَوَاللهِ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتُؤَدِّي الأمانَةَ، وَتحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ عَلى نَوَائِبِ الْحَقّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِي إلى وَرَقَةَ بنِ نَوْفَل بنِ أسَدٍ، قالَتْ: اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أخِيكَ، فَسأَلنِي، فأخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقالَ: هَذا النَّامُوسُ الَّذِي أُنـزلَ عَلَى مُوسَى صَلى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ، لَيْتَنِي فِيها جَذَعٌ، لَيْتَنِي أكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، قُلْتُ: أوَ مُخْرِجيَّ هُمْ؟ قال: نَعَمْ، إنَّهُ لَمْ يَجِئ رَجُلٌ قَطّ بِمَا جِئْتَ بِهِ، إلا عُودِيَ، وَلَئِنْ أدْرَكَنِي يَوْمُك أنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ كانَ أوَّل ما نـزلَ عَليَّ مِنَ القُرْآنِ بَعْدَ( اقرأ ) : ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ * فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ و يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى فَجَثَوْتُ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: ثني عروة أن عائشة أخبرته، وذكر نحوه، غير أنه لم يقل: فَجَثَوْتُ ل ما أنـزل عليّ من القرآن... الكلام إلى آخره.
حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا سليمان الشيباني، قال: ثنا عبد الله بن شدّاد، قال: أتى جبريل محمدا، فقال: يا محمد اقرأ، فقال: &; 24-521 &; فَجَثَوْتُ قال: فضمه، ثم قال: يا محمد اقرأ، قال: " وما اقرأ؟" قال: ( بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) حتى بلغ ( عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ). قال: فجاء إلى خديجة، فقال: " يا خديجة ما أراه إلا قد عرض لي"، قالت: كلا والله ما كان ربك يفعل ذلك بك، وما أتيت فاحشة قطّ؛ قال: فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر، قال: لئن كنت صادقة إن زوجك لنبيّ، ولَيَلْقَينّ من أمته شدة، ولئن أدركته لأومننّ به، قال: ثم أبطأ عليه جبريل، فقالت له خديجة: ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنـزل الله: وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، قال: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة- قال إبراهيم: قال سفيان: حفظه لنا ابن إسحاق- إن أوّل شيء أُنـزل من القرآن: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ).
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، قال: ثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن الزهريّ عن عروة، عن عائشة، أن أوّل سورة أُنـزلت من القرآن ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ).
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عُبيد بن عُمير، قال: أوّل سورة نـزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ).
قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال. ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عُبيد بن عُمير يقول، فذكر نحوه.
حدثنا خلاد بن أسلم، قال. أخبرنا النضر بن شميل، قال: ثنا قرّة، قال: أخبرنا أبو رجاء العُطارديّ، قال: كنا في المسجد الجامع، ومقرئنا أبو موسى الأشعري ، كأني أنظر إليه بين بُردين أبيضين؛ قال أبو رجاء: عنه أخذت هذه السورة: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) وكانت أوّل سورة نـزلت على محمد.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن عطاء بن يسار، قال: أوّل سورة نـزلت من القرآن ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ).
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي، قالا ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أوّل ما نـزل من القرآن: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) وزاد ابن مهدي: و ن وَالْقَلَمِ .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عُبيد بن عُمير يقول: أوّل ما أنـزل من القرآن ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ).
قال ثنا وكيع، عن قُرّة بن خالد، عن أبي رجاء العُطارديّ، قال: إني لأنظر إلى أبي موسى وهو يقرأ القرآن في مسجد البصرة، وعليه بُردان أبيضان، فأنا أخذت منه ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، وهي أوّل سورة أنـزلت على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: إن أوّل سورة أُنـزلت: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ). ثم ن وَالْقَلَمِ .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ إذا وضعتَ القلمَ على القِرطاس فنتجَ منهما أصنافُ العلوم، فتأمَّل مَن الذي أجرى المعانيَ على قلبك، وأجرى العباراتِ الدالة عليها على لسانك وبنانك؟!
وقفة
[4، 5] ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ إذا وضعت القلم علي القرطاس فنتج منهما أصناف العلوم , فتأمل من الذي أجري المعاني علي قلبك , وأجري العبارات الدالة عليها علي لسانك وبنانك ؟!
وقفة
[4، 5] قوله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بالقَلَمَ﴾ مبهمٌ فسَّره بقوله بعده: ﴿عَلَّمَ الِإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.
الإعراب :
- ﴿ الَّذِي: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية للرب والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها. والموصوف هو- ربك الذي خلق- في الآية الكريمة الأولى.
- ﴿ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. بالقلم: جار ومجرور متعلق بعلم وحذف مفعولها اختصارا اي علم الانسان بالقلم. وقيل علم الخط بالقلم.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا أرادَ اللهُ أنْ يَزِيدَهُ اطْمِئْنانًا بِهَذِهِ المَوْهِبَةِ الجَدِيدَةِ؛ وَصَفَ مانِحَها بِأنَّهُ:
﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾
التفسير :
[عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم.
فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم، الذي به تحفظ به العلوم، وتضبط الحقوق، وتكون رسلًا للناس تنوب مناب خطابهم، فلله الحمد والمنة، الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق.
وجملة عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ خبر عن قوله- تعالى-: وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ وما بينهما اعتراض، ويصح أن تكون بدل اشتمال مما قبلها وهو قوله عَلَّمَ بِالْقَلَمِ أى:
علم الإنسان بالقلم وبدونه ما لم يكن يعلمه من الأمور على اختلافها، والمراد بالإنسان في هذه الآيات جنسه.
والمتأمل في هذه الآيات الكريمة، يراها قد جمعت أصول الصفات الإلهية، كالوجود، والوحدانية، والقدرة والعلم، والكرم.
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهو أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه- تعالى- أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة ... .
وقال المرحوم الشيخ محمد عبده: ثم إنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه، من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحى، بهذه الآيات الباهرات، فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى، ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض، وإلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم ... وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين، ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع ... فلا أرشدهم الله ... .
من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم ، فشرفه وكرمه بالعلم ، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة والعلم تارة يكون في الأذهان ، وتارة يكون في اللسان ، وتارة يكون في الكتابة بالبنان ، ذهني ولفظي ورسمي ، والرسمي يستلزمهما من غير عكس ، فلهذا قال : ( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) وفي الأثر : قيدوا العلم بالكتابة . وفيه أيضا : " من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن [ يعلم ] .
وقوله: ( عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) يقول تعالى ذكره: علَّم الإنسان الخطّ بالقلم، ولم يكن يَعْلَمُهُ، مع أشياء غير ذلك، مما علمه ولم يكن يعلمه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) قال: علَّم الإنسان خطا بالقلم.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
اسقاط
[5] ﴿علم الإنسان مالم يعلم﴾ كنت جاهلًا لا تعلم، ثم بفضل الله تعلمت واتقنت، فما الذي غرك بربك الكريم؟!
وقفة
[5] سورة العلق بدئت بـ﴿اقْرَأْ﴾، مفتاح العلم الذي بُيِّن بآية: ﴿عَلَّمَ الِإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾، وختمت بآية: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ [19]؛ ففيها بيان المنهج الحق الذي ضل عنه اليهود الذين لم يعملوا بعملهم، والنصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال، فالطريق المستقيم: عبادة الله وحده على علم وبصيرة، مع توحيد مصدر التلقي المشار إليه بقوله: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ﴾ [19].
وقفة
[5] كل علم أو اكتشاف هو بفضل الله وحده يمن به على من يشاء، قال الله ﷻ: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾.
عمل
[5] اقرأ صفحتين من كتاب علم شرعي ﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.
عمل
[5] ادع الله أن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك علمًا ﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.
الإعراب :
- ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسانَ: ﴾
- اعربت في الآية الكريمة السابقة. الانسان: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ ما لَمْ يَعْلَمْ: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان.لم: حرف نفي وجزم وقلب. يعلم: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة «لَمْ يَعْلَمْ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: ما لم يعلمه بمعنى:علم عباده ما لم يعلموه ونقلهم من ظلمة الجهل الى نور العلم.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا نَبَّه على ما في الكتابةِ مِنَ المنافِعِ الَّتي لا يُحيطُ بها غيرُه سُبحانَه؛ لأنَّه انبَنَت عليها استقامةُ أُمورِ الدُّنيا والدِّينِ في الدُّنيا والآخِرةِ، وهي كافيةٌ في الدَّلالةِ على دَقيقِ حِكمتِه تعالى، ولطيفِ تَدبيرِه؛ زادَ ذلك عَظَمةً على وَجهٍ يَعُمُّ غَيرَه، فقال تعالى:
﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴾
التفسير :
والإنسان -لجهله وظلمه- إذا رأى نفسه غنيًا، طغى وبغى وتجبر عن الهدى
ثم بين- سبحانه- بعد ذلك الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان فقال: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى. أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى.
و «كلا» حرف ردع وزجر لمن تكبر وتمرد ... فهو زجر عما تضمنه ما بعدها، لأن ما قبلها ليس فيه ما يوجب الزجر والردع، ويصح أن تكون «كلا» هنا بمعنى حقا. وقوله:
لَيَطْغى من الطغيان، وهو تجاوز الحق في التكبر والتمرد.
يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان.
وقوله: ( كَلا ) يقول تعالى ذكره: ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أن يُنْعِم عليه ربُّه بتسويته خَلقه، وتعليمه ما لم يكن يعلم، وإنعامه بما لا كُفءَ له، ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك، ويطغى عليه، أن رآه استغنى.
وقوله: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى *عَبْدًا إِذَا صَلَّى) ...
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿كلا إن الإنسان ليطغى﴾ يرزقه الله من فضله فيتكبر على الخلق والخالق، وهو لا يملك عمره، ولا ما لديه لدقيقة قادمة.
وقفة
[6] من أخطر أسباب طغيان الإنسان: غناه وإقبال الدنيا عليه مع نسيان ربه ولقائه ﴿كلا إن الإنسان ليطغى﴾.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ طبيعة بشرية تعتري كل من يرى استغناءه بالمال أو العلم أو الجاه، لضبطها اقرأ أول وآخر سورة العلق.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا: ﴾
- حرف زجر وردع لا عمل له اي ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وان لم يذكر لدلالة الكلام عليه وقيل هو حرف جواب بمعنى نعم حقا وليس ردا.
- ﴿ إِنَّ الْإِنْسانَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الانسان: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ لَيَطْغى: ﴾
- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ان» واللام لام التوكيد- المزحلقة- يطغى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ في مقَدِّمةِ السُّورةِ دلائِلَ ظاهِرةً على التَّوحيدِ والقُدرةِ والحِكمةِ بحيثُ يَبعُدُ مِن العاقِلِ ألَّا يطَّلِعَ عليها، ولا يَقِفَ على حقائِقِها؛ أتْبَعَها بما هو السَّبَبُ الأصليُّ في الغَفلةِ عنها، وهو: حُبُّ الدُّنيا، والاشتِغالُ بالمالِ والجاهِ، والثَّروةِ والقُدرةِ؛ فإنَّه لا سَبَبَ لعَمى القَلبِ في الحقيقةِ إلَّا ذلك، قال تعالى:
﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴾
التفسير :
والإنسان -لجهله وظلمه- إذا رأى نفسه غنيًا، طغى وبغى وتجبر عن الهدى
والضمير في قوله رَآهُ يعود على الإنسان الطاغي، والجملة متعلقة بقوله لَيَطْغى بحذف لام التعليل، والرؤية بمعنى العلم.
والمعنى: حقا إن الإنسان ليتعاظم ويتكبر ويتمرد على الحق، لأنه رأى نفسه ذا غنى في المال والجاه والعشيرة، ورآها- لغروره وبطره- ليست في حاجة إلى غيره.
والمراد بالإنسان هنا: جنسه لأن من طبع الإنسان أن يطغى، إذا ما كثرت النعم بين يديه، إلا من عصمه الله- تعالى- من هذا الخلق الذميم، بأن شكره- سبحانه- على نعمه، واستعملها في طاعته.
وقيل المراد بالإنسان هنا: أبو جهل، وأن هذه الآيات وما بعدها حتى آخر السورة قد نزلت في أبى جهل، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة، لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لئن فعل لأخذته الملائكة» .. . ونزول هذه الآيات في شأن أبى جهل لا يمنع عموم حكمها، ويدخل في هذا الحكم دخولا أوليا أبو جهل، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه.
التدبر :
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ ومن الطغيان طغيان العلم، فالمرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانًا فيتعدى على غيره، ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ؛ لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاض، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ فتنبعث منه شرورٌ كثيرة؛ من التكذيب، وانتقاص المؤمنين، ويتفاوت الناس في ذلك، وقلَّ من يسلم من مقدماته، فتفقد قلبك قبل أن تهلك.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ سمة في الانسان، وهي الطغيان حين الشعور بالاستغناء حال الصحة والأمن والرغد والنعمة، ولذا تأتي المصائب للمؤمن لتعيده إلى رشده، وتذكره بضعفه وحاجته إلى ربه تعالى.
وقفة
[6،7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ خطر الغنى إذا جرَّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ إن من الناس من لا يصلح له إلا الفقر, ولو اغتني لطغي.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ يبدأ الطغيان باستغناء العبد عن فضل ربه واعتماده على نفسه.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ ليس الطغيان بسبب الثراء المالي وحده، قد يطغى الإنسان بسبب إحساسه بالثراء المعرفي أيضًا.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ لولا المصائب لبطر العبد وبغي وطغي، فيحميه بها من ذلك، ويطهره مما فيه، فسبحان من يرحم ببلائه، ويبتلي بنعمائه.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ الطغيان مذموم في كل شئ حتي العلم, فإذا انفصل العلم عن القيم والأخلاق عاد وبالًا وفسادًا.
وقفة
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ الشعور بالاستغناء بالعلم يحمل صاحبه علي الكبر والعجب المفضيان إلي الظلم, والغرب أكبر شاهد علي الطغيان بالعلم في عصرنا هذا.
عمل
[6، 7] ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ سـخِّـر غناك في طاعة الذي أغنـاك.
وقفة
[6، 7] لا تجد طاغية إلا وهو معجب بنفسه أو ماله أو جنده ﴿كَلا إن الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾.
عمل
[6، 7] ﴿لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ احرس قلبَكَ عند ميلادِ نعمةٍ، حيثُ يُولَدُ معها جنينُ استعلاءٍ وكبرٍ.
الإعراب :
- ﴿ أَنْ رَآهُ: ﴾
- حرف مصدري لا عمل له لدخوله على فعل ماض. رآه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اول لانه من افعال الشك والعلم يقال في افعال القلوب رأيتني وعلمتني وذلك بعض خصائصها، ومعنى الرؤية العلم، ولو كانت بمعنى الابصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين. وجملة «رَآهُ اسْتَغْنى» صلة «ان» المصدرية. التقدير: برؤيته نفسه مستغنيا لان «أَنْ رَآهُ» بمعنى ان رأى نفسه. و «أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف محذوف بتقدير: برؤيته. والجار والمجرور متعلق «بيطغى».
- ﴿ اسْتَغْنى: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة «استغنى» في محل نصب مفعول به ثان للفعل «رأى» التقدير مستغنيا.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد ذَمِّ الطغيان؛ بَيَّنَ اللهُ هنا السبب الذي يحمل الإِنسان على الطغيان، قال تعالى:
﴿ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
رآه:
1- بألف بعد الهمزة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بحذفها، وهى قراءة قنبل، بخلاف عنه.
مدارسة الآية : [8] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾
التفسير :
ونسي أن إلى ربه الرجعى، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه، ويدعو [غيره] إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان.
وقوله- تعالى-: إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
تهديد ووعيد لهذا الطاغي، والرّجعى:
مصدر بمعنى الرجوع. تقول: رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعي بمعنى واحد.
والمعنى: لا تحزن- أيها الرسول الكريم- مما تفوه به هذا الطاغي وأمثاله، فإن إلى ربك وحده مرجعهم، وسيشاهدون بأعينهم ما أعددناه لهم من عذاب مهين، وسيعلمون حق العلم أن ما يتعاظمون به من مال، لن يغنى عنهم من عذاب الله شيئا يوم القيامة.
خبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان ، إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : ( إن إلى ربك الرجعى ) أي : إلى الله المصير والمرجع ، وسيحاسبك على مالك : من أين جمعته ؟ وفيم صرفته ؟
قال ابن أبي حاتم : حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ ، حدثنا جعفر بن عون ، حدثنا أبو عميس ، عن عون ، قال : قال عبد الله : منهومان لا يشبعان ، صاحب العلم وصاحب الدنيا ، ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن ، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان . قال ثم قرأ عبد الله : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وقال للآخر : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر : 28 ] .
وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منهومان لا يشبعان : طالب علم ، وطالب دنيا " .
وقوله: ( إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ) : يقول: إن إلى ربك يا محمد مَرْجِعَه، فذائق من ليم عقابه ما لا قبل له به.
التدبر :
وقفة
[8] ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ الحياة تبدأ بظُلمة البطن وبياض المهد، وتنتهي بظلمة القبر وبياض الكفن.
اسقاط
[8] ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ مرجعي ومرجعك إلى الله؛ فماذا أعددنا لذلك اليوم؟
وقفة
[8] ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ سأعود لخالقي وإن طال الأمد، سأُسأل عن كل ما أحصاه ونسيته، رب رحمتك.
وقفة
[8] ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ هو تحذير صريح لكل من أطغاه ماله أو علمه أو منصبه؛ فإن مرجعك ومآلك شئت أو لم تشأ إنما هو إلي الله, وهيهات أن تفر من قضائه.
وقفة
[8] من استحضر ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾؛ عمل لهذه الساعة.
وقفة
[8] أهرب حيث شئت: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾، واعمَل ما شئت، فهناك كتاب: ﴿لا يُغادرُ صغيرةً ولا كبِيرَة ًإلا أحصَاهَا﴾ [الكهف: 49].
عمل
[8] لكي تجد أثر صلاتك؛ استشعر: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾، أنت عائد إليه، ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ [14]، الله مطلع عليك.
وقفة
[8] يا من خُلق ﴿من علق﴾ [4] ثم سوَّاك ربك ﴿في أحسن تقويم﴾ [التين: 4] كيف لك (لتطغى)؟ إن كان ﴿إلى ربك الرجعى﴾؟!
وقفة
[8] الجنة وطن، والدنيا سفر، ومهما طالت السّفْرة، فلا بد من رجعة ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ إِلى رَبِّكَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الى: حرف جر. ربك:اسم مجرور بالى وعلامة جره الكسرة. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة والجار والمجرور متعلق بخبر «ان» المقدم. والقول واقع على طريقة الالتفات الى الانسان
- ﴿ الرُّجْعى: ﴾
- اسم «ان» المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف للتعذر اي الرجوع وهو مصدر كالبشرى. وقيل «الرجعى» توافقا مع الفواصل اي رؤوس الآي «عَبْداً إِذا صَلَّى» و «كَذَّبَ وَتَوَلَّى» وفي القول الكريم تهديد للانسان وتحذير من عاقبة الطغيان
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد ذَمِّ الطغيان، وبيان سببِه؛ حَذَّرَ اللهُ من الطغيان وأنذر من عاقبته، وأبان أن ما بيد الطاغي عارية، وليست نفسه بباقية، وأن مرجع الأمر كله لله، قال تعالى:
﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [9] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴾
التفسير :
يقول الله لهذا المتمرد العاتي:{ أَرَأَيْتَ} أيها الناهي للعبد إذا صلى
ثم عجّب- سبحانه- نبيه صلى الله عليه وسلم من حال هذا الشقي وأمثاله، فقال: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى. عَبْداً إِذا صَلَّى. فالاستفهام في قوله- تعالى-: أَرَأَيْتَ ... للتعجيب من جهالة هذا الطاغي، وانطماس بصيرته، حيث نهى عن الخير، وأمر بالشر، والمراد بالعبد: رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكيره للتفخيم والتعظيم.
أى: أرأيت وعلمت- أيها الرسول الكريم- حالا أعجب وأشنع من حال هذا الطاغي الأحمق، الذي ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذي خلقك وخلقه.
نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا.
القول في تأويل قوله تعالى : أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9)
ذُكر أن هذه الآية وما بعدها نـزلت في أبي جهل بن هشام، وذلك أنه قال فيما بلغنا: لئن رأيت محمدا يصلي، لأطأنّ رقبته؛ وكان فيما ذُكر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا محمد أبا جهل الذي يَنْهاك أن تصلي عند المقام، وهو مُعرض عن الحقّ، مكذّب به. يُعجِّب جلّ ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل، وجراءته على ربه، في نهيه محمدا عن الصلاة لربه، وهو مع أياديه عنده مكذّب به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. في قول الله: ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) قال: أبو جهل، يَنْهي محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى.
حدثنا بشر. قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد. عن قتادة ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) نـزلت في عدوّ الله أبي جهل، وذلك لأنه قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأنّ على عنقه، فأنـزل الله ما تسمعون.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قول الله: ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي، لأطأنّ على عنقه؛ قال: وكان يقال: لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل.
حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطيّ، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه أبو جهل، فنهاه أن يصلي، فأنـزل الله :( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ...) إلى قوله: كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ .
التدبر :
وقفة
[9] ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ﴾ إذا جاءت (أرأيت) فهي تدل على أن أمرًا عجيبًا سيرد ذكره.
وقفة
[9، 10] ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ حقًّا، يستحق العجب إنه يصلي فقط، لِمَ ينهاه؟!
وقفة
[9، 10] ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾، ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ [12] كل من حارب المصلحين وأهل الحسبة فهو على خطى أبي جهل في نهيه للنبي ﷺ.
وقفة
[9، 10] ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
الإعراب :
- ﴿ أَرَأَيْتَ: ﴾
- الالف الف تقرير وتنبيه بلفظ استفهام. رأيت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل رفع فاعل بمعنى اخبرني عن.
- ﴿ الَّذِي يَنْهى: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول والجملة الشرطية في الآية الكريمة الحادية عشرة في محل نصب مفعول به ثان للفعل «رأى». ينهى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «ينهى» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والضمير في «رأيت» يعود على الرسول الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلم).
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد ذَمِّ الطغيان والتحذير منه؛ ذكرَ اللهُ هنا مثالًا لِمَنْ طَغَى: أبو جهلٍ الذي كانَ يَنْهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاةِ، قال تعالى:
﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [10] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾
التفسير :
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ
ثم عجَّب - سبحانه - نبيه صلى الله عليه وسلم من حال هذا الشقى وأمثاله ، فقال : ( أَرَأَيْتَ الذي ينهى . عَبْداً إِذَا صلى ) . فالاستفهام فى قوله - تعالى - : ( أَرَأَيْتَ . . . ) للتعجيب من جهالة هذا الطاغى ، وانطماس بصيرته ، حيث نهى عن الخير ، وأمر بالشر ، والمراد بالعبد : رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكيره للتفخيم والتعظيم .
أى : أرأيت وعلمت - أيها الرسول الكريم - حالا أعجب وأشنع من حال هذا الطاغى الأحمق ، الذى ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذى خلقك وخلقه .
نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا.
ذُكر أن هذه الآية وما بعدها نـزلت في أبي جهل بن هشام، وذلك أنه قال فيما بلغنا: لئن رأيت محمدا يصلي، لأطأنّ رقبته؛ وكان فيما ذُكر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا محمد أبا جهل الذي يَنْهاك أن تصلي عند المقام، وهو مُعرض عن الحقّ، مكذّب به. يُعجِّب جلّ ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل، وجراءته على ربه، في نهيه محمدا عن الصلاة لربه، وهو مع أياديه عنده مكذّب به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. في قول الله: ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) قال: أبو جهل، يَنْهي محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى.
حدثنا بشر. قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد. عن قتادة ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) نـزلت في عدوّ الله أبي جهل، وذلك لأنه قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأنّ على عنقه، فأنـزل الله ما تسمعون.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قول الله: ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي، لأطأنّ على عنقه؛ قال: وكان يقال: لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل.
حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطيّ، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه أبو جهل، فنهاه أن يصلي، فأنـزل الله :( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ...) إلى قوله: كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[9، 10] ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ قال الرازي: «هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل؛ فكل من نهي عن طاعة الله فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد».
الإعراب :
- ﴿ عَبْداً إِذا صَلَّى: ﴾
- مفعول به للفعل «ينهى» منصوب بالفتحة. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه وحذف جوابه اختصارا لانه معلوم ولان ما قبله يدل عليه. صلى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة «صلى» في محل جر بالاضافة و «عبدا» هو النبي الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلم).
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا كان أفحشَ ما يكونُ صَدُّ العبدِ عن خدمةِ سَيِّدِه؛ قال مُعبِّرًا بالعبوديَّةِ مُنكِرًا للمبالغةِ في تقبيحِ النَّهيِ والدَّلالةِ على كمالِ العبوديَّةِ، قال تعالى:
﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [11] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴾
التفسير :
{ إِنْ كَانَ} العبد المصلي{ عَلَى الْهُدَى} العلم بالحق والعمل به،
وقوله- سبحانه-: أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى خطاب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أى: أرأيت- أيها الرسول الكريم- إن صار هذا الإنسان- الطاغي الكافر- على الهدى، فاتبع الحق، ودعا إلى البر والتقوى ... أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر، ومن نهيه إياك عن الصلاة، فجواب الشرط محذوف للعلم به.
فالمراد بالهدى: اهتداؤه إلى الصراط المستقيم، والمراد بالتقوى: صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله- تعالى-، وأمره غيره بذلك.
أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله.
القول في تأويل قوله تعالى : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11)
يقول تعالى ذكره: ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ) محمد ( عَلَى الْهُدَى ) يعني: على استقامة وسَدَاد في صلاته لربه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[11، 12] ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ أي: هذا العبد المنهي هو على الهدى، ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ أي: هو عبد مهتدٍ مصلٍ مستقيم يأمر بالتقوى، ومع هذه الحالة الطيبة والخصال الطيبة يأتيه شخص ويقول له: لا تصل، لا تأمر بالهدى، لا تأمر بالتقوى، ابتعد عن طريق الهدى، أمرك غريب، فالاستفهام يحمل معنى التوبيخ لهذا الناهي والتعجب منه.
الإعراب :
- ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ: ﴾
- اعربت. وهي زائدة مكررة للتوكيد. ان: حرف شرط جازم. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو وحذف جواب الشرط لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني التقدير ان كان على الهدى او امر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى.
- ﴿ عَلَى الْهُدى: ﴾
- جار والمجرور متعلق بخبر «كان» وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة على الالف للتعذر.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد التعجب من حالِه؛ يأتي هنا تعجب آخر، قال تعالى:
﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [12] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴾
التفسير :
{ أَوْ أَمْرٍ} غيره{ بِالتَّقْوَى} .
فهل يحسن أن ينهى، من هذا وصفه؟ أليس نهيه، من أعظم المحادة لله، والمحاربة للحق؟ فإن النهي، لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى.
قوله- سبحانه-: أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى خطاب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أى: أرأيت- أيها الرسول الكريم- إن صار هذا الإنسان- الطاغي الكافر- على الهدى، فاتبع الحق، ودعا إلى البر والتقوى ... أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر، ومن نهيه إياك عن الصلاة، فجواب الشرط محذوف للعلم به.
فالمراد بالهدى: اهتداؤه إلى الصراط المستقيم، والمراد بالتقوى: صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله- تعالى-، وأمره غيره بذلك.
بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته.
( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ) أو أمر محمد هذا الذي ينهي عن الصلاة، باتقاء الله، وخوف عقابه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى) قال محمد: كان على الهدى، وأمر بالتقوى.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى: ﴾
- سبق اعرابهما. كذب: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجواب الشرط في الآية الكريمة التالية.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ ما لَعَلَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ في تَكْمِيلِ نَفْسِهِ؛ ذَكَرَ ما لَعَلَّهُ يُعانِيهِ مِن إنْجاءِ غَيْرِهِ، قال تعالى:
﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء