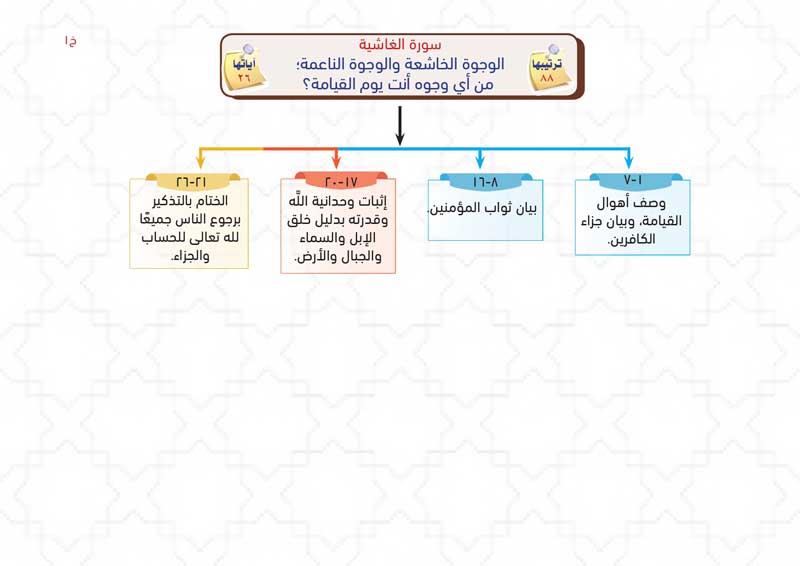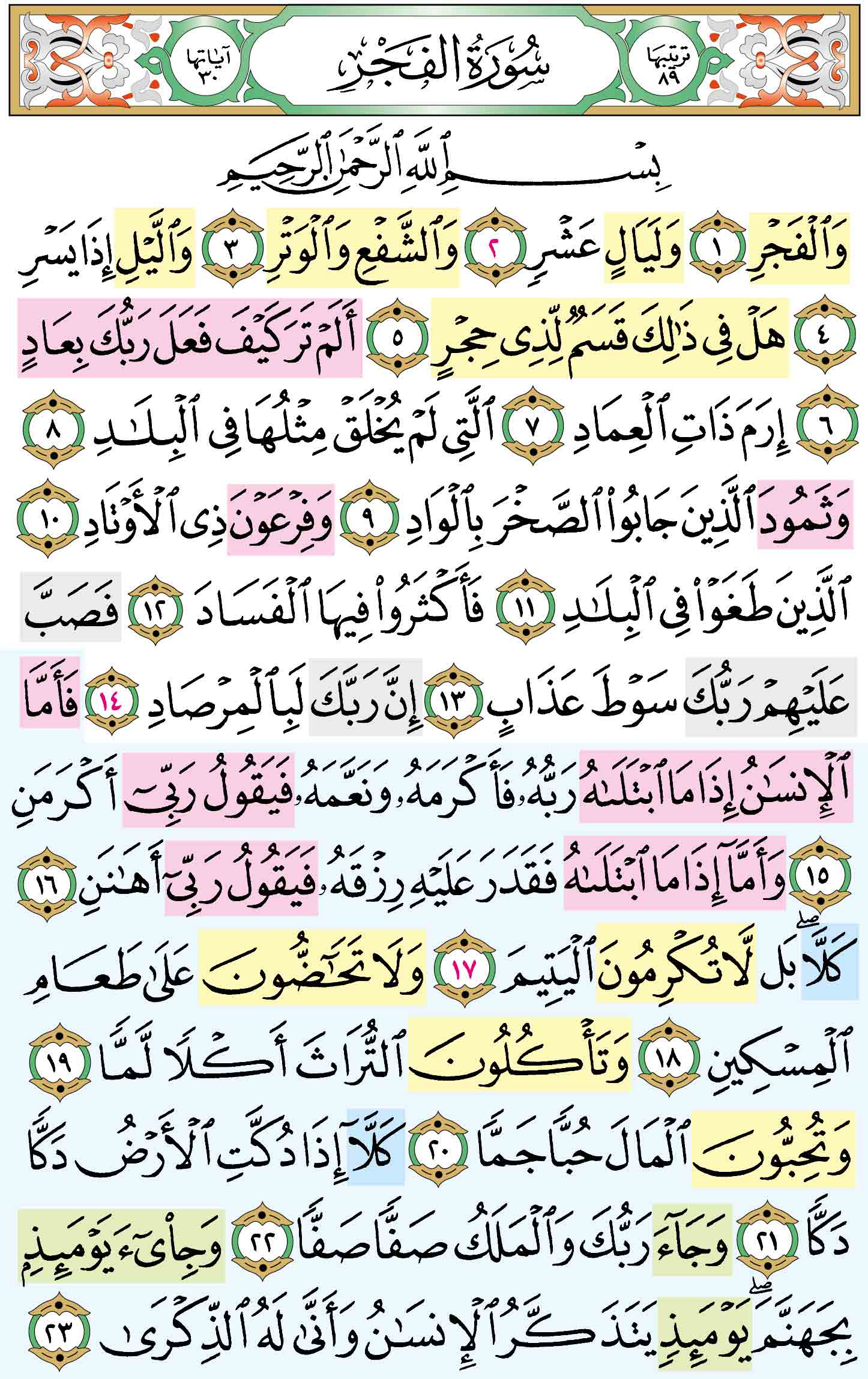
الإحصائيات
سورة الغاشية
| ترتيب المصحف | 88 | ترتيب النزول | 68 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.90 |
| عدد الآيات | 26 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.30 |
| ترتيب الطول | 86 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الاستفهام: 3/6 | _ | ||
سورة الفجر
| ترتيب المصحف | 89 | ترتيب النزول | 10 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.30 |
| عدد الآيات | 30 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |
| ترتيب الطول | 80 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| القسم: 10/17 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (14) عدد الآيات (14)
القَسَمُ بالفجرِ وعشرِ ذي الحجَّة والشَّفعِ والوترِ والليلِ على أنَّ عذابَ الكُفَّارِ واقعٌ بلا شكٍ، ثُمَّ قصصُ بعضِ الأممِ الظَّالمةِ كعادٍ وثمودَ وقومِ فرعونَ، وبيانُ ما حلَّ بهم،
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (15) الى الآية رقم (23) عدد الآيات (9)
ثُمَّ تذكيرُ المشركينَ بأنَّ حالَهم كحالِ أولئك المترفينَ الطُّغاةِ، وتنبيهُهم أنَّ كثرةَ النِّعمِ ليست دليلاً على إكرامِ اللَّهِ للعبدِ، ولا العكسِ، ثُمَّ بيانُ حبِّ الإنسانِ للمالِ، ووصفُ يومِ القيامةِ وأهوالِه، =
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة الغاشية
الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة؛ من أي وجوه أنت يوم القيامة؟
أولاً : التمهيد للسورة :
- • نقاط السورة: السورة تدور حول: والهدف من هذا التذكير هو: الاستعداد.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الغاشية».
- • معنى الاسم :: الغاشية: اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى -أي تغطي- الخلائق بأهوالها وشدائدها.
- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لَفْظِ «الْغَاشِيَةِ» فِي أَولهَا.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «هَلْ أَتَاكَ»، و«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الخوف من أهوال القيامة، والتذكير بجزاء الأبرار وجزاء الكفار.
- • علمتني السورة :: أن وجوه الناس يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: وجوه خاشعة، وجوه ناعمة، فاتق الله تكن من أصحاب الوجوه الناعمة: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ... وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ...﴾
- • علمتني السورة :: كم من ناصب خاشع؛ عمله لا يسمن ولا يغني من جوع؛ لأنه لم يتقنه: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾
- • علمتني السورة :: المجالس التي تخلو من اللغو من نعيم أهل الجنة: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِـ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)».
• عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: «كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبَرنا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الغاشية من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الغاشية من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • يستحب قراءة سورة الغاشية مع سورة الأعلى في صلاة العيد والجمعة (لحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ السابق).
• كما يستحب قراءة سورة الغاشية مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة (سبق الحديث منذ قليل).
• وتقرأ في الركعة الثانية في كلتا الصلاتين، والسنة في ما سبق أن تقرأ السورة كاملة، ولا يقتصر على بعضها.
• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعد ليوم القيامة.
• أن نحرص على الإخلاص ومتابعة السنة في أعمالنا: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ (3، 4).
• أن نهتم بالترتيب والنظام؛ فهذا من نعيم الجنة: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ (15).
• أن نكثر من التفكر في خلق الله: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (17).
• أن نُذكَّرَ مسلمًا بالله: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ (21).
• ألا نشق على أنفسنا ولا نحزن إن أعرض الناس عن دعوتنا: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (20، 21 ).
• أن نقرأ سورة الغاشية مع سورة الأعلى في صلاة العيد والجمعة .
• أن نقرأ سورة الغاشية مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة .
سورة الفجر
لكل مقدمة خاتمة/ إهلاك الطغاة والجبابرة
أولاً : التمهيد للسورة :
- • نقاط السورة: السورة تدور حول: مقدمة الشيء عنوان يقود إلى الخاتمة، والخاتمة هي النتيجة الطبيعية للمقدمة، وفي قول الإنسان: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (24) دليل واضح أن الدنيا هي المقدمة، وأن الآخرة هي الخاتمة، وإذا كانت المقدمة من صنع الإنسان فهو الذي يختار ويعمل، وهو الذي يصوغها كما يشاء؛ فإن الخاتمة والنتائج النهائية من صناعة الخالق، فهو الذي يقوم بها، وهي نتائج واضحة سلفًا لا تحتاج إلى فكر وروية، وكل إنسان يرى خاتمته التي تنتظره في ضوء مقدمته التي اختارها.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الفجر».
- • معنى الاسم :: الفجر: هو ضوء الصباح قبل ظهور الشمس.
- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالفجر.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها أسماء آخرى
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: إهلاك الله للطغاة والجبابرة.
- • علمتني السورة :: فضل العشر من ذي الحِجَّة: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾
- • علمتني السورة :: أن كثرة فساد الظالم في الأرض؛ مؤذنٌ بقرب عقوبته وزواله: ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾
- • علمتني السورة :: ازجر نفسَك وهدِّد من ظلمَك بـ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الفجر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الفجر من المفصل.
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الفجر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نطمئن؛ فهذا الليل الذي يحياه المؤمنون إلى زوال، مهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر.
• أن نستشعر أن كل ما نقوم به فالله يرصده وسيحاسبنا عليه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (14).
• أن نرضى بقضاء الله وقدره: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ (16).
• أن نكرم اليتامى والفقراء والمساكين؛ ولا نكتفي بتقديم الطعام والشراب فقط: ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (17).
• أن نحض غيرنا على الإنفاق والإحسان للمحتاجين: ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (18).
• أن نقسم المواريث بحسب الشرع: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ (19).
• أن نتذكر دومًا عرض جهنم يوم القيامة: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (23، 24).
• أن نغتنِم الحياةَ، فإنَّما هي ساعاتٌ قبل أن يحِلَّ زمانُ الأمنياتِ: ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (24).
• أن نسأل الله حسن الخاتمة: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (27، 28).
تمرين حفظ الصفحة : 593
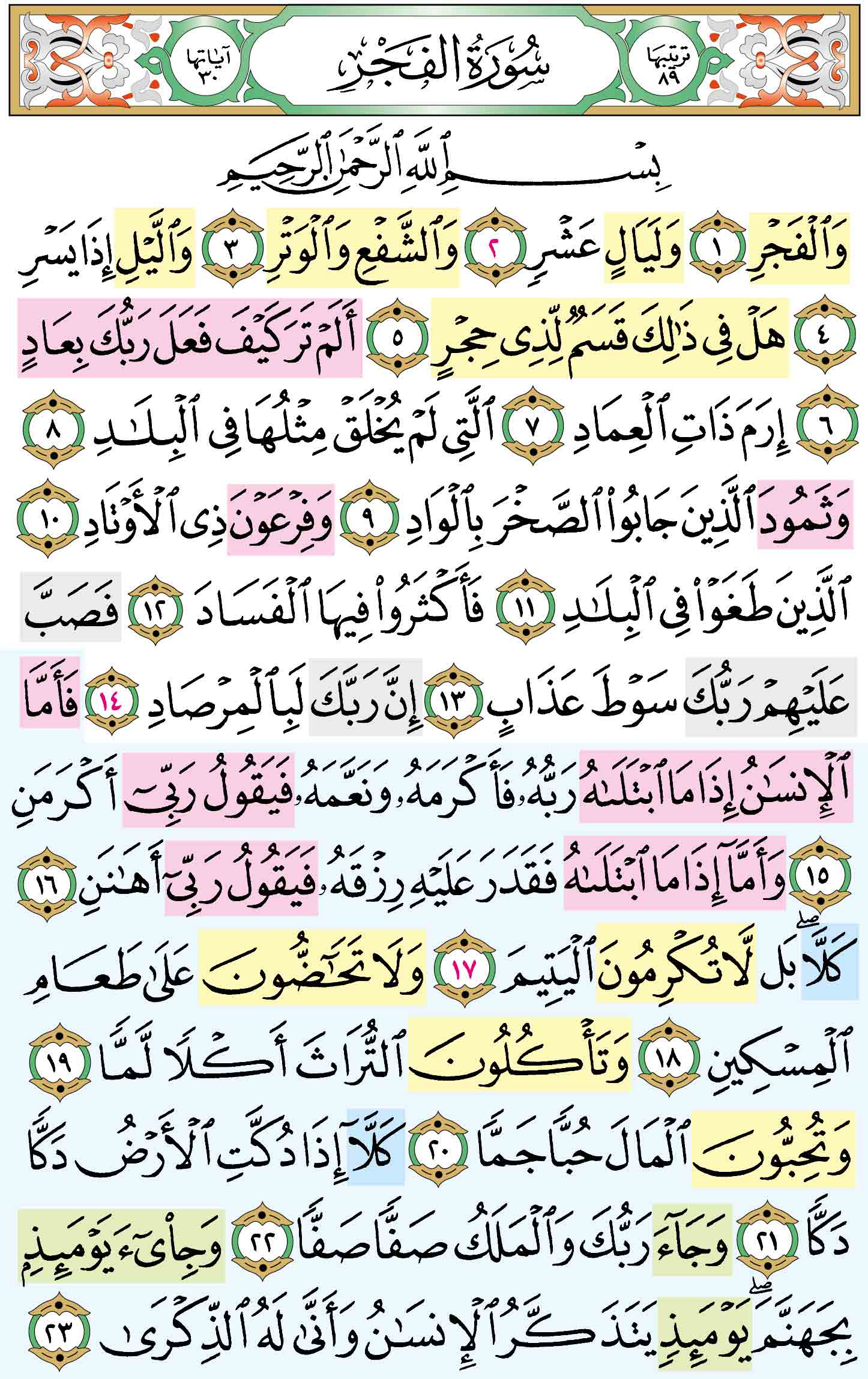
مدارسة الآية : [23] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾
التفسير :
{ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ} أي:لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله
وقوله- سبحانه-: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ كلام معترض بين قوله: فَذَكِّرْ ... وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ والاستثناء فيه استثناء منقطع، و «إلا» بمعنى لكن، و «من» موصولة مبتدأ.. والخبر. «فيعذبه الله العذاب الأكبر» ..
أى: داوم- أيها الرسول الكريم- على التذكير.. لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك وإرشادك، وأصر على كفره، فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا.
وقوله : ( إلا من تولى وكفر ) أي : تولى عن العمل بأركانه ، وكفر بالحق بجنانه ولسانه . وهذه كقوله : ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) [ القيامة : 31 ، 32 ]
وقوله: ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) يتوجَّه لوجهين: أحدهما: فذكر قومك يا محمد، إلا من تولى منهم عنك، وأعرض عن آيات الله فكفر، فيكون قوله " إلا " استثناء من الذين كان التذكير عليهم، وإن لم يذكروا، كما يقال: مضى فلان، فدعا إلا من لا تُرْجَى إجابته، بمعنى: فدعا الناس إلا من لا ترجى إجابته. والوجه الثاني: أن يجعل قوله: ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) منقطعا عما قبله، فيكون معنى الكلام حينئذ لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، يعذّبه الله، وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأن يحسن معه إنّ، فإذا حسنت معه كان منقطعا، وإذا لم تحسن كان استثناء متصلا صحيحا، كقول القائل: سار القوم إلا زيدا، ولا يصلح دخول إن هاهنا لأنه استثناء صحيح.
التدبر :
لمسة
[23، 24] ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ من أهل العلم من قال: (إِلَّا) هنا بمعنى: (لكن)، فالمعنى: لكن من تولى وكفر ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِلَّا مَنْ: ﴾
- اداة استثناء. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى بإلا وهو استثناء منقطع اي لست بمستول عليهم ولكن من تولى. ويجوز ان يكون استثناء متصلا من قوله فذكرهم اي فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى.
- ﴿ تَوَلَّى وَكَفَرَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «تولى» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. وكفر: معطوفة بالواو على «تولى» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة الظاهرة اي من اعرض وكفر فاستحق العذاب.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [23] لما قبلها : ولَمَّا نفى عنهم تسَلُّطَ الدُّنيا، وكان التَّقديرُ: فمَنْ أقْبَلَ وآمَنَ فإنَّ اللهَ يُنَعِّمُه النَّعيمَ الأكبَرَ؛ قال مُستَدرِكًا قَسيمَهم في صورةِ الاستثناءِ، قال تعالى:
﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
إلا:
1- حرف استثناء، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- ألا، حرف تنبيه، وهى قراءة ابن عباس، وزيد بن على، وقتادة، وزيد بن أسلم.
مدارسة الآية : [24] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴾
التفسير :
{ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ} أي:الشديد الدائم،
وقوله- سبحانه-: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ كلام معترض بين قوله: فَذَكِّرْ ... وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ والاستثناء فيه استثناء منقطع، و «إلا» بمعنى لكن، و «من» موصولة مبتدأ.. والخبر. «فيعذبه الله العذاب الأكبر» ..
أى: داوم- أيها الرسول الكريم- على التذكير.. لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك وإرشادك، وأصر على كفره، فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا.
ولهذا قال : ( فيعذبه الله العذاب الأكبر ) قال الإمام أحمد :
حدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية ، فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ألا كلكم يدخل الجنة ، إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله " .
تفرد بإخراجه الإمام أحمد وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ، ولم يزد على ما هاهنا : " روى عن أبي أمامة ، وعنه سعيد بن أبي هلال " .
وقوله: ( فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ ) : هو عذاب جهنم، يقول: فيعذبه الله العذاب الأكبر على كفره في الدنيا، وعذاب جهنم في الآخرة.
المعاني :
التدبر :
لمسة
[24] قال تعالى: ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ﴾ ولم يقل: (الكبير)، وفي ذلك لطيفة، قال أهل العلم: وإنما قال: (الأكبر)؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل.
تفاعل
[24] ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.
الإعراب :
- ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ: ﴾
- الفاء استئنافية او عاطفة على مضمر اي فان لله الولاية والقهر فهو يعذبه اي يتولاه فيعذبه. يعذبه: فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.
- ﴿ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الأكبر: صفة- نعت- للعذاب مرفوعة بالضمة اي الذي هو عذاب جهنم او تكون «العذاب مفعولا به ثانيا. وتكون الجملة الفعلية على المعنى في محل رفع خبر المبتدأ المقدر «هو».
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [24] لما قبلها : وبعد الشرط؛ جاء جوابُ الشرط، قال تعالى:
﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [25] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾
التفسير :
{ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ} أي:رجوع الخليقةوجمعهم في يوم القيامة.
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ.
وهاتان الآيتان تعليل لقوله- تعالى- قبل ذلك لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
والإياب مأخوذ من الأوب بمعنى الرجوع إلى المكان الذي كان فيه قبل ذلك. والمراد به هنا: الرجوع إلى الله- تعالى- يوم القيامة للحساب والجزاء.
أى: داوم- أيها الرسول الكريم- على تذكير الناس بدعوة الحق، بدون إجبار لهم، أو تسلط عليهم، واتركهم بعد ذلك وشأنهم.. فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا،
وقوله : ( إن إلينا إيابهم ) أي : مرجعهم ومنقلبهم
وقوله: ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ) يقول: إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ) يقول: ثم إن على الله حسابه، وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه، يُعْلِمُ بذلك نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه المتولي عقوبته دونه، وهو المجازي والمعاقب، وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ الرسالة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) قال: حسابه على الله.
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ إِلَيْنا: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الى: حرف جر و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالى. والجار والمجرور «شبه الجملة» في محل رفع خبر «ان» المقدم.
- ﴿ إِيابَهُمْ: ﴾
- اسم «ان» مؤخر منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي رجوعهم. وفي تقديم الجار والمجرور- الظرف- تشديد في الوعيد.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [25] لما قبلها : وبعد بيان تعذيب الله لمن تولى وكفر؛ أَكَّدَ هنا أنه لا خلاص لهم من الويل الذي أوعدوا به، فإنهم راجعون إلى الله، قال تعالى:
﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
إيابهم:
1- بتخفيف الياء، مصدر «آب» ، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بشدها، وهى قراءة أبى جعفر، وشيبة.
مدارسة الآية : [26] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾
التفسير :
{ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر.
آخر تفسير سورة الغاشية، والحمد لله رب العالمين
ثم إن علينا وحدنا- أيضا- حسابهم على أعمالهم، ومجازاتهم عليها بالجزاء الذي نراه مناسبا لهم.
وصدر- سبحانه- الآيتين بحرف التأكيد «إن» وعطف الثانية على الأولى بحرف «ثم» المفيد للتراخي في الرتبة، وقدم خبر «إن» في الجملتين على اسمها.. لإفادة التهديد والوعيد، وتأكيد أن رجوعهم إليه- تعالى- أمر لا شك فيه. وأن حسابهم يوم القيامة سيكون حسابا عسيرا، لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
( ثم إن علينا حسابهم ) أي : نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .
آخر تفسير سورة " الغاشية " ولله الحمد والمنة .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ) يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب.
آخر تفسير سورة الغاشية
المعاني :
التدبر :
وقفة
[25، 26] ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ إن كان الأمر كذلك، فأين المفر؟!
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ ﴾
- معطوفة بثم على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. ومعنى «ثم» الدلالة على أن الحساب أشد من الإياب لأنه موجب العذاب اي حسابهم على كفرهم.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [26] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الحِسابُ مُتَأخِّرًا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وعَظِيمًا كَمًّا وكَيْفًا؛ عَظَّمَهُ بِأداةِ التَّراخِي، فقال تعالى:
﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالْفَجْرِ ﴾
التفسير :
الظاهر أن المقسم به، هو المقسم عليه، وذلك جائز مستعمل، إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمًا، وهو كذلك في هذا الموضع.
فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار، من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبرلجميع الأمور، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح:ليالي عشر رمضان، أو [عشر] ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها.
تفسير سورة الفجر
مقدمة وتمهيد
1- سورة «الفجر» من السور المكية الخالصة، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور قرآنية، فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة «والليل إذا يغشى» ، وقبل سورة «الضحى» ، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التاسعة والثمانون.
وعدد آياتها: ثلاثون آية في المصحف الكوفي، واثنتان وثلاثون في الحجازي، وتسع وعشرون في البصري.
2- ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة: تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، كقوم عاد وثمود وفرعون، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة، برضا ربها عنها، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرض.
افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء لها شرفها وعظمها ، ولها فوائدها الدينية والدنيوية . . ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته - تعالى - .
أقسم أولا - بالفجر ، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم ، ووقت بزوغ الضياء وانتشاره علىالكون بعد ليل بهيم .
فالمراد بالفجر : الوقت الذى يبدأ فيه النهار فى الظهور ، بعد ظلام الليل ، والتعريف فيه للجنس ، لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم .
وقيل المراد بالفجر هنا : صلاة الفجر ، لأنها صلاة مشهودة ، أى : تشهدها الملائكة ، كما أن التعريف فيه للعهد ، فقيل : فجر يوم النحر ، وقيل : فجر يوم الجمعة . .
ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح ، لأن قوله - تعالى - بعد ذلك ( وَلَيالٍ عَشْرٍ ) يرجح أن المراد به وقت معين . هذا الوقت يوجد مع كل يوم جديد .
تفسير سورة الفجر وهي مكية .
قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن سليمان ، عن محارب بن دثار وأبي صالح ، عن جابر قال : صلى معاذ صلاة ، فجاء رجل فصلى معه فطول ، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف ، فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل الفتى ، فقال : يا رسول الله ، جئت أصلي معه فطول علي ، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد ، فعلقت ناضحي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفتان يا معاذ ؟ أين أنت من ( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) ( والفجر ) ( والليل إذا يغشى ) .
أما الفجر فمعروف ، وهو : الصبح . قاله علي ، وابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي . وعن مسروق ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة ، وهو خاتمة الليالي العشر .
وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده ، كما قاله عكرمة .
وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس .
القول في تأويل قوله تعالى : وَالْفَجْرِ (1)
هذا قسم، أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالفجر، وهو فجر الصبح.
واختلف أهل التأويل في الذي عُنِي بذلك، فقال بعضهم: عُنِي به النهار.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأغرّ المِنقريّ، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْفَجْرِ ) قال: النهار.
وقال آخرون: عُنِيَ به صلاة الصبح.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْفَجْرِ ) يعني: صلاة الفجر.
وقال آخرون: هو فجر الصبح.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عكرِمة، في قوله: ( وَالْفَجْرِ ) قول: الفجر: فجر الصبح.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ( وَالْفَجْرِ ) قال: الفجر: قسم أقسم الله به.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ إن إدبار الليل وإقبال النهار آية من الآيات اليومية الباهرة الدالة على كمال قدرة الله، وأنه وحده المدبر لكل الأمور، فتفاءل برب قدير كريم.
عمل
[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قال ابن عباس: «هو انفجار الصبح كل يوم»، يقسم ربنا برحيل الظلام وميلاد الضياء، فأبشروا.
وقفة
[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ الفَجر والفرَج: بينهما تقارب في المبنى والمعنى، وهو الانتقال من حالة إلى أحسن منها، الفجر من ظلام إلى نور، والفرج من ضيق إلى سعة.
عمل
[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (الفجر، الفرج) نفس الحروف، مع اختلاف الترتيب، فهما متقاربان في المبنى والمعنى، فمع كل فجر يسبقه ظلام، تذكَّر قرب الفرج مهما طالت الأيام.
عمل
[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ أقسم الله بالفجر في سياق القسم بأزمان فاضلة؛ بيانًا لفضل الفجر وبركته, فلنحرص علي اغتنام بركاته.
لمسة
[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قسمٌ وجوابه مع ما بعده محذوفٌ، تقديرهُ: لتعذبُنَّ يا كفَّارَ مكة.
وقفة
[1، 2] ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ العظيم لا يقسم إلا بعظيم.
وقفة
[1، 2] ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قسم بإدبار الظلام وميلاد الضياء.
وقفة
[1، 2] ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هذه الأيام التي كان الصحابة يجتهدون فيها بالعبادة، فهي أفضل الأيام على الإطلاق؛ لأنه يجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من أمهات العبادات؛ من صلاة وصيام وصدقة، ولا يتأتى هذا الاجتماع في غير هذه الأيام، وعلى رأس العبادات التي فيها الحج.
الإعراب :
- ﴿ وَالْفَجْرِ: ﴾
- الواو واو القسم حرف جر. الفجر: مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف اي أقسم بالفجر وابدلت الباء بالواو او يكون التقدير: ورب الفجر او وحق الفجر.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ على أنَّ عذابَ الكُفَّارِ واقعٌ بلا شكٍّ، فأقسمَ اللهُ بـ: ١- الفجر، قال تعالى:
﴿ وَالْفَجْرِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾
التفسير :
وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها، صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام.
وفي أيام عشر ذي الحجة، الوقوف بعرفة، الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة، مستحقة لأن يقسم الله بها.
وأقسم- سبحانه- ثانيا بقوله: وَلَيالٍ عَشْرٍ والمراد بها: الليالى العشر الأول من شهر ذي الحجة، لأنها وقت مناسك الحج، ففيها الإحرام، والطواف، والوقوف بعرفة..
وقيل المراد بها: الليالى العشر الأواخر من رمضان وقيل: الليالى العشر الأول من شهر المحرم..
قال الإمام ابن كثير: والليالى العشر: المراد بها: عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف.
وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام العمل الصالح، أحب إلى الله- تعالى- فيهن، من هذه الأيام» - يعنى: عشر ذي الحجة- قالوا: «ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء» ..
وقيل: المراد بذلك: العشر الأول من المحرم. وقيل: العشر الأول من رمضان.
والصحيح القول الأول.. .
الليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن عباس ، وابن الزبير ، ومجاهد ، وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت في صحيح البخاري ، عن ابن عباس مرفوعا : " ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام " - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء " .
وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم ، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدينة ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ( وليال عشر ) قال : هو العشر الأول من رمضان .
والصحيح القول الأول ; قال الإمام أحمد :
حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عياش بن عقبة ، حدثني خير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن العشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم النحر " .
ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله ، كل منهما عن زيد بن الحباب ، به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، من حديث زيد بن الحباب ، به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم ، وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم.
وقوله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أيّ ليال هي، فقال بعضهم: هي ليالي عشر ذي الحجة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن زرارة، عن ابن عباس، قال: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها، هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) : عشر الأضحى؛ قال: ويقال: العشر: أولَ السنة من المحرم.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وَهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزبير ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) أوّل ذي الحجة إلى يوم النحر.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عوف، قال: ثنا زرارة بن أوفى، قال: قال ابن عباس: إن الليالي العشر اللاتي أقسم الله بهنّ: هن الليالي الأوَل من ذي الحجة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجة، وهي التي وعد الله موسى صلى الله عليه وسلم.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عكرِمة ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأغرّ المنقريّ، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر الأضحى.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: كنا نحدَّث أنها عشر الأضحى.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثَور، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، قال: ليس عمل في ليال من ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر، وهي عشر موسى التي أتمَّها الله له.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن أبى إسحاق، عن مسروق، قال: ليال العشر، قال: هي أفضل أيام السنة.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) يعني: عشر الأضحى.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: أوّل ذي الحجة؛ وقال: هي عشر المحرّم من أوّله.
والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأن عبد الله بن أبي زياد القَطْوانيّ، حدثني قال: ثني زيد بن حباب، قال: أخبرني عياش بن عقبة، قال: ثني جُبير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "(وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ) قال: عَشْرُ الأضْحَى ".
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ فضلُ العشرِ من ذي الحِجَّة.
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ سبحان من فضل هذه الأمة، وفتح لها على يدي نبيها نبي الرحمة، أبواب الفضائل الجمة! فما من عمل عظيم يقوم به قوم، ويعذر عنه آخرون؛ إلا وقد جعل الله عملًا يقاومه، أو يفضل عليه، فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه.
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ يا عبد الله لذ بالجناب ذليلًا، وقف على الباب طويلًا، واتخذ في هذه العشر سبيلًا، واجعل جناب التوبة مقيلًا، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا، قل في الأسحار: «أنا تائب»، ناد في الدجى: «قد قدم الغائب».
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هي ليال معلومة للسامعين، موصوفة بأنها عشر، ولم يقل (الليالي العشر)؛ لأن في تنوينها تعظيمًا، وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج، ففيها غالبًا الإحرام، ودخول مكة، وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروية، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر.
لمسة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ إن قلتَ: كيف نكَّرها دون بقيَّةِ ما أقسم به؟ قلتُ: لاختصاصها من بين الليالي بفضيلةٍ ليست لغيرها، فلم يُجمع بينها وبين البقيَّة بلام الجنس.
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ مَن عجَز عن الحج في عامٍ؛ قدر في العشر على عمل يعمله في بيته؛ يكون أفضلَ من الجهاد.
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هي عشر ليال ليس غير, ولكنها تعدل الكثير الغفير, فالعبرة ليست بالعدد, ولكن بما يجعل الله فيها من خير وبركة.
وقفة
[2] من أسرار التعبير بهذه الجملة: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ فليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة، التي هي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام، ودخول مكة، وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروبة، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر.
وقفة
[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ إن كان في نهار العشر فضيلة الصيام، ففي لياليها فضيلة القيــام والوتــر.
الإعراب :
- ﴿ وَلَيالٍ عَشْرٍ: ﴾
- معطوفة بالواو على «الفجر» مجرورة مثلها وعلامة جرها الفتحة المقدرة على الياء قبل حذفها ولان الاصل «ليالي» بالفتح لانه ممنوع من الصرف فاختصرت الفتحة النائبة عن الكسرة لثقلها وعوض التنوين بما حذف. عشر: صفة- نعت- لليال مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المنونة. وهي عشر ذي الحجة ونونت «لَيالٍ عَشْرٍ» لانها ليال مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها وجواب القسم محذوف التقدير: لنعذبن المشركين.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، قال تعالى:
﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
وليال عشر:
1- بالتنوين، فيهما، وهى قراءة الجمهور.
وقرئا:
2- بالإضافة، وهى قراءة ابن عباس.
مدارسة الآية : [3] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾
التفسير :
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
وأقسم- سبحانه- ثالثا ورابعا بقوله: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ والشفع: ما يكون ثانيا لغيره، والوتر: هو الشيء المنفرد.
وقد ذكر المفسرون في المراد بهذين اللفظين أقوالا متعددة، فمنهم من يرى أنهما يعمان كل الأشياء شفعها ووترها، ومنهم من يرى أن المراد بالشفع: يوم النحر، لكونه اليوم العاشر من ذي الحجة، وأن المراد بالوتر: يوم عرفة، لأنه اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. ومنهم من يرى أن المراد بهما: الصلاة المكتوبة، ما كان منها شفعا، كصلاة الظهر والعصر والعشاء والصبح، وما كان منها وترا كالمغرب.
ومنهم من يرى أن المراد بالشفع: جميع المخلوقات، وبالوتر: الله- تعالى- الواحد الصمد.
وقد رجح بعض العلماء هذا القول فقال ما ملخصه: والواقع أن أقرب الأقوال عندي- والله أعلم-. أن المراد بالوتر، هو الله- تعالى-، للحديث: «إن الله وتر يحب الوتر» ، وما سواه شفع.. لأنه ثبت علميا أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى الوتر قط، حتى الحصاة الصغيرة، فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات، والذرة لها نواة ومحيط.
ولهذا كان القول بأن الوتر هو الله، وبأن الشفع: جميع المخلوقات.. هو الراجح، وهو الأعم في المعنى.. .
وقوله : ( والشفع والوتر ) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة ، لكونه التاسع ، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . وقاله ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك أيضا .
قول ثان : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثني عقبة بن خالد ، عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله : ( والشفع والوتر ) قلت : صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لا ولكن الشفع يوم عرفة ، والوتر ليلة الأضحى .
قول ثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، حدثني أبي ، عن النعمان - يعني ابن عبد السلام - عن أبي سعيد بن عوف ، حدثني بمكة قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن الشفع والوتر . فقال : الشفع قول الله ، - عز وجل - : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) والوتر قوله : ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) [ البقرة : 203 ] .
وقال ابن جريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول : الشفع أوسط أيام التشريق ، والوتر آخر أيام التشريق .
وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر " .
قول رابع : قال الحسن البصري ، وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع ، ووتر ، أقسم تعالى بخلقه . وهو رواية عن مجاهد ، والمشهور عنه الأول .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( والشفع والوتر ) قال : الله وتر واحد ، وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة ، والوتر : صلاة المغرب .
قول خامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عبيد بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : ( والشفع والوتر ) قال : الشفع الزوج ، والوتر : الله - عز وجل - .
وقال أبو عبد الله ، عن مجاهد : الله الوتر ، وخلقه الشفع ، الذكر والأنثى .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : ( والشفع والوتر ) كل شيء خلقه الله شفع ، السماء والأرض ، والبر والبحر ، والجن والإنس ، والشمس والقمر ، ونحو هذا . ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) [ الذاريات : 49 ] أي : لتعلموا أن خالق الأزواج واحد .
قول سادس : قال قتادة ، عن الحسن : ( والشفع والوتر ) هو العدد ، منه شفع ومنه وتر .
قول سابع : في الآية الكريمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ، ثم قال ابن جرير : وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير : حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني ، حدثنا زيد بن الحباب ، أخبرني عياش بن عقبة ، حدثني خير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الشفع اليومان ، والوتر اليوم الثالث " .
هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم ، وما رواه هو أيضا ، والله أعلم .
قال أبو العالية ، والربيع بن أنس ، وغيرهما : هي الصلاة ، منها شفع كالرباعية والثنائية ، ومنها وتر كالمغرب ، فإنها ثلاث ، وهي وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل .
وقد قال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عمران بن حصين : ( والشفع والوتر ) قال : هي الصلاة المكتوبة ، منها شفع ومنها وتر . وهذا منقطع وموقوف ، ولفظه خاص بالمكتوبة . وقد روي متصلا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه عام ، قال الإمام أحمد :
حدثنا أبو داود - هو الطيالسي - حدثنا همام ، عن قتادة ، عن عمران بن عصام : أن شيخا حدثه من أهل البصرة ، عن عمران بن حصين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشفع والوتر ، فقال : " هي الصلاة ، بعضها شفع ، وبعضها وتر " .
هكذا وقع في المسند ، وكذا رواه ابن جرير عن بندار ، عن عفان وعن أبي كريب ، عن عبيد الله بن موسى ، كلاهما عن همام - وهو ابن يحيى - عن قتادة ، عن عمران بن عصام ، عن شيخ ، عن عمران بن حصين وكذا رواه أبو عيسى الترمذي ، عن عمرو بن علي ، عن ابن مهدي وأبي داود ، كلاهما عن همام ، عن قتادة ، عن عمران بن عصام ، عن رجل من أهل البصرة ، عن عمران بن حصين ، به . ثم قال : غريب ، لا نعرفه إلا من حديث قتادة ، وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة .
وقد روي عن عمران بن عصام ، عن عمران نفسه ، والله أعلم .
قلت : ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن عمران بن عصام الضبعي - شيخ من أهل البصرة - عن عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، هكذا رأيته في تفسيره ، فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام [ الضبعي ] .
وهكذا رواه ابن جرير : حدثنا نصر بن علي ، حدثني أبي ، حدثني خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن عمران بن عصام ، عن عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفع والوتر قال : " هي الصلاة منها شفع ، ومنها وتر " .
فأسقط ذكر الشيخ المبهم ، وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري ، إمام مسجد بني ضبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه قتادة ، وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد ، وأبو التياح يزيد بن حميد . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة ، وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف ، ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث ، وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد . وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه ، والله أعلم .
ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر .
وقوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ) اختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به من الوتر بقوله: ( والْوَتْرِ ) فقال بعضهم: الشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس، قال: الوتر: يوم عرفة، والشفع: يوم الذبح.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عوف، قال: ثنا زرارة بن أوفى، قال: قال ابن عباس: الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، قال: قال عكرِمة، عن ابن عباس: الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله، عن عكرِمة ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة.
وحدثنا به مرّة أخرى، فقال: الشفع: أيام النحر، وسائر الحديث مثله.
حدثني يعقوب: قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عكرِمة في قوله: ( والشَّفْعِ ) قال: يوم النحر ( والْوَتْرِ ) قال: يوم عرفة.
حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرِمة، قال: الشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة.
قال: ثنا مهران، عن أبي سنان، عن الضحاك ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) قال: أقسم الله بهنّ لما يعلم من فضلهنّ على سائر الأيام، وخير هذين اليومين لما يُعلَم من فضلهما على سائر هذه الليالي ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان عكرِمة يقول: الشفع: يوم الأضحى، والوتر: يوم عرفة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: قال عكرِمة: عرفة وَتْر، والنحر شفع، عرفة يوم التاسع، والنحر يوم العاشر.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( والشَّفْعِ ) يوم النحر ( والْوَتْرِ ) يوم عرفة.
وقال آخرون: الشفع: اليومان بعد يوم النحر، والوَتر: اليوم الثالث.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: يومان بعد يوم النحر، والوتر: يوم النَّفْر الآخرِ، يقول الله: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .
وقال آخرون: الشفع: الخلق كله، والوتر: الله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الله وتر، وأنتم شفع، ويقال: الشفع: صلاة الغداة، والوتر صلاة المغرب.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: كلّ خلق الله شفع، السماء والأرض والبرّ والبحر والجنّ والإنس والشمس والقمر، والله الوَتر وحده.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال مجاهد، في قوله: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ قال: الكفر والإيمان، والسعادة والشقاوة، والهدى والضلالة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والجنّ والإنس، والوَتْر: الله؛ قال: وقال في الشفع والوتر مثل ذلك.
حدثني عبد الأعلى بن واصل، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: خلق الله من كل شيء زوجين، والله وَتْر واحد صَمَد.
حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: الزوج، والوتر: الله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الوتر: الله، وما خلق الله من شيء فهو شفع.
وقال آخرون: عُنِيَ بذلك الخلق، وذلك أن الخلق كله شفع ووتر.
قال: ثنا ابن ثور، عن مَعْمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الخلق كله شفع ووتر، وأقسم بالخلق.
قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن في ذلك: الخلق كله شفع ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: كان أبي يقول: كلّ شيء خلق الله شفع ووتر، فأقسم بما خلق، وأقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون.
وقال آخرون: بل ذلك: الصلاة المكتوبة، منها الشفع كصلاة الفجر والظهر، ومنها الوتر كصلاة المغرب.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال: كان عمران بن حصين يقول: ( الشَّفْعِ والْوَتْرِ ) : الصلاة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال عمران: هي الصلاة المكتوبة فيها الشفع والوتر.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: ذلك صلاة المغرب، الشفع: الركعتان، والوتر: الركعة الثالثة، وقد رفع حديث عمران بن حصين بعضهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثني أبي، قال: ثني خالد بن قيس، عن قتادة، عن عمران بن عصام، عن عمران بن حصين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم - في الشفع والوتر - قال: " هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ، وَمِنْها وَتْرٌ".
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا همام، عن قتادة، أنه سُئل عن الشفع والوتر، فقال: أخبرني عمران بن عصام الضُّبعي، عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: " هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ، وَمنها وَتْرٌ".
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن عمران بن عصام، عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: " هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ، وَمِنْها وَتْرٌ".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) إن من الصلاة شفعا، وإن منها وترا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، أنه سُئل عن الشفع والوتر، فقال: قال الحسن: هو العدد. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزُّبير.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطْوَانيّ، قال: ثنا زيد بن حُباب، قال: أخبرني عَياش بن عقبة، قال: ثني جبير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشَّفْع: الْيَوْمَانِ وَالْوَتْرُ: الْيَوْمُ الْوَاحِدُ".
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا لعموم قسَمه بذلك.
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( وَالْوَتْرِ ) فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة بكسر الواو.
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قَرَأةِ الأمصار، ولغتان مشهورتان في العرب، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
المعاني :
التدبر :
عمل
[3] ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ صلِّ صلاة الوتر.
وقفة
[3] أقسم الله بيوم عرفة مرتين في كتابه: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ الوتر هو يوم عرفة، ﴿وشاهد ومشهود﴾ [البروج: 3] المشهود هو يوم عرفة.
الإعراب :
- ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «الفجر» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. والوتر: معطوفة بالواو على «الشفع» وتعرب اعرابها اي ويوم النحر ويوم عرفة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٣، ٤- الزوج والفرد من الأشياء، قال تعالى:
﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
والوتر:
1- بفتح الواو وسكون التاء، وهى لغه قريش، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بكسر الواو، وهى لغة تميم، وهى قراءة الأغر، عن ابن عباس، وأبى رجاء، وابن وثاب، وقتادة، وطلحة، والأعمش، والحسن، بخلاف عنه، والأخوين.
مدارسة الآية : [4] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾
التفسير :
{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} أي:وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون، رحمة منه تعالى وحكمة.
وأقسم- سبحانه- خامسا- بقوله: وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ أى: وحق الليل عند ما يسرى ويمضى، تاركا من خلفه ظلامه، ليحل محله النهار بضيائه.
أو المعنى: وحق الليل وقت أن يسرى فيه السارون، بعد أن أخذوا حظهم من النوم، فإسناد السّرى إلى الليل على سبيل المجاز، كما في قولهم: ليل نائم، أى: ينام فيه الناس، وقرأ الجمهور يسر بحذف الياء وصلا ووقفا، اكتفاء عنها بالكسرة تخفيفا.
وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء عند الوصل، وبحذفها عند الوقف.
والمراد بالليل هنا: عمومه، وقيل: المراد به هنا: ليلة القدر، أو ليلة المزدلفة.
وقوله : ( والليل إذا يسر ) قال العوفي ، عن ابن عباس : أي إذا ذهب .
وقال عبد الله بن الزبير : ( والليل إذا يسر ) حتى يذهب بعضه بعضا .
وقال مجاهد ، وأبو العالية ، وقتادة ، ومالك ، عن زيد بن أسلم وابن زيد : ( والليل إذا يسر ) إذا سار .
وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس ، أي : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار ، أي : أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب ; لأنه في مقابلة قوله : ( والفجر ) فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل ، فإذا حمل قوله : ( والليل إذا يسر ) على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار ، وبالعكس ، كقوله : ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ) [ التكوير : 17 ، 18 ] . وكذا قال الضحاك : ( [ والليل ] إذا يسر ) أي : يجري .
وقال عكرمة : ( والليل إذا يسر ) يعني : ليلة جمع . رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم .
ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، يقول في قوله : ( والليل إذا يسر ) قال : اسر يا سار ولا تبين إلا بجمع .
وقوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) يقول: والليل إذا سار فذهب، يقال منه: سرى فلان ليلا يَسْرِي: إذا سار.
وقال بعضهم: عُنِيَ بقوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) ليلة جَمْع، وهي ليلة المزدلفة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزبير ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) حتى يُذهِب بعضه بعضا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) يقول: إذا ذهب.
حدثني محمد بن عُمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبى يحيى، عن مجاهد: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: إذا سار.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العاليه ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: والليل إذا سار.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) يقول: إذا سار.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: إذا سار.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: الليل إذا يسير.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن عكرِمة ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: ليلة جمع.
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الشام والعراق ( يَسْرِ ) بغير ياء. وقرأ ذلك جماعة من القرّاء بإثبات الياء، وحذف الياء في ذلك أعجب إلينا، ليوفق بين رءوس الآي إذ كانت بالراء. والعرب ربما أسقطت الياء في موضع الرفع مثل هذا، اكتفاء بكسرة ما قبلها منها، من ذلك قول الشاعر:
لَيْسَ تخْــفى يَســارَتِي قَـدْرَ يَـوْمٍ
وَلَقَــدْ تُخْــفِ شِـيمَتِي إعْسَـارِي (1)
------------------------
الهوامش:
(1) البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 365 ) قال : وقوله : { والليل إذا يسر } ذكروا أنها ليلة المزدلفة . وقد قرأ القراء " يسري " بإثبات الياء ، و " يسر " بحذفها . وحذفها أحب إلي ، لمشاكلتها رءوس الآيات ؛ ولأن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها ، أنشدني بعضهم :
كَفَّــاك : كـف مـا تُلِيـقُ دِرهمًـا
جُـودًا , وأُخـرَى تُعْـطِ بالسَّيْفِ الدَّما
وأنشدني آخر : " ليس تخفي يسارتي ... " البيت .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ أي يسري فيمضي، وبه العمر ينقضي، أما المؤمن فأحيا ليله بالطاعات, يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا.
وقفة
[4] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ قال السعدي: «أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون، رحمة منه تعالى وحكمة».
الإعراب :
- ﴿ وَاللَّيْلِ إِذا: ﴾
- معطوفة بالواو على «الفجر» وتعرب اعرابها. اذا: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بحال محذوفة من الليل. التقدير:أقسم بالليل كائنا اذا يسري.
- ﴿ يَسْرِ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة خطا واختصارا ولتشابه رؤوس الآيات التي قبلها والكسرة دالة على الياء المحذوفة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اي يسري فيه او يقبل بعد النهار.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٥- الليل إذا يَسْري بظلامه، وجواب هذه الأقسام: لَتُجازُنَّ على أعمالكم، قال تعالى:
﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يسر:
1- بحذف الياء وصلا ووقفا، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بإثباتها وصلا ووقفا، وهى قراءة ابن كثير.
3- بياء فى الوصل، وبحذفها فى الوقف، وهى قراءة نافع، وأبى عمرو، بخلاف عنه.
مدارسة الآية : [5] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي .. ﴾
التفسير :
{ هَلْ فِي ذَلِكَ} المذكور{ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} أي:[لذي] عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
والاستفهام في قوله- تعالى-: هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ للتقرير والتعظيم لما أقسم به- سبحانه- من مخلوقات. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى تلك الأشياء التي أقسم الله- تعالى- بها.
والمراد بالحجر العقل، وسمى بذلك لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن ارتكاب مالا ينبغي، كما سمى عقلا، لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب السيئات، كما يعقل العقال البعير عن الضلال.
والمعنى: هل في ذلك الذي أقسمنا به من الفجر، والليالى العشر، والشفع والوتر..
قسم، أى: مقسم به، حقيق أن تؤكد به الأخبار عند كل ذي عقل سليم؟.
مما لا شك فيه أن كل ذي عقل سليم، يعلم تمام العلم، أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق أن يقسم به، لكونها- أى: هذه الأشياء- أمورا جليلة، خليقة بالإقسام بها لفخامة شأنها، كما أن كل ذي عقل سليم يعلم- أيضا- أن المقسم بهذا القسم، وهو الله- عز وجل- صادق فيما أقسم عليه.
فالمقصود من وراء القسم بهذه الأشياء، تحقيق المقسم عليه. بأسلوب فيه ما فيه من التأكيد والتشويق وتحقيق المقسم عليه.
وجواب القسم محذوف دل عليه قوله- تعالى- بعد ذلك: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ. إلى قوله: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ.
والتقدير: وحق هذه المخلوقات لتعذبن- أيها الكافرون- كما عذب الذين من قبلكم، مثل عاد وثمود وفرعون.
قال الجمل: فإن قلت: ما فائدة قوله- تعالى-: هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ.
بعد أن أقسم- سبحانه- بالأشياء المذكورة؟ قلنا: هو لزيادة التأكيد والتحقيق للمقسم عليه، كمن ذكر حجة باهرة، ثم قال: أفيما ذكرته حجة؟.
وجواب القسم محذوف، أى: لتعذبن يا كفار مكة، وقيل هو مذكور وهو قوله: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ، وقيل محذوف لدلالة المعنى عليه، أى لنجازين كل أحد بعمله.. .
وقوله : ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) أي : لذي عقل ولب وحجا [ ودين ] وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة ، وحجر الحاكم على فلان : إذا منعه التصرف ، ( ويقولون حجرا محجورا ) [ الفرقان : 22 ] ، كل هذا من قبيل واحد ، ومعنى متقارب ، وهذا القسم هو بأوقات العبادة ، وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها [ إليه عباده ] المتقون المطيعون له ، الخائفون منه ، المتواضعون لديه ، الخاشعون لوجهه الكريم .
وقوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) يقول تعالى ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر، وإنما عُنِيَ بذلك: إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) : فإنه لِذِي حِجًي وذِي عقل؛ يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرًا لها ضابطا: إنه لذو حِجْر، ومنه قولهم: حَجَر الحاكم على فلان.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي النُّهَى والعقل.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) قال: لأولي النُّهى.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: ذو الحِجْر والنُّهى والعقل.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس: ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل، لذي نُهَى.
قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأغرّ المِنقريّ، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي لُبّ، لذي حِجًى.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل.
حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: لذي عقل، لذي رأي.
حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي لبّ، أو نُهى.
حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا خلف بن خليفة، عن هلال بن خباب، عن مجاهد، في قوله: ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، عن الحسن ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي حلم.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي حجى؛ وقال الحسن: لذي لُبّ.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) لذي حِجى، لذي عقل ولُبّ.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل، وقرأ: لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و لأُولِي الأَلْبَابِ وهم الذين عاتبهم الله وقال: العقل واللُّبّ واحد، إلا أنه يفترق في كلام العرب.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ أي: لذي عقل ولب ودين وحجى، وإنما سمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال.
وقفة
[5] ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ سمي العقل حِجْرًا لأنه يعقل صاحبه ويحجزه عما لا يليق به شرعًا وعرفًا، لكن مهمة العقل ليست مجرد المنع والحجر، بل إن من لوازم منعه عما لا يليق به: أن يصرفه إلى ما خلق له من الإبداع والتفكير والإنتاج؛ ولذا أكَّد القرآن على ذلك: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 176]، ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: 68].
وقفة
[5] ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي، كما سمي عقلًا؛ لأنه يعقله عن القبائح.
وقفة
[5] ﴿هَل في ذلِكَ قَسَمٌ لِذي حِجرٍ﴾ إن كان عقلك راجح فطن؛ ستتعظ بتلك الأقسام.
وقفة
[5] ﴿هَل في ذلِكَ قَسَمٌ لِذي حِجرٍ﴾، أي: عقل، ونأخذ من الآية معنى يحسن التنبيه إليه: وهو أن القرآن يخاطب العقول، وبالتالي فلا تناقض بين هداية القرآن ودلالة العقل، بل العقل الرشيد الصادق لا تخطئ دلالته، ولهذا أحالنا القرآن عليه: ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164]، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 176].
الإعراب :
- ﴿ هَلْ فِي ذلِكَ: ﴾
- حرف استفهام لا محل له من الاعراب. في: حرف جر. ذا:اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بفي واللام للبعد والكاف حرف خطاب. والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم.
- ﴿ قَسَمٌ: ﴾
- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة اي هل فيما اقسمت به من هذه الاشياء مقسم به او هل في إقسامي بها إقسام لذي حجر؟
- ﴿ لِذِي حِجْرٍ: ﴾
- اللام حرف جر. ذي: اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. حجر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي لصاحب عقل.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا أقسمَ اللهُ بهذه الخمسة؛ قَرَّرَ هنا فخامةَ هذه الأشياء التي أقسمَ بها قبل، وكونها أهلًا لأن تُعظَّم، فقال تعالى:
﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى:{ أَلَمْ تَرَ} بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية
ثم ذكر- سبحانه- على سبيل الاستشهاد، ما أنزله من عذاب مهين، بالأقوام المكذبين. فقال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ.
والاستفهام في قوله: أَلَمْ تَرَ.. للتقرير، والرؤية: علمية، تشبيها للعلم اليقيني بالرؤية في الوضوح والانكشاف، لأن أخبار هذه الأمم كانت معلومة للمخاطبين.
ويجوز أن تكون الرؤية بصرية، لكل من شاهد آثار هؤلاء الأقوام البائدين..
والمراد بعاد: تلك القبيلة المشهورة بهذا الاسم، والتي كانت تسكن الأحقاف، وهو مكان في جنوب الجزيرة العربية، معروف للعرب، قال- تعالى-: وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
سموا بذلك نسبة إلى أبيهم عاد بن عوص، بن إرم، بن سام، بن نوح- عليه السلام-
ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين ، خارجين عن طاعته مكذبين لرسله ، جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم ، وجعلهم أحاديث وعبرا ، فقال : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) وهؤلاء عاد الأولى ، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ، قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا ، عليه السلام ، فكذبوه وخالفوه ، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم ، وأهلكهم بريح صرصر عاتية ، ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ) [ الحاقة : 7 ، 8 ] وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ، ليعتبر بمصرعهم المؤمنون .
القول في تأويل قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6).
وقوله: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك، فترى كيف فعل ربك بعاد؟
التدبر :
لمسة
[6] ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ يعني: (ألم تعلم)، ويقال: (ألم تخبر)، واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقرير، يعني فذلك خبر عاد.
الإعراب :
- ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾
- الألف ألف استفهام لفظا بمعنى التقدير. لم: حرف نفي وجزم وقلب. تر: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره حرف العلة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. وأصل الفعل «ترأى» حذفت الهمزة تخفيفا ويجوز ان يكون المخاطب من لم ير ولم يسمع لان الكلام جرى مجرى المثل في التعجيب وفي هذه الحالة يكون الفاعل ضميرا مستترا جوازا تقديره هو اي ألم تعلم أو ألم تخبر. وتكون الهمزة بمعنى التوبيخ.
- ﴿ كَيْفَ فَعَلَ: ﴾
- اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. وقيل هو مفعول به بفعل والوجه الاول أعرب. فعل: فعل ماض مبني على الفتح والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول به للفعل «ترى».
- ﴿ رَبُّكَ بِعادٍ: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. بعاد: جار ومجرور متعلق بفعل.وصرف «عاد» لانه اسم الأب أو الجد وليس اسم قبيلة
المتشابهات :
| الفجر: 6 | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ |
|---|
| الفيل: 1 | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد أن أقسمَ اللهُ أنَّه سيعذب الكافرين جزاء كفرهم؛ ذَكَرَ هنا بعض قصص الأمم السابقة ممن كفروا الله ورسوله، فأوقع بهم شديد العذاب؛ ليكون في ذلك زجرًا لهؤلاء المكذبين، وتثبيتًا للمؤمنين، قال تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾
التفسير :
{ إِرَمَ} القبيلة المعروفة في اليمن{ ذَاتِ الْعِمَادِ} أي:القوة الشديدة، والعتو والتجبر.
فقوله- تعالى-: إِرَمَ عطف بيان لعاد، لأنه جده الأدنى.
وقوله- تعالى-: ذاتِ الْعِمادِ صفة لعاد، و «ذات» وصف مؤنث لأن المراد بعاد القبيلة، سمى أولاده باسمه، كما سمى بنو هاشم هاشما.
والمقصود بهذه القبيلة عاد الأولى، التي أرسل الله- تعالى- إليهم هودا- عليه السلام-. وكانوا معروفين بقوتهم وضخامة أجسامهم.. وقد جاء الحديث عنهم كثيرا في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله- تعالى-: فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً....
فقوله تعالى : ( إرم ذات العماد ) عطف بيان ; زيادة تعريف بهم .
وقوله : ( ذات العماد ) لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد ، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم ، فقال : ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله [ لعلكم تفلحون ] ) [ الأعراف : 69 ] . وقال تعالى : ( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) [ فصلت : 15 ] ، وقال هاهنا : ( التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أي : القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم ، لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم .
قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعني : عادا الأولى ، كما قال قتادة بن دعامة ، والسدي : إن إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد قوي .
وقال مجاهد ، وقتادة ، والكلبي في قوله : ( ذات العماد ) كانوا أهل عمود لا يقيمون .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : إنما قيل لهم : ( ذات العماد ) لطولهم .
واختار الأول ابن جرير ، ورد الثاني فأصاب .
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( إرَمَ ) فقال بعضهم: هي اسم بلدة، ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عُنِيت بذلك، فقال بعضهم: عُنِيت به الإسكندرية.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ، عن أبي صخر، عن القُرَظي، أنه سمعه يقول: ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) الإسكندرية.
قال أبو جعفر، وقال آخرون: هي دِمَشق.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عبد الله الهلالي من أهل البصرة، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقْبري ( بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) قال: دمشق.
وقال آخرون: عُنِي بقوله: ( إرَمَ ) : أمة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد قوله: ( إرَمَ ) قال: أمة.
وقال آخرون: معنى ذلك: القديمة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إرَمَ ) قال: القديمة.
وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) قال: كنا نحدّث أن إرم قبيلة من عاد، بيت مملكة عاد.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( إرَمَ ) قال: قبيلة من عاد كان يقال لهم: إرم، جدّ عاد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ) يقول الله: بعاد إرم، إن عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح.
وقال آخرون: ( إرَمَ ): الهالك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ) يعني بالإرم: الهالك؛ ألا ترى أنك تقول: أرم بنو فلان؟
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( بِعَادٍ إِرَمَ ) الهلاك؛ ألا ترى أنك تقول أُرِمَ (2) بنو فلان: أي هَلَكوا.
والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك ردّت على عاد للإتباع لها، ولم يجر من أجل ذلك، وإما اسم قبيلة فلم يُجر أيضا، كما لا يُجْرى أسماء القبائل، كتميم وبكر، وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة، وأما اسم عاد فلم يجر، إذ كان اسما أعجميا.
فأما ما ذُكر عن مجاهد أنه قال: عُنِيَ بذلك القديمة، فقول لا معنى له، لأن ذلك لو كان معناه لكان محفوظا بالتنوين، وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة.
وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها، وترك إجرائها، كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل، وهي قبيلة، فترك إجراؤها لذلك، وهي في موضع خفض بالردّ على تميم، ولو كانت إرم اسم بلدة، أو اسم جدّ لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما يقال: هذا عمروُ زبيدٍ وحاتمُ طيئ، وأعشى هَمْدانَ، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى، كما قال قتادة، والله أعلم، فلذلك أجمعت القرّاء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء.
وقوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: ذات الطول، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب للرجل الطويل: رجل مُعَمَّد، وقالوا: كانوا طوال الأجسام.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) يعني: طولهم مثل العماد.
حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: كان لهم جسم في السماء.
وقال بعضهم: بل قيل لهم: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) لأنهم كانوا أهل عَمَد، ينتجِعون الغيوث، وينتقلون إلى الكلأ حيث كان، ثم يرجعون إلى منازلهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( الْعِمَادِ ) قال: أهل عَمُود لا يقيمون.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: ذُكر لنا أنهم كانوا أهل عَمُود لا يقيمون، سيارة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: كانوا أهلَ عمود.
وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناء بناه بعضهم، فشيَّد عَمَده، ورفع بناءه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: عاد قوم هود بنَوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف، قال: ( لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا ) مثل تلك الأعمال في البلاد، قال: وكذلك في الأحقاف في حضرموت، ثم كانت عاد، قال: وثم أحقاف الرمل، كما قال الله: بالأحقاف من الرمل، رمال أمثال الجبال تكون مظلة مجوّفة.
وقال آخرون: قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم.
* ذكر من قال ذلك:
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) يعني: الشدّة والقوّة.
وأشبه الأقوال في ذلك بما دلّ عليه ظاهر التنـزيل قول من قال: عُنِيَ بذلك أنهم كانوا أهل عمود، سيارة لأن المعروف في كلام العرب من العماد، ما عمل به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء، ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح، بل وجه أهل التأويل قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) إلى أنه عُنِيَ به طول أجسامهم، وبعضهم إلى أنه عُنِيَ به عماد خيامهم، فأما عماد البنيان، فلا يعلم كثير أحد من أهل التأويل وجهه إليه، وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك سبيلا دون الأنكر.
------------------------
الهوامش:
(2) في ( اللسان : أرم ) الأرم : القطع ، وأرمتهم السنة أرما : قطعتهم ، وبناء عليه يكون الفعل الذي عبر به المؤلف هنا مبنيا للمجهول ، أي : أبادهم الدهر .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[7، 8] ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ لقد كانت حضارة عمرانية وصناعية رائعة، ولكنهم كانوا في غاية الانحطاط، هل فهمنا الفرق؟
الإعراب :
- ﴿ إِرَمَ: ﴾
- عطف بيان لعاد وهو مضاف اليه لمضاف مقدر تقديره أهل إرم مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث اسم قبيلة او ارض.
- ﴿ ذاتِ الْعِمادِ: ﴾
- صفة- نعت- لإرم مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.العماد: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي ذات الرفعة او ذات العماد الرفيع او بعاد اهل اعلام ذات العماد.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ عاد؛ ذكرَ القبيلة، قال تعالى:
﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي .. ﴾
التفسير :
{ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا} أي:مثل عاد{ فِي الْبِلَادِ} أي:في جميع البلدان [في القوة والشدة]، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام:{ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .
وقوله- سبحانه-: الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ صفة أخرى لقبيلة عاد.
والمعنى: لقد وصل إلى علمك- أيها الرسول الكريم- بصورة يقينية، خبر قبيلة عاد، التي جدها الأدنى «إرم بن سام بن نوح «والتي كانت تسكن بيوتا ذات أعمدة، ترفع عليها خيامهم ومبانيهم الفارهة.. والتي لم يخلق مثلها- أى: مثل هذه القبيلة- أحد في ضخامة أجسام أفرادها، وفي قوة أبدانها، وفيما أعطاها الله- تعالى- من غنى وقوة.
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: قوله- تعالى-: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ. إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ هؤلاء كانوا متمردين عتاة.. فذكر- سبحانه- كيف أهلكهم.
وهؤلاء هم عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وهم الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا- عليه السلام- فكذبوه فأهلكهم الله- تعالى-.
فقوله: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ عطف بيان، زيادة تعريف بهم. وقوله: ذاتِ الْعِمادِ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشّعر التي ترفع بالأعمدة الشداد.
وقال هاهنا: الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ أى: القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم، لقوتهم وشدتهم، وعظم تركيبهم.. فالضمير في مِثْلُها يعود إلى القبيلة.
ومن زعم أن المراد بقوله: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ مدينة إما دمشق أو الاسكندرية.. ففيه نظر.. لأن المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وليس المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بما ذكره جماعة من المفسرين من أن المراد بقوله- تعالى-: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ ... مدينة مبنية بلبن الذهب والفضة.. فهذا كله من خرافات الإسرائيليين.. .
وقوله : ( التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أعاد ابن زيد الضمير على العماد ; لارتفاعها ، وقال : بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد . وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة ، أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد ، يعني في زمانهم . وهذا القول هو الصواب ، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ; لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلاد ، وإنما قال : ( لم يخلق مثلها في البلاد )
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثنا معاوية بن صالح ، عمن حدثه ، عن المقدام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : " كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم " .
ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا أنس بن عياض ، عن ثور بن زيد الديلي . قال : قرأت كتابا - قد سمى حيث قرأه - : أنا شداد بن عاد ، وأنا الذي رفعت العماد ، وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد ، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع ، لا يخرجه إلا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - .
قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها ، أو أعمدة بيوتهم للبدو ، أو سلاحا يقاتلون به ، أو طول الواحد منهم - فهم قبيلة وأمة من الأمم ، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع ، المقرونون بثمود كما هاهنا ، والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : ( إرم ذات العماد ) مدينة إما دمشق ، كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة ، أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ، ففيه نظر ، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان ، فإنه لا يتسق الكلام حينئذ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد ، وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد ، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم .
وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية ، من ذكر مدينة يقال لها : ( إرم ذات العماد ) مبنية بلبن الذهب والفضة ، قصورها ودورها وبساتينها ، وإن حصباءها لآلئ وجواهر ، وترابها بنادق المسك ، وأنهارها سارحة ، وثمارها ساقطة ، ودورها لا أنيس بها ، وسورها وأبوابها تصفر ، ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام ، وتارة باليمن ، وتارة بالعراق ، وتارة بغير ذلك من البلاد - فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ، من وضع بعض زنادقتهم ، ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك .
وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب - وهو عبد الله بن قلابة - في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت ، فبينما هو يتيه في ابتغائها ، إذ طلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب ، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها ، وأنه رجع فأخبر الناس ، فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا .
وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة ( إرم ذات العماد ) هاهنا مطولة جدا ، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك ، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج ، وليس كذلك . وهذا مما يقطع بعدم صحته . وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين ، من وجود مطالب تحت الأرض ، فيها قناطير الذهب والفضة ، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير ، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها ، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء ، فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ، ونحو ذلك من الهذيانات ، ويطنزون بهم . والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة ، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت ، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم ، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب .
وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله : ( إرم ) قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف فيه نظر ; لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة ، ولهذا قال بعده :
وقوله: ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ) يقول جلّ ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني: مثل عاد، والهاء عائدة على عاد. وجائز أن تكون عائدة على إرم لما قد بينا قبل أنها قبيلة. وإنما عُنِيَ بقوله: لم يُخْلق مثلها في العِظَم والبطش والأيد.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ) ذكر أنهم كانوا اثني عشر ذراعا طولا في السماء.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثل الأعمدة في البلاد، وقالوا: التي لم يخلق مثلها من صفة ذات العماد، والهاء التي في مثلها إنما هي من ذكر ذات العماد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فذكر نحوه. وهذا قول لا وجه له، لأن العماد واحد مذكر، والتي للأنثى، ولا يوصف المذكر بالتي، ولو كان ذلك من صفة العماد لقيل: الذي لم يخلق مثله في البلاد، وإن جعلت التي لإرم، وجعلت الهاء عائدة في قوله: ( مِثْلُهَا ) عليها، وقيل: هي دمشق أو إسكندرية، فإن بلاد عاد هي التي وصفها الله في كتابه فقال: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ والأحقاف: هي جمع حِقْف، وهو ما انعطف من الرمل وانحنى، وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمال، بل ذلك الشِّحْرَ من بلاد حضرموت، وما والاها.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[8] ﴿الَّتي لَم يُخلَق مِثلُها فِي البِلادِ﴾ حتى الآن، وحتى قيام الساعة.
الإعراب :
- ﴿ الَّتِي: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية لإرم والجملة بعده صلته لا محل لها.
- ﴿ لَمْ يُخْلَقْ: ﴾
- حرف نفي وجزم وقلب. يخلق: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون.
- ﴿ مِثْلُها فِي الْبِلادِ: ﴾
- نائب فاعل مرفوع بالضمة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. في البلاد: جار ومجرور متعلق بيخلق.أي لم يخلق الله مثل عاد في البلدان.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا كان بناءً عاليًا ثابتًا بالأعمدةِ التي لم يكنْ في هذه الدَّارِ مِثلُها؛ لذا قال تعالى:
﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يخلق:
1- مبنيا للمفعول، و «مثلها» رفع، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- مبنيا للفاعل، و «مثلها» نصب، وهى قراءة ابن الزبير.
مدارسة الآية : [9] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾
التفسير :
{ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} أي:وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور، فاتخذوها مساكن.
وقوله- تعالى-: وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ معطوف على ما قبله. والمراد بثمود: القبيلة المسماة بهذا الاسم، نسبة إلى جدها ثمود، وقد أرسل الله- تعالى- إليهم نبيهم صالحا- عليه السلام- فكذبوه، فأهلكهم الله- تعالى-.
وكانت مساكنهم بين الشام والحجاز، وما زالت معروفة حتى الآن باسم قرى صالح.
وقوله: جابُوا بمعنى قطعوا. من الجواب بمعنى القطع والخرق، والصخرة الحجارة العظيمة.
والواد: اسم للأرض المنخفضة بين مكانين مرتفعين، وكان هؤلاء القوم يقطعون الصخور من الجبال، ليتخذوا منها بيوتهم بواديهم، أى: بالمكان الذي كانوا يسكنونه.
فقوله: بِالْوادِ علم بالغلبة للمكان الذي كانوا يسكنون فيه، ويسمى بوادي القرى، وقد قال- تعالى- في شأنهم: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ.
(وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) يعني : يقطعون الصخر بالوادي . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد . ومنه يقال : " مجتابي النمار " . إذا خرقوها ، واجتاب الثوب : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضا . وقال الله تعالى : ( وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) [ الشعراء : 149 ] . وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا قول الشاعر :
ألا كل شيء - ما خلا الله - بائد كما باد حي من شنيف ومارد هم ضربوا في كل صماء
صعدة بأيد شداد أيدات السواعد
وقال ابن إسحاق : كانوا عربا ، وكان منزلهم بوادي القرى . وقد ذكرنا قصة " عاد " مستقصاة في سورة " الأعراف " بما أغنى عن إعادته .
وقوله: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يقول: وبثمود الذين خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه بيوتا، كما قال جلّ ثناؤه: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ والعرب تقول: جاب فلان الفلاة يجوبها جوبا: إذا دخلها وقطعها، ومنه قول نابغة:
أتـاكَ أبُـو لَيْـلَى يَجُـوبُ بِـهِ الدُّجَى
دُجَـى اللَّيـلِ جَـوّابُ الفَـلاةِ عَمِيـمُ (3)
يعني بقوله: يجوب يدخل ويقطع.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يقول: فخرقوها.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يعني: ثمود قوم صالح، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا.
حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد في قوله: ( الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) قال: جابوا الجبال، فجعلوها بيوتا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) : جابوها ونحتوها بيوتا.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: ( جَابُوا الصَّخْرَ ) قال: نَقبوا الصخر.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يقول: قَدُّوا الحجارة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) : ضربوا البيوت والمساكن في الصخر في الجبال، حتى جعلوا فيها مساكن. جابوا: جوّبوها تجوّبوا البيوت في الجبال، قال قائل:
ألا كُـلُّ شَـيْءٍ مـا خَـلا اللـهَ بـائِدٌ
كمَـا بـادَ حَـيٌّ مِـنْ شَـنِيقٍ وَمارِدِ
هُـمُ ضَرَبُـوا فِـي كُلّ صَلاءَ صَعْدَةٍ
بــأيْدٍ شِــدَادٍ أيِّــدَاتِ السَّــوَاعِدِ (4)
------------------------
الهوامش:
(3) البيت لأبي ليلى النابغة الجعدي . وفي ( اللسان : جوب ) وجاب الشيء جوبا واجتابه : خرقه ، وجاب الصخرة جوبا : نقبها وفي التنزيل العزيز : { وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد } قال الفراء : جابوا : خرقوا الصخر فاتخذوه بيوتا . ونحو ذلك قال الزجاج : واعتبره بقوله : { وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين } . وجاب يجوب جوبا : قطع وخرق . ا هـ .
(4) هذان البيتان لا أعرف قائلهما ، ولست على ثقة من بعض ألفاظهما ، ولعل قوله : " صلاء صعدة " محرف عن " صعداء صلة " والصعداء : الأكمة يصعب ارتقاؤها . والصلة : الأرض اليابسة ، جمعها : صلال .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[9] ﴿الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ (جَابُوا) بمعنى قطعوا الصخر ونحتوه، وليس (أحضروه) كما عند العامة.
الإعراب :
- ﴿ وَثَمُودَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «عاد» وتعرب اعرابها وعلامة جرها الفتحة بدلا من الكسرة لانها ممنوعة من الصرف للتأنيث والتعريف لانها اسم قبيلة.
- ﴿ الَّذِينَ: ﴾
- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة لثمود والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.
- ﴿ جابُوا الصَّخْرَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. الصخر: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا. وثمة وجوه لاعراب «الذين» في الآية الحادية عشرة.
- ﴿ بِالْوادِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بجابوا وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة خطا واختصارا وبقيت الكسرة دالة عليها ولتشابه رؤوس الآي.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ أقوى الجبارين في الأرض من الأمم القديمة في جنوب الجزيرة العربية (عاد)؛ ذكرَ هنا أقوى الجبارين في شمال الجزيرة العربية (ثمود)، قال تعالى:
﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
وثمود:
1- بالمنع من الصرف، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بالتنوين، وهى قراءة ابن وثاب.
مدارسة الآية : [10] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾
التفسير :
{ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَاد} أي:[ذي] الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها.
والمراد بفرعون هنا: هو وقومه. والمراد بالأوتاد: الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه ويقوونه، كما تشد الخيام وتقوى بالأوتاد.
قال الآلوسى: وصف فرعون بذلك لكثرة جنوده وخيامهم، التي يضربون أوتادها في منازلهم، أو لأنه كان يدق لمن يريد تعذيبه أربعة أوتاد، ويشده بها.. .
وقال بعض العلماء: ووصف فرعون بذي الأوتاد، لأن مملكته كانت تحتوى على الأهرامات، التي بناها أسلافه، لأن صورة الهرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق، ويجوز أن يكون المراد بالأوتاد: التمكن والثبات على سبيل الاستعارة، أى: ذي القوة.. .
وقال صاحب الظلال: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ وهي على الأرجح الأهرامات، التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان، وفرعون المشار إليه هنا، هو فرعون الطاغية الجبار، الذي أرسل الله- تعالى- إليه موسى- عليه السلام-.. .
والمعنى: لقد علمت- أيها الرسول الكريم- وعلم معك كل من هو أهل للخطاب، ما فعله ربك بقبيلة عاد، التي جدها إرم بن سام بن نوح، والتي كانت صاحبة أعمدة عظيمة ترفع عليها بيوتها، والتي لم يخلق في بلادها مثلها في القوة والغنى.
وعلمت- أيضا- ما فعله ربك بقوم ثمود، الذين قطعوا صخر الجبال، واتخذوا منها بيوتا بوادي قراهم، التي ما زالت معروفة.
وعلمت- كذلك- ما فعلناه بفرعون صاحب المبانى القوية الفخمة وصاحب الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه.
وقوله : ( وفرعون ذي الأوتاد ) قال العوفي ، عن ابن عباس : الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا قال مجاهد : كان يوتد الناس بالأوتاد . وهكذا قال سعيد بن جبير ، والحسن ، والسدي . قال السدي : كان يربط الرجل ، كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه .
وقال قتادة : بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب ، يلعب له تحتها ، من أوتاد وحبال .
وقال ثابت البناني ، عن أبي رافع : قيل لفرعون ( ذي الأوتاد ) ; لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ، ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت .
وقوله: ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) يقول جلّ ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون صاحب الأوتاد.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( ذِي الأوْتَادِ ) ولم قيل له ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ذي الجنود الذي يقوّون له أمره، وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع: الجنود.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) قال: الأوتاد: الجنود الذين يشدّون له أمره، ويقال: كان فرعون يُوتِد في أيديهم وأرجلهم أوتادًا من حديد، يعلقهم بها.
وقال آخرون: بل قيل له ذلك لأنه كان يُوتِد الناس بالأوتاد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( ذِي الأوْتَادِ ) قال: كان يوتد الناس بالأوتاد.
وقال آخرون: كانت مظالّ وملاعب يلعب له تحتها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) ذُكر لنا أنها كانت مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ذِي الأوْتَادِ ) قال: ذي البناء كانت مظال يلعب له تحتها، وأوتادا تضرب له.
قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، قال: أوتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد، ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت.
وقال آخرون: بل ذلك لأنه كان يعذّب الناس بالأوتاد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل، عن محمود، عن سعيد بن جُبير ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) قال: كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهنا، ويدا هاهنا ويدا هاهنا بالأوتاد.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( ذِي الأوْتَادِ ) قال: كان يوتد الناس بالأوتاد.
وقال آخرون: إنما قيل ذلك لأنه كان له بنيان يعذّب الناس عليه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل، عن رجل، عن سعيد بن جُبير ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) قال: كان له منَارات يعذّبهم عليها.
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عُنِيَ بذلك: الأوتاد التي تُوتَد، من خشب كانت أو حديد، لأن ذلك هو المعروف من معاني الأوتاد، ووصف بذلك لأنه إما أن يكون كان يعذّب الناس بها، كما قال أبو رافع وسعيد بن جُبير، وإما أن يكون كان يُلعب له بها.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[10] ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ أي الذي ثبَّت ملكه تثبيت من يظن أنه لا يزول بالعساكر والجنود، وغيرهم من كل ما يظن أنه يشد أمره، فصارت له اليد المبسوطة في الملك.
وقفة
[10] ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ قيل: أوتاد يثبت بها الناس تعذيبًا، فكان الوتد ينغرس في قلب الرجل بغضًا لفرعون قبل أن ينغرس في الأرض.
الإعراب :
- ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «ثمود» وتعرب اعرابها ومنعت من الصرف للعجمة. ذي: صفة- نعت- لفرعون مجرورة وعلامة جرها الياء لأنها من الاسماء الخمسة وهي مضافة. الأوتاد: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. وقيل له ذو الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم- خيمهم-.
المتشابهات :
| ص: 12 | ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴾ |
|---|
| الفجر: 10 | ﴿ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ أقوى الجبارين في الأرض من الأمم القديمة عاد وثمود؛ ذكرَ هنا ثالث أقوى الجبارين (فرعون)، قال تعالى:
﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [11] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴾
التفسير :
{ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ} هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله، وآذوا عباد الله، في دينهم ودنياهم، ولهذا قال:
والَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فأفسدوها، وتجاوزوا كل حد في العصيان والظلم.
أي تمردوا وعتوا.
وقوله: ( الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ ) يعني بقوله جلّ ثناؤه ( الذين ) : عادًا وثمود وفرعون وجنده، ويعني بقوله ( طَغَوْا ) : تجاوزوا ما أباحه لهم ربهم، وعتوا على ربهم إلى ما حظره عليهم من الكفر به. وقوله: ( فِي الْبِلادِ ) : التي كانوا فيها.
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة التاسعة و «الذين» صفة لعاد وثمود وفرعون.و«طغوا» تجاوزوا الحد وأحسن الوجوه في اعراب «الذين» ان يكون في محل نصب على الذم بفعل محذوف تقديره اعني. ويجوز ان يكون مرفوعا على * «هم الذين طغوا» اي يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هم
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد ذكرِ الأمم الثلاثة؛ وصفهم جميعًا بتجاوز الحدِّ في الجَبَرُوت والظلم، قال تعالى:
﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [12] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴾
التفسير :
{ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ} وهو العمل بالكفر وشعبه، من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله.
فَأَكْثَرُوا فِيهَا أى: في البلاد الْفَسادَ عن طريق الفسوق والخروج عن طاعتنا.
عاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس.
القول في تأويل قوله تعالى : فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12)
يقول تعالى ذكره: فأكثروا في البلاد المعاصي، وركوب ما حرّم الله عليهم .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[12، 13] ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ حتى فرعون لم يعاجله الله بالعقوبة رغم إفساده حتى أكثر الفساد، ما أحلم الله!
وقفة
[12، 13] ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ كثرة فساد الظالم في الأرض؛ مؤذنٌ بقرب عقوبته وزواله.
وقفة
[12، 13] ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أيها المفسدون؛ استلمتُم من الله رسالة: لا تغتروا، إمهالي ليس بالإهمال.
وقفة
[12، 13] قد يمهل الله العباد، فإذا كثر الفساد أخذهم ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ ﴾
- معطوفة بالفاء على «طغوا» والآية الكريمة تعرب إعراب الآية التاسعة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ أنَّهم طَغَوا؛ فَسَّرَ هنا طغيانَهم، وذكرَ ما تسبب عن هذا الطغيان، وهو إكثار الفساد، قال تعالى:
﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [13] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾
التفسير :
فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم، أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذاب.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ أى: فكانت نتيجة طغيانهم وفسادهم، أن أنزل ربك عليهم، نوعا عظيما من العذاب المهين.
والسوط: آلة تتخذ من الجلود القوية، يضرب بها الجاني، وإضافتها إلى العذاب، من إضافة الصفة إلى الموصوف. أى: فصب عليهم ربك عذابا. «سوطا» أى: كالسوط في سرعته، وشدته وتتابعه، فهو تشبيه بليغ.
وعبر- سبحانه- على إنزال العذاب بهم بالصب- وهو الإفراغ لما في الظرف بقوة- للإيذان بكثرته وتتابعه.
وسميت أنواع العذاب النازلة بهم سوطا تسمية للشيء باسم آلته..
قال صاحب الكشاف: وذكر السوط. إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة، كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به.
وعن عمر بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطا كثيرة، فأخذهم بسوط منها.. .
أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين.
( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ) يقول تعالى ذكره: فأنـزل بهم يا محمد ربك عذابه، وأحلّ بهم نقمته، بما أفسدوا في البلاد، وطغَوْا على الله فيها. وقيل: فصبّ عليهم ربك سَوط عذاب. وإنما كانت نِقَما تنـزل بهم، إما ريحا تُدَمرهم، وإما رَجفا يُدَمدم عليهم، وإما غَرَقا يُهلكهم من غير ضرب بسوط ولا عصا؛ لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بهذا القرآن، الجلد بالسياط، فكثر استعمال القوم الخبر عن شدّة العذاب الذي يعذّب به الرجل منهم أن يقولوا: ضُرب فلان حتى بالسياط، إلى أن صار ذلك مثلا فاستعملوه في كلّ معذَّب بنوع من العذاب شديد، وقالوا: صَبّ عليه سَوْط عذاب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( سَوْطَ عَذَابٍ ) قال: ما عذّبوا به.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ) قال: العذاب الذي عذّبهم به سماه: سوط عذاب.
التدبر :
وقفة
[13] ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ استعارة السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره. قاله ابن عطية، وقال الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا؛ إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن السوط أهون من القتل.
وقفة
[13] ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ مع كل ما نزل عليهم من العذاب إنما هو سوط، فاحذر سياط الله.
وقفة
[13] ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: «إن عند الله أسواطًا كثيرة، فأخذهم بسوط منها».
تفاعل
[13] ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.
لمسة
[13، 14] العدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى (ربك) في قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﱠ﴾ إيماءٌ إلى أن فاعلَ ذلك ربُّه الذي شأنه أن ينتصر له، فهو مؤمل بأن يعذب الذين كذبوه انتصارًا له انتصار المولى لوليه.
الإعراب :
- ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ: ﴾
- الفاء عاطفة للتسبيب. صب: فعل ماض مبني على الفتح. على: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بصب. ربك: فاعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ سَوْطَ عَذابٍ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عذاب: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي ألم سوط عذاب والمراد:الشدة لان الضرب بالسوط اعظم ألما من غيره وقيل: نصيب عذاب.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ولَمَّا كان الإكثارُ في الفساد سببًا لغضب الله؛ صبَّ عليهم العذاب، قال تعالى:
﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [14] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾
التفسير :
{ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} لمن عصاهيمهله قليلًا، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
وقوله- سبحانه-: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ تذييل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب.
والمرصاد في الأصل: اسم للمكان الذي يجلس فيه الجالس لترقب أو رؤية شيء ما.
والمراد: إن ربك- أيها الرسول الكريم- يرصد عمل كل إنسان، ويحصيه عليه، ويجازيه به، دون أن يخفى عليه- سبحانه- شيء في الأرض أو السماء.
وفي هذه الآيات الكريمة تخويف شديد للكافرين، وتهديد لهم على إصرارهم في جحودهم، وأنهم إذا ما ساروا في طريق الجحود والعناد، فسيصيبهم ما أصاب هؤلاء الطغاة.
ثم ذكر- سبحانه- حال الإنسان عند اليسر والعسر، والغنى والفقر، والسراء والضراء فقال:
وقوله : ( إن ربك لبالمرصاد ) قال ابن عباس : يسمع ويرى . يعني : يرصد خلقه فيما يعملون ، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى ، وسيعرض الخلائق كلهم عليه ، فيحكم فيهم بعدله ، ويقابل كلا بما يستحقه . وهو المنزه عن الظلم والجور .
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا جدا - وفي إسناده نظر وفي صحته - فقال : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن أبي الحواري ، حدثنا يونس الحذاء ، عن أبي حمزة البيساني ، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معاذ ، إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ ، إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذ ، إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته ، وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله ، - عز وجل - فالقرآن دليله ، والخوف محجته ، والشوق مطيته ، والصلاة كهفه ، والصوم جنته ، والصدقة فكاكه ، والصدق أميره ، والحياء وزيره ، وربه ، - عز وجل - من وراء ذلك كله بالمرصاد " .
قال ابن أبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان ، وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان عن أبي حمزة لكان حسنا . أي : لو كان من كلامه لكان حسنا . ثم قال ابن أبي حاتم :
حدثنا أبي ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن أيفع بن عبد الكلاعي : أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول : إن لجهنم سبع قناطر - قال : والصراط عليهن ، قال : فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى ، فيقول : ( وقفوهم إنهم مسئولون ) [ الصافات : 24 ] ، قال : فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها ، قال : فيهلك فيها من هلك ، وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها ، وكيف خانوها ؟ قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا . فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها ؟ قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا . قال : والرحم يومئذ متدلية إلى الهوي في جهنم تقول : اللهم من وصلني فصله ، ومن قطعني فاقطعه . قال : وهي التي يقول الله - عز وجل - : ( إن ربك لبالمرصاد ) .
هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه.
وقوله: ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يا محمد لهؤلاء الذين قصصت عليك قَصَصَهم، ولِضُرَبائهم من أهل الكفر، لبالمِرصاد يرصدهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، على قناطر جهنم، ليكردسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة.
واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى قوله: ( لَبِالْمِرْصَادِ ) بحيث يرى ويسمع.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) يقول: يَرى ويسمع.
وقال آخرون: يعني بذلك أنه بمَرصد لأهل الظلم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن المبارك بن مجاهد، عن جُويْبِر، عن الضحاك في هذه الآية، قال: إذا كان يوم القيامة، يأمر الربّ بكرسيه، فيوضع على &; 24-412 &; النار، فيستوي عليه، ثم يقول: وعزّتي وجلالي، لا يتجاوزني اليوم ذو مَظلِمة، فذلك قوله: ( لَبِالْمِرْصَادِ ) .
قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمرو بن قيس، قال: بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر: قنطرة عليها الأمانة، إذا مرّوا بها تقول: يا ربّ هذا أمين، يا ربّ هذا خائن، وقنطرة عليها الرحِم، إذا مرّوا بها تقول: يا ربّ هذا واصل، يا ربّ هذا قاطع؛ وقنطرة عليها الربّ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) .
قال: حدثنا مهران، عن سفيان ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) يعني: جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرحمة، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها الربّ تبارك وتعالى.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) قال: مِرْصاد عمل بني آدم.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[14] ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ قال ابن عباس: «يسمع ويرى»، يعني: يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلًّا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلًّا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم.
عمل
[14] ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ ازجر بها نفسَك، وهدِّد بها من ظلمَك.
عمل
[14] ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ أهلك المكذبين الأولين، وسيهلك الآخرين المعاندين؛ فكن به على ثقة ويقين.
عمل
[14] ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ اجعلها نصب عينيك، ازجر بها نفسك، وهدد بها من ظلمك، وتسل بها، فالله معك وهو ناصرك ولن يضيعك.
وقفة
[14] ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ بالمرصاد: يراقبك وسوف يعاقبك، ومن لوازم أنه بالمرصاد: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ربك: اسم «ان» منصوب بالفتحة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ لَبِالْمِرْصادِ: ﴾
- اللام لام التوكيد- المزحلقة-. بالمرصاد: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» اي مراقبك لا يفوته شيء.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنَّه أذاقهم عذابَه الشديد؛ ذكرَ هنا العلة في تعذيبِه لهم، قال تعالى:
﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [15] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ .. ﴾
التفسير :
يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم، لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه.
والفاء في قوله: فَأَمَّا الْإِنْسانُ ... للتفريع على ما تقدم، ولترتيب ما بعدها على ما قبلها.
والمراد بالإنسان هنا: جنسه. وقيل المراد به الكافر. ولفظ «الإنسان» مبتدأ، وخبره:
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
والمعنى: هذه سنة ربك- أيها العاقل- في عباده، أنه- تعالى- لهم بالمرصاد، فهو يراقب أعمالهم، ويحاسبهم عليها، ويجازيهم بها، والسعيد من الناس هو الذي يفقه هذه الحقيقة، فيؤدى ما كلفه خالقه به ... فأما الإنسان، الشقي الغافل عن طاعة ربه..
إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ أى: إذا ما اختبره وامتحنه ربه بألوان من النعم، بأن منحه المال الكثير، والجاه العريض، وأسباب القوة والمنعة فَيَقُولُ على سبيل التباهي والتفاخر.. رَبِّي أَكْرَمَنِ أى: ربي أعطانى ذلك، لأنى مستحق لهذه النعم، كما قال- تعالى-: وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، لَيَقُولَنَّ هذا لِي، وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى .
يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك ، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك ، بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى : ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) [ المؤمنون : 55 ، 56 ] . و
* وقوله: ( فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ ) يقول تعالى ذكره: فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغنى ( فأكْرَمَهُ ) بالمال، وأفضل عليه، ( وَنَعَّمَهُ ) بما أوسع عليه من فضله ( فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) فيفرح بذلك ويسرّ به ويقول: ربي أكرمني بهذه الكرامة.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) وحقّ له.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[15] ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث؛ إنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلَّته، فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره.
وقفة
[15] ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ كم من مُكرَمٍ مُنعَّمٍ وهو في الحقيقة مبتلى!
وقفة
[15] ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ يظن كرامة اﷲ في كثرة المال, وهوانه في قلته، إنما يكرم بطاعته من أكرم، ويهين بمعصيته من أهان.
وقفة
[15] ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ لو تأمل المبتلى أن أحب الخلق إلى الله أشدهم بلاء؛ لعلم أن ابتلاءه قد يكون إكرامًا، لا كما يوسوس له الشيطان من سوء ظن بربه.
وقفة
[15] ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ قال مجاهد: «ظن الإنسان كرامة الله في كثرة المال، وهوانه في قلته، وكذب! إنما يُكرم بطاعته من أكرم، ويهين بمعصيته من أهان».
تفاعل
[15] ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ قل: اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة.
وقفة
[15] ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أكْرَمَنِ﴾ إن قلتَ: كيف ذمَّ من يقول: (ربِّي أكرمَنِ) مع أنه صادق فيه، لقوله تعالى: ﴿فأكرمَهُ ونَعَّمه﴾، ومع أنه متحدِّث بالنعمة، وهو مأمور بالتحدث بها، لقوله تعالى: ﴿وأمَّا بنعمةِ ربِّك فحدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، قلتُ: المرادُ أن يقول ذلك مفتخرًا به على غيره، ومستدلًا به على علُوِّ منزلته في الآخرة، ومعتقدًا استحقاق ذلك على ربه، كما في قوله تعالى: ﴿قال إنما أُوتيتُهُ على عِلْمٍ عندي﴾ [القصص: 78]، وكلُّ ذلك منهيٌّ عنه، وأمَّا إذا قاله على وجه الشكر، والتحدُّثِ بنعمةِ الله تعالى؛ فليس بمذمومٍ بل ممدوح.
وقفة
[15، 16] ﴿فَأَمَّا الإِنسانُ إِذا مَا ابتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقولُ رَبّي أَكرَمَنِ * وَأَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزقَهُ فَيَقولُ رَبّي أَهانَنِ﴾ وهذا من سوء الفهم.
وقفة
[15، 16] بسط الرزق وتقتيره كلاهما ابتلاء من الله تعالي لعباده, ففي الأول اختبار للشكر, وفي الثاني اختبار للصبر.
الإعراب :
- ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسانُ: ﴾
- الفاء استئنافية متعلقة بقوله «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ». اما:حرف شرط وتفصيل لا عمل له. الانسان: مبتدأ مرفوع بالضمة.
- ﴿ إِذا مَا: ﴾
- ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب. ما:زائدة او يجوز ان تكون صلة.
- ﴿ ابْتَلاهُ رَبُّهُ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. ربه: فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة وجملة «ابْتَلاهُ رَبُّهُ» في محل جر بالاضافة اي اختبره بالغنى.
- ﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ: ﴾
- الجملتان معطوفتان بالفاء والواو على «ابتلاه» وتعربان اعرابها وعلامة بناء الفعلين الفتحة الظاهرة وفاعلهما ضمير مستتر جوازا تقديره هو اي الرب سبحانه.
- ﴿ فَيَقُولُ: ﴾
- الفاء واقعة في جواب «أما». يقول: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يقول» في محل رفع خبر المبتدأ «الانسان».
- ﴿ رَبِّي أَكْرَمَنِ: ﴾
- الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به- مقول القول-.ربي: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الباء حذفت بسبب الياء والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل جر بالاضافة. أكرمن: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والنون نون الوقاية واصله: اكرمني وحذفت الياء خطا واختصارا ولملاءمة رؤوس الآي والياء المحذوفة ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب مفعول به وبقيت الكسرة دالة على الياء المحذوفة. وجملة «أكرمني» في محل رفع خبر المبتدأ.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنَّ عادةَ هؤلاء الفِرَقِ كانت الطُّغيانَ، وذكَرَ أنَّ عادةَ الرَّبِّ فيمَن تولَّى وكَفَر أنَّه يُعَذِّبُه؛ ذَكَرَ هنا عادةَ الإنسانِ عِندَ الابتلاءِ في حالَيِ السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، قال تعالى:
﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
أكرمن:
قرئ:
1- بالياء، وهى قراءة ابن كثير.
2- بالياء، وصلا وحذفها وقفا، وهى قراءة نافع.
3- بحذفها، وصلا ووقفا، وهى قراءة باقى السبعة.
مدارسة الآية : [16] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ .. ﴾
التفسير :
وأنه إذا{ قدر عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي:ضيقه، فصار يقدر قوته لا يفضل منه، أن هذا إهانة من الله له.
وقوله- سبحانه-: وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ... بيان لموقف هذا الإنسان عند فقره. أى: وأما إذا ما امتحنا هذا الإنسان بسلب بعض النعم عنه، وبضيق الرزق..
فَيَقُولُ على سبيل التضجر والتأفف وعدم الرضا بقضائه- سبحانه-: رَبِّي أَهانَنِ أى: ربي أذلنى بالفقر، وأنزل بي الهوان والشرور.
وقول هذا الإنسان في الحالين، قول مذموم، يدل على سوء فكره، وقصور نظره، وانطماس بصيرته، لأنه في حالة العطاء والسعة في الرزق. يتفاخر ويتباهى، ويتوهم أن هذه النعم هو حقيق وجدير بها، وليست من فضل الله- تعالى- وكأنه يقول ما قاله قارون:
إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي وفي حالة المنع والضيق في الرزق يجزع، ويأبى أن يرضى بقضاء الله وقدره.. ولا يخطر بباله أن نعم الله، إنما هي فضل تفضل به- سبحانه- عليه ليختبره، أيشكر أم يكفر. وأن تضييقه عليه في الرزق، ليس من الإهانة في شيء، بل هو للابتلاء- أيضا- والامتحان، كما قال- تعالى-: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ.
قال الإمام الشوكانى عند تفسيره لهاتين الآيتين: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في متاعها، ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد من زينتها، فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته، ويوفقه لعمل الآخرة.
ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم، لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخير، وما أصيب به من الشر في الدنيا، ليس إلا للاختبار والامتحان، وأن الدنيا بأسرها، لا تعدل عند الله- تعالى- جناح بعوضة.. .
واقتصر- سبحانه- في الآية الكريمة على تقتير الرزق، في مقابلة النعمة، دون غير ذلك من الأمراض والآفات، للإشعار بأن هذا الإنسان يعتبر دنياه جنته ومنتهى آماله. فهو لا يفكر إلا في المال ولا يحزن إلا من أجله، وأن المقياس عنده لمقادير الناس هو على حسب ما عندهم من أموال كما قال شاعرهم:
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ... ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي ... بنون كرام، سادة لمسوّد
ولما كان هذا القول مذموما من هذا الإنسان في الحالين. لعدم شكره لله- تعالى- في حالة الرخاء، ولعدم صبره على قضائه في حالة البأساء.
وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له.
القول في تأويل قوله تعالى : وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16).
وقوله: ( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) يقول: وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر ( فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) يقول: فضيَّق عليه رزقه وقَتَّره، فلم يكثر ماله، ولم يوسع عليه ( فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ) يقول: فيقول ذلك الإنسان: ربي أهانني، يقول: أذلني بالفقر، ولم يشكر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه، ورزقه من العافية في جسمه.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ) ما أسرع كفر ابن آدم.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، قوله: ( فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) قال: ضَيَّقه.
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) فقرأت عامة قرّاء الأمصار ذلك بالتخفيف، فقَدَر: بمعنى فقتر، خلا أبي جعفر القارئ، فإنه قرأ ذلك بالتشديد ( فَقَدَّرَ ) . وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: قدّر، بمعنى يعطيه ما يكفيه، ويقول: لو فعل ذلك به ما قال ربي أهانني.
والصواب من قراءة ذلك عندنا بالتخفيف، لإجماع الحجة من القرّاء عليه.
التدبر :
وقفة
[15، 16] المؤمن إذا ابتلي صبر، وإن أعطي شكر.
وقفة
[16] ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ الله لم يحرمه الرزق، وإنما قَدَّر عليه فأعطاه بقدر محدود، فلم يحمد ربه على العطاء لكن جزع من التضييق.
وقفة
[16] ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ لا تفسر ما يصيبك من آلام وأحزان ومرض وفقر بأنه إهانة من الله لك, ولكنه اختبار كاختبار الغني, فيا فوز الناجحين.
وقفة
[16] الرضا بقضاء الله وقدره من صفات المؤمنين ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾.
وقفة
[16] ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ كم من كلمة يقولها الإنسان تغضب الله، والله برئ منها عليه! فأعطاه بقدر محدود فلم يحمد ربه على العطاء لكن جزع من التضييق.
وقفة
[16] ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ كم من كلمةٍ يقولها الإنسان تغضب الله، والله برئ منها! فراجع ألفاظك.
وقفة
[16، 17] ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * ﲭ﴾ قال ابن القيم: «وأخبر تعالى أن توسعته على من وسَّع عليه وإن كان إكرامًا له في الدنيا فليس ذلك إكرامًا على الحقيقة، ولا يدل على أنه كريم عنده من أهل محبته، وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده، بل يوسع ويقتر ابتلاء وامتحانا، فيبتلى بالنعم كا يبتلى بالمصائب».
الإعراب :
- ﴿ وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها وحذف المبتدأ هنا اختصارا لان ما قبله يدل عليه والتقدير: وأما هو إذا ما ابتلاه ربه ....وفاعلا الفعلين «ابتلى» و «قدر» ضميران مستتران تقديرهما هو. عليه: جار ومجرور متعلق بقدر اي ضيق. رزقه: مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [16] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ حالَه عند النعماء؛ ذكرَ حالَه عند البلاء، قال تعالى:
﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
فقدر:
1- بخف الدال، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بشدها، وهى قراءة أبى جعفر، وعيسى، وخالد، والحسن، بخلاف عنه، وابن عامر.
أهانن:
قرئ:
1- بالياء، وصلا ووقفا، وهى قراءة ابن كثير.
2- بالياء، وصلا وحذفها وقفا، وهى قراءة نافع.
3- بحذفها، وصلا ووقفا، وهى قراءة باقى السبعة.
مدارسة الآية : [17] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴾
التفسير :
فرد الله عليه هذا الحسبان:بقوله{ كَلَّا} أي:ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر، والسعة والضيق، ابتلاء من الله، وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل.
وأيضًا، فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط، من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال:{ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ} الذي فقد أباه وكاسبه، واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه.
فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم، وعدم الرغبة في الخير.
لما كان الأمر كذلك جاء حرف الردع بعد ذلك فقال- تعالى-: كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ.
فقول- تعالى-: كَلَّا زجر وردع عن قول هذا الإنسان رَبِّي أَكْرَمَنِ عند حصول النعمة، وعن قوله رَبِّي أَهانَنِ عند حصول التقتير في الرزق، لأن الله- تعالى- قد يوسع على الكافر وهو مهان ومبغوض منه- تعالى-، وقد يضيق- سبحانه- على المؤمن مع محبته له، وكلا الأمرين حاصل بمقتضى حكمته- عز وجل- والمؤمن الصادق هو الذي يشكر عند الرخاء، ويصبر عند البأساء.
و «بل» هنا للإضراب الانتقالى، من ذمهم على القبيح من القول، إلى ذمهم بما هو أشنع منه، وهو ارتكابهم للقبيح من الأفعال.
أى: كلا ليس قولكم هذا وهو أن الإكرام في الإعطاء، والإهانة في المنع- هو القبيح فحسب، بل هناك ما هو أقبح منه، وهو أنكم- أيها الكافرون-.
لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ أى: لا تعطفون على اليتيم وهو الذي مات أبوه وهو صغير، بأن تتركوه معرضا للفقر والاحتياج، دون أن تعملوا على تقديم يد المساعدة إليه.
قال الله : ( كلا ) أي : ليس الأمر كما زعم ، لا في هذا ولا في هذا ، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ، ويضيق على من يحب ومن لا يحب ، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين ، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك ، وإذا كان فقيرا بأن يصبر .
وقوله : ( بل لا تكرمون اليتيم ) فيه أمر بالإكرام له ، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يحيى بن سليمان ، عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه " ثم قال بأصبعه : " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا " .
وقال أبو داود : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم - حدثني أبي ، عن سهل - يعني ابن سعد - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة " . وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام .
وقوله: ( كَلا بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ )
اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: ( كَلا ) في هذا الموضع، وما الذي أنكر بذلك، فقال بعضهم: أنكر جلّ ثناؤه أن يكون سبب كرامته من أكرم كثرة ماله، وسبب إهانته من أهان قلة ماله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ) ما أسرع ما كفر ابن آدم، يقول الله جلّ ثناؤه: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأُهينُ من أهنت بمعصيتي.
وقال آخرون: بل أنكر جلّ ثناؤه حمد الإنسان ربه على نِعمه دون فقره، وشكواه الفاقة، وقالوا: معنى الكلام، كلا أي: لم يكن ينبغي أن يكون هكذا، ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعا، على الغنى والفقر.
وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة لدلالة قوله: ( بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ) والآيات التي بعدها، على أنه إنما أهان من أهان بأنه لا يكرم اليتيم، ولا يَحُضّ على طعام المسكين، وسائر المعاني التي عدّد، وفي إبانته عن السبب الذي من أجله أهان من أهان، الدلالة الواضحة على سبب تكريمه من أكرم، وفي تبيينه ذلك عَقيب قوله: فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ بيان واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا.
وقوله: ( بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ) يقول تعالى ذكره: بل إنما أهنت من أهَنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم، فأخرج الكلام على الخطاب، فقال: بل لستم تكرمون اليتيم، فلذلك أهنتكم .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ ليست مجرَّد نفقة، أو كسوة، أو متاع، بل إكرامٌ تامٌّ بنفس كريمة.
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ ليست قضيةُ طعامٍ وشرابٍ فحَسْب، الآيةُ تحثُّ على الإكرامِ وليس مجرَّدَ الإطعامِ.
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ ليست قضية طعام وشراب وسكن فحسب؛ إنها شعور اليتيم بالتقدير والكرامة.
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ الآية تحث على (الإكرام) وليس مجرد (الإطعام)، فقد تطعم الفقير مع التكبر والإهانة، وأما الإكرام فينصرف إلى حفظ المشاعر والتقدير التي تحفظ الكرامة.
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ حفظ كرامة اليتيم أهم من إطعامه، رسالة لمن يصورون المحتاجين أثناء الإحسان إليهم.
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ تأمل في: (تكرمون)، ولم يقل: رحمة أو عطف؛ فلا بد أن يشعر بالإكرام كما تكرم الضيف، فله مكانته.
وقفة
[17] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ الاهتمام باليتيم ليست قضية طعام وشراب وسكن فحسب، إنها شعور اليتيم بالتقدير والكرامة.
عمل
[17] أكرم يتيمًا بهدية أو كلمة طيبة ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾.
عمل
[17] أكرم الفقراء والمساكين ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾.
وقفة
[17، 18] ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ وقوف همة العبد عند مراد نفسه دليل أنانيته وانحطاط عزيمته, أما النفوس الكبيرة فيتجاوز اهتمامها الذات إلي أحوال الضعفاء والمحتاجين.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا بَلْ لا: ﴾
- حرف ردع وزجر اي ردع للانسان عن قوله هذا. بل: حرف اضراب يفيد هنا التحقيق. لا: نافية فيها تأكيد الجحد.
- ﴿ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. اليتيم: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [17] لما قبلها : وبعد ذكرِ حال الإنسان عند النعماء وعند البلاء؛ صحح اللهُ مفاهيم هذا الإنسان في العطاء والمنع، والسعة والضيق، ثم ذكر أربعة أسباب لإهانة العبد عند ربِّه، وهي: ١- عدم إكرام اليتيم، قال تعالى:
﴿ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تكرمون:
قرئ:
1- بياء الغيبة، وهى قراءة الحسن، ومجاهد، وأبى رجاء، وقتادة، والجحدري، وأبى عمرو.
2- بتاء الخطاب، وهى قراءة باقى السبعة.
وكذا «وتأكلون» الآية: 19، و «تحبون» الآية: 20.
مدارسة الآية : [18] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾
التفسير :
{ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين} أي:لا يحض بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب.
وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ أى: ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين والبائسين.
ونفى الحض على إطعامهم، نفى لإطعامهم من باب أولى، وفي ذلك زيادة لمذلتهم، لأنهم لا يطعمون، ولا يحضون غيرهم عليه، لأنهم قوم خلت قلوبهم من الرحمة والعطف.
قال الآلوسى: قوله- سبحانه-: بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ... إلخ. انتقال وترق من ذم هذا الإنسان على القبيح من القول، إلى الأقبح من الفعل، والالتفات إلى الخطاب، لتشديد التقريع، وتأكيد التشنيع.. والجمع باعتبار معنى الإنسان، إذ المراد الجنس. أى: بل لكم أفعال وأحوال أشد شرا مما ذكر، وأدل على تهالككم على المال، حيث أكرمكم- سبحانه- بكثرة المال، ولكنكم لم تؤدوا ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم.
والمراد بطعام المسكين: إطعامه، فالطعام مصدر بمعنى الإطعام.. أو المراد به: الشيء المطعوم، ويكون الكلام على حذف مضاف. أى: على بذل طعام المسكين.. .
يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك.
( وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) .
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأه من أهل المدينة أبو جعفر وعامة قرّاء الكوفة ( بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلا تَحَاضُّونَ ) بالتاء أيضا وفتحها وإثبات الألف فيها، بمعنى: ولا يحضّ بعضكم بعضًا على طعام المسكين. وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء المدينة بالتاء وفتحها وحذف الألف ( وَلا تَحُضُّون ) بمعنى: ولا تأمرون بإطعام المسكين. وقرأ ذلك عامة قرّاء البصرة ( يَحُضُّون ) بالياء وحذف الألف بمعنى: ولا يكرم القائلون إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ربي أكرمني، وإذا قدر عليه رزقه ربي أهانني - اليتيم -( ولا يحضون على طعام المسكين ) وكذلك يقرأ الذين ذكرنا من أهل البصرة ( يُكْرِمُونَ ) وسائر الحروف معها بالياء على وجه الخبر عن الذين ذكرت. وقد ذُكر عن بعضهم أنه قرأ ( تُحاضُّونَ ) بالتاء وضمها وإثبات الألف، بمعنى: ولا تحافظون.
والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه قراءات معروفات في قَرَأة الأمصار، أعني: القراءات الثلاث صحيحات المعاني، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب.
التدبر :
وقفة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ أي: يحث بعضكم بعضًا, فإن فاتك الإطعام فالحث على الإطعام ليس بأقل منه حظوة عند الله, وليس شرطًا أن تطعم لكي تحض غيرك.
وقفة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ أي: لا يحض بعضكم بعضًا على طعام المحاويج من المساكين والفقراء؛ وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب.
لمسة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾، فتأمل الإتيان بصيغة الجمع في قوله: (وَلَا تَحَاضُّونَ) ففي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك مجهود جماعي في الحث على الإطعام، ويؤكد هذا أن القرآن في الفترة المكية أبرز قضية العناية بحقوق الناس، وخاصة الضعفاء؛ لأن حفظ الحقوق يحفظ المجتمعات، وبالإطاحة بها تنهار المجتمعات من داخلها.
وقفة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ إن فاتك الإطعام فالحث على الإطعام ليس بأقل منه، ليس شرطًا أن تطعم لكي تحض غيرك.
وقفة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ قال رسول الله ﷺ: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» [الطبراني في الكبير 1/66/1، وصححه الألباني].
وقفة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ فيه ذم عدم التواصي بالخير والحض عليه، وفيه أن أفراد الأمة متكافلون، ومأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع التزام كل واحد بما يأمر به، وابتعاده عما نهى عنه.
وقفة
[18] ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ ليس للفقير عذر في إهمال المساكين، فإن فقدت المال، فلم تقدر على الإطعام، فليس أقل من حض غيرك عليه، ولك نفس الأجر مع التمام.
الإعراب :
- ﴿ وَلا تَحَاضُّونَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «لا تُكْرِمُونَ» وتعرب اعرابها واصلها:تتحاضون حذفت احدى التاءين تخفيفا اي ولا يحض بعضكم بعضا.
- ﴿ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بلا تحاضون. المسكين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [18] لما قبلها : ٢- عدم الحثِّ على إطعام المسكين، قال تعالى:
﴿ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تحاضون:
1- بفتح التاء والألف، وهى قراءة الأعمش.
وقرئ:
2- بضم التاء والألف، وهى قراءة عبد الله، وعلقمة، وزيد بن على، وعبد الله بن المبارك، والشيرازي، عن الكسائي.
مدارسة الآية : [19] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴾
التفسير :
{ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ} أي:المال المخلف{ أَكْلًا لَمًّا} أي:ذريعًا، لا تبقون على شيء منه.
وقوله- سبحانه-: وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا بيان لرذيلة ثالثة من رذائلهم المتعددة. والتراث: هو المال الموروث عن الغير. والمراد بالأكل مطلق الانتفاع، وخص الأكل بالذكر، لأنه يشمل معظم وجوه التصرفات المالية.
والّمّ: الجمع بدون تفرقة بين الحلال والحرام، مأخوذ من قولهم: لمّ الطعام، إذا أكله كله دون أن يترك منه شيئا.
أى: ومن صفاتكم القبيحة أنكم تأكلون المال الموروث عن غيركم، أكلا شديدا، بحيث لا تتركون منه شيئا، ولا تفرقون بين ما هو حلال أو حرام، ولا بين ما يحمد وما لا يحمد، بل تأخذون حقوقكم وحقوق غيركم من النساء والصبيان.
"تأكلون التراث" يعني الميراث "أكلا لما" أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام.
وقوله: ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) يقول تعالى ذكره: وتأكلون أيها الناس الميراث أكلا لمًّا، يعني: أكلا شديدًا لا تتركون منه شيئا، وهو من قولهم: لممت ما على الخِوان أجمع، فأنا ألمه لمًّا: إذا أكلت ما عليه فأتيت على جميعه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عمرو بن سعيد بن يسار القرشي، قال: ثنا الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) قال: الميراث.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ ) أي الميراث، وكذلك في قوله: ( أَكْلا لَمًّا ).
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) يقول: تأكلون أكلا شديدا.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلية، عن يونس، عن الحسن، في قوله: ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) قال: نصيبه ونصيب صاحبه.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( أَكْلا لَمًّا ) قال: اللمّ السفّ، لفّ كل شيء.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( أَكْلا لَمًّا ) أي: شديدا.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( أَكْلا لَمًّا ) يقول: أكلا شديدا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول الله: ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) قال: الأكل اللمّ: الذي يأكل كلّ شيء يجده ولا يسأل، فأكل الذي له والذي لصاحبه، كانوا لا يُوَرِّثون النساء، ولا يورّثون الصغار، وقرأ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أي: لا تورِّثونهنّ أيضا( أَكْلا لَمًّا ) يأكل ميراثه، وكلّ شيء لا يسأل عنه، ولا يدري أحلال أو حرام.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ). يقول: سَفًّا.
حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة البستيّ، عن زُهير، عن سالم، قال: قد سمعتُ بكر بن عبد الله يقول في هذه الآية: ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) قال اللمّ: الاعتداء في المِيراث، يأكل ميراثه وميراث غيره.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[19] ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ لم يقل: (المال)؛ لأن النفس الجشعة تتلهف لكل شيء يأتي بلا تعب ولو كان متاعًا حقيرًا، فلا صاحبها أغنت ولا لجوعها سدت.
الإعراب :
- ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ: ﴾
- الواو عاطفة. تأكلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و «التراث» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ أَكْلًا لَمًّا: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لما: صفة- نعت- لأكلا منصوبة مثلها بالفتحة. اي أكلا ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [19] لما قبلها : ٣- أكل حقوق الآخرين في الميراث وغيره، قال تعالى:
﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [20] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾
التفسير :
{ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} أي:كثيرًا شديدًا، وهذا كقوله تعالى:{ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}{ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} .
ومن صفاتكم- أيضا- أنكم تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا أى: حبا كثيرا مع حرص وشره. يقال: جمّ الماء في الحوض، إذا كثر واجتمع، ومنه الجموم للبئر الكثيرة الماء.
والحب المفرط للمال من الصفات الذميمة، لأنه يؤدى إلى جمعه من كل طريق، بدون تفرقة بين ما يحل منه وما يحرم.
فأنت ترى أن الله- تعالى- قد وصف هذا النوع من الناس، بأنه قد جمع في سوء سلوكه، بين النطق بالقبيح من الأقوال، وبين ارتكاب القبيح من الأفعال، وهي: ترك اليتيم بلا رعاية، وعدم الحض على إطعام المحتاج، وجمع المال الموروث بدون تفرقة بين حلاله وحرامه، والإفراط في حب المال بطريقة ذميمة.
أي كثيرا زاد بعضهم فاحشا.
القول في تأويل قوله تعالى : وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) .
يعني تعالى ذكره بقوله: ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) وتحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حبا كثيرا شديدا، من قولهم: قد جمّ الماء في الحوض: إذا اجتمع، ومنه قول زُهير بن أبي سلمى:
فَلَمَّــا ورَدْنَ المَـاءَ زُرْقًـا جِمامُـهُ
وَضَعْـنَ عِصِـيَّ الْحـاضِرِ المُتَخَـيَّمِ (5)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) يقول: شديدا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) فيحبون كثرة المال.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( حُبًّا جَمًّا ) قال: الجمّ: الكثير.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) : أي حبا شديدا.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( حُبًّا جَمًّا ) : يحبون كثرة المال.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) قال: الجمّ: الشديد.
------------------------
الهوامش:
(5) البيت من معلقة زهير ( مختار الشعر الجاهلي 229 ) قال شارحه : وردن الماء : أتينه وحللن عليه . وجمامة : جمع جم ، وهو ما تجمع وكثر . وزرقة الماء : من شدة صفاء لونه ؛ لأنه لم يورد قبلهن ولم يحرك . ووضع العصى : كناية عن النزول بالمكان ، والإقامة فيه . ا هـ وفي ( اللسان : جم ) الجم والجمم ( محركا ) : الكثير من كل شيء . ومال جم :كثيرا . وفي التنزيل العزيز : { وتحبون المال حبا جما } أي : كثيرا . وكذلك فسره أبو عبيدة . وقيل الجم : الكثير المجتمع ؛ جم يجم كيجلس ويقعد والضم أعلى ، جموما . ا هـ .
التدبر :
وقفة
[20] ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ شيء مؤسف أن يجد الإنسان نفسه متورطًا في قصة عشق كهذه.
وقفة
[20] ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ القرآن يضع أيدينا من أول يوم على موطن الداء، ومكمن المرض العضال، إنه مرض ذو شعبتين: شعبة تنخر في نفسية الفرد، وشعبة تف في كيان الأمة والدولة.
لمسة
[20] تصدق بمال يخفف حبه في قلبك ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾.
وقفة
[20] ﴿وتحبون المال حبًا جمًّا﴾ أحب شيء للإنسان في هذه الدنيا هو المال، هذا المحبوب لن ينفع محبَّه في الآخرة، ولن يغني عنه من الله شيئًا ﴿ما أغنى عنّي ماليه﴾ [الحاقة: 28].
الإعراب :
- ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. أي حبا شديدا مع الحرص والشره.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [20] لما قبلها : ٤- محبة المال حبًّا شديدًا، قال تعالى:
﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [21] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا .. ﴾
التفسير :
{ كَلَّا} أي:ليس [كل] ما أحببتم من الأموال، وتنافستم فيه من اللذات، بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم، وهول جسيم، تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعًا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمت.
وبعد هذا الزجر والردع لهم، لسوء أقوالهم وأفعالهم، أخذت السورة الكريمة في زجرهم وردعهم عن طريق تذكيرهم بأهوال الآخرة فقال: - تعالى-: كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. وقوله- تعالى-: كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ردع لهم وزجر عن أفعالهم السابقة، وهي عدم إكرام اليتيم، وعدم الحض على طعام المسكين.
وقوله: دُكَّتِ الْأَرْضُ من الدك: بمعنى الكسر والدق والزلزلة الشديدة، والتحطيم الجسيم، وانتصب لفظ «دكا» الأول على أنه مصدر مؤكد للفعل، وانتصاب الثاني على أنه تأكيد للأول. وقيل: تكرار «دكا» للدلالة على الاستيعاب، كقولك: قرأت النحو بابا بابا، أى: قرأته كله.
قال القرطبي: قوله- تعالى-: كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ... أى: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فهو رد لانكبابهم على الدنيا، وجمعهم لها، فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض، ولا ينفعه الندم، والدك: الكسر والدق، أى: زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك.
وقوله: دَكًّا دَكًّا أى: مرة بعد مرة، زلزلت فكسر بعضها بعضا فتكسر كل شيء على ظهرها.. .
يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى "كلا" أي حقا"إذا دكت الأرض دكا دكا" أي وطئت ومهدت وسويت الجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم.
ويعني جلّ ثناؤه بقوله: ( كَلا ) : ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. ثم أخبر جلّ ثناؤه عن ندمهم على أفعالهم السِّيئة في الدنيا، وتلهُّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم الندم، فقالّ جل ثناؤه: ( إِذَا دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا ) يعني: إذا رجت وزُلزلت زلزلة، وحرّكت تحريكا بعد تحريك.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( إِذَا دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا ) يقول: تحريكها.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني حرملة بن عمران، أنه سمع عمر مولى غُفْرة يقول: إذا سمعت الله يقول: كلا فإنما يقول: كذبت.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[21، 22] ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ ليس للتأكيد كما يظنه طائفة من الناس، وإنما المراد الدك المتتابع، أي: دكًّا بعد دك، وكذلك قوله: ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ ليس للتأكيد، إذ المراد صفًّا بعد صف، أي صفًّا يتلوه صف.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا إِذا: ﴾
- حرف ردع وزجر اي ردع لهم عن ذلك وانكار لفعلهم. اذا:ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق- منصوب- بجوابه متضمن معنى الشرط وجوابه او عامل النصب فيه «يتذكر» في الآية الكريمة الثالثة والعشرين.
- ﴿ دُكَّتِ الْأَرْضُ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. دكت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين و «الارض» نائب فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ دَكًّا دَكًّا: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة. دكا:مصدر مؤكد تأكيد او تكرار للاولى منصوب بالفتحة. اي دكا بعد دك حتى عادت هباء منثورا. وقيل كرر الثاني تأكيدا وقيل: ليست من تأكيد الاسم خلافا لكثير من النحويين لأن المعنى دكا بعد دك وان الدك كرر عليها حتى صارت هباء منثورا.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [21] لما قبلها : وبعد ذكرِ الابتلاء؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أن نتيجة الابتلاء بالمال وسعة الرزق تَظْهَرُ يوم القيامة، وذكرَ بعض أوصافه: ١- إذا حُرِّكت الأرض تحريكًا شديدًا وزُلْزِلت، قال تعالى:
﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [22] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾
التفسير :
ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام، أهل السماوات كلهم، صفًا صفا أي:صفًا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا، يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار.
وقوله- تعالى-: وَجاءَ رَبُّكَ ... هذه الآية وأمثالها من آيات الصفات التي يرى السلف وجوب الإيمان بها كما جاءت، بمعنى أننا نؤمن بمجيء الله- تعالى- ولكن من غير تكييف ولا تمثيل، بل نكل علم كيفية مجيئه إلى مشيئته- تعالى-.
والخلف يؤولون ذلك بأى المجيء هنا بمعنى مجيء أمره وقضائه.
قال الآلوسى: قوله- تعالى-: وَجاءَ رَبُّكَ ... قال منذر بن سعيد، معناه: ظهر- سبحانه- للخلق هنالك، وليس ذلك بمجيء نقلة.. وقيل: الكلام على حذف مضاف للتهويل، أى: وجاء أمر ربك وقضاؤه. واختار جمع أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره- تعالى- وتبيين آثار قدرته وسلطانه، مثلت حاله- سبحانه- في ذلك، بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم، وأنت تعلم ما للسلف في المتشابه من الكلام.
وَالْمَلَكُ أى: جنس الملك، فيشمل جميع الملائكة صَفًّا صَفًّا أى: مصطفين، أو ذوى صفوف.. .
( وجاء ربك ) يعني : لفصل القضاء بين خلقه ، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد - صلى الله عليه وسلم - بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد ، فكلهم يقول : لست بصاحب ذاكم ، حتى تنتهي النوبة إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - فيقول : " أنا لها ، أنا لها " . فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك ، وهي أول الشفاعات ، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة " سبحان " فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء ، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا .
وقوله: ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفا صفا بعد صفّ.
كما حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب، قالا ثنا عوف، عن أبي المنهال، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مدّ الأديم، وزيد في سعتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد، جنهم وإنسهم، فإذا كان ذلك اليوم قيضت (6) هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض، وَلأهل السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بضعف فإذا نثروا على وجه الأرض فزِعوا منهم، فيقولون: أفيكم ربنا: فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا ليس فينا، وهو آت، ثم تقاض السماء الثانية، وَلأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض، فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا، ليس فينا، وهو آت، ثم تقاضُ السموات سماء سماء، كلما قيضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض، فزِع إليهم أهل الأرض، فيقولون لهم مثل ذلك، ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاض السماء السابعة، فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ستِّ سموات، ومن جميع أهل الأرض بضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جِثيّ صفوف، وينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحمادون لله على كل حال؛ قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعًا، ومما رزقناهم ينفقون؟ فيسرحون إلى الجنة؛ ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلَّب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عُنُق من النار، فأشرف على الخلائق، له عينان تبصران، ولسان فصيح، فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة: بكلّ جبار عنيد، فيلقُطهم من الصفوف لقط الطير حبّ السمسم، فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثانية فيقول: إني وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم لقط الطير حبّ السمسم، فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثالثة، قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت بأصحاب التصاوير، فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حبّ السمسم، فيحبس بهم في جهنم، فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة، ومن هؤلاء ثلاثة، نُشرت الصحف، ووُضعت الموازين، ودُعي الخلائق للحساب.
حدثني موسى بن عبد الرحمن قال: ثنا أبو أُسامة، عن الأجلح، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: إذا كان يوم القيامة، أمر الله السماء الدنيا بأهلها، ونـزل من فيها من الملائكة، وأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، فصَفُّوا صفًا دون صفّ، ثم ينـزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل الأرض ندّوا، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ، وذلك قوله: ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) وقوله: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ وذلك قول الله: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القُرَظيّ، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تُوقفُونَ مَوْقِفا وَاحِدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ مِقْدَارَ سَبْعِينَ عاما، لا يُنْظُر إلَيْكُمْ وَلا يُقْضَى بَيْنَكُمْ، قَدْ حُصِرَ عَلَيْكُمْ، فَتَبْكُونَ حتى يَنْقطِعَ الدَّمْعُ، ثُمَّ تَدْمعُون دما وَتَبْكُون حتى يَبْلُغَ ذلكَ مِنْكُمْ الأذْقَانَ، أوْ يُلْجِمَكُمْ فَتَضُجُّونَ، ثُمَّ تَقُولُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَنا إلى رَبِّنا، فَيَقْضِي بَيْنَنا، فَيَقُولُونَ مَنْ أحَقُّ بِذلكَ مِنْ أبِيكُمْ، جَعَلَ اللهُ تُرْبَتَهُ وَخَلْقَهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وكَلَّمَهُ قُبُلا فَيُؤْتَى آدَمُ صَلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَيُطْلَبُ ذلكَ إلَيْهِ فَيأْبَى، ثُمَّ يَسْتَقْرُونَ الأنبِياءَ نَبِيًّا نَبِيًّا، كُلَّما جاءُوا نَبِيًّا أبى " قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " حتى يَأْتونِي، فإذَا جاءُونِي خَرَجْتُ حتى آتِي الفَحْص " ، قال أبو هريرة: يا رسول الله، ما الفحصُ؟ قال: " قُدَّامَ العَرْشِ، فأخِرُّ ساجِدًا، فَلا أزَالُ ساجِدًا حتى يَبْعَثَ اللهُ إليَّ مَلَكًا، فَيأخُذَ بعَضُدِي، فَيرْفَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ اللهُ لِي: مُحَمَّدٌ، وَهُوَ أعْلَمُ، فأقُولُ: نَعْم، فَيَقُولُ: ما شأنُكَ؟ فأقول: يا رَبِّ وَعَدْتَنِي الشَّفاعَةَ، شَفِّعْنِي فِي خَلْقِكَ فاقْضِ بَيْنَهُمْ، فَيَقُولُ: قَدْ شَفَّعْتُكَ، أنا آتِيكُمْ فأقْضِي بَيْنَكُمْ". قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " فأنصَرِفُ حتى أقِفَ مَعَ النَّاسِ، فَبَيْنا نَحْنُ وَقُوفٌ، سَمِعْنا حِسًّا مِنَ السَّماءِ شَدِيدًا، فَهالَنا، فَنـزلَ أهْلُ السَّماءِ الدُّنْيا بِمِثْلَيْ مَنْ فِي الأرْضِ مِنَ الجِنّ والإنسِ، حتى إذَا دنوْا مِنَ الأرْضِ، أشْرَقَتِ الأرْضُ، بِنُورِهِمْ، وأخَذُوا مَصَافَّهُمْ، وَقُلْنَا لَهُمْ: أفِيكُمْ رَبُّنا؟ قالوا: لا وَهُوَ آتٍ، ثُمَّ يَنـزلُ أهْلُ السَّماءِ الثَّانِيَةِ بِمِثْلَيْ مَنْ نـزلَ مِنَ المَلائِكَةِ، وَبِمِثْلَيْ مَنْ فِيها مِنَ الجِنّ وَالإنْسِ، حتى إذَا دَنَوْا مِنَ الأرْضِ أشْرَقَتِ الأرضُ بِنُورِهِمْ، وأخَذُوا مَصَافَّهُمْ، وَقُلْنَا لَهُمْ: أفِيكُمْ رَبُّنا؟ قالوا: لا وَهُوَ آتٍ. ثُمَّ نـزلَ أهْلُ السَّمَاوَاتِ عَلى قَدْرِ ذلكَ مِنَ الضِّعْفِ حتى نـزلَ الجَبَّارُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالمَلائِكَةِ، وَلَهُمْ زَجَلٌ مِنْ تَسْبِيحِهِمْ، يَقُولُونَ: سُبْحانَ ذِي المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ، سُبْحانَ رَبِّ العَرْشِ ذِي الجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ سُبْحانَ الَّذِي يميت الخلائق ولا يَمُوتُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّوحِ، قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، سُبْحانَ رَبِّنا الأعْلَى سُبْحان ذِي الجَبرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِياءِ والسُّلْطانِ والعَظَمَةِ سُبْحانَهُ أبَدًا أبَدًا، يَحْمِلُ عَرْشَهُ يَوْمَئِذٍ ثمَانِيَةٌ، وَهمُ اليَوْمَ أرْبَعَةٌ، أقْدَامُهُم على تُخُومِ الأرْضِ السُّفْلَى، والسَّمَاوَاتُ إلى حُجَزِهِمْ، وَالعَرْشُ عَلى مَناكِبِهمْ، فَوَضَعَ الله عَرْشَهُ حَيْثُ شَاء مِنَ الأرْض، ثُمَّ يُنادِي بِنِدَاءٍ يُسْمِعُ الخَلائِقَ فَيَقُولُ يا مَعْشَرَ الجِنِّ والإنْسِ، إنِّي قَدْ أنْصَتُّ مُنْذُ يَوْمِ خَلَقْتُكُمْ إلى يَوْمِكُمْ هَذَا، أسمَعُ كَلامَكُمْ، وأُبْصِرُ أعمالَكمْ، فَأنْصِتُوا إليَّ، فإنَّمَا هِيَ صُحُفُكُمْ وأعمالكُمْ &; 24-420 &; تُقْرأُ علَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيرَ ذلكَ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ، ثُمَّ يأْمُرُ اللهُ جَهَنَّمَ فَتُخْرِجُ مِنْها عُنُقا ساطِعا مُظْلِما، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إلى قوله: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ فيتميز الناس ويَجْثُونَ، وَهِيَ التي يَقُولُ اللهُ: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ ... الآية، فَيَقْضِي اللهُ بَينَ خَلْقِهِ الجِنِّ والإنْسِ وَالْبَهائمِ، فإنَّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ لِلْجَمَّاءِ مِنْ ذَاتِ القُرُونِ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدةٍ لأخْرَى قال اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ يا لَيْتَني كُنْتُ تُرَابًا، ثُمَّ يَقْضِي اللهُ سُبْحانَهُ بَينَ الجِنِّ والإنْسِ".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) صفوف الملائكة.
------------------------
الهوامش:
(6) في ( اللسان : قيض ) وذكر طرفا من حديث ابن عباس هذا ، قال : قيضت : أي نقضت . يقال : قضت البناء فانقاض ، وقيل : معناه : شقت ، من قاض الفرخ البيض ، فانقاضت .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[22] ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به؛ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
وقفة
[22] ﴿وَجاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ثبوت المجئ لله تعالى يوم القيامة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
وقفة
[22] ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ إن يقينك أيها العبد بمجيء الملك الجبار يوم القيامة للحساب؛ يدعوك إلي الاستعداد لذلك اللقاء, بكثرة الطاعات, والرغبة في الدار الآخرة.
الإعراب :
- ﴿ وَجاءَ رَبُّكَ: ﴾
- الواو عاطفة. جاء: فعل ماض مبني على الفتح. ربك:فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. اي وجاء امر ربك اي وظهرت آيات اقتداره وآثار اقتداره وسلطانه وحذف المضاف الفاعل لدلالة قرينة عليه فقام المضاف اليه مقامه في اعرابه رفعا.
- ﴿ وَالْمَلَكُ: ﴾
- معطوفة بالواو على كلمة «ربك» مرفوعة بالضمة اي الملائكة لانه في معنى الجماعة.
- ﴿ صَفًّا صَفًّا: ﴾
- مصدر في موضع الحال اي ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ٢- جاء اللهُ للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفًا، قال تعالى:
﴿ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء