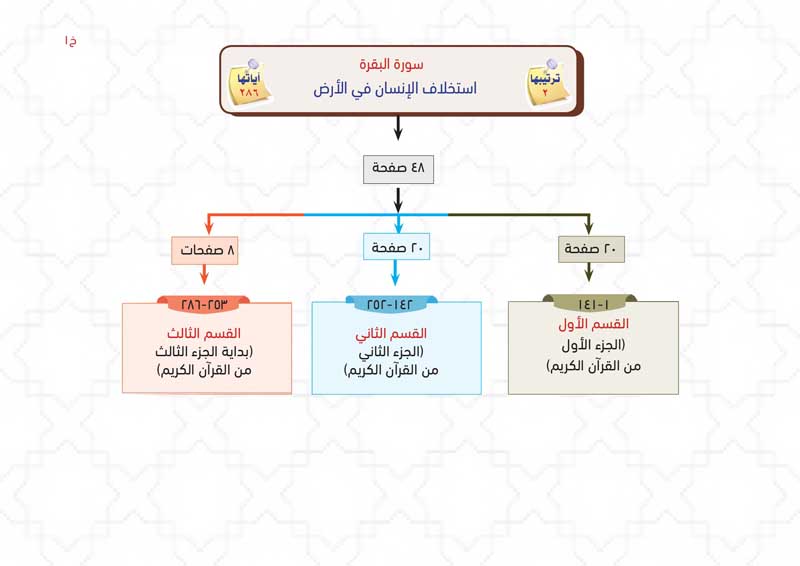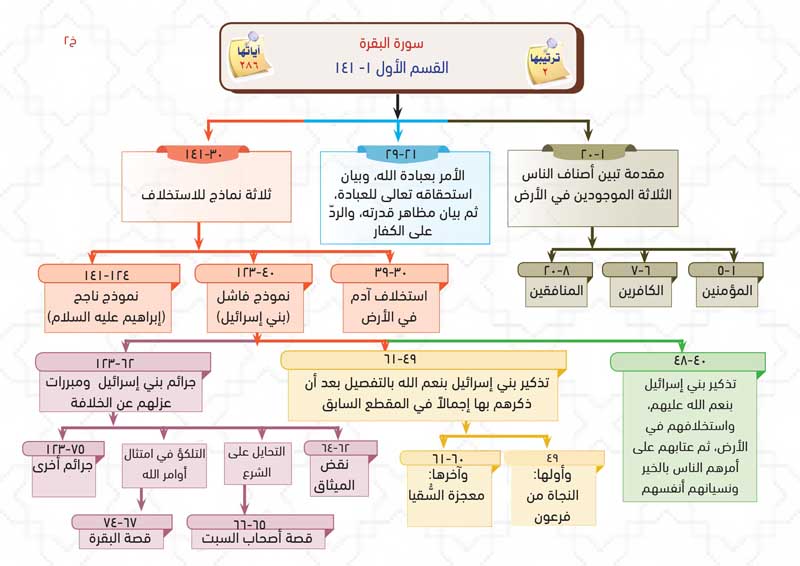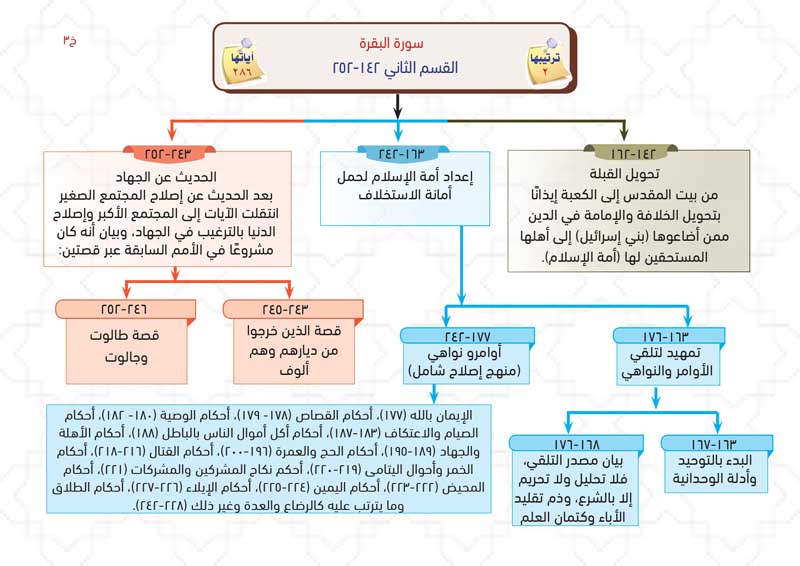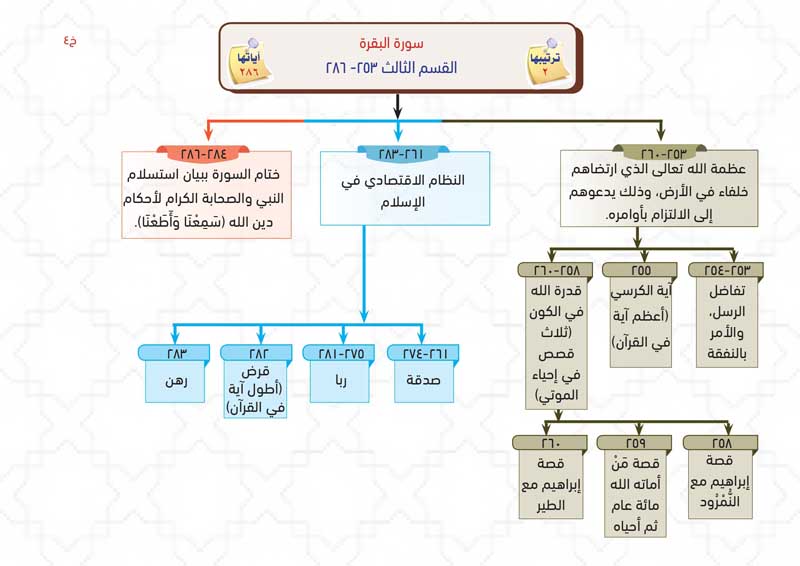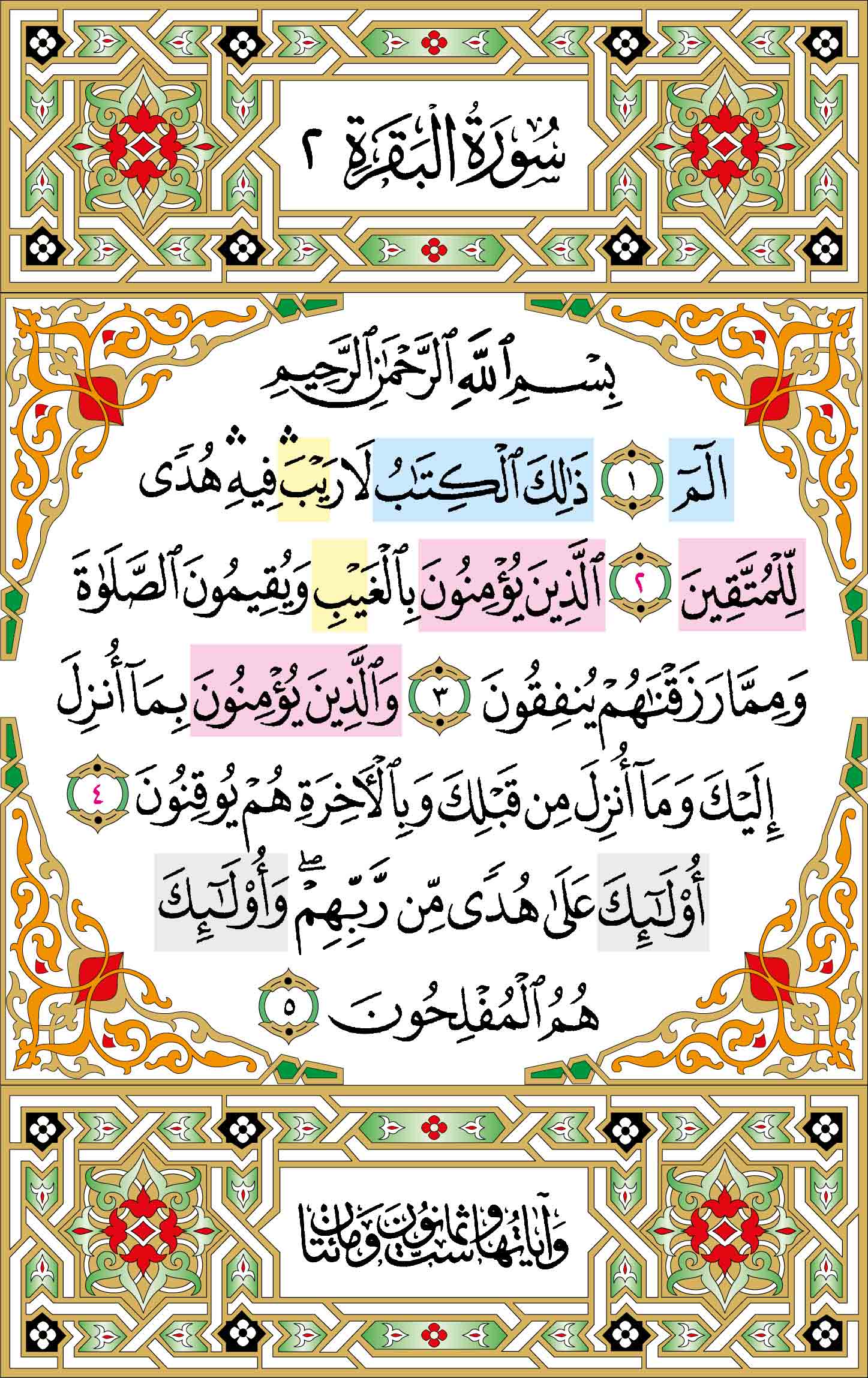
الإحصائيات
سورة البقرة
| ترتيب المصحف | 2 | ترتيب النزول | 87 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 48.00 |
| عدد الآيات | 286 | عدد الأجزاء | 2.40 |
| عدد الأحزاب | 4.80 | عدد الأرباع | 19.25 |
| ترتيب الطول | 1 | تبدأ في الجزء | 1 |
| تنتهي في الجزء | 3 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 1/29 | آلم: 1/6 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)
هي أطولُ سورةٍ في القرآنِ، وبدأَتْ ببيانِ وظيفةِ القرآنِ، وأنَّه كتابُ هدايةٍ وإرشادٍ، ثُمَّ تقسيمِ النَّاسِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ معَ ذكرِ بعضِ صفاتِهم في 20 آيةً، فتحدَّثَتْ الآياتُ (1- 5) عن المؤمنينَ، والآيتان (6، 7) عن الكافرينَ، والآياتُ (8- 20) عن المن
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة البقرة
استخلاف الإنسان في الأرض/ العبادة/ الإسلام لله تعالى
أولاً : التمهيد للسورة :
- • فلماذا سميت السورة بالبقرة؟: قد يتساءل البعض لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ قد يجيب البعض بأنها سميت كذلك لأنّ قصة البقرة جاءت في هذه السورة. فنقول: إنَّ هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة، فلماذا سميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ العناوين دلالة الاهتمام، فهذه إشارة إلى أهمية هذه القصة، أو أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة.
- • ليست مجرد قصة:: لم تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) مجرد قصة من قصص بني إسرائيل، ولكنها تجسيد لحال بني إسرائيل مع أوامر الله، تلكأ في تنفيذ أوامر الله، تعنت، وتشدد، وتحايل، ومماطلة، وجدال، وجحود، وعناد. وهذا في غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على الاستجابة ﻷوامر الله، فقد تضمنت الكثير من التشريعات والأحكام، فكأن الاسم شعار للمؤمنين ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة، لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولهذا خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (285).
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة البقرة»، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين».
- • معنى الاسم :: البقرة: حيوان معروف، لحمه يؤكل ولبنه يشرب، والزهراوان: المُنيرتان المُضيئتان، واحدتها زهراء.
- • سبب التسمية :: سميت سورة البقرة؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها، ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة غيرها، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين»؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: وتسمى أيضًا «سَنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه، فسميت بذلك تعظيمًا لشأنها، و«فُسطاط القرآن» والفسطاط هو المدينة الجامعة، لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: وجوب الاستجابة لأوامر لله، والاستسلام الكامل لأحكامه، والانقياد والإذعان لها.
- • علمتني السورة :: أن هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا أحكامه، ولاهدايته: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾
- • علمتني السورة :: تكريم الله للإنسان بسجود الملائكة له، وتعليمه أسماء جميع الأشياء، وإسكانه الجنة، واستخلافه في الأرض: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾
- • علمتني السورة :: أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود لم يعلموا من التوراة إلا التلاوة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».
• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». ففي حرَّ يوم القيامة الشديد، عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، تأتي سورة البقرة لتظلل على صاحبها.تأمل كيف أنّ سورتي البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما.
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».
• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:« يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ:" اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». زَادَ أَحْمَد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَينِ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ».
• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ».
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ»، فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ».
• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».
• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة البقرة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.
خامسًا : خصائص السورة :
- • هي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق
• أول سورة نزلت في المدينة.
• أول سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة من أصل 29 سورة افتتحت بذلك.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة ﴿الم﴾ من أصل 6 سور افتتحت بذلك.
• هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة.
• تحتوي على أعظم آية (آية الكرسي)، وأطول آية (آية الدين).
• تحتوي على آخر آية نزلت -على الراجح- وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (281).
• كثرة أحكامها، قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: «فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر».
• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستقبل أوامر الله بـ "سمعنا وأطعنا"، وأن نحذر من: "سمعنا وعصينا".
• أن نرتبط بكتاب الله علمًا وتدبرًا وعملًا؛ لنصل إلى الهداية ونبتعد عن طريق الغواية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (2).
• أن نتحلى بصفات المتقين، ومنها: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله، الإيمان باليوم الِآخر: ﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...﴾ (2-5).
• أن نحذر من صفات المنافقين، ومنها: لا يعترفون بأخطائهم، يصرون على الذنوب، يمثلون أمام الناس أنهم مصلحون وهم المفسدون، يخادعون أنفسهم (8-20).
• أن نبتعد عن الكبر؛ فالكبر هو معصية إبليس: ﴿... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ...﴾ (34).
• أن نمتثل أوامر الله تعالى ونحذر من وساوس الشيطان: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...﴾ (35، 36).
• أن نحذر الذنوب، فبذنبٍ واحد خرج أبونا من الجنة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (36).
• أن نسارع بالتوبة كما فعل أبونا آدم عليه السلام (37).
• أن نتجنب الأخطاء التي وقعت من بني إسرائيل، ولا نفعل مثل ما فعلوا (40-123).
• أن نذكِّر الناس ونرشدهم إلى الخير؛ ولا ننسى أنفسنا من ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ (44). • أن نختار كلماتنا بعناية شديدة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (83).
• أن نسارع بالاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (131)، وأن نحذر عناد بني إسرائيل وجدالهم.
• أن نكثر من ذكر الله تعالى وشكره حتى نكون من الذاكرين: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (152).
• أن نقول: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (156).
• أن نكثر التأمل والتفكر في خلق الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (164).
• أن نأتي كل أمر من أمورنا من الطريق السهل القريب: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (189).
• أن نبادر في قضاء فريضة الحج، ونحرص على عدم الرفث والفسوق والجدال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...﴾ (197).
• أن نحذر من خطوات الشيطان ووساوسه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (208).
• أن نحسن الظن بالله وبما قدَّره لنا في حياتنا، حتى لو أننا كرهناه فهو بالتأكيد خير لنا، فكل أقداره عز وجل خير: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ...﴾ (216).
• أن نبتعد عن الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ...﴾ (219).
• أن نحافظ على الصلاة تحت أي ظرف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (238).
• ألا نَمُن على أحد أنفقنا عليه، ولا نؤذيه، ولا ننتظر الأجر إلا من الله: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ...﴾ (262).
• أن نحذر الربا، ونبتعد عنه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ...﴾ (275-279).
• أن نصبر على المعسر الذي لم يستطع القضاء، أو نسقط عنه الدين كله أو بعضه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (280).
• أن نقول لكل ما جاء به الرسول عن ربنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (285)، بلا جدال، ولا نقاش، ولا تكاسل.
تمرين حفظ الصفحة : 2
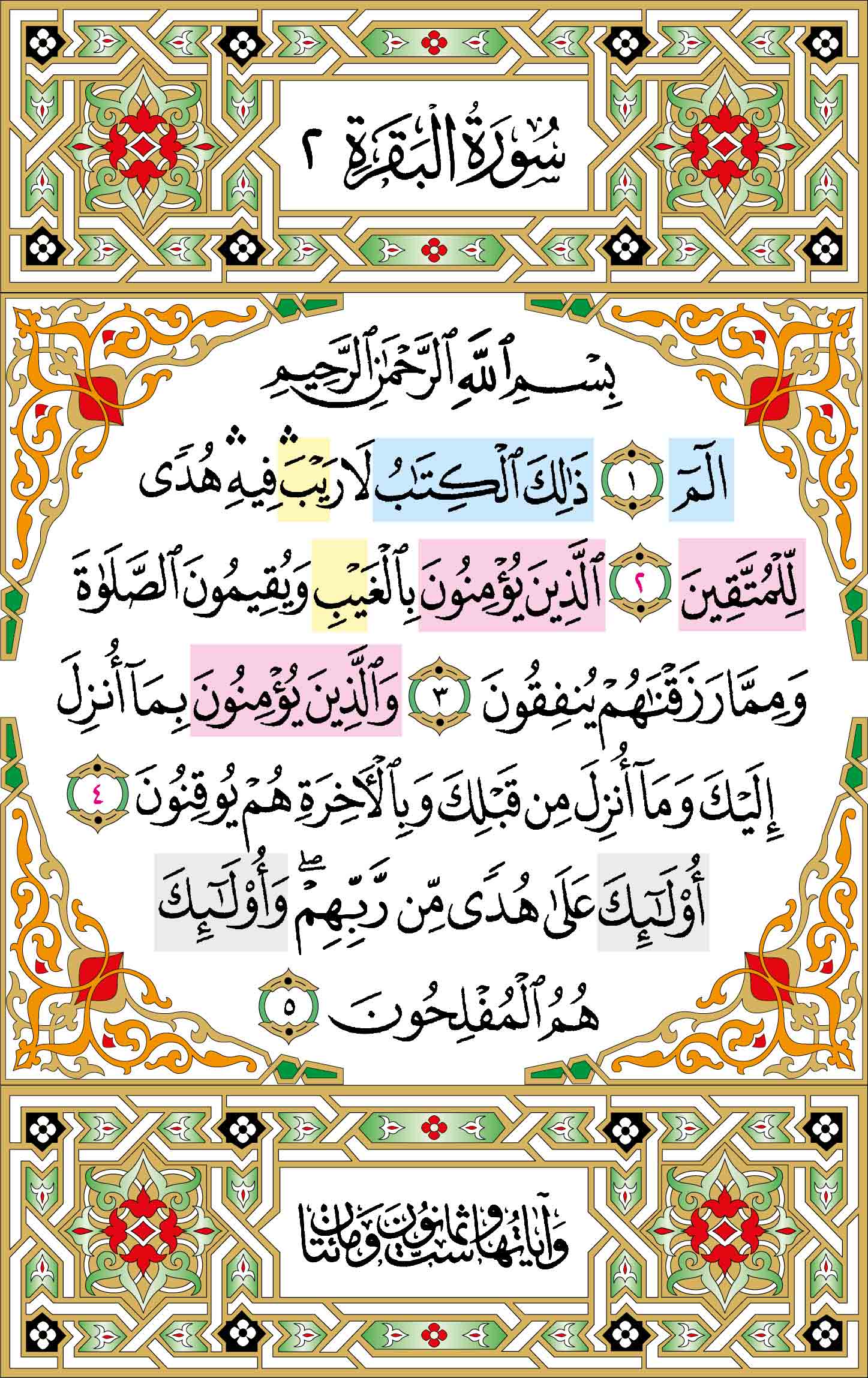
مدارسة الآية : [1] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الم ﴾
التفسير :
الحروف المقطعة في أوائل السور, الأسلم فيها, السكوت عن التعرض لمعناها [من غير مستند شرعي], مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.
سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، فقد استغرقت جزءين ونصف جزء تقريبا من ثلاثين جزءا قسم إليها القرآن. وتبلغ آياتها ستا وثمانين ومائتي آية. وقيل سبع وثمانون ومائتا آية.
وسميت بذلك لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي كلف قوم موسى بذبحها بعد أن قتل فيهم قتيل ولم يعرفوا قاتله.
وهي مدنية بإجماع الآراء، وقد ابتدأ نزولها بعد هجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، وقد نزل معظمها في السنوات الأولى من الهجرة، واستمر نزولها إلى قبيل وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بفترة قليلة.
وكانت آخر آية من القرآن نزولا منها، هي قوله- تعالى-:
وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ.
مناسبتها لسورة الفاتحة: هناك مناسبة ظاهرة بين السورتين، لأن سورة الفاتحة قد اشتملت على أحكام الألوهية والعبودية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم اشتمالا إجماليا، فجاءت سورة البقرة ففصلت تلك المقاصد، ووضحت ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من هدايات وتوجيهات.
فضلها: وقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث متعددة، وآثار متنوعة منها ما جاء في مسند أحمد وصحيح مسلّم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان.
وروى ابن حبان في صحيحه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (إن لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام) .
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: (بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم بعثا، وهم ذوو عدد فاستقرأ كل واحد منهم عما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال:
ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال:
نعم. قال. اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اقرءوا القرآن وتعلموه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب أوكي أي أغلق- على مسك.
قال القرطبي: وهذه السورة فضلها عظيم، وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها «1» .
مقاصدها: عند ما نفتح كتاب الله فنطالع فيه سورة البقرة بتدبر وعناية، نراها في مطلعها تنوه بشأن القرآن الكريم، وتصرح بأنه حق لا ريب فيه، وتبين لنا أن الناس أمام هدايته على ثلاثة أقسام:
قسم آمن به وانتفع بهداياته فكانت عاقبته السعادة والفلاح.
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقسم جحد واستكبر واستحب العمى على الهدى، فأصبح لا يرجى منه خير ولا إيمان، فكانت عاقبته الحرمان والخسران.
خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
ثم فصلت السورة الحديث عن قسم ثالث هو شر ما تبتلى به الأمم وهم المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. وقد تحدثت السورة عنهم في ثلاث عشرة آية، كشفت فيها عن خداعهم، وجبنهم، ومرض قلوبهم، وبينت ما أعده الله لهم من سوء المصير، ثم زادت في فضيحتهم وهتك سرائرهم فضربت مثلين لحيرتهم واضطرابهم، قال- تعالى-:
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ.
إلى أن يقول: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ثم وجهت السورة نداء إلى الناس جميعا دعتهم فيه إلى عبادة الله وحده وأقامت لهم الأدلة الساطعة على صدق هذه القضية، وتحدتهم- إن كانوا في ريب من القرآن- أن يأتوا بسورة من مثله. وبينت لهم أنهم لن يستطيعوا ذلك لا في الحاضر ولا في المستقبل.
ثم ختم الربع الأول منها ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جمعت لذائذ المادة والروح، وهم فيها خالدون. ثم قررت السورة الكريمة أن الله- تعالى- لا يمتنع عن ضرب الأمثال بما يوضح ويبين دون نظر إلى قيمة الممثل به في ذاته أو عند
الناس، كما قررت أن المؤمنين يقابلون هذه الأمثال بالإيمان والإذعان، أما الكافرون فيقابلونها بالاستهزاء والإنكار.
وقد وبخت السورة بعد ذلك أولئك الكافرين على كفرهم، مع وضوح الدلائل على وحدانية الله في أنفسهم وفي الآفاق فقالت:
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
ثم ذكرت السورة بعد ذلك جانبا من قصة آدم، وقد حدثتنا فيه عن خلافة آدم في الأرض، وعما كان من الملائكة من استفسار بشأنه- وعن سكن آدم وزوجه الجنة، ثم عن خروجهما منها بسبب أكلهما من الشجرة المحرمة.
وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالُوا: أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قالَ: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ.. إلخ الآيات الكريمة.
هذا، وقد عرفنا قبل ذلك أن سورة البقرة نزلت بالمدينة بعد أن هاجر المسلمون إليها، وأصبحت لهم بها دولة فتية، وكان يجاورهم فيها عدد كبير من اليهود الذين كان أحبارهم يبشرون. بمبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم. فأخذت السورة الكريمة تتحدث عنهم- في أكثر من مائة آية- حديثا طويلا متشعبا..
فنراها في أواخر الربع الثاني توجه إليهم نداء محببا إلى نفوسهم، تدعوهم فيه إلى الوفاء بعهودهم، وإلى الإيمان بنبي الله محمد صلّى الله عليه وسلّم فتقول:
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ، وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
ثم تذكرهم في الربع الثالث بنعم الله عليهم، وبموقفهم الجحودي من هذه النعم، تذكرهم بنعمة تفضيلهم على عالمي زمانهم، وبنعمة إنجائهم من عدوهم، وبنعمة فرق البحر بهم، وبنعمة عفو الله عنهم مع تكاثر ذنوبهم، وبنعمة بعثهم من بعد موتهم، وبنعمة تظليلهم بالغمام، وبنعمة إنزال المن والسلوى عليهم. إلخ.
ولقد كان موقف بني إسرائيل من هذه النعم يمثل الجحود والعناد والبطر، فكانت نتيجة ذلك أن.
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ.
ثم تحدثت السورة بعد ذلك حديثا مستفيضا عن رذائلهم وقبائحهم ودعواهم الباطلة، والعقوبات التي حلت بهم جزاء كفرهم وجحودهم.
فنراها في الربع الرابع تذكر لنا تنطعهم في الدين وإلحافهم في المسألة عند ما قال لهم نبيهم موسى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ثم تذكر قسوة قلوبهم فتقول على سبيل التوبيخ لهم:
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ، وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ. وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
ونراها في الربع الخامس تحدثنا عن تحريفهم للكلم عن مواضعه عن تعمد وإصرار، وتتوعدهم على ذلك بسوء المصير:
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
ثم تحدثنا عن قولهم الباطل: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
وترد عليهم بما يبطل حجتهم، وعن نقضهم لعهودهم ومواثيقهم مع الله ومع الناس ومع أنفسهم، وعن عدائهم لرسول الله، وعن جحودهم للحق بدافع الحسد والعناد فتقول:
وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً، أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ.
ثم نراها في الربع السادس تحكي لنا نماذج من مزاعمهم الباطلة، ومن ذلك زعمهم أن الجنة خالصة لهم من دون الناس، ثم ترد عليهم بما يخرس ألسنتهم، وبصور جبنهم وحرصهم المشين على أية حياة حتى لو كانت ملطخة بالذل والهوان.
استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى ذلك بأسلوبه البليغ فيقول:
قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ.
ثم تسوق لنا نماذج من سوء أدبهم مع الله، وعداوتهم لملائكته ونبذهم كتاب الله، واتباعهم للسحر والأوهام.
ثم نراها في الربع السابع تقص علينا بعض الصور من المجادلات الدينية، والمخاصمات الكلامية، التي استعملوها مع النبي صلّى الله عليه وسلّم لحرب الدعوة الاسلامية، كجدالهم في قضية النسخ، وفي كون الجنة لن يدخلها لا من كان هودا أو نصارى، وفي كون القرآن ليس معجزة- في زعمهم- وإنما هم يريدون معجزة كونية.. إلخ.
وقد رد القرآن عليهم بما يزهق باطلهم، ويزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم.
وكما ابتدأ القرآن الحديث معهم ابتداء محببا إلى نفوسهم يا بَنِي إِسْرائِيلَ، فقد اختتمه- أيضا- بالنداء نفسه، لكي يستحثهم على الإيمان فقال:
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً، وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ، وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ، وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ.
ثم أخذت السورة بعد ذلك في الربع الثامن منها تحدثنا عن الكلمات التي اختبر الله بها نبيه إبراهيم، وعن قصة بناء البيت الحرام، وعن تلك الدعوات الخاشعات التي كان إبراهيم وإسماعيل يتضرعان بها إلى خالقهما وهما يقومان بهذا العمل الجليل.
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَأَرِنا مَناسِكَنا، وَتُبْ عَلَيْنا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
ثم أخذت تقيم الحجج الباهرة، والأدلة الساطعة على أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وعلى أن يعقوب قد وصى ذريته من بعده أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا.
ثم ختمت تلك المحاورات والمجادلات التي أبطلت بها دعاوى أهل الكتاب الباطلة، ببيان سنة من سنن الله في خلقه، هذه السنة تتلخص في بيان أن كل إنسان سيجازى بحسب عمله يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن اتكال اليهود- أو غيرهم- على أنهم من نسل الأنبياء أو الصالحين دون أن يعملوا بعملهم لن ينفعهم شيئا. فقال- تعالى-:
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ، وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ.
ثم عادت السورة في الربع التاسع منها إلى الحديث عن الشبهات التي أثارها اليهود عند تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقد رد القرآن عليهم بما يدحض هذه الشبهات، ويهوى باليهود ومن حذا حذوهم في مكان سحيق، قال- تعالى-:
سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ إلى أن يقول: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد فصلت الحديث عن بني إسرائيل تفصيلا يحمل المسلمين على العظة والاعتبار، ويعرفهم طبيعة أولئك القوم الذين خسروا أنفسهم حتى يأخذوا حذرهم منهم، وينفروا من التشبه بهم.
أما المقدار الباقي من السورة الكريمة- وهو أكثر من نصفها بقليل- فعند ما نراجعه بتفكر وتدبر، نراه زاخرا بالتشريعات الحكيمة، والآداب العالية، والتوجيهات السامية.
نرى السورة الكريمة في هذا المقدار منها تحدثنا في الربع العاشر منها عن بعض شعائر الله التي تتعلق بالحج، وعن الأدلة على وحدانية الله.
إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ، وَما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
ثم بعد أن تصور لنا بأسلوب بليغ مؤثر حسرة المشركين يوم القيامة وهم يتبادلون التهم، ويتبرأ بعضهم من بعض، بعد كل ذلك توجه نداء عاما إلى الناس، تأمرهم فيه أن يقيدوا أنفسهم بما أحل الله.. وأن يبتعدوا عن محارمه فتقول:
يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.
فإذا ما وصلنا إلى الربع الحادي عشر منها، رأيناها تسوق لنا في مطلعه آية جامعة لألوان البر، وأمهات المسائل الاعتقادية والعملية وهي قوله- تعالى-:
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ. إلخ.
ثم أتبعت ذلك بالحديث عن القصاص، وعن الوصية، وعن الصيام وحكمته، وعن الدعاء وآدابه، ونهت المسلمين في ختامها عن مقارفة الحرام في شتى صوره وألوانه فقالت:
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
وفي مطلع الربع الثاني عشر حكت بعض الأسئلة التي كان المسلمون يوجهونها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأجابت عنها بطريقة حكيمة تدعوهم إلى التدبر والاتعاظ، ثم حضت المسلمين على الجهاد في سبيل الله، ونهتهم عن البغي والاعتداء. استمع إلى القرآن وهو يحرض المؤمنين على القتال ويرسم لهم حدوده وآدابه فيقول:
وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
ثم فصلت السورة الحديث عن الحج، فتحدثت عن جانب من آدابه وأحكامه، وحضت المسلمين على الإكثار من ذكر الله، وأن يتجنبوا التفاخر بالأحساب والأنساب، وأن يرددوا في دعائهم قوله- تعالى-:
رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ.
وفي الربع الثالث عشر نراها تبين لنا ألوان الناس في هذه الحياة، وأن منهم من يسعى في الإفساد وإهلاك الحرث والنسل، فإذا ما نصح أخذته العزة بالإثم، وتمادى في طغيانه وإفساده، وأن منهم من يبيع نفسه عن طواعية واختيار ابتغاء مرضاة الله.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ.
ثم تبين لنا بأن الناس جميعا كانوا أمة واحدة، وأن هذه الحياة مليئة بالمصائب والمحن والفتن، وأن العاقل هو الذي يقابل كل ذلك بإيمان عميق، وصبر جميل، حتى يفوز برضى الله يوم القيامة، ويظفر بنصره في الحياة الدنيا.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: مَتى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.
ثم تحدثنا السورة الكريمة في الربعين الرابع عشر والخامس عشر حديثا جامعا عن النكاح ثم حذرت السورة بعد ذلك المؤمنين من التعامل بالربا، ووصفت آكليه بصفات تنفر منها القلوب، وتعافها النفوس، ووجهت إلى المؤمنين نداء أمرتهم فيه بتقوى الله، وأنذرتهم بحرب من الله لهم إن لم يتوبوا عن التعامل بالربا فقالت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.
ثم تحدثت بعد ذلك عن الديون والرهون، فصاغت للمؤمنين دستورا هو أدق الدساتير المدنية في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل، ثم ختمت السورة حديثها الجامع عن العقائد والشرائع والآداب والمعاملات، بذلك الدعاء الخاشع:
رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا، أَنْتَ مَوْلانا، فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ.
تلك هي سورة البقرة، أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف ينادى كل عضو فيها بأنه قد أخذ مكانه المقسوم وفقا لخط جامع مرسوم، رسمه مربي النفوس ومزكيها، ومنور العقول وهاديها ومرشد الأرواح وحاديها. فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزولها، لكان جمع أشتاتها على هذه الصورة معجزة، فكيف وكل نجم منها كان يوضع في رتبته من فور نزوله، وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارا لحلوله. وهكذا كان ما ينزل منها معروف الرتبة، محدد الموقع قبل أن ينزل.
لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات، وفي أساليب ترتيبه معجزات، وفي نبوءاته الصادقة معجزات، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات لعمري إنه في ترتيب آياته على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات .
وبعد: فهذا عرض سريع لأهم مقاصد سورة البقرة، قدمناه بين يديها لنعطي القارئ الكريم صورة متميزة عنها. ومن هذا العرض نرى أنها بجانب احتوائها على أصول العقائد، وعلى كثير من أدلة التوحيد، قد وجهت عنايتها إلى أمرين اقتضتهما حالة المسلمين، بعد أن أصبحت لهم دولة بالمدينة يجاورهم فيها عدد كبير من اليهود.
أما الأمر الأول فهو توجيه الدعوة إلى بني إسرائيل، ومناقشتهم فيما كانوا يثيرونه حول الرسالة الإسلامية من مؤامرات. وإماطة اللثام عن تاريخهم المظلم، وأخلاقهم المرذولة حتى يحذرهم المسلمون.
وأما الأمر الثاني فهو التشريع للدولة الإسلامية الفتية، وقد رأينا أن سورة البقرة في النصف الثاني منها قد تحدثت عن تلك الجوانب التشريعية حديثا مفصلا منوعا تناول أحكام القصاص، والوصية، والصيام والاعتكاف والحج، والعمرة، والقتال، والنكاح، والإنفاق في سبيل الله.
والمعاملات المالية. إلى غير ذلك من التشريعات التي سبق الحديث عنها. والآن فلنبدأ في تفسير السورة الكريمة فنقول- وبالله التوفيق-.
سورة البقرة من السور التي ابتدئت ببعض حروف التهجي .
وقد وردت هذه الفواتح تارة مفردة بحرف واحد ، وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة .
فالسور التي بدأت بحرف واحد ثلاثة وهي سورة ص ، ق ، ن .
والسورة التي بدأت بحرفين تسعة وهي : طه ، يس ، طس ، ( وحم ) في ست سور هي : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الجاثية ، الأحقاف .
والسورة التي بدأت بثلاثه أحرف ثلاث عشرة سورة وهي : ( ألم ) في ست سور : البقرة ، وآل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة و ( الر ) في خمس سور هي : يونس ، هود ، يوسف ، الحجر ، إبراهيم ( طسم ) في سورتين هما : الشعراء ، القصص .
وهناك سورتان بدئتا بأربعة أحرف وهما . الرعد ، ( المر ) ، والأعراف ، ( المص ) وسورتان - أيضاً - بدئنا بخمسة أحرف وهما : مريم ( كهيعص ) والشورى ( حم عسق ) .
فيكون مجموع السور التي افتتحت بالحروف المقطعة تسعا وعشرين سورة .
هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء في المعنى المقصود بتلك الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجمال خلافهم في رأيين رئيسين :
الرأي الأول يرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .
وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - في إحدى رواياته - كما ذهب إليه الشعبي ، وسفيان الثوري ، وغيرهم من العلماء ، فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي أنه سئل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سراً ، وإن سر هذا القرآن في فواتح السور . ويروى عن ابن عباس أنه قال : عجزت العلماء عن إدراكها . وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : " إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي؟ . وفي رواية أخرى عن الشعبي أنه قال : " سر الله فلا تطلبوه " .
ومن الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الرأي ، أنه كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس ، لأنه من المتشابه ، فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثله كمثل المتكلم بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها .
وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين - ولكن الذي ننفيه أن يكون الناس جميعاً فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور .
وهناك مناقشات أخرى للعلماء حول هذا الرأي يضيق المجال عن ذكرها .
أما الرأي الثاني فيرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .
وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة ، من أهمها ما يأتي :
1- أن هذه الحروف أسماء للسور ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
" من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن يصبح " وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة ولا يخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيراً من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، والغرض من التسمية رفع الاشتباه .
2- وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .
3 - وقيل : إنها حروف مقطعة ، بعضها من أسماء الله - تعالى - وبعضها من صفاته ، فمثلاً ( الاما ) أصلها : أنا الله أعلم .
4 - وقيل : إنها اسم الله الأعظم . إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال ، والتي أوصلها السيوطي في " الإتقان " إلى أكثر من عشرين قولا .
5 - ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها ، ويقدرون على تأليف الكلام منها ، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله ، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة ، وفضلا عن ذلك فإن تصدير السور بمثل هذه الحروف المقطعة يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبر ، لأنه يطرق أسماعهم في أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة في مجاري كلامهم ، وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ، فيستمعوا حكما وحججاً قد يكون سبباً في هدايتهم واستجابتهم للحق .
هذه خلاصة لأراء العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ومن أراد مزيداً لذلك فليرجع - مثلاً - إلى كتاب " الإتقان " للسيوطي ، وإلى كتاب " البرهان " للزركشي ، وإلى تفسير الألوسي .
خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف ، وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة ، ومائتان وستة وثمانون آية في عدد الكوفي وعدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
ذكر ما ورد في فضلها :
قال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البقرة سنام القرآن وذروته ، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا ، واستخرجت : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ البقرة : 255 ] من تحت العرش ، فوصلت بها ، أو فوصلت بسورة البقرة ، و " يس " : قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ، واقرءوها على موتاكم ، انفرد به أحمد .
وقد رواه أحمد - أيضا - عن عارم ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوها على موتاكم يعني : يس .
فقد بينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى . وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .
وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير ، وفيه ضعف ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل شيء سنام ، وإن سنام القرآن البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي .
وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي ، من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثني ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سنان بن سعد ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه .
سنان بن سعد ، ويقال بالعكس ، وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره .
وقال أبو عبيد : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، يعني ابن مسعود ، قال : إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة . ورواه النسائي في اليوم والليلة ، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل ، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ، ويدع سورة البقرة يقرؤها ، فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة ، وإن أصفر البيوت ، الجوف الصفر من كتاب الله .
وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة ، عن محمد بن نصر ، عن أيوب بن سليمان ، به .
وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . وقال : إن لكل شيء سناما ، وإن سنام القرآن سورة البقرة ، وإن لكل شيء لبابا ، وإن لباب القرآن المفصل . وروى - أيضا - من طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة ، أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية : لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق .
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل شيء سناما ، وإن سنام القرآن البقرة ، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام .
رواه أبو القاسم الطبراني ، وأبو حاتم ، وابن حبان في صحيحه .
وقد روى الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن سعيد المقبري ، عن عطاء مولى أبي أحمد ، عن أبي هريرة ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذوو عدد ، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ، يعني ما معه من القرآن ، فأتى على رجل من أحدثهم سنا ، فقال : ما معك يا فلان ؟ قال : معي كذا وكذا وسورة البقرة ، فقال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم . قال : اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن واقرءوه ، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ، ومثل من تعلمه ، فيرقد وهو في جوفه ، كمثل جراب أوكي على مسك .
هذا لفظ رواية الترمذي ، ثم قال : هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث ، عن سعيد ، عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم .
قال البخاري : وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه مربوطة عنده ، إذ جالت الفرس ، فسكت ، فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت ، فسكنت ، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه يحيى قريبا منها . فأشفق أن تصيبه ، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ يا ابن حضير . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى ، وكان منها قريبا ، فرفعت رأسي وانصرفت إليه ، فرفعت رأسي إلى السماء ، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ، فخرجت حتى لا أراها ، قال : وتدري ما ذاك ؟ . قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم .
وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام ، في كتاب فضائل القرآن ، عن عبد الله بن صالح ، ويحيى بن بكير ، عن الليث به .
وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير ، كما تقدم ، والله أعلم .
وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - وذلك فيما رواه أبو عبيد [ القاسم ] : حدثنا عباد بن عباد ، عن جرير بن حازم ، عن جرير بن يزيد : أن أشياخ أهل المدينة حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن شماس ؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح ، قال : فلعله قرأ سورة البقرة . قال : فسئل ثابت ، فقال : قرأت سورة البقرة .
وهذا إسناد جيد ، إلا أن فيه إبهاما ، ثم هو مرسل ، والله أعلم .
[ ذكر ] ما ورد في فضلها مع آل عمران
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : تعلموا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة . قال : ثم سكت ساعة ، ثم قال : تعلموا سورة البقرة ، وآل عمران ، فإنهما الزهراوان ، يظلان صاحبهما يوم القيامة ، كأنهما غمامتان أو غيايتان ، أو فرقان من طير صواف ، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب ، فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر ، وأسهرت ليلك ، وإن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويكسى والداه حلتين ، لا يقوم لهما أهل الدنيا ، فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن ، ثم يقال : اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها ، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا .
وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه ، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم ، فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ، ووثقه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، إلا أن الإمام أحمد قال فيه : هو منكر الحديث ، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي .
قلت : ولكن لبعضه شواهد ؛ فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي ؛ قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اقرءوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة ، اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ، أو كأنهما غيايتان ، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما ثم قال : اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة .
وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد بن سلام ، عن جده أبي سلام ممطور الحبشي ، عن أبي أمامة صدي بن عجلان [ الباهلي ] ، به .
الزهراوان : المنيران ، والغياية : ما أظلك من فوقك . والفرق : القطعة من الشيء ، والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة السحرة ، ومعنى لا تستطيعها أي : لا يمكنهم حفظها ، وقيل : لا تستطيع النفوذ في قارئها ، والله أعلم .
ومن ذلك حديث النواس بن سمعان . قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مهاجر ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير ، قال : سمعت النواس بن سمعان الكلابي ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران . وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد ، قال : كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق ، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما .
ورواه مسلم ، عن إسحاق بن منصور ، عن يزيد بن عبد ربه ، به .
والترمذي ، من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، به . وقال : حسن غريب .
وقال أبو عبيد : حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال حماد : أحسبه عن أبي منيب ، عن عمه ؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران ، فلما قضى صلاته قال له كعب : أقرأت البقرة وآل عمران ؟ قال : نعم . قال : فوالذي نفسي بيده ، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال : فأخبرني به . قال : لا والله لا أخبرك ، ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت .
[ قال أبو عبيد ] : وحدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن سليم بن عامر : أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل ، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان : هل فيكم من يقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران ؟ قال : فإذا قال الرجل : نعم . دنتا منه بأعذاقهما ، حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل .
[ قال أبو عبيد ] وحدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي عمران : أنه سمع أم الدرداء تقول : إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له ، فقتله ، وإنه أقيد به ، فقتل ، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة ، حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ، ثم إن آل عمران انسلت منه ، وأقامت البقرة جمعة ، فقيل لها : ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) [ ق : 29 ] قال : فخرجت كأنها السحابة العظيمة .
قال أبو عبيد : أراه ، يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه ، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن .
وقال أيضا : حدثنا أبو مسهر الغساني ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث : أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم ، برئ من النفاق حتى يمسي ، ومن قرأهما من ليلة برئ من النفاق حتى يصبح ، قال : فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه .
[ قال أيضا : ] وحدثنا يزيد ، عن ورقاء بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان - أو كتب - من القانتين .
فيه انقطاع ، ولكن ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة .
[ ذكر ] ما ورد في فضل السبع الطول
قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي ، عن محمد بن شعيب ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أعطيت السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل .
هذا حديث غريب ، وسعيد بن بشير ، فيه لين .
وقد رواه أبو عبيد [ أيضا ] ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن سعيد بن أبي هلال ، قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . فذكره ، والله أعلم . ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن حبيب بن هند الأسلمي ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ السبع فهو حبر .
وهذا أيضا غريب ، وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي ، روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة ، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا ، فالله أعلم .
وقد رواه الإمام أحمد ، عن سليمان بن داود ، وحسين ، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر ، به .
ورواه - أيضا - عن أبي سعيد ، عن سليمان بن بلال ، عن حبيب بن هند ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر .
قال أحمد : وحدثنا حسين ، حدثنا ابن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال عبد الله بن أحمد : وهذا أرى فيه ، عن أبيه ، عن الأعرج ، ولكن كذا كان في الكتاب بلا " أبي " ، أغفله أبي ، أو كذا هو مرسل ، ثم قال أبو عبيد : حدثنا هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، في قوله تعالى : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) [ الحجر : 87 ] ، قال : هي السبع الطول : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس . قال : وقال مجاهد : هي السبع الطول . وهكذا قال مكحول ، وعطية بن قيس ، وأبو محمد الفارسي ، وشداد بن عبيد الله ، ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك ، وفي تعدادها ، وأن يونس هي السابعة .
[ فصل ]
والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف ، قال بعض العلماء : وهي مشتملة على ألف خبر ، وألف أمر ، وألف نهي .
وقال العادون : آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات ، وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة ، وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف ، فالله أعلم .
قال ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنزل بالمدينة سورة البقرة .
وقال خصيف : عن مجاهد ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : أنزل بالمدينة سورة البقرة .
وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، قال : نزلت البقرة بالمدينة .
وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء ، والمفسرين ، ولا خلاف فيه .
وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا الحسن بن علي بن الوليد [ الفارسي ] حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا عبيس بن ميمون ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا : سورة البقرة ، ولا سورة آل عمران ، ولا سورة النساء ، وكذا القرآن كله ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها آل عمران ، وكذا القرآن كله .
هذا حديث غريب لا يصح رفعه ، وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص ، وهو ضعيف الرواية ، لا يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين ، عن ابن مسعود : أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ، فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . أخرجاه .
وروى ابن مردويه ، من حديث شعبة ، عن عقيل بن طلحة ، عن عتبة بن فرقد قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا ، فقال : يا أصحاب سورة البقرة . وأظن هذا كان يوم حنين ، حين ولوا مدبرين ، أمر العباس فناداهم : يا أصحاب الشجرة ، يعني أهل بيعة الرضوان . وفي رواية : يا أصحاب البقرة ، لينشطهم بذلك ، فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة ، جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر بني حنيفة ، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة ، حتى فتح الله عليهم . رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .
( بسم الله الرحمن الرحيم . الم )
قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور ، فمنهم من قال : هي مما استأثر الله بعلمه ، فردوا علمها إلى الله ، ولم يفسروها [ حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - به ، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم ، واختاره أبو حاتم بن حبان ] .
ومنهم من فسرها ، واختلف هؤلاء في معناها ، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما هي أسماء السور [ قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : وعليه إطباق الأكثر ، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه ] ، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : " الم السجدة " ، وهل أتى على الإنسان .
وقال سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : أنه قال : " الم " ، و " حم " ، و " المص " ، و " ص " ، فواتح افتتح الله بها القرآن .
وكذا قال غيره : عن مجاهد . وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عنه ، أنه قال : " الم " ، اسم من أسماء القرآن .
وهكذا قال قتادة ، وزيد بن أسلم ، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد : أنه اسم من أسماء السور ، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن ، فإنه يبعد أن يكون " المص " اسما للقرآن كله ؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول : قرأت " المص " ، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف ، لا لمجموع القرآن . والله أعلم .
وقيل : هي اسم من أسماء الله تعالى . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى ، وكذلك قال سالم بن عبد الله ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، وقال شعبة عن السدي : بلغني أن ابن عباس قال : " الم " اسم من أسماء الله الأعظم . هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة .
ورواه ابن جرير عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن شعبة ، قال : سألت السدي عن " حم " و " طس " و " الم " ، فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم .
وقال ابن جرير : وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا شعبة ، عن إسماعيل السدي ، عن مرة الهمداني قال : قال عبد الله ، فذكر نحوه [ وحكي مثله عن علي وابن عباس ] .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به ، وهو من أسماء الله تعالى .
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة أنه قال : " الم " ، قسم .
ورويا - أيضا - من حديث شريك بن عبد الله ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس : " الم " ، قال : أنا الله أعلم .
وكذا قال سعيد بن جبير ، وقال السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود . وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " الم " . قال : أما " الم " فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى .
وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ( الم ) قال : هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه ، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه ، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم . قال عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، وعجب ، فقال : وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه ، فكيف يكفرون به ؛ فالألف مفتاح اسم الله ، واللام مفتاح اسمه " لطيف " والميم مفتاح اسمه " مجيد " فالألف آلاء الله ، واللام لطف الله ، والميم مجد الله ، والألف سنة ، واللام ثلاثون سنة ، والميم أربعون [ سنة ] . هذا لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير ، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها ، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر ، وأن الجمع ممكن ، فهي أسماء السور ، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور ، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته ، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه . قال : ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله ، وعلى صفة من صفاته ، وعلى مدة وغير ذلك ، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية ؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة ، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين ، كقوله تعالى : (إنا وجدنا آباءنا على أمة ) [ الزخرف : 22 ، 23 ] . وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله ، كقوله : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) [ النحل : 120 ] وتطلق ويراد بها الجماعة ، كقوله : ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) [ القصص : 23 ] ، وقوله : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) [ النحل : 36 ] وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله : ( وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ) [ يوسف : 45 ] أي : بعد حين على أصح القولين ، قال : فكذلك هذا .
هذا حاصل كلامه موجها ، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية ، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا ، وعلى هذا ، وعلى هذا معا ، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح ، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام ، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ، ليس هذا موضع البحث فيها ، والله أعلم ؛ ثم إن لفظ الأمة تدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع ، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره ، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف ، والمسألة مختلف فيها ، وليس فيها إجماع حتى يحكم به .
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة ، فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا ، كما قال الشاعر :
قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف
تعني : وقفت . وقال الآخر :
ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا
قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذا وكذا ، فاكتفى بالياء من يفعل ، وقال الآخر :
بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تا
يقول : وإن شرا فشر ، ولا أريد الشر إلا أن تشاء ، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام ، والله أعلم .
[ قال القرطبي : وفي الحديث : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث . قال شقيق : هو أن يقول في اقتل : إق ] .
وقال خصيف ، عن مجاهد ، أنه قال : فواتح السور كلها " ق " و " ص " و " حم " و " طسم " و " الر " وغير ذلك هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هي حروف من حروف المعجم ، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها ، التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا ، كما يقول القائل : ابني يكتب في : ا ب ت ث ، أي : في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها . حكاه ابن جرير .
قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا ، وهي : ا ل م ص ر ك ي ع ط س ح ق ن ، يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر . وهي نصف الحروف عددا ، والمذكور منها أشرف من المتروك ، وبيان ذلك من صناعة التصريف .
[ قال الزمخشري : وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ، ومن الرخوة والشديدة ، ومن المطبقة والمفتوحة ، ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته ، وهذه الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منها ، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله ] .
ومن هاهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما ، فقال : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ؛ ومن قال من الجهلة : إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية ، فقد أخطأ خطأ كبيرا ، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر ، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به ، وإلا وقفنا حيث وقفنا ، وقلنا : ( آمنا به كل من عند ربنا ) [ آل عمران : 7 ] .
ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين ، وإنما اختلفوا ، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه ، وإلا فالوقف حتى يتبين . هذا مقام .
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ، ما هي ؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها . فقال بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور . حكاه ابن جرير ، وهذا ضعيف ؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه ، وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة .
وقال آخرون : بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين - إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه . حكاه ابن جرير - أيضا - ، وهو ضعيف أيضا ؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها ، بل غالبها ليس كذلك ، ولو كان كذلك - أيضا - لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم ، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين ، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه .
وقال آخرون : بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه [ تركب ] من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها .
ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته ، وهذا معلوم بالاستقراء ، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ، ولهذا يقول تعالى : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) [ البقرة : 1 ، 2 ] . ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) [ آل عمران : 1 - 3 ] . المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) [ الأعراف : 1 ، 2 ] . الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ) [ إبراهيم : 1 ] ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) [ السجدة : 1 ، 2 ] . ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) [ فصلت : 1 ، 2 ] . ( حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) [ الشورى : 1 - 3 ] ، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر ، والله أعلم .
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد ، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم ، فقد ادعى ما ليس له ، وطار في غير مطاره ، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، صاحب المغازي ، حدثني الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن جابر بن عبد الله بن رئاب ، قال : مر أبو ياسر بن أخطب ، في رجال من يهود ، برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتلو فاتحة سورة البقرة : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) [ هدى للمتقين ) [ البقرة : 1 ، 2 ] فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود ، فقال : تعلمون - والله - لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) فقال : أنت سمعته ؟ قال : نعم . قال : فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالوا : يا محمد ، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : ( الم ذلك الكتاب لا [ ريب ] ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلى . فقالوا : جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ فقال : نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب ، وأقبل على من كان معه ، فقال لهم : الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، فهذه إحدى وسبعون سنة ، أفتدخلون في دين نبي ، إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، هل مع هذا غيره ؟ فقال : نعم ، قال : ما ذاك ؟ قال : " المص " ، قال : هذا أثقل وأطول ، الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والصاد سبعون ، فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة . هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم قال : ما ذاك ؟ قال : " الر " . قال : هذا أثقل وأطول ، الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والراء مائتان . فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم ، قال : ماذا ؟ قال : " المر " . قال : فهذه أثقل وأطول ، الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والراء مائتان ، فهذه إحدى وسبعون ومائتان ، ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد ، حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا . ثم قال : قوموا عنه . ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ، ولمن معه من الأحبار : ما يدريكم ؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان ، فذلك سبعمائة وأربع سنين . فقالوا : لقد تشابه علينا أمره ، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [ آل عمران : 7 ] .
فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي ، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها ، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة ، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] سورة البقرة سنام القرآن، ومقصدها: إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله؛ فلنتدبرها.
وقفة
[1] ﴿الم﴾ هذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله.
وقفة
[1] ﴿الم﴾ بعض الحروف المقطعة عُدَّت آية، وبعضها ما عُدَّ آية.
عمل
[1] ﴿الم﴾ في أول سورة البقرة ننطقها بأسماء الحروف: ألف، لام، ميم، بينما ننطقها بمسميات الحروف في سور أخرى، مع أن الكتابة واحدة في الاثنين، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ ...﴾ [الشرح: 1]، ﴿أَلَمْ تَرَ ...﴾ [الفيل: 1]، وهذا دليل على أن رسول الله r سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام إليه هكذا، إذن فالقرآن أصله السماع، فقبل أن تقرأه استمع إلى متقن.
وقفة
[1] ﴿الم﴾ كل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل، ما عدا فواتح السور المكونة من حروف؛ فهي مبنية على الوقف، فلا تقرأ في أول سورة البقرة: (الم) والميم عليها ضمة، بل تقرأ ألف ساكنة ولام ساكنة وميم ساكنة، كل حرف منفرد بوقف، مع أن الوقف لا يوجد في ختام السور، ولا في القرآن الكريم كله.
الإعراب :
- ﴿ الم: ﴾
- هذه الأحرف من الأسرار المحجوبة أو هي إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام وأثير حولها جدل بين العلماء ... فمنهم من يراها أسماء لله تعالى أو أيمان لله عزّ وجلّ .. وذهب الاكثرون إلى أنهّا أسماء لسور القرآن الكريم. أماّ موضع إعرابها ففيه عدّة أوجه .. إن جعلت اسما للسورة فتكون «الم» مبتدأ و «ذلِكَ» مبتدأ ثانيا و «الْكِتابُ» خبره .. والجملة الاسمية: خبر المبتدأ الأول والعائد فيها هو اسم الإشارة القائم مقام الضمير ومعناه: انّ ذلك هو الكتاب. أدخل ضمير الفصل «هو» بين المبتدأ والخبر. وثمة وجه آخر هو كون «الم» خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألم ويكون «ذلِكَ» خبرا ثانيا أو بدلا على أنّ «الْكِتابُ» صفة أو تكون «الم» مجرورة على القسم وحرف القسم محذوف وبقي عمله بعد الحذف لأنه مراد فهو كالملفوظ به. كما يقال: الله لأفعلن. ويجوز أن تكون «الم» مفعولا به لفعل محذوف تقديره: أتل «الم». '
المتشابهات :
| البقرة: 1 | ﴿ الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ |
|---|
| آل عمران: 1 | ﴿ الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ |
|---|
| العنكبوت: 1 | ﴿ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ |
|---|
| الروم: 1 | ﴿ الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ |
|---|
| لقمان: 1 | ﴿ الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ |
|---|
| السجدة: 1 | ﴿ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- -قال الواحدي : قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والخوف والحر والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى فكان كما قال الله تعالى: {وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر} . قلت: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وأخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي قال:أصابهم هذا يوم الأحزاب حين قال قائلهم: {مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا} .٢- قال الواحدي: وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضرر عليهم فإنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضى الله ورسوله وأظهرت لهم اليهود العداوة وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّة} الآية.'
- المصدر المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:
﴿ الم ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ .. ﴾
التفسير :
وقوله{ ذَلِكَ الْكِتَابُ} أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة, المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم, والحق المبين. فـ{ لَا رَيْبَ فِيهِ} ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه, يستلزم ضده, إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة, أن النفي المقصود به المدح, لا بد أن يكون متضمنا لضدة, وهو الكمال, لأن النفي عدم, والعدم المحض, لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال:{ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} والهدى:ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال{ هُدًى} وحذف المعمول, فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية, ولا للشيء الفلاني, لإرادة العموم, وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية, ومبين للحق من الباطل, والصحيح من الضعيف, ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم, في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر:{ هُدًى لِلنَّاسِ} فعمم. وفي هذا الموضع وغيره{ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق.فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا. ولم يقبلوا هدى الله, فقامت عليهم به الحجة, ولم ينتفعوا به لشقائهم، وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر, لحصول الهداية, وهو التقوى التي حقيقتها:اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه, بامتثال أوامره, واجتناب النواهي, فاهتدوا به, وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية, والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان:هداية البيان, وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان, وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها, ليست هداية حقيقية [تامة].
ثم قال - تعالى - : ( ذَلِكَ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) .
( ذَلِكَ ) اسم إشارة واللام للبعد حقيقة في الحس ، مجازاً في الرتبة ، والكاف للخطاب ، والمشار إليه - على الراجح - الكتاب الموعود به صلى الله عليه وسلم في قوله - تعالى - ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أخبرني عن تأليف ( ذَلِكَ الكتاب ) مع ( الم ) قلت : إن جعلت ( الم ) اسماً للسورة ففي التأليف وجوه . أن يكون ( الم ) مبتدأ و ( ذَلِكَ ) مبتدأ ثانياً ، و ( الكتاب ) خبره . والجملة خبر المبتدأ الأول .
ومعناه أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل ، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص ، وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً ، كما تقول : هو الرجل ، أي : الكامل في الرجولية ، الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال .
وإن جعلت ( الم ) بمنزلة الصوت ، كان " ذلك " مبتدأ خبره " الكتاب " ، أي : ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل .
. . اه ملخصاً .
وقيل : المشار إليه ( الم ) على أنه اسم للسورة والمراد المسمى .
و ( الكتاب ) مصدر كتب كالكتب ، وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة ، واستعمل عرفا في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط ، وأريد به هنا المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه التي يتألف منها في الخط ، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه .
و ( الريب ) في الأصل مصدر رابه الأمر إذا حصل عنده فيه ريبة ، وحقيقة الريبة ، قلق النفس واضطرابها ، ثم استعمل في معنى الشك مطلقاً . وقال ابن الأثير : الريب هو الشك مع التهمة .
و ( هدى ) . مصدر هداه هدى وهداية وهدية - بكسرها - فهدى ، ومعناه الدلالة الموصلة إلى البغية ، وضده الضلال .
و ( المتقون ) جمع متق ، اسم فاعل من اتقى وأصله أوتقى - بوزن افتعل - من وقى الشيء وقاية ، أي : صانه وحفظه مما يضره ويؤذيه .
والمعنى : ذلك الكتاب الكامل ، وهو القرآن الكريم ، ليس محلا لأن يرتاب عاقل أو منصف في أنه منزل من عند الله ، وأنه هداية وإرشاد للمتقين الذين يجتنبون كل مكروه من قول أو فعل حتى يصونوا أنفسهم عما يضرها ويؤذيها .
وكانت الإشارة بصيغة البعيد ، لأنه سامي المنزلة أينما توجهت إليه ، فإن نظرت إليه ناحية تراكيبه فهو معجز للبلغاء ، وإن نظرت إليه من ناحية معانية فهو فوق مدارك الحكماء ، وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه فهو أصدق محدث عن الماضين ، وأدق محدد لتاريخ السابقين ، فلا جرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن ، وقد شاع في كلام البلغاء تمثل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال ، لأن الشيء النفيس عزيز على أهله ، فمن العادة أن يجعلوه في مكان مرتفع بعيد عن الأيدي .
وصحت الإشارة إلى الكتاب وهو لم ينزل كله بعد ، لأن الإشارة إلى بعضه كالإشارة إلى الكل حيث كان بصدد الإنزال ، فهو حاضر في الأذهان ، فشبه بالحاضر في العيان .
ونفى عنه الريب على سبيل الاستغراق مع وقوع الريب فيه من المشركين حيث وصفوه بأنه أساطير الأولين ، لأنه لروعة حكمته ، وسطوع حجته ، لا يرتاب ذو عقل متدبر في كونه وحياً سماوياً ، ومصدر هداية وإصلاح .
فالجملة الكريمة تنفي الريب في القرآن عمن شأنهم أن يتدبروه ، ويقبلوا على النظر فيه بروية ، ومن ارتاب في القرآن فلأنه لم يقبل عليه بأذن واعية ، أو بصيرة نافذة ، أو قلب سليم .
وقدم جملة ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) على جملة ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) لأنه أراد أن ينفي عن ساحة كونه كتاباً هادياً غبار الريب ، وغيوم الشكوك ، حتى يستقر في النفوس وصفه ، وتطمئن القلوب لآثاره ومقاصده وهداياته .
وفصل جملة ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) عما قبلها لكمال الاتصال ، حيث كانت جملة ( ذَلِكَ الكتاب ) مفيدة لكماله ، وجملة ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) مفيدة لنفي الريب عنه .
والمراد بكونه ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) مع أنه هداية لهم ولغيرهم ، لأنهم هم المنتفعون به دون سواهم .
قال تعالى : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ والذين لاَ يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ) ومعنى كونه هدى لهم أنه يزيدهم هدى على ما لديهم من الهدى كما قال - تعالى - :
( والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ ) ويصح أن يكون المعنى : هدى للناس الذين صاروا متقين بهذه الهداية ، كما أقول : هديت مهتديا ، أو كتبت مكتوبا ، على معنى أني هديت شخصاً صار مهدياً بهذه الهداية ، وكتبت خطاباً صار مكتوباً بهذه الكتابة ، وهو أسلوب عربي صحيح . كما ورد في حديث " من قتل قتيلا فله سلبه " .
قال صاحب الكشاف : ومحل ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) الرفع ، لأنه خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر مع ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) ل " ذلك " . . . والذي هو أرسخ عرقاً في البلاعة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً ، وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة برأسها .
و ( ذَلِكَ الكتاب ) جملة ثانية . و ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) ثالثة . ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) رابعة . وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم ، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير نسق ، وذلك لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض . فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها ، وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة : بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به ، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال . فكان تقريراً لجهة التحدي ، وشدا من أعضاده ثم نفى عنه أن يتشبث به من طرف الريب ، فكان شهادة وتسجيلا بكماله . لأنه لا كمال أكمل من الحق واليقين . ولا نقص أنقص ما للباطل والشبه .
وقيل لبعض العلماء : فيم لذتك؟ فقال : في حجة تتبختر اتضاحاً ، وفي شبهة تتضاءل افتضاحاً . ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين ، فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله ، وحقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لم تخل كل واحدة من الأربع - بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق - من نكتة ذات جزالة . ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه . وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة ، وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف ، وفي الرابعة الحذف .
( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)
قال ابن جريج : قال ابن عباس : ذلك الكتاب : هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والسدي ومقاتل بن حيان ، وزيد بن أسلم ، وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذا ، والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر ، وهذا معروف في كلامهم .
و ( الكتاب ) القرآن . ومن قال : إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل ، كما حكاه ابن جرير وغيره ، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع ، وتكلف ما لا علم له به .
والريب : الشك ، قال السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ريب فيه ) لا شك فيه .
وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم في هذا خلافا .
[ وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل :
بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب
واستعمل - أيضا - في الحاجة كما قال بعضهم :
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا
]
ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب - وهو القرآن - لا شك فيه أنه نزل من عند الله ، كما قال تعالى في السجدة : ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) [ السجدة : 1 ، 2 ] . [ وقال بعضهم : هذا خبر ومعناه النهي ، أي : لا ترتابوا فيه ] .
ومن القراء من يقف على قوله : ( لا ريب ) ويبتدئ بقوله : ( فيه هدى للمتقين ) والوقف على قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) أولى للآية التي ذكرنا ، ولأنه يصير قوله : ( هدى ) صفة للقرآن ، وذلك أبلغ من كون : ( فيه هدى ) .
و ( هدى ) يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ، ومنصوبا على الحال .
وخصت الهداية للمتقين . كما قال : ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) [ فصلت : 44 ] . وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) [ الإسراء : 82 ] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن ؛ لأنه هو في نفسه هدى ، ولكن لا يناله إلا الأبرار ، كما قال : ( ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) [ يونس : 57 ] .
وقد قال السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هدى للمتقين ) يعني : نورا للمتقين .
وقال الشعبي : هدى من الضلالة . وقال سعيد بن جبير : تبيان للمتقين . وكل ذلك صحيح .
وقال السدي : عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هدى للمتقين ) قال : هم المؤمنون .
وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( للمتقين ) أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به .
وقال أبو روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : ( للمتقين ) قال : المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ، ويعملون بطاعتي .
وقال سفيان الثوري ، عن رجل ، عن الحسن البصري ، قوله : ( للمتقين ) قال : اتقوا ما حرم الله عليهم ، وأدوا ما افترض عليهم .
وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتقين ، قال : فأجبته . فقال [ لي ] سل عنها الكلبي ، فسألته فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمش ، فقال : نرى أنه كذلك . ولم ينكره .
وقال قتادة ( للمتقين ) هم الذين نعتهم الله بقوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) الآية والتي بعدها [ البقرة : 3 ، 4 ] .
واختار ابن جرير : أن الآية تعم ذلك كله ، وهو كما قال .
وقد روى الترمذي وابن ماجه ، من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ربيعة بن يزيد ، وعطية بن قيس ، عن عطية السعدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس . ثم قال الترمذي : حسن غريب .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن عمران ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، يعني الرازي ، عن المغيرة بن مسلم ، عن ميمون أبي حمزة ، قال : كنت جالسا عند أبي وائل ، فدخل علينا رجل ، يقال له : أبو عفيف ، من أصحاب معاذ ، فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف ، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال : بلى سمعته يقول : يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد ، فينادي مناد : أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر . قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان ، وأخلصوا لله العبادة ، فيمرون إلى الجنة .
وأصل التقوى : التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية . قال النابغة :
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
وقال الآخر :
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم
وقد قيل : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، سأل أبي بن كعب عن التقوى ، فقال له : أما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال : بلى قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت ، قال : فذلك التقوى .
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال :
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى
وأنشد أبو الدرداء يوما :
يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة ، إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله .
القول في تأويل قوله جَل ثناؤه: ذَلِكَ الْكِتَابُ .
قال عامّة المفسرين: تأويل قول الله تعالى ( ذلك الكتاب ) : هذا الكتاب.
* ذكر من قال ذلك:
247- حدثني هارون بن إدريس الأصم الكوفيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن ابن جُريج, عن مجاهد: " ذلك الكتاب " قال: هو هذا الكتاب.
248- حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن عُلَية, قال: أخبرنا خالد الحذّاء, عن عكرمة, قال: " ذلك الكتاب ": هذا الكتاب.
249- حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا الحَكَم بن ظُهَير, عن السُّدِّي، في قوله " ذلك الكتاب " قال: هذا الكتاب (34) .
250- حدثنا القاسم بن الحسن, قال: حدثنا الحسين بن داود. قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، قوله: " ذلك الكتاب ": هذا الكتاب. قال: قال ابن عباس: " ذلك الكتاب " : هذا الكتاب (35) .
فإن قال قائل: وكيف يجوزُ أن يكون " ذلك " بمعنى " هذا "؟ و " هذا " لا شكّ إشارة إلى حاضر مُعايَن, و " ذلك " إشارة إلى غائب غير حاضر ولا مُعايَن؟
قيل: جاز ذلك، لأن كل ما تَقضَّى، بقُرْبِ تَقضِّيه من الإخبار (36) ، فهو -وإن صار بمعنى غير الحاضر- فكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل يحدِّث الرجلَ الحديثَ فيقول السامع: " إن ذلك والله لكما قلت ", و " هذا والله كما قلت ", و " هو والله كما ذكرت "، فيخبرُ عنه مَرَّة بمعنى الغائب، إذْ كان قد تَقضَّى ومضى, ومرة بمعنى الحاضر، لقُرْب جوابه من كلام مخبره، كأنه غير مُنْقَضٍ. فكذلك " ذلك " في قوله (ذلك الكتاب) لأنه جلّ ذكره لما قدم قبلَ " ذلك الكتاب " الم ، التي ذكرنا تصرُّفَها في وجُوهها من المعاني على ما وصفنا، قال لنبيه صلى الله عليه و سلم: يا محمد، هذا الذي ذكرته وبيَّنته لك، الكتابُ. ولذلكَ حسن وضع " ذلك " في مكان " هذا ", لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمَّنهُ قوله الم من المعاني، بعد تقضّي الخبر عنه بـ " الم ", فصار لقرب الخبر عنه من تقضِّيه، كالحاضر المشار إليه, فأخبر به بـ " ذلك " لانقضائه، ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب، وترجمهُ المفسِّرون (37) : أنه بمعنى " هذا "، لقرب الخبر عنه من انقضائه, فكانَ كالمشاهَد المشار إليه بـ " هذا "، نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم, وكما قال جل ذكره: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيَارِ * هَذَا ذِكْرٌ [سورة ص: 48، 49] فهذا ما في " ذلك " إذا عنى بها " هذا ".
وقد يحتمل قوله جل ذكره (ذلك الكتاب) أن يكون معنيًّا به السُّوَرُ التي نـزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة, فكأنه قال جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اعلم أنّ ما تضمَّنتْه سُوّرُ الكتاب التي قد أنـزلتها إليك، هو الكتابُ الذي لا ريبَ فيه. ثم ترجمه المفسرون (38) بأن معنى " ذلك " " هذا الكتاب ", &; 1-227 &; إذْ كانت تلك السُّور التي نـزلت قبل سورة البقرة، من جملة جميع كتابنا هذا، الذي أنـزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم.
وكان التأويل الأول أولى بما قاله المفسرون، لأنّ ذلك أظهرُ معاني قولهم الذي قالوه في " ذلك ".
وقد وَجَّه معنى " ذلك " بعضُهم، إلى نظير معنى بيت خُفاف بن نُدبة السُّلميّ:
فَـإن تَـكُ خَـيْلي قـد أُصِيبَ صَمِيمُها
فَعَمْـدًا عـلى عَيْـنٍ تَيَمَّمْـتُ مَالِكَـا (39)
أقـولُ لـه, والـرُّمحُ يـأطِرُ مَتْنَـهُ:
تــأمَّل خُفاَفًــا, إننــي أنـا ذلِكَـا (40)
كأنه أراد: تأملني أنا ذلك. فزعم أنّ " ذلك الكتاب " بمعنى " هذا "، نظيرُه (41) . أظهر خفافٌ من اسمه على وجه الخبر عن الغائب، وهو مخبر عن نفسه. فكذلك أظهر " ذلك " بمعنى الخبر عن الغائب (42) ، والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهَد.
والقول الأول أولى بتأويل الكتاب، لما ذكرنا من العلل.
وقد قال بعضهم: (ذلك الكتاب)، يعني به التوراة والإنجيل, وإذا وُجّه &; 1-228 &; تأويل " ذلك " إلى هذا الوجه، فلا مؤونة فيه على متأوِّله كذلك، لأن " ذلك " يكون حينئذ إخبارًا عن غائب على صحة.
* * *
القول في تأويل قوله : لا رَيْبَ فِيهِ .
وتأويل قوله: " لا ريب فيه "" لا شك فيه ". كما:-
251- حدثني هارون بن إدريس الأصم, قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ابن جُريج, عن مجاهد: لا ريب فيه, قال: لا شك فيه.
252- حدثني سَلام بن سالم الخزاعي, قال: حدثنا خَلَف بن ياسين الكوفي, عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن عطاء، " لا ريب فيه ": قال: لا شك فيه (43) .
253- حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري, قال: حدثنا الحَكم بن ظُهَير, عن السُّدِّيّ, قال: " لا ريب فيه "، لا شك فيه.
254- حدثني موسى بن هارون الهَمْداني, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط, عن السُّدّي في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس -وعن مُرَّة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم: " لا ريب فيه "، لا شك فيه.
255- حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا سَلَمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير , &; 1-229 &; عن ابن عباس: " لا ريبَ فيه "، قال: لا شكّ فيه.
256- حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين, قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس: " لا ريب فيه "، يقول: لا شك فيه.
257- حدثنا الحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة: " لا ريب فيه "، يقول: لا شك فيه.
258- حُدِّثت عن عَمّار بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه، عن الربيع بن أنس: قوله " لا ريب فيه "، يقول: لا شك فيه (44) .
وهو مصدر من قول القائل: رابني الشيء يَريبني رَيبًا. ومن ذلك قول ساعدة بن جُؤَيَّة الهذليّ:
فقـالوا: تَرَكْنَـا الحَـيَّ قد حَصِرُوا به,
فـلا رَيْـبَ أنْ قـد كـان ثَـمَّ لَحِـيمُ (45)
ويروى: " حَصَرُوا " و " حَصِرُوا " والفتحُ أكثر, والكسر جائز. يعني بقوله " حصروا به ": أطافوا به. ويعني بقوله " لا ريب ". لا شك فيه. وبقوله " أن قد كان ثَمَّ لَحِيم "، يعني قتيلا يقال: قد لُحِم، إذا قُتل.
والهاء التي في " فيه " عائدة على الكتاب, كأنه قال: لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هُدًى للمتقين.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: هُدًى
259- حدثني أحمد بن حازم الغفاري, قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا &; 1-230 &; سفيان, عن بَيَان, عن الشعبي،" هُدًى " قال: هُدًى من الضلالة (46) .
260- حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط بن نصر, عن إسماعيل السُّدّي, في خبر ذكره عن أبي مالك, وعن أبي صالح , عن ابن عباس وعن مُرة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، " هدى للمتقين "، يقول: نور للمتقين (47) .
والهدى في هذا الموضع مصدرٌ من قولك: هديتُ فلانًا الطريق -إذا أرشدتَه إليه، ودللَته عليه, وبينتَه له- أهديه هُدًى وهداية.
فإن قال لنا قائل: أوَ ما كتابُ الله نورًا إلا للمتّقين، ولا رَشادًا إلا للمؤمنين؟ قيل: ذلك كما وصفه رّبنا عزّ وجل. ولو كان نورًا لغير المتقين, ورشادًا لغير المؤمنين، لم يخصُصِ الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدًى, بل كان يعُمّ به جميع المنذَرين. ولكنه هدًى للمتقين, وشفاءٌ لما في صدور المؤمنين, وَوَقْرٌ في آذان المكذبين, وعمىً لأبصار الجاحدين، وحجةٌ لله بالغةٌ على الكافرين. فالمؤمن به مُهتدٍ, والكافر به محجوجٌ (48) .
وقوله " هدى " يحتمل أوجهًا من المعاني:
أحدُها: أن يكون نصبًا، لمعنى القطع من الكتاب، لأنه نكرة والكتاب معرفة (49) . فيكون التأويل حينئذ: الم ذلك الكتاب هاديًا للمتقين. و ذَلِكَ مرفوع بـ الم , و الم به, والكتابُ نعت لـ ذَلِكَ .
وقد يحتمل أن يكون نصبًا، على القطع من رَاجع ذكر الكتاب الذي في فِيهِ , فيكونُ معنى ذلك حينئذ: الم الذي لا ريب فيه هاديًا.
وقد يحتمل أن يكون أيضًا نصبًا على هذين الوجهين, أعني على وجه القطع من الهاء التي في فِيهِ , ومن الْكِتَابُ ، على أن الم كلام تام, كما قال ابن عباس إنّ معناه: أنا الله أعلم. ثم يكون ذَلِكَ الْكِتَابُ خبرًا مستأنفًا, فيرفع حينئذ الْكِتَابُ بـ ذَلِكَ ، و ذَلِكَ بـ الْكِتَابُ , ويكون " هُدًى " قطعًا من الْكِتَابُ , وعلى أن يرفع ذَلِكَ بالهاء العائدة عليه التي في فِيهِ , و الْكِتَابُ نعتٌ له؛ والهدى قطع من الهاء التي في فِيهِ . وإن جُعِل الهدى في موضع رفع، لم يجز أن يكون ذَلِكَ الْكِتَابُ إلا خبرًا مستأنفًا، و الم كلاما تامًّا مكتفيًا بنفسه، إلا من وجه واحد، وهو أن يُرفع حينئذ " هُدًى " بمعنى المدح، كما قال الله جل وعز: الم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ [سورة لقمان: 1-3] في قراءة من قرأ " رحمةٌ". بالرفع، على المدح للآيات.
والرفع في " هدى " حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه: أحدُها ما ذكرنا من أنه مَدْحٌ مستأنفٌ. والآخر: على أن يُجعل مُرافعَ ذَلِكَ , و الْكِتَابُ نعتٌ " لذلك ". والثالث: أن يُجعل تابعًا لموضع لا رَيْبَ فِيهِ , ويكون ذَلِكَ الْكِتَابُ مرفوعًا بالعائد في فِيهِ . فيكون كما قال تعالى ذكره: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ [سورة الأنعام: 92].
وقد زعم بعض المتقدمِّين في العلم بالعربية من الكوفيين، أنّ الم مرافعُ ذَلِكَ الْكِتَابُ بمعنى: هذه الحروف من حروف المعجم, ذلك الكتابُ الذي وعدتُك أن أوحَيه إليك (50) . ثم نقض ذلك من قوله فأسرع نَقْضَه, وهَدمَ ما بنى فأسرع هَدْمَه, فزعم أن الرفع في " هُدًى " من وجهين، والنصبَ من وجهين. وأنّ أحد وَجهي الرفع: أن يكون الْكِتَابُ نعتًا لِـ ذَلِكَ و " الهدى " في موضع رفعٍ خبرٌ لِـ ذَلِكَ . كأنك قلت: ذلك هدًى لا شكّ فيه (51) . قال: وإن جعلتَ لا رَيْبَ فِيهِ خبرَه، رفعتَ أيضًا " هدى "، بجعله تابعًا لموضع لا رَيْبَ فِيهِ ، كما قال الله جل ثناؤه: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ، كأنه قال: وهذا كتابٌ هُدًى من صفته كذا وكذا. قال: وأما أحدُ وجهي النَّصْب فأن تَجعَل الكتاب خبرًا لـ ذَلِكَ ، وتنصبَ" هدى " على القطع، لأن " هدى " نكرة اتصلت بمعرفة، وقد تمّ خبرُها فنصبْتَها (52) لأن النكرة لا تكون دليلا على معرفة. وإن شئت نصبت " هدى " على القطع من الهاء التي في فِيهِ كأنك قلت: لا شك فيه هاديًا (53) .
قال أبو جعفر: فترك الأصل الذي أصَّله في الم وأنها مرفوعة بـ ذَلِكَ الْكِتَابُ ، ونبذه وراء ظهره. واللازم كان له على الأصل الذي أصَّله، أن لا يجيز الرَّفع في " هدى " بحالٍ إلا من وَجْه واحدٍ, وذلك من قِبَلِ الاستئناف، إذ كان مَدْحًا. فأما على وجه الخبر " لذلك ", أو على وجه الإتباع لموضع لا رَيْبَ فِيهِ , فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ. وذلك أن الم إذا رافعت ذَلِكَ الْكِتَابُ ، فلا شك أن " هدى " غيرُ جائز حينئذٍ أن يكون خبرًا " لذلك "، بمعنى المرافع له, أو تابعًا لموضع لا رَيْبَ فِيهِ , لأن موضعه حينئذ نصبٌ، لتمام الخبر قبلَه، وانقطاعه -بمخالفته إيّاه- عنه.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لِلْمُتَّقِينَ (2)
261- حدثنا سفيان بن وكيع, قال: حدثنا أبي، عن سفيان, عن رجل, عن الحسن، قوله: " للمتقين " قال: اتَّقَوْا ما حُرِّم عليهم، وأدَّوا ما افتُرِض عليهم.
262- حدثنا محمد بن حُميد, قال: حدثنا سَلَمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: " للمتقين "، أي الذين يحذَرُون من الله عز وجل عقوبتَه في تَرْك ما يعرفون من الهُدى, ويرجون رحمَته بالتَّصديق بما جاء به.
263- حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط, عن السُّدّي في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرّة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم: " هدًى للمتقين "، قال: هم المؤمنون.
264- حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش, قال: سألني الأعمش عن " المتقين ", قال: فأجبتُه, فقال لي: سئل عنها الكَلْبَيّ. فسألتُه، فقال: الذين يَجتنِبُون كبائِرَ الإثم. قال: فرجَعْت إلى الأعمش, فقال: نُرَى أنه كذلك. ولم ينكره.
265- حدثني المثنى بن إبراهيم الطبري, قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن عبد الله, قال حدثنا عمر أبو حفص, عن سعيد بن أبي عَرُوبة, عن قتادة: " هدى للمتقين "، هم مَنْ نعتَهم ووصفَهم فأثبت صفتهم، فقال: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .
266- حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قال: حدثنا بشر بن عُمَارة, عن أبي رَوق، عن الضحاك، عن ابن عباس: " للمتقين " قال: المؤمنين الذين يتَّقُون الشِّرك بي، ويعملون بطاعتي (54) .
وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه (هدى للمتقين)، تأويلُ من وصَف القومَ بأنهم الذين اتَّقوُا اللهَ تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه, فتجنبوا معاصِيَه، واتَّقوْه فيما أمرهم به من فرائضِه، فأطاعوه بأدائها. وذلك أنّ الله عزّ وجلّ وصَفهم بالتقوَى، فلم يحصُرْ تقواهم إياه على بعضِ ما هو أهلٌ له منهم دون بعض (55) . فليس لأحد من الناس أن يحصُر معنى ذلك، على وَصْفهم بشيء من تَقوى الله عز وجل دون شيء، إلا بحجة يجبُ التسليمُ لها. لأن ذلك من صفة القوم -لو كان محصورًا على خاصّ من معاني التقوى دون العامّ منها- لم يدعِ الله جل ثناؤه بيانَ ذلك لعباده: إما في كتابه, وإما على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم، إذْ لم يكن في العقل دليلٌ على استحالة وصفهم بعموم التقوى.
فقد تبيّن إذًا بذلك فسادُ قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو: الذين اتَّقَوُا الشرك وبرئوا من النِّفاق. لأنه قد يكون كذلك، وهو فاسقٌ غيرُ مستَحِق أن يكون من المتقين، إلا أن يكون -عند قائل هذا القول- معنى النفاق: ركوبُ الفواحش التي حَرَّمها الله جل ثناؤه، وتضييعُ فرائضه التي فرضها عليه. فإن جماعةً من أهل العلم قد كانت تسمِّي من كان يفعل ذلك منافقًا. فيكون -وإن كان مخالفًا في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم- مصيبًا تأويلَ قول الله عز وجل " للمتقين ".
-------------
الهوامش :
(34) الأثر 249- الحكم بن ظهير -بضم الظاء المعجمة- الفزاري ، أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي : ضعيف جدًا ، رمى بوضع الحديث . قال البخاري في الكبير 1/2/ 342 - 343 : "تركوه منكر الحديث" . وقال ابن أبي حاتم في الجرح 1/2/ 118 - 119 عن أبي زرعة : "واهي الحديث" . وقال ابن حبان في كتاب المجروحين ، رقم 239 : "كان يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات" .
(35) هذه الآثار جميعًا 247 - 250 ذكرها ابن كثير في تفسيره 1 : 70 ، والدر المنثور 1 : 24 ، والشوكاني 1 : 21 .
(36) في المطبوعة"وقرب تقضيه" . يريد : أن ذكر ما انقضى ، وانقضاؤه قريب من إخبارك عنه .
(37) ترجمه : أي فسره المفسرون وبينوه بوضع حرف مكان حرف . انظر ما مضى 70 تعليق 1/93 : 4/ ومواضع أخر .
(38) ترجمه : أي فسره المفسرون وبينوه بوضع حرف مكان حرف . انظر ما مضى 70 تعليق 1/93 : 4/ ومواضع أخر .
(39) الأغاني 2 : 329/ 13 : 134 ، 135/16 : 134 ، والخزانة 2 : 470 ، وغيرهما ، ويأتي في الطبري 1 : 314 ، 437 . يقول الشعر في مقتل ابن عمه معاوية بن عمرو أخى الخنساء . ومالك ، هو مالك بن حِمَار الشمخي الفزاري . والخيل هنا : هم فرسان الغارة ، وكان معاوية وخفاف غزوَا بني مرة وفزارة . والصميم : الخالص المحض من كل شيء . وأراد معاوية ومقتله يومئذ . ويقال : "فعلت هذا الأمر عمد عين ، وعمدًا على عين" ، إذا تعمدته مواجهة بجد ويقين . وتيمم : قصد وأمَّ .
(40) "أقول له" ، يعني لمالك بن حِمَار . وأطر الشيء يأطره أطرًا : هو أن تقبض على أحد طرفي الشيء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . وأراد أن حر الطعنة جعله يتثنى من ألمها ، ثم ينحني ليهوى صريعًا إذ أصاب الرمح مقتله . وأرى أن الإشارة في هذا البيت إلى معنى غائب ، كأنه قال : "أنا ذلك الذي سمعت به وببأسه" . وهذا المعنى يخرج البيت عن أن يكون شاهدًا على ما أراد الطبري .
(41) في المطبوعة : "كأنه أراد : تأملني أنا ذلك ، فرأى أن"ذلك الكتاب" بمعنى"هذا" نظير ما أظهر خفاف من اسمه . . . " ، وهو تغيير لا خبر فيه .
(42) في المطبوعة : "فلذلك أظهر ذلك . . " .
(43) الأثر 252 - سلام ، شيخ الطبري : لم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد 9 : 198 قال : "سلام بن سالم أبو مالك الخزاعي الضرير : حدث عن يزيد بن هارون ، وعمر بن سعيد التنوخي ، وموسى بن إبراهيم المروزي ، والفضل بن جبير الوراق . روى عنه الحسين بن إسماعيل المحاملي" . ليس غير . وأما شيخ سلام في هذا الإسناد"خلف بن ياسين الكوفي" : فلم أجد إلا ترجمة في الميزان 1 : 211 ولسان الميزان 2 : 405 لراو اسمه"خلف بن ياسين بن معاذ الزيات" ، وهو رجل سخيف كذاب ، لا يشتغل به . لا أدري أهو هذا أم غيره؟
(44) هذه الآثار جميعًا 251 - 258 ساقها ابن كثير 1 : 71 ، وبعضها في الدر المنثور 1 : 24 ، والشوكاني 1 : 22 . وقال ابن كثير بعد سياقتها : "قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في هذا خلافًا" .
(45) ديوان الهذليين 1 : 232 ، واللسان (حصر) .
(46) الأثر 59 - بيان ، بفتح الباء الموحدة والياء التحتية المخففة : هو ابن بشر الأحمسي ، ثقة من الثقات ، كما قال أحمد . وسفيان ، الراوي عنه : هو الثوري . وهذا الأثر نقله السيوطي 1 : 24 ، ونسبه لوكيع والطبري .
(47) الخبر 260 - نقله ابن كثير 1 : 71 ، ونقله السيوطي 1 : 24 ، والشوكاني 1 : 22 مع الخبر الآتي 263 ، جعلاه خبرًا واحدًا ، وذكراه عن ابن مسعود فقط .
(48) حجه يحجه فهو محجوج : غلبه بالحجة فهو مغلوب .
(49) يريد بقوله"لمعنى القطع" ، أن يقطع عن نعت الكتاب ، ويصير حالا .
(50) يعني بصاحب هذا القول ، الفراء في كتابه معاني القرآن 1 : 10 .
(51) في المطبوعة والمخطوطة"ذلك لا شك فيه" ، والتصحيح من معاني القرآن للفراء 1 : 11 .
(52) في المطبوعة"فتنصبها" ، والتصحيح من المخطوطة ومعاني القرآن للفراء .
(53) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 11 - 12 .
(54) الآثار 261 - 266 ساقها جميعًا ابن كثير في تفسيره 1 : 71 - 72 ، وبعضها في الدر المنثور 1 : 24 ، والشوكاني 1 : 22 .
(55) في المطبوعة : "وذلك أن الله عز وجل إنما وصفهم" ، ولا فائدة من زيادة"إنما" . ثم جاء في المخطوطة والمطبوعة : "فلم يحصر تقواهم إياه على بعضها من أهل منهم دون بعض"؛ وهو كلام مختلط ، وصوابه ما أثبته ، وهو معنى الكلام كما ترى بعد .
المعاني :
التدبر :
لمسة
[2] ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ دلالة استخدام اسم الإشارة للبعيد (ذَلِكَ) إشارة إلى علو مرتبته، وبُعْده عن الريب، وأنه بعيد المنال لا يستطيع أن يؤتى بمثله، وهذا نوع من تشريف الكتاب وتعظيمه، وقيل: إنه إشارة إلى الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، لأنه لما أراد ما بين أيدي الناس أشار إليه بالقريب: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: 9].
وقفة
[2] ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ مرة واحدة في البقرة، أشير له بالبعد (ذلك)؛ لما كان المقصود التحدي، فمحال أن يؤتى بمثله، وبعيد مناله، وثلاث مرات: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ﴾ [الأنعام: 92، 155، الأحقاف: 12]، أشير له بالقرب (هذا)؛ لمن أراد الهدى به والاتباع والبركة، فهو قريب منه.
وقفة
[2] كُلُّ كتابٍ في الدنيا فيه نقص وقصور قلّ أو كثر، فيبدأ قائلهُ باعتذارٍ عن أي سهوٍ أو خطأٍ إلا كتاب الله، فقد بدأ فيه بالتحدّي: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.
وقفة
[2] ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ لن تنال هدايات القرآن إلا بتقوى الله.
وقفة
[2] ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا في أحكامه، ولا في هدايته.
وقفة
[2] تبحث عن الهداية؟ محتار تائه بين الكتب والنظريات والأقوال؟ تعال هنا : ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾.
وقفة
[2] لما قال العبد بتوفيق ربه: (اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ)، قيل له: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ هو مطلوبك، وفيه أربك وحاجتك، وهو الصراط المستقيم: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ القائلين: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، والخائفين من حال: المغضوب عليهم والضالين.
وقفة
[2] ﴿لَا رَيْبَ﴾ الثقة المطلقة في نفي الرَّيب دليل على أنَّه من عند الله؛ إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه.
وقفة
[2] ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ كل شئ يأخذ قيمته من مصدره، فكتاب مصدره من الله لن تجد فيه عوجًا أو نقصًا أو ظلمًا.
وقفة
[2] ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ بقدرِ التقوى في قلبك تنزل الهدايةُ على قلبِك.
وقفة
[2] ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ إنما يهتدي من يقبل الاهتداء؛ وهم المتقون، لا كل أحد.
لمسة
[2] ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لم يقل: هدى للمصلحة الفلانية، ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع المصالح.
وقفة
[2] ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لا يهتدي بأنوار القرآن غير المتقين؛ لأن غير المتقين أطفئوا نور الطاعة في قلوبهم, وآثروا ظلمة الذنب, فكانوا كالعميان!
وقفة
[2] ﴿هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴾ ما أقل من اتقي؛ ولذا ما أقل المهتدين!
اسقاط
[2] ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ مبنى التقوى على مخالفة شرع الله لهوى نفسك اختبارًا لإيمانك، فحدد أمرًا في حياتك ترى أنك تقدِّم فيه هوى نفسك على شرع الله سبحانه، وتراجع عنه مستغفرًا ربك.
تفاعل
[2] ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ادعُ الله دومًا أن يجعلك منهم؛ كأن تقول مثلًا: «اللهم اجعلني من المتقين» كلما مررت بهذه الآية.
وقفة
[2] ﴿هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴾ الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ لاتقائهم بذلك النار.
وقفة
[2] ﴿هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴾ تنويهٌ بمنزلة التقوى، وأن المتصف بها هو المنتفع بالقرآن، المهتدي بأنواره، المطلع على دقائق أسراره.
وقفة
[2] إذا عُـمِّـر قلب العبد بالتقوى انتفع بالقرآن، قال تعالى: ﴿هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴾، وبهذه الآية يُعرف سر عدم انتفاع كثير من الناس بالقرآن.
وقفة
[2] لماذا قال تعالى عن كتابه: ﴿هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴾، وقد بين في آيات أخرى أنه هدى للناس أجمعين؟ الجواب: الهدى في قوله تعالى: ﴿هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴾ يرجع إلى هداية التوفيق والإنتفاع، وأما الهدى في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [185]؛ فيرجع إلى هداية البيان والدلالة، فالقرآن بيان وإرشاد ودلالة لجميع الناس، ولكن لم يهتد به وينتفع إلا المتقون، فالفرق راجع إلى تعدد أنواع الهداية والله أعلم.
الإعراب :
- ﴿ ذلِكَ الْكِتابُ: ﴾
- اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو يكون في محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف بتقدير هذا ذلك. اللام للبعد والكاف للخطاب. الكتاب صفة أو بدل من «ذلِكَ» مرفوع بالضمة.
- ﴿ لا رَيْبَ فِيهِ: ﴾
- أداة نافيه للجنس. ريب: اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب فيه: جار ومجرور متعلق بخبر «لا» المحذوف وجوبا في محل رفع. لأن «لا» النافية للجنس تعمل عمل «أن» ويجوز أن يعرب شبة الجملة «فِيهِ» خبرا مقدما و «هُدىً» مبتدأ مؤخرا والجملة في محل نصب حالا مؤكدا.
- ﴿ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ: ﴾
- خبر للمبتدأ «ذلِكَ» مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر. للمتقين جار ومجرور متعلق بهدى أو بصفة محذوفة من «هُدىً» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- ٢- قوله تعالى: {ذَلِكَ} . قال مقاتل بن سليمان: "لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد إلى الإسلام فقالا: ما أنزل الله تعالى من بعد موسى كتابا أنزل الله تعالى {الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ} يعني هذا الكتاب الذي جحدتم نزوله لا ريب فيه أنه أنزل من عند الله تعالى على محمد".وقال الطبري: يحتمل أن تكون الإشارة لما أنزل من قبل سورة البقرة وقيل: الإشارة إلى التوراة والإنجيل وحكى ابن ظفر في تفسيره المسمى "ينبوع الحياة" ما نصه: "قيل: ذكر في كتب الله السالفة أن علامة القرآن الموعود بإنزاله أن في أوائل سورة منه حروفا غير منظومة فنزل القرآن كما قيل لهم وأشار بقوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} إلى ما وعدهم" وقال أبو جعفر بن الزبير: يحتمل أنهم لما أمروا في الفاتحة أن يقولوا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم} فقالوا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم} فقيل لهم ذلك الصراط هو الكتاب لا ريب فيه.قوله تعالى: {الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِين} إلى {الْمُفْلِحُونَ} البقرة: - .أسند الواحدي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: "أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا نزلتا في الكافرين، وثلاث عشرة آية نزلت في المنافقين". قلت: وقال مقاتل بن سليمان: "نزلت الآية ان الأوليان في المؤمنين من المهاجرين والأنصار، والآية ان بعدها في من آمن من أهل الكتاب، منهم عبد الله بن سلام وأسيد بن زيد وأسيد بن كعب، وسلام بن قيس وثعلبة بن عمرو، وأبو يامين واسمه سلام أيضا".'
- المصدر المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كان المرادُ بـ (الم) أنَّ هذا الكتاب من جِنس حُروفكم التي قد فُقتُم في التكلُّم بها سائرَ الخلق، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بسورةٍ مِن مثلِه لأنَّه كلامُ الله؛ لذا قال الله تعالى هنا:
﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾
القراءات :
فيه:
قرئ:
فيهى، موصولا بياء، وهى قراءة ابن كثير.
للمتقين:
1- إذا كان موصولا بما بعده، على أن ما بعده (الذين يؤمنون) صفة، كان الوقف على «المتقين» حسنا غير تام.
2- وإذا كان مقتطعا عما بعده، مبتدأ خبره (أولئك على هدى) ، كان الوقف على المتقين وقفا تاما.
مدارسة الآية : [3] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ .. ﴾
التفسير :
ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة, والأعمال الظاهرة, لتضمن التقوى لذلك فقال:{ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} حقيقة الإيمان:هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل, المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس, فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. إنما الشأن في الإيمان بالغيب, الذي لم نره ولم نشاهده, وإنما نؤمن به, لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر, لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به, أو أخبر به رسوله, سواء شاهده, أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله, أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية, لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم, ومرجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب, [الإيمان بـ] بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة, وأحوال الآخرة, وحقائق أوصاف الله وكيفيتها, [وما أخبرت به الرسل من ذلك] فيؤمنون بصفات الله ووجودها, ويتيقنونها, وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال:{ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} لم يقل:يفعلون الصلاة, أو يأتون بالصلاة, لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة, إقامتها ظاهرا, بإتمام أركانها, وواجباتها, وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحها, وهو حضور القلب فيها, وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها:{ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته, إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال:{ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة, والنفقة على الزوجات والأقارب, والمماليك ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليهم, لكثرة أسبابه وتنوع أهله, ولأن النفقة من حيث هي, قربة إلى الله، وأتى بـ "من "الدالة على التبعيض, لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم, غير ضار لهم ولا مثقل, بل ينتفعون هم بإنفاقه, وينتفع به إخوانهم. وفي قوله:{ رَزَقْنَاهُمْ} إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم, ليست حاصلة بقوتكم وملككم, وإنما هي رزق الله الذي خولكم, وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده, فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم, وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن, لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود, وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه, فلا إخلاص ولا إحسان.
ثم فصل القرآن بعد ذلك أوصاف المتقين ، ومدحهم بجملة من المناقب الحميدة ، فقال : ( الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب ) أي : يصدقون بما غاب عن حواسهم ، كالصانع وصفاته ، وكاليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب .
والإيمان لغة التصديق والإذعان ، وهو إفعال من الأمن . وشرعاً التصديق بما علم بالضرورة أنه من الدين ، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .
. . الخ ، وعدى ( يُؤْمِنُونَ ) بالباء لتضمينه معنى أقر واعترف .
والغيب : مصدر غاب يغيب ، وكثيراً ما يستعمل بمعنى الغائب ، وهو الظاهر من هذه الآية الكريمة . ومعناه : ما لا تدركه الحواس ، ولا يعلم ببداهة العقل .
قال بعض العلماء : وخص بالذكر الإيمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان ، لأن الإيمان بالغيب هو الأصل في اعتقاد إمكان ما لا تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي ، فإذا آمن به المرء وتصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما يبلغه عن الله - تعالى - فسهل عليه إدراك الأدلة ، وأما من يعتقد أنه ليس من وراء عالم الماديات عالم آخر ، فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة ، كما هو حال الماديين الذين يقولون : " ما يهلكنا إلا الدهر :
والإيمان بالغيب : يستلزم التصديق به على وجه الجزم ، وهو لا يحصل إلا عن دليل .
ولا شك أن قيام البراهين على صدق من أخبر بالغيب يجعل المؤمن بهذا الغيب مصدقاً عن دليل ، فنحن لا نحتاج في الإيمان بالملائكة والكتب السماوية السابقة ، والرسل الذين أرسلوا من قبل ، والبعث وما فيه من ثواب وعقاب ، لا نحتاج في الإيمان بكل ذلك إلى دليل زائد على الأدلة التي قامت على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
والإيمان بالغيب دليل على اتساع العقول ، وسلامة القلوب ، إذ أن معنى الإيمان بالغيب هو أن عقولهم قد سلم إدراكها ، وتقشعت عنها غشاواتها ، وامتد نظرها في الكائنات فأدركت أن لها مبدعاً حكيماً وخالقاً قديراً ، جعلها تسير بنظام محكم ، فهذه كواكب تظهر وتغيب ، وسماء مرفوعة بغير عمد ، وأرض راسية لا تميد ولا تضطرب . . . ( صُنْعَ الله الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) فكان من ذلك لتلك العقول براهين قاطعة على وجود خالق مدبر ، وحكيم قدير ، ومبدع لا تأخذه سنة ولا نوم .
والإيمان بالغيب الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقوي ويعظم كلما قوي الإيمان في القلوب ، واستولى الصفاء على النفوس ، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالغيب في أحاديث متعددة ، منها ما جاء عن خالد بن دريك ، عن ابن محيريز قال : قلت لابن جمعة : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم أحدثك حديثاً . تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال : " يا رسول الله ، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك .
قال : نعم ، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني " .
قال ابن كثير : فقد مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً .
وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وأبو نعيم عن بديلة بنت أسلم قالت : صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة ، واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ، ثم جاء من يخبرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت ، فتحول الرجال مكان النساء ، والنساء مكان الرجال ، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
" أولئك قوم آمنوا بالغيب "
تلك أول صفة نتيجة التقوى وهي الإيمان بالغيب ، أما الصفة الثانية التي مدح الله بها المتقين فهي قوله - تعالى - :
( وَيُقِيمُونَ الصلاة ) .
الصلاة في اللغة الدعاء ، من صلى يصلي إذا دعا ، واستعملها الشارع في العبادة ذات الركوع والسجود لاشتمالها على الدعاء ، والإقامة في الأصل : الدوام والثبات ، من قولك : قام الحق أي : ظهر وثبت .
ومعنى ( وَيُقِيمُونَ الصلاة ) : يؤدونها في أوقاتها المقدرة لها ، مع تعديل أركانها ، وإيقاعها مستوفية لواجباتها وسننها وآدابها وخشوعها ، فإن الصلاة المقامة بحق هي تلك التي يصحبها الإخلاص ، واستحضار جلال الله في الركوع والسجود ، وهي التي تترتب عليها الآثار العظيمة من تزكية النفس ، وعفافها ، وتركها لكل الشرور والآثام ، كما قال - تعالى - ( إِنَّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشآء والمنكر ) وقدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة تعظيماً لعمل القلب ، واعتداداً بشرطية الإيمان في صحة أعمال الجوارح .
وقدم إقامة الصلاة على الإنفاق ، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولأنها تتكرر في اليوم خمس مرات ، ولأنها صلة بين العبد وربه ، والإنفاق صلته بالناس ، ولأن مشروعيتها كانت سابقة على مشروعية الزكاة .
أما الصفة الثالثة التي مدح الله بها المتقين فهي قوله - تعالى - :
( وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) .
أي : ومما أعطيناهم وملكناهم يتصدقون في وجوه الخير ، ويمدون أيديهم بالإحسان إلى الفقير والمسكين .
والرزق عند جمهور العلماء ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراماً ، خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن الحرام ليس برزق . والإنفاق : إخراج المال وإنفاده وصرفه ، يقال : نفق - كفرح ونصر - نفد وفني أو قلّ . وأنفق ماله أنفده ، وأصل المادة يدل على الخروج والذهاب ، ومنه : نافق فلان ، والنافقاء ، والنفق . وقال " ينفقون " ولم يقل أنفقوا ، ليشعر بأن الإنفاق منهم يتجدد بين وقت وآخر . ولم يحدد وجوه الإنفاق بل تركها مطلقة لتشمل الفرض والواجب وغيرهما من وجوه الإحسان .
وإيراد " من " في قوله تعالى - ( وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ ) للإشارة إلى أن مواظبتهم على إنفاق أموالهم بين الحين والحين ، كفيل بتوصيلهم إلى زمرة المهتدين المفلحين ، وللإشعار بأنهم ينفقون بعض أموالهم مبتعدين عن الإسراف والتبذير حتى لا يتركوا ورثتهم عالة يتكففون وجوه الناس .
هذا ، وقد عنى القرآن الكريم عناية فائقة بالحض على الإنفاق في وجوه الخير ، ومدح الذين يفعلون ذلك مدحاً عظيماً في عشرات الآيات ، وذلك لأن الأمة التي يكثر فيها المنفقون لأموالهم في وجوه الخير ، لا بد أن تعز كلمتها ، وتسلم من كوارث شتى ، كالجهل ، والفقر ، والمرض .
فببذل الماء تسد حاجات البؤساء ، وتشاد معاهد التعليم ، وتقام وسائل حفظ الصحة ، وتنمو المحبة والمودة بين الأغنياء والفقراء .
قال تعالى : ( مَّثَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ والله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ثم أضاف القرآن إلى صفات المتقين وصفاً رابعاً فقال :
( الذين يؤمنون بالغيب )
قال أبو جعفر الرازي ، عن العلاء بن المسيب بن رافع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : الإيمان التصديق .
وقال علي بن أبي طلحة وغيره ، عن ابن عباس ، ( يؤمنون ) يصدقون .
وقال معمر عن الزهري : الإيمان العمل .
وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : ( يؤمنون ) يخشون .
قال ابن جرير وغيره : والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان ، الذي هو تصديق القول بالعمل ، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله ، وتصديق الإقرار بالفعل . قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض ، وقد يستعمل في القرآن ، والمراد به ذلك ، كما قال تعالى : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) [ التوبة : 61 ] ، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) [ يوسف : 17 ] ، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال ؛ كقوله : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) [ الانشقاق : 25 ، والتين : 6 ] ، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا .
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة ، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة .
ومنهم من فسره بالخشية ، لقوله تعالى : ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب ) [ الملك : 12 ] ، وقوله : ( من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) [ ق : 33 ] ، والخشية خلاصة الإيمان والعلم ، كما قال تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر : 28 ] .
وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه ، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد .
قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، في قوله : ( يؤمنون بالغيب ) قال : يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وجنته وناره ولقائه ، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث ، فهذا غيب كله .
وكذا قال قتادة بن دعامة .
وقال السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة ، وأمر النار ، وما ذكر في القرآن .
وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( بالغيب ) قال : بما جاء منه ، يعني : من الله تعالى .
وقال سفيان الثوري ، عن عاصم ، عن زر ، قال : الغيب : القرآن .
وقال عطاء بن أبي رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب .
وقال إسماعيل بن أبي خالد : ( يؤمنون بالغيب ) قال : بغيب الإسلام .
وقال زيد بن أسلم : ( الذين يؤمنون بالغيب ) قال : بالقدر . فكل هذه متقاربة في معنى واحد ؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به .
وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا ، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به ، قال : فقال عبد الله : إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه ، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب ، ثم قرأ : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله : ( المفلحون ) [ البقرة : 1 - 5 ] .
وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم في مستدركه ، من طرق ، عن الأعمش ، به .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .
وفي معنى هذا الحديث الذي رواه [ الإمام ] أحمد ، حدثنا أبو المغيرة ، أخبرنا الأوزاعي ، حدثني أسيد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن دريك ، عن ابن محيريز ، قال : قلت لأبي جمعة : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم ، أحدثك حديثا جيدا : تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ، فقال : يا رسول الله ، هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك . قال : نعم ، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني .
طريق أخرى : قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن صالح بن جبير ، قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ، ليصلي فيه ، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة ، فلما انصرف خرجنا نشيعه ، فلما أراد الانصراف قال : إن لكم جائزة وحقا ؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلنا : هات رحمك الله قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة ، فقلنا : يا رسول الله ، هل من قوم أعظم أجرا منا ؟ آمنا بك واتبعناك؟ قال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء ، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين .
ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة ، عن مرزوق بن نافع ، عن صالح بن جبير ، عن أبي جمعة ، بنحوه .
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث ، كما قررته في أول شرح البخاري ؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا .
وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي : حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي ، عن المغيرة بن قيس التميمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الخلق أعجب إليكم إيمانا ؟ . قالوا : الملائكة . قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ . قالوا : فالنبيون . قال : وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ . قالوا : فنحن . قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها .
قال أبو حاتم الرازي : المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث .
قلت : ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده ، وابن مردويه في تفسيره ، والحاكم في مستدركه ، من حديث محمد بن أبي حميد ، وفيه ضعف ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله أو نحوه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا ، والله أعلم .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ، حدثنا إسحاق بن إدريس ، أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري ، أخبرني جعفر بن محمود ، عن جدته تويلة بنت أسلم ، قالت : صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة ، فاستقبلنا مسجد إيلياء ، فصلينا سجدتين ، ثم جاءنا من يخبرنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام ، فتحول النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، فصلينا السجدتين الباقيتين ، ونحن مستقبلون البيت الحرام .
قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال : أولئك قوم آمنوا بالغيب .
هذا حديث غريب من هذا الوجه .
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ابن عباس : ( ويقيمون الصلاة أي : يقيمون الصلاة بفروضها .
وقال الضحاك ، عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها وفيها .
وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها ، ووضوئها ، وركوعها وسجودها .
وقال مقاتل بن حيان : إقامتها : المحافظة على مواقيتها ، وإسباغ الطهور فيها ، وتمام ركوعها وسجودها ، وتلاوة القرآن فيها ، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها .
وقال علي بن أبي طلحة ، وغيره عن ابن عباس : ( ومما رزقناهم ينفقون قال : زكاة أموالهم .
وقال السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومما رزقناهم ينفقون قال : هي نفقة الرجل على أهله ، وهذا قبل أن تنزل الزكاة .
وقال جويبر ، عن الضحاك : كانت النفقات قربات ، يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم ، حتى نزلت فرائض الصدقات : سبع آيات في سورة " براءة " ، مما يذكر فيهن الصدقات ، هن الناسخات المثبتات .
وقال قتادة : ( ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله ؛ هذه الأموال عواري ، وودائع عندك يا ابن آدم ، يوشك أن تفارقها .
واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات ؛ فإنه قال : وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ، زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل ، أو عيال ، وغيرهم ، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك ، وغير ذلك ؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك ، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه .
قلت : كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال ؛ فإن الصلاة حق الله وعبادته ، وهي مشتملة على توحيده ، والثناء عليه ، وتمجيده ، والابتهال إليه ، ودعائه ، والتوكل عليه ، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم ، وأولى الناس بذلك القرابات ، والأهلون ، والمماليك ، ثم الأجانب ، فكل من النفقات الواجبة ، والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . والأحاديث في هذا كثيرة .
وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء ، قال الأعشى :
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما
وقال أيضا :
وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم
أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . وقال الآخر :
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
يقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي . وهذا ظاهر ، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة ، بشروطها المعروفة ، وصفاتها ، وأنواعها [ المشروعة ] المشهورة .
وقال ابن جرير : وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة ؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله ، مع ما يسأل ربه من حاجته .
[ وقيل : هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع ، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب ، ومنه سمي المصلي ؛ وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل ، وفيه نظر ، وقيل : هي مشتقة من الصلى ، وهو الملازمة للشيء من قوله : ( لا يصلاها ) أي : يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى ) [ الليل : 15 ] وقيل : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم ، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) [ العنكبوت : 45 ] واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر ، والله أعلم ] .
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه ، إن شاء الله .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
267- حدثنا محمد بن حُميد الرازي, قال: حدثنا سَلَمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " الذين يؤمنون "، قال: يصدِّقون.
268- حدثني يحيى بن عثمان بن صالح السَّهمي, قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " يؤمنون ": يصدِّقون (56) .
269- حدثني المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: " يؤمنون ": يخشَوْنَ.
270- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, قال: حدثنا محمد بن ثور، عن مَعْمَر, قال: قال الزهري: الإيمانُ العملُ (57) .
271- حُدِّثْتُ عن عمّار بن الحسن قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن العلاء بن المسيَّب بن رافع, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص، عن عبد الله, قال: الإيمان: التَّصْديق (58) .
ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق, فيُدْعَى المصدِّق بالشيء قولا مؤمنًا به, ويُدْعى المصدِّق قولَه بفِعْله، مؤمنًا. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ [سورة يوسف: 17]، يعني: وما أنت بمصدِّق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان، الذي هو تصديق القولِ بالعمل. والإيمان كلمة جامعةٌ للإقرارَ بالله وكتُبه ورسلِه, وتصديقَ الإقرار بالفعل. وإذْ كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل الآيةِ، وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغَيْبِ قولا واعتقادًا وعملا إذ كان جلّ ثناؤه لم يحصُرْهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى, بل أجمل وصْفهم به، من غير خُصوصِ شيء من معانيه أخرجَهُ من صفتهم بخبرٍ ولا عقلٍ.
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: بِالْغَيْبِ
272- حدثنا محمد بن حُميد الرازي, قال: حدثنا سَلَمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: " بالغيب "، قال: بما جاء منه, يعني: من الله جل ثناؤه.
273- حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط، عن السُّدّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرّة الهَمْداني , عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، " بالغيب ": أما الغيْبُ فما غابَ عن العباد من أمر الجنة وأمرِ النار, وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. لم يكن تصديقهُم بذلك -يعني المؤمنين من العرب- من قِبَل أصْل كتابٍ أو عِلْم كان عندَهم.
274- حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزّبيري, قال: حدثنا سفيان، عن عاصم, عن زرٍّ, قال: الغيبُ القرآن (59) .
275- حدثنا بشر بن مُعَاذ العَقَدي, قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع, عن سعيد بن أبي عَرُوبة, عن قتادة في قوله " الذين يُؤمنون بالغيب "، قال: آمنوا بالجنّة والنار، والبَعْث بعدَ الموت، وبيوم القيامة, وكلُّ هذا غيبٌ (60) .
276- حُدِّثت عن عمّار بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, &; 1-237 &; عن أبيه, عن الربيع بن أنس، " الذين يؤمنون بالغيب ": آمنوا بالله وملائكته ورُسُلِه واليومِ الآخِر، وجَنّته وناره ولقائه, وآمنوا بالحياة بعد الموت. فهذا كله غيبٌ (61) .
وأصل الغيب: كُلّ ما غاب عنك من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فُلان يغيبُ غيبًا.
وقد اختلفَ أهلُ التأويل في أعيان القوم الذين أنـزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة فيهم, وفي نَعْتهم وصِفَتهم التي وَصفَهم بها، من إيمانهم بالغيب, وسائر المعاني التي حوتها الآيتان من صفاتهم غيرَه.
فقال بعضُهم: هم مؤمنو العربِ خاصة, دون غيرهم من مؤمني أهل الكتاب.
واستدَلُّوا على صحّة قولهم ذلك وحقيقة تأويلهم، بالآية التي تتلو هاتين الآيتين, وهو قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْـزِلَ مِنْ قَبْلِكَ . قالوا: فلم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنـزله الله عزّ وجلّ على محمد صلى الله عليه وسلم، تدينُ بتصديقِه والإقرار والعملِ به. وإنما كان الكتابُ لأهل الكتابين غيرِها. قالوا: فلما قصّ الله عز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنـزل إلى محمد وما أنـزل من قبله -بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب- علمنا أن كلَّ صِنفٍ منهم غيرُ الصنف الآخر , وأن المؤمنين بالغيب نوعٌ غيرُ النوع المصدِّق بالكتابين اللذين أحدهما مُنـزل على محمد صلى الله عليه وسلم, والآخرُ منهما على مَنْ قَبْلَ رسول الله (62) .
قالوا: وإذْ كان ذلك كذلك، صحَّ ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى: ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ )، إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة والنار، والثَّواب والعقاب والبعث, والتصديقِ بالله ومَلائكته وكُتُبه ورسله، وجميع ما كانت العرب لا تدينُ به في جاهليِّتها, مما أوجب الله جل ثناؤه على عِبَاده الدَّيْنُونة به - دون غيرهم.
* ذكر من قال ذلك:
277- حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حمّاد, قال: حدثنا أسباط، عن السُّدّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرة الهمداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم: أما( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ )، فهم المؤمنون من العرب, وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار, وما ذكر الله في القرآن. لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم.( و الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب (63) .
وقال بعضهم: بل نـزلت هذه الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصة, لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله جل ثناؤه إياهم فيه عن الغيوب التي كانوا يخفونها بينهم ويسرونها, فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه و سلم على ذلك منهم في تنـزيله، أنه من عند الله جل وعز, فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصدقوا بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا علم لهم بها، لما استقر عندهم - بالحجة التي احتج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه, من الإخبار فيه عما كانوا يكتمونه من ضمائرهم - أن جميع ذلك من عند الله.
وقال بعضهم: بل الآيات الأربع من أول هذه السورة، أنـزلت على محمد صلى الله عليه و سلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفتهم من العرب والعجم، وأهل الكتابين وسواهم (64) . وإنما هذه صفة صنف من الناس, والمؤمن بما أنـزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم، وما أنـزل من قبله، هو المؤمن بالغيب.
قالوا: وإنما وصفهم الله بالإيمان بما أنـزل إلى محمد وبما أنـزل إلى من قبله، بعد تقضي وصفه إياهم بالإيمان بالغيب، لأن وصفه إياهم بما وصفهم به من الإيمان بالغيب، كان معنيا به أنهم يؤمنون بالجنة والنار والبعث وسائر الأمور التي كلفهم الله جل ثناؤه الإيمان بها، مما لم يروه ولم يأت بعد مما هو آت, دون الإخبار عنهم أنهم يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل ومن الكتب.
قالوا: فلما كان معنى قوله تعالى ذكره: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْـزِلَ مِنْ قَبْلِكَ غير موجود في قوله ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) - كانت الحاجة من العباد إلى معرفة صفتهم بذلك ليعرفوهم، نظير حاجتهم إلى معرفتهم بالصفة التي وصفوا بها من إيمانهم بالغيب، ليعلموا ما يرضى الله من أفعال عباده ويحبه من صفاتهم, فيكونوا به -إن وفقهم له ربهم- [مؤمنين] (65) .
* ذكر من قال ذلك:
278- حدثني محمد بن عمرو بن العباس الباهلي, قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد, قال: حدثنا عيسى بن ميمون المكي, قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين، &; 1-240 &; وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين (66) .
279- حدثنا سفيان بن وكيع, قال: حدثنا أبي، عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد، بمثله (67) .
280- حدثني المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا موسى بن مسعود, قال: حدثنا شِبْل, عن ابن أبي نَجيح, عن مجاهد، مثله (68) .
281- حُدِّثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه، عن الربيع بن أنس, قال: أربعُ آياتٍ من فاتحة هذه السورة -يعني سورة البقرة- في الذين آمنوا, وآيتان في قادة الأحزاب.
وأولى القولين عندي بالصواب، وأشبههما بتأويل الكتاب, القولُ الأول, وهو: أنّ الذين وَصَفهم الله تعالى ذِكره بالإيمان بالغيب, وبما وصفهم به جَلَّ ثناؤه في الآيتين الأوَّلتَيْن (69) ، غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنـزِل على محمد والذي أنـزل على مَنْ قبله من الرسل، لما ذكرت من العلل قبلُ لمن قال ذلك.
ومما يدلّ أيضًا مع ذلك على صحّة هذا القول، أنه جنَّسَ - بعد وصف المؤمنين بالصِّفتين اللتين وَصَف, وبعد تصنيفه كلَّ صنف منهما على ما صنَّف الكفار - جنْسَيْن (70) فجعل أحدهما مطبوعًا على قلبه، مختومًا عليه، مأيوسًا من إيابه (71) والآخرَ منافقًا، يُرائي بإظهار الإيمان في الظاهر, ويستسرُّ النفاق في الباطن. فصيَّر الكفار جنسَيْن، كما صيَّر المؤمنين في أول السورة جِنْسين. ثم عرّف عباده نَعْتَ كلِّ صنف منهم وصِفَتَهم، وما أعدَّ لكلّ فريق منهم من ثواب أو عقاب, وَذمّ أهل الذَّم منهم، وشكرَ سَعْيَ أهل الطاعة منهم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَيُقِيمُونَ
وإقامتها: أداؤها -بحدودها وفروضها والواجب فيها- على ما فُرِضَتْ عليه. كما يقال: أقام القومُ سُوقَهم, إذا لم يُعَطِّلوها من البَيع والشراء فيها, وكما قال الشاعر:
أَقَمْنَــا لأَهْـلِ الْعِـرَاقَيْنِ سُـوقَ الـ
ـضِّــرَاب فَخَــامُوا وَوَلَّـوْا جَمِيعَـا (72)
282- وكما حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا سَلَمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس،" ويقيمون الصلاة "، قال: الذين يقيمون الصلاةَ بفرُوضها.
283- حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عُمارة, عن أبي رَوْق, عن الضحاك, عن ابن عباس،" ويقيمون الصلاة " قال: إقامة &; 1-242 &; الصلاة تمامُ الرُّكوع والسُّجود، والتِّلاوةُ والخشوعُ، والإقبالُ عليها فيها (73) .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الصَّلاةَ
284- حدثني يحيى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جُوَيْبر، عن الضحاك في قوله: " الذين يقيمون الصلاة ": يعني الصلاة المفروضة (74) .
وأما الصلاةُ فإنها في كلام العرب الدُّعاءُ، كما قال الأعشى:
لَهَـا حَـارِسٌ لا يَـبْرَحُ الدَّهْـرَ بَيْتَهَا
وَإِنْ ذُبِحَـتْ صَـلَّى عَلَيْهَـا وَزَمْزَمَـا (75)
يعني بذلك: دعا لها, وكقول الأعشى أيضًا (76) .
وَقَابَلَهَـــا الــرِّيحَ فِــي دَنِّهَــا
وصَــلَّى عَــلَى دَنِّهَــا وَارْتَسَـمْ (77)
وأرى أن الصلاة المفروضة سُمِّيت " صلاة "، لأنّ المصلِّي متعرِّض لاستنجاح طَلِبتَه من ثواب الله بعمله، مع ما يسأل رَبَّه من حاجاته، تعرُّضَ الداعي بدعائه ربَّه استنجاحَ حاجاته وسؤلَهُ.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)
اختلف المفسرون في تأويل ذلك, فقال بعضهم بما:-
285- حدثنا به ابن حُميد, قال: حدثنا سَلَمة, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس، " ومما رزقناهم ينفقون "، قال: يؤتون الزكاة احتسابًا بها.
286- حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, عن معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس، " ومما رزقناهم ينفقون "، قال: زكاةَ أموالهم (78) .
287- حدثني يحيى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جُوَيْبر، عن الضحاك، " ومما رزقناهم يُنفقون "، قال: كانت النفقات قُرُبات يتقرَّبون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجُهْدهم, حتى نَـزَلت فرائضُ الصدقات: سبعُ آيات في سورة براءَة, مما يذكر فيهنّ الصدقات, هنّ المُثْبَتات الناسخات (79) .
وقال بعضهم بما:-
288- حدثني موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط، عن السُّدّي في خبر ذَكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرَّة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب &; 1-244 &; النبي صلى الله عليه وسلم، " ومما رَزقناهم ينفقون ": هي َنفقَةُ الرّجل على أهله. وهذا قبل أن تنـزِل الزكاة (80) .
وأوْلى التأويلات بالآية وأحقُّها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم, مُؤدِّين، زكاةً كان ذلك أو نفَقةَ مَنْ لزمتْه نفقتُه، من أهل وعيال وغيرهم, ممن تجب عليهم نَفَقتُه بالقرابة والمِلك وغير ذلك. لأن الله جل ثناؤه عَمّ وصفهم إذْ وصَفهم بالإنفاق مما رزقهم, فمدحهم بذلك من صفتهم. فكان معلومًا أنه إذ لم يخصُصْ مدْحَهم ووصفَهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبُها دونَ نوعٍ بخبر ولا غيره - أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمودِ عليها صاحبُها من طيِّب ما رزقهم رَبُّهم من أموالهم وأملاكهم, وذلك الحلالُ منه الذي لم يَشُبْهُ حرامٌ.
---------------
الهوامش :
(56) الأثر 267- سيأتي باقيه بهذا الإسناد : 272 . ونقلهما ابن كثير 1 : 73 مفرقين . ونقل 268 مع أولهما . ونقل السيوطي 1 : 25 الثلاثة مجتمعة .
(57) الأثران 269 - 270 : ذكرهما ابن كثير 1 : 73
(58) الخبر 271- عبد الله : هو ابن مسعود . وقد نقل ابن كثير هذا الخبر وحده 1 : 73 ، ثم نقل الخبر الآتي 273 وحده . وفصل إسناد كل واحد منهما . أما السيوطي 1 : 25 فقد جمع اللفظين دون بيان ، وأدخل معهما لفظ الخبر 277! وهو تصرف غير سديد ، لاختلاف الإسنادين أولا ، ولأن 273 ، 277 ليسا عن ابن مسعود وحده ، كما ترى .
(59) الأثر 274- سفيان : هو الثوري ، عاصم : هو ابن أبي النجود -بفتح النون- القارئ . زر ، بكسر الزاي وتشديد الراء : هو ابن حبيش ، بضم الحاء . وهو تابعي كبير إمام . وهذا الأثر عند ابن كثير 1 : 73 - 74 .
(60) الأثر 275- ذكره ابن كثير والسيوطي أيضًا .
(61) الأثر 276- ذكره ابن كثير 1 : 73 هكذا : "قال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية . . . " . وذكره السيوطي 1 : 25 هكذا : "وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية . . " . فأخشى أن يكون ذكر"عن أبي العالية" سقط من الإسناد من نسخ الطبري ، لثبوته عند هذين الناقلين عنه .
(62) في المخطوطة : "والآخر منهما على من قبله رسول الله" ، والظاهر أن صوابها : "على من قبل رسول الله" ، كما أثبتناها . وأما المطبوعة ففيها : "على من قبله من رسل الله تعالى ذكره" .
(63) الخبر 277- سبق أوله بهذا الإسناد : 273 . ولم يذكره ابن كثير بهذا اللفظ المطول . وقد مضى في شرح 271 أن السيوطي جمع الألفاظ الثلاثة : 271 ، 273 ، 277 في سياقة واحدة!
(64) في المطبوعة والمخطوطة"وأهل الكتابين سواهم" ، والصواب أن يقال"وسواهم" . فقد ذكر الطبري ثلاثة أقوال : أما الأول : فهو أن المعنى به العرب خاصة ، والثاني : أن المعنى به أهل الكتاب خاصة ، فيكون الثالث : أن يعني به الصنفين جميعا وسواهم من الناس .
(65) هذه الزيادة بين القوسين واجبة لتمام المعنى . وليست في المطبوعة ولا المخطوطة .
(66) الأثر 278- أبو عاصم : هو النبيل ، الحافظ الكبير . عيسى بن ميمون المكي : هو المعروف بابن داية ، قال ابن عيينة : "كان قارئًا للقرآن . قرأ على ابن كثير" . وثقه أبو حاتم وغيره .
(67) الأثر 279- هذا إسناد ضعيف ، بضعف سفيان بن وكيع ، ولإبهام الرجل الذي روى عنه سفيان الثوري . ولكن الأثر موصول بالإسنادين اللذين قبله وبعده .
(68) الأثر 280- موسى بن مسعود : هو أبو حذيفة النهدي ، وهو ثقة ، روى عنه البخاري في صحيحه ، ووثقه ابن سعد والعجلي . وترجمه البخاري في الكبير 4/1/ 295 . شبل : هو ابن عباد المكي القارئ ، وهو ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما .
وهذا الأثر ، بأسانيده الثلاثة ، ذكره ابن كثير 1 : 80 دون تفصيلها ، قال : "والظاهر قول مجاهد - فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ، ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، أنه قال . . . " .
(69) الأولة : الأولى ، وليست خطأ .
(70) سياقه : "جنَّس . . . جنسين" ، وما بينهما فصل ، وجنس الشيء : جعله أجناسًا ، كصنفه أصنافًا .
(71) في المطبوعة : "إيمانه" ، وهي صحيحة المعنى أيضًا . والإياب : الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة . ومنه قوله تعالى : { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ }
(72) في المطبوعة"فحاسوا" ، وفي المخطوطة"مجآمرا" . وخام في الحرب عن قرنه بخيم خيمًا : جبن ونكص وانكسر . ولم أعرف قائل البيت .
(73) الخبران 282 ، 283- في تفسير ابن كثير 1 : 77 ، والدر المنثور 1 : 27 ، والشوكاني 1 : 25 .
(74) الأثر 284- إسناده ضعيف جدًّا . يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان : قال الذهبي : "محدث مشهور . . . وثقه الدارقطني وغيره . . . والدارقطني من أخبر الناس به" . مات سنة 275 عن 95 سنة . يزيد : هو ابن هارون ، أحد الحفاظ الأعلام المشاهير ، من شيوخ الأئمة أحمد وابن معين وابن راهويه وابن المديني . جويبر - بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدي البلخي ، ضعيف جدًّا ، ضعفه يحيى القطان ، فيما روى عنه البخاري في الكبير 1/2/ 256 ، والصغير : 176 ، وقال النسائي في الضعفاء : 8"متروك الحديث" ، وفي التهذيب 2 : 124"قال أبو قدامة السرخسي : قال يحيى القطان : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث . ثم ذكر الضحاك وجويبرًا ومحمد بن السائب . وقال : هؤلاء لا يحتمل حديثهم ، ويكتب التفسير عنهم" .
(75) ديوانه : 200 ، يذكر الخمر في دنها . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلف الكلام عند الأكل وهو مطبق فمه بصوت خفي لا يكاد يفهم . وفعلهم ذلك هو الزمزمة . "ذبحت" أي بزلت وأزيل ختمها . وعندئذ يدعو مخافة أن تكون فاسدة ، فيخسر .
(76) في المطبوعة والمخطوطة : "وكقول الآخر أيضًا" ، والصواب أنه الأعشى ، وسبق قلم الناسخ .
(77) ديوان الأعشى : 29 . وقوله"وقابلها الريح" أي جعلها قبالة مهب الريح ، وذلك عند بزلها وإزالة ختمها . ويروى : "فأقبلها الريح" وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ ، مخافة أن يجدها قد فسدت ، فتبور تجارته .
(78) الخبر 286- في المخطوطة"ابن المثنى" ، وهو خطأ . والخبر ذكره ابن كثير 1 : 77 .
(79) الأثر 287- ذكره ابن كثير 1 : 77 ، والسيوطي 1 : 27 ، والشوكاني 1 : 25 . وقوله"المثبتات" : بفتح الباء ، أي التي أثبت حكمها ولم ينسخ ، ويجوز كسرها ، بمعنى أنها أثبتت الفريضة بعد نسخها ما سبقها في النزول . وبدلها عند السيوطي والشوكاني"الناسخات المبينات" . وليس بشيء
(80) الخبر 288- نقله ابن كثير أيضًا . ونقله السيوطي مختصرًا ، وجعله من كلام ابن مسعود وحده . وقلده الشوكاني دون بحث .
المعاني :
التدبر :
عمل
[3] ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ لا تخسر هذه الصفة بكثرة تتبع أخبار الإعجاز العلمي التي تؤيد ما جاء في القرآن، بل اجعل شعارك: (إن كان قال فقد صدق).
وقفة
[3] ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ هذه أول صفة مدح الله بها عباده في كتابه، وبها يتمايز الخلق، فأشدهم إيمانًا أعظمهم تصديقًا بالغيب، ولهذا سبقنا أبو بكر t.
تفاعل
[3] ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [285] اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد.
وقفة
[3] من أخص خصائص المتقين الإيمان بالغيب؛ لأنه من تمام التسليم لله تعالى، ولذلك جاء في بداية سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾.
وقفة
[3] من أهمية وقيمة وأثر الإيمان بالغيب على الانسان وصف الله المتقين كأول صفة لهم ببداية سورة البقرة فقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، وأكد في نهاية السورة فقال عز وجل: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [285].
وقفة
[3] خواطر صائم: لم نر أبواب الجنة التى تفتح، ولا أبواب النار التى تغلق، ولا سلسلة الشياطين، ولكننا نبتدئ شهر القرآن بما ابتدأ الله به القرآن: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾.
وقفة
[3] ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ هذه الصفات الثلاث الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق هي عمدة فضائل العبادات؛ فالإيمان بالغيبيات يتعلق بعمل القلب، وإقامة الصلاة تتعلق بأعمال الجسد، والنفقة تتعلق بالأخوة الإيمانية.
اسقاط
[3] ابحث عن تقوى الله في ثلاث مواطن: في قلبك: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، في بدنك: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾، في مالك: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.
عمل
[3] اختبر إيمانك باليوم الآخر ويقينك به بالإنفاق اليوم من مال الله الذي آتاك، موقنًا أن الله تعالى سيخلفه عليك في الدنيا والآخرة ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.
عمل
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ تُريد التوفيق؟ تريد الرزق؟ تريد صلاح الحال؟ تريد الستر؟ فعليك بالصلاة، الصلاة تجلب كل خير وتدفع كل شر.
لمسة
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ لم يقل: يفعلون الصلاة، أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة؛ فإقامة الصلاة: إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنًا بإقامة روحها؛ وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله منها.
عمل
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ حاسب نفسك في أمر الصلاة، وتفقد اليوم جوانب التقصير فيها فكَمِّله، وأقِمْه على الوجه المطلوب شرعًا.
وقفة
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ قال أبو العالية: «كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقده من أمره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه، وقلت: هو لغير الصلاة أضيع».
وقفة
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ عنوان سعادة العبد: إخلاصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق.
وقفة
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة؛ لأنَّ الصلاة إخلاص للمعبود، والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة.
وقفة
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ قال الرازي: «تتضمن الآية الأمر بالصلاة والزكاة».
تفاعل
[3] ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ادعُ الله أن يعينك على إقامة الصلاة والخشوع فيها، وأن ييسر لك الإنفاق.
لمسة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ أتى بـ (من) الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم، غير ضار لهم، ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه، وينتفع به إخوانهم.
لمسة
[3] في قوله: ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾ إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم؛ ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله أنعم به عليكم.
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ المال مال الله, ثم يمدحنا على إنفاقه.
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ اهتم القرآن الكريم بمدح المنفقين والحث على الإنفاق، إذ كان من أعظم الوسائل إلى رقي الأمم وسلامتها من كوارث شتى كالفقر والجهل والمرض، فببذل المال تُسد حاجات الفقراء، وتُشاد معاهد التعليم، وغير ذلك.
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ من أنفق من وقته وعلمه وخلقه وماله وجاهه هنيئًا له؛ ينام قرير العين وألسن الساهرين المنتفعين منه تلهج له بالدعوات!
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ كأنهم اعترفوا واستشعروا أن هذا مال الله، فهذا المعنى أعظم من ذلك الذي يظن أنه هو المتفضل، وأن هذا ماله.
لمسة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ عبر سبحانه بالنفقة، ولم يعبر بالزكاة؛ لأن النفقة أعم، فهو ينفق على نفسه، وعلى أهله، وعلى أقاربه، وينفق الزكاة وغيرها.
لمسة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ولم يقل: (ينفقون من أموالهم)؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الانفاق، من نشر العلم، والدعوة، وكل أوجه الانفاق.
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ يدخل في معناها قول الحسن: «من أعظم النفقة: نفقة العلم»، وقول أبو الدرداء: «ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانًا له».
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ الزكاة كأنها مضاربة بين الله تعالى وعبده، فهو الذي أعطاك رأس المال كله (الرزق) ثم يأخذ منك بعد ذلك ربع العشر، ولا يأخذ لنفسه؛ بل لأهل الزكاة.
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ تمنع الاستكبار في نفس المعطي والمنفق؛ لأن الرزق كان من عند الله تعالى له، فكما أنه لم يستنكف عن أخذ الرزق من الله، فلا يتكبر في إعطاء النفقة للغير، ومن أجل ذلك -أي حماية المعطي والمتصدق من الكبر ،وحماية الآخذ من الانكسار- جعلت الشريعة توزيع الزكاة بيد ولي الأمر؛ لأن الناس حين يأخذون من ولي الأمر لا يحسون بالغلبة ولا بالانكسار، كما لو أخذوه من أصحاب الأموال.
وقفة
[3] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر؛ فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم، هذا رزق الأجساد وقوتها، وهذا رزق القلوب وقوتها.
الإعراب :
- ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ: ﴾
- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة للمتقين. ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: هم الذين. يؤمنون: الجملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالغيب: جار ومجرور متعلق بيؤمنون.
- ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «يُؤْمِنُونَ» وتعرب إعرابها. الصلاة: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: ﴾
- الواو: استئنافية. مما: جار ومجرور متعلق بينفقون. وأصلها: من: حرف جر و «ما» اسم موصول مبني أدغم به حرف الجر «من» مبني على السكون في محل جر بمن. رزقناهم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. وجملة «رَزَقْناهُمْ» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ينفقون: تعرب إعراب «يُؤْمِنُونَ» ويجوز أن تكون «من» للتبعيض. '
المتشابهات :
| البقرة: 3 | ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ |
|---|
| التوبة: 71 | ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل أن القرآن هدًى للمتقين؛ ناسب أن يذكر هنا صفاتهم؛ تعريفًا لهم، وهي: 1- الإيمان بالغيب. 2- إقامة الصلاة. 3- الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى:
﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ .. ﴾
التفسير :
ثم قال:{ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} وهو القرآن والسنة، قال تعالى:{ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول, ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه, فيؤمنون ببعضه, ولا يؤمنون ببعضه, إما بجحده أو تأويله, على غير مراد الله ورسوله, كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة, الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم, بما حاصله عدم التصديق بمعناها, وإن صدقوا بلفظها, فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله:{ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه, خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال:{ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} و "الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت، وخصه [بالذكر] بعد العموم, لأن الإيمان باليوم الآخر, أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، و "اليقين "هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك, الموجب للعمل.
( والذين يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ )
والمراد بقوله - تعالى - ( بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ) القرآن الكريم ، وإنما عبر عنه بلفظ الماضي - وإن كان بعضه مترقباً - تغليباً للموجود على ما لم يوجد . والمراد - بقوله - تعالى - ( وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ) الكتب الإلهية السابقة التي أنزلها الله على أنبيائه كموسى وعيسى وداود . وهذا كقوله - تعالى - :
( يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ آمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ والكتاب الذي نَزَّلَ على رَسُولِهِ والكتاب الذي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ) والإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان برسالته ، ويستوجب العمل بما تضمنته شريعته .
وإيجاب العمل بما تضمنه القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم باق على إطلاقه . أما الكتب السماوية السابقة فيكفي الإيمان بأنها كانت وحياً وهداية ، وقد تضمن القرآن الكريم ما اشتملت عليه هذه الكتب من هدايات وأصبح بنزوله مهيمناً عليها ، قال - تعالى - :
( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) وصار من المحتم على كل عاقل أن يعمل بما جاء به القرآن من توجيهات .
وقدم الإيمان بما أنزل عليه على الإيمان الذين من قبله - مع أن الترتيب يقتضي العكس - لأن إيمانهم بمن قبله لا قيمة له إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم .
ولم يقل : ويؤمنون بما أنزل من قبلك بتكرير يؤمنون ، للإشعار بأن الإيمان به وبهم واحد ، لا تغاير فيه وإن تعدد متعلقه .
ويرى بعض العلماء أن المراد من الآية الكريمة ، أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن ، نم لما نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه الحق - آمنوا به أيضاً - ، فصار لهم أجران ، كما جاء في الحديث الشريف ، الذي ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها " .
ثم وصف الله المتقين بوصف خامس فقال : ( وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ ) الآخرة تأنيث الآخر .
وهذا اللفظ تارة يجيء وصفاً ليوم القيامة مع ذكر الموصوف ، كما في قوله - تعالى - ( وَلَلدَّارُ الآخرة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ) وتارة بهذا المعنى ولكن بدون ذكر الموصوف ، كما في الآية التي معنا ، وكما في قوله - تعالى -
( وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ) وسميت آخرة لأنها تأتي بعد الدنيا التي هي الدار الأولى .
و ( يُوقِنُونَ ) من الإيقان وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، بحيث لا يطرأ عليه شك ، ولا تحوم حوله شبهة . يقال يقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته ، ويقال : يقنت - بالكسر - يقناً ، وأيقنت ، وتيقنت ، واستيقنت بمعنى واحد .
والمعنى : وبالدار الآخرة وما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب هم يوقنون إيقاناً قطعياً ، لا أثر فيه للادعاءات الكاذبة ، والأوهام الباطلة .
وفي إيراد " هم " قبل قوله " يوقنون " تعريض ، بغيرهم ، ممن كان اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق للحقيقة أو غير بالغ مرتبة اليقين .
ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ، له أثر عظيم في فعل الخيرات ، واجتناب المنكرات ، لأن من أدرك أن هناك يوماً سيحاسب فيه على عمله ، فإنه من شأنه أن يسلك الطريق القويم الذي يكسبه رضي الله يوم يلقاه .
قال أبو حيان : وذكر لفظة ( هُمْ ) في قوله : ( وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ ) ولم يذكرها في قوله : ( وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) لأن وصف إيقانهم بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إلى التوكيد ولم يحتج ذلك إلى تأكيد ولأنه لو ذكر ( هُمْ ) هناك لكان فيه قلق لفظي ، إذ يكون التركيب " ومما رزقناهم هم ينفقون " .
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الثمار التي ترتبت على تقواهم فقال :
قال ابن عباس : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) أي : يصدقون بما جئت به من الله ، وما جاء به من قبلك من المرسلين ، لا يفرقون بينهم ، ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون ) أي : بالبعث والقيامة ، والجنة ، والنار ، والحساب ، والميزان .
وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا ، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا : هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) [ البقرة : 3 ] ومن هم ؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير :
أحدهما : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا ، وهم كل مؤمن ، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم ، قاله مجاهد ، وأبو العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة .
والثاني : هما واحد ، وهم مؤمنو أهل الكتاب ، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات ، كما قال تعالى : ( سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ) [ الأعلى : 1 - 5 ] وكما قال الشاعر :
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم
فعطف الصفات بعضها على بعض ، والموصوف واحد .
والثالث : أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب ، والموصوفون ثانيا بقوله : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) الآية مؤمنو أهل الكتاب ، نقله السدي في تفسيره ، عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة ، واختاره ابن جرير ، ويستشهد لما قال بقوله تعالى : ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ) الآية [ آل عمران : 199 ] ، وبقوله تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ) [ القصص : 52 - 54 ] . وثبت في الصحيحين ، من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها .
وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة ، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين ، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين : منافق وكافر ، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي .
قلت : والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري ، عن رجل ، عن مجاهد . ورواه غير واحد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال : أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين ، وآيتان في نعت الكافرين ، وثلاث عشرة في المنافقين ، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي ، وكتابي من إنسي وجني ، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى ، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها ، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة ، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك ، كما قال : ( ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ) الآية [ النساء : 136 ] . وقال : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ) الآية [ العنكبوت : 46 ] . وقال تعالى : ( ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ) [ النساء : 47 ] وقال تعالى : ( قل ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ) [ المائدة : 68 ] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك ، فقال تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) الآية [ البقرة : 285 ] وقال : ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ) [ النساء : 152 ] وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه . لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية ، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين ، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان ، بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح :إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، ولكن قولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام ، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية ، فغيرهم [ قد ] يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم ، والله أعلم .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت, وأي أجناس الناس هم (81) . غير أنَّا نذكر ما رُوي في ذلك عمن روي عنه في تأويله قولٌ:
289- فحدثنا ابن حُميد, قال: حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس، " والذين يؤمنون بما أنـزِل إليك وما أنـزل من قبلك ": أي يصدِّقونك &; 1-245 &; بما جئت به من الله جلّ وعز وما جاء به مَنْ قبلك من المرسلين, لا يفرِّقون بينهم، ولا يجْحَدون ما جاءوهم به من عند ربهم (82) .
290- حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط، عن السُّدّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مُرَّة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،" والذين يؤمنون بما أنـزل إليك وما أنـزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ": هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب (83) .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)
قال أبو جعفر: أما الآخرةُ فإنها صفة للدار, كما قال جل ثناؤه وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [سورة العنكبوت: 64]. وإنما وصفت بذلك لمصيرها آخِرةً لأولى كانت قبلها، كما تقول للرجل: " أنعمتُ عليك مرَّة بعد أخرى، فلم تشكر لي الأولى ولا الآخرة "، وإنما صارت آخرة للأولى, لتقدُّم الأولى أمامها. فكذلك الدارُ الآخرة، سُمِّيت آخرةً لتقدُّم الدار الأولى أمامها, فصارت التاليةُ لها آخرةً. وقد يجوز أن تكون سُمِّيت آخرةً لتأخُّرها عن الخلق, كما سميت الدنيا " دنيا " لِدُنُوِّها من الخلق.
وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين - بما أنـزل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنـزل إلى من قبله من المرسلين - من إيقانهم به من أمر الآخرة, فهو إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين: من البعث والنشور والثواب والعقاب والحساب والميزان, وغير ذلك مما أعد الله لخلقه يوم القيامة. كما:-
291- حدثنا به محمد بن حميد, قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس، ( وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ): أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان, أي، لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك، ويكفرون بما جاءك من ربك (84) .
وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح عن أن السورة من أولها - وإن كانت الآيات التي في أولها من نعت المؤمنين - تعريض من الله عز وجل بذم كفار أهل الكتاب، الذين زعموا أنهم - بما جاءت به رسل الله عز وجل الذين كانوا قبل محمد صلوات الله عليهم وعليه - مصدقون، وهم بمحمد صلى الله عليه مكذبون, ولما جاء به من التنـزيل جاحدون, ويدعون مع جحودهم ذلك أنهم مهتدون، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأكذب الله جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْـزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . وأخبر جل ثناؤه عباده: أن هذا الكتاب هدى لأهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، المصدقين بما أنـزل إليه وإلى من قبله من رسله من البينات والهدى - خاصة, دون من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به, وادعى أنه مصدق بمن قبل محمد عليه الصلاة والسلام من الرسل وبما جاء به من الكتب. ثم أكد جل ثناؤه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنـزل إليه وإلى من قبله من الرسل - بقوله: أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فأخبر أنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون غيرهم, وأن غيرهم هم أهل الضلال والخسار.
---------------
الهوامش :
(81) انظر 237 - 241 .
(82) الخبر 289- ذكره ابن كثير 1 : 79 مع باقيه الآتي : 291 . وذكره السيوطي 1 : 27 ، والشوكاني 1 : 25 بزيادة أخرى على الروايتين ، منسوبًا لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم .
(83) الخبر 290- وهذا ذكره ابن كثير أيضًا ، لكن بالإشارة إليه دون سياقة لفظه . وقلده الشوكاني .
وعلى الأصل المخطوط بعد هذا ما نصه
سمع أحمد ومحمد والحسن ، بنو عبد الله بن أحمد الفرغاني جميعه .
سمع محمد بن محمد الطرسوسي والحسن بنو محمد بن عبدان ، والحسن بن إبراهيم الحناس جميعه . والحمد لله كثيرًا .
(84) الخبر 291- هو تتمة الخبر السابق 289 وقد أشرنا إليه هناك .
المعاني :
التدبر :
عمل
[3، 4] اختبر إيمانك باليوم الآخر ويقينك به بالإنفاق اليوم من مال الله الذي آتاك، موقنًا أن الله تعالى سيخلفه عليك في الدنيا والآخرة: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ... وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.
لمسة
[4] ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ قال تعالى: (يُؤْمِنُونَ) بصيغة المضارع، ولم يقل (آمنوا) بالماضي؛ لأن الإيمان هنا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة.
وقفة
[4] ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ تقديم الجار والمجرور على الفعل، فلم يقل: (وهم يوقنون بالآخرة)، قَدَّمَ الآخرة للإهتمام والقصر؛ لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق، فكثير من الناس يؤمنون بالله لكن لا يؤمنون بالآخرة .
وقفة
[4] ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ اليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه، وكلما عظم العلم بالآخرة؛ عظم العمل لها.
الإعراب :
- ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما: ﴾
- الواو: عاطفة. الذين يؤمنون: معطوفة على «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ» في الآية السابقة وتعرب إعرابها. بما: جار ومجرور متعلق بيؤمنون: و «ما»: اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل جر بالباء
- ﴿ أُنْزِلَ إِلَيْكَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «أُنْزِلَ» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إليك: جار ومجرور متعلق بأنزل. والأصل: إلاك أبدلت الألف ياء لا تصل لها بالضمير.
- ﴿ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ: ﴾
- الواو: عاطفة. ما أنزل: معطوفة على «ما أُنْزِلَ» السابقة وتعرب إعرابها. من قبلك: جار ومجرور متعلق بأنزل. والكاف:ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
- ﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: ﴾
- الواو: استئنافية. بالآخرة: جار ومجرور. هم: ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ويوقنون: تعرب إعراب «يُؤْمِنُونَ» والجملة الفعلية «يُوقِنُونَ» في محل رفع خبر «هُمْ» والجملة الاسمية «هُمْ يُوقِنُونَ» في محل نصب حال. والجار والمجرور بالآخرة متعلق بيوقنون. '
المتشابهات :
| البقرة: 4 | ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ |
|---|
| النمل: 3 | ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ |
|---|
| لقمان: 4 | ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : 4- الإيمان بكتب الله جميعًا. 5- الإيمان باليوم الآخر، قال تعالى:
﴿ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾
القراءات :
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك:
قرئ:
1- أنزل، مبنيا للمفعول فى الاثنين. وهى قراءة الجمهور.
2- أنزل، مبنيا للفاعل فى الاثنين، وهى قراءة النخعي، وأبى حيوة، ويزيد بن قطيب.
3- أنزل، بتشديد اللام، وهى قراءة شاذة، ووجها أنه أسكن اللام، ثم حذف همزة «إلى» ، ونقل كسرتها إلى لام «أنزل» ، فالتقى المثلان فى كلمتين، والإدغام جائز، فأدغم.
وبالآخرة:
قرئ:
1- وبالآخرة، بتسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التي بعدها للقطع، وهى قراءة الجمهور.
2- وبالآخرة، بالحذف ونقل الحركة إلى اللام، وهى قراءة ورش.
يوقنون:
قرئ:
1- يوقنون، بواو ساكنة بعد الياء، وهى قراءة الجمهور.
2- يؤقنون، بهمزة ساكنة بدل الواو، وهى قراءة أبى حية النحوي، ووجهها أن الواو لما جاورت المضموم كانت كأن الضمة منها، وهم يبدلون من الواو المضمومة همزة
مدارسة الآية : [5] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ .. ﴾
التفسير :
{ أُولَئِكَ} أي:الموصوفون بتلك الصفات الحميدة{ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} أي:على هدى عظيم, لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة، وهل الهداية [الحقيقية] إلا هدايتهم، وما سواها [مما خالفها]، فهو ضلالة. وأتى بـ "على "في هذا الموضع, الدالة على الاستعلاء, وفي الضلالة يأتي بـ "في "كما في قوله:{ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى, مرتفع به, وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال:{ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} والفلاح [هو] الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم, وما عدا تلك السبيل, فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك.
( أولئك على هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وأولئك هُمُ المفلحون ) .
المفلحون : من الفلاح وهو الظفر والفوز بدرك البغية ، وأصله من الفلح - بسكون اللام - وهو الشق والقطع ، ومنه فلاحة الأرض وهو شقها للحرث . وأستعمل منه الفلاح في الفوز كأن الفائز شق طريقه وفلحه للوصول إلى مبتغاه ، أو انفتحت له طريق الظفر وانشقت .
والمعنى : أولئك المتصفون بما تقدم من صفات كريمة ، على نور من ربهم ، وأولئك هم الفائزون بما طلبوا ، الناجون مما منه هربوا ، بسبب إيمانهم العميق ، وأعمالهم الصالحة .
والآية الكريمة كلام مستأنف لبيان أن أولئك المتقين في المنزلة العليا من الكمال الإنساني ، فقد وصفهم - سبحانه - بأنهم على هدى عظيم ، ويدل على عظم هذا الهدى إيراده بصيغة التنكير ، إن من المعلوم عند علماء البيان أن التنكير يدل بمعونة المقام على التعظيم . كما يدل - أيضاً - على عظم هذا الهدى وصفه بأنه " من ربهم " فهو الذي وفقهم إليه ، ويسر لهم أسبابه .
وفي قوله - تعالى - : ( على هُدًى ) إشعار بأنهم تمكنوا منه تمكن من استعلى على الشيء ، وصار في قرار راسخ منه .
وجملة " وأولئك هم المفلحون " بيان لما ظفر به المتقون الحائزون لتلك الخصال ، من سعادة في الدنيا والآخرة .
وتعريف الخبر وهو ( المفلحون ) مع إيراد ضمير الفصل " هم " يفيد أن الفلاح مقصور على أولئك المتقين ، فمن لم يؤمن بالغيب ، أو أضاع الصلاة ، أو بخل بالمال الذي منحه الله إياه فلم يؤده في وجوهه المشروعة ، فإنه لا يكون من المهتدين ، ولا من المفلحين الذين سعدوا في دنياهم وآخرتهم .
قال الإمام الرازي : " وفي تكرير " ( أولئك ) تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدى ، فقد ثبت لهم الاختصاص بالفلاح - أيضاً - فقد تميزوا عن غيرهم بهذين الاختصاصين ، فإن قيل : فلم جيء بالعاطف؟ وما الفرق بينه وبين قوله : ( أولئك كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هُمُ الغافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران ههنا فلذلك دخل العاطف ، بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان ، لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد ، وكانت الثانية مقررة لما في الأولى ، فهي من العطف بمعزل " .
وقال صاحب الكشاف بعد تفسيره لهذه الآية الكريمة " . . . فانظر كيف كرر الله التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى ، وهي : ذكر اسم الإشارة ، وتكريره ، وتعريف المفلحين ، وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين أولئك ، ليبصرك مرتباتهم ، ويرغبك في طلب ما طلبوا ، وينشطك لتقديم ما قدموا ، ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب والتمني على الله ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته . . . " .
وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد مدحت القرآن الكريم بما يستحقه ، وأثنت على من اهتدوا بهديه ، ووصفتهم بالصفات السامية ، وبشرتهم بالبشارات الكريمة .
وبعد أن انتهى القرآن من بيان شأن الكتاب وأثره في الهداية والإرشاد ، وتصوير حال المتقين الذين اهتدوا به ، وما اكتسبوه بالهداية من أوصاف سامية ، وما كان لهم على ذلك من خير العاقبة وحسن الجزاء ، أقول بعد أن انتهى من بيان كل ذلك شرع في بيان حال الكافرين ، وما هم عليه من سوء الحال وقبيح الأوصاف فقال :
( إِنَّ الذين كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ . . . )
يقول الله تعالى : ( أولئك ) أي : المتصفون بما تقدم : من الإيمان بالغيب ، وإقام الصلاة ، والإنفاق من الذي رزقهم الله ، والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل ، والإيقان بالدار الآخرة ، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات .
( على هدى ) أي : نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . ( وأولئك هم المفلحون ) أي : في الدنيا والآخرة .
وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( أولئك على هدى من ربهم ) أي : على نور من ربهم ، واستقامة على ما جاءهم ، ( وأولئك هم المفلحون ) أي : الذين أدركوا ما طلبوا ، ونجوا من شر ما منه هربوا .
وقال ابن جرير : وأما معنى قوله : ( أولئك على هدى من ربهم ) فإن معنى ذلك : أنهم على نور من ربهم ، وبرهان واستقامة وسداد ، بتسديد الله إياهم ، وتوفيقه لهم وتأويل قوله : ( وأولئك هم المفلحون ) أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله ، من الفوز بالثواب ، والخلود في الجنات ، والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب .
وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) الآية ، على ما تقدم من الخلاف . [ قال ] وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) منقطعا مما قبله ، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره ( [ أولئك على هدى من ربهم و ] أولئك هم المفلحون ) واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب ، لما رواه السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما الذين يؤمنون بالغيب ، فهم المؤمنون من العرب ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب . ثم جمع الفريقين فقال : ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة ، والإشارة عائدة عليهم ، والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهد ، وأبي العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، رحمهم الله .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له : يا رسول الله ، إنا نقرأ من القرآن فنرجو ، ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس ، أو كما قال . قال : فقال : أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) إلى قوله تعالى : ( المفلحون ) هؤلاء أهل الجنة . قالوا : إنا نرجو أن نكون هؤلاء . ثم قال : ( إن الذين كفروا سواء عليهم ) إلى قوله : ( عظيم ) هؤلاء أهل النار . قالوا : لسنا هم يا رسول الله . قال : أجل .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله جل ثناؤه بقوله: " أولئك على هدى من ربهم ": فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الصفتين المتقدمتين, أعني: المؤمنين بالغيب من العرب، والمؤمنين بما أنـزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله من الرسل. وإياهم جميعا وصف بأنهم على هدى منه، وأنهم هم المفلحون.
* ذكر من قال ذلك من أهل التأويل:
292- حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ , فهم المؤمنون من العرب, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ ، المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: " أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون " (85) .
وقال بعضهم: بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهم الذين يؤمنون &; 1-248 &; بما أنـزل إلى محمد, وبما أنـزل إلى من قبله من الرسل.
وقال آخرون: بل عنى بذلك الذين يؤمنون بما أنـزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم, وبما أنـزل إلى من قبله, وهم مؤمنو أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به, وكانوا مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتب.
وعلى هذا التأويل الآخر يحتمل أن يكون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ في محل خفض, ومحل رفع.
فأما الرفع فيه فإنه يأتيها من وجهين: أحدهما: من قبل العطف على ما في يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ من ذكر الَّذِينَ ، والثاني: أن يكون خبر مبتدأ, أو يكون " أولئك على هدى من ربهم "، مرافعها.
وأما الخفض فعلى العطف على " المتقين "، وإذا كانت معطوفة على الَّذِينَ اتجه لها وجهان من المعنى: أحدهما: أن تكون هي و الَّذِينَ الأولى، من صفة المتقين. وذلك على تأويل من رأى أن الآيات الأربع بعد الم ، نـزلت في صنف واحد من أصناف المؤمنين. والوجه الثاني: أن تكون " الَّذِينَ" الثانية معطوفة في الإعراب على " المتقين " بمعنى الخفض, وهم في المعنى صنف غير الصنف الأول. وذلك على مذهب من رأى أن الذين نـزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد قوله الم ، غير الذين نـزلت فيهم الآيتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين.
وقد يحتمل أن تكون " الَّذِينَ" الثانية مرفوعة في هذا الوجه بمعنى الائتناف (86) ، إذ كانت مبتدأ بها بعد تمام آية وانقضاء قصة. وقد يجوز الرفع فيها أيضا بنية الائتناف، إذ كانت في مبتدأ آية، وإن كانت من صفة المتقين.
فالرفع إذا يصح فيها من أربعة أوجه, والخفض من وجهين.
وأولى التأويلات عندي بقوله ( أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ) ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس, وأن تكون " أولئك " إشارة إلى الفريقين, أعني: المتقين، والذين يؤمنون بما أنـزل إليك, وتكون " أولئك " مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله " على هدى من ربهم "؛ وأن تكون " الذين " الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام، على ما قد بيناه.
وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية, لأن الله جل ثناؤه نعت الفريقين بنعتهم المحمود، ثم أثنى عليهم. فلم يكن عز وجل ليخص أحد الفريقين بالثناء، مع تساويهما فيما استحقا به الثناء من الصفات. كما غير جائز في عدله أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال، فيخص أحدهما بالجزاء دون الآخر، ويحرم الآخر جزاء عمله. فكذلك سبيل الثناء بالأعمال، لأن الثناء أحد أقسام الجزاء.
وأما معنى قوله ( أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ) فإن معنى ذلك: أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد، بتسديد الله إياهم، وتوفيقه لهم. كما:-
293- حدثني ابن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس،" أولئك على هدى من ربهم ": أي على نور من ربهم, واستقامة على ما جاءهم (87) .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
وتأويل قوله: " وأولئك هم المفلحون " أي أولئك هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله, من الفوز بالثواب, والخلود في الجنان, والنجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب. كما:-
294- حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, قال: حدثنا ابن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: ( وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) أي الذين أدْركوا ما طلبوا، ونجَوْا من شرّ ما منه هَرَبُوا.
ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح، إدراكُ الطَّلِبة والظفر بالحاجة، قول لبيد بن ربيعة:
اعْقِــلِي, إِنْ كُــنْتِ لَمَّــا تَعْقِـلِي,
وَلَقَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ كَـانَ عَقَـلْ (88)
يعني ظَفِر بحاجته وأصابَ خيرًا، ومنه قول الراجز:
عَــدِمتُ أُمــًّا ولَــدتْ رِياحــَا
جَــاءَتْ بِــهِ مُفَرْكَحــًا فِرْكَاحَـا (89)
تَحْسِــبُ أَنْ قَــدْ وَلَـدَتْ نَجَاحَـا!
أَشْـــهَدُ لا يَزِيدُهَـــا فَلاحَـــا
يعني: خيرًا وقربًا من حاجتها. والفلاحُ مصدر من قولك: أفلح فلان يُفلح إفلاحًا وفلاحًا وفَلَحًا. والفلاح أيضًا: البقاءُ, ومنه قول لبيد:
نَحُــلُّ بِــلادًا, كُلُّهَـا حُـلَّ قَبْلَنَـا
وَنَرْجُـو الْفَـلاحَ بَعْـدَ عَـادٍ وَحِـمْيَرِ (90)
يريد البقاء، ومنه أيضًا قول عَبيد:
أَفْلِحَ بِمَـا شِـئْتَ, فَقَـدْ يُدْرَكُ بِالضَّـ
ـعْـفِ, وَقَــدْ يُخْــدَعُ الأَرِيــبُ (91)
يريد: عش وابقَ بما شئت، وكذلك قول نابغة بني ذبيان:
وَكُــلُّ فَتًــى سَتَشْــعَبُهُ شَـعُوبٌ
وَإِنْ أَثْــرَى, وَإِنْ لاقَــى فَلاحــًا (92)
أي نجاحًا بحاجته وبَقاءً.
-------------------
الهوامش:
(85) الخبر 292- نقله ابن كثير 1 : 81 ، والشوكاني 1 : 26 . ونقله السيوطي 1 : 25 مطولا ، جمع معه الأخبار الماضية : 273 ، 277 ، 281 ، جعلها سياقا واحدا ، عن ابن مسعود وحده ، ونسبه للطبري .
(86) في المطبوعة : "الاستئناف" في هذا الموضع والذي يليه . وهما بمعنى .
(87) الخبر 293- ذكره ابن كثير 1 : 81 مع تتمته الآتية : 294 .
(88) ديوانه 2 : 12 ، والخطاب في البيت لصاحبته .
(89) البيت الثاني في اللسان (فركح) . والفركحة : تباعد ما بين الأليتين . والفركاح والمفركح منه ، يعني به الذم وأنه لا يطيق حمل ما يحمَّل في حرب أو مأثرة تبقى .
(90) ديوانه القصيدة رقم : 14 ، يرثى من هلك من قومه .
(91) ديوانه : 7 ، وفي المطبوعة والديوان"فقد يبلغ" ، وهما روايتان مشهورتان .
(92) من قصيدة ليست في زيادات ديوانه منها إلا أبيات ثلاثة ، ليس هذا أحدها . وشعوب : اسم للمنية والموت ، غير مصروف ، لأنها تشعب الناس ، أي تصدعهم وتفرقهم . وشعبته شعوب : أي حطمته من ألافه فذهبت به وهلك .
التدبر :
لمسة
[5] ﴿أُولَئِكَ﴾ للبعيد كأن هؤلاء أصحاب مرتبة عليا، فيشار إليهم بفلاحهم وعلو منزلتهم، فالذي على هدى هو مستعلٍ.
لمسة
[5] ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى﴾ أتى بحرف الاستعلاء (عَلَى) لأنهم تمكنوا من الهداية والتوفيق، فكأنهم استعلوا وركبوا الهدى وتمكنوا منه, وهذه هي الهداية الكاملة التي يُسعى إليها.
لمسة
[5] ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى﴾ (على) دائمًا تأتي مع الهدى، و(في) تأتي مع الضلال: فـ (على) مقصود بها الاستعلاء، (على الهدى) يعني متمكن مبصر لما حوله، في الطريق ثابت عليه، أما (في) للظرفية، (في) معناه ساقط فيه، لما يقول: ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [15] أي ساقطين فيه، والساقط في الشيء ليس كالمستعلي، ولذلك يستعمل (في) مع الريب والشك والطغيان والضلال.
لمسة
[5] ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ جاء بـ (أولئك) للبعيد وبضمير الفصل (هم) وجاء بالتعريف (المفلحون)، فلم يقل (أولئك مفلحون)، ولم يقل (هم مفلحون) للحصر، فهؤلاء هم المفلحون حصرًا، ليس هنالك مفلح آخر.
تفاعل
[5] ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المفلحين.
وقفة
[5] ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ عبر بالفلاح، ولم يعبر بالفائزين؛ لأن الفلاحة أمرٌ مشاهد للفلاحين الذين يرمون بذرهم في الأرض، فتعطيهم مائة حبة إلى سبعمائة ضعف، فهذا عطاء الأرض، وعطاء الله أكبر من عطائها، وهو شيء شاهدتموه في الأرض فكونوا على يقين من مشاهدته في الآخرة.
وقفة
[3-5] سعادتك بالفلاح، والفلاح لا يناله إلا من اتصف بهذه الصفات: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ أُولئِكَ عَلى هُدىً: ﴾
- أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف: للخطاب. على هدى: جار ومجرور وعلامة جرّ الاسم الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. ونكّر الاسم ليفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنهه.
- ﴿ مِنْ رَبِّهِمْ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بهدى أو بصفة محذوفة من «هُدىً» و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة. والجار والمجرور «عَلى هُدىً» متعلق بخبر «أُولئِكَ» المحذوف. ويجوز أن تكون «مِنْ» لابتداء الغاية على تقدير من هدى ربهم.
- ﴿ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: ﴾
- : الواو: عاطفة. أولئك: معطوفة على «أُولئِكَ» الأولى وتعرب إعرابها. هم: مبتدأ ثان. ضمير منفصل مبني في محل رفع. المفلحون: خبر «هُمُ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون تعويض عن تنوين المفرد. والجملة الاسمية «هُمُ الْمُفْلِحُونَ» في محل رفع خبر المبتدأ الأول «أُولئِكَ» ويجوز إعراب «هُمُ» ضمير فصل لا محل له أو عمادا وتكون «الْمُفْلِحُونَ» خبر «أُولئِكَ» وحركت الميم في «هُمُ» بالضم للاشباع أو لالتقاء الساكنين. '
المتشابهات :
| البقرة: 5 | ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ |
|---|
| لقمان: 5 | ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل صفات المتقين؛ ناسب هنا أن يذكر ثمرات التقوى، وهي: الهداية في الدنيا، والفلاح في الآخرة، قال تعالى:
﴿ أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء