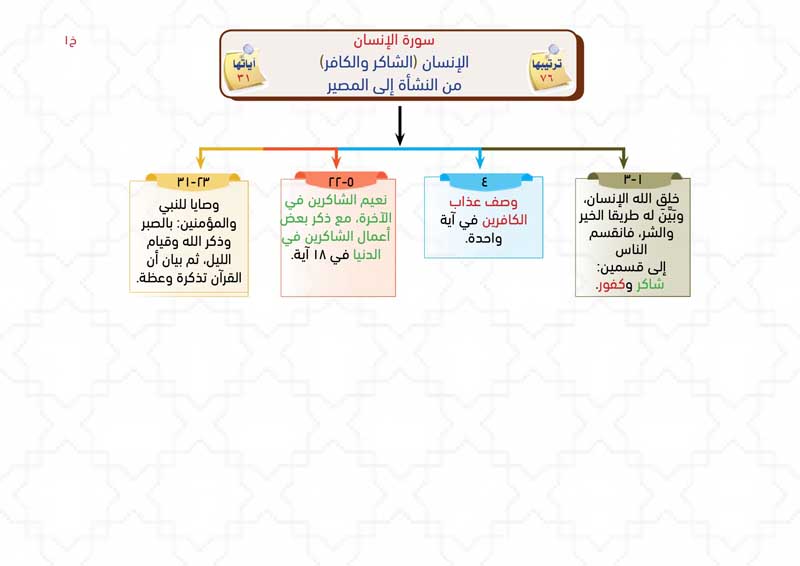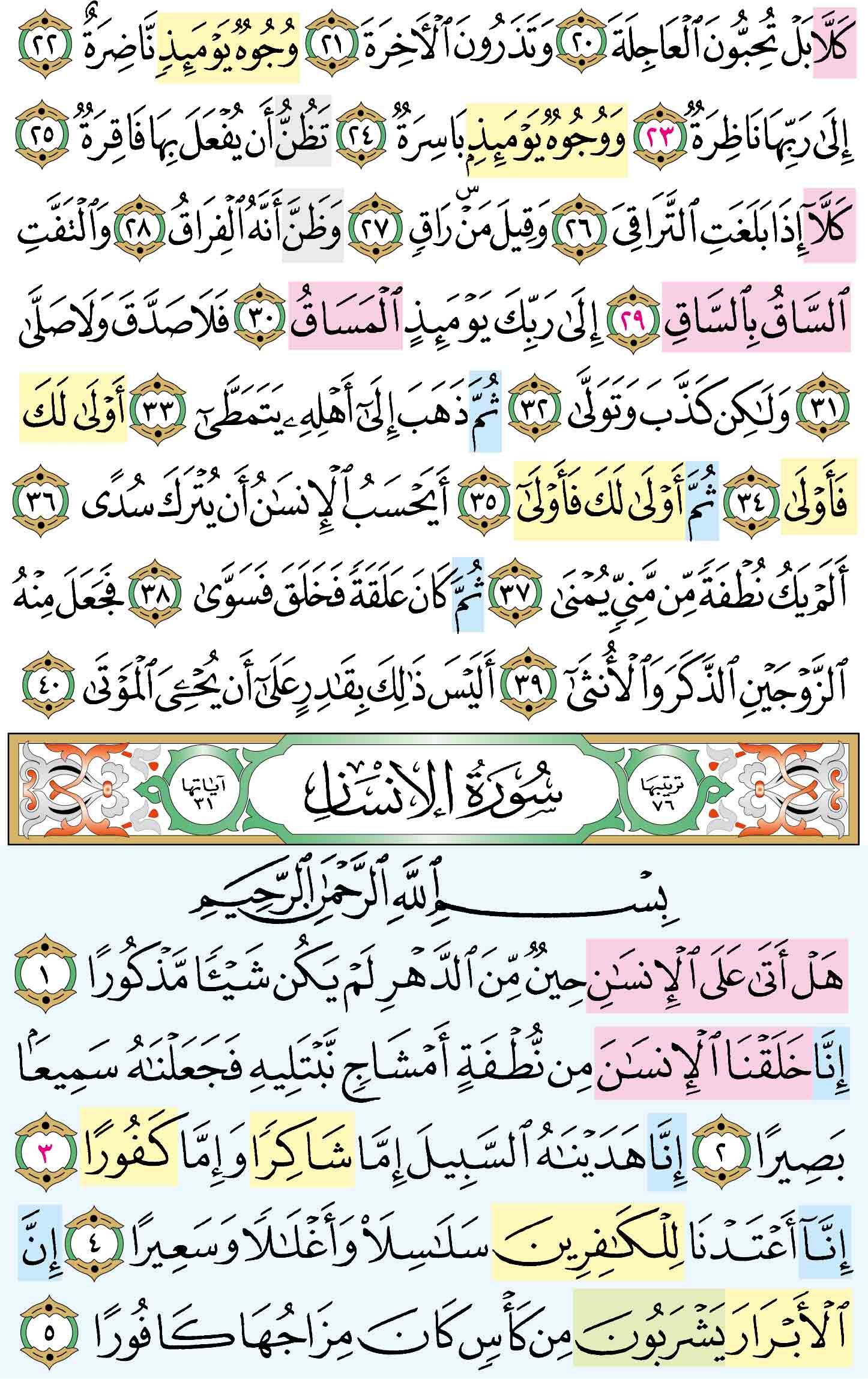
الإحصائيات
سورة القيامة
| ترتيب المصحف | 75 | ترتيب النزول | 31 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.20 |
| عدد الآيات | 40 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.55 |
| ترتيب الطول | 79 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| القسم: 5/17 | _ | ||
سورة الانسان
| ترتيب المصحف | 76 | ترتيب النزول | 98 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.00 |
| عدد الآيات | 31 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |
| ترتيب الطول | 65 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الاستفهام: 1/6 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (20) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (21)
سببُ إنكارِ البعثِ هو حبُّ الإنسانِ للدُّنيا وتركُ الآخرةِ، وانقسامُ النَّاسِ في الآخرةِ إلى فريقينِ، ووصفُ ما فيها من أهوالٍ، وأنَّه لابدَّ من الموتِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)
خلقَ اللهُ الإنسانَ، وبَيَّنَ له طريقَ الخيرِ وطريقَ الشرِّ، فانقسَمَ النَّاسُ إلى فئتينِ: شاكرٍ وكفورٍ، ثُمَّ ذكَرَ اللهُ جزاءَ الكافرينَ وجزاءَ الشاكرينَ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة القيامة
التذكير بيوم القيامة وأهوالها
أولاً : التمهيد للسورة :
- • ثم بيان أن القرآن موكول حفظه وبيانه إلى الله عز وجل:: رسالة السورة واضحة من اسمها: تذكير الناس بيوم القيامة والاستعداد للوقوف بين يديه.فأول كلماتها: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (1-4).
- • ثم الختام: • ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (16-19). • ثم بيان انقسام الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياء، وبيان أحوالهم: (20)- (25).ثم التذكير بالموت والنهاية، وبيان حال المرء وقت الاحتضار: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ * وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ * إِلَىٰ رَبّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ﴾ (26-35).
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «القيامة».
- • معنى الاسم :: القيامة هو اسم من أسماء الآخرة، حيث يقوم الناس من قبورهم للحساب.
- • سبب التسمية :: للِوُقُوعِ الْقَسَمِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي أَوَّلِهَا.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ لَا أُقْسِمُ»، «سُورَةُ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ لافتتاحها به.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الاستعداد ليوم القيامة.
- • علمتني السورة :: لأهمية محاسبة النفس: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾
- • علمتني السورة :: أن كل نفس تلوم صاحبها يوم القيامة: إن كان مؤمنًا لامته على عدم الزيادة من الخير، وإن كان كافرًا لامته على عدم الإيمان بالله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾
- • علمتني السورة :: أنه لا مفر من الله إلا إلى الله: ﴿يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ * كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرّ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة القيامة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة القيامة من المفصل.
• سورة القيامة من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القيامة مع سورة الإنسان، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة القيامة، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (40)، وما شابه ذلك من القرآن أن يقول: (سبحانك فبلى) أو (بلى)؛ فعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّى فَوْقَ بَيْتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتَى﴾، قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
• وهذا من باب التفاعل مع القرآن الكريم، حيث يستحضر القارئ أو المستمع أنه مخاطب بهذا القرآن.
• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعد ليوم القيامة، ونجتهد في العمل الصالح.
• أن نعاتب أنفسنا ونحاسبها قبل أن نندم: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (2).
• أن نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (13).
• أن نعلم أن أعمالنا مستنسخة في كتبنا، وأننا شهود على أنفسنا، ولا تقبل الأعذار يوم القيامة: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ * بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ (13-15).
• أن نتبع القرآن ونعمل به: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (18).
• أن ندعو الله: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (20، 21).
• أن نحرص على الأعمال التي تجعلنا في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (22، 23).
• أن نحذر من صفات أهل النار، التي اجتمعت في تكذيب الله ورسوله، والتولي والإعراض عن طاعتهما: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (31، 32).
سورة الانسان
الإنسان (الشاكر والكافر) من النشأة إلى المصير
أولاً : التمهيد للسورة :
- • والختام بوصايا للنبي ﷺ والمؤمنين:: رسورة الإنسان تقول لنا: • الإنسان يختار مصيره، ويتحمل نتيجة اختياره.خلق الله الإنسان: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (1، 2). وبَيَّنَ له طريقي الخير والشر؛ فانقسم الناس إلى قسمين: شاكرٍ وكفورٍ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).فذكر الله جزاء الكافرين في آية واحدة فقط: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ (4). وفي 18 آية بَيَّنَ جزاء الشاكرين وأعمالهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ...﴾ (5-22). • وذلك: للمقارنة بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر، وشحذ همة أسمى المخلوقات (الإنسان) للوصول إلى أسمى الغايات «الجنة».
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الإنسان».
- • معنى الاسم :: --
- • سبب التسمية :: لافتتاحها بذكر الإنسان.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ هَلْ أَتَى»، و«سُورَةُ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»، و«الدَّهْرِ» و«الأمشاج» و«الأبرار»؛ لذكر هذه الألفاظ بها.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: رحلة الإنسان من العدم إلى دار الخلود، مع ما يتخلل ذلك من ترغيب وترهيب.
- • علمتني السورة :: مهما علا نسبك فأصلك: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾
- • علمتني السورة :: أن الله خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
- • علمتني السورة :: بَيَّنَ اللهُ لك طريق الخير والشر؛ فاختر لنفسك طريق النجاة: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ)».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة الإنسان من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة الإنسان من المفصل.
• سورة الإنسان من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الإنسان مع سورة القيامة، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الإنسان هي أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الاستفهام، وعدد السور التي افتتحت بالاستفهام ست سور، وهي: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والشرح، والفيل، والماعون، وكلها مكية وفي المفصل.
• اشتملت سورة الإنسان على وصف مطول للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة، استغرق 18 آية، فهي تعتبر من أكثر السور وصفًا لنعيم أهل الجنة بعد سورتي: الرحمن والواقعة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نقارن بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر.
• أن نتفكر في خلق الإنسان: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (2).
• أن نسأل الله الهداية دائمًا: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).
• أن نوفي بالنذر إذا نذرنا: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (7).
• أن نجاهد أنفسنا أن تكون أقوالنا وأفعالنا وشأننا كله لله فقط: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (9).
• أن نتذكر إذا اشتدَّ البرد: ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (13)، ثم نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة.
• أن نتفكر في نعيم أهل الجنة: ﴿إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾ (22).
• أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء وغيرها: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (25، 26).
• أن نسأل الله أن يدخلنا في رحمته: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (31).
أن نقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.
تمرين حفظ الصفحة : 578
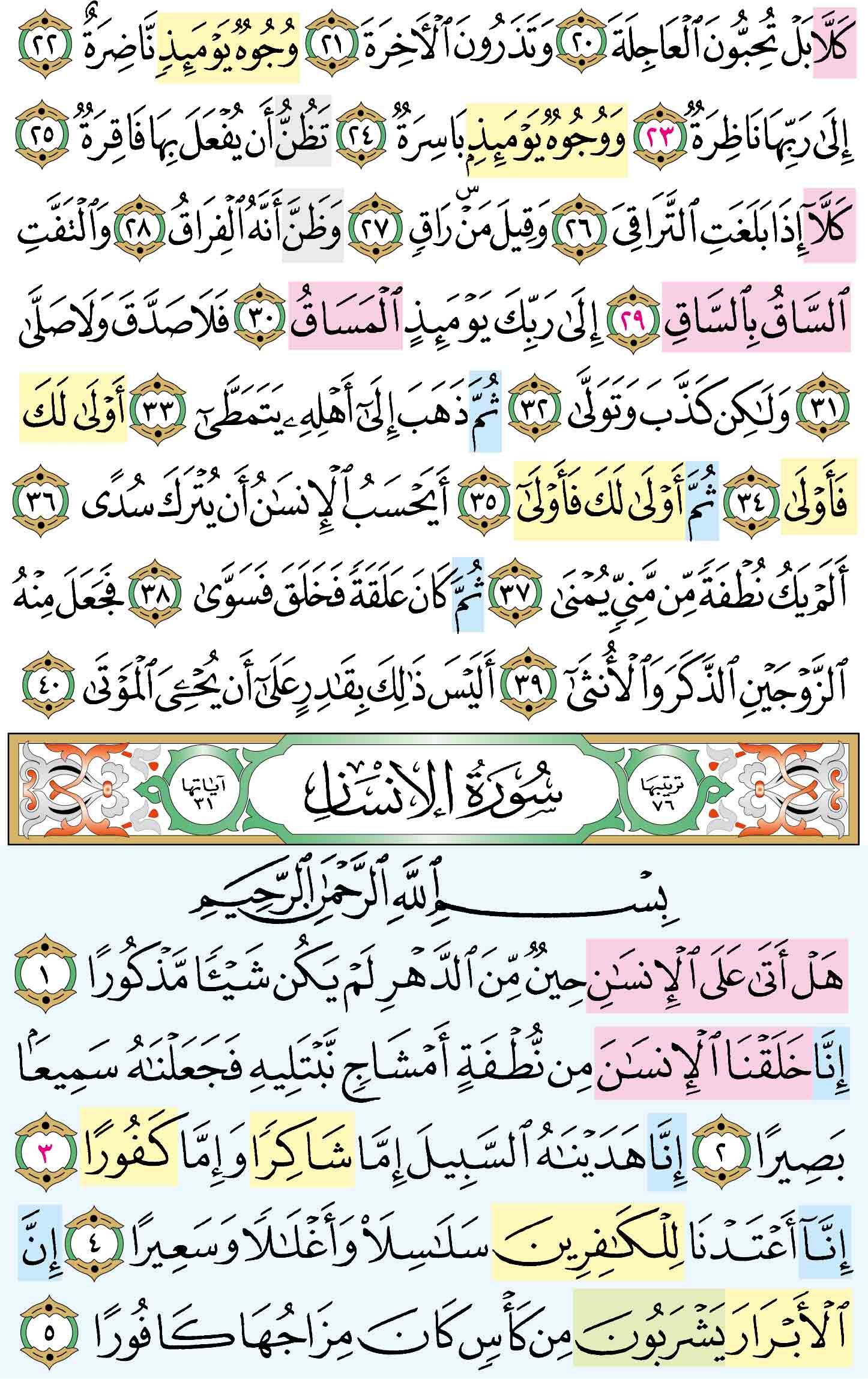
مدارسة الآية : [20] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾
التفسير :
أي:هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم{ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} وتسعون فيما يحصلها، وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها، كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار، التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا، ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم، وربحتم ربحا لا خسار معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه.
وقوله- سبحانه- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ بيان لما جبل عليه كثير من الناس، من إيثارهم منافع الدنيا الزائلة، على منافع الآخرة الباقية، وزجر ونهى لهم عن سلوك هذا المسلك، الذي يدل على قصر النظر، وضعف التفكير.
أى: كلا- أيها الناس- ليس الرشد في أن تتركوا العمل الصالح الذي ينفعكم يوم القيامة، وتعكفوا على زينة الحياة الدنيا العاجلة.. بل الرشد كل الرشد في عكس ذلك، وهو أن تأخذوا من دنياكم وعاجلتكم ما ينفعكم في آخرتكم، كما قال- سبحانه-: وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا.
وشبيه بهاتين الآيتين قوله- تعالى- إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا
أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) يقول: حلاله وحرامه، فذلك بيانه.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) بيان حلاله، واجتناب حرامه، ومعصيته وطاعته.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم إن علينا تبيانه بلسانك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) قال: تبيانه بلسانك.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[20] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ قال الرازي: «خُلِقتم من عجّل، وطبعتم عليه، تعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة».
اسقاط
[20، 21] ﴿كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ * وَتَذَرونَ الآخِرَةَ﴾ الخيار لك، أيهما تحب؟
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ قال قتادة: «اختار أكثر الناس العاجلة، إلا من رحم الله وعصم».
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ من جعل الدنيا همَّه؛ آتاه الله إن شاء من طيباتها، وعجَّل له من بهارجها، وحَرَمَه من بركات الآخرة، ومن النجاة فيها.
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل.
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ اختيار (وَتَذَرُونَ) على (تَدَعون) له سببه؛ ذلك أن الفعل (وذر) في عموم معانيه يفيد الذم، والموقف موقف ذم، فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فاختار الفعل الذي يقال في عموم معانيه للذم، وهو اختيار فَنيٌّ رفيع.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا بَلْ: ﴾
- حرف ردع وزجر أي ردع عن عادة العجلة وانكار لها. بل: حرف اضراب للاستئناف.
- ﴿ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. العاجلة: مفعول به منصوب بالفتحة أو تكون صفة لموصوف- مفعول به- محذوف. أي الحياة العاجلة أي تعجلون في كل شيء.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [20] لما قبلها : وبعد هذه الآيات الأربع المتعلقة بحفظ القرآن وتلاوته وتدبر معانيه؛ تعود الآيات إلى حالِ الإنسانِ السَّابقِ ذِكرُه المنكِرِ البَعثَ، فذكرَ اللهُ السببَ في إنكار البعث، وهو حبُّ بنى آدم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء، قال تعالى:
﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
تحبون:
1- بتاء الخطاب، لكفار قريش، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- يحبون، بياء الغيبة، وهى قراءة مجاهد، والحسن، وقتادة، والجحدري، وابن كثير، وأبى عمرو.
مدارسة الآية : [21] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾
التفسير :
أي:هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم{ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} وتسعون فيما يحصلها، وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها، كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار، التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا، ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم، وربحتم ربحا لا خسار معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه.
وقوله- سبحانه- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ بيان لما جبل عليه كثير من الناس، من إيثارهم منافع الدنيا الزائلة، على منافع الآخرة الباقية، وزجر ونهى لهم عن سلوك هذا المسلك، الذي يدل على قصر النظر، وضعف التفكير.
أى: كلا- أيها الناس- ليس الرشد في أن تتركوا العمل الصالح الذي ينفعكم يوم القيامة، وتعكفوا على زينة الحياة الدنيا العاجلة.. بل الرشد كل الرشد في عكس ذلك، وهو أن تأخذوا من دنياكم وعاجلتكم ما ينفعكم في آخرتكم، كما قال- سبحانه-: وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا.
وشبيه بهاتين الآيتين قوله- تعالى- إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا
إنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة.
يقول تعالى ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم، ولا تجازون بأعمالكم، لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة، وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تومنون بالعاجلة، وتكذّبون بالآجلة.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ أقلُّ درجات حب الدنيا أن يُشغِل عن أعظم سعادة للعبد، وهو تفريغ قلبه لحب الله، ولسانه لذكره، فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا.
لمسة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ لم يقل: (وتكرهون الآخرة)، فمُجرَّدُ الانشغال عن الآخرة مذموم، ولو لم نكرهها بالقلوب! إنه توبيخٌ للكُسالى!
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة.
تفاعل
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ادع الله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي.
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ليس كل حب للدنيا مذمومًا، إنما يُذم من الدنيا ما أضرّ بالآخرة.
وقفة
[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ لم أحَبّ الدنيا؟! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما يُنتقي أطايب الثمَر».
وقفة
[20، 21] من رام فهم كتاب الله؛ ليقبل على الآخرة وليحذر من التعلق بالدنيا ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية السابقة وتعرب اعرابها. أي وتتركون الحياة الآخرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [21] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ السببَ في إنكار البعث، وهو حبُّ بني آدم للحياة الدنيا؛ أتبعه بإعراضهم عن الحياة الآخرة، قال تعالى:
﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
وتذرون:
1- بتاء الخطاب، لكفار قريش، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- ويذرون، بياء الغيبة، وهى قراءة مجاهد، والحسن، وقتادة، والجحدري، وابن كثير، وأبى عمرو.
مدارسة الآية : [22] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴾
التفسير :
ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة، ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا:{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} أي:حسنة بهية، لها رونق ونور، مما هم فيه من نعيم القلوب، وبهجة النفوس، ولذة الأرواح،
ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.
وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.
وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.
والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.
والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.
والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.
والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.
وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.
وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ) اختار أكثر الناس العاجلة، إلا من رحم الله وعصم.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ النضارة ليست اليوم، بل في ذلك اليوم، ومعايير الآخرة تختلف عن معايير الدنيا، فكم من ضاحك هنا باكي هناك! وقد يبكي هنا من يضحك هناك، والعبرة بمن يضحك في الآخرة.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ إن روح الإنسان لتستمتع بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس، فكيف بها وهي تنظر -لا إلى جمال صنع الله- ولكن إلى جمال ذات الله؟ ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من الله، ويحتاج ثانيًا إلى تثبيت من الله؛ ليملك الإنسان نفسه، فيثبت، ويستمتع بالسعادة التي لا يحبط بها وصف، ولا يتصور حقيقتها إدراك!
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قال الحسن البصري: «تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تُنَضَّر وهي تنظر إلى الخالق».
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤية.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ كل ألم تشعر به في جسدك، في قلبك، في مشاعرك، كل لمة حزن تطيف بك، كل أصناف الآلام وتنوعها، ففي الجنة من السعادة ضدها.
وقفة
[22، 23]﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ حقًّا إن هذه الآية تزهدك بكل جمال ونعيم ومتعة في الدنيا.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ عينٌ سترى ربها يوما ما بإذن الله، شرِّفها بألا تنظر لحرام واغسلها بدموع التوبة إجلالًا لله.
وقفة
[22، 23]﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تُنَضَّر وهي تنظر إلى الخالق.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ يبتهج الإنسان وتنفرج أساريره حين ينظر إلى شئ جميل، فكيف إذاكان النظر لخالق الجمال.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أحسَنوا في الدنيا الأعمال فاستحقوا في الآخرة الجمال والنظر لذي الجمال والجلال.
تفاعل
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أجملُ لقاء، هذا النعيمُ وكفى.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أطيب ما في الدنيا معرفة الله، وأطيب ما في الآخرة النظر إلى الله.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أيها المهموم، أيها المغموم، أيها المريض، أيها المبتلى: كل هذه المآسي تذوب عند أول نظرة لوجه ربك.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ تلك الوجوه قد تكون في الدنيا بخلاف ما هي عليه في الآخرة، معايير الآخرة مختلفة، لا تبتئس ولا تغتر.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أي عمل فعلوه فأرضاه حتى يروه سبحانه! كيف كانت قلوبهم ليكون هذا جزاؤهم، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر الى وجهك الكريم.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ عن محمد بن كعب القُرَظيّ قال: «نَضَّر الله تلك الوجوهَ وحسَّنها للنظر إليه»، فإذا كان هذا حالَ الوجوه، فكيف حالُ القلوب؟ لقد مُلئت من السرور والفرح بما لا تحيطُ به عبارة.
عمل
[22، 23] حرص على الأعمال التي تجعل المؤمن في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.
وقفة
[22، 23] إن في اليوم الآخر لموعدًا يملؤه ضياء ونورًا، موعدًا عمل له الأنبياء والصديقون! وتعلق به العاملون أولًا وآخرًا! إنه: رؤية الله ذي الجلال والجمال! ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.
وقفة
[22، 23] أعظم نعيم الجنة رؤية الله حينما يكشِف عن وجهه لعباده فيها ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾؛ يارب لا تحرمنا فضلك.
وقفة
[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ دليل على أن المؤمنين يرونه يومئذ».
الإعراب :
- ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ: ﴾
- مبتدأ مرفوع بالضمة. يومئذ: سبق اعرابها.أي يوم القيامة. ناضرة: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة أو تكون صفة- نعتا- لوجوه. ويكون خبر المبتدأ «وجوه» ناظرة في الآية الكريمة التالية.و«ناضرة» أي حسنة بهية.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ الآخِرةَ الَّتي أعرَضوا عنها؛ ذكَرَ ما يكونُ فيها؛ بيانًا لِجَهْلِهم وسَفَهِهم وقِلَّةِ عُقولِهم، وترهيبًا لِمَن أدبَرَ عنها، وترغيبًا لِمَن أقبَلَ عليها؛ لُطفًا بهم، ورحمةً لهم، قال تعالى:
﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
ناضرة:
1- بألف، وهى قراءة الجمهور.
قرئ:
2- نضرة، بغير ألف، وهى قراءة زيد بن على.
مدارسة الآية : [23] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾
التفسير :
{ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} أي:تنظر إلى ربهاعلى حسب مراتبهم:منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر، الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم.
ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.
وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.
وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.
والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.
والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.
والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.
والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.
وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.
وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
وقد أخذ العلماء من قوله- تعالى-: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ أن الله- تعالى- يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها- سبحانه-.
ومنهم من فسر ناظِرَةٌ بمعنى منتظرة، أى: منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله- تعالى- به عليها.
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل-في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. لحديث أبى سعيد وأبى هريرة- وهما في الصحيحين- أن ناسا قالوا:
يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» .
ثم قال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا- بحمد الله- مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام.
ومن تأول إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ فقال: تنتظر الثواب من ربها.. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله- تعالى- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.
قال الشافعى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه- عز وجل-.. .
( إلى ربها ناظرة ) أي : تراه عيانا ، كما رواه البخاري ، رحمه الله ، في صحيحه : " إنكم سترون ربكم عيانا " . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح ، من طرق متواترة عند أئمة الحديث ، لا يمكن دفعها ولا منعها ; لحديثأبي سعيد وأبي هريرة - وما في الصحيحين - : أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : " هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ " قالوا : لا . قال : " فإنكم ترون ربكم كذلك " . وفي الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال : " إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا " وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن " . وفي أفراد مسلم ، عن صهيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة " قال : " يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ " قال : " فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ، وهي الزيادة " . ثم تلا هذه الآية : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [ يونس : 26 ] .
وفي أفراد مسلم ، عن جابر في حديثه : " إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك " - يعني في عرصات القيامة - ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات ، وفي روضات الجنات .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبد الملك بن أبجر ، حدثنا ثوير بن أبي فاختة ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي سنة ، يرى أقصاه كما يرى أدناه ، ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين " .
ورواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن شبابة ، عن إسرائيل ، عن ثوير قال : " سمعت ابن عمر . . " . فذكره ، قال : " ورواه عبد الملك بن أبجر ، عن ثوير ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قوله " . وكذلك رواه الثوري ، عن ثوير ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، لم يرفعه ، ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن ، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير ، وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام .
ومن تأول ذلك بأن المراد ب ) إلى ) مفرد الآلاء ، وهي النعم ، كما قال الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد : ( إلى ربها ناظرة ) فقال تنتظر الثواب من ربها . رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضا - فقد أبعد هذا القائل النجعة ، وأبطل فيما ذهب إليه . وأين هو من قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ؟ [ المطففين : 15 ] ، قال الشافعي ، رحمه الله : ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل . ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة ، وهي قوله : ( إلى ربها ناظرة ) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا آدم ، حدثنا المبارك ، عن الحسن : ( وجوه يومئذ ناضرة ) قال : حسنة ، ( إلى ربها ناظرة ) قال تنظر إلى الخالق ، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق .
وقوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة ناضرة: يقول حسنة جميلة من النعيم؛ يقال من ذلك: نَضُر وجه فلان: إذا حَسُن من النعمة، ونضَّرَ الله وجهه: إذا حسَّنه كذلك.
واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بالذي قلنا فيه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا آدم، قال: ثنا المبارك، عن الحسن ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: حسنة.
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: نُضرة الوجوه: حُسنها.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: الناضرة: الناعمة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: الوجوه الحسنة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: من السرور والنعيم والغبطة.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنها مسرورة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهد، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: مسرورة ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) .
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: أنها تنظر إلى ربها.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[23] ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قال الحسن البصري: «لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة؛ لذابت أنفسهم في الدنيا».
وقفة
[23] كم شعرنا بالسعادة لرؤية شيئ جميل وعشنا ذكراه زمن طويل، فكيف برؤية خالق الجمال؟! رب أكرمنا بشرف ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.
وقفة
[23] كان ابن عمر، يقول: «أكرَمُ أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»، ثم تلا هذه الآية: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ: ﴾
- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر ثان للمبتدأ «وجوه» أو تكون «ناظرة» خبرا ثانيا لوجوه والجار والمجرور «إِلى رَبِّها» متعلقا بناظرة.إلى رب: جار ومجرور. و «ها» ضمير متصل في محل رفع خير مقدم. ناظرة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [23] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن وجوههم مشرقة بَهِيَّة لها نور؛ ذكرَ هنا ما تسبب في كونهم بهذه الهيئة، وهو النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، قال تعالى:
﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [24] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾
التفسير :
وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة:{ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ} أي:معبسة ومكدرة، خاشعة ذليلة.
ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.
وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.
وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.
والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.
والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.
والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.
والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.
وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.
وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
وقد أخذ العلماء من قوله- تعالى-: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ أن الله- تعالى- يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها- سبحانه-.
ومنهم من فسر ناظِرَةٌ بمعنى منتظرة، أى: منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله- تعالى- به عليها.
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل-في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. لحديث أبى سعيد وأبى هريرة- وهما في الصحيحين- أن ناسا قالوا:
يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» .
ثم قال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا- بحمد الله- مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام.
ومن تأول إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ فقال: تنتظر الثواب من ربها.. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله- تعالى- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.
قال الشافعى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه- عز وجل-.. .
وقوله : ( وجوه يومئذ باسرة ) هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدي : تغير ألوانها . وقال ابن زيد ( باسرة ) أي : عابسة .
حدثنا محمد بن منصور الطوسي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحويّ، عن عكرِمة قال: ( تنظر إلى ربها نظرا ) .
حدثتا محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: أخبرني الحسين بن واقد في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) من النعيم ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: أخبرني يزيد النحوي، عن عكرِمة وإسماعيل بن أبي خالد، وأشياخ من أهل الكوفة، قال: تنظر إلى ربها نظرا.
حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا آدم قال: ثنا المبارك عن الحسن، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: حسنة ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق.
حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عرفجة، عن عطية العوفي، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم، فذلك قوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ .
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها تنتظر الثواب من ربها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن منصور، عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر منه الثواب.
قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب من ربها.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور عن مجاهد ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب من ربها، لا يراه من خلقه شيء.
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن الأعمش، عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: نضرة من النعيم ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر رزقه وفضله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان أناس يقولون في حديث: " فيرون ربهم " فقلت لمجاهد: إن ناسا يقولون إنه يرى، قال: يَرى ولا يراه شيء.
قال ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر من ربها ما أمر لها.
حدثني أبو الخطاب الحساني، قال: ثنا مالك، عن سفيان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: " إن أدنى أهل الجنة منـزلة لمن ينظر إلى مُلكِه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفع أهل الجنة منـزلة لمن ينظر إلى وجه الله بُكرة وعشية " .
قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا أشجع، عن أبي الصهباء الموصلي، قال: " إن أدنى أهل الجنة منـزلة، من يرى سرره وخدمه ومُلكهُ في مسيرة ألف سنة، فيرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منـزلة، من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية ".
وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرِمة، من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حدثني عليّ بن الحسين بن أبجر، قال: ثنا مصعب بن المقدام، قال: ثنا إسرائيل بن يونس، عن ثوير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ أدْنى أهْلِ الجَنَّةِ مَنـزلَةً، لَمَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ ألْفَيْ سَنَةٍ، قال: وإنَّ أفضَلَهُمْ مَنـزلَةً لَمَن يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ كُلَّ يَوْم مَرَّتَينِ ; قال: ثم تلا( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: بالبياض والصفاء، قال: ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنظر كلّ يوم في وجه الله عزّ وجلّ".
وقوله: ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: ووجوه يومئذ متغيرة &; 24-74 &; الألوان، مسودة كالحة، يقال: بسرت وجهه أبسره بسًرا: إذا فعلت ذلك، وبسر وجهه فهو باسر بيِّن البسور.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( باسِرَةٌ ) قال: كاشرة.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[24] ﴿وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ باسِرَةٌ﴾ لا تعبس مهما ضاقت بك الأرض.
وقفة
[22-24] لا للغرور، قال ابن عقيل: «تسمع ﴿وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ باسِرَةٌ﴾، فتهش لها كأنها فيك نزلت، وتسمع بعدها: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾، فتطمئن أنها لغيرك، ومن أين ثبت هذا الأمر؟ ومن أين جاء الطمع؟ الله، الله، وما هذه إلا خدعة تحول بينك وبين التقوى».
وقفة
[24، 25] ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ قال الرازي: «والظن هنا بمعنى اليقين، هكذا قاله المفسرون، وعندي أن الظن إنما ذكِر هنا على سبيل التهكم؛ كأنه قيل: إذا شاهدوا تلك الأحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق».
تفاعل
[24، 25] ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الثانية والعشرين وتعرب اعرابها. و «باسرة» شديدة العبوس. أي مقطبة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [24] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ أهلَ النِّعْمةِ؛ أتْبَعَه أضْدادَهم مِن أهلِ النِّقْمةِ، قال تعالى:
﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [25] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾
التفسير :
{ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ} أي:عقوبة شديدة، وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست.
ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.
وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.
وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.
والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.
والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.
والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.
والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.
وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.
وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
وقد أخذ العلماء من قوله- تعالى-: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ أن الله- تعالى- يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها- سبحانه-.
ومنهم من فسر ناظِرَةٌ بمعنى منتظرة، أى: منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله- تعالى- به عليها.
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل-في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. لحديث أبى سعيد وأبى هريرة- وهما في الصحيحين- أن ناسا قالوا:
يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» .
ثم قال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا- بحمد الله- مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام.
ومن تأول إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ فقال: تنتظر الثواب من ربها.. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله- تعالى- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.
قال الشافعى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه- عز وجل-.. .
( تظن ) أي : تستيقن ، ( أن يفعل بها فاقرة ) قال مجاهد : داهية . وقال قتادة : شر . وقال السدي : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار .
وهذا المقام كقوله : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) [ آل عمران : 106 ] وكقوله ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) [ عبس : 38 - 42 ] وكقوله ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) إلى قوله : ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ) [ الغاشية : 2 - 10 ] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ) أي: كالحة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( باسِرَةٌ ) قال: عابسة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( باسِرَةٌ ) قال: عابسة.
التدبر :
وقفة
[25] ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ ما ظنت أنه يفعل بها فاقرة, الداهية العظيمة, إلا أنها تذكرت طوامًا عملتها, وجاءت بالظن ﴿تَظُنُّ﴾ دون القطع والعلم؛ لأنها تحسن الظن برحمة ربها العظيم في تلك الساعة.
لمسة
[25] ﴿تَظُنُّ أَن يُفعَلَ بِها فاقِرَةٌ﴾ الظن هنا بمعنى التيقن من الأمر، سلم يا رب سلم.
الإعراب :
- ﴿ تَظُنُّ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل رفع صفة- نعت- لباسرة وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. بمعنى: تتوقع
- ﴿ أَنْ يُفْعَلَ: ﴾
- حرف مصدرية ونصب. يفعل: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ بِها فاقِرَةٌ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيفعل. فاقرة: نائب فاعل مرفوع بالضمة أو صفة- نعت- لنائب فاعل موصوف تقديره: فعلة فاقرة أي داهية تكسر فقار ظهرها فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. وجملة «يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «تظن». أو سد مسد مفعوليها.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [25] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ أن وجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة؛ بَيَّنَ هنا سبب عبوسها، قال تعالى:
﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [26] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ﴾
التفسير :
يعظ تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب، ويطلب كل وسيلة وسبب، يظن أن يحصل به الشفاء والراحة،
ثم زجر- سبحانه- الذين يكذبون بيوم الدين، ويؤثرون العاجلة على الآجلة، زجرهم بلون آخر من ألوان الردع والزجر، حيث ذكرهم بأحوالهم الأليمة عند ما يودعون هذه الدنيا فقال: كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ وَقِيلَ مَنْ راقٍ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ.
والضمير في بَلَغَتِ يعود إلى الروح المعلومة من المقام. كما في قوله- تعالى- فَلَوْلا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.. ومنه قول الشاعر:
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
والتراقي: جمع ترقوة، وهي العظام المحيطة بأعالى الصدر عن يمينه، وعن شماله، وهي موضع الحشرجة، وجواب الشرط محذوف.
أى: حتى إذا بلغت روح الإنسان التراقي، وأوشكت أن تفارق صاحبها.. وجد كل إنسان ثمار عمله الذي عمله في دنياه، وانكشفت له حقيقة عاقبته.
والمقصود من الآية الكريمة وما بعدها: الزجر عن إيثار العاجلة على الآجلة.
فكأنه- تعالى- يقول: احذروا- أيها الناس- ذلك قبل أن يفاجئكم الموت، وقبل أن تبلغ أرواحكم نهايتها، وتنقطع عند ذلك آمالكم.
يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال - ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت - فقال تعالى : ( كلا إذا بلغت التراقي ) إن جعلنا ) كلا ) رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به ، بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى ( حقا ) فظاهر ، أي : حقا إذا بلغت التراقي ، أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك ، والتراقي : جمع ترقوة ، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق ، كقوله : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ) [ الواقعة : 83 - 87 ] . وهكذا قال هاهنا : ( كلا إذا بلغت التراقي ) ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحاش الذي تقدم في سورة " يس " . والتراقي : جمع ترقوة ، وهي قريبة من الحلقوم .
وقوله: ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: تعلم أنه يفعل بها داهية، والفاقرة: الداهية.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) قال: داهية.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) أي: شرّ.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، في قوله: ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) قال: تظن أنها ستدخل النار، قال: تلك الفاقرة، وأصل الفاقرة: الوسم الذي يُفْقَر به على الأنف.
التدبر :
وقفة
[26] ما هي معاني لفظة (كلا) الواردة في القرآن الكريم؟ الجواب: (كلا) وردت في 33 موضعًا في القرآن، وهي بمعنى الردع والزجر في معظم المواضع، وتأتي بمعنى التهديد والوعيد.
وقفة
[26، 27] ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ قال ابن عباس: «إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر، فيقول ملك الموت: من يرقى بهذا الكافر؟».
وقفة
[26، 27] ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ يظل الإنسان متشبثًا بالحياة حتى وهو يصارع الموت.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا إِذا: ﴾
- حرف ردع وزجر أي ردع عن ايثار الدنيا على الآخرة بمعنى: ارتدعوا عن ذلك. اذا: ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب. أو هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه أو في محل نصب بباسرة.
- ﴿ بَلَغَتِ التَّراقِيَ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة. بلغت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على الروح أو النفس وان لم يجر لها ذكر لأن الكلام الذي وقعت منه يدل عليها. التراقي. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهي جمع ترقوة: وهي أعالي الصدر أي العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [26] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعظيمَ أحوالِ الآخِرةِ؛ بَيَّنَ أنَّ الدُّنيا لا بدَّ فيها مِن الانتهاءِ والنَّفادِ، والوُصولِ إلى تجَرُّعِ مرارةِ الموتِ، قال تعالى:
﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [27] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾
التفسير :
{ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ} أي:من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق إلا الأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر، إذا حتم وجاء فلا مرد له،
وقوله- سبحانه-: وَقِيلَ مَنْ راقٍ
بيان لما يقوله أحباب الإنسان الذي بلغت روحه التراقي، على سبيل التحسر والتوجع واستبعاد شفائه. ومَنْ
اسم استفهام مبتدأ. وراقٍ
خبره، وهو اسم فاعل من الرّقية، وهي كلام يقوله القائل، أو فعل يفعله الفاعل من أجل شفاء المريض. والمراد به هنا: مطلق الطبيب الذي يرجى على يديه الشفاء لهذا المحتضر.
أى: اذكروا- أيها الناس- وقت بلوغ الروح نهايتها، ووقت أن وقف من يهمهم أمر المريض مستسلمين لقضاء الله- تعالى- وملتمسين من كل من بيده شفاء مريضهم، أن يتقدم لإنقاذه مما هو فيه من كرب، ولكنهم لا يجدون أحدا يحقق لهم آمالهم.
قال الآلوسى: قوله وَقِيلَ مَنْ راقٍ
أى: وقال من حضر صاحبها، من يرقيه وينجيه مما هو فيه، من الرقية، وهو ما يستشفى به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك، ولعله أريد به مطلق الطبيب، أعم من أن يطب بالقول أو بالفعل.. والاستفهام عند البعض حقيقى. وقيل: هو استفهام استبعاد وإنكار. أى: قد بلغ هذا المريض مبلغا لا أحد يستطيع أن يرقيه.
وقيل هذا الكلام من كلام ملائكة الموت. أى: أيكم يرقى بروحه، أملائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب، من الرقى وهو العروج. والاستفهام عليه حقيقى.
ووقف حفص رواية عن عاصم على مَنْ
وابتدأ بقوله: راقٍ
وكأنه قصد أن لا يتوهم أنهما كلمة واحدة، فسكت سكتة لطيفة، لتشعر أنهما كلمتان .
( وقيل من راق ) قال : عكرمة ، عن ابن عباس : أي من راق يرقي ؟ وكذا قال أبو قلابة : ( وقيل من راق ) أي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي ، حدثنا عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس : ( وقيل من راق ) قال : قيل : من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة .
يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها.
وقال ابن زيد في قول الله: ( كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ) قال: التراقي: نفسه.
التدبر :
وقفة
[27] ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ أي: من يرقيه -من الرقية- لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهية.
الإعراب :
- ﴿ وَقِيلَ: ﴾
- الواو عاطفة. قيل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح.والجملة الاسمية بعده في محل رفع نائب فاعل
- ﴿ مَنْ راقٍ: ﴾
- اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. راق: خبر «من» مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة قبل التنوين لأنه نكرة منقوص ولالتقاء الساكنين: سكون الياء وسكون التنوين بمعنى: أيكم يرقيه ليشفيه مما به. وقيل هو من كلام الملائكة أي ملائكة الموت: أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [27] لما قبلها : ولَمَّا كانَ أهْلُ المَيِّتِ يَشْتَدُّ انْزِعاجُهم إذْ ذاكَ ويَشْتَدُّ تَطَلُّبُهم لِما يُنْجِي المُحْتَضِرَ مِن غَيْرِ أنْ يُفِيدَهم ذَلِكَ شَيْئًا؛ ذكرَ اللهُ هنا ما يقوله أحبابُ المُحْتَضِر الذي بلغت روحه التراقي، على سبيل التحسر والتوجع واستبعاد شفائه، قال تعالى:
﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [28] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾
التفسير :
{ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ} للدنيا.
والضمير المستتر في قوله- تعالى-: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ يعود إلى هذا الإنسان الذي أشرف على الموت، والذي بلغت روحه نهاية حياتها، والظن هنا بمعنى اليقين، أو بمعنى العلم المقارب لليقين.
أى: وأيقن هذا المحتضر، أو توقع أن نهايته قد اقتربت، وأنه عما قليل سيودع أهله وأحبابه ... وسيفارقهم فراقا لا لقاء بعده، إلا يوم يقوم الناس للحساب.
حدثني بذلك يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) يقول تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نـزل به، وطلبوا له الأطباء والمداوين، فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نـزل به شيئا.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( مَنْ رَاقٍ ) فقال بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرِمة ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هل من راق يرقي.
حدثنا أبو كُرَيب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قِلابة ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هل من طبيب شاف.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قلابة، مثله.
حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن أبي بسطام، عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى ذكره: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هو الطبيب.
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن جويبر، عن الضحاك في ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هل من مداوٍ.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) أي: التمسوا له الأطباء فلم يُغْنوا عنه من قضاء الله شيئا.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن يزيد في قوله: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: أين الأطباء، والرُّقاة: من يرقيه من الموت.
وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض، يقول بعضهم لبعض: من يَرقى بنفسه فيصعد بها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ( كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: إذا بلغت نفسه يرقى بها، قالت الملائكة: من يصعد بها، ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب ؟
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، في قوله: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: بلغني عن أبي قلابة قال: هل من طبيب ؟ قال: وبلغني عن أبي الجوزاء أنه قال: قالت الملائكة بعضهم لبعض: من يرقَى: ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب ؟
وقوله: ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) يقول تعالى ذكره: وأيقن الذي قد نـزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد.
وبنحو الذي قلنا في ذاك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
تفاعل
[28] سَل الله حسن الختام ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَظَنَّ: ﴾
- الواو عاطفة. ظن: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي المحتضر.
- ﴿ أَنَّهُ الْفِراقُ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» و «أن» وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «ظن» أي تحقق. الفراق:خبر «ان» مرفوع بالضمة أي أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنيا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [28] لما قبلها : ولَمَّا وصلت الروحُ إلى أعالي الصدر؛ أيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت، قال تعالى:
﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [29] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾
التفسير :
{ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} أي:اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدنولم تزل معه،
وقوله- تعالى-: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أى: والتوت والتصقت إحدى ساقيه بالأخرى. عند سكرات الموت وشدته، فصارتا متلاصقتين لا تكاد إحداهما تتزحزح عن الأخرى، فكأنهما ملتفتان.
ويصح أن يكون المعنى: والتفت الساق بالساق عند وضع هذا الذي أدركه الموت في كفنه، لأن هذا الكفن قد ضم جميع جسده، والتصقت كل ساق بالأخرى.
ومنهم من يرى أن هذه الآية الكريمة: كناية عن هول الموت وشدته كما في قوله- تعالى-: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام، ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق.
قال صاحب الكشاف: «والتفت» ساقه بساقه والتوت عليها عند الموت، وعن قتادة:
ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليهما جوالا. وقيل: التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، على أن الساق مثل في الشدة. وعن سعيد ابن المسيب: هما ساقاه حين تلفان في أكفانه
وبهذا الإسناد ، عن ابن عباس في قوله : ( والتفت الساق بالساق ) قال : التفت عليه الدنيا والآخرة . وكذا قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( والتفت الساق بالساق ) يقول : آخر يوم في الدنيا ، وأول يوم من أيام الآخرة ، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله .
وقال عكرمة : ( والتفت الساق بالساق ) الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء ببلاء . وقال الحسن البصري في قوله : ( والتفت الساق بالساق ) هما ساقاك إذا التفتا . وفي رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه ، وقد كان عليها جوالا . وكذا قال السدي ، عن أبي مالك .
وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في الكفن .
وقال الضحاك : ( والتفت الساق بالساق ) اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون جسده ، والملائكة يجهزون روحه .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) أي: استيقن أنه الفراق.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) قال: ليس أحد من خلق الله يدفع الموت، ولا ينكره، ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره ؟ فالظنّ كما هاهنا هذا.
التدبر :
وقفة
[29] ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ هذا مشهدٌ ﻵخِرِ يومٍ للعبدِ في الدُّنيا وأوَّلُ يومٍ ﻵخرتِه، مشهدٌ عصيبٌ ينبغي لكلِّ عاقلٍ استحضارُه قبل أن يتحسَّرَ ويندمَ.
وقفة
[29] ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ بدأ المحتضر يطوي قدميه عن الأرض ويجمعهما ليغادر الدنيا التي طالما ركض في أرجائها وسعى في مناكبها.
وقفة
[29] ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ قيل: معناه لفهما في الكفن، وقيل: انتهاء أمرهما بالموت، وكل ما دل في تفسير الآية يراد به حالة من حالات الموت الذي حصل يقينًا لا ظنًّا.
عمل
[29] لنستعد؛ ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع، قال الضحاك رحمه الله: «هو في أمر عظيم، الناس يجهزون بدنه، والملائكة يجهزون روحه».
الإعراب :
- ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ: ﴾
- الواو عاطفة. التفت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الساق: فاعل مرفوع بالضمة. أي التفت احداهما بالأخرى نتيجة الضعف.
- ﴿ بِالسَّاقِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بالتفت. أي التفت ساقه بساقه ضعفا والتوت عليها.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [29] لما قبلها : وبعد أن أيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ ظهرت أمارات الفِراق، قال تعالى:
﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [30] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾
التفسير :
فتساق إلى الله تعالى، حتى يجازيها بأعمالها، ويقررها بفعالها.
فهذا الزجر، [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها، ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذيلا تنفع فيه الآيات، لا يزال مستمرا على بغيه وكفره وعناده.
وقوله- سبحانه-: إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ أى: إلى ربك- أيها الرسول الكريم- مساق الناس ومرجعهم- لا إلى غيره- يوم القيامة.. لكي يحاسبوا على أعمالهم.
فالمساق مصدر ميمى من ساق الشيء إذا سيره أمامه إلى حيث يريد.
وقوله : ( إلى ربك يومئذ المساق ) أي : المرجع والمآب ، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات ، فيقول الله عز وجل : ردوا عبدي إلى الأرض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى . كما ورد في حديث البراء الطويل . وقد قال الله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) [ الأنعام : 61 ، 62 ] .
وقوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفَّت شدّة أمر الدنيا بشدّة أمر الآخرة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبى، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: الدنيا بالآخرة شدّة
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) يقول: آخر يوم من الدنيا، وأوّل يوم من الآخرة، فتلتقي الشدّة بالشدة، إلا من رحم الله.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) يقول: والتفَّت الدنيا بالآخرة، وذلك ساق الدنيا والآخرة، ألم تسمع أنه يقول: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ).
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثنا الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: التفّ أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت.
حدثنا أبو كُريب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد، قال: آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: قال الحسن: ساق الدنيا بالآخرة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن مجاهد، قال: هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت.
حدثني عليّ بن الحسين، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن أبي سنان الشيباني، عن ثابت، عن الضحاك في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: أهل الدنيا يجهزون الجسد، وأهل الآخرة يجهزون الروح.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي سنان، عن الضحاك، مثله
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الضحاك، قال: اجتمع عليه أمران، الناس يجهِّزون جسده، والملائكة يجهزون روحه.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: ساق الدنيا بساق الآخرة.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا جعفر بن عون، عن أبي جعفر، عن الربيع مثله، وزاد: ويقال: التفافهما عند الموت.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن يمان، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية قال: الدنيا والآخرة.
قال: ثنا ابن يمان، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قال: أمر الدنيا بأمر الآخرة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: أمر الدنيا بأمر الآخرة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: الشدّة بالشدّة، ساق الدنيا بساق الآخرة.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سألت إسماعيل بن أبي خالد، فقال: عمل الدنيا بعمل الآخرة.
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سلمة، عن الضحاك، قال: هما الدنيا والآخرة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: العلماء يقولون فيه قولين: منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. وقال آخرون: قلّ ميت يموت إلا التفَّت إحدى ساقيه بالأخرى. قال ابن زيد: غير أنَّا لا نشكّ أنها ساق الآخرة، وقرأ: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) قال: لما التفَّت الآخرة بالدنيا، كان المساق إلى الله، قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفَّت ساقا الميت إذا لفتا في الكفن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا بشير بن المهاجر، عن الحسن، في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: لفُّهما في الكفن.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع وابن اليمان، عن بشير بن المهاجر، عن الحسن، قال: هما ساقاك إذا لفَّتا في. الكفن.
حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا وكيع عن بشير بن المهاجر، عن الحسن، مثله.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفاف ساقي الميت عند الموت.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا حميد بن مسعدة، قال ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن عامر ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: ساقا الميت.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى، قالا ثنا داود، عن عامر قال: التفَّت ساقاه عند الموت.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثني ابن أبى عديّ، عن داود، عن الشعبيّ مثله.
حدثني إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد، عن داود، عن عامر، بنحوه.
حدثنا أبو كُريب وأبو هشام قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن حصين عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: عند الموت.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السديّ، عن أبي مالك، قال: التفَّت ساقاك عند الموت.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) لفَّهما أمر الله.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر قال: قال الحسن: ساقا ابن آدم عند الموت.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السديّ، عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: هما ساقاه إذا ضمت إحداهما بالأخرى.
حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قالا ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال قتادة: أما رأيته إذا ضرب برجله رجله الأخرى.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء، فقد كان عليهما جوّالا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن السديّ، عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: ساقاه عند الموت.
وقال آخرون: عُنِيَ بذلك يبسهما عند الموت.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السديّ، عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: يبسهما عند الموت.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السديّ، مثله.
وقال آخرون: معنى ذلك: والتفّ أمر بأمر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب وأبو هشام قالا ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي خالد، عن أبي عيسى ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: الأمر بالأمر.
وقال آخرون: بل عني بذلك: والتفّ بلاء ببلاء.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
التدبر :
وقفة
[30] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ من لك إذا ألم الألم وسكت الصوت، وتمكن الندم، ووقع الفوت، وأقبل لأخذ الروح ملك الموت، وجاءت جنوده، وقيل: من راق؟ ونزلت منزلًا ليس بمسكون، وتعوَّضت بعد الحرمات السكون، فيا أسفًا لك كيف تكون؟ وأهوال القبر لا تطاق، أكثر عمرك قد مضى، وأعظم زمانك قد انقضى، أفي أعفالك ما يصلح للرضا إذا التقينا يوم التلاق؟
وقفة
[30] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ الملائكة يسوقون الروح إلى الله، حيث يأمرهم بأن يحملوها إما إلى عليين، وإما إلى سجين.
الإعراب :
- ﴿ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخبر مقدم والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. يومئذ: سبق اعرابها. والجملة الاسمية جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. أي جواب «اذا» الواردة في الآية السادسة والعشرين.
- ﴿ الْمَساقُ: ﴾
- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. أي يساق الى الله والى حكمه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [30] لما قبلها : وبعد نزول الموت؛ يكون مساق العباد يوم القيامة: إما إلى الجنة وإما إلى النَّار، قال تعالى:
﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [31] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾
التفسير :
{ فَلَا صَدَّقَ} أي:لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره{ وَلَا صَلَّى}
ثم بين- سبحانه- جانبا من الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة المكذبين للحق، فقال- تعالى-: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى. وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى.
والفاء للتفريع على ما تقدم، من قوله- تعالى-: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ.. إلخ.
أو للتفريع والعطف على قوله- سبحانه-: إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ.. أى: أن هذا الإنسان الذي أنكر الحساب والجزاء، وفارق الحياة، كانت عاقبة أمره خسرا، فلا هو صدق بالحق الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو أدى الصلاة التي فرضها الله- تعالى- عليه،
هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى "فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى".
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، قال: بلاء ببلاء.
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفَّت ساق الدنيا بساق الآخرة، وذلك شدّة كرب الموت بشدة هول المطلع، والذي يدل على أن ذلك تأويله، قوله: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) والعرب تقول لكلّ أمر اشتدّ: قد شمر عن ساقه، وكشف عن ساقه، ومنه قول الشاعر:
إذَا شَــمَّرَتْ لَــكَ عَــنْ سـاقها
فَرِنهــــا رَبِيـــعُ وَلا تَســـأَم (1)
عني بقوله: ( الْتَفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ ) التصقت إحدى الشِّدّتين بالأخرى، كما يقال للمرأة إذا التصقت إحدى فخذيها بالأخرى: لفَّاء.
وقوله: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) يقول: إلى ربك يا محمد يوم التفاف الساق بالساق مساقه.
القول في تأويل قوله تعالى : فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) .
يقول تعالى ذكره: فلم يصدّق بكتاب الله، ولم يصلّ له صلاة، ولكنه كذّب بكتاب الله، وتولى فأدبر عن طاعة الله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[31] ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ فسد باطنه وضعف تصديقه وإيمانه فأتبعه ضعف الصلاة، فقدم عمل القلب لأنه أصل عمل الجوارح.
وقفة
[31، 32] ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ * وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ أي لا صدَّق رسول الله، ولا وقف بين يدي الله فصلى، ولكن كذب رسول الله، وتولى عن طاعة الله، فترك التصديق خصلة، والتكذيب خصلة، وترك الصلاة خصلة، والتولي عن طاعة الله خصلة، فهذه أربع خصال.
الإعراب :
- ﴿ فَلا صَدَّقَ: ﴾
- الفاء عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. صدق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. يعود على الانسان في قوله «أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» والجملة معطوفة على «يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ» أي لا يؤمن بالبعث فلا صدق بالرسول والقرآن ولا صلى. ويجوز أن يكون فلا صدق ماله أي فلا زكاة. وحذف المفعول اختصارا لأنه معلوم.
- ﴿ وَلا صَلَّى: ﴾
- الواو عاطفة. لا: حرف نفي لا عمل له. صلى: تعرب اعراب «صدق» وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. وقيل «لا» هنا بمعنى «لم» أي فلم يتصدق. وكررت «لا» لدخولها على فعل ماض.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [31] لما قبلها : وبعد بيان سوء عاقبة المكذبين للحق؛ ذَكَرَ اللهُ هنا جانبًا من الأسباب التى أدت بهم إلى ذلك، قال تعالى:
﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [32] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾
التفسير :
[وَلَكِنْ كَذَّبَ} بالحق في مقابلة التصديق،{ وَتَوَلَّى} عن الأمر والنهي، هذا وهو مطمئن قلبه، غير خائف من ربه،
ولكنه كذب بكل ذلك ، وتولى ، وأعرض عن سبيل الرشاد .
هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى "فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ) لا صدّق بكتاب الله، ولا صلى لله
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[31، 32] تعلمني سورة القيامة: الحذر من صفات أهل النار، التي اجتمعت في تكذيب الله ورسوله، والتولي والإعراض عن طاعتهما ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ * وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَلكِنْ: ﴾
- الواو: زائدة. لكن: حرف عطف للاستدراك مهملة لأنها مخففة ولزوال اختصاصها بالجملة الاسمية.
- ﴿ كَذَّبَ وَتَوَلَّى: ﴾
- تعرب اعراب «صدق» وصلى» الواردة في الآية الكريمة السابقة أي وأعرض.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [32] لما قبلها : ولَمَّا نفى عنه أفعالَ الخَيرِ؛ أثبَتَ له أفعالَ الشَّرِّ، فقال. تعالى:
﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [33] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾
التفسير :
بل يذهب{ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} أي:ليس على باله شيء،
ثم بعد ذلك: ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أى: ذهب إلى أهله متبخترا متفاخرا، متباهيا بإصراره على كفره وفجوره.
وقوله: يَتَمَطَّى من المط بمعنى المد. وأصله: يتمطط، قلبت فيه الطاء حرف علة، ووصف المتبختر في مشيه بذلك، لأنه يمط خطاه، ويمدها على سبيل الإعجاب بنفسه، والتباهي بما هو عليه من كفر وضلال.
ولم يذكر- سبحانه- المتعلق والمفعول في الآيات الكريمة، للإشعار بأن هذا الإنسان الجاحد الجاهل.. لم يصدق بشيء من الحق، ولم يؤد لله- تعالى- فرضا ولا سنة، ولكنه استمر على تكذيبه وإعراضه عن الصراط المستقيم، ولم يكتف بكل ذلك، بل تفاخر وتباهي أمام غيره بما هو عليه من باطل.
(ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أي : جذلا أشرا بطرا كسلانا ، لا همة له ولا عمل ، كما قال : ( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ) [ المطففين : 34 ] . وقال ( إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ) أي : يرجع ( بلى إن ربه كان به بصيرا ) [ الانشقاق : 13 - 15 ] .
وقال الضحاك : عن ابن عباس : ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) [ أي ] . يختال . وقال قتادة وزيد بن أسلم : يتبختر .
( وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) كذّب بكتاب الله، وتولى عن طاعة الله.
التدبر :
وقفة
[33] ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ﴾ أي يتبختر افتخارًا بذلك وقيل: أصله يتمطط؛ وهو: التمدد من التكسل والتثاقل؛ فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق.
وقفة
[33] ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهلِهِ يَتَمَطّى﴾ بماذا وعلى ماذا؟ هكذا الجهلة لا يعملون عقولهم فيما فيه الفائدة لهم.
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ: ﴾
- حرف عطف. ذهب: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.
- ﴿ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى: ﴾
- جار ومجرور متعلق بذهب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. يتمطى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي يتبختر بمعنى: كذب برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأعرض عنه ثم ذهب الى قومه يتبختر افتخارا بذلك وجملة «يتمطى» في محل نصب حال من ضمير «ذهب».'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [33] لما قبلها : ولَمَّا كان من صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن يخاف من حلول غضب الله به فيمشي خائفًا منه؛ ذَكَرَ اللهُ هنا أن هذا الكافر يذهب إلى أهله يختال في مشيته من الكبر، قال تعالى:
﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [34] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾
التفسير :
توعده بقوله:{ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} وهذه كلمات وعيد، كررها لتكرير وعيده، ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول
وقوله- سبحانه-: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى. ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى دعاء على هذا الإنسان الشقي، المصر على إعراضه عن الحق.. بالهلاك وسوء العاقبة. وأَوْلى اسم تفضيل من ولى، وفاعله ضمير محذوف يقدره كل قائل أو سامع بما يدل على المكروه.
والكاف في قوله لَكَ للتبيين، والكاف خطاب لهذا الإنسان المخصوص بالدعاء عليه.
وقوله: فَأَوْلى تأكيد لقوله أَوْلى لَكَ
ال الله تعالى : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به المتبختر في مشيته ، أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك ، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) [ الدخان : 49 ] . وكقوله : ( كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) [ المرسلات : 46 ] ، وكقوله ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) [ الزمر : 15 ] ، وكقوله ( اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 40 ] . إلى غير ذلك .
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ، عن إسرائيل ، عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت سعيد بن جبير قلت : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) ؟ قال : قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ، ثم نزل به القرآن .
وقال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا إبراهيم بن يعقوب . حدثنا أبو النعمان ، حدثنا أبو عوانة - ( ح ) وحدثنا أبو داود : حدثنا محمد بن سليمان . حدثنا أبو عوانة - عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) ؟ قال : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزله الله عز وجل .
قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي ، حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا شعيب ، عن إسحاق ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) وعيد على أثر وعيد ، كما تسمعون ، وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه ، ثم قال : " أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى " ، فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدني يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا ، وإني لأعز من مشى بين جبليها .
وقوله: ( ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) يقول تعالى ذكره: ثم مضى إلى أهله منصرفا إليهم، يتبختر في مِشيته.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) أي: يتبختر.
حدثني سعيد بن عمرو السكوني، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن ميسرة بن عبيد، عن زيد بن أسلم، في قوله: ( ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) قال: يتبختر، قال: هي مشية بني مخزوم.
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن إسماعيل بن أمية عن مجاهد ( ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) قال: رأى رجلا من قريش يمشي، فقال: هكذا كان يمشي كما يمشي هذا، كان يتبختر.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( يَتَمَطَّى ) قال: يتبختر وهو أبو جهل بن هشام، كانت مِشيته.
وقيل: إن هذه الآية نـزلت في أبي جهل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( يَتَمَطَّى ) قال: أبو جهل.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) قال: هذا في أبي جهل متبخترا.
وإنما عُني بقوله: ( يَتَمَطَّى ) يلوي مطاه تبخترا، والمطا: هو الظهر، ومنه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذَا مَشَتْ أُمَّتِي المُطَيطَاءَ " وذلك أن يلقي الرجل بيديه ويتكفأ.
وقوله ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) هذا وعيد من الله على وعيد لأبي جهل.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) وعيد على وعيد، كما تسمعون، زعم أن هذا أنـزل في عدوّ الله أبي جهل. ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) فقال عدوّ الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا، والله لأنا أعزّ من مشى بين جبليها.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيده، يعني بيد أبي جهل، فقال: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) فقال: يا محمد، ما تستطيع أنت وربك فيّ شيئا، إني لأعزّ من مشى بين جبليها، فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال: لا يُعبد الله بعد هذا اليوم، وضرب الله عنقه، وقتله شرّ قِتلة.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[34، 35] ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ * ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ أي احذر فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه، وقد قرأها النبي ﷺ على أبي جهل فولى، وقال: بأي شيء تهددني.
وقفة
[34، 35] ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ * ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ هذا ليس من باب التكرار، بل هو وعيد ودعاء، يعني: قرب منك ما يهلك قربًا بعد قرب، كما تقول: غفر لك ثم غفر الله لك، أي: غفر لك بعد مغفرة، فليس هذا بتكرار محض، ولا من باب التأكيد اللفظي، بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب، ونظيره: اضربه ثم اضربه.
وقفة
[34، 35] ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ * ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ جاء الوعيد بأربعة (أَوْلَىٰ) في مقابل ترك أربع خصال.
وقفة
[34، 35] ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ * ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ ما معناه؟ وما فائدة تكراره؟ الجواب: هو دعاء على المخاطب بالويل وهو مشتق من (ولى) إذا قرب، ومعناه: أقرب لك الويل، وأما تكراره فإما تأكيد له، أو أن الأول للدنيا، والثانى للآخرة، أي: ويل له فيهما.
وقفة
[34، 35]: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ أي أولاك اللَّهُ ما تكره، وكرَّره مرارًا بقوله: ﴿ثُمَّ أَوْلَى لكَ فأَوْلَى﴾ مبالغةً في التهديد والوعيد، فهو تهديدٌ بعد تهديد، ووعيدٌ بعد وعيد.
الإعراب :
- ﴿ أَوْلى لَكَ: ﴾
- مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر. لك: جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف بمعنى: ويل لك وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه
- ﴿ فَأَوْلى: ﴾
- معطوفة بالفاء على «أَوْلى لَكَ» وتعرب اعرابها. وحذف الجار والمجرور لأن ما قبله يدل عليه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [34] لما قبلها : وبعد بيان حال هذا الكافر؛ توعده اللهُ هنا بالهلاك وسوء العاقبة، قال تعالى:
﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [35] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾
التفسير :
توعده بقوله:{ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} وهذه كلمات وعيد، كررها لتكرير وعيده، ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول
وجملة ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى مؤكدة للجملة الأولى. أى: أجدر بك هذا الهلاك الذي ينتظرك قريبا- أيها الإنسان- الجاحد، ثم أجدر بك، لأنك أصررت على كل ما هو باطل وسوء.
قال القرطبي ما ملخصه: هذا تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد..
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم، فاستقبله أبو جهل على باب المسجد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فهزه مرة أو مرتين ثم قال: «أولى لك فأولى» .
فقال أبو جهل: أتهددني- يا محمد- فو الله إنى لأعز أهل هذا الوادي وأكرمه، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لأبى جهل .
وجيء بحرف «ثم» في عطف الجملة الثانية على الأولى، لزيادة التأكيد، وللارتقاء في الوعيد، وللإشعار بأن التهديد الثاني أشد من الأول، كما في قوله- تعالى-: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.
ال الله تعالى : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به المتبختر في مشيته ، أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك ، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) [ الدخان : 49 ] . وكقوله : ( كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) [ المرسلات : 46 ] ، وكقوله ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) [ الزمر : 15 ] ، وكقوله ( اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 40 ] . إلى غير ذلك .
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ، عن إسرائيل ، عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت سعيد بن جبير قلت : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) ؟ قال : قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ، ثم نزل به القرآن .
وقال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا إبراهيم بن يعقوب . حدثنا أبو النعمان ، حدثنا أبو عوانة - ( ح ) وحدثنا أبو داود : حدثنا محمد بن سليمان . حدثنا أبو عوانة - عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) ؟ قال : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزله الله عز وجل .
قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي ، حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا شعيب ، عن إسحاق ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) وعيد على أثر وعيد ، كما تسمعون ، وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه ، ثم قال : " أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى " ، فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدني يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا ، وإني لأعز من مشى بين جبليها .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) قال: قال أبو جهل: إن محمدا ليوعدني، وأنا أعزّ أهل مكة والبطحاء، وقرأ: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، قال: قلت لسعيد بن جُبير: أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَل نفسه، أم أمر أمره الله به ؟ قال: بل قاله من قِبَل نفسه، ثم أنـزل الله: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ).
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[34، 35] خرج رسول الله ﷺ من المسجد يومًا، فاستقبله أبو جهل، فأخذ رسول الله ﷺ بثياب أبي جهل، وقال له: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ * ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾، فأنزلها الله في القرآن.
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ﴾
- معطوفة بثم على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [35] لما قبلها : وبعد أن توعد اللهُ هذا الكافر بالهلاك وسوء العاقبة؛ كَرَّرَ هنا هذا الوعيد للتأكيد، قال تعالى:
﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [36] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾
التفسير :
{ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} أي:معطلا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله بغير ما يليق بحكمته.
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بالإشارة إلى الحكمة من البعث والجزاء، وببيان جانب من مظاهر قدرته فقال: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.
والاستفهام للإنكار كما قال في قوله- تعالى- قبل ذلك: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ.
و «سدى» - بضم السين مع القصر- بمعنى مهمل. يقال: إبل سدّى، أى: مهملة ليس لها راع يحميها.. وهو حال من فاعل «يترك» .
أى: أيظن هذا الإنسان الذي أنكر البعث والجزاء، أن نتركه هكذا مهملا، فلا نجازيه على أعماله التي عملها في الدنيا؟ إن كان يحسب ذلك فهو في وهم وضلال، لأن حكمتنا قد اقتضت أن نكرم المتقين، وأن تعاقب المكذبين.
وقوله : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) قال السدي : يعني : لا يبعث .
وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني لا يؤمر ولا ينهى .
والظاهر أن الآية تعم الحالين ، أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث ، بل هو مأمور منهي في الدنيا ، محشور إلى الله في الدار الآخرة . والمقصود هنا إثبات المعاد ، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ، ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال .
وقوله: ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) يقول تعالى ذكره: أيظنّ هذا الإنسان الكافر بالله أن يترك هملا أن لا يؤمر ولا ينهى، ولا يتعبد بعبادة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس قوله: ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) يقول: هملا.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) قال: لا يُؤمر، ولا يُنْهى.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) قال السديّ: الذي لا يفترض عليه عمل ولا يعمل.
التدبر :
وقفة
[36] ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ حاشا أحكم الحاكمين أن يتركنا هملًا، بلا أمر أو نهي، ولا ثواب أو عقاب، بل تكليفنا في الدنيا مقصود منه الجزاء في الآخرة.
وقفة
[36] ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ كثيرٌ من الظالمين يموتون ولم ينتصف المظلومُ منهم، فكان لابد من بعثٍ يُجازى بعده النَّاسُ، وينتصفُ بعضهم من بعض، وذلك تمامُ العدل.
الإعراب :
- ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة الثالثة. ان: حرف مصدري ناصب.
- ﴿ يُتْرَكَ: ﴾
- فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والفعل مبني للمجهول. وجملة «يترك» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ان» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «يحسب».
- ﴿ سُدىً: ﴾
- حال من الضمير في «يترك» منصوب بالفتحة المقدرة للتعذر على الألف قبل تنوينها لأنها اسم مقصور نكرة. أي مهملا لا يؤمر ولا يعاقب.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [36] لما قبلها : وبعد أن بدأت السورةُ بالقَسَم على أنَّ البعثَ حقٌ؛ خَتَمَ اللهُ السورةَ بالإِشارة إلى الحكمةِ من البعث والجزاء، والإِنكار على الكافرين تكذيبهم بالعبث، قال تعالى:
﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [37] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ .. ﴾
التفسير :
{ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى}
والاستفهام في قوله: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى.. للتقرير، والنطفة: القليل من الماء ويُمْنى يراق هذا المنى في رحم المرأة.
أى: كيف يحسب هذا الإنسان أنه سيترك سدى؟ ألم يك في الأصل قطرة ماء تصب من الرجل في رحم المرأة وتراق فيه؟ بل إنه كان كذلك.
( ألم يك نطفة من مني يمنى ) ؟ أي : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى ، يراق من الأصلاب في الأرحام .
يقول تعالى ذكره: ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد مماته، وإيجاده من بعد فنائه ( نُطْفَةً ) يعني: ماء قليلا في صلب الرجل من منيّ.
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( يُمْنَى ) فقرأه عامة قرّاء المدينة والكوفة: ( تُمْنَى ) بالتاء بمعنى: تمنى النطفة، وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة والبصرة: ( يُمْنَى ) بالياء، بمعنى: يمنى المنيّ.
والصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[37] ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ﴾ قال الرازي: «فإن قيل: ما الفائدة في يمنى في قوله: (مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ)؟ قلنا: فيه إشارة إلى حقارة حاله، كأنه قيل: إنه مخلوق من المني الذي جرى على مخرج النجاسة، فلا يليق بمثل هذا الشيء أن يتمرد عن طاعة الله تعالى».
وقفة
[37] ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ﴾ قال الغزالي: «من كان هذا بدأه، وهذه أحواله، فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء، وهو على التحقيق أخسّ الأخساء، وأضعف الضعفاء؟!».
الإعراب :
- ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً: ﴾
- الهمزة همزة انكار دخلت على المنفي فرجع الى معنى التقرير.أو استفهام انكار للنفي مبالغة في الاثبات. لم: حرف نفي وجزم وقلب.يك: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره «النون» المحذوفة جوازا اختصارا وحذفت الواو وجوبا لالتقاء الساكنين واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو نطفة خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة.المراد بها: ماء الرجل.
- ﴿ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لنطفة. يمنى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وجملة «يمنى» أي يصب: في محل جر صفة- نعت- لمني.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [37] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ حالَ الإنسانِ في الموتِ، وما كان مِن حالِه في الدُّنيا؛ قرَّرَ له أحوالَه في بِدايتِه ليَتأمَّلَها، فلا يُنكِرَ معها جَوازَ البَعثِ مِن القبورِ، قال تعالى:
﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يك:
1- بياء الغيبة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بتاء الخطاب، على سبيل الالتفات، وهى قراءة الحسن.
يمنى:
1- بالياء، وهى قراءة ابن محيصن، والجحدري، وسلام، ويعقوب، وحفص، وأبى عمرو، بخلاف عنه.
وقرئ:
2- تمنى، بالتاء، أي: النطفة، وهى قراءة الجمهور.
مدارسة الآية : [38] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴾
التفسير :
[ ثُمَّ كَانَ} بعد المني{ عَلَقَةً} أي:دما،{ فَخَلَقَ} الله منها الحيوان وسواه أي:أتقنه وأحكمه،
ثم كانَ بعد ذلك عَلَقَةً أى: قطعة دم متجمد فَخَلَقَ فَسَوَّى أى: فخلقه الله- تعالى- خلقا آخر بقدرته، وسواه في أحسن تقويم، كما قال: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ...
أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا آخر سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره؟.
وقوله: ( ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً ) يقول تعالى ذكره: ثم كان دما من بعد ما كان نطفة، ثم علقة، ثم سوّاه بشرًا سويا، ناطقا سميعا بصيرا.
التدبر :
وقفة
[ 38، 39] ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ من لم يتركك وأنت نطفة، بل قلّب النطفة علقة، ثم قلّب العلقة مضغة، ثم سوى خلقها، حتى صرت بشرًا سويًّا، فكيف يتركك سدي؟! ولا يسوقك إلى أسباب هدايتك؟ ولا يدلك على طريق جنتك؟!
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ كانَ عَلَقَةً: ﴾
- حرف عطف. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو علقة خبر «كان» منصوب بالفتحة.أي دما متجمدا.
- ﴿ فَخَلَقَ: ﴾
- الفاء عاطفة تفيد الترتيب. خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الله سبحانه. وحذف المفعول اختصارا لأن ما قبله دال عليه أي فخلقه الله. أي فخلق الله الانسان.
- ﴿ فَسَوَّى: ﴾
- طوفة بالفاء على «خلق» وتعرب اعرابها. وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. بمعنى: فعدل منه أي من الأنسان.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [38] لما قبلها : ولَمَّا كانَ تَكْثِيرُ تِلْكَ النُّطْفَةِ وتَحْوِيلُها أمْرًا عَظِيمًا عَجِيبًا؛ أشارَ إلَيْهِ بِأداةِ البُعْدِ مَعَ إفادَتِها لِلتَّراخِي في الزَّمانِ أيْضًا فَقالَ تعالى:
﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [39] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾
التفسير :
{ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى]
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
فصار خلقا آخر سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره ولهذا قال تعالى "فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى".
( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ) يقول تعالى ذكره: فجعل من هذا الإنسان بعدما سوّاه خلقا سويا أولادًا له، ذكورا وإناثا.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الإعراب :
- ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ: ﴾
- معطوفة بالفاء على «فسوى» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة الظاهرة على آخره. منه: جار ومجرور متعلق بجعل. أي فجعل من الانسان على معنى «فخلق» يتعدى الى مفعول واحد. وعلى معنى «فصير منه» تكون «منه» في مقام المفعول الثاني للفعل «جعل».
- ﴿ الزَّوْجَيْنِ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.
- ﴿ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى: ﴾
- بدل من «الزوجين» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة. الأنثى معطوفة بالواو على «الذكر» وتعرب اعرابها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الألف للتعذر.'
المتشابهات :
| النجم: 45 | ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴾ |
|---|
| القيامة: 39 | ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴾ |
|---|
| الليل: 3 | ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [39] لما قبلها : ولَمَّا كانَ اسْتِبْعادُهم لِلْقِيامَةِ إمّا لِاسْتِبْعادِ القُدْرَةِ عَلى إعادَةِ الأجْزاءِ بَعْدَ تَفَرُّقِها، أوْ لِاسْتِبْعادِ القُدْرَةِ عَلى تَمْيِيزِ تُرابِها مِن تُرابِ الأرْضِ بَعْدَ الِاخْتِلاطِ، وكانَ تَمْيِيزُ النُّطْفَةِ إلى ذَكَرٍ وأُنْثى كافِيًا في رَدِّ الِاسْتِبْعادَيْنِ؛ قال تعالى:
﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [40] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن .. ﴾
التفسير :
[أَلَيْسَ ذَلِكَ} الذي خلق الإنسان [وطوره إلى] هذه الأطوار المختلفة{ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} بلى إنه على كل شيء قدير. تم تفسير سورة القيامة، ولله الحمد والمنة، وذلك في 16 صفر سنة 1344
المجلد التاسع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله:عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين.
وجملة أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بمثابة النتيجة بعد المقدمات والأدلة.
أى: أليس ذلك الرب العظيم الشأن والقدرة، الذي أحسن كل شيء خلقه: والذي خلق الإنسان في تلك الأطوار المتعددة ... أليس ذلك الإله صاحب الخلق والأمر.
بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى وعلى أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، ليجازى الذين أساءوا بما عملوا، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى؟ بلى إنه لقادر على ذلك قدرة تامة.
وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث منها: أن رجلا كان إذا قرأ هذه الآية قال: سبحانك اللهم وبلى. فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا شبابة ، عن شعبة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن آخر : أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن ، فإذا قرأ : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) ؟ قال : سبحانك اللهم فبلى ، فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . وقال أبو داود ، رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي فوق بيته ، فكان إذا قرأ : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) ؟ قال سبحانك ، فبلى ، فسألوه عن ذلك فقال : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ، ولا يضر ذلك .
وقال أبو داود أيضا : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ، حدثنا سفيان ، حدثني إسماعيل بن أمية : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) ؟ فليقل : بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ : ( لا أقسم بيوم القيامة ) فانتهى إلى : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ : ( والمرسلات ) فبلغ ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) ؟ فليقل : آمنا بالله " .
ورواه أحمد ، عن سفيان بن عيينة . ورواه الترمذي ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عيينة . وقد رواه شعبة ، عن إسماعيل بن أمية قال : قلت له : من حدثك ؟ قال رجل صدق ، عن أبي هريرة
وقال ابن جرير : حدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال : " سبحانك وبلى " .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) ؟ ، قال : سبحانك ; فبلى .
آخر تفسير سورة " القيامة " ولله الحمد والمنة
( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) يقول تعالى ذكره: أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا الإنسان من نطفة، ثم علقة حتى صيره إنسانا سويا، له أولاد ذكور وإناث، بقادر على أن يُحيي الموتى من مماتهم، فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم. يقول: معلوم أن الذي قَدِر على خَلق الإنسان من نطفة من منيّ يمنى، حتى صيره بشرا سويًا، لا يُعجزه إحياء ميت من بعد مماته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك قال: بلى.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك وبلَى.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
عمل
[40] ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ من كان قادرًا على أن يحيي الموتى؛ فيسير عليه أن يحيي أحلامك وآمالك؛ ثِق بربك ولا تيأس.
تفاعل
[40] تفاعل مع القراءة، قال النووي: «ويُستحب لكل من قرأ: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) [التين: ۸] أن يقول: بلي، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ قال: بلى، أشهد، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185] قال: آمنت بالله، وإذا قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: سُبحان ربي الأعلى».
وقفة
[40] ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ﴾ الذي خلق الإنسان وطوَّره إلى هذه الأطوار المختلفة ﴿بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾؟ بلى إنه على كل شيء قدير.
الإعراب :
- ﴿ أَلَيْسَ: ﴾
- الهمزة همزة انكار دخلت على المنفي فرجع الى معنى التقرير. أو استفهام انكار للنفي مبالغة في الاثبات. ليس: فعل ماض ناقص مبني على الفتح.
- ﴿ ذلِكَ: ﴾
- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع اسم «ليس» اللام للبعد والكاف للخطاب والمشار اليه الذي أنشأ وهو الله سبحانه وتعالى.
- ﴿ بِقادِرٍ عَلى أَنْ: ﴾
- الباء حرف جر زائد. قادر: اسم مجرر لفظا منصوب محلا لأنه خبر «ليس» على: حرف جر. أن: حرف مصدري ناصب. والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ يُحْيِيَ الْمَوْتى: ﴾
- فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. الموتى: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. و «أن» المصدرية وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بقادر. أي بقادر على الاعادة أي على احياء الموتى.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [40] لما قبلها : وبعد هذه المقدمات والأدلة؛ تأتي النتيجة: أليس الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النُطْفَة المَذِرَة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء، قال تعالى:
﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ .. ﴾
التفسير :
ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاها.
فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم بل ليس مذكورا.
تفسير سورة الإنسان
مقدمة وتمهيد
1- سورة «الإنسان» يرى بعضهم أنها من السور المكية الخالصة، ويرى آخرون أنها من السور المدنية.
قال الآلوسى: هي مكية عند الجمهور، وقال مجاهد وقتادة: مدنية كلها، وقال الحسن: مدنية إلا آية واحدة، وهي قوله- تعالى-: وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً .
2- والذي تطمئن إليه النفس أن هذه السورة، من السور المكية الخالصة، فإن أسلوبها وموضوعها ومقاصدها.. كل ذلك يشعر بأنها من السور المكية، إذ من خصائص السور المكية، كثرة حديثها عن حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة المكذبين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر، وإثبات أن هذا القرآن من عند الله- تعالى- والتحريض على مداومة ذكر الله- تعالى- وطاعته.. وكل هذه المعاني نراها واضحة في هذه السورة.
ولقد رأينا الإمام ابن كثير- وهو من العلماء المحققين- عند تفسيره لهذه السورة، قال بأنها مكية، دون أن يذكر في ذلك خلافا، مما يوحى بأنه لا يعتد بقول من قال بأنها مدنية.
3- وتسمى هذه السورة- أيضا- بسورة «هل أتى على الإنسان» ، فقد روى البخاري- في باب القراءة في الفجر- عن أبى هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر سورة «ألم السجدة» . وسورة. «هل أتى على الإنسان» .
وتسمى- أيضا- بسورة: الدهر، والأبرار، والأمشاج، لورود هذه الألفاظ فيها.
عدد آياتها: إحدى وثلاثون آية بلا خلاف.
4- ومن مقاصدها البارزة: تذكير الإنسان بنعم الله- تعالى- عليه، حيث خلقه- سبحانه- من نطفة أمشاج، وجعله سميعا بصيرا، وهداه السبيل.
وحيث أعد له ما أعد من النعيم الدائم العظيم.. متى أطاعه واتقاه.
كما أن من مقاصدها: إنذار الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم. وإثبات أن هذا القرآن من عند الله- تعالى- وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بالصبر والإكثار من ذكر الله- تعالى- بكرة وأصيلا.
وبيان أن حكمته- تعالى- قد اقتضت أنه: يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً.
والاستفهام في قوله- تعالى-: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ.. للتقرير. والمراد بالإنسان: جنسه، فيشمل جميع بنى آدم، والحين: المقدار المجمل من الزمان، لا حد لأكثره ولا لأقله. والدهر: الزمان الطويل غير المحدد بوقت معين.
والمعنى: لقد أتى على الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ أى: وقت غير محدد من الزمان الطويل الممتد في هذه الحياة الدنيا.
لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً أى: لم يكن هذا الإنسان في ذلك الحين من الدهر، شيئا مذكورا من بين أفراد جنسه، وإنما كان شيئا غير موجود إلا في علم الله- تعالى-.
ثم أوجده- سبحانه- بعد ذلك من نطفة فعلقة فمضغة.. ثم أنشأه- سبحانه- بعد ذلك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
فالمقصود بهذه الآية الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته- عز وجل- حيث أوجد الإنسان من العدم، ومن كان قادرا على ذلك، كان- من باب أول- قادرا على إعادته إلى الحياة بعد موته، للحساب والجزاء.
قال الإمام الفخر الرازي ما ملخصه: اتفقوا على أن «هل» هاهنا، وفي قوله- تعالى-: هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ. بمعنى قد، كما تقول: هل رأيت صنيع
فلان، وقد علمت أنه قد رآه. وتقول: هل وعظتك وهل أعطيتك، ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته.
والدليل على أن «هل» هنا ليست للاستفهام الحقيقي.. أنه محال على الله- تعالى- فلا بد من حمله على الخبر .
وجاءت الآية الكريمة بأسلوب الاستفهام، لما فيه من التشويق إلى معرفة ما سيأتى بعده من كلام.
وجملة لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً في موضع نصب على الحال من الإنسان، والعائد محذوف. أى: حالة كون هذا الإنسان، لم يكن في ذلك الحين من الدهر، شيئا مذكورا من بين أفراد جنسه. وإنما كان نسيا منسيا، لا يعلم بوجوده أحد سوى خالقه- عز وجل-.
تفسير سورة الإنسان وهي مكية .
قد تقدم في صحيح مسلم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة " الم تنزيل " السجدة ، و " هل أتى على الإنسان "
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة : " هل أتى على الإنسان حين من الدهر " وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود ، فلما بلغ صفة الجنان ، زفر زفرة فخرجت نفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخرج نفس صاحبكم - أو قال : أخيكم - الشوق إلى الجنة " . مرسل غريب .
يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه ، فقال : ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) ؟
يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ ) قد أتى على الإنسان، وهل في هذا الموضع خبر لا جحد، وذلك كقول القائل لآخر يقرّره: هل أكرمتك؟ وقد أكرمه؛ أو هل زرتك؟ وقد زاره، وقد تكون جحدا في غير هذا الموضع، وذلك كقول القائل لآخر: هل يفعل مثل هذا أحد؟ بمعنى: أنه لا يفعل ذلك أحد. والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ): هو آدم صلى الله عليه وسلم كذلك.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ ) آدم أتى عليه ( حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) إنما خلق الإنسان ها هنا حديثا، ما يعلم من خليقة الله كانت بعد الإنسان.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) قال: كان آدم صلى الله عليه وسلم آخر ما خلق من الخلق.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ) قال: آدم.
وقوله: ( حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ) اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو أربعون سنة، وقالوا: مكثت طينة آدم مصوّرة لا تنفخ &; 24-88 &; فيها الرّوح أربعين عامًا، فذلك قدر الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع، قالوا: ولذلك قيل: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) لأنه أتى عليه وهو جسم مصوّر لم تنفخ فيه الروح أربعون عاما، فكان شيئا، غير أنه لم يكن شيئا مذكورا، قالوا: ومعنى قوله: ( لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة، ولا شرف، إنما كان طينا لازبًا وحمأ مسنونا.
وقال آخرون: لا حدّ للحين في هذا الموضع؛ وقد يدخل هذا القول من أن الله أخبر أنه أتى على الإنسان حين من الدهر، وغير مفهوم في الكلام أن يقال: أتى على الإنسان حين قبل أن يوجد، وقبل أن يكون شيئا، وإذا أُريد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلق، ولم يقل أتى عليه. وأما الدهر في هذا الموضع، فلا حدّ له يوقف عليه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[1] يستحب في صلاة الفجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ)» [البخاري 891].
وقفة
[1] ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ سؤال لكل انسان، ولمن يتجبر ويظلم ويستنكف عن عبادة ربه، فهل يتفكر في نفسه.
وقفة
[1] ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ الذي أوجدك عندما كنت من عدم قادر على أن يعيد سيرتك اﻷولى بعد أن تصبح عدم.
وقفة
[1] ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره؛ ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة لنفسه، وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية، والاعتناء الإلهي، والتكرمة؛ فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: 53].
وقفة
[1] ﴿هَل أَتى عَلَى الإِنسانِ حينٌ مِنَ الدَّهرِ﴾ عند همك بالمعصية تذكر، عند أكلك الحرام تذكر، عند تطاولك على والديك تذكر، عند اختلاسك نظرة لا تحل لك تذكر ﴿لَم يَكُن شَيئًا مَذكورًا﴾.
اسقاط
[1] ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ سبحان الله لم تكن شيئًا، وأصبحت شيئًا يطمع في كل شئ؛ دع عنك مطامع الدنيا، أنت هنا لتبتلى لتشكر أم تكفر، فماذا أنت فاعل؟
عمل
[1] ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ تأمل هوانك وضعفك الذي كنت عليه، وأنك سترجع لنفس المصير، فهذا أدعى ألا تتكبر؟
وقفة
[1] مهما علا نسبك فأصلك ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾.
وقفة
[1] كان السلف لعظم خوفهم من الله، وشدة قلقهم من لحظة وقوفهم أمام الله جل جلاله، يتمنون أنهم لم يخلقوا، كما قال الفاروق رضي الله عنه لما سمع رجلًا يقرأ: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾، فقال عمر: ليتها تمت، أي: ليتني لم أكن شيئًا مذكورًا! فهل مر بك هذا الشعور أخي وأنت تقرأ هذه الآية.
عمل
[1] تأمل ضعفك ﴿لم يكن شيئاً مذكورا﴾.
الإعراب :
- ﴿ هَلْ: ﴾
- بمعنى: قد في الاستفهام والأصل: أهل والمعنى قد أتى على التقرير والتقريب جميعا ولا يجوز أن يجعل «هل» استفهاما لأن الهمزة للاستفهام وحرف الاستفهام لا يدخل على مثله.
- ﴿ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ ﴾
- عل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر.على الانسان: جار ومجرور متعلق بأتى.
- ﴿ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة. من الدهر: جار ومجرور متعلق بصفة لحين. أي أتى على الانسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد والمراد بالانسان: جنس بني آدم.
- ﴿ لَمْ يَكُنْ: ﴾
- حرف نفي وجزم وقلب. يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو لالتقاء الساكنين واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أي لم يكن فيه.
- ﴿ شَيْئاً مَذْكُوراً: ﴾
- خبر «يكن» منصوب بالفتحة. مذكورا: صفة- نعت- لشيئا منصوبة مثلها بالفتحة بمعنى: كان شيئا منسيا غير مذكور أي كان نطفة في الأصلاب. وجملة «لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً»في محل نصب حال من الانسان على معنى هل أتى عليه حين من الدهر غير مذكور. أو في محل رفع صفة- نعت- لحين.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالإخبارِ بأنَّه قد مَرَّ على الإنسانِ قبْلَ أن يُخلَقَ زَمَنٌ طَويلٌ لم يكُنْ فيه شَيئًا مَذكورًا، قال تعالى:
﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ .. ﴾
التفسير :
ثم لما أراد الله تعالى خلقه، خلق [أباه] آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا{ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} أي:ماء مهين مستقذر{ نَبْتَلِيهِ} بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه؟
فأنشأه الله، وخلق له القوى الباطنة والظاهرة، كالسمع والبصر، وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده.
ثم فصل- سبحانه- بعد هذا التشويق، أطوار خلق الإنسان فقال: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ والمراد بالإنسان هنا- أيضا- جنسه وجميع أفراده.
و «أمشاج» بمعنى أخلاط من عناصر شتى، مشتق من المشج بمعنى الخلط، يقال: مشج فلان بين كذا وكذا- من باب ضرب- إذا خلط ومزج بينهما، وهو جمع مشج- كسبب، أو مشج- ككتف، أو مشيج- كنصير.
قال الجمل: «أمشاج» نعت لنطفة. ووقع الجمع صفة لمفرد، لأنه في معنى الجمع، أو جعل كل جزء من النطفة نطفة، فاعتبر ذلك فوصف بالجمع.. .
ويرى صاحب الكشاف ان لفظ «أمشاج» مفرد جاء على صيغة أفعال، كلفظ أعشار في قولهم: برمة أعشار، أى: برمة متكسرة قطعا قطعا، وعليه يكون المفرد قد نعت بلفظ مفرد مثله. فقد قال- رحمه الله-: «من نطفة أمشاج» كبرمة أعشار.. وهي ألفاظ مفردة غير جموع.
ولذلك وقعت صفات للأفراد، والمعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان...
وجملة «نبتليه» حال من الإنسان. أو من فاعل «خلقنا» .
أى: إنا خلقنا الإنسان بقدرتنا وحدها. «من نطفة» أى: من منّى، وهو ماء الرجل وماء المرأة، «أمشاج» أى: ممتزج أحدهما بالآخر امتزاجا تاما.
أو خلقناه من نطفة مختلطة بعناصر متعددة، تتكون منها حياة الإنسان بقدرتنا وحكمتنا.
وخلقناه كذلك حالة كوننا مريدين ابتلاءه واختباره بالتكاليف، في مستقبل حياته حين يكون أهلا لهذه التكاليف.
فَجَعَلْناهُ بسبب إرادتنا ابتلاءه واختباره بالتكاليف عند بلوغه سن الرشد سَمِيعاً بَصِيراً أى: فجعلناه بسبب هذا الابتلاء والاختبار والتكاليف مزودا بوسائل الإدراك، التي بواسطتها يسمع الحق ويبصره ويستجيب له ويدرك الحقائق والآيات الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسلنا.. إدراكا سليما، متى اتبع فطرته، وخالف وساوس الشيطان وخطواته.
وخص- سبحانه- السمع والبصر بالذكر، لأنهما أنفع الحواس للإنسان، إذ عن طريق السمع يتلقى دعوة الحق وما اشتملت عليه من هدايات، وعن طريق البصر ينظر في الأدلة المتنوعة الكثيرة التي تدل على وحدانية الله- تعالى- وعلى صدق أنبيائه فيما جاءوا به من عند ربهم.
ثم بين ذلك فقال : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) أي : أخلاط . والمشج والمشيج : الشيء الخليط ، بعضه في بعض .
قال ابن عباس في قوله : ( من نطفة أمشاج ) يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ، وحال إلى حال ، ولون إلى لون . وهكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، والحسن ، والربيع بن أنس : الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة .
وقوله : ( نبتليه ) أي : نختبره ، كقوله : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) [ الملك : 2 ] . ( فجعلناه سميعا بصيرا ) أي : جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية .
وقوله: ( إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ )يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا ذرّية آدم من نطفة، يعني: من ماء الرجل وماء المرأة، والنطفة: كلّ ماء قليل في وعاء كان ذلك ركية أو قربة، أو غير لك، كما قال عبد الله بن رواحة:
هَلْ أنْتِ إلا نُطْفَةٌ في شَنَّه (2)
وقوله: ( أمْشاجٍ ) يعني: أخلاط، واحدها: مشج ومشيج، مثل خدن وخدين؛ ومنه قول رؤبة بن العجاج:
يَطْرَحْــنَ كُــلَّ مُعْجَــلٍ نَشَّـاج
لَــمْ يُكْـسَ جِـلْدًا فـي دَمٍ أمْشـاجِ (3)
&; 24-89 &;
يقال منه: مشجت هذا بهذا: إذا خلطته به، وهو ممشوج به ومشيج: أي مخلوط به، كما قال أبو ذؤيب:
كــأنَّ الــرّيشَ والفُــوقَيْن مِنْـه
خِــلالَ النَّصْـل سِـيطَ بِـهِ مَشِـيجُ (4)
واختلف أهل التأويل في معنى الأمشاج الذي عني بها في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب وأبو هشام الرفاعي قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن عكرِمة ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) قال: ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن عكرِمة قال: ماء الرجل وماء المرأة يختلطان.
قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا زكريا، عن عطية، عن ابن عباس، قال: ماء المرأة وماء الرجل يمشجان.
قال: ثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن السديّ، عمن حدّثه، عن ابن عباس، قال: ماء المرأة وماء الرجل يختلطان.
قال: ثنا عبد الله، قال: أخبرنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، قال: إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج.
قال: ثنا أبو أُسامة، قال: ثنا المبارك، عن الحسن، قال: مُشج ماء المرأة مع ماء الرجل.
&; 24-90 &;
قال: ثنا عبيد الله، قال: أخبرنا عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة، وقد قال الله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .
قال: ثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، قال: خلق من تارات ماء الرجل وماء المرأة.
وقال آخرون: إنما عُني بذلك: إنا خلقنا الإنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها، يكون نطفة، ثم يصير علقة، ثم مضغة، ثم عظما، ثم كسي لحما.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) الأمشاج: خلق من ألوان، خلق من تراب، ثم من ماء الفرج والرحم، وهي النطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظما، ثم أنشأه خلقا آخر فهو ذلك.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن عكرِمة، في هذه الآية ( أمْشاجٍ ) قال: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظما.
حدثنا الرفاعي، قال: ثنا وهب بن جرير ويعقوب الحضْرَميّ، عن شعبة، عن سماك، عن عكرِمة، قال: نطفة، ثم علقة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ) أطوار الخلق، طورا نطفة، وطورا علقة، وطورا مضغة، وطورا عظاما، ثم كسى الله العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، أنبت له الشعر.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) قال: الأمشاج: اختلط الماء والدم، ثم كان علقة، ثم كان مضغة.
وقال آخرون: عُني بذلك اختلاف ألوان النطفة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) يقول: مختلفة الألوان.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن يمان، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ألوان النطفة.
&; 24-91 &;
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أيّ الماءين سبق أشبه عليه أعمامه وأخواله.
قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) قال: ألوان النطفة؛ نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة حمراء وخضراء.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
وقال آخرون: بل هي العروق التي تكون في النطفة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، قال: ثنا المسعودي، عن عبد الله بن المخارق، عن أبيه، عن عبد الله، قال: أمشاجها: عروقها.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن يمان، قال: ثنا أُسامة بن زيد، عن أبيه، قال: هي العروق التي تكون في النطفة.
وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك ( مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ) نطفة الرجل ونطفة المرأة، لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج، وهي إذا انتقلت فصارت علقة، فقد استحالت عن معنى النطفة فكيف تكون نطفة أمشاجا وهي علقة؟ وأما الذين قالوا: إن نطفة الرجل بيضاء وحمراء، فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سحراء على لون واحد، وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة، وإذا كانت لونا واحدا لم تكن ألوانا مختلفة، وأحسب أن الذين قالوا: هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى.
وقد حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: إنما خلق الإنسان من الشيء القليل من النطفة. ألا ترى أن الولد إذا أسكت ترى له مثل الرّير؟ وإنما خلق ابن آدم من مثل ذلك من النطفة أمشاج نبتليه.
وقوله: ( نَبْتَلِيهِ ) نختبره. وكان بعض أهل العربية يقول: المعنى: جعلناه سميعًا بصيرا لنبتليه، فهي مقدّمة معناها التأخير، إنما المعنى خلقناه وجعلناه سميعًا بصيرا لنبتليه، ولا وجه عندي لما قال يصحّ، وذلك أن الابتلاء إنما هو بصحة الآلات وسلامة العقل من الآفات، وإن عدم السمع والبصر، وأما إخباره إيانا أنه جعل لنا أسماعا وأبصارا &; 24-92 &; في هذه الآية، فتذكير منه لنا بنعمه، وتنبيه على موضع الشكر؛ فأما الابتلاء فبالخلق مع صحة الفطرة، وسلامة العقل من الآفة، كما قال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ .
وقوله: ( فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) يقول تعالى ذكره: فجعلناه ذا سمع يسمع به، وذا بصر يبصر به، إنعاما من الله على عباده بذلك، ورأفة منه لهم، وحجة له عليهم.
التدبر :
لمسة
[2] ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الِإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ وصفَ النطفةَ مع أنها مفردٌ بـ (أَمْشَاجٍ) وهو جمعٌ، لأنها في معنى الجمع، أو بجعلِ أجزائها نُطَفًا، وقيل: (أَمْشَاجٍ) مفردٌ لا جمعٌ، كبرمةٍ أعشار، وثوبِ أخلاقٍ.
وقفة
[2] ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ أي: ماء مهين مستقذر، ﴿نَّبْتَلِيهِ﴾ بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها، أم ينساها وتغره نفسه.
عمل
[2] ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه﴾ إذا أردت راحة النفس وما يعينك علي التجلد والصبر, فاستحضر دومًا أن الدنيا دار ابتلاء، لا دار قرار وبقاء.
عمل
[2] ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه﴾ (نَبتَليهِ) أيها الإنسان أنت في اختبار؛ فلا تغفل.
عمل
[2] ﴿إِنّا خَلَقنَا الإِنسانَ مِن نُطفَةٍ أَمشاجٍ نَبتَليهِ فَجَعَلناهُ سَميعًا بَصيرًا﴾ ابتلاؤك الأعظم يجيئك من السمع والبصر؛ فاحترس لهما.
وقفة
[2] ﴿أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ﴾ ننتهي من بلاء وندخل في آخر، دار كبد طبعت على كدر، اللهم أخرجنا من الابتلاءات بالرضا عنك، وحسن الظن بك، واليقين وصدق التوكل عليك.
وقفة
[2] ﴿نَبْتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ فإن قلتَ: كيف عَطَفَ على (نبْتلِيهِ) ما بعدَه بالفاء، مع أنَّ الابتلاءَ متأخرٌ عنه؟ قلتُ: (نبْتلِيهِ) حالٌ مُقدَّرة أي مريدين ابتلاءه حين تأهُّله، فجعلناه سميعًا بصيرًا، فالمعطوفُ عليه هو إرادةُ الابتلاء لا الابتلاءُ.
وقفة
[2] ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ السمع والبصر هما أهم وسائل الهداية، فهما الصمامان اللذان يوصلان النور والهدى للقلب.
عمل
[2] تفكر في خلق الإنسان ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.
وقفة
[2، 3] ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ أي: جعلنا له سمعًا وبصرًا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» خلق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
- ﴿ الْإِنْسانَ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وجملة «خَلَقْنَا الْإِنْسانَ» في محل رفع خبر «ان».
- ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «الانسان» التقدير حال كونه من نطفة أي من ماء قليل. و «من» حرف جر بياني. أمشاج:صفة- نعت- لنطفة مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة أي من نطفة قد امتزج فيها الماءان.
- ﴿ نَبْتَلِيهِ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وجملة «نبتليه» في محل نصب حال. أي خلقناه مبتلين له بمعنى: مريدين ابتلاءه.
- ﴿ فَجَعَلْناهُ: ﴾
- معطوفة بالفاء على «خلقنا» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول.
- ﴿ سَمِيعاً بَصِيراً: ﴾
- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بصيرا:صفة- نعت- لسميعا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة وهما من صيغ المبالغة: فعيل بمعنى فاعل.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ مُطْلَقَ خَلْقِ الإنسانِ، وأنَّه قد كان لا شيءَ، ثمَّ أنعَم اللهُ عليه بنعمةِ الإيجادِ؛ شَرَع يَذكُرُ كيفيَّةَ خَلْقِه، فقال تعالى:
﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا .. ﴾
التفسير :
ثم أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة إلى الله، ورغبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إلى الله.
ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهبه منها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور لنعمة الله عليه، أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية، فردها، وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك.
ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند الجزاء فقال:
وقوله- سبحانه- إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ تعليل لقوله نَبْتَلِيهِ، وتفصيل لقوله- تعالى- فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً، والمراد بالهداية هنا: الدلالة إلى طريق الحق، والإرشاد إلى الصراط المستقيم.
أى: إنا بفضلنا وإحساننا- قد أرشدنا الإنسان إلى ما يوصله إلى طريق الحق والصواب، وأرشدناه إلى ما يسعده، عن طريق إرسال الرسل وتزويده بالعقل المستعد للتفكر والتدبر في آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا.
وقوله: إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً حالان من ضمير الغيبة في «هديناه» وهو ضمير الإنسان.
و «إما» للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات: أو للتقسيم للمهدي بحسب اختلاف الذوات والصفات.
أى: إنا هديناه ودللناه على ما يوصله إلى الصراط المستقيم، في حالتي شكره وكفره، لأنه إن أخذ بهدايتنا كان شاكرا، وإن أعرض عنها كان جاحدا وكافرا لنعمنا، فالهداية موجودة في كل الأحوال، إلا أن المنتفعين بها هم الشاكرون وحدهم.
ومثل ذلك كمثل رجلين، يرشدهما مرشد إلى طريق النجاة، فأحدهما يسير في هذا الطريق فينجو من العثرات والمتاعب والمخاطر.. والآخر يعرض عن ذلك فيهلك.
ولما كان الشكر قل من يتصف به، كما قال- سبحانه-: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ جاء التعبير بقوله- سبحانه- شاكِراً بصيغة اسم الفاعل. ولما كان الجحود والكفر يعم أكثر الناس، جاء التعبير بقوله- تعالى- كَفُوراً بصيغة المبالغة.
والمقصود من الآية الكريمة: قفل الباب أمام الذين يفسقون عن أمر ربهم، ويرتكبون ما يرتكبون من السيئات.. ثم بعد ذلك يعلقون أفعالهم هذه على قضاء الله وقدره، ويقولون- كما حكى القرآن عن المشركين-: لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ .
ثم بين- سبحانه- بعد هذه الهداية، ما أعده لفريق الكافرين، وما أعده لفريق الشاكرين، فقال- تعالى-:
وقوله : ( إنا هديناه السبيل ) أي : بيناه له ووضحناه وبصرناه به ، كقوله : ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) [ فصلت : 17 ] ، وكقوله : ( وهديناه النجدين ) [ البلد : 10 ] ، أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد - في المشهور عنه - والجمهور .
وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله : ( إنا هديناه السبيل ) يعني خروجه من الرحم . وهذا قول غريب ، والصحيح المشهور الأول .
وقوله : ( إما شاكرا وإما كفورا ) منصوب على الحال من " الهاء " في قوله : ( إنا هديناه السبيل ) تقديره : فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ، عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها " . وتقدم في سورة " الروم " عند قوله : ( فطرت الله التي فطر الناس عليها ) [ الروم : 30 ] من رواية جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ، فإذا أعرب عنه لسانه ، فإما شاكرا وإما كفورا " .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته ، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته . وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته ، فلم يزل تحت راية الشيطان ، حتى يرجع إلى بيته " .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن ابن خثيم ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : " أعاذك الله من إمارة السفهاء " . قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون من بعدي ، لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ، فأولئك ليسوا مني ولست منهم ، ولا يردون على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ، فأولئك مني وأنا منهم ، وسيردون على حوضي . يا كعب بن عجرة ، الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة ، والصلاة قربان - أو قال : برهان - يا كعب بن عجرة ، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت ، النار أولى به . يا كعب ، الناس غاديان ، فمبتاع نفسه فمعتقها ، وبائع نفسه فموبقها " .
ورواه عن عفان ، عن وهيب ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، به .
يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ) إنا بينا له طريق الجنة، وعرّفناه سبيله، إن شكر، أو كفر. وإذا وُجِّه الكلام إلى هذا المعنى، كانت إما وإما في معنى الجزاء، وقد يجوز أن تكون إما وإما بمعنى واحد، كما قال: إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فيكون قوله: ( إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) حالا من الهاء التي في هديناه، فيكون معنى الكلام إذا وُجه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه السبيل، إما شقيا وإما سعيدا، وكان بعض نحويِّي البصرة يقول ذلك كما قال: إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ كأنك لم تذكر إما، قال: وإن شئت ابتدأت ما بعدها فرفعته.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ) قال: الشقوة والسَّعادة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ) للنعم ( وَإِمَّا كَفُورًا ) لها.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ... ) إلى ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ) قال: ننظر أيّ شيء يصنع، أيّ الطريقين يسلك، وأيّ الأمرين يأخذ، قال: وهذا الاختبار.
التدبر :
لمسة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ لقلة الشاكرين جاء (شَاكِرًا) اسم فاعل يفيد القلة, ولكثرة الكفور الجحود أصبح (كَفُورًا) صيغة مبالغة, فالآية تحفز الهمم لشكر الله, فالحمد لله كبيرًا كثيرًا.
وقفة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ لا طريق ثالث.
وقفة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ إذا أردتَ أن تعرفَ هدايةَ اللهِ لك، فانظُر إلى حالِك: هل أنتَ من الشَّاكِرين أم لا؟
وقفة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ثبوت الاختيار للإنسان، وهذا من تكريم الله له.
وقفة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ قال القشيري: «إما للشقاوة، وإما للسعادة، إما شاكرًا من أوليائنا، وإما أن يكون كافرًا من أعدائنا، فإن شكر فبالتوفيق، وإن كفر فبالخذلان».
وقفة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ مهما بلغ عملك لن تأدي شكر الله.
اسقاط
[3] ﴿إِنّا هَدَيناهُ السَّبيلَ إِمّا شاكِرًا وَإِمّا كَفورًا﴾ الطريق واضح، والخيار لك.
لمسة
[3] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ جمع بين الشاكر والكفور، ولم يقل: إما شكورًا، وإما كفورًا مع اجتماعهما في صيغة المبالغة، فنفي المبالغة في الشكر وأثبتها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يؤدى مهما كثر، فانتفت عنه المبالغة، ولم تنتف عن الكفر المبالغة، فإن أقل الكفر مع كثرة النعم على العبد يكون جحودًا عظيمًا لتلك النعم.
تفاعل
[3] سَل الله الهداية ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾.
وقفة
[3] ﴿إما شاكرا وإما كفورا﴾كان السلف يسأل بعضهم بعضًا عن حاله وصحته؛ لأجل أن يسمع: «الحمد لله».
الإعراب :
- ﴿ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ: ﴾
- تعرب اعراب «إِنَّا خَلَقْنَا» في الآية السابقة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. السبيل: مفعول به ثان منصوب بالفتحة.
- ﴿ إِمَّا شاكِراً: ﴾
- حرف تفصيل للتخيير بمعنى «أو» لا عمل لها. شاكرا: حال منصوبة بالفتحة.
- ﴿ وَإِمَّا كَفُوراً: ﴾
- معطوفة بالواو على «إِمَّا شاكِراً» وتعرب اعرابها. وهي من صيغ المبالغة فعول بمعنى «فاعل» أي كثير الكفران.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن ذَكَرَ اللهُ أنَّه خَلَقَ الإنسانَ، وأعطاه الحواسَّ الظَّاهِرةَ والباطِنةَ؛ ذَكَرَ هنا أنه بَيَّنَ له سَبيلَ الهُدى وسَبيلَ الضَّلالِ، قال تعالى:
﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا .. ﴾
التفسير :
إلى آخر الثواب أي:إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله، وكذب رسله، وتجرأ على المعاصي{ سَلَاسِلَ} في نار جهنم، كما قال تعالى:{ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ}.
{ وَأَغْلَالًا} تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها.
{ وَسَعِيرًا} أي:نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم،{ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} وهذا العذاب دائم لهم أبدا، مخلدون فيه سرمدا.
فقوله- سبحانه-: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ.. كلام مستأنف لبيان جزاء الكافرين، بعد أن تطلعت إليه النفس، بعد سماعها لقوله- تعالى-: إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً.
وابتدأ- سبحانه- بذكر جزاء الكافر، لأن ذكره هو الأقرب ولأن الغرض بيان جزائه على سبيل الإجمال، ثم تفصيل القول بعد ذلك في بيان جزاء المؤمنين.
والسلاسل: جمع سلسلة، وهي القيود المصنوعة من الحديد والتي يقيد بها المجرمون. وقد قرأ بعض القراء السبعة هذا اللفظ بالتنوين، وقرأه آخرون بدون تنوين.
والأغلال: جمع غل- بضم الغين- وهو القيد الذي يقيد به المذنب ويكون في عنقه، قال- تعالى-: إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ، وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ.
والمعنى: إنا أعتدنا وهيأنا للكافرين سلاسل يقادون بها، وأغلالا تجمع بها أيديهم إلى أعناقهم على سبيل الإذلال لهم، وهيأنا لهم- فوق ذلك- نارا شديدة الاشتعال تحرق بها أجسادهم.
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير ، وهو اللهب والحريق في نار جهنم ، كما قال : ( إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ) [ غافر : 71 ، 72 ] .
وقوله: ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ ) يقول تعالى ذكره: إنا أعتدنا لمن كفر نعمتنا وخالف أمرنا سلاسل يُسْتَوْثَق بها منهم شدّا في الجحيم ( وأغْلالا ) يقول: وتشدّ بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم.
وقوله: ( وَسَعِيرًا ) يقول: ونارا تُسْعر عليهم فتتوقد.
التدبر :
وقفة
[4] ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ خوَّفكم الله كي تحذروه، قال الرازي: «وأما السلاسل فتُشَدُّ بها أرجلهم، وأما الأغلال فتُشَدُّ بها أيديهم إلى رقابهم، وأما السعير فهو النار التي تُسعَّر عليهم، فتوقد فيكونون حطبًا لها، وهذا من أغلظ أنواع الترهيب والتخويف».
وقفة
[4] ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: «ارفعوا هذه الأيدي إلى الله تعالى قبل أن تُغَلَ بالأغلال».
وقفة
[4] ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ أطلقوا العنان لأهوائهم وشهواتهم ولم يقيدوها بقيد من مخافة الله تعالي؛ فاستحقوا أن يصفدوا ويقيدوا عقوبة وانتقامًا.
وقفة
[4] ﴿إِنّا أَعتَدنا لِلكافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغلالًا وَسَعيرًا﴾ جهنم معدة سلفًا؛ فتجنبها.
تفاعل
[4] ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ: ﴾
- تعرب اعراب «إِنَّا خَلَقْنَا» في الآية الكريمة الثانية.للكافرين: جار ومجرور متعلق بأعتدنا أي هيأنا. وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.
- ﴿ سَلاسِلَ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن «مفاعل». والألف في آخر «سلاسلا» زائدة لأن فوقها صفرا مستديرا ووضعت مراعاة لكلمتي «أغلالا» و «سعيرا».
- ﴿ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً: ﴾
- معطوفتان بواوي العطف على «سلاسل» منصوبتان مثلها بالفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا قَسَّمَهم اللهُ إلى القِسمَينِ؛ ذكَرَ جزاءَ كُلِّ قِسمٍ، قال تعالى:
﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
سلاسل:
1- سلاسل، ممنوع من الصرف، وقفا ووصلا، وهى قراءة طلحة، وعمرو بن عبيد، وابن كثير، وأبى عمرو، وحمزة.
وقرئ:
2- بالتنوين، وصلا، وبالألف المبدلة منه وقفا، وهى قراءة الأعمش.
مدارسة الآية : [5] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ .. ﴾
التفسير :
وأما{ الْأَبْرَارِ} وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته، والأخلاق الجميلة، فبرت جوارحهم، واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم{ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ} أي:شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي:خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور [في غاية اللذة] قد سلم من كل مكدر ومنغص، موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في الآخرة.
كما قال تعالى:{ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ}{ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ}{ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ}{ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ}.
ثم بين- سبحانه- ما أعده للمؤمنين الصادقين من خير عميم فقال: إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً.
والأبرار: جمع برّ أو بارّ. وهو الإنسان المطيع لله- تعالى- طاعة تامة، والمسارع في فعل الخير، والشاكر لله- تعالى- على نعمه.
والكأس: هو الإناء الذي توضع فيه الخمر، ولا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت الخمر بداخله، ويصح أن يطلق الكأس على الخمر ذاتها على سبيل المجاز، من باب تسمية الحال باسم المحل، وهو المراد هنا. لقوله- تعالى- كانَ مِزاجُها كافُوراً. و «من» للتبعيض.
والضمير في قوله مِزاجُها يعود إلى الكأس التي أريد بها الخمر، والمراد «بمزاجها» : خليطها من المزج بمعنى الخلط يقال: مزجت الشيء بالشيء، إذا خلطته به.
والكافور: اسم لسائل طيب الرائحة، أبيض اللون، تميل إليه النفوس.
أى: إن المؤمنين الصادقين، الذين أخلصوا لله- تعالى- الطاعة والعبادة والشكر..
يكافئهم- سبحانه- على ذلك، بأن يجعلهم يوم القيامة في جنات عالية، ويتمتعون بالشراب من خمر، هذه الخمر كانت مخلوطة بالكافور الذي تنتعش له النفوس، وتحبه الأرواح والقلوب، لطيب رائحته، وجمال شكله.
وذكر- سبحانه- هذه الأشياء في هذه السورة- من الكافور- والزنجبيل، وغيرهما، لتحريض العقلاء على الظفر في الآخرة بهذه المتع التي كانوا يشتهونها في الدنيا، على سبيل تقريب الأمور لهم، وإلا فنعيم الآخرة لا يقاس في لذته ودوامه بالنسبة لنعيم الدنيا الفاني.
قال ابن عباس: كل ما ذكر في القرآن مما في الجنة وسماه، ليس له من الدنيا شبيه إلا في الاسم. فالكافور، والزنجبيل، والأشجار والقصور، والمأكول والمشروب، والملبوس والثمار، لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم.
ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ) وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة ، مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة .
قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل ; ولهذا قال :
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) .
يقول تعالى ذكره: إن الذين برّوا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه، واجتناب معاصيه، يشربون من كأس، وهو كل إناء كان فيه شراب ( كَانَ مِزَاجُها ) يقول: كان مزاج ما فيها من الشراب ( كافُورًا ) يعني: في طيب رائحتها كالكافور. وقد قيل: إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة، فمن قال ذلك، جعل نصب العين على الردّ على الكافور، تبيانا عنه، ومن جعل الكافور صفة للشراب نصبها، أعني العين عن الحال، وجعل خبر كان قوله: ( كافُورًا ) ، وقد يجوز نصب العين من وجه ثالث، وهو نصبها بإعمال يشربون فيها فيكون معنى الكلام: إن الأبرار يشربون عينا يشرب بها عباد الله، من كأس كان مزاجها كافورا. وقد يجوز أيضا نصبها على المدح، فأما عامة أهل التأويل فإنهم قالوا: الكافور صفة للشراب على ما ذكرت.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( مِزَاجُهَا كَافُورًا ) قال: تمزج.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ) قال: قوم تمزج لهم بالكافور، وتختم لهم بالمسك.
--------------------------------------------------------------------------------
الهوامش:
(1) لم أقف على قائل البيت، وقد جاءت فيه كلمة "فرنها" هكذا في المخطوطة والمطبوعة، ولم نهتد إلى تصويبها. وقد أنشده المؤلف عند تفسير قوله تعالى: { والتفت الساق بالساق } . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 183 ) { والتفت الساق بالساق } مثل: شمرت عن ساقها . ا هـ . وقال الفراء في معاني القرآن ( 350 ) : أتاه أول شدة أمر الآخرة، وأشد آخر أمر الدنيا. ويقال: التفت ساقاه كما يقال للمرأة إذا التصقت فخذاها: هي لفاء.
(2) البيت من مشطور الرجز لسيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري، من أبيات قالها في غزوة مؤتة من أرض الشام ( سيرة ابن هشام: طبعة الحلبي الأولى 4 : 21 ) والنطفة: الماء القليل الصافي. والشنة: السقاء البالي. ومعناه: فيوشك أن تهراق النطفة، أو يتخرق السقاء، ضرب ذلك مثلا لنفسه في جسده.
(3) البيتان لرؤبة بن العجاج ( ديوانه 32 ) . وقبله:
حـــتى مســـيناهن بــالإخداج
يقـــذفن كــل معجــل نشــاج
والنون: راجعة إلى النياق ومسيناهن ومسوناهن: أي أدخلنا أيدينا في حيائهن لإخراج الأجنة من بطونهن، من كل ولد ذي صوت، ولكنه لم يكس جلدا بعد، نخرجهن مع دم مختلط بغيره، مما يتجمع في الرحم والمشيمة. قال في ( اللسان: مشج ) وفي التنزيل العزيز { إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج } قال الفراء: الأمشاج: هي الأخلاط: ماء الرجل وماء المرأة، والدم والعلقة؛ ويقال للشيء من هذا إذا خلط: مشيج، كقولك: خليط، وممشوج: كقولك مخلوط، مشجت بدم وذلك الدم دم الحيض. وقال أبو إسحاق ( الزجاج ) أمشاج: أخلاط من مني ودم، ثم ينقل من حال إلى حال. ويقال: نطفة أمشاج: ماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها. ا هـ .
(4) البيت في ( اللسان: مشج ) ونسبه لزهير بن حرام الهذلي، وهو الملقب بالداخل. ( وانظره في شرح السكري لأشعار الهذليين طبعة لندن 269 ) . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 183 ) إلى أبي ذؤيب، وعنه نقل المؤلف. ونسب في الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي 838 ) إلى الشماخ، وليس بصحيح. أما رواية البيت فتختلف ألفاظها في المراجع، وأجودها رواية الكامل، ( لسان العرب: شرخ ) وهي:
كــأنَّ المَتْــنَ والشَّــرْخَينِ مِنْـهُ
خِـلافَ النَّصْـلِ سـيطَ بِـهِ مَشِـيج
قال المبرد: يريد سهما رمى به، فأنفذ الرمية، وقد اتصل به دمها. والمتن: متن السهم. وشرخ كل شيء: حده. فأراه شرخي الفوق وهما حرفاه. والمشيج: اختلاط الدم بالنطفة. هذا أصله. وفي ( اللسان: شرخ ) وشرخ كل شيء: حرفه الناتئ، كالسهم ونحوه. وشرخا الفوق: حرفاه المشرفان اللذان يقع بينهما الوتر. ا هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ قوله: (مِن كَأْسٍ) مِنْ تبعيضية على أحد الأقوال، والمعنى: يشربون بعض الكأس لا كله، وهي عادة أهل الترف والتنعم، وطريقة شرب مزاجية لا حاجية، نسأل لله من فضله, فالدافع لها الترفة وليس العطش.
وقفة
[5] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ الأبرار: هم الذين خلطوا مباحات مع الطاعات، فخُلط لهم الشرابُ بالكافور؛ كما خلطوا أعمال الطاعات بالمباحات، جزاءً وفاقًا, فما أعدل الله!
وقفة
[5] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ فرَّق بينهما في الشرب وطريقته: فالأبرار يشربون ﴿مِن كَأْسٍ﴾ فإناؤهم محدود، وطريقة مشروبهم ممزوج بكافور وزنجبيل كما قال: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾. أما المقربون: فيشربون من العينٍ وليس من الكأس كما قال: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا﴾ فشربهم أكمل, ويشربون مشروبهم صافيًا ماءً وخمرًا غير ممزوج, لأن المقربين أكمل من الأبرار لكمال أعمالهم.
وقفة
[5] ﴿إِنَّ الأَبرارَ يَشرَبونَ مِن كَأسٍ كانَ مِزاجُها كافورًا﴾ (يَشرَبونَ) الفعل فى زمن المضارع؛ للاستمرارية والمداومة وحصول المتعة منه، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى.
وقفة
[5] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ هي عين في الجنة تُسمَّى كافورًا، يُمزج منها شراب الأبرار، وهم المقتصدون من أصحاب اليمين، بعكس المقربين الذين يشربون بتلك العين صرفًا خالصًا.
وقفة
[5] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ فائدة فعل (كان) في قوله: (كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) إفادة أن ذلك المزاج الكافوري لا يفارق شراب الأبرار في الجنة، مع ندرة هذا المزاج في الدنيا لغلاء ثمنه وندرة وجوده.
تفاعل
[5] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.
وقفة
[5] قال تعالى: ﴿كان مزاجها كافورا﴾، وقال تعالى بعد ذلك: ﴿مزاجها زنجبيلا﴾ [17] كيف نجمع بينهما؟ الجواب: أشار بالأولى إلى برودتها وطيبها، والثانية: إلى طعمها ولذتها؛ لأن العرب كانت تستطيب الشراب البارد، وتستلذ طعم الزنجبيل، وذكرت ذلك في أشعارها، فظاهر القرآن أنهما أسماء عينين في الجنة، فقيل: الكافور للإبراد، والزنجبيل يمزجون بها أشربتهم، ويشربها المقربون صرفًا.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ الْأَبْرارَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الأبرار: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
- ﴿ يَشْرَبُونَ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ان» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.
- ﴿ مِنْ كَأْسٍ ﴾
- جار ومجرور متعلق بيشربون. و «من» حرف جر للابتداء والغاية أي من خمر.
- ﴿ كانَ مِزاجُها كافُوراً: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر صفة- نعت- لكأس. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. مزاج: اسم «كان» مرفوع بالضمة. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. كافورا: خبر «كان» منصوب بالفتحة. أي ان ما تمزج به كان ماء كافور وهو اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته.'
المتشابهات :
| الانسان: 5 | ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ |
|---|
| الانسان: 17 | ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ سُوءَ حالِ الكافرينَ، وأوجز فيه؛ أتْبَعَه هنا حُسنَ حالِ الشَّاكرينَ، وأطنَبَ فيه؛ تأكيدًا للتَّرغيبِ، قال تعالى:
﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
كافورا:
وقرئ:
قافورا، بالقاف، وهى قراءة عبد الله.