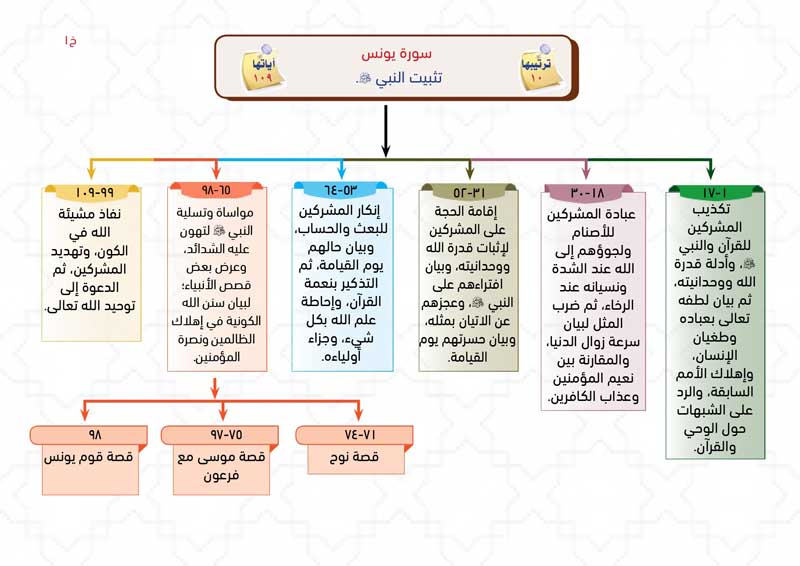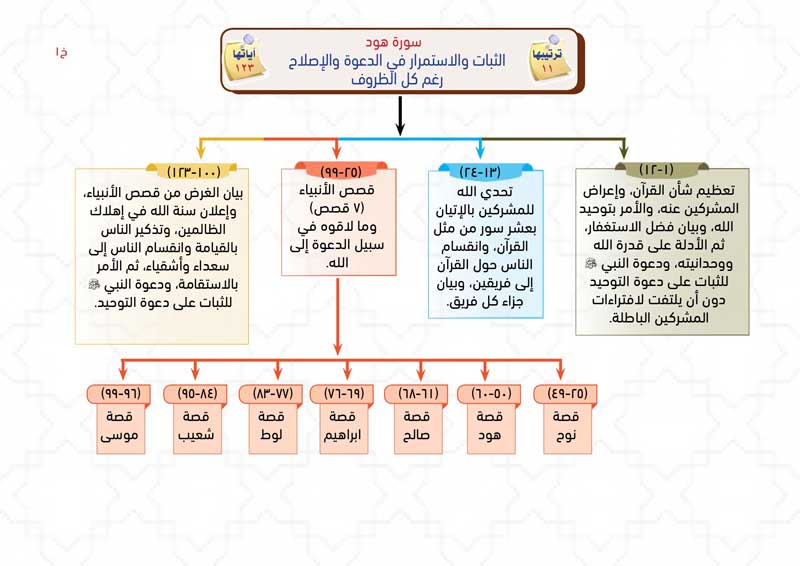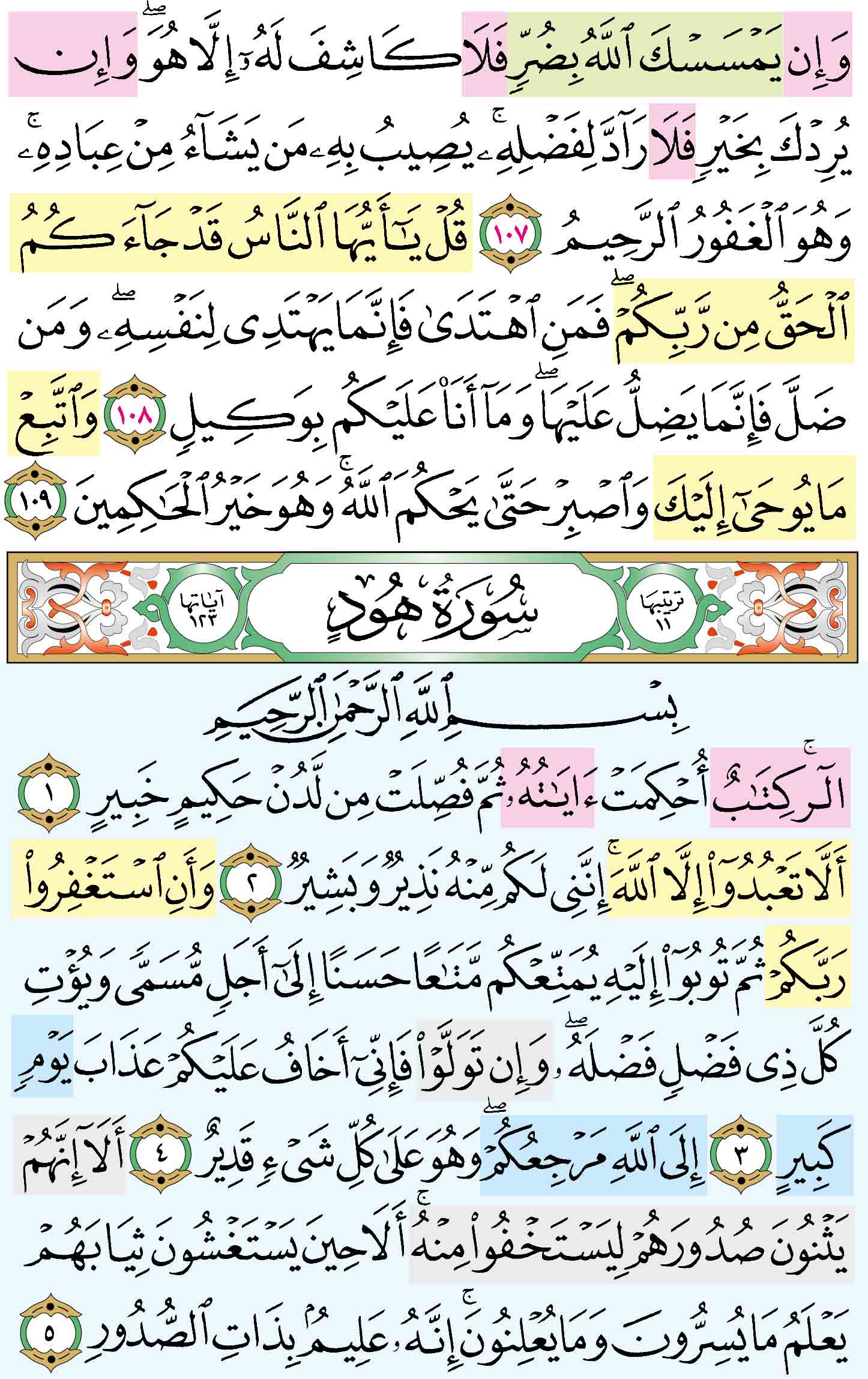
الإحصائيات
سورة يونس
| ترتيب المصحف | 10 | ترتيب النزول | 51 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 13.50 |
| عدد الآيات | 109 | عدد الأجزاء | 0.65 |
| عدد الأحزاب | 1.30 | عدد الأرباع | 5.30 |
| ترتيب الطول | 10 | تبدأ في الجزء | 11 |
| تنتهي في الجزء | 11 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 4/29 | آلر: 1/5 | ||
سورة هود
| ترتيب المصحف | 11 | ترتيب النزول | 52 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 14.00 |
| عدد الآيات | 123 | عدد الأجزاء | 0.65 |
| عدد الأحزاب | 1.30 | عدد الأرباع | 5.90 |
| ترتيب الطول | 8 | تبدأ في الجزء | 11 |
| تنتهي في الجزء | 12 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 5/29 | آلر: 2/5 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (107) الى الآية رقم (109) عدد الآيات (3)
لَمَّا بَيَّنَ اللهُ أنَّ الأصنامَ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ النَّفْعَ والضُّرَّ بيدِ اللهِ وحدَه، وأنَّه المُنفَرِدُ بذلك، ثُمَّ بَيَّنَ أنَّ فائدةَ الطَّاعةِ ليسَتْ راجعةً إلَّا للعبادِ، وضرَرَ النُّفورِ ليسَ عائدًا إلَّا عليهِم.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)
بدأَتْ السُّورةُ بتمجيدِ القرآنِ الكريمِ، والدَّعوةِ إلى عبادةِ اللهِ وحدَهُ، والاستغفارِ والتوبةِ، ثُمَّ بيانُ إعراضِ الكُفَّارِ عن الحقِّ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة يونس
تثبيت النبي ﷺ/ الدعوة إلى الإيمان بالله قبل فوات الأوان/ التسليم لقضاء الله وقدره وبيان حكمة الله وتدبيره
أولاً : التمهيد للسورة :
- • هل تتحدث سورة يونس عن قصة يونس عليه السلام ؟: الجواب: لا، لم تتحدث سورة يونس عن قصة يونس عليه السلام. لم تذكر قصته، بل ذكرت قومه مرة واحدة فقط (وفي آية واحدة فقط، آية من 109 آية)، وهى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ (98). فالكلام هنا عن قومه، وهو الآن ليس موجودًا معهم، لأنه تركهم وكان في بطن الحوت عند إيمانهم. ذُكِرَ يونس عليه السلام في القرآن 6 مرات: 4 بالاسم الصريح في: النساء والأنعام ويونس والصافات، وذكر بالوصف في سورتين؛ في الأنبياء: ذا النون، وفي القلم: صاحب الحوت. وذكرت قصته في: الأنبياء والصافات والقلم، وذكر الاسم فقط في: النساء والأنعام ويونس.
- • لماذا سميت السورة باسم يونس ولم تذكر قصته هنا؟: والجواب: أن قوم نوح هلكوا، وآل فرعون غرقوا، لكن قوم يونس نجوا، فكانت السورة رسالة للنبي ﷺ: اصبر يا محمد ﷺ على قومك، لا تستعجل كما استعجل يونس، فسوف يؤمن أهل مكة كما آمن قوم يونس (وقد وقع هذا بالفعل في فتح مكة). ولهذا نحن الآن لا نستغرب ما فعله النبي ﷺ عندما جاءه مَلَكُ الْجِبَالِ أثناء رجوعه من الطائف، وقال له: «يَا مُحَمّدُ، إنْ شِئْت أَطْبَقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ»، فكان رده ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» . ونلاحظ: أن يونس عليه السلام هو النبي الوحيد الذي آمن به قومه ولم يهلكهم العذاب. فكانت السورة بشري ضمنية لرسول الله ﷺ أنك ستكون مثل يونس في هذا الأمر، قومك سيسلمون علي يديك بإذن الله، ولن يهلكهم العذاب (وهذا ما حدث بالفعل في فتح مكة بعد ذلك).
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «يونس».
- • معنى الاسم :: هو نبي الله يونس بن متى عليه السلام ، أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل.
- • سبب التسمية :: لما تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب، وهذه من الخصائص التي خصَّ الله بها قوم يونس.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: : لا أعرف لها اسمًا غيره.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده دون ما سواه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾
- • علمتني السورة :: التسليم لقضاء الله وقدره.
- • علمتني السورة :: أن الله حافظ عبده، فبقي يونس في بطن الحوت دون أن يموت، وقد أعاده الله للحياة.
- • علمتني السورة :: ما يقدره الله حولك من أحداث وأخبار ونوازل إنما هو تذكير لك، فاحذر أن تكون عنها غافلًا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- o عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة يونس من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة يونس تعتبر -بحسب ترتيب المصحف- أول سور المئين.
• سورة يونس تعتبر -بحسب ترتيب المصحف- أول سورة تسمى باسم نبي، والسور التي سميت باسم نبي 6 سور، هي: يونس، وهود، وإبراهيم، ويوسف، ومحمد، ونوح عليهم السلام.
• سورة يونس تشبه سورة الأنعام من حيث الموضوع والأسلوب، فكلتاهما تتناول حقائق العقيدة من حيث الجانب النظري، ومواجهة ومجادلة المشركين.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، قبل أن يقال لنا: (آلآن) كما قيل لفرعون.
• أن نُسَلِّم لقضاء الله وقدره.
• أن لا نيأس من دعوة الناس أبدًا.
• أن نطيع الله وننفذ ما يأمرنا به مهما شعرنا باليأس والتعب، سيأتي الفرج يومًا من عنده.
• أن نتذكر كلّما خشينا أمرًا، أو اعترانا همّ، أو أصابتنا كُربة، أن الله وحده من: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ (3).
• أن نتذكر ضُّرًا أو مرضًا كشفه الله عنا، ثم نجتهد في حمده وشكره: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ﴾ (12).
• ألا نؤمل في الناس خيرًا أكثر من اللازم: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾ (12)، فقد تحسن إلى إنسان فلا يكافئك على إحسانك، فلا تتعجب، فمن الناس من يكشف الله عنه الضُرَّ فيمر كأن الله لم يكشف عنه شيئًا، فإذا كان هذا تعامله مع خالقه فمن باب أولى أن يكون تعامله مع عبد مثله ومخلوق مثله أردى من ذلك وأسوأ.
• أن نستمر في تذكر الآخرة؛ ففي هذا حماية من الوقوع في المعاصي: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (15).
• أن نحذر من الوقوع في الشرك، ونحذر من حولنا، ونبين لهم أن من الشرك دعاء غير الله أو الاستشفاع بالأموات: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّـهِ﴾ (18).
• أن نتقي ثلاثة أمور فإنها ترجع على صاحبها: 1- المكر: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر 43). 2- البغي: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم﴾ (23). 3- النكث: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (الفتح 10).
• ألا نغتر بالحياة الدنيا وزينتها؛ فإنها حياة قصيرة: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ... فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾ (24).
• أن نحسن أعمالنا في الدنيا ليحسن الله إلينا يوم القيامة: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (26). • ألا نقلق؛ فالذي يدبر الأمر هو الله، حتى المشركين يعرفون ذلك: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ... وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ (31).
• أن نقرأ آيات التحدي، ونتفكر في عجز المشركين: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (38).
• أن نحدد شخصًا أو مجموعة يذكروننا بالمعصية، ونحتسب الأجر في ترك صحبتهم: ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (41).
• أن نفتدي أنفسنا اليوم من عذاب الله، ولو بقليل مال، أو يسير طعام أو شراب، أو ركعة، أو سجدة، قبل أن نتمنى أن نفتدي بالدنيا وما فيها: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ (54).
• أن نحتاط في الفتوى، ونحذر من القول على الله بلا علم: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (60).
• أن نتقي الله تعالى في سرنا وجهرنا؛ فجميع أعمالنا محصاة علينا من خير وشر: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (61).
• أن نُذَكِّر أنفسنا بـ: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ﴾ (72) عند كل عمل نقوم به، لا ننتظر جزاءً إلا من الله. • ألا نترك موضع إبرة في قلوبنا فيه اعتماد على غير الله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ (84).
• أن نحرص على التأمين حال سماع الدعاء؛ فإن التأمين بمنْزلة الدعاء: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ (89). • أن تكون دعوتنا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وليست بالإكراه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (99).
• أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له: ﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (105). • ألا نقلق، بل نطمئن ونتوكل على الله فهو المدبر: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (107).
سورة هود
الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف/ التوازن (أو: الثبات على الحق دون تهور أو ركون)
أولاً : التمهيد للسورة :
- • السورة تقدم 7 نماذج من الأنبياء الكرام:: في ظل هذه الأجواء تنزل سورة "هود" لتقول: اثبتوا واستمروا في الدعوة. نزلت بهدف : تثبيت النبي ﷺ والذين معه على الحق. نزلت تنادي: الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف.
- • سورة هود شيبت النبي ﷺ:: ذكرت السورة 7 نماذج من الأنبياء الكرام، وصبرهم على ما لاقوه من أقوامهم، كل منهم يواجه الجاهلية الضالة ويتلقى الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهديد والإيذاء، وهم: نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، موسى. وهم الأنبياء أنفسهم الذين ذُكروا في سورة الشعراء والعنكبوت (لكن ليس بنفس هذا الترتيب). وأيضًا نفس الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأعراف إلا إبراهيم (وبنفس ترتيب هود). وكأنها تقول للنبي ﷺ وأصحابه: هذا ما حدث للأنبياء قبلكم، أصابتهم المحن ولاقوا من المصاعب ما لاقوا خلال دعوتهم، ومع هذا ثبتوا وصبروا واستمروا؛ فاثبتوا واصبروا واستمروا مثلهم.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «هود».
- • معنى الاسم :: هو نبي الله هود عليه السلام، أرسله الله إلى عاد في الأحقاف التي تقع جنوب الجزيزة العربية بين عُمان وحضر موت.
- • سبب التسمية :: لتكرار اسمه فيها خمس مرات، ولأنه ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: : لا أعرف لها اسمًا غيره.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: رعاية الله عز وجل لأوليائه ولطفه بهم في أوقات الشدائد والمحن.
- • علمتني السورة :: أن التوحيد أول الواجبات: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ...﴾
- • علمتني السورة :: أن العبرة بالأحسن، لا بالأكثر! فالله لم يقل: (أكثر عملًا)، بل قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾
- • علمتني السورة :: أن أقارن بين خاتمة المجرمين والمؤمنين، فقد وجدت الكافرين في النار، ليس لهم أولياء يدفعون عنهم العذاب الأليم، أما المؤمنون فـ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (23)، فالفريق الأول (الكفار) مثلهم كمثل الأعمى الأصم، والفريق الثاني (المؤمنون) كالبصير السميع، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (24).
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة هود من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.
• عَنْ كَعْب الأحبار قَالَ: «فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة هود من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم (حديث: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ» سبق قبل قليل).
• سورة هود احتوت على أطول قصة لنوح في القرآن الكريم، وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور، ولا سورة الأعراف على طولها، ولا سورة نوح التي أفردت لقصته.
• سورة هود تشبه سورة الأعراف من حيث الموضوع؛ فكلتاهما تتناولان قصة التوحيد في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ من خلال قصص الأنبياء، ولكن تبقى لكل سورة أسلوبها الخاص؛ فمثلًا نجد سورة الأعراف ركزت وفصلت كثيرًا في قصة موسى خاصة مع بني إسرائيل في ما يقارب من 70 آية من السورة، بينما قصة موسى ذكرت في 4 آيات من سورة هود، ونجد سورة هود فصلت أكثر في قصة نوح من سورة الأعراف.
• سورة هود وسورة النحل تعتبر من أطول سور المئين، فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطِّوَال.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نصبر ونستمر في الدعوة إلى الله رغم كل الظروف، دون أي تهور أو ركون.
• أن نستغفر الله دومًا ونتوب إليه: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، فإذا تم هذا كان العيشُ الهانئ في الدنيا: ﴿يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، والتكريم في الآخرة: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾، وإلا كان التهديد والوعيد بعذاب الآخرة الدائم: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (3).
• أن نراقب الله في السر والعلن: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (5).
• أن نجتهد في طلب الرزق، متيقنين أن الله هو الرزاق: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (6).
• ألا نتكبر إذا أصابنا الخير بعد الشر؛ بل نشكر الله تعالى على نعمه: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ (10).
• أن نراجع مشروعاتنا في الحياة؛ هل سننتفع بها في الآخرة؟: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (16).
• أن نعمل أعمالًا صالحة تشهد لنا بها الأشهاد يوم القيامة: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ (18).
• أن نتقي ظلم أنفسنا بالمعاصي، أو ظلم غيرنا بإضلالهم: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ (18، 19).
• أن نصلي ركعتين، ثم ندعو الله ونتضرع إليه أن يرزقنا الإخبات إليه (أي: التواضع والتسليم له): ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (23).
• ألا نحتقر أحدًا في دعوتنا لمكانته الاجتماعية أو المادية: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (27).
• أن نحتسب في تعليم المسلمين ودعوتهم إلى الله: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـه﴾ (29).
• أن نكثر من زيارة الضعفاء، ونقدّم لهم الهدايا والعطايا: ﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ (30).
• ألا نيأس إذا قَلَّ من يسمع نصحنا، أو كَثُرَ مخالفونا؛ فإنَّ الأنبياء قد أفنوا أعمارهم الطويلة في الدعوة، ولم يستجب لبعضهم إلا القليل: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (40).
• أن نُذَكِّر من حولنا بنعم الله تعالى عليهم وإحسانه لهم: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه﴾ (61).
• أن نلقي السلام، وأن نرد بأحسن منه، فضيوف إبراهيم عليه السلام حين دخلوا سلموا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا﴾ (69)، وهو رد: ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ هم حيـَّوه بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث، ورد عليهم بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت، فكان رد إبراهيم عليه السلام بأحسن من تحيتهم.
• أن نتم الكيل والوزن، ولا نبخس الناس أشياءهم: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (85).
• أن نفتش في أنفسنا: هل ظلمنا أحدًا في عرض، أو مال، أو غيره، ثم نردّ الحقوق لأهلها: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (85).
• أن نبتعد عن الظلم والظالمين: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (113).
• أن نحافظ على أداء الصلوات أول وقتها مع الجماعة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ (114).
• أن ننكر على أهل البدع أو المجاهرين بالمعاصي بأسلوب حكيم: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ (116).
تمرين حفظ الصفحة : 221
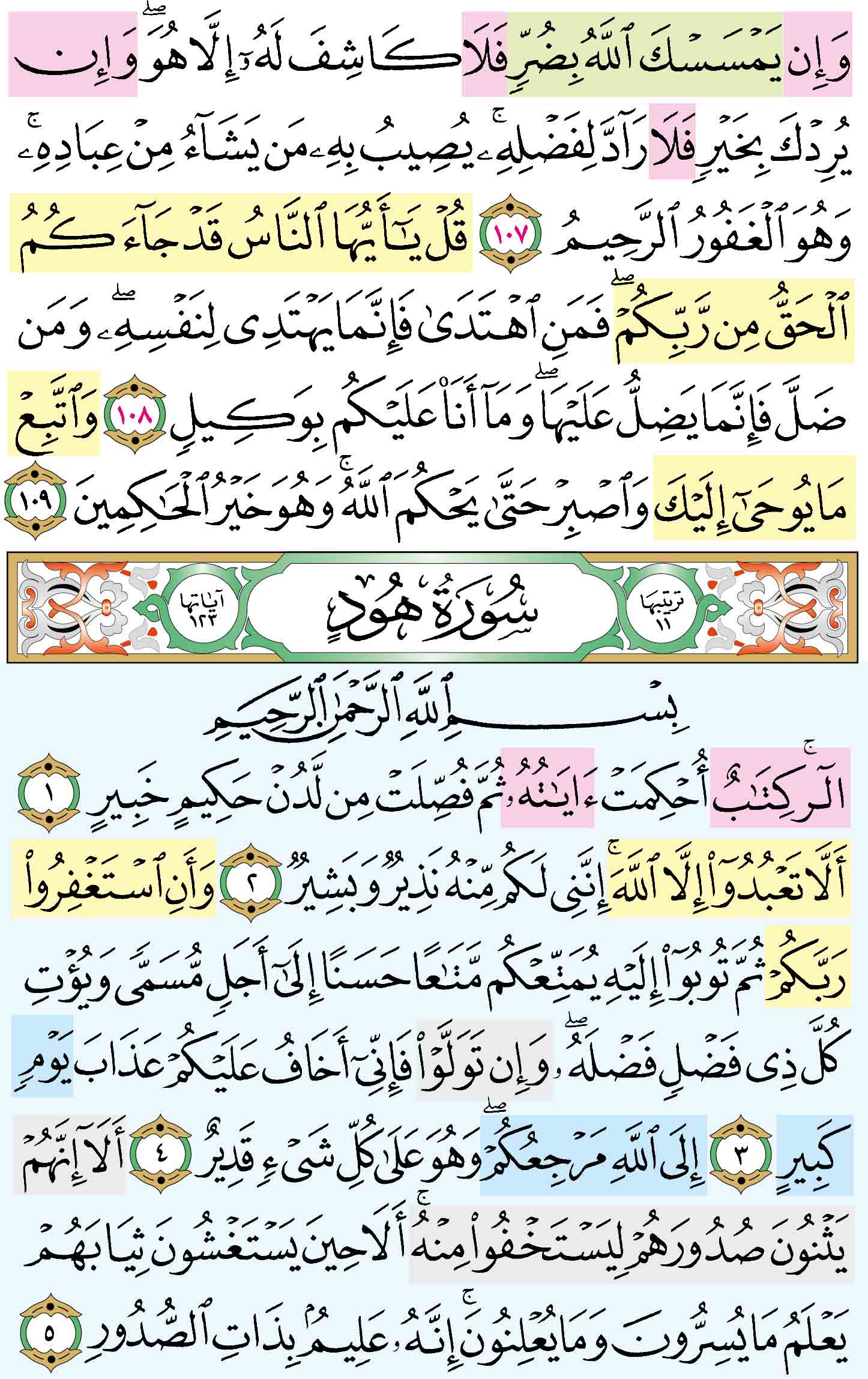
مدارسة الآية : [107] :يونس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ .. ﴾
التفسير :
هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر، كفقر ومرض، ونحوها{ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} لأن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده الله، ولهذا قال:{ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} أي:لا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى:{ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ، فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ}
{ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي:يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم،{ وَهُوَ الْغَفُورُ} لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد، غفر الله ذنوبه، كبارها، وصغارها.
{ الرَّحِيمِ} الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغنى عن إحسانه، طرفة عين، فإذا عرف العبد بالدليل القاطع، أن الله، هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحدًا من الخلق، ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
ثم بين- سبحانه- أنه وحده هو الضار والنافع فقال: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
«المس» : أعم من اللمس في الاستعمال، يقال: مسه السوء والكبر والعذاب والتعب، أى: أصابه ذلك ونزل به.
والضر: اسم للألم والحزن وما يفضى إليهما أو إلى أحدهما، كما أن النفع اسم للذة والسرور وما يفضى إليهما أو إلى أحدهما.
والخير: اسم لكل ما كان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو مستقبلة.
والمعنى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كمرض وتعب وحزن، فلا كاشف له، أى: لهذا الضر إِلَّا هُوَ- سبحانه-.
وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ كمنحة وغنى وقوة فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ أى: فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير عنك.
وعبر- سبحانه- بالفضل مكان الخير للإرشاد إلى تفضله على عباده بأكثر مما يستحقون من خيرات.
وقوله يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أى: يصيب بذلك الفضل والخير مَنْ يَشاءُ إصابته مِنْ عِبادِهِ.
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أى: وهو الكثير المغفرة والرحمة لمن تاب إليه، وتوكل عليه، وأخلص له العبادة.
وفي معنى هذه الآية جاء قوله- تعالى-: ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها،وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
.
وقال ابن كثير: «وروى ابن عساكر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته، يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوه أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم» .
وقوله : ( وإن يمسسك الله بضر ) إلى آخرها ، بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد ، فهو الذي يستحق العبادة وحده ، لا شريك له .
روى الحافظ ابن عساكر ، في ترجمة صفوان بن سليم ، من طريق عبد الله بن وهب : أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى ، عن صفوان بن سليم ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اطلبوا الخير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته ، يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم ، ويؤمن روعاتكم "
ثم رواه من طريق الليث ، عن عيسى بن موسى ، عن صفوان ، عن رجل من أشجع ، عن أبي هريرة مرفوعا ؛ بمثله سواء
وقوله : ( وهو الغفور الرحيم ) أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه ، ولو من أي ذنب كان ، حتى من الشرك به ، فإنه يتوب عليه .
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن يصبك الله ، يا محمد ، بشدة أو بلاء ، (1) فلا كاشف لذلك إلا ربّك الذي أصابك به ، دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والأنداد (2) ، (وإن يردك بخير ) ، يقول: وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور (3) ، (فلا رادّ لفضله ) ، يقول: فلا يقدر أحدٌ أن يحول بينك وبين ذلك ، ولا يردّك عنه ولا يحرمكه; لأنه الذي بيده السّرّاء والضرّاء ، دون الآلهة والأوثان ، ودون ما سواه ، (يصيب به من يشاء ) ، يقول: يصيب ربك ، يا محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء ، من يشاء ويريد (4) ( من عباده وهو الغفور ) ، لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه إلى الإيمان به وطاعته ، (الرحيم ) بمن آمن به منهم وأطاعه ، أن يعذبه بعد التوبة والإنابة. (5)
* * *
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لمسة
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ﴾ (إن) للافتراض والاحتمال، فإذن كِلا الأمرين على الاحتمال، إن وقع كذا وإن وقع كذا.
عمل
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أيها المبتلى: لا تستعجل، ستأتي اللحظات التي تكون نسبة ضرك لمقدار شفائك (إنما هي مساس فقط).
وقفة
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ كم ستشرق القلوب الموجوعة إذا قامت فيها هذه الحقيقة القرآنية؟!
وقفة
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كيف تخاف فوات شيء من الخير أراده الله بك ، وإن لم يرده بك فمن الذي يقدر على أن يعطيه لك ؟!
وقفة
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
وقفة
[107] من عرف الناس استراح، قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، آية تقطع التعلّق بالناس.
وقفة
[107] عن عامر بن قيس قال: «أربع آيات من كتاب الله تعالى إذا قرأتهن، فما أبالي ما أصبح عليه وأمسي، وذكر منها: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.
وقفة
[107] من الإعجاز اللفظي في القرآن: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، ففي الضرِّ قال: ﴿يَمْسَسْكَ﴾ بينما قال في الخير: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾؛ لأن الأشياء المكروهة لا تُنسب إلى إرادة الله؛ ولأن الضرر عند الله ليس مرادًا لذاته بل لغيره، ولما يترتب عليه من المصالح، بينما الخير مراد الله بذاته، ومفعول له.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ لأنه (الرحيم) جعل الضر بيده.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله، دون ما سواه.
عمل
[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ مرر معاني هذه الآية على قلبك كثيرًا كلما أصابك ضر، واعلم أنه لن تُربتَ على أكتافنا الأفراح ما لم نحسن الظن بـالله.
وقفة
[107] كثيرون يقرؤون هذه الآية: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وينحصر فهمهم بأنَّ الخير في الكشف فحسب، مع أنَّ الخير قد يكون بإصابته بالضر لا بكشفه؛ مغفرةً لذنوبه، ورحمةً به: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، فكلُّ ما يقضيه فهو له خير، كما في الصحيح: عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» [مسلم 2999].
وقفة
[107] رسالة ربانية لكل مريض ومبتلى بضر أو مصيبة، ولكل من يخاف حاسدًا على فضل الله عليه ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.
لمسة
[107] مع الضر قال: ﴿فَلاَ كَاشِفَ﴾، ومع الخير قال: ﴿فَلَا رَادَّ﴾؛ لأن الردّ يكون للشيء قبل وقوعه، أما الكشف فيكون عن الشيء بعد وقوعه، فاستعمل كلمة كاشف مع المس؛ لأنه واقع، واستعمل كلمة رادّ مع الخير؛ لأنه لم يقع بعد.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كرمُه وعطاؤه سبحانه يأتيك بدون اختيار منك أو سؤال، فكيف إذا دعوتَه ورجوتَه بيقين؟! فما ظنك بأكرم الأكرمين؟!
عمل
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لن يستطيع أحد أن يمنع فضل الله عنك، اشتغل بطلبه فقط ولا تقلق، وثق بربك.
عمل
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا تقلـق، لن يمنع فضل الله عنك أحد، اشتغل بطلبه فقط.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا يقدر أحد أن يرد فضل الله عليك، فما كان لك سوف يصلك على ضعفك ، وما لم يكن لك لن تصل إليه بقوتك!
عمل
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾كن نفسًا هادئة؛ ولا تحمل همًّا.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ الخير المكتوب لك يأتيك حتى يصيبك، فلا تنشغل بحسد الحساد، وثـق بربك.
عمل
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا تظن أن أمرًا ما يقف أمام إرادة الله العزيز القدير وفضله.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كل سبل الأرض لا تقِف أمام خير أرَاده الله لك .
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ آية تدفعك حين تشعر أن هناك من يمنعك.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ عطاؤه سبحانه قد يأتيك دون اختيار منك أو سؤال، فكيف إذا دعوتَه عن يقين؟ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 87].
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كل سبل الأرض والبشر والكون لا تقف أمام خيرٍ أراده الله لك، اللهم اكتب لنا الخير حيث كان، وبارك لنا فيه.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا راد لفضله ولو كانت الدنيا بأسرها، فمن الذي يحرِم من أراد الله عطاءه؟! ومن يشقي من أراد الله إسعاده.
عمل
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ فلا تحمل همًّا.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ سيقتحم كل العقبات ويأتيك رغم الحواجز سيتجاوز الكارهون سيصل لك.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ ما قسم الله لك من خير فهو آت مضمون، فلا أحد يستطيع منعه.
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ مهما كانت القيود ثقيلة، والمسافات طويلة، والقوى مجتمعة، فلن تستطيع الصمود أمام فضل كتبه الله لك ﴿إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: 3].
وقفة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ على قدر اليقـين تُفتح الخـزائن.
لمسة
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ استعمال الفضل هنا، لم يقل: (فلا راد لهذا الخير)؛ لأن كل خير يصيب الإنسان هو ليس معاوضًا لعمله، وليس حقًّا واجبًا على الله سبحانه، وإنما هو تفضُّل من الله سبحانه وتعالى، فلا يقول الإنسان أنا صليت وعبدت الله عز وجل فجاءني الفضل مقابل هذه العبادة؛ لأنه مهما فعل الإنسان لا يستطيع أن يقابل فضل الله تعالى.
وقفة
[107] من دواعي الاطمئنان: أن تقرأ قول ربِّي سبحانه: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.
عمل
[107] لا تخف على رزقك وربك يقول: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.
وقفة
[107] لا تستطيع أي قوة أن تمنع خيرًا قدره الله، لا عين ولا سحر ولا سُلطة ولا مؤامرة ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
عمل
[107] حدد أكبر أمنياتك أو احتياجاتك، وألح على الله بطلبها محسنًا الظن به سبحانه ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.
تفاعل
[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ سَل الله من فضله الآن.
تفاعل
[107] استعذ بالله من الحسد؛ فإن الله تعالى إذا كتب فضلًا لأحد من عباده؛ فإنه لا راد لعطائه وكرمه ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وإنْ يمسسك الله بضرّ: ﴾
- الواو: استئنافية. إن حرف شرط جازم يمسسك: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإنْ بمعنى: يصبك وعلامة جزمه السكون والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. بضر: جار ومجرور متعلق بيمسسك.
- ﴿ فلا كاشف له: ﴾
- الفاء واقعة في جواب الشرط. لا: نافية للجنس تعمل عمل \"ان\" كاشف: اسم \"لا\" مبني على الفتح في محل نصب. له: جار ومجرور متعلق بكاشف.
- ﴿ إلاّ هو: ﴾
- أداة استثناء ويجوز أن تكون أداة حصر. هو. ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في موضع رفع بدل من موضع \"لا كاشف\" لأن موضع \"لا\" وما عملت فيه رفع بالابتداء ولو كان موضع المستثنى نصبًا لكان إلاّ إياّه. وخبر في لا\" النافية للجنس محذوف تقديره: كائن أو موجود. وجملة \"فلا كاشف\" وما تلاها: جواب شرط جازم مسبوق بنفي مقترن بالفاء في محل جزم بإنْ.
- ﴿ وإنْ يردك بخير فلا رادّ لِفَضْلِه: ﴾
- معطوفة بالواو على \"إن يمسسك الله بضر فلا كاشف\" وتعرب إعرابها وحذفت ياء \"يرد\" لالتقاء الساكنين وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. لفضله: جار ومجرور متعلق بخبر \"لا\" أي لا راد موجود لفضله. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة.
- ﴿ يصيب به من يشاء: ﴾
- يصيب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. به. جار ومجرور متعلق بيصيب. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يشاء: تعرب إعراب \"يصيب\" وصلة الموصول هي جملة \"يشاء\" والعائد ضمير منصوب محلًا لأنه مفعول به بمعنى: من يريده.
- ﴿ من عباده وهو: ﴾
- من عباد: جار ومجرور والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. الواو: استئنافية. هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. و \"من\" حرف جر بياني والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من الموصول \"من\".
- ﴿ الغفور الرحيم: ﴾
- الغفور: خبر \"هو\" مرفوع بالضمة. الرحيم: صفة -نعت- للغفور ويجوز أن يكون خبرًا ثانيًا لهو. '
المتشابهات :
| الأنعام: 17 | ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ |
|---|
| يونس: 107 | ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [107] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل أنَّ الأصنامَ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ النَّفْعَ والضُّرَّ بيدِ اللهِ وحدَه، وأنَّه المُنفَرِدُ بذلك، قال تعالى:
﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [108] :يونس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ .. ﴾
التفسير :
أي:{ قُلْ} يا أيها الرسول، لما تبين البرهان{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ} أي:الخبر الصادق المؤيد بالبراهين، الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم، أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية، ما فيه أعظم تربية لكم، وإحسان منه إليكم، فقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق لأحد شبهة.
{ فَمَنِ اهْتَدَى} بهدى الله بأن علم الحق وتفهمه، وآثره على غيره فلِنَفْسِهِ والله تعالى غني عن عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم.
{ وَمَنْ ضَلَّ} عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به،{ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} ولا يضر الله شيئًا، فلا يضر إلا نفسه.
{ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل. فانظروا لأنفسكم، ما دمتم في مدة الإمهال.
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بنداء آخر- أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوجهه للناس فقال: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ...
أى: قل- أيها الرسول الكريم- مخاطبا جميع الناس، سواء منهم من سمع نداءك أم من سيبلغه هذا النداء من بعدك قل لهم جميعا: قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ المتمثل في كتاب الله وفي سنتي مِنْ رَبِّكُمْ وليس من أحد سواه.
فَمَنِ اهْتَدى إلى هذا الحق، وعمل بمقتضاه فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أى: فإنما تكون منفعة هدايته لنفسه لا لغيره.
وَمَنْ ضَلَّ عن هذا الحق وأعرض عنه فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها أى: فإنما يكون وبال ضلاله على نفسه.
وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ أى بحفيظ يحفظ أموركم، وإنما أنا بشير ونذير والله وحده هو الذي يتولى محاسبتكم على أعمالكم.
ثم أمره- سبحانه- باتباع ما أوحاه إليه فقال: وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ.
يقول تعالى آمرا لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه ، [ ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه ]
( وما أنا عليكم بوكيل ) أي : وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به ، وإنما أنا نذير لكم ، والهداية على الله تعالى .
القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل ) ، يا محمد ، للناس : (يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ) ، يعني: كتاب الله، فيه بيان كل ما بالناس إليه حاجة من أمر دينهم ، ( فمن اهتدى) ، يقول: فمن استقام فسلك سبيل الحق، وصدّق بما جاء من عند الله من البيان ، (فإنما يهتدي لنفسه) ، يقول: فإنما يستقيم على الهدى، ويسلك قصد السبيل لنفسه، فإياها يبغي الخيرَ بفعله ذلك لا غيرها (6) ، ( ومن ضل) ، يقول: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند الله، وخالف دينَه، وما بعث به محمدًا والكتابَ الذي أنـزله عليه ، ( فإنما يضل عليها) ، يقول: فإن ضلاله ذلك إنما يجني به على نفسه لا على غيرها، لأنه لا يؤخذ بذلك غيرها ، ولا يورد بضلاله ذلك المهالكَ سوى نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى (7) ، (وما أنا عليكم بوكيل) ، يقول: وما أنا عليكم بمسلَّط على تقويمكم، إنما أمركم إلى الله، وهو الذي يقوّم من شاء منكم، وإنما أنا رسول مبلّغ أبلغكم ما أرسلتُ به إليكم. (8)
* * *
المعاني :
التدبر :
وقفة
[108] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ اختيار وصف الرب للتنبيه على أنه إرشاد مِنَ الذي يحب صلاح عباده ، ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم ، وهذا شأن من يربي ، أي يسوس الأمر ويدبره.
وقفة
[108] ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ ما نَفَعَ نَفْسَكَ كَنَفْسِكَ، وما ضَرَّهَا مثلها.
وقفة
[108] ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، والرب سبحانه إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه.
عمل
[108] ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ لا تجادل من ينصحك فالهداية لنفسك، ليست لصالح غيرك، والضلالة عليك، ليست على غيرك؛ فاجلب لنفسك الخير تهنأ دنيا وأخرى.
الإعراب :
- ﴿ قل: ﴾
- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت.
- ﴿ يا أيها الناس: ﴾
- يا: أداة نداء. أي منادى مبني على الضم في محل نصب و\"ها\" للتنبيه. الناس: بدل من \"أيّ\" مرفوع بالضمة.
- ﴿ قد جاءكم الحق من ربكم: ﴾
- قد: حرف تحقيق. جاء: فعل ماضٍ مبني على الفتح. الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور حرك بالضم للإشباع. الحق: فاعل مرفوع بالضمة. من رب: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من \"الحق\" الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ فمن اهتدى: ﴾
- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وحرك آخره بالكسر لالتقاء الساكنين. اهتدى: فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر فعل الشرط في محل جزم بمن أي اهتدى به والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر \"منْ\".
- ﴿ فإنما يهتدي لنفسه: ﴾
- الجملة: جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم إنما: كافة ومكفوفة أوأداة حصر لا عمل لها. يهتدي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. لنفسه: جار ومجرور متعلق بيهتدي. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة.
- ﴿ ومن ضلّ فإنما يضل عليها: ﴾
- معطوفة بالواو على \"من اهتدى فانما يهتدي لنفسه\" وتعرب إعرابها. والفعل \"ضل\" مبني على الفتح الظاهر. والفعل \"يضل\" مرفوع بالضمة الظاهرة.
- ﴿ وما أنا عليكم بوكيل: ﴾
- الواو: استئنافية. ما: نافية تعمل عمل \"ليس\" أنا: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم \"ما\". عليكم: جار ومجرور متعلق بخبر \"ما\" والميم علامة جمع الذكور بوكيل: الباء حرف جر زائد. وكيل اسم مجرور لفظًا بحرف الجر منصوب محلًا لأنه خبر \"ما\". '
المتشابهات :
| الأعراف: 158 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ |
|---|
| يونس: 104 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ﴾ |
|---|
| يونس: 108 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ |
|---|
| الحج: 49 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [108] لما قبلها : ولَمَّا كَثُرَت الأوامِرُ والنَّواهي في هذه السُّورةِ؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا للناس أنَّ فائدةَ الطَّاعةِ ليست راجعةً إلَّا إليهم، وضرَرَ النُّفورِ ليس عائدًا إلَّا عليهم، قال تعالى:
﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [109] :يونس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ .. ﴾
التفسير :
{ وَاتَّبَعَ} أيها الرسول{ مَا يُوحَى إِلَيْكَ} علمًا، وعملاً، وحالاً، ودعوة إليه،{ وَاصْبِرْ} على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دم على ذلك، واثبت،{ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ} بينك وبين من كذبك{ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} فإن حكمه، مشتمل على العدل التام، والقسط الذي يحمد عليه.
وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، وثبت على الصراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعد ما نصره [الله] عليهم، بالحجة والبرهان، فلله الحمد، والثناء الحسن، كما ينبغي لجلاله، وعظمته، وكماله وسعة إحسانه.
تم تفسير سورة يونس
والحمد لله رب العالمين.
أى: وَاتَّبِعْ- أيها الرسول الكريم- في جميع شئونك ما يُوحى إِلَيْكَ من ربك من تشريعات حكيمة، وآداب قويمة..
وَاصْبِرْ على مشاق الدعوة وتكاليفها..
حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بينك وبين قومك، وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ. لأنه هو العليم بالظواهر والبواطن، وهو الذي لا معقب لحكمه.
وبعد: فهذه هي سورة يونس- عليه السلام- رأينا ونحن نفسرها كيف أقامت الأدلة على وحدانية الله- عز وجل- وعلى كمال قدرته، وشمول علمه، ونفاذ إرادته، وسعة رحمته، وسمو عزته..
وكيف أنها أقامت الأدلة- أيضا- على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عنده- سبحانه.
وكيف أنها ساقت الأدلة على أن يوم القيامة حق، وعلى أحوال الناس فيه، مما يرقق القلوب القاسية، ويبعث في النفوس الخشية وحسن الاستعداد لهذا اليوم الهائل الشديد، وكيف أنها ساقت جانبا من أحوال بعض الأنبياء مع أممهم، وقررت سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي نجاة رسل الله والمؤمنين بهم، وجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
وكيف أنها بينت أحوال الناس في السراء والضراء ... بيانا صادقا قويا مؤثرا، من شأنه أن يحملهم على التحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق الذميمة.
نسأل الله- تعالى- أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأنس نفوسنا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.
وقوله : ( واتبع ما يوحى إليك واصبر ) أي : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه واصبر على مخالفة من خالفك من الناس ، ( حتى يحكم الله ) أي : يفتح بينك وبينهم ، ( وهو خير الحاكمين ) أي : خير الفاتحين بعدله وحكمته .
القول في تأويل قوله تعالى : وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واتبع ، يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك ، وتنـزيله الذي ينـزله عليك، فاعمل به، واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذى والمكاره ، وعلى ما نالك منهم ، حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعلٍ فاصلٍ ، ( وهو خير الحاكمين) ، يقول: وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين . (9) فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَدْرٍ، ، وقتلهم بالسيف، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم ، أو يتوبوا ويُنيبوا إلى طاعته، كما:-
17914- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) ، قال: هذا منسوخ ، (حتى يحكم الله) ، حكم الله بجهادهم ، وأمره بالغلظة عليهم . (10)
آخر تفسير سورة يونس
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[109] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ﴾ أنت في حاجة إلى صبر من أجل اتباع الحق وتحصيله والعمل به، ثم الدعوة إليه.
وقفة
[109] الوصايا الختامية في سورة يونس: التوحيد ونبذ الشرك: ﴿وأن أقم وجهك للدين حنيفًا ولا تكونن من المشركين﴾ [105]، الإخلاص لله وحده: ﴿ولا تدعُ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك﴾ [106]، اتباع الوحي: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، التزود بالصبر: ﴿وَاصْبِرْ﴾.
عمل
[109] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ وجوب اتباع الكتاب والسُّنَّة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله.
وقفة
[109] قد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا وخصوصًا؛ فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها؛ تصديقًا لخبر الله، وطاعة لأمره.
عمل
[109] اصبر على طاعة الله وعن معاصيه؛ فإن المتبع للوحي يتعرض للشدائد؛ وخاصة في أزمنة الفتن ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.
عمل
[109] اعلم أن الله تعالى هو خير الحاكمين؛ الذي قضى بنصر عباده المؤمنين، ورفع ذكرهم، وكبت عدوهم ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.
عمل
[109] عندما يعصر الحزن واليأس قلبك بشّره بهذه الآية: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ربّك يدبر الأمر!
وقفة
[109] أول آية في السورة: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [1]، وآخر آيةٍ في السورة: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، فكأن مجمل السورة يقول: اتبع آيات الكتاب الحكيم، واصبر على ما يصيبك في سبيل ذلك، فإنه طريق صعب، وإن الجنة غالية المهر.
وقفة
[109] ﴿وَاصْبِرْ﴾، ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ﴾ [إبراهيم: 12]، ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: 24]، ﴿وَاصْبِرُوا﴾ [الأعراف: 128، الأنفال: 46، ص: 6]، ﴿اصْبِرُوا﴾ [آل عمران: 200]، ﴿وَاصْبِرْ﴾ [هود: 115، النحل: 127]، ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24]، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [البلد: 17، العصر: 3]، ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ [البقرة: 45]، وسياقات أخرى غزيرة تذكرنا بأن الصبر هو راحلة هذا الطريق.
عمل
[109] ﴿وَاصْبِرْ﴾ أيها المظلوم، أيها المريض، أيها المهموم، أيها المبتلى، أيها المدين، أيها المأسور ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ واتبع: ﴾
- الواو عاطفة. اتبع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنت.
- ﴿ ما يوحى إليك: ﴾
- ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يوحى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. إليك: جار ومجرور متعلق بيوحى بمعنى ما يوحى إليك من القرآن.
- ﴿ واصبر حتى يحكم الله: ﴾
- واصبر: معطوفة بالواو على \"اتبع\" وتعرب إعرابها. حتى: حرف غاية وجر. يحكم: فعل مضارع منصوب بأنْ مضمرة بعد \"حتى\" وعلامة نصبه: الفتحة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. و \"أنْ\" المضمرة وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلق باصبر وجملة \"يحكم الله\" صلة أنْ المضمرة المصدرية لا محل لها. بمعنى: حتى يحكم الله بينك وبين قومك.
- ﴿ وهو خير الحاكمين: ﴾
- الواو: استئنافية. هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. خير: خبر \"هو\" مرفوع بالضمة. الحاكمين: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. '
المتشابهات :
| الأنعام: 106 | ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ |
|---|
| يونس: 109 | ﴿وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ﴾ |
|---|
| الأحزاب: 2 | ﴿وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [109] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ عز وجل للناس ذلك؛ أمرَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما يوحى إليه، سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا، ويصبر على ما يصيبه من الأذى والمكاره، حتى يقضي الله بينه وبين المكذبين له، قال تعالى:
﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [1] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى:هذا{ كِتَابٌ} عظيم، ونزل كريم،{ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} أي:أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظه بهية معانيه.
{ ثُمَّ فُصِّلَتْ} أي:ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان،{ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ} يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته،{ خَبِيرٌ} مطلع على الظواهر والبواطن.
تعريف بسورة هود- عليه السلام-
1- سورة هود- عليه السلام- هي السورة الحادية عشرة في ترتيب المصحف فقد سبقتها في هذا الترتيب سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس.
أما ترتيبها في النزول، فهي السورة الثانية والخمسون، وكان نزولها بعد سورة يونس.
2- وعدد آياتها: ثلاث وعشرون ومائة آية.
3- وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة هود، فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال:
قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! قال: «شيبتني» «هود» و «الواقعة» ، و «المرسلات» و «عم يتساءلون» و «إذا الشمس كورت» .
وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها.
قال القرطبي بعد أن ساق بعض الأحاديث في فضل هذه السورة. ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس. وتشيب منه الرءوس» .
4- متى نزلت سورة هود؟
جمهور العلماء على أن سورة هود جميعها مكية، وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات منها: وهي قوله- تعالى- فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ، وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ... الآية 12.
وقوله- تعالى- أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ الآية 17.
وقوله- تعالى-: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ الآية 114.
والذي نرجحه أن السورة كلها مكية، وسنرى عند تفسيرنا لهذه الآيات التي قيل بأنها مدنية، ما يشهد لصحة ما ذهبنا إليه.
كذلك نرجح أن هذه السورة الكريمة، كان نزولها في الفترة التي أعقبت حادث الإسراء والمعراج، وذلك لأن نزولها- كما سبق أن أشرنا- كان بعد سورة يونس، وسورة يونس كان نزولها بعد سورة الإسراء، التي افتتحت بالحديث عنه.
وهذه الفترة التي كانت قبيل حادث الإسراء والمعراج والتي أعقبته، تعتبر من أشق الفترات وأحرجها وأصعبها في تاريخ الدعوة الإسلامية.
ففي هذه الفترة مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه، وماتت كذلك السيدة خديجة- رضى الله عنها- التي كانت نعم المواسى له عما يصيبه من أذى ... ففقد الرسول صلى الله عليه وسلم بموتهما نصيرين عزيزين، كانت لهما مكانتهما العظيمة في نفسه، وتعرض صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لألوان من الأذى والاضطهاد فاقت كل ما سبقها وبلغت الحرب المعلنة من المشركين عليه وعلى دعوته، أقسى وأقصى مداها..
قال ابن إسحاق خلال حديثه عن هذه الفترة: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة- وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها- ويهلك عمه أبى طالب- وكان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين.
فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبى طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا.
ثم قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير قال لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب، وهي تبكى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: «لا تبكى يا بنية، فإن الله مانع أباك» ..
قال: ويقول بين ذلك: «ما نالت منى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب» .
وسنرى عند استعراضنا للسورة الكريمة، أنها صورت هذه الفترة أكمل تصوير.
5- مناسبتها لسورة يونس- عليه السلام-:
قال الآلوسى- رحمه الله-: ووجه اتصالها بسورة يونس، أنه ذكر في سورة يونس قصة نوح- عليه السلام- مختصرة جدا ومجملة، فشرحت في هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور.. ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك، فإن قوله- تعالى- هنا الر. كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ... نظير قوله- سبحانه- هناك الر. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ ... بل بين مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط- أيضا-، حيث ختمت بنفي الشرك، واتباع الوحى، وافتتحت هذه ببيان الوحى والتحذير من الشرك.
6- عرض إجمالى للسورة الكريمة:
عند ما نطالع سورة هود بتدبر وتأمل، نراها في الربع الأول منها- قد افتتحت بالتنويه بشأن القرآن الكريم. وبدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله- تعالى- وحده، وإلى التوجه إليه بالاستغفار والتوبة الصادقة، حتى ينالوا السعادة في دنياهم وآخرتهم.
قال- تعالى-: الر. كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ثم وضحت السورة جانبا من مسالك الكافرين، تلك المسالك التي تدل على جهالاتهم بعلم الله التام، وبقدرته النافذة، وفصلت مظاهر هذه القدرة، وشمول هذا العلم..
قال- تعالى-: أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ، يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
ثم بينت أحوال الإنسان في حالة منحه النعمة، وفي حالة سلبها عنه، وساقت للرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يسليه عما أصابه من كفار مكة، وتحدتهم أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن الكريم، وأنذرتهم بسوء عاقبة المعرضين عن دعوة الله، الصادين عن سبيله، الكافرين بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، وبشرت المؤمنين بحسن العاقبة، وضربت المثل المناسب لكل من فريقى الكافرين والمؤمنين.
استمع إلى السورة الكريمة وهي تصور كل ذلك بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول:
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ....
إلى أن تقول بعد حديث مفصل عن الكافرين وسوء عاقبتهم: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا، أَفَلا تَذَكَّرُونَ.
فإذا ما وصلنا إلى الربع الثاني من سورة هود، وجدناها تسوق لنا بأسلوب مفصل، قصة نوح- عليه السلام- مع قومه، فتحكى أمره لهم بعبادة الله وحده، كما تحكى الرد القبيح الذي رد به عليه زعماؤهم، وكيف أنه- عليه السلام- لم يقابل سفاهتهم بمثلها، بل خاطبهم بلفظ «يا قوم» الدال على أنه واحد منهم، يسره ما يسرهم، ويؤلمه ما يؤلمهم، ومع هذا فقد لجوا في طغيانهم وقالوا له- كما حكى القرآن عنهم- يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا، فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ....
فكان رده عليهم إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ....
وقد أتاهم الله- تعالى- بالعذاب الذي استعجلوه فأغرقهم بالطوفان الذي غشيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والذي قطع دابرهم.
ثم نراها بعد ذلك في الربع الثالث، تقص علينا مشهدا مؤثرا، مشهد نوح- عليه السلام- وهو ينادى ابنه الذي استحب الكفر على الإيمان فيقول له بشفقة وحرص:
يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ.
ولكن الابن العاق لا يستمع إلى نصيحة أبيه العطوف بل يقول له: سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ.
ويجيبه الأب بحزن وحسم لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ.
ويتضرع الأب الحزين إلى ربه فيقول: رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ.
ويأتيه الجواب من الله- تعالى-: يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ، فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ.
ويلجأ نوح- عليه السلام- إلى خالقه، مستعيذا به من غضبه فيقول: رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ.
فيقبل الله- تعالى- ضراعته فيقول: يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ، وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ.
ثم يختم الله- تعالى- قصة نوح، بتسلية النبي- صلى الله عليه وسلم-، وبما يدل على أن هذا القرآن من عند الله، فيقول: تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ، إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.
ثم تسوق السورة بعد ذلك قصة هود- عليه السلام- مع قومه، فتحكى دعوته لهم إلى عبادة الله- تعالى-، ومصارحته إياهم بأنه لا يريد منهم أجرا على دعوته وإرشادهم إلى ما يزيدهم غنى على غناهم وقوة على قوتهم، ولكنهم قابلوا تلك النصائح الغالية بالتكذيب والسفاهة، فقالوا له- كما حكت السورة عنهم- يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ، وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ، وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ.....
فيرد عليهم هود بقوله: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ، وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها....
ثم كانت النتيجة بعد هذه المحاورات والمجادلات أن نجى الله هودا، والذين آمنوا معه، أما الكافرون بدعوته، فقد نزل بهم العذاب الغليظ، الذي تركهم صرعى، كأنهم أعجاز نخل خاوية ...
وفي الربع الرابع منها تسوق لنا السورة الكريمة، ما دار بين صالح وقومه، حيث أمرهم بعبادة الله، وذكرهم بنعمه عليهم، وحذرهم من الاعتداء على الناقة التي هي لهم آية.. ولكنهم استخفوا بتذكيره وبتحذيره فكانت النتيجة إهلاكهم ...
قال- تعالى- فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها، أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ.
ثم قصت علينا السورة الكريمة، ما فعله إبراهيم- عليه السلام- عند ما جاءه رسل الله بالبشرى، وكيف أنهم قالوا له عند ما أنكرهم وأوجس منهم خيفة: لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ....
ثم وضحت حال لوط- عليه السلام- عند ما جاءه هؤلاء الرسل وحكت ما دار بينه وبين قومه الذين جاءوه يهرعون إليه عند ما رأوا الرسل، فقال لهم: يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ.....
فيقولون له في صفاقة وانحراف عن الفطرة السليمة: لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ.
وأسقط في يد لوط- عليه السلام-، وأحس بضعفه أمام هؤلاء المنحرفين المندفعين إلى ارتكاب الفاحشة، اندفاع المجنون إلى حتفه، فقال بأسى وحزن: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ.
وهنا كشف له الرسل عن طبيعتهم، وأخبروه بمهمتهم وطلبوا منه أن يغادر هو ومن آمن معه مكان إقامتهم، فإن العذاب نازل بهؤلاء المجرمين بعد وقت قصير.
قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
ثم تتابع السورة الكريمة في الربع الخامس ، حديثها عن جانب من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، فتحدثنا عن قصة شعيب- عليه السلام- مع قومه، وكيف أنه قال لهم مقالة كل رسول لقومه يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ.
ثم نهاهم بأسلوب رصين حكيم، عن ارتكاب الفواحش التي كانت منتشرة فيهم، وهي إنقاص الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم ...
ولكنهم- كعادة السفهاء الطغاة- قابلوا نصائحه بالتهكم والاستخفاف والوعيد ...
فكانت النتيجة أن حل بهم عذاب الله الذي أهلكهم، كما أهلك أمثالهم.
قال- تعالى- وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها، أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ.
ثم تسوق السورة بعد ذلك بإيجاز، جانبا من قصة موسى مع فرعون وملئه، الذين اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد.
ثم تعقب على كل تلك القصص السابقة، بتعقيب يدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه- سبحانه- لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ... قال- تعالى-:
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ....
أما في الربع السادس والأخير منها، فنراها تبين بأسلوب قوى منذر، أن الناس سيأتون ارتكاب الفاحشة، اندفاع المجنون إلى حتفه، فقال بأسى وحزن: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ.
وهنا كشف له الرسل عن طبيعتهم، وأخبروه بمهمتهم وطلبوا منه أن يغادر هو ومن آمن معه مكان إقامتهم، فإن العذاب نازل بهؤلاء المجرمين بعد وقت قصير.
قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
ثم تتابع السورة الكريمة في الربع الخامس ، حديثها عن جانب من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، فتحدثنا عن قصة شعيب- عليه السلام- مع قومه، وكيف أنه قال لهم مقالة كل رسول لقومه يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ.
ثم نهاهم بأسلوب رصين حكيم، عن ارتكاب الفواحش التي كانت منتشرة فيهم، وهي إنقاص الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم ...
ولكنهم- كعادة السفهاء الطغاة- قابلوا نصائحه بالتهكم والاستخفاف والوعيد ...
فكانت النتيجة أن حل بهم عذاب الله الذي أهلكهم، كما أهلك أمثالهم.
قال- تعالى- وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها، أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ.
ثم تسوق السورة بعد ذلك بإيجاز، جانبا من قصة موسى مع فرعون وملئه، الذين اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد.
ثم تعقب على كل تلك القصص السابقة، بتعقيب يدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه- سبحانه- لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ... قال- تعالى-:
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ....
أما في الربع السادس والأخير منها، فنراها تبين بأسلوب قوى منذر، أن الناس سيأتون يوم القيامة، منهم الشقي ومنهم السعيد، وأنه- سبحانه- سيوفى كل فريق منهم جزاءه غير منقوص.
ثم ترشد إلى ما يوصل إلى السعادة، فتدعو إلى الاستقامة على أمر الله، وإلى عدم الركون إلى الظالمين، وإلى إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وإلى الصبر الجميل.
قال- تعالى-: فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا، إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
ثم ختمت السورة الكريمة ببيان أن من أهم مقاصد ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، وتسليته عما أصابه، وتبشيره بأن العاقبة له ولأتباعه.
قال- تعالى-: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ، وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
7- أهم الموضوعات التي عنيت السورة الكريمة بالحديث عنها:
من استعراضنا لسورة هود، ومن معرفة الفترة التي نزلت فيها، نستطيع أن نقول: إن السورة الكريمة قد عنيت بالحديث عن موضوعات متنوعة من أهمها ما يأتى:
(ا) ترغيب الناس في طاعة الله، وتحذيرهم من معصيته، وهذا المعنى نراه في كثير من آيات سورة هود، ومن ذلك:
قوله- تعالى-: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ....
وقوله- تعالى- حكاية عن هود- عليه السلام-: وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ....
وقوله- تعالى- حكاية عن شعيب- عليه السلام-: وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ، وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ....
(ب) تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه، ومن مظاهر هذه التسلية، أن السورة الكريمة قد اشتملت في معظم آياتها على قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم. فقد ذكرت نواحي متنوعة من قصة نوح مع قومه، ومن قصة هود مع قومه، ومن قصة صالح مع قومه، ومن قصة شعيب مع قومه، ومن قصة لوط مع قومه ...
وقد تحدثت خلال كل قصة عن المسالك الخبيثة، والمجادلات الباطلة، التي اتبعها الطغاة مع أنبيائهم الذين جاءوا لسعادتهم وهدايتهم.
كما ختمت كل قصة من هذه القصص، ببيان حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة المكذبين..
وفي ذلك ما فيه من التسلية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عما لحقه من أذى، وما أصابه من اضطهاد، وما تعرض له من اعتداء عليه وعلى أصحابه.
وكأن ما ورد في هذه السورة من قصص طويل متنوع، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن ما أصابك من قومك يا محمد، قد أصاب الأنبياء السابقين من أقوامهم، فاصبر كما صبروا، فإنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك.
(ج) إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، وليس من كلام البشر..
فقد تحداهم هنا أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم في موطن آخر أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، وساق لهم- على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من أخبار الأولين، ومن قصص الأنبياء مع أقوامهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معاصرا لهؤلاء السابقين، ولم يكن قارئا لأخبارهم فدل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه.
قال- تعالى-: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
وقال- تعالى-: تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ، إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.
(د) بيان سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي أنه- سبحانه- لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بإعراضهم عن الحق، واتباعهم للهوى، واستحقاقهم للعقوبة التي هي جزاء عادل لكل ظالم.
وهذا البيان نراه في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك قوله- تعالى- في ختام الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم.
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ، ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.....
وبعد: فهذه تعريفات عن سورة هود، رأينا أن نذكرها قبل البدء في تفسيرها، وأرجو أن يكون في ذكرها ما يعطى القارئ صورة واضحة عن هذه السورة الكريمة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد سيد طنطاوى
سورة هود- عليه السلام- من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجي، وقد سبق أن تكلمنا بشيء من التفصيل عند تفسيرنا لسور: البقرة، وآل عمران، والأعراف، ويونس، عن آراء العلماء في المراد بهذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور.
ورجحنا أن هذه الحروف المقطعة، قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن، على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن.
فكأن الله- تعالى- يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله- تعالى-: هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون به كلامكم، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم، فإن كنتم في شك من كونه منزلا من عند الله فهاتوا مثله، وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك، أو هاتوا عشر سور من مثله، أو هاتوا سورة واحدة.
فلما عجزوا- وهم أهل الفصاحة والبيان- ثبت أن غيرهم أعجز، وأن هذا القرآن من عند الله، وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.
وقوله: أُحْكِمَتْ آياتُهُ من الإحكام- بكسر الهمزة- وهذه المادة تستعمل في اللغة لمعان متعددة، ترجع إلى شيء واحد هو المنع. يقال: أحكم الأمر. أى: أتقنه ومنعه من الفساد. أى: منع نفسه ومنع الناس عما لا يليق: ويقال أحكم الفرس، إذا جعل له حكمة تمنعه من الجموح والاضطراب.
وقوله: ثُمَّ فُصِّلَتْ من التفصيل، بمعنى التوضيح والشرح للحقائق والمسائل المراد بيانها، بحيث لا يبقى فيها اشتباه أو لبس.
والمعنى: هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد، هو كتاب عظيم الشأن، جليل القدر، فقد أحكم الله آياته إحكاما بديعا، وأتقنها إتقانا معجزا، بحيث لا يتطرق إليها خلل أو فساد. ثم فصل- سبحانه- هذه الآيات تفصيلا حكيما، بأن أنزلها نجوما، وجعلها سورا سورا، مشتملة على ما يسعد الناس في دنياهم وآخرتهم، من شئون العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب، والأحكام.
قال صاحب الكشاف ما ملخصه: أُحْكِمَتْ آياتُهُ أى: نظمت نظما رصينا محكما، بحيث لا يقع فيه نقض ولا خلل، كالبناء المحكم المرصف.. وقيل: منعت من الفساد، من قولهم: أحكمت الدابة، إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح، قال جرير:
أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إنى أخاف عليكمو أن أغضبا
ثُمَّ فُصِّلَتْ كما تفصل القلائد بالفرائد، ومن دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص، أو جعلت فصولا سورة سورة، وآية آية، أو فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» .
وثُمَّ في قوله- سبحانه- «ثم فصلت» للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل، لما في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس، لأن العقول ترتاح إلى التفصيل بعد الإجمال، والتوضيح بعد الإيجاز.
وجملة مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ صفة أخرى للكتاب، وصف بها، لإظهار شرفه من حيث مصدره، بعد أن وصف بإحكام آياته وتفصيلها الدالين على علو مرتبته من حيث الذات أى: هذا الكتاب الذي أتقنت آياته إتقانا بديعا، وفصلت تفصيلا رصينا، ليس هو من عند أحد من الخلق، وإنما هو من عند الخالق الحكيم في كل أقواله وأفعاله، الخبير بظواهر الأمور وبواطنها.
قال الشوكانى: وفي قوله مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لف ونشر، لأن المعنى: أحكمها حكيم، وفصلها خبير، عالم بمواقع الأمور .
تفسير سورة هود [ وهي مكية ]
قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة قال : قال أبو بكر : سألت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما شيبك ؟ قال : " شيبتني هود ، والواقعة ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت " .
وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، قد شبت ؟ قال : " شيبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت " وفي رواية : " هود وأخواتها " .
وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا حماد بن الحسن ، حدثنا سعيد بن سلام ، حدثنا عمر بن محمد ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " شيبتني هود وأخواتها : الواقعة ، والحاقة ، وإذا الشمس كورت " وفي رواية : " هود وأخواتها " .
وقد روي من حديث ابن مسعود ، فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أحمد بن طارق الرائشي ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه; أن أبا بكر قال : يا رسول الله ، ما شيبك ؟ قال : " هود ، والواقعة " .
عمرو بن ثابت متروك ، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود . والله أعلم .
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا ، وبالله التوفيق .
وأما قوله : ( أحكمت آياته ثم فصلت ) أي : هي محكمة في لفظها ، مفصلة في معناها ، فهو كامل صورة ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهد ، وقتادة ، واختاره ابن جرير .
وقوله : ( من لدن حكيم خبير ) أي : من عند الله الحكيم في أقواله ، وأحكامه ، الخبير بعواقب الأمور .
القول في تأويل قوله تعالى : الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1)
قال أبو جعفر: قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله : (الر) ، والصواب من القول في ذلك عندنا بشواهده ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (11)
* * *
وقوله: (كتاب أحكمت آياته) ، يعني: هذا الكتاب الذي أنـزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن.
* * *
ورفع قوله: " كتاب " بنيّة: " هذا كتاب ".
فأما على قول من زعم أن قوله: (الر) ، مرادٌ به سائر حروف المعجم التي نـزل بها القرآن، وجعلت هذه الحروف دلالةً على جميعها، وأن معنى الكلام: " هذه الحروف كتاب أحكمت آياته " ، فإن الكتاب على قوله ، ينبغي أن يكون مرفوعًا بقوله: (الر).
* * *
وأما قوله: (أحكمت آياته ثم فصلت) ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: تأويله: أحكمت آياته بالأمر والنهي، ثم فصلت بالثَّواب والعقاب.
*ذكر من قال ذلك:
17915- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم، قال، أخبرني أبو محمد الثقفي، عن الحسن في قوله: (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) ، قال: أحكمت بالأمر والنهي، وفصلت بالثواب والعقاب. (12)
17916- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن: (الر كتاب أحكمت آياته) ، قال: أحكمت في الأمر والنهى ، وفصلت بالوعيد. (13)
17917- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير، عن ابن عيينة، عن رجل، عن الحسن: (الر كتاب أحكمت آياته) ، قال: بالأمر والنهي ، (ثم فصلت) ، قال: بالثواب والعقاب.
* * *
وروي عن الحسن قولٌ خلاف هذا. وذلك ما:-
17918- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين، قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن أبي بكر، عن الحسن، قال ، وحدثنا عباد بن العوام، عن رجل، عن الحسن قال: (أحكمت) ، بالثواب والعقاب ، (ثم فصلت) ، بالأمر والنهي.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: ( أحكمت آياته ) من الباطل، ثم فصلت، فبين منها الحلال والحرام.
*ذكر من قال ذلك:
17919- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) ، أحكمها الله من الباطل ، ثم فصلها بعلمه، فبيّن حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته.
* * *
17920- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: (أحكمت آياته ثم فصلت) ، قال: أحكمها الله من الباطل، ثم فَصَّلها، بيَّنها.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قولُ من قال: معناه: أحكم الله آياته من الدَّخَل والخَلَل والباطل، ثم فصَّلها بالأمر والنهي.
وذلك أن " إحكام الشيء " إصلاحه وإتقانه ، و " إحكام آيات القرآن " إحكامها من خلل يكون فيها ، أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قِبَله. (14)
وأما " تفصيل آياته " فإنه تمييز بعضها من بعض، بالبيان عما فيها من حلال وحرام ، وأمرٍ ونهي. (15)
* * *
وكان بعض المفسرين يفسر قوله: (فصلت)، بمعنى: فُسِّرت، وذلك نحو الذي قلنا فيه من القول.
*ذكر من قال ذلك:
17921- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى قال ، حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: (ثم فصلت) ، قال: فُسِّرت .
17922- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (فصلت)، قال: فُسّرت.
17923-. . . . قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال، بلغني عن مجاهد: (ثم فصلت) ، قال: فسّرت .
17924- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
17925-. . . . قال، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
17926- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
* * *
وقال قتادة: معناه: بُيِّنَتْ، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبلُ، وهو شبيه المعنى بقول مجاهد.
* * *
وأما قوله: (من لدن حكيم خبير)، فإن معناه: (حكيم ) بتدبير الأشياء وتقديرها، خبير بما تؤول إليه عواقبُها. (16)
17927- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: (من لدن حكيم خبير)، يقول: من عند حكيم خبير. (17)
-------------------------
الهوامش :
(1) انظر تفسير " المس " فيما سلف ص : 49 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
وتفسير " الضر " فيما سلف من فهارس اللغة ( ضرر ) .
(2) انظر تفسير " الكشف " فيما سلف 11 : 354 / 13 : 73 / 15 : 36 ، 205 .
(3) انظر تفسير " الخير " فيما سلف من فهارس اللغة ( خير ) .
(4) انظر تفسير " الإصابة " فيما سلف من فهارس اللغة ( صوب ) .
(5) انظر تفسير " الغفور " و " الرحيم " فيما سلف من فهارس اللغة ( غفر ) ، ( رحم ) .
(6) انظر تفسير " الاهتداء " فيما سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .
(7) انظر تفسير " الضلال " فيما سلف من فهارس اللغة ( ظلل ) .
(8) انظر تفسير " وكيل " فيما سلف 12 : 33 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
(9) انظر تفسير " الحكم " فيما سلف 12 : 561 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
(10) عند هذا الموضع ، انتهى جزء من التقسيم القديم ، وفي مخطوطتنا بعد هذا ما نصه :
" آخر تفسير سورة يونس عليه السلام والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله .
يتلوه تفسير السورة التي يذكر فيها هود " .
يتلوه :
" بسم الله الرحمن الرحيم ربّ يسِّرْ "
(11) انظر ما سلف 1 : 205 - 224 / 6 : 149 - 12 : 293 ، 294 / 15 : 7 .
(12) الأثر : 17915 - " أبو محمد الثقفي " ، الراوي عن الحسن ، لم أعلم من يكون .
(13) الأثر : 17916 - " عبد الكريم بن محمد الجرجاني " ، قاضي جرجان ، روى عن قيس بن الربيع ، وأبي حنيفة ، وزهير بن معاوية ، وابن جريج ، وغيرهم . روى عنه أبو يوسف القاضي ، وابن عيينة ، وهما أكبر منه ، والشافعي ، وغيرهم . مات سنة نيف وسبعين ومائة ، فلا أدري أيدرك محمد بن حميد أن يروي عنه أم لا ؟ مترجم في التهذيب .
(14) انظر تفسير " الإحكام " فيما سلف 6 : 170 ، 174 - 182 .
(15) انظر تفسير " تفصيل الآيات " فيما سلف ص : 91 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
(16) انظر تفسير " حكيم " و " خبير " فيما سلف من فهارس اللغة ( حكم ) ، ( خبر ) .
(17) انظر تفسير " من لدن " فيما سلف 6 : 362 .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] سورة هود فيها ذكر الأمم، وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى؛ فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظات البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى يلطف بهم في تلك الأحايين؛ حتى يقرؤوا كلامه.
وقفة
[1] ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ لو نزعت من القرآن لفظة، ثم بحثت بلسان العرب لفظة أحسن منها؛ لم توجد .
وقفة
[1] ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ أهمية الكتاب تكمن في أمرين: الأول: الجهة التي أصدرته (حَكِيمٍ خَبِيرٍ) هذا يدل على العلو، فكتاب الموظف ليس مثل كتاب المدير ولا السلطان، إذن الكتاب أهميته تكون من أهمية المرسِل، الثاني: محتواه، ماذا فيه؟ الحكمة.
وقفة
[1] ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فُصِّلت الأحكام فيها تفصيلًا تامًّا، والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظمًا محكمًا، لا يلحقها تناقض ولا خلل، وقيل: أُحكم نزولًا؛ لأنه قد نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم فُصل حسب الحوادث.
وقفة
[1] ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، قال تعالى: ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ فأحكمت ألفاظه، وفصلت معانيه، أو بالعكس -على الخلاف-، فكلٌّ من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر، سواء بسواء، وأمر بكل خير، ونهى عن كل شر.
وقفة
[1] مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.
وقفة
[1] ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ كتاب بهذا الوصف فصله (حكيم) يضع الأمور في مواضعها، (خبير) يعلم ما كان وما سيكون؛ لحريٌّ بِنَا أن نجعله منهاج حياة.
وقفة
[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ الخوض في التفاصيل مظنة الزلل والخلل إلا القرآن؛ فهو محكم متقن مع ما فيه من تفصيل.
وقفة
[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ أي محكمة في لفظها ومفصلة في معناها، فهو كامل من جهتين الصورة والمعنى.
لمسة
[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ (ثُمَّ) هنا لترتيب الإخبار وليس ترتيبًا زمانيًا، كما تقول: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ ... * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [البلد: 12-17]، فلو لم يكن مؤمنًا فلا قيمة لما أنفق، إذن هذا ترتيب الإخبار لا ترتيب الوقوع.
وقفة
[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ لم يجمع هذين الوصفين الإحكام والتفصيل إلا في هذا الموضع، إما أن يذكر الإحكام: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: 1]، أو التفصيل: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [فصلت: 3]، ﴿أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114].
وقفة
[1] ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته، وجلاله، واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة.
وقفة
[1] ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ ولم يقل: من رحمن ولا رحيم؛ للتنصيص على أنه لابد من الحكمة.
وقفة
[1] ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ اســم الله (الـحـكـيـم): الموصوف بكمال الحكمة.
الإعراب :
- ﴿ الر كتاب: ﴾
- الر: شرحت وأعربت في سورة سابقة. كتاب: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، مرفوع بالضمة.
- ﴿ أحكمت آيات: ﴾
- الجملة: في محل رفع صفة -نعت- لكتاب. أحكمت: فعل ماضٍ مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. آياته: نائب فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. بمعنى: نظمت نظمًا محكمًا.
- ﴿ ثم فصلت: ﴾
- ثم: عاطفة معناها التراخي في الحال وليس في الوقت. فصلت: تعرب إعراب \"أحكمت\" ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هي أي الآيات. بمعنى: فصلت بالعقائد والأحكام والمواعظ والأخبار.
- ﴿ من لدن حكيم خبير: ﴾
- الجرور المتعلق بفصلت في محل رفع صفة ثانية لكتاب، ويجوز أن يكون في محل رفع خبرًا ثانيًا أي خبرًا بعد خبر. أو صلة لأحكمت وفصلت: أي من عنده إحكامها وتفصيلها، وفيها طباق حسن. '
المتشابهات :
| هود: 1 | ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ |
|---|
| فصلت: 3 | ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعةِ؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:
﴿ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
فصلت:
قرئ:
فصلت، بفتحتين، خفيفة، على لزوم الفعل للآيات، وهى قراءة عكرمة، والضحاك، والجحدري، وزيد بن على، وابن كثير.
مدارسة الآية : [2] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي .. ﴾
التفسير :
} فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا، عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة . وإنما أنزل الله كتابه لـ{ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} أي:لأجل إخلاص الدين كله لله، وأن لا يشرك به أحد من خلقه.
{ إِنَّنِي لَكُمْ} أيها الناس{ مِنْهُ} أي:من الله ربكم{ نَذِيرٍ} لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة،{ وَبَشِيرٌ} للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة.
وقوله: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ جملة تعليلية، أى: أنه- سبحانه- فعل ما فعل من إحكام الكتاب وتفصيله وتنزيله من لدن حكيم خبير، لكي تخلصوا له العبادة والطاعة، وتتركوا عبادة غيره لأن من أنزل هذا الكتاب المعجز، من حقه أن يفرد بالخضوع والاستعانة.
وقوله: إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بيان لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
والضمير المجرور في «منه» يعود على الله- تعالى-.
أى: عليكم- أيها الناس- أن تخلصوا لله- تعالى- العبادة والطاعة، فإنه- سبحانه- قد أرسلنى إليكم لكي أنذر الذين فسقوا عن أمره بسوء العاقبة، وأبشر الذين استجابوا لدعوته بحسن المثوبة.
وقدم- سبحانه- الإنذار على التبشير لأن الخطاب موجه إلى الكافرين، الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى.
قال بعضهم: «والجمع بين النذارة والبشارة، لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب ترك عبادة غير الله. بطريق النهى، وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء، فالنذارة ترجع إلى الجزء الأول، والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني» .
( ألا تعبدوا إلا الله ) أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 25 ] ، قال : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 36 ] .
وقوله : ( إنني لكم منه نذير وبشير ) أي : إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه ، وبشير بالثواب إن أطعتموه ، كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صعد الصفا ، فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب ، فاجتمعوا ، فقال يا معشر قريش ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ، ألستم مصدقي ؟ " فقالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : " فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد " .
القول في تأويل قوله تعالى : أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2)
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: ثم فُصّلت بأن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له ، وتخلعوا الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ، يا محمد ، للناس (إنني لكم ) ، من عند الله ، (نذير) ينذركم عقابه على معاصيه وعبادة الأصنام ، (وبشير) ، يبشركم بالجزيل من الثواب على طاعته وإخلاص العبادة والألُوهَةِ له. (18)
-------------------------
الهوامش :
(18) انظر تفسير " النذير " فيما سلف ص : 215 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
، وتفسير " البشير " فيما سلف من فهارس اللغة ( بشر ) .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[2] ﴿أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ﴾ جوهر جميع الرسالات هو التوحيد، لا إله إلا الله، جاء به جميع الرسل عليهم السلام.
لمسة
[2] ﴿إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ النذارة في المكروة، والبشارة في المحبوب، وقدَّم النذير لأن التحذير من النار أهم، وأسلوب الترهيب أجدى مع أكثر النفوس؛ ولأن العبور إلى الجنة لا يتم إلا بعد العبور فوق النار عبر الصراط.
وقفة
[2] ﴿إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ لم يجمع القرآن (بشير ونذير) على لسان رسول من الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الرسل عندما يتكلمون عن أنفسهم يقولون: (نذير) فقط.
الإعراب :
- ﴿ ألاّ تعبدوا: ﴾
- ألّا: مكونة من \"أن\" حرف مصدرية ونصب و \"لا\" نافية أو ناهية جازمة. تعبدوا: فعل مضارع منصوب بأن أو مجزوم بلا وعلامة نصبه أو جزمه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة و \"أن\" وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر مقّدر بتقدير لئلا تعبدوا والجملة: في محل نصب مفعول لأجله وجملة \"لا تعبدوا\" صلة \"أنْ\" المصدرية لا محل لها. ويجوز أن تكون \"أن\" تفسيرية لا محل لها لأن في تفصيل الآيات معنى الآيات بتقدير: قال لا تعبدوا إلّا الله، أو أمركم بأن لا تعبدوا إلاّ الله.
- ﴿ إلاّ الله: ﴾
- إلّا: أداة حصر لا عمل لها. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة.
- ﴿ إنني لكم منه: ﴾
- إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم \"انّ\". لكم: جار ومجرور والميم علامة جمع الذكور. منه: جار ومجرور متعلق بصفة مقدمة من \"نذير\" في محل نصب حال أي من قبله. والنون الثانية في \"انني\" هي نون الوقاية.
- ﴿ نذير وبشير: ﴾
- ندير: خبر \"إنّ\" مرفوع بالضمة أي نذير للكافرين. وبشير: معطوفة بالواو على \"نذير\" وتعرب إعرابها، بمعنى: وبشير للمؤمنين. والجار والمجرور \"لكم\" يعرب إعراب \"منه\" والميم علامة جمع الذكور. '
المتشابهات :
| هود: 2 | ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ |
|---|
| فصلت: 14 | ﴿إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ قَالُواْ لَوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةٗ﴾ |
|---|
| الأحقاف: 21 | ﴿وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ﴾ |
|---|
| هود: 26 | ﴿ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد بيان إحكام القرآن وتفصيله؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا أنه أنزل هذا القرآن المحْكَم المفصَّل لعبادة الله وحده، لا شريك له، قال تعالى:
﴿ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ .. ﴾
التفسير :
{ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} عن ما صدر منكم من الذنوب{ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه، بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه.
ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال:{ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا} أي:يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به وتنتفعون.
{ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} أي:إلى وقت وفاتكم{ وَيُؤْتِ} منكم{ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} أي:يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره، ما هو جزاء لإحسانهم، من حصول ما يحبون، ودفع ما يكرهون.{ وَإِنْ تَوَلَّوْا} عن ما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه، وربما كذبتم به{ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ} وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر
ثم بين- سبحانه- ما يترتب على طاعته من خيرات فقال: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ...
والاستغفار طلب المغفرة والرحمة من الله- تعالى-.
والتوبة: الإقلاع عن كل ما نهى الله، مع التصميم على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل.
ويمتعكم: من الإمتاع، وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه: أمتعنا الله بك أى: أطال لنا بقاءك.
والآية الكريمة معطوفة على قوله- سبحانه- قبل ذلك: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ...
والمعنى: وعليكم- أيها الناس- بعد أن نبذتم كل عبادة لغير الله، أن تديموا طلب مغفرته ورحمته، وأن تتوبوا إليه توبة نصوحا، فإنكم إن فعلتم ذلك يُمَتِّعْكُمْ الله- تعالى- مَتاعاً حَسَناً بأن يبدل خوفكم أمنا، وفقركم غنى، وشقاءكم سعادة.
قوله: إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى أى: إلى نهاية حياتكم التي قدرها الله لكم في هذه الدنيا.
وقوله: وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ أى: ويعط كل صاحب عمل صالح جزاء عمله.
فالمراد بالفضل الأول: العمل الصالح. والمراد بالفضل الثاني الثواب الجزيل من الله- تعالى-.
فالجملة الكريمة، وعد كريم عن الله- تعالى- لكل من آمن وعمل صالحا.
وجملة ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ معطوفة على استغفروا. وثُمَّ هنا على بابها من التراخي، لأن الإنسان يستغفر أولا ربه من الذنوب، ثم يتوب إليه التوبة الصادقة النصوح التي لا رجعة معها إلى ارتكاب الذنوب مرة أخرى.
ووصف المتاع بالحسن، ليدل على أنه عطاء ليس مشوبا بالمكدرات والمنغصات التي تقلق الإنسان في دنياه، وإنما هو عطاء يجعل المؤمن يتمتع بنعم الله التي أسبغها عليه، مع المداومة على شكره- سبحانه- على هذه النعم.
قال- تعالى- مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.
ثم حذر- سبحانه- من الإعراض عن طاعته فقال: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ.
أى: ذكرهم أيها الرسول الكريم بأن في إخلاصهم العبادة لله، وفي طاعتهم له، سعادتهم الدنيوية والأخروية، وفي إعراضهم عن ذلك شقاؤهم وحلول العذاب بهم.
أى: إن تتولوا- أيها الناس- عن الحق الذي جئتكم به، فإنى أخاف عليكم عذاب يوم القيامة، الذي هو عذاب كبير هوله، عظيم وقعه، كما أخاف عليكم عذاب الدنيا.
فتنكير يَوْمٍ للتهويل والتعميم، حتى يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، حيث إنهم كانوا ينكرون البعث والحساب، فتخويفهم بالعذابين أزجر لنفوسهم القاسية، وقلوبهم العاتية.
وفي وصفه بالكبر، زيادة- أيضا- في تهويله وشدته، حتى يثوبوا إلى رشدهم، ويقلعوا عن غيهم وعنادهم.
وقوله : ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ) أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه ، وأن تستمروا على ذلك ، ( يمتعكم متاعا حسنا ) أي : في الدنيا ( إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ) أي : في الدار الآخرة ، قاله قتادة ، كقوله : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) [ النحل : 97 ] ، وقد جاء في الصحيح : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد : " وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتك " .
وقال ابن جرير : حدثت عن المسيب بن شريك ، عن أبي بكر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن مسعود في قوله : ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات ، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات . ثم يقول : هلك من غلب آحاده أعشاره .
وقوله : ( وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى ، وكذب رسله ، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة
القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: ثم فصلت آياته ، بأن لا تعبدوا إلا الله ، وبأن استغفروا ربكم. ويعني بقوله: (وأن استغفروا ربكم) ، وأن اعملوا أيها الناس من الأعمال ما يرضي ربكم عنكم، فيستر عليكم عظيمَ ذنوبكم التي ركبتموها بعبادتكم الأوثان والأصنام ، وإشراككم الآلهة والأنداد في عبادته. (19)
وقوله: (ثم توبوا إليه) ، يقول: ثم ارجعوا إلى ربكم بإخلاص العبادة له دون ما سواه من سائر ما تعبدون من دونه بعد خلعكم الأنداد وبراءتكم من عبادتها. (20)
ولذلك قيل: (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) ، ولم يقل: " وتوبوا إليه " ، لأن " التوبة " معناها الرجوع إلى العمل بطاعة الله، والاستغفار: استغفار من الشرك الذي كانوا عليه مقيمين، والعملُ لله لا يكون عملا له إلا بعد ترك الشرك به، فأما الشرك فإنّ عمله لا يكون إلا للشيطان، فلذلك أمرهم تعالى ذكره بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشرك، لأن أهل الشرك كانوا يرون أنهم يُطِيعون الله بكثير من أفعالهم ، وهم على شركهم مقيمون.
وقوله: (يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى)، يقول تعالى ذكره للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنكم إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زينتها، وأنسأ لكم في آجالكم إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. (21)
* * *
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
17928- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: (يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى) ، فأنتم في ذلك المتاع ، فخذوا بطاعة الله ومعرفة حقّه، فإن الله منعم يحبّ الشاكرين ، وأهل الشكر في مزيدٍ من الله، وذلك قضاؤه الذي قضى.
* * *
وقوله: (إلى أجل مسمى)، يعني الموت.
17929- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (إلى أجل مسمى) ، قال: الموت.
17930- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: (إلى أجل مسمى) ، وهو الموت .
17931- حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة: (إلى أجل مسمى)، قال: الموت.
* * *
وأما قوله: (ويؤت كل ذي فضل فضله) ، فإنه يعني: يثيب كل من تفضَّل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره محتسبًا بذلك ، مريدًا به وجه الله ، أجزلَ ثوابه وفضله في الآخرة، كما:-
17932- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (ويؤت كل ذي فضل فضله) ، قال: ما احتسب به من ماله، أو عمل بيده أو رجله، أو كَلِمة، أو ما تطوَّع به من أمره كله.
17933- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال ،
17934-. . . . وحدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، بنحوه ، إلا أنه قال: أو عملٍ بيديه أو رجليه وكلامه، وما تطوَّل به من أمره كله.
17935- حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد بنحوه ، إلا أنه قال: وما نطق به من أمره كله.
17936- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة: (ويؤت كل ذي فضل فضله) ، أي : في الآخرة.
* * *
وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في تأويل ذلك ما:-
17937- حدثت به عن المسيب بن شريك، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير، عن ابن مسعود، في قوله: (ويؤت كل ذي فضل فضله) ، قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات. فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات. وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة ، وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من غلب آحادُه أعشارَه !!
* * *
وقوله: (وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) ، يقول تعالى ذكره: وإن أعرضوا عما دعوتُهم إليه ، (22) من إخلاص العبادة لله ، وترك عبادة الآلهة ، وامتنعوا من الاستغفار لله والتوبة إليه ، فأدبروا مُوَلِّين عن ذلك، (فإني) ، أيها القوم ، (أخاف عليكم عذاب يوم كبير) شأنُه , عظيمٍ هَوْلُه، وذلك يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
* * *
وقال جل ثناؤه: (وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) ، ولكنه مما قد تقدّمه قولٌ، والعرب إذا قدَّمت قبل الكلام قولا خاطبت ، ثم عادت إلى الخبر عن الغائب ، ثم رجعت بعدُ إلى الخطاب، وقد بينا ذلك في غير موضع ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (23)
--------------------------
الهوامش :
(19) انظر تفسير " الاستغفار " فيما سلف من فهارس اللغة ( غفر ) .
(20) انظر تفسير " التوبة " فيما سلف من فهارس اللغة ( توب ) .
(21) انظر تفسير " المتاع " فيما سلف من فهارس اللغة ( متع ) .
، وتفسير " الأجل المسمى " فيما سلف من فهارس اللغة ( أجل ) .
(22) انظر تفسير " التولي " فيما سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .
(23) انظر ما سلف 13 : 314 ، تعليق ، 3 : والمراجع هناك .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾، وقال هود لقومه: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ [52]، وقال شعيب لقومه: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ [90]، وقال نوح لقومه: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: 10]؛ أعلم الخلق بالله يصفون لكم الدواء.
لمسة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ (ثم) ليست دائمًا للتراخي، ولكن للبعد بين المنزلتين، قد يكون ما بعد (ثم) أعلى مما قبلها، فهو بعد معنوي وليس بعدًا زمنيًّا.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ الاستغفار أعظم ممهدات التوبة، جسر موصل إلى التوبة.
لمسة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ العطف بـ(ثم) يشير إلى إمكانية تباطؤ المدة بين استغفارك وإذن الله لك بالتوبة، فلا تمل من قرع بابه.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ التوبة قمة رفيعة؛ طريقها الاستغفار.
عمل
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ استغفر الله تعالى، وتب إليه في اليوم سبعين مرة.
اسقاط
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ كثرة الاستغفار تهيئ القلب للتوبة النصوح؛ فلا يزال لسانك رطبًا من الاستغفار.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ قال قتادة: «إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم؛ فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار».
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ التوبة وعد، ووعد الحر دين عليه! سمع مطرف رجلًا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فأخذ مطرف بذراعه وقال: «لعلك لا تفعل! من وعد فقد أوجب».
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ قال القشيري: «توبوا إليه بعد الاستغفار، من توهمكم أن نجاتكم باستغفاركم، بل تحققوا بأنكم لا تجدون نجاتكم إلا بفضل ربكم، فبفضله وبتوفيقه توصلتم إلى استغفاركم، لا باستغفاركم وصلتم إلى نجاتكم».
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ كثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح.
اسقاط
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها؛ فالمغفرة أول في المطلوب، وآخر في السبب، ويحتمل أن يكون المعنى: استغفروه من الصغائر، وتوبوا إليه من الكبائر.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ الاستغفار: نظر للماضي السيء، إقلاع ندم، والتوبة: نظر للمستقبل، إقبال على الله وعمل للصالحات.
تفاعل
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ قل الآن: «أستغفر الله وأتوب إليه».
عمل
[3] ﴿وأن اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ﴾ لا تجعل استغفارك عبارة عن كلماتٍ ترددها لا تعرف معناها! بل قلها بيقين وتب وارجع إلى ربك؛ لتنال ما وعدك الله به.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ أعظم المتع وأحسنها تجدها في قلوب التائبين.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ من أدمن الاستغفار رزق المتاع، وكلما كان الاستغفار صادقًا زاد المتاع حسنًا.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ الخطيئة تشعرنا بالتعاسة وفقدان احترام ذواتنا، والاستغفار يمنحنا فرصة البناء من جديد.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ استغفار فمتاع، كانوا كما يحب الله؛ فمتعهم الله كما يحبون.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ كل المتاع في القرآن ومشتقاته لمتاع الدنيا، إن كنت تشكو ضيق الدنيا فاستغفر يمتعك الله.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ الاستغفار من ثماره بسط رزق، واستمتاع بالحياة، وبركة عُمْر.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ من فوائد الآية الكريمة: ترتيب المتاع الحسن على الاستغفار؛ وعليه: فمن أدمن الاستغفار رزق المتاع, وكلما كان الاستغفار صدقًا زاد المتاع حسنًا.
وقفة
[3] الاستغفار من أسباب الطمأنينة والتسرية ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾.
وقفة
[3] راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ كثيرًا ما نجد من لم يتب ولم يستغفر، ومع هذا يمتعه الله متاعًا حسنًا فيرزقه ويوسع عليه، فما السبب؟! الجواب: أن المتاع الحسن -المقيد بالاستغفار والتوبة- هو الحياة في ظل الطاعة مع القناعة، ولا يجتمعان إلا للمستغفر التائب، فمن ضُيق عليه رزقه من المستغفرين التائبين فاعلم أنه يمتع متاعًا حسنًا، بحسن صلته بربه وطمأنينة القلب ورضاه.
لمسة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (ثُمَّ) للترتيب الإِخباري لا الوجودي، إذِ التوبةُ سابقة على الاستغفار، أو المعنى: استغفروا ربكم من الشِّرك، (ثُمَّ تُوبُوا) أي ارجعوا إليه بالطاعة.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إن قلتَ: نجدُ من لم يستغفرِ اللَّهَ ولم يَتُبْ، يمتِّعُه اللَّهُ متاعًا حسنًا إلى أجلِهِ، أي يرزُقُه ويوسِّعُ عليهِ كما قال ابنُ عباس، أو يُعمِّره كما قال ابن قتيبة، فما فائدةُ التقييدِ بالاستغفار والتوبة؟! قلتُ: قال غيرهما: المتاعُ الحسنُ -المقيَّدُ بالاستغفارِ والتوبةِ- هو الحياةُ في الطَّاعةِ والقناعة، ولا يكونانِ إلّاَ للمستغفِر التَّائب.
وقفة
[3] ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يعيشكم عيشةً حسنةً في خفض ودعة، وأمن وسعة، ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ ويؤت كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره، وثوابه في الآخرة.
وقفة
[3] كثرة الاستغفار والتوبة مفتاح لدار السعادة وباب الرزق وطول العمر ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.
وقفة
[3] المأمور به: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ الاستغفار والتوبة ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة ليس لها رصيد في القلب؛ فلنُحسنهما؛ لنجني ثمارهما اليانعة: ﴿يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾.
وقفة
[3] ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب.
وقفة
[3] ﴿يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ أول ثمرات الإيمان: المتاع الحسن، ولم يبين صورة هذا المتاع الحسن؛ لتذهب كل نفس في تقدير هذا المتاع كل مذهب.
وقفة
[3] ﴿يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ المتاع الحسن، القوة، المطر، الرحمة، إجابة الدعاء، كلها جاءت بعد قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ﴾.
وقفة
[3] ﴿يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ سمى منافع الدنيا متاعًا؛ للتنبيه على حقارتها، ونبه مع هذه الحقارة على أنها منفضَّة، فقال: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، فدلت الآية في شدة إيجاز على كون الدنيا حقيرة زائلة.
عمل
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ ابذل ما فضل عندك؛ والله يجازيك بالفضل من عنده.
عمل
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ ابذل (الفضل) منك، لتنال اﻹفضال منه تعالى.
وقفة
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ المراد بالفضل الأول: العمل الصالح، والفضل الثاني: ثواب الله، فالجملة وعد من الكريم بحسن مجازاة الصالحين.
وقفة
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ تتفاوت الدرجات في الآخرة بحسب تفاوت أعمال العباد، قال يحيى بن معاذ: «إنما ينبسطون (ينشطون ويجتهدون) إليه على قدر منازلهم لديه».
وقفة
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ غمرك الله بفضله مرتين، المرة الأولى بأن وفقك للعمل الصالح وحببه إلى قلبك، والمرة الثانية بأن تقبله منك.
وقفة
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ من تفضل على غيره تفضل الله عليه، ومن منع إحسانه وفضله فقد حرم نفسه.
وقفة
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ الفعل (يُؤْتِ) فاعله الله سبحانه وتعالى، و(كُلَّ) مفعول به من البشر، و(فَضْلَهُ) فيها احتمالين: احتمال يعود الضمير على صاحب الفضل، الذي يفعل الخير يؤتيه ربنا، لا يبخس منه شيئًا، يؤتيه حقه بل ويزيد عليه، واحتمال أن يعود الضمير على الله، إن الله يؤتي صاحب الفضل فضل الله، والمعنيان صحيحان.
عمل
[3] لن تنال اﻹحسان إﻻ باﻹحسان؛ فكن من أهل الفضائل تتعرض لنيل فضل الرحمن ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾.
تفاعل
[3] ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ سَل الله من فضله الآن.
وقفة
[3] ﴿وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ هدد الغافل بأهوال يوم القيامة لعله يعود، قيل لعمر بن عبد العزيز: ما كان بدء إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي، فقال: يا عمر، اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة.
عمل
[3] ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ عبر عن مشاعرك بحرارة تجاه قومك ووطنك، أظهر مشاعرك الحقيقية على مستقبلهم، حدثهم عن حبك لمستقبل باسم لهم.
لمسة
[3] ﴿أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ قال ابن عاشور: «وتنكير (يوم) للتهويل، لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يومًا في الدنيا أو في الآخرة؛ لأنهم كانوا يُنكرون الحشر، فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم».
تفاعل
[3] ﴿أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.
الإعراب :
- ﴿ وأن استغفروا: ﴾
- معطوفة بالواو على \"أن تعبدوا\" أي آمركم بالتوحيد والاستغفار ويجوز أن تكون الجملة كلامًا مبتدأ منقطعًا عما قبله على لسان النبي (-صلى الله عليه وسلم-) ويدل عليه قوله إنيّ لكم منه نذير وبشير. أنْ: حرف مصدري. استغفروا: فعل أمر مبني على حذف النون لأنّ مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وكسر آخر \"أن\" لالتقاء الساكنين. وجملة \"استغفروا\" صلة \"أنْ\" المصدرية لا محل لها من الإعراب.
- ﴿ ربكم ثم توبوا: ﴾
- ربّ: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة. الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أي استغفروا ربّكم من الشرك. ثم: عاطفة. توبوا: معطوفة على \"استغفروا\" وتعرب إعرابها. أي توبوا إليه سبحانه بالطاعة.
- ﴿ إليه يمتعكم: ﴾
- جار ومجرور متعلق بتوبوا. يمتعكم: فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب -الأمر- وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. أي يمتعكم في الدنيا بالرزق الوفير.
- ﴿ متاعًا حسنًا: ﴾
- متاعًا أي تمتيعًا: مفعول مطلق منصوب بالفتحة. حسنًا: صفة -نعت- لمتاعًا منصوبة مثلها بالفتحة.
- ﴿ إلى أجل مسمّى: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيمتع. مسمى: أي مقدر بمعنى: إلى مدة مقدرة وهي صفة لأجل مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرِة المقدرة للتعذر على الألف قبل تنوينها. لأنها اسم مذكر مقصور نكرة ونُوِّنتْ لأنها مقصور رباعي.
- ﴿ ويؤت كل ذي فضل فضله: ﴾
- ويؤت: معطوفة بالواو على \"يمتّع\" وتعرب إعرابها وعلامة جزم الفعل حذف آخره -حرف العلة- كلّ: مفعول به منصوب بالفتحة. ذي: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. فضل: مضاف إليه مجرور بالكسرة. فضله: أي جزاء فضله فحذف المضاف وبقي المضاف إليه وهو مفعول به ثانٍ بفعل \"يؤت\" لأن معناه \"يعطي\" منصوب بالفتحة والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة.
- ﴿ وإنّ تولوا: ﴾
- الواو. استئنافية. إنْ: حرف شرط جازم. تولوا: أي \"تتولّوا\" فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإنْ وعلامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وحذفت إحدى التاءين اختصارًا.
- ﴿ فإني أخاف عليكم: ﴾
- الجملة وما تلاها جواب شرط جازم مسبوق بإنّ مقترن بالفاء في محل جزم. الفاء: واقعة في جواب الشرط، إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم \"إن\". أخاف: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا وجملة \"أخاف وما بعدها\" في محل رفع خبر \"انّ\". عليكم: جار ومجرور متعلق بأخاف والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ عذاب يوم كبير: ﴾
- عذاب. مفعول به منصوب بالفتحة. يوم: مضاف إليه مجرور بالكسرة. كبير: صفة ليوم مجرورة مثلها بالكسرة. '
المتشابهات :
| هود: 3 | ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ |
|---|
| هود: 52 | ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾ |
|---|
| هود: 90 | ﴿وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ |
|---|
| هود: 61 | ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد تحديد مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذير وبشير؛ جاء هنا أن ما دعا إليه هذا الرسول بعد توحيد الله هو الاستغفار والتوبة، قال تعالى: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ/ وبعد التَّبشير؛ جاء التَّحذير، قال تعالى: /وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)
﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يمتعكم:
قرئ:
يمتعكم، بالتخفيف، من «أمتع» ، وهى قراءة الحسن، وابن هرمز، وزيد بن على، وابن محيصن.
تولوا:
قرئ:
1- بضم التاء واللام وفتح الواو، مضارع «ولى» ، وهى قراءة اليماني، وعيسى بن عمر.
2- بضم التاء واللام وسكون الواو، مضارع «أولى» ، وهى قراءة الأعرج.
مدارسة الآية : [4] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى .. ﴾
التفسير :
وفي قوله:{ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه قدير على كل شيء، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا.
وقوله- سبحانه- إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تحذير آخر لهم، إثر التحذير من الإعراض عما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم.
والمرجع: مصدر ميمى بمعنى الرجوع الذي لا انفكاك لهم منه، ولا محيد لهم عنه.
أى: إلى الله- تعالى- وحده رجوعكم مهما طالت حياتكم، ليحاسبكم على أعمالكم، ويجازيكم عليها بما تستحقونه من جزاء، وهو- سبحانه- على كل شيء قدير، لا يعجزه أمر، ولا يحول بينه وبين نفاذ إرادته حائل.
وما دام الأمر كذلك، فأخلصوا لله العبادة، واستغفروه ثم توبوا إليه لتظفروا بالسعادة العاجلة والآجلة.
( إلى الله مرجعكم ) أي : معادكم يوم القيامة ، ( وهو على كل شيء قدير ) أي : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه ، وانتقامه من أعدائه ، وإعادة الخلائق يوم القيامة ، وهذا مقام الترهيب ، كما أن الأول مقام ترغيب .
القول في تأويل قوله تعالى : إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : (إلى الله)، أيها القوم ، مآبكم ومصيركم، (24)
فاحذروا عقابه إن توليتم عما أدعوكم إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة والأصنام، فإنه مخلدكم نارَ جهنم إن هلكتم على شرككم قبل التوبة إليه ، (وهو على كل شيء قدير) ، يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم، وعقابكم على إشراككم به الأوثانَ وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم قادرٌ. (25)
---------------------
الهوامش :
(24) انظر تفسير " المرجع " فيما سلف ص : 146 ، تعليق : 5 ، والمراجع هناك .
(25) انظر تفسير " قدير " فيما سلف من فهارس اللغة ( قدر ) .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[4] ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ لا مفر ولا مهرب من الوقوف غدًا بين يدي الله.
لمسة
[4] ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ التقديم والتأخير للتخصيص والحصر، أي: لا يرجعون إلى غيره.
وقفة
[4] هنا قال: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ فقط، وأحيانًا: ﴿إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 48]، في كل القرآن إذا قال: (جَمِيعًا) يذكر جهات متعددة مختلفة، وعندما يقول: (مَرْجِعُكُمْ) فقط فالمخاطبون جهة واحدة، ففي المائدة ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ... وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]، فالآية ذكرت معتقدات اليهود والنصارى، ذكر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء في سبع آيات مستمرة في هذه المسألة فقال (جَمِيعًا).
الإعراب :
- ﴿ إلى الله مرجعكم: ﴾
- إلى الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر مقدم. مرجعكم أي رجوعكم: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ وهو على عل شيء قدير: ﴾
- الواو: استئنافية. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. على كل. جار ومجرور متعلق بقدير شيء مضاف إليه مجرور بالكسرة. قدير: خبر \"هو\" مرفوع بالضمة. '
المتشابهات :
| هود: 4 | ﴿ إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ |
|---|
| المائدة: 48 | ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ |
|---|
| المائدة: 105 | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد التحذير من عذاب يوم القيامة؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا أنه لا بد مهما طالت الحياة من رجوع جميع النَّاس إلى الله، ليحاسبهم على أعمالهم، ويجازيهم عليها، وهو قادر على البعث والحساب والجزاء وكل شيء، قال تعالى:
﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ .. ﴾
التفسير :
يخبر تعالى عن جهل المشركين، وشدة ضلالهم، أنهم{ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ} أي:يميلونها{ لِيَسْتَخْفُوا} من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم، وبصره لهيئاتهم.
قال تعالى -مبينا خطأهم في هذا الظن-{ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ} أي:يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال، التي هي من أخفى الأشياء.
بل{ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ} من الأقوال والأفعال{ وَمَا يُعْلِنُونَ} منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو:{ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي:بما فيها من الإرادات، والوساوس، والأفكار، التي لم ينطقوا بها، سرا ولا جهرا، فكيف تخفى عليه حالكم، إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه.
ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته، أنهم -من شدة إعراضهم- يثنون صدورهم، أي:يحدودبون حين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يراهم ويسمعهم دعوته، ويعظهم بما ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟"
ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم، وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم.
ثم حكى- سبحانه- جانبا من جهالات المنحرفين عن الحق، ومن أوهامهم الباطلة، فقال- تعالى-:
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
وقوله: يَثْنُونَ من الثنى بمعنى الطى والستر. يقال: ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من الأشياء المستورة.
وثنى الصدور: إمالتها وطأطأتها وحنيها بحيث تكون القامة غير مستقيمة. والاستخفاء:
محاولة الاختفاء عن الأعين، ومنه قوله- تعالى- يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ..
.
وقوله: يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ.. أى: يتدثرون ويتغطون بها، مبالغة في الاستخفاء عن الأعين. فالسين والتاء فيه للتأكيد، كما في قوله- تعالى- وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ ... أى: جعلوها كالغشاء عليهم.
وقد ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية روايات منها: أنه كان الرجل من الكفار يدخل بيته، ويرخى ستره، ويحنى ظهره، ويتغشى بثوبه ثم يقول: هل يعلم الله ما في قلبي فنزلت هذه الآية.
وقيل: نزلت في المنافقين، كان أحدهم إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره. وتغشى بثوبه لئلا يراه.
وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق، وكان رجلا حلو المنطق، حسن السياق للحديث، يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة، ويضمر في قلبه ما يضادها..» .
وعلى أية حال فإن الآية الكريمة تصور تصويرا بديعا جهالات بعض الضالين بعلم الله- تعالى- المحيط بكل شيء، كما تصور تصويرا دقيقا أوضاعهم الحسية حين يأوون إلى فراشهم، وحين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والضمير المجرور في قوله مِنْهُ يعود إلى الله- تعالى- وعليه يكون المعنى ألا إن هؤلاء المشركين يلوون صدورهم عن الحق الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم توهما منهم أن فعلهم هذا يخفى على الله- تعالى-.
ومنهم من يرى أن الضمير في قوله مِنْهُ يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يكون المعنى:
ألا إن هؤلاء المشركين يعرضون عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ويطأطئون رءوسهم عند رؤيته، ليستخفوا منه، حتى لا يؤثر فيهم بسحر بيانه.
ومع أن كلا القولين له وجاهته وله من سبب النزول ما يؤيده، إلا أننا نميل إلى كون الضمير يعود على الله- تعالى- لأن قوله- تعالى- بعد ذلك يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ يؤيد عودة الضمير إليه- سبحانه- إذ علم السر والعلن مرده إليه وحده.
وافتتحت الآية الكريمة بحرف التنبيه أَلا وجيء به مرة أخرى في قوله أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ.. للاهتمام بمضمون الكلام، وللفت أنظار السامعين إلى ما بلغه هؤلاء الضالون من جهل وانطماس بصيرة.
ثم بين- سبحانه- أنه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم فقال: أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ، يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
أى: ألا يعلم هؤلاء الجاهلون أنهم حين يأوون إلى فراشهم، ويتدثرون بثيابهم، يعلم الله- تعالى- ما يسرونه في قلوبهم من أفكار، وما يعلنونه بأفواههم من أقوال، لأنه- سبحانه- محيط بما تضمره النفوس من خفايا، وما يدور بها من أسرار.
وجملة إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ تعليلية لتأكيد ما قبلها من علمه- سبحانه- بالسر والعلن. والمراد بذات الصدور: الأسرار المستكنة فيها.
هذا، وقد ذكر ابن كثير رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية فقال: قال ابن عباس:
كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية رواه البخاري من حديث ابن جريج.
وفي لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم..» .
وظاهر من هذا الكلام المنقول عن ابن عباس أنها نزلت في شأن جماعة من المسلمين هذا شأنهم، ولعل مراده أن الآية تنطبق على صنيعهم وليس فعلهم هو سبب نزولها، لأن الآية مسوقة للتوبيخ والذم، والذين يستحقون ذلك هم أولئك المشركون وأشباههم الذين أعرضوا عن الحق، وجهلوا صفات الله- تعالى-.
قال الجمل بعد أن ذكر قول ابن عباس: وتنزيل الآية على هذا القول بعيد جدا، لأن الاستحياء من الجماع وقضاء الحاجة في حال كشف العورة إلى جهة السماء، أمر مستحسن شرعا، فكيف يلام عليه فاعله ويذم بمقتضى سياق الآية» .
وإذا فالذي يستدعيه السياق ويقتضيه ربط الآيات، كون الآية في ذم المشركين ومن على شاكلتهم من المنحرفين عن الطريق المستقيم.
ثم ساق- سبحانه- ما يدل على كمال قدرته، وسابغ فضله، وشمول علمه فقال- تعالى-:
قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم ، وحال وقاعهم ، فأنزل الله هذه الآية . رواه البخاري من حديث ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ; أن ابن عباس قرأ : " ألا إنهم تثنوني صدورهم " ، فقلت : يا أبا عباس ، ما تثنوني صدورهم ؟ قال : الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي - أو : يتخلى فيستحيي فنزلت : " ألا إنهم تثنوني صدورهم " .
وفي لفظ آخر له : قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا ، فيفضوا إلى السماء ، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء ، فنزل ذلك فيهم .
ثم قال : حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو قال : قرأ ابن عباس " ألا إنهم يثنوني صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم " .
قال البخاري : وقال غيره ، عن ابن عباس : ( يستغشون ) يغطون رءوسهم .
وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية : يعني به الشك في الله ، وعمل السيئات ، وكذا روي عن مجاهد ، والحسن ، وغيرهم : أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه ، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك ، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل ، ( يعلم ما يسرون ) من القول : ( وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ) أي : يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر . وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة :
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ، فمهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر
ليوم حساب ، أو يعجل فينقم
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات ، وبالمعاد وبالجزاء ، وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة .
وقال عبد الله بن شداد : كان أحدهم إذا مر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثنى صدره ، وغطى رأسه فأنزل الله ذلك .
وعود الضمير على الله أولى; لقوله : ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ) .
وقرأ ابن عباس : " ألا إنهم تثنوني صدورهم " ، برفع الصدور على الفاعلية ، وهو قريب المعنى .
القول في تأويل قوله تعالى : أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5)
قال أبو جعفر : اختلفت القراء في قراءة قوله: ( ألا أنهم يثنون صدورهم ) ، فقرأته عامة الأمصار: ( أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ) ، على تقدير " يفعلون " من " ثنيت "، و " الصدور " منصوبة.
واختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله، فقال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين ، كان إذا مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم غطَّى وجهه وثَنَى ظهره.
*ذكر من قال ذلك:
17938- حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، عن عبد الله بن شداد في قوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم) ، قال: كان أحدهم إذا مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بثوبه على وجهه ، وثنى ظهره. (26)
17939- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه)، قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: كان المنافقون إذا مرُّوا به ثنى أحدهم صدره ، ويطأطئ رأسه. فقال الله: (ألا إنهم يثنون صدورهم)، الآية.
17940- حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم، عن حصين قال: سمعت عبد الله بن شداد يقول في قوله: (يثنون صدورهم) ، قال: كان أحدهم إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثَنَى صدره، وتغشَّى بثوبه ، كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
وقال آخرون: بل كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله وظنًّا أن الله يخفى عليه ما تضمره صدورهم إذا فعلوا ذلك.
*ذكر من قال ذلك:
17941- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (يثنون صدورهم) قال: شكًّا وامتراءً في الحق، ليستخفوا من الله إن استطاعوا.
17942- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (يثنون صدورهم) ، شكًّا وامتراءً في الحق.(ليستخفوا منه) ، قال: من الله إن استطاعوا.
17943- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن نجيح، عن مجاهد: (يثنون صدورهم) ، قال: تضيق شكًّا .
17944- حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (يثنون صدورهم) ، قال: تضيق شكًّا وامتراءً في الحق. قال: (ليستخفوا منه) ، قال: من الله إن استطاعوا
17945- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، بنحوه.
17946- حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا هوذة قال ، حدثنا عوف، عن الحسن في قوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم)، قال: من جهالتهم به، قال الله: (ألا حين يستغشون ثيابهم) ، في ظلمة الليل ، في أجواف بيوتهم ، (يعلم) ، تلك الساعة (ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ).
17947- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي رزين: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم)، قال: كان أحدهم يحني ظهره ، ويستغشي بثوبه.
* * *
وقال آخرون: إنما كانوا يفعلون ذلك لئلا يسمعوا كتاب الله . (27)
*ذكر من قال ذلك:
17948- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة : ( ألا إنهم يثنون صدورهم) الآية، قال: كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله، قال تعالى: (ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) وذلك أخفى ما يكون ابن آدم ، إذا حنى صدره واستغشى بثوبه ، وأضمر همَّه في نفسه، فإن الله لا يخفى ذلك عليه. (28)
17949- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: (يستغشون ثيابهم) ، قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسرَّ في نفسه شيئًا وتغطَّى بثوبه، فذلك أخفى ما يكون، والله يطلع على ما في نفوسهم، والله يعلم ما يسرُّون وما يعلنون.
* * *
وقال آخرون: إنما هذا إخبارٌ من الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين كانوا يضمرون له العداوة والبغضاء ، ويبدون له المحبة والمودة، أنهم معه وعلى دينه. (29) يقول جل ثناؤه: ألا إنهم يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله، ثم أخبر جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سرائرهم وعلانيتهم.
* * *
وقال آخرون: كانوا يفعلون ذلك إذا ناجى بعضهم بعضًا.
*ذكر من قال ذلك:
17950- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) ، قال: هذا حين يناجي بعضهم بعضًا. وقرأ: (ألا حين يستغشون ثيابهم) الآية.
* * *
وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: (أَلا إِنَّهُمْ تَثْنَونِي صُدُورُهُمْ )، على مثال: " تَحْلَولِي الثمرة " ، " تَفْعَوْعِل ".
17951- حدثنا . . . قال ، حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقرأ (أَلا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ )، قال: كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم ، كراهة أن يُفْضُوا بفروجهم إلى السماء. (30)
17952- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول، سمعت ابن عباس يقرؤها: (أَلا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ )، قال: سألته عنها فقال: كان ناس يستحيون أن يتخلَّوا فيُفْضُوا إلى السماء، وأن يصيبوا فيْفضُوا إلى السماء.
* * *
وروي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر، وهو ما:-
17953- حدثنا به محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال، أخبرت ، عن عكرمة: أن ابن عباس قرأ (أَلا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ )، وقال ابن عباس: " تثنوني صدورهم "، الشكُّ في الله ، وعمل السيئات ، (يستغشون ثيابهم) ، يستكبر، أو يستكنّ من الله ، والله يراه، يعلم ما يسرُّون وما يعلنون.
17954- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق، قال، أخبرنا معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قرأ: (أَلا إِنَّهُمْ تَثْنَونِي صُدُورُهُمْ )، قال عكرمة: " تثنوني صدورهم "، قال: الشك في الله ، وعمل السيئات، فيستغشي ثيابه ، ويستكنّ من الله، والله يراه ويعلم ما يسرُّون وما يعلنون
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار، وهو: ( أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ) ، على مثال " يفعلون "، و " الصدور " نصب ، بمعنى: يحنون صدورهم ويكنُّونها، (31) كما:-
17955- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: (يثنون صدورهم) ، يقول: يكنُّون. (32)
17956- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم) ، يقول: يكتمون ما في قلوبهم ، (ألا حين يستغشون ثيابهم)، يعلم ما عملوا بالليل والنهار.
17957- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم) ، يقول: (تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ).
قال أبو جعفر: وهذا التأويل الذي تأوّله الضحاك على مذهب قراءة ابن عباس، إلا أن الذي حدثنا ، هكذا ذكر القراءة في الرواية.
* * *
فإذا كانت القراءة التي ذكرنا أولى القراءتين في ذلك بالصواب ، لإجماع الحجة من القراء عليها. فأولى التأويلات بتأويل ذلك، تأويلُ من قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم ، أو تناجوه بينهم.
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن قوله: (ليستخفوا منه) ، بمعنى: ليستخفوا من الله، وأن الهاء في قوله، (منه) ، عائدة على اسم الله، ولم يجر لمحمّدٍ ذكر قبلُ ، فيجعل من ذكره صلى الله عليه وسلم وهي في سياق الخبر عن الله. فإذا كان ذلك كذلك ، كانت بأن تكون من ذكر الله أولى. وإذا صحّ أن ذلك كذلك، كان معلومًا أنهم لم يحدِّثوا أنفسهم أنهم يستخفون من الله ، إلا بجهلهم به. فأخبرهم جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سرُّ أمورهم وعلانيتها على أيّ حالٍ كانوا ، تغشَّوا بالثياب ، أو أظهروا بالبَرَاز، (33)
فقال: (ألا حين يستغشون ثيابهم) ، يعني: يتغشَّون ثيابهم ، يتغطونها ويلبسون.
* * *
يقال منه: " استغشى ثوبه وتغشّاه "، قال الله: وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ [سورة نوح: 7 ]، وقالت الخنساء:
أَرْعَـى النُّجُـومَ وَمَـا كُـلِّفْتُ رِعْيَتَهَا
وَتَــارَةً أَتَغَشَّــى فَضْـلَ أَطْمَـارِي (34)
* * *
، (يعلم ما يسرون) ، يقول جل ثناؤه: يعلم ما يسرُّ هؤلاء الجهلة بربهم، الظانُّون أن الله يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا حنوها على ما فيها ، وثنوها، وما تناجوه بينهم فأخفوه (35) ، (وما يعلنون) ، سواء عنده سرائرُ عباده وعلانيتهم ، (إنه عليم بذات الصدور) ، يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه ، من إيمان وكفر ، وحق وباطل ، وخير وشر، وما تستجنُّه مما لم تُجنُّه بعدُ، (36) كما:-
17958- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: (ألا حين يستغشون ثيابهم) ، يقول: يغطون رءوسهم.
* * *
قال أبو جعفر: فاحذروا أن يطلع عليكم ربكم وأنتم مضمرون في صُدُوركم الشكّ في شيء من توحيده أو أمره أو نهيه، أو فيما ألزمكم الإيمان به والتصديق، فتهلكوا باعتقادكم ذلك.
--------------------------
الهوامش :
(26) قوله : " قال بثوبه على وجهه " ، أي : أخذ ثوبه وحاول أن يغطي به وجهه حتى لا يراه صلى الله عليه وسلم . و " قال " حرف من اللغة ، يستخدم في معان كثيرة ، ويراد به تصوير الحركة .
انظر ما سلف 2 : 546 ، 547 / الأثر : 5796 ج 5 ص 400 ، تعليق : 1 / الأثر 12523 ج 10 ص 572 ، تعليق : 1 / الأثر 17429 ، ج 14 ص : 541 ، تعليق : 2 .
(27) في المطبوعة : " كلام الله تعالى " ، وأثبت ما في المخطوطة .
(28) ما بين القوسين ساقط من المخطوطة .
(29) في المطبوعة : " وأنهم " بالواو ، وما في المخطوطة صواب جيد .
(30) الأثر : 17951 - في المطبوعة : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة " ، وهذا ليس في المخطوطة ، بل الذي فيها ما أثبته : " حدثنا قال .... حدثنا أبو أسامة " ، بياض بين الكلامين وفوقه كتب " كذا " ، يعني ، هكذا البياض بالأصل .
(31) في المطبوعة : " يكبونها " و " يكبون " ، بالباء في الموضعين ، والصواب ما في المخطوطة وهي منقوطة هناك فيهما .
(32) في المطبوعة : " يكبونها " و " يكبون " ، بالباء في الموضعين ، والصواب ما في المخطوطة وهي منقوطة هناك فيهما .
(33) " البراز " ( بفتح الباء ) : الفضاء البعيد الواسع ، ليس فيه شجر ولا ستر .
(34) ديوانها : 109 ، من شعرها في مراثي أخيها صخر ، تقول قبله :
إنِّــي أَرِقْـتُ فبِـتُّ اللَّيْـلَ سَـاهِرَةً
كَأَنَّمَــا كٌحِــلَتْ عَيْنِــي بِعُــوَّارِ
" العوار " القذى . وقولها : " أرعى النجوم " ، تراقبها ، من غلبة الهم عليها ليلا ، فهي ساهرة تأنس بتطويح البصر في السماوات . و " الأطمار " ، أخلاق الثياب . تقول : طال حدادها وحزنها ، فلا تبالي أن يكون لها جديد ، فهي في خلقان ثيابها ، فإذا طال سهرها وغلبها ما غلبها ، تغطت بأطمارها فعل الحزين ، وبكت أو انطوت على أحزانها .
(35) انظر تفسير " الإسرار " فيما سلف : 103 .
(36) انظر تفسير " ذات الصدور " فيما سلف 13 : 570 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ مع الله: كل محاولات الاختباء غباء.
وقفة
[5] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ فيها قولان: الأول: إذا ثنينا صدورنا على عداوة محمد، فكيف سيعلم بنا؟ وهي إشارة إلى النفاق، الثاني: ينصرفون عن النبي حتى لا يسمعوا كلامه، وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من الطعن فيه.
وقفة
[5] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ قيل: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله يردون إليه ظهورهم لئلا يروه؛ من شدة البغض والعداوة.
وقفة
[5] ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ عند الله: أشد ما تكون منسترًا، أكثر ما تكون منفضحًا، إلا إذا اتزرت بالتقوى.
وقفة
[5] ﴿أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ، يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ﴾ لا يغرك الغطاء والستار والجدار؛ فالله مطلع على كل الأسرار.
وقفة
[5] ﴿أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ، يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ﴾ سبحانه محيط بما تضمره النفوس من خفايا، وما يدور بها من أسرار، علمه تعالى بنوايا قلبك لا تحول بينه وبينها الأبواب الموصدة.
لمسة
[5] ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ فيها احتمالان: أن تكون (ما) مصدرية، يعني إسرارهم وإعلانهم، وتحتمل أن تكون اسمًا موصولًا، يعني الذي يسرونه والذي يعلنونه، والآية تحتمل المعنيين بحذف العائد (الذي) فهو يعلم الإسرار والإعلان، ويعلم الذي يسرونه ويعلنونه، هذا يسمى توسعًا في المعنى، والمقصود كل شيء، يعلم إسرارهم وإعلانهم مداره وكيفيته.
عمل
[5] ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ رسالة ربانية تقنعك بالسكوت عن إفصاح مشاعرك للناس، يكفيك أن الله يعلم مكنونك، استغنِ بالله وهو سيغنيك.
وقفة
[5] ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ ما المقصود بذات الصدور؟ فيها أمران: إما الأسرار المستكنة في الصدر لم تخرج بعد، وإما القلوب التي في الصدور، هذه كلها ذات الصدور.
الإعراب :
- ﴿ ألا إنهم: ﴾
- ألا: حرف استفتاح وتنبيه لا عمل له. إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و \"هم\" ضمير الغائبين أي الكافرين مبني على السكون في محل نصب اسم \"إن\".
- ﴿ يثنون صدورهم: ﴾
- يثنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. صدور: مفعول به منصوب بالفتحة و \"هم\" ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أي يثنون صدورهم عن الحق والجملة الفعلية \"يثنون صدورهم\" في محل رفع خبر \"إن\".
- ﴿ ليستخفوا منه: ﴾
- أي ليستخفوا من الله بسرّهم. اللام: للتعليل حرف جر. يستخفوا: فعل مضارع منصوب بأنْ مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه: حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة، منه: جار ومجرور متعلق بيستخفوا و \"أنّ\" المضمرة وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جز باللام والجار والمجرور متعلق بيثنون. وجملة \"يستخفوا منه\" صلة \"أنْ\" المصدرية لا محل لها.
- ﴿ ألا حين يستغشون ثيابهم: ﴾
- ألا: حرف استفتاح وتنبيه. أي ألا إنهم. حين: ظرف زمان منصوب على الظرفية بالفتحة. يستغشون: تعرب إعراب \"يثنون\" وجملة \"يستغشون\" في محل جر بالإضافة لوقوعها بعد الظرف \"حين\". ثياب: مفعول به منصوب بالفتحة و \"هم\" ضمير الغائبين في محل جر بالإضافة.
- ﴿ يعلم ما يسرّون: ﴾
- الجملة: في محل رفع خبر \"إن\" المقدرة من سياق الجملة. يعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة بعده: صلة الموصول لا محل لها. يسرون: تعرب إعراب \"يثنون\" والعائد إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به.
- ﴿ وما يعلنون إنه: ﴾
- معطوفة بالواو على \"ما يسرّون\" وتعرب إعرابها. إنه: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم \"انّ\". التقدير: ما يسّرونه وما يعلنونه.
- ﴿ عليم بذات الصدور: ﴾
- خبر \"إن\" مرفوع بالضمة. بذات: جار ومجرور متعلق بعليم. الصدور: مضاف إليه مجرور بالكسر بمعنى: بإسرار الصدور. '
المتشابهات :
| البقرة: 77 | ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ |
|---|
| هود: 5 | ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ |
|---|
| النحل: 23 | ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡتَكۡبِرِينَ﴾ |
|---|
| يس: 76 | ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ألا إنَّهم يَثْنُونَ صُدُورَهم لِيَسْتَخْفُوا مِنهُ﴾ نَزَلَتْ في الأخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ، وكانَ رَجُلًا حُلْوَ الكَلامِ، حُلْوَ المَنظَرِ، يَلْقى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِما يُحِبُّ، ويَنْطَوِي بِقَلْبِهِ عَلى ما يَكْرَهُ. وقالَ الكَلْبِيُّ: كانَ يُجالِسُ النَّبِيَّ ﷺ ويُظْهِرُ لَهُ أمْرًا حَسَنًا يَسُرُّهُ، ويُضْمِرُ في قَلْبِهِ خِلافَ ما يُظْهِرُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ألا إنَّهم يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ . يَقُولُ: يُكْمِنُونَ ما في صُدُورِهِمْ مِنَ العَداوَةِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ . '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد التَّبشير والتَّحذير؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا كيف تلقى القوم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يُثني صدره ويغطي وجهه بثيابه إذا مرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يستمع إلى القرآن، ولا ينتفع به، قال تعالى:
﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يثنون:
1- بفتح الياء، مضارع «ثنى» ، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بضمها، مضارع «أثنى» ، و «صدورهم» بالرفع، وهى قراءة سعيد بن جبير.
3- تثنونى، مضارع «اثنونى» ، و «صدورهم» بالرفع، وهى قراءة ابن عباس، وعلى بن الحسين، وابناه: زيد ومحمد، وابنه جعفر، ومجاهد، وابن يعمر، ونصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن أبزى، والجحدري، وابن أبى إسحاق، وأبى الأسود الدؤلي، وأبى رزين، والضحاك.
4- يثنونى، بالياء، و «صدورهم» بالرفع، وهى قراءة ابن عباس أيضا، ومجاهد، وابن يعمر، وابن أبى إسحاق.
ألا حين يستغشون:
وقرئ:
على حين يستغشون، وهى قراءة ابن عباس.