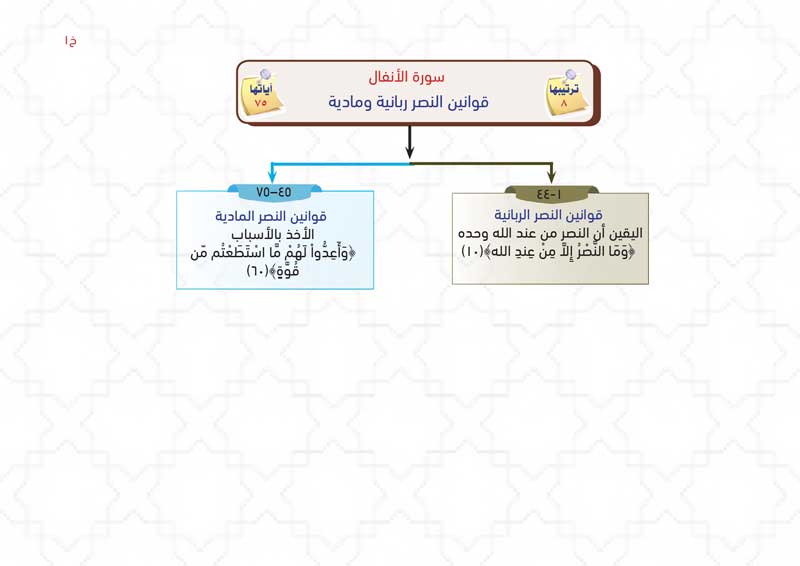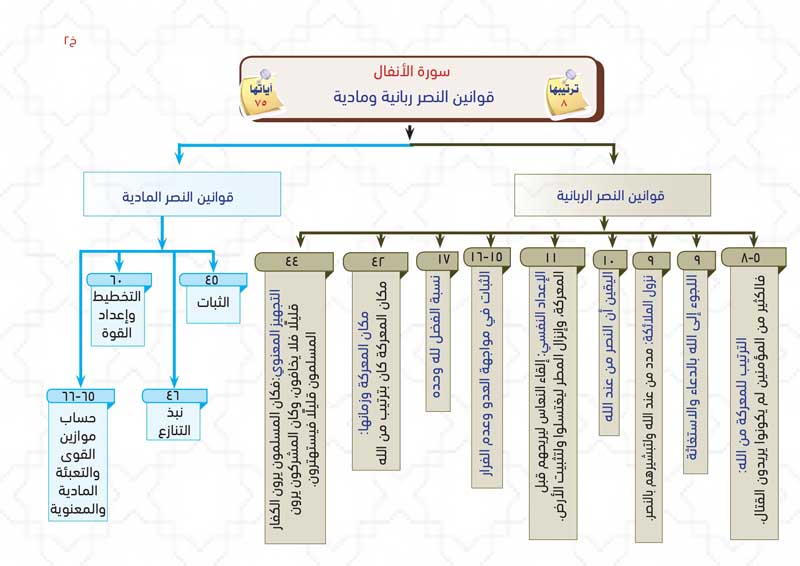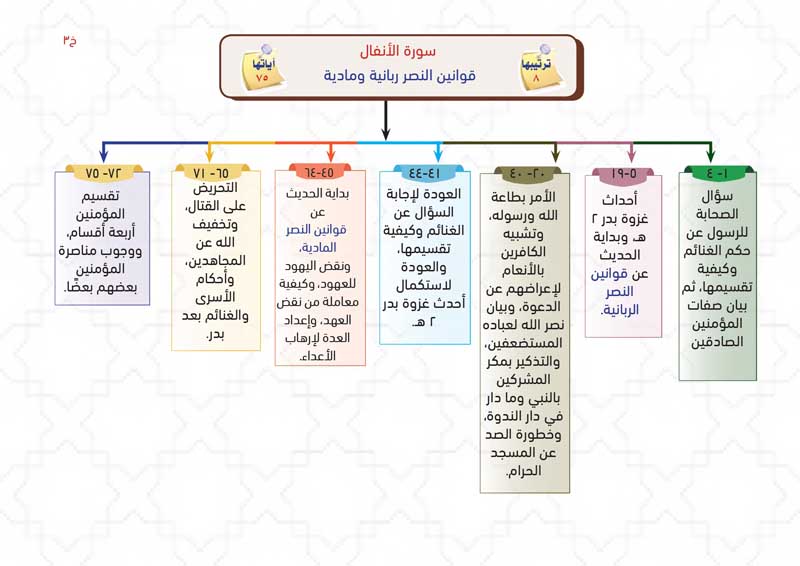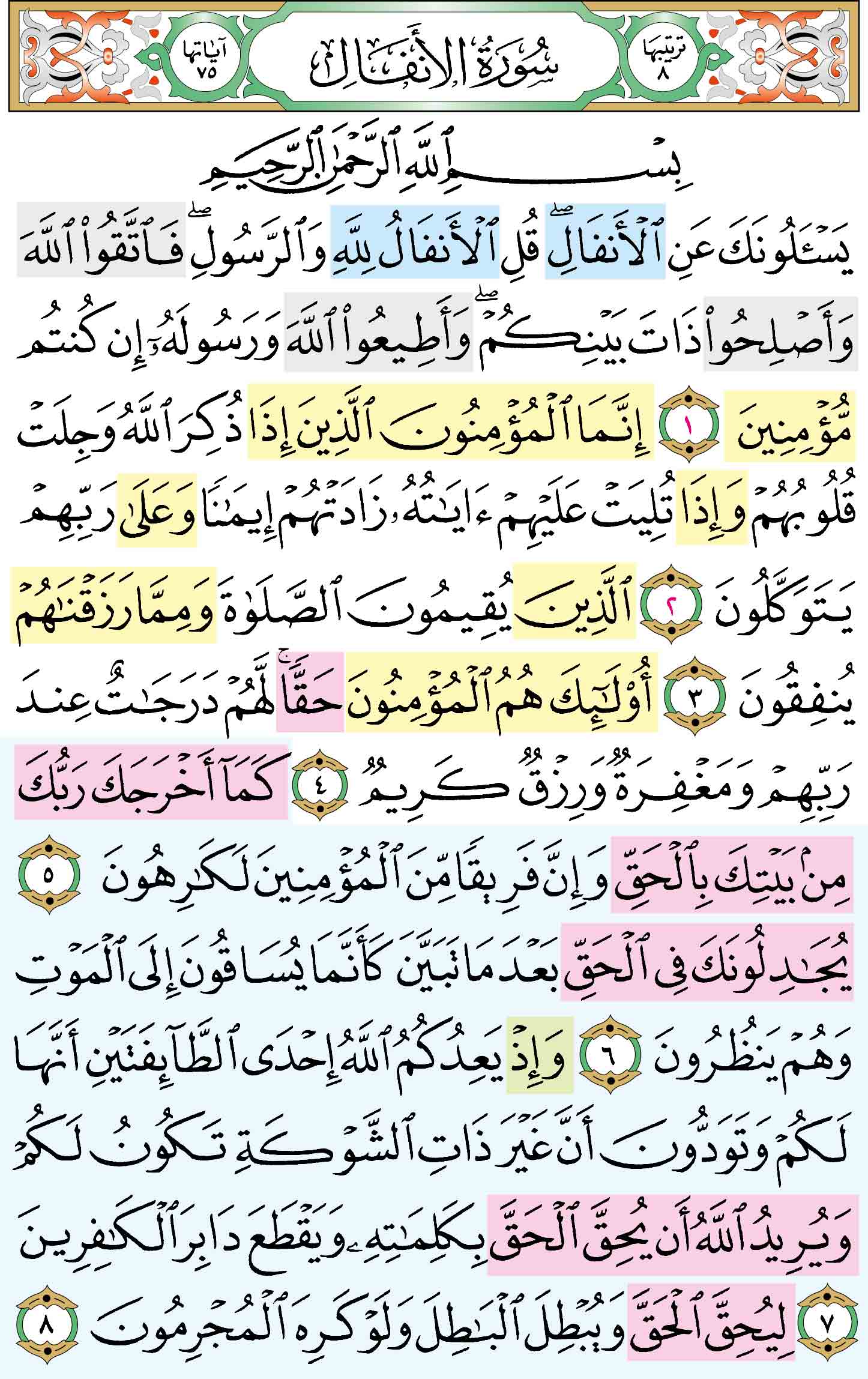
الإحصائيات
سورة الأنفال
| ترتيب المصحف | 8 | ترتيب النزول | 88 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 10.00 |
| عدد الآيات | 75 | عدد الأجزاء | 0.50 |
| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |
| ترتيب الطول | 18 | تبدأ في الجزء | 9 |
| تنتهي في الجزء | 10 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الجمل الخبرية: 1/21 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)
سؤالُ الصَّحابةِ للنَّبي ﷺ عن حُكمِ الغَنائِمِ التى غَنِمُوها من كفَّارِ قُريشٍ في غزوةِ بَدرٍ، ولِمَن هي، وكيف تُقسَّمُ؟ ثُمَّ بيانُ صفاتِ المؤمنينَ وجزائِهم.
فيديو المقطع
المقطع الثاني
من الآية رقم (5) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (4)
بدايةُ أحداثِ غزوةِ بَدرٍ 2هـ بخروجِ النَّبي ﷺ والصَّحابةِ من المدينةِ للقاءِ قريشٍ معَ كراهةِ البعضِ لذلك، ووعدُ اللهِ لهم بإحدي الطائفتينِ: عِيرِ قُرَيْشٍ القادمةِ من الشامِ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ أَرْزَاقٍ، أَوِ النَّفِيرِ الآتي من مكةَ.
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة الأنفال
قوانين النصر ربانية ومادية (كيف تنصرون؟)/ أسباب النصر/ أولئك هم المؤمنون حقًا/ التعبئة النفسية والمادية للجهاد
أولاً : التمهيد للسورة :
- • فتبدأ السورة بـ:: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ...﴾ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟! كانوا على وشك الاعتقاد أنهم على قمة جبل التقوى والصلاح، فتعالجهم السورة في مطلعها، وهي تقول لهم: اتقوا الله.
- • ثثم تذكرهم: أن منهم من لم يكونوا يريدون الخروج لبدر أصلًا، وأنهم جادلوا في ذلك: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾. جادلوا فيما قاد إلى هذا النصر الذي يمكن للشيطان أن يوسوس لهم أنه كان نتيجة حتمية لجهودهم
- • ثم تسحب السورة منهم: "استحقاق النصر": ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. هل أصابكم الغرور بسبب ما تحقق؟! حسنًا، خذوا هذه الآن: أنتم لم تقاتلوا أصلًا، وهذا الرمي الموفق لم يكن رميكم، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. نعم، لو كان النصر يقاس بالمقاييس المادية، فإن المسلمين لم يكونوا لينتصروا في ذلك اليوم أبدًا، لأن عدد المسلمين كان 313 رجلًا ولم يكونوا مهيئين نفسيًا أو مجهزين عتادًا للقتال (كان معهم فرس واحد)، في حين كان عدد الكفار 1000 مقاتل كامل الجهوزية للحرب (كان معهم 300 فرس).ولننتبه أن هذا لم يحدث قبل القتال، بل حدث بعده، وبعد تحقق النصر، ولو كان حدث قبل لما قاد إلى النصر.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الأنفال».
- • معنى الاسم :: االأنفال: هي الغنائم التي يَغْنَمُها المُقَاتِلُون في الحرب.
- • سبب التسمية :: لذكرها في الآية الأولى، ولم يرد لفظ «الأنفال» في غيرها من سور القرآن الكريم.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة بدر»؛ لأن معظمها في ذكر هذه الغزوة، و«سورة الجهاد».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن النصر من عند الله، وهو ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ، مع وجوب الأخذ بالأسباب.
- • علمتني السورة :: الحذر من تحول القتال من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرخيصة.
- • علمتني السورة :: البدريون يحتاجون لدعوة الصلح، فهل نحن لا نحتاج؟! الصلح خير: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾
- • علمتني السورة :: أن الإيمان يزيد وينقص: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ: «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَنْفَالِ».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأنفال من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.
• عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ»، فَقَالَ: «فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِى النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلاَقُنَا؛ فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، والأصح أنها ثانية السور نزولًا بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالجملة الخبرية من أصل 21 سورة افتتحت بذلك.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- من سور "المثاني" البالغة 30 سورة.
• نزلت بعد غزوة بدر (رمضان 2 هـ) لتعقب على أحداثها.
• اهتمت ببيان أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله، وقواعد القتال، والإعداد له، وإيثار السِّلم على الحرب إذا جنح له العدو، وآثار الحرب في الأشخاص (الأسرى) والأموال (الغنائم).
سادسًا : العمل بالسورة :
- • ألا تكون الغنائم هي الأساس للخروج في الجهاد، بل الأساس هو الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإن لم تكن هناك غنائم، فإن أتت الغنائم فهي نافلة وزيادة وعطية من الله.
• أن نسعى في الصلح بين شخصينِ من المسلمين اختلفَا: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (1).
• أن نحاسب أنفسنا على صلاتنا، وننظر في أي جانب قصرنا فيه، سواءً كان في أركانها أو واجباتها أو مستحباتها، ثم نسد هذا النقص والخلل: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (3).
• أن نلح على الله في الدعاء؛ فإنه يحب الاستغاثة به والتضرع إليه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ (9).
• أن نبحث عن الأخبار السارة عن الدعوة والإغاثة وننشرها؛ ففيها بشارة للمؤمنين وتطمين لقلوبهم: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّـهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ (10).
• أن نتيقن بأن النصر من عند الله؛ فنسأله وحده دون غيره: ﴿وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱلله﴾ (10).
• أن ننسب الفضل لله دومًا: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (17).
• أن نطيع الله ورسوله، ونحذر من أعمال المنافقين والكفار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ...﴾ (20-23).
• أن نحذر من الإعراض عن الأوامر والنواهي؛ فقد يؤدي ذلك إلى شرور كثيرة أولها الختم على القلب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (24).
• أن نحذر من الخيانة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (27).
• إذا رزقنا الله المال والولد فلا تطغى محبتهما على محبته سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّـهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (28).
• ألا ندع على أنفسنا ولا على من نحب بالهلاك، فهذا من الجهل: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّـهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (32).
• أن نكثر من الاستغفار؛ فهو أمان من عذاب الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (33).
• أن نتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية تقربًا إلى الله تعالى ومخالفة لصنيع المشركين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ (36).
• أن نبادر اليوم بتوبة صادقة؛ فقد وعد الكفار وهم أشد منا ذنبًا بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (38).
• أن نتجنب التشبُّه بالكافرين في أفعالهم وأقوالهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (47)، فلا نغتر أو نتفاخر بالنصر، لا يقل أحدنا: أنا قَتلت، أو أنا فعلت كذا وكذا، أو أنا أَسَرت، فهذا الفخر والعُجب لا يليق بنا.
• أن نبحث عن معصية في أنفسنا -قد نكون غافلين عنها- ونتب إلى الله منها، لعل الله أن يغير حالنا إلى الأفضل: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (53).
• ألا نخلف وعدًا أو ننقض عهدًا، ولو كان ذلك مع الكفار؛ فليس ذاك من صفات المؤمنين: ﴿الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ (56).
• إذا كان بيننا وبين قوم عهد وخفنا خيانتهم؛ فنخبرهم بنقض العهد الذي بيننا وبينهم، ولا نغدر بهم: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (58).
• أن نستعد دومًا للقاء العدو: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (60).
• أن نعمل أعمالًا نصل بها أرحامنا مثل: تعليمهم أو إطعامهم أو قضاء حاجتِهم؛ فهمْ أولى بنا من غيرِهم: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ (75).
تمرين حفظ الصفحة : 177
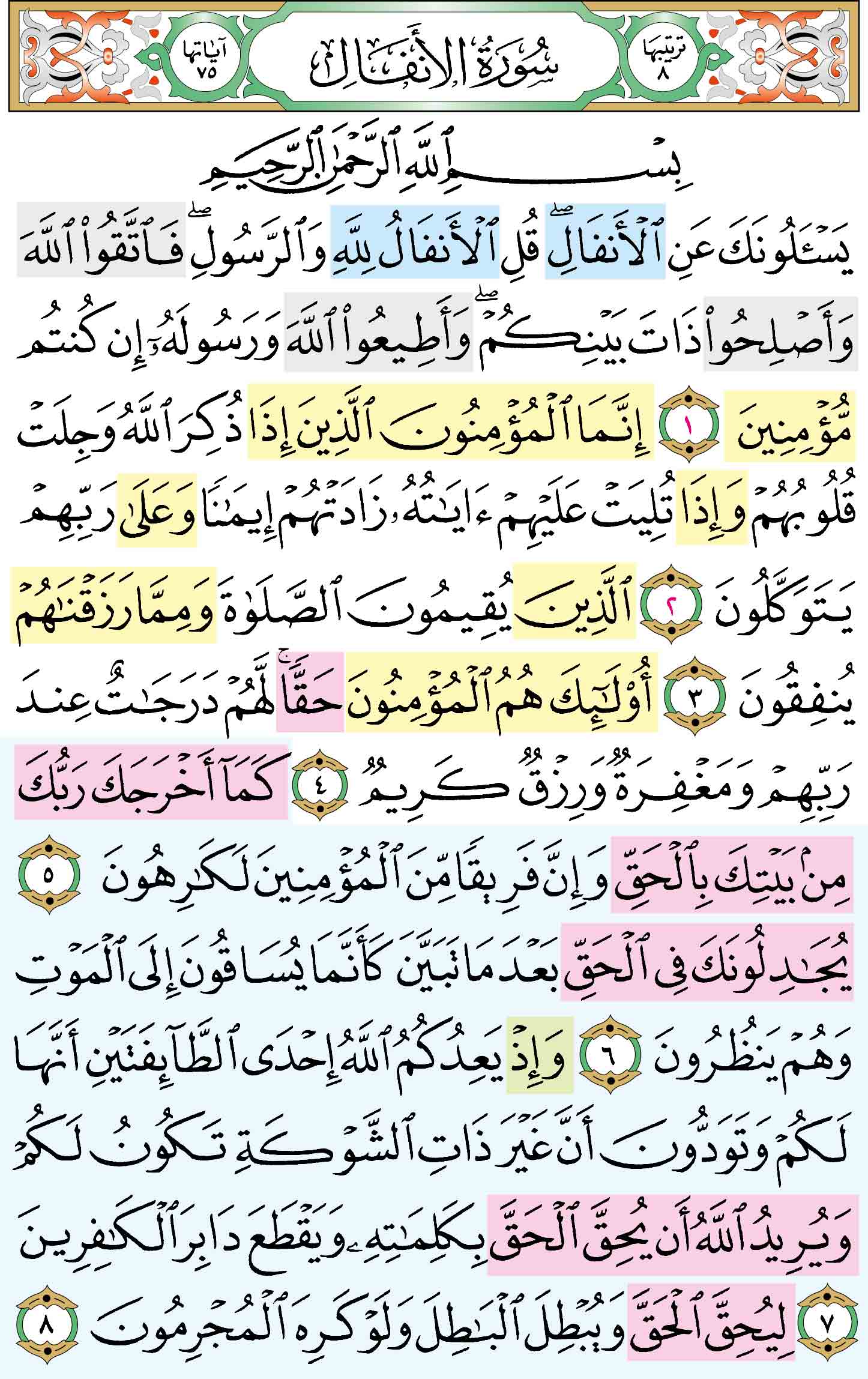
مدارسة الآية : [1] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ .. ﴾
التفسير :
الأنفال هي الغنائم التي ينفلها اللّه لهذه الأمة من أموال الكفار، وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نـزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، .فحصل بين بعض المسلمين فيها نـزاع، فسألوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عنها، فأنـزل اللّه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَال كيف تقسم وعلى من تقسم؟ قُلْ لهم:الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءا، فلا اعتراض لكم على حكم اللّه ورسوله،. بل عليكم إذا حكم اللّه ورسوله أن ترضوا بحكمهما، وتسلموا الأمر لهما،. وذلك داخل في قوله فَاتَّقُوا اللَّهَ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ أي:أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بالتوادد والتحاب والتواصل..فبذلك تجتمع كلمتكم، ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع -من التخاصم، والتشاجر والتنازع. ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم، والعفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر،.والأمر الجامع لذلك كله قوله:وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان يدعو إلى طاعة اللّه ورسوله،.كما أن من لم يطع اللّه ورسوله فليس بمؤمن.
سورة الأنفال
تمهيد بين يدي تفسير السورة
1- سورة الأنفال هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف، فقد تقدمتها سورة الفاتحة وهي مكية، ثم جاءت بعد سورة الفاتحة أربع سور مدنية، هن أطول السور المدنية في القرآن الكريم، وهن سور: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. ثم جاءت بعد هذه السور الأربع سورتان مكيتان، وهما أطول السور المكية في القرآن، سورتا: الأنعام والأعراف.
ثم جاءت سورة الأنفال بعد ذلك، فكانت الثامنة في ترتيب سور المصحف.
2- وعدد آياتها خمس وسبعون آية في المصحف الكوفي، وست وسبعون في الحجازي، وسبع وسبعون في الشامي.
3- وقد سميت سورة الأنفال بهذا الإسم، لحديثها عن الأنفال أى الغنائم في أكثر من موضع.
وقد أطلق عليها بعض الصحابة سورة بدر، فقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عنها فقال: تلك سورة بدر .
4- وسورة الأنفال كلها مدنية، وممن قال بذلك: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح والحسن، وعكرمة.
قال صاحب المنار: وقيل إنها مدنية إلا آية «64» وهي قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب، فعلى هذا وضعت في سورة الأنفال وقرئت مع آياتها التي نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام، وروى عن مقاتل استثناء قوله- تعالى- وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ... «الآية «30» لأن موضوعها ائتمار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، بل في الليلة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر بقصد الهجرة وباتا في الغار، وهذا استنباط من المعنى، وهو استنباط يرده ما صح عن ابن عباس من أن الآية نفسها نزلت في المدينة.
وزاد بعضهم استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآية، وهي قوله- تعالى-: وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا.. إلى قوله: بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ «الآيات من 31- 35» لأن موضوعها حال كفار قريش في مكة، وهذا لا يقتضى نزولها في مكة، بل ذكّر الله بها رسوله بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني».
والذي ترتاح إليه النفس أن سورة الأنفال جميعها مدنية، وأن ما في بعض آياتها من أوصاف لأحوال المشركين في مكة قبل الهجرة لا يعنى كون هذه الآيات مكية لأن هذه الآيات إنما هي من باب تذكير الرسول وأصحابه بما كان عليه أولئك القوم من عناد ومكابرة وانحراف عن الطريق القويم، أدى بهم إلى الهزيمة في بدر وفي غيرها من المعارك التي كان النصر فيها للمؤمنين.
5- وقد ذكر بعض المفسرين- ومنهم الزمخشري- أن سورة الأنفال نزلت بعد سورة البقرة، ولعل مرادهم بذلك أن نزولها كان بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة، لأنه من المعروف أن سورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة، وإنما ابتدأ نزولها بعد الهجرة، ثم امتد هذا النزول لآياتها إلى قبيل وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- بمدة قصيرة.
6- قال الآلوسى: ووجه مناسبتها لسورة الأعراف أن سورة الأعراف فيها خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ... وفي هذه- أى الأنفال- كثير من أفراد المأمور به، وفي الأعراف ذكر قصص الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- مع أقوامهم، وفي هذه ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جرى بينه وبين قومه.
وقد فصل- سبحانه- في تلك- قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ...
وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله- تعالى-: وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَها ... وصرح بذلك هنا إذ يقول.. وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا ... إلى غير ذلك من المناسبات.
ثم قال الآلوسى: «والظاهر أن وضعها هنا توقيفي، وكذا وضع براءة بعدها، وإلى ذلك ذهب غير واحد ... ».
والحق أنه بمطالعتنا لما يقوله الآلوسى وغيره من المفسرين في بيان وجه مناسبة السورة للتي قبلها، نرى أن هذه الأقوال لا تخلو من تكلف، وأن كثيرا مما ذكروه من مناسبات بين سورتين معينتين لا يختص بهما، بل هو موجود فيهما وفي غيرهما.
فالآلوسى- مثلا- يجعل من وجوه مناسبة الأنفال للأعراف أن الأعراف فيها وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. وأن الأنفال فيها كثير من أفراد المأمور به..
وهذا المعنى نراه في كثير من السور المتتالية، فسورة آل عمران- مثلا- من بين آياتها قوله- تعالى-: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...
وسورة النساء- التي بعدها- فيها- أيضا- كثير من أفراد المأمور به لأن الأمر بالمعروف من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامى.
والذي تميل إليه النفس أن ترتيب السور توقيفي، وأن كل سورة لها موضوعاتها التي نراها بارزة بصورة تميزها عن غيرها.
7- وسورة الأنفال عند ما نتأمل ما اشتملت عليه من آيات، نراها تحدثنا- في مجموعها- عن غزوة بدر، فتعرض أحداثها الظاهرة، كما تعرض بشارات النصر فيها، وتكشف عن قدرة الله وتدبيره في وقائع هذه الغزوة الحاسمة، وتبين كثيرا من الإرشادات والتشريعات الحربية التي يجب على المؤمنين اتباعها حتى ينالوا النجاح والفلاح.
أخرج البخاري عن ابن عباس أن سورة الأنفال نزلت في بدر:
(أ) لقد افتتحت السورة الكريمة ببيان أن قسمة الأنفال أى- الغنائم- مردها إلى الله ورسوله، وأن على المؤمنين أن يذعنوا لما يفعله فيها رسولهم صلى الله عليه وسلم ثم وصفت المؤمنين الصادقين أكمل وصف، وبشرتهم بأسمى المنازل، وأرفع الدرجات.
قال- تعالى-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
(ب) وبعد هذا الحديث الطيب عن أوصاف المؤمنين الصادقين، تبدأ السورة في الحديث عن حال بعض الذين اشتركوا في غزوة بدر، وكيف أنهم كرهوا القتال في أول الأمر، لأنهم لم يخرجوا من أجله وإنما خرجوا من أجل الحصول على التجارة التي قدم بها مشركو قريش من بلاد الشام لكن الله- تعالى- أراد أن يعلمهم وغيرهم أن الخير فيما قدره، لا فيما يقدرون ويريدون.
استمع إلى السورة الكريمة بتأمل وتدبر وهي تصور هذه المعاني بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول.
كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ. يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
(ج) ثم تسوق السورة بعد ذلك ألوانا من البشارات التي تشعر المؤمنين بأن الله- تعالى- قد أجاب لهم دعاءهم، وأنه- سبحانه- سيجعل النصر في هذه المعركة حليفا لهم.
ومن مظاهر هذه البشارات أن الله- تعالى- أمدهم بألف من الملائكة مردفين، وأمدهم بالنعاس ليكون مصدر طمأنينة لقلوبهم، وأمدهم بمياه الأمطار ليتطهروا بها، ولتثبت الأرض من تحتهم، وأمدهم قبل ذلك وبعده بعونه الذي جعلهم يقبلون على قتال أعدائهم بقلوب ملؤها الإقدام والشجاعة.
قال- تعالى-: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ.
(د) ثم وجهت السورة الكريمة خمسة نداءات إلى المؤمنين، أرشدتهم في كل واحد منها إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم.
فقد أمرتهم في النداء الأول بالثبات في وجوه أعدائهم، ونهتهم عن الفرار منهم، وهددت من يوليهم دبره بسوء المصير، وأخبرتهم بأن الله معهم ما داموا معتمدين عليه، ومستجيبين لما يدعوهم إليه.
وأمرتهم في النداء الثاني بطاعة الله ورسوله، وحذرتهم من المعصية، ومن التشبه بالكافرين الذين «قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» .
وأمرتهم في النداء الثالث بالمسارعة إلى أداء ما كلفوا به من تكاليف فيها سعادتهم وفلاحهم، وخوفتهم من ارتكاب ذنوب لا يحيق شرها بالذين ارتكبوها وحدهم، وإنما يعمهم وغيرهم ممن رأوا المنكر فلم يعملوا على تغييره.
ونهتهم في النداء الرابع عن خيانة الله ورسوله، أى: عن ترك فرائض الله، وعن هجر سنة رسوله.. وحذرتهم من أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله وعن أداء واجباته.
ثم بشرتهم في النداء الخامس بأنهم إذا ما اتقوا الله حق تقاته، فإنه- سبحانه- سيرزقهم الهداية والنصر والنجاة من كل مكروه.
تدبر معى- أخى القارئ- هذه النداءات، وما اشتملت عليه من توجيهات سامية وإرشادات عالية، حيث يقول- سبحانه-:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ..
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ..
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ..
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ..
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ..
(هـ) ثم أخذت السورة بعد ذلك في تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ليزدادوا له شكرا، وفي تصوير ما عليه الكافرون من جهل وعناد وخسران.
فحكت ما قالوه في شأن القرآن من كذب ومكابرة.
وحكت استهزاءهم بالدين، وإمعانهم في الجحود، وتعجلهم للعذاب..
وحكت ما كانوا يقومون به من تصفيق ولغو عند قراءة القرآن، حتى يشغلوا الناس عن سماعه..
وحكت مسارعتهم إلى إنفاق أموالهم، لا في وجوه الخير، ولكن في وجوه الشر التي ستكون عاقبتها الخسران وسوء المصير.
وبعد أن حكت كل هذه الرذائل عن الكافرين، أمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم أنهم إذا ما انتهوا عن كفرهم وعنادهم، فإن الله- تعالى- سيغفر لهم ما سلف من ذنوبهم.
أما إذا استمروا في طغيانهم وجحودهم، فستدور الدائرة عليهم.
قال- تعالى-: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ. وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا، لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا، إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ. وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
(و) وبعد أن افتتحت السورة الكريمة بالحديث المجمل عن الغنائم وساقت في أعقابه ما ساقت من توجيه وإرشاد وترغيب وترهيب.
بعد كل ذلك عادت السورة إلى الحديث عن الغنائم، ففصلت ما أجملته في مطلعها، وذكّرت المؤمنين بنعم أخرى منحهم الله إياها في بدر.
ومن ذلك: أنّه- سبحانه- هيأ لهم المكان المناسب لقتال أعدائهم، وجعل اللقاء الحاسم بين الفريقين بدون موعد سابق.. وقلل كل فريق في عين الآخر ليقضى- سبحانه- قضاءه النافذ..
قال- تعالى-: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(ز) ثم يأتى بعد ذلك النداء السادس والأخير للمؤمنين، فيأمرهم- سبحانه- فيه بالثبات عند لقائهم لأعدائهم، وبالإكثار من ذكره، وبالطاعة التامة له ولرسوله، وبالابتعاد عن التنازع والاختلاف.
ثم ينهاهم عن التشبه بالمرائين، والمتكبرين، والمغرورين، الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم- ولكنه عند ما تراءى الجمعان نكص على عقبيه- والذين سيكون مصيرهم الهزيمة في الدنيا، والعذاب المهين في الآخرة بسبب كفرهم بآيات الله، وإيثارهم الضلالة على الهداية.
قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ.
(ح) ثم تمضى السورة الكريمة في تصوير رذائل الكافرين، وفي تشجيع المؤمنين على قتالهم، وإعداد العدة لدحرهم وتشريدهم ما داموا مستمرين على كفرهم وخيانتهم..، فإن جنحوا للسلم. ومالوا إلى المصالحة والمهادنة فاقبل منهم ذلك- أيها الرسول الكريم،واحترس من خداعهم وغدرهم، وحرض أتباعك على قتالهم بصبر وجلد.
قال- تعالى-: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ. وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
(ط) ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن أسرى غزوة بدر من المشركين فبينت ما كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في شأنهم، وعاتبتهم لإيثارهم أخذ الفداء على ما عند الله من ثواب عظيم، وأباحت لهم أن يأكلوا مما غنموه، فإنه حلال طيب، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الأسرى إلى الدين الحق، وأن يخبرهم بأنهم متى آمنوا ظفروا بخير الدنيا والآخرة..
تأمل معى- أخى القارئ- هذه الآيات الكريمة التي ساقتها السورة في هذا المعنى.
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
(ى) وإذا كانت السورة قد تحدثت في أوائلها عن صفات المؤمنين.. الصادقين، وعن حال الذين كرهوا الخروج إلى القتال في بدر.. فإنها قد تحدثت في ختامها- أيضا- عن أصناف المؤمنين.. فمدحت المهاجرين السابقين، ومدحت الأنصار الذين آووا ونصروا، لأنهم قد اشتركوا جميعا في بذل أموالهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الله.. ثم بينت ما يجب عليهم نحو غيرهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا، بل ظلوا في أرض الشرك. ثم مدحت المؤمنين الذين تأخرت هجرتهم عن صلح الحديبية- وإن كانوا أقل في الدرجات من المهاجرين السابقين.
قال- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ، وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
8- هذا عرض مجمل لما اشتملت عليه سورة الأنفال من توجيهات سامية، وآداب عالية، وتشريعات حكيمة ...
ومن هذا العرض نرى أن السورة الكريمة قد اهتمت بأمور من أبرزها ما يلي:
(ا) تربية المؤمنين على العقيدة السليمة، وعلى الطاعة لله ولرسوله. وإصلاح ذات بينهم، والثبات في وجه أعدائهم، والإكثار من التقرب إلى خالقهم، والمداومة على مراقبته وخشيته وشكره، فهو الذي هداهم للإيمان، وهو الذي آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات.. بعد أن كانوا ضالين ومستضعفين في الأرض.
ولقد أفاضت السورة في غرس هذه المعاني في نفوس المؤمنين لأنها نزلت كما سبق أن بينا- في أعقاب اللقاء الأول بينهم وبين أعدائهم- فكان من المناسب أن تكرر غرس هذه المعاني في القلوب حتى تستمر على طاعة الله ورسوله، تلك الطاعة التي من ثمارها الظفر الدائم والخير الباقي..
(ب) تذكير المؤمنين بما عليه أعداؤهم من جحود وعناد، وبما كان منهم من مكر برسولهم صلى الله عليه وسلم ومن استهزائهم بدينهم وقرآنهم ومن عداوة شديدة للحق وأهله، ومن صفات ذميمة جعلتهم أهلا لاستحواذ الشيطان عليهم ...
وهذا التذكير قد تكرر كثيرا في سورتنا هذه، لكي يستمر المؤمنون على حسن استعدادهم، ولكي لا تنسيهم نشوة النصر في بدر ما يضمره لهم أعداؤهم من كراهية وبغضاء، وما يبيتونه لهم من سوء وشر.
(ج) إرشاد المؤمنين إلى المنهاج الذي يجب أن يسيروا عليه في حالتي حربهم وسلمهم، لأنه متى ساروا عليه حالفهم النصر، وصاحبهم التوفيق.
ففي حالة الحرب: أمرتهم السورة الكريمة بأن يعدوا لأعدائهم كل ما يستطيعون من قوة.
وأن يبذلوا أموالهم بسخاء من أجل نصرة الحق.. وأن يقاتلوا خصومهم بشجاعة وإقدام، وأن يكثروا من التقرب إلى الله بصالح الأقوال والأعمال- خصوصا في مواطن القتال-.. وأن يجعلوا غايتهم في قتالهم إحقاق الحق وإبطال الباطل حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ....
وأن يؤثروا السلم على الحرب متى وجد السبيل إليه، فإن السلم هو الأصل أما الحرب فهي أمر لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التي تقتضيها.. أما في حالة سلمهم: فقد أمرتهم السورة الكريمة بالتآخى والتناصر والتواد والتراحم والتصالح.. ونبذ التنازع والتخاصم والاختلاف والبطر.
كما أمرتهم بتقوى الله وبإيثار ما عنده من ثواب وأجر على الأموال والأولاد.
قال- تعالى-: وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
وهناك موضوعات أخرى تعرضت لها السورة:
كحديثها عن الغنائم، وعن الأسرى، وعن المعاهدات، وعن أحداث غزوة بدر، وعن المشاعر التي تحركت في نفوس بعض المشتركين فيها قبل أن تبدأ المعركة وخلالها وبعدها.
وقد ساقت السورة الكريمة كل ذلك بأسلوب يهدى القلوب، ويشرح الصدور، ويرشد الناس إلى مواطن عزهم وسعادتهم.
هذا، ونرى من المناسب- أخى القارئ- أن نختم هذا العرض المجمل لسورة بدر- كما سماها ابن عباس- بتلخيص لقصة هذه الغزوة لنتنسم الجو الذي نزلت فيه هذه السورة، ولندرك مرامي النصوص فيها.. لأننا نعتقد أن ما يعين على فهم الآيات القرآنية فهما قويما مستنيرا، أن يكون القارئ أو المفسر لها ملما بأسباب نزولها وبالجو التاريخى الذي نزلت فيه، وبالأحداث التي لا بست نزولها.. يجانب إلمامه بمدلولاتها اللغوية والبيانية..
قال الإمام ابن هشام عند حديثه عن «غزوة بدر الكبرى».
قال ابن إسحاق: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة.. ندب المسلمين إليها وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها» فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا.
وكان أبو سفيان- حين دنا من الحجاز- يتجسس الأخبار، ويسأل من لقى من الركبان: تخوفا على أمر الناس- أى: على أموالهم التي معه في القافلة حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة.
فلما وصلها أخذ يصرخ ببطن الوادي.. ويقول يا معشر قريش: اللطيمة اللطيمة- أى:
العير التي تحمل الطيب والمسك والثياب..- أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث.
فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد.
- خرجوا بالقيان والدفوف يغنين في كل منهل، وينحرون الجزر، وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا، وقادوا مائة فرس، عليها مائة درع سوى درع المشاة، وكانت إبلهم سبعمائة بعير.
قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، واستعمل على المدينة أبا لبابة.. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير.
وكان إبل المسلمين يومئذ سبعين بعيرا، فاعتقبوها- أى كانوا يركبونها بالتعاقب- وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ.
وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة.. ثم نزل قريبا من بدر.. وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر فقال وأحسن.
ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك لأنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلى ديارنا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا.
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله.
ففرح- رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد..
ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله- تعالى- قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم.
قال ابن إسحاق: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فسارا حتى وقفا على شيخ من العرب. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك.
قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم، قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرنى، فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به المسلمون.
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرنى صدقنى، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش.
فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه.
ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فلما أمسى أرسل بعضهم إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له.. فأصابوا ساقيين لقريش فأتوا بهما.. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرانى عن قريش.
قالا: هم والله وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى.
فقال لهما: كم القوم؟ قالا كثير قال: ما عددهم؟ قالا لا ندري قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال: القوم فيما بين التسعمائة والألف ثم قال لهما.
فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأمية بن خلف.. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها..
قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، فنقيم عليه ثلاثة، ننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها.
وقال الأخنس بن شريق لبنى زهرة، يا بنى زهرة قد نجى الله لكم أموالكم فارجعوا فرجعوا فلم يشهد غزوة بدر زهري واحد.
ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي: وبعث الله السماء بالماء فأصاب المسلمون منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء، حتى إذا جاء ماء نزل به..
فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله؟ أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأى والمكيدة والحرب؟.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأى والمكيدة والحرب.
فقال الحباب يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فنزله، ثم نغور ما وراءه من القلب- أى: ثم نغطى ما خلفه من الآبار- ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد أشرت بالرأى» ثم نهض ومعه الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء ماء. ثم قال سعد بن معاذ يا رسول الله، ألا نبنى لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا. كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا. فقد تخلف عنك أقوام- يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك.
فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم بنى لرسول الله عريش فكان فيه.
ثم ارتحلت قريش حين أصبحت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمة من الكثيب إلى الوادي قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني. اللهم أحثهم الغداة» .
ثم أرسلت قريش عمير بن وهب الجمحي فقالوا له: احزر لنا أصحاب محمد، فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: هم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا..
ولقد رأيت- يا معشر قريش- البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع.
قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم.
فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن تفعل شيئا تذكر به بخير إلى آخر الدهر؟ فقال عتبة: وما ذاك يا حكيم؟
قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي ...
قال عتبة: قد فعلت.. ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال:
يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله.. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون..
وبلغ كلام عتبة أبا جهل فسبه.. ثم بعث أبو جهل إلى ابن الحضرمي فقال له: هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثارك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك- أى: فقم فاطلب من الناس الوفاء بالعهد والأخذ بثأر أخيك..
فقام ابن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: وا عمراه، وا عمراه، فحميت الحرب، واشتد أمر الناس، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد أبو جهل الرأى الذي دعا عتبة الناس إليه..
قال ابن إسحاق: ثم خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي- وكان شرسا سيئ الخلق- فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه فلما دنا منه خرج إليه حمزة بن عبد المطلب. فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه- أى.
أطارها- وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه. ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، فضربه حمزة حتى قتله في الحوض..
ثم خرج عتبة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة.. فنادى يا محمد: أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة وقم يا حمزة وقم يا على.. أما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه- أى: جرحه جرحا شديدا لا يملك معه الحركة- وكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه، واحتملا عبيدة فحازاه إلى أصحابه.
قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله الناس أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل» ...
ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ورجع إلى العريش فدخله- ومعه أبو بكر الصديق.. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويقول فيما يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، وأبو بكر يقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك» .
ثم خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرس.. يقوده على ثناياه النقع» - أى الغبار.
وكان قد رمى مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل.. من المسلمين.
ثم رمى حارثة بن سراقة وهو يشرب من الحوض بسهم فقتل.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: «والذي نفس محمد بيده.
لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة» ...
ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها، ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الهزيمة فقتل الله- تعالى- من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم..
فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يخافون عليه كرة العدو، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم!» .
فقال سعد: أجل والله يا رسول الله؟ كانت هذه أول موقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال..
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يومئذ: «إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، ولا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا يقتله ومن لقى أبا البحتري فلا يقتله..
قال ابن إسحاق: - وبعد انتهاء المعركة- أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى من المشركين أن يطرحوا في القليب فلما طرحوا وقف عليهم فقال: «بئس العشيرة كنتم لنبيكم- يا أهل القليب- لقد كذبتموني وصدقنى الناس، وأخرجتموني وآوانى الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس» ..
ثم قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما وعدني ربي حقا» فقال المسلمون: يا رسول الله! أتنادي قوما قد جيّفوا؟
فقال صلى الله عليه وسلم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني» .
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، فاختلف فيه المسلمون، فقال من جمعه: هو لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو..: والله لولا نحن ما أصبتموه..
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشر أهل المدينة بنصر الله لهم على المشركين.
ثم فرق الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرى من المشركين بين أصحابه وقال لهم:
«استوصوا بالأسارى خيرا» .
قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي فقالوا له: ما وراءك؟ فقال، قتل عتبة، وشيبة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف..
فلما جعل يعدد أشراف قريش الذين قتلوا، قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عنى!! فقالوا له: ما فعل صفوان بن أمية؟ فقال: ها هو ذاك في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا..
ولما قدم أبو سفيان بن الحارث قال له أبو لهب: هلم إلى، فعندك لعمري الخبر!! فجلس إليه الناس قيام عليه فقال له أبو لهب: يا ابن أخى أخبرنى كيف كان أمر الناس؟
فقال أبو سفيان: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا..
أما بعد: فهذا ملخص لغزوة بدر سقناه قبل البدء في التفسير التحليلى لسورة الأنفال، وقصدنا من ذكر هذا الملخص لهذه الغزوة الحاسمة: أن نتنسم الجو الذي نزلت فيه السورة- كما سبق أن أشرنا وأن نستعين به على فهم الآيات فهما واضحا مستنيرا..
لأن سورة الأنفال هي سورة بدر كما سماها ابن عباس- رضى الله عنه- وفي ختام هذا التعريف بسورة الأنفال، نسأل الله- تعالى- أن يوفقنا لتفسير آياتها تفسيرا واضحا مقبولا، بعيدا عن الانحراف. محررا من لغو القول وباطله..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
لعل من الخير قبل أن نتكلم فى تفسير هذه الآيات الكريمة أن نذكر بعض الروايات التى وردت فى سبب نزولها . فإن معرفة سبب النزول يعين على الفهم السليم .
قال الإِمام ابن كثير - ما ملخصه - روى الإِمام أحمد بن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدت معه بدرا فالتقى الناس . فهزم الله - تعالى - العدو ، فانطلقت طائفة فى آثام يهزمون ويقتلون . وأقبلت طائفة على العسكر يجوزونه ويجمعونه . وأحدثت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكى لا يصيب العدو منه غرة . حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض ، قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها ، فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم بأحق بها منا ، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لستم أحق بها منا . نحن أحدقنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم مخافة أن صيب منه غرة فاشتغلنا به - فنزلت : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول ) . . فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين .
وروى أبو داود والنسائى وابن جرير وابن مردويه - واللفظ له - عن ابن عباس قال : " لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فتسارع فى ذلك شبان القوم ، وبقى الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذى جعل لهم . فقال الشيوخ : لا تسأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم ، لو انكشفتم لبثتم إينا . فتنازعوا ، فأنزل الله - تعالى - : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول ) " .
وقال الثورى ، عن الكلبى ، عن أبى صالح عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا " ، فجاء أبو اليسر بأسيرين ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليك - أنت وعدتنا . فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شئ ، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجر ولا جبن عن العدو ، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . فتشاجروا ، ونزل القرآن : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرس
وهي مدنية ، آياتها سبعون وست آيات ، كلماتها ألف كلمة ، وستمائة كلمة ، وإحدى وثلاثون كلمة ، حروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا ، والله أعلم .
قال البخاري : قال ابن عباس الأنفال : الغنائم : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال ؟ قال : نزلت في بدر .
أما ما علقه عن ابن عباس ، فكذلك رواه علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أنه قال : " الأنفال " : الغنائم ، كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة ، ليس لأحد منها شيء . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والضحاك ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، ومقاتل بن حيان ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغير واحد : إنها الغنائم .
وقال الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس أنه قال : الأنفال : الغنائم ، قال فيها لبيد :
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل
وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال ، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الفرس من النفل ، والسلب من النفل . ثم عاد لمسألته ، فقال ابن عباس ذلك أيضا . ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ، مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد قال : قال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا سئل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا زاجرا آمرا محلا محرما . قال القاسم : فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال ، فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه الرجل ، فقال له مثل ذلك ، ثم أعاد عليه حتى أغضبه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ، حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على : رجليه فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك .
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه ، بعد قسم أصل المغنم ، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل ، والله أعلم .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمس بعد الأربعة الأخماس ، فنزلت : ( يسألونك عن الأنفال )
وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف ، إنما النفل قبل التقاء الصفوف . رواه ابن أبي حاتم عنهما .
وقال ابن المبارك وغير واحد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح : ( يسألونك عن الأنفال ) قال : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال ، من دابة أو عبد أو أمة أو متاع ، فهو نفل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع به ما يشاء . .
وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء ، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال .
وقال ابن جرير : وقال آخرون : هي أنفال السرايا ، حدثني الحارث ، حدثنا عبد العزيز ، حدثنا علي بن صالح بن حي قال : بلغني في قوله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ) قال : السرايا .
ويعني هذا : ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش ، وقد صرح بذلك الشعبي ، واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسم ، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية ، وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن عبد الله الثقفي ، عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر ، وقتل أخي عمير ، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه ، وكان يسمى " ذا الكتيفة " ، فأتيت به نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اذهب فاطرحه في القبض . قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي . قال : فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب فخذ سيفك .
وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أسود بن عامر ، أخبرنا أبو بكر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن مالك قال : قال : يا رسول الله ، قد شفاني الله اليوم من المشركين ، فهب لي هذا السيف . فقال : إن هذا السيف لا لك ولا لي ، ضعه قال : فوضعته ، ثم رجعت ، قلت : عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي ! قال : رجل يدعوني من ورائي ، قال : قلت : قد أنزل الله في شيئا ؟ قال : كنت سألتني السيف ، وليس هو لي وإنه قد وهب لي ، فهو لك قال : وأنزل الله هذه الآية : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول )
ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من طرق ، عن أبي [ بكر ] بن عياش ، به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة ، أخبرنا سماك بن حرب ، قال : سمعت مصعب بن سعد ، يحدث عن سعد قال : نزلت في أربع آيات : أصبت سيفا يوم بدر ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : نفلنيه . فقال : ضعه من حيث أخذته مرتين ، ثم عاودته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ضعه من حيث أخذته ، فنزلت هذه الآية : ( يسألونك عن الأنفال .
وتمام الحديث في نزول : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) [ العنكبوت : 8 ] وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر ) [ المائدة : 90 ] وآية الوصية . وقد رواه مسلم في صحيحه ، من حديث شعبة ، به .
وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر ، وكان السيف يدعى بالمرزبان ، فلما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل ، أقبلت به فألقيته في النفل ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع شيئا يسأله ، فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، فسأله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأعطاه إياه .
ورواه ابن جرير من وجه آخر .
[ سبب آخر في نزول الآية ] :
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي أمامة قال : سألت عبادة عن الأنفال ، فقال : فينا - أصحاب بدر - نزلت ، حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فانتزعه الله من أيدينا ، وجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين عن بواء - يقول : عن سواء .
وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا معاوية بن عمرو ، أخبرنا أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهدت معه بدرا ، فالتقى الناس ، فهزم الله [ تعالى ] العدو ، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه . وأحدقت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل ، وفاء الناس بعضهم إلى بعض ، قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها ، فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق به منا ، نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لستم بأحق منا ، نحن أحدقنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخفنا أن يصيب العدو منه غرة ، فاشتغلنا به ، فنزلت : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين ، وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع ، فإذا أقبل وكل الناس راجعا ، نفل الثلث ، وكان يكره الأنفال ويقول : ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم .
ورواه الترمذي وابن ماجه ، من حديث سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .
وروى أبو داود والنسائي ، وابن جرير ، وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان ، والحاكم من طرق ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فتسارع في ذلك شبان الرجال ، وبقي الشيوخ تحت الرايات ، فلما كانت المغانم ، جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا ردءا لكم ، لو انكشفتم لفئتم إلينا . فتنازعوا فأنزل الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ) إلى قوله : ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )
وقال الثوري ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا . فجاء أبو اليسر بأسيرين ، فقال : يا رسول الله ، وعدتنا ، فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ، إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء ، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ، ولا جبن عن العدو ، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك ، نخاف أن يأتوك من ورائك ، فتشاجروا ، ونزل القرآن : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) قال : ونزل القرآن : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [ وللرسول ] ) إلى آخر الآية [ الأنفال : 41 ] .
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - في كتاب " الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها " : أما الأنفال : فهي المغانم ، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب ، فكانت الأنفال الأولى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد ، ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس ، فنسخت الأولى .
قلت : هكذا روى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، سواء . وبه قال مجاهد ، وعكرمة والسدي .
وقال ابن زيد : ليست منسوخة ، بل هي محكمة .
قال أبو عبيد : وفي ذلك آثار ، والأنفال أصلها : جمع الغنائم ، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب ، وجرت به السنة . ومعنى الأنفال في كلام العرب : كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه ، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم ، فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل .
قلت : شاهد هذا في الصحيحين عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر الحديث ، إلى أن قال : وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وذكر تمام الحديث .
ثم قال أبو عبيد : ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم ، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو . وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع ، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى :
فإحداهن : في النفل لا خمس فيه ، وذلك السلب .
والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس ، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب ، فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس .
والثالثة : في النفل من الخمس نفسه ، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ، ثم تخمس ، فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى .
والرابعة : في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء ، وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها ، وفي كل ذلك اختلاف .
قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال : ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب .
قال أبو عبيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم ، وذلك من خمس النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن له خمس الخمس من كل غنيمة ، فينبغي للإمام أن يجتهد ، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم ، وقل من بإزائه من المسلمين ، نفل منه اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا لم يكن ذلك لم ينفل .
والوجه الثالث من النفل : إذا بعث الإمام سرية أو جيشا ، فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فله بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط الإمام ؛ لأنهم على ذلك غزوا ، وبه رضوا . انتهى كلامه .
وفيما تقدم من كلامه وهو قوله : " إن غنائم بدر لم تخمس " ، نظر . ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر ، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا ولله الحمد [ والمنة ] .
وقوله تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) أي : اتقوا الله في أموركم ، وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا ؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه ، ( وأطيعوا الله ورسوله ) أي : في قسمه بينكم على ما أراده الله ، فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف .
وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [ الله ] ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد .
وقال السدي : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) أي : لا تستبوا . ونذكر هاهنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - رحمه الله - في مسنده ، فإنه قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس ، عن أنس - رضي الله عنه - قال : بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه ، فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ فقال : رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة ، تبارك وتعالى ، فقال أحدهما : يا رب ، خذ لي مظلمتي من أخي . قال الله تعالى : أعط أخاك مظلمتك . قال : يا رب ، لم يبق من حسناتي شيء . قال : رب ، فليحمل عني من أوزاري ، قال : وفاضت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبكاء ، ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم ، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم ، فقال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر في الجنان ، فرفع رأسه فقال : يا رب ، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ ، لأي نبي هذا ؟ لأي صديق هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال : يا رب ، ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه . قال : ماذا يا رب ؟ قال : تعفو عن أخيك . قال : يا رب ، فإني قد عفوت عنه . قال الله تعالى : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة .
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الأنفال { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال } اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال التي ذكرها الله في هذا الموضع , فقال بعضهم : هي الغنائم , وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي , فقل هي لله ولرسوله . ذكر من قال ذلك . 12136 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا وكيع , قال : ثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن زيد , عن عكرمة : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . 12137 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال : الأنفال : المغنم . 12138 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد الأحمر , عن جويبر , عن الضحاك : { يسألونك عن الأنفال } قال : الغنائم . * - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { الأنفال } قال : يعني الغنائم . 12139 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . * - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { يسألونك عن الأنفال } الأنفال : الغنائم . 12140 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . 12141 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : الأنفال : الغنائم . 12142 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا ابن المبارك , عن ابن جريج , عن عطاء : { يسألونك عن الأنفال } قال : الغنائم . وقال آخرون : هي أنفال السرايا . ذكر من قال ذلك . 12143 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا علي بن صالح بن حي , قال : بلغني في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : السرايا . وقال آخرون : الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة وما أشبه ذلك . ذكر من قال ذلك . 12144 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا جابر بن نوح , عن عبد الملك , عن عطاء , في قوله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : هو ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال دابة أو عبد أو متاع , ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا ابن نمير , عن عبد الملك , عن عطاء : { يسألونك عن الأنفال } قال : هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع أو نفل , فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء . 12145 - قال : ثنا عبد الأعلى , عن معمر , عن الزهري , أن ابن عباس سئل عن الأنفال , فقال : السلب والفرس . 12146 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , ويقال : الأنفال : ما أخذ مما سقط من المتاع بعدما تقسم الغنائم , فهي نفل لله ولرسوله . 12147 - حدثني القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , قال : قال ابن جريج : أخبرني عثمان بن أبي سليمان , عن محمد بن شهاب أن رجلا قال لابن عباس : ما الأنفال ؟ قال : الفرس والدرع والرمح . 12148 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد , قال : قال ابن جريج , قال عطاء : الأنفال : الفرس الشاذ , والدرع , والثوب . 12149 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن الزهري , عن ابن عباس , قال : كان ينفل الرجل فرس الرجل وسلبه . 12150 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني مالك بن أنس , عن ابن شهاب , عن القاسم بن محمد , قال : سمعت رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال , فقال ابن عباس : الفرس من النفل , والسلب من النفل . ثم عاد لمسألته , فقال ابن عباس ذلك أيضا , ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه , فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن القاسم بن محمد , قال : قال ابن عباس : كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نبيه عليه السلام إلا زاجرا آمرا محللا محرما . قال القاسم : فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال , فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه الرجل , فقال له مثل ذلك , ثم أعاد عليه حتى أغضبه , فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبيه , أو على رجليه , فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . * - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا ابن المبارك , عن عبد الملك , عن عطاء : { يسألونك عن الأنفال } قال : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد , فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : النفل : الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس . ذكر من قال ذلك . 12151 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { يسألونك عن الأنفال } قال : هو الخمس . قال المهاجرون : لم يرفع عنا هذا الخمس ؟ لم يخرج منا ؟ فقال الله : هو لله والرسول . 12152 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا عباد بن العوام , عن الحجاج , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس , فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } . قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال : هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم ; إما من سلبه على حقوقهم من القسمة , وإما مما وصل إليه بالنفل , أو ببعض أسبابه , ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين , أو صلاح أحد الفريقين . وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك , ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس ; لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهر , يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام , وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر . وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب , لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء , يقال منه : نفلتك كذا , وأنفلتك : إذا زدتك , والأنفال : جمع نفل ; ومنه قول لبيد بن ربيعة : إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل فإذ كان معناه ما ذكرنا , فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة , إن كان ذلك لبلاء أبلاه أو لغناء كان منه عن المسلمين , بتنفيل الوالي ذلك إياه , فيصير حكم ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل , فهو منفل ما زيد من ذلك ; لأن الزيادة وإن كانت مستوجبة في بعض الأحوال بحق , فليست من الغنيمة التي تقع فيها القسمة , وكذلك كل ما رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة فهو نفل , لأنه وإن كان مغلوبا عليه فليس مما وقعت عليه القسمة . فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا بين الغنيمة والنفل , أن الغنيمة هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر نفل منه منفل أو لم ينفل ; والنفل : هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة . وإذ كان ذلك معنى النفل , فتأويل الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر لمن هو قل لهم يا محمد : هو لله ولرسوله دونكم , يجعله حيث شاء . واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية , فقال بعضهم : نزلت في غنائم بدر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفل أقواما على بلاء , فأبلى أقوام وتخلف آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب , فأنزل الله هذه الآية على رسوله , يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فماض جائز . ذكر من قال ذلك . 12153 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا معتمر بن سليمان , قال : سمعت داود بن أبي هند يحدث , عن عكرمة , عن ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى مكان كذا وكذا , فله كذا وكذا , أو فعل كذا وكذا , فله كذا وكذا " . فتسارع إليه الشبان , وبقي الشيوخ عند الرايات . فلما فتح الله عليهم , جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لهم الأشياخ : لا تذهبوا به دوننا ! فأنزل الله عليه الآية : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } . * - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الأعلى , وحدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا داود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لما كان يوم بدر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صنع كذا وكذا , فله كذا وكذا " قال : فتسارع في ذلك شبان الرجال , وبقيت الشيوخ تحت الرايات ; فلما كانت الغنائم , جاءوا يطلبون الذي جعل لهم , فقالت الشيوخ : لا تستأثروا علينا , فإنا كنا ردءا لكم , وكنا تحت الرايات , ولو انكشفتم لفئتم إلينا ! فتنازعوا , فأنزل الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } . * - حدثني إسحاق بن شاهين , قال : ثنا خالد بن عبد الله , عن داود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لما كان يوم بدر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من فعل كذا فله كذا وكذا من النفل " قال : فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات , فلم يبرحوا , فلما فتح عليهم , قالت المشيخة : كنا ردءا لكم , فلو انهزمتم انحزتم إلينا , لا تذهبوا بالمغنم دوننا ! فأبى الفتيان وقالوا : جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : فكان ذلك خيرا لهم , وكذلك أيضا : أطيعوني فإني أعلم . 12154 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عكرمة في هذه الآية : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صنع كذا فله من النفل كذا " فخرج شبان من الرجال فجعلوا يصنعونه , فلما كان عند القسمة , قال الشيوخ : نحن أصحاب الرايات , وقد كنا ردءا لكم ! فأنزل الله في ذلك : { قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } . 12155 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا يعقوب الزبيري , قال : ثني المغيرة بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن سليمان بن موسى , عن مكحول مولى هذيل , عن أبي سلام , عن أبي أمامة الباهلي , عن عبادة بن الصامت , قال : أنزل الله حين اختلف القوم في الغنائم يوم بدر : { يسألونك عن الأنفال } إلى قوله : { إن كنتم مؤمنين } فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن سواء . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا سلمة , عن محمد , قال : ثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا , عن سليمان بن موسى الأسدي , عن مكحول , عن أبي أمامة الباهلي , قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال , فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل , وساءت فيه أخلاقنا , فنزعه الله من أيدينا , فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن سواء , يقول : على السواء , فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين . وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآية لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من المغنم شيئا قبل قسمتها , فلم يعطه إياه , إذ كان شركا بين الجيش , فجعل الله جميع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر من قال ذلك . 12156 - حدثني إسماعيل بن موسى السدي , قال : ثنا أبو الأحوص , عن عاصم , عن مصعب بن سعد , عن سعد , قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف , فقلت : يا رسول الله هذا السيف قد شفى الله به من المشركين ! فسألته إياه , فقال : " ليس هذا لي ولا لك " . قال : فلما وليت , قلت : أخاف أن يعطيه من لم يبل بلائي . فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي , قال : فقلت : أخاف أن يكون نزل في شيء ! قال : " إن السيف قد صار لي " . قال : فأعطانيه , ونزلت : { يسألونك عن الأنفال } . 12157 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا أبو بكر , قال : ثنا عاصم , عن مصعب بن سعد , عن سعد بن مالك , قال : لما كان يوم بدر , جئت بسيف , قال : فقلت : يا رسول الله , إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا , فهب لي هذا السيف ! فقال لي : " هذا ليس لي ولا لك " . فرجعت فقلت : عسى أن يعطي هذا من لم يبل بلائي ! فجاءني الرسول , فقلت : حدث في حدث : فلما انتهيت , قال : " يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي , وإنه قد صار لي فهو لك " . ونزلت : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن إسرائيل , عن سماك بن حرب , عن مصعب بن سعد , عن أبيه , قال : أصبت سيفا يوم بدر , فأعجبني , فقلت : يا رسول الله هبه لي ! فأنزل الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } . * - حدثنا ابن المثنى وابن وكيع , قال ابن المثنى , ثني معاوية , وقال ابن وكيع : ثنا أبو معاوية , قال : ثنا الشيباني , عن محمد بن عبيد الله , عن سعد بن أبي وقاص , قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص , وأخذت سيفه , وكان يسمى ذا الكتيفة , فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذهب فاطرحه في القبض " ! فطرحته ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي , قال : فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت عليه سورة الأنفال , فقال : " اذهب فخذ سيفك " . ولفظ الحديث لابن المثنى . 12158 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يونس بن بكير , وحدثنا ابن حميد , قال : ثنا سلمة جميعا , عن محمد بن إسحاق , قال : ثني عبد الله بن أبي بكر , عن قيس بن ساعدة , قال : سمعت أبا أسيد بن مالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائد يوم بدر , وكان السيف يدعى المرزبان ; فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا ما في أيديهم من النفل , أقبلت به فألقيته في النفل , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله , فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي , فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأعطاه إياه . 12159 - حدثني يحيى بن جعفر , قال : ثنا أحمد بن أبي بكر , عن يحيى بن عمران , عن جده عثمان بن الأرقم , عن عمه , عن جده , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : " ردوا ما كان من الأنفال ! " فوضع أبو أسيد الساعدي سيف ابن عائد المرزبان , فعرفه الأرقم فقال . هبه لي يا رسول الله ! قال : فأعطاه إياه . 12160 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن سماك بن حرب , عن مصعب بن سعد , عن أبيه , قال : أصبت سيفا . قال : فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نفلنيه ! فقال : " ضعه ! " ثم قام فقال : يا رسول الله نفلنيه ! قال : " ضعه ! " قال : ثم قام فقال : يا رسول الله نفلنيه ! أجعل كمن لا غناء له ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ضعه من حيث أخذته ! " فنزلت هذه الآية { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } . * - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا إسرائيل , عن سماك , عن مصعب بن سعد , عن سعد , قال : أخذت سيفا من المغنم , فقلت : يا رسول الله هب لي هذا ! فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } . 12161 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا إسرائيل , عن إبراهيم بن مهاجر , عن مجاهد , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : قال سعد : كنت أخذت سيف سعيد بن العاص بن أمية , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت : أعطني هذا السيف يا رسول الله ! فسكت , فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } إلى قوله : { إن كنتم مؤمنين } قال : فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : بل نزلت لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دونهم ليس لهم فيه شيء . وقالوا : معنى " عن " في هذا الموضع " من " وإنما معنى الكلام : يسألونك من الأنفال , وقالوا : قد كان ابن مسعود يقرؤه : " يسألونك الأنفال " على هذا التأويل . ذكر من قال ذلك . 12162 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سفيان , عن الأعمش , قال : كان أصحاب عبد الله يقرءونها : " يسألونك الأنفال " . 12163 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا المحاربي , عن جويبر , عن الضحاك , قال : هي في قراءة ابن مسعود " يسألونك الأنفال " . ذكر من قال ذلك . 12164 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : الأنفال : المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء , ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال } لي ; جعلتها لرسولي ليس لكم فيها شيء { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } , ثم أنزل الله : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سمي في الآية . 12165 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج : { يسألونك عن الأنفال } قال : نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا . قال : واختلفوا فكانوا أثلاثا . قال : فنزلت : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } وملكه الله رسوله , فقسمه كما أراه الله . 12166 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا عباد بن العوام , عن الحجاج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده : أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم بدر , فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } . 12167 - قال : ثنا عباد بن العوام , عن جويبر , عن الضحاك : { يسألونك عن الأنفال } قال : يسألونك أن تنفلهم . 12168 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا حماد بن زيد , قال : ثنا أيوب , عن عكرمة , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : يسألونك الأنفال . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال أن يعطيهموها , فأخبرهم الله أنها لله وأنه جعلها لرسوله . وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها , وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه , وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش . واختلفوا فيها , أمنسوخة هي أم غير منسوخة ؟ فقال بعضهم : هي منسوخة , وقالوا : نسخها قوله : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 الآية . ذكر من قال ذلك . 12169 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن جابر , عن مجاهد وعكرمة , قالا : كانت الأنفال لله وللرسول فنسختها : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 . 12170 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { يسألونك عن الأنفال } قال : أصاب سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا , فاختصم فيه وناس معه , فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم , فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم , فقال الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } الآية , فكانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة , فنسخها الله بالخمس . 12171 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : أخبرني سليم مولى أم محمد , عن مجاهد , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : نسختها : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } 8 41 . * - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا شريك , عن جابر , عن مجاهد وعكرمة , أو عكرمة وعامر , قالا : نسخت الأنفال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } 8 41 . وقال آخرون : هي محكمة وليست منسوخة . وإنما معنى ذلك : قل الأنفال لله , وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة , وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه . ذكر من قال ذلك . 12172 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } فقرأ حتى بلغ : { إن كنتم مؤمنين } فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا ويضعانها حيث أرادا , فقالوا : نعم . ثم جاء بعد الأربعين : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 الآية , ولكم أربعة أخماس , وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : " وهذا الخمس مردود على فقرائكم يصنع الله ورسوله في ذلك الخمس ما أحبا , ويضعانه حيث أحبا , ثم أخبرنا الله الذي يجب من ذلك " ثم قرأ الآية : { لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } 59 7 . قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم ينفل من شاء , فنفل القاتل السلب , وجعل للجيش في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس , ونفل قوما بعد سهمانهم بعيرا بعيرا في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينفل على ما يرى مما فيه صلاح المسلمين , وعلى من بعده من الأئمة أن يستنوا بسنته في ذلك , وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت , وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها , فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه ينفيه من كل معانيه , أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر . وقد ذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان ينكر أن يكون التنفيل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلا منه لقول الله تعالى : { قل الأنفال لله والرسول } . 12173 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبدة بن سليمان , عن محمد بن عمرو , قال : أرسل سعيد بن المسيب غلامه إلى قوم سألوه عن شيء , فقال : إنكم أرسلتم إلي تسألوني عن الأنفال , فلا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد بينا أن للأئمة أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم بفعله , فينفلوا على نحو ما كان ينفل , إذا كان التنفيل صلاحا للمسلمين .فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
القول في تأويل قوله تعالى : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } . يقول تعالى ذكره : فخافوا الله أيها القوم , واتقوه بطاعته واجتناب معاصيه , وأصلحوا الحال بينكم . واختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله : { وأصلحوا ذات بينكم } فقال بعضهم : هو أمر من الله للذين غنموا الغنيمة يوم بدر وشهدوا الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في الغنيمة أن يردوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض . ذكر من قال ذلك . 12174 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } قال : كان نبي الله ينفل الرجل من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله , ثم أنزل الله : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } أمرهم أن يرد بعضهم على بعض . 12175 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الرجل على قدر جده وغنائه على ما رأى , حتى إذا كان يوم بدر وملأ الناس أيديهم غنائم , قال أهل الضعف من الناس : ذهب أهل القوة بالغنائم ! فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فنزلت : { قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } ليرد أهل القوة على أهل الضعف . وقال آخرون : هذا تحريج من الله على القوم , ونهي لهم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره . ذكر من قال ذلك . 12176 - حدثني محمد بن عمارة , قال : ثنا خالد بن يزيد , وحدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قالا : ثنا أبو إسرائيل , عن فضيل , عن مجاهد , في قول الله : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } قال : حرج عليهم . 12177 - حدثني الحارث , قال : ثنا القاسم , قال : ثنا عباد بن العوام , عن سفيان بن حسين , عن مجاهد , عن ابن عباس : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم . قال عباد , قال سفيان : هذا حين اختلفوا في الغنائم يوم بدر . 12178 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } أي لا تستبوا . واختلف أهل العربية في وجه تأنيث البين , فقال بعض نحويي البصرة : أضاف ذات إلى البين وجعله ذاتا , لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم مؤنث , وبعضا يذكر نحو الدار , والحائط أنث الدار وذكر الحائط . وقال بعضهم : إنما أراد بقوله : { ذات بينكم } الحال التي للبين فقال : وكذلك " ذات العشاء " يريد الساعة التي فيها العشاء . قال : ولم يضعوا مذكرا لمؤنث ولا مؤنثا لمذكر إلا لمعنى . قال أبو جعفر : هذا القول أولى القولين بالصواب للعلة التي ذكرتها له .وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
وأما قوله : { وأطيعوا الله ورسوله } فإن معناه : وانتهوا أيها القوم الطالبون الأنفال إلى أمر الله وأمر رسوله فيما أفاء الله عليكم , فقد بين لكم وجوهه وسبله . { إن كنتم مؤمنين } يقول : إن كنتم مصدقين رسول الله فيما آتاكم به من عند ربكم . كما : 12179 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا , ويضعانها حيث أرادا .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] في رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، التي سماها الله (يوم الفرقان)، وجاءت سورة الأنفال تتحدث عن تفاصيل هذه الغزوة، وما فيها من الدروس والعبر، فحَرِيٌّ بالمؤمن أن يتدبرها، ويتأملها، ويعتبر بما فيها من آيات عظيمة، ومما ينصح به قراءة: تفسير السعدي لهذه السورة، مع تعليق ابن القيم عليها في زاد المعاد.
وقفة
[1] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلاَقُنَا؛ فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ. [أحمد 22747، قال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره]، ومعنى قوله "عَنْ بَوَاءٍ": أي: عَلَى السَّوَاءِ.
وقفة
[1] وردت في القرآن: (يسألونك) و(ويسألونك)، فما دلالة إضافة الواو وحذفها؟ الجواب: الواو تكون عاطفة، لكن لما يبدأ موضوعًا جديدًا لا يبدأ بالواو، وإنما يبدأ بـ (يسألونك)؛ لأنه لا يريد أن يستكمل كلامًا سابقًا مثل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ أى غير معطوفة على ما قبلها.
وقفة
[1] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ أَمْر قسمة الغنائم متروك للرّسول ﷺ، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما.
وقفة
[1] كل ما جاء في القرآن الكريم من لفظ (يسألونك) جاء الجواب (قل) نحو: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾، إلا ما جاء في سورة طه، جاء الجواب: (فقل)، ذلك أن الأسئلة التي سئل عنها الرسول عليه السلام وقعت، إلا سؤال طه لم يقع فجاء الجواب (فقل).
وقفة
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ خير الأجيال يحتاجون للدعوة إلى التقوى وإصلاح ذات البين، فكيف لا نحتاجها نحن؟!
اسقاط
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ البدريون يحتاجون لدعوة الصلح، ونحن لا نحتاج؟! الصلح خير.
وقفة
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ في بدايات سورة الأنفال ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [63] في نهايات سورة الأنفال دلالة على عظم شأن التأليف بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم.
تفاعل
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ عبادة غالية عند الله، قليلة الوجود بين الناس، هي صفاء القلب وإصلاح ذات البين، قل: «اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين».
وقفة
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ المتراشقون بالاتهامات على صفحات وسائل التواصل، والسّاعون لشقّ صفوف الأمة الواحدة، أما آن لهم الامتثال لهذا الأمر الإلهي العظيم؟!
وقفة
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ هل يبقى بعد هذا النداء الرباني أحد بينه وبين أخيه خصومة أو شحناء تمنع الألفة؟!
عمل
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ كلما قرأتَ أو سمعتَ هذه الآية فاحرص ألا يكون بينك وبين أحد خلاف, وحاول إن كان هناك خلاف أن تمحوه؛ تطبيقًا لهذه الآية.
وقفة
[1] تأمل كيف قدم ربنا إصلاح ذات البين على طاعته وطاعة رسوله في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾! فكم هو مؤسف أن يمر العيد على أناس يقرؤون هذه الآية، وهم مصرون على القطيعة؟ أليس العيد فرصة لتحقيق هذا النداء الرباني؟ ونيل هذه الفضيلة التي صح الحديث بأنه خير من درجة الصائم المصلي المتصدق؟
وقفة
[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ وصية جامعة ومنهج عملي للمجتمع، وطريق لتحقيق الإيمان، وكان بعض الصالحين إذا حضرته الوفاة أوصى أبناءه بها.
وقفة
[1] يولي القرآن الكريم إصلاح ذات البين عناية قصوى؛ فقد ورد الأمر به مسبوقًا بأمر عام بتقوى الله، وأعقبه بأمر عام بطاعة الله ورسوله، مع جعله من شروط الإيمان: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾.
وقفة
[1] لما حضرت الإمام نافعًا المدني -وهو أحد القراء السبعة- الوفاة، قال له أبناؤه: أوصنا! قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، فما أجمل أن تتضمن وصايانا لأهلنا وأولادنا وصايا قرآنية! فهي أعلى وأغلى أنواع الوصايا، وأعظمها أثرًا.
عمل
[1] ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ اسْعَ في صلحٍ بين شخصينِ من المسلمين اختلفَا.
وقفة
[1] ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ إصلاح ذات البين والألفة وترك التنازع من سمات أهل الإيمان، وهو الطريق لقوة المجتمع وتماسكه ونصره.
وقفة
[1] لا بد من تضافر جميع الجهود للإصلاح فيما بيننا؛ وكل منا يتحمل من هذا الأمر ما أمكنه ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾، فالأصل الإصلاح وليس إشعال فتيل النزاع.
وقفة
[1] ﴿وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ علامة الإيمان اقتداء لا ادعاء، وجوهر لا مظهر، ومن نقصت طاعته الله ورسوله، فهو علامة نقص إيمانه.
وقفة
[1] ألم يلفت نظرك التركيز على الإيمان في هذه السورة؟! تأمل: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، ﴿إنما المؤمنون﴾ [2]، ﴿زادتهم إيمانا﴾ [2]، ﴿أولئك هم المؤمنون﴾ [4]، ﴿وإن فريقًا من المؤمنين﴾ [5]، ﴿فثبتوا الذين آمنوا﴾ [12]، ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ [15، 20، 24، 27، 29، 45]، ﴿وليبلي المؤمنين﴾ [17]، ﴿وأن الله مع المؤمنين﴾ [19].
عمل
[1] اقرأ من كتب التفسير أو السيرة عن سبب نزول هذه الآية.
الإعراب :
- ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ: ﴾
- يسألون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. عن الأنفال: جار ومجرور متعلق بيسألون.أي عن حكم الأنفال وهي الغنائم التي تغنم في الحروب وكسرت نون «عَنِ» لالتقاء الساكنين والتقدير: يسألون عن الأنفال فقل لهم.
- ﴿ قُلِ: ﴾
- فعل أمر مبني على السكون وحرك آخره بالكسر لالتقاء الساكنين وحذفت واوه للسبب نفسه والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ: ﴾
- الجملة: في محل نصب مفعول به- مقول القول- الأنفال: مبتدأ مرفوع بالضمة. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ أي أنّ أمرها مختص بالله ورسوله. والرسول: معطوف بالواو على لفظ الجلالة. ومجرور أيضا وعلامة جره الكسرة
- ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ: ﴾
- الفاء: استئنافية. اتقوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة. وأصلحوا ذات: تعرب إعراب «اتقوا الله» و «ذاتَ» مضاف بمعنى: أحوال بينكم أي ما بينكم من الأحوال.
- ﴿ َيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ: ﴾
- بين: مضاف اليه مجرور بالكسرة. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. وأطيعوا الله: معطوفة بالواو على «اتقوا الله» وتعرب إعرابها.
- ﴿ وَرَسُولَهُ إِنْ: ﴾
- معطوف بالواو على لفظ الجلالة منصوب بالفتحة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. إن: حرف شرط جازم.
- ﴿ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: ﴾
- كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «كان». والميم علامة جمع الذكور. مؤمنين: خبرها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه. التقدير: إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : تبدأ السورة بـ سؤال الصَّحابةِ للنَّبي ﷺ عن حُكمِ الغَنائِمِ التي غَنِمُوها من كفَّارِ قُريشٍ في غزوةِ بَدرٍ، ولِمَن هي، وكيف تُقسَّمُ؟ قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ/ ولَمَّا حكمَ اللهُ عز وجل بأنَّ أمْرَ قِسْمَة الأنفالَ موكولٌ لله؛ ذكَّرَهم هنا بأنْه قد وجب عليهم الرِّضا بما يقسِمُه الرَّسولُ مِنها، فقال تعالى: /فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)﴾.
﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
عن الأنفال:
وقرئ:
أنفال، بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف، وحذف الهمزة والاعتداد بالحركة والإدغام، وهى قراءة، ابن محيصن.
مدارسة الآية : [2] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ .. ﴾
التفسير :
ومن نقصت طاعته للّه ورسوله، فذلك لنقص إيمانه،ولما كان الإيمان قسمين:إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء، والفوز التام، وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال:إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ أي:خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية اللّه تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف اللّه تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم،.لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه،أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقا إلى كرامة ربهم،أو وجلا من العقوبات، وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان. وَعَلَى رَبِّهِمْ وحده لا شريك له يَتَوَكَّلُونَ أي:يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن اللّه تعالى سيفعل ذلك. والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به.
ثم وصف- سبحانه- المؤمنين الصادقين بخمس صفات، وبشرهم بأعلى الدرجات، فقال في بيان صفتهم الأولى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ.. فالجملة الكريمة مستأنفة وهي مسوقة لبيان أحوال المؤمنين الذين هم أهل لرضا الله وحسن ثوابه، حتى يتأسى بهم غيرهم.
وقوله وَجِلَتْ من الوجل وهو استشعار الخوف. يقال: وجل يوجل وجلا فهو وجل، إذا خاف وفزع.
والمراد بذكر الله: ذكر صفاته الجليلة، وقدرته النافذة، ورحمته الواسعة، وعقابه الشديد، وعلمه المحيط بكل شيء، وما يستتبع ذلك من حساب وثواب وعقاب.
والمعنى: إنما المؤمنون الصادقون الذين إذا ذكر اسم الله وذكرت صفاته أمامهم، خافت قلوبهم وفزعت، استعظاما لجلاله وتهيبا من سلطانه، وحذرا من عقابه، ورغبة في ثوابه، وذلك لقوة إيمانهم، وصفاء نفوسهم، وشدة مراقبتهم لله- عز وجل- ووقوفهم عند أمره ونهيه..
وقد جاء التعبير عن صفاتهم بصيغة من صيغ القصر وهي «إنما» ، للإشعار بأن من هذه صفاتهم هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم وإخلاصهم، أما غيرهم ممن لم تتوفر به هذه الصفات، فأمره غير أمرهم، وجزاؤه غير جزائهم.
قال الفخر الرازي: فإن قيل: إنه- تعالى- قال هاهنا: وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وقال في آية أخرى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ... فكيف الجمع بينهما؟
قلنا: الاطمئنان: إنما يكون عن ثلج اليقين، وشرح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل:
إنما يكون من خوف العقوبة. ولا منافاة بين هاتين الحالتين. بل نقول: هذان الوصفان اجتمعا في آية واحدة وهي قوله- تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ...
والمعنى تقشعر الجلود من خوف عذاب الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله.
والصفة الثانية من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين عبر عنها- سبحانه- بقوله: وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً.
أى أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم إذا قرئت عليهم آيات الله أى: حججه وهي القرآن زادتهم إيمانا، أى: زادتهم قوة في التصديق، وشدة في الإذعان، ورسوخا في اليقين، ونشاطا في الأعمال الصالحة، وسعة في العلم والمعرفة.
وجاء التعبير بصيغة الفعل المبنى للمفعول في قوله: ذُكِرَ اللَّهُ وتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ، للإيذان بأن هؤلاء المؤمنين الصادقين إذا كانوا يخافون عند ما يسمعون من غيرهم آيات الله.. فإنهم يكونون أشد خوفا وفزعا عند ذكرهم لله وعند تلاوتهم لآياته بألسنتهم وقلوبهم.
فالمقصود من هذه الصيغة: مدحهم، والثناء عليهم، وبيان الأثر الطيب الذي يترتب على ذكر الله وعلى تلاوة آياته.
والصفة الثالثة من صفاتهم قوله- تعالى-: وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
أى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين- أيضا- أنهم يعتمدون على ربهم الذي خلقهم بقدرته، ورباهم بنعمته، فيفوضون أمورهم كلها إليه وحده- سبحانه- لا إلى أحد سواه، كما يدل عليه تقديم المتعلق على عامله.
ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهذه الجملة: أى: أنهم لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك لا شريك له، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: «التوكل على الله جماع الإيمان».
ومن الواضح عند ذوى العقول السليمة أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب التي شرعها- سبحانه- بل إن الأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأمر بها لبلوغ الغايات، لدليل على قوة الإيمان، وعلى حسن طاعته- سبحانه- فيما شرعه وفيما أمر به.
وليس من الإيمان ولا من العقل ولا من التوكل على الله أن ينتظر الإنسان ثمارا بدون غرس، أو شبعا بدون أكل، أو نجاحا بدون جهد، أو ثوابا بدون عمل صالح.
إنما المؤمن العاقل المتوكل على الله، هو الذي يباشر الأسباب التي شرعها الله لبلوغ الأهداف مباشرة سليمة.. ثم بعد ذلك يترك النتائج له- سبحانه- يسيّرها كيف يشاء، وحسبما يريد..
قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) قال : المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون ، ولا يصلون إذا غابوا ، ولا يؤدون زكاة أموالهم ، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين ، ثم وصف المؤمنين فقال : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) فأدوا فرائضه . ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) يقول : تصديقا ( وعلى ربهم يتوكلون ) يقول : لا يرجون غيره .
وقال مجاهد : ( وجلت قلوبهم ) فرقت ، أي : فزعت وخافت . وكذا قال السدي وغير واحد .
وهذه صفة المؤمن حق المؤمن ، الذي إذا ذكر الله وجل قلبه ، أي : خاف منه ، ففعل أوامره ، وترك زواجره . كقوله تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) [ آل عمران : 135 ] وكقوله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) [ النازعات : 40 ، 41 ] ولهذا قال سفيان الثوري : سمعت السدي يقول في قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) قال : هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال : يهم بمعصية - فيقال له : اتق الله فيجل قلبه .
وقال الثوري أيضا : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أم الدرداء في قوله : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) قالت : الوجل في القلب إحراق السعفة ، أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك ، فإن الدعاء يذهب ذلك .
وقوله : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا [ وعلى ربهم يتوكلون ] ) كقوله : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ) [ التوبة : 124 ] .
وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب ، كما هو مذهب جمهور الأمة ، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة ، كالشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد ، كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح البخاري ، ولله الحمد والمنة .
( وعلى ربهم يتوكلون ) أي : لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يلوذون إلا بجنابه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ، ولا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب ؛ ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان .
القول في تأويل قوله : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ليس المؤمن بالذي يخالف الله ورسوله، ويترك اتباعَ ما أنـزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه، والانقياد لحكمه, ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وَجِل قلبه، وانقاد لأمره، وخضع لذكره، خوفًا منه، وفَرَقًا من عقابه, وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدّق بها، (46) وأيقن أنها من عند الله, فازداد بتصديقه بذلك، إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قبل ذلك، تصديقًا. وذلك هو زيادة ما تلى عليهم من آيات الله إيَّاهم إيمانًا (47) = " وعلى ربهم يتوكلون "، يقول: وبالله يوقنون، في أن قضاءه فيهم ماضٍ، فلا يرجون غيره، ولا يرهبون سواه. (48)
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
15684- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، قال: المنافقون، لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه, ولا يؤمنون بشيء من آيات الله, ولا يتوكلون على الله, ولا يصلّون إذا غابوا, ولا يؤدُّون زكاة أموالهم. فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين, ثم وصف المؤمنين فقال: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، فأدوا فرائضه= " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا "، يقول: تصديقًا= " وعلى ربهم يتوكلون "، يقول: لا يرجون غيره.
15685- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثير, عن مجاهد: " الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، قال: فَرِقت.
15686-. . . . قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن السدي: " الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، قال: إذا ذكر الله عند الشيء وجِلَ قلبه.
15687 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، يقول: إذا ذكر الله وَجِل قلبه.
15688 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: " وجلت قلوبهم "، قال: فرقت.
15689 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " وجلت قلوبهم "، فرقت.
15690- . . . . قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك, عن سفيان قال: سمعت السدي يقول في قوله: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، قال: هو الرجل يريد أن يظلم = أو قال: يهمّ بمعصية = أحسبه قال: فينـزع عنه.
15691- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان الثوري, عن عبد الله بن عثمان بن خثيم, عن شهر بن حوشب, عن أبي الدرداء في قوله: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، قال: الوجل في القلب كإحراق السَّعَفة, (49) أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى! قال: إذا وجدت ذلك في القلب فادع الله, فإن الدعاء يذهب بذلك.
15692- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، قال: فرقًا من الله تبارك وتعالى, ووَجلا من الله, وخوفًا من الله تبارك وتعالى.
* * *
وأما قوله: " زادتهم إيمانًا "، فقد ذكرت قول ابن عباس فيه. (50)
* * *
وقال غيره فيه, ما:-
15693- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا "، قال: خشية.
15694- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون "، قال: هذا نعت أهل الإيمان, فأثبت نَعْتهم, ووصفهم فأثبت صِفَتهم.
----------------------
الهوامش :
(46) انظر تفسير " التلاوة " فيما سلف ص : 252 ، تعليق 2 ، والمراجع هناك .
(47) انظر تفسير " زيادة الإيمان " فيما سلف 7 : 405 .
(48) انظر تفسير " الوكيل " فيما سلف 12 : 563 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
(49) " السعفة " ( بفتحتين ) ورق جريد النخل إذا يبس .
(50) يعني رقم : 15684 .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ وهذه صفة المؤمن الحق؛ الذي إذا ذكر الله وجل قلبه؛ أي: خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره، قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول: هو الرجل يريد أن يظلم -أو قال: يهم بمعصية- فيقال له: اتق الله؛ فَيَجِلُ قلبه.
وقفة
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يُذكّر بالله !
وقفة
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ قدم تعالى أعمال القلوب؛ لأنها أصل أعمال الجوارح، وأفضل منها.
عمل
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ إذا لم يتحرك قلبك عند ذكر الله وعند سماع آياته؛ فراجع إيمانك.
وقفة
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشيةُ الله الانكفافَ عن المحارم، فإن خوف الله أكبر علاماته أن يحجز صاحبَه عن الذنوب.
وقفة
[2] لا يبكي من سماع القرآن إلا مؤمن ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾، وعندما يخشع القلب تنهمر العين، ﴿ويخرون للإذقان يبكون﴾ [الإسراء: 109].
وقفة
[2] ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ قال السدي رحمه الله: «هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله؛ فينزع عنها».
وقفة
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ من أعظم علامات الإيمان: التأثر بكلام الله تعالى.
تفاعل
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ هل تشعر بهذا إذا قرأت القرآن؟
اسقاط
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ اسأل نفسك كلما قرأت القرآن أو استمعت لآياته: هل وجل قلبك؟ هل زادتك هذه الآيات إيمانًا؟ إن كان هذا قد حدث لك هذا فاحمد الله تعالى على فضله، وإن لم تجد أثرًا في قلبك فتفقد إيمانك، واستعن بالله، وتضرع إليه أن يثبت قلبك على دينه، ويزيدك إيمانًا وتقوى، ويزيل الأقفال والأغلفة عن قلبك وسمعك؛ حتى يكون للقرآن أثر فيك وتكون من المؤمنين.
عمل
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ليكن لك ورد سماعي من القرآن يرقق قلبك ويزيد إيمانك، فإنَّ سماع القرآن من أعظم ما يزيد الإيمان، استمع، وانصت، واستجمع فؤادك وكأن كل آية تخاطبك أنت أنت، ثم انظر لقلبك إذا استشعر أن الله يخاطبه كيف يكون؟
وقفة
[2] إن القلوب لتصدأ، فما جلاؤها؟ الجواب: ذكر الله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.
وقفة
[2] ليست العبرة كم ختمت القرآن من مرة في رمضان؟ وإنما الغنيمة والظفر بمقدار أي تغير إيجابي تجده في نفسك من أثر تلاوته وتدبره؟ قف مع نفسك بصدق، واعرضها على هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.
تفاعل
[2] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ قل الآن: يا رب اجعلنا منهم.
وقفة
[2] قال ابن رجب: «إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان، ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحل اللسان ذكر الله وما والاه، وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾».
اسقاط
[2] إذا أردت أن تعرف المقياس الحقيقي لإيمانك فاعرض نفسك على هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.
وقفة
[2] أفعال قلبية لزيادة الإيمان: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون﴾.
وقفة
[2] ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الذكر والطاعات لها أثر على القلب؛ ولهذا (وَجِلَتْ) قلوبهم, وأشد الذكر على القلب تلاوة القرآن.
عمل
[2] ذكر الله في كتابه أن ذكره علاج لقسوة القلب: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّـهِ﴾ [الحديد: 16]؛ فتدارك قلبك قبل قسوته وموته بالذكر، قال رجل للحسن البصري: «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي»، قال: «أذِبه بالذكر».
وقفة
[2] ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ من أعظم علامات الإيمان: التأثر بكلام الله.
لمسة
[2] قال هنا: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 28]، فكيف الجمع بينهما؟ والجواب: الاطمئنان يكون انشراح الصدر بذكر الله، والوجل يكون من خوف العقوبة، والمؤمن -أثناء سيره إلى الله- يتقلب بين الحالتين.
وقفة
[2] قال هنا: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 28]، فكيف الجمع بينهما؟ الجواب: أن المراد بـ(الذكر) ذكر عظمة الله وجلاله، وشدة انتقامه ممن عصى أمره، لأن الآية نزلت عند اختلاف الصحابة في غنائم بدر، فناسب ذِكْرَ التخويف، وآية الرعد: نزلت فيمن هداه الله وأناب إليه، والمراد بذلك الذكر: ذكر رحمته وعفوه ولطفه لمن أطاعه وأناب إليه، وجمع بينهما في آية الزمر، فقال تعالى: ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [الزمر: 23]، أي عند ذكر عظمته وجلاله وعقابه، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر رحمته وعفوه وكرمه.
وقفة
[2] قلوب المؤمنين تستجيب لذكر الله تعالى؛ وجلًا وخوفًا وعظمةً له ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ نية جديدة احتسبها كلما قرأت القرآن: أن تكون سببًا في زيادة إيمان غيرك.
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ استدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص.
اسقاط
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ هل نحن من الذين يسمعون آيات الله فيزدادون إيمانًا، أم لنا -أو أن أكثرنا- يسمع آيات القرآن للطرب وللعجب، فإذا سمعها لم تجاوز أذنيه ولم تصل إلى قلبه وعقله؟
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ هذا حال يجده المؤمن إذا تُليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن. والسؤال: كم هي المرات التي نسمع فيها آيات الله، ولا تحصل لنا هذه الثمرات؟
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ووجه ذلك: أنهم يلقون له السمع، ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى ما كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقاً إلى كرامة ربهم، أو وجلاً من العقوبات، وازدجاراً عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان.
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ أيها القارئ للقرآن: احتسِبْ (زيادةَ إيمانِ غيرك).
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ليس اﻹيمان بالكلام فقط، حتى حال استماعهم (يزدادون إيمانًا).
وقفة
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ من أعظم ما يزيد الإيمان: الاستماع لآيات الرحمن.
وقفة
[2] شأن أهل الإيمان مع القرآن: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ لأنهم يلقون السمع، ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب؛ ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، أو وجلًا من العقوبات، وازدجارًا عن المعاصي.
وقفة
[2] هل الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، والزيادة ثبتت بالآيات الصريحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾، وقوله: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ [التوبة: 124]، وقوله: ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: 17]، إلى غير ذلك من الآيات، وفي القرآن ثمان آيات كلها مصرحة بالزيادة، ولم يرد التصريح في القرآن بالنقصان، لكن الإمام مالك يقول: (ما قَبِل الزيادة قَبِل النقصان)، وقد جاء في حديث نقصان دين المرأة: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ ...» [البخاري: 304]، فدل على أن الدين ينقص، وزيادته بما يقوي الإيمان من الأعمال الصالحة مثل كثرة الذكر وتلاوة القرآن وغيرها.
وقفة
[2] طالبو الإيمان الكامل يتعاهدون ويتفقدون إيمانهم، ويسعون لزيادته، ومن أسباب زيادته: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾، فتحضر قلوبهم وتنصت وتتدبر حال سماعهم آيات القرآن.
عمل
[2] ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ حاول واجتهد في شهر القرآن أن تكون من أهل هذه الآية، فلن تجد فرصة أعظم من هذه.
وقفة
[2] ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه ويُنمِّيه؛ لأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها.
وقفة
[2] ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ كلما ازداد إيمانك ازداد توكلك.
وقفة
[2] ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه، لا على أنفسهم، وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها.
وقفة
[2] ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ من صفات المؤمنين: التوكل على الله، وعدم التوكل على غيره.
وقفة
[2، 3] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ قدم تعالى أعمال القلوب؛ لأنها أصل لأعمال الجوارح، وأفضل منها.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ: ﴾
- إنما: كافة ومكفوفة. المؤمنون: مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في الاسم المفرد. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ بمعنى إنما المؤمنون علامتهم أنه اذا ذكر الله .. ويجوز أن يكون «الَّذِينَ» خبر مبتدأ محذوف وتقديره «هم» والجملة الاسمية «هم الذين» خبر المبتدأ الأول «الْمُؤْمِنُونَ».
- ﴿ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ: ﴾
- الجملة: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو أداة شرط غير جازمة. ذكر: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: نائب فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. وجلت: فعل ماض مبني على الفتح. والتاء: تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. قلوب: فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة وجملة «ذُكِرَ اللَّهُ» في محل جر بالاضافة. وجملة «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» جواب شرط غير جازم لا محل لها.
- ﴿ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ: ﴾
- الواو: عاطفة. إذا: أعربت. تليت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. عليهم: جار ومجرور متعلق بتليت و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى. آيات: نائب فاعل مرفوع بالضمة. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة.
- ﴿ زادَتْهُمْ إِيماناً: ﴾
- الجملة: جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب.زادت: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. والتاء: تاء التأنيث الساكنة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به ايمانا: تمييز منصوب بالفتحة.
- ﴿ وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الواو استئنافية على رب: جار ومجرور متعلق بيتوكلون و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة يتوكلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. ' ﴾
المتشابهات :
| الأنفال: 2 | ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ وصَفَ اللهُ عز وجل هنا المؤمنينَ ذوي الإيمانِ الكامِلِ، فقال تعالى:
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
وجلت:
وقرئ:
بفتح الجيم، وهى لغة.
مدارسة الآية : [3] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ .. ﴾
التفسير :
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ من فرائض ونوافل، بأعمالها الظاهرة والباطنة، كحضور القلب فيها، الذي هو روح الصلاة ولبها،. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ النفقات الواجبة، كالزكوات، والكفارات، والنفقة على الزوجات والأقارب، وما ملكت أيمانهم،.والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير.
أما الصفتان الرابعة والخامسة من صفات هؤلاء المؤمنين فهما قوله- تعالى- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ.
والمراد بإقامة الصلاة: أداؤها في مواقيتها مستوفية لأركانها وشروطها وآدابها وخشوعها- من أقام الشيء إقامة إذا قومه وأزال عوجه لأن الشأن في صلاة المؤمنين أن تكون: إحساسا عميقا بالوقوف بين يدي الله، وانقطاعا تاما لمناجاته، وتمثلا حيا لجلاله وكبريائه، واستغراقا كاملا في دعائه.
والمراد بقوله: يُنْفِقُونَ يخرجون ويبذلون، من الإنفاق وهو إخراج المال وبذله وصرفه.
والجملة الكريمة في محل رفع صفة للموصول في الآية السابقة أو بدل منه أو بيان له.
والمعنى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يؤدون الصلاة في مواقيتها مستوفية لأركانها وشروطها وسننها وآدابها وخشوعها.. وأنهم يبذلون أموالهم للفقراء والمحتاجين بسماحة نفس، وسخاء يد، استجابة لتعاليم دينهم.
فأنت ترى أنه- سبحانه- قد وصف هؤلاء المؤمنين بخمس صفات: الأولى والثانية والثالثة منها ترجع إلى العبادات القلبية التي تدل على شدة خشيتهم من ربهم، وقوة تأثرهم بآيات خالقهم، واعتمادهم عليه- سبحانه- وحده لا على أحد سواه.
والصفة الرابعة ترجع إلى العبادات البدنية، وهي إقامة الصلاة بإخلاص وخشوع.
أما الصفة الخامسة فترجع إلى العبادات المالية، وهي إنفاق المال في سبيل الله ولا شك أن هذه الصفات متى تمكنت في النفس، كان صاحبها أهلا لمحبة الله ورضوانه،
وقوله ( الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) ينبه بذلك على أعمالهم بعد ما ذكر اعتقادهم ، وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها ، وهو إقامة الصلاة ، وهو حق الله تعالى .
وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها ووضوئها ، وركوعها ، وسجودها .
وقال مقاتل بن حيان : إقامتها : المحافظة على مواقيتها ، وإسباغ الطهور فيها ، وتمام ركوعها وسجودها ، وتلاوة القرآن فيها ، والتشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا إقامتها . .
والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج الزكاة ، وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب ، والخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه .
قال قتادة في قوله ( ومما رزقناهم ينفقون ) فأنفقوا مما أعطاكم الله ، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم ، أوشكت أن تفارقها .
القول في تأويل قوله : الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الذين يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها, وينفقون مما رزقهم الله من الأموال فيما أمرهم الله أن ينفقوها فيه، من زكاة وجهاد وحج وعمرة ونفقةٍ على من تجب عليهم نفقته, فيؤدُّون حقوقهم= " أولئك "، يقول: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال (51) = " هم المؤمنون "، لا الذين يقولون بألسنتهم: " قد آمنا " وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقًا, لا يقيمون صلاة ولا يؤدُّون زكاة.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
-------------------------
الهوامش :
(51) انظر تفسير : " إقامة الصلاة " ، و " الرزق " ، و " النفقة " فيما سلف من فهارس اللغة ( قوم ) ، ( رزق ) ، ( نفق ) .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لمسة
[3] ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ وجيء بالفعلين المضارعين في (يقيمون) و(ينفقون) للدلالة على تكرر ذلك وتجدده.
وقفة
[3] ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ دائما يقترنان في القرآن؛ لأن كليهما فيه بذل وتضحية، فالصلاة تقتطع جزءًا من وقتك للوقوف بين يدي الله، والزكاة تقتطع جزءًا من مالك.
وقفة
[3] ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ مدحهم أولًا بمكارم الأعمال القلبية من الخشية والإخلاص والتوكل، ثم مدحهم هنا بمحاسن أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة، وقدم أعمال القلوب؛ لأنها أصل أعمال الجوارح وأثقل منها في الميزان.
عمل
[3] حاسب نفسك على صلاتك، وانظر في أي جانب قصرت فيها، سواءً كان في أركانها أو واجباتها أو مستحباتها، ثم سد هذا النقص والخلل ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ: ﴾
- الذين: بدل من «الَّذِينَ» في الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. يقيمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الصلاة: مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة: صلة الموصول.
- ﴿ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: ﴾
- الواو: عاطفة. مما: مكونة من «من» حرف جر. و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بينفقون. رزق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ينفقون: تعرب اعراب «يُقِيمُونَ '
المتشابهات :
| البقرة: 3 | ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ |
|---|
| الأنفال: 3 | ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ذكَر اللهُ عز وجل من أعمالهم الحسنة أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل؛ ذكر هنا أعمال الجوارج من الصلاة والزكاة، قال تعالى:
﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ .. ﴾
التفسير :
أُولَئِكَ الذين اتصفوا بتلك الصفات هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق اللّه وحقوق عباده. وقدم تعالى أعمال القلوب، لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها،.وفيها دليل على أن الإيمان، يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه،.وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب اللّه تعالى والتأمل لمعانيه.ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال:لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ أي:عالية بحسب علو أعمالهم. وَمَغْفِرَةٌ لذنوبهم وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وهو ما أعد اللّه لهم في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من يصل إلى درجتهم في الإيمان - وإن دخل الجنة - فلن ينال ما نالوا من كرامة اللّه التامة.
ولذا مدح- سبحانه- أصحاب هذه الصفات، وبين ما أعده لهم من ثواب جزيل فقال: أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
أى: أولئك المتصفون بتلك الصفات الكريمة هم المؤمنون إيمانا حقا لَهُمْ دَرَجاتٌ عالية، ومكانة سامية عِنْدَ رَبِّهِمْ ولهم مَغْفِرَةٌ شاملة لما فرط منهم من ذنوب، ولهم رِزْقٌ كَرِيمٌ في الجنة، يجعلهم يحيون فيها حياة طيبة لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ.
وقوله حَقًّا منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف، أى: أولئك هم المؤمنون إيمانا حقا.
والتنوين في قوله دَرَجاتٌ للتعظيم والتهويل أى: لهم درجات رفيعة، ومنازل عظيمة، وفي وصف هذه الدرجات بأنها عِنْدَ رَبِّهِمْ مزيد تشريف لهم، ولطف بهم، وإيذان بأن ما وعدهم به متيقن الوقوع، لأنه وعد من كريم لا يخلف وعده- سبحانه- وفي وصف الرزق الذي أعده لهم بالكرم، زيادة في إدخال السرور على قلوبهم لأن لفظ الكريم يصف به العرب كل شيء حسن في بابه، بحيث يكون لا قبح فيه ولا شكوى معه.
وبذلك نرى أن أصحاب تلك الصفات الحميدة قد مدحهم الله- تعالى- مدحا عظيما، وكافأهم على إيمانهم الحق بالدرجات العالية، والمغفرة الشاملة، والرزق الكريم: ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
هذا، وقد استنبط العلماء من تلك الآيات جملة من الأحكام والآداب منها:
1- حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم.
فإن قيل: كيف تأتى لأصحابه الذين شهدوا بدرا- وهم من هم في عفتهم وزهدهم- أن يختلفوا في شأن الغنائم.
فالجواب،، أن بعض الصحابة المشتركين في هذه الغزوة هم الذين حدث بينهم الخلاف في شأنها لأنهم لم يكن لهم عهد سابق بكيفية تقسيمها، أما أكثر الصحابة فإنهم لم يلتفتوا إلى هذه الغنائم، بل تركوا أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها كيف يشاء.
وأيضا فإن هؤلاء الذين حدث بينهم الخلاف في شأن الغنائم، كان من الدوافع التي دفعتهم إلى هذا الخلاف، ما فهموه من أن حيازة الغنائم تدل على حسن البلاء، وشدة القتال في سبيل الله، فكان كل واحد منهم يحرص على أن يظهر بهذا المظهر المشرف وهم في أول لقاء لهم مع أعدائهم.
وعند ما جاوز هذا الحرص حده، بأن غطى على ما يجب أن يسود بينهم من سماحة وصفاء، نزل القرآن ليربيهم بتربيته الحكيمة، وليؤدبهم بأدبه السامي، وليخبرهم بحكم الله في شأن هذه الأنفال.. وبعد أن عرفوا حكم الله في شأنها، قابلوه بالرضا والإذعان والتسليم.
2- أن القرآن في ترتيبه للحوادث، لا يلزم سردها على حسب زمن وقوعها، وإنما يرتبها بأسلوبه الخاص الذي يراعى فيه مقتضى حال المخاطب.
فلقد افتتحت السورة التي معنا بالحديث عن الغنائم التي غنمها المسلمون في بدر- مع أن ذلك كان بعد انتهاء الغزوة- ليشعر المخاطبين من أول الأمر أن النصر في هذه الغزوة كان للمسلمين، وأن الإسلام قد صرع الكفر منذ أول معركة نازله فيها.
وهذا اللون من الافتتاح هو ما يعبر عنه البلغاء ببراعة الاستهلال.
ولقد أفاض بعض العلماء في شرح هذا المعنى فقال ما ملخصه.
وقد بدأت السورة بموضوع الأنفال واختلافهم في قسمتها وسؤالهم عنها، فساقت في ذلك أربع آيات، هن: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ.. إلى قوله- وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
وقد عالجت هذه الآيات نفوس المؤمنين، وعملت على تطهيرها من الاختلاف الذي ينشأ عن حب المال والتطلع إلى المادة، ولا ريب أن حب المال والتطلع إلى المادة من أكبر أسباب الفشل.
ولأهمّيّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السورة، وإن كان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخرا في الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى بدر، وقتال الأعداء.
وقد عرفنا من سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع أنه لا يعرض لها مرتبة حسب وقوعها، وذلك لأنه لا يذكرها على أنها تاريخ يعين لها الوقت والمكان، وإنما يذكرها لما فيها من العبر والمواعظ، ولما تتطلبه من الأحكام والحكم.
وقد بدأت السورة بالحديث عن الأنفال للمسارعة من أول الأمر بنتائج النصر الذي كفله الله للمؤمنين.
وليس من تربية النفوس أن نبدأ الكلام معها بما يدل على الاضطراب والفزع والتردد أمام وسائل العزة والشرف، متى وجد لهم بجانب هذا التردد ما يدل على مواقف الشرف والكرامة..
ولا كذلك يكون الأمر إذا بدئت ببيان تثاقلهم في الخروج إلى الغزوة، وانظر كيف يكون وقع المطلع إذا جاء على هذا الوجه «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ... إلخ» .
لا ريب أنه مطلع شديد الوقع على النفوس، يصور علاقة المؤمنين بنبيهم في صورة يأباها إيمانهم به وامتثالهم لأمره. يصورهم في شقاق واختلاف مع قائدهم ورسولهم ويصورهم في ثوب الكراهية الشديدة لمعالي الأمور وعز الحياة.
لهذا كله جاء الأسلوب في سرد الوقائع غير مكترث بمخالفة ترتيبها في الوجود الخارجي.
3- استدل جمهور العلماء بقوله- تعالى- وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً على أن الإيمان يزيد وينقص..
ومن المفسرين الذين بسطوا القول في هذه المسألة الإمام الآلوسى، فقد قال ما ملخصه:
قوله- تعالى- وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ أى: القرآن زادَتْهُمْ إِيماناً أى:
تصديقا كما هو المتبادر، فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مما لا ريب في كونه موجبا لذلك.
وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلا.
بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل- أيضا- وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي، مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة، واللازم باطل فكذا الملزوم.
وقال النووي: إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضها، فكذا التصديق والمعرفة يتفاضلان بحسب ظهور البراهين وكثرتها.
وذهب الإمام أبو حنيفة وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واختاره إمام الحرمين، محتجين بأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان، وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان فالمصدق إذا أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا، وإنما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة.
وذهب جماعة منهم الإمام الرازي إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه وعدمهما لفظي، وهو فرع تفسير الإيمان، فمن فسره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص، ومن فسره بالأعمال مع التصديق قال: إنه يزيد وينقص، وعلى هذا قول البخاري «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهو المعنى بما روى عن ابن عمر أنه قال. قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص، قال، نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار.
ويبدو لنا أن رأى جمهور العلماء في هذه المسألة، أولى بالقبول لأنه من الواضح أن إيمان الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- أرسخ وأقوى من إيمان آحاد الناس، ولأنه كلما تكاثرت الأدلة كان الإيمان أشد رسوخا في النفس وأعمق أثرا في القلب، فلا تزلزله الشبهات ولا تزعزعه العوارض والفتن.
ومن أوضح الأدلة على أن الإيمان يقوى بقوة البرهان إلى درجة الاطمئنان، ما حكاه الله- تعالى- عن إبراهيم في قوله: وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى، قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ: بَلى، وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.
فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن مقام الطمأنينة في الإيمان، يزيد على ما دونه من الإيمان المطلق قوة وكمالا. إن إبراهيم- عليه السلام- لا شك أنه كان مؤمنا عند ما سأل ربه هذا السؤال، سأله ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة أعلى: وهي مرتبة عين اليقين ...
هذا، وشبيه بهذه الآية في الدلالة على قبول الإيمان للزيادة والنقصان قوله- تعالى-:
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً...
وقوله- تعالى-: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ...
وقوله- تعالى-: وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ.
وقوله- تعالى-: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَتَسْلِيماً، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي وردت في هذا المعنى.
4- في هذه الآيات الكريمة تربية ربانية للمؤمنين، وتوجيه لهم إلى ما يسعدهم، وإرشاد لهم إلى أن المؤمن الصادق في إيمانه، هو الذي يجمع بين سلامة العقيدة، وسلامة الخلق، وصلاح العمل، وأن المؤمن متى جمع بين هذه الصفات ارتفع إلى أعلى الدرجات، وأحس بحلاوة الإيمان في قلبه..
روى الحافظ الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصارى أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «كيف أصبحت يا حارث» ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك» ؟ فقال الحارث: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلى، وأظمأت نهاري. وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: «يا حارث عرفت فالزم» ثلاثا.
ثم أخذت السورة- بعد هذا الافتتاح المشتمل على أروع استهلال وأبلغه وأحكمه..، في الحديث عن الغزوة التي كان من ثمارها تلك الأنفال، فاستعرضت مجمل أحداثها، وصورت نفوس فريق من المؤمنين الذين اشتركوا فيها أكمل تصوير، استمع معى- أخى القارئ- بتدبر وتعقل إلى قوله- تعالى-:
وقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان . .
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد السكسكي ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن محمد بن أبي الجهم ، عن الحارث بن مالك الأنصاري ؛ أنه مر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : انظر ماذا تقول ، فإن لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي ، وأظمأت نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ، فقال : يا حارث ، عرفت فالزم - ثلاثا .
وقال عمرو بن مرة في قوله : ( أولئك هم المؤمنون حقا ) إنما أنزل القرآن بلسان العرب ، كقولك : فلان سيد حقا ، وفي القوم سادة ، وفلان تاجر حقا ، وفي القوم تجار ، وفلان شاعر حقا ، وفي القوم شعراء .
وقوله : ( لهم درجات عند ربهم ) أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات ، كما قال تعالى : ( هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ) [ آل عمران : 163 ] .
( ومغفرة ) أي : يغفر لهم السيئات ، ويشكر لهم الحسنات .
وقال الضحاك في قوله : ( لهم درجات عند ربهم ) أهل الجنة بعضهم فوق بعض ، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه ، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد .
ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء ، قالوا : يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم ؟ فقال : بلى ، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين .
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد [ و ] أهل السنن من حديث عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما .
15695- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي, عن ابن عباس: " الذين يقيمون الصلاة "، يقول: الصلوات الخمس= " ومما رزقناهم ينفقون "، يقول: زكاة أموالهم (52) = " أولئك هم المؤمنون حقًّا "، يقول: برئوا من الكفر. ثم وصف الله النفاق وأهله فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ : إلى قوله: أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا [سورة النساء: 150-151] فجعل الله المؤمن مؤمنًا حقًّا, وجعل الكافر كافرًا حقًّا, وهو قوله: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ [سورة التغابن: 2] .
15696- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: " أولئك هم المؤمنون حقًّا "، قال: استحقُّوا الإيمان بحق, فأحقه الله لهم.
* * *
القول في تأويل قوله : لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " لهم درجات "، لهؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم= " درجات ", وهي مراتب رفيعة. (53)
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في هذه " الدرجات " التي ذكر الله أنها لهم عنده، ما هي؟
فقال بعضهم: هي أعمال رفيعة، وفضائل قدّموها في أيام حياتهم.
* ذكر من قال ذلك:
15697- حدثني أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن أبي يحيى القتات, عن مجاهد: " لهم درجات عند ربهم "، قال: أعمال رفيعة. (54)
* * *
وقال آخرون: بل ذلك مراتب في الجنة.
* ذكر من قال ذلك:
15698- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن هشام عن جبلة, عن عطية, عن ابن محيريز: " لهم درجات عند ربهم "، قال: الدرجات سبعون درجة, كل درجة حُضْر الفرس الجواد المضمَّر سبعين سنة. (55)
* * *
وقوله: " ومغفرة "، يقول: وعفو عن ذنوبهم، وتغطية عليها (56) = " ورزق كريم "، قيل: الجنة= وهو عندي: ما أعد الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب وهنيء العيش. (57)
15699- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق, عن هشام, عن عمرو, عن سعيد, عن قتادة: " ومغفرة "، قال: لذنوبهم= " ورزق كريم "، قال: الجنة.
-------------------
الهوامش :
(52) انظر تفسير " حقا " فيما سلف من فهارس اللغة ( حقق ) .
(53) انظر تفسير " الدرجة " فيما سلف 12 : 289 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
(54) الأثر : 15697 - " أبو يحيى القتات " ، ضعيف ، مضى برقم : 12139 .
(55) الأثر : 15698 - " سفيان " هو ، الثوري .
و " هشام " هو : " هشام بن حسان القردوسي " ، مضى برقم : 2827 ، 7287 ، 9837 ، 10258.
و " جبلة " هو " جبلة بن سحيم التيمي " ، مضى برقم : 3003 ، 10258 ، زكان في المطبوعة والمخطوطة : " هشام بن جبلة " ، وهو خطأ صرف .
وأما " عطية " ، فلا أعرف من يكون ، وأنا في شك منه .
و " ابن محيريز " ، هو : " عبد الله بن محيريز الجمحي " ، مضى برقم : 8720 ، 10258 .
وهذا الخبر ، روى مثله في تفسير غير هذه الآية ، فيما سلف برقم : 10258 قال : " حدثنا علي بن الحسين الأزدي ، قال حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن هشام بن حسان ، عن جبلة ابن سحيم ، عن ابن محيريز " ، ليس فيه " ابن عطية " هذا الذي هنا .
و " الحضر " ( بضم فسكون ) ، ارتفاع الفرس في عدوه .
و " المضمر "، هو الذي أعد للسباق والركض .
(56) انظر تفسير " المغفرة " فيما سلف من فهارس اللغة ( غفر ) .
(57) انظر تفسير " كريم " فيما سلف 8 : 259 .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[4] ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ لن تكون مؤمنًا حقًا حتي تجمع بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين أعمال القلوب والجوارح، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده.
وقفة
[4] ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ جمعوا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح.
وقفة
[4] ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ في مفتتح الأنفال ثناء عليهم لعبادتهم، وفي ختامها ثناء عليهم لعملهم، الإيمان الحق: تكامل عبادة وعمل.
وقفة
[4] ﴿أُولَـٰئِكَ﴾ الموصوفون بهذه الصفات الخمس ﴿هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ وصدقًا، ﴿لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي: منازل عالية، متفاوتة العلو والارتفاع في الجنة، ﴿وَ﴾ لهم قبل ذلك ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ كاملة لذنوبهم.
وقفة
[4] ﴿لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ يتنافس أهل الدنيا في نيل الدرجات، والرتب الوظيفية العالية، ويتسابقون إليها وهذا لاحرج فيه إن كان بحق ولكن المؤمنون حقاً وعدهم الله بالدرجات العالية عنده.. فشتان بينهما اللهم ارزقنا الدرجات العلى عندك.
تفاعل
[4] ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.
وقفة
[2-4] صفات المؤمنين حقًا: وجل القلب، زيادة الإيمان، التوكل على الله، إقامة الصلاة، الإنفاق، والجائزة: درجات، مغفرة، رزق كريم.
الإعراب :
- ﴿ أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ: ﴾
- أولاء: اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. هم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان.المؤمنون: خبر «هُمُ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد والجملة الاسمية «هُمُ الْمُؤْمِنُونَ» في محل رفع خبر «أُولئِكَ» وحرك ميم «هُمُ» بالضم للاشباع. والكاف في «أُولئِكَ»: حرف خطاب.
- ﴿ حَقًّا: ﴾
- صفة للمصدر المحذوف أو نائبة عنه منصوبة بالفتحة أي: المؤمنون ايمانا حقا ويجوز أن تكون مصدرا مؤكدا للجملة الاسمية «أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ» أي نائبا عن المفعول المطلق بتقدير: حق ذلك حقا.
- ﴿ لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ: ﴾
- الجملة في محل رفع بدل من الجملة «هُمُ الْمُؤْمِنُونَ» ويجوز أن تكون في محل نصب حالا. من الجملة السابقة. لهم:اللام حرف جر و «هُمُ» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. درجات: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة عند: طرف مكان منصوب بالفتحة على الظرفية المكانية متعلق بدرجات.ربّ: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة و «هُمُ»: ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
- ﴿ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ: ﴾
- الاسمان معطوفان بواوي العطف على «دَرَجاتٌ» مرفوعان مثلها بالضمة. كريم: صفة لرزق مرفوعة مثلها بالضمة. '
المتشابهات :
| الأنفال: 4 | ﴿ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ |
|---|
| الأنفال: 74 | ﴿وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن ذكَر اللهُ عز وجل أعمال المؤمنين: أعمال القلوب وأعمال الجوارج؛ بَيَّنَ هنا أن هؤلاء الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حق الإيمان، قال تعالى: ﴿أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا/ وبعد أن ذكَر اللهُ عز وجل أعمال المؤمنين؛ ذكَرَ هنا ثوابَهم، قال تعالى: /لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)﴾.
﴿ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ .. ﴾
التفسير :
تفسير الآيات من 5 حتى 8:قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم اللّه به،.كذلك أخرج اللّه رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه اللّه تعالى، وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. فحين تبين لهم أن ذلك واقع، جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق، ومما أمر اللّه به ورضيه،. فبهذه الحال ليس للجدال محل [فيها] لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر،. فأما إذا وضح وبان، فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم،.وكذلك الذين عاتبهم اللّه، انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم اللّه، وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة،.فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس،.فخرج معه ثلاثمائة، وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا، يعتقبون عليها، ويحملون عليها متاعهم،.فسمعت بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم، في عَدَدٍ كثير وعُدَّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من الألف. فوعد اللّه المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير،.فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة،.ولكن اللّه تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا. أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم،. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ فينصر أهله وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أي:يستأصل أهل الباطل، ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. لِيُحِقَّ الْحَقَّ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه،. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فلا يبالي اللّه بهم.
الكاف في قوله- تعالى-: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ.. بمعنى مثل، أى: للتشبيه وهي خبر لمبتدأ محذوف هو المشبه، وما بعدها هو المشبه به، ووجه الشبه مطلق الكراهة، وما ترتب على ذلك من خير للمؤمنين.
والمعنى: حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية، مثل حال بعضهم في كراهة الخروج للقتال، مع ما في هذه القسمة والقتال من خير وبركة.
ونحن عند ما نستعرض أحداث غزوة بدر، نرى أنه قد حدث فيها أمران يدلان على عدم الرضا من فريق من الصحابة، ثم أعقبهما الرضا والإذعان والتسليم لحكم الله ورسوله.
أما الأمر الأول فهو أن فريقا من الصحابة- وأكثرهم من الشبان- كانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسوية فيها إجحاف بحقهم، لأنهم هم الذين قاموا بالنصيب الأوفر في القتال، وأن غيرهم لم يكن له بلاؤهم- كما سبق أن بينا في أسباب نزول قوله- تعالى- «يسألونك عن الأنفال.. إلخ» .
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بين الجميع بالسوية، كما أمره الله- تعالى-.
وكان هذا التقسيم خيرا للمؤمنين، إذ أصلح الله به بينهم، وردهم إلى حالة الرضا والصفاء..
وأما الأمر الثاني: فهو أن جماعة منهم كرهوا قتال قريش بعد نجاة العير التي خرجوا من أجل الحصول عليها، وسبب كراهيتهم لذلك أنهم خرجوا بدون استعداد للقتال، لا من حيث العدد ولا من حيث العدد.
ولكنهم استجابوا بعد قليل لما نصحهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من وجوب قتال قريش،.
وكان في هذه الاستجابة نصر الإسلام، ودحر الطغيان.
قال ابن كثير: روى الحافظ بن مردويه- بسنده- عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: «إنى أخبرت عن عير أبى سفيان بأنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمنا إياها؟ فقلنا نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا:
«ما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم» ؟ فقلنا: ما لنا طاقة بقتال العدو ولكننا أردنا العير، ثم قال: «ما ترون في قتال القوم» ؟ فقال المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال بنو إسرائيل لموسى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ.. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
وفي رواية أن أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ تكلموا بكلام سر له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا، وما قررناه قبل ذلك من أن الكاف في قوله- تعالى- كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ..
بمعنى مثل، هو ما نرجحه من بين أقوال المفسرين التي أوصلها بعضهم إلى عشرين قولا.
قال الجمل، قوله كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ.. فيه عشرون وجها، أحدهما: أن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره الأنفال ثابتة لله ثبوتا كما أخرجك ربك، أى: ثبوتا بالحق كإخراجك من بيتك، يعنى أنه لا مرية في ذلك.
الثاني: أن تقديره وأصلحوا ذات بينكم إصلاحا كما أخرجك، وقد التفت من خطاب الجماعة إلى خطاب الواحد.
الثالث: تقديره: وأطيعوا الله ورسوله طاعة ثابتة محققة كما أخرجك أى: كما أن إخراج الله إياك لا مرية فيه ولا شبهة. إلخ.
والحق أن معظم الوجوه النحوية التي ذكرها الجمل وغيره من المفسرين- كأبى حيان والآلوسى- أقول: إن معظم هذه الوجوه يبدو عليها التكلف ومجانبة الصواب.
ورحم الله صاحب الكشاف فقد أهمل أكثر ما ذكره المفسرون في ذلك، واكتفى بوجهين فقال:
قوله: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ. فيه وجهان أحدهما: أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجك. يعنى أن حالهم في كراهية ما رأيت من تنفيل الغزوة مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب.
والثاني: أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدر في قوله: الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ أى: الأنفال استقرت لله والرسول، وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون.
والوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما صاحب الكشاف هو الذي نميل إليه، وهو الذي ذكرناه قبل ذلك بصورة أكثر تفصيلا.
وأضاف- سبحانه- الإخراج إلى ذاته فقال: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ للإشعار بأن هذا الإخراج كان بوحي منه- سبحانه- وبأنه هو الراعي له في هذا الخروج.
والمراد بالبيت في قوله: مِنْ بَيْتِكَ مسكنه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو المراد المدينة نفسها، لأنها مثواه ومستقره، فهي في اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه.
وقوله: بِالْحَقِّ متعلق بقوله: أَخْرَجَكَ والباء للسببية، أى: أخرجك بسبب نصرة الحق، وإعلاء كلمة الدين، وإزهاق باطل المبطلين.
ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف على أنه حال من مفعول أخرجك، وتكون الباء للملابسة، أى: أخرجك إخراجا متلبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل.
قال الآلوسى: وقوله: وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ، أى: للخروج، إما لعدم الاستعداد للقتال، أو للميل للغنيمة، أو للنفرة الطبيعية عنه، وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار، فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة.
والجملة في موضع الحال، وهي حال مقدرة لأن الكراهة وقعت بعد الخروج.
والمعنى الإجمالى للآية الكريمة: حال بعض المسلمين في بدر في كراهة قسمة الغنيمة بالسوية بينهم، مثل حال فريق منهم في كراهة الخروج للقتال، مع أنه قد ثبت أن هذه القسمة وذلك القتال، كان فيهما الخير لهم، إذ الخير فيما قدره الله وأراده، لا فيما يظنون.
قال الإمام أبو جعفر الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه " الكاف " في قوله : ( كما أخرجك ربك ) فقال بعضهم : شبه به في الصلاح للمؤمنين ، اتقاؤهم ربهم ، وإصلاحهم ذات بينهم ، وطاعتهم الله ورسوله .
ثم روى عن عكرمة نحو هذا .
ومعنى هذا أن الله تعالى يقول : كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم ، وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقسمها على العدل والتسوية ، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم ، وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة - وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم ، وإحراز عيرهم - فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم ، وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد - رشدا وهدى ، ونصرا وفتحا ، كما قال تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [ البقرة : 216 ] .
قال ابن جرير : وقال آخرون : معنى ذلك : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره من فريق من المؤمنين ، كذلك هم كارهون للقتال ، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم ، ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال : ( كما أخرجك ربك ) قال : كذلك يجادلونك في الحق .
وقال السدي : أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) لطلب المشركين ( يجادلونك في الحق بعدما تبين )
وقال بعضهم : يسألونك عن الأنفال مجادلة ، كما جادلوك يوم بدر فقالوا : أخرجتنا للعير ، ولم تعلمنا قتالا فنستعد له .
قلت : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان ، التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام ، فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين من خف منهم ، فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر ، وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبه ، فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكة ، فنهضوا في قريب من ألف مقنع ، ما بين التسعمائة إلى الألف ، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا ، وجاء النفير فوردوا ماء بدر ، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد ، لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم ، والتفرقة بين الحق والباطل ، كما سيأتي بيانه .
والغرض : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه خروج النفير ، أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما النفير ، ورغب كثير من المسلمين إلى العير ؛ لأنه كسب بلا قتال ، كما قال تعالى : ( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين )
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة : إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها ؟ فقلنا : نعم ، فخرج وخرجنا ، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا : ما ترون في قتال القوم ؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم ؟ فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ، ولكنا أردنا العير ، ثم قال : ما ترون في قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو : إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) [ المائدة : 24 ] قال : فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم ، قال : فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) وذكر تمام الحديث .
ورواه ابن أبي حاتم ، من حديث ابن لهيعة ، بنحوه .
ورواه ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أبيه ، عن جده قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر ، حتى إذا كان بالروحاء ، خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر . ثم خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله إيانا تريد ؟ فوالذي أكرمك [ بالحق ] وأنزل عليك الكتاب ، ما سلكتها قط ولا لي بها علم ، ولئن سرت [ بنا ] حتى تأتي " برك الغماد " من ذي يمن لنسيرن معك ، ولا نكون كالذين قالوا لموسى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون ، ولعلك أن تكون خرجت لأمر ، وأحدث الله إليك غيره ، فانظر الذي أحدث الله إليك ، فامض له ، فصل حبال من شئت ، واقطع حبال من شئت ، وعاد من شئت ، وسالم من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت ، فنزل القرآن على قول سعد : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) الآيات .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : لما شاور النبي - صلى الله عليه وسلم - في لقاء العدو ، وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر ، أمر الناس فعبئوا للقتال ، وأمرهم بالشوكة ، فكره ذلك أهل الإيمان ، فأنزل الله : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون )
القول في تأويل قوله : كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه " الكاف " التي في قوله: " كما أخرجك "، وما الذي شُبِّه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق.
فقال بعضهم: شُبِّه به في الصلاح للمؤمنين, اتقاؤهم ربهم, وإصلاحهم ذات بينهم, وطاعتهم الله ورسوله. وقالوا: معنى ذلك: يقول الله: وأصلحوا ذات بينكم, فإن ذلك خير لكم, كما أخرج الله محمدًا صلى الله عليه وسلم من بيته بالحقّ، فكان خيرًا له. (58)
* ذكر من قال ذلك:
15700- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود, عن عكرمة: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ"، الآية، أي: إن هذا خيرٌ لكم, كما كان إخراجك من بيتك بالحق خيرًا لك
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: كما أخرجك ربك، يا محمد، من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم يكرهون القتال, فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم.
* ذكر من قال ذلك:
-------------------------
الهوامش :
(58) في المطبوعة ، والمخطوطة : " كان خيرًا له " ، بغير فاء ، والصواب ما أثبت ، وهي في المخطوطة سيئة الكتابة .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
لمسة
[5] ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ الكاف للتشبيه، أي امضِ على ما رأيته صوابًا، من تنفيل الغُزاة في قسمة الغنائم وإن كرهوا، كما مضيت في خروجك من بيتك بالحق وهم كارهون.
وقفة
[5] أسباب النصر ثقيلة على النفوس وقد تكرهها، كره بعضهم غزوة بدر فكانت نصرًا للأمة ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾.
وقفة
[5] قد يكره الإنسان أن يسلك طريقًا ما، ولا يعلم أن هذا الطريق سيحوله في وقت العودة إلى عظيم ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾.
وقفة
[5] ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ عندما يقع ما لا تحب تفاءل أيضًا؛ فبدر الكبرى طلائعها شيء لم يحبوه.
عمل
[5] ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ لا تتحسر عند عدم تحقق مرادك، وارض بما كتب الله لك وقدر؛ فقد يكون خيرًا ساقه الله إليك تسعد به في الدارين.
عمل
[5] ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ عندما يقع لك ما لا تحب؛ فتفاءل، فلعله الطريق إلى ما تحب، کما حدث يوم بدر.
وقفة
[5] من سنن الحياة: أن الأشياء التي تفيدنا والتي هي في صالحنا، ليست هي بالضرورة ما نحب ونرتاح لفعله ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾.
وقفة
[5، 6] غزوة بدر تربي في العبد عبودية التسليم والانقياد للأمر الشرعي والكوني، وإن وقع على خلاف المراد، ألم يقل الله: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾؟ ولكنهم لا يدركون أن القدر يسوقهم إلى أعز نصر ستدركه الدعوة الإسلامية في حياة الرسول ﷺ.
الإعراب :
- ﴿ كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ: ﴾
- لكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا الحال مثل حال إخراجك. ويجوز أن يكون الكاف في محل نصب صفة مصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول أي الأنفال استقرت لله ورسوله وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات اخراج ربك اياك من بيتك وهم كارهون. ما: مصدرية. أخرج: فعل ماض مبني على الفتح والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ربّ: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. و «ما» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة. وجملة «أَخْرَجَكَ رَبُّكَ» صلة «ما» المصدرية لا محل لها.
- ﴿ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأخرجك والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. بالحق: جار ومجرور متعلق بحال أو بصفة لمفعول مطلق محذوف بتقدير: اخراجا متلبسا بالحق. ويجوز أن يتعلق بحال من الضمير الفاعل في «أَخْرَجَكَ» بتقدير: أخرجك وهو محق.
- ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ: ﴾
- الجملة في محل نصب حال أي أخرجك من حال كراهتهم الواو: حالية. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. فريقا: اسم «إِنَّ» منصوب بالفتحة. من المؤمنين: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «فَرِيقاً» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. لكارهون: اللام لام التوكيد- المزحلقة-. كارهون: خبر «إِنَّ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد الحديث عن حُكمِ الغَنائِمِ التي غَنِمها المؤمنون من كفَّارِ قُريشٍ في غزوةِ بَدرٍ؛ يبدأ هنا الحديث عن أحداثِ غزوةِ بَدرٍ 2هـ بخروجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم والصَّحابةِ من المدينةِ للقاءِ قريشٍ معَ كراهةِ البعضِ لذلك، قال تعالى:
﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ .. ﴾
التفسير :
تفسير الآيات من 5 حتى 8:قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم اللّه به،.كذلك أخرج اللّه رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه اللّه تعالى، وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. فحين تبين لهم أن ذلك واقع، جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق، ومما أمر اللّه به ورضيه،. فبهذه الحال ليس للجدال محل [فيها] لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر،. فأما إذا وضح وبان، فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم،.وكذلك الذين عاتبهم اللّه، انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم اللّه، وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة،.فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس،.فخرج معه ثلاثمائة، وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا، يعتقبون عليها، ويحملون عليها متاعهم،.فسمعت بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم، في عَدَدٍ كثير وعُدَّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من الألف. فوعد اللّه المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير،.فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة،.ولكن اللّه تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا. أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم،. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ فينصر أهله وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أي:يستأصل أهل الباطل، ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. لِيُحِقَّ الْحَقَّ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه،. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فلا يبالي اللّه بهم.
وقوله- تعالى-: يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ حكاية لما حدث من هذا الفريق الكاره للقتال، وتصوير معجز لما استبد به من خوف وفزع.
والمراد بقوله يُجادِلُونَكَ مجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن القتال وقولهم له: ما كان خروجنا إلا للعير، ولو أخبرتنا بالقتال لأعددنا العدة له.
والضمير يعود للفريق الذي كان كارها للقتال.
والمراد بالحق الذي جادلوا فيه: أمر القتال الذي حضهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعدوا أنفسهم له.
وقوله: بَعْدَ ما تَبَيَّنَ متعلق: يُجادِلُونَكَ وما مصدرية والضمير في الفعل تَبَيَّنَ يعود على الحق.
والمراد بتبينه: إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم سينصرون على أعدائهم فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم قبل نجاة العير بأن الله وعده الظفر بإحدى الطائفتين: العير أو النفير، فلما نجت العير علم أن الظفر الموعود به إنما هو النفير، أى: على المشركين الذين استنفرهم أبو سفيان للقتال لا على العير، أى: الإبل الحاملة لأموال المشركين.
والمعنى: يجادلك بعض أصحابك- يا محمد- فِي الْحَقِّ أى في أمر القتال بَعْدَ ما تَبَيَّنَ أى، بعد ما تبين لهم الحق بإخبارك إياهم بأن النصر سيكون حليفهم، وأنه لا مفر لهم من لقاء قريش تحقيقا لوعد الله الذي وعد بإحدى الطائفتين.
وقوله: كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ أى: يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت، وهو ناظر إلى أسبابه، ومشاهد لموجباته.
والجملة في محل نصب على الحالية من الضمير في قوله: لَكارِهُونَ.
وفي هذه الجملة الكريمة تصوير معجز لما استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من القتال يسبب قلة عددهم وعددهم.
وقوله: بَعْدَ ما تَبَيَّنَ زيادة في لومهم، لأن الجدال في الحق بعد تبينه أقبح من الجدال فيه قبل ظهوره.
وقال مجاهد : يجادلونك في الحق : في القتال . وقال محمد بن إسحاق : ( يجادلونك في الحق [ بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ] ) أي : كراهية للقاء المشركين ، وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم .
وقال السدي : ( يجادلونك في الحق بعدما تبين ) أي : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به .
قال ابن جرير : وقال آخرون : عنى بذلك المشركين .
حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله تعالى : ( يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) قال : هؤلاء المشركون ، جادلوه في الحق ( كأنما يساقون إلى الموت ) حين يدعون إلى الإسلام ) وهم ينظرون ) قال : وليس هذا من صفة الآخرين ، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر .
ثم قال ابن جرير : ولا معنى لما قاله ؛ لأن الذي قبل قوله : ( يجادلونك في الحق ) خبر عن أهل الإيمان ، والذي يتلوه خبر عنهم ، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين .
وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق ، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام ، والله أعلم . .
15701- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " كما أخرجك ربك من بيتك بالحق "، قال: كذلك يجادلونك في الحق.
15702 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " كما أخرجك ربك من بيتك بالحق "، كذلك يجادلونك في الحقِّ, القتالِ.
15703- . . . . قال: حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: " كما أخرجك ربك من بيتك بالحق "، قال: كذلك أخرجك ربك. (59)
15704- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: أنـزل الله في خروجه = يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم= إلى بدر، ومجادلتهم إياه فقال: " كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون "، لطلب المشركين, " يجادلونك في الحق بعد ما تبين " .
* * *
واختلف أهل العربية في ذلك.
فقال بعض نحويي الكوفيين: ذلك أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم, على كره من أصحابه, كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العِير وهم كارهون. (60)
* * *
وقال آخرون منهم: معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال مجادلةً، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: " أخرجتنا للعِير, ولم تعلمنا قتالا فنستعدَّ له ".
وقال بعض نحويي البصرة، يجوز أن يكون هذا " الكاف " في (كما أخرجك)، على قوله: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ، (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق). وقال: " الكاف " بمعنى " على ". (61)
* * *
وقال آخرون منهم (62) هي بمعنى القسم. قال: ومعنى الكلام: والذي أخرجك ربّك. (63)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قولُ من قال في ذلك بقول مجاهد, وقال: معناه: كما أخرجك ربك بالحقّ على كره من فريق من المؤمنين, كذلك يجادلونك في الحق بعد ما تبين= لأن كلا الأمرين قد كان, أعني خروج بعض من خرج من المدينة كارهًا, وجدالهم في لقاء العدو وعند دنوِّ القوم بعضهم من بعض, فتشبيه بعض ذلك ببعض، مع قرب أحدهما من الآخر، أولى من تشبيهه بما بَعُد عنه.
* * *
وقال مجاهد في " الحق " الذي ذكر أنهم يجادلون فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما تبينوه: هو القتال.
15705- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (يجادلونك في الحق)، قال: القتال.
15706 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة، قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.
15707 - حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.
* * *
وأما قوله: (من بيتك)، فإن بعضهم قال: معناه: من المدينة.
* ذكر من قال ذلك:
15708- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة، قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي بزة: (كما أخرجك ربك من بيتك)، المدينة، إلى بدر.
15709- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، أخبرني محمد بن عباد بن جعفر في قوله: (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق)، قال: من المدينة إلى بدر.
* * *
وأما قوله: (وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون)، فإن كراهتهم كانت، كما:-
15710- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق قال، حدثني محمد بن مسلم الزهري, وعاصم بن عمر بن قتادة, وعبد الله بن أبي بكر، ويزيد بن رومان, عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا, عن عبد الله بن عباس, قالوا: لما سمع رَسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشأم, ندب إليهم المسلمين, (64) وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم, (65) فاخرجوا إليها، لعل الله أن ينفِّلكموها! فانتدب الناس, فخفّ بعضهم وثقُل بعضهم, وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربًا. (66)
15711- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون)، لطلب المشركين.
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: (يجادلونك في الحق بعد ما تبين).
فقال بعضهم: عُني بذلك: أهلُ الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه حين توجَّه إلى بدر للقاء المشركين.
* ذكر من قال ذلك:
15712- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قال، لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء القوم, وقال له سعد بن عبادة ما قال، وذلك يوم بدر, أمرَ الناس, فتعبَّوْا للقتال, (67) وأمرهم بالشوكة, وكره ذلك أهل الإيمان, فأنـزل الله: (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) .
15713- حدثني ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق قال: ثم ذكر القومَ= يعني أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم = ومسيرَهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , حين عرف القوم أن قريشًا قد سارت إليهم, وأنهم إنما خرجوا يريدون العيرَ طمعًا في الغنيمة, فقال: (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق)، إلى قوله: (لكارهون)، أي كراهيةً للقاء القوم, وإنكارًا لمسير قريش حين ذُكِروا لهم. (68)
* * *
وقال آخرون: عُني بذلك المشركون.
* ذكر من قال ذلك:
15714- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)، قال: هؤلاء المشركون، جادلوه في الحق (69) = " كأنما يساقون إلى الموت "، حين يدعون إلى الإسلام=(وهم ينظرون)، قال: وليس هذا من صفة الآخرين, هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر.
15715- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا يعقوب بن محمد قال، حدثني عبد العزيز بن محمد, عن ابن أخي الزهري, عن عمه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر: (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)، خروجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العِير. (70)
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحاق, من أن ذلك خبرٌ من الله عن فريق من المؤمنين أنهم كرهوا لقاء العدو, وكان جدالهم نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا: " لم يُعلمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم, وإنما خرجنا للعير ". ومما يدلّ على صحته قولُه (71) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ، ففي ذلك الدليلُ الواضح لمن فهم عن الله، أن القوم قد كانوا للشوكة كارهين، وأن جدالهم كان في القتال، كما قال مجاهد, كراهيةً منهم له= وأنْ لا معنى لما قال ابن زيد, لأن الذي قبل قوله: (يجادلونك في الحق)، خبرٌ عن أهل الإيمان, والذي يتلوه خبرٌ عنهم, فأن يكون خبرًا عنهم، أولى منه بأن يكون خبرًا عمن لم يجرِ له ذكرٌ.
* * *
وأما قوله: (بعد ما تبين)، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله.
فقال بعضهم: معناه: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله.
* ذكر من قال ذلك:
15816- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: بعد ما تبين أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به.
* * *
وقال آخرون: معناه: يجادلونك في القتال بعدما أمرت به.
* ذكر من قال ذلك:
15717- رواه الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس. (72)
* * *
وأما قوله: (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)، فإن معناه: كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدوّ، من كراهتهم للقائهم إذا دعوا إلى لقائهم للقتال، " يساقون إلى الموت ".
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
15718- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، قال ابن إسحاق: (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)، أي كراهةً للقاء القوم, وإنكارًا لمسير قريش حين ذكروا لهم. (73)
----------------------
الهوامش :
(59) هكذا في المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب : " قال : كذلك يجادلونك " ، وهو ما تدل عليه الآثار السالفة عن مجاهد .
(60) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 403
(61) في المطبوعة : " وقيل : الكاف ... " ، كأنه قول آخر ، والصواب ما في المخطوطة . ولعل قائل هذا هو الأخفش ، لأنه الذي قال : " الكاف بمعنى : على " ، وزعم أن من كلام العرب إذا قيل لأحدهم : " كيف أصبحت " ، أن يقول : " كخير " ، والمعنى : على خير .
وانظر تفسير " كما " فيما سلف 3 : 209 ، في قوله تعالى : " كما أرسلنا فيكم رسولا " [ سورة البقرة : 151 ] .
(62) في المطبوعة : " وقال آخرون " ، جمعًا ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب ، وقائل ذلك هو أبو عبيدة معمر بن المثنى .
(63) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 : 240 ، 241 .
(64) " ندب الناس إلى حرب أو معونة ، فانتدبوا " ، أي : دعاهم فاستجابوا وأسرعوا إليه .
(65) " العير " ، ( بكسر العين ) : القافلة ، وكل ما امتاروا عليه من أبل وحمير وبغال . وهي قافلة تجارة قريش إلى الشام .
(66) الأثر: 15710 - سيرة ابن هشام 2 :257 ، 258.
(67) " عبى الجيش " و " عبأة " بالهمز ، واحد . و " تعبوا للقتال " و " تعبأوا " ، تهيأوا له .
(68) الأثر : 15713- سيرة ابن هشام 2 : 322 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 15655 .
(69) في المطبوعة : " جادلوك " ، وأثبت الصواب الجيد من المخطوطة .
(70) الأثر : 15715 - " يعقوب بن محمد الزهري " ، مضى قريبًا برقم 15654 ، وهو يروي عن ابن أخي الزهري مباشرة ، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة .
و" عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي " ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 10676 .
و " ابن أخي الزهري " ، هو " محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري " ، ثقة ، متكلم فيه ، روى له الجماعة . يروي عن عمه " ابن شهاب الزهري " .
(71) في المطبوعة والمخطوطة : " على صحة قوله " ، والصواب ما أثبت .
(72) الأثر : 15717 - هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة ، لم يذكر نصًا ، وكأن صواب العبارة : " رواه الكلبي ... " .
(73) الأثر : 15718 - سيرة بن هشام 2 : 322 ، وهو جزء من الخبر السالف رقم : 15713 .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[6] تأمل كيف سمى الله تعالى قتال أعدائه ومناجزتهم حقًا، خلافًا لمن يسميه بأسماء مشوهة ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾.
وقفة
[6] ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان.
وقفة
[6] ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ الجدال في الحق بعد تبينه أقبح من الجدال فيه قبل ظهوره.
وقفة
[6] ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ إذا ظهر الحق واستبان، فلا يصح أن يجادل فيه أهل العقل والإيمان.
عمل
[6] ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ إذا بان لك الحق فاستجب واترك الجدال.
عمل
[6] ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ جادلوا في الحق بعدما تبين؛ لكن القرآن لم يسلبهم وصف الإيمان، لا تسلب مخالفيك حقوقهم.
وقفة
[6] ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ لو كان أحدٌ غير الأنبياء معصومًا من هذا لعصم منه أصحاب النبي ﷺ وأفضل الخلق.
عمل
[6] لا تجادل في الحق بعد تبينه لك خشية من تبعاته ومشقته عليك ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾.
وقفة
[6] ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ إنهم يساقون إلى المعركة، ولكن المعركة ليست هي الموت, الموت هو القدر, ليس شيئًا آخر.
وقفة
[6] ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ كانوا غير متحمسين للسير، بل مدفوعين إليه دفعًا، كأنهم ينتظرون الموت لأن مواجهة ألف رجل من قريش أمام ثلاثمائة تجعل الموت أقرب؛ لكن غاب عنهم أن الله مع القلة المؤمنة ضد الكثرة الكافرة.
وقفة
[6] ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ کره فريق منهم القتال وقالوا: ما كان خروجنا إلا للعير، ولو أخبرتنا بالقتال لأعددنا له عدة، وكان خوفهم لثلاثة أمور: أحدها: قلة العدد، وثانيها: أنهم كانوا رجالة، روي أنه ما كان فيهم إلا فارسان، وثالثها: قلة السلاح معهم.
الإعراب :
- ﴿ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. في الحق: جار ومجرور متعلق بيجادلون.
- ﴿ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ: ﴾
- بعد: ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة متعلق بيجادلونك وهو مضاف. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة. تبين: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الحقّ. وجملة «تَبَيَّنَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ: ﴾
- كأنما: كافة ومكفوفة. يساقون إلى الموت:تعرب إعراب «يجادلون في الحق».
- ﴿ وَهُمْ يَنْظُرُونَ: ﴾
- الواو حالية. هم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ينظرون: تعرب اعراب «يجادلون» والجملة الفعلية «يَنْظُرُونَ» في محل رفع خبر «هُمْ» والجملة الاسمية «هُمْ يَنْظُرُونَ» في محل نصب حال. '
المتشابهات :
| الأنفال: 6 | ﴿يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلۡمَوۡتِ﴾ |
|---|
| البقرة: 109 | ﴿حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ﴾ |
|---|
| النساء: 115 | ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ |
|---|
| التوبة: 113 | ﴿وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ |
|---|
| محمد: 25 | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّيۡطَٰنُ﴾ |
|---|
| محمد: 32 | ﴿وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ عز وجل أن بعض الصحابة كَرِهوا لقاءَ كُفَّارِ قُريشٍ يَومَ بَدرٍ؛ ذكر هنا دليل كراهيتهم، قال تعالى:
﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
ما تبين:
وقرئ:
ما بين، بضم الياء من غير تاء، وهى قراءة عبد الله.
مدارسة الآية : [7] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ .. ﴾
التفسير :
تفسير الآيات من 5 حتى 8:قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم اللّه به،.كذلك أخرج اللّه رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه اللّه تعالى، وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. فحين تبين لهم أن ذلك واقع، جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق، ومما أمر اللّه به ورضيه،. فبهذه الحال ليس للجدال محل [فيها] لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر،. فأما إذا وضح وبان، فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم،.وكذلك الذين عاتبهم اللّه، انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم اللّه، وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة،.فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس،.فخرج معه ثلاثمائة، وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا، يعتقبون عليها، ويحملون عليها متاعهم،.فسمعت بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم، في عَدَدٍ كثير وعُدَّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من الألف. فوعد اللّه المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير،.فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة،.ولكن اللّه تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا. أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم،. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ فينصر أهله وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أي:يستأصل أهل الباطل، ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. لِيُحِقَّ الْحَقَّ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه،. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فلا يبالي اللّه بهم.
ثم حكى- سبحانه- جانبا من مظاهر فضله على المؤمنين، مع جزع بعضهم من قتال عدوه وعدوهم، وإيثارهم العير على النفير فقال: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ.
والمراد بإحدى الطائفتين: العير أو النفير، والخطاب للمؤمنين.
والمراد بغير ذات الشوكة: العير، والمراد بذات الشوكة: النفير.
والشوكة في الأصل واحدة الشوك وهو النبات الذي له حد، ثم استعيرت للشدة والحدة، ومنه قولهم: رجل شائك السلاح أى: شديد قوى.
والمعنى: واذكروا- أيها المؤمنون- وقت أن وعدكم الله- تعالى- على لسان رسوله-- بأن إحدى الطائفتين: العير أو النفير هي لكم تظفرون بها، وتتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وأنتم مع ذلك تودون وتتمنون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح وهي العير.
وعبر- سبحانه- عن وعده لهم بصيغة المضارع يَعِدُكُمُ مع أن هذا الوعد كان قبل نزول الآية، لاستحضار صورة الموعود به في الذهن، ولمداومة شكره- سبحانه- على ما وهبهم من نصر وفوز.
وإنما وعدهم- سبحانه- إحدى الطائفتين على الإبهام مع أنه كان يريد إحداهما وهي النفير، ليستدرجهم إلى الخروج إلى لقاء العدو حتى ينتصروا عليه، وبذلك تزول هيبة المشركين من قلوب المؤمنين.
وقوله إِحْدَى مفعول ثان ليعد، وقوله: أَنَّها لَكُمْ بدل اشتمال من إِحْدَى مبين لكيفية الوعد.
أى: يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم، ومختصة لكم، تتسلطون عليها تسلط الملاك، وتتصرفون فيها كيفما شئتم.
وقوله: وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ معطوف على قوله: يَعِدُكُمُ أى: وعدكم- سبحانه- إحدى الطائفتين بدون تحديد لإحداهما، وأنتم تحبون أن تكون لكم طائفة العير التي لا قتال فيها يذكر، على طائفة النفير التي تحتاج منكم إلى قتال شديد، وإلى بذل للمهج والأرواح.
وفي هذه الجملة تعريض بهم، حيث كرهوا القتال، وأحبوا المال، وما هكذا يكون شأن المؤمنين الصادقين.
ثم بين لهم- سبحانه- أنهم وإن كانوا يريدون العير، إلا أنه- سبحانه- يريد لهم النفير، ليعلو الحق، ويزهق الباطل، فقال: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ، وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ.
أى: ويريد الله بوعده غير ما أردتم، أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ أى أن يظهر الحق ويعلمه بآياته المنزلة على رسوله، وبقضائه الذي لا يتخلف، وأن يستأصل الكافرين ويذلهم،ويقطع دابرهم أى آخرهم الذي يدبرهم.
والدابر: التابع من الخلف، يقال: دبر فلان القوم يدبرهم دبورا، إذا كان آخرهم في المجيء، والمراد أنه سبحانه يريد أن يستأصلهم استئصالا.
وقد هلك في غزوة بدر عدد كبير من صناديد قريش الذين كانوا يحاربون الإسلام، ويستهزئون بتعاليمه.
قال صاحب الكشاف في معنى الآية الكريمة، قوله: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ ... يعنى أنكم تريدون العاجلة وسفساف الأمور، وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم، والله- عز وجل- يريد معالى الأمور، وما يرجع إلى عمارة الدين، ونصرة الحق، وعلو الكلمة والفوز في الدارين، وشتان ما بين المرادين ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة، وكسر قوتهم بضعفكم، وغلب كثرتهم بقلتكم، وأعزكم وأذلهم، وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما فيها».
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : حدثنا يحيى بن أبي بكير وعبد الرزاق قالا حدثنا إسرائيل ، عن سمال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس دونها شيء فناداه العباس بن عبد المطلب - قال عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه - ثم اتفقا : إنه لا يصلح لك ، قال : ولم ؟ قال : لأن الله - عز وجل - إنما وعدك إحدى الطائفتين ، وقد أعطاك ما وعدك .
إسناد جيد ، ولم يخرجه .
ومعنى قوله تعالى ( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) أي : يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال ، تكون لهم وهي العير ( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ) أي : هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ، ليظفركم بهم ويظهركم عليهم ، ويظهر دينه ، ويرفع كلمة الإسلام ، ويجعله غالبا على الأديان ، وهو أعلم بعواقب الأمور ، وهو الذي دبركم بحسن تدبيره ، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم ، كما قال تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم [ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] [ البقرة : 216 ] ) .
وقال محمد بن إسحاق - رحمه الله - : حدثني محمد بن مسلم الزهري ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا ، عن عبد الله بن عباس - كل قد حدثني بعض هذا الحديث ، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - قالوا : لما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم ، وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس ، فخف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقى حربا ، وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ، ويسأل من لقي من الركبان ، تخوفا على أمر الناس ، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان : أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك ، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري ، فبعثه إلى أهل مكة ، وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة ، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له " ذفران " ، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل ، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس ، وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر - رضي الله عنه - فقال ، فأحسن ، ثم قام عمر - رضي الله عنه - فقال ، فأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أمرك الله به ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) [ المائدة : 24 ] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق ، لو سرت بنا إلى " برك الغماد " - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا ، ودعا له بخير ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أشيروا علي أيها الناس - وإنما يريد الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس ، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله ، إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة ، من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل قال : فقال : فقد آمنا بك ، وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت . فوالذي بعثك بالحق ، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل الله [ أن ] يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول سعد ، ونشطه ذلك ، ثم قال : سيروا على بركة الله وأبشروا ، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم .
وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا ، وكذلك قال السدي ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغير واحد من علماء السلف والخلف ، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق .
القول في تأويل قوله : وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واذكروا، أيها القوم=(إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين)، يعني إحدى الفرقتين, (74) فرقة أبي سفيان بن حرب والعير, وفرقة المشركين الذين نَفَروا من مكة لمنع عيرهم.
* * *
وقوله: (أنها لكم)، يقول: إن ما معهم غنيمة لكم=(وتودون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم)، يقول: وتحبون أن تكون تلك الطائفة التي ليست لها شوكة= يقول: ليس لها حدٌّ، (75) ولا فيها قتال= أن تكون لكم. يقول: تودُّون أن تكون لكم العيرُ التي ليس فيها قتال لكم، دون جماعة قريش الذين جاءوا لمنع عيرهم، الذين في لقائهم القتالُ والحربُ.
* * *
وأصل " الشوكة " من " الشوك ".
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
15719- حدثنا علي بن نصر, وعبد الوارث بن عبد الصمد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال، حدثنا أبان العطار قال، حدثنا هشام بن عروة, عن عروة: أن أبا سفيان أقبل ومن معه من رُكبان قريش مقبلين من الشأم, (76) فسلكوا طريق الساحل. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ندب أصحابه, وحدّثهم بما معهم من الأموال، وبقلة عددهم. فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركب معه، لا يرونها إلا غنيمة لهم, لا يظنون أن يكون كبيرُ قتالٍ إذا رأوهم. وهي التي أنـزل الله فيها (77) (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) . (78)
15720- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن مسلم الزهري, وعاصم بن عمر بن قتادة, وعبد الله بن أبي بكر, ويزيد بن رومان, عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا, (79) عن عبد الله بن عباس, كُلٌّ قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سُقت من حديث بدر, قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشأم، ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش، فيها أموالهم, فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفِّلكموها! فانتدب الناس, فخف بعضهم وثقل بعض, وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربًا. وكان أبو سفيان يستيقن حين دنا من الحجاز ويتحسس الأخبار، (80) ويسأل من لقي من الركبان، تخوفًا على أموال الناس, (81) حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان: " أن محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعِيرك "! (82) فحذر عند ذلك, واستأجر ضمضم بن عمرو الغِفاري, فبعثه إلى مكة, وأمره أن يأتي قريشًا يستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة. (83) وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديًا يقال له " ذَفِرَان ", فخرج منه, (84) حتى إذا كان ببعضه، نـزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عِيرهم, فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ, وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر رضوان الله عليه، فقال فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه، فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض إلى حيث أمرك الله، فنحن معك, والله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ( اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ )، [سورة المائدة: 24]، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون! فوالذي بعثك بالحق، لئن سرت بنا إلى بَرْك الغِمَاد = يعني: مدينة الحبشة (85) = لجالدنا معك مَن دونه حتى تبلغه! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا, ثم دعا له بخيرٍ, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا عليّ أيها الناس!= وإنما يريد الأنصار, وذلك أنهم كانوا عَدَدَ الناس, وذلك أنهم حين بايعوه على العقبة قالوا: " يا رسول الله، إنا برآء من ذِمامك حتى تصل إلى ديارنا, فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا, (86) نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا "، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نُصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه, (87) وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٍّ من بلادهم= قال: فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل! قال: فقد آمنا بك وصدَّقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق, وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت, فوالذي بعثك بالحق إن استعرضتَ بنا هذا البحرَ فخضته لخُضناه معك، (88) ما تخلف منا رجل واحد, وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا, (89) إنا لصُبُرٌ عند الحرب, صُدُقٌ عند اللقاء, (90) لعلّ الله أن يريك منا ما تَقرُّ به عينك, فسر بنا على بركة الله! فسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك, ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا, فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, (91) والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدًا ". (92)
15721- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: أن أبا سفيان أقبل في عير من الشأم فيها تجارة قريش, وهي اللَّطيمة, (93) فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد أقبلت، فاستنفر الناس, فخرجوا معه ثلثمائة وبضعة عشر رجلا. فبعث عينًا له من جُهَينة, حليفًا للأنصار، يدعى " ابن أريقط", (94) فأتاه بخبر القوم. وبلغ أبا سفيان خروج محمد صلى الله عليه وسلم , فبعث إلى أهل مكة يستعينهم, فبعث رجلا من بني غِفار يدعى ضمضم بن عمرو, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر بخروج قريش, فأخبره الله بخروجهم, فتخوف من الأنصار أن يخذلوه ويقولوا: " إنا عاهدنا أن نمنعك إن أرادك أحد ببلدنا "! فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب العِير, فقال له أبو بكر رحمة الله عليه: إنّي قد سلكت هذا الطريق, فأنا أعلم به, وقد فارقهم الرجل بمكان كذا وكذا, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم , ثم عاد فشاورهم, فجعلوا يشيرون عليه بالعير. فلما أكثر المشورة, تكلم سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله, أراك تشاور أصحابك فيشيرون عليك، وتعود فتشاورهم, فكأنك لا ترضى ما يشيرون عليك، وكأنك تتخوف أن تتخلف عنك الأنصار! أنت رسول الله, وعليك أنـزل الكتاب, وقد أمرك الله بالقتال، ووعدك النصر, والله لا يخلف الميعاد, امض لما أمرت به، فوالذي بعثك بالحق لا يتخلف عنك رجل من الأنصار! ثم قام المقداد بن الأسود الكندي فقال: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: ( اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ )، [سورة المائدة: 24]، ولكنا نقول: أقدم فقاتل، إنا معك مقاتلون! ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: إن ربي وعدني القوم، وقد خرجوا، فسيروا إليهم! فساروا.
15722- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، قال: الطائفتان إحداهما أبو سفيان بن حرب إذ أقبل بالعير من الشأم, والطائفة الأخرى أبو جهل معه نفر من قريش. فكره المسلمون الشوكة والقتال, وأحبوا أن يلقوا العير, وأراد الله ما أراد.
15723- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين)، قال: أقبلت عير أهل مكة = يريد: من الشأم (95) = فبلغ أهل المدينة ذلك, فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير. فبلغ ذلك أهل مكة, فسارعوا السير إليها، لا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين, فكانوا أن يلقوا العير أحبَّ إليهم، وأيسر شوكة، وأحضر مغنمًا. فلما سبقت العير وفاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم, فكره القوم مسيرهم لشوكةٍ في القوم.
15724- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، قال: أرادوا العير. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول, فأغار كُرْز بن جابر الفهري يريد سَرْح المدينة حتى بلغ الصفراء, (96) فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فركب في أثره, فسبقه كرز بن جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم , فأقام سنَتَه. ثم إن أبا سفيان أقبل من الشأم في عير لقريش, حتى إذا كان قريبًا من بدر, نـزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، فنفر النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين, وهم يومئذ ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا منهم سبعون ومئتان من الأنصار, وسائرهم من المهاجرين. وبلغ أبا سفيان الخبر وهو بالبطم, (97) فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة, فنفرت قريش وغضبت.
15725- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، قال: كان جبريل عليه السلام قد نـزل فأخبره بمسير قريش وهي تريد عيرها, ووعده إما العيرَ, وإما قريشًا وذلك كان ببدر, وأخذوا السُّقاة وسألوهم, فأخبروهم, فذلك قوله: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، هم أهل مكة.
15726- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، إلى آخر الآية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهم يريدون يعترضون عِيرًا لقريش. قال: وخرج الشيطان في صورة سُرَاقة بن جعشم, حتى أتى أهل مكة فاستغواهم، وقال: إنّ محمدًا وأصحابه قد عرضوا لعيركم! وقال: لا غالبَ لكم اليوم من الناس من مثلكم, وإنّي جار لكم أن تكونوا على ما يكره الله! فخرجوا ونادوا أن لا يتخلف منا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه! وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالروحاء عينًا للقوم, فأخبره بهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وعدكم العير أو القوم! فكانت العير أحبّ إلى القوم من القوم, كان القتال في الشوكة, والعير ليس فيها قتال, وذلك قول الله عز وجل: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، قال: " الشوكة "، القتال, و " غير الشوكة "، العير.
15727- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال، حدثنا عبد الله بن وهب, عن ابن لهيعة, عن ابن أبي حبيب, عن أبي عمران, عن أبي أيوب قال: أنـزل الله جل وعز: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم)، فلما وعدنا إحدى الطائفتين أنها لنا، طابت أنفسنا: و " الطائفتان "، عِير أبي سفيان, أو قريش. (98)
15728 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك, عن ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي حبيب, عن أسلم أبي عمران الأنصاري, أحسبه قال: قال أبو أيوب=: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، قالوا: " الشوكة " القوم و " غير الشوكة " العير، فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين، إما العير وإما القوم, طابت أنفسنا. (99)
15729- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثني يعقوب بن محمد قال، حدثني غير واحد في قوله: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، إن " الشوكة "، قريش.
15730- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، هي عير أبي سفيان, ودّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العير كانت لهم، وأن القتال صُرِف عنهم.
15731- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، أي الغنيمة دون الحرب. (100)
* * *
وأما قوله: (أنها لكم)، ففتحت على تكرير " يعد ", وذلك أن قوله: (يعدكم الله)، قد عمل في " إحدى الطائفتين ".
فتأويل الكلام: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين)، يعدكم أن إحدى الطائفتين لكم, كما قال: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً . [سورة الزخرف : 66 ]. (101)
* * *
قال: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)، فأنث " ذات "، لأنه مراد بها الطائفة. (102) ومعنى الكلام: وتودون أن الطائفة التي هي غير ذات الشوكة تكون لكم, دون الطائفة ذات الشوكة.
القول في تأويل قوله : وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)
* * *
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يحق الإسلام ويعليه (103)
= " بكلماته ", يقول: بأمره إياكم، أيها المؤمنون، بقتال الكفار, وأنتم تريدون الغنيمة، والمال (104) وقوله: (ويقطع دابر الكافرين)، يقول: يريد أن يَجُبَّ أصل الجاحدين توحيدَ الله.
* * *
وقد بينا فيما مضى معنى " دابر ", وأنه المتأخر, وأن معنى: " قطعه "، الإتيان على الجميع منهم. (105)
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
15731- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد, في قول الله: (ويريد الله أن يحق الحق بكلماته)، أن يقتل هؤلاء الذين أراد أن يقطع دابرهم, هذا خيرٌ لكم من العير.
15732- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين)، أي: الوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر. (106)
----------------------
الهوامش :
(74) انظر تفسير " الطائفة " فيما سلف 12 : 560 ، تعليق : 3 ، والمراجع هناك .
(75) " الحد " ( بفتح الحاء ) هو : الحدة ( بكسر الحاء ) ، والبأس الشديد ، والنكاية .
(76) " الركبان " و " الركب " ، أصحاب الإبل في السفر ، وهو اسم جمع لا واحد له .
(77) في المطبوعة : " وهي ما أنزل الله " ، وفي المخطوطة : " وهي أنزل الله " ، وأثبت ما في تاريخ الطبري .
(78) الأثر : 15719 - " علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضي " ، الثقة الحافظ ، شيخ الطبري ، روى عنه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والبخاري ، في غير الجامع الصحيح . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 207 .
و " عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري " ، شيخ الطبري . ثقة ، مضى برقم : 2340 .
وأبوه : " عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري " ، ثقة ، مضى مرارًا كثيرة .
و " أبان العطار " ، هو " أبان بن يزيد العطار " ، ثقة ، مضى برقم : 3832 ، 9656 .
وهذا الخبر رواه أبو جعفر ، بإسناده هذا في التاريخ 2 : 267 ، مطولا مفصلا ، وهو كتاب من عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان . وكتاب عروة إلى عبد الملك بن مروان كتاب طويل رواه الطبري مفرقًا في التاريخ ، وسأخرجه مجموعًا في تعليقي على الأثر 16083 .
(79) القائل " من علمائنا ... " إلى آخر السياق ، هو محمد بن إسحاق .
(80) في المطبوعة ، وفي تاريخ الطبري ، وفي سيرة ابن هشام : " وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس " ، ليس فيها " يستقين " ، وليس فيها واو العطف في " يتحسس " ، ولكن المخطوطة واضحة ، فأثبتها .
وكان في المطبوعة : " يتجسس " بالجيم ، وإنما هي بالحاء المهملة ، و " تحسس الخبر " ، تسمعه بنفسه وتبحثه وتطلبه .
(81) في المطبوعة : " تخوفًا من الناس " ، وفي سيرة ابن هشام : " تخوفًا على أمر الناس " ، وأثبت ما في تاريخ الطبري .
(82) " استنفر الناس " ، استنجدهم واستنصرهم ، وحثهم على الخروج للقتال .
(83) عند هذا الموضع انتهي ما في سيرة ابن هشام 2 : 257 ، 258 ، وسيصله بالآتي في السيرة بعد 2 : 266 ، وعنده انتهي الخبر في تاريخ الطبري 2 : 270 ، وسيصله بالآتي في التاريخ أيضًا 2 : 273 .
وانظر التخريج في آخر هذا الخبر .
(84) في السيرة وحدها " فجزع فيه " ، وهي أحق بهذا الموضع ، ولكني أثبت ما في لمطبوعة والمخطوطة والتاريخ . و " جزع الوادي " ، قطعه عرضًا .
(85) " برك الغماد " ، " برك " ( بفتح الباء وكسرها ) ، و " الغماد " ، ( بكسر الغين وضمها " . قال الهمداني : " برك الغماد " ، في أقاصي اليمن ( معجم ما استعجم : 244 ) .
(86) " الذمام " و " الذمة " ، العهد والكفالة والحرمة .
(87) في المطبوعة " خاف أن لا تكون الأنصار " ، وأثبت ما في سيرة ابن هشام ، وتاريخ الطبري . و " يتخوف " ساقطة من المخطوطة .
و " دهمه " ( بفتح الهاء وكسرها ) : إذا فاجأه على غير استعداد .
(88) " استعرض البحر ، أو الخطر " : أقبل عليه لا يبالي خطره . وهذا تفسير للكلمة ، استخرجته ، لا تجده في المعاجم .
(89) في المطبوعة : " أن يلقانا عدونا غدًا " ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وهذا هو الموافق لما في سيرة ابن هشام ، وتاريخ الطبري .
(90) " صدق " ( بضمتين ) جمع " صدوق " ، مجازه : أن يصدق في قتاله أو عمله ، أي يجد فيه جدًا ، كالصدق في القول الذي لا يخالطه كذب ، أي ضعف .
(91) قوله في آخر الجملة الآتية " غدًا " ، ليست في سيرة ابن هشام ولا في التاريخ ، ولكنها ثابتة في المخطوطة .
(92) الأثر : 15720 - هذا الخبر ، روى صدر منه فيما سلف : 15710 . وهو في سيرة ابن هشام مفرق 2 : 257 ، 258 ، ثم 2 : 266 ، 267 .
وفي تاريخ الطبري 2 : 270 ثم 2 : 273 ، ثم تمامه أيضًا في : 273 .
(93) " اللطيمة " ، هو الطيب ، و " لطيمة المسك " ، وعاؤه ثم سموا العير التي تحمل الطيب والعسجد ، ونفيس بز التجار : " اللطيمة " .
(94) في المطبوعة : " ابن الأريقط " ، وأثبت ما في المخطوطة .
(95) في المخطوطة : " يريد الشأم " ، وما في المطبوعة هو الصواب .
(96) " السرح " ، المال يسام في المرعى ، من الأنعام والماشية ترعى . و " الصفراء " قرية فويق ينبع ، كثيرة المزارع والنخل ، وهي من المدينة على ست مراحل ، وكان يسكنها جهينة والأنصار ونهد .
(97) هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة ، ولم أجد مكانًا ولا شيئا يقال له " البطم " ، وأكاد أقطع أنه تحريف محض ، وأن صوابه ( بِإضَمٍ ) . و " إضم " واد بجبال تهامة ، وهو الوادي الذي فيه المدينة . يسمى عند المدينة " قناة " ، ومن أعلى منها عند السد يسمى " الشظاة " ، ومن عند الشظاة إلى أسفل يسمى " إضما " . وقال ابن السكيت : " إضم " ، واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر ، وأعلى إضم " القناة " التي تمر دوين المدينة . و " إضم " من بلاد جهينة .
والمعروف في السير أن أبا سفيان في تلك الأيام ، نزل على ماء كان عليه مجدى بن عمير الجهني ، فلما أحس بخبر المسلمين ، ضرب وجه عيره ، فساحل بها ، وترك بدرًا بيسار . فهو إذن قد نزل بأرض جهينة ، و " إضم " من أرضهم ، وهو يفرغ إلى البحر ، فكأن هذا هو الطريق الذي سلكه . ولم أجد الخبر في مكان حتى أحقق ذلك تحقيقًا شافيًا .
(98) الأثر : 15727 - " يعقوب بن محمد الزهري " ، سلف قريبًا رقم : 15715 .
و" عبد الله بن وهب المصري " ، الثقة ، مضى برقم 6613 ، 10330 .
و " ابن لهيعة " ، مضى الكلام في توثيقه مرارًا .
و " ابن أبي حبيب " ، هو " يزيد بن أبي حبيب المصري " ، ثقة مضى مرارًا كثيرة .
و " أبو عمران " هو : " أسلم أبو عمران " ، " أسلم بن يزيد التجيبي " ، روى عن أبي أيوب ، تابعي ثقة ، وكان وجيهًا بمصر . مترجم في التهذيب ، والكبير 1 2 25 ، وابن أبي حاتم 1 1 307 . وسيأتي في هذا الخبر بإسناد آخر ، في الذي يليه .
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6 : 73 ، 74 مطولا ، وقال : " رواه الطبراني ، وإسناده حسن ".
(99) الأثر : 15728 - " أسلم ، أبو عمران الأنصاري " ، هو الذي سلف في الإسناد السابق ، وسلف تخريجه .
(100) الأثر : 15731 - سيرة ابن هشام 2 : 322 ، وهو تابع الأثريين السالفين ، رقم : 15713 ، 15718 .
(101) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 404 ، وزاد " فأن ، في موضع نصب كما نصب الساعة " .
(102) انظر ما قاله آنفًا في " ذات بينكم " ص : 384 .
(103) انظر تفسير " حق " فيما سلف من فهارس اللغة ( حقق ) .
(104) انظر تفسير " كلمات الله " فيما سلف 11 : 335 ، وفهارس اللغة ( كلم ) .
(105) انظر تفسير " قطع الدابر " 11 : 363 ، 364 12 : 523 ، 524 .
(106) الأثر : 15731 - سيرة ابن هشام 2 : 322 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 15730.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[7] أحيانًا تحب ما لا يكون فيه تمام مصلحتك، فيختار الله لك الأنفع والأصلح، وإن شق عليك أولًا، فإنه يعلم ما لا تعلم، وهذا من جميل لطف الله بعباده.
وقفة
[7] ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّـهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير، فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما أحبوا؛ أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم؛ ﴿وَيُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ فينصر أهله ﴿وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: يستأصل أهل الباطل، ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر ببالهم.
عمل
[7] حتى ولو كانت كل ظواهر الأمر تجعلك تتمناه وتقطع بأنه خير، لا تقلق من فواته، خيرة الله لك أفضل، تأمل: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾.
وقفة
[7] ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ أرادوا غير ذات الشوكة، وأراد الله ذات الشوكة؛ ليكسر شوكة الكفر، وكان ما أراد الله.
وقفة
[7] ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ قد يكون الخير لك في ما تستصعبه نفسك.
وقفة
[7] أحيانًا يقدر الله عليك طريق ابتلاء لابد أن تسيره؛ لأن نهايته نصرك وظفرك ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾.
وقفة
[7] ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أرادوا عرضًا دنيويًا، وأراد الله لهم نصرًا فيه عزهم في الدنيا، ورفعة درجتهم في الآخرة.
وقفة
[7] ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ الحق يثبت بالحجة لا بالقوة القوة تحمي الحق وتحرسه لا تغرسه.
وقفة
[7] ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ اســم الله (الحـق): الذي يحق الحق بكلماته.
تفاعل
[7] ﴿وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ: ﴾
- الواو: استئنافية. إذ: اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل مضمر. أي باضمار اذكروا والجملة بعده: في محل جر بالاضافة. يعد: فعل مضارع مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. والميم علامة جمع الذكور حركت بالضم للاشباع. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.
- ﴿ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: ﴾
- إحدى: مفعول به ثان منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر. الطائفتين: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه مثنى والنون عوض عن تنوين المفرد وحركته. ويجوز أن تكون «إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» مجرورة بحرف جر مقدر مفعول «يَعِدُكُمُ» محذوفا بتقدير: يعدكم الظفر بإحدى الطائفتين.
- ﴿ أَنَّها لَكُمْ: ﴾
- الجملة: في محل نصب أو جر بدل من «إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» أنّ:حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «ها» ضمير الغائبة مبني على السكون في محل نصب اسم «أن». لكم: جار ومجرور متعلق بخبر «أن» والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ وَتَوَدُّونَ: ﴾
- الواو حالية: تودون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون.والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة في محل نصب حال والتقدير: وأنتم تودون.
- ﴿ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ: ﴾
- أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. غير:اسم «أَنَّ» منصوب بالفتحة. ذات: مضاف اليه مجرور بالكسرة وهو مضاف. الشوكة: مضاف اليه مجرور بالكسرة.
- ﴿ تَكُونُ لَكُمْ: ﴾
- الجملة: في محل رفع خبر «أَنَّ» تكون: فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة واسمها: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هي لكم: جار ومجرور متعلق بخبر «تَكُونُ» والميم علامة جمع الذكور. وأنّ مع اسمها وخبرها في محل نصب مفعول به للفعل «تود».
- ﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ: ﴾
- الواو: عاطفة. يريد: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الله:لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.
- ﴿ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ: ﴾
- أن حرف مصدري ناصب. يحق: فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الحق: مفعول به منصوب بالفتحة. بكلمات: جار ومجرور متعلق بيحق. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة و «أَنَّ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «يُرِيدُ».
- ﴿ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ: ﴾
- معطوفة بواو العطف على «يُحِقَّ الْحَقَّ».الكافرين: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. '
المتشابهات :
| يونس: 82 | ﴿ وَيُحِقُّ اللَّـهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ |
|---|
| الأنفال: 7 | ﴿وَيُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ |
|---|
| الشورى: 24 | ﴿وَيَمْحُ اللَّـهُ الْبَاطِلَ و يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد ذكر جدال هؤلاء الذين كَرِهوا لقاءَ كُفَّارِ قُريشٍ يَومَ بَدرٍ؛ ذكرهم اللهُ عز وجل هنا بأنه وعدهم بإحدي الطائفتينِ: عِيرِ قُرَيْشٍ القادمةِ من الشامِ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ أَرْزَاقٍ، أَوِ النَّفِيرِ الآتي من مكةَ، قال تعالى:
﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يعدكم:
وقرئ:
يعدكم، بسكون الدال لتوالى الحركات، وهى قراءة مسلمة بن محارب.
إحدى:
وقرئ:
أحد، على التذكير، إذ تأنيث «الطائفة» مجاز، وهى قراءة ابن محيصن.
بكلماته:
وقرئ:
بكلمته، على التوحيد، وهى قراءة مسلم بن محارب.
مدارسة الآية : [8] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ .. ﴾
التفسير :
تفسير الآيات من 5 حتى 8:قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم اللّه به،.كذلك أخرج اللّه رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه اللّه تعالى، وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. فحين تبين لهم أن ذلك واقع، جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق، ومما أمر اللّه به ورضيه،. فبهذه الحال ليس للجدال محل [فيها] لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر،. فأما إذا وضح وبان، فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم،.وكذلك الذين عاتبهم اللّه، انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم اللّه، وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة،.فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس،.فخرج معه ثلاثمائة، وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا، يعتقبون عليها، ويحملون عليها متاعهم،.فسمعت بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم، في عَدَدٍ كثير وعُدَّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من الألف. فوعد اللّه المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير،.فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة،.ولكن اللّه تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا. أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم،. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ فينصر أهله وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أي:يستأصل أهل الباطل، ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. لِيُحِقَّ الْحَقَّ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه،. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فلا يبالي اللّه بهم.
ثم بين- سبحانه- الحكمة في اختيار ذات الشوكة لهم، ونصرتهم عليهم فقال: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
أى: فعل ما فعل من النصرة والظفر بالأعداء لِيُحِقَّ الْحَقَّ أى: ليثبت الدين الحق دين الإسلام وَيُبْطِلَ الْباطِلَ أى: ويمحق الدين الباطل وهو ما عليه المشركون من كفر وطغيان.
وقوله: وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بيان لنفاذ إرادته- سبحانه-، أى: اقتضت إرادته أن يعز الدين الحق وهو دين الإسلام، وأن يمحق ما سواه، ولو كره المشركون ذلك لأن كراهيتهم لا وزن لها، ولا تعويل عليها..
وبهذا يتبين أنه لا تكرار بين الآيتين السابقتين، لأن المراد بإحقاق الحق في قوله- تعالى- وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ: إعلاؤه وإظهاره ونصرته عن طريق قتال المؤمنين للمشركين.
والمراد بإحقاق الحق في قوله بعد ذلك في الآية الثانية لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ:
تثبيت دين الإسلام وتقويته وإظهار شريعته، ويمحق دين الكفر.
فكان ما اشتملت عليه الآية الأولى هو الوسيلة والسبب وما اشتملت عليه الآية الثانية هو المقصد والغاية.
وقد بسط هذا المعنى الإمام الرازي فقال ما ملخصه: فإن قيل: أليس قوله: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ ثم قوله بعد ذلك: لِيُحِقَّ الْحَقَّ تكرارا محضا، فالجواب:
ليس هاهنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر والظفر بالأعداء، والمراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة، لأن الذي وقع من المؤمنين يوم بدر بالكافرين، كان سببا لعزة الدين وقوته، ولهذا السبب قرنه بقوله وَيُبْطِلَ الْباطِلَ الذي هو الشرك، وذلك في مقابلة الْحَقَّ الذي هو الدين والإيمان.
وإلى هنا نرى السورة الكريمة قد حدثتنا في الأربع الآيات الأولى منها عن حكم الله- تعالى- في غنائم بدر بعد أن اختلف بعض المؤمنين في شأنها، وعن صفات المؤمنين الصادقين الذين يستحقون من الله- تعالى- أرفع الدرجات.
ثم حدثتنا في الأربع الآيات الثانية منها عن حال بعض المؤمنين عند ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال أعدائهم، وعن مجادلتهم له في ذلك، وعن إيثارهم المال على القتال، وعن إرادة ما هو خير لهم في دنياهم وآخرتهم، وفي ذلك ما فيه من العبر والعظات لقوم يعقلون.
ثم ساق- سبحانه- بعض مظاهر تدبيره المحكم في هذه الغزوة، وبعض النعم التي أنعم بها على المؤمنين، وبعض البشارات التي تقدمت تلك الغزوة أو صاحبتها، والتي كانت تدل دلالة واضحة على أن النصر سيكون للمسلمين فقال- تعالى-:
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
القول في تأويل قوله : لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين، كيما يحق الحق, كيما يُعبد الله وحده دون الآلهة والأصنام, ويعزّ الإسلام, وذلك هو " تحقيق الحق "=(ويبطل الباطل)، يقول ويبطل عبادة الآلهة والأوثان والكفر، ولو كره ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا المآثم والأوزار من الكفار. (107)
15733- حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)، هم المشركون.
* * *
وقيل: إن " الحق " في هذا الموضع، الله عز وجل.
------------------------
الهوامش:
(107) انظر تفسير " المجرم " فيما سلف ص : 70 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[8] ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ إرادة تحقيق النّصر الإلهي للمؤمنين؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
وقفة
[8] ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ ليعز الإسلام وأهله، ويذهب الشرك وأهله، ولو كره المشركون.
وقفة
[8] ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ تصريح بأن الله لا يرضى بالباطل، لكن يبقيه إلى أجل ليختبر به صدق المؤمنين، ويدفعهم إلى العمل، ثم يمحقه.
وقفة
[8] ﴿وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ إحقاق الحق يكون باستئصال مُعانِديه، فأنتم أردتم نفعًا قليلًا عاجلًا، وأراد الله نفعًا عظيمًا في العاجل والآجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الإعراب :
- ﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ: ﴾
- ذاللام: للتعليل حرف جر. يحقّ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو.الحق: مفعول به منصوب بالفتحة. و «أن» المضمرة وما تلاها: في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بيقطع. وجملة «يحق الحق» صلة «أن» لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ: ﴾
- معطوفة بالواو على «يحق الحق» وتعرب اعرابها.الواو حالية. لو: مصدرية. ولو وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب حال بتقدير: مع كره المجرمين.
- ﴿ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح. المجرمون: فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد وحذف المفعول اختصارا. أي ولو كرهوا ذلك. '
المتشابهات :
| الأنفال: 8 | ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ |
|---|
| يونس: 82 | ﴿وَيُحِقُّ اللَّـهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل أن الصحابة أرادوا لقاء الطَّائفة التي ليس معها سِلاح أي: عِير قريش؛ بَيَّنَ اللهُ هنا الحكمة التي لإجلها اختار لهم لقاء النَّفِيرِ الآتي من مكةَ، وهذه الحكمة هي:
﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء