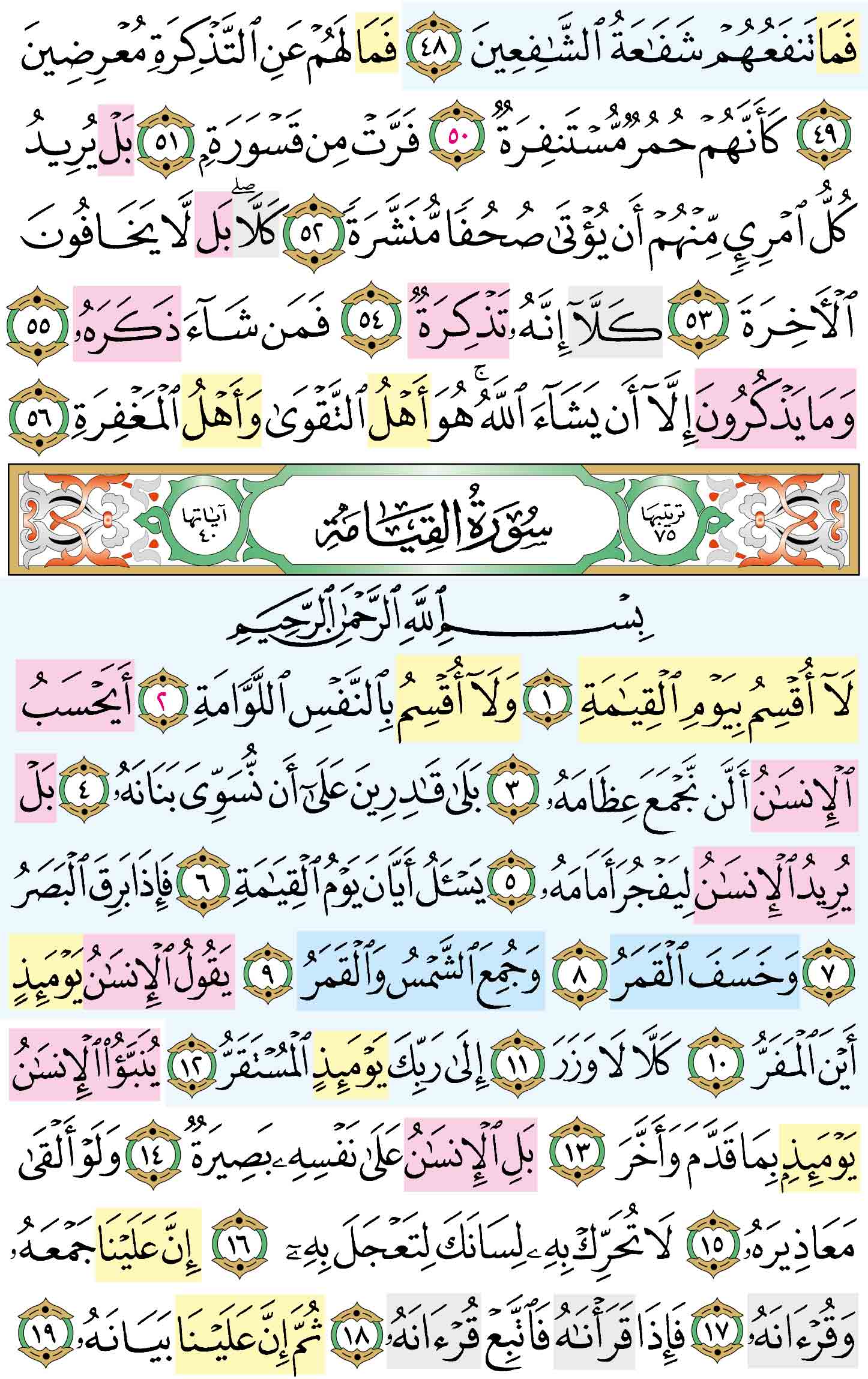
الإحصائيات
سورة المدثر
| ترتيب المصحف | 74 | ترتيب النزول | 4 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.80 |
| عدد الآيات | 56 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |
| ترتيب الطول | 68 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 10/10 | يا أيها المدثر: 1/1 | ||
سورة القيامة
| ترتيب المصحف | 75 | ترتيب النزول | 31 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.20 |
| عدد الآيات | 40 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.55 |
| ترتيب الطول | 79 | تبدأ في الجزء | 29 |
| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| القسم: 5/17 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (49) الى الآية رقم (56) عدد الآيات (8)
ختامُ السُّورةِ بتوبيخِ المُشركينَ لإعْراضِهم عن الاتعاظِ بالقرآنِ، وتشبيهِهم بالحُمُرِ الوحشيةِ إذا هربتْ من الأسدِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (12) عدد الآيات (12)
القَسَمُ بيومِ القيامةِ وبالنَّفسِ اللوَّامةِ أنَّ البعثَ حقٌ، ثُمَّ ذِكرُ بعضِِ علاماتِ ذلك اليومِ، وأنَّه لا فرارَ منه،
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثالث
من الآية رقم (13) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (7)
وإخبارُ الإنسانِ يومَ القيامةِ بجميعِ أعمالِه، ثُمَّ نهيُه ﷺ عن محاولةِ حفظِ آياتِ القرآنِ أثناءَ الوحي.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة المدثر
الحركة والنهوض بالدعوة (قم فأنذر)
أولاً : التمهيد للسورة :
- • سورة المدثر هي سورة الحركة والنهوض بالدعوة إلى الله:: أيها الداعي إلى الله، بعد أن أخذت زادك (سورة المزمل)، وتعرفت على من ستدعو إليه (سورة الملك)، ورأيت نماذج مضيئة من الدعاة إلى الله (سورة نوح)، ماذا أنت فاعل في مكانك؟ لماذا لا تزال ساكنًا؟
- • ومن الملفت في السورة:: ﴿يأَيُّهَا ٱلْمُدَّثّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبّرْ﴾ (1-3). هذه الآية لا تعني أن تقول بلسانك: «الله أكبر» وحسب، عرّف كل الناس على قدر الله، واجعل الأرض كلها تكبر الله، لتكن أوامر الله أكبر من أي شيء في حياتك.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «المدثر».
- • معنى الاسم :: المدثر: الْمُلْتَفُّ بِالدِّثَارِ، والدثار: الثوب الذي يستدفأ به.
- • سبب التسمية :: لأنه اللَّفْظ الْوَاقِع فِي أَوَّلِهَا، ومحورها يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من حالة، فوصفه الله وناداه بحالته التي كان عليها، وهى التدثر بالثوب.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الحركة والنهوض بالدعوة إلى الله.
- • علمتني السورة :: لا وقت للراحة، مضى زمان النوم.
- • علمتني السورة :: أن الدعوة إلى الله تنافي الكسل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ﴾
- • علمتني السورة :: أن الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكرامًا: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة المدثر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة المدثر من المفصل.
• سورة المدثر من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المدثر مع سورة المزمل، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَل؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة المدثر آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب النداء، والسور التي افتتحت بالنداء 10 سور، وهي: سورتان افتتحتا بنداء عام للناس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وهما: النساء والحج، وثلاث سور افتتحت بنداء خاص للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهي: المائدة والحجرات والممتحنة، وخمس سور افتتحت بنداء مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، إما بصفة النبوة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ وهي: الأحزاب والطلاق والتحريم، وإما بوصف حال كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، وهما: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾.
• ذهب بعض العلماء أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة المدثر، والصحيح: أول ما نزل صدر سورة العلق، أما سورة المدثر فهي أول ما نزل بعد فترة الوحي في بداية الدعوة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نتحرك، وننهض، وننطلق في الدعوة إلى الله.
• أن نسعى لتطهير قلوبنا وإصلاح أعمالنا وأخلاقنا، فإذا كانت الثيابُ يجبُ تطهيرُها؛ فالقلبُ من بابِ أولى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (4).
• ألا نعدد أعمالنا وإنجازاتنا امتنانًا، ولا نظن أن ما قدمناه في سبيل الله هو محض جهدنا، لا، بل الله الذي اختارنا وهدانا ومنّ علينا: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ (6).
• أن نراقب أعمالنا؛ فكلُّ شيءٍ مكتوبٌ عند اللهِ حتَّى تقطيبِ الجبينِ: ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ (22).
• أن نؤدي الصلوات الخمس مع المصلين في المسجد: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (43).
• أن نطعم المساكين والمحتاجين حتى ننجو من النار: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (44).
• أن نتجنب تقليد اﻵخرين في الباطل، ومسايرة السفهاء والبطالين، والسهر على القيل والقال، وإشاعة اﻷخبار دون تثبت: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (45).
• أن نسأل الله أن ننال شفاعة النبي ﷺ، ونستعين على ذلك بصالح الأعمال: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (48).
• أن نقبِل على الدروس والمواعظ ولا نكن من المعرضين عن التذكرة: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (49).
• أن نطمع في رحمة الله ومغفرته: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (56).
سورة القيامة
التذكير بيوم القيامة وأهوالها
أولاً : التمهيد للسورة :
- • ثم بيان أن القرآن موكول حفظه وبيانه إلى الله عز وجل:: رسالة السورة واضحة من اسمها: تذكير الناس بيوم القيامة والاستعداد للوقوف بين يديه.فأول كلماتها: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (1-4).
- • ثم الختام: • ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (16-19). • ثم بيان انقسام الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياء، وبيان أحوالهم: (20)- (25).ثم التذكير بالموت والنهاية، وبيان حال المرء وقت الاحتضار: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ * وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ * إِلَىٰ رَبّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ﴾ (26-35).
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «القيامة».
- • معنى الاسم :: القيامة هو اسم من أسماء الآخرة، حيث يقوم الناس من قبورهم للحساب.
- • سبب التسمية :: للِوُقُوعِ الْقَسَمِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي أَوَّلِهَا.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ لَا أُقْسِمُ»، «سُورَةُ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ لافتتاحها به.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: الاستعداد ليوم القيامة.
- • علمتني السورة :: لأهمية محاسبة النفس: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾
- • علمتني السورة :: أن كل نفس تلوم صاحبها يوم القيامة: إن كان مؤمنًا لامته على عدم الزيادة من الخير، وإن كان كافرًا لامته على عدم الإيمان بالله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾
- • علمتني السورة :: أنه لا مفر من الله إلا إلى الله: ﴿يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ * كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرّ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة القيامة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة القيامة من المفصل.
• سورة القيامة من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القيامة مع سورة الإنسان، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة القيامة، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (40)، وما شابه ذلك من القرآن أن يقول: (سبحانك فبلى) أو (بلى)؛ فعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّى فَوْقَ بَيْتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتَى﴾، قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
• وهذا من باب التفاعل مع القرآن الكريم، حيث يستحضر القارئ أو المستمع أنه مخاطب بهذا القرآن.
• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعد ليوم القيامة، ونجتهد في العمل الصالح.
• أن نعاتب أنفسنا ونحاسبها قبل أن نندم: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (2).
• أن نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (13).
• أن نعلم أن أعمالنا مستنسخة في كتبنا، وأننا شهود على أنفسنا، ولا تقبل الأعذار يوم القيامة: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ * بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ (13-15).
• أن نتبع القرآن ونعمل به: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (18).
• أن ندعو الله: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (20، 21).
• أن نحرص على الأعمال التي تجعلنا في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (22، 23).
• أن نحذر من صفات أهل النار، التي اجتمعت في تكذيب الله ورسوله، والتولي والإعراض عن طاعتهما: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (31، 32).
تمرين حفظ الصفحة : 577
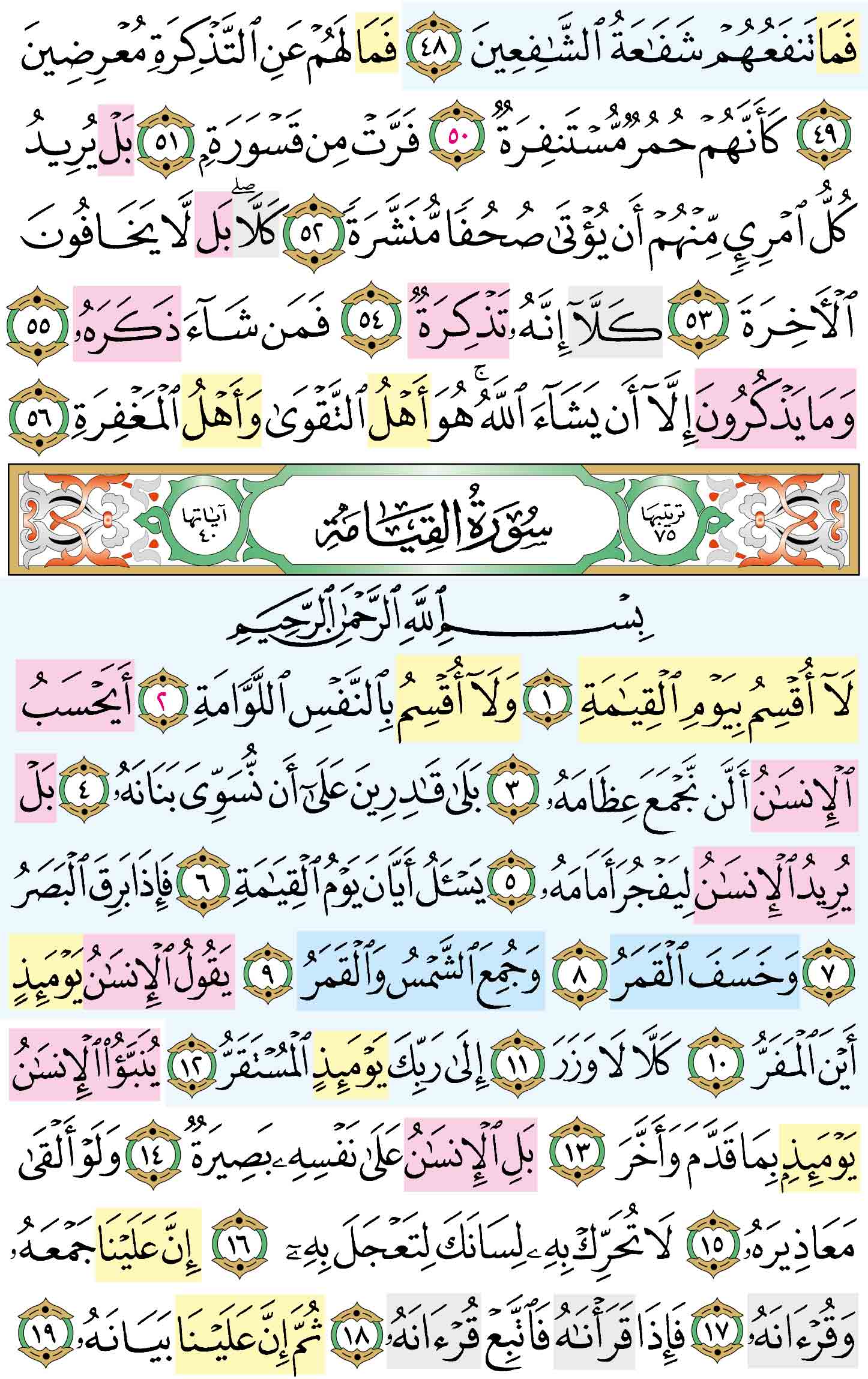
مدارسة الآية : [48] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾
التفسير :
{ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. فلما بين الله مآل المخالفين، ورهب ممايفعل بهم، عطف على الموجودين بالعتاب واللوم.
وقوله- سبحانه-: فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ حكم منه- سبحانه- عليهم بحرمانهم ممن يشفع لهم أو ينفعهم.
أى: أن هؤلاء المجرمين لن تنفعهم يوم القيامة شفاعة أحد لهم، فيما لو تقدم أحد للشفاعة لهم على سبيل الفرض والتقدير، وإنما الشفاعة تنفع غيرهم من المسلمين.
أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها.
( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) يقول: فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد، فتنفعهم شفاعتهم، وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: ثنا أبو الزعراء، عن عبد الله في قصة ذكرها في الشفاعة، قال: ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون، ويشفعهم الله فيقول: أنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النار، ثم يقول: أنا أرحم الراحمين، ثم قرأ عبد الله يأيها الكفار مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وعقد بيده أربعا، ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خير، ألا ما يُترك فيها أحد فيه خير.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت عمي وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، قال: قال عبد الله: لا يبقى في النار إلا أربعة، أو ذو الأربعة - الشك من أبي جعفر الطبري - ثم يتلو: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) تعلمن أن الله يشفع المومنين يوم القيامة. ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إنَّ مِنْ أُمَّتِي رَجُلا يُدْخِلُ اللهُ بِشَفاعَتِهِ الجَنَّةَ أكْثَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ " .
قال الحسن: أكثر من ربيعة ومضر، كنا نحدَّث أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمر، عن قتادة ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) قال: تعلمن أن الله يشفع بعضهم في بعض.
قال: ثنا أبو ثور، قال معمر: وأخبرني من سمع أنس بن مالك يقول: إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة والرجل.
قال: ثنا أبو ثور، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: يدخل الله بشفاعة رجل من هذه الأمة الجنة مثل بني تميم، أو قال: أكثر من بني تميم، وقال الحسن: مثل ربيعة ومضر.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[48] ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ مَن كنا نؤمل فيهم قضاء حوائجنا في الدنيا هناك، لن يغنوا عنا من الله شيئًا.
وقفة
[48] ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة، وتفصيلها في صحاح الأخبار.
وقفة
[48] ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ من الملائكة والأنبياء والشهداء والصَّالحينَ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشفاعة، فإنه ليس للكفار شفيع يشفع لهم.
وقفة
[48] ﴿فَما تَنفَعُهُم شَفاعَةُ الشّافِعينَ﴾ فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين؛ لأن من شرط قَبول الشفاعة الرضا عن المشفوع.
وقفة
[48] ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ الشفاعة شرف لا يناله من ذل نفسه بالعصيان.
عمل
[48] سَل الله أن تنال شفاعة نبيك محمد ﷺ، واستعن على ذلك بصالح الأعمال ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَما تَنْفَعُهُمْ: ﴾
- الفاء استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. تنفع: فعل مضارع مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم
- ﴿ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة. الشافعين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد اي لا شافع فلا شفاعة منه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [48] لما قبلها : ولَمَّا أقَرُّوا عَلى أنْفُسِهِمْ بكل ما سبق؛ حكم اللهُ عليهم بحرمانهم ممن يشفع لهم أو ينفعهم، قال تعالى:
﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [49] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾
التفسير :
{ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} أي:صادين غافلين عنها.
والاستفهام في قوله: فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ للتعجيب من إصرارهم على كفرهم، ومن إعراضهم عن الحق الذي دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالتذكرة: التذكير بمواعظ القرآن وإرشاداته،
أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين.
وقوله: ( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) يقول: فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين، لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) أي: عن هذا القرآن.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
عمل
[49] أقبِل على الدروس والمواعظ ولا تكن من المعرضين عن التذكرة ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾.
وقفة
[49] يهوون الفساد، ويألفون المنكر، وينأون عن المعروف، فإذا نصحوا في الله دارت حماليق أعينهم ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾.
وقفة
[49] ﴿فَما لَهُم عَنِ التَّذكِرَةِ مُعرِضينَ﴾ أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن؟!
وقفة
[49، 50] من أعظم خصال أعداء الدعوة: إعراضهم عن تدبر القرآن! ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَما لَهُمْ: ﴾
- اسم استفهام يفيد الانكار والتوبيخ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر المبتدأ «ما». الفاء: استئنافية.
- ﴿ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بمعرضين اي عن التذكير وهو العظة يريد القرآن او غيره من المواعظ. معرضين: حال من الضمير في «لهم» منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد اي صادين.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [49] لما قبلها : ولَمَّا كانَ هَذا الإخْبارَ بِنَعِيمِ المُنْعِمِ وعَذابِ المُعَذَّبِ مُوجِبًا لِلتَّذَكُّرِ؛ وَبَّخَ اللهُ المُشركينَ هنا لإعْراضِهم عن الاتعاظِ بالقرآنِ، قال تعالى:
﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [50] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾
التفسير :
{ كَأَنَّهُمْ} في نفرتهم الشديدة منها{ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ} أي:كأنهم حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضا، فزاد عدوها،
والحمر: جمع حمار، والمراد به الحمار الوحشي المعروف بشدة نفوره وهروبه إذا ما أحس بحركة المقتنص له.
وقوله: مُسْتَنْفِرَةٌ أى: شديدة النفور والهرب فالسين والتاء للمبالغة.
والقسورة: الأسد، سمى بذلك لأنه يقسر غيره من السباع ويقهرها، وقيل: القسورة اسم لجماعة الرماة الذين يطاردون الحمر الوحشية، ولا واحد له من لفظه، ويطلق هذا اللفظ عند العرب على كل من كان بالغ النهاية في الضخامة والقوة. من القسر بمعنى القهر. أى:
ما الذي حدث لهؤلاء الجاحدين المجرمين، فجعلهم يصرون إصرارا تاما على الإعراض عن مواعظ القرآن الكريم، وعن هداياته وإرشاداته، وأوامره ونواهيه.. حتى لكأنهم- في شدة إعراضهم عنه، ونفورهم منه- حمر وحشية قد نفرت بسرعة وشدة من أسد يريد أن يفترسها، أو من جماعة من الرماة أعدوا العدة لاصطيادها؟.
قال صاحب الكشاف: شبههم- سبحانه- في إعراضهم عن القرآن، واستماع الذكر والموعظة، وشرادهم عنه- بحمر جدت في نفارها مما أفزعها.
وفي تشبيههم بالحمر: مذمة ظاهرة، وتهجين لحالهم بين، كما في قوله- تعالى-:
كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً، وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل، ولا ترى مثل نفار حمير الوحش، واطرادها في العدو، إذا رابها رائب ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب، في وصف الإبل، وشدة سيرها، بالحمر، وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص...
والتعبير بقوله: فَما لَهُمْ ... وما يشبهه قد كثر استعماله في القرآن الكريم، كما في قوله- تعالى-: فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ... والمقصود منه التعجيب من إصرار المخاطبين على باطلهم، أو على معتقد من معتقداتهم.. مع أن الشواهد والبينات تدل على خلاف ذلك.
وقال- سبحانه- عَنِ التَّذْكِرَةِ بالتعميم، ليشمل إعراضهم كل شيء يذكرهم بالحق، ويصرفهم عن الباطل.
أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش.
يقول تعالى ذكره: فما لهؤلاء المشركين بالله عن التذكرة معرِضين، مولِّين عنها تولية الحُمُر المستنفرة ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) .
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( مُسْتَنْفِرَةٌ ) ، فقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة والبصرة بكسر الفاء، وفي قراءة بعض المكيين أيضا بمعنى نافرة (1) .
والصواب من القول في ذلك عندنا، أنهما قراءتان معروفتان، صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وكان الفرّاء يقول: الفتح والكسر في ذلك كثيران في كلام العرب ؛ وأنشد:
أمْسِــكْ حِمَــارَكَ إنَّــهُ مُسْـتَنْفِرٌ
فِــي إثْـرِ أحْـمِرَةٍ عَمَـدْن لِغُـرَّب (2)
التدبر :
لمسة
[50] ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾ شبَّه اللهُ المُعرِضَ عن التَّذكِرةِ وسماع القرآنِ بالحُمُرِ الوحشيةِ.
وقفة
[50] ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾ تأمل كيف أذل الله من أعرض عن ذكره وعن القرآن، وشبهه بالحمار، أعزكم الله.
وقفة
[50] ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾ يَكفي الـمُعرض عن تدبر القرآن ذُلًّا تَشبيهه بالحمار.
وقفة
[50] ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾ لا يكره أحدٌ النصحَ وأهلَه والدين وأهله إلا استحق أقبح وصف يخرجه من آدمية بلا دين.
وقفة
[50، 51] ﴿كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُستَنفِرَةٌ * فَرَّت مِن قَسوَرَةٍ﴾ تشبيه مبهر.
الإعراب :
- ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ: ﴾
- الجملة في محل نصب حال ثان. كأن: حرف نصب مشبه بالفعل يفيد التشبيه و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «كأن». حمر:خبرها مرفوع بالضمة اي حمير جمع «حمار».
- ﴿ مُسْتَنْفِرَةٌ: ﴾
- صفة- نعت- لحمر مرفوعة مثلها بالضمة. شبه سبحانه فرار الكفار من النبي الكريم وهربهم من سماع الذكر ونفورهم منه بالحمير الشديدة النفار.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [50] لما قبلها : وبعد أن وَبَّخَ اللهُ المُشركينَ لإعْراضِهم عن الاتعاظِ بالقرآنِ؛ شبَّههم هنا في نفورِهم عن القرآن بالحُمُرِ الوحشيةِ، قال تعالى:
﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
حمر:
1- بضم الميم، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بإسكانها، وهى قراءة الأعمش.
مستنفرة:
قرئ:
1- بفتح الفاء، وهى قراءة نافع، وابن عامر، والمفضل، عن عاصم.
2- بكسرها، وهى قراءة باقى السبعة.
مدارسة الآية : [51] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾
التفسير :
{ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} أي:من صائد ورام يريدها، أو من أسد ونحوه، وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق، ومع هذا الإعراض وهذا النفور، يدعون الدعاوى الكبار.
والحمر: جمع حمار، والمراد به الحمار الوحشي المعروف بشدة نفوره وهروبه إذا ما أحس بحركة المقتنص له.
وقوله: مُسْتَنْفِرَةٌ أى: شديدة النفور والهرب فالسين والتاء للمبالغة.
والقسورة: الأسد، سمى بذلك لأنه يقسر غيره من السباع ويقهرها، وقيل: القسورة اسم لجماعة الرماة الذين يطاردون الحمر الوحشية، ولا واحد له من لفظه، ويطلق هذا اللفظ عند العرب على كل من كان بالغ النهاية في الضخامة والقوة. من القسر بمعنى القهر. أى:
ما الذي حدث لهؤلاء الجاحدين المجرمين، فجعلهم يصرون إصرارا تاما على الإعراض عن مواعظ القرآن الكريم، وعن هداياته وإرشاداته، وأوامره ونواهيه.. حتى لكأنهم- في شدة إعراضهم عنه، ونفورهم منه- حمر وحشية قد نفرت بسرعة وشدة من أسد يريد أن يفترسها، أو من جماعة من الرماة أعدوا العدة لاصطيادها؟.
قال صاحب الكشاف: شبههم- سبحانه- في إعراضهم عن القرآن، واستماع الذكر والموعظة، وشرادهم عنه- بحمر جدت في نفارها مما أفزعها.
وفي تشبيههم بالحمر: مذمة ظاهرة، وتهجين لحالهم بين، كما في قوله- تعالى-:
كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً، وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل، ولا ترى مثل نفار حمير الوحش، واطرادها في العدو، إذا رابها رائب ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب، في وصف الإبل، وشدة سيرها، بالحمر، وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص...
والتعبير بقوله: فَما لَهُمْ ... وما يشبهه قد كثر استعماله في القرآن الكريم، كما في قوله- تعالى-: فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ... والمقصود منه التعجيب من إصرار المخاطبين على باطلهم، أو على معتقد من معتقداتهم.. مع أن الشواهد والبينات تدل على خلاف ذلك.
وقال- سبحانه- عَنِ التَّذْكِرَةِ بالتعميم، ليشمل إعراضهم كل شيء يذكرهم بالحق، ويصرفهم عن الباطل.
( كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) أي : كأنهم في نفارهم عن الحق ، وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ، قاله أبو هريرة وابن عباس - في رواية عنه - وزيد بن أسلم ، وابنه عبد الرحمن . أو : رام ، وهو رواية عن ابن عباس ، وهو قول الجمهور .
وقال حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس : الأسد ، بالعربية ، ويقال له بالحبشية : قسورة ، وبالفارسية : شير وبالنبطية : أويا .
وقوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) اختلف أهل التأويل في معنى القسورة، فقال بعضهم: هم الرماة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: الرماة.
حدثني ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أبي موسى ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: الرماة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: هي الرماة.
قال ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( قَسْوَرَةٍ ) قال: عصبَة قناص من الرماة. زاد الحارث في حديثه. قال: وقال بعضهم في القسورة: هو الأسد، وبعضهم: الرماة.
حدثنا هناد بن السريّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن عكرِمة، في قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: القسورة: الرماة، فقال رجل لعكرِمة: هو الأسد بلسان الحبشة، فقال عكرِمة: اسم الأسد بلسان الحبشة عنبسة.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أبو رجاء، عن عكرِمة، في قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: الرماة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن عبد الله السلولي، عن ابن عباس، قال: هي الرماة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) وهم الرماة القناص.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: قسورة النبل.
وقال آخرون: هم القناص.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) يعني: رجال القَنْص.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبى بشر، عن سعيد بن جُبير في هذه الآية ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: هم القناص.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير قال: هم القناص.
وقال آخرون: هم جماعة الرجال.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي حمزة، قال: سألت ابن عباس عن القسورة، فقال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب: الأسد، هي عصب الرجال.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هي عِصب الرجال.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: سمعت أبي يحدّث، قال: ثنا داود، قال: ثني عباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، قال: سئل ابن عباس عن القسورة، قال: جمع الرجال، ألم تسمع ما قالت فلانة في الجاهلية:
يــا بِنْــتَ لُــؤَيّ خَـيْرَةً لخَـيْرَه
أحْوَالُهُـا فـي الحَـيّ مِثـلُ القَسْـوَرَهْ (3)
&; 24-42 &; وقال آخرون: هي أصوات الرجال.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: ركز الناس أصواتهم.
قال أبو كريب، قال سفيان: هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا .
وقال آخرون: بل هو الأسد.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: هو الأسد.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن سيلان، أن أبا هريرة كان يقول في قول الله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: هو الأسد.
حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا هشام، عن زيد بن أسلم، في قول الله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: الأسد.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، في قول الله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: هو الأسد.
حدثني محمد بن خالد بن خداش، قال ثني سلم بن قتيبة، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أنه سُئل عن قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: هو بالعربية: الأسد، وبالفارسية: شار، وبالنبطية: أريا، وبالحبشية: قسورة.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) يقول: الأسد.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص بن غياث، عن هشام بن سعد، عن &; 24-43 &; زيد بن أسلم، عن أبي هريرة قال: الأسد.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) قال: القسورة: الأسد.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[51] ﴿فَرَّت مِن قَسوَرَةٍ﴾ قال ابن القيم: «وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئًا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم، كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها».
وقفة
[49-51] ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ * فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ﴾ فشبه هؤلاء في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمير رأت أسودًا، أو رماة ففرت منهم، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمير، وهي لا تعقل شيئًا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الدم لهؤلاء.
وقفة
[49-51] ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ * فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ﴾ قال ابن تيمية: «فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه».
وقفة
[49-51] شبه ﷻ المعرضين عن القرآن كالحمير الفارَّة من الأسد خوفا منه ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ * فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ﴾.
الإعراب :
- ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية لحمر ويجوز ان تكون في محل نصب حالا منها بعد وصفها بمستنفرة فرّت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي والجار والمجرور من قسورة متعلق بفرت اي فرت من جماعة الرماة الذين يتصيدونها وقيل الاسد.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [51] لما قبلها : ولَمَّا شبَّه اللهُ المُشركينَ في نفورِهم عن القرآن بالحُمُرِ الوحشيةِ؛ بَيَّنَ هنا سببَ نفورِها، قال تعالى:
﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [52] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ .. ﴾
التفسير :
فـ{ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً} نازلة عليه من السماء، يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك، وقد كذبوا، فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فإنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا.
وقوله- سبحانه-: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً معطوف على كلام مقدر يقتضيه المقام، وهو بيان لرذيلة أخرى من رذائلهم الكثيرة.
والصحف: جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيها. ومنشره: صفة لها والمراد بها: الصحف المفتوحة غير المطوية. بحيث يقرؤها كل من رآها.
وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لن نتبعك حتى تأتى لكل واحد منا بكتاب من السماء، عنوانه: من رب العالمين، إلى فلان بن فلان، نؤمر في هذا الكتاب باتباعك.
أى: إن هؤلاء الكافرين لا يكتفون بمواعظ القرآن.. بل يريد كل واحد منهم أن يعطى صحفا مفتوحة، وكتبا غير مطوية، بحيث يقرؤها كل من يراها. وفيها الأمر من الله- تعالى- لهم بوجوب اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم.
وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ ...
( بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) أي : بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على النبي . قاله مجاهد وغيره ، كقوله : ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [ الأنعام : 124 ] ، وفي رواية عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل .
وقوله: ( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ) يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه من عند الله، ولكن كلّ رجل منهم يريد أن يؤتى كتابا من السماء ينـزل عليه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ) قال: قد قال قائلون من الناس: يا محمد إن سرّك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان، نؤمر فيه باتباعك، قال قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ) قال: إلى فلان من رب العالمين.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[52] ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ قال مطر الوراق: «أرادوا أن يُعْطَوا بغير عمل»، وهكذا أكثر الناس.
وقفة
[52] ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ كان المشركون يقولون: «إن كان محمد صادقًا، فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته من النار»، وقال بعضهم: «بلّغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوبًا ذنبه وكفارته، فأتنا يا محمد بمثل هذا».
وقفة
[52] ﴿بَل يُريدُ كُلُّ امرِئٍ مِنهُم أَن يُؤتى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ هو الكبر والعناد والاستكبار.
الإعراب :
- ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ: ﴾
- حرف اضراب لا عمل له يفيد الاستئناف. يريد: فعل مضارع مرفوع بالضمة. كل: فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ امْرِئٍ مِنْهُمْ: ﴾
- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. من:حرف جر بياني و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة لامرئ.
- ﴿ أَنْ يُؤْتى: ﴾
- حرف مصدرية ونصب. يؤتى: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو وجملة «يؤتى» صلة «ان» لمصدرية لا محل لها من الإعراب و «ان» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل يريد.
- ﴿ صُحُفاً مُنَشَّرَةً: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. منشرة: صفة- نعت- لصحفا منصوبة مثلها بالفتحة اي قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بها.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [52] لما قبلها : وبعد أن شبَّه اللهُ المُشركينَ في نفورِهم عن القرآن بالحُمُرِ الوحشيةِ؛ بَيَّنَ هنا أنهم بلغوا في العناد حدًّا لا تجدي معهم التذكرة، فكل واحد من هؤلاء المشركين يطمع أن يُنزل اللهُ عليه كتابًا من السماء يخبره أن محمدًا رسول من الله، قال تعالى:
﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [53] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴾
التفسير :
{ كَلَّا} أن نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز،{ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ} فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى.
وقوله- سبحانه- كَلَّا بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ إبطال آخر لكلامهم، وزجر لهم عن هذا الجدال السخيف. أى: كلا ليس الأمر كما أرادوا وزعموا بل الحق أن هؤلاء القوم لا يخافون الآخرة، وما فيها من حساب وجزاء، لأنهم لو كانوا يخافون لما اقترحوا تلك المقترحات السخيفة المتعنتة..
أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها.
وقوله: ( كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ) يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يزعمون من أنهم لو أوتوا صحفا منشَّرة صدّقوا، ( بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ) ، يقول: لكنهم لا يخافون عقاب الله، ولا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب؛ فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله، وهوّن عليهم ترك الاستماع لوحيه وتنـزيله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ) إنما أفسدهم أنهم كانوا لا يصدّقون بالآخرة، ولا يخافونها، هو الذي أفسدهم.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[53] ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ أصل الفساد وسر العناد: عدم اليقين بالآخرة، وبالتالي عدم الخوف منها، والجرأة على الله.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا بَلْ لا: ﴾
- حرف زجر وردع لا عمل له اي ردعهم عن تلك الارادة وزجرهم عن اقتراح الآيات. بل: حرف عطف واضراب. لا: نافية لا عمل لها.
- ﴿ يَخافُونَ الْآخِرَةَ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الآخرة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [53] لما قبلها : وبعد بيان عنادِهم وتعنتِهم؛ ردَعهم اللهُ وزجَرهم هنا، وبَيَّنَ سببَ هذا العناد والتعنت، قال تعالى:
﴿ كَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يخافون:
1- بياء الغيبة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بتاء الخطاب، التفاتا، وهى قراءة أبى حيوة.
مدارسة الآية : [54] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾
التفسير :
{ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ} الضمير إما أن يعود على هذه السورة، أو على ما اشتملت عليه [من] هذه الموعظة،
وقوله- تعالى- بعد ذلك: كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ زجر آخر مؤكد للزجر السابق. أى:
كلا ثم كلا، لن نمكنهم مما يريدون، ولن نستجيب لمقترحاتهم السخيفة.. لأن القرآن الكريم فيه التذكير الكافي، والوعظ الشافي، لمن هو على استعداد للاستجابة لذلك.
فالضمير في إِنَّهُ يعود إلى القرآن، لأنه معلوم من المقام، والجملة بمنزلة التعليل للردع عن سؤالهم الذي اقترحوا فيه تنزيل صحف مفتوحة من عند الله- تعالى- تأمرهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم..
أي حقا إن القرآن تذكرة.
يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ) ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر، وأنه قول البشر، ولكنه تذكرة من الله لخلقه، ذكرهم به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ) أي: القرآن.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[54] ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾ القرآن فيه التذكير الكافي، والوعظ الشافي، لمن كان لديه استعدادٌ للاستجابة والهداية، دون الحاجة إلى خوارق ومعجزات.
وقفة
[54] ما الفرق بين: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ [عبس: 11]، ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾؟ الجواب: بحسب السياق، في الأولى: (إنها) أي القصة، وفي الثانية: (إنه) أي القرآن.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ: ﴾
- حرف زجر وردع لا عمل له. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» يعود على التذكرة في قوله «فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ» وانما ذكر لانها في معنى الذكر او القرآن. تذكرة: خبر «ان» مرفوع بالضمة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [54] لما قبلها : وبعد ردعهم وزجرهم؛ كَرَّرَ اللهُ الرَّدعَ والزَّجرَ لهم، فقال تعالى:
﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [55] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ﴾
التفسير :
{ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} لأنه قد بين له السبيل، ووضح له الدليل.
وقوله- سبحانه-: فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ تفريع عن كون القرآن تذكرة وعظة لمن كان له قلب يفقه، أو عقل يعقل.
أى: إن القرآن الكريم مشتمل على ما يذكر الإنسان بالحق، وما يهديه إلى الخير والرشد، فمن شاء أن يتعظ به اتعظ، ومن شاء أن ينتفع بهداياته انتفع، ومن شاء أن يذكر أوامره ونواهيه وتكاليفه.. فعل ذلك، وظفر بما يسعده، ويشرح صدره.
والتعبير بقوله- تعالى- فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ يشعر بأن تذكر القرآن وحفظه. والعمل بأحكامه وإرشاداته.. في إمكان كل من كان عنده الاستعداد لذلك.
أى: إن التذكر طوع مشيئتكم- أيها الناس- متى كنتم جادين وصادقين ومستعدين لهذا التذكر، فاعملوا لذلك بدون إبطاء أو تردد..
( فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) كقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) [ الإنسان : 30 ] .
وقوله: ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ) يقول تعالى ذكره: فمن شاء من عباد الله الذين ذكرهم الله بهذا القرآن ذكره، فاتعظ فاستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[55] ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ تذكر القرآن والعمل بأحكامه في إمكان الجميع، فأزمة الهداية أزمة إرادة أكثر منها أزمة جهالة.
الإعراب :
- ﴿ فَمَنْ: ﴾
- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبره
- ﴿ شاءَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بمن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف مفعولها اختصارا اي فمن شاء ان يذكره اي ذكره.
- ﴿ ذَكَرَهُ: ﴾
- فعل ماض يعرب إعراب «شاء» وهو في محل جزم لانه جواب الشرط والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وجملة «ذكره» جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها.'
المتشابهات :
| المدثر: 54 | ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |
|---|
| المدثر: 55 | ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |
|---|
| عبس: 11 | ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |
|---|
| عبس: 12 | ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [55] لما قبلها : وبعد بيان أن هذا القرآن -الذي أعرضوا عن سماعه ونفروا منه- تذكرة وعظة؛ بَيَّنَ هنا أن من شاء أن يتعظ به اتعظ، ومن شاء أن ينتفع بهداياته انتفع، فإن نفعَ ذلك يعود إليه، قال تعالى:
﴿ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [56] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء .. ﴾
التفسير :
{ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} فإن مشيئتهنافذة عامة، لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية، الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة، ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته،{ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} أي:هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. تم تفسير سورة المدثر ولله الحمد
ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بما يدل على نفاذ مشيئته وإرادته فقال:
وَما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ، هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
أى: فمن شاء أن يذكر القرآن وما فيه من مواعظ ذكر ذلك، ولكن هذا التذكر والاعتبار والاتعاظ. لا يتم بمجرد مشيئتكم، وإنما يتم في حال مشيئة الله- تعالى- وإرادته، فهو - سبحانه- أهل التقوى، أى: هو الحقيق بأن يتقى ويخاف عذابه، وهو- عز وجل- «أهل المغفرة» أى: هو- وحده- صاحب المغفرة لذنوب عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
فالمقصود من الآية الكريمة، بيان أن هذا التذكر لمواعظ القرآن، لا يتم إلا بعد إرادة الله- تعالى- ومشيئة، لأنه هو الخالق لكل شيء، وبيان أن مشيئة العباد لا أثر لها إلا إذا كانت موافقة لمشيئة الله، التي لا يعلمها أحد سواه.
أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فقال: قد قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله، فمن اتقاني فلم يجعل معى إلها آخر، فأنا أهل أن أغفر له.
وبعد: فهذا تفسير لسورة المدثر، نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
( فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) كقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) [ الإنسان : 30 ] .
وقوله : ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أي : هو أهل أن يخاف منه ، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة .
وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب ، أخبرني سهيل - أخو حزم - حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) وقال : " قال ربكم : أنا أهل أن أتقى ، فلا يجعل معي إله ، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له " .
ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب ، والنسائي من حديث المعافى بن عمران ، كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي ، به ، وقال الترمذي : حسن غريب وسهيل ليس بالقوي . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه ، عن هدبة بن خالد ، عن سهيل ، به . وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي ، وغيرهم ، من حديث سهيل القطعي ، به .
آخر تفسير سورة " المدثر " ولله الحمد والمنة
[ وحسبنا الله ونعم الوكيل ]
( وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) يقول تعالى ذكره: وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به، ويستعملون ما فيه، إلا أن يشاء الله أن يذكروه؛ لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله يقدره عليه، ويعطيه القدرة عليه.
وقوله: ( هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) يقول تعالى ذكره: الله أهل أن يتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه، فيجتنبوا معاصيه، ويُسارعوا إلى طاعته، ( وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) يقول: هو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك، ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) ربنا محقوق أن تتقى محارمه، وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) قال: أهل أن تتقى محارمه، ( وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ): أهل أن يغفر الذنوب.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[56] ﴿وَما يَذكُرونَ إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهلُ التَّقوى وَأَهلُ المَغفِرَةِ﴾ خلاصة القول.
وقفة
[56] قال السعدي: «فإن مشيئته نافذة عامة، لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها ردٌّ على القدريَّة، الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلًا، وجعل ذلك تابعًا لمشيئته».
وقفة
[56] مشيئة العبد مُقَيَّدة بمشيئة الله ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾.
وقفة
[56] ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب.
وقفة
[56] ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ما أجمل توسل يحيى بن معاذ! حين قال: «يا من أعطانا خير ما في خزائنه؛ الإيمان قبل السؤال، لا تحرمنا من عفوك مع السؤال».
وقفة
[56] ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ لو ساورتك شكوك القنوط واليأس لعظم ذنوبك؛ فاستشعر أن ربك أهل المغفرة مهما كانت فداحة ذنوبك وخطاياك.
وقفة
[56] المؤمن لا يتقِ الله لأنه في قبضته فحسب، بل يتقِ الله لأنه ﷻ أهلُ التقوىٰ ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾.
عمل
[56] لا تجعل الماضي مهما بدا لك منحرفًا عقبة بينك وبين الله فربك سبحانه ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَما يَذْكُرُونَ: ﴾
- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. يذكرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وحذف مفعولها اختصارا لانه معلوم وكذلك مفعول «يشاء» للسبب نفسه
- ﴿ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ: ﴾
- اداة حصر لا عمل لها. ان: حرف مصدرية ونصب. يشاء: فعل مضارع منصوب بأن لله علامة نصبه الفتحة. او لفظ الجلالة:فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. وجملة «يَشاءَ اللَّهُ» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الإعراب و «ان» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر اي الا بمشيئة الله اي الا ان يقسرهم على الذكر ويلجئهم اليه لانهم لا يؤمنون اختيارا.
- ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى: ﴾
- ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.اهل: خبر «هو» مرفوع بالضمة. التقوى: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف للتعذر
- ﴿ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «أَهْلُ التَّقْوى» وتعرب إعرابها اي هو حقيق بالتقوى والمغفرة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [56] لما قبلها : وبعد بيان أن من شاء أن يتعظ بالقرآن اتعظ، ومن شاء أن ينتفع بهداياته انتفع؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنه لا اتعاظ ولا انتفاع إلا أن يشاء الله؛ فالتذكر والانتفاع يتم بمشيئة العبد وفق مشيئة الله، قال تعالى:
﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
يذكرون:
وقرئ:
1- بياء الغيبة وشد الذال، ورويت عن أبى حيوة.
2- بالتاء، وإدغام التاء فى الذال، ورويت عن أبى جعفر.
مدارسة الآية : [1] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾
التفسير :
ليست{ لا} [ها] هنا نافية، [ولا زائدة] وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين، لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح.
فالمقسم به في هذا الموضع، هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم.
تفسير سورة القيامة
مقدمة وتمهيد
1- سورة «القيامة» من السور المكية الخالصة، وتعتبر من السور التي كان نزولها في أوائل العهد المكي، فهي السورة الحادية والثلاثون في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة (القارعة) وقبل سورة (الهمزة) . أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الخامسة والسبعون.
وعدد آياتها أربعون آية في المصحف الكوفي، وتسع وثلاثون في غيره.
2- والسورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وعن أحوال الناس فيه:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.
كما أنها تتحدث عن إمكانية البعث، وعن حتمية وقوعه: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى. ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى. أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى؟.
ولقد روى عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه قال: من سأل عن يوم القيامة، أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعه، فليقرأ هذه السورة.
افتتح الله- تعالى- هذه السورة الكريمة بقوله- تعالى-: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ.
وللعلماء في مثل هذا التركيب أقوال منها: أن حرف «لا» هنا جيء به، لقصد المبالغة في تأكيد القسم، كما في قولهم: لا والله.
قال الآلوسى: إدخال «لا» النافية صورة على فعل القسم، مستفيض في كلامهم وأشعارهم.
ومنه قول امرئ القيس: لا وأبيك يا ابنة العامري.. يعنى: وأبيك.
ثم قال: وملخص ما ذهب إليه جار الله في ذلك، أن «لا» هذه، إذا وقعت في خلال الكلام كقوله- تعالى- فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ فهي صلة تزاد لتأكيد القسم، مثلها في قوله- تعالى-: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ لتأكيد العلم...
ومنها: أن «لا» هنا، جيء بها لنفى ورد كلام المشركين المنكرين ليوم القيامة، فكأنه- تعالى- يقول: لا، ليس الأمر كما زعموا، ثم قال: أقسم بيوم القيامة الذي يبعث فيه الخلق للجزاء.
قال القرطبي: وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل. فلا هنا رد لكلام قد مضى، وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحق، كأنك أكذبت قوما أنكروها...
ومنها: أن «لا» في هذا التركيب وأمثاله على حقيقتها للنفي، والمعنى لا أقسم بيوم القيامة ولا بغيره، على أن البعث حق، فإن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى قسم.
وقد رجح بعض العلماء القول الأول فقال: وصيغة لا أقسم، صيغة قسم، أدخل حرف النفي على فعل «أقسم» لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به، بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به، ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: لا أقسم به، أى:
ولا أقسم بأعز منه عندي. وذلك كناية عن تأكيد القسم .
تفسير سورة القيامة وهي مكية .
قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا ، جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد ، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد ; ولهذا قال تعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعا . هكذا حكاه ابن أبي حاتم . وقد حكى ابن جرير ، عن الحسن والأعرج أنهما قرآ : " لأقسم [ بيوم القيامة ] " ، وهذا يوجه قول الحسن ; لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله ، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ، واختاره ابن جرير .
فأما يوم القيامة فمعروف ، وأما النفس اللوامة ، فقال قرة بن خالد ، عن الحسن البصري في هذه الآية : إن المؤمن - والله - ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه .
اختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار: ( لا أُقْسِمُ ) [لا] (4) مفصولة من أقسم، سوى الحسن والأعرج، فإنه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك ( لأقسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ ) بمعنى: أقسم بيوم القيامة، ثم أدخلت عليها لام القسم.
والقراءة التي لا أستجيز غيرها في هذا الموضع " لا " مفصولة، أقسم مبتدأة على ما عليه قرّاء الأمصار، لإجماع الحجة من القرّاء عليه.
وقد اختلف الذين قرءوا ذلك على الوجه الذي اخترنا قراءته في تأويله، فقال بعضهم " لا " صلة، وإنما معنى الكلام: أقسم بيوم القيامة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن سعيد بن جُبير ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال: أقسم بيوم القيامة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن سعيد بن جُبير ( لا أُقْسِم ) قال: أقسم.
وقال آخرون منهم: بل دخلت " لا " توكيدًا للكلام.
* ذكر من قال ذلك:
سمعت أبا هشام الرفاعي يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قوله: ( لا أُقْسِمُ ) توكيد للقسم كقوله: لا والله. وقال بعض نحويِّي الكوفة: لا ردّ لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار، ثم ابتدئ القسم، فقيل: أقسم بيوم القيامة، وكان يقول: كلّ يمين قبلها ردّ لكلام، فلا بدّ من تقديم " لا " قبلها، ليفرق بذلك بين اليمين التي تكون جحدًا، واليمين التي تستأنف، ويقول: ألا ترى أنك تقول مبتدئا: والله إن الرسول لحقّ; وإذا قلت: لا والله إن الرسول لحقّ، فكأنك أكذبت قوما أنكروه.
واختلفوا أيضا في ذلك، هل هو قسم أم لا؟ فقال بعضهم: هو قسم أقسم ربنا بيوم القيامة، وبالنفس اللوّامة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي الخير بن تميم، عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: ممن أنت ؟ فقلت: من أهل العراق، فقال: أيهم ؟ فقلت: من بني أسد، فقال: من حريبهم (5) ، أو ممن أنعم الله عليهم ؟ فقلت: لا بل ممن أنعم الله عليهم، فقال لي: سل، فقلت: لا أقسم بيوم القيامة، فقال: يقسم ربك بما شاء من خلقه.
-----------------
الهوامش :
(4) ( لا ) زيادة يقتضيها المعنى
(5) لعل المراد بالحريب هنا: الفقير المحروب، أي: الذي ذهب ماله.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ هذا قسَم بيوم القيامة، والهدف منه: إثبات المعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد، من عدم بعث الأرواح والأجساد.
وقفة
[1، 2] ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ لما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه؛ قرن بينهما في الذكر.
وقفة
[1، 2] ﴿لا أُقسِمُ بِيَومِ القِيامَةِ * وَلا أُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ﴾ فمن أسباب لوم الأنفس خشية عذاب يوم عظيم.
وقفة
[1، 2] ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ وجه الربط بين يوم القيامة والنفس اللوامة؛ أن تمام اللوم إنما يظهر يوم القيامة.
الإعراب :
- ﴿ لا أُقْسِمُ: ﴾
- لا: زائدة نافية أدخلت على فعل القسم لتوكيده. وقد اختلف العلماء حولها فقيل هي صلة مثلها في لئلا يعلم أهل الكتاب. وقالوا: لا تزاد في أول الكلام. وانما تزاد في وسطه وأجيبوا بأن القرآن الكريم في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض. والوجه أن يقال هي للنفي والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له كما قال الزمخشري وأضاف:ويدلك على ذلك قوله تعالى «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» فكأنه بادخال حرف النفي يقول: ان إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام: يعني أنه يستأهل فوق ذلك. وقيل إن لا نفي لكلام ورد له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا: أي ليس الأمر على ما ذكرتم، ثم قيل أقسم بيوم القيامة. وقيل: انّ لا التي قبل أقسم زيدت توطئة للنفي بعده وقدرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفيا تقديره. لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى. أقسم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.
- ﴿ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ: ﴾
- الباء حرف جر. يوم: مقسم به مجرور بباء القسم وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بأقسم. القيامة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.'
المتشابهات :
| الواقعة: 75 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ |
|---|
| الحاقة: 38 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ |
|---|
| المعارج: 40 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ |
|---|
| التكوير: 15 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴾ |
|---|
| الإنشقاق: 16 | ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ |
|---|
| القيامة: 1 | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ *﴾ |
|---|
| القيامة: 2 | ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ |
|---|
| البلد: 1 | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَم بيومِ القيامةِ على أنَّ البعثَ حقٌّ، قال تعالى:
﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾
التفسير :
{ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت{ لوامة} لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه، من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق، أو غفلة، فجمع بين الإقسام بالجزاء، وعلى الجزاء، وبين مستحق الجزاء.
والمراد بالنفس اللوامة: النفس التقية المستقيمة التي تلوم ذاتها على ما فات منها، فهي- مهما أكثرت من فعل الخير- تتمنى أن لو ازدادت من ذلك، ومهما قللت من فعل الشر، تمنت- أيضا- أن لو ازدادت من هذا التقليل.
قال ابن كثير: عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتى؟ ... وإن الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه.
وفي رواية عن الحسن- أيضا- ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة».
وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال : ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم ، عن إسرائيل ، عن سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال : يلوم على الخير والشر : لو فعلت كذا وكذا .
ورواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن إسرائيل .
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن سعيد بن جبير في : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال : تلوم على الخير والشر .
ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال : هي النفس اللئوم .
وقال علي بن أبي نجيح ، عن مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة .
وقال قتادة : ( اللوامة ) الفاجرة .
قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى ، الأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) قال: أقسم بهما جميعا.
وقال آخرون: بل أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوّامة. وقال: معنى قوله: ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) ولست أقسم بالنفس اللوّامة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال الحسن: أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوّامة.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن الله أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوّامة، وجعل " لا " ردا لكلام قد كان تقدّمه من قوم، وجوابا لهم.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن المعروف من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال أحدهم: لا والله، لا فعلت كذا، أنه يقصد بلا ردّ الكلام، وبقوله: والله، ابتداء يمين، وكذلك قولهم: لا أقسم بالله لا فعلت كذا; فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا، فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائره جاريا مجراه، ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف بما يجب التسليم له. وبعد: فإن الجميع من الحجة مجمعون على أن قوله: ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قسم فكذلك قوله: ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) إلا أن تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسم والآخر خبر. وقد دللنا على أن قراءة من قرأ الحرف الأوّل لأقسم بوصل اللام بأقسم قراءة غير جائزة بخلافها ما عليه الحجة مجمعة، فتأويل الكلام إذا: لا ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء، أقسم بيوم القيامة، وكانت جماعة تقول: قيامة كل نفس موتها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان ومسعر، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة، قال: يقولون: القيامة القيامة، وإنما قيامة أحدهم: موته.
قال ثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي قبيس، قال: شهدت جنازة فيها علقمة، فلما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته.
وقوله: ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( اللَّوَّامَةِ ) فقال بعضهم: معناه: ولا أقسم بالنفس التي تلوم على الخير والشرّ.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن سعيد بن جبير، في قوله: ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) قال: تلوم على الخير والشرّ.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن عكرِمة ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) قال: تلوم على الخير والشرّ.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي الخير بن تميم، عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) قال: هي النفس اللئوم.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها تلوم على ما فات وتندم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) قال: تندم على ما فات وتلوم عليه.
وقال آخرون: بل اللوّامة: الفاجرة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) أي: الفاجرة.
وقال آخرون: بل هي المذمومة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) يقول: المذمومة.
وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها، فمتقاربات المعاني، وأشبه القول في ذلك بظاهر التنـزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشرّ وتندم على ما فات، والقرّاء كلهم مجمعون على قراءة هذه بفصل " لا " من أقسم.
التدبر :
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ إنَّ المؤمنِ لا تراه إلا يلومُ نفسَه، ما أردتُ بقولِ كذا، ما أردتُ بفعلِ كذا.
عمل
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ انتبه قبل أن تسيء للآخرين، أول العقوبات سياط نفسك اللوامة ووخزها الموجع.
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ أشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله ﷻ.
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ في دواخلنا تجري حوارات صاخبة مقرِّعة محرِّضة بين أنفسنا والشيطان.
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب، أو التقصير في الطاعات؛ فإن النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرها النفس المطمئنة، وشرها النفس الأمارة بالسوء، وبينهما النفس اللوامة.
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ إنَّ المؤمنَ لا تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديثي نفسي؟ ولا أراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدمًا لا يعاتب نفسه؟
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ قال الحسن: «هو الذي لا تراه إلا يلوم نفسه؛ ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟».
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ وَنَبَّه سبحانه بكونها لوامةً على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يُعَرِّفُها الخير والشر، ويدلها عليه، ويرشدها إليه، ويلهمها إياه؛ فيجعلها مريدة للخير، مرشدة له، كارهة للشر، مجانبة له؛ لتخلص من اللوم، ومن شر ما تلوم عليه، ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يُعَرِّفُها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها.
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ أقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة وفعل المعصية، فيندم ويتحسر لتأنيبها له.
عمل
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ لا يقسم ربنا إلا بعظيم، فهذه النفس التي ضعفت مدحها ﷲ عند ندمها وتوبتها؛ فلا تيأس أيها التائب.
وقفة
[2] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ كن ممتنًّا لضميرك الحيِّ، وإن أورَثَك القلق، هذا الفؤاد الواجِف ينظر الله إليه، ويحبُّه.
وقفة
[2] ربَّ ذنب أدخل صاحبه الجنة لشدة ندم صاحبه عليه، فيشق به طريقًا إلى الجنة ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾.
وقفة
[2] ثمة من يرتكب إثمًا صغيرًا فيغتم، وثمة من يرتكب فاحشة ولا يتأثر، انظر للون الأبيض يلوثه أي شئ، أما الأسود فيتحمل الأوساخ كثيرًا قال تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾.
وقفة
[2] ﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾ أي كثيرة اللوم لصاحبها، فعلى أي شيء تلومه؟ تلومه على كل خير ديني أو دنيوي فاتها او بلاء دنيوي او أخروي أصابها فقيل: تلومه على الذنب حتى يتوب وقيل: تلومه على التفريط في الطاعات حتى يفعلها. وقال مجاهد: تندم على ما فات وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل.
وقفة
[2] أهمية محاسبة النفس ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾.
عمل
[2] عاتب نفسك قبل أن تندم على أعمالك ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾.
وقفة
[2، 3] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ من عِظَم شأن النفس التى تلوم صاحبها على التقصير فى فعل الطاعات وترك الموبقات؛ أقسم الله بها على وقوع البعث والجزاء.
الإعراب :
- ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. اللوامة: صفة- نعت- للنفس مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. وهي من صيغ المبالغة أي النفس الكثيرة اللوم لصاحبها'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن أقسمَ اللهُ بيومِ القيامةِ؛ أقسمَ هنا بالنَّفسِ اللوَّامةِ التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة، وعلى فعل السيئات، قال تعالى:
﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾
التفسير :
ثم أخبر مع هذا، أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة، فقال:{ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أن لَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ} بعد الموت، كما قال في الآية الأخرى:{ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} ؟ فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن.
وجواب القسم يفهم من قوله- تعالى- بعد ذلك: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ. والمراد بالإنسان: جنسه. أو المراد به الكافر المنكر للبعث. والاستفهام للتوبيخ والتقريع.
وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن بعض المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد حدثني عن يوم القيامة، فأخبره صلى الله عليه وسلم عنه. فقال المشرك: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك- يا محمد- أو يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآية.
والمعنى: أقسم بيوم القيامة الذي لا شك في وقوعه في الوقت الذي نشاؤه، وأقسم بالنفس اللوامة التقية التي تلوم ذاتها على الخير، لماذا لم تستكثر منه، وعلى الشر لماذا فعلته، لنجمعن عظامكم- أيها الناس- ولنبعثنكم للحساب والجزاء.
وافتتح- سبحانه- السورة الكريمة بهذا القسم، للإيذان بأن ما سيذكر بعده أمر مهم، من شأن النفوس الواعية أن تستشرف له، وأن تستجيب لما اشتمل عليه من هدايات وإرشادات.
ووصف- سبحانه- النفس باللوامة بصيغة المبالغة للإشعار بأنها كريمة مستقيمة تكثر من لوم ذاتها، وتحض صاحبها على المسارعة في فعل الخيرات.
والعظام المراد بها الجسد، وعبر عنه بها، لأنه لا يقوم إلا بها، وللرد على المشركين الذين استبعدوا ذلك، وقالوا- كما حكى القرآن عنهم-: مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
أي يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة.
وقوله: ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ) يقول تعالى ذكره: أيظنّ ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرّقها، بلى قادرين على أعظم من ذلك، أن نسوي بنانه، وهي أصابع يديه ورجليه، فنجعلها شيئا واحدا كخفّ البعير، أو حافر الحمار، فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم، ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بها، ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط، فحسن خلقه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
تفاعل
[3] ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ سَبِّح الله الآن.
وقفة
[3، 4] ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ البنان: الأصابع، فنبَّه بالبنان -وهي عظم صغير- على بقية أعضاء الجسم، فلما زعموا أن الله لا يبعث الموتى، ولا يقدر على جمع العظام، قال لهم: بلى قادرين على أن نعيد هذه السلاميات على صغرها، ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر.
الإعراب :
- ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ ﴾
- الجملة جواب القسم لا محل لها من الاعراب بتقدير:لتبعثن: الهمزة همزة انكار وتعجيب بلفظ استفهام. يحسب: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة بمعنى: أيظن. الانسان: فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ أَلَّنْ: ﴾
- أصلها: أن أدغمت في «لن» و «ان» ملغاة لأن العرب اذا جمعت بين حرفين عاملين ألغت أحدهما. أو تكون هو «أن» المخففة من «أن» الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها مفصول عنها.بحرف نفي «لن نجمع عظامه» في محل رفع. و «ان» واسمها وخبرها في محل نصب بتأويل مصدر سدّ مسدّ مفعولي «يحسب».
- ﴿ نَجْمَعَ عِظامَهُ: ﴾
- فعل مضارع منصوب بلن وهي حرف نفي واستقبال ونصب وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره:نحن. عظامه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة بمعنى: نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا مختلطا بالتراب.'
المتشابهات :
| القيامة: 3 | ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ |
|---|
| القيامة: 36 | ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أيَحْسَبُ الإنسانُ ألَّن نَّجْمَعَ عِظامَهُ﴾ نَزَلَتْ في عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، وذَلِكَ أنَّهُ أتى النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: حَدِّثْنِي عَنْ يَوْمِ القِيامَةِ مَتى يَكُونُ ؟ وكَيْفَ أمْرُها وحالُها ؟ فَأخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقالَ: لَوْ عايَنْتُ ذَلِكَ اليَوْمَ لَمْ أُصَدِّقْكَ يا مُحَمَّدُ، ولَمْ أُومِن بِهِ، أوَيَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ العِظامَ ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ. '
- المصدر
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد القسم بهذين الأمرين ليبعثنَّ النَّاس للحساب والجزاء؛ وَبَّخَ اللهُ هنا الكافرين الذين أنكروا البعث بعد الموت، قال تعالى:
﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ
مدارسة الآية : [4] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ .. ﴾
التفسير :
فرد عليه بقوله:{ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} أي:أطراف أصابعه وعظامه، المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان، فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما [وقع] ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذببما أمامه من البعث. والفجور:الكذب مع التعمد.
وقوله- سبحانه-: بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ تأكيد لقدرته- تعالى- على إحياء الموتى بعد أن صاروا عظاما نخرة، وإبطال لنفيهم إحياء العظام وهي رميم.
وقادِرِينَ حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلى. وقوله: نُسَوِّيَ من التسوية، وهي تقويم الشيء وجعله متقنا مستويا، يقال: سوى فلان الشيء إذا جعله متساويا لا عوج فيه ولا اضطراب.
والبنان: جمع بنانة، وهي أصابع اليدين والرجلين، أو مفاصل تلك الأصابع وأطرافها.
أى: ليس الأمر كما زعم هؤلاء المشركون من أننا لا نعيد الإنسان إلى الحياة بعد موته للحساب والجزاء، بل الحق أننا سنجمعه وسنعيده إلى الحياة حالة كوننا قادرين قدرة تامة، على هذا الجمع لعظامه وجسده، وعلى جعل أصابعه وأطرافه وأنامله مستوية الخلق، متقنة الصنع، كما كانت قبل الموت.
وخصت البنان بالذكر، لأنها أصغر الأعضاء، وآخر ما يتم به الخلق، فإذا كان- سبحانه- قادرا على تسويتها مع لطافتها ودقتها، فهو على غيرها مما هو أكبر منها أشد قدرة.
قال سعيد بن جبير والعوفي ، عن ابن عباس : أن نجعله خفا أو حافرا . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وابن جرير . ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا .
والظاهر من الآية أن قوله : ( قادرين ) حال من قوله : ( نجمع ) أي : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه ، أي : قدرتنا صالحة لجمعها ، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان ، فنجعل بنانه - وهي أطراف أصابعه - مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي الخير بن تميم، عن سعيد بن جُبير، قال: قال لي ابن عباس: سل، فقلت: ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) قال: لو شاء لجعله خفا أو حافرا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قال: أنا قادر على أن أجعل كفه مجمرة مثل خفّ البعير.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، عن إسرائيل، عن مغيرة، عمن حدثه عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس ( قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قال: نجعله خفا أو حافرا.
قال: ثنا وكيع، عن النضر، عن عكرِمة ( عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قال: على أن نجعله مثل خفّ البعير، أو حافر الحمار.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قال: جعلها يدا، وجعلها أصابع يقبضهنّ ويبسطهنّ، ولو شاء لجمعهنّ، فاتقيت الأرض بفيك، ولكن سوّاك خلقا حسنا. قال أبو رجاء: وسُئل عكرِمة فقال: لو شاء لجعلها كخفّ البعير.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) رجليه، قال: كخفّ البعير فلا يعمل بهما شيئا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قادر والله على أن يجعل بنانه كحافر الدابة، أو كخفّ البعير، ولو شاء لجعله كذلك، فإنما ينقي طعامه بفيه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قال: لو شاء جعل بنانه مثل خفّ البعير، أو حافر الدابة.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) قال: البنان: الأصابع، يقول: نحن قادرون على أن نجعل بنانه مثل خفّ البعير.
واختلف أهل العربية في وجه نصب ( قَادِرِينَ ) فقال بعضهم: نصب لأنه واقع موقع نفعل، فلما ردّ إلى فاعل نصب، وقالوا: معنى الكلام: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نقدر على أن نسوّي بنانه ; ثم صرف نقدر إلى قادرين. وكان بعض نحويِّي الكوفة يقول: نصب على الخروج من نجمع، كأنه قيل في الكلام: أيحسب أن لن نقوَى عليه ؟ بل قادرين على أقوى منك. يريد: بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا. وقال: قول الناس بلى نقدر، فلما صرفت إلى قادرين نصبت خطأ، لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل. ألا ترى أنك تقول: أتقوم إلينا، فإن حوّلتها إلى فاعل قلت: أقائم، وكان خطأ أن تقول قائما; قال: وقد كانوا يحتجون بقول الفرزدق:
عَـليَّ قَسَـم لا أشْـتُمُ الدَّهْـرَ مُسْـلِما
وَلا خارِجــا مِـنْ فِـيَّ زُورُ كَـلام (6)
فقالوا: إنما أراد: لا أشتم ولا يخرج، فلما صرفها إلى خارج نصبها، وإنما نصب لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتما أحدا، ولا خارجا من فيّ زور كلام ; وقوله: لا أشتم، في موضع نصب. وكان بعض نحويِّي البصرة يقول: نصب على نجمع، أي بل نجمعها قادرين على أن نسوّي بنانه، وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب أهل العربية.
----------------
الهوامش :
(6) البيت للفرزدق ( ديوانه 769 طبع الصاوي ) من قصيدة قالها في المربد، ويروى: " علي حلفة " في موضع " علي قسم ". وقد أنشده الفراء في معاني القرآن ( 349 ) عند قوله تعالى: { بلى قادرين } قال: وقوله: { بلى قادرين } نصبت على الخروج من نجمع، كأنك قلت في الكلام: أتحسب أن لن نقوى عليك، بلى قادرين على إقوامك، يريد: بلى نقوى قادرين، بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا. قال: ولو كانت رفعا على الاستئناف، كأنه قال: بلى نحن قادرين على أكثر من ذا، كان صوابا، وقول الناس: بلى نقدر، فلما صرفت إلى قادرين نصبت خطأ؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل ألا ترى أنك تقول: أتقوم إلينا؟، فإن حولتها إلى فاعل، قلت: أقائمًا إلينا؟ وكان خطأ أن تقول: أقام إلينا؟ وقد كانوا يحتجون بقول الفرزدق: " علي قسم ... " البيت فقالوا: إنما أراد: لا أشتم ولا يخرج، فلما صرفها إلى يخرج نصبها وإنما نصب لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتما أحدا، ولا خارجا من في زور كلام. ا هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ أي: أطراف أصابعه وعظامه، لفظ بنانه مستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان، فقد تمت خلقة الجسد.
وقفة
[4] ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ قال ابن عباس: «لو شاء الله لجعل بَنان الإنسان كخُفِّ البعير أو حافر الحمار، ولكن جعله خلقاً سويًّا حسناً يقبض به ويبسط»، فتبارك الله أحسن الخالقين.
وقفة
[4] عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾، فقال: «إن الله أعفَّ مطعم ابن آدم ولم يجعله خفًّا ولا حافرًا، فهو يأكل بيديه ويتقي بها، وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه».
الإعراب :
- ﴿ بَلى: ﴾
- حرف جواب لا عمل له يجاب به عن النفي ويقصد به الايجاب وهو هنا بمعنى الجمع أي بلى نجمعها.
- ﴿ قادِرِينَ: ﴾
- حال من الضمير في «نجمع» العظام قادرين على تأليف جميعها وإعادتها الى التركيب الأول. أي يكون عامل الحال هنا محذوفا جوازا لأنه دلت على حضور معناه قرينة حالية أي نجمعها. منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.
- ﴿ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ: ﴾
- حرف جر. أن: حرف مصدرية ونصب. نسوي:فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وجملة «نسوي» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «ان» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بقادرين. التقدير: قادرين على تسوية بنانه.
- ﴿ بَنانَهُ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي على أن نسوي أصابعه أو على أن نجعلها أي نسوي أصابع يديه ورجليه ونجعلها مستوية شيئا واحدا.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا قالوا: لا نبعث؛ لأننا نتفتت وننمحق؛ رَدَّ اللهُ عليهم هنا بأنه قادر على إحياء الموتى بعد أن صاروا عظامًا، فقال تعالى:
﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
قادرين:
1- بالنصب، على الحال، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- قادرون، بالرفع، أي: نحن قادرون، وهى قراءة ابن أبى عبلة، وابن السميفع.
مدارسة الآية : [5] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾
التفسير :
وإنما [ وقع] ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث. والفجور:الكذب مع التعمد.
ثم ذكر أحوال القيامة فقال:
وقوله- تعالى- بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ بيان لحال أخرى من أحوال فجور هؤلاء المشركين وطغيانهم، وانتقال من إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال هذا الإنسان.
والفجور: يطلق على القول البالغ النهاية في السوء، وعلى الفعل القبيح المنكر، ويطلق على الكذب، ولذا وصفت اليمين الكاذبة، باليمين الفاجرة فيكون فجر بمعنى كذب، وزنا ومعنى.
ولفظ «الأمام» يطلق على المكان الذي يكون في مواجهة الإنسان، والمراد به هنا:
الزمان المستقبل وهو يوم القيامة، الذي دل عليه قوله- تعالى- بعد ذلك: يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ.
وقوله : ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) قال سعيد ، عن ابن عباس : يعني يمضي قدما .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( ليفجر أمامه ) يعني : الأمل ، يقول الإنسان : أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة ، ويقال : هو الكفر بالحق بين يدي القيامة .
وقال مجاهد ( ليفجر أمامه ) ليمضي أمامه راكبا رأسه . وقال الحسن : لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما ، إلا من عصمه الله .
وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي ، وغير واحد من السلف : هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد ، وهذا هو الأظهر من المراد ; ولهذا قال بعده
يقول تعالى ذكره: ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه، ولكنه يريد أن يمضي أمامه قُدُما في معاصي الله، لا يثنيه عنها شيء، ولا يتوب منها أبدا، ويسوّف التوبة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي الخير بن تميم الضبي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في قوله: ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: يمضي قُدُمًا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) يعني الأمل، يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال: هو الكفر بالحقّ بين يدي القيامة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: يمضي أمامه راكبا رأسه.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: قال الحسن: لا تلقى ابن آدم إلا تنـزع نفسه إلى معصية الله قُدُما قدما، إلا من قد عصم الله.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، في قوله: ( لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: قُدُما في المعاصي.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن عمرو، عن إسماعيل السدي ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: قُدُما.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن النضر، عن عكرِمة ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: قدما لا ينـزع عن فجور.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير ( لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: سوف أتوب.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يركب رأسه في طلب الدنيا دائبا ولا يذكر الموت.
* ذكر من قال ذلك:
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) هو الأمل يؤمل الإنسان، أعيش وأصيب من الدنيا كذا، وأصيب كذا، ولا يذكر الموت.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) يقول: الكافر يكذّب بالحساب.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) قال: يكذّب بما أمامه يوم القيامة والحساب.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل يريد الإنسان ليكفر بالحقّ بين يدي القيامة، والهاء على هذا القول في قوله: ( أمامَهُ ) من ذكر القيامة، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبل.
التدبر :
وقفة
[5] ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ أي: يريد الإنسان أن يمضي قدمًا ليفجر في معاصي الله, لا يثنيه عنها شئ, ولا يتوب منها أبدًا, ألا يكفي البعض أن فجر في ماضيه فيريد أن يفجر في مستقبله, فلا تنو الفجور لاحقًا ولو فعلته سابقًا.
وقفة
[5] ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ قال ابن عباس: «يعني الكافر يُكذب بما أمامه من البعث والحساب».
وقفة
[5] ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ قال سعيد بن جبير: «يُقدِم على الذنب ويؤخر التوبة، فيقول: سوف أتوب، سوف أعمل، حتى يأتيه الموت على شرِّ أحواله وأسوأ أعماله».
وقفة
[5] يولع المرء بالدنيا وزخرفها، فتصرفه عن ربه رويدًا رويدًا حتى يطول أمله ويسوف توبته، فينغمس في البعد عن الله بقية عمره ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾.
وقفة
[5، 6] ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ متى تجاهلت الآخرة في نفسك، فإنك ستجعل الدنيا هي غايتك.
وقفة
[5، 6] نسي الفاجر زاد الآخرة، فتزود بالفجور ليسعد في العاجلة.
وقفة
[5، 6] عن سعيد بن جبير قال: لا يزال المرء يقدِّمُ الذنبَ ويُؤخِّرُ التوبة؛يقول: سوف أتوب، حتى يأتيَه الموتُ على شرِّ أحواله، وأسوأ أعماله.
الإعراب :
- ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ: ﴾
- حرف اضراب لا عمل له يفيد الاستئناف. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على «أيحسب» فتكون مثلها استفهاما. يريد: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الانسان: فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ لِيَفْجُرَ: ﴾
- اللام لام «كي» في معنى- موضع «أن» لورودها بعد فعل الارادة.يفجر: فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره «هو» وجملة «يفجر» صلة لا لا محل لها من الاعراب والمصدر المتكون من اللام وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «يريد» وهذا قول الفراء والكوفيين في حين يرى الأخفش الذي يتفق مع ما ذهب اليه سيبويه والزجاج والمبرد أنها حرف جر للتعليل ونصب الفعل يكون بأن مضمرة بعدها لابها وهي جارة لمصدر المنسبك من «أن» والفعل.
- ﴿ أَمامَهُ: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بيفجر والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن وَبَّخَ اللهُ الكافرين الذين أنكروا البعث بعد الموت، ورَدَّ عليهم؛ بَيَّنَ هنا السببَ الحقيقي في إنكارِ الكافرِ للبعثِ والنُّشورِ، وهو أنه يريد الاستمرار على كفره وفجوره فيما بقى من عمره، قال تعالى:
﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾
التفسير :
أى: أن هذا الإنسان المنكر للبعث والحساب لا يريد أن يكف عن إنكاره وكفره، بل يريد أن يستمر على فجوره وتكذيبه لهذا اليوم بكل إصرار وجحود، فهو يسأل عنه سؤال استهزاء وتهكم فيقول: أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ أى: متى يجيء يوم القيامة هذا الذي تتحدثون عنه- أيها المؤمنون- وتخشون ما فيه من حساب وجزاء؟
قال القرطبي: قوله- تعالى-: بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ قال ابن عباس:
يعنى الكافر. يكذب بما أمامه من البعث والحساب.. ودليله يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ.
أى: يسأل متى يكون؟ على وجه التكذيب والإنكار، فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب.
ولكن يأثم لما بين يديه. ومما يدل أن الفجور: التكذيب، ما ذكره القتبى وغيره، من أن أعرابيا قصد عمر بن الخطاب، وشكا إليه نقب إبله ودبرها- أى: مرضها وجربها- وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله. فقال الأعرابى.
أقسم بالله أبو حفص عمر ... ما مسها من نقب ولا دبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر يعنى إن كان كذبني فيما ذكرت...
وأعيد لفظ الإنسان في هذه الآيات أكثر من مرة، لأن المقام يقتضى توبيخه وتقريعه، وتسجيل الظلم والجحود عليه.
والضمير في «أمامه» يجوز أن يعود إلى يوم القيامة. أى: بل يريد الإنسان ليكذب بيوم القيامة. الثابت الوقوع في الوقت الذي يشاؤه الله- عز وجل-.
ويجوز أن يعود على الإنسان، فيكون المعنى: بل يريد الإنسان أن يستمر في فجوره وتكذيبه بيوم القيامة في الحال وفي المآل. أى: أن المراد بأمامه: مستقبل أيامه.
وجيء بلفظ «أيان» الدال على الاستفهام للزمان البعيد، للإشعار بشدة تكذيبهم، وإصرارهم على عدم وقوعه في أى وقت من الأوقات.
يسأل أيان يوم القيامة ) ؟ أي : يقول متى يكون يوم القيامة ؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه ، وتكذيب لوجوده ، كما قال تعالى : ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) [ سبأ : 29 ، 30 ] .
قوله: ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) يقول تعالى ذكره: يسأل ابن آدم السائر دائبا في معصية الله قُدُما: متى يوم القيامة؟ تسويفا منه للتوبة.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[6] ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ كان عمر بن الخطاب يقول: «من سُئل عن يوم القيامة، فليقرأ هذه السورة».
وقفة
[6] ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ هذا سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة، وقد جاء بأداة الاستفهام (أيان) التي تدل على شدة الاستبعا،د وهذا المتعنت المستبعد لقيام الساعة هو الذي يقدم الفجور والمعصية ويؤخر التوبة، وهو المذكور في الآية السابقة.
الإعراب :
- ﴿ يَسْئَلُ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي يسأل مستهزئا أي سؤال متعنت مستبعدا لقيام الساعة. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب مفعول به.
- ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ: ﴾
- اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان متعلق بالخبر المقدم المحذوف. يوم: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. القيامة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي متى قيامها؟ .'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد بيان أن الكافرَ يريد الاستمرار على كفره وفجوره؛ جاء هنا الدليل على ذلك، وهو أنه يسأل عن يوم القيامة على وجه الاستهزاء والتهكم؛ لاعتقادِه استحالةَ وقوعِه، قال تعالى:
﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴾
التفسير :
أي:إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم، وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى:{ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}
ثم ساق- سبحانه- جانبا من أهوال يوم القيامة، على سبيل التهديد والوعيد لهؤلاء المكذبين.
فقال: فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ.
و «برق» - بكسر الراء وفتحها- دهش وفزع وتحير ولمع من شدة شخوصه وخوفه.
يقال: برق بصر فلان- كفرح ونصر- إذا نظر إلى البرق فدهش وتحير.
وقال تعالى هاهنا : ( فإذا برق البصر ) قال أبو عمرو بن العلاء : ( برق ) بكسر الراء ، أي : حار . وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى : ( لا يرتد إليهم طرفهم ) [ إبراهيم : 43 ] ، بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا ، لا يستقر لهم بصر على شيء ; من شدة الرعب .
وقرأ آخرون : " برق " بالفتح ، وهو قريب في المعنى من الأول . والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ، ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور .
متى يوم القيامة؟ تسويفا منه للتوبة فبين الله له ذلك فقال: ( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ... ) الآية.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن عطية، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن قتادة، قوله: ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) يقول: متى يوم القيامة، قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سُئل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) متى يكون ذلك، فقرأ: ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) قال: فكذلك يكون يوم القيامة.
التدبر :
وقفة
[7] ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ شخَص بصره، فلا يطرف من هول ما يرى، واختلفوا في متى تحصل هذه الحالة على ثلاثة أقوال، فقيل: عند الموت، وقيل: عند البعث، وقيل: عند رؤية جهنم.
الإعراب :
- ﴿ فَإِذا: ﴾
- الفاء استئنافية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون متعلق بجوابه وهو متضمن معنى الشرط خافض لشرطه. وجوابها في الآية الكريمة العاشرة.
- ﴿ بَرِقَ الْبَصَرُ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. برق: فعل ماض مبني على الفتح. البصر: فاعل مرفع بالضمة.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد السؤال عن يوم القيامة على وجه الاستهزاء والتهكم؛ ذكرَ اللهُ هنا من علامات يوم القيامة أمورًا ثلاثة: ١- إذا تحيَّر البصر واندهش حين يرى ما كان يكذِّب به، قال تعالى:
﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
برق:
1- بكسر الراء، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بفتحها، وهى قراءة زيد بن ثابت، ونصر بن عاصم، وعبد الله بن أبى إسحاق، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة، والزعفراني، وابن مقسم، ونافع، وزيد بن على، وأبان عن عاصم، وهارون، ومحبوب، وكلاهما عن أبى عمرو، والحسن، والجحدري، بخلاف عنهما.
3- بلق، باللام، أي: انفتح وانفرج، هى قراءة أبى السمال.
مدارسة الآية : [8] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾
التفسير :
{ وَخَسَفَ الْقَمَرُ} أي:ذهب نوره وسلطانه،
والمراد بخسوف القمر : انطماس نوره ، واختفاء ضوئه .
أي ذهب ضوءه.
وقوله: ( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأه أبو جعفر القارئ ونافع وابن أبي إسحاق ( فإذَا بَرَقَ ) بفتح الراء، بمعنى شخص، وفُتِح عند الموت ; وقرأ ذلك شيبة وأبو عمرو وعامة قرّاء الكوفة ( بَرِقَ ) بكسر الراء، بمعنى: فزع وشقّ.
وقد حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثني حجاج، عن هارون، قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عنها، فقال: ( بَرِقَ ) بالكسر بمعنى حار، قال: وسألت عنها عبد الله بن أبي إسحاق فقال: ( بَرَقَ ) بالفتح، إنما برق الخيطل (7) والنار والبرق. وأما البصر فبرق عند الموت. قال: وأخبرت بذلك ابن أبي إسحاق، فقال: أخذت قراءتي عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه، فذكرت لأبي عمرو، فقال: لكن لا آخذ عن نصر ولا عن أصحابه، فكأنه يقول: آخذ عن أهل الحجاز.
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب كسر الراء ( فَإِذَا بَرِقَ ) بمعنى: فزع فشُقّ وفُتِح من هول القيامة وفزع الموت. وبذلك جاءت أشعار العرب. أنشدني بعض الرواة عن أبي عُبيدة الكلابي:
لَمّــا أتــانِي ابْـنُ صُبَيْـحٍ رَاغِبـا
أعْطَيْتُــهُ عَيْســاء مِنْهــا فَـبرَقْ (8)
وحُدثت عن أبي زكريا الفرّاء قال: أنشدني بعض العرب:
نَعــــانِي حَنانَـــةُ طُوبالَـــةً
تَسَــفُّ يَبيســا مِــنَ الْعِشْــرقِ
فَنَفْسَـــك فـــانْعَ وَلا تَنْعَنِـــي
ودَاوِ الْكُلـــــومَ وَلا تَــــبْرَقِ (9)
بفتح الراء، وفسَّره أنه يقول: لا تفزع من هول الجراح التي بك ; قال: وكذلك يبرُق البصر يوم القيامة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ) يعني ببرق البصر: الموت، وبروق البصر: هي الساعة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( بَرِقَ الْبَصَرُ ) قال: عند الموت.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ) شخص البصر.
-----------------
الهوامش :
(7) من معاني الخيطل في اللسان: السنور، والكلب.
(8) الرجز من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( الورقة 182 ) عند قوله تعالى: { فإذا برق البصر } . وأنشده أبو زكريا التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ( طبع القاهرة 75 ) قال: البرق ( بالتحريك ) : أن يبرق البصر، وهو أن يتحير فلا يطرف، قال الأعور ابن براء الكلابي: كلاب مرة: " لما أتاني ابن صبيح ... " البيت. ومعه بيت آخر، وهو:
أعْطَيْتُــــهُ مَبْنِيَّـــةً دَأيَاتُهَـــا
مَــائِرَةَ الضَّبْعَيْـنِ سَـطْعَاءَ الْعُنُـقْ
قال صبيح: من هلال بن عامر، وكان الأعور خاله، فسأل ابن صبيح الأعور، فأعطاه ناقة من إبله، فذهب بها الهلالي، وهجا الأعور فقال:
أعْطَيْتَنِـــي سَــاقِطَةً أضْرَاسُــهَا
لَــوْ تَعْجُـمُ الْبَيْـضَ إذَنْ لَـمْ يَنْفَلِـقْ
مع أبيات غيرها فأجابه الأعور بقصيدة فيها البيتان المتقدمان. والدأيات: فقار الظهر، الواحدة دأية. والضبعان: العضدان.
ومائرة الضبعين: أي سريعة. والسطعاء: الطويلة العنق. ا هـ .
وفي ( اللسان برق ) وبرق بصره برقا ( كفرح فرحا ) وبرق يبرق بروقا ( كقعد يقعد قعودا ) الأخيرة عن اللحيان: دهش فلم يبصر. وقيل: تحير فلم يطرف. وفي التنزيل: { فإذا برق البصر } وبرق ( من بابي فرح وقعد ) قرئ بهما جميعا. ا هـ . وقال الفراء في معاني القرآن ( 349 ) : وقوله: { فإذا برق البصر } قرأهل الأعمش وعاصم والحسن وبعض أهل المدينة: برق، بكسر الراء. وقرأها نافع المدني: برق البصر، بفتح الراء، من البريق لمن فتح عينيه أي: شخص. وقوله: برق ( بالكسر ) أي: فزع. ا هـ .
(9) البيتان في ديوان طرفة طبعة " أدرنه - ك " سنة 1909 ص 15 قال: وقال في شأن إبل أخيه، وكان بشبكة امرئ القيس، فوثب حنانة الحاجب ليضربه، فانتزع طرفة سيفه. فقال في ذلك، ولم يروها الشنتمري. وفي ( اللسان: حنن ) وحنانة: اسم راع في قول طرفة: " نعاني حنانة ... " البيت.
قال ابن بري: رواه ابن القطاع : بغاني حنانة، بالباء والغين المعجمة. والصحيح: بالنون والعين غير المعجمة، كما وقع في الأصول، بدليل قوله بعد هذا البيت: " فنفسك فانع ... " البيت. وفي ( اللسان: طبل ) الطوبالة: النعجة. ا هـ . ونصبها على الذم له كأنه قال: أعني: طوبالة. وتسف: تأكل. والعشرق: نبت معروف عندهم. وقوله " لا تبرق " فسره اللسان بقوله: لا تفزع من هول الجراح التي بك، وفسره شارح الديوان السابق الذكر: أي لا تهددني. وفسره الفراء في معاني القرآن ( 349 ) فقال: وقوله: { برق } فزع، أنشدني بعض العرب: " نعاني حنانة ... " البيتين. فتح الراء أي: لا تفزع من هول الجراح التي بك. ا هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[8] ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ فلنتذكر مع كل خسوف قمر، خسوفه يوم القيامة.
الإعراب :
- ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها أي وذهب ضؤوه'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ٢- ذهب نور القمر، قال تعالى:
﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
وخسف:
1- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- مبنيا للمفعول، وهى قراءة أبى حيوة، وابن أبى عبلة، وزيد بن قطيب، وزيد بن على.
مدارسة الآية : [9] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾
التفسير :
{ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة، ويخسف القمر، وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين.
والمراد بخسوف القمر: انطماس نوره، واختفاء ضوئه.
والمراد بجمع الشمس والقمر: اقترانهما ببعضهما بعد افتراقهما واختلال النظام المعهود للكون، اختلالا تتغير معه معالمه ونظمه. وجواب فَإِذا قوله: يَقُولُ الْإِنْسانُ أى: فإذا برق بصر الإنسان وتحير من شدة الفزع والخوف، بعد أن رأى ما كان يكذب به في الدنيا.
والتعريف في البصر: للاستغراق، إذ أبصار الناس جميعا في هذا اليوم، تكون في حالة فزع، إلا أن هذا الفزع يتفاوت بينهم في شدته.
وَخَسَفَ الْقَمَرُ أى: ذهب ضوؤه. وانطمس نوره.
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ أى: وقرن بينهما بعد أن كانا متفرقين.
والتصقا بعد أن كانا متباعدين، وغاب ضوؤهما بعد أن كانا منيرين.
( وجمع الشمس والقمر ) قال مجاهد : كورا . وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية : ( إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ) [ التكوير : 1 ، 2 ] وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : " وجمع بين الشمس والقمر " .
وقوله: ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ) يقول: ذهب ضوء القمر.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ): ذهب ضوءه فلا ضوء له.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ) هو ضوءه، يقول: ذهب ضوءه.
التدبر :
وقفة
[9] ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ غدًا تلتهم الشمسُ القمر، وذلك بسبب اختلال الجاذبية التي جعلها الله في النظام الشمسي، لكنها تنهار يوم القيامة.
الإعراب :
- ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ: ﴾
- الواو: عاطفة. جمع: فعل ماض مبني على الفتح. الشمس: نائب فاعل مرفوع بالضمة. والقمر: معطوفة بالواو على «الشمس» وتعرب اعرابها. أي جمعا في الطلوع من المغرب بمعنى جمع بينهما في ذهاب ضوئهما عند قيام الساعة. والفعل «جمع» مبني للمجهول'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ٣- جُمِع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما، قال تعالى:
﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [10] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴾
التفسير :
{ يَقُولُ الْإِنْسَانُ} حين يرى تلك القلاقل المزعجات:{ أَيْنَ الْمَفَرُّ} أي:أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وأصابنا?
يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ أى: فإذا ما تم كل ذلك، يقول الإنسان في هذا الوقت الذي يبرق فيه البصر، ويخسف فيه القمر، ويجمع فيه بين الشمس والقمر: أين المفر. أى: أين الفرار من قضاء الله- تعالى- ومن قدره وحسابه. فالمفر مصدر بمعنى الفرار. والاستفهام بمعنى التمني أى: ليت لي مكانا أفر إليه مما أراه.
أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر أي هل من ملجإ أو موئل.
وقوله: ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) يقول تعالى ذكره: وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما، وهي في قراءة عبد الله فيما ذُكر لي ( وجُمِعَ بَين الشَّمْس والقَمَرِ ) وقيل: إنهما يجمعان ثم يكوّران، كما قال جلّ ثناؤه: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وإنما قيل: ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) لما ذكرت من أن معناه جمع بينهما. وكان بعض نحويِّي الكوفة يقول: إنما قيل: وجمع على مذهب وجمع النوران، كأنه قيل: وجمع الضياءان، وهذا قول الكسائي.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) قال: كوّرا يوم القيامة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) قال: جُمعا فرُمي بهما في الأرض.
وقوله: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ قال: كوّرت في الأرض والقمر معها.
قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن أبي شيبة الكوفيّ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية يوما: ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) قال: يجمعان يوم القيامة، ثم يقذفان في البحر، فيكون نار الله الكبرى.
التدبر :
وقفة
[10] ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾ هذا القول موعظة، تردعك عن طلب الفرار وتمنيه يوم القيامة، فاهجر اليوم كل ما يدعوك لطلب الفرار غدًا.
عمل
[10] ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾؟ لا زال لديك متسع من الوقت، فِر إلى الله الآن.
الإعراب :
- ﴿ يَقُولُ الْإِنْسانُ: ﴾
- الجملة الفعلية: جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. يقول: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الانسان: فاعل مرفوع بالضمة والجملة الاسمية بعده: في محل نصب مفعول به- مقول القول-.
- ﴿ يَوْمَئِذٍ: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بيقول وهو مضاف و «اذ» اسم مبني على السكون الظاهر على آخره وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين: سكونه وسكون التنوين وهو في محل جر مضاف اليه أيضا والجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين في محل جر مضاف اليه. التقدير:يومئذ يخسف القمر وتجمع الشمس والقمر يقول الانسان ...
- ﴿ أَيْنَ الْمَفَرُّ: ﴾
- اسم استفهام يعرب اعراب «أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ» في الآية الكريمة السادسة وهي مصدر أي الفرار.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا يرى الكافرُ هذه الأهوال؛ يقول وقتها: أين المهرب من العذاب؟، قال تعالى:
﴿ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
المفر:
1- بفتح الميم والفاء، أي: الفرار، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بفتح الميم وكسر الفاء، وهو موضع الفرار، وهى قراءة الحسن بن على بن أبى طالب، والحسين بن زيد، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، وأيوب السختياني، وكلثوم بن عياض، ومجاهد، وابن يعمر، وحماد بن سلمة، وأبى رجاء، وعيسى، وابن أبى إسحاق، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة، والزهري.
3- بكسر الميم وفتح الفاء، أي: الجيد الفرار، وعزاهما ابن عطية إلى الزهري.
مدارسة الآية : [11] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾
التفسير :
{ كَلَّا لَا وَزَرَ} أي:لا ملجأ لأحد دون الله،
وقوله- سبحانه-: كَلَّا لا وَزَرَ. إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إبطال لهذا التمني، ونفى لأن يكون لهذا الإنسان مهرب من الحساب.
والوزر: المراد به الملجأ والمكان الذي يحتمي به الشخص للتوقي مما يخافه، وأصله: الجبل المرتفع المنيع، من الوزر وهو الثقل.
أى: كلا لا وزر ولا ملجأ لك. أيها الإنسان- من المثول أمام ربك في هذا اليوم للحساب والجزاء.
ومهما طال عمرك، وطال رقادك في قبرك.. فإلى ربك وحده نهايتك ومستقرك ومصيرك، في هذا اليوم الذي لا محيص لك عنه.
قال الله تعالى : ( كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ) قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ، وغير واحد من السلف : أي لا نجاة .
وهذه كقوله : ( ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من نكير ) [ الشورى : 47 ] أي : ليس لكم مكان تتنكرون فيه ، وكذا قال هاهنا ( لا وزر ) أي : ليس لكم مكان تعتصمون فيه
وقوله: ( يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ) بفتح الفاء، قرأ ذلك قرّاء الأمصار، لأن العين في الفعل منه مكسورة، وإذا كانت العين من يفعل مكسورة، فإن العرب تفتحها في المصدر منه إذا نطقت به على مَفعَل، فتقول: فرّ يفرّ مفرّا، يعني فرًّا، كما قال الشاعر:
يــا لَبَكْــرٍ انْشِــرُوا لـي كُلَيْبـا
يــا لَبَكْــرٍ أيْــنَ أيْــنَ الْفِـرَارُ (10)
إذا أريد هذا المعنى من مفعل قالوا: أين المفرّ بفتح الفاء، وكذلك المدبّ من دبّ يدبّ، كما قال بعضهم:
كــأنَّ بَقايــا الأثْـرِ فَـوْقَ مُتُونِـه
مَـدَبُّ الـدَّبَى فَـوْقَ النَّقا وَهْوَ سارِح (11)
وقد يُنشد بكسر الدال، والفتح فيها أكثر، وقد تنطق العرب بذلك، وهو مصدر بكسر العين. وزعم الفرّاء أنهما لغتان، وأنه سُمع: جاء على مَدبّ السيل، ومدِبّ السيل، وما في قميصه مصَحّ ومصِحّ. فأما البصريون فإنهم في المصدر يفتحون العين من مَفْعَل إذا كان الفعل على يَفعِل، وإنما يُجيزون كسرها إذا أريد بالمفعل المكان الذي يفرّ إليه، وكذلك المضرب: المكان الذي يضرب فيه إذا كُسرت الراء. ورُوِي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك بكسر الفاء، ويقول: إنما المفِرّ: مفِر الدابة حيث تفرّ.
والقراءة التي لا أستجيز غيرها الفتح في الفاء من المَفرّ، لإجماع الحجة من القرّاء عليها، وأنها اللغة المعروفة في العرب إذا أريد بها الفرار، وهو في هذا الموضع الفرار. وتأويل الكلام: يقول الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة: أين المفرّ من هول هذا الذي قد نـزل، ولا فرار.
التدبر :
وقفة
[11] ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ الوَزَر: المراد به الملجأ والمكان الذي يحتمي به الشخص ليتقي به ما يخاف، وأصله: الجبل المرتفع المنيع، من الوَزَر وهو الثِّقَل، فلا مفرَّ يوم القيامة من الحساب.
الإعراب :
- ﴿ كَلَّا لا: ﴾
- حرف ردع وزجر أي ردع عن طلب المفر. لا: أداة نافية للجنس تعمل عمل «أن».
- ﴿ وَزَرَ: ﴾
- اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف وجوبا. أي لا ملجأ ولا منجي كائن.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا كانَ ذَلِكَ اليَوْمُ يَوْمَ انْقِطاعِ الأسْبابِ؛ نفى اللهُ ما سألَ عَنْهُ بِأداةِ الرَّدْعِ، لا فرار في ذلك اليوم، ولا مَلْجأ، ولا مُعْتَصَم يعتصم به، قال تعالى:
﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [12] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴾
التفسير :
{ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ} لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله،
ومهما طال عمرك ، وطال رقادك فى قبرك . . فإلى ربك وحده نهايتك ومستقرك ومصيرك ، فى هذا اليوم الذى لا محيص لك عنه .
أي المرجع والمصير.
يقول تعالى ذكره: ( لا وَزَرَ ) يقول جلّ ثناؤه: ليس هناك فرار ينفع صاحبه، لأنه لا ينجيه فِراره، ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل، من أمر الله الذي قد حضر، وهو الوزر.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) يقول: لا حرز.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) يعني: لا حصن، ولا ملجأ.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: ثنا إبراهيم بن طريف، قال: سمعت مُطَرِّف بن الشِّخِّير يقرأ: ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) فلما أتى على: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: هو الجبل، إن الناس إذا فرّوا قالوا عليك بالوَزَر.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مَهديّ، عن شعبة، عن أدهم، قال: سمعت مُطَرِّفا يقول: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: كلا لا جَبَل.
حدثنا نصر بن عليّ الجهضمي، قال: ثني أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، قال: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: لا جبل.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: كانت العرب تخيف بعضها بعضا، قال: كان الرجلان يكونان في ماشيتهما، فلا يشعران بشيء حتى تأتيهما الخيل، فيقول أحدهما لصاحبه، يا فلان الوَزَر الوَزَر، الجَبَل الجَبَل.
حدثني أبو حفص الحيريّ، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا أبو مودود، عن الحسن، في قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: لا جبل.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي مودود، قال: سمعت الحسن فذكر نحوه.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( لا وَزَرَ ) لا ملجَأ ولا جبل.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( كَلا لا وَزَرَ ) لا جبل ولا حِرْز ولا منجى. قال الحسن: كانت العرب في الجاهلية إذا خشوا عدوّا قالوا: عليكم الوزر: أي عليكم الجبل.
حدثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا ابن المبارك، عن سفيان عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قلابة في قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: لا حصن.
حدثنا أحمد بن هشام، قال: ثنا عبيد الله، قال: أخبرنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قلابة بمثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قلابة مثله.
قال (12) ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا مسلم بن طهمان، عن قتادة، في قوله: ( لا وَزَرَ ) يقول: لا حصن.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( لا وَزَرَ ) قال: لا جبل.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبيه، عن مولى للحسن، عن سعيد بن جُبير ( لا وَزَرَ ): لا حصن.
قال ثنا وكيع، عن أبي حجير، عن الضحاك: لا حصن.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) يعني: الجبل بلغة حِمْير.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( كَلا لا وَزَرَ ) قال: لا مُتَغَيَّب يُتَغيب فيه من ذلك الأمر، لا منجَى له منه.
-----------------
الهاومش :
(10) البيت لمهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليب بن ربيعة ( العقد الفريد: في يوم الذنائب ) . وقافيته مختلفة عن رواية المؤلف، وبعد:
تِلْـــكَ شَــيْبَان تَقُــولُ لِبَكْــرٍ
صَــرَّحَ السِّـــرُّ وَبَــانَ السِّـرَارُ
وبنـــو عِجْـــلٍ تَقُـــولُ لِقَيْسٍ
وَلِتَيْــمِ الــلاتِ سِــيرُوا فَسَـارُوا
وفي ( اللسان: فر ) وقوله تعالى: { أين المفر } أين الفرار؟ وقرئ: أين المفر؟ ( بكسر الفاء ) أي: أين موضع الفرار؟ عن الزجاج. وفي معاني القرآن للفراء ( 349 ) وقوله: { أين المفر } بفتح الفاء. وبإسناد ثعلب إلى ابن عباس أنه قرأ: " أين المفر " ( أي بكسر الفاء ) وقال: إنما المفر ( أي بالفتح ) : مفر الدابة : حيث تفر. وهما لغتان: المفر والمفر، والمدب والمدب ( أي بفتح الفاء والدال، وبكسرهما ) . ا هـ .
(11) وهذا البيت أيضا من شواهد الفراء ( 350 ) وكلامه فيه متمم لكلامه في الشاهد الذي قبله، قال: وما كان: " يفعل " ( المضارع ) فيه مكسورا ( مكسور العين ) مثل: يدب ويفر ويصح، تقول: مفر ومفر، ومصح ومصح، ومدب ومدب، ( أي: بفتح العين وكسرها ) وأنشدني بعضهم: " كأن بقايا الأثر ... " البيت. ينشدونه مدب ( لعله بفتح الدال ) وهو أكثر من مدب.
ويقال: جاء على مدب السيل ومدب السيل، وما في قميصه مصح ولا مصح. ا هـ . والأثر، بفتح الهمزة وكسرها وبضمتين على فعل، هو واحد ليس بجمع: فرند السيف ورونقه. والجمع: أثور ( اللسان: أثر ) . ا هـ .
(12) لعله قد أسقط صدر السند من هذا الحديث؛ لأنه كالذي قبله.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[12] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ أي: إلي ربك أيها الإنسان الإستقرار, وهذا يدل على أن الناس في الحياة الدنيا سائرون يكدحون ويعملون حتي يكون الاستقرار عند الله.
وقفة
[12] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ لا محيد عن الرجوع إليه، ليستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.
الإعراب :
- ﴿ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. يومئذ: أعربت في الآية الكريمة العاشرة. أي خاصة يومئذ.
- ﴿ الْمُسْتَقَرُّ: ﴾
- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة أي استقرار العباد بمعنى عند ربك خاصة يومئذ.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [12] لما قبلها : وبعد بيان أنه لا فرار في ذلك اليوم، ولا مَلْجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا مُعْتَصَم يعتصم به؛ كشفَ اللهُ هنا عن حقيقة الحال وبَيَّنَها: إلى الله وحده في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب والجزاء، قال تعالى:
﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [13] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ .. ﴾
التفسير :
{ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ} أي:بجميع عمله الحسن والسيء، في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره.
وقوله- سبحانه- يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ
بيان لما يحدث له يوم القيامة، أى: يخبر الإنسان في هذا اليوم بما قدم من أعمال حسنة. وبما أخر منها فلم يعملها، مع أنه كان في إمكانه أن يعملها، والمقصود بالآية المجازاة على الأعمال لا مجرد الإخبار.
قال الإمام ابن كثير: قوله- تعالى-: يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ
أى:
يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، كما قال- سبحانه-:
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً.
ثم قال تعالى : ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) أي : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها ، أولها وآخرها ، صغيرها وكبيرها ، كما قال تعالى : ( ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) [ الكهف : 49 ]
وقوله: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) يقول تعالى ذكره: إلى ربك أيها الإنسان يومئذ الاستقرار، وهو الذي يقرّ جميع خلقه مقرّهم.
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) قال: استقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. وقرأ قول الله: وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .
وقال آخرون: عني بذلك إلى ربك المنتهى.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ): أي المنتهى.
يقول تعالى ذكره: يُخْبَر الإنسان يومئذ، يعني يوم يُجْمَع الشمس والقمر فيكوّران بما قدّم وأخَّر.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
تفاعل
[13] ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ قل: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت».
وقفة
[13] ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ متى هذا النبأ؟! والجواب: قولان: الأول: يوم القيامة عند وزن الأعمال. والثاني: عند الموت. والأول أرجح؛ لأن الميت تصله صدقاته الجارية بعد موته.
تفاعل
[13] ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ حتى آثارُ عملك الباقية ستُسأل عنها وتُحاسب يوم تلاقي الله، فاحرِص أن تُخلِّفَ أثرًا جميلًا؛ من ذرية صالحة، أو صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به.
عمل
[13] ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ قدِّم ما يسرك أن تسمعه يوم القيامة، واستغفر الله مما يسوؤك سماعه.
وقفة
[13] ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ هذه الآية متناسبة مع ذكر النفس اللوامة، في أول السورة في حالتيها اللتين تدعوان إلى اللوم، أن تفعل فعلًا ما كان ينبغي لها أن تفعله، فتلوم نفسها عليه، وهذا يدخل فيما قدم، أو تقعد عن عمل كان ينبغي لها أن تعمله، فلم تعمله وهو يدخل فيما أخر.
الإعراب :
- ﴿ يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ: ﴾
- فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة. الانسان:نائب فاعل مرفوع بالضمة
- ﴿ يَوْمَئِذٍ بِما: ﴾
- أعربت في الآية الكريمة العاشرة. الباء حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بينبأ.أي يخبر.
- ﴿ قَدَّمَ وَأَخَّرَ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «قدم» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. أي بما قدمه من عمل أو يكون العائد المحذوف شبه جملة. التقدير: بما قدم من عمل عمله. وأخر: معطوفة بالواو على «قدم» وتعرب اعرابها. أي وبما أخر من عمل لم يعمله أو بما قدم من عمل الخير والشر وبما أخر سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [13] لما قبلها : وبعد بيان أن إلى الله وحده المرجع والمصير للحساب والجزاء، ذكرَ اللهُ هنا أنَّ الإنسانَ يُخبَرُ يومَ القيامةِ بأعمالِه، وأن مآلَه رهن بما عمل، قال تعالى:
﴿ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [14] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾
التفسير :
{ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} أي:شاهد ومحاسب،
ثم أكد- سبحانه- هذا المعنى بقوله: بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ.
والبصيرة هنا بمعنى الحجة المشاهدة عليه، وهي خبر عن المبتدأ وهو الْإِنْسانُ والجار والمجرور متعلق بلفظ بصيرة والهاء فيها للمبالغة، مثل هاء علامة ونسابة.
أى: بل الإنسان حجة بينة على نفسه، وشاهدة بما كان منه من الأعمال السيئة، ولو أدلى بأية حجة يعتذر بها عن نفسه. لم ينفعه ذلك.
قال صاحب الكشاف: بَصِيرَةٌ
أى: حجة بينة، وصفت بالبصارة على المجاز، كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله: فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً أو: عين بصيرة والمعنى أنه ينبأ بأعماله، وإن لم ينبأ ففيه ما يجزئ عن الإنباء، لأنه شاهد عليها بما عملت، لأن جوارحه تنطق بذلك، كما قال- تعالى- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ.
وهكذا قال هاهنا : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) أي : هو شهيد على نفسه ، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر ، كما قال تعالى : ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) [ الإسراء : 14 ] .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) يقول : سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه .
وقال قتادة : شاهد على نفسه . وفي رواية قال : إذا شئت - والله - رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه ، وكان يقال : إن في الإنجيل مكتوبا : يا ابن آدم ، تبصر القذاة في عين أخيك ، وتترك الجذل في عينك لا تبصره .
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ) فقال بعضهم: معنى ذلك: بما قدّم من عمل خير، أو شرّ أمامه، مما عمله في الدنيا قبل مماته، وما أخَّر بعد مماته من سيئة وحسنة، أو سيئة يعمل بها من بعده.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ) يقول: ما عمل قبل موته، وما سَنّ فعُمِل به بعد موته.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود قال: ( بِمَا قَدَّمَ ) من عمله ( وأخَّرَ ) من سنة عمل بها من بعده من خير أو شرّ.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: يُنَبأُ الإنسان بما قدم من المعصية، وأخر من الطاعة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ) يقول: بما قدّم من المعصية، وأخَّر من الطاعة، فينبأ بذلك.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ينبأ بأوّل عمله وآخره.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور عن مجاهد ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ) قال: بأول عمله وآخره.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مجاهد، مثله.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد وإبراهيم، مثله.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( بمَا قَدَّمَ ) من طاعة ( وأخَّرَ ) من حقوق الله التي ضيَّعها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ ) من طاعة الله ( وأخَّرَ ) مما ضيع من حقّ الله.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ) قال: بما قَدّم من طاعته، وأخَّر من حقوق الله.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: بما قدّم من خير أو شرّ مما عمله، وما أخَّر مما ترك عمله من طاعة الله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ) قال: ما أخر ما ترك من العمل لم يعمله، ما ترك من طاعة الله لم يعمل به، وما قدم: ما عمل من خير أو شرّ.
والصواب من القول في ذلك عندنا، أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبأ بكلّ ما قدّم أمامه مما عمل من خير أو شرّ في حياته، وأخَّر بعده من سنة حسنة أو سيئة مما قدّم وأخَّر، كذلك ما قدّم من عمل عمله من خير أو شرّ، وأخَّر بعده من عمل كان عليه فضيَّعه، فلم يعمله مما قدّم وأخَّر، ولم يخصص الله من ذلك بعضا دون بعض، فكلّ ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة.
التدبر :
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ بينت اﻵية أن فقه النفس يقوم على: التبصر في أعماق النفس؛ فمن غاص في أعماقها عرف أسرارها.
وقفة
[14] مهما تظاهرت أمام الناس لتحسن صورتك؛ فلا تصدق ما يقولون، فأنت تعلم حقيقتك ﴿بَلِ الإِنسانُ عَلى نَفسِهِ بَصيرَةٌ﴾
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ استحضار العبد لخطاياه وذنوبه؛ تجعله لا يرى لنفسه على أحد فضلًا، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه متبسط فقد أحسن إليه، فما أطيب عيشه! وما أنعم باله! خلافًا لمن يرى لنفسه على الناس حقوقًا من الإكرام يطلبها منهم، ويذمهم على ترك القيام بها.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ السرُّ الوحيد الذي لا يعلمه غيرك، هو سرُّ العلاقة بربِّك؛ فَلا يغرُّك المادحون ولا يضرُّك القادحون.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أنت الميزان فلا يغرك مادح ولا يضرك قادح.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ قال ابن المبارك: «ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ؛ ﺃَﻣرهُ ﻓﻲ ﺳﺘﺮ، ﻭﻧﻬﺎﻩُ ﻓﻲ ﺳﺘﺮ؛ ﻓﻴﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺳﺘﺮه، ﻭﻳﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﻴﻪ».
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ من أبصر هذه الآية علم أن الجوارح التي يعصي بها ليمتعها ستكون شاهدة عليه يوم العرض والحساب.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ صوت الضمير القابع في أعماقنا يفضح معاذيرنا الخادعة.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أنت أدرى الناس بنفسك، وتستطيع أن تخدع الجميع إلا نفسك التي بين جنبيك.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ قال ابن العربي: «فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه».
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ إذا عرفت نفسك، فلن يغرك مدح مادح، ولن يضرك قدح قادح.
اسقاط
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ جوارحك ستشهد عليك بما عملت؛ فهل من توبة قبل شهادتها بالسوء عنك؟!
عمل
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أنت تعرف نفسك جيدًا؛ فلا يغرك ثناء الناس عليك.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ الإنسان عالم بنفسه، شهيد على ما فعله، ولو اعتذر وأنكر.
عمل
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ قد يجد المسلم خلافًا في مسألةٍ من مسائل الفقه، فيميل إلى قولٍ دون قول، لا لأنه الحقُّ، ولكن لأنه يوافق هواه، فلينتبه وليتذكر هذه الآية.
وقفة
[14] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أنت الأعلم بنفسك، وبما قدمته في هذه الحياة.
وقفة
[14] كثيرًا ما يعتذر الإنسان عن تقصيره وأخطائه بمعاذير مع قرارة نفسه بالخطأ، وخير ما يذكر به قول الله: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾.
عمل
[14] داوِ قلبك وعِظْ نفسَك بـ: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾.
عمل
[14] لن يكشف أسرار خباياك ويخلي بينك وبين نفسك مثل القرآن ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، فتدبره لتقرأ ما في روحك فيه.
عمل
[14] القاعدة: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أنت أعلم الناس بقضايا نفسك وسرائرها؛ فاجتهد وأخلص.
عمل
[14، 15] عند تلاوة هذه الاية: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ قف متدبرًا متأملًا، ثم اسأل نفسك بصدق وتجرد: هل جميع همومك خاضعة لهم هذا الدين؟ أو (هو) مجرد هم من تلك الهموم؟
وقفة
[14، 15] حين يقرؤك الآخرون؛ يرون فيك جانبك الظاهر، ولن يغوص إلى ذاك الخفي سواك، ولن تكون هناك قناة أخرى تثبت تردداته إلاك ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾.
وقفة
[14، 15] ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ تجد الشخص في الدنيا يبحث عن مائة عذر وعذر ليتجاوز لوم الضمير وتأنيب الفؤاد، بل وملامة المخلوقين، أما في القيامة فما تصنع المعاذير أمام العليم الخبير؟
عمل
[14، 15] لا تبيع الوهم على نفسك، وأصدق معها، ولو أوجعتها، فمرارة الانكسار أهون من حرارة النار ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾.
الإعراب :
- ﴿ بَلِ الْإِنْسانُ: ﴾
- حرف اضراب لا عمل له يفيد الاستئناف وكسر آخره لالتقاء الساكنين. الانسان: مبتدأ مرفوع بالضمة.
- ﴿ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ: ﴾
- جار ومجرور متعلق ببصيرة. والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. بصيرة: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. أي حجة بينة وصفت بالبصارة على المجاز كما وصفت الآيات بالابصار في قوله تعالى «فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً» أو عين بصيرة. وأنث خبر المبتدأ «الانسان بصيرة» للمبالغة أو جاءت التاء كما ذكر على معنى «حجة بينة» أي الانسان حجة بينة على نفسه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ أنَّ الإنسانَ يُخبَرُ يومَ القيامةِ بأعمالِه؛ ذَكَر هنا أنَّه شاهِدٌ على نَفْسِه بما عَمِلَ، قال تعالى:
﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [15] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾
التفسير :
{ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} فإنها معاذير لا تقبل، ولا تقابل ما يقرر به العبد، فيقر به، كما قال تعالى:{ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} .
فالعبد وإن أنكر، أو اعتذر عما عمله، فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره، وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه:{ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ}
وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ أى: ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها.
وعن الضحاك: ولو أرخى ستوره، وقال: المعاذير: الستور، واحدها معذار، فإن صح فلأنه يمنع رؤية المحتجب، كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب..
فإن قلت: أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير؟ قلت: المعاذير ليس بجمع معذرة، إنما هو اسم جمع لها. ونحوه: المناكير في المنكر
فالمقصود بهاتين الآيتين: بيان أن الإنسان لن يستطيع أن يهرب من نتائج عمله مهما حاول ذلك، لأن جوارحه شاهدة عليه، ولأن أعذاره لن تكون مقبولة، لأنها جاءت في غير وقتها، كما قال- تعالى-: يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
وقال مجاهد : ( ولو ألقى معاذيره ) ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : ( ولو ألقى معاذيره ) ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه . وقال السدي : ( ولو ألقى معاذيره ) حجته . وكذا قال ابن زيد والحسن البصري ، وغيرهم . واختاره ابن جرير .
وقال قتادة ، عن زرارة ، عن ابن عباس : ( ولو ألقى معاذيره ) يقول : لو ألقى ثيابه .
وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره ، وأهل اليمن يسمون الستر : المعذار .
والصحيح قول مجاهد وأصحابه ، كقوله : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) [ الأنعام : 23 ] وكقوله ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) [ المجادلة : 18 ] .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( ولو ألقى معاذيره ) هي الاعتذار ، ألم تسمع أنه قال : ( لا ينفع الظالمين معذرتهم ) [ غافر : 52 ] وقال ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) [ النحل : 87 ] ( فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ) [ النحل : 28 ] وقولهم ( والله ربنا ما كنا مشركين )
وقوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله، ويشهدون عليه به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) يقول: سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحهوالبصيرة على هذا التأويل ما ذكره ابن عباس من جوارح ابن آدم وهي مرفوعة بقوله: ( عَلَى نَفْسِهِ ) ، والإنسان مرفوع بالعائد من ذكره في قوله: نفسه.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل الإنسان شاهد على نفسه وحده، ومن قال هذا القول جعل البصيرة خبرًا للإنسان، ورفع الإنسان بها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) يقول: الإنسان شاهد على نفسه وحده.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) قال: شاهد عليها بعملها.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم، غافلا عن ذنوبه؛ قال: وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك، ولا تبصر الجذع المعترض في عينك.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) قال: هو شاهد على نفسه، وقرأ: اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ومن قال هذه المقالة يقول: أدخلت الهاء في قوله ( بَصِيرَةٌ ) وهي خبر للإنسان، كما يقال للرجل: أنت حجة على نفسك، وهذا قول بعض نحويِّي البصرة. وكان بعضهم يقول: أدخلت هذه الهاء في بصيرة وهي صفة للذكر، كما أدخلت في راوية وعلامة.
التدبر :
وقفة
[15] ﴿وَلَو أَلقى مَعاذيرَهُ﴾ قال السيوطي: «لو اعتذر بعد الإقرار لم يُقبل منه، ففيه دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يُقبَل».
وقفة
[15] ﴿وَلَو أَلقى مَعاذيرَهُ﴾ لن ينفعك اعتذارك وقتها.
وقفة
[15] ﴿وَلَو أَلقى مَعاذيرَهُ﴾ جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان: «أن هشام بن عبد الملك أرسل إلى الأعمش أن اكتب لي مناقب عثمان بن عفان ومساوئ علي، فكتب إليه الأعمش: بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد، فلو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك، فإياك أن يكون شغلك الشاغل عيوب فلان وسقطاته وزلاته، فإنك لا تحاسب عليها، وحسنات الناس لأنفسهم لا لك، فاشغل نفسك بإصلاح عيوبك، والتوبة من سيئاتك، وزيادة حسناتك فهي الباقية في كتابك، فعلامة خسران العبد انشغاله بعيوب الناس».
الإعراب :
- ﴿ وَلَوْ أَلْقى: ﴾
- الواو: حالية. لو: مصدرية. ألقى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «أَلْقى مَعاذِيرَهُ» صلة «لو» لا محل لها من الاعراب و «لو» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر. التقدير حتى القاء معاذيره والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة التقدير مبديا القاء معاذيره أي اكثار معاذيره.
- ﴿ مَعاذِيرَهُ: ﴾
- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي اعذاره وهي اسم جمع لمعذرة والقياس أن تجمع «المعذرة» على معاذر و «معاذير» مثل «مناكير» في «منكر'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الإنْسانُ يَعْتَذِرُ في ذَلِكَ اليَوْمِ عَنْ كُلِّ سُوءِ عَمَلِهِ، ويُجادِلُ أعْظَمَ مُجادَلَةٍ، وكانَ المُجادِلُ في الغالِبِ يَظُنُّ أنَّهُ لَمْ يُذْنِبْ أوْ لا يَعْلَمُ لَهُ ذَنْبًا؛ قال تعالى:
﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [16] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ .. ﴾
التفسير :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي، وشرع في تلاوته عليه، بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن هذا، وقال:{ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}
وقال هنا:{ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه، ويجمعه الله في صدره،
ثم أرشد الله- تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب عليه عند تبليغ القرآن إليه عن طريق الوحى. فقال- سبحانه-: لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ.
والضمير في بِهِ
يعود إلى القرآن الكريم المفهوم من المقام. والمراد بقوله:
لا تُحَرِّكْ
نهيه صلى الله عليه وسلم عن التعجل في القراءة.
هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك ، فإنه كان يبادر إلى أخذه ، ويسابق الملك في قراءته ، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له ، وتكفل له أن يجمعه في صدره ، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه ، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ، فالحالة الأولى جمعه في صدره ، والثانية تلاوته ، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه ; ولهذا قال : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) أي : بالقرآن ، كما قال : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ) [ طه : 114 ] .
وقوله: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) اختلف أهل الرواية في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: بل للإنسان على نفسه شهود من نفسه، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم، وركب من المعاصي، وجادل بالباطل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) يعني الاعتذار، ألم تسمع أنه قال: لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وقال الله: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ (13) . وقولهم: وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبير، في قولة: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) قال: شاهد على نفسه ولو اعتذر.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) ولو جادل عنها، فهو بصيرة عليها.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن عمران بن حدير، قال: سألت عكرِمة، عن قوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) قال: فسكت، فقلت له: إن الحسن يقول: ابن آدم عملك أولى بك، قال: صدق.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) قال: معاذيرهم التي يعتذرون بها يوم القيامة فلا ينتفعون بها، قال: وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ويوم يؤذن لهم فيعتذرون فلا تنفعهم ويعتذرون بالكذب.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرّد.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني نصر بن عليّ الجهضمي، قال: ثني أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس، في قوله: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) قال: لو تجرّد.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن خلف العسقلاني، قال: ثنا رَوّاد، عن أبي حمزة، عن السديّ في قوله: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) ولو أرخى الستور، وأغلق الأبواب.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) لم تقبل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثني أ بي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) لم تُقبل معاذيره.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) قال: ولو اعتذر.
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معناه: ولو اعتذر لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنـزيل، وذلك أن الله جلّ ثناؤه أخبر عن الإنسان أن عليه شاهدًا من نفسه بقوله: ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك، ولو جادل عنها بالباطل، واعتذر بغير الحقّ، فشهادة نفسه عليه به أحقّ وأولى من اعتذاره بالباطل.
----------------
الهوامش :
(13) في سورة النحل: { فألقوا السلم ما كنا ... } إلخ. وفي آية أخرى منها: { وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ... } الآية.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[16] ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ إذا كان الله تعالى نهى نبيه ﷺ عن الاستعجال بقراءة القرآن مع وجود سبب معتبر، فماذا يقول من يَهذُّهُ بلا فهم ولا تدبُّر، أو علة لها حظ من النظر.
وقفة
[16] ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضيَ كلامه، ثم يعيده عليه، أو يسأل عما أشكل عليه منه، ولا يبادره قبل فراغه.
وقفة
[16] ﴿لا تُحَرِّك بِهِ لِسانَكَ لِتَعجَلَ بِهِ﴾ العجلة لا تعين على الفهم.
عمل
[16] رتل ولا تعجل! تأمل هذه الآية التي خوطب بها نبيك ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ فالترتيب هو الطريقة الشرعية للدخول إلى عالم التدبر، وقد كرر الله الأمر به في مواضع: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ﴾ [الإسراء: 106]، فإياك والهذرمة وسرعة القراءة التي تفقدك لذة التدبر.
الإعراب :
- ﴿ لا تُحَرِّكْ: ﴾
- ناهية جازمة. تحرك: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
- ﴿ بِهِ لِسانَكَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بتحرك أو بحال من الضمير في «تحرك» أي لا تحرك لسانك قارئا به أي بالقرآن أو بقراءة الوحي ما دام جبريل عليه السلام يقرأ. لسانك: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ لِتَعْجَلَ بِهِ: ﴾
- اللام حرف جر للتعليل. تعجل: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. به: جار ومجرور متعلق بتعجل وجملة «تعجل به» صلة «ان» المضمرة لا محل لها من الاعراب. أي: لتأخذه على عجلة ولئلا ينفلت منك. و «أن» المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بلا تحرك.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [16] لما قبلها : وبعد أن ذَكَرَ اللهُ أن مُنكِرَ القِيامةِ والبَعثِ مُعرِضٌ عن آياتِ اللهِ؛ ذكَرَ هنا حالَ مَن يُقبل على تَعلُّمِ آياتِ اللهِ وحِفظِها، فظَهَرَ بذلك تَبايُنُ مَن يَرغَبُ في تَحصيلِ آياتِ اللهِ ومَن يَرغَبُ عنها، وبضِدِّها تَتميَّزُ الأشياءُ، قال تعالى:
﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [17] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾
التفسير :
{ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} فالحرص الذي في خاطرك، إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك.
والمقصود بقوله: قرآنه، قراءته عليك، وتثبيته على لسانك وفي قلبك بحيث تقرؤه متى شئت فهو مصدر مضاف لمفعوله.
قال الآلوسى: قوله: وَقُرْآنَهُ
أى: إثبات قراءته في لسانك، فالقرآن هنا، وكذا فيما بعده، مصدر كالرجحان بمعنى القراءة.. مضاف إلى المفعول وقيل: قرآنه، أى: تأليفه على لسانك...
أي في صدرك وقرآنه أي أن تقرأه.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرّك يا محمد بالقرآن لسانك لتعجل به.
واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) فقال بعضهم: قيل له ذلك، لأنه كان إذا نـزل عليه منه شيء عجل به، يريد حفظه من حبه إياه، فقيل له: لا تعجل به فإنَّا سَنحفظُه عليك.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن حُبير، عن ابن عباس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا نـزل عليه القرآن تعجَّل يريد حفظه، فقال الله تعالى ذكره: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) وقال ابن عباس: هكذا وحرّك شفتيه.
حدثني عبيد بن إسماعيل الهبَّاريّ ويونس قالا ثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جُبير، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا نـزل عليه القرآن تعجَّل به يريد حفظه؛ &; 24-66 &; وقال يونس: يحرِّك شفتيه ليحفظه، فأنـزل الله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ).
حدثني عبيد بن إسماعيل الهبَّاريّ، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي عائشة، سمع سعيد بن جُبير، عن ابن عباس مثله، وقال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ) قال: هكذا، وحرَّك سفيان فاه.
حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا جرير، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، في قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نـزل عليه جبريل بالوحي، كان يحرّك به لسانه وشفتيه، فيشتدّ عليه، فكان يعرف ذلك فيه، فأنـزل الله هذه الآية في لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ).
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نـزل عليه القرآن، حرّك شفتيه، فيعرف بذلك، فحاكاه سعيد، فقال: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قال: لتعجل بأخذه.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ). قال: كان جبريل عليه السلام ينـزل بالقرآن، فيحرِّك به لسانه، يستعجل به، فقال: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ).
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ربعي بن علية، قال: ثنا داود بن أبى هند، عن الشعبيّ في هذه الآية: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قال: كان إذا نـزل عليه الوحي عَجِل يتكلم به من حبه إياه، فنـزل: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ).
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قال: لا تكلم بالذي أوحينا إليك حتى يقضى إليك وحيه، فإذا قضينا إليك وحيه، فتكلم به.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت &; 24-67 &; الضحاك يقول في قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ) قال: كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم إذا نـزل عليه الوحي من القرآن حرّك به لسانه مخافة أن ينساه.
وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك، أنه كان يُكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، فقيل له: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) إن علينا أن نجمعه لك، ونقرئكه فلا تنسى.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قال: كان لا يفتر من القرآن مخافة أن ينساه، فقال الله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) إن علينا أن نجمعه لك، ( وقرآنه ) : أن نقرئك فلا تنسى.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ) قال: كان يستذكر القرآن مخافة النسيان، فقال له: كفيناكه يا محمد.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَيَّه، قال: ثنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرّك به لسانه ليستذكره، فقال الله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) إنا سنحفظه عليك.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يحرّك به لسانه مخافة النسيان، فأنـزل الله ما تسمع.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيكثر مخافة أن ينسى.
التدبر :
وقفة
[16، 17] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ * بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾» [البخاري 7524].
وقفة
[16، 17] أدب قرآني: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ * بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ من الآداب التي أدَّب الله بها نبيه ﷺ أنْ أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي؛ فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى ينتهي، ثم يسأل عما أشكل عليه منه.
وقفة
[17] ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قال ابن عاشور: «سور القرآن حين كانت قليلة، كان النبي ﷺ لا يخشى تفلُّت بعض الآيات عنه، فلما كثرت السور، فبلغت زهاء ثلاثين حسب ما عَدّه سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور، صار النبي ﷺ يخشى أن ينسى بعض آياتها، فلعله أخذ يحرِّك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطًا لحفظه، وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه، فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة، لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة».
وقفة
[17] قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقًا، وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، وتحقيقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾، ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه؛ كما تعهد تعالى بذلك، والله تعالى أعلم.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ عَلَيْنا: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد هنا تعليل النهي عن العجلة. على: حرف جر و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى. والجار والمجرور متعلق بخبر «انّ» المقدم.
- ﴿ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ: ﴾
- اسم «انّ» منصوب بالفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. وقرآنه: معطوف بالواو على «جمعه» ويعرب مثله. أي جمعه في صدرك واثبات قراءته في لسانك.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [17] لما قبلها : ولَمَّا كان صلى الله عليه وسلم يحرِّك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل عليه السلام من قراءة الوحي؛ حرصًا على أن يحفظه، وخوفًا أن يتفلَّت منه، ونهاه اللهُ عن هذه العجلة؛ بَيَّنَ اللهُ له هنا سببَ النهي، وهو أنه تعالى ضَمِنَ له أن يحفظه، ويجمعه في صدره، قال تعالى:
﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [18] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾
التفسير :
{ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} أي:إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى اللهإليك، فحينئذ اتبع ما قرأه وأقرأه.
أى: لا تتعجل- أيها الرسول الكريم- بقراءة القرآن الكريم عند ما تسمعه من أمين وحينا جبريل- عليه السلام-، بل تريث وتمهل حتى ينتهى من قراءته ثم اقرأ من بعده، فإننا قد تكفلنا بجمعه في صدرك وبقراءته عليك عن طريق وحينا، وما دام الأمر كذلك، فمتى قرأ عليك جبريل القرآن فاتبع قراءته ولا تسبقه بها،
"فإذا قرأناه" أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى "فاتبع قرآنه" أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك.
وأشبه القولين بما دلّ عليه ظاهر التنـزيل، القول الذي ذُكر عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، وذلك أن قوله: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) ينبئ أنه إنما نهى عن تحريك اللسان به متعجلا فيه قبل جمعه، ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبيّ صلى الله عليه وسلم من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك.
وقوله: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) يقول تعالى ذكره: إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد حتى نثبته فيه ( وُقرآنَهُ ) يقول: وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ) قال: في صدرك ( وَقُرآنَهُ ) قال: تقرؤه بعد.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) أن نجمعه لك، ( وَقُرآنَهُ ) : أن نُقرئك فلا تنسى.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) يقول: إن علينا أن نجمعه لك حتى نثبته في قلبك.
وكان آخرون يتأوّلون قوله: ( وَقُرآنَهُ ) وتأليفه. وكان معنى الكلام عندهم: إن علينا جمعه في قلبك حتى تحفظه، وتأليفه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) يقول حفظه وتأليفه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) قال: حفظه وتأليفه. وكان قتادة وجَّه معنى القرآن إلى أنه مصدر من قول القائل: قد قَرَأَتْ هذه الناقةُ في بطنها جَنينا، إذا ضمت رحمها على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم:
ذِرَاعَــيْ عَيْطَــلٍ أدْمَــاءَ بِكْـرٍ
هِجــانِ اللَّــوْنِ لـمْ تَقـرأ جَنِينـا (14)
يعني بقوله: ( لَمْ تَقرأ ) لم تضمّ رحما على ولد. وأما ابن عباس والضحاك فإنما وجها ذلك إلى أنه مصدر من قول القائل: قرأت أقرأ قرآنا وقراءة.
---------------
الهوامش :
(14) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة ( انظره في شرح الزوزني والتبريزي على المعلقات ) وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( الورقة 182 ) { فإذا قرأناه } : جمعناه، وهو من قول العرب: ما قرأت هذه المرأة نسلا قط، قال عمرو بن كلثوم: " لم تقرأ جنينا " . ا هـ . وقال الفراء في معاني القرآن (350 ) { إن علينا جمعه وقرآنه } : جمعه في قلبك، وقرآنه: قراءته. أي: أن جبريل سيعيد عليك. وقوله: { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } إذا قرأه عليك جبريل. والقراءة والقرآن: مصدران، كما تقول: راجح بين الرجحان والرجوح، والمعرفة والعرفان، والطواف والطوفان ( بتحريك الطاء والواو ) . ا هـ . وفي شرح الزوزني: العيطل: الطويلة العنق من النوق. والأدماء: البيضاء منها. والأدمة: البياض في الإبل. والبكر: الناقة التي حملت بطنا واحدا، ويروى بفتح الباء، وهو الفتى من الإبل، وكسر الباء أعلى الروايتين. والهجان الأبيض الخالص البياض. يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع، وينعت به الإبل والرجال وغيرهما. ولم تقرأ جنينا: أي لم تضم في رحمها ولدا.ا هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[18] ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ الواجب المطلوب من كل مسلم: اتباع القرآن والعمل به بعد سماعه.
الإعراب :
- ﴿ فَإِذا: ﴾
- الفاء: استئنافية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط.
- ﴿ قَرَأْناهُ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أي قرأناه على لسان الملك «جبريل».
- ﴿ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ: ﴾
- الجملة: جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب.الفاء واقعة في جواب الشرط. اتبع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قرآنه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي قراءته.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [18] لما قبلها : وبعد أن نهاه؛ أمَرَه، قال تعالى:
﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [19] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾
التفسير :
{ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} أي:بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون، فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا، أنصت له، فإذا فرغ قرأه.
وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ منالمسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله، حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه، وفيها:أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد بين لهم معانيه.
ثم إن علينا بعد ذلك بيان ما خفى عليك منه، وتوضيح ما أشكل عليك من معانيه.
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه هذا تعليم من الله- تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحى من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه، ويسابق الملك في قراءته.
روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه- يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء، أو من شدة رغبته في حفظه- فأنزل الله- تعالى- هذه الآيات.
فأنت ترى أن الله- تعالى- قد ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع له القرآن في صدره وأن يجريه على لسانه، بدون أى تحريف أو تبديل، وأن يوضح له ما خفى عليه منه.
قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما نزل عليه الوحى بعد ذلك بالقرآن، أطرق وأنصت، وشبيه بهذه الآيات قوله- سبحانه-: فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً.
ثم عادت السورة الكريمة مرة أخرى إلى الحديث عن يوم القيامة، وعن أحوال الناس فيه، وعن حالة الإنسان في وقت الاحتضار، وعن مظاهر قدرته- تعالى- وعن حكمته في البعث والحساب والجزاء، فقال- سبحانه-:
( ثم إن علينا بيانه ) أي : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ، ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن أبي عوانة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ، فكان يحرك شفتيه - قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه . وقال لي سعيد : وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه - فأنزل الله عز وجل ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ) قال : جمعه في صدرك ، ثم تقرأه ، ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) فاستمع له وأنصت . ( ثم إن علينا بيانه ) فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه .
وقد رواه البخاري ومسلم ، من غير وجه ، عن موسى بن أبي عائشة ، به ، ولفظ البخاري : فكان إذا أتاه جبريل أطرق ، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو يحيى التيمي ، حدثنا موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة ، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه ، يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره ، فأنزل الله : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به )
وهكذا قال الشعبي ، والحسن البصري ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك ، وغير واحد : إن هذه الآية نزلت في ذلك .
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي ، عن ابن عباس : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه ، فقال الله : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا ) أن نجمعه لك ( وقرآنه ) أن نقرئك فلا تنسى .
وقال ابن عباس وعطية العوفي : ( ثم إن علينا بيانه ) تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة .
وقوله: ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال بعضهم: تأويله: فإذا أنـزلناه إليك فاستمع قرآنه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور وابن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ): فإذا أنـزلناه إليك ( فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) قال: فاستمع قرآنه.
حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا جرير، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ): فإذا أنـزلناه إليك فاستمع له.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا تُلي عليك فاتبع ما فيه من الشرائع والأحكام.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) يقول: إذا تلي عليك فاتبع ما فيه.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) يقول: اتبع حلالَه، واجتنب حرامه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) يقول: فاتبع حلاله، واجتنب حرامه.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) يقول: اتبع ما فيه.
وقال آخرون: بل معناه: فإذا بيَّناه فاعمل به.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) يقول: اعمل به.
وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: فإذا تُلي عليك فاعمل به من الأمر والنهي، واتبع ما أُمرت به فيه، لأنه قيل له: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ) في صدرك ( وقُرآنَهُ ) ودللنا على أن معنى قوله: ( وقُرآنَهُ ) : وقراءته، فقد بين ذلك عن معنى قوله: ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) يقول تعالى ذكره: ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه، وأحكامه لك مفصلة.
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: نحو الذي قلنا فيه.
* ذكر من قال ذلك:
المعاني :
التدبر :
وقفة
[16-19] ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ هنا أدب لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله، حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهمًا يتمكن به من الكلام عليه.
وقفة
[16-19] ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ حرص رسول الله ﷺ على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكفَّل اللهَ له بجمعه في صدره وحفظه كاملًا فلا ينسى منه شيئًا.
وقفة
[16-19] ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ما أجدرَ أن نتَّبعَ القرآن تلاوةً وعملًا، حتى يصير لنا خُلُقًا، فيقودنا إلى كلِّ بِرٍّ وخير.
عمل
[16-19] ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ يا من ترومُ الفوزَ بشرف حفظ القرآن: لا تتعجل الحفظ، وأكثر من القراءة والإصغاء إلى القرَّاء، واستعن على الحفظ بتدبر الآيات وفهم المعاني.
الإعراب :
- ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ﴾
- معطوفة بثم على الآية الكريمة السابعة عشرة. أي بيانه بلسانك اذا أشكل عليك شيء من معانيه.'
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [19] لما قبلها : وبعد أن ضَمِنَ له أن يحفظه؛ ضَمِنَ له هنا توضيح ما أشكل عليه فهمه من معانيه وأحكامه، قال تعالى:
﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء

