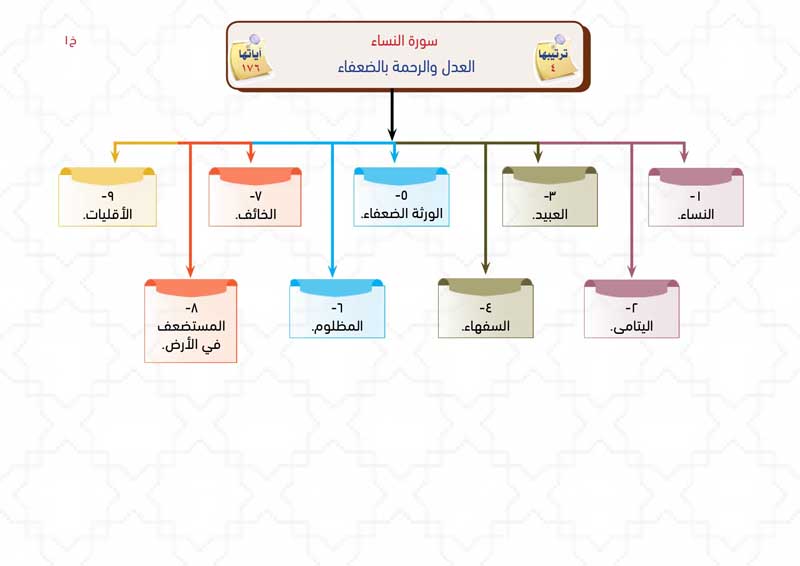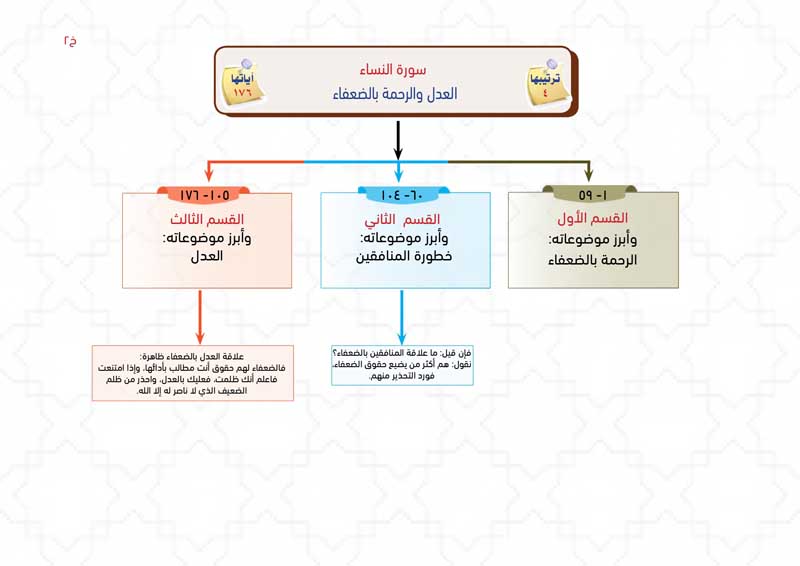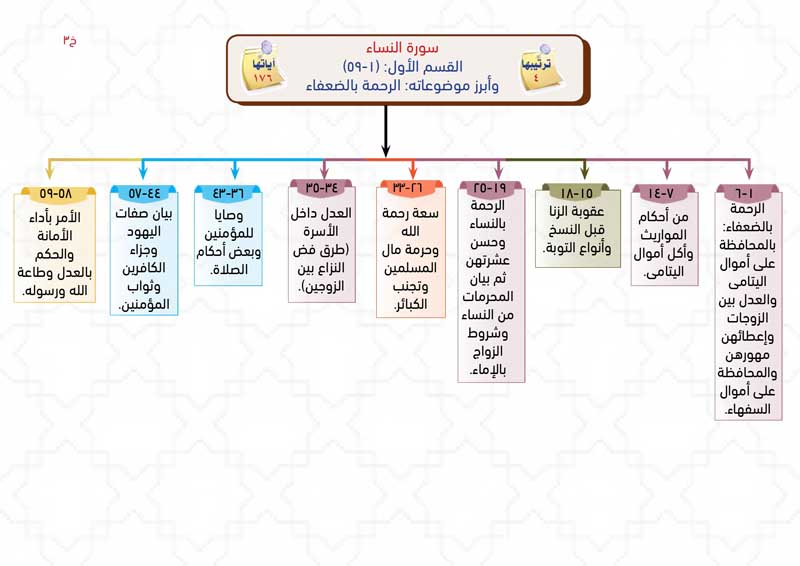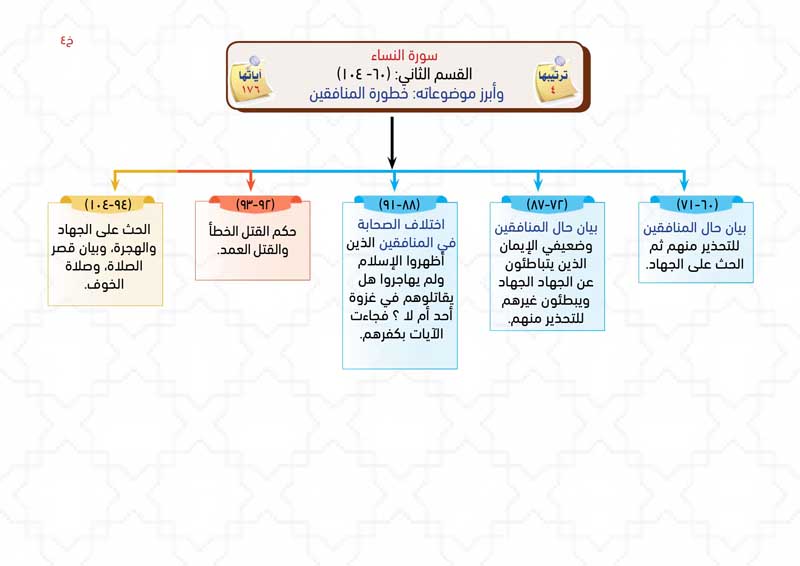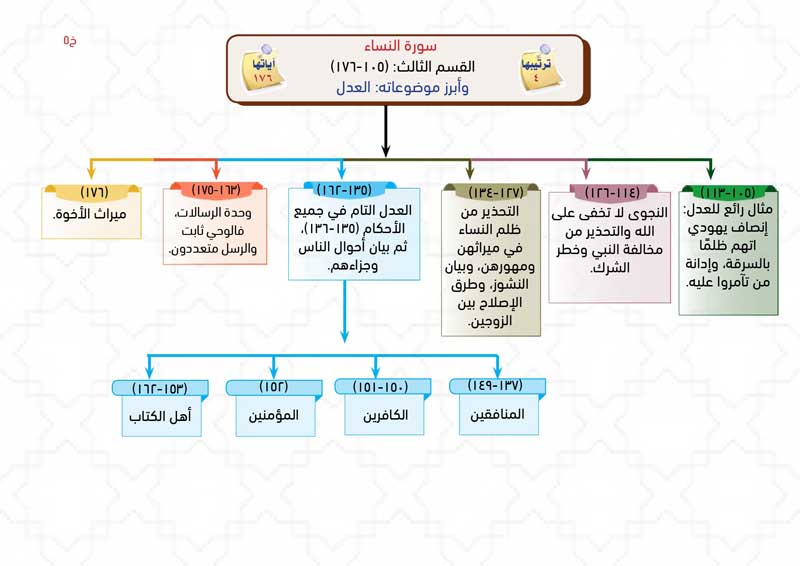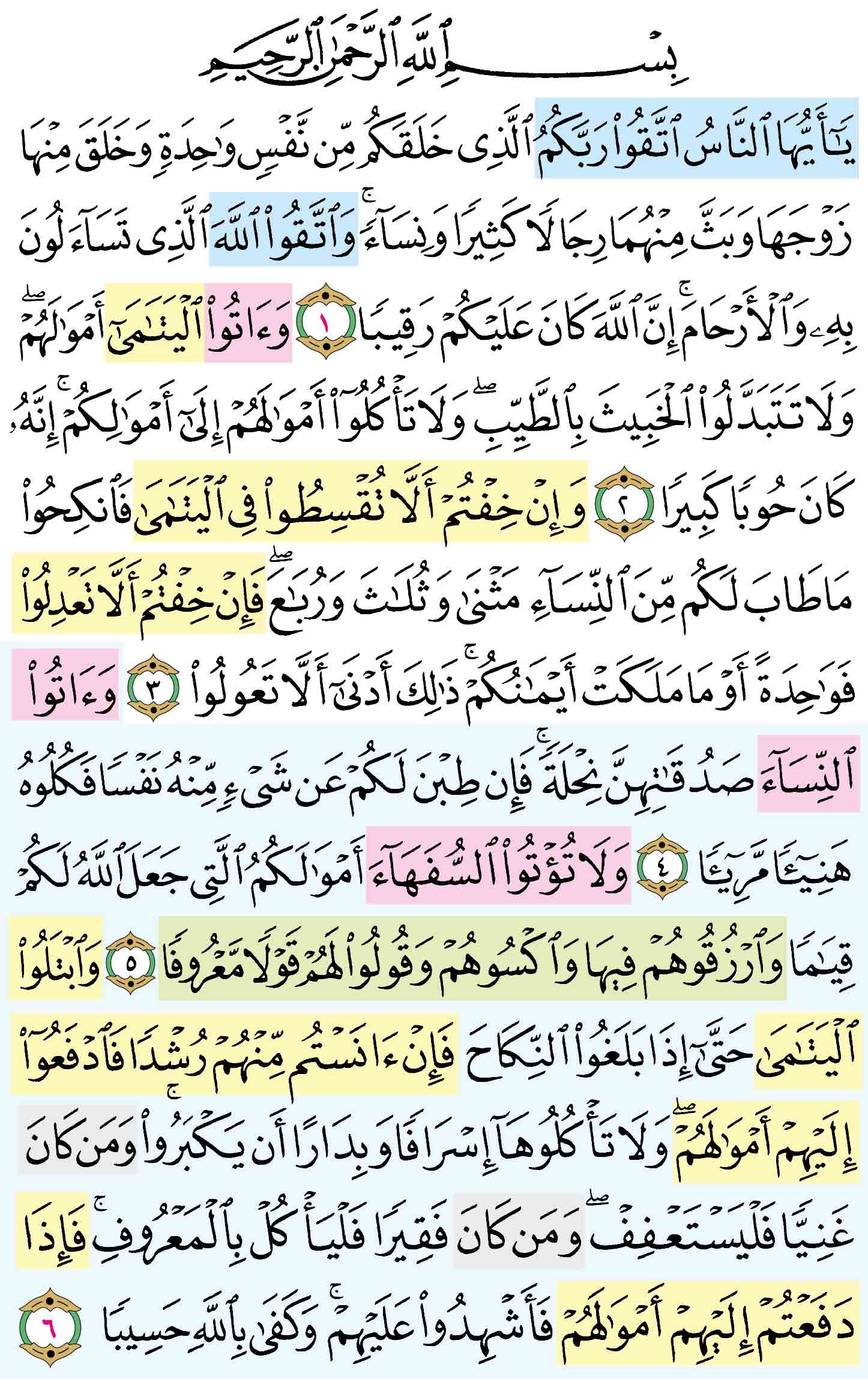
الإحصائيات
سورة النساء
| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |
| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |
| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |
| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |
| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)
التذكيرُ بأن أصلَ البشريةِ واحدٌ (آدمُ عليه السلام) عَطفًا لقلوبِ بعضِهم على بعضٍ، ثُمَّ الوصيةُ بالأرحامِ، وإيتاءُ اليتامى أموالَهم وتحريمُ أكلِها، وإباحةُ تعدُّدِ الزوجاتِ إلى أربعٍ.
فيديو المقطع
المقطع الثاني
من الآية رقم (4) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (3)
بعدَ ذكرِ تعدُّدِ الزوجاتِ أمرَ بإيتاءِ النِّساءِ مهورَهن، ثُمَّ نهى عن دفعِ أموالِ السفهاءِ إليهم أيتامًا كانوا أو غيرَهم إلا بشرطينِ: بلوغِ النكاحِ، وإيناسِ الرشدِ.
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة النساء
العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع
أولاً : التمهيد للسورة :
- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.
- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «النساء».
- • معنى الاسم :: ---
- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".
- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾
- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».
• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).
• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.
• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).
• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).
• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.
• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.
• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.
• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).
• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:
- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).
- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).
- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).
- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).
* الإسلام وحقوق النساء:
- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.
• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).
• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).
• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).
• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).
• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.
• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).
• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).
• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).
• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).
• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).
• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).
• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).
• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).
• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).
• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).
• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).
• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.
• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).
• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).
• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).
• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).
• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.
• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).
• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).
• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).
• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).
• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).
• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).
تمرين حفظ الصفحة : 77
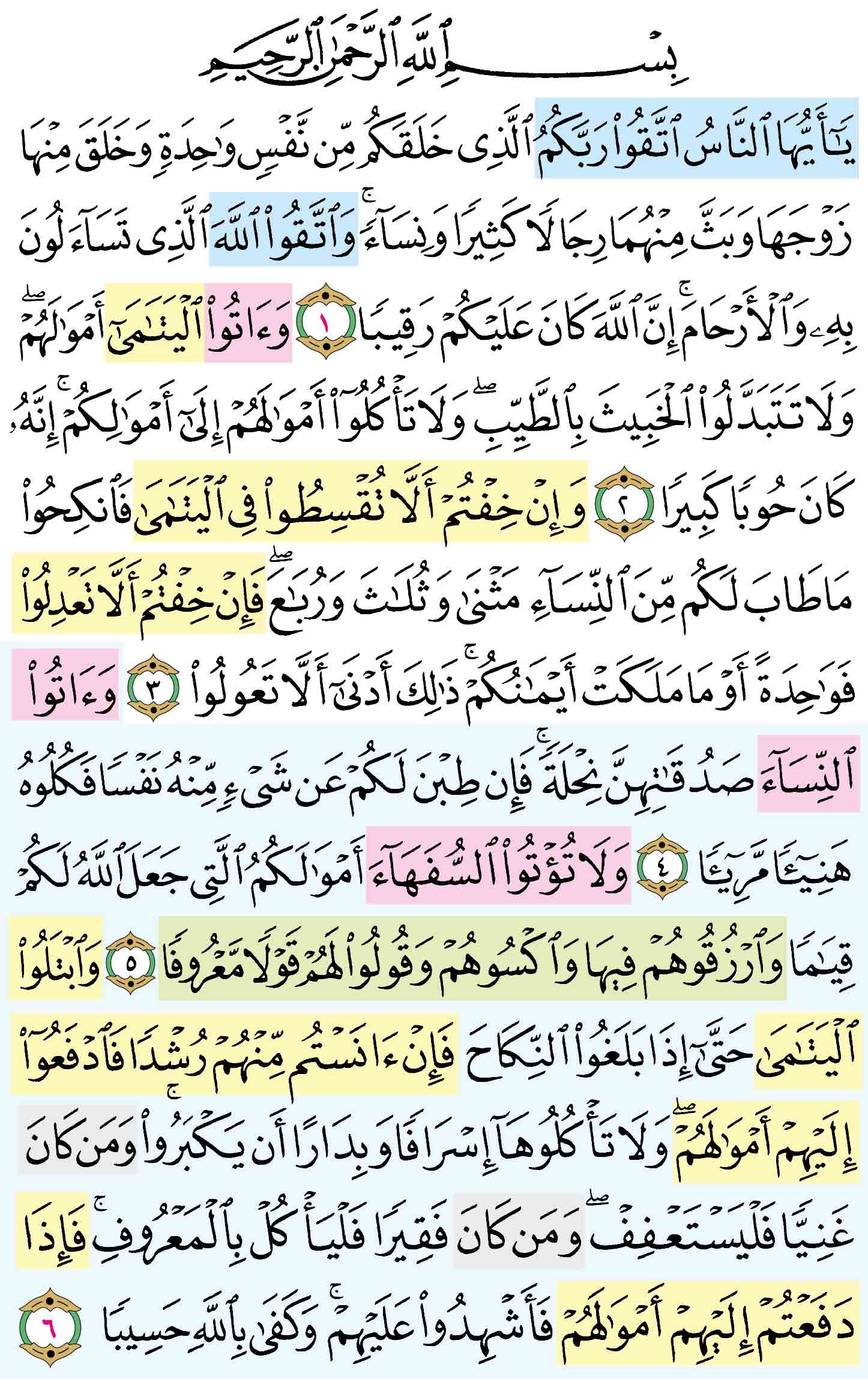
مدارسة الآية : [1] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ .. ﴾
التفسير :
افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه، والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام، والحث على ذلك. وبيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه{ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} ورزقكم، ورباكم بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم{ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل به السرور، وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم بـها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره:أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي:مطلع على العباد في حال حركاتـهم وسكونـهم، وسرهم وعلنهم، وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته، وشدة الحياء منه، بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض، مع رجوعهم إلى أصل واحد -ليعطف بعضهم على بعض، ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله، كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل، من أول السورة إلى آخرها. فكأنـها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله:{ وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا} تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال، وأقرب علاقة.
سورة النساء
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدّمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
وبعد: فإن خير ما اشتغل به العقلاء، هو خدمة كتاب الله- تعالى-، الذي أنزله- سبحانه- على قلب نبيه محمد- صلى الله عليه وسلم- لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور.
ولقد عنى المسلمون منذ فجر الإسلام عناية كبرى بشأن القرآن الكريم. وقد شملت هذه العناية جميع نواحيه، وأحاطت بكل ما يتصل به، وكان لها آثارها المباركة النافعة التي استفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط الفكرى والعملي عرفه الناس في حياتهم الروحية والمادية.
وكان من أبرز مظاهر هذه العناية بشأن القرآن الكريم، الاشتغال بتفسيره وتأويله على قدر الطاقة البشرية.
ولقد سبق لي أن كتبت تفسيرا وسيطا لسور: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران.
ويسعدني أن أتبع ذلك بتفسير لسورة النساء، حاولت فيه أن أكتب عما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من هدايات جامعة، وتشريعات حكيمة وتوجيهات رشيدة، وآداب سامية، من شأنها أن توصل المتمسكين بها إلى طريق السعادة في دنياهم وآخرتهم.
وقبل أن أبدأ في تفسير آيات هذه السورة الكريمة بالتفصيل والتحليل. رأيت من الخير أن أسوق بين يديها تعريفا بها، يتناول زمان نزولها، وعدد آياتها، وسبب تسميتها بهذا الاسم، ومناسبتها لما قبلها، والمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها.
والله نسأل أن يوفقنا لخدمة كتابه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ونافعا لعباده، إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تمهيد بين يدي السورة
1- سورة النساء هي الرابعة في ترتيب المصحف. فقد سبقتها سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران.
ويبلغ عدد آياتها خمسا وسبعين ومائة آية عند علماء الحجاز والبصريين، ويرى الكوفيون أن عدد آياتها ست وسبعون ومائة آية، لأنهم عدوا قوله- تعالى- أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ آية.
ويرى الشاميون أن عدد آياتها سبع وسبعون ومائة آية، لأنهم عدوا قوله- تعالى- وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً آية.
كما أنهم وافقوا الكوفيين في أن قوله- تعالى- أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ آية.
أما علماء الحجاز والبصريون فيرون أن ما ذكره الكوفيون والشاميون إنما هو جزء من آية وليس آية كاملة.
2- وسورة النساء من السور المدنية. وكان نزولها بعد سورة الممتحنة ويؤيد أنها مدنية ما رواه البخاري عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: «ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
ومن المتفق عليه عند العلماء أن دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة كان بعد الهجرة. وروى العوفى عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت.
قال الآلوسى: «وزعم بعض الناس أنها مكية. مستندا إلى أن قوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ... نزلت بمكة في شأن مفتاح الكعبة. وتعقبه السيوطي بأن ذلك مستند واه، لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات بمكة، من سورة طويلة، نزل معظمها بالمدينة، أن تكون مكية. خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ومن راجع أسباب نزولها عرف الرد عليه».
والحق، أن الذي يقرأ سورة النساء من أولها إلى آخرها بتدبر وإمعان، يرى في أسلوبها وموضوعاتها سمات القرآن المدني. فهي زاخرة بالحديث عن الأحكام الشرعية: من عبادات ومعاملات وحدود. وعن علاقة المسلمين ببعضهم وبغيرهم. وعن أحوال أهل الكتاب والمنافقين، وعن الجهاد في سبيل الله. إلى غير ذلك من الموضوعات التي يكثر ورودها في القرآن المدني.
ومن هنا قال القرطبي: «ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها».
3- سورة النساء سميت بهذا الاسم لأن ما نزل منها في أحكام النساء أكثر مما نزل في غيرها.
وكثيرا ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الكبرى» تمييزا لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شئون النساء وهي «سورة الطلاق» التي كثيرا ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الصغرى» .
4- ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة آل عمران التي قبلها: أن سورة آل عمران اختتمت بالأمر بالتقوى في قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وسورة النساء افتتحت بالأمر بالتقوى. قال- تعالى-:
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ.
قال الآلوسى: «وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور. وهو نوع من أنواع البديع يسمى في الشعر: تشابه الأطراف. وقوم يسمونه بالتسبيغ. وذلك كقول ليلى الأخيلية:
إذا نزل الحجاج أرضا مريضة ... تتبع أقصى دائها فشفاها
شفاها من الداء العضال الذي بها ... غلام إذا هز القناة رواها
رواها فأرواها بشرب سجالها ... دماء رجال حيث نال حشاها
ومنها أن في سورة آل عمران تفصيلا لغزوة أحد. وفي سورة النساء حديث موجز عنها في قوله- تعالى-: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا.
وكما في قوله- تعالى-: وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ.
ومنها: أن في كلتا السورتين محاجة لأهل الكتاب، وبيانا لأحوال المنافقين، وتفصيلا لأحكام القتال.
ومن أمعن نظره- كما يقول الآلوسى- وجد كثيرا مما ذكر في هذه السورة مفصلا لما ذكر فيما قبلها. فحينئذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك» .
5- ومن الآثار التي وردت في فضل سورة النساء، ما رواه قتادة عن ابن عباس أنه قال:
ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت.
أولهن: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ.
والثانية: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً.
والثالثة: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً.
والرابعة: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها.
والخامسة: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ.
والسادسة: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ.
والسابعة: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ.
والثامنة: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
.
وكأن ابن عباس- رضى الله عنهما- قد نظر إلى ما تدل عليه هذه الآيات الكريمة من فضل الله على عباده. ورحمة بهم، وفتح لباب التوبة والمغفرة في وجوههم، وإلا فإن القرآن كله بكل سوره وآياته خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت.
6- هذا، وسورة النساء تعتبر أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة. وإنك لتقرؤها بتدبر وتفهم فتراها قد اشتملت على مقاصد عالية، وآداب سامية. وتوجيهات حكيمة، وتشريعات جليلة.
تراها تنظم المجتمع الإسلامى تنظيمة دقيقا قويما، يؤدى اتباعه إلى سعادة المجتمع واستقراره داخليا وخارجيا.
فأنت تراها في مطلعها تحض الناس على تقوى الله والخشية منه، وتبين الارتباط الإنسانى الجامع الذي تلتقي عنده البشرية جميعا.
قال- تعالى- يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً.
وإذا كان الناس جميعا ينتهون إلى أصل واحد، فإن هذا الاتحاد يقتضى منهم أن يكونوا متراحمين متعاطفين، ومن أبرز مظاهر التراحم، الأخذ بيد الضعفاء ومعاونتهم في كل ما يحتاجون إليه.
لذا نجد السورة الكريمة بعد أن تفتتح بأمر الناس بتقوى الله، تتبع ذلك بالأمر بالإحسان إلى اليتامى- الذين هم أوضح الضعفاء مظهرا- في خمس آيات في الربع الأول منها.
وهذه الآيات هي قوله- تعالى-: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.
وقوله- تعالى-: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.
وقوله- تعالى-: وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.
وقوله- تعالى-: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ.
وقوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً.
ولم تكتف السورة الكريمة في أوائلها بالحض على الإحسان إلى اليتامى، بل حضت- أيضا- على الإحسان إلى النساء، وإعطائهن حقوقهن كاملة.
ثم تراها بعد ذلك في الربع الثاني منها تتحدث عن التوزيع المالى للأسرة عند ما يموت واحد منها، وتضع لهذا التوزيع أحكم الأسس وأعدلها وأضبطها وتبين أن هذا التوزيع حد من حدود الله التي يجب التزامها وعدم مخالفتها.
قال- تعالى-: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ.
ثم تحدثت السورة الكريمة عن حكم النسوة اللاتي يأتين الفاحشة، وعن التوبة التي يقبلها الله- تعالى-، والتوبة التي لا يقبلها. ووجهت نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه عن أخذ شيء من حقوق النساء، وأمرتهم بحسن معاشرتهن، كما نهتهم عن نكاح أنواع معينة منهن، لأن نكاحهن يتنافى مع شريعة الإسلام وآدابه.
قال- تعالى-: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا.
ثم تراها في الربع الثالث منها تتحدث عن المحصنات من النساء وعن حقوقهن، وبينت للناس أن الله- تعالى- ما شرع هذه الأحكام القويمة إلا لمصلحتهم ومنفعتهم.
استمع إلى السورة الكريمة وهي تحكى هذا المعنى فتقول: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً. يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً.
ثم صرحت السورة الكريمة بأن للرجال القوامة على النساء، وذكرت ضروب التأديب التي يملكها الرجل على زوجته، وكلها من غير قسوة ولا شذوذ ولا طغيان، ودعت أهل الخير إلى الإصلاح بين الزوجين إذا ما نشب بينهما نزاع أو شقاق.
قال- تعالى-: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً.
وبعد أن فصلت السورة الكريمة الحديث عما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين، وبين أفراد الأسرة، انتقلت في الربع الرابع منها إلى بيان العلاقة بين العبد وخالقه، وأنها يجب أن تقوم على إخلاص العبادة له- سبحانه- كما يجب على المسلم أن يجعل علاقته مع والديه ومع أقاربه ومع اليتامى والمساكين. وغيرهم، قائمة على الإحسان وعلى التعاطف والتراحم.
ثم توعدت السورة الكريمة من يشرك بالله، ويخالف أوامره بالعذاب الأليم. وبينت أن الكافرين سيندمون أشد الندم على كفرهم يوم القيامة ولكن ندمهم لن ينفعهم، لأنه جاء بعد فوات الأوان.
قال- تعالى- يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً.
ثم شنت السورة الكريمة حملة عنيفة على اليهود الذين كانوا يجاورون المؤمنين بالمدينة، والذين كانوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا والذين كانوا ينطقون بالباطل ويشهدون الزور عن تعمد وإصرار، وقد بينت السورة الكريمة أن حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعهم إلى افتراء الكذب على الله- تعالى- وأنهم قد طردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وعنادهم وإيذائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم.
قال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً.
ثم بينت السورة الكريمة بعد ذلك في الربع الخامس منها: الأساس الذي يقوم عليه الحكم في الإسلام، فذكرت أن العدل والأمانة هما الدعامتان الراسختان اللتان يقوم عليهما الحكم في الإسلام. ووجهت إلى المؤمنين نداء أمرتهم فيه بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر منهم، كما أمرتهم بأن يردوا كل تنازع يحصل بينهم إلى ما يقضى به كتاب الله وسنة رسوله، لأن التحاكم إلى غيرهما لا يليق بمؤمن.
ثم أخذت السورة الكريمة في توبيخ المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون ومع ذلك يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بزجرهم وبالإعراض عنهم، وأخبرته بأنهم لا إيمان لهم ما داموا لم يرتضوا حكمه.
قال- تعالى-: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
وبعد هذا التهديد والتوبيخ للمنافقين، ساقت السورة الكريمة البشارات السارة للمؤمنين الصادقين فقالت: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً. ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ عَلِيماً.
ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن الجهاد في سبيل الله، لأن الحق يجب أن يكون هو السائد في الأرض ولأن المؤمن لا يليق به أن يستسلم للأعداء، بل عليه أن يجاهدهم وأن يغلظ عليهم حتى تكون كلمة الله هي العليا.
لذا نجد السورة الكريمة توجه إلى المؤمنين نداء تأمرهم فيه بالحذر وأخذ الأهبة لقتال أعدائهم، وتحرضهم على هذا القتال للأعداء، بأقوى ألوان التحريض وأحكمها.
فأنت تراها في الربع السادس منها تأمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله، وتبشر هؤلاء المقاتلين بأنهم لن يصيبهم إلا إحدى الحسنيين، وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.
وتستبعد أن يقصر المؤمنون في أداء هذا الواجب، لأن تقصيرهم يتنافى مع إيمانهم، وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ وتبين لهم أن قتالهم إنما هو من أجل إعلاء كلمة الله، وقتال أعدائهم لهم إنما هو من أجل إعلاء كلمة الطاغوت.
الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.
وتضرب لهم الأمثال بسوء عاقبة الذين جبنوا عن القتال حين كتب عليهم وقالوا: رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْلا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ.
وتخبرهم بأن الموت سيدرك المقدام كما يدرك الجبان فعليهم أن يكونوا من الذين يقدمون على الموت بدون جبن أو وجل مادام الجبن لا يؤخر الحياة كما أن الإقدام لا ينقصها.
قال- تعالى- أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.
وهكذا تحرض السورة الكريمة المؤمنين على القتال في سبيل الله بأسمى ألوان التحريض وأشدها وأنفعها.
ثم عادت السورة الكريمة إلى تحذير المؤمنين من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والذين يعوقون أهل الحق عن قتال أعدائهم، وأمرت النبي- صلى الله عليه وسلم- بأن يمضى هو ومن معه في طريق القتال من أجل إعلاء كلمة الله دون أن يلتفت إلى هؤلاء المنافقين، لأنهم لا يريدون بهم إلا الشر.
قال- تعالى-: فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.
ثم واصلت السورة في الربع السابع منها حديثها عن المنافقين، فذكرت ما ينبغي أن يعاملوا به، وكشفت عن طبائعهم الذميمة، وأخلاقهم القبيحة، ونهت المؤمنين عن اتخاذهم أولياء أو نصراء، وأمرتهم أن يضيقوا عليهم ويقتلوهم إذا ما استمروا في نفاقهم وشقاقهم وارتكاسهم في الفتنة.
قال- تعالى-: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً، فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً.
ثم تحدثت السورة عن حكم القتل الخطأ. وتوعدت من يقتل مؤمنا متعمدا بغضب الله عليه، ولعنه له، وإنزال العذاب العظيم به.
ثم أمرت المؤمنين بأن يجعلوا قتالهم من أجل إعلاء كلمة الله، لا من أجل المغانم والأسلاب، وألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. وبشرت المجاهدين في سبيل الله بما أعده الله لهم من درجات عالية يتميزون بها عن غيرهم من القاعدين، وتوعدت الذين يرضون الذلة لأنفسهم بسوء المصير، وذلك لأن الحق لا تعلو رايته في الأرض إلا إذا كان أتباعه أقوياء. يأبون الذل والخضوع لغير سلطان الله- تعالى-.
قال- سبحانه-: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ، قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها؟ فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ، لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً.
ثم بشرت السورة الكريمة في مطلع الربع الثامن منها الذين يهاجرون في سبيل الله، بالخير الوفير والأجر الجزيل فقالت.
وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.
ثم أرشدت المؤمنين إلى الطريقة التي يؤدون بها فريضة الصلاة في حال جهادهم، لأن الصلاة فريضة محكمة لا يسقطها الجهاد، بل هي تقوى دوافعه، وتحسن ثماره ونتائجه.
كما أمرتهم بالإكثار من ذكر الله في كل أحوالهم، وبمواصلة جهاد أعدائهم بدون كلل أو ملل حتى تكون كلمة الله هي العليا.
قال- تعالى-: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً. وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ.
ثم بينت السورة الكريمة أن الله- تعالى- قد أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يحكم بين الناس بالعدل الذي أراه الله إياه، ونهت الأمة في شخصه صلى الله عليه وسلم عن الخيانة والميل مع الهوى ووبخت المنافقين الذين «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كما وبخت الذين يدافعون عنهم أو يسيرون في ركابهم. وذكرت جانبا من مظاهر عدله- سبحانه-، ورحمته الشاملة.
أما عدله فمن مظاهره أنه جعل الجزاء من جنس العمل وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ.
وأما شمول رحمته فمن مظاهرها أنه- سبحانه- فتح باب التوبة لعباده وأكرمهم بقبولها متى صدقوا فيها: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً.
ثم بينت السورة الكريمة في مطلع الربع التاسع منها أن الاستخفاء بالأقوال والأفعال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره لا خير فيه فقالت:
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.
ثم تحدثت عن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوعدتهم بسوء المصير، ووبختهم على جهالاتهم وضلالاتهم وسيرهم في ركاب الشيطان الذي يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً. أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً.
ثم بينت أن الله- تعالى- لا تنفع عنده الأمانى والأنساب، وإنما الذي ينفع عنده هو الإيمان والعمل الصالح.
قال- تعالى-: لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً.
ثم تحدثت السورة الكريمة عن بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء وأمرت بالإصلاح بين الزوجين، وبينت أن العدل التام بين النساء من كل الوجوه غير مستطاع، فعلى الرجال أن يكونوا متوسطين في حبهم وبغضهم، وعليهم كذلك أن يعاشروا النساء بالمعروف وأن يفارقوهن كذلك بالمعروف وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً.
ثم وجهت السورة الكريمة في الربع العاشر منها نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يلتزموا الحق في كل شئونهم، وأن يجهروا به ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، لأن العدالة المطلقة التي أتى بها الإسلام لا تعرف التفرقة بين الناس.
ثم بينت السورة الكريمة حقيقة النفاق والمنافقين وكررت تحذيرها للمؤمنين من شرورهم.
وإن أدق وصف لهؤلاء المنافقين هو قوله- تعالى- في شأنهم: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ، وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.
وقد توعدهم الله بسبب نفاقهم وخداعهم بأشد ألوان العذاب فقال- سبحانه-:
إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً.
ثم حكت السورة الكريمة في الربع الحادي عشر منها ما أدب الله به عباده، وما أرشدهم إليه من خلق كريم وهو منع الجهر بالسوء من القول، ولكنه- سبحانه- رخص للمظلوم أن يتكلم في شأن ظالمه بالكلام الحق. لأنه- تعالى- لا تخفى عليه خافية. قال- تعالى لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً. إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً.
ثم تحدثت عن بعض رذائل اليهود. وعن العقوبات التي عاقبهم الله بها بسبب ظلمهم وفسوقهم.
قال- تعالى-: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ، وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً.
أما في الربع الثاني عشر والأخير منها فقد تحدثت السورة الكريمة عن وحدة الرسالة الإلهية.
وبينت أن الله- تعالى- قد أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبله، وأن حكمته- سبحانه- قد اقتضت أن يرسل رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
ثم وجهت في أواخرها نداء عاما إلى الناس تأمرهم فيه بالإيمان بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. كما وجهت نداء آخر إلى أهل الكتاب تنهاهم فيه عن السير في طريق الضلالة، وعن الأقوال الباطلة التي قالوها في شأن عيسى، فإن عيسى كغيره من البشر من عباد الله- تعالى-، ولن يستنكف أن يكون عبدا لله- تعالى-:
ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ، وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً.
وكما تحدثت السورة الكريمة في أوائلها عن بعض أحكام الأسرة، فقد اختتمت بالحديث عن ذلك، لكي تبين للناس أن الأسرة هي عماد المجتمع، وهي أساسه الذي لا صلاح له إلا بصلاحها.
قال- تعالى-: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
هذا عرض إجمالى لبعض المقاصد السامية، والآداب العالية، والتشريعات الحكيمة، والتوجيهات القويمة التي اشتملت عليها السورة الكريمة.
ومن هذا العرض نرى أن سورة النساء- كما يقول بعض العلماء-: «قد عالجت أحوال المسلمين فيما يتعلق بتنظيم شئونهم الداخلية، عن طريق إصلاح الأسرة وإصلاح المال في ظل تشريع قوى عادل، مبنى على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانية، مجرد من تحكيم الأهواء والشهوات.
وذلك إنما يكون إذا كان صادرا عن حكيم خبير بنزعات النفوس واتجاهاتها وميولها.
كما عالجت أحوالهم فيما يختص بحفظ كيانهم الخارجي، عن طريق التشريعات والتوجيهات التي اشتملت عليها السورة الكريمة، والتي من شأنها أن تحفظ للأمة كيانها وشخصيتها متى تمسكت بها، وأن تجعلها قادرة على دفع الشر الذي يطرأ عليها من أعدائها.
بل إن السورة الكريمة لم تقف عند حد التنبيه على عناصر المقاومة المادية، وإنما نبهت على ما يجب أن تحفظ به عقيدة الأمة ومبادئها من التأثر بما يلقى في شأنها من الشكوك والشبه. وفي هذا إيحاء يجب على المسلمين أن يلتفتوا إليه، وهو أن يحتفظوا بمبادئهم كما يحتفظون بأوطانهم.
وأن يحصنوا أنفسهم من شر حرب أشد خطرا، وأبعد في النفوس أثرا من حرب السلاح المادي: تلك هي حرب التحويل من مبدأ إلى مبدأ، ومن دين إلى دين، مع البقاء في الأوطان والإقامة في الديار والأموال.
ألا وإن شخصية الأمة ليتطلب بقاؤها الاحتفاظ بالجانبين: جانب الوطن والسلطان.
وجانب العقيدة والإيمان. وعلى هذا درج سلفنا الصالح فعاشوا في أوطانهم آمنين. وبمبادئهم وعقائدهم متمسكين».
وبعد: فهذا تمهيد بين يدي تفسير سورة النساء. تعرضنا خلاله لعدد آياتها. ولزمان نزولها.
ولسبب تسميتها بهذا الاسم. ولوجه المناسبة بينها وبين سابقتها. ولجانب من فضائلها.
وللمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها.
ولعلنا بذلك- أخى القارئ- نكون قد قدمنا لك تعريفا لهذه السورة يعينك على تفهم أسرارها، ومقاصدها. وتوجيهاتها قبل أن نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل.
والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
افتتحت السورة الكريمة بهذا النداء الشامل لجميع المكلفين من وقت نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وذلك لأن لفظ الناس لا يختص بقبيل دون قبيل ، ولا بقوم دون قوم ، وقد دخلته الألف واللام المفيدة للاستغراق؛ ولأن ما في مضمون هذا النداء من إنذار وتبشير وأمر بمراقبة الله وخشيته ، يتناول جميع المكلفين لا أهل مكة وحدهم كما ذكره بعضهم؛ لأن تخصيص قوله - تعالى - ( ياأيها الناس ) بأهل مكة تخصيص بغير مخصص .
والمراد بالنفس الواحدة هنا : آدم - عليه السلام - . وقد جاء الوصف وهو واحدة بالتأنيث باعتبار لفظ النفس فإنها مؤنثة .
ومن فى قوله ( مِنْهَا ) للتبعيض . والضمير المؤنث " ها " يعود إلى النفس الواحدة .
والمراد بقوله - تعالى - : ( زَوْجَهَا ) حواء؛ فإنها أخرجت من آدم كما يقتضيه ظاهر قوله - تعالى - ( مِنْهَا ) .
قال الفخر الرازى ما ملخصه : " المراد من هذا الزوج هو حواء . وفى كون حواء مخلوقة من آدم قولان :
الأول : وهو الذي عليه الأكثرون : أنه لما خلق الله - تعالى - آدم ألقى عليه النوم ، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه ، فلما استيقظ رآها ومال إليها وألفها ، لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه . واحتجوا عليه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها "
والقول الثانى : وهو اختيار أبى مسلم الأصفهانى : أن المراد من قوله ( وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) أى من جنسها . وهو كقوله - تعالى - ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) وكقوله ( إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ) وقوله ( لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ) قال القاضى : والقول الأول أقوى ، لكى يصح قوله : ( خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) ، إذ لو كانت حواء مخلوقة إبتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة .
وقد تضمن هذا النداء لجميع المكلفين تنبيهم إلى أمرين :
أولهما : وحدة الاعتقاد بأن ربهم جميعا واحد لا شريك له . فهو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم ، وهو الذى يميتهم وهو الذى يحييهم ، وهو الذى أوجد أبيضهم وأسودهم ، وعربيهم وأعجميهم .
وثانيهما : وحدة النوع والتكوين ، إذ الناس جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم قد انحدروا عن أصل واحد وهو آدم - عليه السلام - .
فيجب أن يشعر الجميع بفضل الله عليهم . وأن يخلصوا له العبادة والطاعة ، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإِثم والعدوان ، وأن يوقنوا بأنه لا فضل لجنس على جنس ، ولا للون على لون إلا بمقدار حسن صلتهم بربهم وما لكهم ومدبر أمورهم .
والمعنى : يا أيها الناس اتقوا ربكم بأن تطيعوه فلا تعصوه ، وبأن تشكروه فلا تكفروه ، فهو وحده الذى أوجدكم من نفس واحدة هى نفس أبيكم آدم ، وذلك من أظهر الأدلة على كمال قدرته - سبحانه ، ومن أقوى الدواعى إلى اتقاء موجبات نقمته ، ومن أشد المقتضيات التى تحملكم على التاطف والتراحم والتعاون فيما بينكم ، إذ أنتم جميعا قد أوجدكم - سبحانه - من نفس واحدة .
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : " فإن قلت : الذى يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته ، أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويحث عليها فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكره موجبا للتقوى وداعيا إليها؟
قلت : لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة . ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شىء ، ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهم ، فحقهم أن يتقوه فى كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها . أو أراد بالتقوى تقوى خاصة ، وهى أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم ، فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله فقيل : اتقوا ربكم الذى وصل بينكم؛ حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم لبعض ، فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه وهذا المعنى مطابق لمعانى السورة " .
وقوله : ( وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) معطوف على قوله ( خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) . أو معطوفة على محذوف والتقدير : خلقكم من نفس واحدة ابتدأها وخلق منها زوجها .
ثم بين - سبحانه - ما ترتب على هذا الازدواج من تناسل فقال : ( وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً ) .
والبث معناه : النشر والتفريق . يقال : بث الخيل فى الغارة ، أى فرقها ونشرها . ويقال : يثثت البسط إذا نشرتها . قال - تعالى - ( وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) أى منشورة .
والمعنى : ونشر وفرق من تلك النفس الواحدة وزوجها على وجه التوالد والتناسل ، رجالا كثيرا ونساء كثيرة .
والتعبير بالبث يفيد أن هؤلاء الذين توالدوا وتناسلوا عن تلك النفس وزوجها ، قد تكاثروا وانتشروا فى أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ، وأن من الواجب عليهم مهما تباعدت ديارهم ، واختلفت ألسنتهم وأشكالهم أن يدركوا أنهم جميعا ينتمون إلى أصل واحد ، وهذا يقتضى تراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم . وقوله ( كَثِيراً ) صفة لقوله ( رِجَالاً ) وهو صفة مؤكدة لما إفاده التنكير من معنى الكثرة . وجاء الوصف بصيغة الإِفراد ، لأن ( كَثِيراً ) وإن كان مفردا لفظا إلا أنه دال على معنى الجمع . واستغنى عن وصف النساء بالكثرة ، اكتفاء بوصف الرجال بذلك ، ولأن الفعل ( وَبَثَّ ) يقضى الكثرة والانتشار .
وقال الفخر الرازى : خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء ، لأن شهرة الرجال أتم ، فكانت كثرتهم أظهر ، فلا جرم خصوا بوصف الكثرة . وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج البروز . واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول " .
وقوله : ( واتقوا الله الذي تَسَآءَلُونَ بِهِ والأرحام ) تكرير للأمر بالتقوى لتربية المهابة فى النفس وتذكير ببعض آخر من الأمور الموجبة لخشية الله وامتثال أوامره .
وقوله ( تَسَآءَلُونَ ) أصلها تتساءلون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا . وهى قراءة عصام وحمزة الكسائى .
وقرأ الباقون " تساءلون " بالتشديد بإدغام تاء التفاعل فى السينه لتقاربهما فى الهمس . والأرحام : جمع رحم وهى القرابة . مشتقة من الرحمة ، لأن ذوى القرابة من شأنهم أن يتراحموا ويعطف بعضهم على بعض .
وكلمة ( والأرحام ) قرأها الجمهور بالنصب عطفا على اسم الله تعالى .
والمعنى؛ واتقوا الله الذى يسأل بعضكم بعضا به ، بأن يقول له على سبيل الاستعطاف : أسألك بالله أن تفعل كذا ، أو أن تترك كذا . واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإِحسان ، فإن قطيعتها وعدم صلتها مما يجب أن يتقى ويبعد عنه ، وإنما الذى يجب أن يفعل هو صلتها وبرها .
وقرأها حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور فى ( به ) . أى : اتقوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام بأن يقول بعضكم لبعض مستعطفا أسألك بالله وبالرحم أن تفعل كذا .
وقد كان من عادة العرب أن يقرنوا الأرحام بالله تعالى - فى المناشدة والسؤال فيقولون : اسألك بالله وبالرحم .
ولم يرتض كثير من النحويين هذه القراءة من حمزة ، وقالوا : إنها تخالف القواعد النحوية التى تقول : إن عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور المتصل بدون إعادة الجار لا يصح ، لأن الضمير المجرور المتصل بمنزلة الحرف ، والحرف لا يصح عطف الاسم الظاهر عليه ، ولأن الضمير المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها ، وكما أنه لا يجوز أن يعطف على بعض الكلمة فكذلك لا يجوز أن يعطف عليه . إلى غير ذلك مما قالوه فى تضعيف هذه القراءة . وقد دافع كثير من المفسرين عن هذه القراءة التى قرأها حمزة . وأنكروا على النحويين تشنيعهم عليه .
ومما قاله القرطبى فى دفاعه عن صحة هذه القراءة : ومثل هذا الكلام - أى من النحويين - مردود عند أئمة الدين ، لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبى صلى الله عليه وسلم واسقبح ما قرأ به .
وهذا مقام محذور ، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ، فإن العربية تتلقى من النبى صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد فى فصاحته .
ثم قال : والكوفى يجيز عطف الظاهر على الضمير المجرور ولا يمنع منه ، ومنه قولهم :
فاذهب فما بك والأيام من عجب
ومما قاله الفخر الرازى فى ذلك : واعلم أن هذه الوجوه - أى التى احتج بها النحويون في تضعيف قراءة حمزة - ليست وجوها قوية فى رفع الروايات الواردة فى اللغات؛ وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة ، ولم يأت بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ، والقياس يتضاءل عند سماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التى هى أوهن من بيت العنكبوت .
وأيضا فلهذه القراءة وجهان :
أحدهما : أنها على تقدير تكرير الجار . كأنه قيل : تساءلون به وبالأرحام .
وثانيهما : أنه ورد ذلك فى الشعر ومنه :
نعلق فى مثل السوارى سيوفنا ... وما بينها والكعب غوط نفائف
ثم قال : والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بمثل هذه الأبيات المجهولة ، ولا يستحسنوا إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد ، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف فى علم القرآن " .
هذا ، وهناك قراءة بالرفع . قال الآلوسى : وقرأ ابن زيد ( والأرحام ) بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر . أى والأرحام كذلك أى مما يتقى لقرينه ( واتقوا ) . أو مما يتساءل به لقرينة ( تَسَآءَلُونَ ) .
ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يحمل العقلاء على المبالغة فى تقوى الله ، وفى صلة الرحم فقال - تعالى : ( إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) . أى حافظا يحصى عليكم كل شىء . من رقبه إذا حفظه .
أو مطلعا على جميع أحوالكم وأعمالكم ، ومنه المرقب للمكان العالى الذى يشرف منه الرقيب ليطلع على ما دونه .
وقد أكد - سبحانه - رقابته على خلقه ، واطلاعه على جميع أحوالهم بأوثق المؤكدات . فقد أكد - سبحانه - الجملة الكريمة بإن ، وبتكرار لفظ الجلالة التى يبعث فى النفوس كل معانى الخشية والعبودية له ، وبالتعبير بكان الدالة على الدوام والاستمرار ، وبذكر الفوقية التى يدل عليها لفظ ( عَلَيْكُمْ ) إذ هو يفيد معنى الاطلاع الدائم مع السيطرة والقهر ، وبالإِتيان بصيغة المبالغة وهى قوله : ( رَقِي
قال العوفي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة . وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وروى من طريق عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حبس " .
وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، حدثنا محمد بن بشر العبدي ، حدثنا مسعر بن كدام ، عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) الآية ، و ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية ، و ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) و ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ) الآية ، و ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) ثم قال : هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه ، فقد اختلف في ذلك .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء : لهن أحب إلي من الدنيا جميعا : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) وقوله : ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وقوله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله : ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) وقوله : ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ) رواه ابن جرير : ثم روى من طريق صالح المري ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، أولاهن : ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ) والثانية : ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) والثالثة : ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) .
ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ، يعني في الخمسة . الباقية .
وروى الحاكم من طريق أبي نعيم ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن ابن أبي مليكة ; سمعت ابن عباس يقول : سلوني عن سورة النساء ، فإني قرأت القرآن وأنا صغير . ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .
بسم الله الرحمن الرحيم
( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( 1 ) )
يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه ، وهي عبادته وحده لا شريك له ، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة ، وهي آدم ، عليه السلام ( وخلق منها زوجها ) وهي حواء ، عليها السلام ، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم ، فاستيقظ فرآها فأعجبته ، فأنس إليها وأنست إليه .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن مقاتل ، حدثنا وكيع ، عن أبي هلال ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : خلقت المرأة من الرجل ، فجعل نهمتها في الرجل ، وخلق الرجل من الأرض ، فجعل نهمته في الأرض ، فاحبسوا نساءكم .
وفي الحديث الصحيح : " إن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج " .
وقوله : ( وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) أي : وذرأ منهما ، أي : من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم ، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر .
ثم قال تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) أي : واتقوا الله بطاعتكم إياه ، قال إبراهيم ومجاهد والحسن : ( الذي تساءلون به ) أي : كما يقال : أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك : واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ولكن بروها وصلوها ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، والضحاك ، والربيع وغير واحد .
وقرأ بعضهم : ( والأرحام ) بالخفض على العطف على الضمير في به ، أي : تساءلون بالله وبالأرحام ، كما قال مجاهد وغيره .
وقوله : ( إن الله كان عليكم رقيبا ) أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : ( والله على كل شيء شهيد ) [ البروج : 9 ] .
وفي الحديث الصحيح : " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب ; ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [ واحد ] وأم واحدة; ليعطف بعضهم على بعض ، ويحننهم على ضعفائهم ، وقد ثبت في صحيح مسلم ، من حديث جرير بن عبد الله البجلي; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النمار - أي من عريهم وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته : ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) حتى ختم الآية وقال : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد [ واتقوا الله ] ) [ الحشر : 18 ] ثم حضهم على الصدقة فقال : " تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من صاع بره ، صاع تمره . . . " وذكر تمام الحديث .
وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم [ الذي خلقكم من نفس واحدة ] ) الآية .
القول في تأويل قوله عز وجل : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "، احذروا، أيها الناس، ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم، فيحلّ بكم من عقوبته ما لا قِبَل لكم به.
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحِّد بخلق جميع الأنام من شخص واحد، مُعَرِّفًا عباده كيف كان مُبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، (1) ومنبِّهَهم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة= وأن بعضهم من بعض، وأن حق بعضهم على بعض واجبٌ وجوبَ حق الأخ على أخيه، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة= وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض، وإن بَعُدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب &; 7-514 &; الأدنى= (2) وعاطفًا بذلك بعضهم على بعض، ليتناصفوا ولا يتظالموا، وليبذُل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له، فقال: " الذي خلقكم من نفس واحدة "، يعني: من آدم، كما:-
8400 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أمّا " خلقكم من نفس واحدة "، فمن آدم عليه السلام. (3)
8401 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "، يعني آدم صلى الله عليه. (4)
8402 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد: " خلقكم من نفس واحدة "، قال: آدم.
* * *
ونظير قوله: " من نفس واحدة "، والمعنيُّ به رجل، قول الشاعر.
أَبُــوكَ خَلِيفَــةٌ وَلدَتْــهُ أُخْــرَى
وَأَنْـــتَ خَلِيفَـــةٌ, ذَاكَ الكَمَــالُ (5)
فقال،" ولدته أخرى "، وهو يريد " الرجل "، فأنّث للفظ " الخليفة ". وقال تعالى ذكره: " من نفس واحدة " لتأنيث " النفس "، والمعنى: من رجل واحد. ولو قيل: " من نفس واحد "، وأخرج اللفظ على التذكير للمعنى، كان صوابًا. (6)
* * *
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " وخلق منها زوجها "، وخلق من النفس الواحدة زوجها= يعني بـ" الزوج "، الثاني لها. (7) وهو فيما قال أهل التأويل، امرأتها حواء.
* ذكر من قال ذلك:
8403 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " وخلق منها زوجها "، قال: حواء، من قُصَيري آدم وهو نائم، (8) فاستيقظ فقال: " أثا "= بالنبطية، امرأة.
8404 - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8405 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " وخلق منها زوجها "، يعني حواء، خلقت من آدم، من ضِلَع من أضلاعه.
8406 - حدثني موسى بن هارون قال، أخبرنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: أسكن آدمَ الجنة، فكان يمشي فيها وَحْشًا ليس له زوج يسكن إليها. (9) فنام نومةً، فاستيقظ، فإذا عند رأسه امرأة قاعدة، خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ. (10)
8407 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قال: ألقي على آدم صلى الله عليه وسلم السَّنة -فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم، عن عبدالله بن العباس وغيره- ثم أخذ ضِلَعًا من أضلاعه، من شِقٍّه الأيسر، ولأم مكانه، (11) وآدم نائمٌ لم يهبَّ من نومته، حتى خلق الله تبارك وتعالى من ضِلَعه تلك زوجته حواء، فسوَّاها امرأة ليسكن إليها، فلما كُشِفت عنه السِّنة وهبَّ من نومته، رآها إلى جنبه، فقال -فيما يزعمون، والله أعلم-: لحمي ودمي وزوجتي! فسكن إليها. (12)
8408 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وخلق منها زوجها ". جعل من آدم حواء.
* * *
وأما قوله: " وبثَّ منهما رجالا كثيرًا ونساء "، فإنه يعني: ونشر منهما، يعني من آدم وحواء=" رجالا كثيرًا ونساء "، قد رآهم، كما قال جل ثناؤه: كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ [سورة القارعة: 4]. (13)
* * *
يقال منه: " بثَّ الله الخلق، وأبثهم ". (14)
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
8409 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل، قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء "، وبثَّ، خلق.
* * *
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ
قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه عامة قرأة أهل المدينة والبصرة: " تَسَّاءَلونَ" بالتشديد، بمعنى: تتساءلون، ثم أدغم إحدى " التاءين " في" السين "، فجعلهما " سينًا " مشددة.
* * *
وقرأه بعض قرأة الكوفة: " تَسَاءَلُونَ"، بالتخفيف، على مثال " تفاعلون "،
* * *
وهما قراءتان معروفتان، ولغتان فصيحتان= أعني التخفيف والتشديد في قوله: " تساءلون به "= وبأيِّ ذلك قرأ القارئ أصابَ الصواب فيه. لأن معنى ذلك، بأيّ وجهيه قرئ، غير مختلف.
* * *
وأما تأويله: واتقوا الله، أيها الناس، الذي إذا سأل بعضكم بعضًا سأل به، فقال السائل للمسئول: " أسألك بالله، وأنشدك بالله، وأعزِم عليك بالله "، وما أشبه ذلك. يقول تعالى ذكره: فكما تعظّمون، أيها الناس، رّبكم بألسنتكم حتى تروا أنّ من أعطاكم عهده فأخفركموه، (15) فقد أتى عظيمًا. فكذلك فعظّموه بطاعتكم إياه فيما أمركم، واجتنابكم ما نهاكم عنه، واحذروا عقابه من مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه، كما:-
8410 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به "، قال يقول: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به.
8411 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " واتقوا الله الذي تساءلون به "، يقول: اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون.
8412 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس مثله.
8413 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، أخبرنا حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: " تساءلون به "، قال: تعاطفون به.
* * *
وأما قوله: " والأرحام "، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: واتقوا الله الذي إذا سألتم بينكم قال السائل للمسئول: " أسألك به وبالرّحِم "
ذكر من قال ذلك:
8414 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم: " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، يقول: اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. يقول: الرجل يسأل بالله وبالرَّحم.
8415 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: هو كقول الرجل: " أسألك بالله، أسألك بالرحم "، يعني قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ".
8416 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: " أسألك بالله وبالرحم ".
8417 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: هو كقول الرجل: " أسألك بالرحم ".
8418 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: " أسألك بالله وبالرحم ".
8419 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن منصور -أو مغيرة- عن إبراهيم في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال: هو قول الرجل: " أسألك بالله والرحم ".
8420 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن قال: هو قول الرجل: " أنشدك بالله والرحم ".
* * *
قال محمد: (16) وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: " وَالأرْحَامِ" بالخفض عطفًا بـ" الأرحام "، على " الهاء " التي في قوله: " به "، كأنه أراد: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام= فعطف بظاهر على مكنيّ مخفوض. وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب، لأنها لا تَنسُق بظاهر على مكني في الخفض، (17) إلا في ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر. (18) وأما الكلام، فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق، والرديء في الإعراب منه. ومما جاء في الشعر من ردّ ظاهر على مكنيّ في حال الخفض، قول الشاعر: (19)
نُعَلِّـقُ فِـي مِثْـلِ السَّـوَارِي سُـيُوفَنَا
وَمَـا بَيْنَهَـا والكَـعْبِ غُـوطٌ نَفَـانِفُ (20)
فعطف بـ" الكعب " وهو ظاهر، على " الهاء والألف " في قوله: " بينها " وهي مكنية.
* * *
وقال آخرون: تأويل ذلك:واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها.
* ذكر من قال ذلك:
8421 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، يقول: اتقوا الله، واتقوا الأرحام لا تقطعوها.
8422 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد عن قتادة: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبًا "، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتقوا الله، وصلُوا الأرحام، فإنه أبقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة.
8423 - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله في الأرحام فصِلُوها.
8424 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال: اتقوا الذي تساءلون به، واتقوه في الأرحام.
8425 - حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة في قول الله: " الذي تساءلون به والأرحام "، قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.
8426 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال: هو قول الرجل: " أنشدك بالله والرَّحم ".
8427 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله، وصلوا الأرحام.
8428 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " الذي تساءلون به والأرحام "، قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.
8429 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثني أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: اتقوا الله في الأرحام فصلوها.
8430 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: واتقوا الله في الأرحام فصلوها.
8431 - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي حماد، وأخبرنا أبو جعفر الخزاز، عن جويبر، عن الضحاك: أن ابن عباس كان يقرأ: " والأرحام "، يقول: اتقوا الله لا تقطعوها.
8432 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: اتقوا الأرحام.
8433 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال،" واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، أن تقطعوها.
8434 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به "، واتقوا الأرحام أن تقطعوها= وقرأ: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ [سورة الرعد: 21].
* * *
قال أبو جعفر: وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبًا بمعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها= عطفًا بـ" الأرحام "، في إعرابها بالنصب &; 7-523 &; على اسم الله تعالى ذكره.
قال: والقراءة التي لا نستجيز لقارئٍ أن يقرأ غيرها في ذلك، (21) النصب: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ )، بمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهرٍ من الأسماء على مكنيّ في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر، على ما قد وصفت قبل. (22)
* * *
القول في تأويل قوله : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: إنّ الله لم يزل عليكم رقيبًا.
* * *
ويعني بقوله: " عليكم "، على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، والمخاطب والغائب إذا اجتمعا في الخبر، فإن العرب تخرج الكلام على الخطاب، فتقول: إذا خاطبتْ رجلا واحدًا أو جماعة فعلتْ هي وآخرون غُيَّبٌ معهم فعلا " فعلتم كذا، وصنعتم كذا ".
ويعني بقوله: " رقيبًا "، حفيظًا، مُحصيًا عليكم أعمالكم، متفقدًا رعايتكم حرمةَ أرحامكم وصلتكم إياها، وقطعكموها وتضييعكم حرمتها، كما:-
8435 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " إن الله كان عليكم رقيبًا "، حفيظًا.
8435م - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد في قوله: " إن الله كان عليكم رقيبًا "، على أعمالكم، يعلمها ويعرفها.
ومنه قول أبي دُؤاد الإيادِيّ:
كَمَقَاعِدِ الرُّقَبَاءِ لِلضُّرَبَاءِ أَيْدِيهمْ نَوَاهِدْ (23) ---------------------
الهوامش :
(1) في المطبوعة والمخطوطة وعرف عباده..." ، واستظهرت من نهج أبي جعفر في بيانه ، ومن قوله بعد: "ومنبههم" ثم قوله: "وعاطفًا" ، على أن الصواب"ومعرفًا" ، وهو مقتضى سياق الكلام بعد ذلك كله.
(2) قوله: "وعاطفًا" ، عطف على قوله: "معرفًا عباده... ومنبههم...".
(3) في المطبوعة: "صلى الله عليه وسلم" ، وأثبت ما فيه المخطوطة.
(4) في المطبوعة: "صلى الله عليه وسلم" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(5) سلف البيت وتخريجه في 6: 362.
(6) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 252.
(7) انظر تفسير"الزوج" فيما سلف 1: 514 / 2: 446 ، وأراد بقوله في تفسير"الزوج""الثاني لها" ، أن"الزوج" هو"الفرد الذي له قرين" ، فكل واحد من القرينين ، يقال له: "زوج" ، ثم قيل لامرأة الرجل ، وللرجل صاحب المرأة: "زوج".
(8) القصرى (بضم القاف وسكون الصاد وفتح الراء) والقصيري (بضم القاف وفتح الصاد ، على التصغير): أسفل الأضلاع ، أو هي الضلع التي تلي الشاكلة ، بين الجنب والبطن.
(9) قوله: "وحشا" ، أي وحده ليس معه غيره.
(10) الأثر: 4806- مضى هذا الأثر مطولا برقم: 710 ، وكان في المطبوعة هنا: "لتسكن إلي" باللام في أولها ، وأثبت نص المخطوطة ، وما سلف في الأثر: 710.
(11) لأم الشيء لأمًا ، ولاءمه ، فالتأم: أصلحه حتى اجتمع وذهب ما كان فيه من الصدع. وفي روايته في الأثر رقم: 711: "ولأم مكانه لحما".
(12) الأثر: 8407- مضى هذا الأثر برقم: 711 ، وتخريجه هناك.
(13) انظر معاني القرآن للفراء 1: 252.
(14) انظر تفسير"بث" فيما سلف 3: 275.
(15) أخفر الذمة والعهد: نقضه وغدره وخاس به ، ولم يف بعهده.
(16) قوله: "قال محمد" ، يعني محمد بن جرير الطبري ، أبا جعفر صاحب التفسير. وهذه أول مرة يكتب فيها الطبري ، أو أحد تلامذته ، أو بعض ناسخي تفسيره"قال محمد" ، دون كنيته قال"أبو جعفر". وانظر ما سيأتي ص: 569 ، تعليق: 2.
(17) قوله: "تنسق" ، أي تعطف. و"النسق" العطف ، انظر فهارس المصطلحات في هذه الأجزاء من التفسير ، و"المكني" الضمير ، انظر فهارس المصطلحات.
(18) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 252 ، 253 ، وقد ذكر هذه القراءة بإسنادها إلى إبراهيم بن يزيد النخعي ، وهي قراءة حمزة وغيره.
(19) هو مسكين الدارمي.
(20) معاني القرآن للفراء 1: 253 ، الحيوان 6: 493 ، 494 ، الإنصاف: 193 ، الخزانة ، 2: 338 ، العيني (بهامش الخزانة) 4: 164 ، وهو من أبيات ذكرها الجاحظ ، وأتمها العيني ، يمجد نفسه وقومه ، قال:
لَقَــدْ عَلِمَـتْ قَيْسٌ وَخِـنْدِفُ أنَّنــي
بِثَغْـرِهِمُ مِـنْ عَـارِمِ النَّـاسِ وَاقِـفُ
وَقَـدْ عَلِمُـوا أَنْ لَـنْ يُبقَّـى عَـدُوُّهُمْ
إِذَا قَذَفَتْــه فــي يَــدَيّ القَـوَاذِفُ
وأنَّ أبَانَــا بِكــرُ آدَمَ، فَــاعْلَمُوا،
وَحَـوَّاءَ، قَــرْمٌ ذُو عَثَـانينَ شَـارِفُ
كَــأَنَّ عَــلَى خُرْطُومِــهِ مُتَهافِتًـا
مِـنَ القُطْــنِ هَاجَتْـهُ الأكُفُ النَّوَادِفُ
وَللَصَّــدَأُ المُسْــوَدُّ أَطْيـبُ عِنْدَنَـا
مِـنَ المِسْـكِ، دَافَتْـهُ الأَكُفُّ الـدَّوَائِفُ
تُعَلَّـقُ في مِثْـلِ السَّـوَارِي سُـيُوفُنَا
ومـا بَيْنَهـا والكَـعْبِ غُـوطٌ نفـانِفُ
وَتَضْحَـكُ عِرْفَـانَ الـدرُوع جُلُودُنَـا
إِذَا جَـاء يَـوْمٌ مُظْلِـمُ اللَّـوْن كاسِفُ
في أبيات أخر ، ورواية الحيوان: "والكعب منا تنائف" ، وفي الطبري ومعاني القرآن والخزانة"نعلق" بالنون ، وكلتاهما صواب. و"السواري" جمع سارية ، وهي الأسطوانة. و"الغوط" جمع غائط ، وهو المطمئن من الأرض. و"النفانف" جمع نفنف: وهو الهواء بين شيئين ، وكل شيء بينه وبين الأرض مهوي بعيد فهو نفنف.
(21) في المخطوطة والمطبوعة: "لا نستجيز القارئ أن يقرأ" بتعريف"القارئ" ، وهو خطأ صوابه ما أثبت.
(22) انظر ما سلف قريبا ص: 519 ، 520.
(23) تهذيب الألفاظ: 475 ، المعاني الكبير: 1148 ، مجاز القرآن 1: 113 ، الميسر والقداح: 133 ، وغيرها ، وهو من أبيات جياد في نعت الثور الأبيض ، لم أجدها مجتمعة ، منها:
وَقَـــوَائِمٌ خُــذُفٌ، لَهَــا مِــنْ
خَلْفِهَــــا زَمَـــــعٌ زَوَائِـــدْ
كَمقَـــاعِدِ الرُّقَبَـــاءِ لِلضُّـــرَ
بَــــاءِ أَيْــــدِيهِمْ نَوَاهِــــدْ
لَهَـــقٌ كَنَــارِ الـرَّأْسِ بِــالـ
عَلْيَــــاءِ تُذْكِيهَـــا الأَعَـــابِدْ
وَيُصِيــخُ أَحْيَانًــا كَمَـــا اسْـ
ـتَمَــعَ المُضِــلُّ لِصَــوْتِ نَاشِـدْ
يصف قوائم هذا الثور ، "خذف" جمع خذوف ، وهي السريعة السير والعدو ، تخذف الحصى بقوائمها. أي تقذفه. و"الزمع" جمع زمعة ، وهي هنة زائدة ناتئة فوق ظلف الشاة والثور ، مدلاة فيها شعر. ثم وصف هذه الزمع الناتئة خلف أظلاف الثور ، وشبه إشرافها على الأظلاف بالرقباء المشرفين على الضرباء ، وقد مدوا أيديهم. وهذا وصف في غاية البراعة والحسن. و"الرقباء" جمع رقيب ، وهو أمين أصحاب الميسر ، يحفظ ضربهم بالقداح ويرقبهم. و"الضرباء" جمع ضريب ، وهو الضارب بالقداح. وزعم ابن قتيبة أن قوله: "أيديهم" أي: أيدي الضرباء ، وأخطأ ، إنما عنى أيدي الرقباء لا الضرباء. وقوله: "لهق" هو البياض ، يعني بياض الثور ، فشبه بياضه بياض النار على رأس رابية مشرقة ، تذكي لهيبها العبيد. ثم وصف الثور عند الارتياع ، فقال إنه يصيخ -أي ينصت مميلا رأسه ناحية من الفزع- و"المضل" الذي أضاع شيئًا فهو يترقب أن يجده."والناشد" ، هو الذي ينشد ضالة ، أي يعرفها ويصفها. فهو يصغي لصوت المنشد المعرف إصغاء من يرجو أن تكون هي ضالته. وهذا من جيد الشعر وبارعه.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] سورة النِّساء ابتدأَت بالنِّداء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾، والنِّداء بـ: (يَا أَيُّهَا) أعمُّ وأشمل من النِّداء بـ ﴿يا أيُّها الذِّين آمنوا﴾؛ لأنَّ سُورةَ النِّساء وَردت فيها حُقُوق إن صَحَّ أن نُسَّمِيها (حقوق الإنسان).
وقفة
[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ذكر الله تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على بعض، ويحننهم على ضعفائهم.
وقفة
[1] في سورة النساء لطيفة عجيبة، وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ، وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم: ﴿وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]، وهذان الوصفان -العلم والقدرة- بهما تثبت الربوبية والألوهية والجلال والعزة، وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعًا للأوامر والنواهي منقادًا للتكاليف.
لمسة
[1] استخدام كلمة (الربِّ) في قوله تعالى: ﴿اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾ لأن لفظ الجلالة يُذكر دائمًا في مقام التكليف والتهديد، أما كلمة (الربِّ) فتأتي عند ذكر الهداية، أو ذكر فضل الله على الناس، فهو سبحانه المتفضِّل عليهم، وهو المالك والسيِّد والمربي والهادي والمرشد والمعلم.
وقفة
[1] ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي حواء، فإِن قلتَ: إذا كانت مخلوقةً من (آدمَ) ونحنُ مخلوقون منه أيضًا، تكون نسبتُها إليه نسبةَ الولد، فتكونُ أختًا لنا، لا أمًّا؟ قلتُ: خلقُها من آدم لم يكن بتوليد، كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيها.
وقفة
[1] ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ تنبيه على أن زوجتك بُضعة منك، ومن أقرب الناس إليك، فعليك بمراعاتها والقيام بحقها.
وقفة
[1] الزوجة لابد لها أن تكون في ظل زوجها وتحت كنفه وولايته ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾.
وقفة
[1] طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام هي علاقة تكاملية لا تنافسية، فحواء لم تخلق كما خلق آدم، بل خلقت منه ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، فإن ظلمها؛ فإنما يظلم نفسه.
وقفة
[1] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ صلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر، فله دينه وللواصل دينه.
وقفة
[1] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ قرن الله الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها؛ ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله، كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصًا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به.
وقفة
[1] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم، وأن يرحم بعضهم بعضًا.
عمل
[1] ابدأ اليوم بوضع جدول لزيارة أرحامك، والاتصال على البعيد منهم ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾.
وقفة
[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ رؤيته لك أسرع من رؤيتك للحرام.
وقفة
[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ مقام المراقبة -وهو مقام شريف- أصله: علمٌ وحال؛ أما العلم فهو: معرفة العبد أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، وأما الحال فهي: ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه، ولا يغفل عنه. ولا يكفي العلم دون هذه الحال.
وقفة
[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ اســم الله (الـرقـيب): المطلع على كل شئ فى كل وقت، وفى كل مكان، وفى كل زمان.
عمل
[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ اقرأوا سورة النساء قراءة متدبر، باحثين عن أسماء الله الحسنى التي وردت في السورة، والأسماء الحسنى التي ختمت بها آيات السورة بلغت 55 اسمًا منها: غفور، رحيم، عليم، حكيم، عليًا، كبيرًا، شهيدًا، خبيرًا، عفوًا، عزيزًا، توابًا، حفيظًا ...، سورة نحتاج أن نقرأها من جديد.
لمسة
[1] تختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ لأن كلمة (اتَّقُواْ) تعني اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة، واجتناب ما نهى الله عنه، والرقيب من رقب أي أن هناك من يرصدك، فالله سبحانه ليس بصيرًا فقط، ولكنه رقيب أيضًا.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا النَّاسُ: ﴾
- يا: أداة نداء. أيّ: منادى مبني على الضم في محل نصب. و«ها» للتنبيه. و «النَّاسُ» عطف بيان لأيّ أو نعت- صفة- لأي مرفوعة بالضمة.
- ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمُ: ﴾
- أي خافوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف فارقة، ربّ: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ: ﴾
- الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للمفعول به «رَبَّكُمُ» أو بدل منه و «خَلَقَكُمْ» فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة «خَلَقَكُمْ» صلة الموصول.
- ﴿ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخلقكم. واحدة: صفة- نعت- لنفس مجرورة مثلها وأنثت لأن معناها الروح
- ﴿ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها: ﴾
- وخلق: معطوفة بواو العطف على «خَلَقَكُمْ» أي خلق من نفس آدم وخلق منها أمكم حواء. منها: جار ومجرور زوجها: مفعول به منصوب بالفتحة و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ويجوز أن تعطف جملة «وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها» على محذوف في محل نصب صفةوالتقدير: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق فيها زوجها وإنما حذف لدلالة المعنى عليه و «مِنْها» متعلق بخلق
- ﴿ وَبَثَّ مِنْهُما: ﴾
- أي ونشر: معطوفة بواو العطف على «خَلَقَ» وتعرب اعرابها منهما: جار ومجرور متعلق ببث. الميم: حرف عماد والألف: حرف دال على تثنية الغائبين.
- ﴿ رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً: ﴾
- رجالا: مفعول به منصوب بالفتحة. كثيرا: صفة- نعت- منصوبة مثلها بالفتحة. ونساء: معطوف بواو العطف على «رِجالًا» منصوب مثله بالفتحة
- ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي: ﴾
- الجملة: معطوفة بواو العطف على «اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي» وتعرب اعرابها. أي اعراب «ربّ» دون «كم».
- ﴿ تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ: ﴾
- أي «تتساءلون» بحذف التاء الثانية اختصارا أو لاجتماع التاءين وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بتساءلون. والأرحام:معطوفة بواو العطف على لفظ الجلالة أي اتقوا الله والارحام
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ كانَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ولفظ الجلالة: اسمها منصوب للتعظيم بالفتحة. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة «كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» في محل رفع خبر «إِنَّ».
- ﴿ عَلَيْكُمْ رَقِيباً: ﴾
- جار ومجرور متعلق برقيبا. والميم علامة جمع الذكور. رقيبا:خبر «كانَ» منصوب بالفتحة.'
المتشابهات :
| البقرة: 21 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ...﴾ |
|---|
| النساء: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ |
|---|
| الحج: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ﴾ |
|---|
| لقمان: 33 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ...﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : مقصد سورة النساء هو: العدل والرحمة بالضعفاء؛ ولذا بدأت السورة بالتذكير بأن أصلَ الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليرحم بعضهم بعضًا، وخاصة الضعفاء منهم، ولَمَّا أمَر الله عز وجل بتقواه؛ ذكَر اللهُ هنا السبَّبَ الدَّاعيَ لهذه التَّقْوى، فقال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾
القراءات :
واحدة:
قرئ:
1- بالتاء، على تأنيث لفظ النفس، وهى قراءة الجمهور.
2- واحد، على مراعاة المعنى، إذ المراد به آدم، أو على أن «النفس» تذكر وتؤنث، وهى قراءة ابن أبى عبلة.
وخلق:
وقرئ:
وخالق، على اسم الفاعل، وهو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وهو خالق.
وبث:
وقرئ:
وباث، على اسم الفاعل.
تساءلون:
وقرئ:
1- تسألون، مضارع «سأل» الثلاثي، وهى قراءة عبد الله.
2- تسلون، بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين.
والأرحام:
قرئ:
1- بنصب الميم، عطفا على لفظ الجلالة، أو على موضع «به» ، وهى قراءة الجمهور.
2- بجرها، عطفا على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، وهى قراءة النخعي، وقتادة، والأعمش.
3- بضمها، على أنها مبتدأ والخبر محذوف، وهى قراءة عبد الله بن يزيد.
مدارسة الآية : [2] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ .. ﴾
التفسير :
وقوله تعالى:{ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم، وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا، كاملة موفرة، وأن لا{ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ} الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق.{ بِالطَّيِّبِ} وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة.{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أي:مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله. فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى{ حُوبًا كَبِيرًا} أي:إثمًا عظيمًا، ووزرًا جسيمًا. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس، ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفيه الولاية على اليتيم، لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله، ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.
والأمر في قوله وَآتُوا يتناول كل من له ولاية أو وصاية أو صلة باليتيم، كما يتناول الجماعة الإسلامية بصفة عامة، لكي تتكاتف وتتعاون على تمكين اليتيم من وصول حقه إليه بدون بخس أو مماطلة.
والْيَتامى جمع يتيم وهو الصغير الذي مات أبوه، مأخوذ من اليتم بمعنى الانفراد. ومنه الدرة اليتيمة.
قال صاحب الكشاف وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم، وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم.
وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبى طالب إما على القياس، وإما حكاية للحال التي كان عليها صغيرا في حجر عمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد الحلم» فهو تعليم شريعة لا لغة.
أى أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار» .
والمراد باليتامى هنا الصغار، والمراد بإيتائهم أموالهم حفظها لهم وعدم الطمع في شيء منها لا من قبل الورثة ولا من قبل الأوصياء ولا من قبل غيرهم وعلى هذا المعنى يكون لفظ الإيتاء قد أول بلازم معناه وهو الحفظ والرعاية لمال اليتامى، لا تسليم المال إليهم لأنه من المعروف شرعا ألا يسلم المال إليهم إلا بعد البلوغ، إذ هم في حال الصغر لا يصلحون للتصرف.
ويكون هذا التعبير من باب الكناية بإطلاق اللازم- وهو الإيتاء، وإرادة الملزوم وهو الحفظ، أو من باب المجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء.
ويرى بعضهم أن المراد باليتامى هنا الكبار الذين أونس منهم الرشد وأن المراد بالإيتاء دفع أموالهم إليهم على سبيل الحقيقة.
ويكون التعبير عنهم باليتامى- مع أنهم كبار- باعتبار أن اسم اليتيم يتناول لغة كل من فقد أباه، أو باعتبار قرب عهدهم بالصغر، أو باعتبار ما كان أى الذين كانوا يتامى. قالوا: وفي التعبير عنهم باليتامى مع أنهم كبار، إشارة إلى وجوب المسارعة في تسليم أموالهم إليهم متى أونس منهم الرشد، حتى لكأن اسم اليتيم ما زال باقيا عليهم، غير منفصل عنهم:
ويبدو لنا أن الرأى الأول أولى، لأن الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم. بعد بلوغهم قد جاء صريحا في قوله- تعالى- بعد ذلك: وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.
فكان حمل الآية التي معنا على أن المراد باليتامى: الصغار، وبإيتاء أموالهم حفظها لهم، أولى وأقرب إلى المنطق، لأنه على الرأى الأول يكون الأمر وما يذكر به تأسيسات أحكام، وعلى الرأى الثاني يكون ما في الآية الثانية مؤكدا لما في الآية التي معنا. والتأسيس أولى من التأكيد.
ولأن قوله- تعالى- بعد ذلك في الآية التي معنا وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ- إنما هو تحذير للأوصياء والأولياء من الطمع في مال اليتيم أو إضاعته ما دام المال في أيديهم واليتيم في حجرهم، وهذا يؤيد هذا الرأى الأول القائل بأن المراد باليتامى: الصغار، وبإيتاء أموالهم: حفظها ورعايتها حتى تسلم إليهم عند بلوغهم كاملة غير منقوصة.
وقوله وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ معناه: لا تجعلوا رديء المال لهم بدل الجيد، بأن تأخذوا لأنفسكم كرائم الأموال ونفائسها، وتتركوا لهم الخسيس منها.
قال القرطبي: وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى فكانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم ويقولون اسم باسم، ورأس برأس، فنهاهم الله عن ذلك. وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدى والضحاك وهو ظاهر الآية، إذ التبديل جعل شيء بدل شيء» .
ويرى صاحب الكشاف أن المراد بالخبيث: الحرام، وبالطيب: الحلال فقد قالوا:
وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ أى: ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه، أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع عنها».
وقوله- تعالى- وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ نهى آخر عن الاعتداء على أموال اليتامى عن طريق خلط أموال اليتامى بأموال الأوصياء، والمراد من الأكل: مطلق الانتفاع والتصرف وخص الأكل بالذكر، لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف.
والمعنى: ولا تضموا أيها الأوصياء أموال اليتامى إلى أموالكم في الإنفاق فتأكلوها مع أموالكم، وتسووا بينهما في الانتفاع، لأن أموالكم أحل الله لكم أكلها، أما أموال اليتامى فقد حرم الله عليكم أكلها.
فالآية الكريمة صريحة في النهى عن خلط مال اليتيم القاصر بمال الوصي عليه بقصد أكله، لأن هذا لون من ألوان الاستيلاء المحرم على أموال اليتامى، كما أنها تتضمن النهى عن خلط مال اليتيم بمال الوصي عليه ولو لم يقصد أكله، لأن هذا الخلط قد يؤدى إلى ضياعه وعدم تميزه فقد يموت الوصي فلا يعرف مال اليتيم من ماله، فيؤدى الأمر إلى أكله وإن لم يكن مقصودا، ولذا قال الفقهاء: إذا مات الوصي على اليتيم مجهلا مال اليتيم اعتبر مستهلكا له.
والخلاصة أن الآية الكريمة تحرم على الأولياء والأوصياء وغيرهم أن يتصرفوا في أموال اليتامى أى تصرف يؤدى إلى الإضرار بها، بل عليهم أن يحفظوها لهم حتى يدفعوها إليهم سالمة عند البلوغ.
هذا، وليس قيد «إلى أموالكم» محط النهى، بل النهى واقع على أكل أموال اليتامى مطلقا، سواء أكان للآكل مال يضم إليه مال اليتيم أم لم يكن. ولكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء، وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثر أو توفير أموالهم، جيء بهذا القيد رعاية لهذا الغالب، وليكون ذمهم على جشعهم وضعف دينهم أشد وأشنع حيث أكلوا حقوق اليتامى مع أنهم في غنى عنها بما رزقهم الله من أموال.
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: فإن قلت: قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم فلم ورد النهى عن أكله معها؟ قلت: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال- وهم مع ذلك يطمعون فيها- كان القبح أبلغ والذم أحق، ولأنهم كانوا يفعلون ذلك فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون أزجر لهم».
ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً.
والحوب: اسم مصدر من حاب يحوب حوبا: إذا اكتسب إثما. يقال: فلان يتحوب أى يتأثم. والحوباء: النفس المرتكبة للإثم. ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي، أى إثمى.
وأصله الزجر للإبل، فسمى الإثم حوبا لأنه يزجر عنه وبه.
والضمير في قوله إِنَّهُ يعود إلى أكل مال اليتيم بأى طريق محرم.
والمعنى: إن أكل مال اليتيم بأى طريقة من الطرق المحرمة كان إثما كبيرا، وذنبا عظيما، لأن هذا الأكل اعتداء على نفس ضعيفة فقدت من يعولها ومن يدافع عنها، ومن اعتدى على نفس ضعيفة، وضيع حقها، وخان الأمانة كان مرتكبا لذنب عظيم يؤدى به إلى العقوبة والعذاب الأليم.
والجملة بمنزلة التعليل للنهى عن أكل مال اليتيم، وعن الطمع بدون وجه حق فيها.
ثم شرع- سبحانه- في نهيهم عن منكر آخر كانوا يباشرونه فقال- تعالى-:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.
وقوله وَإِنْ خِفْتُمْ شرط، وجوابه قوله فَانْكِحُوا.
والمراد من الخوف: العلم، وعبر عنه بذلك للأشعار بكون المعلوم مخوفا محذورا. ويقوم الظن الغالب مقام العلم.
وقوله تُقْسِطُوا من الإقساط وهو العدل. يقال: أقسط الرجل إذا عدل. قال- تعالى-: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ويقال: قسط الرجل إذا جار وظلم صاحبه.
قال- تعالى- أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً.
والمراد «باليتامى» : يتامى النساء. قال الزمخشري: ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة.
ومعنى ما طابَ لَكُمْ ما مالت إليه نفوسكم واستطابته من النساء اللائي أحل الله لكم نكاحهن.
هذا، وللعلماء أقوال في تفسير هذه الآية الكريمة منها: ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة- رضى الله عنها- عن هذه الآية فقالت: يا ابن أختى هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها.
فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره.
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله- تعالى-: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ.
قالت عائشة: وقول الله- تعالى- وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال» .
وعلى هذه الرواية التي ساقها أئمة المحدثين عن عائشة في المراد من الآية الكريمة يكون المعنى: وإن علمتم أيها الأولياء على النساء اليتامى أنكم لن تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن- بأن تسيئوا إليهن في العشرة، أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب لهن- إذا علمتم ذلك فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائي تميل إليهن نفوسكم ولا تظلموا هؤلاء اليتامى بنكاحهن دون أن تعطوهن حقوقهن فإن الله- تعالى- قد وسع عليكم في نكاح غيرهن.
فالمقصود من الآية الكريمة على هذا المعنى: نهى الأولياء عن نكاح النساء اليتامى اللائي يلونهن عند خوف عدم العدل فيهن، إلا أنه أوثر التعبير عن ذلك بالأمر بنكاح النساء الأجنبيات، كراهة للنهى الصريح عن نكاح اليتيمات، وتلطفا في صرف المخاطبين عن نكاح اليتامى حال العلم بعدم العدل فيهن.
فكأنه- سبحانه- يقول: إن علمتم أيها الأولياء الجور والظلم في نكاح اليتامى اللائي في ولايتكم فلا تنكحوهن، وانكحوا غيرهن مما طاب لكم من النساء.
وعلى هذا القول الذي أورده المحدثون عن عائشة- رضى الله عنها- سار كثير من المفسرين في تفسير الآية الكريمة. وبعضهم اقتصر عليه ولم يذكر سواه.
قال بعض العلماء: وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. وهي وإن لم تسند ما قالته إلى رسول الله، إلا أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة، اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول.
لا سيما وقد قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم، وتكون قد جمعت إلى جانب حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة، حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها النساء اليتامى كمهور لهن عند الزواج بهن..».
أما الرأى الثاني فيرى أصحابه أن الآية مسوقة للنهى عن نكاح ما فوق الأربع خوفا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم.
وقد حكى هذا القول الإمام ابن جرير فقال: وقال آخرون بل معنى ذلك: النهى عن نكاح ما فوق الأربع، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدما مال على مال اليتيمة التي في حجره فأنفقه، أو تزوج به، فنهوا عن ذلك. وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم، - إن خفتم ذلك. فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع. وإن خفتم أيضا من الأربع ألا تعدلوا في أموالهم- أى أموال اليتامى-، فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم - أى إن كان زواجكم بالأربع يؤدى إلى الجور في أموال اليتامى فاقتصروا على الزواج بامرأة واحدة-» .
وقد انتصر ابن جرير لهذا القول وعده أرجح الأقوال، فقال ما ملخصه وإنما قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية لأن الله- تعالى- افتتح الآية التي قبلها بالنهى عن أكل أموال اليتامى بغير حقها. ثم أعلمهم- هنا- المخلص من الجور في أموال اليتامى فقال: انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته: مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أيضا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة فلا تنكحوها، ولكن تسروا من المماليك، فإنكم أحرى ألا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموالكم، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور».
وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس وسعيد بن جبير، والسدى، وقتادة، وعكرمة.
وقال مجاهد: إن الآية الكريمة مسوقة للنهى عن الزنا. وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال: كانوا لا يتحرجون من الزنا. ويتحرجون من ولاية اليتامى. فقيل لهم: إن خفتم الجور في حق اليتامى، فخافوا الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء، ولا تحوموا حول المحرمات» .
هذه أشهر الأقوال في معنى الآية الكريمة، ويبدو لنا أن أرجحها أولها، لأنه هو الظاهر من معنى الآية، ولأن الغالب أن السيدة عائشة- رضى الله عنها- ما فسرت الآية بهذا التفسير الذي قالته لابن أختها عروة إلا عن توقيف ومعاينة لحال النزول، ولأن الملازمة بين الشرط والجزاء في الآية على هذا الوجه تكون ظاهرة. إذ التقدير وإن خفتم أيها الأولياء الجور والظلم في نكاح اليتامى اللاتي في ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء.
أما على القول الثاني فمحل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء وهو قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
وعلى قول مجاهد تضعف الملازمة بين الشرط والجزاء.
هذا، والأمر في قوله فَانْكِحُوا- على التفسير الأول- للإباحة كما في قوله- تعالى- كُلُوا وَاشْرَبُوا ... خلافا للظاهرية الذين يرون أنه للوجوب. وما في قوله- تعالى- ما طابَ لَكُمْ
موصولة أو موصوفة. وما بعدها صلتها أو صفتها. وأوثرت على من: لأنها أريد بها الصفة وهو الطيب من النساء بدون تحديد لذات معينة، ولو قال فانكحوا من طاب لكم لتبادر إلى الذهن أن المراد نسوة طيبات معروفات بينهم.
وقوله- تعالى- مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ حال من فاعل طابَ المستتر أو من مرجعه- وهو ما-، أو بدل منه.
وهذه الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد. وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها. فمثنى تدل على اثنين اثنين. وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة. ورباع تدل على أربعة أربعة.
والمراد منها هنا: الإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين.
والمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء معدودات هذا العدد: ثنتين ثنتين. وثلاثا ثلاثا.
وأربعا أربعا. حسبما تريدون وتستطيعون.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع. فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع.
قلت: الخطاب للجميع. فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له. كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال- وهو ألف درهم-: درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى.
فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟
قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة. وليس لهم أن يجمعوا بينها. فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضا على تثليث، وبعضا على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو.
وتحريره: أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحهن من النساء على طريق الجمع: إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاءوا متفقين فيها، محظورا عليهم ما وراء ذلك» .
يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة ، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم; ولهذا قال : ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) قال سفيان الثوري ، عن أبي صالح : لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك .
وقال سعيد بن جبير : لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم ، يقول : لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام .
وقال سعيد بن المسيب والزهري : لا تعط مهزولا وتأخذ سمينا .
وقال إبراهيم النخعي والضحاك : لا تعط زائفا وتأخذ جيدا .
وقال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ، ويقول شاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ، ويقول : درهم بدرهم .
وقوله : ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، والسدي ، وسفيان بن حسين : أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا .
وقوله : ( إنه كان حوبا كبيرا ) قال ابن عباس : أي إثما كبيرا عظيما .
وقد رواه ابن مردويه ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله : ( حوبا كبيرا ) قال : " إثما كبيرا " . ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف وهكذا روي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، وأبي مالك ، وزيد بن أسلم ، وأبي سنان مثل قول ابن عباس .
وفي الحديث المروي في سنن أبي داود : " اغفر لنا حوبنا وخطايانا " .
وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل ، مولى أبي عيينة ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس : أن أبا أيوب طلق امرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أبا أيوب ، إن طلاق أم أيوب كان حوبا " قال ابن سيرين : الحوب الإثم .
ثم قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي ، حدثنا بشر بن موسى ، أخبرنا هوذة بن خليفة ، أخبرنا عوف ، عن أنس : أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها " ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم ، عن حميد الطويل ، سمعت أنس بن مالك يقول : أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن طلاق أم سليم لحوب " فكف .
والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه .
القول في تأويل قوله : وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره أوصياءَ اليتامى. يقول لهم: وأعطوا يا معشر أوصياء اليتامى: [اليتامى] أموالهم إذا هم بلغوا الحلم، (24) وأونس منهم الرشد (25) = " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، يقول: ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال لكم، كما:-
8436 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، قال: الحلال بالحرام.
8437 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8438 - حدثني سفيان قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، قال: الحرام مكان الحلال.
* * *
قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في صفة تبديلهم الخبيث كان بالطيب، الذي نهوا عنه، ومعناه. (26)
فقال بعضهم: كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيِّد من ماله والرفيعَ منه، ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس، فذلك تبديلهم الذي نهاهم الله تعالى عنه.
* ذكر من قال ذلك:
8439 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، قال: لا تعط زيفًا وتأخذ جيِّدًا.
8440 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السدي= وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب= ومعمر عن الزهري، قالوا: يعطي مهزولا ويأخذ سمينًا.
8441 - وبه عن سفيان، عن رجل، عن الضحاك قال: لا تعط فاسدًا، وتأخذ جيدًا.
8442 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول: " شاة بشاة "! ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف، ويقول: " درهم بدرهم "!!
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تستعجل الرزق الحرام فتأكله قبل أن يأتيك الذي قُدِّر لك من الحلال.
* ذكر من قال ذلك:
8443 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، قال: لا تعجِّل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدِّر لك.
8444 - وبه عن سفيان، عن إسماعيل، عن أبي صالح مثله.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك، كالذي:-
8445 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون النساءَ ولا يورِّثون الصغار، يأخذه الأكبر= وقرأ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قال: إذا لم يكن لهم شيء: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ [سورة النساء: 127]، لا يورثونهم. (27) قال: فنصيبه من الميراث طيِّب، وهذا الذي أخذه خبيث.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، قول من قال: تأويل ذلك: ولا تتبدلوا أموال أيتامكم -أيها الأوصياء- الحرامَ عليكم الخبيثَ لكم، فتأخذوا رفائعها وخيارَها وجيادَها. بالطيب الحلال لكم من أموالكم= [أي لا تأخذوا] الرديء الخسيس بدلا منه. (28)
وذلك أنّ" تبدل الشيء بالشيء " في كلام العرب: أخذ شيء مكان آخر غيره، يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ. (29)
* * *
فإذْ كان ذلك معنى " التبدل " و " الاستبدال "، (30) فمعلوم أنّ الذي قاله ابن زيد= من أن معنى ذلك: هو أخذ أكبرِ ولد الميت جميع مال ميِّته ووالده، دون صغارهم، إلى ماله- قولٌ لا معنى له. لأنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله دون الأصاغر منهم، فلم يستبدل مما أخذ شيئًا. فما " التبدل " الذي قال جل ثناؤه: " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "، ولم يتبدَّل الآخذ مكان المأخوذ بدلا؟
* * *
وأما الذي قاله مجاهد وأبو صالح من أن معنى ذلك: لا تتعجل الرزق الحرام قبل مجيء الحلال= فإنهما أيضًا، إن لم يكونا أرادا بذلك نحو القول الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: " إن الرجل ليحرم الرزق بالمعصية يأتيها "، ففساده نظير فساد قول ابن زيد. لأن من استعجل الحرام فأكله، ثم آتاه الله رزقه الحلال، فلم يبدِّل شيئًا مكان شيء. وإن كانا قد أرادا بذلك، (31) أن الله جل ثناؤه نهى عباده أن يستعجلوا الحرام فيأكلوه قبل مجيء الحلال، فيكون أكلُهم ذلك &; 7-528 &; سببًا لحرمان الطيِّب منه فذلك وجه معروف، ومذهب معقول. يحتمله التأويل. غير أن أشبه [القولين] في ذلك بتأويل الآية، ما قلنا؛ (32) لأن ذلك هو الأظهر من معانيه، لأن الله جل ثناؤه إنما ذكر ذلك في قصة أموال اليتامى وأحكامها، فلأن يكون ذلك من جنس حُكمِ أول الآية وآ خرها، [أولى] من أن يكون من غير جنسه. (33)
* * *
القول في تأويل قوله : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: ولا تخلِطوا أموالهم -يعني: أموال اليتامى بأموالكم- فتأكلوها مع أموالكم، (34) كما:-
8446 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم "، يقول: لا تأكلوا أموالكم وأموالهم، تخلطوها فتأكلوها جميعًا.
8447 - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن مبارك، عن الحسن قال: لما نـزلت هذه الآية في أموال اليتامى، كرهوا أن يخالطوهم، وجعل وليُّ اليتيم يعزل مالَ اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [سورة البقرة: 220] قال: فخالطوهم واتقوا. (35)
* * *
القول في تأويل قوله : إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره [بقوله]: (36) " إنه كان حوبًا كبيرًا "، إن أكلكم أموال أيتامكم، حوبٌ كبير.
* * *
و " الهاء " في قوله: " إنه " دالة على اسم الفعل، أعني" الأكل ".
* * *
وأما " الحوب "، فإنه الإثم، يقال منه: " حاب الرجل يَحُوب حَوبًا وحُوبًا وحِيَابة "، ويقال منه: " قد تحوَّب الرجل من كذا "، إذا تأثم منه، ومنه قول أمية بن الأسكر الليثي: (37)
وَإنَّ مُهَـــــاجِرَيْنِ تَكنَّفَـــــاهُ
غَدَاتَئِــذٍ لقَــدْ خَطَئَــا وحَابَــا (38)
ومنه قيل: " نـزلنا بحَوبة من الأرض، وبحِيبَةٍ من الأرض "، إذا نـزلوا بموضع سَوْءٍ منها.
* * *
و " الكبير " العظيم. (39)
* * *
فمعنى ذلك: إنّ أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم، إثم عند الله عظيم.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
8448 - حدثني محمد بن عمرو وعمرو بن علي قالا حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: " حوبًا كبيرًا " قال: إثمًا.
8449 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8450 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " إنه كان حوبًا كبيرًا "، قال: إثمًا عظيما.
8451 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " كان حوبًا " أما " حوبا " فإثمًا.
8452 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: " حوبًا "، قال: إثمًا.
8453 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " إنه كان حوبًا كبيرًا " يقول: ظلمًا كبيرًا.
8454 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد يقول في قوله: " إنه كان حوبًا كبيرًا " قال: ذنبا كبيرًا= وهي لأهل الإسلام.
8455 - حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا قرة بن خالد قال، سمعت الحسن يقول: " حوبًا كبيرًا "، قال: إثمًا والله عظيمًا.
------------------------
الهوامش :
(24) في المخطوطة والمطبوعة ، أسقط ما وضعته بين القوسين ، ولكن السياق يقتضي إثباتها ، وكأن الناسخ غره التكرار ، فأسقط إحداهما ، فأساء.
(25) انظر تفسير"آتى" في فهارس اللغة ، وتفسير"اليتامى" فيما سلف 2: 292 / 3: 345 / 4: 295.
(26) في المطبوعة: "في صفة تبديلهم الخبيث بالطيب" ، أسقط الناشر"كان" لأن عربيته أنكرت عربية أبي جعفر!! وهي الصواب المحض ، فأثبتها.
(27) في المطبوعة والمخطوطة: "لا يورثوهم" ، والصواب ما أثبت.
(28) هذا الذي زدته بين القوسين ، استظهار من تأويله الآتي. والجملة بغير هذه الزيادة لا تكاد تستقيم.
ثم انظر تفسير"الخبيث" فيما سلف 5: 559 / 7: 424 = وتفسير"الطيب" فيما سلف 3: 301 / 5: 555 / 6: 361 / 7: 424.
(29) انظر تفسير"تبدل" و"استبدل" فيما سلف 2: 112 ، 130 ، 494.
(30) في المطبوعة: "التبديل" ، وأثبت الصواب من المخطوطة.
(31) في المطبوعة: "وإن كانا أراد بذلك" بحذف"قد" وفي المخطوطة: "وإن كان قال أراد بذلك" وهو فساد من عجلة الناسخ ، ولكن صواب قراءتها ما أثبت.
(32) في المطبوعة: "غير أن الأشبه في ذلك بتأويل الآية ما قلنا" ، وهو غير جيد ، وفي المخطوطة: "غير أن أشبه في ذلك بتأويل الآية ما قلنا" ، وبين أن الناسخ عاد فسها ، فأسقط"القولين" وهو ما أثبته ما بين القوسين.
(33) في المطبوعة: "فلا يكون ذلك من جنس حكم أول الآية ، فأخرجها من أن يكون من غير جنسه" جعل"وآخرها" ، "فأخرجها" ، فأنزل الكلام منزلة من الفساد لا مخرج منها. وأما المخطوطة فكان سياقها: "فلا يكون ذلك من جنس حكم أول الآية وآخرها من أن يكون من غير جنسه" ، وهو سهو من الناسخ وعجلته أفسد الجملة ، صواب"فلا يكون""فلأن يكون" ، والصواب أيضًا زيادة"أولى" التي وضعتها بين القوسين.
(34) انظر تفسير"أكل الأموال" فيما سلف 3: 548 ، 549 = وتفسير"إلى" بمعنى"مع" فيما سلف 1: 299 / 6: 443 ، 444.
(35) الأثر: 8447- هذا الأثر لم يروه أبو جعفر في تفسير آية سورة البقرة 4: 349- 355 ، وهو من الدلائل على اختصاره تفسيره هذا.
(36) الذي بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام بغيرها.
(37) في المطبوعة والمخطوطة: "بن الأسكن" ، وهو خطأ صرف.
(38) مضى البيت وتخريجه في 2: 110 ، وسيأتي في 13: 37 (بولاق) ، وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 13 ، ولم أثبتت هناك ، مواضع تكراره في التفسير ، فليقيد هناك ، وروايته هناك: "لعمر الله قد خطئا وخابا" بالخاء ، وأرجح أن أجود الروايتين ، روايته في هذا الموضع ، بالحاء المهملة؛ وإن كانت أكثر الكتب قد أثبتها بالخاء المعجمة ، وأرجح أيضًا أنه تصحيف قديم ، ومعنى رواية أبي جعفر أشبه بسياق الشعر إن شاء الله.
(39) انظر تفسير"كبير" فيما سلف 2: 15 / 3: 166 / 4: 300.
التدبر :
وقفة
[2] ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ فيه تحذير من أكل مال اليتيم؛ وأنه من الكبائر.
وقفة
[2] ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ أى: إذا بلغوا، وإن لم يسموا أيتامًا بعد البلوغ، وإنما سموا أيتامًا هنا لقرب عهدهم بالبلوغ.
وقفة
[2] من السبع الطوال في القرآن، وثاني آية منها: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾! في ظل الإسلام لا خوف على حقوقك؛ وإن كنت ضعيفًا.
عمل
[2] ساعد أيتامًا على حفظ مالهم ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾.
عمل
[2] ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ عن أبي صالح: «لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك».
وقفة
[2] ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ وليس الطيب بالخبيث؛ القاعدة أن الباء تكون مع المتروك كما في قوله تعالى: ﴿اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: 16].
لمسة
[2] نهيُ المؤمن عن أكل مال اليتيم بـ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾، ولم يأت النهي عن الأخذ بـ (ولا تأخذوا)؛ لأن الأكل هو أشد دلالة وأقوى تعبيرًا، ويوحي بأن الشخص قد أحرز ما أكله في داخل جسده وعندها لا مطمع في إرجاعه، ولا دليل على أنه أخذ هذا المال.
لمسة
[2] ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ عدّى فعل (أكل) بـ (إلى) لتضمين معنى الضم؛ أي: لا تضموا أموال اليتامى وتأكلوها.
لمسة
[2] ﴿وَلاَ تَأْكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ﴾ أي مضمومة إليها، فإن قلتَ: أكلُ مال اليتيم حرامٌ وإِن لم يُضمَّ إلى مال الوصيِّ، فلم خصَّ النهي بالمضموم؟ قلتُ: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبحُ، فلذلك خصَّ النهي به، ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه، فجاء النهي على ما وقع منهم.
الإعراب :
- ﴿ وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ: ﴾
- وآتوا: معطوفة بواو العطف على «اتَّقُوا» في الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. اليتامي: مفعول به أول منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر. أموالهم: مفعول به. ثان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره و «هم» ضمير الغائبين المتصل في محل جر بالاضافة
- ﴿ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ: ﴾
- الواو: استئنافية. لا: ناهية جازمة. تتبدلوا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. الخبيث: مفعول به منصوب بالفتحة بالطيب: جار ومجرور متعلق بتتبدلوا.
- ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ: ﴾
- ولا تأكلوا أموال: تعرب إعراب «وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة الى أموالكم جار ومجرور متعلق بحال محذوفة التقدير: مضمومة الى أموالكم. ويجوز أن يكون المعنى مع أموالكم. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. واسمها: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. حوبا: خبر «كانَ» منصوب بالفتحة. كبيرا: صفة «لحوبا» منصوبة بالفتحة. وجملة «كانَ حُوباً» في محل رفع خبر «إن» بمعنى كان ذنبا عظيما. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : بعد التذكير بأن أصلَ الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليرحم بعضهم بعضًا، وخاصة الضعفاء منهم؛ بدأ الحديث هنا عن أول الضعفاء في هذه السورة، وهم اليتامى، فأمرَ اللهُ الأولياءَ هنا بإعطاء اليتامَى أموالهم عند البلوغ، ونهاهم عن أكل أموالهم بأى طريقة، وعده ذنبًا كبيرًا؛ لأنه اعتداء على نفس ضعيفة فقدت من يدافع عنها، قال تعالى:
﴿ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾
القراءات :
حوبا:
قرئ:
1- بضم الحاء، وهى قراءة الجمهور.
2- بفتحها، وهى قراءة الحسن، وهى لغة بنى تميم وغيرهم.
3- حابا، وهى قراءة لبعض القراء.
وكلها مصادر.
مدارسة الآية : [3] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي .. ﴾
التفسير :
أي:وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا{ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} أي:ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك"وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال:{ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي:من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين{ ذَلِك} أي:الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين{ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي:تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض، له بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
ثم بين- سبحانه- لعباده ما ينبغي عليهم فعله في حال توقعهم عدم العدل بين الزوجات فقال- تعالى- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
فالمراد بالعدل هنا: العدل بين الزوجات المتعددات.
أى: فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الزوجة الواحدة في القسم والنفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم، كما علمتم في حق اليتامى أنكم لا تعدلون- إذا علمتم ذلك فالزموا زوجة واحدة، أو أى عدد شئتم من السراري بالغة ما بلغت.
فكأنه- سبحانه- لما وسع عليهم بأن أباح لهم الزواج بالمثنى والثلاث والرباع من النساء، أنبأهم بأنه قد يلزم من هذه التوسعة خوف الميل وعدم العدل. فمن الواجب عليهم حينئذ أن يحترزوا بالتقليل من عدد النساء فيقتصروا على الزوجة الواحدة.
ومفهومه: إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات المتعددات.
وقوله فَواحِدَةً منصوب بفعل مضمر والتقدير: فالزموا واحدة أو فاختاروا واحدة فإن الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به.
وقرئ بالرفع أى فحسبكم واحدة. أَوْ للتسوية أى سوى- سبحانه- في السهولة واليسر بين نكاح الحرة الواحدة وبين السراري من غير تقييد بعدد، لقلة تبعتهن، ولخفة مؤنتهن، وعدم وجوب القسم فيهن.
وقوله ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا جملة مستأنفة بمنزلة لتعليل لما قبلها.
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اختيار الواحدة أو التسرى.
وقوله أَدْنى هنا بمعنى أقرب. وهو قرب مجازى. أى أحق وأعون على أن لا تعولوا.
وقوله تَعُولُوا مأخوذ من العول وهو في الأصل الميل المحسوس.
يقال. عال الميزان عولا إذا مال. ثم نقل إلى الميل المعنوي وهو الجور والظلم ومنه عال الحاكم إذا جار، والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدل.
والمعنى: أن ما ذكر من اختيار الزوجة الواحدة والتسرى، أقرب بالنسبة إلى ما عداهما إلى العدل وإلى عدم الميل المحظور، لأن من اختار زوجة واحدة فقد انتفى عنه الميل والجور رأسا لانتفاء محله ومن تسرى فقد انتفى عنه خطر الجور والميل. أما من اختار عددا من الحرائر فالميل المحظور متوقع منه لتحقق المحل والخطر.
ولأن التعدد في الزوجات يعرض المكلف غالبا للجور وإن بذل جهده في العدل.
وهذا المعنى على تفسير (تعولوا) بمعنى تجوروا وتميلوا عن الحق. وهو اختيار أكثر المفسرين.
وقيل: إن معنى أَلَّا تَعُولُوا ألا تكثر عيالكم. يقال: عال يعول، إذا كثرت عياله. وقد حكى صاحب الكشاف هذا المعنى عن الإمام الشافعى فقال:
«والذي يحكى عن الشافعى- رحمه الله- أن فسر أَلَّا تَعُولُوا بأن لا تكثر عيالكم.
فوجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم كقولهم: ما نهم يمونهم إذا أنفق عليهم. لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب.
ثم قال: وكلام مثله من أعلام العلم، وأئمة الشرع، ورءوس المجتهدين، حقيق بالحمل على الصحة والسداد.
وقرأ طاوس: أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى من حيث المعنى الذي قصده».
هذا، وقد أخذ العلماء من هذه الآية أحكاما منها: جواز تعدد الزوجات إلى أربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن مجتمعات، لأن هذا العدد قد ذكر في مقام التوسعة على المخاطبين، ولو كانت تجوز الزيادة على هذا العدد لذكرها الله- تعالى-.
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع، ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز الجمع بين ما هو أكثر من الأربع الحرائر، لأن ما ذهب إليه هؤلاء المبتدعة لا يعتد به. إذ الإجماع قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء المبتدعين المخالفين.
وقد رد العلماء على هؤلاء المخالفين بما يهدم أقوالهم، ومن العلماء الذين تولوا الرد عليهم الإمام القرطبي فقد قال- ما ملخصه-:
«اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع. كما قاله من بعد فهمه عن الكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، جعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع.
وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لا يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.
وأخرج مالك في الموطأ والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة «اختر منهن أربعا وفارق سائرهن» .
وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته.
وأما قولهم إن الواو جامعة. فقد قيل ذلك، ولكن الله- تعالى- خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن يقول، أعط فلانا أربعة، ستة، ثمانية، ولا يقول: ثمانية عشر.
وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أى انكحوا ثلاث بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع.
وقد قال مالك والشافعى في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع: عليه الحد إن كان عالما.
وقال الزهري: يرجم إن كان عالما، وإن كان جاهلا فعليه أدنى الحدين الذي هو الجلد، ولها مهرها، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا» .
كذلك من الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وإن كان قد أباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، إلا أنه- سبحانه- قد قيد هذه الإباحة
بالعدل بينهم فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، بأن يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية. فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد.
وللإمام الشيخ محمد عبده كلام حسن في المعنى، فقد قال- رحمه الله- «قد أباحت الشريعة الإسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة. قال- تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل، وساءت معيشة العائلة إذ العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، والعلماء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله في العدل بينهن. فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات في نوبة الأخرى إلا بإذنها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» .
وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ميله القلبي بقوله: «اللهم هذا- أى العدل في البيات والعطاء- جهدي فيما أملك، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك- يعنى الميل القلبي» . وكان يقرع بينهن إذا أراد سفرا.
ثم قال في نهاية حديثه: فعلى العقلاء أن يتبصروا قبل طلب التعدد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعا من العدل وحفظ الألفة بين الأولاد، وحفظ النساء من الغوائل التي تؤدى بهن إلى الأعمال التي لا تليق بمسلمة.
هذا، وقد ذكر العلماء حكما كثيرة لمشروعية تعدد الزوجات، ومن هذه الحكم أن في هذا التعدد وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد عدد المواليد فيها. ولا شك أن كثيرا من الأمم الإسلامية التي اتسعت أرضها، وتعددت موارد الثروة فيها، في حاجة إلى تكثير عدد أفرادها حتى تنتفع بما حباها الله من خيرات، وتستطيع الدفاع عن نفسها إذا ما طمع فيها الطامعون، واعتدى عليها المعتدون.
ومنها أن التعدد يعين على كفالة النساء وحفظهن وصيانتهن من الوقوع في الفاحشة، لا سيما في أعقاب الحروب التي- عادة- تقضى على الكثيرين من الرجال، ويصبح عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال.
ومنها أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الزنا تحريما قاطعا، وعاقبت مرتكبه بأقسى أنواع
العقوبات وأزجرها، بسبب ما يجر إليه من فساد في الأخلاق والأنساب ونظام الأسر، فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد، مستطيعا لتكاليفه ومطالبه.
ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق، فإن المرأة قد لا تكون قادرة على القيام بالمطالب الزوجية التي تحتمها حياتها مع زوجها بسبب مرضها أو عجزها أو عقمها أو غير ذلك من الأسباب، فيلجأ زوجها إلى الزواج بأخرى غيرها مع بقاء الزوجة الأولى في عصمته بدل أن يطلقها فتفقد حياتها الزوجية، وقد تكون هي في حاجة إلى هذا الزوج الذي يقوم برعايتها وحمايتها والقيام بشأنها.
والخلاصة أن الله- تعالى- قد علم أن مصلحة الرجال والنساء قد تستدعى تعدد الزوجات، - بل قد توجبه في بعض الحالات- فأباح لهم هذا التعدد، وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، وقيد- سبحانه- هذه الإباحة بالعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، فإن علم الإنسان من نفسه عدم القدرة على العدل بينهن لم يبح له التعدد.
ولو أن المسلمين ساروا على حسب ما شرع الله لهم لسعدوا في دنياهم وفي آخرتهم لأن الله- تعالى- ما شرع لهم إلا ما فيه منفعتهم وسعادتهم.
ثم أمر الله تعالى الرجال أن يعطوا النساء مهورهن كاملة عن رضا وسماحة نفس، وألا يطمعوا في شيء مما أعطاه الله لهن فقال- تعالى-:
وقوله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه .
وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن ابن جريج ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة; أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق . وكان يمسكها عليه ، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه : ( وإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى ] ) أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله .
ثم قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله [ تعالى ] ( ويستفتونك في النساء ) قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : ( وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .
وقوله : ( مثنى وثلاث ورباع ) أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين ، [ وإن شاء ثلاثا ] وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى : ( جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) [ فاطر : 1 ] أي : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه ، بخلاف قصر الرجال على أربع ، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء; لأن المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره .
قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .
وهذا الذي قاله الشافعي ، رحمه الله ، مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين ، وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد علقه البخاري ، وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ، ودخل منهن بثلاث عشرة ، واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة ، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع .
ذكر الأحاديث في ذلك :
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا معمر ، عن الزهري . قال ابن جعفر في حديثه : أنبأنا ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا . فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا . وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم ، كما رجم قبر أبي رغال .
وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن اسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة ، وسفيان الثوري ، وعيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ ، عن معمر - بإسناده - مثله إلى قوله : اختر منهن أربعا . وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي ، حيث قال بعد روايته له : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب وغيره ، عن الزهري ، حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ، فذكره . قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .
وهذا التعليل فيه نظر ، والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك ، عن الزهري مرسلا . قال أبو زرعة : وهو أصح .
قال البيهقي : ورواه عقيل ، عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد .
قال أبو حاتم : وهذا وهم ، إنما هو الزهري عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره .
قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة ، عن الزهري ، عن محمد بن أبي سويد .
وهذا كما علله البخاري . وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين ثم قد روي من غير طريق معمر ، بل والزهري قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو علي الحافظ ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ، حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أخبرنا سيف بن عبيد حدثنا سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا . هكذا أخرجه النسائي في سننه . قال أبو علي بن السكن : تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة ، وكذا وثقه ابن معين . قال أبو علي : وكذلك رواه السميدع بن واهب عن سرار .
قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وصفوان بن أمية - يعني حديث غيلان بن سلمة .
فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
حديث آخر في ذلك : روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن حميضة بن الشمردل - وعند ابن ماجه : بنت الشمردل ، وحكى أبو داود أن منهم من يقول : الشمرذل بالذال المعجمة - عن قيس بن الحارث . وعند أبي داود في رواية : الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " اختر منهن أربعا " .
وهذا الإسناد حسن ، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله ، لما للحديث من الشواهد .
حديث آخر في ذلك : قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله ، في مسنده : أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول : أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية الديلي ، رضي الله عنه ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر أربعا أيتهن شئت ، وفارق الأخرى " ، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ، فطلقتها .
فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله .
وقوله : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن ، كما قال تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء : 129 ] فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة ، أو على الجواري السراري ، فإنه لا يجب قسم بينهن ، ولكن يستحب ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج .
وقوله : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال بعضهم : [ أي ] أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي ، رحمهم الله ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا ( فسوف يغنيكم الله من فضله ) [ التوبة : 28 ] وقال الشاعر
فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
وتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة ، إذا افتقر ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر; فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر ، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا . والصحيح قول الجمهور : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي : لا تجوروا . يقال : عال في الحكم : إذا قسط وظلم وجار ، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
وقال هشيم : عن أبي إسحاق قال : كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول . رواه ابن جرير .
وقد روى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه ، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا محمد بن شعيب ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن عبد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال : " لا تجوروا " .
قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح : عن عائشة . موقوف .
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس ، وعائشة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وأبي مالك وأبي رزين والنخعي ، والشعبي ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : أنهم قالوا : لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ، رحمه الله ، ببيت أبي طالب الذي قدمناه ، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة ، وقد رواه ابن جرير ، ثم أنشده جيدا ، واختار ذلك .
القول في تأويل قوله : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا= إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة= فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.
* ذكر من قال ذلك:
8456 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: " وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء "، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجر ولِّيها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سُنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهُنَّ من النساء. (40)
8457 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء "، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة، تكون في حجر ولِّيها تُشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوَّجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتَّهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن= قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال يقول: اتركوهنّ، فقد أحللت لكم أربعًا. (41)
8458 - حدثنا الحسن بن الجنيد وأخبرنا سعيد بن مسلمة قالا. أنبأنا إسماعيل بن أمية، عن ابن شهاب، عن عروة قال: سألت عائشة أم المؤمنين فقلت: يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "؟ قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك: أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيكمِّلوا لهن الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا سواهن من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق. (42)
8459 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال، حدثني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث يونس، عن ابن وهب.
8460 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، مثل حديث ابن حميد، عن ابن المبارك. (43)
8461 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: نـزل= تعني قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، الآية= في اليتيمة تكون عند الرجل، وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها، وهي لا تعجبه، ثم يضربها، ويسيء صحبتها، فوُعظ في ذلك. (44)
* * *
قال أبو جعفر: فعلى هذا التأويل، جواب قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا "، قوله: " فانكحوا " .
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم. (45) وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به. فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها= فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم، &; 7-535 &; فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ= وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم.
ذكر من قال ذلك:
8462 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سماك قال، سمعت عكرمة يقول في هذه الآية: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النِّسوة، ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، قال: فنـزلت هذه الآية: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " .
8463 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والستَّ والعشر، فيقول الرجل: " ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان "؟ فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع.
8464 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربعٍ من أجل أموال اليتامى.
8465 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك.
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم كانوا يتحوّبون في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيها، ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدِلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم أن &; 7-536 &; لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك. وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم.
* ذكر من قال ذلك:
8466 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، كان الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو يُنهوا عنه، قال: فذكروا اليتامى، فنـزلت: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء.
8467 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) إلى: " أيمانكم "، كانوا يشددون في اليتامى، ولا يشددون في النساء، ينكح أحدُهم النسوة، فلا يعدل بينهن، فقال الله تبارك وتعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى، فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
8468 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " حتى بلغ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ، يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، (46) وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة &; 7-537 &; فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعًا، ثم صيَّرهن إلى أربع قوله: (47) " مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة "، يقول، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة. وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
8469 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، يقول: ما أحل لكم من النساء=" مثنى وثلاث ورباع "، فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى: أن لا تقسطوا فيهنَّ.
8470 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: جاء الإسلام والناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء فيتّبعوه، أو ينهوا عن شيء فيجتنبوه، حتى سألوا عن اليتامى، فأنـزل الله تبارك وتعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ".
8471 - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو النعمان عارم قال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، بعث الله تبارك وتعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنـزل الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، قال: فكما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى، فخافوا أن لا تقسطوا وتعدِلوا في النساء.
8472 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى، وكانوا &; 7-538 &; يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية، فقال: " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. (48)
8473 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، كانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتيم شيئا، وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله في اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ إلى إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ووعظهم في شأن النساء فقال: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " الآية، وقال: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [سورة النساء: 22].
8474 - حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " إلى " ما ملكت أيمانكم "، يقول: فإن خفتم الجور في اليتامى وغمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، (49) قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعًا، وصيَّرهم إلى أربع، يقول: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم في اليتامى، فكذلك فتخوفوا في النساء أن تَزْنُوا بهن، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء.
* ذكر من قال ذلك:
8475 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، يقول: إن تحرَّجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانًا وتصديقًا، فكذلك فتحرّجوا من الزّنا، وانكحوا النساء نكاحًا طيبًا=" مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
8476 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم وُلاتهن، فلا تنكحوهن، وانكحوا أنتم ما حل لكم منهن.
* ذكر من قال ذلك:
8477 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "، قال: نـزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، هو وليها، ليس لها ولي غيره، وليس أحد ينازعه فيها، ولا ينكحها لمالها، فيضربها، ويسيء صحبَتها. (50)
8478 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن في هذه الآية: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم " أي: ما حَلّ لكم من يتاماكم من قراباتكم=" مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " .
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية، قول من قال: تأويلها: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجورُوا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة أيضًا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن ".
وإنما قلنا إنّ ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخَلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالى ذكره: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرّجوا فيه، فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء، مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، (51) كما عرّفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى، فقال: انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن وحلّلته، مثنى وثُلاث ورباع، فإن خفتم أيضًا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة، بأن لا تقدروا على إنصافها، فلا تنكحوها، &; 7-541 &; ولكن تسرَّوا من المماليك، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموالكم، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور.
ففي الكلام -إذ كان المعنى ما قلنا- متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم، فلا تتزوجوا منهنّ إلا ما أمنتم معه الجور مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أيضًا في ذلك فواحدة. وإن خفتم في الواحدة، فما ملكت أيمانكم= فترك ذكر قوله: " فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء "، بدلالة ما ظهر من قوله تعالى: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
* * *
فإن قال قائل: فأين جواب قوله: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى "؟
قيل: قوله " فانكحوا ما طاب لكم "، غير أن المعنى الذي يدل على أن المراد بذلك ما قلنا قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ".
* * *
وقد بينا فيما مضى قبلُ أن معنى " الإقساط" في كلام العرب: العدل والإنصاف= وأن " القسط": الجور والحيف، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (52)
* * *
وأما " اليتامى "، فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم في هذا الموضع. (53)
* * *
وأما قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، فإنه يعني: فانكحوا ما حلَّ لكم منهن، دون ما حُرِّم عليكم منهنّ، كما:-
8479 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، ما حلّ لكم.
8480 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير في قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، يقول: ما حلَّ لكم.
* * *
فإن قال قائل: وكيف قيل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، ولم يقل: " فانكحوا مَنْ طاب لكم "؟ وإنما يقال: " ما " في غير الناس.
قيل: معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبتَ إليه، وإنما معناه: فانكحوا نكاحًا طيبًا، كما:-
8481 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، فانكحوا النساء نكاحًا طيبًا.
8481م - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
* * *
فالمعنيّ بقوله: " ما طاب لكم "، الفعل، دون أعيان النساء وأشخاصهنَّ، فلذلك قيل " ما " ولم يقل " من "، كما يقال: " خذ من رقيقي ما أردت "، إذا عنيت: خذ منهم إرادتك. ولو أردت: خذ الذي تريد منهم، لقلت: " خذ من رقيقي من أردت منهم ". (54) وكذلك قوله: " أو ما ملكت أيمانكم "، بمعنى: أو ملك أيمانكم.
* * *
وإنما معنى قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، كما قيل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [سورة النور: 4].
* * *
وأما قوله: " مثنى وثلاث ورباع "، فإنما تُرك إجراؤهن، لأنهن معدولات عن " اثنين " و " ثلاث " و " أربع "، كما عدل " عمر " عن " عامر "، و " زُفرَ" عن " زافِر " فترك إجراؤه، وكذلك،" أحاد " و " ثناء " و " مَوْحد " و " مثنى " و " مَثْلث " و " مَرْبع "، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومما يدلّ على أن ذلك كذلك، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، ما قيل في هذه السورة و " سورة فاطر "، [1]: " مثنى وثلاث ورباع " يراد به " الجناح "، و " الجناح " ذكر= وأنه أيضًا لا يضاف إلى ما يضاف إليه " الثلاثة " و " الثلاث " وأن " الألف واللام " لا تدخله= فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة، ولو كان نكرة لدخله " الألف واللام "، وأضيف كما يضاف " الثلاثة " و " الأربعة ". (55) ومما يبين في ذلك قول تميم بن أبيّ بن مقبل:
تَـرَى النُّعَـرَاتِ الـزُّرْقَ تَحْـتَ لَبَانِهِ
أُحَــادَ وَمَثْنَـى أَصْعَقَتْهَـا صَوَاهِلُـهْ (56)
فرد " أحاد ومثنى "، على " النعرات " وهي معرفة. وقد تجعلها العرب نكرة فتجريها، كما قال الشاعر: (57)
وَإنَّ الغُـــلامَ المُسْــتَهَامَ بذِكْــرِهِ
قَتَلْنَـا بِـهِ مِـنْ بيـن مَثْنًـى وَمَوْحَدِ (58)
بِأَرْبَعَــةٍ مِنْكُــمْ وَآخَــرَ خَـامِسٍ
وَسَـادٍ مَـعَ الإظْـلامِ فِـي رُمْح مَعْبَدِ
ومما يبين أن " ثناء " و " أحاد " غير جاريةٍ، قول الشاعر: (59)
وَلَقَــدْ قَتَلْتُكُــمُ ثُنَــاءَ وَمَوْحَــدًا
وَتَــرَكْتُ مُـرَّةَ مِثْـلَ أَمْسِ المُدْبِـرِ (60)
وقول الشاعر: (61)
مَنَــتْ لَــكَ أنْ تُلاقِيَنــي المَنَايَـا
أُحَــادَ أُحَــادَ فِـي شَـهْرٍ حَـلالِ (62)
ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز " الرُّبَّاع " و " المَرْبع " عن جهته. لم يسمع منها " خماس " ولا " المخْمس "، ولا " السباع " ولا " المسبع "، وكذلك ما فوق " الرباع " إلا في بيت للكميت. (63) فإنه يروي له في" العشرة "،" عشار " وهو قوله:
فَلَــمْ يَسْــتَرِيثُوكَ حَــتَّى رَمَــيْ
تَ فَـوْقَ الرِّجَـالِ خِصَـالا عُشَـارَا (64)
يريد: " عشرًا، عشرًا "، يقال: إنه لم يسمع غير ذلك. (65)
* * *
= وأما قوله: " فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة "، فإن نصب " واحدة "، بمعنى: فإن خفتم أن لا تعدلوا= فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح، (66) فيما أوجبه الله لهن عليكم= فانكحوا واحدة منهن.
ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع، كان جائزًا، بمعنى: فواحدة كافية، أو: فواحدة مجزئة، كما قال جل ثناؤه: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (67) [سورة البقرة: 282].
* * *
وإن قال لنا قائل: قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر، نكاحُ أربع، فكيف قيل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "، وذلك في العدد تسع؟ (68)
قيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم= وإما ثلاث، إن لم تخافوا ذلك= وإما أربع، إن أمنتم ذلك فيهن.
يدل على صحة ذلك قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، لأن المعنى: فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. ثم قال: وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم.
* * *
فإن قال قائل: فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام، وقد قال تعالى ذكره: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، وذلك أمر، فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب؟
قيل: نعم، والدليل على ذلك قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ". فكان معلومًا بذلك أن قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجورَ فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح، فإن المعنيّ به: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فتحرجتم فيهن، فكذلك فتحرّجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجورَ فيه منهن، ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تُخرِج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال جل ثناؤه: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [سورة الكهف: 29]، وكما قال: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [سورة النحل: 55 ، سورة الروم: 34]، فخرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيدُ والزجر والنهي، (69) فكذلك قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، بمعنى النهي: فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء.
* * *
وعلى النحو الذي قلنا في معنى قوله: " أو ما ملكت أيمانكم " قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
8482 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، يقول: فإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
8483 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " أو ما ملكت أيمانكم "، السراري.
8484 - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.
8485 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك، قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا "، قال: في المجامعة والحب.
* * *
القول في تأويل قوله : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (3)
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره (70) وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباعَ فنكحتم واحدة، أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم، فهو " أدنى " يعني: أقرب، (71) =" ألا تعولوا "، يقول: أن لا تجوروا ولا تميلوا.
* * *
يقال منه: " عال الرجل فهو يعول عَوْلا وعيالة "، إذا مال وجار. ومنه: " عَوْل الفرائض "، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص.
وأما من الحاجة، فإنما يقال: " عال الرجل عَيْلة "، وذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر: (72)
وَمَــا يَــدْرِي الفَقِـيرُ مَتَـى غِنَـاهُ
وَمَــا يَــدْرِي الغَنُّـي مَتَـى يَعِيـل (73)
بمعنى: يفتقر.
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
8486 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، قال: العوْل الميل في النساء.
8487 - حدثنا ابن حميد قال، حدثني حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: لا تميلوا.
8488 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، أن لا تميلوا.
8489 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8490 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل &; 7-550 &; قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة: " ألا تعولوا " قال: أن لا تميلوا= ثم قال: أما سمعت إلى قول أبي طالب:
بِمِيزان قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ (74)
8491 - حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد بن زيد، عن الزبير، عن حريث، عن عكرمة في هذه الآية: " ألا تعولوا "، قال: أن لا تميلوا= قال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:
بِمــيزَانِ قِسْــطٍ لا يُخِـسُّ شَـعِيرَةً
وَوَازِنِ صِــدْقٍ وَزْنُـهُ غَـيْرُ عَـائِلِ (75)
* * *
قال أبو جعفر ويروي هذا البيت على غير هذه الرواية:
بِمِــيزَانِ صِــدْقٍ لا يُغـلُّ شَـعِيرَةً
لَـهُ شَـاهِدٌ مِـنْ نَفْسِـهِ غَـيْرُ عَائِلِ (76)
* * *
8492 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " ألا تعولوا "، قال: أن لا تميلوا.
8493 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.
8494 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه عليه فيه: " إنِّي لست بميزان لا أعول ".
8495 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثّام بن علي قال، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك في قوله: " أدنى ألا تعولوا "، قال: لا تميلوا. (77)
8496 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، أدنى أن لا تميلوا.
8497 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " ألا تعولوا "، قال: تميلوا.
8498 - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: أن لا تميلوا.
8499 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: تميلوا.
8500 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " أدنى ألا تعولوا "، يعني: أن لا تميلوا.
8501 - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: ذلك أدنى أن لا تميلوا.
8502 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن أبي مالك في قوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، قال: أن لا تجوروا.
8503 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون، وعارم أبو النعمان قالا حدثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك مثله.
8504 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: " ذلك أدنى ألا تعولوا " قال: تميلوا. (78)
8505 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل من ثنتين= وثلاث وأربع، وجاريتُك أهون نفقة من حُرة=" أن لا تعولوا "، أهون عليك في العيال. (79)
------------------
الهوامش :
(40) الحديث: 8456- روى الطبري هذا الحديث- مطولا ومختصرًا- بسبعة أسانيد: 8456- 8461 ، 8477. وهو ثابت صحيح ، في الصحيحين وغيرهما.
وهذا الإسناد: هو من رواية عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري. وسيأتي: 8460 ، من رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، دون ذكر لفظه ، إحالة على هذه الرواية.
وقد رواه البخاري في صحيحه اثنتي عشرة مرة ، سنشير إليها ، إن شاء الله.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7: 141- 142 ، بأسانيد ، من أوجه متعددة.
(41) الحديث: 8457- وهذا من رواية ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري.
وسيأتي: 8459 ، من رواية الليث بن سعد ، عن يونس ، عن الزهري ، دون ذكر لفظه ، إحالة على هذه الرواية. ورواه البخاري 5: 94- 95 (فتح) ، من طريق الليث ، عن يونس ، عن الزهري.
وقد رواه مسلم 2: 398- 399 ، من طريق ابن وهب ، عن يونس- أطول مما هنا. لكن ليس فيه ما ذكر في آخره هنا ، من كلام ربيعة الذي رواه عنه يونس. وليس هذا من صلب الحديث.
ورواه البخاري 9: 91 (فتح) ، من رواية حسان بن إبراهيم ، عن يونس ، عن الزهري- بنحو مما هنا ، مع اختصار قليل. وليس فيه كلمة ربيعة.
وقوله: "أعلى سنتهن في الصداق"- هذا هو الثابت في صحيح مسلم أيضًا. وفي المخطوطة"سبيلهن" بدل"سنتهن". والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.
(42) الحديث: 8458- الحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البزار البغدادي: ثقة. أخرج عنه ابن خزيمة في صحيحه. وترجمه ابن أبي حاتم 1 / 2 / 4 ، فلم يذكر فيه جرحًا والخطيب 7: 292 ، كلاهما في ترجمة"الحسن". وترجمه الحافظ المزي في التهذيب الكبير باسم"الحسين". وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ، تبعًا لترتيب الكتاب ، ولكنه صرح بأنه"بفتح الحاء والسين" ، يعني"الحسن" ، وهو الصواب. سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان: ضعيف. قال البخاري في الكبير 2 / 1 / 473: "فيه نظر". وذكر أن عنده"مناكير". وقال في الضعفاء ، ص15: "منكر". وقال ابن معين: "ليس بشيء". وقال أبو حاتم: "هو ضعيف الحديث ، منكر الحديث"- ابن أبي حاتم 2 / 1 / 67.
ووقع في المطبوعة هنا: "الحسن بن جنيد وأبو سعيد بن مسلمة" ، وهو خطأ ، كتب"وأبو" بدل"وأنا" اختصار"وأخبرنا".
إسماعيل بن أمية الأموي: مضت ترجمته في: 2615. وضعف هذا الإسناد ، من أجل سعيد بن مسلمة ، لا يمنع صحة الحديث في ذاته من أوجه أخر ، كما مضى ، وكما سيأتي.
(43) الحديثان: 8459 ، 8460- هما تكرار للحديثين: 8457 ، 8456. وقد أشرنا إلى كل منهما في موضعه.
(44) الحديث: 8461- القاسم: هو ابن الحسن. و"الحسين": هو ابن داود الملقب"سنيد". انظر ما مضى في الإسناد: 8398.
حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. مضت ترجمته في: 1691. وترجم له أخي السيد محمود ، في ج6 ص548 ، تعليق: 3.
والحديث -من هذا الوجه- رواه البخاري 8: 179 (فتح). من طريق هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، به ، نحوه. ولكن سياقه يوهم أنها نزلت في شخص معين. فقال الحافظ: "والمعروف عن هشام بن عروة التعميم. وكذلك أخرجه الإسماعيلي ، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج. ولفظه: أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة ، إلخ".
أقول: ورواية حجاج ، هي هذه التي في الطبري أيضًا.
ورواه البخاري أيضًا 8: 199 (فتح) ، من طريق أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، على الصواب.
وكذلك رواه مسلم ، بنحوه 2: 399 ، من طريق أبي أسامة ، عن هشام.
ورواه البخاري أيضًا ، بنحوه 9: 119 ، من طريق عبدة ، وهو ابن سليمان ، عن هشام ابن عروة.
وسيأتي: 8477 ، من رواية وكيع ، عن هشام. ونخرجه هناك ، إن شاء الله.
ونحن ذاكرون هنا باقي طرقه في الصحيحين -عدا رواية وكيع تتمة للفائدة:
فرواه البخاري 5: 94- 95 (فتح) ، ومسلم 2: 399 = كلاهما من طريق صالح ، عن الزهري ، عن عروة.
ورواه البخاري 5: 292 (فتح) ، و 9: 169- 170 و 12: 298 = من طريق شعيب ، عن الزهري.
ورواه أيضًا 9: 117 ، 169- 170= من طريق عقيل ، عن الزهري.
ورواه أيضًا 9: 162 ، من طريق أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، مختصرًا.
وابن كثير ذكر حديث عائشة 2: 342- 343 ، من روايتين من روايات البخاري. ولم يزد في تخريجه شيئا.
والسيوطي ذكره بثلاثة ألفاظ ، مطولا ومختصرًا 2: 118. وزاد نسبته لعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم.
(45) في المطبوعة: "حذرًا على أموال اليتامى" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(46) في المخطوطة: "جميع النساء" ، والصواب ما في المطبوعة.
(47) في المطبوعة: "ثم الذي صيرهن إلى أربع" ، زاد"الذي" ، وما في المخطوطة صواب جيد.
(48) الحديث: 8472- عبد الله بن صالح ، كاتب الليث بن سعد: مضت ترجمته وتوثيقه في: 186.
معاوية بن صالح الحضرمي: سبق توثيقه في: 186. وهو مترجم في التهذيب ، والكبير للبخاري 4 / 1 / 335 ، والصغير ، ص: 193 ، وابن سعد 7 / 2 / 207 ، وابن أبي حاتم 4 / 1 / 382- 383. وتاريخ قضاة قرطبة ، ص: 30- 40 ، وقضاة الأندلس للنباهي ، ص: 43.
علي بن أبي طلحة: قد بينا في: 1833 أنه لم يسمع من ابن عباس. فيكون هذا الإسناد منقطعًا ، ضعيف الإسناد لانقطاعه.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 7: 150 ، من طريق عثمان بن سعيد ، عن عبد الله بن صالح ، بهذا الإسناد.
وأشار إليه الحافظ في الفتح 8: 179- 180؛ في شرح حديث عائشة؛ قال: "تأويل عائشة هذا؛ جاء عن ابن عباس مثله. أخرجه الطبري".
وذكره السيوطي 2: 118 ، ونسبه لابن جرير ، وابن أبي حاتم ، فقط.
(49) في المخطوطة والمطبوعة هنا"في جميع النساء" ، والصواب ما أثبت ، وانظر التعليق السالف ص: 536 ، تعليق: 1.
(50) الحديث: 8477- هذا إسناد ضعيف ، لضعف سفيان بن وكيع ، وقد بينا ضعفه مرارًا ، أولها في: 142 ، 143.
ولكن الحديث في ذاته صحيح ، كما مضى في: 8456- 8461 ، وفي الروايات التي خرجناها من الصحيحين.
ثم هو ثابت صحيح من رواية وكيع ، من غير رواية ابنه سفيان عنه.
فرواه البخاري 9: 160 (فتح) ، بأطول مما هنا= عن يحيى ، عن وكيع ، بهذا الإسناد.
ويحيى -شيخ البخاري في هذا الإسناد- قال الحافظ في الفتح: "هو ابن موسى ، أو ابن جعفر. كما بينته في المقدمة". والذي في مقدمة الفتح ، ص: 236 ، أن ابن السكن نسبه"يحيى بن موسى".
(51) لعل الأجود أن يقول: "وأعلمهم كيف المخلص لهم" ، كالتي تليها.
(52) انظر ما سلف 6: 77 ، 270.
(53) انظر تفسير"اليتامى" فيما سلف قريبًا ص: 524 ، تعليق: 3 ، والمراجع هناك.
(54) انظر معاني القرآن للفراء 1: 253 ، 254.
(55) انظر معاني القرآن للفراء 1: 254 ، 255.
(56) من قصيدة له طويلة نقلتها قديمًا ، ومعاني القرآن للفراء 1: 255 ، 345 والحيوان 7: 233. واللسان (نعر) (فرد) (صعق) (ثنى) ، وغيرها ، وسيأتي في التفسير 7: 184 (بولاق). يصف فرسه ، وبعد البيت.
فَرِيسًــا ومَغْشِــيًّا عَلَيْــه، كأَنَّـه
خُيُوطَــةُ مَــارِيٍّ لَــوَاهُنَّ فَاتِلُـهْ
ويروى البيت: "النعرات الخضر" ، و"أحاد ومثنى" و"فراد ومثنى". والنعرات جمع نعرة (بضم النون وفتح العين والراء): وهو ذباب ضخم ، أزرق العين ، أخضر ، له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر فيؤذيها ، وربما دخل أنف الحمار فيركب رأسه ، فلا يرده شيء.
و"اللبان": الصدر من ذي الحافر: و"أصعقتها": قتلتها. و"صواهله" جمع صاهلة ، وهو مصدر على"فاعلة" ، بمعنى"الصهيل" ، كما يقال ، "رواغي الإبل" ، أي رغاءها. وقوله في البيت الثاني: "فريسًا" ، أي قتيلا ، قد افترسه ودقه وأهلكه ، و"الخيوطة" جمع خيط ، كالفحولة والبعولة ، جمع فحل وبعل."والماري": الثوب الخلق. يصف الذباب المغشى عليه ، كأنه من لينه في تهالكه ، خيوط لواه لاو من ثوب خلق.
(57) لم أعرف قائلهما.
(58) معاني القرآن للفراء 1: 254 ، وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة:
قتلنـا بِـه مِـنْ بيـن مَثْنًـى وموْحَدٍ
بأربعــةٍ مِنْكُــمْ وآخــر خـامِسِ
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القرآن ، والذي قاله الطبري هنا ، هو نص مقالة الفراء في معاني القرآن. وقوله: "وساد" أي: سادس ، يقولون: "جاء سادسًا وساديًا وساتًا".
(59) هو صخر بن عمرو السلمي ، أخو الخنساء.
(60) مجاز القرآن 1: 115 ، والأغاني 13: 139 ، والمخصص 7: 124 ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي: 394 ، والبطليوسي: 466 ، والخزانة 4: 474. وسيأتي في التفسير 22: 76 (بولاق) وغيرها ، إلا أن ابن قتيبة في أدب الكاتب رواه"كأمس الدابر" وتابعه ناشر التفسير في هذا الموضع فكتب"كأمس الدابر" ، ولكنه في المخطوطة ، وفي الموضع الآخر من التفسير ، قد جاء على الصواب. وهما بيتان قالهما في قتله دريد بن حرملة المري ، في خبر مذكور ، وبعده:
وَلقَــدْ دَفَعْــتُ إلـى دُرَيْـدٍ طَعْنَـةً
نَجْـلاءَ تُـزْغُلُ مِثْـلَ عَـطَّ المَنْحَـرِ
والطعنة النجلاء: الواسعة. و"أزغلت" الطعنة بالدم: دفعته زغلة زغلة ، أي دفعة دفعة. وعط الثوب عطًا: شقه. والمنحر: هو نحر البعير ، أي أعلى صدره ، حيث ينحر ، أي: يطعن في نحره ، فيتفجر منه الدم.
وأما رواية"كأمس الدابر" فقد ذكر الجواليقي أبياتًا ليزيد بن عمرو الصعق الكلابي هي:
أَعَقَــرْتُمُ جَــمَلِي برَحْــلِيَ قائمًـا
ورَمَيْتُــمُ جَــارِي بِسَــهْمٍ نَـاقِرِ
فــإِذا ركــبتُمْ فَالْبَسُــوا أَدْرَاعَكُـمْ
إنَ الرِّمَــاحَ بَصِــيرَةٌ بالحَاسِــرِ
إِذْ تَظْلِمُــون وتــأكُلُونَ صَــدِيقَكُمْ
فــالظُّلْمُ تَــارِككُمْ بجَــاثٍ عَـاثِرِ
إِنّــي سَــأقتلكُمُ ثُنَــاءَ ومَوْحَـدًا
وَتَــركتُ نَـاصِرَكُمْ كَـأمْسِ الدَّابِـرِ
(61) هو عمرو ذي الكلب ، أخو بني كاهل ، وكان جارًا لهذيل. ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن لصخر الغي الهذلي ، وهو خطأ.
(62) ديوان الهذليين 3: 117 ، مجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 115 ، والمعاني الكبير: 2840 المخصص 17: 124 ، الأغاني 13: 139. ورواية الديوان"في الشهر الحلال" ، وأخطأ صاحب الأغاني فنسب البيت لصخر بن عمرو ، ورواه"في الشهر الحرام". قوله: "منت لك" ، أي: قدرت لك منيتك أن تلقاني في شهر حلال ، خلوين ، وحدي ووحدك ، فأصرعك لا محالة. وذلك أنه كان قد لقيه قبل ذلك في شهر حرام ، فلم يستطع أن يرفع إليه سلاحًا. ويقول بعده:
وَمَــا لَبْــثُ القِتَــالِ إذَا الْتقَيْنَــا
سِـوَى لَفْـتِ اليَمِيـنِ عَـلَى الشِّـمَالِ
أي: لا يلبث القتال بيني وبينك إلا بمقدار ما ترد يمين إلى شمال.
(63) في المطبوعة: "في بيت الكميت" ، والصواب من المخطوطة.
(64) مجازا القرآن لأبي عبيدة 1: 116 ، والأغاني 3: 139 ، واللسان (عشر) ، والمخصص 17: 125 ، والجواليقي 292 ، 293 ، والبطليوسي: 467 ، والخزانة 1: 82 ، 83 ، من قصيدة للكميت ، يمدح بها أبان بن الوليد بن عبد الملك ، وقبله:
رَجَــوْكَ وَلَــم تتكــامَلْ سِـنُوكَ
عَشْــرًا، ولا نَبْــتَ فِيــكَ اتِّغَـارَا
لأَدْنَـى خَسًـا أَوْ زَكًـا مِـنْ سِـنِيكَ
ألــى أَرْبَــعٍ، فَبَقَــوْكَ انْتظــارَا
وقوله: "ولا نبت فيك اتغارا" أي: لم تخلف سنًا بعد سن ، فتنبت أسنانك: اتغر الصبي: سقطت أسنانه وأخلف غيرها. وقوله: "خسا أو زكا" ، أي فردا ، وزوجًا. قوله: "فبقوك" من قولهم: "بقيت فلانًا بقيًا" انتظرته ورصدته. و"استراثه": استبطأه. يقول: تبينوا فيك السؤود لسنة أو سنتين من مولدك ، فرجوا أن تكون سيدًا مطاعًا رفيع الذكر ، فلم تكد تبلغ العشر حتى جازت خصالك خصال السادة من الرجال. وأما قول أبي جعفر"يريد: عشرًا عشرًا" ، فكأنه يعني كثرة الخصال التي فاق بها الرجال.
(65) انظر هذا الفصل كله في معاني القرآن للفراء 1: 254 ، 255 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 114- 116.
(66) في المطبوعة والمخطوطة: "فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة..." ، وهو لا يستقيم ، صوابه"فيما زاد" كما أثبتها.
(67) انظر معاني القرآن للفراء 1: 255.
(68) انظر الناسخ والمنسوخ ، لأبي جعفر النحاس: 92.
(69) انظر ما سلف 2: 293 ، 294.
(70) في المطبوعة والمخطوطة: "يعني بقوله تعالى ذكره" ، والسياق يقتضي ما أثبت.
(71) انظر تفسير"أدنى" فيما سلف 6: 78.
(72) هو أحيحة بن الجلاح .
(73) جمهرة أشعار العرب: 125 ، ومعاني القرآن للفراء 1: 255 ، الجمهرة لابن دريد 2: 193 ، وتا
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى، بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل.
وقفة
[3] ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ الآية في الفتيات اليتيمات اللاتي يكون الوصي عليها ليس من محارمها، ربما من قرابتها ولكن ليس محرمًا، كابن العم مثلًا، فأشارت الآية أن زواجها بها إذا كان يتضمن ظلمًا لها؛ فالأولى له أن يتزوج من غيرها ما شاء.
وقفة
[3] في الآية: الترغيب في النكاح: ﴿فَانكِحُوا﴾، والبحث عن الأطيب لك من النساء: ﴿مَا طَابَ﴾، وينظر إلى المرأة وتنظر إليه لتطيب نفسيهما: ﴿لَكُم﴾.
وقفة
[3] ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ في الإشارة إلى النظر قبل النكاح، وفيه استحباب نكاح الجميلة؛ لأنه أقرب إلى الإعفاف, واستدل به على عدم نكاح الجنيات.
وقفة
[3] ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ فاختاروا، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». [البخاري 5090].
وقفة
[3] تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها؛ لأن الله يقول: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟!
وقفة
[3] قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8]، وقد بَيَّنَ تعالى في مواضع متعددة الإذن في المباحات كقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون: 51]، و﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ [الأنعام: 141]، ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾، ما فائدة السؤال عما أباحه؟ الجواب: أن المراد: لتسألن عن شكر النعيم، فحذف المضاف للعلم به، لأن الشكر واجب، أو أنهم يسألون عن نعيمهم من أين حصلوه وآثروه على طاعة الله تعالى.
وقفة
[3] ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء، بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بما يجب لهن.
لمسة
[3] ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ ما دلالة استخدام (ما) وليس (من)؟ (من) لذات من يعقل، من هذا؟ هذا فلان، (ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل، مثل: ما هذا؟ هذا حصان، وأيضًا تستعمل لصفات العقلاء، مثل أن تقول: من هذا؟ تقول: خالد، ما هو؟ تقول: تاجر، أو شاعر، فـ (مَا طَابَ لَكُم) صفة عاقل، أي: انكحوا الطيِّب من النساء.
لمسة
[3] ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ مثنى معناها: اثنتين اثنتين، يعني مكرر، وثُلاث في اللغة معناها: ثلاث ثلاث، وليس معناها ثلاثة، ورباع معناها: أربع أربع، ليس معناها أربعة، في اللغة لما تقول لجماعة: (خذوا كتابين) يعني: كلهم يشتركون في كتابين، ولما تقول: (خذوا كتابين كتابين) يعني: كل واحد يأخذ كتابين، فلا يصح: (فانكحوا اثنتين)؛ لأنها تعني أن كلهم يشتركون في اثنتين.
وقفة
[3] ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ الزواج نفسه حتى من واحدة مباح، ولكن إذا أخذت الحكم بإباحة التعدد فخذه من كل جوانبه، ولا تأخذه ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا سينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله.
وقفة
[3] وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» [أبي داود ٢١٣٣، وصححه الألباني].
وقفة
[3] ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وفي هذا: أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد.
وقفة
[3] من غلب على ظنه عدم القدرة على العدل بين الزوجات فلا يُعَدِّد ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
وقفة
[3] ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي تجوروا وتميلوا عن الحق، من عال الميزان عولًا إذا مال، ومنه عال الحاكم إذا جار، ثم استعمل في الميل المعنوي؛ لأن تعدد الزوجات يعرض صاحبه غالبًا للجور.
لمسة
[3] ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ العَوْل هنا بمعنى العدوان، أي لا تعتدوا، ولا تتجاوزوا الحق في عدم المساواة بين النسوة، وليس من الإعالة، عال فلان بمعنى ظلم وليس بمعنى تكفَّل، وهذا مستعمل في بعض اللهجات العامية، عايل أي ظالم أو معتدٍ.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ: ﴾
- الواو: استئنافية. إن: حرف شرط جازم. خفتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطبين في محل جزم فعل الشرط. التاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع.
- ﴿ أَلَّا تُقْسِطُوا: ﴾
- أصلها: «أن» حرف مصدري ونصب. و «لا» نافية لا عمل لها. تقسطوا: الجملة صلة «أن» لا محل لها وهي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
- ﴿ فِي الْيَتامى: ﴾
- جار ومجرور متعلق بتقسطوا. وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة على الألف للتعذر.
- ﴿ فَانْكِحُوا: ﴾
- الفاء: واقعة في جواب الشرط. انكحوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «انكحوا» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. وأن وما تلاها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول بخفتم.
- ﴿ ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ: ﴾
- ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طاب: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله. ضمير مستتر جوازا تقديره هو. لكم: جار ومجرور متعلق بطاب والميم علامة جمع الذكور. من النساء: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «ما» وجملة «طابَ» صلة الموصول لا محل لها.
- ﴿ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ: ﴾
- مثنى أي ثنتين ثنتين لأنه معدول عن عدد مكرر منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر وهو حال من الفعل «طابَ». وثلاث ورباع: اسمان معطوفان بواوي عطف على «مَثْنى» وهما حالان منصوبان بالفتحة الظاهرة وهما أيضا معدولان عن عددين مكررين بتقدير: وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولم ينونا لأنهما ممنوعان من الصرف واعتبرت هذه الاعداد أحوالا لأن التقدير: فانكحوا الطيبات لكم معدودات ويجوز أن تكون هذه الأسماء المعدولة في محل نصب بدلا من «ما».
- ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: ﴾
- معطوفة بالفاء على «إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا» وتعرب إعرابها.
- ﴿ فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ﴾
- الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم الفاء واقعة في جواب الشرط. واحدة: مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره فاختاروا. أو: للتخيير. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف «واحدة». ملكت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة. أيمانكم: فاعل مرفوع بالضمة. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. وجملة «مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب
- ﴿ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا: ﴾
- ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد. والكاف للخطاب. أدنى: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. ألا تعدلوا أي لا تجوروا: تعرب اعراب «أَلَّا تُقْسِطُوا» وأن لا تعولوا «بتأويل» مصدر في محل جر بمن. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
- * سَبَبُ النُّزُولِ: 1 - أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنَّسَائِي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضي الله عنها -وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قالت: هي اليتيمة في حَجْرِ وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء.قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعدُ، فأنزل الله - عَزَّ وَجَلَّ -وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. 2 - أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عَذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيهوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) أحسبه قال: كانت شريكتَه في ذلك العذق وفي ماله. * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب النزول عن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وقد أورده جمهور المفسرين مع غيره من الأسباب التي ذكرت لهذه الآية، وقبل الكلام على حديث عائشة الأول سأنقل كلام الحافظ ابن حجر على حديثها الثاني وفيهأن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها) فقالهكذا قال هشام عن ابن جريج فأوهم أنها نزلت في شخص معين، والمعروف عن هشام ابن عروة التعميم، وكذلك أخرجه الإسماعيلي، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظهأنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة .. ) وكذا هو عند المصنف من طريق ابن شهاب عن عروة، وفيه شيء آخر نبّه عليه الإسماعيلي، وهو قولهفكان لها عذق فكان يمسكها عليه) فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحها، وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره، ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها) اهـ محل الشاهد. ومراد الإسماعيلي بالتنبيه الآخر أن لفظ الحديث يخالف سياق القرآن.وبهذا يتبين أن حديث عائشة - رضي الله عنها - الثاني قد وقع فيه وهم فلا يحتج به على السببية أما الحديث الأول لعائشة - رضي الله عنها - في حكم نكاح اليتامى فهو أحد الأقوال في سبب نزول الآية ولهذا قال الطبرياختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن من واحدة إلى أربع.وقال بعضهم: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حذراً على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشاً كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل فإذا صار معدماً، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك.ومن طريق عكرمة فنزلت هذه الآيةوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).وقال بعضهم: كانوا يشددون في اليتامى ولا يشددون في النساء ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن فنزلت الآيةوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى).لكن هذه الأسباب المذكورة لا تقارب حديث عائشة - رضي الله عنها - من جهة الإسناد والرتبة لأنها مراسيل لعكرمة وسعيد بن جبير والحسن.ولعل هذا هو السبب في اقتصار ابن كثير - رحمه الله - على حديث عائشة - رضي الله عنها - دون سائر المذكورات. وقد قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - بعد أن ساق الأسباب السابقةوأقرب هذه الأقوال وأصحها: قول عائشة - إن شاء الله تعالى - وقد اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف فدل ذلك على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف وأن حكمها أعم من ذلك).فإن قال قائل: عائشة لم تسند هذا إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.فالجواب من ابن عاشوروهو أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف، ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول، وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا سيمًا وقد قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم). * النتيجة: أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - في اليتيمة التي يرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها وليُّها لكنه لا يقسط لها في صداقها ولا يعطيها حقها منه، فأمروا أن يتركوهن ويلتمسوا غيرهن من النساء اللاتي يطالبن بحقوقهن أو يطالب بها أولياؤهن لصحة سنده، وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ الآية واتفاق جمهور المفسرين عليه. وسيأتي مزيد بحث لهذا إن شاء الله تعالى عند نزول قوله تعالىوَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ). والله أعلم.'
- المصدر لباب النقول
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد نهي الأولياء عن أكل أموال اليتامى، وكان بعضهم يتزوج اليتيمة التي تحت ولايته، ولا يعطيها مهرها، أو لا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، أو يتزوجها من أجل الحصول على مالها؛ لذا وعظهم اللهُ عز وجل هنا: إن خفتم ألا تعدلوا مع الزوجة اليتيمة؛ فعليكم ألا تتزوجوا بها، فإن الله أباح لكم الزواج بغيرهن، واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، قال تعالى:
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾
القراءات :
طاب:
وقرئ:
بالإمالة، وهى قراءة ابن أبى إسحاق، والجحدري، والأعمش.
وفى مصحف أبى، «طيب» بالياء، وهو دليل الإمالة.
ورباع:
وقرئ:
وربع، ساقطة الألف، وهى قراءة النخعي، وابن وثاب.
فواحدة:
وقرئ:
بالرفع، وهى قراءة الحسن، والجحدري، وأبى جعفر، وابن هرمز.
أو ما ملكت:
وقرئ:
أو من ملكت، وهى قراءة ابن أبى عبلة.
ألا تعولوا:
وقرئ:
ألا تعيلوا، بفتح التاء، وهى قراءة طلحة أي: لا تفتقروا، من «العيلة» .
مدارسة الآية : [4] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن .. ﴾
التفسير :
ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونـهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرًا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء{ صَدُقَاتِهِنَّ} أي:مهورهن{ نِحْلَةً} أي:عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه:أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنـها تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك.{ فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ} أي:من الصداق{ نَفْسًا} بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه.{ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} أي:لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به. وفي قوله:{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال تعالى:{ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وقال:{ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}
وقوله صَدُقاتِهِنَّ جمع صدقة- بضم الدال- وهي ما يعطى للزوجة من المهر.
وقوله نِحْلَةً أى عطية واجبة وفريضة لازمة. إذ النحلة في الأصل: العطية على سبيل التبرع. يقال: نحله كذا ونحلا، إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا مقابلة عوض.
والمعنى: وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس منكم، لأن هذه المهور قد فرضها الله لهن، فلا يجوز أن يطمع فيها طامع، أو يغتالها مغتال، والخطاب للأزواج. قالوا: لأن الرجل كان يتزوج المرأة بلا مهر ويقول لها: أرثك وترثيننى؟ فتقول: نعم. فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء المهور .
وقيل: الخطاب لأولياء النساء، وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت لا تعطى النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئا لك النافجة. أى هنيئا لك هذه البنت التي تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أى تزيده وتكثره.
وقد رجح ابن جرير كون الخطاب للأزواج فقال: «وذلك لأن الله- تعالى- ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين للنساء، ونهاهم عن ظلمهن. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم. فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذين قيل لهم: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ هم الذين قيل لهم: وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتهن نحلة، لأنه قال في الأول: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ.. ولم يقل «فأنكحوا» حتى يكون قوله: وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ مصروفا إلى أنه معنى به أولياء النساء دون أزواجهن. وهذا أمر من الله لأزواج النساء المسمى لهن الصداق أن يؤتوهن صدقاتهن» والذي نراه أن الخطاب في الآية الكريمة يتناول كل من له علاقة بالنساء من الأزواج أو الأولياء وغيرهم من الحكام الذين إليهم المرجع في رد الحقوق إلى ذويها، والضرب على أيدى المعتدين والطامعين في حقوق النساء، وذلك لأن الخطاب من أول السورة موجه إلى الأولياء والأزواج فناسب أن يكون الخطاب هنا شاملا لكليهما فإن أعطوهن عن رضا كان حسنا وإلا أجبرهم الحكام على ذلك.
وقوله نِحْلَةً منصوب على الحالية من قوله صَدُقاتِهِنَّ أى: منحولة معطاة عن طيب نفس. أو منصوب على الحالية من المخاطبين. أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء.
وفي التعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة الأداء. لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر دون أن يكون لهذه النحلة مقابل.
وقوله- تعالى- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً بيان للحكم فيما إذا تنازل النساء عن شيء مما أعطوا عن طيب خاطر منهن أى عليكم أيها الرجال أن تدفعوا للنساء مهورهن مناولة أو التزاما، فإن حدث وتنازل لكم النساء عن شيء من هذه المهور بسماحة ورضا نفس، فكلوه أكلا سائغا، حميد المغبة، حلال الطعمة، خاليا من شائبة الحرام والشبهات:
والضمير المجرور في قوله مِنْهُ يعود إلى الصدقات أى المهور.
وجيء به مفردا مذكرا، لجريانه مجرى اسم الإشارة كأنه قيل: فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من ذلك المذكور وهو الصدقات فكلوه.
قال صاحب الكشاف: وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل: فإن طبن ولم يقل فإن وهبن أو سمحن، إعلاما بأن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب عن طيب خاطر.
والمعنى: فإن وهبن لكم شيئا من الصداق، وتجافت عنه نفوسهن طيبات لا لحياء عرض لهن منكم أو من غيركم، ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم، وسوء معاشرتكم فكلوه هنيئا مريئا» .
وقوله نَفْساً منصوب على التمييز من الضمير وهو نون النسوة في قوله طِبْنَ.. وهو محول عن الفاعل والأصل فان طابت أنفسهن عن شيء منه فكلوه.
وجيء به مفردا لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه كقولك: عندي عشرون درهما.
والمراد بالأكل في قوله فَكُلُوهُ مطلق التصرف والانتفاع.
وإنما خص الأكل بالذكر، لأنه معظم وجوه التصرفات المالية.
وقوله هَنِيئاً مَرِيئاً حالان من الضمير المنصوب في قوله فَكُلُوهُ أو منصوبان على أنهما نعت لمصدر محذوف. أى فكلوه أكلا هنيئا مريئا. وهما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ. يقال:
هنؤ الطعام وهنيء هناءة. إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. وقيل الهنيء ما أناك بلا مشقة ولا تبعة.
ويقال مرأ الطعام- بتثليث الراء- مراءة فهو مريء، إذا كان حميد المغبة والمراد المبالغة في تحليل ما يأتيهم من نسائهم عن طيب خاطر منهن، فقد كانوا يتأثمون من أخذ شيء من مهور نسائهم، فقال الله- تعالى- لهم: إن طابت نفوسهن بالتنازل عن شيء من مهورهن لكم فكلوه هنيئا مريئا، لأنه حلال خالص من الشوائب.
هذا، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة: أنه لا بد في النكاح من صداق يعطى للمرأة سواء أسمى ذلك في العقد أم لم يسم. قال القرطبي: وهو مجمع عليه ولا خلاف عليه ومنها: أن هذا الصداق ملك لها، ومن حقها أن تتصرف فيه بما شاءت. ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أولا. ولذا قال بعض الفقهاء. لها أن تبيع مهرها قبل أن تقبضه لأنه ملك بلا عوض وقال آخرون: ليس لها أن تبيعه حتى تقبضه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.
ومنها: أنه يجوز للمرأة أن تعطى زوجها- برضاها واختيارها- مهرها أو جزءا منه سواء أكان مقبوضا معينا أم كان في الذمة. فشمل ذلك الهبة والإبراء. وأنه ليس من حقها الرجوع فيما أعطت لأنها قد طابت نفسها بذلك. وهذا رأى جمهور العلماء. ويرى بعض العلماء أن من حقها الرجوع فيما أعطت.
قال الفخر الرازي: قال بعض العلماء: إن وهبت ثم طلبت بعد الهبة علم أنها لم تطب عنه نفسا. وعن الشعبي: أن امرأة جاءت مع زوجها إلى شريح القاضي في عطية أعطتها إياه.
وهي تطلب الرجوع. فقال شريح: رد عليها عطيتها. فقال الرجل: أليس قد قال الله- تعالى-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ؟ فقال شريح: لو طابت نفسها لما رجعت فيه.
وعن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه كتب إلى قضاته. أن النساء يعطين رغبة ورهبة. فأيما امرأة اعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها» .
ثم نهى- سبحانه- عن إيتاء الأموال للسفهاء، لدفع توهم إيجاب أن يؤتى كل مال لمالكه ولو كان سفيها فقال تعالى:
وقوله : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : النحلة : المهر .
وقال محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : نحلة : فريضة . وقال مقاتل وقتادة وابن جريج : نحلة : أي فريضة . زاد ابن جريج : مسماه . وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب ، يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق .
ومضمون كلامهم : أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك ، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها ، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك ، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا; ولهذا قال [ تعالى ] ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة ، عن علي قال : إذا اشتكى أحدكم شيئا ، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك ، فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا .
وقال هشيم ، عن سيار ، عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ، ونزل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن عمير الخثعمي ، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قالوا : يا رسول الله ، فما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .
وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنكحوا الأيامى " ثلاثا ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .
ابن البيلماني ضعيف ، ثم فيه انقطاع أيضا .
القول في تأويل قوله : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، (80) وفريضة لازمة.
* * *
يقال منه: " نَحَل فلان فلانًا كذا فهو يَنْحَله نِحْلة ونُحْلا "، (81) كما:-
8506 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا &; 7-553 &; سعيد، عن قتادة قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، يقول: فريضة.
8507 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، أخبرني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، يعني بـ" النحلة "، المهر.
8508 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، قال: فريضة مسماة.
8509 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد يقول في قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، قال: " النحلة " في كلام العرب، الواجب= يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ،إلا بصداقٍ واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.
* * *
وقال آخرون: بل عنى بقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صَدقاتهن.
* ذكر من قال ذلك :
8510 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن سيار، عن أبي صالح قال، كان الرجل إذا زوج أيِّمه أخذ صداقها دونها، (82) فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونـزلت: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " .
* * *
وقال آخرون: بل كان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطى الرجل أخته لرجل، على أن يعطيه الآخر أخته، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك. (83)
* ذكر من قال ذلك:
8511 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثير مهر، فقال الله تبارك وتعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
* * *
قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك، التأويل الذي قلناه. وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساءَ، ونهاهم عن ظلمهنّ والجور عليهن، وعرّفهم سبيلَ النجاة من ظلمهنّ. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صُرِف عنهم إلى غيرهم. فإذْ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل لهم: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، هم الذين قيل لهم: " وآتوا النساء صدقاتهن "= وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتهن نحلة، لأنه قال في أوّل [الآية]: (84) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، ولم يقل: " فأنكحوا "، فيكون قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن "، مصروفًا إلى أنه معنيّ به أولياء النساء دون أزواجهن.
وهذا أمرٌ من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمَّى لهن الصداق، أن يؤتوهن صدُقاتهن، دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسمّ لها في عقد النكاح صداق.
* * *
القول في تأويل قوله : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن وهب لكم، أيها الرجال، نساؤكم شيئًا من صدقاتهن، طيبة بذلك أنفسهن، فكلوه هنيئًا مريئًا، كما:-
8512 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا عمارة، عن عكرمة: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "، قال: المهر.
8513 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثني حَرَميّ بن عمارة قال، حدثنا شعبة، عن عمارة، عن عكرمة، [عن عمارة] في قوله الله تبارك وتعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "، قال: الصدقات. (85)
8514 - حدثني المثنى قال، حدثني الحماني قال، حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " قال: الأزواج.
8515 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن عبيدة قال، قال لي إبراهيم: أكلتَ من الهنيء المريء! قلت: ما ذاك؟ قال: امرأتك أعطتك من صَداقها.
8516 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: دخل رجل على علقمة وهو يأكل من طعام بين يديه، من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غيره، فقال له علقمة: ادْنُ فكل من الهنيء المريء!
8517 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا "، يقول: إذا كان غيرَ إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مريء، كما قال الله جل ثناؤه.
8518 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "، قال: الصداق،" فكلوه هنيئًا مريئًا ".
8519 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد يقول في قوله: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " بعد أن توجبوه لهنّ وتُحُّلوه، =" فكلوه هنيئًا مريئًا ". (86) .
8520 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يتأثمون أن يُراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، (87) فقال الله تبارك وتعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ".
8521 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا "، يقول: ما طابت به نفسًا في غير كَرْه أو هوان، (88) فقد أحلّ الله لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا.
* * *
وقال آخرون: بل عنى بهذا القول أولياء النساء، فقيل لهم: إن طابت أنفس النساء اللواتي إليكم عصمة نكاحهن، بصدقاتهن نفسًا، فكلوه هنيئًا مريئًا.
* ذكر من قال ذلك:
8522 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا سيار، عن أبي صالح في قوله: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "، قال: كان الرجل إذا زوّج ابنته، عمد إلى صداقها فأخذه، قال: فنـزلت هذه الآية في الأولياء: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ".
* * *
قال أبو جعفر وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، التأويلُ الذي قلنا= وأن الآية مخاطب بها الأزواج. لأن افتتاح الآية مبتدأ بذكرهم، وقوله: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " في سياقه.
* * *
وإن قال قائل: فكيف قيل: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "، وقد علمت أنّ معنى الكلام: فإن طابت لكم أنفسهن بشيء؟ وكيف وُحِّدت " النفس "، والمعنى للجميع؟ وذلك أنه تعالى ذكره قال: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .
قيل: أما نقل فعل النفوس إلى أصحاب النفوس، فإن ذلك المستفيض في كلام العرب. من كلامها المعروف: " ضِقت بهذا الأمر ذراعًا وذرعًا "=" وقررت بهذا الأمر عينًا "، والمعنى! ضاق به ذرعي، وقرّت به عيني، كما قال الشاعر: (89)
إِذَا التَيَّــازُ ذُو العَضَــلاتِ قُلْنَــا:
إلَيْـكَ إلَيْـكَ ! ضَـاقَ بِهـا ذِرَاعَـا (90)
فنقل صفة " الذراع " إلى " رب الذراع "، ثم أخرج " الذراع " مفسِّرة لموقع الفعل.
وكذلك وحد " النفس " في قوله: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " إذ كانت " النفس " مفسِّرة لموقع الخبر. (91)
* * *
وأما توحيد " النفس " من النفوس، لأنه إنما أراد " الهوى "، و " الهوى " يكون جماعة، كما قال الشاعر: (92)
بهَـا جِـيَفُ الحَسْـرَى، فَأَمَّـا عِظَامُهَا
فَبِيــضٌ، وأمّــا جِلْدُهَـا فَصَلِيـب (93)
وكما قال الآخر: (94)
فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وَقَدْ شَجِينَا (95)
وقال بعض نحويي الكوفة: جائز في" النفس " في هذا الموضع الجمع والتوحيد،" فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " و " أنفسًا "، و " ضقت به ذراعًا " و " ذَرْعًا " و " أذْرُعًا "، لأنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه، فاكتفى بالواحد عن الجمع لذلك، ولم يذهب الوهم إلى أنه ليس بمعنى جمع، لأن قبله جمعًا.
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، أن " النفس " وقع موقع الأسماء التي تأتي بلفظ الواحد، مؤدِّيةً معناه إذا ذكر بلفظ الواحد، وأنه بمعنى الجمع عن الجميع.
* * *
وأما قوله: " هنيئًا "، فإنه مأخوذ من: " هنأت البعير بالقَطِران "، إذا جَرِب فعُولج به، كما قال الشاعر: (96)
مُتَبَــــذِّلا تَبْـــدُو مَحَاسِـــنُهُ
يَضَــعُ الهِنَــاء مَــوَاضِعَ النُّقْـبِ (97)
فكأنّ معنى قوله: " فكلوه هنيئًا مريئًا "، فكلوه دواء شافيًا.
* * *
يقال منه: " هنأني الطعام ومرَأني"، أي صار لي دواء وعلاجًا شافيًا،" وهنِئني ومرِئني" بالكسر، وهي قليلة. والذين يقولون هذا القول، يقولون: " يهنَأني ويمرَأني"، والذين يقولون: " هَنَأني" يقولون: " يَهْنِيني وَيمْريني". فإذا أفردوا قالوا: " قد أمرأني هذا الطعام إمراء ". ويقال: " هَنَأت القوم " إذا عُلتهم، سمع من العرب من يقول: " إنما سميت هانئًا لتهنأ "، بمعنى: لتعول وتكفي.
-------------------------
الهوامش :
(80) في المخطوطة: "عليه واجبة" ، ووضع على"عليه" حرف"ط" ، دلالة على الخطأ. والصواب ما كان في المطبوعة.
(81) "نحلة" (بكسر النون وسكون الحاء) مصدر مثل"حكمة". و"نحلا" (بضم النون وسكون الحاء) مصدر أيضًا مثل"حكم" (بضم الحاء).
(82) في المطبوعة: "إذا زوج أيمة" بالتاء في آخره ، وهو خطأ. يقال ، "امرأة أيم ، ورجل أيم: ". وهي من النساء التي لا زوج لها ، بكرًا كانت أو ثيبًا= ومن الرجال ، الذي لا امرأة له.
(83) وذلك هو"الشغار" شغار المتناكحين بغير مهر ، إلا بضع وليته أو أيمه. وكان ذلك من نكاح الجاهلية ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
(84) في المخطوطة ، أسقط ذكر"الآية" التي وضعتها بين القوسين ، وفي المطبوعة جعلها"في الأول" ، والسياق يقتضي الزيادة كما أثبتها.
(85) الأثر: 8513-"حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي". أبو روح ، روى عن شعبة. قال أحمد: "صدوق ، كانت فيه غفلة" ، مترجم في التهذيب. و"عمارة" الراوي عن عكرمة ، هو أبو"حرمي بن عمارة" هذا ، وهو"عمارة بن أبي حفصة العتكي". ثقة. مترجم في التهذيب.
أما قوله"عكرمة ، عن عمارة" فلم أعرف فيمن روى عنه عكرمة من يسمى"عمارة" وظني أنه خطأ من الناسخ ، إما أن يكون كرر"عمارة" ، أو يكون صوابه"عن ابن عباس" ، فسها وكتب"عن عمارة". ولذلك وضعتها بين قوسين.
(86) في المطبوعة: "سمعت ابن زيد يقول في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا" ، وهو كلام غير تام ، لم يذكر إلا نص الآية ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإن كان سقط من الناسخ"فكلوه" ، فأثبتها.
(87) في المطبوعة: "أن يرجع أحدهم" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(88) في المخطوطة: "في غير ذكره أو هوان" ، والصواب ما في المطبوعة.
(89) هو القطامي.
(90) ديوانه: 44 ، معاني القرآن للفراء 1: 256 ، واللسان (تيز) ، ثم ج 20: 319 ، وقد استشهدت به فيما سلف 1: 446 ، تعليق: 6 ، فانظره ، من قصيدته التي مجد فيها زفر بن الحارث ، وهذا البيت في صفة ناقته التي أحسن القيام عليها حتى اشتدت وسمنت وامتلأت نشاطًا ، وقبله:
فَلَمَّــا أن جَــرَى سِــمَنٌ عَلَيْهَـا
كمــا بَطَّنْــتَ بــالفَدَن السَّـيَاعَا
أَمَــرْتُ بِهَــا الرِّجَـالَ ليأخُذُوهَـا
وَنَحْــنُ نَظُــنُّ أَنْ لَـنْ تُسْـتَطَاعَا
"السياع" الطين ، و"الفدن" القصر. وقلب الكلام ، وأصله: كما بطنت الفدن بالسياع ، فصار أملس. يصف سمنها حتى امتلأت واشتدت كأنها قصر مشيد. و"التياز": الكثير اللحم الغليظ الشديد. وقوله: "إليك ، إليك" ، أي خذها. يقول له: خذها واضبطها ، ولكنه لم يقو عليها ، وضاق بها ذراعًا. وقد رد ابن بري تفسير"إليك إليك" بمعنى: خذها لتركبها وتروضها ، وقال ، "هذا فيه إشكال ، لأن سيبويه وجميع البصريين ذهبوا إلى أن"إليك" بمعنى: تنح ، وأنها غير متعدية إلى مفعول ، وعلى ما فسروه في البيت ، يقتضي أنها متعدية ، لأنهم جعلوها بمعنى: خذها. ورواه أبو عمرو الشيباني: "لديك لديك" ، عوضًا من"إليك إليك". قال: وهذا أشبه بكلام العرب وقول النحويين ، لأن"لديك" بمعنى"عندك" و"عندك" في الإغراء تكون متعدية".
وعندي أن شرح الشراح في"إليك" صواب جيد ، وقد استدرك ابن بري اجتهاده ، ولم يصب فيما استدرك.
(91) "التفسير ، والمفسر": التمييز والمميز ، اصلاح الكوفيين ، انظر ما سلف في فهرس المصطلحات. وانظر مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 256.
(92) هو علقمة بن عبدة (علقمة الفحل).
(93) ديوانه: 27 ، وشرح المفضليات: 777 ، وسيبويه 1: 107 وسيأتي في التفسير 17: 10 (بولاق) ، من قصيدته في الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني ، حين أسر أخاه شأسًا ، فرحل إليه علقمة يطلب فكه. وقوله: "بها جيف الحسري" ، الضمير عائد إلى"العلوب" في البيت السابق ، وهي آثار الطريق في متان الأرض ، و"الحسري" المعيية ، يتركها أصحابها فتموت ، و"الصليب": الودك الذي يسيل من جلودها إذا مضى على موتها زمن ، وهي تحت الشمس ووقدتها. يقول: ماتت وتقادم بها العهد ، فابيضت عظامها ، وتفانى جلدها فلم يبق منه على أرض الطريق سوى آثار الودك الذي سال من جلودها. والسياق: وأما جلدها ، فلا جلد ، إنما هو الصليب وحده.
والشاهد في البيت"جلدها" وقد أراد"جلودها".
(94) هو المسيب بن زيد مناة الغنوي.
(95) سيبويه 1: 107 ، وشرح المفضليات: 778 ، واللسان (شجا) ، وقبله:
لا تُنْكِــرُوا القَتْــل وَقَــدْ سُـبِينَا
يذكر قومًا سبوا من قومه ، فجاء قومه فقتلوا منهم ، فقال لهم: لا تنكروا قتلنا لكم ، وقد وقع علينا السباء؛ فإن نكن قتلنا منكم حتى صار القتل في حلوقكم كالعظم اعترض في مجراها ، ففي حلوقنا نحن أيضًا شجا قد اعترض ، هو سباؤكم من سبيتم منا. يقول: هذه بهذه.
والشاهد قوله: "في حلقكم" ، وقد أراد"حلوقكم".
(96) هو دريد بن الصمة.
(97) الشعر والشعراء 302 ، والأغاني 10: 22 ، واللسان (نقب) ، وغيرها ، من أبياته التي قالها حين مر بالخنساء بنت عمرو بن الشريد ، وهي تهنأ بعيرًا لها ، وقد تبذلت حتى فرغت منه ، ثم نضت عنها ثيابها فاغتسلت ، ودريد يراها وهي لا تشعر به ، فأعجبته ، فانصرف إلى رحله يقول:
حَــيُّوا تُمَـاضِرَ وَارْبعُــوا صَحْـبى
وَقِفُــوا، فَــإِنَّ وُقُــوفَكُمْ حَسْـبى
أَخُنَــاسَ، قَــدْ هَـامَ الفُـؤَادُ بكُـمْ
وأصابَـــهُ تَبْــلٌ مِــنَ الحُــبِّ
مَــا إِنْ رَأَيْــتُ وَلا سَــمِعْتُ بِـه
كــاليَوْمَ طَــالِيَ أَيْنــقٍ جُــرْبِ
مُتَبَــــــذِّلا ... ... ... ... ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مُتَحَسِّــرًا نَضَــحَ الهِنَــاءُ بِــه
نَضْــحَ العَبِــيرِ برَيْطَـةِ العَصْـبِ
فَسَـــلِيهِمُ عَنِّـــي خُنَــاسَ، إِذَا
عَـضَّ الجَـمِيعَ الخَـطْبُ: مَا خَطْبي?
ثم خطبها إلى أبيها فردته ، فهجاها ، وزعم أنها ردته لأنه شيخ كبير ، فقيل للخنساء: ألا تجيبينه؟ فقالت: لا أجمع عليه أن أرده وأهجوه. و"النقب": (بضم النون وسكون القاف) و"النقب" (بضم ففتح) جمع نقبة: أول الجرب حين يبدو.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[4] في الآية مشروعية المهر، ووجوبه، وأنه لا يخلو نكاح عنه.
وقفة
[4] ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ الصدقة هو مهر المرأة، والمهر فرض وحق للزوجة، وفي التعبير عن إيتاء المهور بالنِحْلة مع كون المهور واجبة، لإفادة أن إيتاء المهر عن طيب الخاطر.
وقفة
[4] ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ المهر علامة فارقة بين النكاح والسفاح، والمهر حق المرأة لا حق الولي، كان الزوج في الجاهلية يعطي مالًا لولي المرأة ويسمونه حلوانًا، ولا تأخذ المرأة منه شيئًا، فأبطل الإسلام ذلك بأن جعل المهر حقًّا للمرأة بموجب هذه الآية.
لمسة
[4] ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وسمى المهر نحلة؛ لأنه أقرب إلى الهدية منه إلى العوض، فما يترتب على الزواج من حقوق وعلاقات أكبر من أي عوض مادي.
لمسة
[4] ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ عطف إيتاء النساء مهورهنَّ على الأمر بإعطاء اليتامى حقهم، فالمرأة واليتيم مستضعفان من المجتمع وحقهما مغبون، فكان في تعاقبهما حراسة لحقهما أشد حراسة.
وقفة
[4] جاءت عقود كثيرة في سورة النساء منها: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [33]، ﴿وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [36]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [43]، ثم قال جلَّ شأنه في مستهل سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]؛ تناسب بديع.
وقفة
[4] ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ لو تدبر هذه الآية أولئك الذين يأخذون أموال الضعفة ممن تحت أيديهم، وبدون طيبة أنفس منهم -وإن أذنوا ظاهرًا- ؛ لعلموا أنهم ربما أكلوه غصة فأعقبهم وبالًا.
لمسة
[4] ﴿نِحْلَةً﴾ النِحلة هي العطيَّة بلا قصد العِوَض، وقد سمى ربنا تعالى الصدقات نِحلة؛ ليكون المهر الذي تدفعه أقرب إلى الهدية، فليست الصدقات عوضًا عن منافع المرأة، فعقد النكاح غايته إيجاد آصرة محبة وتبادل الحقوق والتعاون على إنشاء جيل، وهذا أغلى من أن يكون له عِوَض مالي.
وقفة
[4] ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ فيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج، وقبوله ذلك، فهو شامل للبكر والثيب.
وقفة
[4] ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ نشعر بجمال الأشياء وبركتها وحلاوتها حين يبذلها الآخرون لنا طواعية، حتى الكلمة والبسمة والفعل.
وقفة
[4] ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ کتب عمر بن الخطاب إلى قضاته: «إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته، ثم أرادت أن ترجع فذلك لها».
لمسة
[4] قال ربنا: ﴿طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ ولم يقل: (فإن طابت نفوسهن عن شيء لكم) فأخَّر النفس عن شيء ونصبها على التمييز؛ ليبين لنا مقدار قوة هذا الطيب، ويؤكد أنه طيب نفس لا يشوبه شيء من الضغط والإكراه.
لمسة
[4] قال ربنا: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ ولم يقل: (فخذوه)؛ ذلك ليطمئن المؤمن بجواز الانتفاع بمال زوجته انتفاعًا لا رجوع فيه مادام عن طيب نفس منها لا إرغام فيه.
الإعراب :
- ﴿ وَآتُوا النِّساءَ: ﴾
- الواو: عاطفة. آتوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. النساء: مفعول به أول منصوب بالفتحة.
- ﴿ صَدُقاتِهِنَّ: ﴾
- مفعول به ثان منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. و «هن» ضمير الغائبات مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ نِحْلَةً: ﴾
- مفعول مطلق منصوب على المصدر بتقدير: انحلوا نحلة. ويجوز أن تكون حالا من واو الجماعة أي آتوهن صدقاتهن ناحلين. ومعنى «نِحْلَةً» عطية
- ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ: ﴾
- الفاء: استئنافية. إن: حرف شرط جازم. طبن: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الغائبات ونون النسوة مبني على الفتح في محل رفع فاعل والفعل «طِبْنَ» في محل جزم فعل الشرط لكم عن شيء: جاران مجروران متعلقان بطبن والميم علامة جمع الذكور
- ﴿ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة لشيء. نفسا: تمييز منصوب بالفتحة. فكلوه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. كلوه: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وجملة «فَكُلُوهُ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.
- ﴿ هَنِيئاً مَرِيئاً: ﴾
- صفتان للمصدر «المفعول المطلق» المحذوف أي أكلا هنيئا مريئا ويجوز أن يكونا حالين من الضمير أي فكلوه وهو هنيء مريء أي لا تنغيص فيه. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد الحديث عن أول الضعفاء في السورة -أي اليتامى-؛ يأتي هنا الحديث عن ثاني الضعفاء: النساء، فأمر اللهُ عز وجل الرجال أن يعطوا النساء مهورهن كاملة عن رضا وسماحة نفس، قال تعالى:
﴿ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾
القراءات :
صدقاتهن:
قرئ:
1- بالفتح والضم، جمع صدقة، على وزن «سمرة» ، وهى قراءة الجمهور.
2- بضم الصاد وإسكان الدال، وهى قراءة قتادة.
3- بضمهما، وهى قراءة مجاهد، وموسى بن الزبير، وابن أبى عبلة، وفياض بن غزوان.
4- صدقتهن، بضمهما والإفراد، وهى قراءة النخعي وابن وثاب.
هنيئا مريئا:
وقرئا:
هنيا مريا، دون همز، وهى قراءة الحسن، والزهري.
مدارسة الآية : [5] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي .. ﴾
التفسير :
وقوله تعالى:{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا} السفهاء:جمع "سفيه"وهو:من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه، ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم، ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا، بأن يعدوهم -إذا طلبوها- أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم، ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرًا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء، إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم، إذا كان لهم مال، لقوله:{ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين.
والسفهاء جمع سفيه. والسفه- كما يقول الراغب-: خفة في البدن، ومنه قيل: زمام سفيه أى كثير الاضطراب، وثوب سفيه رديء النسج، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل، ويكون في الأمور الدنيوية والأخروية، قال- تعالى- في السفه الدنيوي: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ وقال في السفه الأخروى وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً والمراد من السفهاء هنا: ضعاف العقول والأفكار الذين لا يحسنون التصرف.
والمراد من قوله قِياماً ما به القيام والتعيش. يقال فلان قيام أهله: أى يقيم شأنهم ويصلهم. وهو المفعول الثاني لجعل. أما المفعول الأول لجعل فمحذوف ويرجع إلى ضمير الأموال.
وقرأ نافع وابن عامر الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً على أنه مصدر مثل الحول والعوض.
وقرأ ابن عمر قَواماً- بكسر القاف وبواو وألف- قال الآلوسى: وفيه وجهان:
الأول: أنه مصدر قاومت قواما مثل لاوذت لواذا فصحت الواو في المصدر كما صحت في الفعل.
والثاني: أنه اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر» .
هذا، وقد اختلف المفسرون في تعيين المخاطبين بقوله- تعالى- وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ كما اختلفوا في المراد من السفهاء على أقوال أشهرها:
أن المخاطبين بهذه الآية هم أولياء اليتامى، وأن المراد من السفهاء هم اليتامى الذين لم يحسنوا التصرف في أموالهم لصغرهم أو لضعف عقولهم، واضطراب أفكارهم. وأن المراد بالأموال في قوله أَمْوالَكُمُ هي أموال هؤلاء اليتامى لا أموال الأولياء.
فيكون المقصود من الآية الكريمة نهى الأولياء عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم التي جعلها الله مناط تعيشهم، خشية إساءة التصرف فيها لخفة أحلامهم.
وإنما أضيفت الأموال في الآية الكريمة إلى ضمير المخاطبين وهم الأولياء، مع أن هذه الأموال في الحقيقة لليتامى:
للتنبيه إلى أن أموال اليتامى كأنها عين أموالهم، مبالغة في حملهم على وجوب حفظها وصيانتها من أى إتلاف أو إضرار بها.
قال الفخر الرازي ما ملخصه: والدليل على أن الخطاب في الآية الكريمة للأولياء قوله- تعالى- بعد ذلك وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وأيضا فعلى هذا القول يحسن تعليق هذه الآية بما قبلها فكأنه- تعالى- يقول: إنى وإن كنت أمرتكم بإيتاء اليتامى أموالهم. فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهم، فأما إذا كانوا غير بالغين أو غير عقلاء، أو إن كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين، فلا تدفعوا إليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه. والمقصود من كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين» .
وقيل: إن الخطاب في الآية الكريمة للآباء، والمراد من السفهاء الأولاد الذين لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه، بل إذا أعطى لهم أفسدوه وأتلفوه.
وعلى هذا الرأى تكون إضافة الأموال إلى المخاطبين على سبيل الحقيقة.
ويكون المعنى: لا تؤتوا أيها الآباء أموالكم لأولادكم السفهاء لأن في إعطائكم إياها لهم إفسادا لهم مع أن فيها قوام حياتكم وصلاح أحوالكم.
والذي نراه أن الخطاب في الآية الكريمة لجميع المكلفين حاكمين ومحكومين ليأخذ كل من يصلح لهذا الحكم حظه من الامتثال. وأن المراد بالسفهاء كل من لا يحسن المحافظة على ماله لصغره، أو لضعف عقله، أو لسوء تصرفاته سواء أكان من اليتامى أم من غيرهم لأن التعميم في الخطاب وفي الألفاظ- عند عدم وجود المخصص- أولى، لأنه أوفر معنى، وأوسع تشريعا.
وفي إضافة الأموال إلى جميع المخاطبين المكلفين من المسلمين إشارة بديعة إلى أن المال المتداول بينهم هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمر، ولكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء لأن وضعه في المواضع التي أمر الله بها منفعة للأمة كلها، وفي وضعه في المواضع التي نهى الله عنها مضرة بالأمة كلها، وتعاليم الإسلام التي تجعل المسلمين جميعا أمة واحدة متكافلة متراحمة تعتبر مصلحة كل فرد من أفرادها عين مصلحة الآخرين.
وبعد أن نهى- سبحانه- عن إيتاء المال للسفهاء، أمر بثلاثة أشياء، أولها وثانيها قوله- تعالى- وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ.
أى اجعلوا هذه الأموال مكانا لرزقهم وكسوتهم، بأن تتجروا فيها حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من أصل المال لئلا يفنيه الإنفاق منه.
وإنما قال: وَارْزُقُوهُمْ فِيها ولم يقل «منها» لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها ويستثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال.
أما الأمر الثالث فهو قوله- تعالى-: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً.
والقول المعروف هو كل ما تسكن إليه النفس لموافقته للشرع وللعقول السليمة، كأن يكلموهم كلاما لينا تطيب به نفوسهم، وكأن يعدوهم عدة حسنة بأن يقولوا لهم: إذا صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم. وكأن ينصحوهم بما يصلحهم ويبعدهم عن السفه وسوء التصرف.
وفي أمره- سبحانه- للمخاطبين بأن يقولوا لهؤلاء السفهاء قولا معروفا، بعد أمره لهم برزقهم وكسوتهم، إشعار بأن من الواجب عليهم أن يقدموا إليهم الرزق والكسوة مصحوبين بوجه طلق، وبقول جميل بعيد عن المن والأذى، فقد جرت عادة من تحت يده المال أن يستثقل إخراجه لمن سأله إياه.
هذا، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة: وجوب المحافظة على الأموال وعدم تضييعها.
قال صاحب الكشاف: وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن. ولأن أترك ما لا يحاسبني الله عليه، خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان- وكانت له بضاعة يقلبها-: لولاها لتمندل بي بنو العباس- أى لولاها لاتخذونى كالمنديل يسخروننى لمصالحهم-. وقيل لأبى الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: لئن أدنتنى من الدنيا فقد صانتنى عنها.
وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. وربما رأوا رجلا في جنازة، فقالوا له: اذهب إلى دكانك» .
وقال بعض العلماء: ولنقف عند قوله- تعالى- وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً لنعلم ما يوحى به من تكافل الأمة ومسئولية بعضها عن بعض. ومن أن المال الذي في يد بعض الأفراد «قوام للجميع» ينتفعون به في المشروعات العامة، ويفرجون به أزماتهم وضائقاتهم الخاصة عن طريق الزكاة، وعن طريق التعاون وتبادل المنافع. وهذا هو الوضع المالى في نظر الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يقول: مالي مالي. هو مالي وحدي لا ينتفع به سواي، ليس لأحد أن يقول هذا أو ذاك. فالمال مال الجميع، والمال مال الله، ينتفع به الجميع عن الطريق الذي شرعه الله في سد الحاجات ودفع الملمات. وهو ملك لصاحبه يتصرف فيه لا كما يشاء ويهوى بل كما رسم الله وبين في كتابه، حتى إذا ما أخل بذلك فأسرف وبذر أو ضن وقتر حجر عليه» .
كذلك من الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة: وجوب الحجر على السفهاء، لأن الله- تعالى- قد أمر بذلك. ووجوب إقامة الوصي والولي والكفيل على الأيتام الصغار ومن في حكمهم ممن لا يحسنون التصرف.
ثم بين- سبحانه- الوقت الذي يتم فيه تسليم أموال اليتامى إليهم، وكيف تجب حياطتهم والعناية بهم وبأموالهم فقال- تعالى-:
ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما ، أي : تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها . ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء ، وهم أقسام : فتارة يكون الحجر للصغر; فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون الحجر للجنون ، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين ، وتارة يكون الحجر للفلس ، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها ، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه .
وقد قال الضحاك ، عن ابن عباس في قوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) قال : هم بنوك والنساء ، وكذا قال ابن مسعود ، والحكم بن عتيبة والحسن ، والضحاك : هم النساء والصبيان .
وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عثمان بن أبي العائكة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها " .
ورواه ابن مردويه مطولا .
وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) قال : الخدم ، وهم شياطين الإنس وهم الخدم .
وقوله : ( وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس يقول [ تعالى ] لا تعمد إلى مالك وما خولك الله ، وجعله معيشة ، فتعطيه امرأتك أو بنيك ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم ، ولكن أمسك مالك وأصلحه ، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى ماله سفيها ، وقد قال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه .
وقال مجاهد : ( وقولوا لهم قولا معروفا ) يعني في البر والصلة .
وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ، ومن تحت الحجر بالفعل ، من الإنفاق في الكساوى والإنفاق والكلام الطيب ، وتحسين الأخلاق .
القول في تأويل قوله : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ (98)
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في" السفهاء " الذين نهى الله جل ثناؤه عباده أن يؤتوهم أموالهم. (99)
فقال بعضهم: هم النساء والصبيان.
* ذكر من قال ذلك:
8523 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: اليتامى والنساء.
8524 - حدثنا المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: لا تعطوا الصغار والنساء.
8525 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن قال: المرأة والصبيّ.
8526 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الحسن قال: النساء والصغار، والنساء أسفه السفهاء.
8527 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: " السفهاء " ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والمرأة ".
8528 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا حميد، عن عبد الرحمن الرؤاسي، عن السدي= قال: يردّه إلى عبدالله= قال: النساء والصبيان.
8529 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، أما " السفهاء "، فالولد والمرأة.
8530 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، يعني بذلك: ولد الرجل وامرأته، وهي أسفه السفهاء.
8531 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: " السفهاء " الولد، والنساء أسفه السفهاء، فيكونوا عليكم أربابًا.
8532 - حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك، قال: أولادكم ونساؤكم.
8533 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا أبي، عن سلمة، عن الضحاك قال: النساء والصبيان.
8534 - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن مجاهد: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: النساء والولدان.
8535 - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا ابن أبي غَنِيّة، عن الحكم: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: النساء والولدان. (100)
8536 - حدثنا بشر بن معاذ: قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا "، أمر الله بهذا المال أن يخزن فتُحسن خِزانته، ولا يملكه المرأة السفيهة والغلامُ السفيه.
8537 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل، عن أبي مالك قال: النساء والصبيان.
8538 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: امرأتك &; 7-563 &; وبنيك= وقال: " السفهاء "، الولدان، والنساء أسفه السفهاء.
* * *
وقال آخرون: بل " السفهاء "، الصبيان خاصة.
* ذكر من قال ذلك:
8539 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: هم اليتامى.
8540 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن شريك، عن سالم، عن سعيد قال: " السفهاء "، اليتامى.
8541 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يونس، عن الحسن في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، يقول: لا تَنْحَلوا الصغار.
* * *
وقال آخرون: بل عنى بذلك: السفهاء من ولد الرجل.
* ذكر من قال ذلك:
8542 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال، أخبرنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده، الذي هو قوامك بعد الله تعالى.
8543 - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، يقول: لا تسلط السفيه من ولدك= فكان ابن عباس يقول: نـزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء. (101)
8544 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلِّقْها، ورجل أعطى ماله سفيهًا وقد قال الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه. (102)
8545 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " الآية، قال: لا تعط السفيه من ولدك رأسًا ولا حائطًا، ولا شيئًا هو لك قيمًا من مالك.
* * *
وقال آخرون: بل " السفهاء " في هذا الموضع، النساء خاصة دون غيره.
* ذكر من قال ذلك:
8546 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم حضرميٌّ أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته، فوضعته في غير الحق، فقال الله تبارك وتعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".
8547 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حميد، عن مجاهد: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: النساء.
8548 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثنا سفيان، عن الثوري، عن حميد، عن قيس، عن مجاهد في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: هنّ النساء.
8549 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا "، قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم، وهنّ سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجًا أو أمهاتٍ أو بنات.
8550 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8551 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا هشام، عن الحسن قال: المرأة.
8552 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: النساء مِنْ أسفه السفهاء.
8553 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن مورّق قال: مرت امرأة بعبدالله بن عمر لها شارَة وهيْئة، فقال لها ابن عمر: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا ".
* * *
وقال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا، أن الله جل ثناؤه عم بقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، فلم يخصص سفيهًا دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهًا ماله، صبيًا صغيرًا كان أو رجلا كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى.
و " السفيه " الذي لا يجوز لوليه أن يؤتِّيه ماله، هو المستحقُّ الحجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوء تدبيره ذلك.
وإنما قلنا ما قلنا، من أن المعنيَّ بقوله: " ولا تؤتوا السفهاء " هو من وصفنا دون غيره، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا &; 7-566 &; بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد، وقد يدخل في" اليتامى " الذكور والإناث، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لَهُم من الأموال، الذكورَ دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور.
وإذْ كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم أموالهم، إليهم، وأجيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم، غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم أموالهم، وحُظِر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم.
فإذْ كان ذلك كذلك، فبيِّنٌ أن " السفهاء " الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم، هم المستحقون الحجرَ والمستوجبون أن يُولى عليهم أموالهم، وهم من وصفنا صفتهم قبل، وأن من عدا ذلك فغير سفيه، لأن الحجر لا يستحقه من قد بلغ وأونس رشده.
* * *
وأما قول من قال: " عنى بالسفهاء النساء خاصة "، فإنه جعل اللغة على غير وجهها. وذلك أن العرب لا تكاد تجمع " فعيلا " على " فُعَلاء " إلا في جمع الذكور، أو الذكور والإناث. وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم، جمعوه على: " فعائل " و " فعيلات "، مثل: " غريبة "، تجمع " غرائب " و " غريبات "، فأما " الغُرَباء "، فجمع " غريب ". (103)
* * *
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارْزُقوهم فيها واكسوهم "،
فقال بعضهم: عنى بذلك: لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيان= على ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل= أيها الرشداء، أموالكم التي تملكونها، فتسلِّطوهم عليها فيفسدوها ويضيعوها، ولكن ارزقوهم أنتم منها إن كانوا ممن تلزمكم نفقته، واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفًا.
وقد ذكرنا الرواية عن جماعة ممن قال ذلك، منهم: أبو موسى الأشعري، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وحضرمي، وسنذكر قول الآخرين الذين لم يذكر قولهم فيما مضى قبل.
8554 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها "، يقول: لا تعط امرأتك وولدك مالك، فيكونوا هم الذين يقومون عليك، وأطعمهم من مالك واكسُهم.
8555 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفًا "، يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك، وأمرَه أن يرزقه منه ويكسوه.
8556 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، قال: لا تعط السفيه من مالك شيئًا هو لك.
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: " ولا تؤتوا السفهاء أموالهم "، ولكنه أضيف إلى الولاة، لأنهم قُوَّامها ومدبِّروها.
* * *
* ذكر من قال ذلك:
8557 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، حدثنا ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "،
&; 7-568 &;
[هو مال اليتيم يكون عندك، يقول: لا تؤته إياه، وأنفقه عليه حتى يبلغ. وإنّما أضاف إلى الأولياء فقال: " أموالكم "، لأنهم قوّامها ومدبروها]. (104)
* * *
قال أبو جعفر: وقد يدخل في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، أموالُ المنهيِّين عن أن يؤتوهم ذلك، وأموال " السفهاء ". لأن قوله: " أموالكم " غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض. ولا تمنع العرب أن تخاطب قومًا خِطابًا، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم، وبعضه عن غُيَّب، وذلك نحو أن يقولوا: " أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل "، فيخاطب الواحد خطاب الجمع، بمعنى: أنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم. فكذلك قوله: " ولا تؤتوا السفهاء "، معناه: لا تؤتوا أيها الناس، سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم، فيضيعوها.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره قد عم بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلَّها، ولم يخصص منها شيئا دون شيء، كان بيِّنًا بذلك أن معنى قوله: " التي جعل الله لكم قيامًا "، إنما هو التي جعل الله لكم ولهم قيامًا، ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله: " لكم ".
* * *
وأما قوله: " التي جعل الله لكم قيامًا "، فإن " قيامًا " و " قِيَمًا " و " قِوَامًا " في معنى واحد. وإنما " القيام " أصله " القوام "، غير أن " القاف " التي قبل " الواو " لما كانت مكسورة، جعلت " الواو "" ياء " لكسرة ما قبلها، كما يقال: " صُمْت صيامًا "،" وصُلْت صِيالا "، (105) ويقال منه: " فلان قوام أهل بيته " و " قيام أهل بيته ".
* * *
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأ بعضهم: ( التي جعل الله لكم قِيَمًا ) بكسر " القاف " وفتح " الياء " بغير " ألف ".
وقرأه آخرون: " قِيَامًا " بألف.
* * *
قال محمد: (106) والقراءة التي نختارها: " قِيَامًا " بالألف، لأنها القراءة المعروفة في قراءة أمصار الإسلام، وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد. وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك، لأن القراآت إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني، فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قَرَأة أمصار الإسلام.
* * *
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: " قيامًا " قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
8558 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال، حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك: " أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا "، التي هي قوامك بعد الله. (107)
8559 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا "، فإن المال هو &; 7-570 &; قيام الناس، قِوَام معايشهم. يقول: كن أنت قيم أهلك، فلا تعط امرأتك [وولدك] مالك، فيكونوا هم الذين يقومون عليك. (108)
8560 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا " يقول الله سبحانه: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلك الله وجعله لك معيشة، فتعطيه امرأتك أو بَنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم. ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنتَ الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. قال: وقوله: " قيامًا "، بمعنى: قوامكم في معايشكم.
8561 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن قوله: " قيامًا " قال: قيام عيشك.
8562 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا بكر بن شرود، عن مجاهد أنه قرأ: " التي جعل الله لكم قيامًا "، بالألف، يقول: قيام عيشك. (109)
8563 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: &; 7-571 &; " أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا "، قال: لا تعط السفيه من ولدك شيئًا، هو لك قيِّم من مالك. (110)
* * *
وأما قوله: " وارزقوهم فيها واكسوهم "، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله.
فأما الذين قالوا: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، [أموالَ] أولياء السفهاء، لا أموال السفهاء، (111) = فإنهم قالوا: " معنى ذلك: وارزقوا، أيها الناس، سفهاءكم من نسائكم وأولادكم، من أموالكم طعامهم، وما لا بد لهم منه من مُؤَنهم وكسوتهم ".
وقد ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى، وسنذكر من لم يُذكر من قائليه.
8564 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: أمروا أن يرزقوا سفهاءهم- من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم- من أموالهم.
8565 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8566 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج عن ابن جريج قال، قال ابن عباس قوله: " وارزقوهم "، قال، يقول: أنفقوا عليهم.
8567 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وارزقوهم فيها واكسوهم "، يقول: أطعمهم من مالك واكسهم.
* * *
وأما الذين قالوا: إنما عنى بقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "، أموالَ السفهاء أن لا يؤتيهموها أولياؤهم "، فإنهم قالوا: " معنى قوله: " وارزقوهم فيها واكسوهم "، وارزقوا، أيها الولاة ولاةَ أموال السفهاء، سفهاءكم من أموالهم، طعامهم وما لا بد لهم من مؤنهم وكسوتهم. وقد مضى ذكر ذلك. (112)
* * *
قال أبو جعفر: وأما الذي نراه صوابًا في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " من التأويل، فقد ذكرناه، ودللنا على صحة ما قلنا في ذلك بما أغنى عن إعادته.
* * *
فتأويل قوله: " وارزقوهم فيها واكسوهم "، على التأويل الذي قلنا في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "= وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين تجب عليكم نفقتهم من طعامهم وكسوتهم في أموالكم، ولا تسلِّطوهم على أموالكم فيهلكوها= وعلى سفهائكم منهم، ممن لا تجب عليكم نفقته، ومن غيرهم الذين تَلُون أنتم أمورهم، من أموالهم فيما لا بد لهم من مؤنهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم. (113) لأن ذلك هو الواجب من الحكم في قول جميع الحجة، لا خلاف بينهم في ذلك، مع دلالة ظاهر التنـزيل على ما قلنا في ذلك.
* * *
القول في تأويل قوله : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (5)
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:
فقال بعضهم: معنى ذلك: عِدْهم عِدَة جميلة من البرِّ والصلة.
* ذكر من قال ذلك:
8568 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، &; 7-573 &; عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " وقولوا لهم قولا معروفًا "، قال: أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفًا في البر والصلة= يعني النساء، وهن السفهاء عنده.
8569 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " وقولوا لهم قولا معروفًا "، قال: عِدَةً تَعِدُهم. (114)
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادعوا لهم.
* ذكر من قال ذلك:
8570 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " وقولوا لهم قولا معروفًا "، إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه، فقل لهم قولا معروفًا، قل لهم: " عافانا الله وإياك "،" وبارك الله فيك ".
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصحة، ما قاله ابن جريج. وهو أن معنى قوله: " وقولوا لهم قولا معروفًا "، أي: قولوا، يا معشر ولاة السفهاء، قولا معروفًا للسفهاء: " إن صَلحتم ورشدتم سلَّمنا إليكم أموالكم، وخلَّينا بينكم وبينها، فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم "، وما أشبه ذلك من القول الذي فيه حث على طاعة الله، ونهي عن معصيته. (115)
------------------
الهوامش :
(98) كان في المطبوعة والمخطوطة سياق الآية إلى "قيامًا". ولكن تفسير أبي جعفر شمل بقية الآية"وارزقوهم فيها واكسوهم ، " كما سيأتي في ص: 571 ، فأتممتها.
(99) انظر تفسير"السفه" و"السفهاء" فيما سلف 1 / 293- 295 / 3: 90 ، 129 / 6 57- 60.
(100) الأثر: 8535-"أبو نعيم" ، هو"الفضل بن دكين". مضت ترجمته برقم: 2554 ، 3035. و"ابن أبي غنية" (بفتح الغين وكسر النون وياء مشددة مفتوحة) هو: "عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، الخزاعي" ، روى عن أبيه ، وأبي إسحاق السبيعي ، وأبي إسحاق الشيباني ، والحكم بن عتيبة. وروى عنه الثوري ، وهو من أقرانه ، ووكيع ، ويحيى بن أبي زائدة ، وعمارة بن بشر ، وأبو نعيم وآخرون. وهو ثقة. وكان في المطبوعة: "ابن أبي عنبسة" ، أما في المخطوطة ، فإن الناسخ لم يحسن كتابة ما كتب فصارت كأنها"ابن أبي عنية" ، والصواب ما أثبت.
و"الحكم" ، هو"الحكم بن عتيبة الكندي" ، مضى مرارًا ، في رقم: 3297.
(101) في المطبوعة والمخطوطة: "وليسوا اليتامى" ، وهي لغة رديئة ، أخشى أن يكون ذلك من سهو الناسخ.
(102) الأثر: 8544- أخرجه الحاكم في المستدرك 2: 203 من طريق أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري. عن أبيه ، عن شعبة ، مرفوعا ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى ، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين" وقد اتفقا جميعًا على إخراجه" وقال الذهبي: "ولم يخرجاه ، لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفًا ، ورفعه معاذ بن معاذ عنه".
(103) هذه الحجة من حسن النظر في العربية ومعاني أبنيتها. والذي استنكره أبو جعفر من جعل اللغة على غير وجهها ، وتحميل العربية ما لا سيبل إليه في بنائها وتركيبها ، وتأويل كتاب الله خاصة بالانتزاع الشديد والجرأة على اللغة ، كأنه قد أصبح في زماننا هذا ، هو القاعدة التي يركب فسادها كل مبتدع في الدين برأيه ، وكل متورك في طلب الصوت في الناس بما يقول في دين ربه الذي ائتمن عليه من أنزل إليهم كتابه ، ليعلمهم ويهديهم ، فخالفوا طريق العلم ، وجاروا عن سنن الهداية.
(104) الأثر: 8557- هذا الذي بين القوسين زيادة ليست في المطبوعة ولا المخطوطة ، زدتها من تفسير البغوي (بهامش ابن كثير) 2: 349. وهي أشبه بنص الطبري في ترجمة هذا القول. وقد نسب البغوي هذا القول الذي نقلته ، ورجحت أنها سقطت من ناسخ تفسير الطبري= إلى سعيد بن جبير وعكرمة. والظاهر أن السيوطي أيضًا وقف على نسخة من تفسير الطبري فيها هذا السقط ، فأغفل مقالة سعيد بن جبير التي نقلها البغوي ، ونقل عن ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ما نصه:
"عن سعيد بن جبير في قوله: (وَلا تؤتوا السفهاء) ، قال: اليتامى- (أموالكم) قال: أموالهم ، بمنزلة قوله: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ)
وبين أن نص البغوي ، أقرب إلى ما ذكر أبو جعفر ، من نص السيوطي في الدر المنثور 2: 120 فلذلك أثبته. وأرجو أن لا يكون سقط من كلام أبي جعفر الآتي شيء.
(105) في المطبوعة والمخطوطة: "حلت حيالا" بالحاء ، وكأن الصواب ما أثبت.
(106) هذه هي المرة الثانية التي كتب فيها"قال محمد"- يعني محمد بن جرير الطبري أبا جعفر- مكان: "قال أبو جعفر ، وانظر 519 تعليق: 1 ، فيما سلف قريبًا.
(107) الأثر: 8558- هو مختصر الأثر السالف رقم: 8542.
(108) الأثر: 8559- هو مختصر الأثر السالف رقم: 8554 ، والزيادة بين القوسين منه وبغيرها لا تستقيم الضمائر. وفي المخطوطة والمطبوعة: "كنت أنت" والصواب"كن أنت" كما أثبتها.
(109) الأثر: 8562-"إسحاق" في هذا الأثر ، هو"إسحاق بن الضيف" ، ويقال: "إسحاق ابن إبراهيم بن الضيف ، الباهلي" ، ثقة. مترجم في التهذيب. وأما "بكر بن شرود" فقد ترجم له البخاري في الكبير 2 / 1 / 90 ، وقال: "صنعاني ، قال ابن معين: رأيته ، ليس بثقة". أما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1 / 1 / 338 ، فقد ترجم له باسم: "بكر بن عبد الله بن شروس= ويقال: ابن شرود ، الصنعاني" ، قال ، "روى عن معمر. روى عنه إسحاق بن إبراهيم بن الضيف. سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث". أما الحافظ ابن حجر ، فقد ترجم له في لسان الميزان 2: 52- 54 ، وروى عن ابن معين أنه قال: "كذاب ، ليس بشيء" ، واستوفى الكلام فيه. وأما "مجاهد" فهو"مجاهد" ابن جبر التابعي الإمام المشهور. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عن ابن مجاهد" ، وزيادة"ابن" خطأ لا شك فيه. كأن الناسخ ظنه"ابن مجاهد" القارئ ، شيخ الصنعة ، أول من سبع القراءات السبعة ، وهو متأخر الميلاد. ولد سنة 245 ، وهو"أبو بكر بن مجاهد" ="أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد التميمي".
(110) الأثر: 8563- انظر الأثر السالف رقم: 8545 ، اختلف لفظاهما مع اتفاق إسنادهما.
(111) هذه الزيادة بين القوسين ، استظهرتها من السياق ، وأثبتها للبيان. وكأن ذلك هو الصواب.
(112) انظر الأثر: رقم: 8557.
(113) انظر تفسير"الرزق" فيما سلف 4: 274 / 5: 44 / 6: 311 = وتفسير"الكسوة" فيما سلف 5: 44 ، 480.
(114) في المطبوعة: "تعدوهم" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(115) انظر تفسير"المعروف" فيما سلف 3: 371 / 4: 547 / 5: 7 ، 44 ، 76 ، 93 137 / 7: 91 ، 105 ، 130= وتفسير"قول معروف" فيما سلف 5: 520.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ فيها الحجر علي السفيه؛ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ.
وقفة
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ في الآية إشارة إلى مدح الأموال، وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالًا يحاسبني الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى الناس، وكانوا يقولون: اتجروا، واكتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه.
وقفة
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ نهى الله أولياء اليتامى عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم خشية إساءة التصرف فيها، وأضاف الأموال إلى الأولياء مع أنها لليتامی، مبالغة في حملهم على حفظها وصيانتها.
وقفة
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ إذا كان هذا أمرًا بحفظ المال؛ فحفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق.
وقفة
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ مشروعية الحَجْر على السفيه الذي لا يحسن التصرف, لمصلحته، وحفظًا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع.
وقفة
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ إن أمة تنفق مئات الملايين في الشهر على المحرمات، وتنفق مثلها على البدع، وتنفق أمثال ذلك كله على الكماليات، ثم تدعي الفقر إذا دعاها الداعي لما يحييها، لأمة كاذبة على الله، سفيهة في تصرفاتها.
عمل
[5] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ احْذَر أنْ تعطِي السُّفهاءَ أموالك، ولو كان قصدُكَ خيرًا، فإنه سيُفسد هذا المال.
وقفة
[5] لا يخلو مجتمع من سفهاء ذوي خفة وطيش، تستوي عندهم المصالح والمفاسد، فإن كان الله قال عنهم في المال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، فأخلاق المجتمع أولى.
عمل
[5] تعامل مع مال اليتيم كما تحب أن يتعامل الناس مع مال ورثتك بعد موتك ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.
عمل
[5] ضع ميزانية شخصية توازن فيها بين متطلبات الدنيا والآخرة ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.
لمسة
[5] قال الله هنا: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ولم يقل: (أموالهم)؛ الكاف هنا للخطاب ليهتم كل وصيٍّ بما معه كأن المال ماله هو.
وقفة
[5] ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ إنما قال: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ ولم يقل: (منها)؛ لأن ﴿فِيهَا﴾ يقتضي بقاءها بالتنمية والتجارة حتى تكون محلًّا للرزق والكسوة.
وقفة
[5] ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾، و﴿فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [8]، الآية الأولى (في) تفيد الظرفية، مما يعني أن يكون المال محل استثمار وينفق على الأولاد من ربحه لئلا ينفد، فلهم حق النفقة، والآية الثانية (من) تبعيضية، والحاضرون لقسمة الميراث يعطون منه تطييبًا لخاطرهم، وتطييبًا لخاطرهم، لا حقًا فيه.
لمسة
[5] لماذا قال الله هنا: ﴿وَاكْسُوهُمْ﴾ ولم يذكرها في الآية الثامنة؟ لأن المال هنا مالهم فيستحقون النفقة والكسوة واحتياجاتهم، أما في الآية الثامنة فالمال ليس مال الفقراء والمساكين، وإنما ملك الورثة، فهم يعطون جزءًا من هذا المال للأقارب والمساكين واليتامى الذين حضروا القسمة من باب التفضّل.
وقفة
[5] ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ في أمره سبحانه أن يقولوا قولًا معروفًا بعد أمره لهم برزقهم وكسوتهم، إشعار بأن من الواجب عليهم أن يبذلوا العطاء بوجه طلق ولسان جميل بعيدًا عن المن والأذى، فقد جرت عادة المنفق أن يستثقل سؤال السائل ويضجر منه.
لمسة
[5، 6] ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ولم يقل: (أموالهم) مع أنها أموال السفهاء؛ حثًّا لهم على حفظها وصيانتها، وقال بعدها: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ فأضافها إليهم حين صاروا رشداء.
الإعراب :
- ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ: ﴾
- الواو: عاطفة. لا: ناهية جازمة. تؤتوا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف: فارقة. السفهاء: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ: ﴾
- أموال: مفعول به ثان منصوب بالفتحة. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة. والميم علامة جمع الذكور. التي: إسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للأموال. جعل: فعل ماض مبني على الفتح. وجملة «جَعَلَ اللَّهُ» صلة الموصول لا محل لها والعائد محذوف التقدير: جعلها.
- ﴿ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً: ﴾
- لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. لكم: جار ومجرور. والميم علامة جمع الذكور. قياما: مفعول مطلق منصوب بالفتح المنون بتقدير: تقومون بها قياما أو يكون مفعول جعل الثاني.
- ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيها: ﴾
- الواو: استئنافية. ارزقوا: فعل امر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «هم» ضمير الغائبين المتصل في محل جر بالاضافة. فيها: جار ومجرور متعلق بارزقوا.
- ﴿ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ: ﴾
- الواو: عاطفة. اكسوهم: معطوفة على «ارْزُقُوهُمْ» وتعرب إعرابها وقولوا: معطوف بواو العطف على «ارزقوا» وتعرب مثلها. لهم: جار ومجرور متعلق بقولوا.
- ﴿ قَوْلًا مَعْرُوفاً: ﴾
- مصدر- مفعول مطلق سّد مسدّ المفعول منصوب بالفتحة. معروفا: صفة لقولا منصوبة بالفتحة. '
المتشابهات :
| النساء: 5 | ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ |
|---|
| النساء: 8 | ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم، ودفع مهور النساء إليهن، بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا أن هذا الكلام إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهم، فأما إذا كانوا غير عقلاء، أو غير بالغين، أو كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين؛ فلا تدفعوا إليهم أموالهم، وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه، فالمقصود من كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء، قال تعالى:
﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾
القراءات :
التي:
1- وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- اللاتي، وهى قراءة الحسن، والنخعي.
3- اللواتى، وهى قراءة شاذة.
قيما:
قرئ:
1- فيما، وهى قراءة نافع، وابن عامر.
2- قياما، وهى قراءة جمهور السبعة.
3- قواما، بكسر القاف، وهى قراءة عبد الله بن عمر.
4- قواما، بفتح القاف، وهى قراءة الحسن، وعيسى بن عمر.
5- قوما، وهى قراءة شاذة.
مدارسة الآية : [6] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ .. ﴾
التفسير :
الابتلاء:هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد، الممكن رشده، شيئا من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمرا كثيرا. فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح{ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} كاملة موفرة.{ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا} أي:مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم، إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم.{ وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} أي:ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا، فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء، الذين ليس عندهم خوف من الله، ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.
وقوله- تعالى- وَابْتَلُوا من الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان.
والخطاب للأولياء والأوصياء وكل من له صلة باليتامى.
والمراد ببلوغ النكاح هنا: بلوغ الحلم المذكور في قوله- تعالى-: وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وقوله آنَسْتُمْ أى تبينتم وشاهدتم وأحسستم.
قال القرطبي: آنَسْتُمْ أى أبصرتم ورأيتم ومنه قوله- تعالى-: فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً أى أبصر ورأى. وتقول العرب: اذهب فاستأنس هل ترى أحدا. معناه: تبصر. وقيل: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد .
والمعنى: عليكم أيها الأولياء والأوصياء أن تختبروا اليتامى، وذلك بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأمور، وحسن التصرف في الأموال وبتمرينهم على ما يليق بأحوالهم حتى لا يجيء وقت بلوغهم إلا وقد صار في قدرتهم أن يصرفوا أموالهم تصريفا حسنا. فإن شاهدتم وأحسستم منهم رُشْداً أى صلاحا في عقولهم، وحفظا لأموالهم، فادفعوها إليهم من غير تأخير أو مماطلة.
وحَتَّى هنا للغاية، وهي داخلة على الجملة، فهي تبين نهاية الصغر، والجملة التي دخلت عليها ظرفية في معنى الشرط.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف نظم الكلام؟ قلت: ما بعد حَتَّى إلى قوله:
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ جعل غاية للابتلاء، وهي حَتَّى التي تقع بعدها الجمل. والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية، لأن إذا متضمنة معنى الشرط. وفعل الشرط بَلَغُوا النِّكاحَ وقوله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح. فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم، فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم.
فإن قلت: فما معنى تنكير الرشد؟ قلت: معناه نوعا من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة. أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد» .
ثم نهى- سبحانه- الأوصياء وغيرهم عن الطمع في شيء من مال اليتامى فقال- تعالى-:
وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا.
أى: ادفعوا أيها الأولياء والأوصياء إلى اليتامى أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ، ولا تأكلوها مسرفين في الأكل ومبادرين بالأخذ خشية أن يكبروا، بأن تفرطوا في إنفاقها وتقولوا: ننفقها كما تريد قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا.
والإسراف في الأصل- كما يقول الآلوسى- تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح. وربما كان ذلك في الإفراط وربما كان في التقصير. غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافا.
وإذا كان في التقصير يقال: سرف يسرف سرفا».
وقوله بِداراً مفاعلة من البدر وهو العجلة إلى الشيء والمسارعة إليه. وهما- أى قوله إِسْرافاً وَبِداراً منصوبان على الحال من الفاعل في قوله تَأْكُلُوها أى: ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم. أو منصوبان على أنهما مفعول لأجله، أى ولا تأكلوها لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم.
والمراد من هذه الجملة الكريمة بيان أشنع الأحوال التي تقع من الأوصياء أو الأولياء وهي أن يأكلوا أموال اليتامى بإسراف وتعجل مخافة أن يبلغ الأيتام رشدهم، فتؤخذ من أولئك الأوصياء تلك الأموال لترد إلى أصحابها وهم اليتامى بعد أن يبلغوا سن الرشد.
ثم بين- سبحانه- ما ينبغي على الوصي إن كان غنيا وما ينبغي له إن كان فقيرا فقال:وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
والاستعفاف عن الشيء تركه. يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك عنه.
والعفة: الامتناع عما لا يحل.
أى: ومن كان من الأولياء أو الأوصياء على أموال اليتامى غنيا فليستعفف أى فليتنزه عن أكل مال اليتيم، وليقنع بما أعطاه الله من رزق وفير إشفاقا على مال اليتيم. ومن كان فقيرا من هؤلاء الأوصياء فليأكل بالمعروف، بأن يأخذ من مال اليتيم على قدر حاجته الضرورية وأجر سعيه وخدمته له. فقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» . أى غير مسرف في الأخذ، ولا مبادر أى متعجل، ولا جامع منه ما يتجاوز حاجتك.
ثم بين- سبحانه- ما ينبغي على الأوصياء عند انتهاء وصايتهم على اليتامى وعند دفع أموالهم إليهم فقال: فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً.
أى: فإذا أردتم أيها الأولياء أن تدفعوا إلى اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم بعد البلوغ والرشد، فأشهدوا عليهم عند الدفع بأنهم قبضوها وبرئت عنها ذممكم، لأن هذا الإشهاد أبعد عن التهمة، وأنفى للخصومة، وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة.
وقوله- تعالى- وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً أى كفى بالله محاسبا لكم على أعمالكم وشاهدا عليكم في أقوالكم وأفعالكم، ومجازيا إياكم بما تستحقون من خير أو شر، لأنه- سبحانه- لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإنكم إن أفلتم من حساب الناس في الدنيا فلن تفلتوا من حساب الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فعليكم أن تتحروا الحلال في كل تصرفاتكم. ففي هذا التذييل وعيد شديد لكل جاحد لحق غيره، ولكل معتد على أموال الناس وحقوقهم، ولا سيما اليتامى الذين فقدوا الناصر والمعين.
هذا، وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة جملة من الأحكام منها:
1- أن على الأوصياء أن يختبروا اليتامى بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها، وأن يمرونهم على ذلك بحسب ما يليق بأحوالهم.
ويرى جمهور العلماء أن هذا الاختبار يكون قبل البلوغ. ويرى بعضهم أن هذا الاختبار يكون بعد البلوغ.
وقد قال القرطبي في بيان كيفية هذا الاختبار ما ملخصه: لا بأس في أن يدفع الولي إلى اليتيم شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه- أى بعد بلوغه- وإن أساء النظر وجب عليه إمساك المال عنه..
وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أن يكون غلاما أو جارية، فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا، وأعطاه شيئا نزرا ليتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه، فإذا رآه متوخيا الإصلاح سلم إليه ماله عند البلوغ وأشهد عليه.
وإن كان جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه فإن رآها رشيدة سلم إليها مالها وأشهد عليها وإلا بقيا تحت الحجر» «1» .
وقد بنى الإمام أبو حنيفة على هذا الاختبار أن تصرفات الصبى العاقل المميز بإذن الولي صحيحة، لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له الولي في البيع والشراء- مثلا- وهذا يقتضى صحة تصرفاته.
ويرى الإمام الشافعى أن الاختبار لا يقتضى الإذن في التصرف ولا يتوقف عليه، بل يكون الاختبار بدون التصرف على حسب ما يليق بحال الصبى فابن التاجر- مثلا- يختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد وحينئذ يعقد الولي إن أراد.
2- كذلك أخذ العلماء من هذه الآية أن الأوصياء لا يدفعون أموال اليتامى إليهم إلا بتحقيق أمرين:
أحدهما: بلوغ النكاح.
والثاني: إيناس الرشد.
والمراد ببلوغ النكاح بلوغ وقته وهو التزوج، وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى، بأن توجد المظاهر التي تدل على الرجولة في الغلام، والتي تدل على مبلغ بلوغ النساء في الفتاة، وذلك يكون بالاحتلام أو بالحيض بالنسبة للفتاة أو ببلوغ سن معينة قدرها بعضهم بخمس عشرة سنة بالنسبة للذكر والأنثى على السواء.
وقدرها أبو حنيفة بسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاة، وبثماني عشرة سنة بالنسبة للفتى.
ومن بلاغة القرآن الكريم أنه عبر عن حالة البلوغ بقوله: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ لأن هذا الوقت يختلف باختلاف البلاد في الحرارة والبرودة، وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف، والصحة والمرض.
والمراد بإيناس الرشد: أن يتبين الأولياء من اليتامى الصلاح في العقل والخلق والتصرف في الأموال.
ويرى جمهور العلماء أن اليتيم لا يدفع إليه ماله مهما بلغت سنه ما لم يؤنس منه الرشد لأن الله- تعالى- يقول: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً.
ويقول: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ومعنى ذلك أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد لا تدفع إليهم أموالهم، بل يستمرون تحت ولاية الأولياء عليهم لأنهم لا يزالون سفهاء لم يتبين رشدهم.
وقد خالف الإمام أبو حنيفة جمهور الفقهاء فقال. لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشد حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها عاقلا ولو غير رشيد فليس لأحد عليه سبيل، ويجب أن يدفع الوصي إليه ماله ولو كان فاسقا أو مبذرا.
قالوا: وإنما اختار أبو حنيفة هذه السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده ثماني عشرة سنة، فإذا زيد عليها سبع سنين- وهي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان- فعند ذلك يدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس، لأن اسم الرشد واقع على العقل في الجملة، والله- تعالى- شرط رشدا منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد، فاقتضى ظاهر الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور في هذه الآية .
3- كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن الوصي على اليتيم إذا كان غنيا فعليه أن يتحرى العفاف. وألا يأخذ شيئا من مال اليتيم، لأن أخذه مع غناه يتنافى مع العفاف الذي يجب أن يتحلى به الأوصياء، ويعتبر من باب الطمع في مال اليتيم.
أما إذا كان الوصي فقيرا فقد أذن الله له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف أى بالقدر الذي تقتضيه حاجته الضرورية، ولا يستنكره الشرع ولا العقل.
وقد بسط الإمام الرازي القول في هذه المسألة فقال ما ملخصه: اختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم أولا؟
فمنهم من يرى أن للوصي أن يأخذ من مال اليتيم بقدر أجر عمله لأن قوله- تعالى- وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة. ولأن قوله- تعالى-إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما وغير ظلم، ولو لم يكن ذلك لم يكن لقوله إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً فائدة. فهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف. ولأن الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبى وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعى في أخذ الصدقات وجمعها فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم فكذا هاهنا.
ومنهم من يرى أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضا، ثم إذا أيسر قضاه، وإن مات ولم يقدر على القضاء بأن كان معسرا فلا شيء عليه».
ويشهد لهذا الرأى قول عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-: إنى أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والى اليتيم. إن استغنيت استعففت. وإن احتجت استقرضت. فإذا أيسرت قضيت».
4- كذلك من الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية أن على الأوصياء عند ما يدفعون أموال اليتامى إليهم أن يشهدوا على دفعها، منعا للخصومات والمنازعات، وإبراء لذمة الأوصياء، ولكي يكون اليتامى على بينة من أمرهم.
وقد اختلف العلماء في أن الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع إليه ماله هل يصدق؟ وكذلك إذا قال: أنفقت عليه في صغره هل يصدق؟
أما الشافعية والمالكية والحنابلة فيرون أنه لا يصدق لأن الآية الكريمة تقول: فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وقوله فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أمر. وظاهر الأمر أنه للوجوب.
وليس معنى الوجوب هنا أنه يأثم إذا لم يشهد. بل معناه أن الاشهاد لا بد منه في براءة ذمته بأن يدفع له ماله أمام رجلين أو رجل وامرأتين حتى إذا دفع المال ولم يشهد ثم طالبه اليتيم فحينئذ يكون القول ما قاله اليتيم بعد أن يقسم على أن الوصي لم يدفع إليه ماله.
ويرى الإمام أبو حنيفة أن الأمر في قوله- قوله- فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ للندب. وأن الوصي إذا ادعى ذلك يصدق ويكتفى في تصديقه بيمينه لأنه أمين لم تعرف خيانته، إذ لو عرفت خيانته لعزل. والأمين يصدق باليمين إذا كان هناك خلاف بينه وبين من ائتمنه. ولأن قوله- تعالى- بعد ذلك وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً يؤيد أن البينة ليست لازمة إذ معناه أنه لا شاهد أفضل من الله- تعالى- فيما بينكم وبينهم.
ثم شرع- سبحانه- في بيان أحكام المواريث بعد أن بين الأحكام التي تتعلق بأموال اليتامى فساق- سبحانه- قاعدة عامة لأصل التوريث في الإسلام هي أن الرجال لا يختصون بالميراث، بل للنساء معهم حظ مقسوم، ونصيب مفروض، سواء أكان الشيء الموروث قليلا أم كثيرا فقال تعالى:
وقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : أي اختبروهم ( حتى إذا بلغوا النكاح ) قال مجاهد : يعني : الحلم . قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم ، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد . وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل " .
وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة ، رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " أو يستكمل خمس عشرة سنة ، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - لما بلغه هذا الحديث - إن هذا الفرق بين الصغير والكبير .
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وهو الشعرة ، هل تدل على بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين ، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة ، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم ; لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه ، فلا يعالجها . والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس ، واحتمال المعالجة بعيد ، ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ، عن عطية القرظي ، رضي الله عنه قال : عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت ، فخلى سبيلي .
وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال الترمذي : حسن صحيح . وإنما كان كذلك; لأن سعد بن معاذ ، رضي الله عنه ، كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية .
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الغريب " : حدثنا ابن علية ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حيان ، عن عمر : أن غلاما ابتهر جارية في شعره ، فقال عمر ، رضي الله عنه : انظروا إليه . فلم يوجد أنبت ، فدرأ عنه الحد . قال أبو عبيد : ابتهرها : أي قذفها ، والابتهار أن يقول : فعلت بها وهو كاذب فإن كان صادقا فهو الابتيار ، قال الكميت في شعره .
قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا
وقوله : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) قال سعيد بن جبير : يعني : صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، وغير واحد من الأئمة . وهكذا قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله ، انفك الحجر عنه ، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه .
وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم .
ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) [ أي ] من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ، ولا يأكل منه شيئا . قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم .
( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج ، حدثنا عبد الله بن سليمان ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) نزلت في مال اليتيم .
وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن . . ، قالت : نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه .
وحدثنا أبي ، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .
ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير ، عن هشام ، به .
قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين : أجرة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا : هل يرد إذا أيسر ، على قولين : أحدهما : لا; لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا . وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي; لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . وقد قال الإمام أحمد :
حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لي مال ، ولي يتيم ؟ فقال : " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك - أو قال : تفدي مالك - بماله " شك حسين .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، حدثنا حسين المكتب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي يتيما عنده مال - وليس عنده شيء ما - آكل من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير مسرف " .
ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث حسين المعلم به .
وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه ، وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي ، عن جعفر بن سليمان ، عن أبي عامر الخزاز ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر : أن رجلا قال : يا رسول الله ، فيم أضرب يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك ، غير واق مالك بماله ، ولا متأثل منه مالا .
وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن يحيى ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاما ، وإن لهم إبلا ولي إبل ، وأنا أمنح في إبلي وأفقر ، فماذا يحل لي من ألبانها ؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها ، وتلوط حوضها ، وتسقي عليها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب .
ورواه مالك في موطئه ، عن يحيى بن سعيد به .
وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل - يقول عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة ، وإبراهيم النخعي ، وعطية العوفي ، والحسن البصري .
والثاني : نعم; لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة . وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر [ بن الخطاب ] رضي الله عنه : إنى أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن احتجت استقرضت ، فإذا أيسرت قضيت .
طريق أخرى : قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : قال لي عمر ، رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، وإن استغنيت استعففت .
إسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) يعني : القرض . قال : وروي عن عبيدة ، وأبي العالية ، وأبي وائل ، وسعيد بن جبير - في إحدى الروايات - ومجاهد ، والضحاك ، والسدي نحو ذلك . وروي من طريق السدي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ( فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل بثلاث أصابع .
ثم قال : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل من ماله ، يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم . قال : وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك .
وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه ، كما يضطر إلى [ أكل ] الميتة ، فإن أكل منه قضاه . رواه ابن أبي حاتم .
وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي نعيم القارئ قال : سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : ( فليأكل بالمعروف ) فقالا ذلك في اليتيم ، إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ، ولم يكن للولي منه شيء .
وهذا بعيد من السياق; لأنه قال : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) يعني : من الأولياء ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) أي : منهم ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالتي هي أحسن ، كما قال في الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) [ الإسراء : 34 ] أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .
وقوله : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) يعني : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [ منهم ] فحينئذ سلموهم أموالهم ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم ( فأشهدوا عليهم ) وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم; لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه .
ثم قال : ( وكفى بالله حسيبا ) أي : وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام ، وحال تسليمهم للأموال : هل هي كاملة موفرة ، أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا ذر ، إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تلين مال يتيم " .
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " وابتلوا اليتامى "، واختبروا عقول يتاماكم في أفهامهم، وصلاحهم في أديانهم، وإصلاحهم أموالهم، كما:-
8571 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن في قوله: " وابتلوا اليتامى "، قالا يقول: اختبروا اليتامى.
8572 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أما " ابتلوا اليتامى "، فجرِّبوا عقولهم.
8573 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " وابتلوا اليتامى "، قال: عقولهم.
8574 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " وابتلوا اليتامى "، قال: اختبروهم.
8575 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح "، قال: اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو. إذا عُرِف أنه قد أُنِس منه رُشد، دفع ليه ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام.
* * *
قال أبو جعفر: وقد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى " الابتلاء " الاختبار، بما فيه الكفاية عن إعادته. (116)
* * *
وأمّا قوله: " إذا بلغوا النكاح "، فإنه يعني: إذا بلغوا الحلم: كما:-
8576 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن &; 7-575 &; ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " حتى إذا بلغوا النكاح "، حتى إذا احتلموا.
8577 - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " حتى إذا بلغوا النكاح "، قال: عند الحلم.
8578 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " حتى إذا بلغوا النكاح "، قال: الحلم.
* * *
القول في تأويل قوله : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
قال أبو جعفر: يعني قوله: " فإن آنستم منهم رُشدًا "، فإن وجدتم منهم وعرفتم، كما:-
8579 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " فإن آنستم منهم رشدًا "، قال: عرفتم منهم.
* * *
يقال: "آنست من فلان خيرًا- وبِرًا "= (117) بمد الألف=" إيناسًا "، و " أنست به آنَسُ أُنْسًا "، بقصر ألفها، إذا ألِفه.
* * *
وقد ذكر أنها في قراءة عبدالله: ( فإن أحسيتم منهم رشدا )، (118) بمعنى: أحسستم، أي: وجدتم.
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى: " الرشد " الذي ذكره الله في هذه الآية. (119)
فقال بعضهم: معنى " الرشد " في هذا الموضع، العقل والصلاح في الدين.
* ذكر من قال ذلك:
8580 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فإن آنستم منهم رشدًا "، عقولا وصلاحًا.
8581 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " فإن آنستم منهم رشدًا "، يقول: صلاحًا في عقله ودينه.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحًا في دينهم، وإصلاحًا لأموالهم.
* ذكر من قال ذلك:
8582 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن مبارك، عن الحسن قال: رشدًا في الدين، وصلاحًا، وحفظًا للمال.
8583 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " فإن آنستم منهم رشدًا "، في حالهم، والإصلاحَ في أموالهم.
* * *
وقال آخرون: بل ذلك العقلُ، خاصة.
* ذكر من قال ذلك:
8584 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: لا ندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، (120) وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشده، العقل.
8585 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: "آنستم منهم رشدًا "، قال: العقل.
8586 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو شبرمة، عن الشعبي قال: سمعته يقول: إن الرجل ليأخُذُ بلحيته وما بلغ رُشده. (121)
* * *
وقال آخرون: بل هو الصلاح والعلم بما يصلحه.
* ذكر من قال ذلك:
8587 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: " فإن آنستم منهم رشدًا "، قال: صلاحًا وعلمًا بما يصلحه.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى " الرشد " في هذا الموضع، العقل وإصلاح المال (122) = لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجرَ عليه في ماله، وحَوْزَ ما في يده عنه، وإن كان فاجرًا في دينه. وإذْ كان ذلك إجماعًا من الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يَدي وصيِّ أبيه، أو في يد حاكم قد وَلي ماله لطفولته= واجبٌ عليه تسليم ماله إليه، إذا كان عاقلا بالغًا، مصلحًا لماله= غير مفسد، لأن المعنى الذي به يستحق أن يولَّى على ماله الذي هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد وليّ، (123) فإنه لا فرق بين ذلك.
وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح &; 7-578 &; ما في يده، الدليلُ الواضح على أنه غير جائز منْع يده مما هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد غيره، لا فرْق بينهما. ومن فرَّق بين ذلك، عُكِس عليه القول في ذلك، وسئل الفرق بينهما من أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعًا، (124) فبيُّنٌ أن " الرشد " الذي به يستحق اليتيم، إذا بلغ فأونس منه، دَفْعَ ماله إليه، ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله.
* * *
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره ولاةَ أموال اليتامى. يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الحلم، فآنستم منهم عقلا وإصلاحًا لأموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تحبسوها عنهم.
* * *
وأما قوله: " فلا تأكلوها إسرافًا "، يعني: بغير ما أباحه الله لك، (125) كما:-
8588 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن: " ولا تأكلوها إسرافًا "، يقول: لا تسرف فيها.
8589 - حدثنا محمد بن الحسين قال، (126) حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا &; 7-579 &; أسباط، عن السدي: " ولا تأكلوها إسرافًا "، قال: يسرف في الأكل.
وأصل " الإسراف ": تجاوز الحد المباح إلى ما لم يُبَحْ. وربما كان ذلك في الإفراط، وربما كان في التقصير. غير أنه إذا كان في الإفراط، فاللغة المستعملة فيه أن يقال: " أسْرف يُسرف إسرافًا "= وإذا كان كذلك في التقصير، فالكلام منه: " سَرِف يَسْرَفُ سَرَفًا "، يقال: " مررت بكم فسَرَفْتكم "، يراد منه: فسهوت عنكم وأخطأتكم، كما قال الشاعر: (127)
أَعْطَــوْا هُنَيْــدَةَ يَحْدُوهَـا ثَمَانِيَـةٌ
مَـا فِـي عَطَـائِهِمُ مَـنٌّ وَلا سَـرَفُ (128)
يعني بقوله: " ولا سرف "، لا خطأ فيه، يراد به: أنهم يصيبون مواضع العطاء فلا يخطئونها.
* * *
القول في تأويل قوله : وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " وبدارًا "، ومبادرة. وهو مصدر من قول القائل: " بادرت هذا الأمر مبادرة وبِدارًا ".
* * *
وإنما يعني بذلك جل ثناؤه ولاةَ أموال اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافًا -يعني ما أباح الله لكم أكله- ولا مبادرة منكم بلوغَهم وإيناسَ الرشد منهم، حذرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمه إليهم، كما:-
8590 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " إسرافًا وبدارًا "، يعني: أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ، فيحول بينه وبين ماله.
8591 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن: " ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا "، يقول: لا تسرف فيها ولا تبادره. (129)
8592 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وبدارًا "، تبادرًا أن يكبروا فيأخذوا أموالهم.
8593 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " إسرافًا وبدارًا "، قال: هذه لولي اليتيم يأكله، جعلوا له أن يأكل معه، إذا لم يجد شيئًا يضع يده معه، فيذهب يؤخره، يقول: " لا أدفع إليه ماله "، وجعلتَ تأكله تشتهي أكله، لأنك إذا لم تدفعه إليه لك فيه نصيب، وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب. (130)
* * *
وموضع " أن " في قوله: " أن يكبروا " نصبٌ بـ" المبادرة "، لأن معنى الكلام: لا تأكلوها مبادرة كِبرهم. (131)
* * *
القول في تأويل قوله : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " ومن كان غنيًّا "، من ولاة أموال اليتامى على أموالهم، فليستعفف بماله عن أكلها -بغير الإسراف والبدار أن يكبروا- بما أباح الله له أكلها به، كما:-
8594 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن الأعمش =وابن أبي ليلى، عن الحكم= عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: " ومن كان غنيًّا فليستعفف "، قال: بغناه من ماله، (132) حتى يستغنى عن مال اليتيم.
8595 - وبه قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: " ومن كان غنيًّا فليستعفف " بغناه.
8596 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: " ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: من مال نفسه، ومن كان فقيرًا منهم، إليها محتاجًا، فليأكل بالمعروف.
* * *
قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في" المعروف " الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به، إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها. (133)
فقال بعضهم: ذلك هو القرضُ يستقرضه من ماله ثم يقضيه.
* ذكر من قال ذلك:
8597 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنّي أنـزلت مالَ الله تعالى مني بمنـزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. (134)
8598 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية، عن زهير، عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: وهو القرض.
8599 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت يونس، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، أنه قال في هذه الآية: " ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: الذي ينفق من مال اليتيم، يكون عليه قرضًا.
8600 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال، سألت عبيدة عن قوله: " ومن &; 7-583 &; كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: إنما هو قرض، ألا ترى أنه قال: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؟ قال: فظننت أنه قالها برأيه.
8601 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا هشام، عن محمد، عن عبيدة في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، وهو عليه قرض.
8602 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: المعروف القرض، ألا ترى إلى قوله: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؟ (135)
8603 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة= مثل حديث هشام. (136)
8604 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، يعني القرض.
8605 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، يقول: إن كان غنيًّا، فلا يحل له من مال اليتيم أن يأكل منه شيئًا، وإن كان فقيرًا فليستقرض منه، فإذا وجد مَيْسرة فليعطه ما استقرض منه، فذلك أكله بالمعروف.
8606 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت أبي يذكر، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: يأكل قرضًا بالمعروف. (137)
8607 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حجاج، عن سعيد بن جبير قال: هو القرض، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر= يعني قوله: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ".
8608 - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا حماد قال، سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: إن أخذ من ماله قدر قوته قرضًا، فإن أيسر بعدُ قضاه، وإن حضره الموت ولم يوسر، تحلَّله من اليتيم. وإن كان صغيرًا تحلله من وليه. (138)
8609 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير: فليأكل قرضًا. (139)
8610 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: هو القرض.
8611 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا قضاه.
8612 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " فليأكل بالمعروف "، قال: قرضًا.
8613 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
8614 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فليأكل بالمعروف "، قال: سَلفًا من مال يتيمه.
8615 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد= وعن حماد، عن سعيد بن جبير=" فليأكل بالمعروف "، قالا هو القرض= قال الثوري: وقاله الحكم أيضًا، ألا ترى أنه قال: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؟
8616 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا حجاج، عن مجاهد قال:هو القرض، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر= يعني: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ".
8617 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: " فليأكل بالمعروف "، قال: القرض، ألا ترى إلى قوله: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ؟
8618 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قرضًا.
8619 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير قال: إذا احتاج الوليُّ أو افتقر فلم يجد شيئًا، أكل من مال &; 7-586 &; اليتيم وكَتَبه، فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة، دعا اليتيمَ فاستحلَّ منه ما أكل.
8620 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، من مال اليتيم، بغير إسراف ولا قضاءَ عليه فيما أكل منه.
* * *
واختلف قائلو هذا القول في معنى: " أكل ذلك بالمعروف ". فقال بعضهم: أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع، ولا يلبس منه.
* ذكر من قال ذلك:
8621 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن السدي قال، أخبرني من سمع ابن عباس يقول: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: بأطراف أصابعه.
8622 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عمن سمع ابن عباس يقول، فذكر مثله. (140)
8623 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، يقول: " فمن كان غنيًا " مَنْ وَلِيَ مال اليتيم، فليستعفف عن أكله (141) =" ومن كان فقيرًا "، مَنْ وَلِيَ مال اليتيم، فليأكل معه بأصابعه، لا يسرف في الأكل، ولا يلبس.
8624 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا حرمي بن عمارة قال، حدثنا شعبة، عن عمارة، عن عكرمة في مال اليتيم: يدُك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قَلَنْسُوة.
8625 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وعكرمة قالا تضع يدك مع يده.
* * *
وقال آخرون: بل " المعروف " في ذلك: أن يأكل ما يسدُّ جوعه، ويلبس ما وارَى العورة.
* ذكر من قال ذلك:
8626 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: إن المعروف ليس بِلبس الكتَّان ولا الحُلَل، ولكن ما سدَّ الجوع ووارى العورة.
8627 - حدثنا بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: ليس المعروف بلبس الكتان والحلل، ولكن المعروفَ ما سد الجوع ووارى العورة.
8628 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم نحوه.
8629 - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثنا أبو معبد قال: سئل مكحول عن وَالي اليتيم، ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس من ثيابه، فأما أن يتخذ من ماله مالا لنفسه فلا.
8630 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " فليأكل بالمعروف "، قال: ما سد الجوع ووارى &; 7-588 &; العورة. أما إنه ليس لَبُوس الكتان والحلل. (142)
* * *
وقال آخرون: بل ذلك " المعروف "، أكل تمْره، وشرب رِسْل ماشيته، (143) بقيامه على ذلك، فأما الذهب والفضة، فليس له أخذ شيء منهما إلا على وجه القرض.
* ذكر من قال ذلك:
8631 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أموالَ أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عباس: ألست تبغي ضالتها؟ (144) قال: بلى! قال: ألست تهنأ جَرْباها؟ (145) قال: بلى! قال: ألست تَلُطُّ حياضها؟ (146) قال: بلى! قال: ألست تَفْرِط عليها يوم وِرْدها؟ (147) قال: بلى! قال: فأصِبْ من رسلها= يعني: من لبنها.
8632 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتامًا، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفقر، (148) فماذا يحلّ لي من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، (149) وتسقى عليها، (150) فاشرب غير مُضرّ بنسل، (151) ولا ناهكٍ في الحلب. (152)
8633 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن أبي العالية في هذه الآية: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: من فَضل الرِّسل والتمرة. (153)
8634 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن أبي العالية في والي مال اليتيم قال: يأكل من رسل الماشية ومن التمرة لقيامه عليه، ولا يأكل من المال. وقال: ألا ترى أنه قال: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ؟
8635 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال سمعت داود، عن رُفيع أبي العالية قال: رُخّص لولي اليتيم أن يصيب من الرِّسل ويأكل من التمرة، وأما الذهب والفضة فلا بد أن تردّ. ثم قرأ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، ألا ترى أنه قال: " لا بد من أن يدفع "؟ (154)
8636 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عوف، عن الحسن أنه قال: إنما كانت أموالهم إذْ ذاك النخل والماشية، (155) فرخّص لهم إذا كان أحدهم محتاجًا أن يصيب من الرِّسْل.
8637 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: إذا كان فقيرًا أكل من التمر، (156) وشرب من اللبن، وأصاب من الرسل.
8638 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، ذكر لنا أن عَمَّ ثابت بن رفاعة =وثابت يومئذ يتيمٌ في حجره= من الأنصار، أتى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن ابن أخي يتيمٌ في حجري، فما يحلُّ لي من ماله؟ قال: أن تأكل بالمعروف، من غير أن تقي مالك بماله، ولا تتخذ من ماله وَفْرًا. (157) وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل، (158) فيقوم وليه على صلاحه وَسقيه، فيصيب من تمرته، (159) أو تكون له الماشية، فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها ومؤونتها، فيصيب من جُزَازها وَعوارضها ورِسْلها. (160) فأما رقاب المال وأصول المال، (161) فليس له أن يستهلكه. (162)
8639 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد ابن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، يعني ركوب الدابة وخدمة الخادم. فإن أخذ من ماله قرضًا في غنى، فعليه أن يؤديه، وليس له أن يأكل من ماله شيئا.
* * *
وقال آخرون منهم: له أن يأكل من جميع المال، إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه.
* ذكر من قال ذلك:
8640 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسماعيل بن صبيح، عن أبي أوَيس، عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعًا، عن القاسم بن محمد قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما يصلُح لوليّ اليتيم قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف. (163)
8641 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يقول: يحل لوليِّ الأمر ما يحلّ لولي اليتيم: " من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ".
8642 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا الفضل بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه.
8643 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قالا ذكر الله تبارك وتعالى مال اليتامى فقال: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، ومعروفُ ذلك: أن يتقي الله في يتيمه.
8644 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى قضاءً على وليّ اليتيم إذا أكل وهو محتاجٌ.
8645 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: " فليأكل بالمعروف "، في الوصي، قال: لا قضاء عليه.
8646 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال في هذه الآية: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: إذا عمل فيه وليُّ اليتيم أكل بالمعروف.
8647 - حدثنا بشر بن محمد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إذا احتاج أكل بالمعروف من المال طُعْمَةً من الله له. (164)
8648 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن البصري قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في حجري يتيمًا، أفأضربه؟ قال: فيما كنت ضاربًا منه ولدك؟ قال: أفأصيب من ماله؟ قال: بالمعروف، غير متأثِّل مالا ولا واقٍ مالك بماله. (165)
8649 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسى، عن الحسن البصري، مثله. (166)
8650 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء أنه قال: يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم، كقَدْر خدمته وقَدْرِ عمله.
8651 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: والي اليتيم، إذا كان محتاجًا، يأكل بالمعروف لقيامه بماله.
8652 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد، وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، قال: إن استغنى كفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم، لِقيامه على أموالهم، وحفظه إياها، يأكل مما يأكلون منه. وإن استغنى كفَّ عنه ولم يأكل منه شيئًا.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: " المعروف " &; 7-594 &; الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه= فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله. (167)
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعًا منهم أنه غير مالكه، (168) وكان غيرَ جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره، يتيمًا كان ربُّ المال أو مدركًا رشيدًا= وكان عليه إن تعدَّى فاستهلكه بأكل أو غيره، ضمانه لمن استهلكه عليه، بإجماع من الجميع= وكان والي اليتيم سبيلُه سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه = (169) كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه، سبيلُه سبيلُ غيره، وإن فارقه في أنّ له الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه، إذا كان قيِّمًا بما فيه مصلحته.
* * *
ولا معنى لقول من قال: " إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع، أكل والي اليتيم من مال اليتيم، لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عَمله وسعيه ". لأنّ لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره، إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة، كما يستأجر له غيره من الأجَراء، وكما يشتري له مَن يعينه، (170) غنيًّا كان الوالي أو فقيرًا.
وإذ كان ذلك كذلك= وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله: " ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "، على أن أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من وُلاته في حال الفقر والحاجة= وكانت الحالُ التي للولاة &; 7-595 &; أن يُؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء، غير مخصوص بها حال غِنًى ولا حال فقر = (171) كان معلومًا أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم، غير المعنى الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال.
ومن أبى ما قلنا، ممن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض، استدلالا بهذه الآية= قيل له: أمجمَعٌ على أن الذي قلت تأويل قوله: " ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "؟
فإن قال: لا!
قيل له: فما برهانك على أن ذلك تأويله، وقد علمت أنه غيرُ مالك مالَ يتيمه؟
فإن قال: لأن الله أذن له بأكله!
قيل له: أذن له بأكله مطلقًا أم بشرط؟ (172)
فإن قال: بشرطٍ، وهو أن يأكله بالمعروف.
قيل له: وما ذلك " المعروف "؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضًا وسلَفًا؟
ويقال لهم أيضًا مع ذلك: أرأيت المولَّى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه، ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لهم؟ فإن قالوا: ذلك لهم= خرجوا من قول جميع الحجة.
وإن قالوا: ليس ذلك لهم.
قيل لهم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكمُ ولاتهم واحدٌ: في أنهم ولاة أموال غيرهم؟
فلن يقولوا في أحدهما شيئًا إلا ألزموا في الآخر مثله. (173)
ويُسألون كذلك عن المحجور عليه: هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالِنَاهُمْ عن أموال المجانين والمعاتيه.
* * *
القول في تأويل قوله عز وجل : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم، يا معشرَ ولاة أموال اليتامى، إلى اليتامى أموالهم=" فأشهدوا عليهم "، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم، ودفعكموه إليهم، كما:-
8653 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم "، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله، فليدفعه إليه بالشهود، كما أمره الله تعالى.
* * *
القول في تأويل قوله : وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكفى بالله كافيًا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه، كما:-
8654 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وكفى بالله حسيبًا "، يقول: شهيدًا.
* * *
يقال منه: " قد أحسبني الذي عندي"، يراد به: كفاني. وسمع من العرب: " لأحْسِبَنَّكم من الأسودين "= يعني به: من الماء والتمر (174) =" والمُحْسِب " من الرجال: المرتفع الحسب،" والمُحْسَب "، المكفِيُّ. (175)
* * *
---------------
الهوامش :
(116) انظر تفسير"الابتلاء" فيما سلف 2: 49 / 3: 7 ، 220 / 5: 339 / 7: 297 ، 325 ، 454.
(117) في المطبوعة: "آنست من فلان خيرًا وقرئ بمد الألف" ، لم يحسن قراءة"وبرًا" في المخطوطة ، فأفسد الكلام إفسادًا.
(118) في معاني القرآن للفراء 1: 257: "فإن أحستم" بسين واحدة ساكنة ، وفي بعض نسخه كما في تفسير الطبري ، أما في المخطوطة فقد كتب في الموضعين: "أحسستم" بسينين ، وهو خطأ ، والصواب ما في المطبوعة ، وما في معاني القرآن للفراء.
(119) انظر تفسير"الرشد" فيما سلف 3: 482 / 5: 416.
(120) قوله: "أخذ بلحيته" يعني: الشيب أخذ بلحيته ، وانظر الأثر التالي: 8586.
(121) الأثر: 8586-"أبو شبرمة" كنية"ابن شبرمة" ، وهو القاضي الفقيه المفتي"عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي". وكان عفيفًا حازمًا عاقلا فقيها ، يشبه النساك ، ثقة في الحديث ، شاعرًا ، حسن الخلق ، جوادا.. هكذا وصفوه رحمه الله.
(122) انظر التعليق السالف ص: 576 ، تعليق: 1 ، في مراجع تفسير"الرشد".
(123) في المخطوطة والمطبوعة: "في يد ولي" ، والصواب حذف هذه الهاء ، فإنه مفسدة للكلام ولو قرئت: "في يد وليه" لكانت جيدة.
(124) في المطبوعة: "فإن كان ما وصفنا" ، والصواب من المخطوطة.
(125) في المطبوعة: "أباحه الله لكم" بالجمع ، وأثبت ما في المخطوطة. وانظر تفسير "أكل المال" فيما سلف 3: 548- 551 / 7: 528.
(126) الأثر: 8589-"محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حنين الكوفي" ، مضت ترجمته برقم: 7120 ، وكان في المخطوطة والمطبوعة: "محمد بن الحسن" ، وهو خطأ ، فهذا إسناد دائر في التفسير.
(127) هو جرير.
(128) ديوانه: 389 ، وطبقات فحول الشعراء: 359 ، والاشتقاق: 241 ، واللسان (هند) (سرف) ، وغيرها ، وسيأتي في التفسير 8: 46 / 30: 159 (بولاق) ، من قصيدته التي مدح بها يزيد بن عبد الملك ، وهجا آل المهلب ، يقول ليزيد ، قبله:
أرْجُــو الفَـوَاضِلَ إِنَّ اللـه فَضَّلَكُـمْ
يَـا قَبْـل نَفْسِـكَ لاقَـى نَفْسِيَ التَّلَفُ
مَـا مَـنْ جَفَانَـا إذَا حَاجَاتُنَـا نَـزَلَتْ
كَـمنْ لَنَـا عِنْـدَه التكْـرِيمُ واللَّطَـفُ
كَـمْ قَـد نَـزَلْتُ بِكُـمْ ضَيْفًا، فَتُلْحِفُنِي
فَضْـلَ اللِّحَـافِ، وَنِعْمَ الفَضْـلُ يُلْتَحَفُ
وقوله: "هنيدة" اسم لكل مئة من الإبل ، لا تصرف ، ولا تدخلها الألف واللام ، ولا تجمع ، ولا واحد لها من جنسها. و"هند" مثلها في المعنى ، وبه سميت المرأة فيما أرجح ، تساق في مهرها مئة من الإبل ، من كرامتها وعزها ورغبة الأزواج فيها لشرفها. وقوله: "ثمانية" أي ثمانية من العبيد يقومون بأمرها.
(129) في المطبوعة: "ولا تبادر" بغير هاء في آخره ، وأثبت ما في المخطوطة.
(130) كانت هذه الجملة في المخطوطة هكذا فاسدة الكتابة غير منقوطة: "هذه لولى اليتيم يأكله جعلوا له أن يأكل معه إذا لم يجد سببا يضع معه يده ، فذهب دوحره يقول لا أدفع إليه ماله وجعلت تأكله لسهى أكله ، لأنك لم تدفعه إليه..." ، وهي فاسدة. أما المطبوعة فقد صححها وكتب: "هذه لولي اليتيم خاصة وجعل له" ، وأساء فيما قرأ وفيما كتب. ثم كتب"فيذهب بوجهه" مكان"يؤخره" ، وقد أساء. ثم زاد"إن" في قوله: "لأنك لم تدفعه إليه"فجعلها""لأنك إن لم تدفعه إليه" ، وقد أصاب ، ولكني آثرت"إذا".
(131) انظر معاني القرآن للفراء 1: 257.
(132) في المطبوعة والمخطوطة: "لغناه عن ماله" ، والصواب بالباء.
(133) انظر تفسير"المعروف" فيما سلف ص: 573 تعليق: 2 ، والمراجع هناك.
(134) الأثر: 8597-"حارثة بن مضرب الكوفي" ، روى عن عمر ، وعلي ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. مترجم في التهذيب ، والكبير 2 / 1 / 87 ، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 255. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "حارثة بن مصرف" ، وهو خطأ وتصحيف.
(135) الأثر: 8602-"سلمة بن علقمة التميمي" ، روى عن محمد بن سيرين. ثقة. مترجم في التهذيب. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "سلمة عن علقمة" ، وهو خطأ ، وانظر الإسناد السالف رقم: 8600 ، جاء على الصواب.
(136) يعني رقم: 8601.
(137) الأثر: 8606-"ابن إدريس" هو"عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي" شيخ أبي كريب ، مضى مرارًا. وكان في المطبوعة والمخطوطة"أبو إدريس" ، وهو خطأ. و"أبوه" هو"إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي" ، روى عن أبيه ، وأبي إسحاق السبيعي ، وسماك بن حرب وغيرهم. مترجم في التهذيب. وكان في المخطوطة"سمعت أبي بكر" ، والصواب ما في المطبوعة.
(138) في المخطوطة: "حلله من وليه" ، ولعلها"حلله منه وليه" ، والذي في المطبوعة موافق للسياق.
(139) في المخطوطة: "فلا يأكل قرضًا" ، وهو خطأ ، والصواب ما في المطبوعة.
(140) الأثر: 8622-"عبيد الله الأشجعي" هو"عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي". قال ابن معين: "ما كان بالكوفة أعلم بسيفان الثوري من الأشجعي". وهو ثقة مأمون. مترجم في التهذيب. وكان في المطبوعة: "عبد الله الأشجعي" ، وهو خطأ.
(141) في المطبوعة: "فليستعفف عن ماله" ، وأثبت الصواب من المخطوطة.
(142) الأثر: 8630-"الأشجعي" ، هو"عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي" ، مضى قريبًا في التعليق على الأثر رقم: 8622.
(143) "الرسل" (بكسر الراء وسكون السين): اللبن.
(144) "بغى الضالة بغاء وبغية وبغاية" (كلها بضم الباء): نشدها وطلبها.
(145) هنأ البعير الأجرب يهنؤه ، إذا طلاه بالهناء (بكسر الهاء) ، وهو القطران ، يعالج به من الجرب.
(146) "لط الحوض يلطه لطًا": ألصقه بالطين حتى يسد خلله ، قال ابن الأثير: "كذا جاء في الموطأ" انظر الموطأ: 934 ، ويشير به إلى الرواية الأخرى"تلوط" ، كما ستأتي في الأثر التالي. وكان في المطبوعة هنا"تليط". ، وهي صواب أيضًا ، جاء في رواية حديث أشراط الساعة: "ولتقومن وهو يليط حوضه ، " أي يطينه أيضًا. ولكنها لم تجيء في المخطوطة ولا في مكان غيره أعرفه.
(147) "فرط يفرط فرطًا": إذ سبق الواردة الإبل إلى الماء ، فهيأ لها الأرسان والدلاء ، وملأ الحياض واستقى لهم. و"يوم الورد" بكسر الراء ، وهو يومها الذي ترد فيه الماء. وكان في المطبوعة: "يوم ورودها" ، وهي صحيحة المعنى ، والذي في المخطوطة هو محض الصواب.
(148) "منح الشاة والناقة يمنحها منحًا": أعارها من لا ناقة له ، يأخذ من لبنها ويرعى عليها. ثم يردها عليه. و"أفقرت فلانًا بعيرًا" إذا أعرته بعيرًا يركب ظهره في سفره ثم يرده إليك ، وهو من"فقار" الظهر ، أي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب.
(149) "لاطه الحوض يلوطه لوطًا": طلاه بالطين وملسه. انظر التعليق السالف ص: 588 ، رقم: 5.
(150) في المخطوطة: "وتسعى عليها" وهو خطأ ، ورواية الموطأ: "وتسقيها يوم وردها".
(151) "نهكت الناقة حلبًا أنهكها" ، إذا بالغت في حلبها ونقصها ، فلم يبق في ضرعها لبن. و"الحلب" (بفتح الحاء واللام) و"الحلب" (بسكون اللام) و"الحلاب" مصدر"حلب الشاء والإبل والبقر يحلبها": إذا استخرج ما في ضرعها من اللبن.
(152) الأثران: 8631 ، 8632- رواه مالك في الموطأ من طريق"يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد" كرواية الأثر الثاني هنا ، مع اختلاف في بعض اللفظ ، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 93 ، ونسبه السيوطي في الدر المنثور 1: 122 ، إلى مالك ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس في ناسخه.
(153) في المطبوعة: "والثمرة" بالثاء المثلثة ، وأثبت ما في المخطوطة هنا ، وستأتي بالمثلثة في المخطوطة في الآثار التالية ، ولكن صوابها"بالتاء" ، وانظر حجتنا في ذلك في الأثر رقم: 8636.
(154) الأثر -8635-"رفيع بن مهران الرياحي" ، "أبو العالية" مضى برقم: 44 ، 184 ومواضع غيرها ، وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا"رفيع عن أبي العالية" بزيادة"عن" وهو خطأ محض.
(155) في المطبوعة: "أدخال النخل والماشية" ، وفي المخطوطة: "ادحال" ، ولم أجد لشيء من ذلك معنى ، مع تقليبها على أكثر وجوه التصحيف ، ثم هديت إلى أن أرجح أن يكون صوابها ما أثبت ، وكأن الناسخ رأي"ذال": "ذاك" متصلة بألفها فظنها"حاء" ، فكتب"الكاف" المتطرفة "لامًا" والذي أثبته هو حاق السياق إن شاء الله.
(156) في المطبوعة: "من الثمر" بالثاء المثلثة ، وأثبت ما في المخطوطة ، وانظر التعليق السالف ص: 589 ، رقم: 6.
(157) "وفر ماله وفرًا": حاطه حتى يكثر ويصير وافرًا ، يعني: أن يتأثل مالا لنفسه ويجمعه من مال يتيمه.
(158) "الحائط" البستان من النخل ، إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ، فإذا لم يحيط فهو"ضاحية".
(159) في المطبوعة: "ثمرته" ، والصواب من المخطوطة ، وانظر ص589 تعليق: 6 والتعليق السالف: 3.
(160) الجزاز والجزازة (بضم الجيم) والجزز (بفتحتين) والجزة (بكسر الجيم وتشديد الزاي) ، وجمعها جزز (بكسر ففتح): هو ما يجزه من صوف الشاة وغيرها. ورواية اللسان والفائق للزمخشري"جززها" جمع"جزة"."والعوارض" جمع عارضة ، وهي الشاة أو البعير تصيبه آفة أو كسر أو داء فيذبحونها ، ومن هجائهم: "بنو فلان لا يأكلون إلا العوارض" ، أي: لا ينحرون الإبل إلا من داء يصيبها."والرسل" اللبن.
(161) "رقاب المال" يعني من الأنعام ، و"أصول المال" يعني من النخيل.
(162) الأثر: 8638- ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ، في ترجمة"ثابت بن رفاعة" ، ولم ينسبه لابن جرير ، ونسبه لابن مندة ، وابن فتحون ، من طريق عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، وقال: "هذا مرسل ، رجاله ثقات".
(163) الأثر: 8640-"إسماعيل بن صبيح اليشكري" مضى برقم: 2996. و"أبو أويس
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] كل نكاح في القرآن: تزوج, إلا ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ فالاحتلام.
لمسة
[6] ما الفرق بين الرُّشد والرَّشد في القرآن الكريم؟ الرُّشد (بالضم) معناه: الصلاح والاستقامة، وهي عامة في أمور الدين والدنيا، في الأمور الدنيوية والأخروية، هنا ورد الرُشد: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا﴾ أمر دنيوي، ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، إذن الرُشد يستعمل في أمور الدنيا والدين، أما الرَشد (بالفتح) أغلب ما يستعمل في أمور الآخرة في أمور الدين: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]، ﴿وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤]، وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآني.
وقفة
[6] الأمر بوجود شاهد عند دفع المال لليتيم تبرئة لذمة القائم على المال، وحفظًا لسمعته ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.
وقفة
[6] ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ الحقوق المالية توثق؛ حتى ولو كانت بين الأقربين.
لمسة
[6] إنما قال: ﴿حَسِيبًا﴾ ولم يقل: (شهيدًا) مع مناسبته؛ تهديدًا للأوصياء لئلا يكتموا شيئًا من مال اليتامى، فإذا علموا أن الله يحاسبهم على النقير والقطمير، ويعاقبهم عليه، انزجروا عن الكتمان.
الإعراب :
- ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتامى: ﴾
- الواو: عاطفة. ابتلوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. اليتامى: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر.
- ﴿ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: ﴾
- حتى: حرف غاية للابتداء. اذا: ظرف زمان مبني على السكون متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه. بلغوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «بَلَغُوا» في محل جر بالاضافة. النكاح: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: ﴾
- الفاء: استئنافية. إن: حرف شرط جازم آنستم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلمين. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور. والفعل «آنس» في محل جزم لأنه فعل الشرط. منهم: جار ومجرور متعلق بآنس أو في محل نصب حال لأنه متعلق بصفة مقدمة على «رُشْداً» و «هم» ضمير الغائبين قي محل جر بمن. رشدا: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ﴾
- الفاء: واقعة في جواب الشرط. ادفعوا: تعرب اعراب «ابْتَلُوا» وجملة «فَادْفَعُوا» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم اليهم: جار ومجرور متعلق بادفعوا. اموالهم: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين المتصل في محل جر بالاضافة وجملتا فعل الشرط وجوابه: ان آنستم .. فادفعوا .. وقعتا جوابا لإذا بلغوا. أي وابتلوا اليتامى الى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفع أموالهم اليهم بشرط إيناس الرشد منهم.
- ﴿ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً: ﴾
- الواو: حرف عطف. لا: ناهية جازمة. تأكلوها: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به. اسرافا: حال منصوب بالفتحة وبدارا معطوفة بالواو على «إِسْرافاً» وتعرب اعرابها أي مسرفين ومبادرين ويجوز أن تكون «إِسْرافاً» مفعولا لأجله.
- ﴿ أَنْ يَكْبَرُوا: ﴾
- أن: حرف مصدرية ونصب. يكبروا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وأن وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر أو في محل نصب ببدار.
- ﴿ وَمَنْ كانَ غَنِيًّا: ﴾
- الواو: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. واسمها: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. غنيا:خبر «كانَ» منصوب بالفتحة وجملتا فعل الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ «مَنْ».
- ﴿ فَلْيَسْتَعْفِفْ: ﴾
- الفاء: رابطة لجواب الشرط اللام: لام الأمر. يستعفف: فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «فَلْيَسْتَعْفِفْ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.
- ﴿ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: ﴾
- معطوفة بالواو على «وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ». بالمعروف: جار ومجرور متعلق بيأكل أو بصفة محذوفة لمصدر محذوف تقديره: أكلا بالمعروف
- ﴿ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ﴾
- الفاء: استئنافية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمان حرف شرط غير جازم خافض لشرطه متعلق بجوابه. دفعتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطبين. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور وجملة «دَفَعْتُمْ» في محل جر بالاضافة إليهم. أموالهم: سبق اعرابهما.
- ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ: ﴾
- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها. الفاء: واقعة في جواب الشرط وما بعدها يعرب اعراب «ادفعوا اليهم».
- ﴿ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً: ﴾
- الواو: استئنافية. كفى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. بالله: الباء حرف جر زائد للتوكيد. لفظ الجلالة مجرور للتعظيم لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل الفعل «كَفى». حسيبا: تمييز منصوب بالفتحة. '
المتشابهات :
| النساء: 6 | ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا ﴾ |
|---|
| الأحزاب: 39 | ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالتوَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف. * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في ذكر نزول الآية بدون قصة وقد أورده بعض المفسرين عند ذكر الآية كالقرطبي وابن كثير والطاهر بن عاشور لكنهم لم يشيروا إلى أن الحديث سبب نزولها.وقد أخرج أبو داود والنَّسَائِي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقالكل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل). وهذا الحديث ليس فيه ذكر لسبب النزول لكن إذا ضممته إلى حديث عائشة في قولها: أنزلت في والي اليتيم، وقولها: إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف، فإنه يوافقه من وجهين:الأول: أن الرجل في حديث عمرو بن شعيب هو ولي اليتيم، والآية أنزلت في والي اليتيم.الثاني: أن الرجل قال إني فقير ليس لي شيء، وهذا يوافق قولها: إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف، ولعل مما يعضد هذا النظر سياق الآية فإنه يوافق كثيرًا حديث عمرو بن شعيب ففي الآيةوَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا) وفي الحديثكل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر).ولقائل أن يقول إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال هذا الحديث أخذاً واستنباطاً من الآية فوافق لفظه لفظها.فالجواب: أن هذا ممكن لكن يعكر عليه قول عائشة: أُنزلت في والي اليتيم فإن هذا مشعر بوجود سبب، ولو لم يوجد حديث عمرو بن شعيب لكان الجزم ممكناً بأنها أرادت التفسير ولم ترد الحديث عن سبب نزول معين والله أعلم. * النتيجة: الحديث المذكور لا يتضمن التصريح بالسببية، لكن بضم الحديثين إلى بعضهما، وانضمامهما إلى الآية الكريمة يغلب على الظن نزول الآية بسبب سؤال الرجل للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكله من مال اليتيم والعلم عند الله تعالى.'
- المصدر لباب النقول
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد النهي عن إعطاء المال للسفهاء من الأيتام وغيرهم؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا الوقت الذي يتم فيه تسليم أموال اليتامى إليهم، قال تعالى:
﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾
القراءات :
فإن آنستم:
وقرئ:
فإن أحسستم، يريد: فإن أحسستم، فحذف عين الكلمة، وهى قراءة ابن مسعود.
رشدا:
وقرئ:
1- بفتحتين، وهى قراءة ابن مسعود، وأبى عبد الرحمن، وأبى السمال، وعيسى الثقفي.
2- بضمتين، وهى قراءة شاذة.