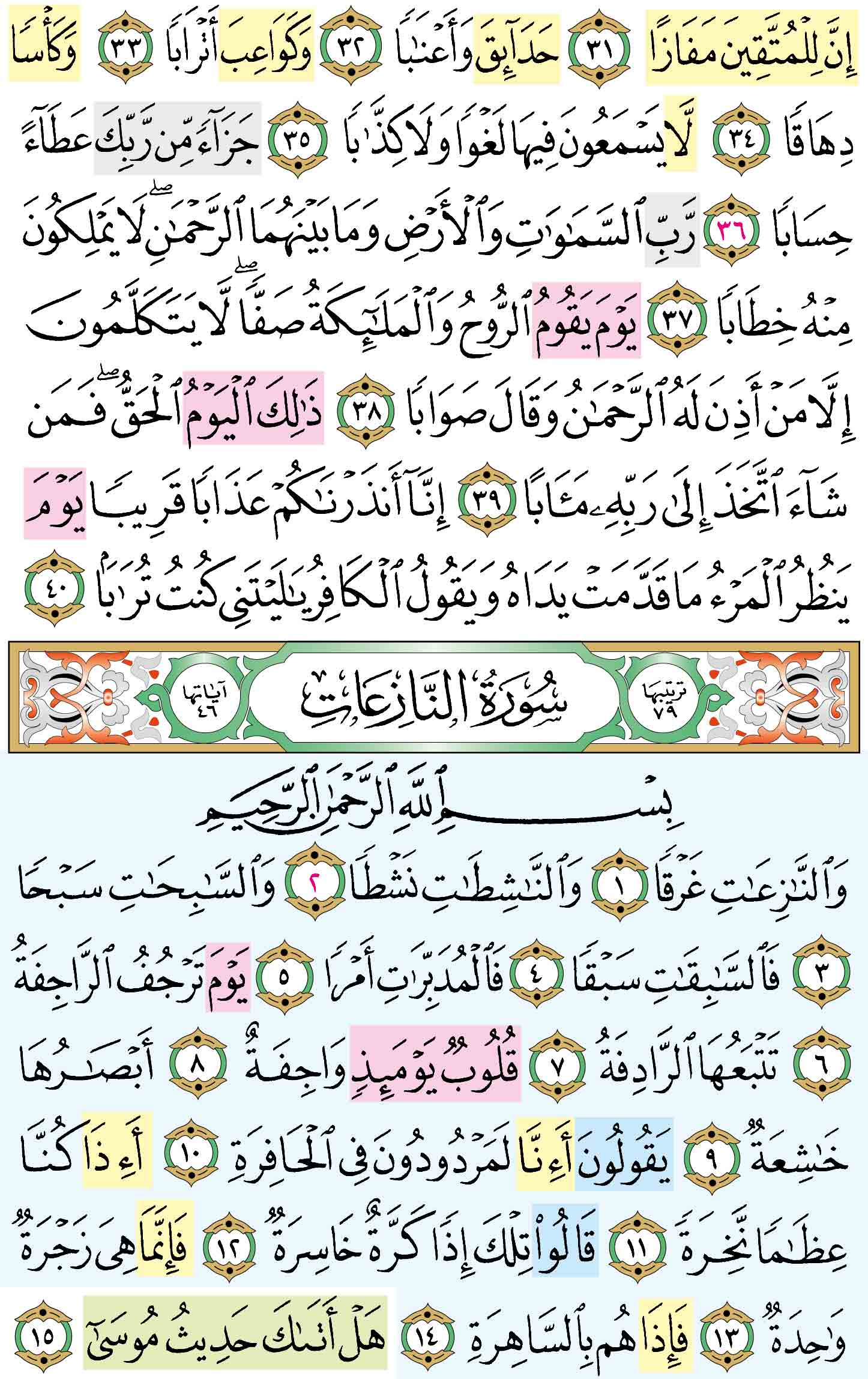
الإحصائيات
سورة النبإ
| ترتيب المصحف | 78 | ترتيب النزول | 80 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |
| عدد الآيات | 40 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |
| ترتيب الطول | 75 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| القسم: 2/6 | _ | ||
سورة النازعات
| ترتيب المصحف | 79 | ترتيب النزول | 81 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |
| عدد الآيات | 46 | عدد الأجزاء | 0.00 |
| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |
| ترتيب الطول | 76 | تبدأ في الجزء | 30 |
| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| القسم: 7/17 | _ | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (31) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (10)
بعدَ ذِكرِ عذابِ الكافرينَ ذكرَ نعيمَ المُتَّقينَ، ثُمَّ خَتَمَ السُّورةَ بالإخبارِ عن عظمتِه وجلالِه، وتهديدِ الكُفَّارِ وإنذارِهم عذابًا قريبًا، يومَ يتمنَّى الكافرُ لو صارَ ترابًا مثلَ الحيواناتِ من شدَّةِ الحسرةِ والنَّدمِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
المقطع الثاني
من الآية رقم (1) الى الآية رقم (14) عدد الآيات (14)
القَسَمُ بالملائكةِ على وقوعِ البعثِ، ووصفُ حالِ المشركينَ المُنكرينَ البعثَ، ومدى الخوفِ الشَّديدِ الذي يكونونَ عليه يومَ القيامةِ.
فيديو المقطع
قريبًا إن شاء الله
مدارسة السورة
سورة النبإ
إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين
أولاً : التمهيد للسورة :
- • ومن مقاصد سورة النبأ:: • السورة تنبيه للقلوب الغافلة عن يوم القيامة (النبأ العظيم)، وما فيه من الشدائد والأهوال؛ ليندفع العبد إلى العمل الجاد المثمر، فالزرع هنا والحصاد هناك. • السورة لفت لنظر المشركين والمشككين إلى الآيات الكونية كبراهين وأدلة على البعث بعد الموت.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «النبأ».
- • معنى الاسم :: النبأ: الخبر، والجمع أنباء.
- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ كَلِمَةِ «النَّبَأِ» فِي أَوَّلِهَا.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ عَمَّ»، و«عم يتساءلون»، و«المعصرات».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: تذكر يوم القيامة.
- • علمتني السورة :: أن الطغيان سبب دخول النار: ﴿لِّلطَّاغِينَ مَآبًا﴾
- • علمتني السورة :: أن عدم الإيمانِ بالحسابِ أو الغفلة عنه سببٌ لتكاثرِ السَّيئاتِ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾
- • علمتني السورة :: تذكَّر ذنبًا عملتَه، ثمَّ استغفِر اللهَ: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة النبأ من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة النبأ من المفصل.
• سورة النبأ من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة النبأ مع سورة المرسلات، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم.
• سورة النبأ أول سورة في الجزء الثلاثين، والذي سُمِّى بما افتتحت به سورة النبأ: (جزء عَمَّ)، وبه 37 سورة -أي تقريبًا ثلث عدد سور القرآن الكريم البالغة 114 سورة-، وكلها مكية إلا البينة والنصر.
• سورة النبأ أُولى سور (أوساط المفصل)، وعددها 15 سورة، تبدأ بالنبأ وتنتهي بالليل.
• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.
• السورة يشيع فيها جو التخويف والتهديد والإنذار، حتى يكاد التالي لها أن يتملكه الذعر والخوف من شدائدها وأهوالها.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعد ليوم القيامة.
• أن نبين للناس إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين.
• أن نحرص على النوم مبكرًا: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (10، 11).
• أن نخوف أنفسنا بهذه الآية: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ (17)، إذا تمردت علينا أنفسنا وانساقت خلف الهوى والدنيا.
• أن نستعذ بالله من عذاب جهنم: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ (21).
• أن نراقب الله، ونتيقن أن كل أفعالنا مكتوبة مسجلة: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (29).
• أن نمتنع عن خمر الدنيا؛ لنتلذذ بشراب الآخرة: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ (34).
• أن نترك اللغو ونبتعد عنه: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ (35).
• أن نعظم الله تعالى، ونوقره: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (38).
أن نصحِّح حياتنا الآن قبل أن نقول: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾ (40).
سورة النازعات
تذكرة بالموت وخروج الروح، والبعث، والقيامة وأهوالها
أولاً : التمهيد للسورة :
- • سورة النازعات دعوة للتفكر:: سورة النازعات جاءت تهز القلوب المكذبة بالبعث والجزاء، من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «النازعات».
- • معنى الاسم :: النازعات: اسم فاعل من النزع، وهو جذب الشئ من مقره، والنازعات: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا شديدًا.
- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالنازعات.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «السَّاهِرَةُ»، و«الطَّامَّةُ».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: تذكر الموت وخروج الروح، والبعث، والقيامة وأهوالها.
- • علمتني السورة :: أن قبض روح الكافر يكون بشدّة وعنف، وأن قبض روح المؤمن يكون برفق ولين: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾
- • علمتني السورة :: دعوة الناس إلى الله بأسلوب حكيم: ﴿فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ﴾
- • علمتني السورة :: أن إمهال الله للطغاة تنكيلًا بهم، وليس حبًا لهم، فإذا حانت ساعتهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّـهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».
وسورة النازعات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَالقُرآنِ المُفَصَّلُ».
وسورة النازعات من المفصل.
• سورة النازعات من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة النازعات مع سورة المعارج، ويقرأهما في ركعة واحدة.
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًاكَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».
وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • سورة النازعات احتوت على آخر آية -بحسب ترتيب المصحف- ذُكِرَ فيها كلمة (يسألونك)، في الآية (42)، وقد ذُكِرَت هذه الكلمة في القرآن الكريم 15 مرة، وفي كل مرة تعقبها كلمة (قل) إلا آية النازعات؛ فلم ترد بها هذه الكلمة.
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستعد ليوم القيامة.
• أن نسابق الملائكة بالعمل: ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ (4).
• أن نحرص على دعوة أيّ شخص إلى الله مهما بلغَ طغيانُه: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (17).
• أن نعمل عملًا صـالحًا نتمنَّى أن نتذكَّرَه يومَ القيـامةِ: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ (35).
• أن نحاسب أنفسنا في الدنيا قبل الآخرة: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ (35).
• أن نحذر الطغيان؛ فإنه من أكبر أسباب إيثار الدنيا: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (37، 38).
• أن نراقب الله دومًا، ونتذكر الوقوف بين يديه: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ (40).
• أن نكف النفس عن هواها: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (40، 41).
أن نتوب ونرجع إلى الله قبل فوات الأوان؛ فالدنيا قصيرة سريعة الزوال: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (46).
تمرين حفظ الصفحة : 583
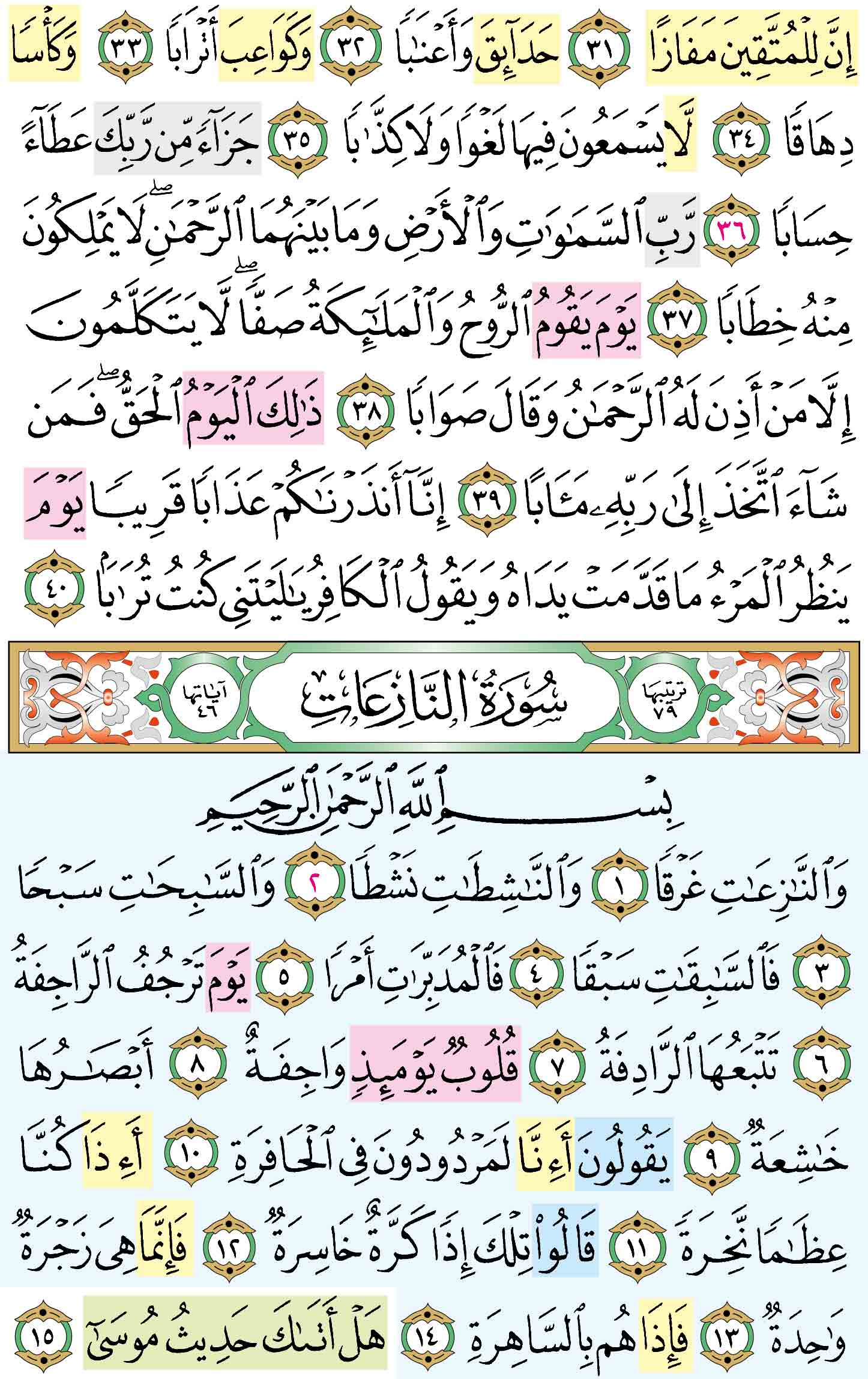
مدارسة الآية : [31] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾
التفسير :
لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال:{ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا} أي: الذين اتقوا سخط ربهم، بالتمسك بطاعته، والانكفاف عما يكرههفلهم مفاز ومنجي، وبعد عن النار.
وكعادة القرآن الكريم فى الموازنة بين عاقبة الأشرار والأخيار ، جاء الحديث عن حسن عاقبة المتقين ، بعد الحديث عن سوء عاقبة الطاغين فقال - تعالى - : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ) أى : للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما لا يرضى ربهم . . ( مَفَازاً ) أى : فوزاً برضوانه وجنته فقوله ( مَفَازاً ) مصدر بمعنى الفوز والظفر بالمطلوب ، وتنوينه للتعظيم .
يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى "إن للمتقين مفازا" قال ابن عباس والضحاك متنزها وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار الأظهر هنا قول ابن عباس.
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)
يقول: إن للمتقين مَنجَى من النار إلى الجنة، ومخلصا منها لهم إليها، وظفرا بما طلبوا.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) قال: فازوا بأن نَجَوا من النار.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) إي والله مفازا من النار إلى الجنة، ومن عذاب الله إلى رحمته.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) قال: مفازا من النار إلى الجنة.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاومة، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) يقول: مُنْتَزَها (1) .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ التقوى سبب دخول الجنَّة.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ مجرد النجاة من الجحيم غنيمة، فكيف إذا كان بعده روعة النعيم؟! قال مجاهد وقتادة: «فازوا، فنجوا من النار».
تفاعل
[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المتقين.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ نهاية التقوى فوز.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ تأمل في النعيم الذي سيلاقونه، وانظر سبب تنعمهم بهذا النعيم.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ فضيلة التقوى وعظم ما أعد الله لأهلها.
وقفة
[31] طريقان: الأول: محفوف بالشهوات المحرمة ومنتهاه: ﴿إنَّ جهنم كانت مرصادا﴾ [21]، والثاني: محفوف بالمكاره وغايته: ﴿إنَّ للمتقين مفازا﴾، ومن سار على الدرب وصل.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ اتباع ذكر جهنم والعذاب بأخبار الجنة؛ يعد من الحكم الإلهية، فوعيد الكفار يتبعه نعيم الجنة للمتقين.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ المفاز: الفوز والنجاة من الكروب.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ المفاز: ظرف زمان وظرف مكان.
وقفة
[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ التقوى تصرف ناتج عن شعور داخلى للاحتياط من أى سوء.
عمل
[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ اعمل ثلاثة أعمال في يومك تدل على التقوى؛ كالصوم, ترك المعصية خوف عقاب الله تعالى واستحياء منه, الصدقة, الإحسان إلى الناس, إدخال السرور على قلب مسلم.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. للمتقين: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.
- ﴿ مَفازاً: ﴾
- اسم «ان» المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي فوزا او موضع فوز وقيل نجاة.
المتشابهات :
| ص: 49 | ﴿هَـٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ |
|---|
| القلم: 34 | ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ |
|---|
| النبإ: 31 | ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [31] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ عذابَ الكافرينَ؛ ذكرَ نعيمَ المُتَّقينَ، قال تعالى:
﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [32] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾
التفسير :
وفي ذلك المفاز لهم{ حَدَائِقَ} وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية، في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق.
ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الفوز فقال : ( حَدَآئِقَ وَأَعْنَاباً ) أى : إن لهم فى هذه الجنان التى ظفروا بها حدائق ، أى : بساتين فيها ماء وأشجار مثمرة .
. سميت بذلك تشبيها لها بحدقة العين فى الهيئة ، وحصول الماء فيها .
وإن لهم - كذلك - فى هذه الجنان ( أعنابا ) جمع عنب ، وهو الكرم ، وخصبت الأعناب بالذكر ، لأنها من أعظم الفواكه وأحبها إلى النفوس .
"حدائق" والحدائق البساتين من النخيل وغيرها.
وقوله: (حَدَائِقَ) والحدائق: ترجمة وبيان عن المفاز، وجاز أن يترجم عنه، لأن المفاز مصدر من قول القائل: فاز فلان بهذا الشيء، إذا طلبه فظفر به، فكأنه قيل: إن للمتقين ظفرا بما طلبوا من حدائق وأعناب، والحدائق: جمع حديقة، وهي البساتين من النخل والأعناب والأشجار المُحَوَّط عليها الحيطان المحدقة بها، لإحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة ، فإن لم تكن الحيطان بها محدقة، لم يَقُل لها حديقة، وإحداقها بها: اشتمالها عليها.
وقوله: (وَأَعْنَابًا) يعني: وكرومَ أعناب، واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر الكروم.
التدبر :
تفاعل
[32] ﴿حَدائِقَ﴾ هى كثيرة، وليست واحدة، قل: «اللهم ارزقنا».
وقفة
[32] ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ سَرْدٌ للمتع البصرية في الجنة التي تستريح لها الروح، فكيف إذا كانت هذه الحدائق كل شجرها ساقه من ذهب؟! وشاهقة حتى أن الشجرة فيها يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها!
وقفة
[32] ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ ليس كل بستان يقال له: حديقة، إنما الحديقة هي البستان الذي عليه حائط يحيط به.
لمسة
[32] ﴿حَدائِقَ وَأَعنابًا﴾ الحديقة هى ذات الأسوار، وخص سبحانه الأعناب بالذكر لشرفها وكثرة منافعها.
وقفة
[32-35] ﴿حدائق وأعنابا * وكواعب أترابا * وكأسا دهاقا * لا يسمعون فيها لغوا﴾ المتقين: أكرم الله نظرهم وبطونهم وفروجهم ولذتهم وأسماعهم.
الإعراب :
- ﴿ حَدائِقَ وَأَعْناباً: ﴾
- بدل من «مفازا» وهو بدل كل من كل منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة ولم تنون لانها ممنوعة من الصرف على وزن «مفاعل».واعنابا: معطوفة بالواو على «حدائق» منصوبة مثلها بالفتحة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [32] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن لِلْمُتَّقِينَ فوزًا؛ فَسَّرَ هنا هذا الفوزَ، وفَصَّلَه، قال تعالى:
﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [33] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴾
التفسير :
ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس{ كَوَاعِبَ} وهي:النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن، وقوتهن ونضارتهن.
{ والأَتْرَاب} اللاتي على سن واحد متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة، في أعدل سن الشباب.
وإن لهم - أيضا - ( وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً ) أى : فتيات فى ريعان الشباب ، قد تقاربت أعمارهن ، وتساوين فى الجمال والنضارة وحسن الهيئة .
فالكواعب ، جمع كاعب ، وهى الفتاة التى وصلت إلى سن البلوغ ، وسميت بذلك لأنها فى تلك السن يتكعب ثدياها ، أى : يستديران مع ارتفاع . .
والأتراب ، جمع تِرْبِ - بكسر التاء وسكون الراء - وهو المساوى لغيره فى السن ، وأكثر ما يطلق هذا اللفظ على الإِناث . قيل : سمى من تقاربن فى السن بذلك ، على سبيل التشبيه بالترائب ، أى : بالضلوع التى فى الصدر فى التساوى . .
أي وحورا كواعب قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد "كواعب" أي نواهد يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة قال ابن أبي حاتم حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الدستكي حدثني أبي عن أبي سفيان عبدالرحمن بن عبدالله بن تيم حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبدالرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب".
وقوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) يقول: ونواهد في سنّ واحدة.
وبنحو الذي قلنا قي ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَكَوَاعِبَ) يقول: ونواهد. وقوله: (أَتْرَابًا) يقول: مُسْتَوِيَات.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) يعني: النساء المستويات.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) قال: نواهد أترابا، يقول: لسن واحدة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، ثم وصف ما في الجنة قال: (حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا)(وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) يعني بذلك النساء أترابا لسنٍّ واحدة.
حدثني عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: الكواعب: النواهد.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) قال: الكواعب: التي قد نهدت وكَعَبَ ثديها، وقال: أترابا: مستويات، فلانة تربة فلانة، قال: الأتراب: اللِّدات.
حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثنا يحيى بن سليمان، عن ابن جريج، عن مجاهد (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) لِدَّات.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[33] ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ فتيات في ريعان الشباب، لا تحتاج الواحدة منهن إلى عمليات تجميل لتبقى على نضارتها وشبابها، إنما جمالها لا يتغير، وعُمرها لا تتقدَّم، والمتعة بها لا تنقص بل تزداد يومًا بعد يوم.
الإعراب :
- ﴿ وَكَواعِبَ أَتْراباً ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. الكواعب: جمع كاعب وهي الفتاة الناهدة الثدي. و «اترابا» المتساويات في السن «اللدات» مفردها ترب وهي صفة لكواعب منصوبة مثلها بالفتحة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [33] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ المساكِنَ النَّزِهةَ المُؤْنِقةَ المُعْجِبةَ؛ ذكَرَ ما يُتمَتَّعُ به، قال تعالى:
﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [34] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾
التفسير :
{ وَكَأْسًا دِهَاقًا} أي:مملوءة من رحيق، لذة للشاربين،
وإن لهم - أيضا - ( وَكَأْساً دِهَاقاً ) أى : كأسا مليئة بالخمر . يقال دهق الحوض - كجعل - وأدهقه ، إذا ملأه حتى فاض من جوانبه .
قال ابن عباس مملوءة متتابعة وقال عكرمة صافية وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد "دهاقا" الملأى المترعة وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة.
وقوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) يقول: وكأسا ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء، وأصله من الدَّهْق: وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدّة وعنف، وكذلك الكأس الدهاق: متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا أبو يزيد يحيى بن ميسرة، عن مسلم بن نَسْطاس، قال: قال ابن عباس لغلامه: اسقني دهاقا، قال: فجاء بها الغلام ملأى، فقال ابن عباس: هذا الدِّهاق.
حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا موسى بن عمير، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: ملأى.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، أخبرني سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: دراكا، قال يونس: قال ابن وهب: الذي يَتْبع بعضُه بعضا.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) يقول: ممتلئا.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: ثنا حميد الطويل، عن ثابت البُنَانيّ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: دمادم (2) .
قال ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: مَلأى.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن يونس، عن الحسن (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الملأى.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: مَلأى.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، مثله.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: مُتْرَعة مَلأى.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الدهاق: المَلأى المُتْرَعة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الدهاق: الممتلئة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( كأْسًا دِهاقًا ) قال: الدِّهاق المملوءة.
وقال آخرون: الدِّهاق: الصافية.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن يحيى الأزديّ وعباس بن محمد، قالا ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنا عمر بن عطاء، عن عكرِمة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: صافية.
وقال آخرون: بل هي المتتابعة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال سعيد بن جُبير في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) دهاقًا: المتتابعة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: المتتابع.
حدثنا عمرو بن عبد الحميد، قال: ثنا جرير، عن حصين، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الملأى المتتابعة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: المتتابعة.
التدبر :
وقفة
[34] ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ امتنعوا عن قطرة خمر واحدة منها في الدنيا؛ فتلذذوا في الجنة بكؤوس خمر ممتلئة متتابعة.
الإعراب :
- ﴿ وَكَأْساً دِهاقاً ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة اي وكأسا ملأى.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [34] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ النِّساءَ؛ ذَكَرَ المُلائِمَ لِعِشْرَتِهِنَّ، فَقالَ تعالى:
﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [35] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا .. ﴾
التفسير :
{ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا} أي:كلاما لا فائدة فيه{ وَلَا كِذَّابًا} أي:إثما.
كما قال تعالى:{ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا}
( لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا ) أى : فى الجنة ( لَغْواً ) أى : كلاما ساقطا لا يعتد به . ولا يسمعون - أيضا - ( كِذَّاباً ) أى كلاما كاذبا .
وقوله : ( لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ) كقوله : ( لا لغو فيها ولا تأثيم ) [ الطور : 23 ] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ، ولا إثم كذب ، بل هي دار السلام ، وكل ما فيها سالم من النقص .
وقوله: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) يقول تعالى ذكره: لا يسمعون في الجنة لغوا، يعني باطلا من القول، ولا كذّابًا، يقول: ولا مكاذبة، أي لا يكذب بعضهم بعضا، وقرأت القرّاء في الأمصار بتشديد الذال على ما بيَّنت في قوله: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا سوى الكسائيّ فإنه خَفَّفها لما وصفت قبل، والتشديد أحبّ إليّ من التخفيف، وبالتشديد القراءة، ولا أرى قراءة ذلك بالتخفيف لإجماع الحجة من القرّاء على خلافه، ومن التخفيف قول الأعشى:
فَصَدَقْتُهــــــا وكَذبْتُهـــــا
والمَــــرْءُ يَنْفَعُـــهُ كِذَابُـــهُ (3)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) قال: باطلا وإثمًا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) قال: وهي كذلك ليس فيها لغوٌ ولا كذَّاب.
التدبر :
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ فلما أحاط بأهل جهنم أشدُّ الأذى بجميع حواسهم، من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق، لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى، وهو أذى سماع ما يكرهه الناس فإن ذلك أقل الأذى.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ من ترك اللغو وابتعد عنه؛ فقد استعجل شيئًا من نعيم الجنة.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ من سعادة المرء أن يعيش مع أناس صادقين.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ حتى مجرد الكلام الذي قد يؤذي نفسية الإنسان لا يسمعه المؤمن في الجنة.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ كلنا لنا جلسات واجتماعات فإذا طهرناها من الفُحش والغيبة والشتيمة والكذب عِشنا في نعيم يؤدي إلى نعيم الجنة.
وقفة
[35] ﴿لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا كِذّابًا﴾ ميزة كبرى نفتقدها فى الحياة الدنيا.
تفاعل
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ قل: «اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل».
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ في تلك الدار حتى السمع في نعيم ورفعه عن سفاسف الأمور.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ لو كان في اللغو خير لما كرم الله أهل الجنة بعدم سماعه.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ مجالس المؤمنين الخالية من اللغو والكذب والفسوق هي من مجالس الجنة.
وقفة
[35] قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ كقوله: ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾ [الطور: 25]؛ أي: ليس فيها كلام لاغٍ عارٍ عن الفائدة، ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص.
وقفة
[35] قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ حتى مجرد الكلام الذي قد يؤذي نفسيتك، لن تسمعه في الجنة.
عمل
[35] قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ اجتنب مجالس اللغو في الدنيا، فهذا مِن طرق الجنة.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ دلت الآية على أن اللغو عكس النعيم، وأن مجالس اللغو من الشقاء، وتجلب للمرء في الدنيا العناء، وتحرمه في الآخرة من أحلى عطاء: الجنة.
وقفة
[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ ليس في الجنة إلا الصدق بجميع أشكاله وصوره، فقد ودَّعت عالم الكذب والادعاء لتنعم بدار الصدق والهناء.
وقفة
[35] من نعيم الجنة: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾، من فقه الآية: سماع اللغو الذي لا فائدة منه عذاب تنزه عنه الجنة، فكم في الدنيا من عذاب!
الإعراب :
- ﴿ لا يَسْمَعُونَ: ﴾
- نافية لا عمل لها. يسمعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة الفعلية «لا يَسْمَعُونَ» وما بعدها في محل نصب حال من «المتقين».
- ﴿ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً: ﴾
- جار ومجرور متعلق بلا يسمعون. لغوا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والواو عاطفة. لا: زائدة لتأكيد معنى النفي. كذابا: معطوفة على «لغوا» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة اي لا يكذب بعضهم بعضا ولا يكذبه او لا يكاذبه.
المتشابهات :
| مريم: 62 | ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ |
|---|
| الواقعة: 25 | ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ |
|---|
| النبإ: 35 | ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [35] لما قبلها : ولَمَّا كانَتْ مَجالِسُ الخَمْرِ في الدُّنْيا مُمْتَلِئَةً بِما يُنَغِّصُها مِنَ اللَّغْوِ والكَذِبِ -إلّا عِنْدَ مَن لا مُرُوءَةَ لَهُ فَلا يُنَغِّصُهُ القَبِيحُ-؛ قالَ تعالى نافِيًا عَنْها ما يُكَدِّرُ لَذَّةَ السَّمْعِ:
﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
كذابا:
1- بالتشديد، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بالتخفيف، وهى قراءة الكسائي.
مدارسة الآية : [36] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَابًا ﴾
التفسير :
وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه].{ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ} لهم{ عَطَاءً حِسَابًا} أي:بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها، وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها.
وقوله - سبحانه - : ( جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً ) بيان لمظاهر فضله ومننه على هؤلاء المتقين . . وقوله : ( جَزَآءً ) منصوب بفعل محذوف من لفظه ، و ( من ) ابتدائية .
أى : هؤلاء المتقون كوفئوا مكافأة صادرة من ربك على سبيل العطاء أى : الإِحسان والتفضل ، حتى شبعوا واكتفوا .
فقوله : ( حسابا ) صفة للعطاء وهو بمعنى كاف . فهو مصدر أقيم مقام الوصف ، من قولهم : أحْسَبَهُ الشئُ ، إذا كفاه حتى قال حسبى ، أى : كافينى .
قال صاحب الكشاف : و ( حِسَاباً ) معناه " محسوبا " أى : كافأهم الله - تعالى - على أعمالهم الحسنة فى الدنيا مكافأة محسوبة ، على قدر أعمالهم الطيبة .
وقوله : ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه ، بفضله ومنه وإحسانه ورحمته ; ( عطاء حسابا ) أي : كافيا وافرا شاملا كثيرا ; تقول العرب : " أعطاني فأحسبني " أي : كفاني . ومنه " حسبي الله " ، أي : الله كافي .
القول في تأويل قوله تعالى : جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36)
يعني بقوله جلّ ثناؤه: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً) أعطى الله هؤلاء المتقين ما وصف في هذه الآيات ثوابًا من ربك بأعمالهم، على طاعتهم إياه في الدنيا.
وقوله: (عَطَاءً) يقول: تفضلا من الله عليهم بذلك الجزاء، وذلك أنه جزاهم بالواحد عشرا في بعض وفي بعض بالواحد سبع مِئَةٍ، فهذه الزيادة وإن كانت جزاء، فعطاء من الله.
وقوله: (حِسَابًا) يقول: محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) قال: عطاء منه حسابًا لما عملوا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا): أي عطاء كثيرا، فجزاهم بالعمل اليسير الخير الجسيم، الذي لا انقطاع له.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن مَعْمر، عن قتادة، في قوله: (عَطَاءً حِسَابًا) قال: عطاء كثيرا، وقال مجاهد: عطاء من الله حسابًا بأعمالهم.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن زيد يقول في قول الله: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) فقرأ: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ... إلى (عَطَاءً حِسَابًا) قال: فهذه جزاء بأعمالهم عطاء الذي أعطاهم عملوا له واحدة، فجزاهم عشرا، وقرأ قول الله: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وقرأ قول الله: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قال: يزيد من يشاء، كان هذا كله عطاء، ولم يكن أعمالا يحسبه لهم، فجزاهم به حتى كأنهم عملوا له، قال: ولم يعملوا إنما عملوا عشرا، فأعطاهم مئة، وعملوا مئة، فأعطاهم ألفا، هذا كله عطاء، والعمل الأوّل، ثم حَسَب ذلك حتى كأنهم عملوا فجزاهم كما جزاهم بالذي عملوا.
التدبر :
لمسة
[36] ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ حسابًا: يعني عطاءً كبيرًا، قال علماء اللغة: هذا عطاء إلى أن تقول: «حسبي، اكتفيت»، خذ ما شئت.
وقفة
[36] ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ عطاء لا على سبيل العوض، بل على سبيل الفضل والكرم، وحسابًا إما بمعنى أنه كاف، أو أنه محسوب على قدر أعمالهم الصالحة.
تفاعل
[36] عامل الله أهل النار بالوفاق والعدل: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ [26]، والمتقين بالرحمة والعطاء: ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾، قل: اللهم عاملنا برحمتك.
وقفة
[36] عاملَ اللهُ أهلَ النَّار بالعدلِ فقال: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ [26] أي دخلوها بأعمالِهم، وعاملَ المتَّقين بالرَّحمةِ فقال: ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾، فلا يدخلُ أحدٌ الجَنَّةَ بعملِه مهما عَمِلَ.
وقفة
[36] قال: ﴿جزاء وفاقا﴾ [26]، وبعده: ﴿جزاء من ربك عطاء حسابا﴾؛ لأن الأول للكفار، وقد قال الله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40]، فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم، والثاني للمؤمنين، وجزائهم جزاء وافيًا كافيًا، فلهذا قال ﴿حسابا﴾ أي كافيًا، من قولهم: أعطاني فأحسبني، أي أكثر عليَّ حتى قلت: «حسبي».
وقفة
[36] ﴿جَزاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا﴾ (حسابًا) تركت مفتوحة؛ لتذهب النفس في تصورها كل مذهبٍ، وهو بشارة للذين يدخلون الجنة، ولتعقد المقارنة فى الذهن؛ ليزداد النفور من النار وأهلها، والرغبة فى الجنة وأهلها، وهذا معنى المثانى أى: الخوف والرجاء.
الإعراب :
- ﴿ جَزاءً: ﴾
- مفعول مطلق- مصدر- مؤكد منصوب وعلامة نصبه الفتحة بتقدير جازى المتقين بمفاز.
- ﴿ مِنْ رَبِّكَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لجزاء والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ عَطاءً حِساباً: ﴾
- مفعول به منصوب بجزاء اي جزاهم عطاء وعلامة نصبه الفتحة. حسابا: صفة- نعت- لعطاء منصوبة مثلها بالفتحة اي كافيا.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [36] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ أنواعَ النعيم؛ بَيَّنَ هنا أن هذا جزاء لهم على ما عملوا؛ لأن العطاءَ إذا كان على المعاوضةِ، كان أَطْيَبَ لنفسِ الآخذِ، قال تعالى:
﴿ جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
حسابا:
1- بكسر الحاء وفتح السين مخففة، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بفتح الحاء وشد السين، وهى قراءة ابن قطيب.
3- بكسر الحاء وشد السين، وهى قراءة شريح بن يزيد، وأبى البرهسم.
4- حسنا، بالنون، وهى قراءة ابن عباس.
5- حسبا، بفتح الحاء، وسكون السين والباء، حكاها العدوى، عن ابن عباس.
مدارسة الآية : [37] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾
التفسير :
أي:الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم{ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الذي خلقها ودبرها{ الرَّحْمَنِ} الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم، ولطف بهم، حتى أدركوا ما أدركوا.
ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون و{ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا} إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين:أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن{ ذَلِكَ الْيَوْمُ} هو{ الْحَقُّ} الذي لا يروج فيه الباطل، ولا ينفع فيه الكذب
وقوله : ( رَّبِّ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا الرحمن . . . ) قرأه بعضهم بجر لفظ " رب " على أنه بدل " من ربك " وقرأه البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف .
أى : هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك ، الذى هو رب أهل السموات وأهل الأرض ، ورب ما بينهما من مخلوقات لا يعلمها إلا هو ، وهو - سبحانه - صاحب الرحمة الواسعة العظيمة التى لا تقاربها رحمة . .
وقوله : ( لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ) مقرر ومؤكد لما قبله ، من كونه - تعالى - هو رب كل شئ . أى : أهل السموات والأرض وما بينهما ، خاضعون ومربوبون لله - تعالى - الواحد القهار ، الذى لا يقدر أحد منهم - كائنا من كان - أن يخاطبه إلا بإذنه ، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته .
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ( مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) وقوله - سبحانه - : ( يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ )
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله ، وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء .
وقوله : ( لا يملكون منه خطابا ) أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه ، كقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : 255 ] ، وكقوله : ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ) [ هود : 105 ]
وقوله: (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ) يقول جلّ ثناؤه: جزاء من ربك ربّ السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلق.
واختلف القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة: (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ) بالرفع في كليهما. وقرأ ذلك بعض أهل البصرة وبعض الكوفيين: (رَبِّ) خفضًا: (الرَّحْمَنِ) رفعًا ولكلّ ذلك عندنا وجه صحيح، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب، غير أن الخفض في الربّ، لقربه من قوله: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ): أعجب إليّ، وأما(الرَّحْمَنِ) بالرفع فإنه أحسن لبعده من ذلك.
وقوله: (الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) يقول تعالى ذكره: الرحمن لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة، إلا من أذن له منهم وقال صوابًا.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) قال: كلاما.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) أي كلاما.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا قال: لا يملكون أن يخاطبوا الله، والمخاطِب: المخاصم الذي يخاصم صاحبه.
التدبر :
وقفة
[37] ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ﴾ ذكر الرحمة هنا بشارة، فنحن أحوج ما نكون إلى رحمة الله يوم القيامة.
وقفة
[37] ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ إذا كانت مجالس الرؤساء والكبراء يجللها الوقار والهيبة, فما ظنكم بمجلس ملك الملوك ورب الأرباب؟! خاب من لم يرج لله وقارًا.
وقفة
[37] ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ لا يملك أحد من الخلق ابتداء الكلام يوم القيامة إلا بإذن الله، وهذا يشمل الشفاعة.
الإعراب :
- ﴿ رَبِّ السَّماواتِ: ﴾
- بدل من «ربك» في الآية الكريمة السابقة او صفة- نعت- له مجرور وعلامة جره الكسرة. السموات: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.
- ﴿ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا: ﴾
- معطوفة بالواو على «السموات» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة والواو حرف عطف. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر لانه معطوف على مجرور. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بصلة الموصول المحذوفة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة و «ما» علامة التثنية.
- ﴿ الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً: ﴾
- الرحمن يعرب إعراب «رَبِّ السَّماواتِ» والجملة الفعلية بعده تعرب إعراب «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً» الواردة في الآية الكريمة الخامسة والثلاثين.
المتشابهات :
| مريم: 65 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا﴾ |
|---|
| الصافات: 5 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ﴾ |
|---|
| الشعراء: 24 | ﴿قَالَ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ |
|---|
| ص: 66 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّٰرُ﴾ |
|---|
| الدخان: 7 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ |
|---|
| النبإ: 37 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِنۡهُ خِطَابٗا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [37] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ سَعةَ فَضْلِه؛ وَصَف نَفْسَه الأقدَسَ بما يَدُلُّ على عَظَمتِه؛ زيادةً في شَرَفِ المُخاطَبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ عَظَمةَ العبدِ على حسَبِ عَظَمةِ السَّيِّدِ، فقال تعالى:
﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
رب ... الرحمن:
قرئا:
1- بجرهما، وهى قراءة عبد الله، وابن أبى إسحاق، والأعمش، وابن محيصن، وابن عامر، وعاصم.
2- برفعهما، وهى قراءة الأعرج، وأبى جعفر، وشيبة، وأبى عمرو، والحرميين.
3- الأول بالجر، والثاني بالرفع، وهى قراءة الأخوين، والحسن، وابن وثاب، والأعمش، وابن محيصن، بخلاف عنهما.
مدارسة الآية : [38] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا .. ﴾
التفسير :
وفي ذلك اليوم{ يَقُومُ الرُّوحُ} وهو جبريل عليه السلام، الذي هو أشرف الملائكة{ وَالْمَلَائِكَةِ} [أيضا يقوم الجميع]{ صَفًّا} خاضعين لله{ لَا يَتَكَلَّمُونَ} إلا بما أذن لهم الله به.
والظرف فى قوله - تعالى - : ( يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّاً . . . ) متعلق بقوله - تعالى - قبل ذلك : ( لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ) . . والمراد بالروح : جبريل - عليه السلام - . أى : لا يملك أحد أن يخاطب الله - تعالى - إلا بإذنه ، يوم القيامة ، ويوم يقوم جبريل - عليه السلام - بين يدى خالقه قيام تذلل وخضوع ، ويقوم الملائكة - أيضا - قياما كله أدب وخشوع ، وهم فى صفوف منتظمة .
( لاَّ يَتَكَلَّمُونَ ) أى : لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا غيرهم الكلام ( إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن ) منهم بالكلام أو بالشفاعة .
( وَقَالَ صَوَابا ) أى : وقال المأذون له فى الكلام قولا صوابا يرضى الخالق - عز وجل - .
وكون المراد بالروح : جبريل - عليه السلام - هو الرأى الراجح ، لأن القرآن الكريم قد وصفه بذلك فى آيات منها قوله - تعالى - : ( نَزَلَ بِهِ الروح الأمين . على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين ) وهناك أقوال أخرى فى المراد به ، منها : أنه ملك من الملائكة ، ومنها : أرواح بنى آدم .
وجملة " لا يتكلمون " مؤكدة لجملة ( لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ) والضمير لجميع الخلائق .
وقد أفادت الآية الكريمة أن الذين يتكلمون فى هذا اليوم الهائل الشديد ، هم الذين يأذن الله - تعالى - لهم بالكلام ، وهم الذين يقولون قولا صوابا يرضى الله - تعالى - عنه .
وجملة : " وقال صوابا " يجوز أن تكون فى موضع الحال من الاسم الموصول " من " أى : لا يستطيع أحد منهم الكلام إلا الشخص الذى قد أذن الله - تعالى - له فى الكلام ، والحال أن هذا المأذون له قد قال صوابا .
ويصح أن تكون معطوفة على جملة ( أَذِنَ لَهُ الرحمن ) أى : لا يستطيعون الكلام إلا الذين أذن لهم الرحمن فى الكلام ، وإلا الذين قالوا قولا صوابا يرضى الله ، فإنهم يتكلمون .
والمقصود من الآية الكريمة ، بيان أن الخلائق جميعا يكونون فى هذا اليوم ، فى قبضة الرحمن وتحت تصرفه ، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه - تعالى - .
وقوله : ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ) اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ، ما هو ؟ على أقوال :
أحدها : رواه العوفي ، عن ابن عباس : أنهم أرواح بني آدم .
الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن ، وقتادة ، وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه .
الثالث : أنهم خلق من خلق الله ، على صور بني آدم ، وليسوا بملائكة ولا ببشر ، وهم يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو صالح والأعمش .
الرابع : هو جبريل . قاله الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) [ الشعراء : 193 ، 194 ] وقال مقاتل بن حيان : الروح : أشرف الملائكة ، وأقرب إلى الرب - عز وجل - وصاحب الوحي .
والخامس : أنه القرآن . قاله ابن زيد ، كقوله : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية [ الشورى : 52 ] .
والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات ; قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله : ( يوم يقوم الروح ) قال : هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا .
وقال ابن جرير : حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، حدثنا رواد بن الجراح ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات ومن الجبال ومن الملائكة ، يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة ، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده ، وهذا قول غريب جدا .
وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري ، حدثنا وهب [ الله بن رزق أبو هريرة ، حدثنا بشر بن بكر ] ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني عطاء ، عن عبد الله بن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن لله ملكا لو قيل له : التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة ، لفعل ، تسبيحه : سبحانك حيث كنت " .
وهذا حديث غريب جدا ، وفي رفعه نظر ، وقد يكون موقوفا على ابن عباس ، ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات ، والله أعلم .
وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها ، والأشبه - والله أعلم - أنهم بنو آدم .
وقوله : ( إلا من أذن له الرحمن ) كقوله : ( لا تكلم نفس إلا بإذنه ) [ هود : 105 ] . وكما ثبت في الصحيح : " ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل " .
وقوله ( وقال صوابا ) أي : حقا ، ومن الحق : " لا إله إلا الله " ، كما قاله أبو صالح ، وعكرمة .
وقوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو مَلَك من أعظم الملائكة خَلْقًا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن خلف العَسْقَلانيّ، قال: ثنا روّاد بن الجرّاح، عن أبي حمزة، عن الشعبيّ، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: الرُّوح: ملك في السماء الرابعة، هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح الله كلّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة، يخلق الله من كلّ تسبيحة مَلَكا من الملائكة، يجيء يوم القيامة صفًّا وحده.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ ) قال: هو ملك أعظم الملائكة خَلْقًا.
وقال آخرون: هو جبريل عليه السلام.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي سنان، عن ثابت، عن الضحاك ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: جبريل عليه السلام.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الضحاك ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: الروح: جبريل عليه السلام.
حدثنا محمد بن خَلَف العَسْقَلانيّ، قال: ثنا روّاد بن الجرّاح، عن أبي حمزة عن الشعبىّ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: الروح جبريل عليه السلام.
وقال آخرون: خَلْق من خلق الله في صورة بني آدم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ( الرُّوحُ ) خَلْق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مسلم، عن مجاهد، قال: ( الرُّوحُ ): خلق لهم أيد وأرجل، وأراه قال: ورءوس يأكلون الطعام، ليسوا ملائكة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، قال: يشبهون الناس وليسوا بالناس.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن مجاهد، قال: ( الرُّوحُ ) خلق كخلق آدم .
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن الأعمش، في قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا ) قال: الروح خلق من خلق الله يضعفون على الملائكة أضعافًا، لهم أيد وأرجل.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن إسماعيل، عن أبي صالح مولى أم هانئ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ ) قال: الروح: خلق كالناس، وليسوا بالناس.
وقال آخرون: هم بنو آدم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: هم بنو آدم، وهو قول الحسن.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، في قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: الروح بنو آدم. وقال قتادة: هذا مما كان يكتمه ابن عباس.
وقال آخرون: قيل: ذلك أرواح بني آدم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ) قال: يعني حين تقوم أرواح الناس مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردّ الأرواح إلى الأجساد.
وقال آخرون: هو القرآن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، كان أبي يقول: الروح: القرآن، وقرأ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ .
والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنّ خَلْقَه لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الرُّوح، والرُّوح خَلْق من خَلْقِه، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت، والله أعلم أيّ ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعنيّ به دون غيره يجب التسليم له، ولاحجة تدلّ عليه، وغير ضائر الجهل به.
وقيل: إنه يقول: سِمَاطان.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبيّ، في قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ) قال: هما سِمَاطان (4) لربّ العالمين يوم القيامة؛ سِماط من الروح، وسِماط من الملائكة.
وقوله: ( لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ) قيل: إنهم يُؤْذَن لهم في الكلام حين يُؤْمَر بأهل النار إلى النار، وبأهل الجنة إلى الجنة.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: ثنا أبو عمرو - الذي يقصّ في طيئ - عن عكرمة، وقرأ هذه الآية: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) قال: يُمرّ بأناس من أهل النار على ملائكة، فيقولون: أين تذهبون بهؤلاء؟ فيقال: إلى النار، فيقولون: بما كَسَبت أيديهم، وما ظلمهم الله، ويمرّ بأناس من أهل الجنة على ملائكة، فيقال: أين تذهبون بهؤلاء؟ فيقولون: إلى الجنة، فيقولون: برحمة الله دخلتم الجنة، قال: فيُؤْذَن لهم في الكلام، أو نحو ذلك.
وقال آخرون: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ) بالتوحيد ( وَقَالَ صَوَابًا ) في الدنيا، فوحَّد الله.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) يقول: إلا من أذن له الربّ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَقَالَ صَوَابًا ) قال: حقا في الدنيا وعمل به.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي صالح في قوله: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) قال: لا إله إلا الله.
قال أبو حفص: فحدثت به يحيى بن سعيد، فقال: أنا كتبته عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن أبي معاوية.
حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا حفص بن عمر العَدَنيّ، قال: ثنا الحكم بن أبان، عن عكرِمة في قوله: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) قال: لا إله إلا الله.
والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن، وقال صوابا، فالواجب أن يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه، ولا على لسان رسوله، أنه عَنَى بذلك نوعا من أنواع الصواب، والظاهر محتمل جميعه.
المعاني :
التدبر :
عمل
[38] ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ﴾ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن هول الموقف صامتون، بم سننطق نحن العصاة؟! لملم شتات نفسك، واشحن الهمة، واعمل.
وقفة
[38] ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ﴾ لا يتكلم الملائكة المقربون، ولا الأنبياء المعصومون، فكيف بمن عداهم؟!
وقفة
[38] ﴿يَومَ يَقومُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمونَ إِلّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ وَقالَ صَوابًا﴾ شرطان للتحدث: أخذ الإذن، وقول الحق.
وقفة
[38] ﴿لا يَتَكَلَّمونَ﴾ صمت الخشية والرهبة من هول يوم عظيم.
وقفة
[38] ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ القول الحق الصواب يشرف صاحبه بالمقامات المحمودة في الدنيا واﻵخرة.
وقفة
[38] ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ تعظيم الله تعالى حق تعظيمه.
الإعراب :
- ﴿ يَوْمَ: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بلا يملكون او بلا يتكلمون.
- ﴿ يَقُومُ الرُّوحُ: ﴾
- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. يقوم: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الروح: فاعل مرفوع بالضمة.
- ﴿ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا: ﴾
- معطوفة بالواو على «الروح» مرفوعة بالضمة. صفا:حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة.
- ﴿ لا يَتَكَلَّمُونَ ﴾
- الجملة الفعلية في محل نصب حال. لا: نافية لا عمل لها.يتكلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.
- ﴿ إِلَّا مَنْ: ﴾
- اداة حصر لا عمل لها. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من الضمير في يتكلمون ويجوز ان تكون «الا» اداة استثناء وتكون «من» في محل نصب مستثنى بإلا.
- ﴿ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ: ﴾
- الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أذن:فعل ماض مبني على الفتح. له: جار ومجرور متعلق بالفعل «أذن». الرحمن: فاعل مرفوع بالضمة اي أذن له في الكلام.
- ﴿ وَقالَ صَواباً: ﴾
- الواو عاطفة. قال: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. صوابا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [38] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ أنَّ أحَدًا مِنَ الخَلْقِ لا يُمكِنُه أن يُخاطِبَ اللهَ في شَيءٍ، أو يُطالِبَه بشَيءٍ؛ قرَّر هذا المعنى وأكَّدَه، فقال تعالى:
﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [39] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء .. ﴾
التفسير :
فلما رغب ورهب، وبشر وأنذر، قال:{ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا} أي:عملا، وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة.
واسم الإِشارة فى قوله - تعالى - : ( ذَلِكَ اليوم الحق ) يعود إلى يوم البعث الذى يقوم الناس فيه الله رب العالمين . أى : ذلك اليوم الذى يقوم فيه الخلائق للحساب والجزاء ، هو اليوم الحق الذى لا شك فى حدوثه ، ولا ريب فى ثبوته .
والفاء فى قوله - تعالى - : ( ذَلِكَ اليوم الحق فَمَن شَآءَ اتخذ إلى رَبِّهِ مَآباً ) هى الفصيحة ، ومفعول المشيئة محذوف . أى : لقد بينا لكم ما يهديكم ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا حسنا وطريقا إلى رضاه ، فليتخذه الآن ، من قبل أن يأتى هذا اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلال .
"ذلك اليوم الحق" أي الكائن لا محالة "فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا" أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه.
القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39)
يقول تعالى ذكره: ذَلِكَ الْيَوْمُ يعني: يوم القيامة، وهو يوم يقوم الروح والملائكة صفا الْحَقُّ يقول: إنه حقّ كائن لا شكّ فيه.
وقوله: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا يقول: فمن شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحقّ، والاستعداد له، والعمل بما فيه النجاة له من أهواله مَآبًا ، يعني: مرجعا، وهو مَفْعَلٌ من قولهم: آب فلان من سفره، كما قال عبيد:
وكُــــل ذِي غَيْبَـــةٍ يَئُـــوب
وغـــائِبُ المَـــوْتِ لا يَئُــوبُ (5)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا قال: اتخذوا إلى الله مآبًا بطاعته، وما يقرّبهم إليه.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة إِلَى رَبِّهِ مَآبًا قال: سبيلا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان مَآبًا يقول: مرجعا منـزلا.
المعاني :
التدبر :
عمل
[39] ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ من أراد أن يرجع إلى الله؛ فليرجع إليه الآن، قبل ألا ينفع درهم ولا دينار، ويؤمر به إلى جنة أو نار.
وقفة
[39] ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض، ثم يقول لها: «كوني ترابًا فتكون، فيتمنى الكافر مثل ذلك».
وقفة
[39] ﴿ذلِكَ اليَومُ الحَقُّ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ اليوم الحق عكس الدنيا، هو يوم يحصل فيه كل الحق.
وقفة
[39] ﴿فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ هذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عندما تسنح الفرصة للواعظ من تهيؤ النفس لقبول الموعظة!
وقفة
[39] ﴿فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح.
وقفة
[39] ﴿فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ ألم يكن أبوانا في الجنة؟ أليست منازلنا الأولى؟ لنتخذ من صالح العمل مركبًا يعيدنا إلى الوطن.
الإعراب :
- ﴿ ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ: ﴾
- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب. اليوم: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو والجملة الاسمية «هو اليوم» في محل رفع خبر «ذلك». الحق: صفة لليوم مرفوعة بالضمة او يكون «اليوم» بدلا من «ذلك» وخبر «ذلك» محذوفا تقديره كائن.
- ﴿ فَمَنْ شاءَ: ﴾
- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من».شاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف مفعولها اختصارا وهو كثير الحذف في القرآن الكريم.
- ﴿ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً: ﴾
- تعرب إعراب «شاء» وجملة «اتخذ» وما بعدها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الإعراب. الى ربه: جار ومجرور متعلق باتخذ والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. مآبا:مفعول به منصوب بالفتحة اي مرجعا بالتوبة.
المتشابهات :
| المزمل: 19 | ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |
|---|
| الانسان: 29 | ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |
|---|
| النبإ: 39 | ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [39] لما قبلها : ولَمَّا قَرَّرَ اللهُ أحوالَ المكَلَّفينَ في دَرَجاتِ الثَّوابِ والعِقابِ، وقَرَّر عَظَمةَ يَومِ القيامةِ؛ بَيَّنَ هنا أن هذا اليوم حقٌّ لا ريب فيه، قال تعالى:
﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [40] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ .. ﴾
التفسير :
{ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا} لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب.
{ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي:هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدنيا إليه، كما قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} الآيات.
فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم.
نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم.
تم تفسير سورة عم، والحمد لله رب العالمين
ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الإِنذار البليغ فقال : ( إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكافر ياليتني كُنتُ تُرَاباً ) .
والإنذار : الإِخبار بحصول شئ تسوء عاقبته ، فى وقت يستطيع المنذر فيه أن يجنب نفسه الوقوع فى ذلك الشئ . أى : إنا أخبرناكم - أيها الناس - بأن هناك عذابا قريبا ، سيحل بمن يستحقه عما قريب .
وذلك العذاب سيكون أشد هولا ، وأبقى أثرا ، يوم القيامة ، ( يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) أى : يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه ، ومسجلا عليه . .
( وَيَقُولُ الكافر ياليتني كُنتُ تُرَاباً ) أى : ويقول الإِنسان الكافر فى هذا اليوم على سبيل الحسرة والندامة ، يا ليتنى كنت فى الدنيا ترابا ، ولم أخلق بشرا ، ولم أكلف بشئ من التكاليف ، ولم أبعث ولم أحاسب .
فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه ، من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وقوله : ( إنا أنذرناكم عذابا قريبا ) يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا ، لأن كل ما هو آت آت .
( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أي : يعرض عليه جميع أعماله ، خيرها وشرها ، قديمها وحديثها ، كقوله : ( ووجدوا ما عملوا حاضرا ) [ الكهف : 49 ] ، وكقوله : ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) [ القيامة : 13 ] .
( ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ) أي : يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ، ولم يكن خلق ، ولا خرج إلى الوجود . وذلك حين عاين عذاب الله ، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة ، وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا ، فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور ، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كوني ترابا ، فتصير ترابا . فعند ذلك يقول الكافر : ( ياليتني كنت ترابا ) أي : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهما .
[ آخر تفسير سورة " عم " ]
وقوله: ( إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ) يقول: إنا حذّرناكم أيها الناس عذابًا قد دنا منكم وقرُب، وذلك ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ) المؤمن ( مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) من خير اكتسبه في الدنيا، أو شرّ سَلَفَهُ، فيرجو ثواب الله على صالح أعماله، ويخاف عقابه على سيئها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) قال: المرء المؤمن يحذَر الصغيرة، ويخاف الكبيرة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن محمد بن جحَّادة، عن الحسن ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) قال: المرء المؤمن.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن محمد بن جحادة، عن الحسن، في قوله: ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) قال: المرء المؤمن.
وقوله: ( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) يقول تعالى ذكره: ويقول الكافر يومئذ تمنيا لما يلقى من عذاب الله الذي أعدّه لأصحابه الكافرين به، يا ليتني كنت ترابًا كالبهائم التي جُعِلت ترابًا.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر وابن أبي عديّ، قالا ثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: " إذا كان يوم القيامة، مُدّ الأديم، وحُشِر الدوابّ والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدوابّ، يقتصّ للشاة الجمَّاء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدوابّ، قال لها: كوني ترابا، قال: فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا ".
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر؛ قال: وحدثني جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصمّ، عن أبي هريرة، قال: " إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا ".
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرظيِّ، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يَقْضِي اللهُ بَينَ خَلْقِهِ الجِنِّ والإنْسِ والبَهائم، وإنَّه لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الجَمَّاءَ مِنَ القَرْناءِ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأخْرَى، قالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ: يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا " .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) وهو الهالك المفرط العاجز، وما يمنعه أن يقول ذلك وقد راج عليه عَوْرَاتُ عمله، وقد استَقبل الرحمن وهو عليه غضبان، فتمنى الموت يومئذ، ولم يكن في الدنيا شيء أكرهَ عنده من الموت.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، قال: إذا قُضِيَ بين الناس، وأمر بأهل النار إلى النار قيل لمؤمني الجنّ ولسائر الأمم سوى ولد آدم: عُودُوا ترابًا، فإذا نظر الكفار إليهم قد عادوا ترابًا، قال الكافر: يا ليتني يا ليتني كنت ترابًا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، في قوله: ( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) قال: إذا قيل للبهائم: كونوا ترابًا، قال الكافر: يا ليتني كنت ترابًا.
آخر تفسير سورة عم يتساءلون.
التدبر :
تفاعل
[40] ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.
وقفة
[40] ﴿إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا﴾ كل ما هو آتٍ فهو قريب.
وقفة
[40] ﴿إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا﴾ قرب يوم القيامة؛ فكل ما هو آت قريب.
وقفة
[40] ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾ الكافر يقول ذلك يوم القيامة، حين لا تُقبل توبة، ولا تنفع حسنة، وأما من يقول ذلك في الدنيا فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله، فيُثاب على خوفه من الله، وقد قالت مريم: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾ [مريم: 23]، ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة.
وقفة
[40] ﴿إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا يَومَ يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا﴾ عود إلى بدء، اتجاه الآيات فى خاتمة السورة الكريمة للتذكير بمستهلها من حيث القوة والعظمة والرهبة فى يوم القيامة.
وقفة
[40] ﴿يَومَ يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ﴾ العمل مثبت خيره وشره.
عمل
[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ احذر أن تكون هذه النظرة أول مرة تنظر في كتابك.
اسقاط
[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ آية يوجل القلب منها؛ ماذا قدمنا لننظره وننتظره ذلك اليوم؟!
وقفة
[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ المؤمن ينظر إلى عمله الذي بين يديه، وهو نور يضيء أمامه الطريق ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [التحريم: 8].
عمل
[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ إياك أن تكون هذه أول مرة تنظر في كتابك.
وقفة
[40] ﴿وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا﴾ يستنكف المتكبر فى الدنيا أن تذكره أن أصله من تراب، ليته يتأمل أن هناك من يتمنى يوم القيامة أن يكون هذا التراب.
وقفة
[40] ﴿وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا﴾ بعد أن يقتص الله من البهائم بعضها البعض يجعلها ترابًا سبحانه، وهى ليست مكلفة فى الإصل، ولكنه تمام العدل الإلهى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، حتّى يُقادَ لِلشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشّاةِ القَرْناءِ» [مسلم 2582].
عمل
[40] صحِّحْ حياتك الآن قبل أن تقول: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. انذر: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة «أنذرناكم» في محل رفع خبر «ان».
- ﴿ عَذاباً قَرِيباً: ﴾
- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قريبا: صفة- نعت- لعذابا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.
- ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ: ﴾
- ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بأنذرناكم. ينظر: فعل مضارع مرفوع بالضمة. المرء: فاعل مرفوع بالضمة وجملة «يَنْظُرُ الْمَرْءُ» في محل جر بالاضافة.
- ﴿ ما قَدَّمَتْ يَداهُ: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل «ينظر». يقال: نظرته بمعنى نظرت اليه ويجوز ان تكون في محل جر بحرف جر محذوف تقديره الى ما قدمت يداه. قدمت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. يداه: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. وجملة «قَدَّمَتْ يَداهُ» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد- الراجع- الى الموصول محذوف اختصارا وهو ضمير منصوب المحل لانه مفعول به التقدير: ما قدمته يداه. او تكون «ما» اسم استفهام في محل نصب مفعولا به مقدما للفعل «قدمت» اي ينظر المرء اي شيء قدمت يداه من الشر والخير. وحذفت النون من يداه للاضافة.
- ﴿ وَيَقُولُ الْكافِرُ: ﴾
- معطوفة بالواو على «يَنْظُرُ الْمَرْءُ» وتعرب إعرابها والجملة بعدها في محل نصب مفعول به.
- ﴿ يا لَيْتَنِي: ﴾
- حرف تنبيه او حرف نداء والمنادى به محذوف والتقدير: يا هؤلاء مثلا. ليت: حرف تمن ونصب من اخوات «ان» والنون للوقاية والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب اسم «ليت» والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرها.
- ﴿ كُنْتُ تُراباً: ﴾
- فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المتكلم- مبني على الضم في محل رفع اسم «كان». ترابا: خبرها منصوب بالفتحة اي يتمنى ان يكون غير مخلوق في الدنيا او في هذا اليوم فلم يبعث يوم القيامة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [40] لما قبلها : وبعد كل ما تقدم من المواعظ، والوعد والوعيد؛ قطعَ اللهُ أعذارَ المعتذرين بأبلغ وجه قبل الموقف العَصيبِ، قال تعالى:
﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
المرء:
1- بفتح الميم، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بضمها، وهى قراءة ابن أبى إسحاق.
مدارسة الآية : [1] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾
التفسير :
هذه الإقسامات بالملائكة الكرام، وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله، وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه، الجزاء والبعث، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة، لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال:{ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح، فتجازى بعملها.
الواو فى قوله ( والنازعات . . ) وما بعده للقسم ، وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : وحق هذه المخلوقات العظيمة . . لتبعثن .
وكذلك المقسم به محذوف ، إذ أن هذه الألفاظ وهى : النازعات ، والناشطات والسابحات ، والسابقات ، والمدبرات ، صفات لموصوفات محذوفة ، اختلف المفسرون فى المراد بها على أقوال كثيرة . أشهرها : أن المراد بهذه الموصوفات ، طوائف من الملائكة ، كلفهم الله - تعالى - فى النزع الحسى : ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ) وقوله - سبحانه - فى النزع المعنوى : ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً على سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ) وقوله : ( غرقا ) اسم مصدر من أغرق ، وأصله إغراقا . والإِغراق فى الشئ ، المبالغة فيه والوصول به إلى نهايته ، يقال : أغرق فلان فلان هذا الأمر ، إذا أوغل فيه ، ومنه قوله : نزع فلان فى القوس فأغرق ، أى : بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النَّصْل .
وهو منصوب على المصدرية ، لالتقائه مع اللفظ الذى قبله فى المعنى ، وكذلك الشأن بالنسبة للالفاظ التى بعده ، وهى : " نشطا ، و " سبحا " و " سبقا " .
والمعنى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم ، نزعا شديدا ، يبلغ الغاية فى القسوة والغلظة .
ويشير إلى هذا المعنى قوله - تعالى - فى آيات متعددة ، منها قوله - سبحانه - : ( وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفَّى الذين كَفَرُواْ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق ).
قال ابن مسعود وابن عباس ، ومسروق ، وسعيد بن جبير ، وأبو صالح ، وأبو الضحى ، والسدي : ( والنازعات غرقا ) الملائكة ، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم ، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها ، و [ منهم ] من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط ، وهو قوله : ( والناشطات نشطا ) قاله ابن عباس .
وعن ابن عباس : ( والنازعات ) هي أنفس الكفار ، تنزع ثم تنشط ، ثم تغرق في النار . رواه ابن أبي حاتم .
وقال مجاهد : ( والنازعات غرقا ) الموت . وقال الحسن ، وقتادة : ( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) هي النجوم .
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : ( والنازعات ) و ) الناشطات ) هي القسي في القتال . والصحيح الأول ، وعليه الأكثرون .
القول في تأويل قوله تعالى : وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1)
أقسم ربنا جلّ جلاله بالنازعات، واختلف أهل التأويل فيها، وما هي، وما تنـزع؟ فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنـزع نفوس بني آدم، والمنـزوع نفوس الآدميين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا النضر بن شُمَيل، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى، عن مسروق، عن عبد الله وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: الملائكة .
حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق أنه كان يقول في النازعات: هي الملائكة .
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا شعبة، عن السُّدِّي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في النازعات قال: حين تنـزع نفسه .
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: تنـزع الأنفس .
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: نـزعت أرواحهم، ثم غرقت، ثم قذف بها في النار .
وقال آخرون: بل هو الموت ينـزع النفوس.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: الموت .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
وقال آخرون: هي النجوم تنـزع من أفق إلى أفق.
حدثنا الفضل بن إسحاق، قال: ثنا أبو قُتَيبة، قال: ثنا أبو العوّام، أنه سمع الحسن في وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: النجوم .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: النجوم .
وقال آخرون: هي القسيّ تنـزع بالسهم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن واصل بن السائب، عن عطاء وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: القسيّ .
وقال آخرون: هي النفس حين تُنـزع.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدّي وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: النفس حين تَغرق في الصدر .
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا، ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكلّ نازعة غرقا، فداخلة في قسمه، ملكا كان أو موتا، أو نجما، أو قوسا، أو غير ذلك. والمعنى: والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[1] ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ أقسم الله بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد، والتي تنشطها أي تخرجها، والتي تسبح في مضيها، والتي تُسرع فتسبق إلى ما أمروا به، والتي تدبّر أمور العباد بما يُصلح دينهم ودنياهم، وأسند الله التدبير إلى الملائكة؛ لأنهم أسبابه.
وقفة
[1] ﴿وَالنّازِعاتِ غَرقًا﴾ تنزع الأرواح نزعًا شديدًا.
تفاعل
[1] ﴿وَالنّازِعاتِ غَرقًا﴾ استعذ بالله من سوء الخاتمة.
وقفة
[1، 2] ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ قبض روح الكافر بشدَّة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين.
وقفة
[1، 2] ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ هم الملائكة ينفذون أوامر خالقهم.
الإعراب :
- ﴿ وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً: ﴾
- الواو: واو القسم حرف جر. النازعات: مقسم به مجرور بواو القسم. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف. أي أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد. التقدير ورب الملائكة النازعات أو وحق الملائكة النازعات. فيكون الموصوف المقسم به محذوفا وحلت الصفة محله. غرقا: مصدر- مفعول مطلق- منصوب بفعل مضمر تقديره فتغرق غرقا: أي اغراقا في النزع وعلامة نصبه الفتحة والمقسم عليه «جواب القسم» محذوف أي لتبعثنّ. وحذف لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ بخمسةِ طوائف من الملائكةِ على أن البعثَ والقيامةَ حقٌّ، وهي: ١- أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وعنف، قال تعالى:
﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [2] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾
التفسير :
{ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا} وهم الملائكة أيضا، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكفار.
وقوله : ( والناشطات نَشْطاً ) : المقصود به طائفة أخرى من الملائكة . والناشطات من النَّشْط ، وهو السرعة فى العمل ، والخفة فى أخذ الشئ ، ومنه الأنشوطة ، للعقدة التى يسهل حلها ، ويقال : نَشَطتُ الدول من البئر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وخفة .
أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة وسهولة ويقولون لهم - على سبيل البشارة والتكريم - : ( ياأيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ).
قال ابن مسعود وابن عباس ، ومسروق ، وسعيد بن جبير ، وأبو صالح ، وأبو الضحى ، والسدي : ( والنازعات غرقا ) الملائكة ، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم ، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها ، و [ منهم ] من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط ، وهو قوله : ( والناشطات نشطا ) قاله ابن عباس .
وعن ابن عباس : ( والنازعات ) هي أنفس الكفار ، تنزع ثم تنشط ، ثم تغرق في النار . رواه ابن أبي حاتم .
وقال مجاهد : ( والنازعات غرقا ) الموت . وقال الحسن ، وقتادة : ( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) هي النجوم .
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : ( والنازعات ) و ) الناشطات ) هي القسي في القتال . والصحيح الأول ، وعليه الأكثرون .
وقوله: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اختلف أهل التأويل أيضا فيهنّ، وما هنّ، وما الذي ينشط، فقال بعضهم: هم الملائكة، تنشِط نفس المؤمن فتقبضُها، كما ينشط العقال من البعير إذا حُلّ عنه.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: الملائكة .
وكان الفرّاء يقول: الذي سمعت من العرب أن يقولوا: أنشطت، وكأنما أنشط من عقال، ورَبْطُها: نشطها، والرابط: الناشط؛ قال: وإذا رَبَطْتَ الحبل في يد البعير فقد نشطته تنشطه، وأنت ناشط، وإذا حللته فقد أنشطته.
وقال آخرون: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا هو الموت يَنْشِط نفسَ الإنسان.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: الموت .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا شعبة عن السديّ، عن ابن عباس وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: حين تَنشِط نفسه .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: نشطها حين تُنشط من القدمين .
وقال آخرون: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: النجوم .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: هنّ النجوم .
وقال آخرون: هي الأوهاق (6) .
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن واصل بن السائب، عن عطاء وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: الأوهاق .
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جلّ ثناؤه أقسم بالناشطات نشطا، وهي التي تنشط من موضع إلى موضع، فتذهب إليه، ولم يخصص الله بذلك شيئا دون شيء، بل عم القسم بجميع الناشطات والملائكة تنشط من موضع إلى موضع، وكذلك الموت، وكذلك النجوم والأوهاق وبقر الوحش أيضا تَنْشُط، كما قال الطِّرِمَّاح:
وَهَـلْ بِحَـلِيفِ الخَـيْلِ مِمَّـنْ عَهِدْتُه
بِــهِ غَــيْرُ أُحْـدانَ النَّوَاشِـطِ رُوع (7)
يعني بالنواشط: بقر الوحش، لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة، كما قال رؤبة بن العجَّاج:
تَنَشَّطَتْــهُ كُلُّ مِغْــلاةِ الْوَهْــق (8)
والهموم تنشط صاحبها، كما قال هِيمان بن قحافة:
أمْسَــتْ هُمُـومِي تَنْشِـطُ المَناشِـطَا
الشَّـامَ بِـي طَـوْرًا وَطَـوْرًا وَاسِـطَا (9)
فكل ناشط فداخل فيما أقسم به إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيّ بالقسم من ذلك بعض دون بعض.
----------------------------
الهوامش :
(6) الأوهاق : جمع وهق ، بسكون الهاء أو تحريكها ، وهي الحبل المغار يرمى فيه أنشوطة ، فتؤخذ فيه الدابة والإنسان .
(7) البيت للطرماح بن حكيم ( ديوانه 115 ) قال شارحه في تفسيره : يعني بالنواشط : بقر الوحش . لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة .
(8) البيت لرؤبة الراجز ( ديوانه 104 ) و ( اللسان : نشط ) قال : وتنشطت الناقة الأرض : قطعتها . وفاعل تنشط : هو الناقة ، والهاء راجعة إلى الخرق المذكور . قال : يقول : تناولته وأسرعت رجع يديها . والمغلاة : البعيدة الخطو . والوهق : المباراة في السير . يريد أنها ناقة سريعة السير وجملة تنشطته خبر ، رب في أول الأرجوزة " وقاتم الأعماق " .
(9) البيتان في ( اللسان : نشط ) لهيمان بن قحافة . قال : قال الأخفش : الحمار ينشط من بلد إلى بلد ، والهموم تنشط بصاحبها ، وقال هميان : " أمست همومي ... " البيت . يقول : صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلد ، فمرة إلى الشام ، ومرة إلى واسط بالعراق .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[2] ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ قال بعض السلف: «إن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلًا رقيقًا، ثم يتركونها حتى تستريح رويدًا، ثم يستخرجونها برفق ولطف؛ كالذي يسبح في الماء؛ فإنه يتحرك برفق لئلا يغرق، فهم يرفقون في ذلك الاستخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة».
وقفة
[2] ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ أرواح المؤمنين المشتاقين إلي ربهم تخرجها الملائكة طيبة سهلة إلي باريها, فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
وقفة
[2] ﴿وَالنّاشِطاتِ نَشطًا﴾ نفس المؤمن تكون نشطة للخروج.
تفاعل
[2] سَلْ اللهَ حسنَ الخاتمةِ عند الموتِ, وتذكَّرْ: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً ﴾
- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الأولى وتعرب إعرابها. أي الملائكة الذين يخرجون الأرواح من الأجساد وقيل: النجوم تنشط من برج إلى برج.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- أقسم بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، قال تعالى:
﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [3] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾
التفسير :
{ وَالسَّابِحَاتِ} أي:المترددات في الهواء صعودا ونزولا{ سَبْحًا}
وقوله - سبحانه - : ( والسابحات سَبْحاً ) قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة ، التى تَسْبَحُ فى هذا الكون ، أى : تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله - تعالى - ، ولتسبيحه ، وتحميده ، وتكبيره ، وتقديسه .
أى : وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل فى هذا الكون إسراعا شديدا ، لتنفيذ ما كلفهم - سبحانه - به ، ولتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص . .
وأما قوله : ( والسابحات سبحا ) فقال ابن مسعود : هي الملائكة . وروي عن علي ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبي صالح مثل ذلك .
وعن مجاهد : ( والسابحات سبحا ) الموت . وقال قتادة : هي النجوم . وقال عطاء بن أبي رباح : هي السفن .
وقوله: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا يقول تعالى ذكره: واللواتي تسبح سبحا.
واختلف أهل التأويل في التي أقسم بها جلّ ثناؤه من السابحات، فقال بعضهم: هي الموت تسبح في نفس ابن آدم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا قال: الموت، هكذا وجدته في كتابي (10) .
وقد حدثنا به ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا قال: الملائكة، وهكذا وجدت هذا أيضا في كتابي، فإن يكن ما ذكرنا عن ابن حميد صحيحا، فإن مجاهدا كان يرى أن نـزول الملائكة من السماء سبَّاحة، كما يقال للفرس الجواد: إنه لسابح إذا مرّ يُسرعُ.
وقال آخرون: هي النجوم تَسْبَح في فلكها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا قال: هِي النجوم .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله .
وقال آخرون: هي السفن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن واصل بن السائب، عن عطاء وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا قال: السفن .
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جلّ ثناؤه أقسم بالسابحات سبحا من خلقه، ولم يخصص من ذلك بعضا دون بعض، فذلك (11) كل سابح، لما وصفنا قبل في النازعات (12) .
--------------------
الهوامش :
(10) كأن جابرا يرى تفسير السابحات وهي جمع : بالموت وهو مفرد ، ليس بشيء ، ولذلك قال : هكذا وجدته في كتابي . لعله يريد : هكذا كتبته كما سمعته عن الشيوخ .
(11) فذلك ... لعل أصل العبارة : فشمل ذلك ... إلخ .
(12) أي في تأويل لفظ " النازعات " .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[3] ﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا﴾ هي الملائكة تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح، والتسبيح هو إبعادُ صفات النقص من أن تُضافَ إلى الله، وتنزيهُ الربِّ سبحانه عن السوء وعمَّا لا يليقُ به، وأصلُ التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك.
وقفة
[3] ﴿وَالسّابِحاتِ سَبحًا﴾ تنزل مسرعة لتنفيذ أوامر الله.
الإعراب :
- ﴿ وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة. أي التي تسبح في مضيها: أي تسرع
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٣- أقسم بالملائكة التي تَسْبَح من السماء إلى الأرض بأمر الله، قال تعالى:
﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [4] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴾
التفسير :
{ فَالسَّابِقَاتِ} لغيرها{ سَبْقًا} فتبادر لأمر الله، وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه.
وقوله - تعالى - : ( فالسابقات سَبْقاً ) المقصود به طائفة رابعة من الملائكة ، تسبق غيرها فى تنفيذ أمر الله - تعالى - ، إذ السبق معناه : أن يتجاوز السائر من يسير معه ، ويسبقه إلى المكان المقصود الوصول إليه ، كما قال - تعالى - فى صفات المتقين : ( أولئك يُسَارِعُونَ فِي الخيرات وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ).
وقوله : ( فالسابقات سبقا ) روي عن علي ، ومسروق ، ومجاهد ، وأبي صالح ، والحسن البصري : يعني الملائكة ; قال الحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . وقال قتادة : هي النجوم وقال عطاء : هي الخيل في سبيل الله .
وقوله: فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا اختلف أهل التأويل فيها، فقال بعضهم: هي الملائكة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قال: الملائكة .
وقد حدثنا بهذا الحديث أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قال: الموت .
وقال آخرون: بل هي الخيل السابقة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن واصل بن السائب ، عن عطاء فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قال: الخيل .
وقال آخرون: بل هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قال: هي النجوم .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال : ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.
والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأحرف الماضية.
المعاني :
التدبر :
عمل
[4] ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ سابِق الملائكة بالعمل؛ قال مجاهد: «الملائكة سبقت بني آدم بالخير والعمل الصالح».
لمسة
[4] ﴿فَالسّابِقاتِ سَبقًا﴾ السباقون لتنفيذ الأوامر، والفاء تعنى أنها من نفس جنس سابقتها.
وقفة
[4] ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ أقسم الله بالسابقات التي تسبق غيرها؛ وأيًّا كان المراد بها إلا أن الآية فيها إشادة بالسبق والمبادرة.
وقفة
[4، 5] ﴿فالسابقات سبقا * فالمدبرات أمرا﴾ من أسرار الاقتران بين السبق والتدبير: من سبق وترك الكسل؛ دبر أمره أحسن تدبير.
الإعراب :
- ﴿ فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً ﴾
- تعرب إعراب الآية السابقة. أي التي تسبق إلى ما أمروا به.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٤- أقسم بالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله، قال تعالى:
﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [5] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾
التفسير :
{ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} الملائكة، الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالمالعلوي والسفلي، من الأمطار، والنبات، والأشجار، والرياح، والبحار، والأجنة، والحيوانات، والجنة، والنار [وغير ذلك].
وقوله : ( فالمدبرات أَمْراً ) المقصود به طائفة خامسة من الملائكة ، من وظائفهم تدبير شأن الخلائق ، وتنظيم أحوالهم بالطريقة التى يأمرهم - سبحانه - بها ، فنسبة التدبير إليهم ، إنما هى على سبيل المجاز ، لأن كل شئ فى هذا الكون إنما هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره .
والمراد بالأمر : الشأن والغرض المهم ، وتنوينه للتعظيم ، ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات . أى : وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق ، وينظمون أمورهم بالطريقة التى يكلفهم - سبحانه - بها .
وجاء العطف فى قوله : ( فالسابقات ) ( فالمدبرات ) بالفاء ، للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها بغير مهلة . وللإِيذان بأن هاتين الصفتين متفرعتين عما قبلهما .
وعلى هذا التفسير الذى سرنا فيه على أن هذه الصفات لموصوف واحد ، سار كثير من المفسرين : فصاحب الكشاف صدر تفسيره لهذه الآيات بقوله : أقسم - سبحانه - بطوائف الملائكة ، التى تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التى تنشطها ، أى تخرجها . . بالطوائف التى تسبح فى مضيها ، أى : تسرع فتسبق إلى ما أمروا به ، فتدبر أمرا من أمور العباد مما يصلحهم فى دنيهم ودنياهم ، كما رسم الله - تعالى - لهم . . وأسند التدبير إليهم - أى إلى الملائكة - لأنهم من أسبابه .
وقال الشوكانى : أقسم - سبحانه - بهذه الأشياء التى ذكرها ، وهى الملائكة التى تنزع أرواح العباد عن أجسادهم ، كما ينزع النازع القوس فيبلغ بها غاية المد ، وكذا المراد بالناشطات ، والسابحات ، والسابقات ، والمدبرات ، يعنى الملائكة ، والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفى ، منزلة التغاير الذاتى ، كما فى قول الشاعر :
إلى الملك القرم ، وابن الهام ... وليث الكتيبة فى المزدحم
وهذا قول الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم . .
ومنهم من يرى أن المراد بالنازعات : النجوم تنتقل من مكان إلى مكان ، أو الأقواس التى تنزع السهام ، أو الغزاة ينزعون من دار الإِسلام إلى دار الحرب . .
ومنهم من يرى أن المراد بالناشطات : الكواكب السيارة ، أو السفن التى تمخر عباب الماء . . وأن المراد بالسابحات والسابقات : النجوم ، أو الشمس والقمر ، والليل والنهار . .
أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة .
قال الجمل : اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الكلمات ، هل هى صفات لشئ واحد ، أو لأشياء مختلفة ، على أوجه : واتفقوا على أن المراد بقوله : ( فالمدبرات أَمْراً ) وصف لشئ واحد ، وهم الملائكة .
ويبدو لنا أن كون هذه الصفات جميعها لشئ واحد ، هو الملائكة ، أقرب إلى الصواب لأنه المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وقوله : ( فالمدبرات أمرا ) قال علي ، ومجاهد ، وعطاء ، وأبو صالح ، والحسن ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي : هي الملائكة ، زاد الحسن : تدبر الأمر من السماء إلى الأرض . يعني : بأمر ربها - عز وجل - . ولم يختلفوا في هذا ، ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك ، إلا أنه حكى في ( فالمدبرات أمرا ) أنها الملائكة ، ولا أثبت ولا نفى .
وقوله: فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يقول: فالملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر الله ، وكذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا قال: هي الملائكة .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[5] ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ الملائكة تنزل بالتدبير من عند الله عز وجل، فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم، كما وقع لقوم صالح.
وقفة
[5] ﴿فَالمُدَبِّراتِ أَمرًا﴾ تدبر الأمر وفق ما أمر الله كالرياح والأمطار وقبض الأرواح وغير ذلك
وقفة
[5] قال ابن القيم: «كل حركة في السموات والأرض: من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ وهي الملائكة، وأما المكذبون للرسل المنكرون اللصانع فيقولون: هي النجوم».
وقفة
[1- 5] ﴿وَالنّازِعاتِ غَرقًا * وَالنّاشِطاتِ نَشطًا * وَالسّابِحاتِ سَبحًا * فَالسّابِقاتِ سَبقًا * فَالمُدَبِّراتِ أَمرًا﴾ لا يقسم الله عز وجل إلا بعظيم، وتلك خمس طوائف من الملائكة، ولكل طائفة منها عمل ووظيفة.
وقفة
[1-5] نتعلم من الملائكة النشاط والهمة وعدم الاعتراض واستشعار عظمة الله عز وجل.
الإعراب :
- ﴿ فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ﴾
- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة. أمرا: مفعول به منصوب لاسم الفاعل «المدبرات». أي بفعله العامل. أي: المدبرات أمرا من أمور العباد مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ٥- أقسم بالملائكة التي تنفذ أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره مِن شؤون الكون، قال تعالى:
﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [6] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾
التفسير :
{ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} وهي قيام الساعة،
ثم شرع - سبحانه - فى بيان علامات القيامة وأهوالها فقال : ( يَوْمَ تَرْجُفُ الراجفة . تَتْبَعُهَا الرادفة . . . ) والراجفة : من الرجف وهو الاضطراب الشديد ، والحركة القوية ، لأن بسببها تضطرب الأمور ، وتختل الشئون . يقال : رجفت الأرض والجبال ، إذا اهتزت اهتزازا شديدا .
والمراد بها : ما يحدث فى هذا الكون عند النفخة الأولى التى يموت بعدها جميع الخلائق .
وقوله : ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية . وهكذا قال مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وغير واحد .
وعن مجاهد : أما الأولى - وهي قوله : ( يوم ترجف الراجفة ) - فكقوله جلت عظمته : ( يوم ترجف الأرض والجبال ) [ المزمل : 14 ] ، والثانية - وهي الرادفة - فهي كقوله : ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) [ الحاقة : 14 ] .
وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه " . فقال رجل : يا رسول الله ، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : " إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك " .
وقد رواه الترمذي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، من حديث سفيان الثوري ، بإسناده مثله ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : " يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه " .
وقوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ يقول تعالى ذكره: يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ تتبعها الأخرى بعدها، هي النفخة الثانية التي ردفت الأولى لبعث يوم القيامة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ يقول: النفخة الأولى.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6] ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ كأن الله سبحانه وتعالى أمدها بقوة؛ فتصبح راجفة بعد أن كانت مرجوفة.
وقفة
[6، 7] ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ, اذْكُرُوا اللهَ, جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». [أحمد 5/136، وحسنه الألباني].
وقفة
[6، 7] ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ من وقع الكلمات تستشعر هول الموقف.
الإعراب :
- ﴿ يَوْمَ: ﴾
- ظرف زمان- مفعول فيه على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بجواب القسم المحذوف. أي لتبعثنّ ويجوز أن يكون منتصبا بما دل عليه قوله تعالى «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ» أي يوم ترجف الراجفة وجفت القلوب.
- ﴿ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ: ﴾
- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة. ترجف: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الراجفة: فاعل مرفوع بالضمة والراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال وهي النفخة الأولى وصفت بما يحدث بحدوثها.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد القَسَمِ بخمسةِ طوائف من الملائكةِ على أن البعثَ والقيامةَ حقٌّ؛ شرعَ اللهُ هنا في بيان علامات القيامة وأهوالها، قال تعالى:
﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [7] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾
التفسير :
{ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ} أي:الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها،
والمراد بالرادفة : النفخة الثانية ، التى تردف الأولى ، أى : تأتى بعدها ، وفيها يبعث الموتى بإذن الله - تعالى - ، يقال : فلان جاء ردف فلان ، إذا جاء فى أعقابه .
أى : اذكر - أيها العاقل - لتعتبر وتتعظ ، يوم ينفخ فى الصور فتضطرب الأرض وتهتز ، ويموت جميع الخلق ، ثم يتبع ذلك نفخة أخرى يبعث بعدها الموتى - بإذن الله - تعالى - .
وجملة " تتبعها الرادفة " فى محل نصب على الحال من الراجفة .
وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ( وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ) .
وقوله : ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية . وهكذا قال مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وغير واحد .
وعن مجاهد : أما الأولى - وهي قوله : ( يوم ترجف الراجفة ) - فكقوله جلت عظمته : ( يوم ترجف الأرض والجبال ) [ المزمل : 14 ] ، والثانية - وهي الرادفة - فهي كقوله : ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) [ الحاقة : 14 ] .
وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه " . فقال رجل : يا رسول الله ، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : " إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك " .
وقد رواه الترمذي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، من حديث سفيان الثوري ، بإسناده مثله ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : " يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه " .
وقوله: تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ يقول: النفخة الثانية .
حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ يقول: تتبع الآخرة الأولى، والراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الآخرة .
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قال: هما النفختان: أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتُحيي الموتى، ثم تلا الحسن: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ .
حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال : ثنا سعيد، عن قتادة يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قال: هما الصيحتان، أما الأولى فتُميت كل شيء بإذن الله، وأما الأخرى فتُحيي كل شيء بإذن الله، إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " بَيْنَهُما أرْبَعُونَ" قال أصحابه: والله ما زادنا على ذلك. وذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " يُبْعَثُ فِي تِلْك الأرْبَعِينَ مَطَرٌ يُقال لَهُ الْحَياةُ، حتى تَطِيبَ الأرْضُ وتَهْتَزَّ، وتَنْبُتَ أجْسادُ النَّاسِ نَباتَ البَقْل، ثُمَّ تُنْفَخُ الثَّانِيَةُ، فإذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ" .
حدثنا أبو كُرَيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد ابن أبي زياد عن رجل، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصور، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: " قَرْنٌ". قال: فكيف هو؟ قال: " قَرْنٌ عَظِيمٌ يُنْفَخُ فِيهِ ثَلاثُ نَفَخاتٍ: الأولى نَفْخَةُ الفَزَع، والثَّانِيَةُ نَفْخَةُ الصَّعْق، والثَّالِثَةُ نَفْخَةُ القِيام، فَيَفْزَعُ أهْلُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ إلا مَنْ شاء الله، ويأمر الله فيدِيمُها، ويطوّلها، ولا يفتر، وهي التي تقول: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فَوَاق فيسير الله الجبال، فتكون سَرابًا، وتُرَجّ الأرضُ بأهلها رجًّا، وهي التي يقول: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبيّ، عن أبيه، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ فقال: " جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه " .
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : النفخة الأولى تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ : النفخة الأخرى.
وقال آخرون: في ذلك ما حدثني به محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ قال: ترجف الأرض والجبال، وهي الزلزلة وقوله: الرَّادِفَةُ قال: هو قوله: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً .
وقال آخرون: ترجف الأرض، والرادفة: الساعة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ الأرض، وفي قوله: تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قال: الرادفة: الساعة .
واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا فقال بعض نحويِّي البصرة: قوله وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا : قسم والله أعلم على إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى وإن شئت جعلتها على يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وهو كما قال الله وشاء أن يكون في كل هذا، وفي كلّ الأمور. وقال بعض نحويي الكُوفة: جواب القسم في النازعات: ما تُرِك لمعرفة السامعين بالمعنى، كأنه لو ظهر كان لَتُبْعَثُنّ ولتحاسبنّ. قال: ويدل على ذلك أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً . ألا ترى أنه كالجواب لقوله: لَتُبْعَثُنَّ إذ قال: أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ، وقال آخر منهم نحو هذا، غير أنه قال: لا يجوز حذف اللام في جواب اليمين، لأنها إذا حذفت لم يُعرف موضعها، وذلك أنها تلي كلّ كلام.
والصواب من القول في ذلك عندنا، أن جواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام، فترك ذكره.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[6، 7] ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ الراجفة هى الصيحة الأولى، والرادفة هى الصيحة الثانية.
الإعراب :
- ﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بالضمة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. الرادفة: فاعل مرفوع بالضمة.أي الواقعة التي تردف الأولى وهي النفخة الثانية. والجملة الفعلية في محل نصب حال أي ترجف تابعتها الرادفة أي حال عن الراجفة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ النفخةَ الأُولى؛ أتْبَعَها النفخةَ الثَّانِيَةَ، قال تعالى:
﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [8] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾
التفسير :
{ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ} أي:موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع.
وقوله - سبحانه - : ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ . أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ) بيان لما يترتب على قيام الساعة ، وبعث الخلائق ، من خوف ورعب .
أى : قلوب كثيرة فى هذا اليوم الهائل الشديد تكون فى نهاية الاضطراب والفزع . يقال : وجف القلبُ يَجِف وَجْفاً ووجيفا ، إذا ارتفعت ضرباته من شدة الخوف . .
قال ابن عباس يعني خائفة وكذا قال مجاهد وقتادة.
وقوله: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ يقول تعالى ذكره: قلوب خَلْقٍ من خلقه يومئذ، خائفة من عظيم الهول النازل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ يقول: خائفة .
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: وَاجِفَةٌ : خائفة .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في وَاجِفَةٌ قال: خائفة .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ يقول: خائفة، وجفت مما عاينت يومئذ .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ قال: الواجفة: الخائفة.
التدبر :
لمسة
[8] ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ ولم يقل: (القلوب يومئذ واجفة)؛ لأن أهل الإيمان لا يخافون يومها، والمراد هنا قلوب الكفار والفجار.
وقفة
[8] ﴿قُلوبٌ يَومَئِذٍ واجِفَةٌ﴾ إذًا هناك أصناف أخرى من القلوب، وجاءت نكرة للتقسيم والكثرة، وهم منكرو البعث والكفار، والمقصود من الجملة: (أبصار أصحاب القلوب واجفة)، حقًا الإعجاز فى الإيجاز.
وقفة
[8، 9] ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ من وجف قلبه في الدنيا وخشع بصره خشية وتعظيمًا لله لعله ينجو من هول الموقف يوم الحساب.
لمسة
[8، 9] ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ قال: ﴿أبصارها﴾، ولم يقل: (أبصارهم)؛ ليبين أن خوف القلب يسري في الجسد كله، فتصبح الأبصار خاشعة بما جرى في القلب.
الإعراب :
- ﴿ قُلُوبٌ: ﴾
- مبتدأ مرفوع بالضمة وخبره الجملة الاسمية «أَبْصارُها خاشِعَةٌ» الواردة في الآية الكريمة التالية. وجاز الابتداء بالنكرة لانها وصفت بواجفة.
- ﴿ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ: ﴾
- ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بترجف وهو مضاف. و «اذ» اسم مبني على السكون الظاهر على آخره وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين سكونه وسكون التنوين. وهو في محل جر مضاف اليه، وهو مضاف أيضا والجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين «أي ترجف الراجفة» في محل جر مضاف اليه. التقدير يومئذ ترجف الراجفة تخشع الأبصار. واجفة: صفة- نعت- لقلوب مرفوعة بالضمة.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ البَعْثَ؛ ذَكَرَ حالَ المُكَذِّبِ بِهِ؛ لِأنَّ السِّياقَ لَهُ، قال تعالى:
﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [9] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾
التفسير :
{ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ} أي:ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف، وأذهل أفئدتهم الفزع، وغلب عليهم التأسف [واستولت عليهم] الحسرة.
وتكون أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة ، أى ذليلة مهينة ، لما يعتريهم من الفزع الشديد ، والرعب الذى لا حدود له . .
ولفظ " قلوب " مبتدأ ، وتنكيره للتكثير ، وقوله ( وَاجِفَةٌ ) صفة للقلوب ، وجملة ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ) خبر ثان للقلوب .
والمراد بهذه القلوب : قلوب المشركين الذين أنكروا فى الدنيا البعث والجزاء ، فلما بعثوا اعتراهم الرعب الشديد ، والفزع الذى لا يقاربه فزع . .
فأما قلوب المؤمنين فهى - بفضل الله ورحمته - تكون فى أمان واطمئنان ، كما قال - تعالى - : ( لاَ يَحْزُنُهُمُ الفزع الأكبر وَتَتَلَقَّاهُمُ الملائكة هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ) وإضافة الأبصار إلى مير القلوب لأدنى ملابسة ، لأن الأبصار لأصحاب هذه القلوب ، وكلاهما من جوارح الأجساد .
أي أبصار أصحابها وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال.
وقوله: ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ) يقول: أبصار أصحابها ذليلة مما قد علاها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب الذي قد نـزل بهم من عظيم هول ذلك اليوم.
كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ) قال: خاشعة للذلّ الذي قد نـزل بها .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ) يقول: ذليلة.
التدبر :
لمسة
[9] ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾: كناية عن الذل والخوف.
وقفة
[9] ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ لأن المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره نظر خاشع ذليل مضطرب، يترقب ما سينزل به من الأمر العظيم.
تفاعل
[9] ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ أَبْصارُها خاشِعَةٌ: ﴾
- مبتدأ مرفوع بالضمة. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة يعود على «قلوب» أي أبصار أصحاب القلوب المضطربة. خاشعة: خبر مرفوع بالضمة أي ذليلة.
المتشابهات :
| طه: 56 | ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴾ |
|---|
| النازعات: 21 | ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا وصَفَها بِالِاضْطِرابِ، وكانَ قَدْ يَخْفى سَبَبُهُ لِكَوْنِهِ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ السُّرُورِ العَظِيمِ كَما قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الوَجِلِ الشَّدِيدِ؛ أخْبَرَ عَنْهُ هنا بِما يُحَقِّقُ مَعْناهُ فَقالَ تعالى:
﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [10] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴾
التفسير :
يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ
وقوله - سبحانه - : ( يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الحافرة . أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً ) حكاية لما كان يقوله هؤلاء الكافرون فى الدنيا ، من إنكار للبعث ، ومن استهزاء لمن كان يذكرهم به ، ومن استبعاد شديد لحصوله . .
والمراد بالحافرة : العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم وتحولهم إلى عظام بالية .
قال صاحب الكشاف : ( فِي الحافرة ) أى : فى الحالة الأولى يعنون : الحياة بعد الموت .
فإن قلت : ما حقيقة هذه الكلمة؟ قلت : يقال : رجع فلان فى حافرته ، أى : فى طريقه التى جاء فيها فحفرها . أى : أثر فيها بمشيه فيها : جعل أثر قدميه حفرا . . ثم قيل لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه ، رجع إلى حافرته ، أى : طريقته وحالته الأولى .
وقوله : ( يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ) ؟ يعني : مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد ، يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة ، وهي القبور ، قاله مجاهد . وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ;
القول في تأويل قوله تعالى : يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)
يقول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المكذّبون بالبعث من مشركي قريش إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت: أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل الممات، فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا، وقبل مماتنا، وهو من قولهم: رجع فلان على حافرته: إذا رجع من حيث جاء؛ ومنه قول الشاعر:
أحــافِرَةً عَــلى صَلَــعٍ وشَـيْبٍ
مَعــاذَ اللــهِ مِــنْ سَـفَهٍ وطَيْشٍ (13)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: الْحَافِرَةِ يقول: الحياة .
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ يقول: أئنا لنحيا بعد موتنا، ونبعث من مكاننا هذا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة يقول: أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة فِي الْحَافِرَةِ قال: أي مردودون خَلقا جديدا .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس أو محمد بن كعب القُرَظيّ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قال: في الحياة .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن السديّ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قال: في الحياة .
وقال آخرون: الحافرة: الأرض المحفورة التي حُفرت فيها قبورهم، فجعلوا ذلك نظير قوله: مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ . يعني مدفوق، وقالوا: الحافرة بمعنى المحفورة، ومعنى الكلام عندهم: أئنا لمردودون في قبورنا أمواتا.
حدثني محمد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: الْحَافِرَةِ قال: الأرض: نبعث خلقا جديدا، قال: البعث .
حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قال: الأرض، نبعث خلقا جديدا .
وقال آخرون: الحافرة: النار.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن زيد يقول في قول الله: أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قال: الحافرة: النار، وقرأ قول الله تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قال: ما أكثر أسماءها، هي النار، وهي الجحيم، وهي سَقَرُ، وهي جهنم، وهي الهاوية، وهي الحافرة، وهي لَظَى، وهي الحُطَمة.
------------------
الهوامش :
(13) البيت في ( اللسان : حفر ) ولم ينسبه . والرواية فيه وفي تفسير الشوكاني ( 5 : 363 ) " من سفه وعار " قال : في اللسان : يقال : رجع على حافرته أي : الطريق الذي جاء منه . والحافرة الخلقة الأولى ، وفي التنزيل : { أئنا لمردودون في الحافرة } أي : في أول أمرنا . وأنشد ابن الأعرابي : " أحافرة ... " البيت . يقول : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأول ، من الغزل أو الصبا ، بعد ما شبت وصلعت . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن : { أئنا لمردودون في الحافرة } : من حيث كنا ، يقال : رجع فلان في حافرته : من حيث جاء ، وعلى حافرته : من حيث كان . ا هـ .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[10] ﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ هؤلاء تعجبوا من البعث بعد الموت، فما حقيقة كلمة (الحافِرة)؟ والجواب: يقال: رجع فلان في حافرته، أي في طريقه التي جاء فيها، فأثَّر فيها بمشيه، وصار أثر قدميه حُفَرًا في الأرض، فهي في الحقيقة محفورة إلا أنها سُمِّيت حافرة، وتقول العرب لمن كان في أمر، فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته.
وقفة
[10] ﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ حين يعجز المبطلون عن البرهان وتنقطع الحجة لديهم , يلجؤون للسخرية والتكذيب , واستبعاد البعث والجزاء.
الإعراب :
- ﴿ يَقُولُونَ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. أي يقول الكافرون.
- ﴿ أَإِنَّا: ﴾
- الهمزة همزة انكار وتعجب بلفظ استفهام. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل نصب اسم «انّ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. أي لعائدون بعد الموت. أي لمعادون.
- ﴿ فِي الْحافِرَةِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بمردودون أي في الحالة الأولى أي الحياة بعد الموت أو الطريقة الأولى.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ حالَ المُكَذِّبِين بالبَعْثَ؛ حكى عنهم هنا أقوالًا ثلاثة استبعدوا بها أمرَ البعثِ، وهي: ١- كانوا يقولون: هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟!، قال تعالى:
﴿ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
الحافرة:
1- بالألف، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- الحفرة، بغير ألف، وهى قراءة أبى حيوة، وأبى بحرية، وابن أبى عبلة.
مدارسة الآية : [11] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴾
التفسير :
يقولون أي:الكفار في الدنيا، على وجه التكذيب:{ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً} أي:بالية فتاتا.
وقوله : ( نَّخِرَةً ) صفة مشتقة من قولهم : نَخِر العظم - بفتح النون وكسر الخاء - إذا بَلِى وصار سهل التفتيت والكسر . وقرأ حمزة والكسائى " ناخرة " بمعنى بالية فارغة جوفاء ، يسمع منها عند هبوب الريح نخير ، أى : صوت .
أى : أن هؤلاء المشركين كانوا يقولون فى الدنيا - على سبيل التعجيب والاستهزاء والإِنكار لأمر البعث والحساب : أنرد إلى الحياة مرة أخرى بعد موتنا وبعد أن نصير فى قبورنا عظاما بالية .
وعبر - سبحانه - عن قولهم هذا بالمضارع " يقولون " لاستحضار حالتهم الغريبة ، حيث أنكروا ما قام الدليل على عدم إنكاره ، وللإِشعار بأن هذا الإِنكار كان متجددا ومستمرا منهم .
وقد ساق - سبحانه - أقوالهم هذه بأسلوب الاستفهام ، للإِيذان بأنهم كانوا يقولون ما يقولون فى شأن البعث على سبيل التهكم والتعجب ممن يحدثهم عنه ، كما هو شأن المستفهم عن شئ الذى لا يقصد معرفة الحقيقة ، وإنما يقصد التعجيب والإِنكار .
وجملة ( أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً ) مؤكدة للجملة السابقة عليها ، التى يستبعدون فيها أمر البعث بأقوى أسلوب .
ولهذا قالوا : ( أئذا كنا عظاما نخرة ) ؟ وقرئ : " ناخرة " .
وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة : أي بالية . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلي ودخلت
الريح فيه .
وقوله: أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً اختلفت القرّاء قي قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والحجاز والبصرة نَخِرَةً بمعنى: بالية. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة ( ناخِرَةً ) بألف، بمعنى: أنها مجوّفة تنخَر الرياح في جوفها إذا مرّت بها. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول: الناخرة والنخرة سواء في المعنى، بمنـزلة الطامع والطمِع، والباخل والبَخِل؛ وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا نَخِرَةً ، بغير ألف، بمعنى: بالية، غير أن رءوس الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف، فأعجب إليّ لذلك أن تُلْحق ناخرة بها ليتفق هو وسائر رءوس الآيات، لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها.
* ذكر من قال نَخِرَةً : بالية:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي ، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً فالنخرة: الفانية البالية .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عِظَامًا نَخِرَةً قال: مرفوتة .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا تكذيبا بالبعث ( نَاخِرَةً ) بالية. قالوا: تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ يقول جلّ ثناؤه عن قيل هؤلاء المكذّبين بالبعث، قالوا: تلك: يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات، إذًا: يعنون الآن، كرّة: يعنون رجعة، خاسرة: يعنون غابنة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
التدبر :
وقفة
[11] ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً﴾ استبعد الماديون البعث؛ لأنهم حكَّموا المحسوس في اللامحسوس، وأقحموا العلم في تفسير الغيب، وغفلوا عن أن الله الذي خلقهم من عدم قادر على أن يبعثهم من العدم.
الإعراب :
- ﴿ أَإِذا: ﴾
- الهمزة همزة انكار وتعجب بلفظ استفهام. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق أو منصوب بجوابه وجوابه محذوف تقديره: نرد ونبعث
- ﴿ كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً: ﴾
- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. كنا: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع اسمها. عظاما: خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نخرة: صفة- نعت- لعظاما منصوبة مثلها بالفتحة أي بالية.
المتشابهات :
| الإسراء: 49 | ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ |
|---|
| الإسراء: 98 | ﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ |
|---|
| النازعات: 11 | ﴿ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ٢- كانوا يقولون: أإذا كنا عظامًا بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟!، قال تعالى:
﴿ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
نخرة:
وقرئ:
1- ناخرة، بألف، وهى قراءة عمر، وأبى، وعبد الله، وابن الزبير، وابن عباس، ومسروق، ومجاهد، والأخوين، وأبى بكر.
2- بغير ألف، وهى قراءة أبى رجاء، والحسن، والأعرج، وأبى جعفر، وشيبة، والسلمى، وابن جبير، والنخعي، وقتادة، وابن وثاب، وأيوب، وأهل مكة، وشبل، وباقى السبعة.
مدارسة الآية : [12] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾
التفسير :
{ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ} أي:استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا [منهم] بقدرة الله، وتجرؤا عليه.
وقوله - تعالى - : ( قَالُواْ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ) حكاية لقول آخر من أقوالهم الفاسدة ، وهو بدل اشتمال من قوله - سبحانه - قبل ذلك : ( يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الحافرة ) .
واسم الإِشارة " تلك " يعود إلى الردة المستفادة من قولهم ( أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ . . . ) .
ولفظ " إذا " جواب لكلامهم المتقدم . والكرة : المرة من الكَرّ بمعنى الرجوع ، وجمعها : كرَّات أى : يقول هؤلاء الجاحدون : أنرد إلى الحياة التى كنا فيها بعد أن نموت ونفنى؟ وبعد أن نصير عظاما نخرة؟ لو حدث هذا بأن رددنا إلى الحياة مرة أخرى ، لكانت عودتنا عودة خاسرة غير رابحة ، وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة فى التهكم والاستهزاء بالبعث .
والخسران : أصله عدم الربح فى التجارة ، والمراد به هنا : حدوث ما يكرهونه لهم .
ونسب الخسران إلى الكرة على سبيل المجاز العقلى ، للمبالغة فى وصفهم الرجعة بالخيبة والفشل ، وإلا فالمراد خيبتهم وفشلهم هم ، لأنهم تبين لهم كذبهم ، وصدق من أخبرهم بأن الساعة حق .
فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ : أي رجعة خاسرة .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قال: وأيّ كرّة أخسر منها، أُحيوا ثم صاروا إلى النار، فكانت كرّة سوء.
التدبر :
وقفة
[12] ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ قال محمد بن كعب: «قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن»، سيتحقق ما تظنون؛ سيبعثكم الله وتخسرون.
وقفة
[12] ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ أعظم السفه السخرية بأبين الحقائق.
وقفة
[12] ﴿قالوا تِلكَ إِذًا كَرَّةٌ خاسِرَةٌ﴾ ستكون بالفعل عليهم خسارة عظيمة.
الإعراب :
- ﴿ قالُوا: ﴾
- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو صمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
- ﴿ تِلْكَ إِذاً: ﴾
- تي: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. اذا: حرف جواب مهمل لا عمل له. بمعنى أنها إن صحت فنحن اذا خاسرون لتكذيبنا بها، وهذا استهزاء منهم.
- ﴿ كَرَّةٌ خاسِرَةٌ: ﴾
- خبر «تلك» مرفوع بالضمة. خاسرة: صفة- نعت- نكرة مرفوعة مثلها بالضمة أي رجعة خاسرة. والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به- مقول القول-
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ٣- كانوا يقولون: إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة، مغبونًا صاحبها، قال تعالى:
﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [13] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾
التفسير :
قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه:{ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ} ينفخ فيها في الصور.
وقد رد - سبحانه - عليهم ردا سريعا حاسما يخرس ألسنتهم فقال : ( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِذَا هُم بالساهرة ) .
والزجرة : المرة من الزجر ، وهو الصياح المصحوب بالغضب ، يقال : زجر فلا فلانا ، إذا أمره أو نهاه عن شئ بحدة وغضب .
والساهرة : الأرض المستوية الخالية من النبات .
والمراد بها هنا : الأرض التى يحشر الله - تعالى - فيها الخلائق .
قال القرطبى : قوله : ( فَإِذَا هُم بالساهرة ) أى : على وجه الأرض ، بعد أن كانوا فى بطنها . سميت بهذا الاسم ، لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم ، والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة ، بمعنى ذات سهر ، لأنه يسهر فيها خوفا منها ، فوصفها بصفة ما فيها . .
والفاء فى قوله : ( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ . . . ) للتفريع على قولهم السابق ، وضمير " هى " يعود إلى الحاة والقصة التى أنكروها ، وهى قيام الساعة .
أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - على سبيل التوبيخ والتقريع : ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث ولا جزاء . . بل الحق أن ذلك لآت لا ريب فيه ، وأن عودتكم إلى الحياة مرة أخرى لا تقتضى من خالقكم سوى صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكته بكم ، فإذا أنتم قيام من قبوركم ، ومجتمعون فى المكان الذى يحدده الله - تعالى - لاجتماعكم ولحسابكم وجزائكم .
قال الله تعالى : ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) أي : فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد ، فإذا الناس قيام ينظرون ، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث ، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب - عز وجل - ينظرون ، كما قال : ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) [ الإسراء : 52 ] وقال تعالى : ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) [ القمر : 50 ] وقال تعالى : ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) [ النحل : 77 ] .
قال مجاهد : ( فإنما هي زجرة واحدة ) صيحة واحدة .
وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم .
وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب . وقال أبو مالك ، والربيع بن أنس : زجرة واحدة : هي النفخة الآخرة .
وقوله: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ يقول تعالى ذكره: فإنما هي صيحة واحدة، ونَفخة تنفخ في الصور، وذلك هو الزجرة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قال: صيحة .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قال: الزجرة: النفخة في الصور.
التدبر :
وقفة
[13] ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ الزجرة: هي النفخة الثانية في الصور، واسمها الرادفة، وبها يُبعَث كل الخلق من جديد.
وقفة
[13] ﴿فَإِنَّما هِيَ زَجرَةٌ واحِدَةٌ﴾ الزجرة قوية وكل ما كان هامدًا يقوم بسرعة من مرقده، وهى زجرة واحدة، وليست بعسيرة على الله سبحانه.
الإعراب :
- ﴿ فَإِنَّما هِيَ: ﴾
- الفاء: استئنافية أو سببية متعلقة بمحذوف معناه: لا تستصعبوها أي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل فانها سهلة في قدرته ما هي إلا صيحة واحدة. انما: كافة ومكفوفة. هي: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
- ﴿ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ: ﴾
- خبر «هي» مرفوع بالضمة. واحدة: صفة- نعت- لزجرة مرفوعة مثلها بالضمة. أي صيحة واحدة أي النفخة الأولى.
المتشابهات :
| الصافات: 19 | ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ﴾ |
|---|
| النازعات: 13 | ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ |
|---|
| النازعات: 14 | ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [13] لما قبلها : وبعد إنْكارِهم لِإحْياءِ العِظامِ النَّخِرَةِ؛ جاء الرَدُّ عليهم هنا: لا تَسْتَصْعِبُوا أمْر البعث، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ، قال تعالى:
﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [14] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾
التفسير :
فإذا الخلائق كلهم{ بِالسَّاهِرَةِ} أي:على وجه الأرض، قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم.
وعبر - سبحانه - عن اجتماعهم بأرض المحشر بإذا الفجائية فقال : ( فَإِذَا هُم بالساهرة ) للإيذان بأن اجتماعهم هذا سيكون فى نهاية السرعة والخفة ، وأنه سيتحقق فى أعقاب الزجرة بدون أقل تأخير .
ووصف - سبحانه - الزجرة بأنها واحدة ، لتأكيد ما فى صيغة المرة من معنى الوحدة ، أى : أن الأمر لا يقتضى سوى الإِذن منا بصيحة واحدة لا أكثر ، تنهضون بعدها من قبوركم للحساب والجزاء ، نهوضا لا تملكون معه التأخر أو التردد . . والمراد بها : النفخة الثانية .
وقال - سبحانه - ( فَإِذَا هُم ) بضمير الغيبة ، إهمالا لشأنهم ، وتحقيرا لهم عن استحقاق الخطاب .
وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ( وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ) وإلى هنا نجد السورة الكريمة قد حثتنا حديثا بليغا مؤثرا عن أهوال يوم القيامة ، وعن أحوال المجرمين فى هذا اليوم العسير .
وقوله : ( فإذا هم بالساهرة ) قال ابن عباس : ( بالساهرة ) الأرض كلها . وكذا قال سعيد بن جبير ، وقتادة ، وأبو صالح .
وقال عكرمة ، والحسن ، والضحاك ، وابن زيد : ( بالساهرة ) وجه الأرض .
وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و ( بالساهرة ) المكان المستوي .
وقال الثوري : ( بالساهرة ) أرض الشام ، وقال عثمان بن أبي العاتكة : ( بالساهرة ) أرض بيت المقدس . وقال وهب بن منبه : ( الساهرة ) جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضا : ( بالساهرة ) جهنم .
وهذه أقوال كلها غريبة ، والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح ، حدثنا بشر بن السري ، حدثنا مصعب بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي : ( فإذا هم بالساهرة ) قال : أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي .
وقال الربيع بن أنس : ( فإذا هم بالساهرة ) ويقول الله - عز وجل - : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ) [ إبراهيم : 48 ] ، ويقول : ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ) [ طه : 105 ، 106 ] . وقال : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) [ الكهف : 47 ] : وبرزت الأرض التي عليها الجبال ، وهي لا تعد من هذه الأرض ، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ، ولم يهراق عليها دم .
وقوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) يقول تعالى ذكره: فإذا هؤلاء المكذبون بالبعث المتعجبون من إحياء الله إياهم من بعد مماتهم، تكذيبا منهم بذلك بالساهرة، يعني بظهر الأرض، والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة، وأراهم سموا ذلك بها، لأن فيه نوم الحيوان وسهرها، فوصف بصفة ما فيه؛ ومنه قول أُميَّة بن أبي الصَّلْت:
وفِيهــا لَحْــمُ ســاهِرَةٍ وبَحْــرٍ
وَمَــا فــاهُوا بِــهِ لَهُــمُ مُقِيـمُ (14)
ومنه قول أخي نهم يوم ذي قار لفرسه:
أَقْــدِمْ " مِحـاجُ" إنهــا الأسـاوِرَه
وَلا يَهُــولَنَّكَ رِجْــــلٌ نــادِرَهْ
فإنَّمَــا قَصْــرُكَ تُرْبُ السَّــاهِرَهْ
ثُــمَّ تَعُــودُ بَعْدَها فِي الْحَــافِرَهْ
مِنْ بَعْــدِ ما كُنْتَ عِظامـا ناخِـرَهْ (15)
واختلف أهل التأويل في معناها، فقال بعضهم مثل الذي قلنا.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: على الأرض، قال: فذكر شعرا قاله أُمية بن أبي الصلت، فقال:
عِنْدَنا صَيْدُ بَحْرٍ وصَيْدُ ساهِرَةٍ (16)
حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: ثنا أبو محصن، عن حصين، عن عكرِمة، في قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: الساهرة: الأرض، أما سمعت: لهم صيد بحر، وصيد ساهرة .
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) يعني: الأرض .
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرِمة، في قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: فإذا هم على وجه الأرض، قال: أو لم تسمعوا ما قال أُمية بن أبي الصلت لهم:
وفِيهــا لَحْــمُ ســاهِرَةٍ وبَحْــرٍ
..........
حدثنا عمارة بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا عمارة، عن عكرمة، في قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: فإذا هم على وجه الأرض، قال أمية:
وفِيهــا لَحْــمُ ســاهِرَةٍ وبَحْــرٍ
..........
حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) فإذا هم على وجه الأرض .
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( بِالسَّاهِرَةِ ) قال: المكان المستوي .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: لما تباعد البعث في أعين القوم قال الله: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يقول: فإذا هم بأعلى الأرض بعد ما كانوا في جوفها .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( بِالسَّاهِرَةِ ) قال: فإذا هم يخرجون من قبورهم فوق الأرض والأرض، الساهرة، قال: فإذا هم يخرجون .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة وأبي الهيثم، عن سعيد بن جُبير ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: بالأرض .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جُبير، مثله.
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حصين، عن عكرمة، مثله.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) : وجه الأرض .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: الساهرة ظهر الأرض فوق ظهرها .
وقال آخرون: الساهرة: اسم مكان من الأرض بعينه معروف.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ بن سهل، قال: ثني الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، قوله: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ قال: بالصُّقْع الذي بين جبل حسان وجبل أريحاء، يمدّه الله كيف يشاء .
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: أرض بالشام .
وقال آخرون: هو جبل بعينه معروف.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا الحسن بن بلال، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا أبو سنان، عن وهب بن منبه، قال في قول الله: ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: الساهرة: جبل إلى جنب بيت المقدس .
وقال آخرون: هي جهنم.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال : ثنا محمد بن مروان العقيلي، قال : ثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قال: في جهنم.
المعاني :
التدبر :
لمسة
[14] ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (إذا) فجائية للدلالة على سرعة حضورهم لأرض المحشر عقب النفخة الثانية مباشرة، حيث يأمر الله بخلق أجساد جديدة تحلُّ فيها الأرواح، ثم تحضر الأجساد والأرواح إلى ساحة الحشر للحساب بأسرع ما يكون.
وقفة
[14] ﴿فَإِذا هُم بِالسّاهِرَةِ﴾ أى لا ينام فيها أحد، وقيل المستوية لا نبات فيها، وقيل لا يوجد بها شئ يختبئ وراءه أحد.
الإعراب :
- ﴿ فَإِذا هُمْ: ﴾
- الفاء استئنافية تفيد التسبيب. اذا: فجائية- حرف فجاءة لا محل لها من الإعراب. هم: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. والجملة الاسمية: استئنافية لا محل لها من الإعراب.
- ﴿ بِالسَّاهِرَةِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بخبر «هم» أي أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتا في جوفها و «الساهرة» الأرض البيضاء المستوية وقيل: فاذا هم في جهنم.
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [14] لما قبلها : وبعد ذكرِ النفخة الثانية؛ يأتي ذكر خروج الموتى على سطح الأرض أحياء، بعد أن كانوا في بطنها، قال تعالى:
﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [15] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾
التفسير :
يقول [الله] تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:{ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه.
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة موسى مع فرعون ، لتكون تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم عما أصابه من هؤلاء الجاحدين ، وتهديدا لهم حتى يقلعوا عن غيهم . . فقال - تعالى - :
( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ . . . ) .
قال الإِمام الرازى : اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين :
الأول : أنه - تعالى - حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث ، حتى انتهوا فى ذلك الإِنكار إلى حد الاستهزاء فى قولهم : ( تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ) وكان ذلك يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر - سبحانه - قصة موسى - عليه السلام - ، وبين أنه تحمل المشقة فى دعوة فرعون ، ليكون ذلك لتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم .
الثانى : أن فرعون كان أقوى من كفار قريش . . فلما تمرد على موسى ، أخذه الله - تعالى - نكال الآخرة والأولى ، فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك ، إن أصروا ، أخذهم الله وجعلهم نكالا . .
والمقصود من الاستفهام فى قوله - تعالى - : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسى . . . ) التشويق إلى الخبر ، وجعل السامع فى أشد حالات الترقب لما سيلقى إليه ، حتى يكون أكثر وعيا لما سيسمعه .
والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لقصد تسليته ، ويندرج فيه كل من يصلح له .
والمعنى : هل وصل إلى علمك - أيها الرسول الكريم - خبر موسى - عليه السلام - مع فرعون؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك ، فتنبه له ، لتزداد ثباتا على ثباتك ، وثقة فى نصر الله - تعالى - لك على ثقتك .
يخبر تعالى رسوله محمدا - صلى الله عليه وسلم - عن عبده ورسوله موسى ، عليه السلام ، أنه ابتعثه إلى فرعون ، وأيده بالمعجزات ، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه ، حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ; ولهذا قال في آخر القصة : ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى )
فقوله : ( هل أتاك حديث موسى ) ؟أي : هل سمعت بخبره ؟
القول في تأويل قوله تعالى : هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) .
-----------------------
الهوامش:
(14) البيت لأمية بن أبي الصلت ( ديوانه : 52 واللسان : سهر ) وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 184 ) قال : " الساهرة " : الفلاة ، ووجه الأرض . قال أمية بن أبي الصلت : " وفيها لحم ساهرة ... " البيت . وفاهموا : تكلموا . وقال الفراء في معاني القرآن ( 456 ) وقوله : { فإذا هم بالساهرة } وهو وجه الأرض كأنها سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها الحيوان : نومهم وسهرهم . وبإسناده إلى ابن عباس أنه قال : الساهرة : الأرض . وأنشد : " ففيها لحم ساهرة ... " البيت . ا هـ . ويصف الجنة بأنهم يطعمون فيها لحما من الصيد ولحم البحر ، وكل ما فاهت به أفواههم من شيء ، وجدوه حاضرا لديهم .
(15) هذه خمسة أبيات من مشطور الرجز ، نسبها صاحب ( اللسان : نخر ) إلى الهمداني . قال ابن بري : وقال الهمداني يوم القادسية ورواية البيتين الأولين مختلفة شيئا وهي :
أقْــدِمْ أخـا نَهْـمٍ عَـلى الأسـاوِرَه
وَلا تَهُــــولَنْكَ رُءُوسٌ نـــادَرِهْ
وبعدهما بقية الأبيات ، كرواية المؤلف . ومحاج في رواية المؤلف بفتح الميم وكسرها : اسم فرس ، وأما على رواية ابن بري فإنه يخاطب رجلا . والأساورة : جمع أسوار بضم الهمزة وكسرها ؛ قيل كما في تاج العروس : هو قائد الفرس ، بمنزلة الأمير في العرب . وقيل : هو الملك الأكبر . وقيل : هو الجيد الرمي بالسهام . وقيل : هو الثابت على ظهر الفرس . والنادرة : التي ندرت عن الجسد وفارقته . وقصرك : نهاية أمرك وغايته ، والساهرة : الأرض أو الفلاة ، كما تقدم ذكره . والحافرة : الأولى قبل الموت . والناخرة بمعنى : النخرة ، وهي البالية . وفي ( اللسان : نخر ) في قوله تعالى : { أئذا كنا عظاما نخرة } وقرئ : ناخرة . قال : وناظرة أجود الوجهين ؛ لأن الآيات بالألف ، ألا ترى أن ناخرة مع الحافرة والساهرة أشبه بمجئ التأويل . قال : والناخرة والنخرة : سواء في المعنى ، بمنزلة الطامع والطمع . قال ابن بري . قال : الهمداني يوم القادسية : " أقدم أخا نهمٍ ... " الأبيات الخمسة . ا هـ .
(16) هذا كلام غير موزون ، وبيت أمية بن أبي الصلت تقدم قريبا ، ونعيده هنا كما وجدناه في ( ديوانه 52 ) .
وفيهــا لَحْــمُ ســاهِرَةٍ وَبحْــرٍ
ومــا فــاهُوا بــه أبَــدا مُقِيـمُ
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[15] ﴿هَل أَتاكَ حَديثُ موسى﴾ من ضمن أهداف القصص القرآنى تسلية الرسول والتسرية عنه، وأيضًا للعظة والاعتبار.
وقفة
[15] ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ وهذا تسلية للنبي ﷺ؛ أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه، وكذلك هؤلاء.
وقفة
[15] ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ فرعون كان أقوى من كل طاغية، ولما تمرد على موسى أخذه الله نكال الآخرة والأولى، فلا تستبعد هلاك من هو دون فرعون في القوة والأعوان، وسلك نفس مسلكه في الطغيان.
وقفة
[15] ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ قصة موسى تبين لنا طريق الدعوة إلى الله؛ فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه.
وقفة
[15] ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ خير ما يتسلي به المحزون قصص من أصابهم مثل حزنه, لذا قص الله علي نبينا صلي الله عليه وسلم قصة موسي ومصير فرعون؛ تثبيتًا له وتصبيرًا علي ما أصابه.
لمسة
[15] ﴿هَل أَتاكَ حَديثُ موسى﴾ الاستفهام هنا لا يقصد به السؤال، إنما يقصد به التشويق.
الإعراب :
- ﴿ هَلْ أَتاكَ: ﴾
- هل: بمعنى «قد» أو تكون حرف استفهام لا عمل له. أتاك:فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم.
- ﴿ حَدِيثُ مُوسى: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة. موسى: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف للتعذر بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعجمة.
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [15] لما قبلها : وبعدَ أن ذَكَرَ اللهُ إصرارَ الكُفَّارِ على إنكارِ البعثِ؛ ذَكَرَ هنا قصَّةَ موسى عليه السلام الذي تَحمَّلَ المشَقَّةَ الكبيرةَ في دَعوةِ فِرعَونَ؛ لِيَكونَ ذلك كالتَّسليةِ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا تمَرَّد على موسى عليه السَّلامُ؛ أخَذَه اللهُ نَكالَ الآخرةِ والأُولى، فكذلك هؤلاء الكُفَّار في تمَرُّدِهم عليك، إنْ أصَرُّوا أخَذَهم اللهُ، وجَعَلَهم نَكالًا، قال تعالى:
﴿ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [16] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ .. ﴾
التفسير :
أي:هل أتاك حديثه{ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى} وهو المحل الذي كلمه الله فيه، وامتن عليه بالرسالة، واختصه بالوحي والاجتباء
والظرف " إذ " فى قوله - تعالى - : ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بالواد المقدس طُوًى ) متعلق بلفظ " حديث " والجملة يدل اشتمال مما قبلها .
و " الواد " المكان المنخفض بين جبلين ، أو بين مكانين مرتفعين . و " المقدس " : بمعنى المطهر . و " طوى " اسم للوادى . وقد جاء الحديث عنه فى آيات متعددة ، منها قوله - تعالى - : ( فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ ياموسى . إني أَنَاْ رَبُّكَ فاخلع نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالواد المقدس طُوًى ) والمعنى : هل بلغك - أيها الرسول الكريم - خبر موسى ، وقت أن ناديناه وهو بالواد المقدس طوى ، الذى هو بجانب الطور الأيمن ، بالنسبة للقادم من أرض مدين التى هى فى شمال الحجاز .
ويدل على ذلك قوله - تعالى - : ( فَلَمَّا قضى مُوسَى الأجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطور نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ امكثوا إني آنَسْتُ نَاراً لعلي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِىءِ الوادي الأيمن فِي البقعة المباركة مِنَ الشجرة أَن ياموسى إني أَنَا الله رَبُّ العالمين ) .
"إذ ناداه ربه" أي كلمه نداء "بالواد المقدس" أي المطهر "طوى" وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه.
القول في تأويل قوله تعالى : إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : هل أتاك يا محمد حديث موسى بن عمران، وهل سمعت خبره حين ناجاه ربه بالواد المقدّس، يعني بالمقدّس: المطهر المبارك. وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك فيما مضى، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع، وكذلك بيَّنَّا معنى قوله: ( طُوًى ) وما قال فيه أهل التأويل، غير أنا نذكر بعض ذلك هاهنا.
وقد اختلف أهل التأويل في قوله: ( طُوى ) فقال بعضهم: هو اسم الوادي.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( طُوًى ) اسم الوادي .
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى قال: اسم المقدّس طوى .
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) كنا نحدّث أنه قدّس مرّتين، واسم الوادي طُوًى .
وقال آخرون: بل معنى ذلك: طأ الأرض حافيا.
* ذكر بعض من قال ذلك:
حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى قال: طأ الأرض بقدمك .
وقال آخرون: بل معنى ذلك أن الوادي قدّس طوى: أي مرّتين، وقد بيَّنا ذلك كله ووجوهه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقرأ ذلك الحسن بكسر الطاء، وقال: بُثَّتْ فيه البركة والتقديس مرّتين. حدثنا بذلك أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا هشيم، عن عوف، عن الحسن.
واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة ( طُوًى ) بالضمّ ولم يجرّوه وقرأ ذلك بعض أهل الشأم والكوفة ( طُوًى ) بضمّ الطاء والتنوين.
التدبر :
اسقاط
[16] ﴿إذ ناداه ربه﴾ كم ينادينا ربنا ويدعونا للعلم والعمل والدعوة والسعي والإيمان والتقوى! فهل نلبي النداء؟!
وقفة
[16] ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ المقدَّس: المطهَّر، والمراد به التطهير المعنوي، وهو التشريف والتبريك لأجل ما نزل فيه من كلام الله دون وساطة ملَك إلى موسى عليه السلام، وهذا تقديس خاص.
وقفة
[16] ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ستجد العظماء في المكان اللائق بهم.
وقفة
[16] ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ تكتسب الأماكن العظمة والجلال مما يكون فيها من أحداث عظام, وهل هناك أعظم من نزول الوحي بالهدي والرشاد؟!
وقفة
[16] ﴿إِذ ناداهُ رَبُّهُ بِالوادِ المُقَدَّسِ طُوًى﴾ الآية دليل على أن الله تعالى ينادى ويتكلم كما يشاء، وهو كلام مسموع وحقيقى، فلا نحرف ولا نبطل ولا نشبه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
الإعراب :
- ﴿ إِذْ ناداهُ: ﴾
- ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بأتاك. نادى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والهاء ضمير متصل- ضمير الغائب- مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. وجملة «ناداهُ رَبُّهُ» في محل جر مضاف اليه.
- ﴿ رَبُّهُ بِالْوادِ: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.بالواد: جار ومجرور متعلق بناداه وحذفت الياء خطا واختصارا واكتفاء بالكسرة الدالة عليها.
- ﴿ الْمُقَدَّسِ طُوىً: ﴾
- صفة- نعت- للوادي مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.طوى: بدل من «الوادي» لأنها اسم الوادي مجرورة أيضا وعلامة جرها الكسرة المقدرة للتعذر على الألف المقصورة قبل تنوينها ونونت وصرفت لأنها اسم مكان وهي نكرة وقيل ان «الْمُقَدَّسِ طُوىً» أي طوي مرتين. بمعنى:قدس مرتين أي ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين هذا ما قاله الحسن وذكره «مختار الصحاح».
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ حَدِيث مُوسَى؛ فَصَّلَ هنا هذا الحديث، قال تعالى:
﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾
القراءات :
جاري إعداد الملف الصوتي
لم يذكر المصنف هنا شيء

