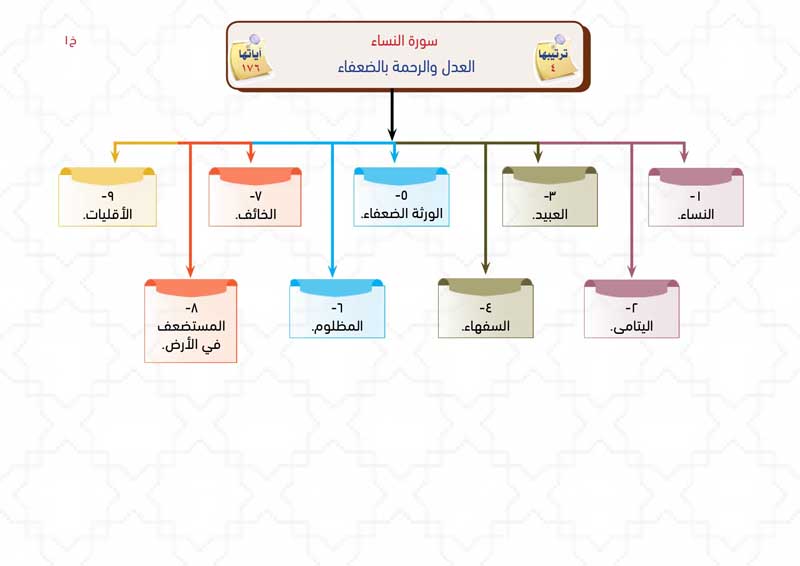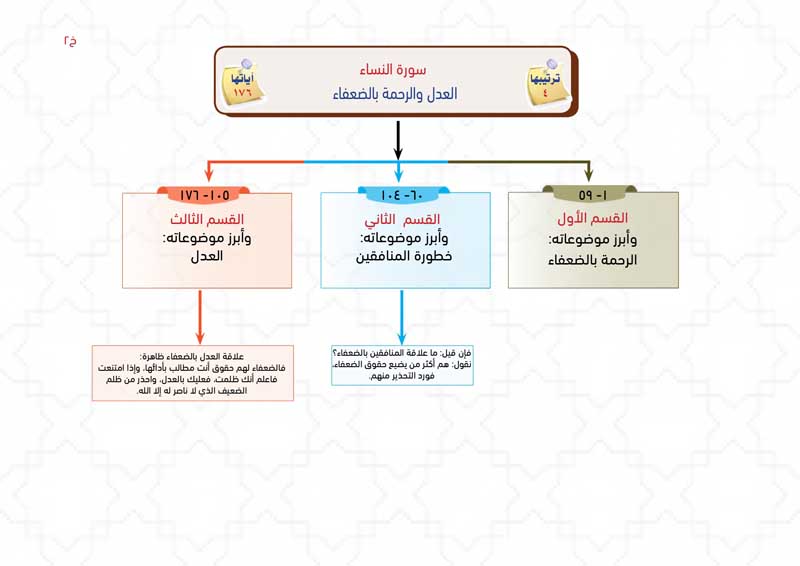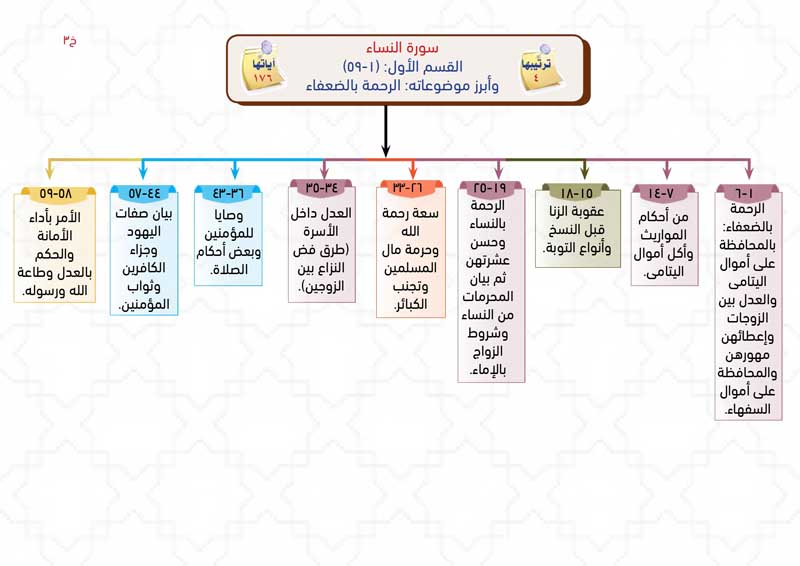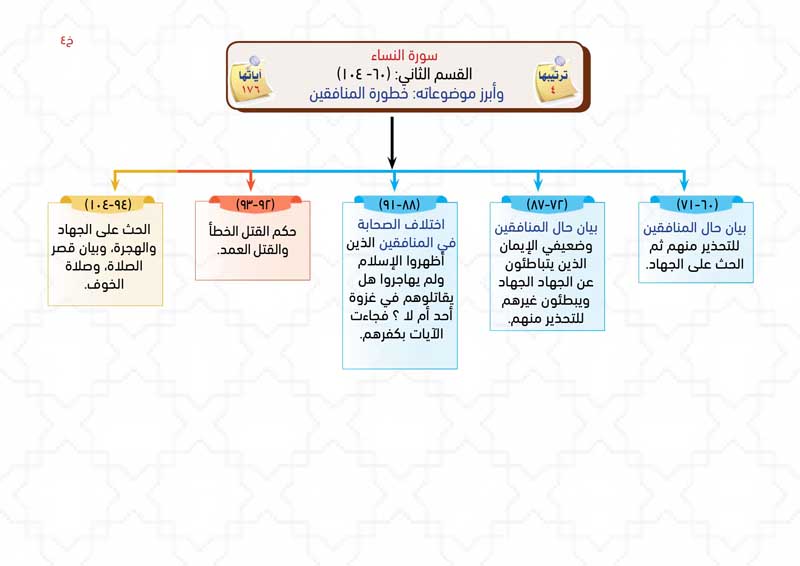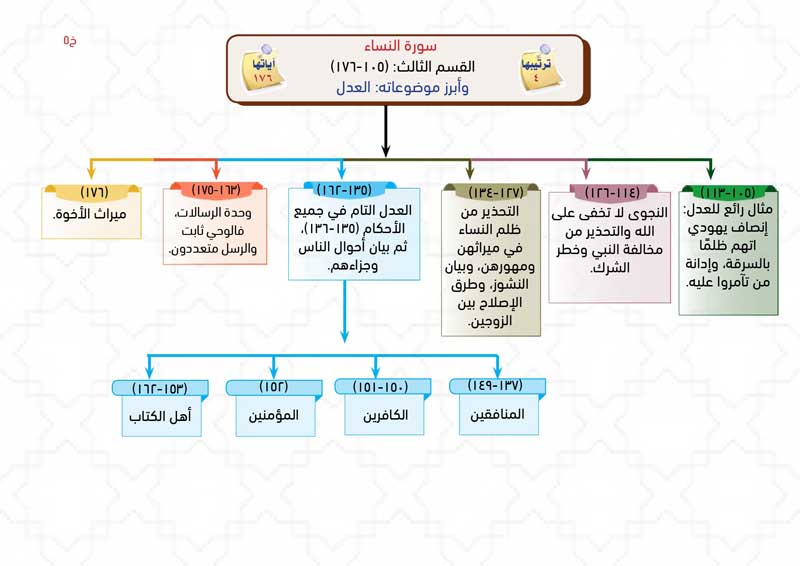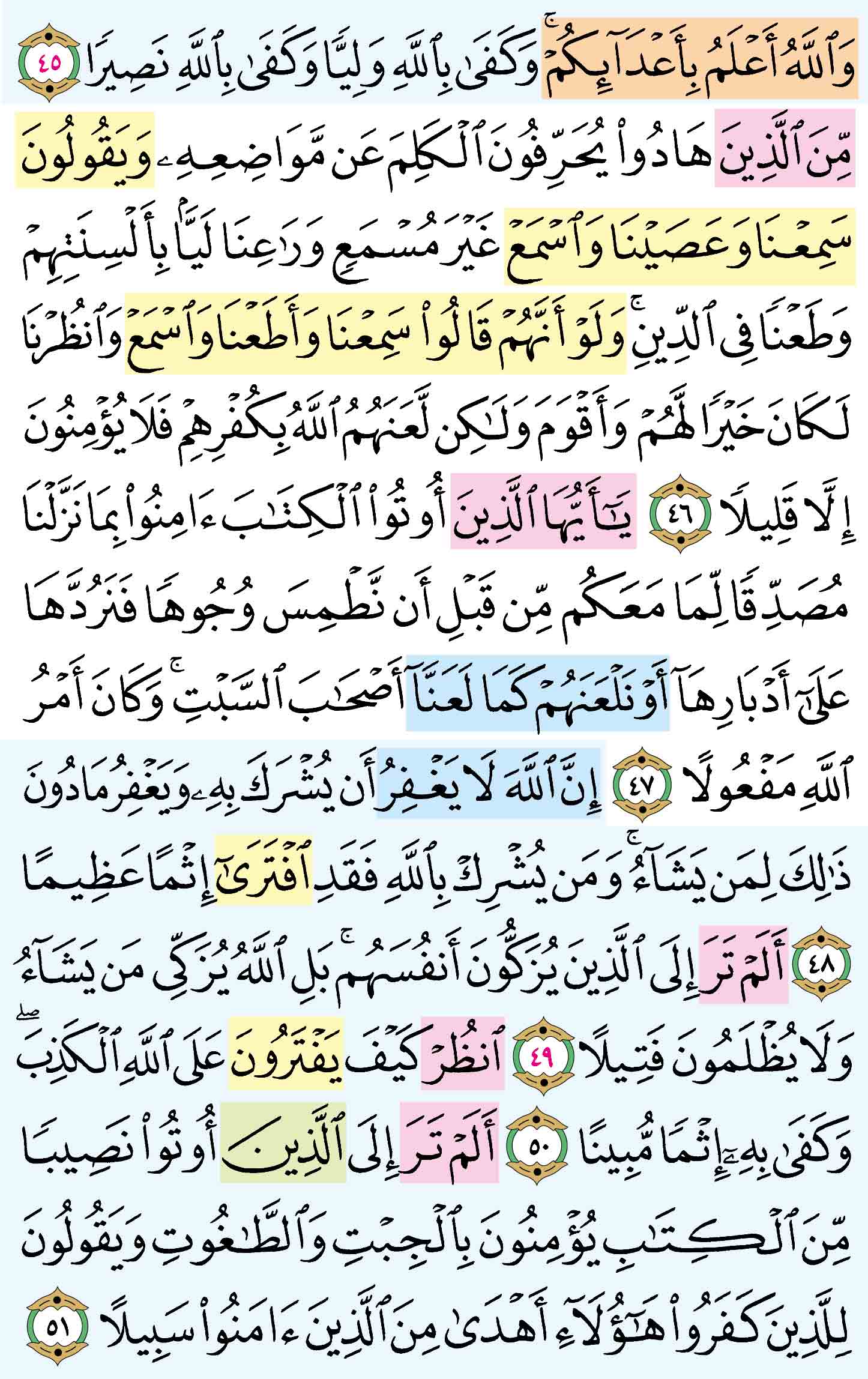
الإحصائيات
سورة النساء
| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |
| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |
| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |
| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |
| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (46) الى الآية رقم (47) عدد الآيات (2)
لمَّا ذكرَ حرصَ اليهودِ على إضلالِ المؤمنينَ بَيَّنَ هنا ما يُضلِّونَ به: تحريفَهم كلامَ اللهِ، ومَكرَهم وإيذاءَهم رسولِه ﷺ، ثُمَّ رجَّاهم ودعاهم للإيمانِ، ثُمَّ هَدَّدَهم وذَكَّرَهم بأصحابِ السبتِ.
فيديو المقطع
المقطع الثاني
من الآية رقم (48) الى الآية رقم (51) عدد الآيات (4)
تهديدٌ آخرٌ: اللهُ لا يغفرُ ولا يتجاوزُ عن المشركِ، ويتجاوزُ ويعفو عمَّا دون الشركِ من الذنوبِ لمن يشاءُ، ثُمَّ توبيخُ الذينَ يزكُّون أنفسَهم.
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة النساء
العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع
أولاً : التمهيد للسورة :
- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.
- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «النساء».
- • معنى الاسم :: ---
- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".
- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾
- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.
• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».
• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).
• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.
• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).
• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).
• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.
• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.
• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.
• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).
• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:
- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).
- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).
- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).
- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).
* الإسلام وحقوق النساء:
- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.
• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).
• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).
• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).
• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).
• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.
• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).
• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).
• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).
• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).
• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).
• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).
• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).
• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).
• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).
• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).
• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).
• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.
• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).
• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).
• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).
• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).
• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.
• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).
• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).
• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).
• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).
• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).
• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).
تمرين حفظ الصفحة : 86
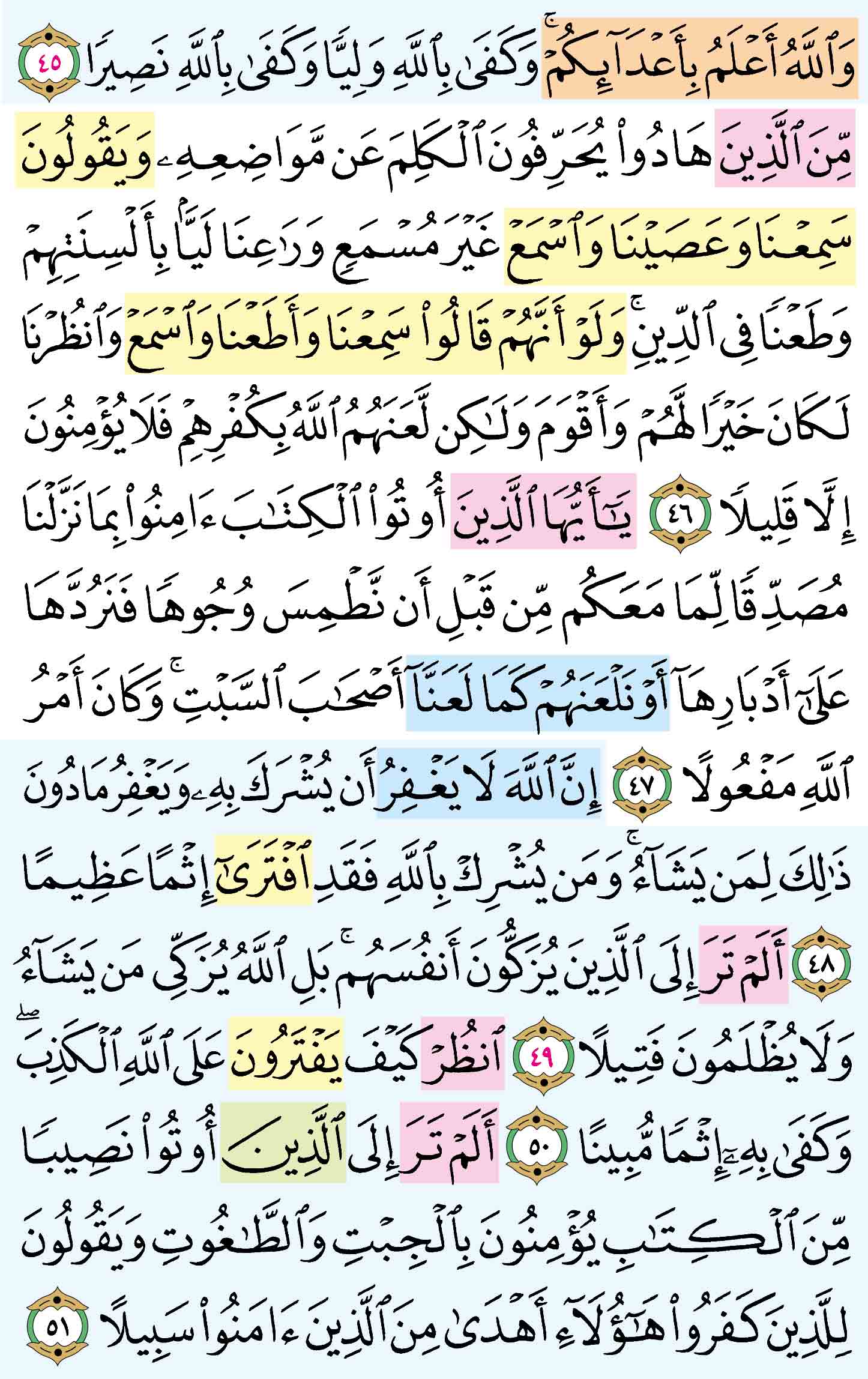
مدارسة الآية : [45] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ .. ﴾
التفسير :
.ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم، بيَّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال:{ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا} أي:يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم.{ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا} ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال الشر.
وقوله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ جملة معترضة للتأكيد والتحذير.
أى: والله- تعالى- أعلم بأعدائكم منكم- أيها المؤمنون- وقد أخبركم بأحوالهم وبما يبيتون لكم من شرور فاحذروهم ولا تلتفتوا إلى أقوالهم وأعدوا العدة لتأديبهم دفاعا عن دينكم وعقيدتكم.
وقوله وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً تذييل قصد به غرس الطمأنينة في نفوس المؤمنين بأن العاقبة لهم.
أى: وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا يتولى أموركم، ويصلح بالكم، وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً يدفع عنكم مكرهم وشرورهم وما دام الأمر كذلك فاكتفوا بولايته ونصرته. واعتصموا بحبله، وأطيعوا أمره، ولا تكونوا في ضيق من مكر أعدائكم فإن الله ناصركم عليهم بفضله وإحسانه.
وقوله وَكَفى فعل ماض. ولفظ الجلالة فاعل والباء مزيدة فيه لتأكيد الكفاية. ووليا ونصيرا منصوبان على التمييز. وقيل على الحال.
وكرر- سبحانه- الفعل كفى لإلقاء الطمأنينة في قلوب المؤمنين، لأن التكرار في مثل هذا المقام يكون أكثر تأثيرا في القلب، وأشد مبالغة فيما سيق الكلام من أجله.
فكأنه- سبحانه- يقول لهم: اكتفوا بولاية الله ونصرته، وكفاكم الله الولاية والنصرة والمعونة. ومن كان الله كافيه نصره على عدوه فاطمئنوا ولا تخافوا.
( والله أعلم بأعدائكم ) أي : هو يعلم بهم ويحذركم منهم ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ) أي : كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره .
القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)
ثم أخبر الله جلّ ثناؤه عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنين أن يستنصحوهم في دينهم إياهم، فقال جل ثناؤه: =" والله أعلم بأعدائكم "، يعني بذلك تعالى ذكره: والله أعلم منكم بعداوَة هؤلاء اليهود لكم، أيها المؤمنون. يقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم، (1) فإني أعلم بما هم عليه لكم من الغشِّ والعداوة والحسد، وأنهم إنما يبغونكم الغوائل، ويطلبون أن تضلوا عن محجة الحق فتهلكوا.
* * *
وأما قوله: " وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرًا "، فإنه يقول: فبالله، أيها المؤمنون، فثقوا، وعليه فتوكلوا، وإليه فارغبوا، دون غيره، يكفكم مهمَّكم، وينصركم على أعدائكم =" وكفى بالله وليًّا "، يقول: وكفاكم وحسْبكم بالله ربكم وليًّا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم، والحراسة من أن يستفزّكم أعداؤكم عن دينكم، أو يصدّوكم عن اتباع نبيكم (2)
" وكفى بالله نصيرًا "، يقول: وحسبكم بالله ناصرًا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم، وعلى من بغاكم الغوائل، وبغى دينكم العَوَج. (3)
----------------
الهوامش :
(1) في المخطوطة: "مما نهيتكم عنه" ، وفي المطبوعة: "عما نهيتكم عنه" ، والصواب ما أثبت.
(2) انظر تفسير: "الولي" فيما سلف 2: 489 ، 564 / 5: 424 / 6: 142 ، 313 ، 497.
(3) انظر تفسير"النصير" فيما سلف 2: 489 ، 564 / 5: 581 / 6: 443 ، 449.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ منكم؛ فلا تستنصحوهم؛ فإنهم أعداؤكم، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا﴾ يدفع عنكم مكرهم وشرهم، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ اكتفوا بولايته ونصرته.
وقفة
[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ الله ﷻ أعلم بعدوك وأقدر عليه منك؛ فإذا أرضيت ربك كفاك عدوك.
وقفة
[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ مهما كان المؤمن حذرًا فهناك أعداء لا يعلمهم, الله يعلمهم ويكفيه همهم, وهذا من لطفه بعباده، ومن ولايته لهم، فنعم المولى ونعم النصير.
وقفة
[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ هناك أعداء لا تعلمهم، وأعداء في صورة أصدقاء (الله يعلمهم) و(يكفيك همهم).
اسقاط
[45] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ إذا تخلى الناس عنك في كرب، فاعلم أن الله يريد أن يتولى أمرك، وكفىٰ بالله وليًّا.
وقفة
[45] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ العاملون على رضا الله وإن سخط الناس أحمد الناس عاقبة، ذلك بأنهم حفظوا الله فحفظهم، وتولوا الله فكفاهم.
وقفة
[45] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه.
عمل
[45] حدد ظلمًا عانيت منه، واستنصر بربك وحده، وقل: يا نصير، انصرني ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ: ﴾
- الواو: استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة والجملة الاسمية استئنافية. لا محل لها. أعلم: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة بأعدائكم: جار ومجرور متعلق بأعلم والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا: ﴾
- الواو: استئنافية. كفى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. بالله الباء: حرف زائد. الله لفظ الجلالة: اسم مجرور للتعظيم لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل الفعل «كَفى». وليا: تمييز منصوب بالفتحة.
- ﴿ وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً: ﴾
- معطوفة بواو العطف على «كَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا» وتعرب إعرابها. ويجوز أن تكون. الواو في الجملتين اعتراضية والجملتان اعتراضيتين وهو الأفصح. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [45] لما قبلها : لمَّا ذكرَ اللهُ عز وجل حرصَ اليهودِ على إضلالِ المؤمنينَ؛ بَيَّنَ هنا ضرورة الالتجاء إليه وطلب العون منه، قال تعالى:
﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [46] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ .. ﴾
التفسير :
ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال:{ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} أي:اليهود وهم علماء الضلال منهم.{ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} إما بتغيير اللفظ أو المعنى، أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها، ولا مقصود بها بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم{ يَقُولون سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} أي:سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون:{ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ} قصدهم:اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره،{ وَرَاعِنَا} قصدهم بذلك الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ -لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور- أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظِ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال:{ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ} ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال:{ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ} وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول، والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم، والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية، أعرضوا عن ذلك، وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال:{ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا}
ثم ذكر- سبحانه- ألوانا من الأقوال والأعمال القبيحة التي كان اليهود يقولونها ويفعلونها للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فقال: مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ.
وتحريف الشيء إمالته وتغييره. ومنه قولهم: طاعون يحرف القلوب، أى يميلها ويجعلها على حرف، أى جانب وطرف. وأصله من الحرف يقال: حرف الشيء عن وجهه، صرفه عنه.
والجملة الكريمة بيان للموصول وهو قوله- تعالى- الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ.
ويجوز أن يكون قوله مِنَ الَّذِينَ هادُوا خبر لمبتدأ محذوف. وقوله يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ صفة له.
أى من الذين هادوا قوم أو فريق من صفاتهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه أى يميلونه عن مواضعه، ويجعلون مكانه غيره، ويفسرونه تفسيرا سقيما بعيدا عن الحق والصواب.
قال الفخر الرازي: في كيفية التحريف وجوه:
أحدها: أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. مثل تحريفهم اسم «ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم «آدم طويل» ، وكتحريفهم الرجم بوضعهم الجلد بدله.
الثاني: أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة، والتأويلات الفاسدة، وصرف اللفظ من معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه من الحيل اللفظية، كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم. وهذا هو الأصح.
الثالث: أنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه» .
والذي نراه أولى أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتناول كل ذلك، لأنهم لم يتركوا وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوها، أملا منهم في صرف الناس عن الدعوة الإسلامية، ولكن الله- تعالى- خيب آمالهم.
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنْ مَواضِعِهِ وفي المائدة مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ؟ قلت: «أما عن مواضعه» فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة وضعه فيها، بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه.
وأما مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ فالمعنى أنه كانت له مواضع قمن بأن يكون فيها. فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان» .
ثم حكى- سبحانه- لونا ثانيا من ضلالتهم فقال: وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا أى.
ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرهم بشيء: سمعنا قولك وعصينا أمرك فنحن مع فهمنا لما تقول لا نطيعك لأننا متمسكون باليهودية.
ثم حكى- سبحانه- لونا ثالثا من مكرهم فقال: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق.
أى: ويقولون ذلك في أثناء مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام ذو وجهين وجه محتمل للشر. بأن يحمل على معنى «اسمع» حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه محتمل للخير. بأن يحمل على معنى اسمع منا غير مسمع كلاما تكرهه.
فأنت تراهم- لعنهم الله- أنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام المحتمل للشر والخير موهمين غيرهم أنهم يريدون الخير، مع أنهم لا يريدون إلا الشر، بسبب ما طفحت به نفوسهم من حسد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين.
ثم حكى- سبحانه- لونا رابعا من خبثهم فقال: وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وهو كلام معطوف على ما قبله وداخل تحت القول السابق.
وكلمة راعِنا كلمة ذات وجهين- أيضا- فهي محتملة للخير بحملها على معنى ارقبنا وأمهلنا أو انتظرنا نكلمك. ومحتملة للشر بحملها على شبه كلمة عبرانية كانوا يتسابون بها. أو على السب بالرعونة أى الحمق.
قال الراغب: قوله: - تعالى- وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ كان ذلك قولا يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم يقصدون به رميه بالرعونة، ويوهمون أنهم يقولون: راعنا أى: أحفظنا. من قولهم: رعن الرجل يرعن رعنا فهو رعن» أى أحمق.
وأصل كلمة لَيًّا لويا لأنه من لويت، فأدغمت الواو في الياء لسبقها بالسكون. واللى:
الانحراف والالتفات والانعطاف.
والمراد أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكلمة أو بالكلام ليكون اللفظ في السمع مشبها لفظا آخر هم يريدونه لأنه يدل على معنى ذميم.
أى أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم والاستهزاء راعِنا ويقصدون بهذا القول الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم وينطقون بهذه الكلمة وما يشابهها نطقا ملتويا منحرفا ليصرفوها عن جانب احتمالها للخير إلى جانب احتمالها للشر. ولذا فقد نهى الله- تعالى- المؤمنين عن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ.
قال ابن كثير: عند تفسيره لقوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا: نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يعلنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص- عليهم لعائن الله-: فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا: يقولون راعنا، ويورون بالرعونه: وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون. السام عليكم. والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم. وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله- تعالى- نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا» .
وقوله وَطَعْناً فِي الدِّينِ أى يقولون ذلك من أجل القدح في الدين والاستهزاء بتعاليمه، وبنبيه صلى الله عليه وسلم.
ثم بين- سبحانه- ما كان بحب عليهم أن يقولوه لو كانوا يعقلون فقال: تعالى- وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ
أى: ولو أنهم قالوا عند سماعهم لما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من حق وخير، سَمِعْنا قولك سماع قبول واستجابة، وأطعنا أمرك بدل قولهم سمعنا وعصينا.
ولو أنهم قالوا عند مخاطبتهم له صلى الله عليه وسلم وَاسْمَعْ إجابتنا لدعوة الحق وَانْظُرْنا حتى نفهم عنك ما تريده منا بدل قولهم وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ لو أنهم فعلوا ذلك لكان قولهم هذا خيرا لهم وأعدل من أقوالهم السابقة الباطلة التي حكاها القرآن عنهم.
ولكنهم لسوء طباعهم لم يفعلوا ذلك فحقت عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة وقد صرح القرآن بذلك فقال: وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. أى: ولكنهم لم يقولوا ما هو خير لهم وأقوم بل قالوا ما هو شر وباطل، فاستحقوا اللعنة من الله بسبب كفرهم وسوء أفعالهم:
ولفظ قَلِيلًا في قوله فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا منصوب على الاستثناء من قوله لَعَنَهُمُ أى: ولكن لعنهم الله إلا فريقا منهم آمنوا فلم يلعنوا: أو منصوب على الوصفية لمصدر محذوف أى: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا أى ضعيفا ركيكا لا يعبأ به، ولا يغنى عنهم من عذاب الله شيئا لأنه إيمان غير صحيح بسبب تفريقهم بين رسل الله في التصديق والطاعة.
قال- تعالى- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا. أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.
ثم قال تعالى : ( من الذين هادوا ) " من " هذه لبيان الجنس كقوله : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان )
وقوله : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) أي : يتأولون على غير تأويله ، ويفسرونه بغير مراد الله ، عز وجل ، قصدا منهم وافتراء ( ويقولون سمعنا وعصينا ) أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه . هكذا فسره مجاهد وابن زيد ، وهو المراد ، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم ، أنهم يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه ، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة .
وقوله ( واسمع غير مسمع ) أي : اسمع ما نقول ، لا سمعت . رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك .
قال ابن جرير : والأول أصح . وهو كما قال . وهذا استهزاء منهم واستهتار ، عليهم لعنة الله [ والملائكة والناس أجمعين ] .
( وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) أي : يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : " راعنا " وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) [ البقرة : 104 ] .
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه : ( ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) يعني : بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم قال تعالى : ( ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه ، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( فقليلا ما يؤمنون ) [ البقرة : 88 ] والمقصود : أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا .
القول في تأويل قوله : مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
قال أبو جعفر: ولقوله جل ثناؤه: " من الذين هادوا يحرفون الكلم "، وجهان من التأويل.
أحدهما: أن يكون معناه: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ =" من الذين هادوا يحرفون الكلم "، فيكون قوله: " من الذين هادوا " من صلة " الذين ". وإلى هذا القول كانت عامة أهلِ العربية من أهل الكوفة يوجِّهون قوله: " من الذين هادوا يحرِّفون ". (4)
* * *
والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يُحرِّف الكلم عن مواضعه، فتكون " مَن " محذوفة من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله: " من الذين هادوا "، عليها. وذلك أن " مِن " لو ذكرت في الكلام كانت بعضًا ل " مَن "، فاكتفى بدلالة " مِنْ"، عليها. والعرب تقول: " منا من يقول ذلك، ومِنا لا يقوله "، (5) بمعنى: منا &; 8-431 &; من يقول ذاك، ومنا من لا يقوله = فتحذف " مَن " اكتفاء بدلالة " مِنْ" عليه، كما قال ذو الرمة:
فَظَلُّــوا, وَمِنْهُـمْ دَمْعُـهُ سَـابِقٌ لَـهُ
وَآخَـرُ يَثْنِـي دَمْعَـةَ العَيْـنِ بِـالهَمْلِ (6)
يعني: ومنهم مَن دمعه، وكما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ [سورة الصافات: 164]. وإلى هذا المعنى كانت عامة أهل العربية من أهل البصرة يوجِّهون تأويل قوله: " من الذين هادوا يحرفون الكلم "، غير أنهم كانوا يقولون: المضمر في ذلك " القوم "، كأن معناه عندهم: من الذين هادوا قوم يحرِّفون الكلم، ويقولون: نظير قول النابغة:
كَــأَنَّكَ مِــنْ جِمَــالِ بَنِـي أُقَيْشٍ
يُقَعْقَــعُ خَــلْفَ رِجْلَيْــهِ بِشَــنِّ (7)
يعني: كأنك جمل من جمال أقيش.
فأما نحويو الكوفة فينكرون أن يكون المضمر مع " مِن " إلا " مَن " أو ما أشبهها. (8)
* * *
قال أبو جعفر: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك: قول من قال: قوله: " من الذين هادوا "، من صلة ( الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ) ، لأن الخبرين جميعًا والصفتين، من صفة نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين وصفَ الله صفتهم في قوله: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ) وبذلك جاء تأويلُ أهل التأويل، فلا حاجة بالكلام = إذ كان الأمر كذلك = إلى أن يكون فيه متروك.
* * *
وأما تأويل قوله: " يُحَرِّفون الكلِمَ عن مواضعه "، (9) فإنه يقول: يبدِّلون معناها ويغيِّرونها عن تأويله.
* * *
و " الكلم " جماع " كلمة ".
* * *
وكان مجاهد يقول: عنى بـ " الكلم "، التوراة.
9691 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " يحرفون الكلم عن مواضعه "، تبديل اليهود التوراة.
9692 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
* * *
وأما قوله: " عن مواضعه "، فإنه يعني: عن أماكنه ووجوهه التي هي وجوهه.
* * *
القول في تأويل قوله : وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
يعني بذلك جل ثناؤه: من الذين هادوا يقولون: سمعنا، يا محمد، قولك، وعصينا أمرك، كما:-
9693 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله: " سمعنا وعصينا "، قال: قالت اليهود: سمعنا ما نقول ولا نطيعك.
9694 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
9695 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
9696 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " سمعنا وعصينا "، قالوا: قد سمعنا، ولكن لا نطيعك.
* * *
القول في تأويل قوله : وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ
قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالَيْ مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره: أنهم كانوا يسبّون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول، ويقولون له: اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يَسُبُّه: " اسمع، لا أسمعَك الله "، كما:-
9697 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " واسمع غير مسمع "، قال: هذا قول أهل الكتاب يهود، كهيئة ما يقول الإنسان: &; 8-434 &; " اسمع لا سمعت "، أذًى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشتمًا له واستهزاءً.
9698 - حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: " واسمع غير مسمع " قال: يقولون لك: " واسمع لا سمعت ".
وقد روي عن مجاهد والحسن: أنهما كانا يتأوّلان في ذلك بمعنى: واسمع غير مقبول منك.
= ولو كان ذلك معناه لقيل: " واسمع غير مسموع "، ولكن معناه: واسمع لا تسمع، ولكن قال الله تعالى ذكره: لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ، فوصفهم بتحريف الكلام بألسنتهم، والطعن في الدين بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
وأما القول الذي ذكرته عن مجاهد: " واسمع غير مسمع "، يقول: غير مقبول ما تقول، فهو كما:-
9699 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " واسمع غير مسمع "، قال: غير مُسْتمع - قال ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد: " واسمع غير مسمع "، غير مقبول ما تقول.
9700 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
9701 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " واسمع غير مسمع "، قال: كما تقول اسمع غير مَسْموع منك.
9702 - وحدثنا موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: كان ناس منهم يقولون: " واسمع غير مسمع "، كقولك: اسمع غير صاغِرٍ. (10)
* * *
القول في تأويل قوله : وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ
قال أبو جعفر: يعني بقوله: " وراعنا "، أي: راعنا سمعك، افهم عنّا وأفهمنا. وقد بينا تأويل ذلك في" سورة البقرة " بأدلته، بما فيه الكفاية عن إعادته. (11)
* * *
ثم أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليًّا بألسنتهم "، يعني تحريكًا منهم بألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه، (12) واستخفافًا منهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنًا في الدين، كما:-
9703 - حدثني الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، قال قتادة: كانت اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: " راعنا سمعك "! يستهزئون بذلك، فكانت اليهود قبيحة أن يقال: (13) " راعنا سمعك " =" ليًّا بألسنتهم " والليّ: تحريكهم ألسنتهم بذلك =" وطعنًا في الدين ".
9704 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " راعنا ليًّا بألسنتهم "، كان &; 8-436 &; الرجل من المشركين يقول: " أرعني سمعك "! يلوي بذلك لسانه، يعني: يحرِّف معناه.
9705 - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أييه، عن ابن عباس: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، إلى " وطعنًا في الدين "، فإنهم كانوا يستهزئون، ويلوون ألسنتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في الدين.
9706 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " وراعنا ليا بألسنتهم وطعنًا في الدين "، قال: " راعنا "، طعنهم في الدين، وليهم بألسنتهم ليبطلوه، ويكذبوه. قال: و " الرَّاعن "، الخطأ من الكلام. (14)
9707 - حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر قال، حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: " ليا بألسنتهم "، قال: تحريفًا بالكذب.
* * *
القول في تأويل قوله : وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم، قالوا لنبي الله: " سمعنا يا محمد قولك، وأطعنا أمرك، وقبلنا ما جئتنا به من عند الله، واسمع منا، وانظرنا ما نقول، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا " =" لكان خيرًا لهم وأقوم "، يقول: لكان ذلك خيرًا لهم عند الله =" وأقوم "، يقول: وأعدل وأصوبَ في القول.
* * *
وهو من " الاستقامة " من قول الله: وَأَقْوَمُ قِيلا [سورة المزمل: 6]، بمعنى: وأصوبُ قيلا (15) كما:-
9708 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم "، قال: يقولون اسمع منا، فإنا قد سمعنا وأطعنا، وانظرنا فلا تعجل علينا.
9709 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو تميلة، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عكرمة ومجاهد قوله: " وانظُرنا "، قال: اسمع منا.
9710 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " وانظرنا "، قال: أفهمنا.
9711 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،" وانظرنا "، قال: أفهمنا.
* * *
قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله مجاهد وعكرمة، من توجيههما معنى: " وانظرنا " إلى: " اسمع منا " = وتوجيه مجاهد ذلك إلى " أفهمنا " = فما لا نعرف في كلام العرب، (16) إلا أن يكون أراد بذلك من توجيهه إلى " أفهمنا " ، انتظرنا نفهم ما تقول = أو: انتظرنا نقل حتى تسمع منا = فيكون ذلك معنًى مفهومًا، وإن كان غير تأويلٍ للكلمة ولا تفسير لها. (17) ولا نعرف: " انظرنا " في كلام العرب، (18) إلا بمعنى: انتظرنا وانظر إلينا = فأما " انظرنا " بمعنى: انتظرنا، فمنه قول الحطيئة:
وَقَــدْ نَظَــرْتُكُمُ لَــوْ أَنَّ دِرَّتَكُـمْ
يَوْمًـا يَجِـيء بهـا مَسْـحِي وَإِبْسَاسِي (19)
وأما " انظرنا "، بمعنى: انظر إلينا، فمنه قول عبد الله بن قيس الرقيات:
ظَـاهِرَاتُ الجَمـالِ وَالحُسْـنِ يَنْظُرْنَ
كَمَـــا يَنْظُـــرُ الأَرَاكَ الظِّبَــاءُ (20)
بمعنى: كما ينظر إلى الأراك الظباء. (21)
* * *
القول في تأويل قوله : وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا (46)
قال أبو جعفر: يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخْزَى هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية، فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق (22) =" بكفرهم "، يعني: بجحودهم نبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبينات =" فلا يؤمنون إلا قليلا "، يقول: فلا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم، ولا يقرُّون بنبوته =" إلا قليلا "، يقول: لا يصدقون بالحق الذي جئتهم به، يا محمد، إلا إيمانًا قليلا كما:-
9712 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " فلا يومنون إلا قليلا "، قال: لا يؤمنون هم إلا قليلا.
قال أبو جعفر: وقد بيّنا وجه ذلك بعلله في" سورة البقرة ". (23)
---------------------
الهوامش :
(4) انظر معاني القرآن للفراء 1: 271.
(5) في المطبوعة: "والعرب تقول: منا من يقول ذلك" بزيادة"من" وهو خطأ ، والصواب من معاني القرآن للفراء. أما المخطوطة فكان فيها: "والعرب تقول ذلك ومثالا لا يقوله" وهو من عبث الناسخ وإسقاطه.
(6) ديوانه 485 ، وقبله: مع اختلاف الرواية:
بَكَـيْتُ عَـلَى مَـيٍّ بِهَـا إذْ عَرَفْتُهَـا
وَهِجْتُ الْهَوَى حَتَّى بَكَى القَوْمُ مِنْ أَجْلِي
فَظَلُّــوا وَمِنْهُـمْ دَمْعُـهُ غَـالِبٌ لَـهُ
وَآخَـرُ يَثْنِـي عَـبْرَةَ العَيْـنِ بـالهَمْلِ
وَهَـلْ هَمَـلانُ الْعَيْـنِ رَاجِعُ مَا مَضَى
مِـنَ الوَجْـدِ، أوْ مُدْنِيكِ يَا مَيُّ مِنْ أَهْلِي
وكان في المطبوعة: "يذري دمعة العين بالمهل" وهو خطأ ، وتغيير من الطابع ، وفي المخطوطة"يثني" كما في الديوان.
وقوله: "يثني دمعة العين" ، أي يرد هملانها. وقوله: "بالهمل" متعلق بقوله"دمعة" ووضع"دمعة" هنا مصدرًا لقوله: "دمعت عينه دمعًا ودمعانًا ودموعًا" ، وزاده هو"دمعة" على وزن"رحمة" في المصادر = وكذلك في رواية"عبرة" ، كلاهما مصدر ، ولم تثبته كتب اللغة. يقول: وآخر يرد إرسال العين دمعها منهملا ، يعني: لولا ذلك لسالت دموعه غزارًا.
(7) مضى تخريجه فيما سلف 1: 179 ، تعليق: 2 ، ونسيت هناك أن أرده إلى هذا المكان ، فأثبته.
(8) انظر مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 271.
(9) انظر تفسير"التحريف" فيما سلف 2: 248 ، 249.
(10) في المطبوعة: "غير صاغ" ، والصواب من المخطوطة.
(11) انظر ما سلف 2: 459-467.
(12) انظر تفسير"اللي" و"اللي بالألسنة" فيما سلف 6: 535-537.
(13) في المخطوطة والمطبوعة: "فكان في اليهود قبيحة فقال" ، وهو كلام لا يستقيم البتة ، وصوابه الذي لا شك فيه ما أثبت ، وانظر كونها كلمة قبيحة لليهود في 2: 460.
(14) انظر القول في"الراعن" فيما سلف 2: 465 ، 466.
(15) انظر تفسر"أقوم" فيما سلف 6: 77 ، 78.
(16) في المطبوعة والمخطوطة: "ما لا نعرف" بغير فاء ، ولكني زدتها لأنها أعرق في العربية وأقوم للسياق.
(17) في المخطوطة والمطبوعة: "غير تأويل الكلمة" والصواب ما أثبت.
(18) في المطبوعة: "فلا نعرف" بالفاء ، والأجود ما في المخطوطة ، كما أثبته.
(19) ديوانه: 52 ، والكامل 1: 351 ، وهذا خطأ لا شك فيه في رواية البيت ، وأثبته على حاله ، لأنه دلالة على عجلة أبي جعفر أحيانًا في كتابة تفسيره ، ودليل على حفظه الشعر ، ولولا ذلك لم يخلط هذا الخلط فإن هذه القصيدة ، هي التي هجا بها الزبرقان بن بدر ، ومدح بغيض ابن عامر ، والتي شكاه من أجلها الزبرقان إلى عمر بن الخطاب فحبسه ، يقول للزبرقان لما غضب حين استضافه بغيض:
مَـا كـانَ ذَنْـبُ بَغِيـض لا أَبَــا لَكُمُ
فِـي بَــائِسٍ جَـاءَ يَحْـدُو آخِرَ الناسِ
لَقَــدْ مَــرَيْتُكُمُ لَــوْ أَنَّ دِرَّتكُــمْ
يَوْمًـا يجِـيءُ بِهَـا مَسْـحِي وَإبْسَاسِي
وَقَــدْ مَدَحْــتُكُمْ عَمْـدًا لأُرْشِــدَكُمْ
كَيْمَـا يَكُــونَ لَكُـمْ مَتْحٍـي وَإمْرَاسِي
ثم يليه بيت الشاهد الذي كان ينبغي أن يذكره هنا أبو جعفر ، كما ذكره فيما سلف في تفسير"انظرنا" من سورة البقرة 2: 467 ، 468 وقد شرحته هناك. ولولا أن أثبت حال أبي جعفر في كتابه ، لألغيت البيت المذكور في المتن ، ولوضعت هذا البيت:
وَقَــدْ نَظَــرْتُكُمُ أَعْشَـاءَ صَـادِرَةٍ
لِلْخِـمْسِ طَـالَ بِهَـا حَوْزِي وَتَنْسَاسِي
وقوله: "لقد مريتكم" من قولهم: "مري الناقة يمريها مريًا": إذا مسح ضرعها لتدر. و"الدرة": الدفعة من اللبن و"المسح" مسح الضرع للحلب. و"الإبساس": هو صوت الراعي ، يلينه لناقته عند الحلب لتسكن ويسهل حلبها. يقول: لقد ترفقت لكم ، أستخرج خيركم بالمديح الرقيق والقول اللين ، فلم ألمق خيرًا ، ولم تجودوا به.
وكان في المخطوطة: "يجيء به" وهو خطأ.
(20) ديوانه: 171 ، من قصيدته التي فخر فيها بقريش ، ومدح مصعب بن الزبير ، وذكر نساء عبد شمس بن عبد مناف فقال:
وَحِسَــانٌ مِثْـلُ الــدُّمَي عَبْشَـمِيَّاتٌ
عَلَيْهِــــن بَهْجَـــةٌ وَحَيَـــاءُ
لا يَبِعْـنَ العِيَـابَ فـي مَوْسِـمٍ النَّاسِ
إذَا طَـــافَ بِالعِيـــابِ النِّسَــاءُ
ظَـاهِرَاتُ الجَمَـالِ والسَّـرْو ........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و"السرو": الشرف وكرم المحتد. وهي أجود الروايتين ، وقوله: "كما ينظر الأراك الظباء" ، من حسن التشبيه ، ودقة الملاحظة للعلاقة بين الشرف والسؤدد. وما يكون للمرء من شمائل وسمت وهيأة. ويعني أنهن قد ينصبن أجيادهن ، كأنهن ظباء تعطو الأراك لتناله. وذلك أظهر لجمال أجيادهن ، وحركتهن. والجيد فيه دلالة من دلائل الخلق لا يخطئها بصير.
(21) انظر تفسير نظيرة هذه الكلمة من آية البقرة: "وقولوا انظرنا" 2: 467 - 469.
(22) انظر تفسير"اللعنة" فيما سلف 2: 328 / 3: 254 ، 261 / 6: 577.
(23) يعني تفسير قوله تعالى"فقليلا ما يؤمنون" 2: 329 - 331.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[46] ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ اليهود محترفو تزویر، وإذا كانوا زوروا كتاب الله؛ فهل يتورعون عن تزييف غيره من الحقائق؟!
وقفة
[46] ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ وفي كيفية التحريف وجوه؛ أحدها: أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر، والثاني: إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة، وصرف اللفظ من معناه الحق إلى معنی باطل بوجوه الحيل اللفظية، والثالث: أنهم كانوا يدخلون على النبي ﷺ ، ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به، فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه».
وقفة
[46] من حَرَّفَ معاني القرآن الكريم فقد أشبه اليهود والنصارى ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾.
لمسة
[46] ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ استخدم القرآن: (كلمات) كجمع قلة، واستخدم (كلِم) كجمع كثرة.
وقفة
[46] ذكر الله تعالى هنا: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ إشارة إلى التأويل الباطل، وفي سورة المائدة: ﴿مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: 41] إشارة إلى حذف اللفظ عن الكتاب، فهما لونان مختلفان من التحريف.
وقفة
[46] ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ قال ابن عباس: «كانوا يقولون للنبي ﷺ: اسمع لا سمعت»، وقال الحسن ومجاهد: «معناه غير مسموع منك، أي غير مقبول منك، ولا مجاب إلى ما تقول».
عمل
[46] على من أراد معرفة الحق أن يتأدب مع العلماء والدعاة، وأن يحسن صيغة سؤاله لهم، ويتلطف معهم ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ﴾.
تفاعل
[46] ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ مِنَ الَّذِينَ هادُوا: ﴾
- الجملة: بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب أو بيان لأعدائكم في الآية السابقة. من: حرف جر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بمن. هادوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة. وجملة «هادُوا» صلة الموصول لا محل لها ويجوز أن تكون جملة «مِنَ الَّذِينَ هادُوا» في محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: قوم. وجملة «يُحَرِّفُونَ» في محل رفع صفة لقوم.
- ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ: ﴾
- بمعنى «يميلون به» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يُحَرِّفُونَ» في محل رفع صفة- نعت- للمبتدأ المحذوف «قوم». الكلم: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى كلام الله.
- ﴿ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيحرفون. والهاء: ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ويقولون: معطوفة بواو العطف على «يُحَرِّفُونَ» وتعرب اعرابها.
- ﴿ سَمِعْنا وَعَصَيْنا: ﴾
- الجملتان: في محل نصب مفعول به «مقول القول».سمعنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلمين و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. وعصينا: معطوفة بواو العطف على «سَمِعْنا» وتعرب اعرابها وحذف مفعولا الفعلين اختصارا.
- ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ: ﴾
- الواو: حالية. او: استئنافية. اسمع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. غير: حال من المخاطب أي اسمع وأنت غير مسمع: أي غير مجاب ويجوز ان تكون مفعولا به للفعل «اسْمَعْ» أو صفة للمفعول أي اسمع كلاما غير مسمع. مسمع: مضاف اليه مجرور بالكسرة.
- ﴿ وَراعِنا: ﴾
- الواو: عاطفة. راعنا. بمعنى راعنا نكلمك أي ارقبنا وانظرنا وجاءت الكمة غير موافقة لمعناها ويحتمل أن تكون عبرانية في لغتهم للسب والشتم والسخرية.
- ﴿ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ: ﴾
- مفعول مطلق منصوب بالفتحة أي يفتلون بألسنتهم فتلا. بألسنتهم: جار ومجرور متعلق بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل جرّ بالاضافة ويجوز أن تكون مفعولا له.
- ﴿ وَطَعْناً فِي الدِّينِ: ﴾
- معطوفة بواو العطف «على لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ» وتعرب إعرابها.
- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا: ﴾
- الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم. أنهم: أن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب اسم «أن» قالوا: تعرب إعراب «هادُوا». سمعنا واطعنا: تعربان اعراب «سَمِعْنا وَعَصَيْنا».
- ﴿ وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ: ﴾
- واسمع: سبق اعرابها وانظرنا معطوفة بواو العطف على «اسْمَعْ» وتعرب مثلها و «نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به لكان اللام لام الجواب بعد «لَوْ» كان. فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها: ضمير مستتر فيها جوازا تقديره هو. أي لكان قولهم. وجملة «كان» مع اسمها وخبرها جواب شرط غير جازم لا محل لها و «أن» بعد «لَوْ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره: ثبت. التقدير: لو ثبت قولهم.
- ﴿ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ: ﴾
- خيرا: خبر «كان» منصوب بالفتحة. لهم: جار ومجرور متعلق بخيرا و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. وأقوم: معطوف بواو العطف على «خَيْراً» منصوب مثله.
- ﴿ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ: ﴾
- الواو: إعتراضية. لكن: حرف استدراك لا عمل له لأنه مخفف. لعنهم: فعل ماض مبني على الفتح و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة وحرك ميم «لَعَنَهُمُ» بالضم للاشباع ولالتقاء الساكنين.
- ﴿ بِكُفْرِهِمْ فَلا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بلعن أي بسبب كفرهم و «هم» ضمير الغائبين في محل جرّ بالاضافة. الفاء: تعليلية. لا: نافية لا عمل لها.
- ﴿ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا: ﴾
- يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إلّا: أداة حصر أو استثناء قليلا نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة. أي إلّا إيمانا قليلا: أي ضعيفا لا يعبأ به أو إلّا قليلا منهم قد آمنوا. '
المتشابهات :
| النساء: 46 | ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ |
|---|
| المائدة: 13 | ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦۚ﴾ |
|---|
| المائدة: 41 | ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنۡ أُوتِيتُمۡ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمۡ تُؤۡتَوۡهُ فَٱحۡذَرُواْۚ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [46] لما قبلها : وبعد التحذير من اليهود؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا بعض جرائمهم، ومنها: تحريفهم كلام الله، وعنادهم، وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾
القراءات :
الكلم:
وقرئ:
1- الكلم، بكسر الكاف وسكون اللام، جمع- كلمة، تخفيف «كلمة» .
2- الكلام، وهى قراءة النخعي، وأبى رجاء.
مدارسة الآية : [47] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ .. ﴾
التفسير :
يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم، المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها، فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، ويوافق بعضها بعضًا. فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله:{ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ} حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم، والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال:{ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق، وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق، فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق، وردها على أدبارها، بأن تجعل في أقفائهم وهذا أشنع ما يكون{ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ} بأن يطردهم من رحمته، ويعاقبهم بجعلهم قردة، كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت{ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}{ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} كقوله:{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}
ثم وجه- سبحانه- نداء إلى اليهود أمرهم فيه باتباع طريق الحق، وأنذرهم بسوء المصير إذا لم يستمعوا إلى هذا النداء فقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود. منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود: اتقوا الله وأسلموا. فو الله انكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. فأنزل الله فيهم: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ.
الآية .
وفي ندائهم بقولهم يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا تحريض لهم على الإيمان، لأن اعطاءهم علم الكتاب من شأنه أن يحملهم على المسارعة إلى تلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وألا تأخذهم العصبية الدينية كما أخذت أهل مكة العصبية الجاهلية، ولأن هذا الإيمان الذي يدعون إليه هو التصديق بما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن، إذ هو يطابق- في جوهره- ما أنزله- سبحانه- على الأنبياء السابقين الذين يزعم أهل الكتاب أنهم يؤمنون بهم. إذا فوحدة المنزل توجب عليهم أن يؤمنوا بجميع ما أنزله الله.
ووصفهم هنا بأنهم أوتوا الكتاب، مع أنه وصفهم قبل ذلك بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، لأن وصفهم هنا بذلك المقصود منه حضهم على الإيمان وترغيبهم فيه وإثارة هممهم للانقياد لتعاليم كتابهم الذي بشرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإيمان به. أما وصفهم فيما سبق بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب فالمقصود منه التعجيب من أحوالهم، والتهوين من شأنهم.
والمعنى: يا معشر اليهود الذين آتاهم الله التوراة لتكون هداية لهم، آمنوا ايمانا حقا بِما نَزَّلْنا من قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن قد نزل مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وموافقا للتوراة التي بين أيديكم في الدعوة إلى وحدانية الله- تعالى- وإلى مكارم الأخلاق، وفي النهى عن الفواحش والمعاصي، ومؤيدا لها فيما ذكرته من صفات تتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آيات تدعو إلى تصديقه والإيمان به.
وعبر عن القرآن بقوله: بِما نَزَّلْنا لأن في هذا التعبير تذكير بعظم شأن القرآن وأنه منزل بأمر الله وحفظه.
وعبر عن التوراة بقوله لِما مَعَكُمْ لأن في هذا التعبير تسجيلا عليهم بأن التوراة كتاب مستصحب عندهم وقريب من أيديهم، وشهادته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جلية، فإذا ما تركوا شهادته مع وضوحها ومع استصحابهم له كان مثلهم كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً.
ثم أنذرهم- سبحانه- بعد ذلك بسوء العاقبة إذا ما أعرضوا عن الإيمان بدعوة الإسلام فقال- تعالى- مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
والطمس إزالة الأثر بالمحو. قال الله- تعالى- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ أى: زالت ومحيت. ويقال: طمست الريح الأثر إذا محته وأزالته. وللمفسرين في المراد من معنى الطمس هنا اتجاهان:
أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه حمل اللفظ على حقيقته بمعنى إزالة ما في الوجه من أعضاء ومحو أثرها.
فيكون المعنى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً أى نمحو تخطيط صورها من عين وأنف وفم وحاجب فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أى فنجعلها على هيئة أدبارها وهي الأقفاء بحيث تكون الوجوه مطموسة مثل الأقفاء. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وقتادة وغيرهما.
قال الإمام الرازي: وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من التشويه في الخلقة والمثلة والفضيحة لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة....» .
ومن المفسرين الذين رجحوا حمل اللفظ على حقيقته الإمام ابن جرير لقد قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى قوله مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً من قبل أن نطمس أبصارها، ونمحو آثارها، فنسويها كالأقفاء. فنردها على أدبارها، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعنى بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه. فيكون معناه: فنحول الوجوه أقفاء، والأقفاء وجوها، فيمشوا القهقرى، كما قال ابن عباس ومن قال بذلك» .
وأصحاب هذا الاتجاه منهم من يرى أن هذه العقوبة تكون في آخر الزمان ومنهم من يرى هذه العقوبة تكون في الآخرة. ومنهم من قال بأن هذه العقوبة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم، وقد آمن بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره وأما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه حمل اللفظ على مجازه، بمعنى أن المراد بالطمس الطمس المعنوي.
فيكون المعنى: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن تقسو قلوبكم، ونطبع عليها بسبب تمسكها بالضلال، وتماديها في العناد.
قال ابن كثير مؤيدا هذا الاتجاه: هذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم، إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلال يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله- تعالى- وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا أى هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى.
قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوها أى عن صراط الحق: فنردها على أدبارها أى في الضلال. وقال السدى: معناه: فنعميها عن الحق ونرجعها كفارا ... .
وقال الفخر الرازي- بعد أن بين معنى الآية على القول الأول-: أما القول الثاني: فهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه ثم ذكروا فيه وجوها.
الأول: قال الحسن: نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها أى على ضلالتها والمقصود بيان إلقائها في أنواع الخذلان وظلمات الضلالات.
الثاني: يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير. وبالوجوه: رؤساؤهم ووجهاؤهم.
والمعنى: من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الإقبال والوجاهة ونكسوهم الصغار والإدبار والمذلة.
الثالث: قال عبد الرحمن بن زيد: هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى. وتأول ذلك في إجلاء قريظة والنضير إلى الشام، فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام.. فيكون المراد بطمس الوجوه على هذا الرأى: إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها» .
وقد مال الفخرى الرازي إلى القول الثاني ووصفه بأنه لا إشكال معه البتة ... » .
وقال بعض العلماء: إن الذي يبدو لنا من ظاهر النص وهو قوله- تعالى- مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها: أنه يراد به سحقهم في القتال، وحملهم على أن يولوا الأدبار، فتكون وجوههم غير بادية بصورها، بعد أن كانوا مقبلين بها، فأزالها السيف والخوف، وجعل صورتها مختفية، وأقفيتهم هي البادية الواضحة، فكأن صورة الوجوه قد زالت وحلت محلها صورة الأدبار.
وعلى ذلك يكون المعنى: إنكم استرسلتم في غيكم وضلالكم. ومع ذلك نطالبكم بالهداية والإيمان قبل أن ينزل بكم غضب الله- تعالى- في الدنيا وذلك بتسليط المؤمنين بالحق عليكم، فيذيقونكم بأس القتال فتفرون، وتختفى وجوهكم ... » .
هذه بعض الوجوه التي قالها من يرى أن المراد بالطمس الطمس المعنوي وأن اللفظ محمول على المجاز، ولعل هذا الاتجاه أقرب إلى الصواب لسلامته من الاعتراضات والإشكالات التي أوردها بعض المفسرين- كالرازي والآلوسى- عند تفسيرهما للآية الكريمة.
وقوله أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ بيان لعقوبة أخرى سوى العقوبة السابقة.
واللعن: هو الطرد من رحمة الله- تعالى-.
فالآية الكريمة دعوة لليهود إلى الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يطبع الله- تعالى- على قلوبهم ويذهب بنورها فلا تتجه إلى الحق ولا تميل إليه. أو من قبل أن يلعنهم ويطردهم من رحمته ويجعلهم عبرة للمعتبرين.
وأصحاب السبت هم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فتحايلوا على استحلال ما حرمه الله بحيل قبيحة، فأنزل الله عليهم عذابه، ومسخهم قردة ...
وقد ذكر الله قصتهم بشيء من التفصيل في سورة الأعراف .
وكلمة «أو» في الآية الكريمة لمنع الخلو. فجوز أن يعاقب الله طائفة منهم بعقوبة من هاتين العقوبتين، ويعاقب طائفة أخرى منهم بالعقوبة الثانية إن هم استمروا في ضلالهم وطغيانهم.
والضمير المنصوب في قوله «نلعنهم» يعود لأصحاب الوجوه. أو للذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات.
وقوله وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا أى كان وما زال جميع ما أمر الله به وقضاه نافذا لا محالة لأنه- سبحانه- لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء:
والجملة الكريمة تذييل قصد به تهديد هؤلاء الضالين المعاندين حتى يثوبوا إلى رشدهم، ويدخلوا في صفوف المؤمنين.
يقول تعالى - آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ، ومتهددا لهم أن يفعلوا ، بقوله : ( من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) قال بعضهم : معناه : من قبل أن نطمس وجوها . طمسها هو ردها إلى الأدبار ، وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد : من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر ، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار .
قال العوفي عن ابن عباس : ( من قبل أن نطمس وجوها ) وطمسها أن تعمى ( فنردها على أدبارها ) يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم ، فيمشون القهقرى ، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه .
وكذا قال قتادة ، وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والنكال ، وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم ، وهذا كما قال بعضهم في قوله : ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ) [ ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ] ) [ يس 8 ، 9 ] إن هذا مثل [ سوء ] ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى .
قال مجاهد : ( من قبل أن نطمس وجوها ) يقول : عن صراط الحق ، ( فنردها على أدبارها ) أي : في الضلالة .
قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس ، والحسن نحو هذا .
قال السدي : ( فنردها على أدبارها ) فنمنعها عن الحق ، قال : نرجعها كفارا ونردهم قردة .
وقال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز .
وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية ، قال ابن جرير :
حدثنا أبو كريب ، حدثنا جابر بن نوح ، عن عيسى بن المغيرة قال : تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب ، فقال : أسلم كعب زمان عمر ، أقبل وهو يريد بيت المقدس ، فمر على المدينة ، فخرج إليه عمر فقال : يا كعب ، أسلم ، قال : ألستم تقرؤون في كتابكم ( مثل الذين حملوا التوراة [ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ] أسفارا ) وأنا قد حملت التوراة . قال : فتركه عمر . ثم خرج حتى انتهى إلى حمص ، فسمع رجلا من أهلها حزينا ، وهو يقول : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) الآية . قال كعب : يا رب آمنت ، يا رب ، أسلمت ، مخافة أن تصيبه هذه الآية ، ثم رجع فأتى أهله في اليمن ، ثم جاء بهم مسلمين .
وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر بلفظ آخر ، فقال : حدثنا أبي ، حدثنا ابن نفيل ، حدثنا عمرو بن واقد ، عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني قال : كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب ، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فبعثه إليه لينظر أهو هو ؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة ، فإذا تال يقرأ القرآن ، يقول : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ، ثم أسلمت .
وقوله : ( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد ، وقد مسخوا قردة وخنازير ، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف .
وقوله : ( وكان أمر الله مفعولا ) أي : إذا أمر بأمر ، فإنه لا يخالف ولا يمانع .
القول في تأويل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب "، اليهود من بني إسرائيل، الذين كانوا حوالَيْ مهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لهم: يا أيها الذين أنـزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به ="آمنوا " يقول: صدِّقوا بما نـزلنا إلى محمد من الفرقان =" مصدقًا لما معكم "، يعني: محقِّقًا للذي معكم من التوراة التي أنـزلتها إلى موسى بن عمران =" من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ".
* * *
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: " طمسه إياها ": محوه آثارها حتى تصير كالأقْفَاء.
وقال آخرون: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيّرها عمياء، ولكن الخبر خرج بذكر " الوجه "، والمراد به بصره =" فنردّها على أدبارها "، فنجعل أبصارَها من قبل أقفائها.
*ذكر من قال ذلك:
9713 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثنا عمي قال حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا " إلى قوله: " من قبل أن نطمس وجوهًا "، وطمسها: أن تعمى =" فنردها على أدبارها "، يقول: أن نجعل وجوههم من قبل أقفِيتهم، فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين في قفاه.
9714 - حدثني أبو العالية إسماعيل بن الهيثم العبْدي قال، حدثنا أبو قتيبة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله: " من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها "، قال: نجعلها في أقفائها، فتمشي على أعقابها القهقرى. (24)
9715 - حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال، حدثنا عبيد الله بن موسى قال، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، بنحوه = إلا أنه قال: طمْسُها: أن يردَّها على أقفائها.
9716 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة: " فنردها على أدبارها "، قال: نحوِّل وجوهها قِبَل ظهورها.
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك (25) من قبل أن نعمي قومًا عن الحق =" فنردها على أدبارها "، في الضلالة والكفر.
*ذكر من قال ذلك:
9717 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، فنردها عن الصراط، عن الحق (26) =" فنردها على أدبارها "، قال: في الضلالة.
9718 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " أن نطمس وجوهًا " عن صراط الحق =" فنردها على أدبارها "، في الضلالة.
9719 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك قراءة، عن ابن جريج، عن مجاهد مثله.
9720 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، الحسن: " نطمس وجوهًا "، يقول: نطمسها عن الحق =" فنردها على أدبارها "، على ضلالتها.
9721 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب " إلى قوله: كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ، قال: نـزلت في مالك بن الصَّيِّف، ورفاعة بن زيد بن التابوت، من بني قينقاع. أما " أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها "، يقول: فنعميها عن الحق ونُرجعها كفارًا.
9722 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، يعني: أن نردهم عن الهدى والبصيرة، فقد ردَّهم على أدبارهم، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: من قبل أن نمحو آثارهم من وجوههم التي هم بها، وناحيتهم التي هم بها =" فنردها على أدبارها "، من حيث جاءوا منه بَديًّا من الشام. (27)
*ذكر من قال ذلك:
9723 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، قال: كان أبي يقول: إلى الشأم.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: " من قبل أن نطمس وجوهًا "، فنمحو أثارها ونسوِّيها =" فنردها على أدبارها "، بأن نجعل الوجوه منابتَ الشَّعر، كما وجوه القردة منابت للشعر، لأن شعور بني آدم في أدبار وجوههم. فقالوا: إذا أنبت الشعر في وجوههم، فقد ردَّها على أدبارها، بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه. (28)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى قوله: " من قبل أن نطمس وجوها "، من قبل أن نطمس أبصارَها ونمحو آثارها فنسوّيها كالأقفاء =" فنردها على أدبارها "، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فنحوّل الوجوه أقْفاءً والأقفَاء وجوهًا، فيمشون القهقرى، كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك.
* * *
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهودَ الذين وصف صفتهم بقوله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ ، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصدِّقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها " الآية، بأسَه وسطوته وتعجيل عَقابه لهم، (29) إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به. ولا شك أنهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارًا.
* * *
وإذْ كان ذلك كذلك، فبيّنٌ فساد قول من قال: تأويل ذلك: أن نعمِيها عن الحق فنردها في الضلالة. فما وجْه ردِّ من هو في الضلالة فيها؟! وإنما يرد في الشيء من كان خارجًا منه. فأما من هو فيه، فلا وجه لأن يقال: " نرده فيه ".
* * *
وإذْ كان ذلك كذلك، وكان صحيحًا أنّ الله قد تهدَّد للذين ذكرهم في هذه الآية بردّه وجوهَهم على أدبارهم = كان بيّنًا فساد تأويل من قال: معنى ذلك: يهددهم بردِّهم في ضلالتهم.
* * *
وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من قبل أن نجعل الوجوه منابتَ الشعر كهيئة وجوه القردة، فقولٌ لقول أهل التأويل مخالف. وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الخالفين، على خطئه شاهدًا.
* * *
وأما قول من قال: معناه: من قبل أن نطمس وجوههم التي هم فيها، فنردّهم إلى الشأم من مساكنهم بالحجاز ونجدٍ، فإنه = وإن كان قولا له وجه = مما يدل عليه ظاهر التنـزيل بعيد. (30) وذلك أن المعروف من " الوجوه " في كلام العرب، التي هي خلاف " الأقفاء "، وكتاب الله يُوَجَّه تأويله إلى الأغلب في كلام مَن نـزل بلسانه، حتى يدلّ على أنه معنيٌّ به غير ذلك من الوجوه، الذي يجب التسليم له. (31)
* * *
وأما " الطمس "، فهو العُفُوّ والدثور في استواء. منه يقال: " طمست أعلام الطريق تطمِسُ طُموسًا "، إذا دثرت وتعفَّت، فاندفنت واستوت بالأرض، كما قال كعب بن زهير:
مِـنْ كُـلِّ نَضَّاحَـةِ الذِّفْرَى إذَا عَرقَتْ
عُرْضَتُهَـا طَـامِسُ الأعْـلام مَجْهُولُ (32)
يعني: " طامس الأعلام "، دائر الأعلام مندفنها. ومن ذلك قيل للأعمى الذي &; 8-445 &; قد تعفَّى غَرُّ ما بين جفني عينيه فدثر: (33) " أعمى مطموس، وطمْيس "، كما قال الله جل ثناؤه: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ [سورة يس: 66].
* * *
= قال أبو جعفر: " الغَرُّ"، الشقّ الذي بين الجفنين. (34)
* * *
فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفت من تأويل الآية، فهل كان ما توعَّدهم به؟ (35)
قيل: لم يكن، لأنه آمن منهم جماعة، منهم: عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسد بن سعية، (36) وأسد بن عبيد، ومُخَيْرِق، (37) وجماعة غيرهم، فدفع عنهم بإيمانهم.
ومما يبين عن أن هذه الآية نـزلت في اليهود الذين ذكرنا صفتهم، ما:-
9724 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير= وحدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة = جميعًا، عن ابن إسحاق قال، حدثني محمد بن أبي محمد &; 8-446 &; مولى زيد بن ثابت قال، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس قال: كلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود: منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا! فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحقٌّ! (38) فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد! وجحدوا ما عرفوا، وأصرّوا على الكفر، فأنـزل الله فيهم: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، الآية (39)
9725 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح، عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلامَ كعبٍ، (40) فقال: أسلم كعب في زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس، فمرّ على المدينة، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب، أسلم! قال: ألستم تقرأون في كتابكم: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا [سورة الجمعة: 5]؟ وأنا قد حملت التوراة! قال: فتركه. ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، قال: فسمع رجلا من أهلها حزينًا وهو يقول: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها "، الآية. فقال كعب: يا رب آمنت، يا رب أسلمت! مخافة أن تصيبه الآية، ثم رجع فأتى أهله باليمن، ثم جاء بهم مسلمين.
* * *
القول في تأويل قوله : أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (47)
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " أو نلعنهم "، أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم قردة =" كما لعنا أصحاب السبت "، يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من أسلافكم. (41) قيل ذلك على وجه الخطاب في قوله: آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ، كما قال: حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا [سورة يونس: 22]. (42)
وقد يحتمل أن يكون معناه: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ، أو نلعن أصحاب الوجوه = فجعل " الهاء والميم " في قوله: " أو نلعنهم "، من ذكر أصحاب الوجوه، إذ كان في الكلام دلالة على ذلك:
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
9726 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلى قوله: " أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت "، أي: نحوّلهم قردة.
9727 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن: " أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت "، يقول: أو نجعلهم قردة.
9728 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت "، أو نجعلهم قردة.
9729 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت "، قال: هم يهود جميعًا، نلعن هؤلاء كما لعنّا الذين لعنّا منهم من أصحاب السبت. (43)
* * *
وأما قوله: " وكان أمر الله مفعولا "، فإنه يعني: وكان جميع ما أمر الله أن يكون، كائنًا مخلوقًا موجودًا، لا يمتنع عليه خلق شيء شاء خَلْقه. و " الأمر " في هذا الموضع: المأمور = سمي" أمر الله "، لأنه عن أمره كان وبأمره.
والمعنى: وكان ما أمر الله مفعولا.
----------------
الهوامش :
(24) الأثر: 9714 -"أبو العالية ، إسماعيل بن الهيثم العبدي" ، لم نجده ، وانظر ما سلف رقم: 9365 ، 9366.
و"أبو قتيبة" هو: سلم بن قتيبة ، مضت ترجمته برقم: 1899 ، 1924 ، 9365.
(25) في المطبوعة ، أسقط: "بل".
(26) في المطبوعة: "عن الصراط الحق" ، أسقط"عن" الثانية.
(27) في المطبوعة: "بدءًا من الشام" ، وأثبت في المخطوطة ، وكلتاهما صواب. و"بديًا" ، في بدء أمرهم. وتفسير"الوجوه" هنا: النواحي.
(28) هو الفراء في معاني القرآن 1: 272.
(29) السياق: ثم حذرهم... بأسه وسطوته...
(30) في المطبوعة: "كما يدل عليه" ، وفيه خطأ ، وفي المخطوطة: "كما يدل على" وفيه خطآن. والصواب ما أثبت.
(31) في المطبوعة: "من الوجوه التي ذكرت ، دليل يجب التسليم له" ، زاد فيما كان في المخطوطة لتستقيم الجملة ، وكان فيها: "من الوجوه التي يجب التسليم له" والأمر أهون من ذلك ، أخطأ فكتب"التي" مكان"الذي" ، وهو حق السياق.
(32) سلف البيت وتخريجه في 4: 424 ، تعليق: 4.
(33) في المطبوعة: "الذي قد تعفى ما بين جفني..." حذف"غر" ، لأنه لم يحسن قراءتها ، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وانظر شرح أبي جعفر لكلمة"غر" ، والتعليق عليه بعد.
(34) في المطبوعة: (العراسق الذي بين الخفين) ، واستدرك عليه الناشر الأول ، وكتب فيه خلطًا شديدًا ، نقله عنه آخرون!! وأما المخطوطة التي لم يحسن الناشر قراءتها فكان فيها: العرالسق الذي بين الخفين" كله غير منقوط ، وصوابه قراءته ما أثبت. وأصل ذلك أن"الغر" (بفتح الغين وتشديد الراء) هو الشق في الأرض. و"الغر" أيضًا: الكسر يكون في الثوب ، والغضون في الجلد ، وهو مكاسر الجلد ، ومنه قليل: "اطو الثوب على غره" أي على كسره. وقد جاءت هذه الكلمة في تفسير أبي جعفر 23: 17 ، 18 مصحفة بالزاي: "والطمس على العين هو أن لا يكون بين جفني العين (غز) ، وذلك هو الشق الذي بين الجفنين". وانظر شرح ابن إسحاق في سيرته 2: 210: "المطموس العين: الذي ليس بين جفنيه شق".
فتبين من هذا صحة قراءتنا وصوابها ، وخلط من لا يحسن أن يخلط ، فضلا عن أن يصيب!!
(35) "كان" هنا تامة ، بمعنى: وقع وحدث.
(36) في المطبوعة والمخطوطة: "أسد بن سعية" وعند ابن إسحاق: "أسيد بن سعية" (بفتح الألف وكسر السين). والاختلاف في اسمه واسم أبيه كثير.
(37) لم أجد"مخيرق" في غير هذا الموضع ، وهو في سائر الكتب وفي ترجمته"مخيريق" ، والاختلاف في أسماء بني إسرائيل كثير. فتركته على حاله هنا ، لأنه هكذا ثبت في المخطوطة.
(38) في المخطوطة: "الذي حكم به لحق" ، وفي هامش النسخة بخط عتيق: "الصواب: بعثت" ، وأخطأ من كتب ، فالصواب ما في المطبوعة ، وهو نص سيرة ابن هشام.
(39) الأثر 9724 - سيرة ابن هشام 2: 209 ، وهو تابع الأثر السالف: 9689 ، 9690.
(40) يعني"كعب الأحبار".
(41) انظر تفسير"اللعنة" فيما سلف قريبًا ص: 439 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.
(42) انظر ما سلف 1: 154 / 3: 304 ، 305 / 6: 238 ، 464 ، ومواضع أخرى كثيرة فيما سلف.
(43) انظر خبر"أصحاب السبت" فيما سلف 2: 166 - 175.
المعاني :
التدبر :
لمسة
[47] كل الضمائر للمتكلم: (نَزَّلْنَا، نَطْمِسَ، فَنَرُدَّهَا، نَلْعَنَهُمْ، لَعَنَّا)، لكن حصل التفات في الأخير من الضمير إلى الاسم الظاهر فقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا﴾، التفات من المتكلم إلى الغائب، فبين لنا أن المتكلم هو الله، هو الذي يفعل ذلك، والالتفات في البلاغة يثير التفات السامع، ويثير نشاطه.
لمسة
[47] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ نداء أهل الكتاب في القرآن (يا أهل الكتاب) ذكر اثنتي عشرة مرة، بينما في هذه المرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ يمكن أن نلحظ هنا شيئين: الأول: أن الله تعالى أراد أن يعظهم وأن يذكرهم بأنه أعطاهم الكتاب، وبأنه أنزل إليهم الكتاب فعليهم أن يعملوا بما فيه، هذا مقام استدعى دعوتهم إلى الإيمان.
وقفة
[47] قال مالك رحمه الله: «كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾، فوضع كفيه على وجهه، ورجع القهقرى إلى بيته، فأسلم مكانه، وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي».
وقفة
[47] ﴿آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾ من رد أمر الإيمان عوقب بالخذلان.
تفاعل
[47] ﴿أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ: ﴾
- يا: أداة نداء. أيّ: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» للتنبيه زائدة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح بدل من أيّ أو عطف بيان لها.
- ﴿ أُوتُوا الْكِتابَ: ﴾
- الجملة صلة الموصول. أوتوا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم الظاهر على الياء المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والألف فارقة. الكتاب: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا: ﴾
- آمنوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة. بما: جار ومجرور متعلق بآمنوا و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. نزلنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «نَزَّلْنا» صلة الموصول.
- ﴿ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ: ﴾
- حال من الموصول «ما» أي القرآن منصوب بالفتحة لما: جار ومجرور متعلق بمصدقا و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. معكم: ظرف مكان يدل على المصاحبة متعلق بفعل محذوف وتقديره: وجد. وجملة «وجد معكم» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد الى الموصول في «انزلنا» ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به أي بما نزلناه.
- ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً: ﴾
- جار ومجرور متعلق بآمنوا. أن: حرف مصدري ونصب. نطمس: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن. وجوها: مفعول به منصوب بالفتحة و «أَنْ وما تلاها» بتأويل مصدر في محل جر مضاف اليه.
- ﴿ فَنَرُدَّها: ﴾
- الفاء: سببية. نردها: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية حرف العطف وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به و «أن المضمرة وما بعدها» بتأويل مصدر معطوف على المصدر «أَنْ نَطْمِسَ».
- ﴿ عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بنردها. و «ها» ضمير متصل في محل جرّ بالاضافة. أو: حرف عطف. نلعن: معطوف على «نَطْمِسَ»: وتعرب مثلها و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.
- ﴿ كَما لَعَنَّا: ﴾
- الكاف: حرف جر للتشبيه. و «ما» مصدرية. لعنّا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم للتعظيم والتفخيم و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و «ما» المصدرية وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق. التقدير: أو نلعنهم لعنا كلعننا. ويجوز اعراب الكاف: اسما بمعنى «مثل» مبنيا على السكون في محل نصب صفة «لمفعول مطلق» مصدر محذوف.
- ﴿ أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ: ﴾
- أصحاب: مفعول به منصوب بالفتحة. السبت: مضاف اليه مجرور بالكسرة. وكان: الواو: استئنافية. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح.
- ﴿ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا: ﴾
- أمر: اسم: «كانَ» مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة مفعولا: خبر «كانَ» منصوب بالفتحة أي نافذا. '
المتشابهات :
| الأحزاب: 38 | ﴿سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ |
|---|
| النساء: 47 | ﴿فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا ﴾ |
|---|
| الأحزاب: 37 | ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [47] لما قبلها : وبعد التحذير من اليهود وبيان بعض جرائمهم؛ أمَرهم اللهُ عز وجل هنا بالإيمانِ، ثُمَّ هَدَّدَهم، وذَكَّرَهم بأصحابِ السبتِ، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾
القراءات :
نطمس:
قرئ:
1- بكسر الميم، وهى قراءة الجمهور.
2- بضم الميم، وهى قراءة أبى رجاء.
مدارسة الآية : [48] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن .. ﴾
التفسير :
يخبر تعالى:أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة{ مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ} ولهذا قال تعالى:{ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} أي:افترى جرما كبيرا، وأي:ظلم أعظم ممن سوى المخلوق -من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده -نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا- بالخالق لكل شيء، الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب{ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب، فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى:{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} أي:لمن تاب إليه وأناب.
وقوله إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. استئناف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد، ولتأكيد وجوب امتثال الأمر بالإيمان، لأنه لا مغفرة إذا انتفى الإيمان.
والمراد بالشرك هنا: مطلق الكفر فيدخل فيه كفر اليهود دخولا أوليا.
والمعنى: إن الله لا يغفر لكافر مات على كفره، ويغفر ما دون الكفر من الذنوب والمعاصي لمن يشاء أن يغفر له إذا مات من غير توبة. فمن مات من المسلمين بدون توبة من الذنوب التي اقترفها فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة.
وقوله وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً استئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك، وزيادة في تشنيع حال المشرك.
أى. ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه، فقد ارتكب من الآثام ما لا تتعلق به المغفرة، لأنه بهذا الإشراك قد افترى الكذب العظيم على الله، واقترف الإفك المبين، وفعل أعظم ذنب في الوجود:
قال القرطبي: قوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فقال له رجل: يا رسول الله والشرك!! فنزل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. الآية. وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة.
وقوله وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه.
فقال ابن جرير الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله- تعالى-» .
وقد أورد ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة ثلاثة عشر حديثا تتعلق بها.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع في الحجاب» قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. ثم قرأ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. الآية.
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، حتى نزلت هذه الآية: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وفي رواية لابن أبى حاتم: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله- تعالى-» .
وقال الآلوسى: ثم إن هذه الآية كما يرد بها على المعتزلة- الذين يسوون بين الإشراك بالله وبين ارتكاب الكبيرة بدون توبة- يرد بها أيضا- على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه مخلد في النار. وذكر الجلال أن فيها ردا أيضا على المرجئة القائلين: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون.
وأخرج ابن الضريس وابن عدى بسند صحيح عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم قوله- تعالى- إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وقال:
«إنى ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتى فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا ورجونا» . وقد استبشر الصحابة بهذه الآية حتى قال على بن أبى طالب: أحب آية إلى في القرآن إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ .
ثم أخبر تعالى : أنه ( لا يغفر أن يشرك به ) أي : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ( ويغفر ما دون ذلك ) أي : من الذنوب ( لمن يشاء ) أي : من عباده .
وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة ، فلنذكر منها ما تيسر :
الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ، أخبرنا صدقة بن موسى ، حدثنا أبو عمران الجوني ، عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدواوين عند الله ثلاثة ; ديوان لا يعبأ الله به شيئا ، وديوان لا يترك الله منه شيئا ، وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره الله ، فالشرك بالله ، قال الله عز وجل : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) [ المائدة : 72 ] وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا ، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه ، من صوم يوم تركه ، أو صلاة تركها ; فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء . وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا ، فظلم العباد بعضهم بعضا ; القصاص لا محالة " .
تفرد به أحمد .
الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار في : حدثنا أحمد بن مالك ، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد ، عن زياد النميري ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الظلم ثلاثة ، فظلم لا يغفره الله ، وظلم يغفره الله ، وظلم لا يتركه الله : فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك ، وقال ( إن الشرك لظلم عظيم ) [ لقمان : 13 ] وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا ، حتى يدين لبعضهم من بعض " .
الحديث الثالث : قال الإمام أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا ثور بن يزيد ، عن أبي عون ، عن أبي إدريس قال : سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل ذنب عسى الله أن يغفره ، إلا الرجل يموت كافرا ، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا " .
رواه النسائي ، عن محمد بن مثنى ، عن صفوان بن عيسى ، به .
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا شهر ، حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يقول : يا عبدي ، ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك ، يا عبدي ، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي ، لقيتك بقرابها مغفرة " .
تفرد به أحمد من هذا الوجه .
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا أبي ، حدثنا حسين ، عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه ، أن أبا الأسود الديلي حدثه ، أن أبا ذر حدثه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ما من عبد قال : لا إله إلا الله . ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة " قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : " وإن زنى وإن سرق " قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : " وإن زنى وإن سرق " . ثلاثا ، ثم قال في الرابعة : " على رغم أنف أبي ذر " ! قال : فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر " . وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول : وإن رغم أنف أبي ذر .
أخرجاه من حديث حسين ، به .
طريق أخرى عنه : قال [ الإمام ] أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال : " كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ، ونحن ننظر إلى أحد ، فقال : " يا أبا ذر " . فقلت : لبيك يا رسول الله ، [ قال ] ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار ، إلا دينارا أرصده - يعني لدين - إلا أن أقول به في عباد الله هكذا " . وحثا عن يمينه وبين يديه وعن يساره . قال : ثم مشينا فقال : " يا أبا ذر ، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا " . فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره . قال : ثم مشينا فقال : " يا أبا ذر ، كما أنت حتى آتيك " . قال : فانطلق حتى توارى عني . قال : فسمعت لغطا فقلت : لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له . قال فهممت أن أتبعه ، ثم ذكرت قوله : " لا تبرح حتى آتيك " فانتظرته حتى جاء ، فذكرت له الذي سمعت ، فقال : " ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " . قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : " وإن زنى وإن سرق " .
أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش ، به .
وقد رواه البخاري ومسلم أيضا كلاهما ، عن قتيبة ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال : خرجت ليلة من الليالي ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ، ليس معه إنسان ، قال : فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد . قال : فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني ، فقال : " من هذا ؟ " فقلت : أبو ذر ، جعلني الله فداك . قال : " يا أبا ذر ، تعال " . قال : فمشيت معه ساعة فقال : " إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن يمينه وشماله ، وبين يديه وورائه ، وعمل فيه خيرا " . قال : فمشيت معه ساعة فقال لي : " اجلس هاهنا " ، قال : فأجلسني في قاع حوله حجارة ، فقال لي : " اجلس هاهنا حتى أرجع إليك " . قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه ، فلبث عني فأطال اللبث ، ثم إني سمعته وهو مقبل ، وهو يقول : " وإن سرق وإن زنى " . قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله ، جعلني الله فداءك ، من تكلم في جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا . قال : " ذاك جبريل ، عرض لي من جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . قلت : يا جبريل ، وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم ، وإن شرب الخمر " .
الحديث السادس : قال عبد بن حميد في : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما الموجبتان ؟ قال : " من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار " . وذكر تمام الحديث . تفرد به من هذا الوجه .
طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني ، حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي ، حدثنا موسى بن عبيدة ، الربذي ، أخبر عبد الله بن عبيدة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من نفس تموت ، لا تشرك بالله شيئا ، إلا حلت لها المغفرة ، إن شاء الله عذبها ، وإن شاء غفر لها : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .
ورواه الحافظ أبو يعلى في ، من حديث موسى بن عبيدة ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة ، عن جابر ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب " . قيل : يا نبي الله ، وما الحجاب ؟ قال : " الإشراك بالله " . قال : " ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى ، إن يشأ أن يعذبها ، وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها " . ثم قرأ نبي الله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .
الحديث السابع : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زكريا ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " .
تفرد به من هذا الوجه .
الحديث الثامن : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو قبيل ، عن عبد الله بن ناشر من بني سريع قال : سمعت أبا رهم قاص أهل الشام يقول : سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم ، فقال لهم : " إن ربكم ، عز وجل ، خيرني بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا بغير حساب ، وبين الخبيئة عنده لأمتي " . فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله ، أيخبئ ذلك ربك ؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر ، فقال : " إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده " قال أبو رهم : يا أبا أيوب ، وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! فقال أبو أيوب : دعوا الرجل عنكم ، أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن ، بل كالمستيقن . إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة " .
الحديث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني ، حدثنا عيسى بن يونس ( ح ) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني - فيما كتب إلي - قال : حدثنا عيسى بن يونس نفسه ، عن واصل بن السائب الرقاشي ، عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام . قال : " وما دينه ؟ " قال : يصلي ويوحد الله تعالى . قال " استوهب منه دينه ، فإن أبى فابتعه منه " . فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : وجدته شحيحا في دينه . قال : فنزلت : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .
الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك ، حدثنا أبي ، حدثنا مستور أبو همام الهنائي ، حدثنا ثابت عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت . قال : " أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ " ثلاث مرات . قال : نعم . قال : " فإن ذلك يأتي على ذلك كله " .
الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن ضمضم بن جوس اليمامي قال : قال لي أبو هريرة : يا يمامي لا تقولن لرجل : والله لا يغفر الله لك . أو لا يدخلك الجنة أبدا . قلت : يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال : لا تقلها ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة ، وكان الآخر مسرفا على نفسه ، وكانا متآخيين وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب ، فيقول : يا هذا أقصر . فيقول : خلني وربي ! أبعثت علي رقيبا ؟ قال : إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه ، فقال له : ويحك ! أقصر ! قال : خلني وربي ! أبعثت علي رقيبا ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك - أو لا يدخلك الجنة أبدا - قال : فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده ، فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر : أكنت بي عالما ؟ أكنت على ما في يدي قادرا ؟ اذهبوا به إلى النار . قال : فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته " .
ورواه أبو داود ، من حديث عكرمة بن عمار ، حدثني ضمضم بن جوس ، به .
الحديث الثاني عشر : قال الطبراني : حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني ، حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ، ما لم يشرك بي شيئا " .
الحديث الثالث عشر : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى [ الموصلي ] حدثنا هدبة - هو ابن خالد - حدثنا سهيل بن أبي حزم ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ، ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار " . تفردا به .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، حدثنا خالد - يعني ابن عبد الرحمن الخراساني - حدثنا الهيثم بن جماز عن سلام بن أبي مطيع ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عمر قال : كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس ، وآكل مال اليتيم ، وقاذف المحصنات ، وشاهد الزور ، حتى نزلت هذه الآية : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة .
ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد به .
وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري حدثنا عبد الله بن عاصم ، حدثنا صالح - يعني المري أبو بشر - عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في الكتاب ، حتى نزلت علينا هذه الآية : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادة ، وأرجينا الأمور إلى الله ، عز وجل .
وقال البزار : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا شيبان بن أبي شيبة ، حدثنا حرب بن سريج ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ، حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال : " أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة " .
وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، أخبرني مجبر ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : لما نزلت : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) [ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ] ) [ الزمر : 53 ] ، قام رجل فقال : والشرك بالله يا نبي الله ؟ فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )
رواه ابن جرير . وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر .
وهذه الآية التي في سورة " تنزيل " مشروطة بالتوبة ، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه ; ولهذا قال : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) [ الزمر : 53 ] أي : بشرط التوبة ، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ، ولا يصح ذلك ، لأنه تعالى ، قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك ، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء ، أي : وإن لم يتب صاحبه ، فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه ، والله أعلم .
وقوله : ( ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ) كقوله ( إن الشرك لظلم عظيم ) [ لقمان : 13 ] ، وثبت في الصحيحين ، عن ابن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك . . . " وذكر تمام الحديث .
وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد ، حدثنا أحمد بن عمرو ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا معن ، حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ; أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخبركم بأكبر الكبائر : الشرك بالله " ثم قرأ : ( ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ) وعقوق الوالدين " . ثم قرأ : ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) .
القول في تأويل قوله : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ = وإن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر، ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام.
* * *
وإذ كان ذلك معنى الكلام، فإن قوله: " أن يشرك به "، في موضع نصب بوقوع " يغفر " عليها (44) = وإن شئت بفقد الخافض الذي كان يخفضها لو كان ظاهرًا. وذلك أن يوجَّه معناه إلى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، على تأويل الجزاء، كأنه قيل: إن الله لا يغفر ذنبًا مع شرك، أو عن شرك. (45)
وعلى هذا التأويل يتوجه أن تكون " أن " في موضع خفض في قول بعض أهل العربية. (46)
* * *
وذكر أن هذه الآية نـزلت في أقوام ارتابوا في أمر المشركين حين نـزلت: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [سورة الزمر: 53].
ذكر الخبر بذلك:
9730 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال، حدثني مُجَبَّر، عن عبد الله بن عمر: أنه قال: لما نـزلت: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ الآية، قام رجل فقال: والشرك، يا نبيَّ الله. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ". (47)
9731 - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: " إن الله لا يغفر أن يشرك له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "، قال: أخبرني مُجَبَّر، عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نـزلت هذه الآية: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ الآية، قام رجل فقال: والشرك يا نبي الله. فكره ذلك النبي، فقال: " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ".
9732 - حدثني محمد بن خلف العسقلاني قال، حدثنا آدم قال، حدثنا الهيثم بن جَمّاز قال، حدثنا بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نَشُك في قاتلِ النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرَّحم، حتى نـزلت هذه الآية: " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "، فأمسكنا عن الشهادة. (48)
وقد أبانت هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة شركًا بالله.
* * *
القول في تأويل قوله : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " ومن يشرك بالله " في عبادته غيره من خلقه =" فقد افترى إثما عظيما "، يقول: فقد اختلق إثما عظيمًا. (49) وإنما جعله الله تعالى ذكره " مفتريًا "، لأنه قال زورًا وإفكًا بجحوده وحدانية الله، وإقراره بأن لله شريكًا من خلقه وصاحبة أو ولدًا. فقائل ذلك مُفترٍ. وكذلك كل كاذب، فهو مفترٍ في كذبه مختلقٌ له.
------------------
الهوامش :
(44) "الوقوع" تعدى الفعل إلى مفعول ، كما سلف مرارًا كثيرة.
(45) في معاني القرآن للفراء 1: 272: "مع شرك ، ولا عن شرك" ، والصواب في التفسير.
(46) انظر معاني القرآن للفراء 1: 272 فهذه مقالته.
(47) الحديث: 9730 - ابن أبي جعفر: هو عبد الله بن أبي جعفر الرازي: مضت ترجمته وترجمة أبيه في: 7030.
الربيع: هو ابن أنس البكري. مضت ترجمته في: 5480.
مجبر - بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المفتوحة ، بوزن"محمد"-: هو ابن أخي عبد الله بن عمر. و"مجبر" لقبه ، واسمه: "عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب". ذكره المصعب في نسب قريش ، ص: 356 ، وابن حزم في جمهرة الأنساب ، ص: 146 ، والمشتبه للذهبي ، ص: 462. مترجم في التعجيل ، ص: 392 - 393 ، وله ذكر فيه أيضًا في ترجمة ابنه"عبد الرحمن" ص: 256 - 257.
وله رواية في المسند: 1402 ، عن عثمان وطلحة. وأظنها رواية منقطعة ، فإن طبقته أصغر من أن يدركهما.
وله ذكر في الموطأ ص: 397: "مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر: أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر ، قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر ، جهل ذلك ، فأمره عبد الله أن يرجع ، فيحلق أو يقصر ، ثم يرجع إلى البيت فيفيض".
ولم أجد له ترجمة غير ذلك. فهذا تابعي عرف شخصه ، ولم يذكر بجرح ، فأقل حالاته أن يكون حديثه حسنًا.
والحديث نقله ابن كثير 2: 481 ، عن هذا الموضع. ثم قال: "وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر".
وذكره السيوطي 1: 169 ، ونسبه أيضًا لابن أبي حاتم.
وسيأتي عقب هذا بإسناد ضعيف ، لإبهام شيخ الطبري.
(48) الحديث: 9732 - آدم: هو ابن أبي إياس العسقلاني. مضت ترجمته في: 187 ، الهيثم بن جماز البكاء ، الحنفي البصري القاضي: ضعيف ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، وغيرهم. مترجم في لسان الميزان 6: 204 - 205 ، والكبير للبخاري 4 / 2 / 216. وابن أبي حاتم 4 / 2 / 81 ، والضعفاء للنسائي ، ص: 30.
و"جماز": بفتح الجيم وتشديد الميم وآخره زاي. ووقع في المخطوطة والمطبوعة"حماد" ، وهو تصحيف. وكذلك وقع مصحفًا في التهذيب 11: 100 ، عند ذكره بترجمة"الهيثم بن أبي الهيثم".
بكر بن عبد الله المزني: تابعي ثقة معروف ، أخرج له الجماعة.
والحديث ذكره السيوطي 2: 169 ، ونسبه أيضًا لابن أبي حاتم ، والبزار.
ومعناه ثابت عن ابن عمر من روايات أخر:
ففي الدر المنثور 2: 169"أخرج ابن الضريس ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وابن عدي - بسند صحيح ، عن ابن عمر ، قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، وقال: إني ادخرت دعوتي ، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ، ثم نطقنا بعد ورجونا". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 5 ، وقال: "رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، غير حرب بن سريج ، وهو ثقة".
وفي مجمع الزوائد 10: 210 - 211"عن ابن عمر ، قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ، حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة. رواه البزار ، وإسناده جيد". وهو نحو الذي قبله.
وفيه أيضًا روايات بهذا المعنى عن ابن عمر 10: 193.
هذا ، وكان في المخطوطة: "لا نشك في المؤمن ، وآكل مال اليتيم": بينهما بياض وقبل"المؤمن" في أعلاه حرف"ط" ، وهذا دال على أن النسخة التي نقل عنها كانت غير واضحة فأثبتنا ما جاء في الروايات الأخر.
(49) انظر تفسير"افترى" فيما سلف 6: 292.
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[48] سبحان من جعل هذه الآية حجة على الروافض، والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة وغيرهم!
عمل
[48] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ الشرك لا يغفره الله، لذلك تحرَّ الإخلاص في عملك، واحرص ألا تقع في الشرك الخفي.
وقفة
[48] قال ابن عمر: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾».
تفاعل
[48] كان الصحابة يستبشرون بهذه الآية؛ حتى قال علي بن أبي طالب: «أحب آية إلي في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾».
وقفة
[48] الذنوب قد يغفرها الله للعبد بالتوبة، أو يكفرها بالأعمال الصالحة، أو يغفرها سبحانه تفضلًا منه ورحمة، أما الشرك فإنه لا يُغفر فاحذره ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾.
عمل
[48] أرسل رسالة تحذر فيها من يحلف بغير الله تعالى؛ كالحلف بالنبي ﷺ أو بالأمانة، ونحوها ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾.
تفاعل
[48] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ استعذ بالله من الشرك.
تفاعل
[48] ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ ادعُ الله الآن أن يغفر لك.
وقفة
[48] في قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما: أنه يقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له بالعذاب وإن كان مصرًّا، والثانية: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمع.
وقفة
[48] بيان خطر الشرك والكفر، وأنه لا يُغْفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ: ﴾
- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «إِنَّ» منصوب للتعظيم بالفتحة. لا: نافية لا عمل لها. يغفر: فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. والجملة الفعلية «يَغْفِرُ» في محل رفع خبر «إِنَّ».
- ﴿ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ: ﴾
- أن: حرف مصدري ونصب. يشرك: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. به: جار ومجرور للتعظيم في محل رفع نائب فاعل وجملة «يُشْرَكَ» صلة «إِنَّ» لا محل لها و «إِنَّ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل يغفر أو في محل جر بحرف جر مقدر بتقدير: بأن يشرك به أي بالشرك. به: والجار والمجرور متعلق بيغفر.
- ﴿ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ: ﴾
- الواو: استئنافية. يغفر: أعربت. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. دون: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بفعل مقدر بمعنى ما كان دون ذلك وجملة «كان دون ذلك» صلة الموصول لا محل لها. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة اللام للبعد والكاف للخطاب.
- ﴿ لِمَنْ يَشاءُ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيغفر. من: اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل جر باللام. يشاء: تعرب اعرابه «يَغْفِرُ». وجملة «يَشاءُ» صلة الموصول لا محل لها ومفعول «يَشاءُ» محذوف.
- ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ: ﴾
- الواو: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يشرك: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون والفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره: هو. بالله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بيشرك وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «مَنْ».
- ﴿ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً: ﴾
- الفاء: واقعة في جواب الشرط. قد: حرف تحقيق. افترى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر.والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. إثما: مفعول به منصوب بالفتحة. عظيما: صفة- نعت- لإثما منصوبة مثله بالفتحة وجملة «فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً» جواب شرط جازم مسبوق بقد المقترن بالفاء في محل جزم. '
المتشابهات :
| النساء: 48 | ﴿ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ |
|---|
| النساء: 116 | ﴿ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [48] لما قبلها : بعد تهديد اليهود وتوعدهم على شركهم وكفرهم؛ جاء هنا التأكيد على أن الله لا يغفر الشرك، حيث ادعوا كذبًا أن اللهَ سيَغفِرُ لهم، قال تعالى:
﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [49] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ .. ﴾
التفسير :
هذا تعجيب من الله لعباده، وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى، ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه. وذلك أن اليهود والنصارى يقولون:{ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} ويقولون:{ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى} وهذا مجرد دعوى لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله:{ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا:{ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ} أي:بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة، والتحلي بالصفات الجميلة. وأما هؤلاء فهم -وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء، وأن الثواب لهم وحدهم- فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب، بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم، ولهذا قال:{ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} وهذا لتحقيق العموم أي:لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها.
ثم حكى- سبحانه- لونا آخر من قبائح اليهود فقال:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ، بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً.
روى المفسرون في سبب نزول هاتين الآيتين أن رجالا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء ذنب؟ فقال: لا. فقالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم.
ما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار» .
ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم قالوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
وحكى عنهم أنهم كانوا يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا.
وحكى عنهم وعن النصارى أنهم قالوا: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ.
والاستفهام في قوله- تعالى- أَلَمْ تَرَ للتعجب من أحوالهم، والتهوين من شأنهم حيث بالغوا في مدح أنفسهم مع أنهم كاذبون في ذلك.
وقوله يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ من التزكية بمعنى التطهير والتنزيه عن القبيح. والمراد بهذا التعبير هنا: أنهم يصفون أنفسهم بالأفعال الحسنة، ويمدحونها مدحا كثيرا، مع أنهم لا يستحقون إلا الذم بسبب سوء أقوالهم وأفعالهم.
والمعنى: ألم ينته علمك يا محمد إلى حال هؤلاء اليهود الذين يمدحون أنفسهم ويثنون عليها مختالين متفاخرين مع ما هم عليه من الكفر وسوء الأخلاق؟ إن كنت لم تعلم أحوالهم أو لم تنظر إليهم فها نحن نكشف لك عن خباياهم لتتعجب من سوء أعمالهم وليتعجب منهم كل عاقل.
وقوله بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ إبطال لمعتقدهم بإثبات ضده، وهو أن التزكية شهادة من الله ولا ينفع أحدا أن يزكى نفسه، وإعلام منه- سبحانه- بأن تزكيته هي التي يعتد بها لا تزكية غيره، فإنه هو العالم بما ينطوى عليه الإنسان من حسن وقبح، وخير وشر.
وقوله وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بيان لكمال عدله- سبحانه- وأنه لا يظلم أحدا من خلقه لا قليلا ولا كثيرا.
والفتيل: هو الخيط الذي يكون في شق النواة. وكثيرا ما يضرب به المثل في القلة والحقارة.
أى أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم بغير حق يعاقبون على هذا الكذب بما يستحقون من عقاب عادل لا ظلم معه لأنه- سبحانه- لا يظلم أحدا من عباده شيئا بل يجازى كل إنسان بما هو أهل له من خير أو شر.
قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية ، وهي قوله : ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) في اليهود والنصارى ، حين قالوا : ( نحن أبناء الله وأحباؤه )
وقال ابن زيد : نزلت في قولهم : ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) [ المائدة : 18 ] ، وفي قولهم : ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) [ البقرة : 111 ] .
وقال مجاهد : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ، ويزعمون أنهم لا ذنب لهم .
وكذا قال عكرمة ، وأبو مالك . روى ذلك ابن جرير .
وقال العوفي ، عن ابن عباس في قوله ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) وذلك أن اليهود قالوا : إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة ، وسيشفعون لنا ويزكوننا ، فأنزل الله على محمد [ صلى الله عليه وسلم ] ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ) رواه ابن جرير .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن مصفى ، حدثنا ابن حمير ، عن ابن لهيعة ، عن بشر بن أبي عمرو عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ، ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب . وكذبوا . قال الله [ تعالى ] إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له " وأنزل الله : ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم )
ثم قال : وروي عن مجاهد ، وأبي مالك ، والسدي ، وعكرمة ، والضحاك - نحو ذلك .
وقال الضحاك : قالوا : ليس لنا ذنوب ، كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك فيهم .
وقيل : نزلت في ذم التمادح والتزكية .
وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم ، عن المقداد بن الأسود قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب .
وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ، فقال : " ويحك . قطعت عنق صاحبك " . ثم قال : " إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة ، فليقل : أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا " .
وقال الإمام أحمد : حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن نعيم بن أبي هند قال : قال عمر بن الخطاب : من قال : أنا مؤمن ، فهو كافر . ومن قال : هو عالم ، فهو جاهل . ومن قال : هو في الجنة ، فهو في النار .
ورواه ابن مردويه ، من طريق موسى بن عبيدة ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، عن عمر أنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه ، فمن قال : إنه مؤمن ، فهو كافر ، ومن قال : إنه عالم فهو جاهل ، ومن قال : إنه في الجنة ، فهو في النار .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة وحجاج ، أنبأنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن معبد الجهني قال : كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإن هذا المال حلو خضر ، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه ، وإياكم والتمادح فإنه الذبح " .
وروى ابن ماجه منه : " إياكم والتمادح فإنه الذبح " عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن غندر ، عن شعبة به .
ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصري القدري .
وقال ابن جرير : حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله بن مسعود : إن الرجل ليغدو بدينه ، ثم يرجع وما معه منه شيء ، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له : والله إنك كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء وقد أسخط الله . ثم قرأ ) ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) الآية .
وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى : ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) [ النجم : 32 ] . ولهذا قال تعالى : ( بل الله يزكي من يشاء ) أي : المرجع في ذلك إلى الله ، عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها .
ثم قال تعالى : ( ولا يظلمون فتيلا ) أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل .
قال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، وغير واحد من السلف : هو ما يكون في شق النواة .
وعن ابن عباس أيضا : هو ما فتلت بين أصابعك . وكلا القولين متقارب .
القول في تأويل قوله : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ألم تر، يا محمد بقلبك، (50) الذين يزكون أنفسهم من اليهود فيبرِّئونها من الذنوب ويطهرونها. (51)
* * *
واختلف أهل التأويل، في المعنى الذي كانت اليهود تُزَكي به أنفسها.
فقال بعضهم: كانت تزكيتهم أنفسَهم، قولهم: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ .
*ذكر من قال ذلك:
9733 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظلمون فتيلا "، وهم أعداء الله اليهود، زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه، فقالوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ . وقالوا: " لا ذنوب لنا ".
9734 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم "، قال: هم اليهود والنصارى، قالوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ . وقالوا: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى .
9735 - وحدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو تميلة، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك قال: قالت يهود: " ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون! فإن كانت لهم ذنوب فإنّ لنا ذنوبًا! فإنما نحن مثلهم "! قال الله تعالى ذكره: انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا
9736 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم "، قال: قال أهل الكتاب: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ، وقالوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ، وقالوا: " نحن على الذي يحب الله ". فقال تبارك وتعالى: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء "، حين زعموا أنهم يدخلون الجنة، وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأهل طاعته.
9737 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل لله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا "، نـزلت في اليهود، قالوا: " إنا نعلم أبناءنا التوراة صغارًا، فلا تكون لهم ذنوب، وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا، ما عملنا بالنهار كُفَّر عنا بالليل ".
* * *
وقال آخرون: بل كانت تزكيتهم أنفسَهم، تقديمهم أطفالهم لإمامتهم في صلاتهم، زعمًا منهم أنهم لا ذنوب لهم.
*ذكر من قال ذلك:
9738 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " يزكون أنفسهم "، قال: يهود، كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمُّونهم، يزعمون أنهم لا ذنوب لهم. فتلك التزكية.
9739 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
9740 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن الأعرج، عن مجاهد قال: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في &; 8-454 &; الدعاء والصلاة يؤمُّونهم، ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم، فتلك تزكية = قال ابن جريج: هم اليهود والنصارى.
9741 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن حصين، عن أبي مالك في قوله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم "، قال: نـزلت في اليهود، كانوا يقدمون صبيانهم يقولون: " ليست لهم ذنوب ".
9742 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبي مكين، عن عكرمة في قوله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم "، قال، كان أهل الكتاب يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا الحِنْث يصلُّون بهم، يقولون: " ليس لهم ذنوب "! فأنـزل الله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم "، الآية. (52)
* * *
وقال آخرون: بل تزكيتهم أنفسهم، كانت قولهم: " إن أبناءنا سيشفعون لنا ويزكوننا ".
*ذكر من قال ذلك:
9743 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم "، وذلك أن اليهود قالوا: " إن أبناءنا قد تُوُفُّوا، وهم لنا قربة عند الله، وسيشفعون ويزكوننا "! فقال الله لمحمد: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم " إلى وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا .
* * *
وقال آخرون: بل ذلك كان منهم، تزكية من بعضهم لبعض.
*ذكر من قال ذلك:
9744 - حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي قال، حدثنا أبي، عن أبيه، &; 8-455 &; عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: إن الرجل ليغدو بدينه، ثم يرجع وما معه منه شيء! يلقى الرجل ليس يملك له نفعًا ولا ضرًا، فيقول: " والله إنك لذَيْتَ وذَيْتَ"، ولعله أن يرجع ولم يَحْلَ من حاجته بشيء، (53) وقد أسخط الله عليه. ثم قرأ: " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم " الآية. (54)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: معنى " تزكية القوم "، الذين وصفهم الله بأنهم يزكون أنفسهم، وَصفهم إياها بأنها لا ذنوب لها ولا خطايا، وأنهم لله أبناء وأحبّاء، كما أخبر الله عنهم أنهم كانوا يقولونه. لأن ذلك هو أظهر معانيه، لإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا يزكون أنفسهم دون غيرها.
* * *
وأما الذين قالوا: معنى ذلك: " تقديمهم أطفالهم للصلاة "، فتأويل لا تدرك صحته إلا بخبر حجة يوجب العلم.
* * *
وأما قوله جل ثناؤه: " بل الله يزكي من يشاء "، فإنه تكذيب من الله المزكِّين أنفسهم من اليهود والنصارى، المبرِّئيها من الذنوب. يقول الله لهم: ما الأمر كما &; 8-456 &; زعمتم أنه لا ذنوب لكم ولا خطايا، وأنكم برآء مما يكرهه الله، ولكنكم أهل فِرْية وكذب على الله، وليس المزكَّي من زكى نفسه، ولكنه الذي يزكيه الله، والله يزكي من يشاء من خلقه فيطهره ويبرِّئه من الذنوب، بتوفيقه لاجتناب ما يكرهه من معاصيه، إلى ما يرضاه من طاعته.
* * *
وإنما قلنا إنّ ذلك كذلك، لقوله جل ثناؤه: انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله قد طهرهم من الذنوب.
* * *
القول في تأويل قوله : وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا (49)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يزكون أنفسهم ولا غيرهم من خلقه، فيبخسهم في تركه تزكيتهم، وتزكية من ترك تزكيته، وفي تزكية من زكى من خلقه = شيئًا من حقوقهم، ولا يضع شيئًا في غير موضعه، ولكنه يزكي من يشاء من خلقه، فيوفِّقه، ويخذل من يشاء من أهل معاصيه. كل ذلك إليه وبيده، وهو في كل ذلك غير ظالم أحدًا = ممن زكاه أو لم يزكه = فتيلا.
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى " الفتيل ".
فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ، إذا فتلتَ إحداهما بالأخرى.
*ذكر من قال ذلك:
9745 - حدثني سليمان بن عبد الجبار [ قال، حدثنا محمد بن الصلت] &; 8-457 &; قال، حدثنا أبو كدينة، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الفتيل ما خرج من بين إصبعيك. (55) 9746 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن التيمي قال: سألت ابن عباس عن قوله: " ولا يظلمون فتيلا "، قال: ما فتلت بين إصبعيك.
9747 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يزيد بن درهم أبي العلاء قال، سمعت أبا العالية، عن ابن عباس: " ولا يظلمون فتيلا "، قال: الفتيل، هو الذي يخرج من بين إصبعي الرجل. (56)
9748 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ولا يظلمون فتيلا "، والفتيل، هو أن تدلُك إصبعيك، (57) فما خرج بينهما فهو ذلك.
9749 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، &; 8-458 &; عن أبي مالك في قوله: " ولا يظلمون فتيلا "، قال: الفتيل: الوَسخ الذي يخرج من بين الكفين.
9750 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي، قال: الفتيل، ما فتلت به يديك، فخرج وَسَخ.
9751 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: " ولا يظلمون فتيلا "، قال: ما تدلكه في يديك فيخرج بينهما.
* * *
وأناس يقولون: الذي يكون في بَطن النواة.
*ذكر من قال ذلك:
9752 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " فتيلا "، قال: الذي في بطن النواة.
9753 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء قال: الفتيل، الذي في بطن النواة.
9754 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني طلحة بن عمرو: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول، فذكر مثله.
9755 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهدًا يقول: الفتيل، الذي في شِقّ النواة.
9756 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن سعيد قال، حدثنا سفيان بن سعيد، عن منصور، عن مجاهد قال: الفتيل، في النَّوى.
9757 - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا &; 8-459 &; معمر، عن قتادة في قوله: " ولا يظلمون فتيلا "، قال: الفتيل الذي في شِقّ النواة.
9758 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: الفتيل، شق النواة.
9759 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: الفتيل، الذي في بطن النواة.
9760 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: الفتيل، الذي يكون في شِقّ النواة.
9761 - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ولا يظلمون فتيلا "، فتيل النواة.
9762 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا قرة، عن عطية قال: الفتيل، الذي في بطن النواة. (58)
* * *
قال أبو جعفر: وأصل " الفتيل "، المفتول، صرف من " مفعول " إلى " فعيل " كما قيل: " صريع " و " دهين " من " مصروع " و " مدهون ".
وإذ كان ذلك كذلك = وكان الله جل ثناؤه إنما قصد بقوله: " ولا يظلمون فتيلا "، الخبرَ عن أنه لا يظلم عبادَه أقلَّ الأشياء التي لا خطر لها، فكيف بما له خطر؟ = وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين كفيه إذا فتل إحداهما على الأخرى، كالذي هو في شق النواة وبطنها، وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي مفتولة، مما لا خطر له، ولا قيمة = فواجبٌ أن يكون كل ذلك داخلا في معنى " الفتيل "، إلا أن يخرج شيئًا من ذلك ما يجب التسليم له، مما دل عليه ظاهر التنـزيل.
-----------------
الهوامش :
(50) انظر تفسير"ألم تر" فيما سلف قريبًا: 426 ، تعليق: 5 ، والمراجع هناك.
(51) انظر تفسير"التزكية" فيما سلف: 369 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.
(52) الأثر: 9742 -"أبو مكين" هو: نوح بن ربيعة الأنصاري ، مولاهم. مترجم في التهذيب.
(53) في المطبوعة: "ويجعله أن يرجع" ، وهو خطأ لا شك فيه ، والصواب في المخطوطة. وقوله: "لم يحل من حاجة بشيء" ، أي لم يظفر منها بشيء ، ولم يصب شيئًا مما ابتغى ، وهو لا يستعمل إلا مع النفي والجحد بهذا المعنى.
وقوله: "ذيت وذيت" من ألفاظ الكنايات ، بمعنى: "كيت وكيت".
(54) الأثر: 9744 -"يحيى بن إبراهيم بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي" سلفت ترجمته برقم: 5379.
و"قيس بن مسلم الجدلي العدواني" روى عن طارق بن شهاب ، وروى عنه الأعمش ، وسفيان الثوري وآخرون. قال أحمد"ثقة في الحديث ، كان مرجئًا" وقال أحمد عن سفيان: "يقولون: ما رفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا لله".
و"طارق بن شهاب الأحمسي" ، روى عنه الأربعة. ورأى طارق النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه مرسلا ، وروى عن الخلفاء الأربعة ، وبلال ، وحذيفة ، وخالد بن الوليد.
(55) الأثر: 9745 -"سليمان بن عبد الجبار بن زريق الخياط" مضى برقم: 5994 = وكذلك مضت ترجمة: "محمد بن الصلت" ، وترجمة"أبي كدينة: يحيى بن المهلب". هذا وقد كان الإسناد مخرومًا فيما رجحت ، سقط منه ذكر"محمد بن الصلت" كما مضى في 5994 ، 7964 ، وكما سيأتي الإسناد نفسه برقم: 9799 ، ولأن سليمان بن عبد الجبار ، لم يلحق"أبا كدينة".
و"قابوس" هو: قابوس بن أبي ظبيان الجنبي ، روى عن أبيه حصين بن جندب. وهو ضعيف ، لا يحتج به ، كما قال ابن سعد. قال ابن حبان: "كان رديء الحفظ ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له".
وأبوه: "حصين بن جندب الجنبي ، أبو ظبيان. روى عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين ، وهو ثقة. مترجم في التهذيب.
(56) الأثر: 9747 -"يزيد بن درهم ، أبي العلاء العجمي" ، أخو: محمد بن درهم ، روى عن أنس بن مالك ، والحسن ، وهذا هو يروي أيضًا عن أبي العالية ، ولم يذكروه. روى عنه وكيع ، وعبد الصمد بن عبد الوارث. قال الفلاس: "ثقة" ، وقال ابن معين: "ليس بشيء". وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ كثيرًا". مترجم في ابن أبي حاتم 4 / 2 / 260 ، ولسان الميزان 6: 286. وانظر الأثر التالي: 9811 ، والتعليق عليه.
هذا ، وكان في المطبوعة: "زيد بن درهم: ..." ، والصواب من المخطوطة.
(57) في المطبوعة"تدلك بين إصبعيك" ، زاد"بين" وليست في المخطوطة.
(58) الأثر: 9762 -"أبو عامر" هو أبو عامر العقدي ، عبد الملك بن عمرو ، مضت ترجمته برقم: 4143.
و"قرة" هو قرة بن خالد السدوسي ، روى عن أبي رجاء العطاردي ، وابن سيرين ، والحسن. وروى عنه شعبة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأبو داود الطيالسي ، وغيرهم. مترجم في التهذيب و"عطية" هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي. مترجم في رقم: 305.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[49] هذه الآية وقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: 32] يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله، وزكاه الله عز وجل؛ فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له.
اسقاط
[49] أخي طالب العلم: كيف تصف نفسك في موقعك الشخصي بـ(فضيلة الشيخ) وأنت تقرأ قول الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم﴾، وقول الله: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: 32]؟!
اسقاط
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ تزكية النفس مكروه عند الله وعند عباده، فلماذا تفعل؟!
تفاعل
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ قـل: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا».
وقفة
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ يزكيك الله وينشر لك الذكر الحسن بقدر ما تقاوم مدح ذاتك تلميحًا أو تصريحًا.
وقفة
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ من زكى نفسه أغضب مولاه، ومن زكاه ربه أكرمه وجعل له القبول في الأرض.
عمل
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ لا تقلق من نظرة الآخرين إليك، فهم لا يصنعون بأنفسهم صورتك في قلوبهم، الله وحده من يخلق مشاعرهم نحوك.
عمل
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ فلنتق الله في أنفسنا وفي الآخرين ممن نتفنن في إطلاق الألقاب عليهم، لنقيهم ونقي أنفسنا شر المديح والغلو في الإطراء.
وقفة
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ قليلًا من التواضع في الألقاب والمسميات، فهي للدنيا، وستبقى للدنيا، رسول الله صلى الله عليه سلم وهو أكرم الخلق على الله وأعبدهم لله وصفه ربه عز وجل في أعظم رحلة في تاريخ البشرية رحلة الإسراء والمعراج بكلمة (عبده)، أشرف لقب يمكن أن يوصف به النبي الخاتم.
وقفة
[49] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾، ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: 32] فإن قلتَ: كيف ذمَّهم على ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلا تَأْمَنُونِي؟ وَأَنا أَمِينُ مَن في السَّماءِ» [البخاري ٧٤٣٢]، وقول يوسف عليه السلام: ﴿قالَ اجْعَلْني عَلى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حفِيظٌ عَليمٌ﴾ [يوسف: 55]؟ قلتُ: إنما قال النبىُّ ما قاله حين قال المنافقون: اعْدِلْ في القسمة تكذيبًا لهم، حيثُ وصفوه بخلافِ ما كان عليه من العدل والأمانة، وإِنما قال يوسف ما قاله ليتوصَّل إلى ما هو وظيفةُ الأنبياء، وهو إقامةُ العدل، وبسطُ الحقِّ، ولأنه عَلِمَ أنه لا أحد في زمنه أقوم منه بذلك العمل، فكان متعَيّنًا عليه.
عمل
[49] أتعلم ما عاقبة العُجب؟ الجواب: تزكية النفس، تدبَّر: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾، فتواضع لله تُرفع.
تفاعل
[49] قـل: «اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكـها أنت خيـر من زكاهـا» ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾.
وقفة
[49] ﴿بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ إن لم تكن تزكيتك من خالق السماء فلن ينفعك من الناس تزكيةٌ ولا ثناء.
عمل
[49] ﴿بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ لا تتسول الجاه من أفواههم، سيزكيك الله إن شاء، ولو كنت بعيدًا في جوف جبل.
عمل
[49] ﴿بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ مهما حاولت أن تغيب محاسنك؛ فسيظهرها الله، لا تهتم بتسويق ذلك.
لمسة
[49] انظر إلى أسلوب إبطال معتقدهم، فلم يقل: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم كاذبون)؛ ليبيِّن حالة التزكية بل قال: ﴿بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾، فقد أبطل معتقدهم في التزكية بإثبات التزكية لله تعالى، وقد أفاد تصوير الجملة بـ (بل) حتمية إبطال تزكيتهم خلافًا لحذفها، فلو قال: (والله يزكي من يشاء) لكان لهم طمع أن يكونوا ممن زكّاه الله تعالى.
تفاعل
[49] ﴿اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.
وقفة
[49] ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ الفتيل: الخيط الرقيق الذي يكون في شقِّ النواة.
وقفة
[49، 50] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ... انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ﴾ النهي عن تزكية الإنسان نفسه، فقد سماها الله في الآية التالية كذبًا.
وقفة
[49، 50] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ... انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ﴾ هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم: الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقًا، وما عليه المؤمنون المسلمون باطلًا، وهذا أعظم الكذب، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلًا، والباطل حقًا.
الإعراب :
- ﴿ أَلَمْ تَرَ: ﴾
- الألف استفهام لفظا ومعناه التقرير أو التعجب أو التعجيب. لم: أداة نفي وجزم وقلب. تر: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره حرف العلة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. ويجوز أن يكون المخاطب هنا لم ير ولم يسمع لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل في التعجيب. وفي هذه الحالة يكون الفاعل ضميرا مستترا جوازا تقديره هو.
- ﴿ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بترى. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالى. يزكون: فعل مضارع مرفوع بثبوت والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. أنفسهم: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة وجملة «يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ» صلة الموصول.
- ﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي: ﴾
- بل: حرف ابتداء او استئناف. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. يزكي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يُزَكِّي» في محل رفع خبر المبتدأ وكسر لام «بَلِ» لالتقاء الساكنين.
- ﴿ مَنْ يَشاءُ: ﴾
- من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يشاء: صلة الموصول لا محل لها تعرب اعراب يزكي وعلامة رفع الفعل الضمة الظاهرة في آخره وحذف مفعول «يَشاءُ» اختصارا.
- ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا: ﴾
- الواو: حالية. لا: نافية لا عمل لها. يظلمون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. فتيلا: تمييز منصوب بالفتحة والجملة في محل نصب حال. '
المتشابهات :
| النساء: 49 | ﴿بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ |
|---|
| الإسراء: 71 | ﴿فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَـٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ |
|---|
| النساء: 77 | ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ |
|---|
| النساء: 124 | ﴿فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [49] لما قبلها : وبعد تهديد اليهود وتوعدهم؛ ذمهم اللهُ عز وجل هنا لأنهم بالَغوا في تزكيةِ أنفسِهم، وذكَر أنَّه لا عبرةَ بتزكيةِ الإنسان نفسَه، وإنَّما العبرةُ بتزكيةِ اللهِ له، قال تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾
القراءات :
ألم تر:
قرئ:
1- بفتح الراء، وهى قراءة الجمهور.
2- بسكونها، إجراء لما وصل مجرى الوقف، وهى قراءة السلمى.
ولا يظلمون:
قرئ:
1- بالياء، وهى قراءة الجمهور.
2- بتاء الخطاب، وهى قراءة طائفة.
مدارسة الآية : [50] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ .. ﴾
التفسير :
{ انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} أي:بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله. لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا. وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا، والباطلِ حقًّا. ولهذا قال:{ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا} أي:ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم.
ثم أكد- سبحانه- التعجيب من أحوالهم فقال: انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ....
أى: انظر أيها العاقل كيف يفترى هؤلاء اليهود على الله الكذب في تزكيتهم لأنفسهم مع كفرهم وعنادهم وارتكابهم الأفعال القبيحة التي تجعلهم أهلا لكل مذمة وسوء عاقبة.
وقد جعل- سبحانه- افتراءهم الكذب لشدة تحقق وقوعه، كأنه أمر مرئى يراه الناس بأعينهم، ويشاهدونه بأبصارهم.
وقوله وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً أى: وكفى بافترائهم الكذب على الله إثما ظاهرا بينا يستحقون يسببه أشد العقوبات، وأغلظ الإهانات.
قال القرطبي ما ملخصه: قوله- تعالى- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ يقتضى الغض من المزكى لنفسه بلسانه، والإعلان بأن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله، وزكاه الله- تعالى-، فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له.
وأما تزكية الغير ومدحه له ففي البخاري من حديث أبى بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحك قطعت عنق صاحبك- يقوله مرارا- إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسبه الله ولا يزكى على الله أحدا» . فنهى صلى الله عليه وسلم أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه ... فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «ويحك قطعت عنق صاحبك» .
ومدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود ليكون منه ترغيبا له في أمثاله، وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه ليس مدحا مذموما.
وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة. ومدح صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: «إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» .
وقوله : ( انظر كيف يفترون على الله الكذب ) أي : في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وقولهم : ( لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) [ البقرة : 111 ] وقولهم : ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) [ البقرة : 80 ] واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة ، وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا ، في قوله : ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون عما كانوا يعملون ] ) [ البقرة : 141 ] .
ثم قال : ( وكفى به إثما مبينا ) أي : وكفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا .
القول في تأويل قوله : انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: انظر، يا محمد، كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب = القائلون: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى، الزاعمون أنه لا ذنوب لهم = الكذبَ والزور من القول، فيختلقونه على الله =" وكفى به "، يقول: وحسبهم بقيلهم ذلك الكذبَ والزورَ على الله =" إثمًا مبينًا "، يعني أنه يبين كذبهم لسامعيه، ويوضح لهم أنهم أفَكَةٌ فجرة، (59) كما:-
9763 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ، قال: هم اليهود والنصارى =" انظر كيف يفترون على الله الكذب " (60)
--------------------
الهوامش :
(59) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيما سلف من فهارس اللغة.
(60) انظر تفسير"ألم تر" ، فيما سلف قريبًا: 452 ، تعليق: 1 ، والمراجع هناك = وتفسير"النصيب" فيما سلف: 427 ، تعليق: 3 ، والمراجع هناك.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[50] ﴿انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ﴾ كذبوا على الله حين قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة: 111]، وحين قالوا: ﴿لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [آل عمران: 24]، وحين قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: 18].
لمسة
[50] ﴿انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ﴾ قال تعالى: (انظر)، ولم يقل: (اسمع) مع أن الكلام المختلق المكذوب تسمعه الآذان؛ لأن الله تعالى جعل الكذب والافتراء الذي تسمعه الأذن كأنه أمر مرئي يراه الناس بأعينهم، ليصف شدة تحقق وقوع ذلك منهم، فهو أمر محتَّم.
الإعراب :
- ﴿ انْظُرْ كَيْفَ: ﴾
- انظر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال و «كَيْفَ» وما تلاها: في محل نصب مفعول به للفعل انظر.
- ﴿ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل على. الله: جار ومجرور متعلق بيفترون.
- ﴿ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ: ﴾
- الكذب: مفعول به منصوب بالفتحة. وكفى: الواو: استئنافية. كفى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. به: الباء: حرف جر زائد. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل.
- ﴿ إِثْماً مُبِيناً: ﴾
- إثما: تمييز منصوب بالفتحة. مبينا: صفة- نعت- منصوب مثله بالفتحة. '
المتشابهات :
| النساء: 50 | ﴿انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ |
|---|
| المائدة: 103 | ﴿وَلَـٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ |
|---|
| يونس: 60 | ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ |
|---|
| يونس: 69 | ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ |
|---|
| النحل: 116 | ﴿لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [50] لما قبلها : وبعد أن ذمَّ اللهُ عز وجل الذين يبالغون في تزكيةِ أنفسِهم؛ وبَّخَهم هنا ووصفهم بالكذب، قال تعالى:
﴿ انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [51] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ .. ﴾
التفسير :
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله. فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعباده غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة الأصنام- على طريق المؤمنين فقال:{ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} أي:لأجلهم تملقا لهم ومداهنة، وبغضا للإيمان:{ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} أي:طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم"كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟"هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء، أو يدخل عقلَ أحد من الجهلاء، فهل يُفَضَّل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن، والإخلاص لله في السر والإعلان، والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق، حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان، وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع
ثم ساق- سبحانه- بعد ذلك لونا آخر من رذائلهم وقبائحهم التي تدعو إلى مزيد من التعجيب من أحوالهم. والتحقير من شأنهم فقال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا.
روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات منها: ما جاء عن ابن عباس أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف خرجا إلى مكة في جمع من اليهود ليحالفوا قريشا على حرب
النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبى سفيان فأحسن مثواه. ونزلت اليهود في دور قريش. فقال أهل مكة لليهود: إنكم أهل كتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب فلا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم.
فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما ففعلوا. ثم قال كعب: يا أهل مكة ليجيء منا ثلاثون ومنكم ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت على قتال محمد صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك. فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا على دينكم.
فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكرماء، ونسقيهم اللبن، ونقرى الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد صلى الله عليه وسلم فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث.
فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية .
والجبت في الأصل: اسم صنم ثم استعمل في كل معبود سوى الله- تعالى-.
والطاغوت: يطلق على كل باطل وعلى كل ما عبد من دون الله، أو كل من دعا إلى ضلالة.
أى: يصدقون بأنهما آلهة ويشركونهما في العبادة مع الله- تعالى-. أو يطيعونهما في الباطل.
قال ابن جرير: والصواب من القول في تأويل يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ أن يقال:
يصدقون بمعبودين من دون الله، ويتخذونهما إلهين، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان» .
وقوله وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بيان لما نطقوا به من زور وبهتان. أى: ويقولون إرضاء للذين كفروا وهم مشركو مكة. هؤلاء في شركهم وعبادتهم للجبت والطاغوت، أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أى أقوم طريقا، وأحسن دينا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
واللام في قوله لِلَّذِينَ كَفَرُوا لام العلة. أى: يقولون لأجل الذين كفروا..
والإشارة بقوله هؤُلاءِ أَهْدى إلى الذين كفروا.
وإيراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعنوان الإيمان، ليس من قبل القائلين، بل من جهة الله تعالى، تعريفا لهم بالوصف الجميل، وتحقيرا لمن رجح عليهم المتصفين بأقبح الصفات.
وقوله : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) أما " الجبت " فقال محمد بن إسحاق ، عن حسان بن فائد ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : " الجبت " : السحر ، و " الطاغوت " : الشيطان .
وهكذا روي عن ابن عباس ، وأبي العالية ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن ، والضحاك ، والسدي .
وعن ابن عباس ، وأبي العالية ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، [ وأبي مالك ] وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن ، وعطية : " الجبت " الشيطان - زاد ابن عباس : بالحبشية . وعن ابن عباس أيضا : " الجبت " : الشرك . وعنه : " الجبت " : الأصنام .
وعن الشعبي : " الجبت " : الكاهن . وعن ابن عباس : " الجبت " : حيي بن أخطب . وعن مجاهد : " الجبت " : كعب بن الأشرف .
وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه " الصحاح " : " الجبت " كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك ، وفي الحديث : " الطيرة والعيافة والطرق من الجبت " قال : وهذا ليس من محض العربية ، لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي .
وهذا الحديث الذي ذكره ، رواه الإمام أحمد في فقال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا ، عوف عن حيان أبي العلاء ، حدثنا قطن بن قبيصة ، عن أبيه - وهو قبيصة بن مخارق - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت " وقال عوف : " العيافة " : زجر الطير ، و " الطرق " : الخط ، يخط في الأرض ، و " الجبت " قال الحسن : إنه الشيطان .
وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي ، به
وقد تقدم الكلام على " الطاغوت " في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا إسحاق بن الضيف ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن " الطواغيت " فقال : هم كهان تنزل عليهم الشياطين .
وقال مجاهد : " الطاغوت " : الشيطان في صورة إنسان ، يتحاكمون إليه ، وهو صاحب أمرهم .
وقال الإمام مالك : " الطاغوت " : هو كل ما يعبد من دون الله ، عز وجل .
وقوله : ( ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) أي : يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم ، وقلة دينهم ، وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم .
وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة قال : جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة ، فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم ، فأخبرونا عنا وعن محمد ، فقالوا : ما أنتم وما محمد . فقالوا : نحن نصل الأرحام ، وننحر الكوماء ، ونسقي الماء على اللبن ، ونفك العناة ، ونسقي الحجيج - ومحمد صنبور ، قطع أرحامنا ، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار ، فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلا . فأنزل الله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من [ الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ] ) .
وقد روي هذا من غير وجه ، عن ابن عباس وجماعة من السلف .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج ، وأهل السدانة ، وأهل السقاية ! قال : أنتم خير . قال فنزلت ( إن شانئك هو الأبتر ) [ الكوثر : 3 ] ونزل : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) إلى ( نصيرا ) .
وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع ، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، وأبو عمار ، ووحوح بن عامر ، وهوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل ، وكان سائرهم من بني النضير ، فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فسلوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم ، فقالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . فأنزل الله عز وجل : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من [ الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ] ) إلى قوله عز وجل : ( وآتيناهم ملكا عظيما ) .
وهذا لعن لهم ، وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة ، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين ، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم ، وقد أجابوهم ، وجاءوا معهم يوم الأحزاب ، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق ، فكفى الله شرهم ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) [ الأحزاب : 25 ] .
القول في تأويل قوله : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ألم تر بقلبك، يا محمد، إلى الذين أُعطوا حظًّا من كتاب الله فعلموه =" يؤمنون بالجبت والطاغوت "، يعني: يصدِّقون بالجبت والطاغوت، ويكفرون بالله، وهم يعلمون أن الإيمان بهما كفر، والتصديقَ بهما شرك.
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في معنى " الجبت " و " الطاغوت ".
فقال بعضهم: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله.
*ذكر من قال ذلك:
9764 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، أخبرني أيوب، عن عكرمة أنه قال: " الجبت " و " الطاغوت "، صنمان.
* * *
وقال آخرون: " الجبت " الأصنام، و " الطاغوت " تراجمة الأصنام. (61)
*ذكر من قال ذلك:
9765 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت "،" الجبت " الأصنام، و " الطاغوت "، الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبّرون عنها الكذبَ ليضلوا الناس.
* * *
وزعم رجال أنّ" الجبت "، الكاهن، و " الطاغوت "، رجل من اليهود يدعى &; 8-462 &; كعب بن الأشرف، وكان سيِّد اليهود.
* * *
وقال آخرون: " الجبت "، السحر، و " الطاغوت "، الشيطان.
*ذكر من قال ذلك:
9766 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن حسان بن فائد قال: قال عمر رحمه الله : " الجبت " السحر، و " الطاغوت " الشيطان. (62)
9767 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حسان بن فائد العبسي، عن عمر مثله. (63)
9768 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عبد الملك، عمن حدثه، عن مجاهد قال: " الجبت " السحر، و " الطاغوت " الشيطان.
9769 - حدثني يعقوب قال، أخبرنا هشيم قال، أخبرنا زكريا، عن الشعبي قال: " الجبت "، السحر، و " الطاغوت "، الشيطان.
9770 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " يؤمنون بالجبت والطاغوت "، قال: " الجبت " السحر، و " الطاغوت "، الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم.
9771 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عبد الملك، عن قيس، عن مجاهد قال: " الجبت " السحر، و " الطاغوت "، الشيطان والكاهن.
* * *
وقال آخرون: " الجبت "، الساحر، و " الطاغوت "، الشيطان.
*ذكر من قال ذلك:
9772 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: كان أبي يقول: " الجبت "، الساحر، و " الطاغوت "، الشيطان.
* * *
وقال آخرون: " الجبت "، الساحر، و " الطاغوت "، الكاهن.
*ذكر من قال ذلك:
9773 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية: " الجبت والطاغوت "، قال: " الجبت " الساحر، بلسان الحبشة، و " الطاغوت " الكاهن.
9774 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن رفيع قال: " الجبت "، الساحر، و " الطاغوت "، الكاهن.
9775 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن أبي العالية أنه قال: " الطاغوت " الساحر، و " الجبت " الكاهن.
9776 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن داود، عن أبي العالية، في قوله: " الجبت والطاغوت "، قال: أحدهما السحر، والآخر الشيطان.
* * *
وقال آخرون: " الجبت " الشيطان، و " الطاغوت " الكاهن.
*ذكر من قال ذلك:
9777 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " يؤمنون بالجبت والطاغوت "، كنا نحدَّث أن الجبت شيطان، والطاغوت الكاهن.
9778 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة مثله.
9779 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: " الجبت " الشيطان، و " الطاغوت " الكاهن.
* * *
وقال آخرون: " الجبت " الكاهن، و " الطاغوت " الساحر. (64)
*ذكر من قال ذلك:
9780 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن سعيد بن جبير قال: " الجبت " الكاهن، و " الطاغوت " الساحر.
9781 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا حماد بن مسعدة قال، حدثنا عوف، عن محمد قال في الجبت والطاغوت، قال: " الجبت " الكاهن، والآخر الساحر.
* * *
وقال آخرون: " الجبت " حيي بن أخطب، و " الطاغوت "، كعب بن الأشرف.
*ذكر من قال ذلك:
9782 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس قوله: " يؤمنون بالجبت والطاغوت "،" الطاغوت ": كعب بن الأشرف، و " الجبت ": حيي بن أخطب.
9783 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك قال: " الجبت ": حيي بن أخطب، و " الطاغوت ": كعب بن الأشرف.
9784 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا &; 8-465 &; جويبر، عن الضحاك في قوله: " الجبت والطاغوت "، قال: " الجبت ": حيي بن أخطب، و " الطاغوت ": كعب بن الأشرف.
* * *
وقال آخرون: " الجبت " كعب بن الأشرف، و " الطاغوت " الشيطان.
*ذكر من قال ذلك:
9785 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد قال: " الجبت ": كعب بن الأشرف، و " الطاغوت ": الشيطان، كان في صورة إنسان.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل: " يؤمنون بالجبت والطاغوت "، أن يقال: يصدِّقون بمعبودَين من دون الله، يعبدونهما من دون الله، ويتخذونهما إلهين.
وذلك أن " الجبت " و " الطاغوت ": اسمان لكل معظَّم بعبادةٍ من دون الله، أو طاعة، أو خضوع له، كائنًا ما كان ذلك المعظَّم، من حجر أو إنسان أو شيطان. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها، كانت معظمة بالعبادة من دون الله = فقد كانت جُبوتًا وطواغيت. وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله. وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لأنهما كانا مطاعين في أهل ملّتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكانا جبتين وطاغوتين.
* * *
وقد بينت الأصل الذي منه قيل للطاغوت: " طاغوت "، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (65)
* * *
القول في تأويل قوله : وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا (51)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ويقولون للذين جحدوا وحدانية الله ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم = : " هؤلاء "، يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر =" أهدى "، يعني: أقوم وأعدل =" من الذين آمنوا "، يعني: من الذين صدَّقوا الله ورسوله وأقرُّوا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم =" سبيلا "، يعني: طريقًا.
* * *
قال أبو جعفر: وإنما ذلك مَثَلٌ. ومعنى الكلام: أن الله وصف الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من اليهود = بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة = في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما، بأنهم قالوا: (66) إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به، وأن دين أهل التكذيب لله ولرسوله، أعدل وأصوبُ من دين أهل التصديق لله ولرسوله. وذكر أن ذلك من صفة كعب بن الأشرف، وأنه قائل ذلك.
ذكر الآثار الواردة بما قلنا:
9786 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، قالت له قريش: أنت حَبْر أهل المدينة وسيدهم؟ (67) قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصُّنبور المنبتر من قومه، (68) يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السِّدانة وأهل السِّقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنـزلت: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ [سورة الكوثر: 3]، وأنـزلت: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ إلى قوله: فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا .
9787 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عكرمة في هذه الآية: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ثم ذكر نحوه.
9788 - وحدثني إسحاق بن شاهين قال، أخبرنا خالد الواسطي، عن داود، عن عكرمة قال: قدم كعب بن الأشرف مكة، فقال له المشركون: احكم بيننا، وبين هذا الصنبور الأبتر، فأنت سيدنا وسيد قومك! فقال كعب: أنتم والله خيرٌ منه! فأنـزل الله تبارك وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ، إلى آخر الآية. (69)
9789 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، أخبرنا أيوب، عن عكرمة: أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش، فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم، (70) وأمرهم أن يغزوه، وقال: إنا معكم نقاتله. فقالوا: إنكم أهل كتاب، وهو صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم! فإن أردت أن نخرج معك، فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. ففعل. ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء، (71) ونسقي اللبن على الماء، ونصل الرحم، ونقري الضيف، ونطوف بهذا البيت، ومحمد قطع رحمه، وخرج من بلده؟ قال: بل أنتم خير وأهدى! فنـزلت فيه: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ".
9790 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: قال: لما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود من بني النضير ما كان، (72) حين أتاهم يستعينهم في دية العامريَّين، فهمّوا به وبأصحابه، (73) فأطلع الله رسوله على ما هموا به من ذلك. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهرب كعب بن الأشرف حتى أتى مكة، فعاهدهم على محمد، فقال له أبو سفيان: يا أبا سعد، إنكم قوم تقرؤون الكتابَ وتعلمون، ونحن قوم لا نعلم! فأخبرنا، ديننا خير أم دين محمد؟ قال كعب: اعرضوا عليّ دينكم. فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء، ونسقي الحجيج الماء، ونقري الضيف، ونعمر بيت ربنا، ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا، ومحمد يأمرنا أن نترك هذا ونتبعه! قال: دينكم خير من دين محمد، فاثبتوا عليه، ألا ترون أنّ محمدًا يزعم &; 8-469 &; أنه بُعِث بالتواضع، وهو ينكح من النساء ما شاء! وما نعلم مُلْكًا أعظم من ملك النساء!! (74) فذلك حين يقول: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ".
9791 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: نـزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش، قال: كفار قريش أهدى من محمد!" عليه السلام " = قال ابن جريج: قدم كعب بن الأشرف، فجاءته قريش فسألته عن محمد، فصغَّر أمره ويسَّره، وأخبرهم أنه ضالٌّ. قال: ثم قالوا له: ننشدك الله، نحن أهدى أم هو؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكُوم، ونسقي الحجيج، ونعمر البيت، ونطعم ما هبَّت الريح؟ (75) قال: أنتم أهدى.
* * *
وقال آخرون: بل هذه الصفة، صفة جماعة من اليهود، منهم: حُيَيّ بن أخطب، وهم الذين قالوا للمشركين ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه لهم.
ذكر الأخبار بذلك:
9792 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمن قاله قال، أخبرني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الذين حَزَّبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة: حيي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع، (76) والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق، (77) &; 8-470 &; وأبو عمار، (78) ووَحْوَح بن عامر، وهوذة بن قيس = فأما وحوح وأبو عمار وهوذة، (79) فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير = فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأوَل، فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم، فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! فأنـزل الله فيهم: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، إلى قوله: وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا . (80)
9793 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، الآية، قال: ذُكر لنا أن هذه الآية أنـزلت في كعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب، ورجلين من اليهود من بني النضير، لقيا قريشًا بمَوْسم، (81) فقال لهم المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فإنا أهل السِّدانة والسقاية، وأهل الحرم؟ فقالا لا بل أنتم أهدى من محمد وأصحابه! وهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حَسَد محمد وأصحابه.
* * *
وقال آخرون: بل هذه صفة حيي بن أخطب وحده، وإياه عنى بقوله: " ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ".
*ذكر من قال ذلك:
9794 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ إلى آخر الآية، قال: جاء حيي بن &; 8-471 &; أخطب إلى المشركين فقالوا: يا حيي، إنكم أصحاب كتب، فنحن خير أم محمد وأصحابه؟ فقال: نحن وأنتم خير منهم! فذلك قوله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ إلى قوله: " ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا ".
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصحة في ذلك، قولُ من قال: إن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من اليهود. وجائز أن تكون كانت الجماعةَ الذين سماهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد، = أو يكون حُيَيًّا وآخر معه، (82) إما كعبًا، وإما غيره.
* * *
---------------
الهوامش :
(61) يعني بقوله: "تراجمة الأصنام" ، الكهان ، تنطق على ألسنة الأصنام ، كأنها تقول للناس بلسانهم ، ما قالته تلك بألسنتها.
(62) الأثر: 9766 -"حسان بن فائد العبسي" ، مضى برقم: 5834 ، وكان في المطبوعة في هذا الأثر والذي يليه: "حسان بن قائد العنسي". ومضى هذا الإسناد برقم: 5835.
(63) الأثر: 9767 - مضى برقم: 5834.
(64) في المطبوعة والمخطوطة: "والطاغوت الشيطان" ، وصواب السياق ما أثبت.
(65) انظر ما سلف 5: 419 ، وسائر الآثار في"الطاغوت" من رقم: 5834 - 5845.
(66) في المخطوطة والمطبوعة: "وأنهم قالوا" بالواو ، والواو متصلة بالألف في المخطوطة ، والصواب ما أثبته ، وقوله: "بأنهم" متعلق بقوله: "إن الله وصف...".
(67) في المطبوعة: "خير أهل المدينة" ، وفي المخطوطة"حبر" ، وإن كانت غير منقوطة في كثير من المواضع. ووقع في لسان العرب مادة (صنبر): "خير" وفي مادة (بتر): "حبر" ، فأثبتها ورجحتها ، لأنهم إنما سألوه عن شأن الدين ، والحبر: العالم من أهل الكتاب ، فهو المسئول عن مثل ما سألوه عنه من أمر خير الدينين.
(68) "الصنبور": سفعات تنبت في جذع النخلة ، غير مستأرضة في الأرض. ثم قالوا للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر"صنبور". فأراد هؤلاء الكفار من قريش أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ، بأبي هو وأمي ، صنبور نبت في جذع نخلة ، فإذا قلع انقطع: فكذلك هو إذا مات ، فلا عقب له. وكذبوا ، ونصر الله رسوله وقطع دابر الكافرين.
و"المنبتر" و"الأبتر": المنقطع الذي لا عقب له.
(69) الأثر: 9788 -"إسحاق بن شاهين الواسطي" ، مضى برقم: 8211 ، ولم نجد له ترجمة . و "خالد الواسطي" ، هو: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي" مضى برقم: 7211.
(70) "استجاش القوم": طلب منهم أن يجيشوا جيشًا.
(71) "الكوماء": هي الناقة المشرقة السنام العاليته ، وهذه خير النوق وأسمنها وأعزها عليهم ، والجمع"كوم".
(72) في المطبوعة: "واليهود بني النضير" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(73) ذلك في سنة أربع من الهجرة ، فأرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمالأوا على أن يلقوا عليه حجرًا من فوق جدار البيت الذي كان رسول الله جالسًا إلى جنبه ، فأطلعه الله على ذلك من أمرهم ، فقام وخرج راجعًا إلى المدينة ، ثم أمر بالتهيؤ لحرب بني النضير ، فحاصرهم ، وأجلاهم ، وفيهم نزلت"سورة الحشر" بأسرها. انظر سيرة ابن هشام 3 : 199 - 213.
(74) لم تزل هذه مقالة كل طاعن على رسول الله من المستشرقين وأذنابهم في كل أرض ، والكفر كله ملة واحدة ، والذي يلقى على ألسنتهم ، هو الذي ألقى على لسان هذا اليهودي الفاجر ، عدو الله وعدو رسوله.
(75) قوله: "نطعم ما هبت الريح" ، يراد به معنى الدوام. ولو أرادوا به زمن الشتاء في القحط ، لكان صوابًا.
(76) في المطبوعة: "وأبو رافع" بزيادة الواو ، وهو خطأ: "أبو رافع" كنية سلام ابن أبي الحقيق. والصواب من المخطوطة ، وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام.
(77) في المطبوعة: "والربيع بن أبي الحقيق" أسقط"بن الربيع" ، والصواب من المخطوطة ، وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام.
(78) "أبو عمار" في المطبوعة في الموضعين"أبو عامر" ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ، وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام.
(79) "أبو عمار" في المطبوعة في الموضعين"أبو عامر" ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ، وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام.
(80) الأثر: 9792 - سيرة ابن هشام 2: 210 ، وهو تابع الآثار التي آخرها رقم: 9724.
(81) الموسم: مجتمع الناس ، في سوق أو في حج أو غيرهما.
(82) في المطبوعة: "أن يكون" ، وهو خطأ لا ريب فيه ، صوابه ما أثبت.
المعاني :
التدبر :
وقفة
[51] يستفاد من الآية أنَّ مَن حكَم بخلاف ما يعلَمُ فهو أقبحُ ممَّن حكَم بما لا يعلَمُ، والكلُّ قبيحٌ، لكن الأوَّل أشدُّ؛ ولذا عظمت مسؤولية العلماء.
وقفة
[51] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ ألا تعجب یا محمد من حال هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله تعالى حظًّا من التوراة، فتركوا الإيمان والعمل به إلى الإيمان بالجبت والطاغوت، وما أشبه المسلمين اليوم بهذه الحال! فقد تركوا كتاب ربهم، واستبدلوه بقوانين وضعية تحل لهم الحرام، وتحرم الحلال.
وقفة
[51] قال ابن عباس: لمَّا قَدِم کعبُ بن الأشرف مكة، قالت له قريش: أنت خيرُ أهل المدينة وسيِّدُهم، قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا المُنبتِر من قومه، يزعُم أنَّه خيرٌ منَّا، ونحن أهلُ الحجيج وأهلُ السدانة؟ قال: أنتم خيرٌ منه، فنزلت: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3]، ونزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾.
وقفة
[51] ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان والوثن، وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة؛ يعظمون السحر والشرك، ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعة.
وقفة
[51] ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعبادة غير الله، وطاعة الشيطان.
وقفة
[51] ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ بعضهم ينحاز لأهل الباطل المحض، ليس قناعة بباطلهم، ولكن نكاية لضغينته على بعض أهل الحق.
وقفة
[51] ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ تأييدك للمخالفين للسنة وطريقة السلف لمجرد الضغينة: وضاعة فكرية وتشبه بأخلاق اليهود.
وقفة
[51] ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ الهزيمة القابعة في أنوية خلاياهم.
وقفة
[46-51] بيان جرائم اليهود، كتحريفهم كلام الله، وسوء أدبهم مع رسوله ﷺ، وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه.
الإعراب :
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ: ﴾
- سبق إعرابها في الآية الكريمة التاسعة والأربعين.
- ﴿ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ: ﴾
- أوتوا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم الظاهر على الياء المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والألف فارقة. نصيبا: مفعول به منصوب بالفتحة. من الكتاب: جار ومجرور متعلق بالفعل أوتوا أو بصفة محذوفة من «نَصِيباً». وجملة «أُوتُوا» صلة الموصول لا محل لها.
- ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ: ﴾
- الجملة في محل نصب حال. يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالجبت: جار ومجرور متعلق بيؤمنون بالطاغوت معطوفة بواو العطف على الجبت.
- ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾
- معطوفة بواو العطف على يؤمنون وتعرب مثلها للذين جار ومجرور متعلق بيقولون و «الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل جر باللام. كفروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف فارقة. وجملة «كَفَرُوا» صلة الموصول لا محل لها.
- ﴿ هؤُلاءِ أَهْدى: ﴾
- الجملة وما تلاها: في محل نصب مفعول به «مقول القول». هؤلاء: الهاء للتنبيه أولاء اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. أهدى: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر.
- ﴿ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأهدى يعرب إعراب «لِلَّذِينَ كَفَرُوا». سبيلا: تمييز منصوب بالفتحة. '
المتشابهات :
| آل عمران: 23 | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّـهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ |
|---|
| النساء: 44 | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ |
|---|
| النساء: 51 | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [51] لما قبلها : وبعد ذكر تزكية اليهود لأنفسهم وافترائهم الكذبَ على الله؛ ذكر اللهُ عز وجل هنا تزكيتهم للكفار، وافتراءهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، قال تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء