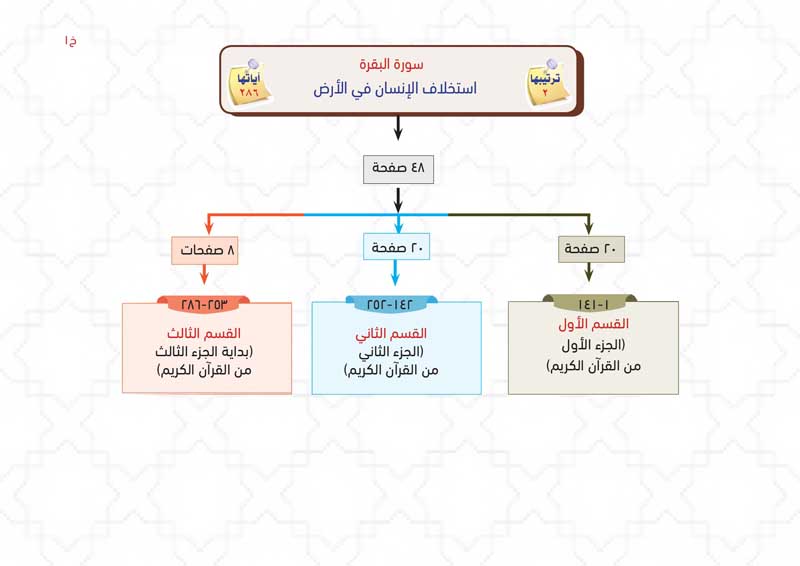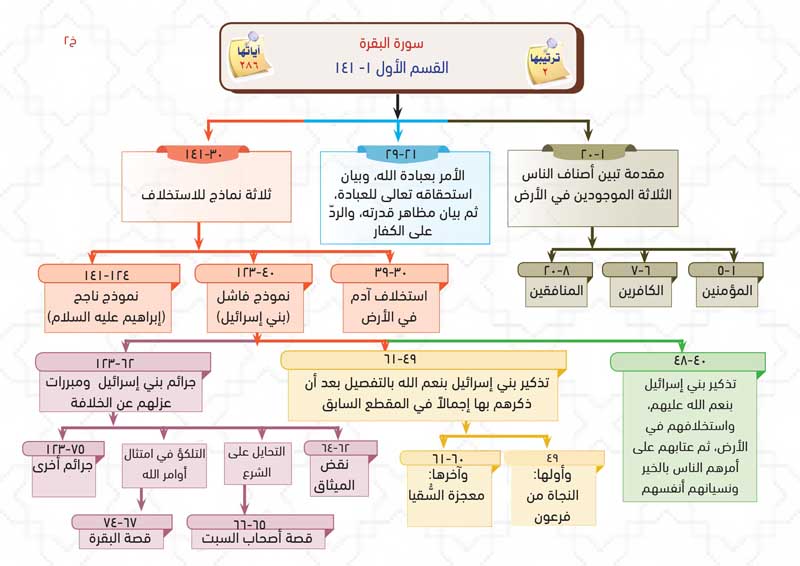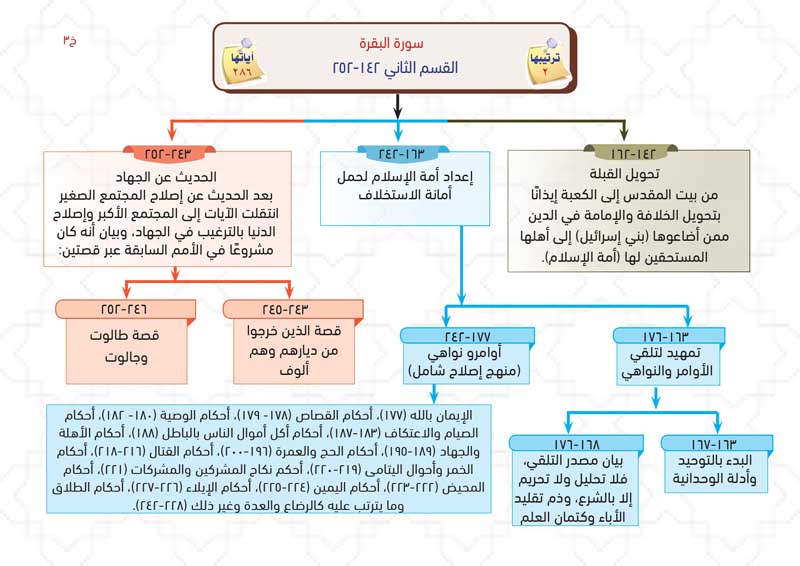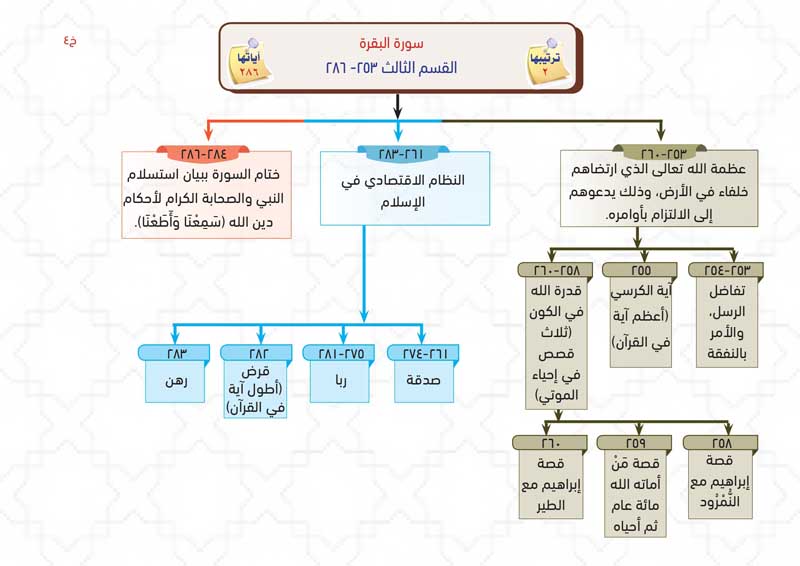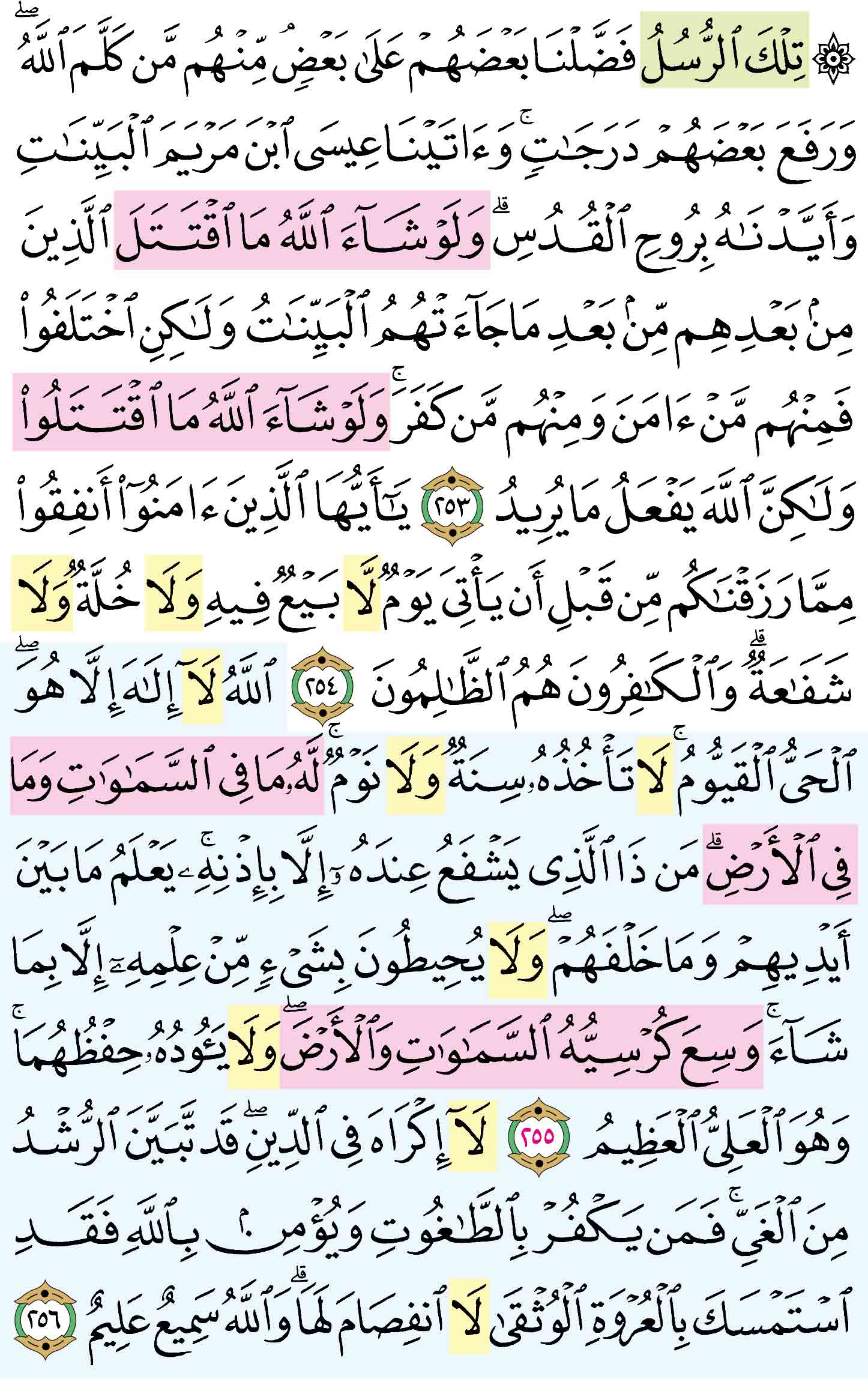
الإحصائيات
سورة البقرة
| ترتيب المصحف | 2 | ترتيب النزول | 87 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 48.00 |
| عدد الآيات | 286 | عدد الأجزاء | 2.40 |
| عدد الأحزاب | 4.80 | عدد الأرباع | 19.25 |
| ترتيب الطول | 1 | تبدأ في الجزء | 1 |
| تنتهي في الجزء | 3 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| حروف التهجي: 1/29 | آلم: 1/6 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (253) الى الآية رقم (254) عدد الآيات (2)
بعدَ ذكرِ الكثيرِ من الرسلِ وأنَّه ﷺ منهم بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّهم متفاضلونَ، خَصَّ بعضَهم بمناقبَ ليست لغيرِهم، ثُمَّ حَثَّ على النفقةِ والجهادِ بالمالِ بعدَ الحديثِ عن الجهادِ بالنفسِ.
فيديو المقطع
المقطع الثاني
من الآية رقم (255) الى الآية رقم (256) عدد الآيات (2)
لمَّا ذَكَرَ اللهُ الشفاعةَ، بَيَّنَ هنا أنَّه لن يشفع أحدٌ لأحدٍ إلا بإذنِه تعالى، (آيةُ الكرسي أعظمُ آيةٍ في القرآن)، وأنَّه لا إكراهَ على الدُّخولِ في الدِّينِ، ووجوب الكفرِ بالطَّاغوت والإيمانِ باللهِ، =
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة البقرة
استخلاف الإنسان في الأرض/ العبادة/ الإسلام لله تعالى
أولاً : التمهيد للسورة :
- • فلماذا سميت السورة بالبقرة؟: قد يتساءل البعض لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ قد يجيب البعض بأنها سميت كذلك لأنّ قصة البقرة جاءت في هذه السورة. فنقول: إنَّ هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة، فلماذا سميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ العناوين دلالة الاهتمام، فهذه إشارة إلى أهمية هذه القصة، أو أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة.
- • ليست مجرد قصة:: لم تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) مجرد قصة من قصص بني إسرائيل، ولكنها تجسيد لحال بني إسرائيل مع أوامر الله، تلكأ في تنفيذ أوامر الله، تعنت، وتشدد، وتحايل، ومماطلة، وجدال، وجحود، وعناد. وهذا في غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على الاستجابة ﻷوامر الله، فقد تضمنت الكثير من التشريعات والأحكام، فكأن الاسم شعار للمؤمنين ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة، لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولهذا خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (285).
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «سورة البقرة»، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين».
- • معنى الاسم :: البقرة: حيوان معروف، لحمه يؤكل ولبنه يشرب، والزهراوان: المُنيرتان المُضيئتان، واحدتها زهراء.
- • سبب التسمية :: سميت سورة البقرة؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها، ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة غيرها، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين»؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.
- • أسماء أخرى اجتهادية :: وتسمى أيضًا «سَنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه، فسميت بذلك تعظيمًا لشأنها، و«فُسطاط القرآن» والفسطاط هو المدينة الجامعة، لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها.
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: وجوب الاستجابة لأوامر لله، والاستسلام الكامل لأحكامه، والانقياد والإذعان لها.
- • علمتني السورة :: أن هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا أحكامه، ولاهدايته: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾
- • علمتني السورة :: تكريم الله للإنسان بسجود الملائكة له، وتعليمه أسماء جميع الأشياء، وإسكانه الجنة، واستخلافه في الأرض: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾
- • علمتني السورة :: أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود لم يعلموا من التوراة إلا التلاوة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».
• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». ففي حرَّ يوم القيامة الشديد، عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، تأتي سورة البقرة لتظلل على صاحبها.تأمل كيف أنّ سورتي البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما.
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».
• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:« يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ:" اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». زَادَ أَحْمَد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَينِ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ».
• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ».
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ»، فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ».
• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».
• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة البقرة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.
خامسًا : خصائص السورة :
- • هي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق
• أول سورة نزلت في المدينة.
• أول سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة من أصل 29 سورة افتتحت بذلك.
• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة ﴿الم﴾ من أصل 6 سور افتتحت بذلك.
• هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة.
• تحتوي على أعظم آية (آية الكرسي)، وأطول آية (آية الدين).
• تحتوي على آخر آية نزلت -على الراجح- وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (281).
• كثرة أحكامها، قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: «فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر».
• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نستقبل أوامر الله بـ "سمعنا وأطعنا"، وأن نحذر من: "سمعنا وعصينا".
• أن نرتبط بكتاب الله علمًا وتدبرًا وعملًا؛ لنصل إلى الهداية ونبتعد عن طريق الغواية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (2).
• أن نتحلى بصفات المتقين، ومنها: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله، الإيمان باليوم الِآخر: ﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...﴾ (2-5).
• أن نحذر من صفات المنافقين، ومنها: لا يعترفون بأخطائهم، يصرون على الذنوب، يمثلون أمام الناس أنهم مصلحون وهم المفسدون، يخادعون أنفسهم (8-20).
• أن نبتعد عن الكبر؛ فالكبر هو معصية إبليس: ﴿... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ...﴾ (34).
• أن نمتثل أوامر الله تعالى ونحذر من وساوس الشيطان: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...﴾ (35، 36).
• أن نحذر الذنوب، فبذنبٍ واحد خرج أبونا من الجنة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (36).
• أن نسارع بالتوبة كما فعل أبونا آدم عليه السلام (37).
• أن نتجنب الأخطاء التي وقعت من بني إسرائيل، ولا نفعل مثل ما فعلوا (40-123).
• أن نذكِّر الناس ونرشدهم إلى الخير؛ ولا ننسى أنفسنا من ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ (44). • أن نختار كلماتنا بعناية شديدة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (83).
• أن نسارع بالاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (131)، وأن نحذر عناد بني إسرائيل وجدالهم.
• أن نكثر من ذكر الله تعالى وشكره حتى نكون من الذاكرين: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (152).
• أن نقول: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (156).
• أن نكثر التأمل والتفكر في خلق الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (164).
• أن نأتي كل أمر من أمورنا من الطريق السهل القريب: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (189).
• أن نبادر في قضاء فريضة الحج، ونحرص على عدم الرفث والفسوق والجدال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...﴾ (197).
• أن نحذر من خطوات الشيطان ووساوسه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (208).
• أن نحسن الظن بالله وبما قدَّره لنا في حياتنا، حتى لو أننا كرهناه فهو بالتأكيد خير لنا، فكل أقداره عز وجل خير: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ...﴾ (216).
• أن نبتعد عن الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ...﴾ (219).
• أن نحافظ على الصلاة تحت أي ظرف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (238).
• ألا نَمُن على أحد أنفقنا عليه، ولا نؤذيه، ولا ننتظر الأجر إلا من الله: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ...﴾ (262).
• أن نحذر الربا، ونبتعد عنه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ...﴾ (275-279).
• أن نصبر على المعسر الذي لم يستطع القضاء، أو نسقط عنه الدين كله أو بعضه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (280).
• أن نقول لكل ما جاء به الرسول عن ربنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (285)، بلا جدال، ولا نقاش، ولا تكاسل.
تمرين حفظ الصفحة : 42
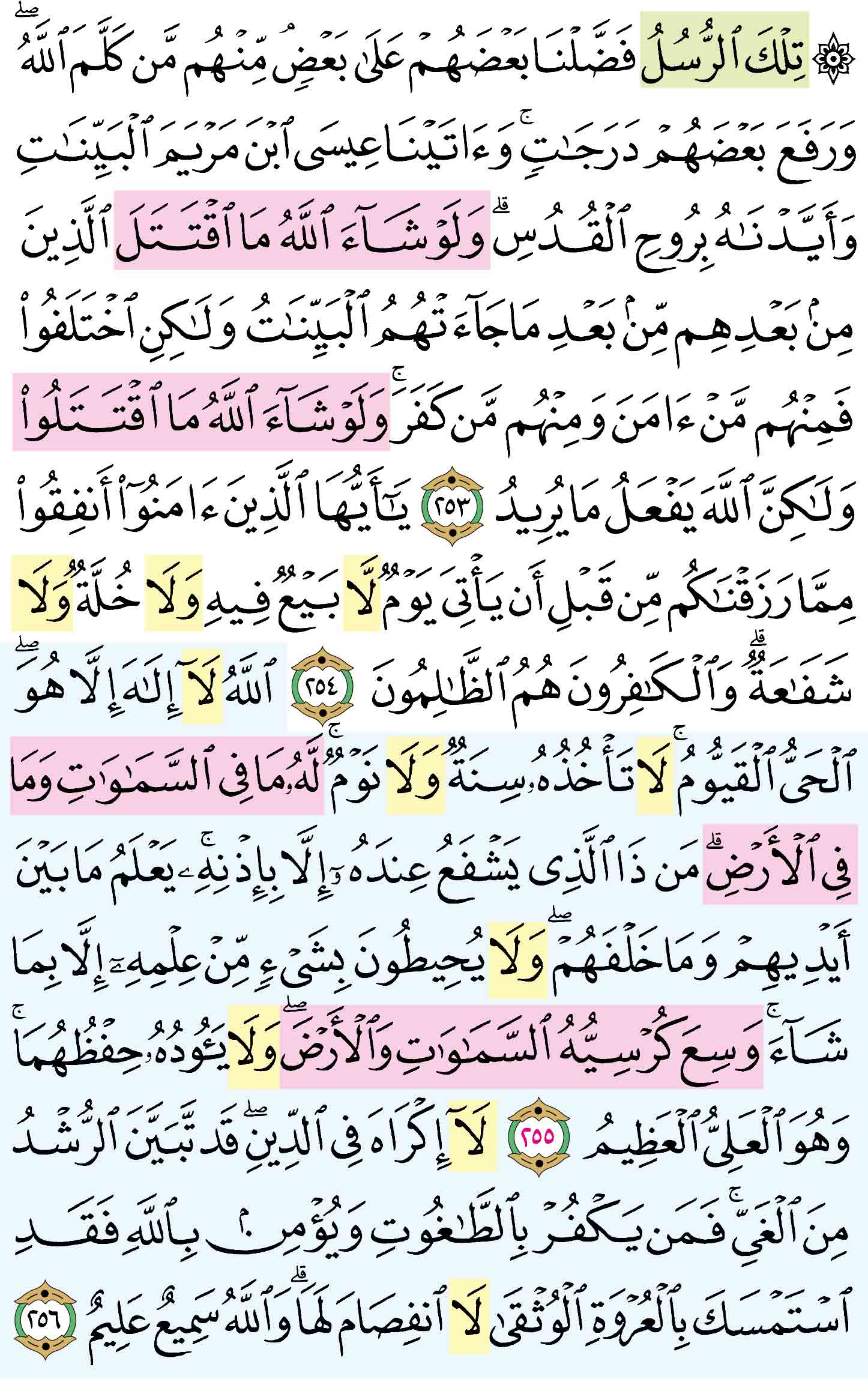
مدارسة الآية : [253] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى .. ﴾
التفسير :
يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس، ودعائهم الخلق إلى الله، ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام، فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين{ وآتينا عيسى ابن مريم البينات} الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه{ وأيدناه بروح القدس} أي:بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به، وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله{ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات} الموجبة للاجتماع على الإيمان{ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر} فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة، ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب، وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة، فإذا وجدت اضمحل كل سبب، وزال كل موجب، فلهذا قال{ ولكن الله يفعل ما يريد} فإرادته غالبة ومشيئته نافذة، وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته، ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستواء والنزول والأقوال، والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية. فائدة:كما يجب على المكلف معرفته بربه، فيجب عليه معرفته برسله، ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم، ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة، منها:أنهم رجال لا نساء، من أهل القرى لا من أهل البوادي، وأنهم مصطفون مختارون، جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار، وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية، وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف، وأن الله تعالى خصهم بوحيه، فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله، ودلائل هذه الجمل كثيرة، من تدبر القرآن تبين له الحق
الإشارة بتلك في قوله: تِلْكَ الرُّسُلُ إلى جماعة الرسل الذين تقدم ذكرهم في السورة والذين أرسلهم الله- تعالى- لهداية البشر، وأمرنا- سبحانه- بالإيمان بهم.
أى أولئك الرسل الذين أرسلناهم لهداية الناس فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ أى جعلنا لبعضهم مناقب وخصائص ومزايا لم تتوافر للبعض الآخر.
وتِلْكَ مبتدأ والرُّسُلُ عطف بيان لتلك. وجملة فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ هي الخبر. وكانت الإشارة باللفظ الدال على البعيد، لبيان سمو مكانة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وأنهم هم المصطفون الأخيار.
ثم بين- سبحانه- بعض مظاهر التفضيل فقال: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ أى منهم من فضله الله بتكليمه إياه كموسى- عليه السلام- فقد وردت آيات صريحه في ذلك، منها قوله- تعالى-: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً وقوله- تعالى-: قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي وقوله- تعالى- وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ.
ثم قال- سبحانه-: وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ أى: ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل مراتب سامية ومنازل عالية.
قيل كإبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، وإدريس الذي رفعه الله مكانا عليا، وداود الذي آتاه الله النبوة والملك.
والذي عليه المحققون من العلماء والمفسرين أن المقصود بقوله- تعالى- وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ هو سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم لأنه هو صاحب الدرجات الرفيعة والمعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة والرسالة العامة الناسخة لكل الرسالات قبلها.
وقد صرح صاحب الكشاف بذلك فقال: قوله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ أى ومنهم من رفعه الله على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم درجات كثيرة. الظاهر أنه أراد محمدا صلّى الله عليه وسلّم لأنه هو المفضل عليهم، حيث أوتى ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر. لو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتى الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى، لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم، يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال فيكون أفخم من التصريح، وسئل الخطيئة عن أشعر الناس، فذكر زهيرا والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث، أراد نفسه، ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره .
ثم قال- تعالى-: وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.
الْبَيِّناتِ: هي المعجزات الظاهرة البينة. وروح القدس: هو جبريل- عليه السلام- والروح هنا بمعنى الملك الخاص. القدس أصل معناه الطهارة، وهو يطلق على الطهارة المعنوية وعلى الخلوص والنزاهة. فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة. قيل القدس اسم الله كالقدوس فإضافة روح إضافة للتشريف أى روح من ملائكة الله.
والمعنى: وأعطينا عيسى بن مريم الآيات الباهرات، والمعجزات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وإخبار قومه بما يأكلونه ويدخرونه في بيتهم، وفضلا عن هذا فقد قويناه بجبريل- عليه السلام- لأن عيسى- عليه السلام- قد عاش حياته محاربا من أعدائه الرومان ومن قومه الذين أرسل إليهم وهم بنو إسرائيل ولم يؤذن له بالقتال ليدافع عن نفسه بل تولى الله- تعالى- الدفاع عنه بجنده الذين من بينهم جبريل- عليه السلام-.
قال الزمخشري: فإن قلت لم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة ولقد بين الله وجه التفضيل حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من الآيات. لما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر في باب التفضيل. هذا دليل بين على أن من زيد تفضيلا بالآيات منهم فقد فضل على غيره. ولما كان نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم هو الذي أوتى منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمها كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع» .
وقال الإمام القرطبي ما ملخصه: هذه الآية نثبت التفاضل بين الأنبياء وهناك أحاديث تقول: «لا تخيرونى على موسى» و «لا تخيروا بين الأنبياء» و «لا تفضلوا بين الأنبياء» أى لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان فكيف الجمع؟ فالجواب أن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل أو أن قوله هذا من باب الهضم والتواضع. أو المراد النهى عن الخوض في ذلك لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال والجدال قد يؤدى إلى أن يذكر بعضهم بما لا ينبغي أن يذكر به، وقد يؤدى إلى قلة احترامهم. ثم قال. وأحسن من هذا القول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة.
الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك فهم رسل، وأولو عزم، ومنهم من كلمه الله..
فالقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل، وأعطى من الوسائل. وبذلك نكون قد جمعنا بين الآية والأحاديث من غير النسخ.
ثم قال- تعالى-: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ.
أى: ولو شاء الله- تعالى- ألا يقتتل الذين جاءوا بعد كل رسول من الرسول وبعد أن جاءهم الرسل بالبينات الدالة على الحق، لو شاء الله ذلك لفعل، ولكن الله- تعالى- لم يشأ ذلك، لأنه خلق الناس مختلفين في تقبلهم للحق، فترتب على هذا الاختلاف أن آمن بالحق الذي جاءت به الرسل من فتح له قلبه، واتجه إليه اختياره، وأن كفر به من آثر الضلالة على الهداية واستحب العمى على الهدى، وترتب عليه- أيضا أن تقاتل الناس وتحاربوا.
ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب الشرط أى لو شاء الله ألا يقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل ما اقتتلوا.
وقدم- سبحانه- المسبب وهو الاقتتال على السبب وهو الاختلاف كما يشهد له قوله:
وَلكِنِ اخْتَلَفُوا.. للتنبيه على سوء مغبة الاختلاف، وللتحذير من الوقوع فيه، لأن وقوعهم فيه سيؤدي إلى أن يقتل بعضهم بعضا، وللإشارة إلى أنه- سبحانه- قادر على إزالة الاقتتال في ذاته حتى مع وجود أسبابه، لأنه- تعالى- هو الخالق للأسباب والمسببات.
وفي قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ إشارة إلى ما جبلت عليه بعض النفوس من العناد الذي يؤدى إلى التنازع والاختلاف والتقاتل حتى بعد ظهور الحق، وانكشاف وجه الصواب، لأن هذه النفوس قد آثرت الهوى على الرشاد، واتخذت طريق الغي طريقا لها.
وفي قوله: وَلكِنِ اخْتَلَفُوا إشارة إلى أنه- سبحانه- لم يشأ أن يزبل القتال الذي حدث بين المقاتلين، لأن هذا القتال قد نشأ بينهم بسبب اختلافهم، وسوء اختيارهم، وعدم استجابتهم للهدايات والتوجيهات والبينات التي جاءتهم بها الرسل- عليهم السلام-.
ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ أى:
لو شاء الله عدم اقتتالهم لأى سبب من الأسباب لما اقتتلوا، ولكنه- سبحانه- يفعل ما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، وترتضيه مشيئته، فهو الكبير المتعال الذي كل شيء عنده بمقدار فالآية الكريمة تبين أن الرسل- عليهم السلام- يتفاضلون فيما بينهم، وتنهى الناس في كل زمان ومكان عن الاختلاف والتنازع لأنهما يؤديان إلى أوخم العواقب، وأسوأ النتائج.
ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه ببذل أموالهم في سبيل الدفاع عن الحق، حتى يكونوا أهلا لرضا الله ومثوبته.
يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ) [ الإسراء : 55 ] وقال هاهنا : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ) يعني : موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم ، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ( ورفع بعضهم درجات ) كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل .
فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ! فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تفضلوني على الأنبياء ؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء " وفي رواية : " لا تفضلوا بين الأنبياء " .
فالجواب من وجوه :
أحدها : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل ، وفي هذا نظر .
الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع .
الثالث : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر .
الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية .
الخامس : ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل ، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به .
وقوله : ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) أي : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به ، من أنه عبد الله ورسوله إليهم ( وأيدناه بروح القدس ) يعني : أن الله أيده بجبريل عليه السلام ثم قال تعالى : ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ) أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره ; ولهذا قال : ( ولكن الله يفعل ما يريد )
القول في تأويل قوله تعالى : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " تلك "، الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة، كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشمويل وداود، وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم = والذي كلمته منهم موسى صلى الله عليه وسلم = ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنـزلة، كما:-
5755 - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تعالى ذكره: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "، قال: يقول: منهم من كلم الله، ورفع بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسى، وأرسل محمدا إلى الناس كافة.
5756 - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.
* * *
&; 5-379 &;
ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك:=
5757 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب، فإن العدو ليرعب مني على مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وقيل لي: سل تعطه، فاختبأتها شفاعة لأمتي، فهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا " (1) .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
قال أبو جعفر :يعني تعالى ذكره بقوله: (2) " وآتينا عيسى ابن مريم البينات "، وآتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته: (3) من إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذي أنـزلته إليه، فبينت فيه ما فرضت عليه.
* * *
ويعني تعالى ذكره بقوله: " وأيدناه "، وقويناه وأعناه= (4) " بروح القدس "، يعني بروح الله، وهو جبريل. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في معنى روح القدس والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك فيما مضى قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع (5) .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله=" ما اقتتل الذين من بعدهم "، (6) يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه.
* * *
ويعني بقوله: " من بعد ما جاءتهم البينات "، يعني: من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق، وأوضح لهم السبيل.
* * *
وقد قيل: إن " الهاء " و " الميم " في قوله: " من بعدهم "، من ذكر موسى وعيسى. * ذكر من قال ذلك:
5758 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: " ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات "، يقول: من بعد موسى وعيسى.
&; 5-381 &;
5759 - حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: " ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات " يقول: من بعد موسى وعيسى.
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253)
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل، لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلوا، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف، وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحي كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك بعضهم. فأخبر تعالى ذكره: أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي، (7) بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ، تعمدا منهم للكفر بالله وآياته.
ثم قال تعالى ذكره لعباده: " ولو شاء الله ما اقتتلوا "، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم - بعصمته وتوفيقه إياهم- عن معصيته فلا يقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا=" ولكن الله يفعل ما يريد "، بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه.
----------------
الهوامش :
(1) الأثر : 5757 -ساقه بغير إسناد ، وقد اختلف ألفاظه ، وهو من حديث ابن عباس في المسند رقم : 2742 ، والمسند 5 : 145 ، 147 ، 148 ، 161 ، 162 (حلبي) والمستدرك 2 : 424 ورواه مسلم بغير اللفظ 5 : 3 ، والبخاري ، (الفتح 1 : 369 ، 444) مواضع أخرى . وهو حديث صحيح .
(2) في المطبوعة والمخطوطة : "يعنى تعالى ذكره بذلك" ، وهو لا يستقيم .
(3) انظر تفسير"البينات"فيما سلف 2 : 328/ 4 : 271 ، والمراجع هناك ، وانظر فهرس اللغة .
(4) انظر تفسير"أيد"فيما سلف 2 : 319 ، 320 .
(5) انظر ما سلف 2 : 320- 323 .
(6) في المطبوعة ، أتم الآية : "من بعد ما جاءتهم البينات" ، وأثبت ما في المخطوطة .
(7) في المخطوطة : "أتوا ما أنزل من الكفر" ، وهو سهو فاحش من شدة عجلة الكاتب ، كما تتبين ذلك جليا من تغيُّر خطه في هذا الموضع أيضًا .
التدبر :
وقفة
[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ بداية الجزء الثالث منسجمة مع خاتمة الجزء الثاني، ففي نهاية الجزء الثاني قال: ﴿... وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [252]، وفي أول الثالث قال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ ...﴾.
وقفة
[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين.
وقفة
[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فاضل الله بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى.
لمسة
[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ إنما قال: (تلك)، ولم يقل: (أولئك الرسل)؛ لأنه ذهب إلى الجماعة، كأنه قيل: تلك الجماعة الرسل.
وقفة
[253] ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ [285] الأنبياء متساوون في مقام النبوة، أما قوله: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فهي تعني الكرامات والمعجزات والاصطفاء.
وقفة
[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ معلوم أن المرسلين يتفاضلون؛ تارة في الكتب المنزلة عليهم، وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم، وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل، وتارة في أممهم.
وقفة
[253] ﴿مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ﴾ إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه قد كلَّم بعض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
وقفة
[253] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ﴾ من أسباب الاقتتال: الاختلاف الذي منبعه الهوى أو الجهل.
وقفة
[253] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم﴾،كرَّره بقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ تأكيدًا وتكذيبًا لمن زعم أنَّ ذلك لم يكن بمشيئة الله.
وقفة
[253] ﴿فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة، ولو شاء لهدى الخلق جميعًا.
وقفة
[253] أسلى عزاء في اﻷقدار المؤلمة: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ﴾، ﴿وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾.
وقفة
[253] جراحات المسلمين وقتلهم وقتالهم كله بقدر ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾؛ فثق بحكيم عليم قدرها، وهو قادر على إحسان عاقبتها.
الإعراب :
- ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ: ﴾
- تي: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد. والكاف: للخطاب. الرسل: صفة والمقصود جماعة الرسل أو بدل من اسم الاشارة مرفوع مثله وعلامة رفعه: الضمة. فضلنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع. و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «فَضَّلْنا» في محل رفع خبر للمبتدأ «تِلْكَ». بعض: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جّر بالاضافة
- ﴿ عَلى بَعْضٍ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بفضلنا و «بَعْضٍ» تلازم الإضافة معنى وان جاءت بحسب اللفظ غير مضافة.
- ﴿ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ: ﴾
- حرف جر أو تبعيضية أي بعضهم و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر أي الذي. كلّم: فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. وجملة «كَلَّمَ اللَّهُ» صلة الموصول والعائد ضمير منصوب محلا لأنه مفعول به. التقدير: كلمه.
- ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ: ﴾
- الواو: عاطفة. رفع: فعل ماض مبني على الفتح معطوف على «كَلَّمَ» وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. بعضهم: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. درجات: تمييز منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.
- ﴿ وَآتَيْنا عِيسَى: ﴾
- الواو: استئنافية. آتينا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عيسى: مفعول به أول منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر
- ﴿ ابْنَ مَرْيَمَ: ﴾
- بدل من «عِيسَى» منصوب مثله بالفتحة ويجوز إعرابه: صفة لعيسى. مريم: مضاف اليه مجرور بالفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف.
- ﴿ الْبَيِّناتِ: ﴾
- مفعول به ثان منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. • وَأَيَّدْناهُ: الواو: عاطفة. أيّدناه: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
- ﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأيّد. القدس: مضاف اليه مجرور بالكسرة. ولو: الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم.
- ﴿ شاءَ اللَّهُ: ﴾
- فعل ماض مبني على الفتح. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. والمفعول محذوف اختصارا بمعنى: لو شاء الله هداية الناس.
- ﴿ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ: ﴾
- ما: نافية لا عمل لها. اقتتل: فعل ماض مبني على الفتح. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل وجملة «مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ» جواب شرط غير جازم لا محل لها بمعنى لما اقتتل.
- ﴿ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره جاءوا من بعدهم. وجملة: «جاؤا من بعدهم» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب و «هم» ضمير الغائبين يعود على الرسل في محل جر بالاضافة. من بعد: جار ومجرور متعلق باقتتل.
- ﴿ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ: ﴾
- ما: مصدرية. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والتاء: تاء التأنيث الساكنة و «هم». ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم على الفاعل. البينات: فاعل مرفوع بالضمة وجملة «جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ» صلة «مَا» المصدرية لا محل لها. و «مَا المصدرية وما بعدها» بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة.
- ﴿ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا: ﴾
- : الواو: زائدة. لكن: حرف استدراك لا عمل له لأنه مخفف. اختلفوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف: فارقة وقد كسّرت نون «لكِنِ» لالتقاء الساكنين
- ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ: ﴾
- الفاء: استئنافية. منهم: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. آمن: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستترفيه جوازا تقديره: هو. وجملة «آمَنَ» صلة الموصول.
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ: ﴾
- الواو: عاطفة. منهم من كفر: معطوفة على جملة «منهم من آمن» وتعرب إعرابها
- ﴿ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا: ﴾
- جملة مكررة للتأكيد. سبق اعرابها والواو في «اقْتَتَلُوا» ضمير متصل في محل رفع فاعل.
- ﴿ وَلكِنَّ اللَّهَ: ﴾
- الواو: استئنافية. لكنّ: حرف مشبّه بالفعل يفيد الاستدراك. الله لفظ الجلالة: اسم «لكِنِ» منصوب بالفتحة.
- ﴿ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ: ﴾
- يفعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. والجملة الفعلية «يَفْعَلُ» في محل رفع خبر «لكِنِ». ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يريد: تعرب إعراب «يَفْعَلُ». وجملة «يُرِيدُ» صلة الموصول لا محل لها والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير ما يريده. '
المتشابهات :
| البقرة: 253 | ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ |
|---|
| الأنعام: 165 | ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمُۢ﴾ |
|---|
| الزخرف: 32 | ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من "تاريخ دمشق" بسند فيه راوٍ ضعيف جدا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: "أتحب عليًّا؟ " قال: نعم، قال: "إنه سيكون بينكما قتال"، قال، فما بعده؟ قال: "عفو الله"، قال: رضيت بقضاء الله، قال: فنزلت {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد} انتهى، وفيه نكارة من أن سياق الآيات ظاهر أن الضمير لمن في قوله قبلها {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا} والمراد بهم ما صرح به في الآية المذكورة {فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ} .'
- المصدر المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [253] لما قبلها : وبعدَ ذكرِ الكثيرِ من الرسلِ، وأنَّه صلى الله عليه وسلم منهم؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا أنَّهم متفاضلونَ، خَصَّ بعضَهم بمناقبَ ليست لغيرِهم، قال تعالى:
﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾
القراءات :
كلم الله:
قرئ:
1- بالتشديد، ورفع اسم الجلالة، والعائد على «من» محذوف، تقديره: من كلمه، وهى قراءة الجمهور.
2- بالتشديد، ونصب اسم الجلالة، والفاعل مستتر فى «كلم» يعود على «من» .
3- كالم الله، بالألف، ونصب اسم الجلالة، وهى قراءة أبى المتوكل، وأبى نهشل، وابن السميفع.
مدارسة الآية : [254] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ .. ﴾
التفسير :
وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله، من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه، فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام، وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى:{ والكافرون هم الظالمون} وهذا من باب الحصر، أي:الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى:{ إن الشرك لظلم عظيم}
الخلة: الصداقة والمودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين، وسميت بذلك لأنها تتخلل النفس أى تتوسطها، أو لشدة الحاجة إليها. ومنه سمى الخليل خليلا لاحتياج الإنسان إليه.
والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم، وتطلق على انضمام شخص إلى آخر لنفعه أو نصرته، وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى ما هو دونه.
والمعنى: عليكم أيها المؤمنون أن تنفقوا في وجوه الخير كإعانة المجاهدين ومساعدة الفقراء والبائسين من أموالكم التي رزقكم الله إياها بفضله وكرمه، ومن قبل أن يأتى يوم القيامة الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى تقدموا عن طريقها ما تفتدون به أنفسكم، ولا يكون فيه صديق يدفع عنكم، ولا شفيع يشفع لكم فيحط من سيئاتكم إلا أن يأذن رب العالمين بالشفاعة تفضلا منه وكرما.
فالآية الكريمة تحض المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، لأنه أهم عناصر القوة في الأمة، وأفضل وسيلة لإقامة المجتمع الصالح المتكافل.
والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل الفرض والنفل، والأمر لمطلق الطلب، إلا أن هذا الطلب قد يصل إلى درجة الوجوب إذا نزلت بالأمة شدة لم تكف الزكاة عن دفعها.
وقوله: مِمَّا رَزَقْناكُمْ إشعار بأن هذا المال الذي بين أيدى الأغنياء ما هو إلا رزق رزقهم الله إياه، ونعمة أنعم بها عليهم، فمن الواجب عليهم شكرها بألا يبخلوا بجزء منه على الإنفاق في وجوه الخير، لأن هذا البخل سيعود عليهم بما يضرهم.
وفي قوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ.. إلخ حث آخر على التعجيل بالإنفاق، لأنه تذكير للناس بهذا الوقت الذي تنتهي فيه الأعمال، ولا يمكن فيه استدراك ما فاتهم، ولا تعويض ما فقدوه من طاعات. فكأنه- سبحانه- يقول لهم: نجوا أنفسكم بالمسارعة إلى الإنفاق من قبل أن يأتى يوم لا منجاة فيه إلا بالعمل الصالح الذي قدمتموه.
ومن في قوله مِمَّا رَزَقْناكُمْ للتبعيض. وفي قوله مِنْ قَبْلِ لابتداء الغاية: ومفعول أنفقوا محذوف والتقدير أنفقوا شيئا مما رزقناكم.
والشفاعة المنفية هنا هي التي لا يقبلها الله- تعالى- وهي التي لا يأذن بها، أما شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلّم فقد أذن الله له بها وقبلها منه، وقد وردت أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي في أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ستكون له شفاعة في دفع العذاب عن أقوام من المؤمنين وتخفيفه عن أهل الكبائر من المسلمين، ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:
أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ أى والكافرون الجاحدون لنعمه هم الظالمون لأنفسهم، لأنهم حالوا بينها وبين الهداية بإيثارهم العاجلة على الآجلة، والغي على الرشد، والشر على الخير، والبخل على السخاء.
أما المؤمنون فليسوا كذلك لأنهم سلكوا الطريق المستقيم، وبذلوا الكثير من أموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي إعانة المحتاجين.
وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد حضت المؤمنين على المسارعة في إنفاق أموالهم في وجوه الخير من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه ما كان نافعا في الدنيا من أقوال وأعمال وأنها قد توعدت من يبخل عن الإنفاق في سبيل الله بسوء العاقبة، لأنه تشبه بالكافرين في بخلهم وإمساكهم عن بذل أموالهم في وجوه الخير.
وبعد أن أمر الله المؤمنين بالإنفاق في وجوه الخير، وذكرهم بأهوال يوم القيامة، أتبع ذلك بآية كريمة اشتملت على تمجيده- سبحانه- فبينت كمال سلطانه، وشمول علمه. وسابغ نعمه على خلقه. استمع إلى القرآن الكريم وهو يصف لك الخالق- عز وجل- بأكمل الصفات وأعظمها فيقول:
يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا ( من قبل أن يأتي يوم ) يعني : يوم القيامة ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) أي : لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ، ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد ، يعني : صداقته بل ولا نسابته كما قال : ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) [ المؤمنون : 101 ] ( ولا شفاعة ) أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين .
وقوله : ( والكافرون هم الظالمون ) مبتدأ محصور في خبره أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا . وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : ( والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل : والظالمون هم الكافرون .
القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم، وتصدقوا منها، وآتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم. وكذلك كان ابن جريج يقول فيما بلغنا عنه:
5760 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم "، قال: من الزكاة والتطوع.
* * *
=" من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة "، يقول: ادخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم، بالنفقة منها في سبيل الله، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة، وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها، وابتاعوا بها ما عنده مما أعده لأوليائه من الكرامة، بتقديم ذلك لأنفسكم، ما دام لكم السبيل إلى ابتياعه، بما ندبتكم إليه، وأمرتكم به من النفقة من أموالكم=" من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه "، يعني من قبل مجيء يوم لا بيع فيه، يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه- بالنفقة من أموالكم التي رزقتكموها- بما أمرتكم به، أو ندبتكم إليه في الدنيا قادرين، (8) لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب، لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية، فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذ- أو &; 5-383 &; بالعمل بطاعة الله، سبيل (9) .
ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم = مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال، (10) إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك به = يوم لا مخالة فيه نافعة كما كانت في الدنيا، فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على من حاوله بمكروه وأراده بسوء، والمظاهرة له على ذلك. فآيسهم تعالى ذكره أيضا من ذلك، لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحدا من الله، بل الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ كما قال الله تعالى ذكره، (11) وأخبرهم أيضا أنهم يومئذ= مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالهم، والعمل بأبدانهم، وعدمهم النصراء من الخلان، والظهراء من الإخوان (12) = لا شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنيا، فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة، وغير ذلك من الأسباب، فبطل ذلك كله يومئذ، كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها: ( فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ [الشعراء: 100-101]
* * *
وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص، وإنما معناه: " من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة "، لأهل الكفر بالله، لأن أهل &; 5-384 &; ولاية الله والإيمان به، يشفع بعضهم لبعض. وقد بينا صحة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع (13) .
* * *
وكان قتادة يقول في ذلك بما:-
5761 - حدثنا به بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة "، قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا، ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين.
* * *
وأما قوله: " والكافرون هم الظالمون "، فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: والجاحدون لله المكذبون به وبرسله=" هم الظالمون "، يقول: هم الواضعون جحودهم في غير موضعه، والفاعلون غير ما لهم فعله، والقائلون ما ليس لهم قوله.
* * *
وقد دللنا على معنى " الظلم " بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته (14) .
* * *
قال أبو جعفر: وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع: " والكافرون هم الظالمون "، دلالة واضحة على صحة ما قلناه، وأن قوله: " ولا خلة ولا شفاعة "، إنما هو مراد به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك: " والكافرون هم الظالمون " . فدل بذلك على أن معنى ذلك: حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء، والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم.
* * *
&; 5-385 &;
فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيد إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان؟
قيل له: إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر، والآخر أهل إيمان، وذلك قوله: وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ . ثم عقب الله تعالى ذكره الصنفين بما ذكرهم به، بحض أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته (15) وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به، قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته. وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به، إذ كان قتال أهل الكفر به في معصيته ونفقتهم في الصد عن سبيله، فقال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي، إذ كان أهل الكفر بي ينفقون في معصيتي= من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فيدرك أهل الكفر فيه ابتياع ما فرطوا في ابتياعه في دنياهم= ولا خلة لهم يومئذ تنصرهم مني، ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي. وهذا يومئذ فعلي بهم جزاء لهم على كفرهم، (16) وهم الظالمون أنفسهم دوني، لأني غير ظلام لعبيدي. وقد:-
5762 - حدثني محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثني عمرو بن أبي سلمة، قال: سمعت عمر بن سليمان، يحدث عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: " والكافرون هم الظالمون "، ولم يقل: " الظالمون هم الكافرون ".
---------------
الهوامش :
(8) في المطبوعة والمخطوطة : "بالنفقة من أموالكم التي أمرتكم به" ، وهو كلام مختل ، سقط فيما أرجح ما أثبته : "رزقتكموها ، بما" . وسياق العبارة : ما كنتم على ابتياعه...بما أمرتكم به... قادرين" . والذي بينهما فواصل .
(9) في المطبوعة و المخطوطة : "فيكون لهم إلى ابتياع..." والصواب في هذا السياق : "لكم وقوله : "سبيل" اسم كان في"فيكون لكم إلى ابتياع..." .
(10) ارتفاع العمل : انقضاؤه وذهابه . يقال : "ارتفع الخصام بينهما" ، و"ارتفع الخلاف" أي انقضى وذهب ، فلم يبق ما يختلفان عليه أو يختصمان . وهو مجاز من"ارتفع الشيء ارتفاعا" : إذا علا . وهذا معنى لم تقيده المعاجم ، وهو عربى صحيح كثير الورود في كتب العلماء ، ن وقد سلف في كلام أبي جعفر ، وشرحته ولا أعرف موضعه الساعة .
(11) هى آية"سورة الزخرف" : 67 .
(12) النصراء جمع نصير . والخلان جمع خليل : والظهراء جمع ظهير : وهو المعين الذي يقوى ظهرك ويشد أزرك .
(13) انظر ما سلف 2 : 23 ، 33 .
(14) انظر معنى"الكفر" فيما سلف من فهارس اللغة / ومعنى"الظلم" فيما سلف 1 : 523 ، 524 ، وفي فهارس اللغة .
(15) في المطبوعة : "يحض" بالياء في أوله ، فعلا . وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قراءتها بباء الجر ، اسما . وقوله : "بحض" ، متعلق بقوله : "ثم عقب الله" .
(16) في المخطوطة والمطبوعة : "وهذا يومئذ فعل بهم" ، وصواب السياق يقتضى ما أثبت .
التدبر :
وقفة
[254] يناديك الرب الكريم ويتودد بلطف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم﴾ أنفق من مالك، أنفق من علمك، أنفق من خبرتك، أنفق من جاهك، انفق من وقتك؛ كل ما رزقك الله أنفق منه ما دمنا في الحياة الدنيا.
وقفة
[254] لا ينفع العبد يوم القيامة إلا عمله الصالح، ومن أعظمه الصدقة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾.
وقفة
[254] ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم﴾ نعم، هو مال الله الذي أستخلفك فيه على هذه الأرض والفضل فيه له، فابتغِ به وجهه.
وقفة
[254] ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ﴾ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه، قبل الحساب الأكبر.
عمل
[254] لتكن لك هذا اليوم صدقة -ولو قليلة- تحاج لك عند الله في يوم ﴿لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾.
وقفة
[254] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قال عطاء بن دينار: «الحمد لله الذي قال: (والكافرون هم الظالمون)، ولم يقل: (والظالمون هم الكافرون)».
لمسة
[254] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قصر ربنا تعالى صفة الظلم على الكافر، فالكفر والظلم متلازمان، ألم تر كيف فصل بين المبتدأ والخبر بالضمير (هم) مع أن حذف هذا الضمير لا يخل بالمعنى، لكن ذكر الضمير (هم) أفاد حصر الظلم على الكافرين، أي الكافرون هم الظالمون حصرًا، وهذا من باب المبالغة يسموه القصر الادعائي، قصر المبالغة، تدّعي القصر في هذا لأنه مبالغة في هذا الأمر، يعني الكافرون هم أولى بهذه التسمية من غيرهم.
وقفة
[254] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ حصر الظلم في الكافرين؛ لأن ظلمهم أشدُّ، فهو حصر إضافيٌّ كما في قوله تعالى: ﴿إنَّما يخشَى اللَّهَ من عبادِهِ العلماءُ﴾ [فاطر: 28].
وقفة
[254] أكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين؛ إنما أريد به المشركون كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾
- يا: أداة نداء أيّ منادى مبني على الضم في محل نصب: و «ها» زائدة للتنبيه. الذين: اسم موصول مبني على الفتح عطف بيان لأيّ. آمنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة وجملة «آمَنُوا» صلة الموصول.
- ﴿ أَنْفِقُوا: ﴾
- فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
- ﴿ مِمَّا رَزَقْناكُمْ: ﴾
- مكونة من «من» حرف جّر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جّر بمن والجار والمجرور متعلق بأنفقوا. رزقناكم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم: علامة الجمع وجملة «رَزَقْناكُمْ» صلة الموصول.
- ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بأنفقوا والمجرور مضاف. أن: حرف مصدري ونصب. يأتي: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة و «أَنْ المصدرية وما بعدها» بتأويل مصدر في محل جر مضاف اليه.
- ﴿ يَوْمٌ: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة وجملة «يَأْتِيَ يَوْمٌ» صلة «أَنْ» المصدرية لا محل لها.
- ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ: ﴾
- لا: نافية تعمل عمل «ليس». بيع: اسم «لا» مرفوع بالضمة فيه: جار ومجرور متعلق بخبر «لا» المحذوف وجملة «لا بَيْعٌ فِيهِ وما بعدها» في محل رفع صفة ليوم.
- ﴿ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ: ﴾
- : الواو: عاطفة لاخلّة ولا شفاعة معطوفان على «لا بَيْعٌ فِيهِ» وأخبار هذه الاسماء في محل نصب بأداة النفي «لا» والأخبار مقدرة أي: لا بيع فيه تبتاعون فيه ولا خلّة يسامحونكم ولا شفاعة يشفعون لكم.
- ﴿ وَالْكافِرُونَ: ﴾
- الواو: استئنافية. الكافرون: مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون: عوض عن تنوين المفرد.
- ﴿ هُمُ الظَّالِمُونَ: ﴾
- هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان. الظالمون: خبر «هُمُ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون: عوض عن تنوين المفرد والجملة الاسمية «هُمُ الظَّالِمُونَ» في محل رفع خبر للكافرون. '
المتشابهات :
| البقرة: 254 | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ |
|---|
| ابراهيم: 31 | ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ |
|---|
| الشورى: 47 | ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّـهِ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [254] لما قبلها : وبعدَ الحديثِ عن الجهادِ بالنفسِ؛ حَثَّ اللهُ عز وجل هنا على النفقةِ والجهادِ بالمالِ، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾
القراءات :
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة:
قرئ:
1- بفتح الثلاثة من غير تنوين، وهى قراءة ابن كثير، ويعقوب، وأبى عمرو.
2- بالرفع والتنوين، وهى قراءة الباقين.
مدارسة الآية : [255] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ .. ﴾
التفسير :
هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات، فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن{ لا إله إلا هو} أي:لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة، وقوله:{ الحي القيوم} هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم:هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، ولهذا قال بعض المحققين:إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته أن{ لا تأخذه سنة ولا نوم} والسنة النعاس{ له ما في السماوات وما في الأرض} أي:هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال:{ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} أي:لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن، ثم قال{ يعلم ما بين أيديهم} أي:ما مضى من جميع الأمور{ وما خلفهم} أي:ما يستقبل منها، فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ولهذا قال:{ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض} وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال:{ ولا يؤوده} أي:يثقله{ حفظهما وهو العلي} بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته{ العظيم} الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا، ثم قال تعالى:
قال بعضهم: هذه آية الكرسي أفضل آية في القرآن. ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتها أكثر منه على غيرها من الآيات. هذا هو التحقيق في تفضيل بعض آيات القرآن على بعض.
وإنما كانت أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى. جاء في الحديث الشريف عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة القرآن- أى أفضله- وهي آية الكرسي» .
وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر جمل فيها ما فيها من صفات الله الجليلة- ونعوته السامية. أما الجملة الأولى والثانية فتتمثل في قوله- تعالى-: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.
ولفظ الجلالة اللَّهُ يقول العلماء: إن أصله إله دخلت عليه أداة التعريف «أل» وحذفت الهمزة فصارت الكلمة الله.
قال القرطبي: قوله: اللَّهُ هذا الاسم أكبر أسمائه- تعالى- وأجمعها، حتى قال بعضهم إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره، ولذلك لم يثن ولم يجمع، فالله اسم الموجود الحق الجامع لصفات الألوهية، المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو- سبحانه-».
ولفظ إِلهَ قالوا إنه من أله فلان يأله أى عبد. فالإله على هذا المعنى هو المعبود، وقيل هو من أله أى تحير.. وذلك أن العبد إذا تفكر في صفاته- سبحانه- تحير فيها ولذا قيل:
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» .
والْحَيُّ أى الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء لها. لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعتريه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء سواه يعتريهم الموت والفناء.
والْقَيُّومُ أى: الدائم القيام بتدبير أمر الخلق وحفظهم، والمعطى لهم ما به قوامهم. وهو مبالغة في القيام. وأصله قيووم- بوزن فيعول- من قام بالأمر إذا حفظه ودبره.
والمعنى: الله- عز وجل- هو الإله الحق المتفرد بالألوهية التي لا يشاركه فيها سواه، وهو المعبود بحق وكل معبود سواه فهو باطل، وهو ذو الحياة الكاملة، وهو الدائم القيام بتدبير شئون الخلق وحياتهم ورعايتهم وإحيائهم وإماتتهم.
والجملة الثالثة قوله- تعالى-: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ وهي جملة سلبية مؤكدة للوصف الإيجابى السابق، فإن قيامه على كل نفس بما كسبت، وعلى تدبير شئون خلقه يقتضى ألا تعرض له غفلة، ولأن السنة والنوم من صفات الحوادث وهو- سبحانه- مخالف لها.
والسنة: الفتور الذي يكون في أول النوم مع بقاء الشعور والإدراك. ويقال له غفوة.
يقال: وسن الرجل يوسن وسنا وسنة فهو وسن ووسنان إذا نعس والمراد أنه- سبحانه- لا يغفل عن تدبير أمر خلقه أبدا، ولا يحجب علمه شيء حجبا قصيرا أو طويلا، ولا يدركه ما يدرك الأجسام من الفتور أو النعاس، أو النوم.
وتقديم السنة على النوم يفيد المبالغة من حيث إن نفى السنة يدل على نفى النوم بالأولى، فنفيه ثانيا صريحا يفيد المبالغة لأن عطف الخاص على العام يفيد المبالغة ولأن عطف الخاص على العام يفيد التوكيد أى لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم.
وفي قوله: لا تَأْخُذُهُ دلالة على أن للنوم قوة قاهرة تأخذ الحيوان أخذا وتقهر الكثير من أجناس المخلوقات قهرا، ولكنه- سبحانه- وهو القاهر فوق عباده- منزه عن ذلك، ومبرأ من أن يعتريه ما يعترى الحوادث.
وقوله- سبحانه- في الجملة الرابعة: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ تقرير لانفراده بالألوهية إذ جميع الموجودات مخلوقاته، وتعليل لا تصافه بالقيومية، لأن من كانت جميع الموجودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قائما بتدبير أمرها.
والمراد بما فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن الأمور الخارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرهم. فالجملة الكريمة تفيد الملكية المطلقة لرب العالمين لكل ما في هذا الوجود من شمس وقمر وحيوان ونبات وجماد وغير ذلك من المخلوقات. وصدرت الجملة بالجار والمجرور «له» لإفادة القصر أى ملك السموات والأرض له وحده ليس لأحد سواه شيء معه.
والاستفهام في قوله في الجملة الخامسة مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ للنفي والإنكار أى: لا أحد يستطيع أن يشفع عنده- سبحانه- إلا بإذنه ورضاه قال- تعالى- وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى.
والمقصود من هذه الجملة- كما يقول الآلوسى- بيان كبرياء شأنه- تعالى- وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقل أن يدفع ما يريده دفعا على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلا عن أن يستقل بدفعه عنادا أو مناصبة وعداوة. وفي ذلك تيئيس للكفار حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند الله».
وقوله- سبحانه- في الجملة السادسة: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ تأكيد لكمال سلطانه في هذا الوجود، وبيان لشمول علمه على كل شيء.
والضمير في (يديهم) و (خلفهم) يعود إلى (ما) في قوله قبل ذلك لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وعبر بضمير الذكور العقلاء، تغليبا لجانبهم على جانب غير العقلاء.
والعلم بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن إحاطة علمه- سبحانه- بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وما يعرفونه من شئونهم الدنيوية وما لا يعرفونه.
وقوله- تعالى- في الجملة السابغة: وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ معطوف على قوله يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ لأنه مكمل لمعناه. والمراد بالعلم المعلوم.
والإحاطة بالشيء معناها العلم الكامل به.
أى: لا يعلمون شيئا من معلوماته- سبحانه- إلا بالقدر الذي أراد أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله. فهو كقوله- تعالى-: عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ.
فالجملة الكريمة بيان لكمال علم الله- تعالى-، ولنقصان علم سواه، إذ أن البشر لم يعطوا من العلم إلا القليل، وهذا القليل ناقص لأنه ليس على إحاطة واستغراق لكل ما تشتمل عليه جزئيات الشيء ووجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده، إذ العلم الكامل بالشيء لا يكون إلا لله رب العالمين.
ثم قال- تعالى- في الجملة الثامنة: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ.
قال الراغب: الكرسي في تعارف العامة: اسم للشيء الذي يقعد عليه، وهو في الأصل منسوب إلى الكرس أى الشيء المجتمع، ومنه الكراسة لأنها تجمع العلم.. وكل مجتمع من الشيء كرس» .
وللعلماء اتجاهان مشهوران في تفسير معنى الكرسي في الجملة الكريمة. فالسلف يقولون: إن لله- تعالى- كرسيا علينا أن نؤمن بوجوده وإن كنا لا نعرف حقيقته، لأن ذلك ليس في مقدور البشر.
والخلف يقولون: الكرسي في الآية كناية عن عظم السلطان، ونفوذ القدرة، وسعة العلم، وكمال الإحاطة.
ولصاحب الكشاف تلخيص حسن لأقوال العلماء في ذلك، فقد قال- رحمه الله- وفي قوله: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ أربعة أوجه:
أحدها: أن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته وما هو إلا تصوير لعظمته ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد.
والثاني: وسع علمه، وسمى العلم كرسيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم.
والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك.
والرابع: ما روى أنه خلق كرسيا هو بين يدي العرش دونه السماوات والأرض وهو إلى العرش كأصغر شيء. وعن الحسن الكرسي هو العرش «2» .
هذا وقد روى المفسرون عن ابن عباس أنه قال «كرسيه علمه» ولعل تفسير الكرسي بالعلم كما قال حبر الأمة هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأنه هو المناسب لسياق الآية الكريمة.
ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بالصفتين التاسعة والعاشرة فقال- تعالى-: وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
يَؤُدُهُ معناه يثقله ويشق عليه. يقال آدني الأمر بمعنى أثقلنى وتحملت منه المشقة.
والْعَلِيُّ هو المتعالي عن الأشياء، والأنداد، والأمثال، والأضداد وعن أمارات النقص ودلالات الحدوث. وقيل هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة وعلو الشأن.
والمعنى: ولا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض ورعايتهما، وهو المتعالي عن الأشباه والنظائر، والمسيطر على خلقه، العظيم في ذاته وصفاته، ففي هاتين الجملتين بيان لعظيم قدرته، وعظيم رعايته لخلقه، وتنزيهه- سبحانه- عن مشابهة الحوادث.
وبعد، فهذه آية الكرسي التي اشتملت على عشر جمل، كل جملة منها تشتمل على وصف أو أكثر من صفات الله الجليلة، ونعوته المجيدة، وألوهيته الحقه، وقدرته النافذة، وعلمه المحيط بكل شيء، قد أقامت الأدلة الساطعة على وحدانية الله- تعالى- ووجوب إفراده بالعبادة.
وقد تكلم العلماء طويلا عن تناسق جملها، وبلاغة تراكيبها ووجوه فضلها ومن ذلك قول صاحب الكشاف: «فإن قلت: لم فضلت هذه الآية على غيرها حتى ورد في فضلها ما ورد؟
قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار» .
ومن الأحاديث التي ساقها الإمام ابن كثير في فضلها ما جاء عن أبى بن كعب أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سأله: «أى آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي. فقال له الرسول صلّى الله عليه وسلّم «ليهنك العلم أبا المنذر» .
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: إن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي» .
وروى أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- خرج ذات يوم على الناس فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أعظم آية في القرآن اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.. الآية .
وبعد أن ساق- سبحانه- في آية الكرسي الأدلة الواضحة على وحدانيته وعظمته وتنزيهه عن صفات الحوادث، عقب ذلك ببيان أن الدين الحق قد ظهر وتجلى لكل ذي عقل سليم، وأنه لا يقسر أحد على الدخول فيه فقال- تعالى-:
هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح ، عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله : " أي آية في كتاب الله أعظم " ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارا ثم قال أبي : آية الكرسي . قال : " ليهنك العلم أبا المنذر ، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش " وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به ، وليس عنده زيادة : " والذي نفسي بيده . . . " إلخ .
حديث آخر : عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي ، قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب : أن أباه أخبره : أنه كان له جرن فيه تمر قال : فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص قال : فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم قال : فسلمت عليه فرد السلام . قال : فقلت : ما أنت ، جني أم إنسي ؟ قال : جني . قلت : ناولني يدك . قال : فناولني ، فإذا يد كلب وشعر كلب . فقلت : هكذا خلق الجن ؟ قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني ، قلت : فما حملك على ما صنعت ؟ قال : بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال : فقال له فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال : هذه الآية : آية الكرسي . ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق الخبيث " .
وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق ، عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال : سمعت أبا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أي آية في القرآن أعظم ؟ " فقال رجل :
( الله لا إله إلا هو ) قال : فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي ، أو قال : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال : " ليهنك العلم يا أبا المنذر " .
حديث آخر : عن الأسفع البكري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي حدثنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن مولى ابن الأسفع رجل صدق أخبره عن الأسفع البكري : أنه سمعه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) حتى انقضت الآية . .
حديث آخر : عن أنس قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال : " أي فلان هل تزوجت " ؟ قال : لا وليس عندي ما أتزوج به . قال : " أوليس معك : ( قل هو الله أحد ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك : ( قل ياأيها الكافرون ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك ( إذا زلزلت ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك : ( إذا جاء نصر الله [ والفتح ] ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن " .
حديث آخر : عن أبي ذر جندب بن جنادة قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا المسعودي أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست . فقال : " يا أبا ذر هل صليت ؟ " قلت : لا . قال : " قم فصل " قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : " يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " قال : قلت : يا رسول الله أوللإنس شياطين ؟ قال : " نعم " قال : قلت : يا رسول الله الصلاة ؟ قال : " خير موضوع ، من شاء أقل ومن شاء أكثر " . قال : قلت : يا رسول الله فالصوم ؟ قال : " فرض مجزئ وعند الله مزيد " قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال : " أضعاف مضاعفة " . قلت : يا رسول الله فأيها أفضل ؟ قال : " جهد من مقل أو سر إلى فقير " قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " قلت : يا رسول الله ونبي كان ؟ قال : " نعم نبي مكلم " قال : قلت : يا رسول الله كم المرسلون ؟ قال : " ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا " وقال مرة : " وخمسة عشر " قال : قلت : يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال : " آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) " ورواه النسائي .
حديث آخر : عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ، رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب : أنه كان في سهوة له ، وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : " فإذا رأيتها فقل : باسم الله أجيبي رسول الله " . قال : فجاءت فقال لها : فأخذها فقالت : إني لا أعود . فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ما فعل أسيرك ؟ " قال : أخذتها فقالت لي : إني لا أعود ، إني لا أعود . فأرسلتها ، فقال : " إنها عائدة " فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تقول : لا أعود . وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : " ما فعل أسيرك ؟ " فأقول : أخذتها فتقول : لا أعود . فيقول : " إنها عائدة " فأخذتها فقالت : أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء : آية الكرسي ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : " صدقت وهي كذوب " .
ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به ، وقال : حسن غريب .
وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة فقال في كتاب " فضائل القرآن " وفي كتاب " الوكالة " وفي " صفة إبليس " من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه . فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله . قال : " أما إنه قد كذبك وسيعود " فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه سيعود " فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود . فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال : " أما إنه قد كذبك وسيعود " فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما هن . قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله . قال : " ما هي ؟ " قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . وكانوا أحرص شيء على الخير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إنه صدقك وهو كذوب . تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ " قلت : لا قال : " ذاك شيطان " .
كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقد رواه النسائي في " اليوم والليلة " عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره :
حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي أخبرنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " تحب أن تأخذ صاحبك هذا ؟ " قال : نعم . قال : " فإذا فتحت الباب فقل : سبحان من سخرك لمحمد " فذهب ففتح الباب فقال : سبحان من سخرك لمحمد . فإذا هو قائم بين يديه قال : يا عدو الله أنت صاحب هذا ؟ قال : نعم دعني فإني لا أعود ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء ، فخلى عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة . فقلت : أليس قد عاهدتني ألا تعود ؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تفعل ، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى قال له : لتفعلن ؟ قال : نعم . قال : ما هن ؟ قال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فأبعد فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما علمت أن ذلك كذلك ؟ " .
وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به ، وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا فهذه ثلاث وقائع .
قصة أخرى : قال أبو عبيد في كتاب " الغريب " : حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك أن تصارعني ؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخل شيطان ؟ فصارعه فصرعه فقال : إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب ، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم ؟ فقال : إني بينهم لضليع فعاودني ، فصارعه فصرعه الإنسي . فقال : تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار .
فقيل لابن مسعود : أهو عمر ؟ فقال : من عسى أن يكون إلا عمر .
قال أبو عبيد : الضئيل : النحيف الجسم ، والخبج بالخاء المعجمة ويقال : بالحاء المهملة : الضراط .
حديث آخر عن أبي هريرة : قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه : حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثني حكيم بن جبير الأسدي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه ! آية الكرسي " .
وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . كذا قال ، وقد رواه الترمذي من حديث زائدة [ به ] ولفظه : " لكل شيء سنام ، وسنام القرآن سورة البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي " . ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير ، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه .
قلت : وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي .
حديث آخر : قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن نافع ، أخبرنا عيسى بن محمد المروزي ، أخبرنا عمر بن محمد البخاري ، أخبرنا أبي ، أخبرنا عيسى بن موسى غنجار ، عن عبد الله بن كيسان ، أخبرنا يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن ؟ فقال ابن مسعود : على الخبير سقطت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أعظم آية في القرآن : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) .
حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد ، حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) و ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ آل عمران : 1 ، 2 ] " إن فيهما اسم الله الأعظم " .
وكذا رواه أبو داود عن مسدد ، والترمذي عن علي بن خشرم ، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه : قال ابن مردويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نمير ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ، أخبرنا هشام بن عمار ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد : أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال : " اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : سورة البقرة وآل عمران وطه " وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق : أما البقرة ف ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وفي آل عمران : ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وفي طه : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) [ طه : 111 ] .
حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي ، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن ، أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس ، أخبرنا محمد بن حمير ، أخبرنا محمد بن زياد ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت " .
وهكذا رواه النسائي في " اليوم والليلة " عن الحسين بن بشر به ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا ، فهو إسناد على شرط البخاري ، وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث . ولكن في إسناد كل منها ضعف .
وقال ابن مردويه أيضا : حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري ، أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي ، أخبرنا زياد بن إبراهيم ، أخبرنا أبو حمزة السكري ، عن المثنى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة ؛ فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين ، ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله " وهذا حديث منكر جدا .
حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها أول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني ، أخبرنا ابن أبي فديك ، عن عبد الرحمن المليكي ، عن زرارة بن مصعب ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ : ( حم ) المؤمن إلى : ( إليه المصير ) وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح " ثم قال : هذا حديث غريب ، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه .
وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث على قراءتها عند الحجامة : أنها تقوم مقام حجامتين ، وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان ، أوردهما ابن مردويه وغير ذلك . وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة .
فقوله : ( الله لا إله إلا هو ) إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق ) الحي القيوم ) أي : الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا القيم لغيره ، وكان عمر يقرأ : " القيام " فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ، ولا قوام لها بدون أمره كقوله : ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) [ الروم : 25 ] وقوله : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم ، فقوله : ( لا تأخذه ) أي : لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس ولهذا قال : ( ولا نوم ) لأنه أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال : " إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل ، وعمل الليل قبل عمل النهار ، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، أخبرني الحكم بن أبان ، عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل ؟ فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما . قال : فجعل ينعس وهما في يده في كل يد واحدة قال : فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما . قال معمر : إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول : فكذلك السماوات والأرض في يديه .
وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره ، وهو من أخبار بني إسرائيل ، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه .
وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير :
حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا هشام بن يوسف ، عن أمية بن شبل ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر ، قال : " وقع في نفس موسى : هل ينام الله ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما " . قال : " فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى ، حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان " قال : " ضرب الله له مثلا عز وجل : أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض " .
وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع ، والله أعلم .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، حدثنا أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا : يا موسى هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك : هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسى ، لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك . وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي .
وقوله : ( له ما في السماوات وما في الأرض ) إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه كقوله :
( إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [ مريم : 9395 ] .
وقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) كقوله : ( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) [ النجم : 26 ] وكقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : 28 ] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة : " آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك ، وقل تسمع ، واشفع تشفع " قال : " فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة " .
وقوله : ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلها كقوله إخبارا عن الملائكة : ( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ) [ مريم : 64 ] .
وقوله : ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله : ( ولا يحيطون به علما ) [ طه : 110 ] .
وقوله : ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا ابن إدريس ، عن مطرف بن طريف ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ( وسع كرسيه ) قال : علمه ، وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به .
قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير مثله . ثم قال ابن جرير : وقال آخرون : الكرسي موضع القدمين . ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين .
وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله : ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) قال : " كرسيه موضع قدميه ، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل " .
كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس ، فذكره وهو غلط ، وقد رواه وكيع في تفسيره : حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره . وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا .
وقال السدي عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش . وقال السدي : السماوات والأرض في جوف الكرسي ، والكرسي بين يدي العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة .
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم .
وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدثني أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس " . قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض " .
وقال أبو بكر بن مردويه : أخبرنا سليمان بن أحمد أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة " .
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا زهير حدثنا ابن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر ، رضي الله عنه قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنة . قال : فعظم الرب تبارك وتعالى وقال : " إن كرسيه وسع السماوات والأرض ، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله " .
وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور ، وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما ، والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما ، والحافظ الضياء في كتاب " المختار " من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور وفي سماعه من عمر نظر ، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا ، ومنهم من يرويه عنه مرسلا ، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ، ومنهم من يحذفها .
وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من سننه ، والله أعلم .
وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء ، والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية .
وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين : أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له : الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آخرون .
وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول : الكرسي هو العرش . والصحيح أن الكرسي غير العرش ، والعرش أكبر منه ، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار ، وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة ، عن عمر في ذلك ، وعندي في صحته نظر ، والله أعلم .
وقوله : ( ولا يئوده حفظهما ) أي : لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما ، بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، الرقيب على جميع الأشياء ، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه ، محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد ، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه . فقوله : ( وهو العلي العظيم ) كقوله : ( وهو [ العلي الكبير ) وكقوله ] : ( الكبير المتعال ) [ الرعد : 9 ] .
وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه .
القول في تأويل قوله تعالى : اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى على تأويل قوله: " الله " (17) .
* * *
وأما تأويل قوله: " لا إله إلا هو " فإن معناه: النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. يقول: " الله " الذي له عبادة الخلق=" الحي القيوم "، لا إله سواه، لا معبود سواه، يعني: ولا تعبدوا شيئا سوى الحي القيوم الذي لا يأخذه سِنة ولا نوم، (18) والذي صفته ما وصف في هذه الآية.
* * *
وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به أقوال المختلفين في البينات= (19) من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذكره أنه فضل بعضهم على بعض= واختلفوا فيه، فاقتتلوا فيه كفرا به من بعض، وإيمانا به من بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به، ووفقنا للإقرار.
* * *
وأما قوله: " الحي" فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد، ولا آخر له بأمد، (20) إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود، وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها، (21) وينقضي بانقضاء غايتها.
* * *
وبما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5763 - حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: " الحي" حي لا يموت.
5764 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، مثله.
* * *
قال أبو جعفر: وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك (22) .
فقال بعضهم: إنما سمى الله نفسه " حيا "، لصرفه الأمور مصارفها وتقديره الأشياء مقاديرها، فهو حي بالتدبير لا بحياة.
وقال آخرون: بل هو حي بحياة هي له صفة.
وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به، فقلناه تسليما لأمره (23) .
* * *
وأما قوله: " القيوم "، فإنه " الفيعول " من " القيام " وأصله " القيووم "،: سبق عين الفعل، وهي" واو " ،" ياء " ساكنة، فأدغمتا فصارتا " ياء " مشددة.
وكذلك تفعل العرب في كل " واو " كانت للفعل عينا، سبقتها " ياء " ساكنة. ومعنى قوله: " القيوم "، القائم برزق ما خلق وحفظه، كما قال أمية: (24) .
لــم تخــلق الســماء والنجــوم
والشــمس معهــا قمــر يعــوم (25)
قــــدره المهيمـــن القيـــوم
والجســـر والجنـــة والجحــيم (26)
إلا لأمــر شـأنه عظيــم
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5765 - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: " القيوم "، قال: القائم على كل شيء.
5766 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " القيوم "، قيم كل شيء، يكلؤه ويرزقه ويحفظه.
5767 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " القيوم " وهو القائم.
&; 5-389 &;
5768 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: " الحي القيوم "، قال: القائم الدائم.
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " لا تأخذه سنة "، لا يأخذه نعاس فينعس، ولا نوم فيستثقل نوما.
* * *
" والوسن " خثورة النوم، (27) ومنه قول عدي بن الرقاع:
وســنان أقصـده النعـاس فـرنقت
فــي عينــه ســنة وليس بنـائم (28)
ومن الدليل على ما قلنا: من أنها خثورة النوم في عين الإنسان، قول الأعشى ميمون بن قيس:
تعـــاطى الضجــيع إذا أقبلــت
بعيــد النعــاس وقبــل الوســن (29)
وقال آخر: (30)
باكرتهـا الأغـراب فـي سـنة النـو
م فتجــري خـلال شـوك السـيال (31)
&; 5-391 &;
يعني عند هبوبها من النوم ووسن النوم في عينها، يقال منه: " وسن فلان فهو يوسن وسنا وسنة وهو وسنان "، إذا كان كذلك.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5769 - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله تعالى: " لا تأخذه سنة " قال: السنة: النعاس، والنوم: هو النوم (32) .
5770 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " لا تأخذه سنة " السنة: النعاس.
5771 - حدثنا الحسن بن يحيي، قال: أخبرنا عبد الرازق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن في قوله: " لا تأخذه سنة " قالا نعسة.
5772 - حدثني المثنى، قال، حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " لا تأخذه سنة ولا نوم " قال: السنة: الوسنة، وهو دون النوم، والنوم: الاستثقال،
5773 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن &; 5-392 &; جويبر، عن الضحاك: " لا تأخذه سنة ولا نوم " السنة: النعاس، والنوم: الاستثقال.
5774 - حدثني يحيي بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، مثله سواء.
5775 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: " لا تأخذه سنة ولا نوم " أما " سنة "، فهو ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان (33) .
5776 - حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " لا تأخذه سنة ولا نوم " قال: " السنة "، الوسنان بين النائم واليقظان.
5777 - حدثني عباس بن أبي طالب، قال: حدثنا منجاب بن الحرث، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل عن يحيى بن رافع: " لا تأخذه سنة " قال: النعاس (34) .
5778 - حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: " لا تأخذه سنة ولا نوم " قال: " الوسنان ": الذي يقوم من النوم لا يعقل، حتى &; 5-393 &; ربما أخذ السيف على أهله.
* * *
قال أبو جعفر: وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: " لا تأخذه سنة ولا نوم " لا تحله الآفات، ولا تناله العاهات. وذلك أن " السنة " و " النوم "، معنيان يغمران فهم ذي الفهم، ويزيلان من أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه.
* * *
فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الذي لا يموت= الْقَيُّومُ على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال=" لا تأخذه سنة ولا نوم "، لا يغيره ما يغير غيره، ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام، بل هو الدائم على حال، والقيوم على جميع الأنام، لو نام كان مغلوبا مقهورا، لأن النوم غالب النائم قاهره، ولو وسن لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكا، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته، والنوم شاغل المدبر عن التدبير، والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه. (35) كما:
5779 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر= قال: أخبرني الحكم بن أبان، (36) عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: " لا يأخذه سنة ولا نوم " أن موسى سأل الملائكة: هل ينام الله؟ فأوحى الله إلى الملائكة، وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام. ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكوه، ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما في يديه، &; 5-394 &; في كل يد واحدة. قال: فجعل ينعس وينتبه، وينعس وينتبه، حتى نعس نعسة، فضرب بإحداهما الأخرى فكسرهما= قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله، يقول: فكذلك السماوات والأرض في يديه.
5780 - حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن أمية بن شبل، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: وقع في نفس موسى: هل ينام الله تعالى ذكره؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، أمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى، ثم نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله مثلا له أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض (37) .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " له ما في السماوات وما في الأرض " أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود (38) .
وإنما يعنى بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه، وليس له خدمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض ملكي وخلقي، فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، لأنه لا ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه، ولا يطيع سوى مولاه.
* * *
وأما قوله: " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم، إلا أن يخليه، ويأذن له بالشفاعة لهم. (39) وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى! (40) فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض ملكا، فلا ينبغي العبادة لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له، من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي.
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك أنه المحيط بكل ما كان وبكل ما هو كائن علما، لا يخفى عليه شيء منه.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5781 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم: " يعلم ما بين أيديهم "، الدنيا=" وما خلفهم "، الآخرة.
5782 - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " يعلم ما بين أيديهم "، ما مضى من الدنيا=" وما خلفهم " من الآخرة.
5783 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج قوله: " يعلم ما بين أيديهم " ما مضى أمامهم من الدنيا=" وما خلفهم " ما يكون بعدهم من الدنيا والآخرة.
5784 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: " يعلم ما بين أيديهم "، قال: [ وأما ]" ما بين أيديهم "، فالدنيا=" وما خلفهم "، فالآخرة (41) .
* * *
وأما قوله: " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء "، فإنه يعني تعالى ذكره: أنه العالم الذي لا يخفي عليه شيء محيط بذلك كله، (42) &; 5-397 &; محص له دون سائر من دونه= وأنه لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه، فأراد فعلمه، وإنما يعني بذلك: أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلا فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البتة من وثن وصنم ؟! يقول: أخلصوا العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلها، (43) يعلمها، لا يخفي عليه صغيرها وكبيرها.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5786 - حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: " ولا يحيطون بشيء من علمه " يقول: لا يعلمون بشيء من علمه =" إلا بما شاء "، هو أن يعلمهم (44) .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى " الكرسي" الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وسع السماوات والأرض.
فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره.
* ذكر من قال ذلك:
5787 - حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة، قالا حدثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " وسع كرسيه " قال: كرسيه علمه.
5788 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مطرف، &; 5-398 &; عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله= وزاد فيه: ألا ترى إلى قوله: وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ؟
* * *
وقال آخرون: " الكرسي": موضع القدمين.
* ذكر من قال ذلك:
5789 - حدثني علي بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمير، عن أبي موسى، قال: الكرسي: موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل (45) .
5790 - حدثني موسى بن هاوون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: " وسع كرسيه السماوات والأرض "، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وهو موضع قدميه.
5791 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك قوله: " وسع كرسيه السماوات والأرض "، قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرش، الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم،
5792 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، قال: الكرسي: موضع القدمين (46) .
&; 5-399 &;
5793 - حدثني عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " وسع كرسيه السماوات والأرض "، قال: لما نـزلت: " وسع كرسيه السماوات والأرض " قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا الكرسي وسع السموات والأرض، فكيف العرش؟ فأنـزل الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إلى قوله: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر: 67] (47) .
5794 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: " وسع كرسيه السماوات والأرض " قال ابن زيد: فحدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس "= قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض (48) .
* * *
وقال آخرون: الكرسي: هو العرش نفسه.
* ذكر من قال ذلك:
5795 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك، قال: كان الحسن يقول: الكرسي هو العرش.
* * *
قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما:-
&; 5-400 &;
5796 - حدثني به عبد الله بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة! فعظم الرب تعالى ذكره، ثم قال: " إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع- ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، إذا ركب، من ثقله " (49) .
5797 - حدثني عبد الله بن أبى زياد، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
5798 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، قال: جاءت امرأة، فذكر نحوه (50) .
* * *
وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عنه أنه قال: " هو علمه " (51) . وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره: وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم، وأحاط به مما في السماوات والأرض، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا [غافر: 7]، &; 5-402 &; فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: " وسع كرسيه السماوات والأرض ".
* * *
قال أبو جعفر: وأصل " الكرسي" العلم. (52) ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب " كراسة "، ومنه قول الراجز في صفة قانص:
* حتى إذا ما احتازها تكرسا * (53)
.
يعني علم. ومنه يقال للعلماء " الكراسي"، لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال: " أوتاد الأرض ". يعني بذلك أنهم العلماء الذي تصلح بهم الأرض، (54) ومنه قول الشاعر: (55)
يحـف بهـم بيـض الوجـوه وعصبة
كراســي بــالأحداث حـين تنـوب (56)
يعني بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلها. والعرب تسمي أصل كل شيء " الكرس "، يقال منه: " فلان كريم الكرس "، أي كريم الأصل، قال العجاج:
&; 5-403 &;
قــد علـم القـدوس مـولى القـدس
أن أبـــا العبـــاس أولــى نفس
* بمعدن الملك الكريم الكِرْس * (57)
يعني بذلك: الكريم الأصل، ويروى:
* في معدن العز الكريم الكِرْس *
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " ولا يئوده حفظهما "، ولا يشق عليه ولا يثقله.
* * *
يقال منه: " قد آدني هذا الأمر فهو يؤودني أودا وإيادا "، (58) ويقال: " ما آدك فهو لي آئد "، يعني بذلك: ما أثقلك فهو لي مثقل.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5799 - حدثنا المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: &; 5-404 &; حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ولا يؤوده حفظهما " يقول: لا يثقل عليه.
5800 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ولا يؤوده حفظهما " قال: لا يثقل عليه حفظهما.
5801 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ولا يؤوده حفظهما " لا يثقل عليه لا يجهده حفظهما.
5802 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله: " ولا يؤوده حفظهما " قال: لا يثقل عليه شيء.
5803 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتي، قال: حدثنا نافع بن مالك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: " ولا يؤود حفظهما " قال: لا يثقل عليه حفظهما.
5804 - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة= وحدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد= قالا جميعا: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: " ولا يؤوده حفظهما " قال: لا يثقل عليه.
5805 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن عبيد، عن الضحاك، مثله.
5806 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعته = يعني خلادا = يقول: سمعت أبا عبد الرحمن المديني يقول في هذه الآية: " ولا يؤوده حفظهما "، قال: لا يكبر عليه (59) .
5807 - حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن &; 5-405 &; ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: " ولا يؤوده حفظهما " قال: لا يكرثه (60) .
5808 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: " ولا يؤوده حفظهما " قال: لا يثقل عليه.
5809 - حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: " ولا يؤوده حفظهما " يقول: لا يثقل عليه حفظهما.
5810 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: " ولا يؤوده حفظهما " قال: لا يعز عليه حفظهما.
* * *
قال أبو جعفر: " والهاء "، و " الميم " و " الألف " في قوله: " حفظهما "، من ذكر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ . فتأويل الكلام: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يثقل عليه حفظ السموات والأرض.
* * *
وأما تأويل قوله: " وهو العلي" فإنه يعني: والله العلي.
* * *
و " العلي" " الفعيل " من قولك: " علا يعلو علوا "، إذا ارتفع،" فهو عال وعلي"،" والعلي" ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته.
* * *
وكذلك قوله: " العظيم "، ذو العظمة، الذي كل شيء دونه، فلا شيء أعظم منه. كما:-
5811 - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " العظيم "، الذي قد كمل في عظمته.
* * *
&; 5-406 &;
قال أبو جعفر: واختلف أهل البحث في معنى قوله: (61) .
" وهو العلي".
فقال بعضهم: يعني بذلك; وهو العلي عن النظير والأشباه، (62) وأنكروا أن يكون معنى ذلك: " وهو العلي المكان ". وقالوا: غير جائز أن يخلو منه مكان، ولا معنى لوصفه بعلو المكان، لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه، كما وصف به نفسه أنه على العرش، فهو عال بذلك عليهم.
* * *
وكذلك اختلفوا في معنى قوله: " العظيم ".
فقال بعضهم: معنى " العظيم " في هذا الموضع: المعظم، صرف " المفعل " إلى " فعيل "، كما قيل للخمر المعتقة،" خمر عتيق "، كما قال الشاعر: (63) .
وكــأن الخـمر العتيـق مـن الإس
فنـــط ممزوجـــة بمــاء زلال (64)
وإنما هي" معتقة ". قالوا: فقوله " العظيم " معناه: المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. قالوا: وإنما يحتمل قول القائل: " هو عظيم "، أحد معنين: أحدهما: ما وصفنا من أنه معظم، والآخر: أنه عظيم في المساحة والوزن. قالوا: وفي بطول القول بأن يكون معنى ذلك: أنه عظيم في المساحة والوزن، صحة القول بما قلنا.
* * *
وقال آخرون: بل تأويل قوله: " العظيم " هو أن له عظمة هي له صفة.
وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية، ولكنا نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات، (65) .
وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظم المعروف من العباد. لأن ذلك تشبيه له بخلقه، وليس كذلك. وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها، وقالوا: لو كان معنى ذلك أنه " معظم "، لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق، وأن يبطل معنى ذلك عند فناء الخلق، لأنه لا معظم له في هذه الأحوال.
* * *
وقال آخرون: بل قوله: إنه " العظيم " وصف منه نفسه بالعظم. وقالوا: كل ما دونه من خلقه فبمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته.
------------------
الهوامش :
(17) انظر تفسير"الله" فيما سلف 1 : 122- 126 .
(18) في المطبوعة : "ولا تعبدوا شيئا سواه الحي القيوم" ، والصواب من المخطوطة .
(19) في المطبوعة : "المختلفين في البينات" ، بزيادة"في" ، وهو خطأ مخل بالكلام ، والصواب ما في المخطوطة ، و"البينات"فاعل"جاءت به" ، و"المختلفين"مفعوله . والجملة التي بين الخطين ، معترضة ، وقةله : بعد"واختلفوا فيه فاقتتلوا فيه..." ، عطف على قوله : "عما جاءت به..." .
(20) في المطبوعة : "لا أول له يحد" بالياء ، فعلا ، ثم جعل التي تليها"ولا آخر له يؤمد" ، فأتى بفعل عجيب لا وجود له في العربية ، وفي المخطوطة : "بحد" غير منقوطة وصواب قراءتها بباء الجر في أوله . وفيها"بأمد" كما أثبت ، والأمد : الغاية التي ينتهى إليها . بقول : ليس له أول له حد يبدأ منه وليس له آخر له أمد ينتهى إليه .
(21) في المطبوعة : "وآخر مأمود" ، أتى أيضًا بالعجب في تغيير المخطوطة ، وباستخراج كلمة لا يجيزها اشتقاق العربية ، ولم تستعمل في كلام قط . وفي المخطوطة"ممدود"كما أثبتها . وهي من قولهم : "مد له في كذا" أي طويل له فيه . بل أولى من ذلك أن يقال إنها من"المد" ، وهي الطائفة من الزمان .
وقد استعملو من المدة : "ماددت القوم" . أي جعلت لهم مدة ينهون إليها . وفي الحديث : "يا ويح قريش ، لقد نهكتهم الحرب! ما ضرهم لو ماددناهم مدة" ، أي جعلنا لهم مدة ، وهي زمان الهدنة . وقال ابن حجر في مقدمته الفتح : 182"قوله : (في المدة التي فيها أبا سفيان) : أي جعل بينه وبينه مدة صلح ، ومنه : (إن شاؤوا ماددتهم) . فهو"فاعل" من"المد" . ولا شك أن الثلاثى منه جائز أن يقال : " مد له مدة" أي جعل له مدة ينتهى من عند آخرها . وكأتى قرأتها في بعض كتب السير ، فأرجو أن أظفر بها فأقيدها إن شاء الله ، فمعنى قوله : "وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها" أي : آخر قد ضربت له مدة ينقطع بانقطاع غايتها .
(22) هذه أول مرة يستعمل فيها الطبري : "أهل البحث" ، ويعنى بذلك أهل النظر من المتكلمين .
(23) في المطبوعة : "فقلناه" ، وما في المخطوطة صواب أيضًا جيد .
(24) هو : أمية بن أبي الصلت الثقفى .
(25) ديوانه : 57 ، والقرطبي 3 : 271 ، وتفسير أبي حيان 25 : 277 . وفي المطبوعة والقرطبي"قمر يقوم" ، وهو لا معنى له ، والصواب في المخطوطة وتفسير أبي حيان . عامت النجوم تعوم عوما : جرب ، مثل قولهم : "سبحت النجوم في الفلك تسبح سبحا"
(26) في المراجع كلها"والحشر" ، وهو خطأ وتصحيف لا ريب فيه عندي ، وهو في المخطوطة"والحسر" غير منقوطة ، وصواب قراءتها"الجسر" كما أثبت . وفي حديث البخاري : "ثم يؤتى بالجسر" قال ابن حجر : أي الصراط ، وهو كالقنطرة بين الجنة والنار ، يمر عليها المؤمنون . ولم يذكر في بابه في كتب اللغة ، فليقيد هناك ، فإن هذا هو سبب تصحيف هذه الكلمة . وفي بعض المراجع : "والجنة والنعيم" ، والذي في الطبري هو الصواب . هذا وشعر أمية كثير خلطه .
(27) الخثورة : نقيض الرقة ، يقال : "خثر اللبن والعسل ونحوهما" ، إذا ثقل وتجمع ، والمجاز منه قولهم : "فلان خاثر النفس" أي ثقيلها ، غير طيب ولا نشيط ، قد فتر فتورا . واستعمله الطبري استعمالا بارعا ، فجعل للنوم"خثورة" ، وهي شدة الفتور ، كأنه زالت رقته واستغلط فثقل ، وهذا تعبير لم أجده قبله .
(28) من أبيات له في الشعر والشعراء : 602 ، والأغانى 9 : 311 ، ومجاز القرآن 1 : 78 ، واللسان (وسن) (رنق) ، وفي جميعها مراجع كثيرة ، وقبل البيت في ذكرها صاحبته"أم القاسم" :
وكأنهــا وســط النسـاء أعارهـا
عينيــه أحـور مـن جـاذر جاسـم
وسـنان أقصـده النعـاس ..........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصطــاد يقظـان الرجـال حديثهـا
وتطــير بهجتهــا بـروح الحـالم
والجآذر بقر الوحش ، وهي حسان العيون . وجاسم : موضع تكثر فيه الجآذر . و" أقصده النعاس" قتله النعاس وأماته . يقال : "عضته حبة فإقصدته" ، أي قتلته على المكان -أي من فوره . و"رفقت" أي خالطت عينه . وأصله من ترنيق الماء ، وهو تكديره بالطين حتى يغلب على الماء . وحسن أن يقال هو من ترنيق الطائر بجناحيه ، وهو رفرفته إذا خفق بجناحيه في الهواء فثبت ولم يطر ، وهذا المجازأعجب إلى في الشعر .
(29) ديوانه : 15 ، وهو يلي البيت الذي سلف 1 : 345 ، 346 ، وفي ذكر نساء استمع بهن :
إذا هـــن نـــازلن أقـــرانهن
وكـان المصـاع بمـا فـي الجـون
تعـــاطى الضجـــيع...........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صريفيـــة طيبـــا طعمهـــا
لهــا زبــد بيــن كــوب ودن
وقوله"تعاطى" من قولهم للمرأة : "هى تعاطى خلها" أي صاحبها -أن تناوله قبلها وريقها .
وقوله : "أقبلت" ، هو عندي بمعنى : سامحت وطاوعت وانقادت ، من"القبول" وهو الرضا . ولم يذكر ذلك أصحاب اللغة ، ولكنه جيد في العربية ، شبيه بقولهم : "أسمحت" ، من السماح ، إذا أسهلت وانقادت ووافقت ما يطلبه صاحبها . وذلك هو الجيد عندي . ليس من الإقبال على الشيء . بل من القبول . ويروي مكمان ذلك : "إذا سامها" ، ورواية الديوان :
"بعيد الرقـــاد وعنــد الوســن"
والصريفية : الخمر الطيبة ، جعلها صريفية ، لأنها أخذت من الدن ساعتئذ ، كاللبن الصريف وهو اللبن الذي ينصرف من الضرع حارا إذا حلب . وفي الديون : "صليفية" ، باللام ، والصواب بالراء يقول : إذا انقادت لصاحبها بعيد رقادها ، أو قبل وسنها ، عاطته من ريقها خمرا صرفا تفور بالزبد بين الكوب و الدن ، ولم يمض وقت عليها فتفسد . يقول : ريفها هو الخمر ، في يقظتها قبل الوسن -وذلك بدء فتور الفس وتغير الطباع -وبعد لومها ، وقد تغيرت أفواه البشر واستكرهت روائحها ينفي عنها العيب في الحالين . وذلك قل أن يكون في النساء أو غيرهن .
(30) هو الاعشى أيضًا
(31) ديوانه : 5 ، واللسان (غرب) ، من قصيدة جليلة ، أفضى فيها إلى ذكر صاحبته له يقول قبله :
وكـأن الخـمر العتيـق مـن الإسفنط
ممزوجــــة بمــاء زلال
باكرتها الأغراب .......................
...............................
الإسفنط : أجود أنواع الخمر وأغلاها . وباكرتها ، أي في أول النهار مبادرة إليها .
والأغراب جمع غرب (بفتح فسكمون) ، وهو القدح . والسيال : شجر سبط الأغصان ، عليه شوك أبيض أصوله أمثال ثنايا اعذارى ، وتشبه به أسنانهن يقول : إذا نامت لم يتغير طيب ثغرها ، بل كأن الخمر تجرى بين ثناياها طيبة الشذا . وقوله : "باكرتها الأغراب" ، وهو كفوله في الشعر السالف أنها"صريفية" أي أخذت من دنها لسعتها . يقول : ملئت الأقداح منها بكرة ، يعنى تبادرت إليها الأقداح من دنها ، وذلك أطيب لها .
هذا ، وقد جاء في شرح الديوان : الأغراب : حد الأسنان وبياضها ، وأظال في شرحه ، ولكنى لا أرتضيه ، والذي شرحته موجود في اللسان ، وهو أعرق في الشعر ، وفي فهمه .
(32) يعنى أن النوم معروف ، والسنة غير النوم ، وانظر الأثر الآتي : 5772 وما بعده .
(33) في المخطوطة"ريح" غير منقوطة . والريح هنا : الغلبة والقوة ، كما جاء في شعر أعشى فهو أو سليك بن السلكة .
أتنظران قليلا ريث غفلتهمأوتعدوان فإن الريح للعادى
أي الغلبة . وربما قرئت أيضًا : "الرنح" (بفتح الراء وسكون النون) وهو الدوار . ومنه : "ترنح من السكر" إذا تمايل ، و"رنح به" (بالبناء للمجهول مشددة النون) إذا دير به كالمغشى عليه ، أو اعتراه وهن في عظامه من ضرب أو فزع أو سكر .
(34) الأثر : 5777 -"عباس بن أبي طالب" ، هو : "عباس جعفر بن الزبرقان" مضت ترجمته في رقم : 880 ، و"المنجاب بن الحارث" ، مضت ترجمته في رقم : 322 -328 ، و"على بن مسهر القرشي" الكوفي الحافظ ، روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهشام بن عروة ، واسماعيل بن أبي خلد . ثقة ، مات سنة 189 . مترجم في التهذيب . و" اسناعيل" هو" اسماعيل بن أبي خالد الأحمس" روي عن أبيه ، وأبيجحيفة ، ن وعبدالله بن أبي أوفى ، وعمرو بن حريث ، وأبي كاهل ، وهؤلاء صحابة . وعن زيد بن وهب والشعبي وغيرهما من كبار التابعين . كان ثقة ثبتا . مات سنه 146 . مترجم في التهذيب . و"يحيى بن رافع" أبو عيسى الثقفى . روي عن عثمان وأبي هريرة ، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد . مترجم في الكبير 4/ 2/ 273 ، وابن أبي حاتم 4/2/ 143 .
(35) في المطبوعة : "يمانع" بالياء في أوله ، وهو خطأ لا خير فيه . وإنما أخطأ قراءة المخطوطة للفتحة على الميم ، اتصلت بأولها .
(36) في المطبوعة والمخطوطة"وأخبرنى الحكم" ، وكأن الصواب حذف الواو"أخبرنا معمر قال ، أخبرنى الحكم بن أبان" كما أثبته فإن معمرا يروي عن الحكم بن أبان . انظر ترجمته في التهذيب ، وكما جاء في ابن كثير 2 : 11 على الصواب . وقال بمقبه : "وهو من أخبار بني إسرائيل ، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل ، وهو منزه عنه" . وأصاب ابن كثير الحق ، فإن أهل الكتاب ينسبون إلى أنبياء الله ، ما لو تركوه لكان خيرا لهم .
(37) الأثر : 5780 -"إسحق بن أبى إسرائيل-واسمه إبراهيم- بن كما مجرا ، أبو يعقوب المروزي" نزيل بغداد . روى عنه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود والنسائى وغيرهم . قال ابن معين : "من ثقات المسلمين ، ما كتب حديثا قط عن أحد من الناس ، إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه" .
وكرهه أحمد لوقفه في أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، فتركه الناس حتى كان الناس يمرون بمسجده ، وهو فيه وحيد لا يقربه أحد . وقال أبو زرعة : "عندي أنه لا يكذب ، وحدث بحديث منكر" . مات سنه 240 . مترجم في التهذيب .
و"هشام بن يوسف الصنعائي"قاضي صنعاء ، ثقة . روى عنه الأئمة كلهم . روي عن معمر ، وابن جريج ، والقاسم بن فياض ، والثوري ، وغيرهم . قال عبد الرزاق : "إن حدثكم القاضي -يعنى هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره" . مترجم في التهذيب .
و"أمية بن شبل الصنعائي" ، سمع الحكم بن أبان طاوس . روى عنه هشام بن يوسف وعبدالرزاق ، وثقه ابن معين ، مترجم في الكبير 1/2/ 12 ، ولم يذكر فيه جرحا ، وابن أبي حاتم 1/ 1/ 302 ، ولسان الميزان 1 : 467 . وقال الحافظ في لسان الميزان : "له حديث منكر ، رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ، قال"وقع في نفس موسى عليه السلام ، هل ينام الله" ، الحديث ، رواه عنه هشام بن يوسف ، وخالفه معمر ، عن الحكم ، عن عكمرمة ، فوقفة ، وهو أقرب . ولا يسوغ أن يكون هذا وقعا في نفس موسى عليه السلام ، وإنما روي أن بني إسرائيل سألوا موسى عن ذلك" .
وساق ابن كثير في تفسير 1 : 11 ، هذه الآثار ، ثم قال : "وأغرب من هذا كله ، الحديث الذي رواه ابن جرير : حدثنا إسحق بن أبي إسرائيل..." ، وساق الخبر ، ثم قال : " وهذا حديث غريب ، والأظهر أنه إسرائيل لا مرفوع ، والله أعلم" . والذي قاله ابن حجر قاطع في أمر هذا الخبر .
(38) انظر ما سلف في تفسير : "له ما في السموات..." ، 2 : 537 .
(39) انظر معنى"شفع" فيما سلف 2 : 31 - 33 ، وما سلف قريبا : 382 - 384 . ومعنى"الإذن" فيما سلف 2 : 449 ، 450/ ثم4 : 286 ، 370/ ثم هذا 352 ، 355 .
(40) هذا تأويل آية"سورة الزمر" : 3 .
(41) زيادة ما بين القوسين ، لاغنى عنها .
(42) انظر تفسير"الإحاطة" فيما سلف 2 : 284 .
(43) في المطبوعة : "أخلصوا" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب .
(44) سقط من الترقيم : 5785 ، سهوا .
(45) الأثر : 5789 -"علي بن مسلم بن سعيد الطوسي" نزيل بغداد . روى عنه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، ثقة ، مات سنة 253 ، مترجم في التهذيب . و"عمارة بن عمير التيمي" ، رأى عبدالله لابن عمرو ، وروي عن الأسود بن يزيد النخعي ، والحارث بن سويد التيمي ، وإبراهيم بن أبي موسى الأشعري . لم يدرك أبا موسى . والحديث منقطع . وخرجه السيوطي في الدر المنثور 1 : 327 ، ونسبه لابن المنذر ، وأبي الشيخ ، والبيهقى في الأسماء والصفات .
الأطيط : صوت الرحل والنسع الجديد ، وصوت الباب ، وهو صوت متمدد خشن ليس كالصرير بل أخشن .
(46) الأثر : 5792 -خرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 13 من طريق سفيان عن عمار الدهني ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ونسبه لوكيع في تفسيره . ورواه الكاكم في المستدرك 2 : 282 مثله ، موقوفا علي ابن عباس ، وقال : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبى قال ابن كثير : " وقد رواه ابن مردويه ، من طريق الحاكم بن ظهير الفزارى الكوفي ، وهو متروك ، عن السدى عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، ولا يصح أيضًا" . وانظر مجمع الزوائد 6 : 323 : والفتح 8 : 149 .
(47) الأثر : 5793 - لم يرد في تفسير الآية من"سورة الزمر" .
(48) الأثر : 5794 -أثر أبي ذر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور 1 : 328 ، ونسبه لأبي الشيخ في العظمة ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، وخرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 13 وساق لفظ ابن مردويه وإسناده ، من طريق محمد بن عبدالتميمي ، عن القاسم بن محمد الثقفي ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ذر .
(49) الأثر : 5796 -"عبدالله بن أبي زياد القطواني" ، هو"عبدالله بن الحكم بن أبي زيادة" سلفت ترجمته برقم : 2247 . و"عبيدالله بن موسي بن أبي المختار ، وأسمه باذام ، العبسى مولاهم" ، روى عنه البخاري ، وروى عنه هو والباقون بواسطة أحمد بن أبي سريج الرازى ، وأحمد بن إسحق البخاري ، وأبي بكر بن أبي شبية ، وعبدالله بن الحكم القطواني وغيرهم . ثقة صدوق حسن الحديث ، كان عالما بالقرآن رأسا فيه ، وأثبت أصحاب إسرائيل . مترجم في التهذيب .
و"عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي" روي عن عمر وجابر ، روى عنه أبو إسحق السبيعى ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب . وهكذا روى الطبري هذا الأثر موقوفا ، وخرجه ابن كثير وفي تفسيره 2 : 13 من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن عبدالله بن خليفة ، عن عمر رضي الله عنه .
قال ابن كثير : "وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور ، وعبد بن بن حميد ، وابن جرير في تفسيريهما ، والطبراني ، وابن أبي عاصم في كتابي السنة ، لها ، والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي إسحق السبيعي ، عن عبدالله بن خليفة ، وليس بذاك المشهور . وفي سماعه من عمر نظطر : ثم منهم من يرويه عنه ، عن عمر موقوفا -قلت : كما رواه الطبري هنا -ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا ، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غربية -قلت : وهي زيادة الطبري في هذا الحديث -ومنهم من يحذفها . وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش ، كما رواه أبو داود في كتاب السنة من سنته (رقم : 4726) ، والله أعلم" .
قال بيده : أشار بها ، وانظر ما سلف من تفسير الطبري لذلك في 2 : 546 -548 .
(50) الأثران : 5797 ، 5798 -يحيى بن أبي بكير ، واسمه نسر ، الأسدي" ، أبو زكريا الكرماني الأصل . سكن بغداد ، روي عن بن عثمان ، وإبراهيم بن طهمان ، وإسرائيل ، وزائدة .
روى عنه الستة ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي خلف ، وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة 208 أو 209 . مترجم في التهذيب . وكان في المطبوعة"يحيى بن أبي بكر" وهو خطأ .
وهذا الأثر ، والذي يليه ، إسنادان آخران للأثر السالف رقم : 5796 ، فانظر التعليق عليهما .
(51) العجب لأبي جعفر ، كيف تناقض قوله في هذا الموضع ! فإنه بدأ فقال : إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، من الحديث في صفة الكرسي ، ثم عاد في هذا الموضع يقول : وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن ، فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه . فإما هذا وإما هذا ، وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى"الكرسي" هو الذي جاء في الحديث الأول ، ويكون معناه أيضًا "العلم" ، كما زعم أنه دل على صحته ظاهر القرآن . وكيف يجمع في تأويل واحد ، معنيان مختلفان في الصفة والجوهر ! ! وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، صحيح الإسناد ، فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، صحيح الإسناد علىشرط الشيخين ، كما قال الحاكم ، وكما في مجمع الزوائد 6 : 323" رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح" ، كما بينته في التعليق على الأثر : 5792 . ومهما قيل فيها ، فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له . وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي : "والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهنى ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : "الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره . قال : وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . قال : ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم ، فقد أبطل" ، وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله .
وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو"العلم" ، بقوله تعالى
المعاني :
التدبر :
وقفة
[255] آية الكرسي أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها؛ وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة؛ فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها، وجعلها وردًا للإنسان في أوقاته: صباحًا، ومساءً، وعند نومه، وأدبار الصلوات المكتوبات.
وقفة
[255] تدبر آية الكرسي أولى ما يكون، ويحق لمن قرأها متدبرًا متفقهًا أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظًا من شرور الشيطان.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ﴾ كل جملة في هذه الآية تصح أن تكون خبرًا للمبتدأ (الله)؛ لأن كل جملة فيها ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى: الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السموات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله لا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيُّه السموات والأرض، الله لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ كلمات قلائل قررت مبدأ التوحيد الخالص المصفى من جميع لوثات الشرك، لقد أغنت هذه الكلمات عن نفي كل أنواع الشرك.
وقفة
[255] ﴿لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ﴾ بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك، وهو المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله.
وقفة
[255] لما قال تعالى: ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ قال بعدها: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك، وهو كماله في نفسه ولغيره، فلا تصلح العبادة إلا لمن هذه شأنه: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: 58].
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نفى الله تعالى عن نفسه النوم؛ لأنه آفة، وهو منزه عن الآفات.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه عز وجل.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ آية الكرسي أعظم آية، وفضلها بشرف موضوعها، وهو الرب القادر المستحق للعبادة وحده، المتفرد بصفات الكمال، المنزه عن ضدها، الشاهدة بذلك مخلوقاته.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ اقرأ آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة؛ فإنه لا يكون بينك وبين الجنة إلا أن تموت، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ». [النسائي في الكبرى 9928، وصححه الألباني].
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ما أعظم ما تسكبه هذه الآية من الراحة والطمأنينة في قلوبنا! يا من تقرأ كلام ربك بفهم وبصيرة، تنام وحاجتك في صدرك، ولك ربٌّ لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف تغتم وتحزن؟!
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ آية الكرسي سيدة آي القرآن كما يقوله القرطبي، تكرر فيها اسم الله بين ظاهر ومضمر ١٨ مرة وهي عقيدة بمفردها.
وقفة
[255] ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ذكر وصفًا يؤكد استحقاقه وحده للعبادة؛ لنراقب إخلاص قلوبنا في العبادات، وتعلقها بالله فيما ينفعنا أو يضرنا.
عمل
[255] اقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء وعند النوم يحفظك الله بها من الشيطان ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾.
عمل
[255] اقرأ آية الكرسي عند حزنك ووحشتك وتعبك وقبل نومك وبعد فراغك من صلاتك، اقرأها على صغارك وفي خلوتك، املأ بها أنفاسك في ليلك ونهارك؛ فهي الركن الوثيق، والجُند الذي لا يغلب، والحصن الذي لا يكسر، إنها أعظم آية في أعظم كتاب أنزل من السماء؛ لِما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ﴿اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾.
وقفة
[255] ﴿الْحَيُّ﴾ اســم الله (الـحى): الذي له كمال الحياة، ولا يموت.
لمسة
[255] ﴿الْحَيُّ﴾ الحيُّ معرَّفة، والحيُّ هو الكامل الاتصاف بالحياة، ولم يقل حيّ؛ لأنها تفيد أنه من جملة الأحياء، فالتعريف بـ(أل) هي دلالة على الكمال والقصر؛ لأن ما سواه يصيبه الموت، والتعريف قد يأتي بالكمال والقصر، فالله له الكمال في الحياة وقصرًا، فالله هو الحيُّ، لا حيَّ سواه على الحقيقة؛ لأن كل ما عداه يجوز عليه الموت، وهو الذي يفيض على الخلق بالحياة.
وقفة
[255] ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ قال كثير من أهل العلم: إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه». [الحاكم 1861، وحسنه الألباني]، قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في البقرة: ﴿اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، وفي آل عمران: ﴿اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، وفي طه: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوم﴾.
وقفة
[255] ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾: الحي الدائم الذي يقوم بتصريف شؤون خلقه وتدبير أمرهم، قال كثير من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.
وقفة
[255] ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ سبحانه الحيُّ حياةً لا بداية لها ولا منتهى لها.
وقفة
[255] لما ذكر الله لنفسه صفة الحياة: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ذكر بعدها: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، وفيه معنى لطيف؛ وهو أن النوم هو الموتة الصغرى، فنفى عن نفسه السِّنة والنوم بعد أن أثبت لنفسه كمال الحياة.
لمسة
[255] ﴿الْقَيُّومُ﴾ من صيغ المبالغة من القيام، ومن معانيها القائم في تدبير أمر خلقه، ومن معانيها القائم على كل شيء، ومن معانيها الذي لا ينعس ولا ينام؛ لأنه إذا نعس أو نام لا يكون قيُّومًا، ومن معانيها القائم بذاته، و(القيُّوم) جاءت معرَّفة؛ لأنه لا قيُّوم سواه على الأرض حصرًا.
وقفة
[255] ﴿ﲙ﴾ اســم الله (الـقـيـوم): القائم بتدبير خلقه، القائمُ الحافظُ لكل شيء.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ينام العـبد على أمر قد يئس منه، ويستيقظ على انفراجـه بعد منامه، لأن مدبر الكون عز وجل لا ينام.
لمسة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ قدَّم السنة على النوم؛ لأنها أسبق منه، فالنعاس يسبق النوم.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ مهما حفَّ بك من الأحبة عند وجعك، عند حزنك وكربتك؛ لكنهم بالنهاية: ينامون، وحده الله معك لا ينام.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ذكر النوم بعد السنة؛ ترقَّى من نفى الأضعف إلى نفي الأقوى.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير، وإثبات لكمال العلم فإن السنة والنوم يشبهان الموت، فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة، وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ عن رعايتنا، ورعاية أحلامنا، عن الضجة المختبئة في حجرات قلوبنا، عن أمورنا المؤرقة، عن أيامنا الثقيلة، سبحانه ونعم الوكيل.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نامَ الملك عن ملكه، وسيأتي صباح يفارقه، وربنا حيٌّ لا يموت ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 27].
عمل
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نمْ أنت، وفوِّض همومك إلى الذي لا ينام.
وقفة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ قال ابن عباس: «السِّنة: النُّعاس».
عمل
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ اذكره قبل أن تنام، ليرعاك بعينه التي لا تنام .
عمل
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نتلوها كل ليلة قبل أن ننام؛ ليحفظنا الله ويرعانا بعينه التي لا تنام.
لمسة
[255] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ المتعارف عليه أن يأتي النعاس ثم ينام الإنسان، ولهذا جاءت (سِنَةٌ) في ترتيب الآية قبل النوم، وهذا ما يعرف بتقديم السبق، فهو سبحانه لا يأخذه حتى ما يتقدم النوم من الفتور، ولم يقل سبحانه: (لا تأخذه سنة ونوم) أو (سنة أو نوم)، ففي قوله: (سنة ولا نوم) ينفيهما سواءً اجتمعا أو افترقا؛ لكن لو قال سبحانه: (سنة ونوم) فإنه ينفي الجمع ولا ينفي الإفراد، فقد تأخذه سنة دون النوم، أو يأخذه النوم دون السنة.
وقفة
[255] لا يصلح توكل القلب إلا على من ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾.
وقفة
[255] ﴿لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ قولوا لأغنى رجل في العالم: «أنت أحد ممتلكات الله».
وقفة
[255] ﴿لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تأمل في أعظم مساحة يملكها تاجر أو حاكم؛ إنها ذرة في هذا الكون الفسيح، وهي تشير -أيضًا- إلى أن ما في أيدي الخلق فمآله إليه، فتبارك من وسع ملكه وسلطانه السماوات والأرض والدنيا والآخرة.
وقفة
[255] من مناسبة قوله تعالى: ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ بعد التوحيد ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ أن قوله: ﴿ مَا ﴾ عام، فكل ما في السموات والأرض لله، مملوك من مماليكه وعبدٌ من عبيده، فكيف يعبد العبد عبدًا ولا يعبد مالكه؟!
وقفة
[255] من مناسبة قوله تعالى: ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ بعد التوحيد ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ أنَّ القلوب متعلِّقة بمن يرزقها كما في قول إبراهيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّـهِ الرِّزْقَ﴾ [العنكبوت:17]، فدلهم على العبوديَّة من الباب الذي يَرغبونه.
وقفة
[255] ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل؛ أنه لا يتجاسر أحدٌ على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة.
وقفة
[255] ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ تذكرك الدائم أن الله يراقبك في السر والعلن، ويعلم ما تخفي وما تعلن؛ يساعدك على التقليل من المعاصي.
لمسة
[255] ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾لم يقل: (بعلمه)، فهم لا يحيطون بعلمه، ولا بشيء من علمه، بل هم إن علموا (شيء) فإنما يعلمونه من وجه دون وجه، أي: بغير إحاطة.
وقفة
[255] قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ ولم يقل: (ولا يعلمون شيئًا من علمه)؛ لأن الإحاطة تقتضي الإحتواء على جميع أطراف الشيء، بحيث لا يشذُّ منه جزء من أوله ولا آخره، فأراد ربنا أن يصور لنا قصر علمنا وضعف مداركنا، فنحن قد نعلم شيئًا كان مجهولًا بالأمس، ولكننا لا نستطيع أن نحيط بكل ما يلزم عنه، ولا نقدر على إدراك كل ما له به صلة، ولذلك فإن علومنا قابلة للتبديل والتعديل، وانظر أيضًا إلى قوله تعالى: ﴿بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾، ولم يقل: (ولا يحيطون بعلمه) وهذا مزيد من الدقة في تصغير معارفنا وعلومنا.
وقفة
[255] ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال: ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾.
وقفة
[255] ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ قال ابن عباس: «الكرسي: موضع قدميه».
وقفة
[255] ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ من حفظ السماء والأرض لن يعجزه أن يحفظك من كل سوء، فاعبده وتوكل عليه.
وقفة
[255] ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ قال ابن عباس: «لا يثقل عليه».
وقفة
[255] ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ قال الماوردي: «وفي الفرق بين العلي والعالي وجهان: أحدهما: أن العالي هو الموجود في محل العلو؛ وإن لم يكن مستحقًّا للعلو، والعلي هو المستحق للعلو. الثاني: أن العالي هو الذي يجوز أن يُشارَك، والعلي هو الذي لا يجوز أن يُشارَك».
لمسة
[255] ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر، فهو وحده العلي؛ أي: ذو العلو المطلق، وهو الارتفاع فوق كل شيء، و﴿الْعَظِيمُ﴾ ؛ أي: ذو العظمة في ذاته وسلطانه وصفاته.
وقفة
[255] ﴿الْعَظِيمُ﴾ قال ذو النُّون: «من أراد التواضع فلْيُوَجِّه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوبُ وتصفو، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطانُ نفسه؛ لأن النفوس كلَّها فقيرةٌ عند هيبته».
وقفة
[255] ﴿الْعَظِيمُ﴾ اســم الله (العـظـيم): العظمة في كل شيء.
لمسة
[255، 256] ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ فيها نفي وإثبات؛ نفي الألوهية وإثباتها لله وحده، وهذا من التخلية قبل التحلية، وقد فصل هذا أيضًا في الآية التي تليها: ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾.
الإعراب :
- ﴿ اللَّهُ لا إِلهَ: ﴾
- الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. لا: نافية للجنس تعمل عمل إنّ. إله: اسم «لا» النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف وجوبا.
- ﴿ إِلَّا هُوَ: ﴾
- : إلّا: أداة استثناء. هو. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل من موضع «لا إِلهَ» لأن موضع «لا» وما عملت فيه رفع بالابتداء ولو كان موضع المستثنى نصبا لكان إلا إياه وخبر «لا» النافية للجنس محذوف تقديره: كائن أو موجود وجملة «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ» في محل رفع خبر أول للفظ الجلالة المبتدأ.
- ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ: ﴾
- الحي: خبر ثان للفظ الجلالة مرفوع بالضمة ويجوز إعرابه: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. ويجوز أن يكون بدلا من «هُوَ» وأن يكون بدلا من «لا إِلهَ». القيوم: خبر ثالث للمبتدأ لفظ الجلالة. ويجوز إعرابه: صفة للحيّ مرفوعا بالضمة.
- ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ: ﴾
- في محل رفع تأكيد للقيوم. لا: نافية لا عمل لها. تأخذه: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. سنة فاعل مرفوع بالضمة. • وَلا نَوْمٌ: الواو: عاطفة. لا: زائدة لتأكيد معنى النفي. نوم: معطوف على «سِنَةٌ» مرفوع مثلها بالضمة. والسنة: هي ما يتقدم للنوم من الفتور الذي يسمى النعاس. و «لا نَوْمٌ» تأكيد لما قبلها.
- ﴿ لَهُ ما فِي السَّماواتِ: ﴾
- له: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. في السموات: جار ومجرور متعلق بجملة الصلة المحذوفة والتقدير: ما هو. كائن واستقر في السموات.
- ﴿ وَما فِي الْأَرْضِ: ﴾
- : الواو: عاطفة. ما في الأرض: معطوفة على «ما فِي السَّماواتِ» وتعرب اعرابها.
- ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي: ﴾
- من: إسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع خبر «مَنْ». الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من «ذَا» أو صفة لها
- ﴿ يَشْفَعُ عِنْدَهُ: ﴾
- يشفع: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يَشْفَعُ» صلة الموصول لا محل لها. عنده: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيشفع. والهاء: ضمير متصل في محل جر بالاضافة
- ﴿ إِلَّا: ﴾
- حرف تحقيق. ويجوز اعتبارها أداة استثناء بعد تقدير: الّا من أذن له الرحمن وتكون «إسما موصولا مستثنى بإلّا والسنة: ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس «وَلا نَوْمٌ» تأكيد.
- ﴿ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيشفع. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة. يعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة. يعلم: في محل نصب حال.
- ﴿ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: ﴾
- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف. أيديهم: مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء للثقل. وضمير الغائبين «هم» مبني على السكون في محل جر مضاف إليه يعود على الاسم الموصول «ما فِي السَّماواتِ» أو لما دل عليه «مَنْ ذَا» من الملائكة والأنبياء وصلة الموصول المحذوفة المتعلق بها الظرف تقديرها: ما هو. كائن بين أيديهم.
- ﴿ وَما خَلْفَهُمْ: ﴾
- الواو: عاطفة. ما خلف: معطوفة على «ما بَيْنَ» وتعرب إعرابها و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.
- ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ: ﴾
- الواو: عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. يحيطون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. بشيء: جار ومجرور متعلق بيحيطون.
- ﴿ مِنْ عِلْمِهِ: ﴾
- حرف جر بياني. علمه: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير متصل في محل جّر بالاضافة والجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة من شيء.
- ﴿ إِلَّا بِما شاءَ: ﴾
- : إلّا: حرف تحقيق بعد النفي أو أداة حصر. بما: الباء حرف جّر و «ما»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بيحيطون. شاء: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «شاءَ» صلة الموصول لا محل لها مفعول الفعل محذوف إختصارا بمعنى. إلا بما أراد احاطتهم به.
- ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ: ﴾
- بمعنى استوعب: فعل ماض مبني على الفتح. كرسيّه: فاعل مرفوع بالضمة. والهاء: ضمير متصل في محل جر بالاضافة.
- ﴿ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ: ﴾
- السموات: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. الواو: حرف عطف. الأرض: معطوفة على «السَّماواتِ» منصوبة وعلامة نصبها الفتحة.
- ﴿ وَلا يَؤُدُهُ: ﴾
- أي لا يشق عليه. الواو: إستئنافية. لا: نافية لا عمل لها. يؤده: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم
- ﴿ حِفْظُهُما: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة والهاء: ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم: حرف عماد والألف: حرف دال على التثنية.
- ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ: ﴾
- الواو: استئنافية. هو. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. العلّي: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. العظيم: صفة للعلّي مرفوع مثله بالضمة. والجملة استئنافية. لا محل لها. '
المتشابهات :
| مريم: 64 | ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ |
|---|
| البقرة: 255 | ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ |
|---|
| طه: 110 | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ |
|---|
| الأنبياء: 28 | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ |
|---|
| الحج: 76 | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّـهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [255] لما قبلها : وبعد عرض الأحكام والتشريعات السابقة؛ جاءت هنا آية الكرسي -أعظم آية في القرآن- تسكبُ في القلب الخشيةَ والخشوعَ لهذا الإله العظيم، وتقود العبد لطاعة ربه، والوقوف عند حدوده، قال تعالى:
﴿ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾
القراءات :
القيوم:
قرئ:
1- القيوم، على وزن «فيعول» ، وهى قراءة الجمهور.
2- القيام، وهى قراءة ابن مسعود، وابن عمر، وعلقمة، والنخعي، والأعمش.
3- القيم، وقرأ بها علقمة أيضا.
وسع:
قرئ شاذا:
1- بسكون السين.
2- بسكونها وضم العين، مبتدأ، وخبره: (السموات والأرض) .
يؤوده:
وقرئ شاذا: بحذف الهمزة.
مدارسة الآية : [256] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد .. ﴾
التفسير :
يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة أثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء، فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان، ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته{ فقد استمسك بالعروة الوثقى} أي:بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة من أمره، لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي{ لا انفصام لها} وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم{ والله سميع عليم} فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر، وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها.
الإكراه معناه: حمل الغير على قول أو فعل لا يريده عن طريق التخويف أو التعذيب أو ما يشبه ذلك. والمراد بالدين دين الإسلام والألف واللام فيه للعهد.
والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، مصدر رشد يرشد ويرشد أى اهتدى.
والمراد هنا: الحق والهدى.
والغي ضد الرشد. مصدر من غوى يغوى إذا ضل في معتقد أو رأى، ويرى بعض العلماء أن نفى الإكراه هنا خبر في معنى النهى، أى: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح في دلائله وبراهينه، فمن هداه الله له ونور بصيرته دخل فيه على بصيرة، ومن أضله وأعمى قلبه لا يفيده الإكراه على الدخول فيه.
وقال بعض العلماء إن الجملة هنا على حالها من الخبرية والمعنى: ليس في الدين- الذي هو تصديق بالقلب، وإذعان في النفس- إكراه وإجبار من الله- تعالى- لأحد، لأن مبنى هذا الدين على التمكين والاختيار، وهو مناط الثواب والعقاب، لولا ذلك لما حصل الابتلاء والاختبار، ولبطل الامتحان.
أو المعنى: كما يرى بعضهم- إن من الواجب على العاقل بعد ظهور الآيات البينات على أن الإيمان بدين الإسلام حق ورشد. وعلى أن الكفر به غي وضلال، أن يدخل عن طواعية واختيار في دين الإسلام الذي ارتضاه الله وألا يكره على ذلك بل يختاره بدون قسر أو تردد.
فالجملة الأولى وهي قوله- تعالى-: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ: تنفى الإجبار على الدخول في الدين، لأن هذا الإجبار لا فائدة من ورائه، إذ التدين إذعان قلبي، واتجاه بالنفس والجوارح إلى الله رب العالمين بإرادة حرة مختارة فإذا أكره عليه الإنسان إزداد كرها له ونفورا منه. فالإكراه والتدين نقيضان لا يجتمعان، ولا يمكن أن يكون أحدهما ثمرة للآخر.
والجملة الثانية وهي قوله- تعالى-: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ بمثابة العلة لنفى هذا الإكراه على الدخول في الدين، أى قد ظهر الصبح لذي عينين، وانكشف الحق من الباطل، والهدى من الضلال وقامت الأدلة الساطعة على أن دين الإسلام هو الدين الحق وغيره من الأديان ضلال وكفران ومادام الأمر كذلك فقد توافرت الأسباب التي تدعو إلى الدخول في دين الإسلام، ومن كفر به بعد ذلك فليحتمل نتيجة كفره، وسوء عاقبة أمره.
ثم قال- تعالى-: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها.
الطاغوت: اسم لكل ما يطغى الإنسان، كالأصنام والأوثان والشيطان وكل رأس في الضلال وكل ما عبد من دون الله. وهو مأخوذ من طغا يطغى- كسعى يسعى- طغيا وطغيانا، أو من يطغو طغوا طغوانا، إذا جاوز الحد وغلا في الكفر وأسرف في المعاصي والفجور.
والعروة: في أصل معناها تطلق على ما يتعلق بالشيء من عراه أى من الجهة التي يجب تعليقه منها، وتجمع على عرى. والعروة من الدلو والكوز مقبضه، ومن الثوب مدخل زره.
والوثقى: مؤنث الأوثق، وهو الشيء المحكم الموثق. يقال وثق- بالضم- وثاقة أى: قوى وثبت فهو وثيق أى ثابت محكم.
والانفصام. الانكسار، والفصم كسر الشيء وقطعة.
والمعنى: فمن خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله، وآمن بالله- تعالى- إيمانا خالصا صادقا فقد ثبت أمره واستقام على الطريقة المثلى التي لا انقطاع لها وأمسك من الدين بأقوى سبب وأحكم رباط.
والفاء في قوله: فَمَنْ يَكْفُرْ للتفريع. والسين والتاء في استمسك للتأكيد والطلب، وقوله: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى فيه- كما يقول الزمخشري- تمثيل للمعلوم بالمنظور والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنما ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده والتيقن به، وجملة «لا انفصام لها» استئناف مقرر لما قبله أو حال من «العروة» والعامل «استمسك» .
ثم ختم- سبحانه الآية بقوله: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أى سميع للأقوال، وهمسات القلوب، وخلجات النفوس، عليم بما يسره الناس وما يعلنونه، وسيجازيهم بما يستحقون من ثواب أو عقاب.
قال القرطبي ما ملخصه: قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا الإسلام. وقيل إنها ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية.. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلّم عن أبيه قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق.
قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب. فقال عمر: اللهم اشهد وتلا: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ .
والذي تسكن إليه النفس أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، لأن التدين لا يكون مع الإكراه- كما أشرنا من قبل- ولأن الجهاد ما شرع في الإسلام لإجبار الناس على الدخول في الإسلام إذ لا إسلام مع إجبار، وإنما شرع الجهاد لدفع الظلم ورد العدوان وإعلاء كلمة الله، والرسول صلّى الله عليه وسلّم ما قاتل العرب ليكرههم على الدخول في الإسلام وإنما قاتلهم لأنهم بدءوه بالعداوة.
ولأن الروايات في سبب نزول هذه الآية تؤيد أنه لا إكراه في الدين، ومن هذه الروايات ما جاء عن ابن عباس أنه قال: نزلت في رجل من الأنجر من بنى سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلّى الله عليه وسلّم ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله هذه الآية وفي رواية أخرى أنه حاول إكراههما على الدخول في الإسلام فاختصموا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال الأنصارى: يا رسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر إليه فنزلت الآية.
ولأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الآيتين وهنا يمكن التوفيق بأن نقول:
إن الآية التي معنا تنفى إكراه الناس على اعتقاد ما لا يريدون وآية يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ جاءت لحض النبي صلّى الله عليه وسلّم وحض أصحابه على قتال الكفار الذين وقفوا في طريق دعوته، حتى يكفوا عن عدوانهم وتكون كلمة الله هي العليا.
ثم بين- سبحانه- حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة الكافرين فقال- تعالى-:
يقول تعالى : ( لا إكراه في الدين ) أي : لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه ، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا . وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار ، وإن كان حكمها عاما .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )
وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه . وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به ، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم : أنها نزلت في ذلك .
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد الجرشي عن زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد [ بن جبير ] عن ابن عباس قوله : ( لا إكراه في الدين ) قال : نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له : الحصيني كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله فيه ذلك .
رواه ابن جرير وروى السدي نحو ذلك وزاد : وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما ، فنزلت هذه الآية .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسق قال : كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول : ( لا إكراه في الدين ) ويقول : يا أسق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين .
وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . وقال آخرون : بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام ، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية ، قوتل حتى يقتل . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : ( ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) [ الفتح : 16 ] وقال تعالى : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) [ التحريم : 9 ] وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ) [ التوبة : 123 ] وفي الصحيح : " عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل " يعني : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة .
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن حميد عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " أسلم " قال : إني أجدني كارها . قال : " وإن كنت كارها " فإنه ثلاثي صحيح ، ولكن ليس من هذا القبيل ، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له : " أسلم وإن كنت كارها ؛ فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص " .
وقوله : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) أي : من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم .
قال أبو القاسم البغوي : حدثنا أبو روح البلدي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم ، عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن فائد العبسي قال : قال عمر رضي الله عنه : إن الجبت : السحر ، والطاغوت : الشيطان ، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال ، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان من أمه ، وإن كرم الرجل دينه ، وحسبه خلقه ، وإن كان فارسيا أو نبطيا . وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره .
ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية ، من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها .
وقوله : ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) أي : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب ، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد ولهذا قال : ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) .
قال مجاهد : ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) يعني : الإيمان . وقال السدي : هو الإسلام . وقال سعيد بن جبير والضحاك : يعني لا إله إلا الله . وعن أنس بن مالك : ( بالعروة الوثقى ) : القرآن . وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبغض في الله .
وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها .
وقال معاذ بن جبل في قوله : ( لا انفصام لها ) أي : لا انقطاع لها دون دخول الجنة .
وقال مجاهد وسعيد بن جبير : ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) ثم قرأ : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [ الرعد : 11 ] .
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال : كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع ، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما فقال القوم : هذا رجل من أهل الجنة . فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له : إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا . قال : سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم ، وسأحدثك لم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خضراء - قالابن عون : فذكر من خضرتها وسعتها - وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة ، فقيل لي : اصعد عليه فقلت : لا أستطيع . فجاءني منصف قال ابن عون : هو الوصيف ، فرفع ثيابي من خلفي ، فقال : اصعد . فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال : استمسك بالعروة . فاستيقظت وإنها لفي يدي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه . فقال : " أما الروضة فروضة الإسلام ، وأما العمود فعمود الإسلام ، وأما العروة فهي العروة الوثقى ، أنت على الإسلام حتى تموت " .
قال : وهو عبد الله بن سلام أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون وأخرجه البخاري من وجه آخر ، عن محمد بن سيرين به .
طريق أخرى وسياق آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال : قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه ، فقلت له : قال بعض القوم : كذا وكذا . فقال : الجنة لله يدخلها من يشاء ، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ، رأيت كأن رجلا أتاني فقال : انطلق . فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما فعرضت لي طريق عن يساري ، فأردت أن أسلكها . فقال : إنك لست من أهلها . ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل فإذا أنا على ذروته ، فلم أتقار ولم أتماسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة فقال : استمسك . فقلت : نعم . فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة ، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " رأيت خيرا ، أما المنهج العظيم فالمحشر ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة ، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء ، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام ، فاستمسك بها حتى تموت " . قال : فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة . قال : وإذا هو عبد الله بن سلام .
وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان ، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن الحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه . وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به .
القول في تأويل قوله : لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
فقال بعضهم: نـزلت هذه الآية في قوم من الأنصار- أو في رجل منهم - كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام.
* ذكر من قال ذلك:
5812 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، &; 5-408 &; عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتا، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنـزل الله تعالى ذكره: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
5813 - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: كانت المرأة تكون مقلى ولا يعيش لها ولد = قال شعبة. وإنما هو مقلات = فتجعل عليها إن بقي لها ولد لتهودنه. قال: فلما أجليت بنو النضير كان فيهم منهم، فقالت الأنصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنـزلت هذه الآية: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي". قال: من شاء أن يقيم أقام، ومن شاء أن يذهب ذهب (66) .
5814 - حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا داود= وحدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية، عن داود= عن عامر، قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتا لا يعيش لها ولد، فتنذر إن عاش ولدها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم، فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم، فقالوا: إنما جعلناهم على دينهم، ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا! وإذ جاء الله بالإسلام فلنكرهنهم! فنـزلت: " لا إكراه في الدين "، فكان &; 5-409 &; فصل ما بين من اختار اليهودية والإسلام، فمن لحق بهم اختار اليهودية، ومن أقام اختار الإسلام= ولفظ الحديث لحميد.
5815 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت داود، عن عامر، بنحو معناه= إلا أنه قال: فكان فصل ما بينهم، إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، فلحق بهم من كان يهوديا ولم يسلم منهم، وبقي من أسلم.
5816 - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عامر بنحوه= إلا أنه قال: إجلاء النضير إلى خيبر، فمن اختار الإسلام أقام، ومن كره لحق بخيبر (67) .
5817 - حدثني ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، قال: نـزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنـزل الله فيه ذلك (68) .
5818 - حدثني المثنى قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" قال: نـزلت هذه في الأنصار، قال: قلت خاصة! قال: خاصة! قال: كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن ولدت ولدا أن تجعله في اليهود، &; 5-410 &; تلتمس بذلك طول بقائه. قال: فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلما أجليت النضير قالوا: يا رسول الله، أبناؤنا وإخواننا فيهم، قال: فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله تعالى ذكره: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم " قال: فأجلوهم معهم (69) .
5819 - حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" إلى: لا انْفِصَامَ لَهَا قال: نـزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين: كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت. فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبي الحصين، فدعوهما إلى النصرانية، فتنصرا فرجعا إلى الشام معهم. فأتى أبوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال (70) إن ابني تنصرا وخرجا، فأطلبهما؟ فقال: " لا إكراه في الدين " (71) .
ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب، وقال: أبعدهما الله! هما أول من كفر! فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما، فنـزلت: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [ سورة النساء: 65] ثم إنه نسخ: " لا إكراه في الدين " فأمر بقتال أهل الكتاب في" سورة براءة " (72) .
5820 - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: " لا إكراه في الدين " قال: كانت اليهود ، يهود بني النضير، (73) أرضعوا رجالا من الأوس، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم، قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم، ولندينن بدينهم! فمنعهم أهلوهم، وأكرهوهم على الإسلام، ففيهم نـزلت هذه الآية.
5821 - حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان= وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد = جميعا، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد: " لا إكراه في الدين "، قال: كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة، فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فنـزلت: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
5822 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني الحجاج، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: كانت النضير يهودا فأرضعوا،= ثم ذكر نحو حديث محمد بن عمرو، عن أبي عاصم= قال ابن جريج، وأخبرني عبد الكريم، عن مجاهد: أنهم كانوا قد دان بدينهم أبناء الأوس، (74) دانوا بدين النضير.
5823 - حدثني المثنى، قال: لنا إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: أن المرأة من الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها لتجعلنه في أهل الكتاب، فلما جاء الإسلام قالت الأنصار: &; 5-412 &; يا رسول الله ألا نكره أولادنا الذين هم في يهود على الإسلام، فإنا إنما جعلناهم فيها ونحن نرى أن اليهودية أفضل الأديان؟ فلما إذ جاء الله بالإسلام، (75) .
أفلا نكرههم على الإسلام؟ فأنـزل الله تعالى ذكره: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
5824 - حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن داود، عن الشعبي مثله = وزاد: قال: كان فصل ما بين من اختار اليهود منهم وبين من اختار الإسلام، إجلاء بني النضير، فمن خرج مع بني النضير كان منهم، ومن تركهم اختار الإسلام (76) .
5825 - حدثني يونس، قال: أخبرنا بن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: " لا إكراه في الدين " إلى قوله: " العروة الوثقى " قال: قال منسوخ.
5826 - حدثني سعيد بن الربيع الرازي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ووائل، عن الحسن: أن أناسا من الأنصار كانوا مسترضعين في بني النضير، فلما أجلوا أراد أهلوهم أن يلحقوهم بدينهم، فنـزلت: " لا إكراه في الدين ".
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية، ولكنهم يقرون على دينهم. وقالوا: الآية في خاص من الكفار، ولم ينسخ منها شيء.
* ذكر من قال ذلك:
5827 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن &; 5-413 &; قتادة: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، قال: أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أميه ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج، ولم يفتنوا عن دينهم، فيخلى عنهم (77) .
5828 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا قتادة في قوله: " لا إكراه في الدين "، قال: هو هذا الحي من العرب، أكرهوا على الدين، لم يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام، وأهل الكتاب قبلت معهم الجزية، ولم يقتلوا.
5829 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " لا إكراه في الدين "، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا " لا إله إلا الله "، أو السيف. ثم أمر فيمن سواهم بأن يقبل منهم الجزية، فقال: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
5830 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " لا إكراه في الدين "، قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف. قال: ولا يكره اليهود ولا النصارى والمجوس، إذا أعطوا الجزية.
5831 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني: يا جرير أسلم. ثم قال: هكذا كان يقال لهم.
5832 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: &; 5-414 &; حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية.
* * *
وقال آخرون: هذه الآية منسوخة، وإنما نـزلت قبل أن يفرض القتال.
* ذكر من قال ذلك:
5833 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله تعالى ذكره: " لا إكراه في الدين "، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحدا في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم، فاستأذن الله في قتالهم فأذن له.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نـزلت هذه الآية في خاص من الناس- وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: " لا إكراه في الدين "، أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا (78) .
وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لما قد دللنا عليه في كتابنا( كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام ): من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ، فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه الخصوص، فهو من الناس والمنسوخ بمعزل (79) .
وإذ كان ذلك كذلك = وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه &; 5-415 &; أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه الآخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم = (80) كان بينا بذلك أن معنى قوله: " لا إكراه في الدين "، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام.
ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربة.
* * *
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن ابن عباس وعمن روي عنه: من أنها نـزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام؟
قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنـزل في خاص من الأمر، ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنـزلت فيه. فالذين أنـزلت فيهم هذه الآية - على ما ذكر ابن عباس وغيره - إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام، وأنـزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم، ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها، وإقرارهم عليها، على النحو الذي قلنا في ذلك.
* * *
قال أبو جعفر: ومعنى قوله: " لا إكراه في الدين ". لا يكره أحد في دين الإسلام عليه، (81) وإنما أدخلت " الألف واللام " في" الدين "، تعريفا للدين الذي عنى الله بقوله: (82) " لا إكراه فيه "، وأنه هو الإسلام.
&; 5-416 &;
وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيبا من " الهاء " المنوية في" الدين "، (83) فيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلي العظيم، لا إكراه في دينه، قد تبين الرشد من الغي. وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي.
* * *
قال أبو جعفر: وأما قوله: " قد تبين الرشد "، فإنه مصدر من قول القائل: " رشدت فأنا أرشد رشدا ورشدا ورشادا "، وذلك إذا أصاب الحق والصواب (84) .
* * *
وأما " الغي"، فإنه مصدر من قول القائل: " قد غوى فلان فهو يغوى غيا وغواية "، وبعض العرب يقول: " غوى فلان يغوى "، والذي عليه قراءة القرأة: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى [ سورة النجم: 2] بالفتح، وهي أفصح اللغتين، وذلك إذا عدا الحق وتجاوزه، فضل.
* * *
فتأويل الكلام إذا: قد وضح الحق من الباطل، واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه، فتميز من الضلالة والغواية، فلا تكرهوا من أهل الكتابين= ومن أبحت لكم أخذ الجزية منه=، (85) .
[ أحدا] على دينكم، دين الحق، فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له، فإلى ربه أمره، وهو ولي عقوبته في معاده.
* * *
القول في تأويل قوله : فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى " الطاغوت ".
فقال بعضهم: هو الشيطان.
* ذكر من قال ذلك:
5834 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حسان بن فائد العبسي قال: قال عمر بن الخطاب: الطاغوت: الشيطان (86) .
5835 - حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثني ابن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن حسان بن فائد، عن عمر، مثله.
5836 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عمن حدثه، عن مجاهد، قال: الطاغوت: الشيطان.
5837 - حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا زكريا، عن الشعبي، قال: الطاغوت: الشيطان.
5838 - حدثنا المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " فمن يكفر بالطاغوت " قال: الشيطان.
5839 - حدثنا بشر بن معاذ، قال، حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: الطاغوت: الشيطان.
5840 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في قوله: " فمن يكفر بالطاغوت " بالشيطان.
* * *
وقال آخرون: الطاغوت: هو الساحر.
* ذكر من قال ذلك:
5841 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود، &; 5-418 &; عن أبي العالية، أنه قال: الطاغوت: الساحر.
* * *
وقد خولف عبد الأعلى في هذه الرواية، وأنا أذكر الخلاف بعد (87) .
* * *
5842 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عوف، عن محمد، قال: الطاغوت: الساحر (88) .
* * *
وقال آخرون: بل " الطاغوت " هو الكاهن.
* ذكر من قال ذلك:
5843 - حدثني ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: الطاغوت: الكاهن (89) .
5844 - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا داود، عن رفيع، قال: الطاغوت: الكاهن (90) .
5845 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج: " فمن يكفر بالطاغوت "، قال: كهان تنـزل عليها شياطين، يلقون على ألسنتهم وقلوبهم = أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول: - وسئل عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال-: كان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، وهي كهان ينـزل عليها الشيطان.
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي في" الطاغوت "، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.
* * *
وأرى أن أصل " الطاغوت "،" الطغووت " من قول القائل: " طغا فلان يطغوا "، إذا عدا قدره، فتجاوز حده، ك " الجبروت "" من التجبر "، و " الخلبوت " من " الخلب "، (91) . ونحو ذلك من الأسماء التي تأتي على تقدير " فعلوت " بزيادة الواو والتاء. ثم نقلت لامه - أعني لام " الطغووت " فجعلت له عينا، وحولت عينه فجعلت مكان لامه، كما قيل: " جذب وجبذ "، و " جاذب وجابذ "، و " صاعقة وصاقعه "، وما أشبه ذلك من الأسماء التي على هذا المثال.
* * *
فتأويل الكلام إذا: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله، فيكفر به=" ويؤمن بالله "، يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده (92) = فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ، يقول: فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه، كما:-
5846 - حدثني أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن حميد بن عقبة، عن أبي الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته، فوجده في السوق وهو يغرغر، لا يفقهون ما يريد.
&; 5-420 &;
فسألهم: يريد أن ينطق؟ قالوا: نعم يريد أن يقول: "آمنت بالله وكفرت بالطاغوت ". قال أبو الدرداء: وما علمكم بذلك؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه، فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بها. فقال أبو الدرداء: أفلح صاحبكم ! إن الله يقول: " فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الفصام لها والله سميع عليم " (93) .
* * *
القول في تأويل قوله : فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
قال أبو جعفر: " والعروة "، في هذا المكان، مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن، فشبهه في تعلقه به وتمسكه به، بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها، إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته.
وجعل تعالى ذكره الإيمان الذي تمسك به الكافر بالطاغوت المؤمن بالله، ومن أوثق عرى الأشياء بقوله: " الوثقى "
* * *
و " الوثقى "،" فعلى " من " الوثاقة ". يقال في الذكر: " هو الأوثق "، وفي الأنثى: " هي الوثقى "، كما يقال: " فلان الأفضل، وفلانة الفضلى ".
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5847 - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " بالعروة الوثقى "، قال: الإيمان.
5848 - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
5849 - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، قال: " العروة الوثقى "، هو الإسلام.
5850 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي السوداء، عن جعفر - يعني ابن أبي المغيرة - عن سعيد بن جبير قوله: " فقد استمسك بالعروة الوثقى "، قال: لا إله إلا الله (94) .
5851 - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي السوداء النهدي، عن سعيد بن جبير مثله.
5852 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، الضحاك: " فقد استمسك بالعروة الوثقى "، مثله.
* * *
القول في تأويل قوله : لا انْفِصَامَ لَهَا
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " لا انفصام لها "، لا انكسار لها." والهاء والألف "، في قوله: " لها " عائد على " العروة ".
* * *
ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه، وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عراها (95) .
* * *
وأصل " الفصم " الكسر، ومنه قول أعشى بني ثعلبة:
ومبســمها عــن شــتيت النبـات
غـــير أكـــس ولا منفصـــم (96)
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
5853 - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " لا انفصام لها "، قال: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
5854 - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
5855 - حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: " لا انفصام لها "، قال: لا انقطاع لها.
* * *
القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: " والله سميع "، إيمان المؤمن بالله وحده، الكافر بالطاغوت، عند إقراره بوحدانية الله، وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد &; 5-424 &; من دون الله=" عليم " بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه، (97) وما انطوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره، وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه، لا ينكتم عنه سر، ولا يخفى عليه أمر، حتى يجازي كلا يوم القيامة بما نطق به لسانه، وأضمرته نفسه، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا.
---------------------------
الهوامش :
(66) الأثران : 5812 ، 5813 -في ابن كثير 2 : 15 ، والدر المنثور 1: 329 قال ابن كثير : "رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به ، ومن وجوه أخرى عن شعبة به نحوه . ورواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به" . والسنن الكبرى للبيهقى 9 : 186 ، وسنن أبي داود -3 : 78 -79 رقم : 2682 . وكان في المطبوعة والمخطوطة في رقم 5813 ، "حدثنا محمد بن جعفر ، عن سعيد" ، وهو خطأ صوابه"شعبة" . وقوله : "قال : من شاء أن يقيم أقام" وهو من كلام سعيد بن جبير ، كما في السنن للبيهقى . والحديث مرفوع هناك إلى ابن عباس وهو الصواب ولكني تركت ما في الطبري على حاله .
وامرأة مقلت (بضم الميم) ومقلات (بكسر الميم) ، هى المرأة التي لايعيش لها ولد . ويأتى أيضًا "مقلات" ، أنها المرأة التي ليس لها إلا ولد واحد . ولكن الأول هو المراد في هذا الأثر .
(67) الآثار 5814 -5816- هى ألفاظ مختلفة لحديث واحد ، وانظر 1 : 329 ، وقال" : أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر" ، ثم انظر الأثرين رقم : 5823 ، 5824 فيما يأتي بعد .
(68) الأثر : 5817 -انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في تحقيق اسم الصحابي في"حصين الأنصاري" غير منسوب ، ثم في باب الكنى"أبو الحصين الأنصاري السالمي" ، وفيهما تحقيق جيد .
وانظر تفسير ابن 2 : 15 ، والدر المنثور 1 : 329 . وانظر الأثر التالي رقم : 5819 .
(69) الأثر : 5818 -في السنن الكبرى للبيهقى 9 : 186 من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة ، وذكره السيوطي في الدر المنثور 1 : 329 وزاد نسبته إلى"سعيد بن منصور ، وعبدبن حميد ، وابن المنذر" وفيها زيادة : "كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت نزورا مقلاتا تنذر لئن ولدت ولدا لتجعلنه في اليهود" وسائر الخبر سواء . وكتب في البيهقي والدر المنثور"مقلاة" بالتاء المربوطة وهو خطأ ، و"امرأة نزرة" (بفتح وكسر" وامرأة نزور" قليلة الولد . وفي الدر"نزورة" وهو خطأ .
(70) في المطبوعة : "إلى رسول الله صلى عليه وسلم" ، والصواب من المخطوطة والدر المنثور .
(71) في المطبوعة : إتمام الآية"قد تبين الرشد من الغى" ، وليس في المخطوطة ولا الدر المنثور .
(72) الأثر : 5819 -في الدر المنثور 1 : 329 ، وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه ، وابن المنذر ، وأشار إليه ابن كثير في تفسيره 2 : 15 . هذا ولم يذكر أبو جعفر هذا الأثر في تفسير آية"سورة النساء" ، ولم يجعلها قولا غير الأقوال التي ذكرها . وهو دليل على اختصاره هذا التفسير ، كما رووا عنه .
(73) في المطبوعة : "كانت في اليهود يهود أرضعوا..." ، وفي المخطوطة كانت اليهود يهودا أرضعوا" وهما خطأ . وفي الدر المنثور 1 : 329 : " كانت النضير أرضعت" . واستظهرت أن تكون العبارة أثبتها ، سقط من الناسخ"بني النضير" -أو يكون صوابها كما سيأتى في الأثر رقم : 5822 : "كانت النضير يهودا..." .
(74) في المخطوطة : "قد دانوا بدينهم أبناء الأوس" ، وأخشى أن يكون ما في المطبوعة أصح .
(75) في المطبوعة : "فلما أن جاء الإسلام" ، وفي المخطوطة : "فلما إذ جاء" ، وصواب ذلك ما أثبت .
(76) الأثران : 5823 ، 5824 -انظر الآثار السالفة : 5814 -5816 .
(77) في المخطوطة : " فخلى عنهم" ، وهما سواء .
(78) في المخطوطة : "منسوخ" ، والصواب ما في المطبوعة .
(79) انظر ما قاله فيما سلف في شرط النسخ 3 : 358 ، 563 .
(80) سياق الجملة : "وإذ كان ذلك كذلك ... كان بينا" . وما بين الخطين ، عطوف متتابعة فاصلة بينهما .
(81) "عليه" ، أي على الإسلام .
(82) في المطبوعة والمخطوطة : "تصريفا للدّين" ، وهو تحريف ، والصواب الواضح ما أثبت .
(83) قوله : "عقيبا" أي بدلا وخلفا منه . أصله من العقيب : وهو كل شيء أعقب شيئا .
وعقيبك : هو الذي يعاقبك في العمل ، يعمل مرة ، وتعمل أنت مرة .
(84) انظر ما سلف في معنى"رشد" 3 : 484 ، 485 .
(85) أي ، فلا تكرهوا من أهل الكتاب... أحدا على دينكم...والزيادة مما يقتضيه السياق .
(86) الأثر : 5834 -"حسان بن فائد العبسي" . روى عنه أبو إسحق السبيعي . قال أبو حاتم"شيخ" ، وقال البخاري يعد في الكوفيين . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . مترجم في التهذيب ، والكبير 2/ 1/ 28 ، وابن أبي حاتم 1/2 /223 . وكان في المطبوعة : "العنسي" ، والصواب من المخطوطة . وهذا الأثر ساقه ابن كثير بتمامه في تفسيره 2 : 16 -17
(87) في لأثر الآتي رقم : 5844 .
(88) الأثر : 5842 -حماد بن مسعدة ، سلف ترجمته في رقم : 3056 . وكان في المطبوعة"حميد بن مسعدة" ، وهو هنا خطأ ، صوابه من المخطوطة . أما"حميد بن مسعدة ، فهو شيخ الطبري ، سلف ترجمته في الأثر رقم : 196 .
(89) الأثر : 5843 -كان في المطبوعة والمخطوطة : "حدثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا سعيد" ، والصواب"شعبة" ، وانظر مثل ذلك في هذا الإسناد نفسه مما سلف رقم : 5813 ، والتعليق عليه .
(90) الأثر 5844 -رفيع ، هو أبو العالية الرياحي ، وقد مضت ترجمته مرارا فيما سلف .
(91) في المطبوعة والمخطوطة"الحلبوت من الحلب" بالحاء المملة ، والصواب ما أثبت . يقال : "رجل خلبوت وامرأة خلبوت" ، وهو المخادع الكذوب ، وجاء في الشعر ، وما أصدق ما قال هذا العربى ، وما أبصره بطباع الناس ، وما أصدقه على زماننا هذا :
ملكــتم فلمــا أن ملكــتم خـلبتم
وشــرالملوك الغــادر الخــلبوت
.
(92) اطلب معنى"الإيمان" فيما سلف في فهارس اللغة .
(93) الأثر : 5846-"أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي" ، أبو العباس ، روي عن بقية بن الوليد ، وعثمان بن سعيد الحمصي ، روى عنه النسائي . وذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب وابن أبي حاتم 1/1 / 53 . و"حميد بن عقبة" ، هو : حميد بن عقبة بن رومان بن زرارة القرشي و"يقال ، الفلسطيني . سمع ابن عمر ، وأبا الدرداء . وروى عنه أبو بكر بن مريم والوليد بن سليمان بن أبي السائب . قال أحمد : "حدثنا أبو الغيرة : سألت أبا بكر فقلت : حميد بن عقبة أراه كبيرا ، وأنت تحدث عنه عن أبي الدرداء؟ قال : حدثني أن كل شيء حدثني عن أبي الدرداء ، سمعه من أبي الدرداء" ، مترجم في الكبير 1/ 2/ 347 ، وابن أبي حاتم 1/ 2 /226 ، وتعجيل المنفعة : 106 .
يقال : "فلان في السوق ، وفي السياق" أي في النزع عند الموت ، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه . و"هو يسوق نفسه ويسوق بنفسه" : أي يعالج سكرة الموت ونزعه . ويقال : "غرغر فلان يغرغر" جاد بنفسه عند الموت ، و"الغرغرة" تردد الروح في الحلق ، وأكثر ذلك أن يكون معها صوت ، كغرغرة الماء في الحلق . وقوله : "حتى انكسر لسانه" : أي عجز عن النطق . وكل من عجز عن شيء ، فقد انكسر عنه . وهو هنا عبارة جيدة تصور ما يكون في لسان الميت .
* * *
وعند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيها ما نصه :
" يتلوه القول في تأويل قوله : فقد استمسك بالعروة الوثقى .
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا"
ثم يبدا الجزء بعده :
"بسم الله الرحمن الرحيم ،
رب يسر" .
(94) الأثر : 5850 ، 5851-"أبو السوداء" ، هو : "عمرو بن عمران النهدي" ، روي عن المسيب بن عبدخير ، وأبي مجلز ، وعبدالرحمن بن باسط والضحاك بن مزاحم ، وروى عنه حفص ابن عبدالرحمن بن سوقة والسفيانان . ثقه ، مترجم في التهذيب .
(95) في المطبوعة والمخطوطة : "كالتمسك بالوثيق" . والصواب الذي يقتضيه السياق ما أثبت .
(96) ديوانه : 2 من قصيدة من جيد شعر الأعشى ، وقبله أبيات من تمام معناه: أتهجــــر غانيــــة أم تلـــم
أم الحـــبل واه بهـــا منجــذم
أم الرشــد أحجــى فــإن امـرءا
ســــينفعه علمــه إن علـــم
كمـــا راشــد تجــدن امــرءا
تبيـــن , ثـم انتهــى إذ قــدم
عصــى المشــفـقين إلــى غيـه
وكـــل نصيـــح لــه يتهــم
ومــا كـــان ذلــك إلا الصبــا
وإلا عقــاب امــرئ قــد أثــم
ونظـــرة عيــن عــلى غــرة
محـــل الخــليط بصحــراء زم
ومبســــــــمها ..............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فبـانت وفـي الصـدر صـدع لهــا
كصــدع الزجاجــة مــا يلتئــم
وقوله : "ومبسهما" منصوب عطفا ما قبله ، وهو مصدر ميمى ، أي ابتسامها . والشتيت : المتفرق المفلج ، يعنى : عن ثغرها شتيت النبات ، غير متراكب نبتة الأسنان . والأكس ، من الكسس (بفتحتين) : وهو أن يكون الحنك الأعلى أقصر من الأسفل ، فتكون الثنيتان العلييان وراء السفليين من داخل الفم . وهو عيب في الخلفية . ورواية الديوان : "منقصم" وهي أجود معنى . يقال : ينصدع الشيء دون أن يبين . وأما"القصم" فهو أن ينكسر كسرا فيه بينونة . ولكن الطبري استشهد به على"الفصم" بالفاء . وكلاهما عيب .
وكان البيت مصحفا في المطبوعة : "... عن سنب النبات غير كسر" ، والصواب في المخطوطة ، ولكنه غير منقوط فأساؤوا قراءته .
(97) السياق : "بما عزم عليه... قلبه" ، مرفوعا فاعل"عزم" .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[256] ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضًا وقَبول، فلا إكراه في دين الله تعالى.
وقفة
[256] ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ في دخوله لا في الخروج منه، فالخروج منه بعد القناعة والرضا هو عبث ولعب واستهزاء، وطعن مبطن وتجريء لآخرين.
وقفة
[256] ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خَفيِّةٍ أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح؛ فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين؛ لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحًا.
وقفة
[256] الإيمان بالله وتوحيده قائمان على الاختيار والطوع، وقد رفع الله الإكراه في الدين كله ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فلا إكراه في العبادة ولا في الطاعة.
وقفة
[256] الفرق بين الرُشد والرَشَد والرشاد:
- الرُّشْد يقال في الأمور الدنيوية والأُخروية، فهي أعمّ مثل: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ في الدنيا.
- الرَّشَد ففي الأمور الآخروية فقط: ﴿وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 24].
- الرشاد هو سبيل القصد والصلاح: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29].
وقفة
[256] ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ كلمة (طاغوت) مبالغة من الطغيان, وهو يتنوع, فمرة يكون الطاغوت شيطانًا, أو كاهنًا, أو ساحرًا، أو حاكمًا.
وقفة
[256] ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الطاغوت: الشيطان».
وقفة
[256] ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ﴾ قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن التخلية قبل التحلية, فلابد أن يتخلى العبد عن الطاغوت أولًا قبل إعلان إيمانه بالله, فقبل أن تكوي الثوب وتعطره لابد لك أن تغسله وتنظفه.
وقفة
[256] ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ لن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالطاغوت.
وقفة
[256] ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ﴾ (قد) إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، أي تحقق استمساكه، وأحيانًا تغير معنى الفعل من دعاء إلى خبر، مثلًا تقول: (رزقك الله) محتمل أنك تدعو له بالرزق، وتحتمل أنك تخبره أن الله رزقه وأعطاه، لكن لو قلت: (قد رزقك الله) لا يمكن أن تكون دعاء، وإنما إخبار، لذا لا يصح أن تقول: (قد غفر الله لك)، وإنما تقول: (غفر الله لك).
وقفة
[256] ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب، حسن في الصفات: (سميع) من أجل النطق، (عليم) من أجل المعتقد.
وقفة
[256] ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ قال ابن عباس: «لا إله إلا الله».
عمل
[256] ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ لا تحمل هم العروة؛ لا انكسار لها، ولكن تعاهد استمساك يديك بها.
وقفة
[256] ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ العروة الوثقى هي الإيمان أو الإسلام أو التوحيد، فلتفلت كل العرى من يديك، ولتقبض على عروة الدين؛ لتبحر آمنًا في بحر الحياة الهائج نحو شطآن النجاة.
وقفة
[256] ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ الاستمساك بكتاب الله وسُنَّة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة.
وقفة
[256] ﴿لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ إلا إن أراد العبد انفصامها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].
الإعراب :
- ﴿ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ: ﴾
- لا: نافية للجنس تعمل عمل «إن» إكراه: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. في الذين: جار ومجرور متعلق بخبر «لا» المحذوف وتقديره: كائن أو موجود بمعنى لا: اجبار في الدين.
- ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ: ﴾
- قد: حرف تحقيق. تبيّن: فعل ماض مبني على الفتح.
- ﴿ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ: ﴾
- أي الهدى: فاعل مرفوع بالضمة. من الغي: جار ومجرور متعلق بتبين أي من الضلال.
- ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ: ﴾
- الفاء: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يكفر: فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه: السكون. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. بالطاغوت: جار ومجرور متعلق بيكفر أي بالشيطان. وجملتا فعل الشرط وجوابه: في محل رفع خبر «من».
- ﴿ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ: ﴾
- الواو: عاطفة. يؤمن بالله: معطوفة على «يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ» وتعرب إعرابها. فقد: الفاء رابطة لجواب الشرط. قد: حرف تحقيق.
- ﴿ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى: ﴾
- أي تمسك: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «فَقَدِ اسْتَمْسَكَ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بالعروة جار ومجرور متعلق باستمسك. الوثقى: صفة «نعت» للعروة مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة للتعذر.
- ﴿ لَا انْفِصامَ لَها: ﴾
- تعرب اعراب «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» والجملة في محل نصب على الحال. أي لا انقطاع لها.
- ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: ﴾
- الواو: استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. سميع: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. عليم: خبر ثان للمبتدأ ويجوز إعرابه: صفة لسميع مرفوعا مثله بالضمة. '
المتشابهات :
| البقرة: 256 | ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ |
|---|
| لقمان: 22 | ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج أبو داود والنَّسَائِي عن ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال: كانت المرأة تكون مقلاةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله - عَزَّ وَجَلَّ -لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ). وفي لفظ للنسائي عنه - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهوِّدنه فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية. * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. قال الطبرياختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار، أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هوَّدوهم أو نصَّروهم فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام). اهـ. وقال ابن كثيريقول تعالىلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاماً). اهـ. * النتيجة: أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية لصحة سنده، وتصريحه بالنزول، وموافقته للفظ الآية، واحتجاج المفسرين به والله أعلم.'
- المصدر لباب النقول
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [256] لما قبلها : ولَمَّا اشتملتْ آيةُ الكُرسيِّ على دلائل الوَحدانيَّة، وعظمة الخالق؛ كان ذلك من شأنه أنْ يسوق ذوي العقول إلى قَبُول هذا الدِّين باختيارهم دون جَبْرٍ ولا إكراه، قال تعالى:
﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
القراءات :
قد تبين:
قرئ:
1- بإدغام دال «قد» فى تاء «تبين» ، وهى قراءة الجمهور.
2- بالإظهار، وهى قراءة شاذة.
الرشد:
قرئ:
1- الرشد، على وزن «القفل» ، والرشد، على وزن «العنق» وهما قراءة الجمهور.
2- الرشد، على وزن «الجبل» ، وهى قراءة أبى عبد الرحمن، والشعبي، والحسن، ومجاهد.
3- الرشاد، بالألف، وقد حكيت عن ابن عطية عن أبى عبد الرحمن.