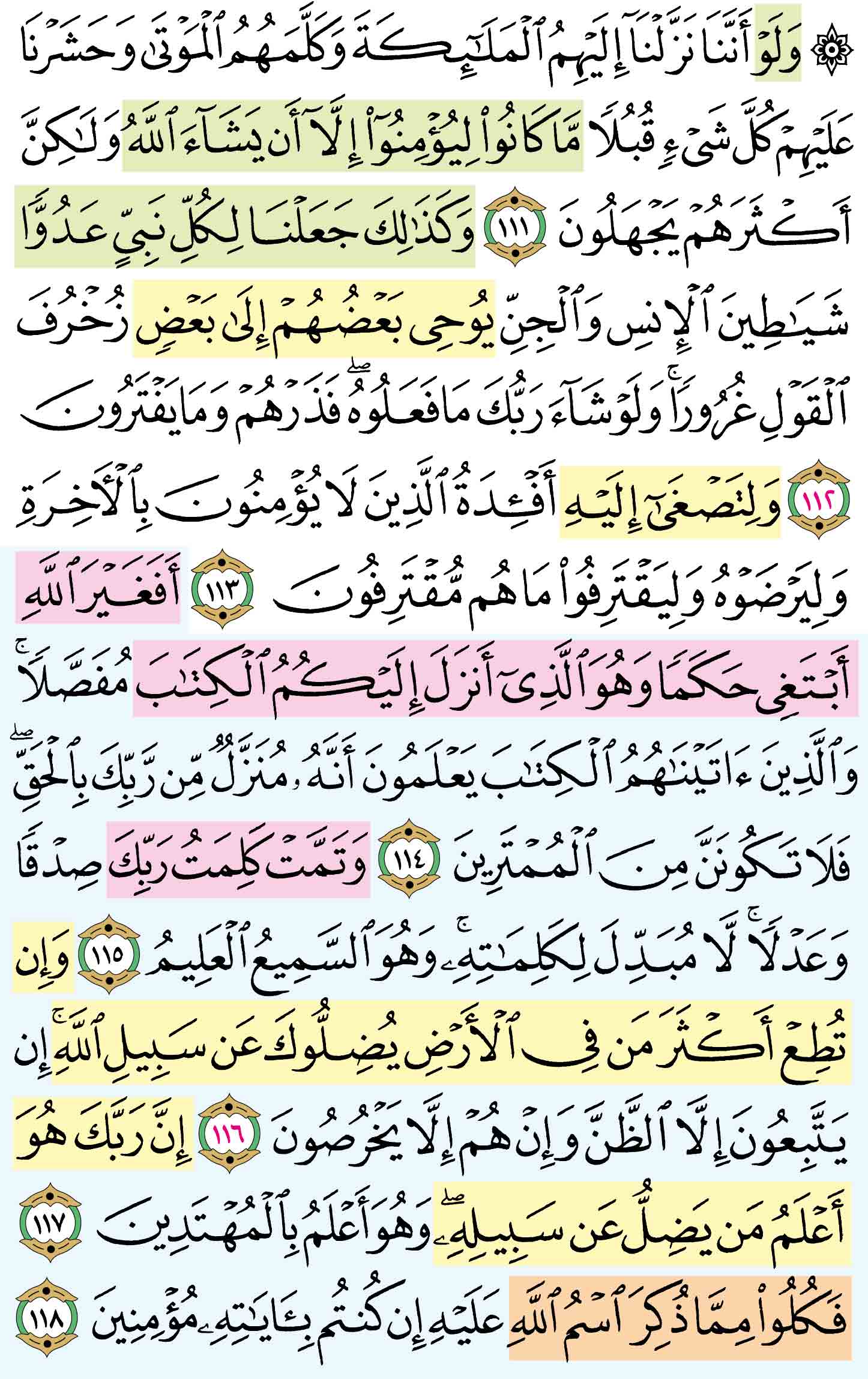
الإحصائيات
سورة الأنعام
| ترتيب المصحف | 6 | ترتيب النزول | 55 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 23.00 |
| عدد الآيات | 165 | عدد الأجزاء | 1.17 |
| عدد الأحزاب | 2.35 | عدد الأرباع | 9.40 |
| ترتيب الطول | 5 | تبدأ في الجزء | 7 |
| تنتهي في الجزء | 8 | عدد السجدات | 0 |
| فاتحتها | فاتحتها | ||
| الثناء على الله: 2/14 | الحمد لله: 2/5 | ||
الروابط الموضوعية
المقطع الأول
من الآية رقم (111) الى الآية رقم (113) عدد الآيات (3)
بعدَ ذكرِ طلبِهم الآياتِ بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه لو أَعْطاهم ما طَلَبُوه مِن الآياتِ والمعجزاتِ لم يؤمنُوا إلا من شاءَ اللهُ له الهدايةَ، ثُمَّ بَيَّنَ أنَّ لكلِّ نبيٍّ أعداءً من الإنسِ والجنِ.
فيديو المقطع
المقطع الثاني
من الآية رقم (114) الى الآية رقم (118) عدد الآيات (5)
بعدَ أن بَيَّنَ اللهُ أنَّ الَّذينَ طلبُوا الآياتِ كاذبونَ، ذكرَ هنا أقوى دليلٍ على صدقِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم ، وهو القرآنُ الكريمُ، وأنَّ أهلَ الكتابِ يعلمُون صدقَه، وأنَّه لا يُستدَلُّ على الحقِّ بكثرةِ أهْلِه.
فيديو المقطع
مدارسة السورة
سورة الأنعام
التوحيد الخالص في الاعتقاد والسلوك/ مجادلة المشركين في إثبات التوحيد والرسالة والبعث/ قذائف الحق
أولاً : التمهيد للسورة :
- • إذًا كيف هذا؟ وما علاقة هذا بالأنعام؟: الأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم. والمشركون من العرب اعترفوا بوجود الله، وكانوا ينظرون للأنعام على أنها الثروة الأساسية وعصب الحياة، فهي الأكل والشرب والمواصلات والثروة. تعامل المشركون من العرب مع الأنعام على أنها تخصهم ولا علاقة لله تعالى بها بزعمهم، فأحلوا وحرموا بعضِ الزروعِ والأنعامِ، وجعلوا لله جزءًا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام، يقدمونه للمساكين وللضيوف، وجعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء للأوثان والأنصاب، ومثل ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام: إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، شقوا أذنها، وتركوها لآلهتهم وامتنعوا عن نحرها وركوبها، وسموها "بحيرة"، وسموا أخرى "سائبة" وأخرى "وصيلة".
- • ما العلاقة بين الأنعام وبين سورة تتحدث عن توحيد الله؟: الله هو الذي خلق الأنعام، وسخرها للإنسان؛ وبالتالي فهو وحده المشرع للأحكام المتعلقة بها.فالتوحيد ليس معناه أنْ يقول المرء في نفسه أنا أوحّد الله وواقع حياته لا يشهد بذلك. وكثير من الناس يوحّدون الله اعتقادًا؛ فهو يجزم بهذا الأمر، ولا مجال للنقاش أو الشك في توحيده لله عزّ وجلْ، ولكن إذا تأملنا واقع حياته، وهل يطبق شرع الله تعالى في كل تصرفاته؟؛ فإننا سنجد أنّ الأمر مختلف. توحيد الله تعالى لا يكون في الاعتقاد فحسبْ، بل لا بد من توحيده في كل تصرفاتنا وحياتنا اليومية.
ثانيا : أسماء السورة :
- • الاسم التوقيفي :: «الأنعام»
- • معنى الاسم :: النَّعَمُ: واحد الأنعام، والأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم.
- • سبب التسمية :: لأنها عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور، وتكرر فيها لفظ (الأنعام) 6 مرات، (أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ)، وجاءت بحديث طويل عنها استغرق 15 آية (من 136 إلى 150).
- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الحجة»، وتسمى الأنعام والأعراف: «الطُّولَيَيْن» (أي: أطول السور المكية).
ثالثا : علمتني السورة :
- • علمتني السورة :: أن توحيد الله لا يكون في الاعتقاد فحسبْ، بل يجب أن يشمل الاعتقاد والسلوك.
- • علمتني السورة :: أن توحيد الله تعالى أجلى حقائق الكون وأوضحها، وأن المنكر لذلك معاند مكابر.
- • علمتني السورة :: أن الله أرحم بنا من أي أحد، ولذا عرفنا بنفسه، وأرسل لنا رسله، وأنزل علينا كتبه، ووعظنا بأحوال السابقين حتى لا نلقي مصيرهم.
- • علمتني السورة :: الأنعام أن الاستغفار من أسباب رفع البلاء وتخفيفه؛ لأن البلاء ينزل بالذنوب: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾
رابعًا : فضل السورة :
- • عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأنعام من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «الْأَنْعَامُ مِنْ نَوَاجِبِ الْقُرْآنِ».
• عَنْ كَعْب الأحبار قَالَ: «فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ: الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا: هُودٌ».
خامسًا : خصائص السورة :
- • أول سورة مكية في ترتيب المصحف.
• نزلت جملة واحدة.
• تعتبر من أطول السور المكية بعد سورة الأعراف؛ لذا توصف الأنعام والأعراف بـ: (الطُّولَيَيْن).
• هي أطول سورة في مُحَاجَّةِ المشركين لإثبات عقيدة التوحيد.
• تكرر فيها لفظ (الأنعام) ست مرات، وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ.
• تكررت فيها كلمة (قل) 44 مرة، وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ.
• أنها أجمع سورة لأحوال العرب في الجاهلية.
• تضمنت أكثر الآيات في مُحَاجَّةِ المشركين لإثبات عقيدة التوحيد.
• ذكرت أسماء 18 رسولًا -من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن- في أربع آيات (الآيات 83-86)، وهي بذلك تكون أكثر سورة ذُكِرَ فيها أسماء الأنبياء، تليها سورة الأنبياء حيث ذُكِرَ فيها أسماء 16 نبيًا.
• اختصت بذكر (الوصايا العشر) التي نزلت في كل الكتب السابقة (الآيات 151- 153).
• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».
سادسًا : العمل بالسورة :
- • أن نوحد الله في الاعتقاد والسلوك، ولا نكون كمشركي العرب في فعلهم في الأنعام.
• أن نُكْثِر من حمد الله سبحانه، فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ...﴾ (1).
• أن نكثر من طاعات السر: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (3).
• أن نأخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (6).
• ألا نحزن إذا استهزأ بنا أحد، ونتذكر الرسل من قبلنا: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (10).
• أن نردد عند الهم بمعصية: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (15).
• ألا نحزن إذا فاتنا شيء من أمور الدنيا، ونعلق همنا بالآخرة: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (32).
• ألا نستغرب تكذيب الناس عندما ندعوهم إلى الخير؛ فإن الناس قد كذبت المرسلين: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا﴾ (34).
• ألا نغتر بما يفتح الله به علينا، فليس كل عطية علامة على رضاه: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ (44)، فالفتح الوارد ذكره هنا ثمرة للعصيان، وهو استدراج؛ كما قال r: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ؛ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ»، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ r: «﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ...﴾».
• أن نبين لمن حولنا حقيقة الكهان والعرافين والمنجمين: ﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّـهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ (50).
• أن نشكر الله دائمًا على نعمه علينا: ﴿اللَّـهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (53).
• أن نسعى في الصلح بين شخصين أو فئتين متنازعتين: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ (65).
• أن نتجنب الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو، ولا نعود لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (68).
• أن نسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه: ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ (71).
• أن نقتدي بأبينا إبراهيم عليه السلام الذي واجه ضلال قومه بثبات ويقين: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (74).
• أن نتنزّل مع الخصوم أثناء النقاش والحوار معهم: ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي﴾ (77). • أن نقتدي بالأنبياء: ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (90).
• أن نلزم الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا نستبدل بهما شيئًا آخر: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ (106).
• ألا نسب آلهة الذين كفروا حتى لا يسبوا الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (108).
• احرص على إطابة مطعمك بأن تأكل المذبوحات التي ذُكِرَ عليها اسم الله، وتترك ما عدا ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (121). • ادع الله تعالى أن يشرح صدرك للحق حيث كان: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّـهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ (125).
• أن نحترس من مجرد الاقتراب من المعاصي؛ فالاقتراب بداية الوقوع: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ (151)، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ (152).
• أن نقبل على كتاب الله متدبرين متعظين بما فيه؛ حتى ننال من بركته وخيره: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (155).
تمرين حفظ الصفحة : 142
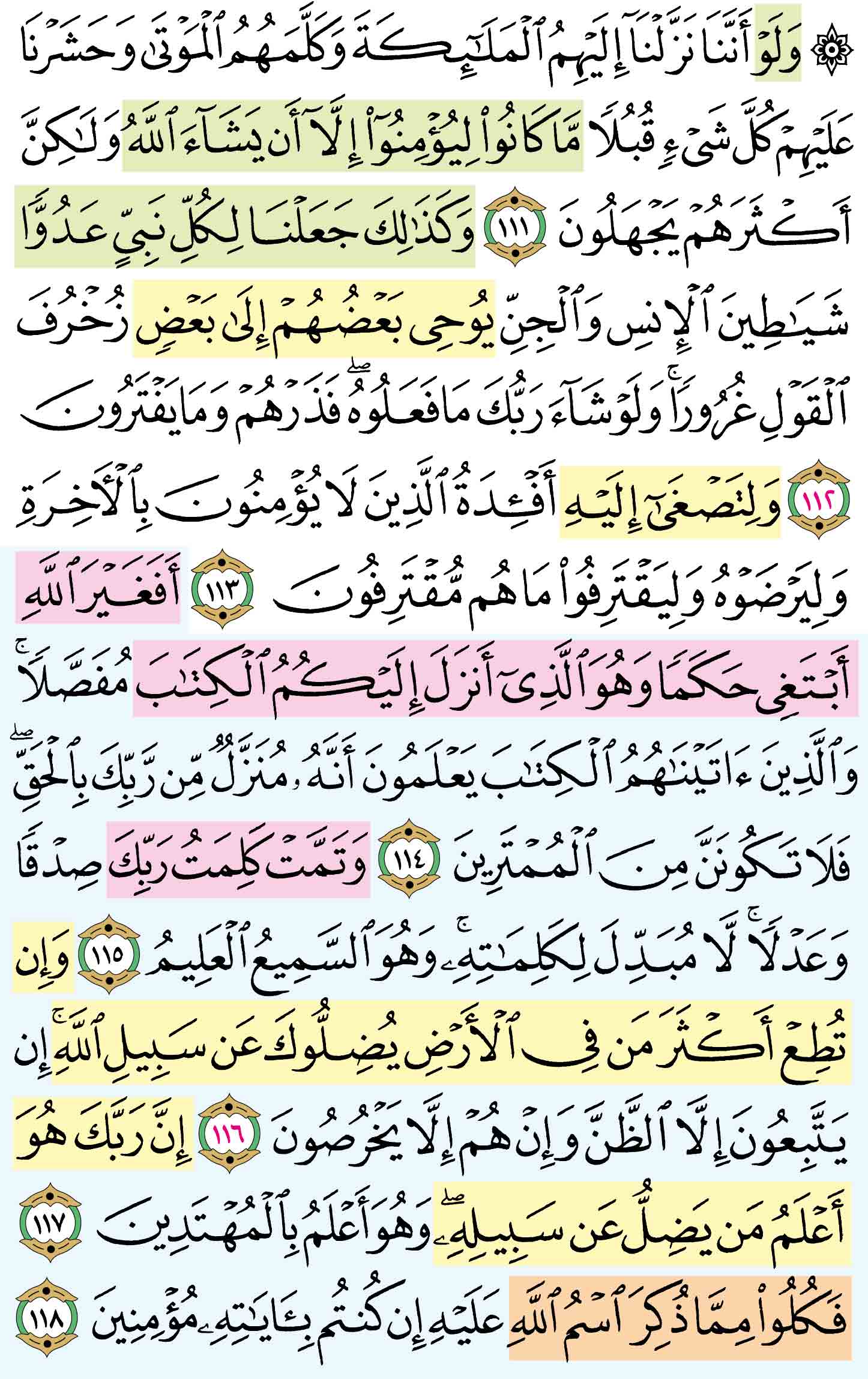
مدارسة الآية : [111] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ .. ﴾
التفسير :
تفسير الآيتين 110 و111:{ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} أي:ونعاقبهم، إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي، وتقوم عليهم الحجة، بتقليب القلوب، والحيلولة بينهم وبين الإيمان، وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله، وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم، وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق، كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم، ومشيئتهم وحدهم، وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة، من تنزيل الملائكة إليهم، يشهدون للرسول بالرسالة، وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم{ قُبُلًا} ومشاهدة، ومباشرة، بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الإيمان، إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم، على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم، أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بينها الله، ويعمل بذلك، ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.
والمعنى: ولو أننا يا محمد لم نقتصر على إيتاء ما اقترحه هؤلاء المشركون من آيات كونية، بل أضفنا إلى ذلك أننا نزلنا عليهم الملائكة يشهدون بصدقك وأحيينا لهم الموتى فشهدوا بحقيقة الإيمان، وزدنا على ذلك فجمعنا لهم جميع الخلائق مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم بأنك على الحق، لو أننا فعلنا كل ذلك ما استقام لهم الإيمان لسوء استعدادهم وفساد فطرهم، وانطماس بصيرتهم، فإن قوما يمرون على تلك الآيات الكونية التي زخر بها هذا الكون والتي استعرضتها هذه السورة فلا تتفتح لها بصائرهم، ولا تتحرك لها مشاعرهم، ليسوا على استعداد لأن يخالط الإيمان شغاف قلوبهم، والذي ينقصهم إنما هو القلب الحي الذي يتلقى ويتأثر ويستجيب وليس الآيات التي يقترحونها فإن أمامهم الكثير منها، واقترحاتهم إنما هي نوع من العبث السخيف، والتعنت المرذول الذي لا يستحق أن يهتم به.
وقُبُلًا- بضم القاف والباء- حال من «كل شيء» وفيه أوجه:
الأول: أنه جمع قبيل بمعنى كفيل مثل قليب وقلب، أى: وحشرنا عليهم كل شيء من المخلوقات ليكونوا كفلاء بصدقك.
والثاني: أنه مفرد كقبل الإنسان ودبره فيكون معناه المواجهة والمعاينة ومنه آتيك قبلا لا دبرا أى آتيك من قبل وجهك والمعنى. وحشرنا عليهم كل شيء مواجهة وعيانا ليشهدوا بأنك على الحق.
والثالث: أن يكون قبلا جمع قبيل لكن بمعنى جماعة جماعة أو صنفا صنفا والمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء فوجا فوجا ونوعا نوعا من سائر المخلوقات ليشهدوا بصدقك.
وجملة ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ جواب لو.
أى: لو فعلنا لهم كل ذلك ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال بسبب غلوهم في التمرد والعصيان، إلا في حال مشيئة الله إيمانهم فيؤمنوا، لأنه- سبحانه- هو القادر على كل شيء.
وقوله وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.
أى: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنوا فهم لذلك يحلفون الأيمان المغلظة بأنهم لو جاءتهم آية ليؤمنن بها. أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات.
وقيل الضمير يعود على المؤمنين فيكون المعنى. ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمان أولئك المشركين عند مجيء الآيات لجهلهم عدم مشيئة الله- تعالى- لإيمانهم، فيتمنون مجيء الآيات طمعا في إيمانهم.
قال الشيخ القاسمى: في قوله إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ حجة واضحة على المعتزلة لدلالته على أن جميع الأشياء بمشيئة الله- تعالى- حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملة شريعتها على أنه «ما شاء الله كان وما لم يشأ لهم يكن» . والمعتزلة يقولون «إلا أن يشاء الله مشيئة قسر وإكراه» .
يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ( لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ) فنزلنا عليهم الملائكة ، أي : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل ، كما سألوا فقالوا : ( أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ) [ الإسراء : 92 ] ( قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) [ الأنعام : 124 ] ، ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) [ الفرقان : 21 ] .
( وكلمهم الموتى ) أي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل ، ( وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ) - قرأ بعضهم : " قبلا " بكسر القاف وفتح الباء ، من المقابلة ، والمعاينة . وقرأ آخرون وقبلا بضمهما قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضا ، كما رواه علي بن أبي طلحة ، والعوفي ، عن ابن عباس . وبه قال قتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
وقال مجاهد : ( قبلا ) أفواجا ، قبيلا قبيلا أي : تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) أي : إن الهداية إليه ، لا إليهم . بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، وهو الفعال لما يريد ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، لعلمه وحكمته ، وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) [ يونس : 96 ، 97 ] .
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد, آيسْ من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثانَ والأصنام ، القائلين لك: " لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك ", فإننا لو نـزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانًا، وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حُجَّةً لك، ودلالة على نبوّتك, وأخبروهم أنك محقٌّ فيما تقول, وأن ما جئتهم به حقٌّ من عند الله, وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهُم لك قبلا ما آمنوا ولا صدّقوك ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم =(ولكن أكثرهم يجهلون)، يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك, يحسبون أن الإيمان إليهم، والكفرَ بأيديهم, متى شاؤوا آمنوا، ومتى شاؤوا كفروا . وليس ذلك كذلك, ذلك بيدي, لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته, ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأضللته .
* * *
وقيل: إن ذلك نـزل في المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم, وما جاء به من عند الله, من مشركي قريش .
* ذكر من قال ذلك:
13755- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج, عن ابن جريج قال: نـزلت في المستهزئين الذين سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم الآية, فقال: قُلْ ، يا محمد، إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ، ونـزل فيهم: (ولو أننا نـزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا) .
* * *
وقال آخرون: إنما قيل: (ما كانوا ليؤمنوا)، يراد به أهل الشقاء, وقيل: (إلا أن يشاء الله)، فاستثنى ذلك من قوله: (ليؤمنوا)، يراد به أهل الإيمان والسعادة .
* ذكر من قال ذلك:
13756- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن ابن عباس قوله: (ولو أننا نـزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا)، وهم أهل الشقاء = ثم قال: (إلا أن يشاء الله)، وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان .
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ ابن عباس, لأن الله جل ثناؤه عمَّ بقوله: (ما كانوا ليؤمنوا)، القوم الذين تقدّم ذكرهم في قوله: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا .
وقد يجوز أن يكون الذين سألوا الآية كانوا هم المستهزئين الذين قال ابن جريج إنهم عُنوا بهذه الآية، ولكن لا دلالة في ظاهر التنـزيل على ذلك، ولا خبر تقوم به حجة بأن ذلك كذلك . والخبر من الله خارجٌ مخرجَ العموم, فالقول بأنَّ ذلك عنى به أهل الشقاء منهم أولى، لما وصفنا .
* * *
واختلفت القرأة في قراءة قوله: (وحشرنا عليهم كل شيء قبلا).
فقرأته قرأة أهل المدينة: " قِبَلا "، بكسر " القاف " وفتح " الباء ", بمعنى: معاينةً= من قول القائل: " لقيته قِبَلا "، أي معاينة ومُجاهرةً .
* * *
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين: ( وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا )، بضم " القاف "،" والباء " .
وإذا قرئ كذلك، كان له من التأويل ثلاثة أوجه:
أحدها أن يكون " القبل " جمع " قبيل "، كالرُّغُف التي هي جمع " رغيف ", و " القُضُب " التي هي جمع " قضيب ", ويكون " القبل "، الضمناء والكفلاء= وإذا كان ذلك معناه, كان تأويل الكلام: وحشرنا عليهم كل شيء كُفَلاء يكفلون لهم بأن الذي نعدهم على إيمانهم بالله إن آمنوا، أو نوعدهم على كفرهم بالله إن هلكوا على كفرهم, ما آمنوا إلا أن يشاء الله .
والوجه الآخر: أن يكون " القبل " بمعنى المقابلة والمواجهة, من قول القائل: " أتيتُك قُبُلا لا دُبُرًا ", إذا أتاه من قبل وجهه .
والوجه الثالث: أن يكون معناه: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلةً قبيلةً, صنفًا صنفًا, وجماعة جماعةً ، فيكون " القبل " حينئذ جمع " قبيل "، الذي هو ج مع " قبيلة ", فيكون " القبل " جمع الجمع . (1)
* * *
وبكل ذلك قد قالت جماعة من أهل التأويل .
* ذكر من قال: معنى ذلك: معاينةً .
13757- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: (وحشرنا عليهم كل شيء قبلا)، يقول: معاينة .
13758- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (وحشرنا عليهم كل شيء قبلا)، حتى يعاينوا ذلك معاينة=(ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) .
* * *
* ذكر من قال: معنى ذلك: قبيلة قبيلة، صنفًا صنفًا .
13759- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن يزيد: من قرأ: (قُبُلا)، معناه: قبيلا قبيلا .
13760- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، قال مجاهد: (قُبُلا)، أفواجًا, قبيلا قبيلا .
13761- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أحمد بن يونس, عن أبي خيثمة قال، حدثنا أبان بن تغلب قال، حدثني طلحة أن مجاهدًا قرأ في" الأنعام ": (كل شيء قُبُلا)، قال: قبائل, قبيلا وقبيلا وقبيلا .
* * *
* ذكر من قال: معناه: مقابلةً .
13762- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (ولو أننا نـزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا)، يقول: لو استقبلهم ذلك كله, لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله .
13763- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وحشرنا عليهم كل شيء قبلا)، قال: حشروا إليهم جميعًا, فقابلوهم وواجهوهم .
13764- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن يزيد: قرأ عيسى: (قُبُلا) ومعناه: عيانًا .
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا, قراءةُ من قرأ: ( وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا )، بضم " القاف " و " الباء "، لما ذكرنا من احتمال ذلك الأوجهَ التي بينّا من المعاني, وأن معنى " القِبَل " داخلٌ فيه, وغير داخل في القبل معاني" القِبَل " .
* * *
وأما قوله: (وحشرنا عليهم)، فإن معناه: وجمعنا عليهم, وسقنا إليهم . (2)
-------------------------
الهوامش :
(1) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 350 ، 351 .
(2) انظر تفسير (( حشر )) فيما سلف 457 : 11 ، تعليق : 5 ، والمراجع هناك .
التدبر :
وقفة
[111] ﴿وَلَو أَننا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وحشرنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيؤمنوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يجهلون﴾ من أعظم الجهل بل هو أعظمه ألا تصل بك الآيات إلى توحيد الله والإيمان به.
وقفة
[111] ﴿وَلَو أَننا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وحشرنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيؤمنوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يجهلون﴾ الآيات على توحيد الله عظيمة لكن يُحجب كثير من الناس عنها بسبب العناد والاستكبار والجهل.
وقفة
[111] ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ يعني جمعنا عليهم، أقمنا عليهم الحجة، أرسلنا عليهم، بعثنا عليهم، أما (إلى) تفيد الانتهاء.
لمسة
[111] عبر الله عن عدم إيمان المشركين بقوله: ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾، ولم يقل: (لا يؤمنون)، لأنها أشد في تقوية نفي إيمانهم مع رؤية المعجزات كلها، لأنهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق.
اسقاط
[111] ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ﴾ إيمانك بمشيئة الله؛ فهل أدركت نعمة الله عليك؟
اسقاط
[111] ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ﴾ إيمانك رهن بمشيئة الله وتوفيقه، فهل أدركت الآن قدر حاجتك إلى ربك؟
عمل
[111] أكثر من دعاء الله سبحانه أن يهديك، ويثبتك على الدين؛ فإن الهداية بيده وحده سبحانه ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا: ﴾
- الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم. أننا:أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «إن». نزّلنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.وجملة «نَزَّلْنا» خبر «أن» و «أن» واسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت. التقدير: لو ثبت إنزالنا أو تنزيلنا الملائكة اليهم ما آمنوا.
- ﴿ إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بنزلنا و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون حرك بالضم لاشباع الميم في محل جر بإلى. الملائكة: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى: ﴾
- الواو: عاطفة. كلم: فعل ماض مبني على الفتح.و«هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وحركت الميم بالضم للاشباع. الموتى: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر.
- ﴿ وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ: ﴾
- معطوفة بالواو على «نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ».شيء: مضاف اليه مجرور بالكسرة المنونة لأنه نكرة.
- ﴿ قُبُلًا: ﴾
- جمع قبيل، أو بمعنى «عيانا» وقيل: جماعات. والكلمة منصوبة على الحال وعلامة نصبها: الفتحة المنونة.
- ﴿ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا: ﴾
- الجملة: جواب شرط غير جازم لا محل لها. ما: نافية لا عمل لها. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة.لِيُؤْمِنُوا: اللام: لام الجحود- حرف جر-. يؤمنوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه: حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف فارقة. و «أن» المضمرة بعد لام الجحود وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بلام الجحود. والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف لكان. والتقدير: ما كانوا مريدين للإيمان. وجملة «يؤمنوا» صلة «أن» المصدرية المضمرة لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ: ﴾
- إلّا: أداة استثناء من الظرف أو المفعول لأجله كأنه قيل ما كانوا ليؤمنوا في جميع الاوقات إلّا وقت أن يشاء الله أو ما كانوا ليؤمنوا إلّا لأن يشاء الله. أن: حرف نصب مصدري. يشاء فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه: الفتحة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. وجملة «يَشاءَ اللَّهُ» صلة «أَنْ» المصدرية لا محل لها من الاعراب. وأن وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة باضافة المستثنى المقدر.أي إلّا وقت مشيئة الله. وهو استثناء منقطع.
- ﴿ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ: ﴾
- الواو: استئنافية. لكنّ: حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك. أكثر: اسم «لكِنَّ» منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. و«هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة. يجهلون:فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يَجْهَلُونَ» في محل رفع خبر «لكِنَّ». '
المتشابهات :
| الأنعام: 111 | ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ﴾ |
|---|
| الأعراف: 101 | ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ﴾ |
|---|
| يونس: 74 | ﴿فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ﴾ |
|---|
| يونس: 13 | ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [111] لما قبلها : وبعد أن أخبر اللهُ عز وجل أن هؤلاء المشركين لن يؤمنوا إذا نزلت الآيات التي اقترحوها؛ جاء هنا التفصيل بعد الإجمال؛ فبَيَّنَ اللهُ هنا أنه لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة، وإحياء الموتى، وجمع لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة؛ لم يؤمنوا، إلا من شاء الله له الهداية، قال تعالى:
﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾
القراءات :
قبلا:
قرى:
1- بكسر القاف وفتح الباء أي: مقابلة وعيانا، وهى قراءة نافع، وابن عامر.
2- بضم القاف والباء، وهى قراءة باقى السبعة.
3- بضم القاف وسكون الباء، على جهة التخفيف من الضم، وهى قراءة الحسن، وأبى رجاء، وأبى حيوة.
4- قبيلا، بفتح القاف وكسر الباء وياء بعدها، وأنتصب على الحال، وهى قراءة أبى، والأعمش.
5- قبلا، بفتح القاف وسكون الباء، وهى قراءة ابن مصرف.
مدارسة الآية : [112] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى -مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم- وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك، ويحاربونك، ويحسدونك، فهذه سنتنا، أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء، من شياطين الإنس والجن، يقومون بضد ما جاءت به الرسل.{ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} أي:يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء، الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا
ثم سلى الله- تعالى- نبيه عن تعنت المشركين وتماديهم في الباطل ببيان أن كل نبي كان له أعداء يسيئون إليه ويقفون عقبة في طريق دعوته فقال:
وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ.
والمعنى: ومثل ما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك- أيضا- أعداء، فلا يحزنك ذلك، قال- تعالى- ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ
.
وقال- تعالى- وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِير .
والمراد بشياطين الإنس والجن، والمردة من النوعين. والشيطان: كل عات متمرد من الإنس والجن.
وجملة وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا إلخ مستأنفة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يشاهده من عداوة قريش له، والكاف في محل نصب على أنها نعت لمصدر مؤكد لما بعده.
وجعل ينصب مفعولين أولهما عَدُوًّا وثانيهما لِكُلِّ نَبِيٍّ وشَياطِينَ بدل من المفعول الأول، وبعضهم أعرب شَياطِينَ مفعولا أولا وعَدُوًّا مفعولا ثانيا، ولِكُلِّ نَبِيٍّ حالا من عَدُوًّا.
وقوله: يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً.
الوحى: الإعلام بالأشياء من طريق خفى دقيق سريع. زخرف القول: باطله الذي زين وموه بالكذب. وأصل الزخرف. الزينة المزوقة، ومنه قيل للذهب: زخرف، ولكل شيء حسن مموه: زخرف.
والغرور: الخداع والأخذ على غرة وغفلة.
والمعنى: يلقى بعضهم إلى بعض بطرق خفية دقيقة القول المزين المموه الذي حسن ظاهره وقبح باطنه لكي يخدعوا به الضعفاء ويصرفونهم عن الحق إلى الباطل.
والجملة مستأنفة لبيان إحكام عداوتهم، أو حال من الشياطين وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أتباعه أن يستعيذوا بالله من شياطين الإنس والجن، فعن أبى ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس. قد أطال فيه الجلوس فقال: «يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين قال: ثم جئت فجلست إليه فقال: يا أبا ذر، هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قال: قلت لا يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال: نعم، هم شر من شياطين الجن» .
وقد ساق الإمام ابن كثير عدة روايات عن أبى ذر في هذا المعنى، ثم قال في نهايتها: فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته» .
وقوله: وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ.
أى: ولو شاء ربك ألا يفعل هؤلاء الشياطين ما فعلوه من معاداة الأنبياء ومن الإيحاء بالقول الباطل لتم له ذلك، لأنه- سبحانه- هو صاحب المشيئة النافذة، والإرادة التامة ولكنه- سبحانه- لم يشأ أن يجبرهم على خلاف ما زينته لهم أهواؤهم باختيارهم، لكي يميز الله الخبيث من الطيب. فدعهم يا محمد وما يفترون من الكفر وغيره من ألوان الشرور، فسوف يعلمون سوء عاقبتهم.
يقول تعالى : وكما جعلنا لك - يا محمد - أعداء يخالفونك ، ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنك ذلك ، كما قال تعالى : ( فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ) [ آل عمران : 184 ] ، وقال تعالى : ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ) [ الأنعام : 34 ] ، وقال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ) [ فصلت : 43 ] ، وقال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ) [ الفرقان : 43 ] . وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي .
وقوله : ( شياطين الإنس والجن ) بدل من ) عدوا ) أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجن ، ومن هؤلاء وهؤلاء ، قبحهم الله ولعنهم .
قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى ( شياطين الإنس والجن ) قال : من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين ، يوحي بعضهم إلى بعض ، قال قتادة : وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن " فقال : أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " .
وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر ، رضي الله عنه ، قال ابن جرير :
حدثنا المثنى ، حدثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة ، عن ابن عائذ ، عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس ، قال ، فقال : " يا أبا ذر ، هل صليت؟ " قال : لا يا رسول الله . قال : " قم فاركع ركعتين " قال : ثم جئت فجلست إليه ، فقال : " يا أبا ذر ، هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ " قال : قلت : لا يا رسول الله ، وهل للإنس من شياطين؟ قال : " نعم ، هم شر من شياطين الجن "
وهذا أيضا فيه انقطاع وروي متصلا كما قال الإمام أحمد :
حدثنا وكيع ، حدثنا المسعودي ، أنبأني أبو عمر الدمشقي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فجلست فقال : " يا أبا ذر هل صليت؟ " قلت : لا . قال : " قم فصل " قال : فقمت فصليت ، ثم جلست فقال : " يا أبا ذر ، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " قال : قلت يا رسول الله ، وللإنس شياطين؟ قال : " نعم " . وذكر تمام الحديث بطوله .
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ، من حديث جعفر بن عون ، ويعلى بن عبيد ، وعبيد الله بن موسى ، ثلاثتهم عن المسعودي ، به .
طريق أخرى عن أبي ذر : قال ابن جرير : حدثني المثنى ، حدثنا الحجاج ، حدثنا حماد ، عن حميد بن هلال ، حدثني رجل من أهل دمشق ، عن عوف بن مالك ، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا ذر ، هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ " قال : قلت يا رسول الله ، هل للإنس من شياطين؟ قال : " نعم " .
طريق أخرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا معان بن رفاعة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن والإنس؟ " قال : يا رسول الله ، وهل للإنس من شياطين؟ قال : " نعم ، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا "
فهذه طرق لهذا الحديث ، ومجموعها يفيد قوته وصحته ، والله أعلم .
وقد روى ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبو نعيم ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن عكرمة : ( شياطين الإنس والجن ) قال : ليس من الإنس شياطين ، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن .
قال : وحدثنا الحارث ، حدثنا عبد العزيز ، حدثنا إسرائيل ، عن السدي ، عن عكرمة في قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) قال : للإنسي شيطان ، وللجني شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن ، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا .
وقال أسباط ، عن السدي ، عن عكرمة في قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض ) في تفسير هذه الآية : أما شياطين الإنس ، فالشياطين التي تضل الإنس ، وشياطين الجن الذين يضلون الجن ، يلتقيان ، فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إني أضللت صاحبي بكذا وكذا ، فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا ، فيعلم بعضهم بعضا .
ففهم ابن جرير من هذا; أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي : الشياطين من الجن الذين يضلون الناس ، لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة ، وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى ، وهو محتمل ، وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذا ، عن ابن عباس من رواية الضحاك ، عنه ، قال : إن للجن شياطين يضلونهم - مثل شياطين الإنس يضلونهم ، قال : فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن ، فيقول هذا لهذا : أضلله بكذا ، أضلله بكذا . فهو قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) .
وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر : إن للإنس شياطين منهم ، وشيطان كل شيء مارده ، ولهذا جاء في صحيح مسلم ، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الكلب الأسود شيطان " ومعناه - والله أعلم - : شيطان في الكلاب .
وقال ابن جريج : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين ، يوحون إلى شياطين الإنس ، كفار الإنس ، زخرف القول غرورا .
وروى ابن أبي حاتم ، عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل ، قال : فقال لي : اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال : فخرجت ، فجاء رجل فقال : ما تقول في الوحي؟ فقلت : الوحي وحيان ، قال الله تعالى : ( بما أوحينا إليك هذا القرآن ) [ يوسف : 3 ] ، وقال الله تعالى : ( شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) قال : فهموا بي أن يأخذوني ، فقلت : ما لكم ذاك ، إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني .
وإنما عرض عكرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد - قبحه الله ، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي ، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات ، ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال : صدق ، قال الله تعالى : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) [ الأنعام : 121 ] ، وقوله تعالى : ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) أي : يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف ، وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره .
( ولو شاء ربك ما فعلوه ) أي : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء .
( فذرهم ) أي : فدعهم ، ( وما يفترون ) أي : يكذبون ، أي : دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم ، فإن الله كافيك وناصرك عليهم .
القول في تأويل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مسلِّيَه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات الله, وحاثًّا له على الصبر على ما نال فيه: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّا)، يقول: وكما ابتليناك، يا محمد، بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطينَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، ليصدُّوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربّك، كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسّل, بأن جعلنا لهم أعداءً من قومهم يؤذُونهم بالجدال والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتك به، لم تخصص به من بينهم وحدك, بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم، مع قدرتي على منع من آذاهم من إيذائهم, فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من غيرهم. يقول: فاصبر أنتَ كما صبر أولو العزم من الرسل .
* * *
وأما " شياطين الإنس والجن "، فإنهم مَرَدتهم ، وقد بينا الفعل الذي منه بُنِي هذا الاسم، بما أغنى عن إعادته . (3)
* * *
ونصب " العدو " و " الشياطين " بقوله: (جعلنا) . (4)
* * *
وأما قوله: (يُوحِي بعضُهم إلى بعض زخرف القول غرورًا)، فإنه يعني أنّه يلقي الملقي منهم القولَ، الذي زيّنه وحسَّنه بالباطل إلى صاحبه, ليغترّ به من سمعه، فيضلّ عن سبيل الله . (5)
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: (شياطين الإنس والجن).
فقال بعضهم: معناه: شياطين الإنس التي مع الإنس, وشياطين الجن التي مع الجنّ، وليس للإنس شياطين .
* ذكر من قال ذلك:
13765- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّا شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ولو شاء ربك ما فعلوه)، أما " شياطين الإنس "، فالشياطين التي تضلّ الإنس=" وشياطين الجن "، الذين يضلون الجنّ، يلتقيان، فيقول كل واحد منهما: " إني أضللت صاحبي بكذا وكذا, وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذا ", فيعلم بعضُهم بعضًا .
13766- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو نعيم, عن شريك, عن سعيد بن مسروق, عن عكرمة: (شياطين الإنس والجن)، قال: ليس في الإنس شياطين، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس, وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . (6)
13767- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل, عن السدي في قوله: (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا)، قال: للإنسان شيطان, وللجنّي شيطان, فيلقَى شيطان الإنس شيطان الجن, فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا .
* * *
قال أبو جعفر: جعل عكرمة والسدي في تأويلهما هذا الذي ذكرت عنهما، عدوّ الأنبياء الذين ذكرهم الله في قوله: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّا)، أولادَ إبليس، دون أولاد آدم، ودون الجن= وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورًا, ولدَ إبليس, وأن مَنْ مع ابن آدم من ولد إبليس يوحي إلى مَنْ مع الجن من ولده زخرفَ القول غرورًا .
وليس لهذا التأويل وجه مفهوم, لأن الله جعل إبليس وولده أعداءَ ابن آدم, فكل ولده لكل ولده عدوّ. وقد خصّ الله في هذه الآية الخبر عن الأنبياء أنه جعل لهم من الشياطين أعداءً. فلو كان معنيًّا بذلك الشياطين الذين ذكرهم السدي, الذين هم ولد إبليس, لم يكن لخصوص الأنبياء بالخبرِ عنهم أنه جعل لهم الشياطين أعداءً، وجهٌ . وقد جعل من ذلك لأعدى أعدائه، مثل الذي جعل لهم. ولكن ذلك كالذي قلنا، من أنه معنيٌّ به أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوًّا يوحي بعضهم إلى بعض من القول ما يؤذيهم به .
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
13768- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد, عن حميد بن هلال قال، حدثني رجل من أهل دمشق, عن عوف بن مالك, عن أبي ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر, هل تعوَّذت بالله من شر شياطين الإنس والجنّ؟ قال: قلت: يا رسول الله, هل للإنس من شياطين؟ قال: نعم! (7)
13769- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة, عن ابن عائذ, عن أبي ذر, أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس, قال فقال: يا أبا ذر, هل صلَّيت؟ قال قلت: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين. قال: ثم جئت فجلستُ إليه فقال: يا أبا ذر، هل تعوَّذت بالله من شرِّ شياطين الإنس والجن؟ قال قلت: يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال: نعم, شرٌّ من شياطين الجن! (8)
13770- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة قال: بلغني أن أبا ذر قام يومًا يُصلّي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعوَّذ يا أبا ذر، من شياطين الإنس والجن. فقال: يا رسول الله، أوَ إنّ من الإنس شياطين؟ قال: نعم! (9)
* * *
وقال آخرون في ذلك بنحو الذي قلنا: من أن ذلك إخبارٌ من الله أنّ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض .
* ذكر من قال ذلك:
13771- حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: (شياطين الإنس والجن)، قال: من الجن شياطين, ومن الإنس شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض = قال قتادة: بلغني أن أبا ذر كان يومًا يصلّي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعوَّذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن. فقال: يا نبي الله, أوَ إن من الإنس شياطين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم!
13772- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّا شياطين الإنس والجن)، الآية, ذكر لنا أنّ أبا ذر قام ذات يوم يصلي, فقال له نبي الله: تعوّذ بالله من شياطين الجن والإنس. فقال: يا نبي الله، أوَ للإنس شياطين كشياطين الجن؟ قال: " نعم, أوَ كذَبْتُ عليه؟" (10)
13773- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، قال مجاهد: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوَّا شياطين الإنس والجن)، فقال: كفار الجنّ شياطين، يوحون إلى شياطين الإنس، كفارِ الإنس، زخرفَ القول غرورًا .
* * *
وأما قوله: (زُخرف القول غرورًا)، فإنه المزيَّن بالباطل، كما وصفت قبل. يقال منه: " زخرف كلامه وشهادته "، إذا حسَّن ذلك بالباطل ووشّاه ، كما:-
13774- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبو نعيم, عن شريك, عن سعيد بن مسروق, عن عكرمة قوله: (زخرف القول غرورًا) قال: تزيين الباطل بالألسنة .
13775- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: أما " الزخرف ", فزخرفوه، زيَّنوه .
13776- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (زخرف القول غرورًا)، قال: تزيين الباطل بالألسنة .
13777- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله .
13778- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (زخرف القول غرورًا)، يقول: حسَّن بعضهم لبعضٍ القول ليتّبعوهم في فتنتهم .
13779- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (زخرف القول غرورًا) قال: " الزخرف "، المزيَّن, حيث زيَّن لهم هذا الغرور, كما زيَّن إبليس لآدم ما جاءه به وقاسمه إنه له لمن الناصحين . وقرأ: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ، [سورة فصلت: 25]. قال: ذلك الزخرف .
* * *
وأما " الغرور "، فإنه ما غرّ الإنسان فخدعه فصدَّه عن الصواب إلى الخطأ وعن الحق إلى الباطل (11) = وهو مصدر من قول القائل: " غررت فلانًا بكذا وكذا, فأنا أغرُّه غرورًا وغرًّا . كالذي:-
13780- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: ( غرورًا ) قال: يغرّون به الناسَ والجنّ .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولو شئت، يا محمد، أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي أعداءً من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم, فعلتُ ذلك، ولكني لم أشأ ذلك، لأبتلي بعضهم ببعض، فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق =(فذرهم)، يقول: فدعهم (12) = يعني الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يوحي إليهم أولياؤهم من شياطين الإنس والجن=(وما يفترون)، يعني: وما يختلقون من إفك وزور. (13)
يقول له صلى الله عليه وسلم: اصبر عليهم، فإني من وراء عقابهم على افترائهم على الله، واختلاقهم عليه الكذبَ والزور .
---------------------
الهوامش :
(3) انظر تفسير (( الشيطان )) فيما سلف 1 : 111 ، 112 ، 296 .
(4) انظر معاني القرآن 1 : 351 .
(5) انظر تفسير (( الوحي )) فيما سلف من فهارس اللغة ( وحي ) .
(6) الأثر : 13466 - (( سعيد بن مسروق الثوري )) ، مضى برقم : 7162 .
(7) الأثر : 13768 - (( حميد بن هلال العدوي )) ، ثقة ، متكلم فيه . سمع من (( عوف ابن مالك )) ، ولكنه رواه بالوسطة ، عن مجهول : (( رجل من أهل دمشق )) . مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 2 / 344 ، وابن أبي حاتم 1 / 2 /230 .
و (( عوف بن مالك بن نضلة الجشمي )) ، ثقة ، مضى برقم : 6172 ، 12825 ، 12826 لم يذكر أنه سمع من أبي ذر . وهذا الخبر فيه مجهول . ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 380
(8) الأثر : 13769 - كان في إسناد هذا الخبر خطأ فاحش ، وقع شك من سهو الناسخ وعجلته ، فإنه كتب (( حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عن ابن عباس ، أبي عبد الله محمد بن أيوب )) ، ثم ضرب على (( ابن عباس )) . ولكنه ترك (( عن علي بن أبي طلحة )) ، وهو خطأ لا شك فيه كما سترى بعد . وسبب ذلك إسناد أبي جعفر المشهور وهو : (( حدثني المثنى ، قال حدثنا عبد الله صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس )) وهو إسناد دائر في التفسير ، آخره رقم : 13756 ، فجعل فكتب الإسناد المشهور ، ثم استدرك فضرب على (( ابن عباس )) ، والصواب أن يضرب أيضًا على (( علي بن أبي طلحة )) ، لأن هذا إسناد مختلف عن الأول كل الاختلاف ، ولذلك حذفت (( عن علي بن أبي طلحة )) ، مع ثبوته في المخطوطة والمطبوعة ، ولكن ابن كثير ذكره في التفسير على الصواب 3 : 379 ، كما أثبته .
و (( أبو عبد الله محمد بن أيوب )) ، كأنه أيضًا خطأ من الناسخ ، وصوابه : (( أبو عبد الملك محمد بن أيوب )) لما سترى .
(( محمد بن أيوب الأزدي )) ، (( أبو عبد الملك )) ، قال البخاري في الكبير 1 / 1 /29 ، 30 ( محمد بن أيوب أبو عبد الملك الأزدي ، عن ابن عائذ ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آدم نبي مكلم . قال لنا : عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن محمد بن أيوب ، حديثه في الشاميين . سمع منه معاوية بن صالح )) وترجمة ابن أبي حاتم 3 / 2 / 196 ، 197 ، فذكر مثله .
و (( ابن عائذ )) هو (( عبد الرحمن بن عائذ الثمالي )) ، ويقال : الأزدي الكندي ، ويقال : اليحصبي . وروى له الأربعة ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 2 / 2 / 270 ، وكان ابن عائذ من حملة العلم ، يطلبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحاب أصحابه . روى عن عمر وعلي مرسلا . وفي التهذيب انه روى عنهما وعن أبي ذر ، وعن غيرهم من الصحابة ، ولم يذكر (( مرسلا )) .
وذكر ابن كثير هذا الأثر والذي يليه في تفسيره 3 : 379 ثم قال : (( وهذا أيضًا فيه انقطاع )) ، وتبين من تفسيره إسناده أنه غير منقطع . ثم قال : (( وروى متصلا كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا المسعودي ، أنبأني أبو عمر الدمشقي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر قال : ... )) وذكر الحديث ، وهو بطوله في مسند أحمد 5 : 178 ، 179 .
ثم ذكر ابن كثير طرقًا أخرى للحديث ثم قال : (( فهذه طرق لهذا الحديث ، ومجموعها يفيد قوته وصحته ، والله أعلم )) .
(9) الأثر : 13770 - هذا أثر منقطع ، انظر التعليق على الخبر السالف ، وما قاله ابن كثير .
(10) قوله : (( أو كذبت عليه )) ، استنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أبي ذر ، فإن نص التنزيل دال على ذلك ، ورسول الله هو الصادق المصدق المبلغ عن ربه الحق الذي لا كذب فيه .
(11) انظر تفسير (( الغرور )) فيما سلف 7 : 453 / 9 : 224 .
(12) انظر تفسير (( ذر )) فيما سلف ص : 46 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
(13) انظر تفسير (( الافتراء )) فيما سلف : 11 : 533 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[112] قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين، كما أن من الجن شياطين، وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن؛ وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانًا.
وقفة
[112] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ كلما كانت رتبة العبد أعلى، كانت البلايا أشد والعداوات أصعب؛ ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام.
وقفة
[112] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ هيهات أن تسلك طريق الأنبياء دون أن تلتقي بأعدائهم على قارعة الطريق!
وقفة
[112] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ من سنَّته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجنِّ للأنبياء وأتباعهم؛ لأنَّ الحقَّ يعرف بضدّه من الباطل.
وقفة
[112] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ إذا ورث العالم من النبي رسالته؛ فلا بد أن يرث معها خصومها، وإلا ففي رسالته خلل، فليفتش عنه.
اسقاط
[112] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ لم يسلم الأنبياء ﷺ من وجود عدو مناوئ، مع أنهم على الحق المحض، فهل تسلم أنت؟! فاصبر وصابر.
وقفة
[112] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ حتى الأنبياء كان لهم أعداء، فكيف تستبعد وجودهم حولك!
وقفة
[112] من ظن أنه سيسلك طريق دعوة الحق بلا أعداء فليتذكر طريق الرسل ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾.
وقفة
[112] من اتبع النبي فسيكون له أعداء بقدر التزامه بمنهجه ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾.
وقفة
[112] كل مصلح لا بد له من خصوم، وكلما ارتفع شأنًا تكاثروا، ولو كان نبيًّا ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾.
وقفة
[112] لا يكاد يتواصى شياطين الإنس والجن كما يتواصون على أفكار الشر، وهذا سر قوَّة الباطل ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾.
وقفة
[112] إذا لم يتعرض المصلح للابتلاء؛ فليس على طريق الأنبياء ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾.
عمل
[112] اقرأ كتابًا عن مخططات الصهيونية العالمية؛ للتعرف على طريقة تفكير أعداء الأنبياء من شياطين الإنس ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾.
وقفة
[112] ﴿جعلنا لكل نبي عدوا ... ولو شاء ربك ما فعلوه﴾ النظر بعين القدر يهون من وطأتهم، ويكشف وهنهم، ويبين أن البلاء بهم له حكمة ونهاية.
وقفة
[112] ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ شياطين الإنس أشد خطورة من شياطين الجن؛ لذا قدم الله ذكرهم هنا.
وقفة
[112] ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ تقدم الجن على الإنس في القرآن؛ لتقدم خلقهم، فما سبب تقديم الإنس على الجن في الأنعام، والإسراء، والجن؟ الجواب: قيل تقديم الجن على الإنس لأن الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار، وتقديم الإنس في بعض المواضع للتنبيه على أن شياطين الإنس أشد عداوة.
وقفة
[112] لو عُرِض الشر على العقول بلا تزيين لم يقبله أحد، ولكن يزخرفونه ليمر عليها فتتقبله ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾.
وقفة
[112] سحر الإعلام: قال ﷻ: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ قال ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي، كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ». [أحمد 1/22، وصححه الألباني].
وقفة
[112] الصادق المنصف يعترض طريقه ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾، فإن التفت روعوه فوسوسوا له، وإن تجاهلهم وذكر الله انخنسوا.
وقفة
[112] ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ كم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق !
وقفة
[112] ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات؛ حتى يجعلوه في أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلًا، والباطل حقًا.
وقفة
[112] ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ لا تغرنك زخارف أقوالهم؛ فإن خلفها دسائس، والمؤمن ينبغي عليه أن يفطن لذلك.
وقفة
[112] ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ لا يحكي ضلاله إلا بعد زخرفته، المؤمن الفطن لا تغره الزخارف.
وقفة
[112] ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ في هذا العصر الخوف يصنعه أُناس، والاستماع للمخوفين والمرجفين هو استماع لصوت الشيطان.
وقفة
[112] ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ قلنا لكم: لا تنصتوا لهؤلاء الجهلة من الرقاة ومفسري الأحلام صُنَّاع الخوف!
وقفة
[112] من أساليب أهلِ الباطل تحسين القول وزخرفته، مع أنه في داخله لا يتضمن إلا الفساد ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾.
وقفة
[112] (المطربة القديرة فلانة تحكي تجربتها ...، مسرحية من بطولة الفنان ...، الفلم العالمي ...) عناوين براقة يطالعنا بها الإعلام، تفتشها فلا تجد شيئًا، فأي مقدار وأي بطولة؟ وصدق الله: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾.
وقفة
[112] إذا وجدت القول مثيرًا بدون دليل من الوحي فاعلم أنه شيء يسمى: ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ﴾.
وقفة
[112] ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ لوﻻ (زخارف القول) لظهرت عيوبه.
وقفة
[112] ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ إذا كثرت (زخارف) القول، فاعلم أنها تخفي وراءها عيوب فكرة باطلة.
عمل
[112] ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ فلا تحزن على ما وقع، ولا تخف من القادم.
وقفة
[112] ظلم القريب، وهجر الحبيب، وكل أذى يصيب، أطفئ لهيبه بقول الله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.
وقفة
[112] أطفئ لهيب الحزن والألم في قلبك، وتعرف على الحكمة الغائبة من الأحداث، وذلك بتأملك في قول ربك: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.
وقفة
[112] ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ ذكرت في موطنين من السورة، مرة بلفظ الرب هنا، ومرة بلفظ الألوهية: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [137]، ولكل منهما دلالته في موطنه وسياقه، ثم عقب: ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾؛ لتسكن النفس وترضى، ومن ثم تكل أمرها إلى الرب المدبر، وتحسن في العبودية، ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ ترسم منهجًا دعويًّا تحتاجه الأمة عند ازدياد الفتن واشتداد المحن.
وقفة
[112] ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ كم من الرضا والسكينة تُفرغ في النفس، وتربط على القلب حين يوقن المرء بهذه المشيئة!
عمل
[112] اطمئن؛ فأمرك بيد الله، واعلم أنه ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾.
الإعراب :
- ﴿ وَكَذلِكَ جَعَلْنا: ﴾
- الواو: عاطفة. الكاف: اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ وهو مضاف. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اللام: للبعد. والكاف: حرف خطاب. جعلنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة «جَعَلْنا» في محل رفع خبر المبتدأ.
- ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا: ﴾
- جار ومجرور متعلق بجعلنا. نبي: مضاف إليه مجرور بالكسرة المنونة. عدوا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة المنونة.
- ﴿ شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ: ﴾
- شياطين: مفعول به أول منصوب مثله بالفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن «مفاعيل» بتقديم المفعول الثاني. الانس: وتعرب مثلها مضاف اليه مجرور بالكسرة. الجن: معطوفة بالواو على الانس.
- ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ: ﴾
- الجملة: في محل نصب حال. يوحي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل. بعض: فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة.
- ﴿ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً: ﴾
- جار ومجرور متعلق بيوحي. ونوّن آخر الاسم لحذف المضاف اليه. زخرف: مفعول به منصوب بالفتحة.القول: مضاف اليه مجرور بالكسرة. غرورا: حال منصوب بالفتحة. أي خدعا منهم وأخذا على غرة أو غرورا منهم ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا على المصدر أي غروا غرورا.
- ﴿ وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ: ﴾
- الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم. شاء:فعل ماض مبني على الفتح. ربك: فاعل مرفوع بالضمة. والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ ما فَعَلُوهُ: ﴾
- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها. ما: نافية لا عمل لها. فعلوه: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو:ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
- ﴿ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ: ﴾
- الفاء: استئنافية. ذر: فعل أمر بمعنى «دع» مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وما: الواو: عاطفة.و«ما» اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير «هم». يفترون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يَفْتَرُونَ» صلة الموصول لا محل لها. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية. و «ما» وما تلاها بتأويل مصدر في محل نصب بتقدير: دعهم ودع افتراءهم. '
المتشابهات :
| الأنعام: 112 | ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ |
|---|
| الفرقان: 31 | ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [112] لما قبلها : وبعد بيان عناد المشركين وما اقترحوه من الآيات؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل لنَبِيِّه صلى الله عليه وسلم هنا أنَّه ما أرسلَ نبيًّا إلَّا جَعَلَ له أعداءً من شياطينِ الإِنسِ والجنِّ، فهذه سُنَّة الله في جميعِ الأنبياءِ، والقَصْدُ من هذا تسليةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتَثبيتُ فؤادِه، قال تعالى:
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [113] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ .. ﴾
التفسير :
{ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ} أي:ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف{ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة، يحملهم على ذلك،{ وَلِيَرْضَوْهُ} بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة، رضوه، وزين في قلوبهم، وصار عقيدة راسخة، وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك، أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي:يأتون من الكذب بالقول والفعل، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة، فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن، المستجيبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان بالآخرة، وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة، فإنهم لا يغترون بتلك العبارات، ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها، وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات ردية، وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها، كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة، ما هو أرق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى، في جعله للأنبياء أعداء، وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه، أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق، وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. فإنه -حينئذ- يتبين من أدلة الحق، وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه، ما هو من أكبر المطالب، التي يتنافس فيها المتنافسون.
وقوله: وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. معطوف على غُرُوراً فيكون علة أخرى للإيحاء، والضمير في إِلَيْهِ يعود إلى زخرف القول.
وأصل الصغو: الميل. يقال: صغا يصغو ويصغى صغوا، وصغى يصغى صغا أى: مال، وأصغى إليه مال إليه يسمعه، وأصغى الإناء: أماله. ويقال: صغت الشمس والنجوم صغوا: مالت إلى الغروب.
والمعنى: يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف القول ليغروا به الضعفاء، ولتميل إلى هذا الزخرف الباطل من القول قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لموافقته لأهوائهم وشهواتهم.
وخص عدم إيمانهم بالآخرة بالذكر- مع أنهم لا يؤمنون بأمور أخرى يجب الإيمان بها- لأن من لم يؤمن بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب يمشى دائما وراء شهواته وأهوائه ولا يتبع إلا زخرف القول وباطله.
ثم بين- سبحانه- تدرجهم السيئ في هذا العمل الأثيم فقال: وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ.
أى: وليرضوا هذا الفعل الخبيث لأنفسهم بعد أن مالت إليه قلوبهم، وليقترفوا ما هم مقترفون أى: وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الأعمال السيئة فإن الله- تعالى- سيجازيهم عليها بما يستحقونه.
وأصل القرف والاقتراف. قشر اللحاء عن الشجر، والجلدة عن الجرح. واستعير الاقتراف للاكتساب مطلقا ولكنه في الإساءة أكثر. فيقال: قرفته بكذا إذا عبته واتهمته.
قال أبو حيان: وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة، لأنه أولا يكون الخداع، فيكون الميل، فيكون الرضا، فيكون الاقتراف، فكل واحد مسبب عما قبله .
ثم أمر الله- تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصارح المشركين بأن الله وحده هو الحكم الحق، وإن كتابه هو الآية الكبرى الدالة على صدقه فيما يبلغه عنه فقال- تعالى-:
وقوله تعالى : ( ولتصغى إليه ) أي : ولتميل إليه - قاله ابن عباس - ( أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم .
وقال السدي : قلوب الكافرين ، ( وليرضوه ) أي : يحبوه ويريدوه . وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة ، كما قال تعالى : ( فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ) [ الصافات : 161 - 163 ] ، وقال تعالى : ( إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) [ الذاريات : 8 ، 9 ] . وليقترفوا ما هم مقترفون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( وليكتسبوا ما هم مكتسبون وقال السدي ، وابن زيد : وليعملوا ما هم عاملون .
القول في تأويل قوله تعالى : وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا =(ولتصغى إليه)، يقول جل ثناؤه: يوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المزيَّن من القول بالباطل, ليغرّوا به المؤمنين من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم=(ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة)، يقول: ولتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة .
* * *
= وهو من " صغَوْت تَصْغَى وتصغُو "= والتنـزيل جاء بـ " تصغَى " =" صَغْوًا، وصُغُوًّا "، وبعض العرب يقول: " صغيت "، بالياء، حكي عن بعض بني أسد: " صَغيت إلى حديثه, فأنا أصغَى صُغِيًّا " بالياء, وذلك إذا ملت. يقال: " صَغْوِي معك "، إذا كان هواك معه وميلك, مثل قولهم: " ضِلَعِي معك ". ويقال: " أصغيت الإناء " إذا أملته ليجتمع ما فيه، ومنه قول الشاعر: (14)
تَـرَى السَّـفِيهَ بِـهِ عَـنْ كُـلِّ مُحْكَمَةٍ
زَيْـغٌ, وفيـهِ إلَـى التَّشْـبِيهِ إصْغَـاءُ (15)
ويقال للقمر إذا مال للغيوب: " صغا " و " أصغى " .
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
* ذكر من قال ذلك:
13781- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن على بن أبي طلحة, عن ابن عباس: (ولتصغى إليه أفئدة)، يقول: تزيغ إليه أفئدة .
13782- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، قال ابن عباس في قوله: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة)، قال: لتميل .
13783- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة)، يقول: تميل إليه قلوبُ الكفار، ويحبونه، ويرضون به .
13784- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة )، قال: " ولتصغى "، وليهووا ذلك وليرضوه. قال: يقول الرجل للمرأة: " صَغَيْت إليها "، هويتها .
* * *
القول في تأويل قوله : وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وليكتسبوا من الأعمال ما هم مكتسبون .
* * *
حكي عن العرب سماعًا منها: " خرج يقترف لأهله ", بمعنى يكسب لهم. ومنه قيل: " قارف فلان هذا الأمر "، إذا واقعه وعمله .
وكان بعضهم يقول: هو التهمة والادعاء. يقال للرجل: " أنت قَرَفْتَنِي"، أي اتهمتني. ويقال: " بئسما اقترفتَ لنفسك " ، وقال رؤبة:
أَعْيَــا اقْـتِرَافُ الكَـذِبِ المَقْـرُوفِ
تَقْــوَى التَّقِــي وعِفَّــةَ العَفِيـفِ (16)
* * *
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: (وليقترفوا)، قال أهل التأويل .
* ذكر من قال ذلك:
13785- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: (وليقترفوا ما هم مقترفون)، وليكتسبوا ما هم مكتسبون .
13786- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (وليقترفوا ما هم مقترفون)، قال: ليعملوا ما هم عاملون .
13787- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وليقترفوا ما هم مقترفون)، قال: ليعملوا ما هم عاملون .
---------------------------
الهوامش :
(14) لم أعرف قائله .
(15) اللسان ( صغا ) ، وأيضًا في تفسير أبي حيان 4 : 205 ، والقرطبي 7 : 69 ، وفي اللسان والقرطبي : (( عن كل مكرمة )) ، وكأن الصواب ما تفسير ابن جرير ، وأبي حيان ، وكأن الشاعر يريد الذين يتبعون ما تشابه من آيات كتاب الله ، ويعرضون عن المحكم من آياته .
(16) ليسا في ديوانه ، وهما في مجاو القرآن 1 : 205 .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[113] التدرج الشيطاني مخادع ورهيب، فأول خطوة: الإصغاء، والثانية: الرضا، والثالثة: اقتراف الحرام.
وقفة
[113] القلوب الفارغة من الإيمان بالله أكثر القلوب إصغاء لأهل الشهوات والشبهات ﴿وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.
وقفة
[113] ﴿وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ﴾ أخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان؛ فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها.
وقفة
[113] ﴿وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ﴾ لا يرضى أحد ما يسخط الله إلا لضعف إيمانه بالآخرة.
وقفة
[113] ﴿ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ولِيرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون﴾ المَيل ثم الرضا ثم الاقتراف.
الإعراب :
- ﴿ وَلِتَصْغى إِلَيْهِ: ﴾
- الواو: عاطفة. وجواب الجملة محذوف تقديره: وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا على أن. اللام: لام الصيرورة وتحقيقها ما ذكر.أو هي لام التعليل. و «تصغى» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. اليه: جار ومجرور متعلق بتصغى
- ﴿ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ: ﴾
- فاعل مرفوع بالضمة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ: ﴾
- الجملة: صلة الموصول لا محل لها. لا: نافية لا عمل لها. يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالآخرة: جار ومجرور متعلق بيؤمنون.
- ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ: ﴾
- معطوفة بالواو على «لِتَصْغى» وتعرب مثلها وعلامة نصب الفعل حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
- ﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا: ﴾
- الواو: استئنافية. اللام: لام الأمر. يقترفوا: فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. أي فليقترفوا من هذه الدسائس ما هم مرتكبون فهم لن يضروك.
- ﴿ ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ: ﴾
- ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مقترفون: خبر «هم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن تنوين المفرد. والجملة صلة الموصول. '
المتشابهات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [113] لما قبلها : لما بَيَّنَ اللهُ عز وجل أن شياطين الإِنسِ والجِنِّ يُلقي بعضُهم إلى بعض بطرق خفية القول المزين الذي حسن ظاهره وقبح باطنه لكى يخدعوا به الضعفاء؛ بَيَّنَ هنا أن بعد الخداع يأتي الميل، ثم الرضا، ثم الاقتراف، قال تعالى:
﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴾
القراءات :
ولتصغى:
وقرئ:
بضم أوله، من «أصغى» ، وهى قراءة النخعي، والجراح بن عبد الله.
ولتصغى ... وليرضوه وليقترفوا:
قرئت:
بسكون اللام فيها، وهى قراءة الحسن.
مدارسة الآية : [114] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ .. ﴾
التفسير :
أي:قل يا أيها الرسول{ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا} أحاكم إليه، وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم. وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص، والعيب، والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما، فهو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر.{ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا} أي:موضَّحا فيه الحلال والحرام، والأحكام الشرعية، وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة، من اليهود والنصارى، يعترفون بذلك{ ويَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} ولهذا، تواطأت الإخبارات{ فَلَا} تشُكَّنَّ في ذلك ولا{ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ}
روى أن مشركي مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل بيننا حكما من أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزل قوله- تعالى- أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً الآية .
وقوله: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً كلام مستأنف على إرادة القول، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام.
والحكم- بفتحتين- هو من يتحاكم إليه الناس ويرضون بحكمه، وقالوا: إنه أبلغ من الحاكم «وأدل على الرسوخ، كما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم.
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أأميل إلى زخارف الشياطين، فأطلب معبودا سوى الله- تعالى- ليحكم بيني وبينكم، ويفصل المحق منها من المبطل.
وأسند صلى الله عليه وسلم الابتغاء لنفسه لا إلى المشركين، لإظهار كمال النصفة أو لمراعاة قولهم: اجعل بيننا وبينك حكما.
وغير مفعول لأبتغى وحَكَماً إما أن يكون حالا لغير أو تمييزا له. وجملة وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا حالية مؤكدة للإنكار أى: أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم، والحال أنه- سبحانه- هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أى مبينا فيه الحق والباطل، والحلال والحرام، والخير والشر، وغير ذلك من الأحكام التي أنتم في حاجة إليها في دينكم ودنياكم، وأسند الإنزال إليهم لاستمالتهم نحو المنزل واستدعائهم إلى قبول حكمه، لأن من نزل الشيء من أجله، من الواجب عليه أن يتقبل حكمه.
ثم ساق- سبحانه- دليلا آخر على أن القرآن حق فقال: وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ.
أى: والذين آتيناهم الكتاب أى التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين أن هذا القرآن منزل عليك من ربك بالحق. لأنهم يجدون في كتبهم البشارات التي تبشر بك، ولأن هذا القرآن الذي أنزله الله عليك مصدق لكتبهم ومهيمن عليها.
فهذه الجملة الكريمة تقرير لكون القرآن منزلا من عند الله، لأن الذين وثق بهم المشركون من علماء أهل الكتاب عالمون بحقيقته وأنه منزل من عند الله.
وقوله: فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ أى: فلا تكونن من الشاكين في أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند ربك بالحق، لأن عدم اعتراف بعضهم بذلك مرده إلى الحسد والجحود، وهذا النهى إنما هو زيادة في التوكيد، وتثبيت لليقين، كي لا يجول في خاطره طائف من التردد في هذا اليقين.
قال ابن كثير: وهذا كقوله- تعالى- فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ قال: وهذا شرط، والشرط لا يقتضى وقوعه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا أشك ولا أسأل» .
وقيل: الخطاب لكل من يتأتى له الخطاب على معنى أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته وصدقه فلا ينبغي أن يشك في ذلك أحد.
وقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم حاشاه من الشك.
يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره : ( أفغير الله أبتغي حكما ) أي : بيني وبينكم ، ( وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) أي : مبينا ، ( والذين آتيناهم الكتاب ) أي : من اليهود والنصارى ، ( يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) ، أي : بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين ، ( فلا تكونن من الممترين ) كقوله ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) [ يونس : 94 ] ، وهذا شرط ، والشرط لا يقتضي وقوعه; ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أشك ولا أسأل "
القول في تأويل قوله : أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام, القائلين لك: " كفَّ عن آلهتنا، ونكف عن إلهك ": إن الله قد حكم عليّ بذكر آلهتكم بما يكون صدًّا عن عبادتها=(أفغير الله أبتغي حكمًا)، أي: قل: فليس لي أن أتعدَّى حكمه وأتجاوزه, لأنه لا حَكَم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه (17) =(وهو الذي أنـزل إليكم الكتاب مفصلا) يعني القرآن=" مفصَّلا ", يعني: مبينًا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركم .
* * *
وقد بينا معنى: " التفصيل "، فيما مضى قبل . (18)
القول في تأويل قوله : وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن أنكر هؤلاء العادلون بالله الأوثان من قومك توحيدَ الله, وأشركوا معه الأندادَ, وجحدوا ما أنـزلته إليك, وأنكروا أن يكون حقًا وكذَّبوا به = فالذين آتيناهم الكتاب ، وهو التوراة والإنجيل ، من بني إسرائيل=(يعلمون أنه منـزل من ربّك)، يعني: القرآن وما فيه =(بالحق) يقول: فصلا بين أهل الحق والباطل, يدلُّ على صدق الصادق في علم الله, (19) وكذبِ الكاذب المفتري عليه =(فلا تكونن من الممترين)، يقول: فلا تكونن، يا محمد، من الشاكين في حقيقة الأنباء التي جاءتك من الله في هذا الكتاب، وغيرِ ذلك مما تضمنه، لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنَّه منـزل من ربك بالحق .
* * *
وقد بيَّنا فيما مضى ما وجه قوله: (فلا تكونن من الممترين)، بما أغنى عن إعادته، مع الرواية المروية فيه ، (20) وقد:
13788- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع قوله: (فلا تكونن من الممترين)، يقول: لا تكونن في شك مما قصَصنا عليك .
---------------------
الهوامش :
(17) انظر تفسير (( الحكم )) فيما سلف من فهارس اللغة ( حكم ) .
(18) انظر تفسير (( التفصيل )) فيما سلف 11 : 394 .
(19) في المطبوعة : (( الصادق في علم الله )) ، وفي المخطوطة : (( الصادق علم الله )) ، والصواب ما أثبت .
(20) انظر تفسير (( الأمتراء )) فيما سلف 3 : 190 - 192 / 6 : 472 ، 473 / 11 : 260
التدبر :
تفاعل
[114] ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ سَبِّح الله الآن.
وقفة
[114] اســم الله (الـحـكـم): لا حكم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه.
لمسة
[114] قال: ﴿حَكَمًا﴾ ولم يقل حاكمًا؛ لأن حكمًا هو الحاكم المتخصص بالحكم، الذي لا يُنقض حكمه، فهو أخص من الحاكم، ولذلك كان من أسمائه تعالى الحكم، ولم يكن منها الحاكم.
وقفة
[114] قال: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾، ولم يقل: (يقولون)؛ فإنَّ العلمَ لا يكون إلا حقًّا، خلاف القول!
الإعراب :
- ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً: ﴾
- الألف: ألف تعجيب وإنكار بلفظ استفهام.الفاء: زائدة- تزيينية-. غير: مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور بعده. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. ابتغي:فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. حكما: تمييز أو حال منصوب بالفتحة. بمعنى حكما بيني وبينكم ويجوز أن يكون مفعولا به ثانيا.
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي: ﴾
- الواو: استئنافية. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.
- ﴿ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا: ﴾
- الجملة: صلة الموصول لا محل لها.أنزل: فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. إليكم: جار ومجرور متعلق بأنزل. والميم علامة جمع الذكور. وحرك بالضم للاشباع. الكتاب: مفعول به منصوب بالفتحة. مفصلا: حال من الكتاب منصوب بالفتحة.
- ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ: ﴾
- الواو: استئنافية. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. آتينا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون حرك بالضم لاشباع الميم في محل نصب مفعول به أول. الكتاب: مفعول به ثان منصوب بالفتحة. وجملة «آتَيْناهُمُ الْكِتابَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ يَعْلَمُونَ: ﴾
- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة: في محل رفع خبر المبتدأ.
- ﴿ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ: ﴾
- أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «أن». منزل: خبرها مرفوع بالضمة و «أن» وما بعدها بتأويل مصدر سدّ مسدّ مفعولي «يعلم» بتقدير: يعلمون تنزيله.
- ﴿ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بمنزل. والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. بالحق: جار ومجرور متعلق بحال من الكتاب أو بصفة لمصدر محذوف تقديره: منزل تنزيلا متلبسا بالحق.
- ﴿ فَلا تَكُونَنَّ: ﴾
- الفاء: استئنافية. لا: ناهية جازمة. تكونن: فعل مضارع ناقص مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة في محل جزم بلا وسبب حذف النون اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والواو: ضمير متصل في محل رفع اسم «تكون» ونون التوكيد الثقيلة: لا محل لها.
- ﴿ مِنَ الْمُمْتَرِينَ: ﴾
- جار ومجرور في محل نصب متعلق بخبر «تكون» وعلامة جر الاسم: الياء: لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن تنوين المفرد. '
المتشابهات :
| آل عمران: 60 | ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ |
|---|
| البقرة: 147 | ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ |
|---|
| يونس: 94 | ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ |
|---|
| الأنعام: 114 | ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [114] لما قبلها : وبعدَ أن بَيَّنَ اللهُ عز وجل أنَّ الَّذينَ طلبُوا الآياتِ -وأقسموا أنهم يؤمنون إذا جاءتهم-كاذبونَ، وأنهم ما هم إلا من شياطين الإنس؛ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هنا أن يصارح المشركين بأن الله وحده هو الحكم الحق، وإن كتابه هو الآية الكبرى الدالة على صدقه، وأنَّ أهلَ الكتابِ يعلمُون صدقَه، قال تعالى:
﴿ أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾
القراءات :
منزل:
قرئ:
1- بالتشديد، وهى قراءة ابن عباس، وحفص.
2- بالتخفيف، وهى قراءة الباقين.
مدارسة الآية : [115] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً .. ﴾
التفسير :
{ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} أي:صدقا في الأخبار، وعدلا في الأمر والنهي. فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه{ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} [حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق، وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها، ولا اقتراح أحسن منها]{ وَهُوَ السَّمِيعُ} لسائر الأصوات، باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.{ الْعَلِيمُ} الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والماضي والمستقبل.
ثم بين- سبحانه- أن هذا الكتاب كامل من حيث ذاته بعد أن بين كماله من حيث إضافته إليه- تعالى- بكونه منزلا منه بالحق فقال- تعالى-: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا وقرئ (كلمات ربك) .
والمراد بها- كما قال قتادة وغيره- القرآن.
أى: كمل كلامه- تعالى- وهو القرآن، وبلغ الغاية في صدق أخباره ومواعيده، وفي عدل أحكامه وقضاياه.
وصدقا وعدلا مصدران منصوبان على الحال من رَبِّكَ أو من كَلِمَةُ وقيل: هما منصوبان على التمييز.
وجملة لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ مستأنفة لبيان فضل هذه الكلمات على غيرها أثر بيان فضلها في ذاتها. أى: لا مغير لها بخلف في الأخبار، أو نقض في الأحكام، أو تحريف أو تبديل كما حدث في التوراة والإنجيل، وهذا ضمان من الله- تعالى- لكتابه بالحفظ والصيانة، قال- تعالى- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.
ثم ختمت الآية بقوله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أى: هو- سبحانه- السميع لكل ما من شأنه أن يسمع، العليم بكل ما يسرون وما يعلنون.
وقوله : ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) قال قتادة : صدقا فيما قال ، وعدلا فيما حكم .
يقول : صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب ، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه ، وكل ما نهى عنه فباطل ، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة ، كما قال : ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) إلى آخر الآية [ الأعراف : 157 ] .
( لا مبدل لكلماته ) أي : ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ( وهو السميع ) لأقوال عباده ، ( العليم ) بحركاتهم وسكناتهم ، الذي يجازي كل عامل بعمله .
القول في تأويل قوله : وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكملت =" كلمة ربك ", يعني القرآن .
* * *
سماه " كلمة "، كما تقول العرب للقصيدة من الشعر يقولها الشاعر: " هذه كلمة فلان ". (21) .
* * *
=(صدقًا وعدلا)، يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل.
* * *
و " الصدق " و " العدل " نصبا على التفسير للكلمة, كما يقال: " عندي عشرون درهما " . (22)
=(لا مبدِّل لكلماته)، يقول: لا مغيِّر لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه ، (23) وذلك نظير قوله جل ثناؤه يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ،[سورة الفتح:15]. فكانت إرادتهم تبديل كلام الله، مسألتهم نبيَّ الله أن يتركهم يحضرون الحرب معه, وقولهم له ولمن معه من المؤمنين: ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ، بعد الخبر الذي كان الله أخبرهم تعالى ذكره في كتابه بقوله: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا الآية، [سورة التوبة: 83] , فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لن يخرجوا مع نبي الله في غَزاةٍ, ولن يقاتلوا معه عدوًّا بقولهم لهم: ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ، فقال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: " يريدون أن يبدلوا "= بمسألتهم إياهم ذلك= كلامَ الله وخبره: قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ . فكذلك معنى قوله: (لا مبدِّل لكلماته)، إنما هو: لا مغيِّر لما أخبرَ عنه من خبر أنه كائن، فيبطل مجيئه وكونه ووُقُوعه على ما أخبرَ جل ثناؤه، لأنه لا يزيد المفترون في كتب الله ولا ينقصون منها. وذلك أن اليهود والنصارى لا شك أنهم أهلُ كتب الله التي أنـزلها على أنبيائه, وقد أخبر جل ثناؤه أنهم يحرِّفون غيرَ الذي أخبر أنَّه لا مبدِّل له .
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
* ذكر من قال ذلك:
13789- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل لكلماته)، يقول: صدقًا وعدلا فيما حكَم .
* * *
وأما قوله: (وهو السميع العليم)، فإن معناه: والله " السميع "، لما يقول هؤلاء العادلون بالله, المقسمون بالله جهد أيمانهم: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها, وغير ذلك من كلام خلقه=" العليم "، بما تؤول إليه أيمانهم من برٍّ وصدق وكذب وحِنْثٍ، وغير ذلك من أمور عباده . (24)
----------------
الهوامش :
(21) انظر تفسير (( الكلمة )) فيما سلف 3 : 7 - 17 / 6 : 371 ، 410 - 412 / 8 : 432 / 9 : 410 / 10 : 129 ، 313
(22) (( التفسير )) ، هو (( التميز )) ، انظر فهارس المصطلحات فيما سلف .
(23) انظر تفسير (( التبديل )) فيما سلف 11 : 335 ، وفهارس اللغة ( بدل ) .
(24) انظر تفسير (( السميع )) و (( العليم )) فيما سلف من فهارس اللغة ( سمع ) و ( علم ) .
المعاني :
التدبر :
وقفة
[115] ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ الله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل من كان أتم علمًا وعدلًا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل.
وقفة
[115] القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، يُعْثَر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما يخالف الحق.
وقفة
[115] ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ كل ما في القرآن لا يزيد عن خبر أو أمر، فخبره صدق، وأمره عدل، بل لا أصدق من الأخبار التي أودعها الله في كتابه، ولا أعدل من أوامره ونواهيه.
وقفة
[115] ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف، والنهي عن كل قبيح.
الإعراب :
- ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ: ﴾
- الواو: استئنافية. تمت: فعل ماض مبني على الفتح.والتاء: تاء التأنيث الساكنة. كلمة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف. و «رَبِّكَ»: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.
- ﴿ صِدْقاً وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ: ﴾
- صدقا: حال منصوب بالفتحة المنونة.وعدلا: معطوفة بالواو على صدقا وتعرب مثلها. لا: نافية للجنس تعمل عمل «إن». مبدّل: اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب. لكلماته: جار ومجرور متعلق بخبر «لا» المحذوف وجوبا. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة. بتقدير: لا محرف كائن لكلماته.
- ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: ﴾
- الواو: استئنافية. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. السميع العليم: خبران للمبتدأ مرفوعان بالضمة. '
المتشابهات :
| الأنعام: 115 | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ |
|---|
| الأعراف: 137 | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ |
|---|
| هود: 119 | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [115] لما قبلها : لما ذكرَ اللهُ عز وجل أن القرآن هو الآية الكبرى الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ بَيَّنَ هنا أن هذا القرآن بلغ الغاية في صدق أخباره، وفي عدل أحكامه، قال تعالى:
﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
القراءات :
كلمة:
قرئت:
1- بالإفراد، وهى قراءة الكوفيين.
2- كلمات، بالجمع، وهى قراءة نافع.
مدارسة الآية : [116] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي .. ﴾
التفسير :
يقول تعالى، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، محذرا عن طاعة أكثر الناس:{ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم، وعلومهم. فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق، ولا إيصال لسواء الطريق. بل غايتهم أنهم يتبعون الظن، الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون، ومن كان بهذه المثابة، فحرى أن يحذِّر الله منه عبادَه، ويصف لهم أحوالهم؛ لأن هذا –وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم- فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام، التي ليست من خصائصه.
وبعد أن أقام- سبحانه- الأدلة على وحدانيته وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم أتبع ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى جهالات أعدائه فقال- تعالى-: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
أى: وإن تطع أكثر من في الأرض من الناس الذين استحبوا العمى على الهدى يضلوك عن الطريق المستقيم، وعن الدين القويم الذي شرعه الله لعباده، لأن هؤلاء المجادلين ما يتبعون في جدالهم وعقائدهم وأعمالهم إلا الظن الذي تزينه لهم أهواؤهم، وما هم إلا يخرصون أى:
يكذبون.
وأصل الخرص: القول بالظن. يقال: خرصت النخل خرصا- من باب قتل- حزرت ثمره وقدرته بالظن والتخمين. واستعمل في الكذب لما يداخله من الظنون الكاذبة، فيقال:
خرص في قوله- كنصر- أى: كذب.
قال صاحب المنار: «وهذا الحكم القطعي بضلال أكثر أهل الأرض ظاهر بما بيّنه به من اتباع الظن والخرص ولا سيما في ذلك العصر- تؤيده تواريخ الأمم كلها، فقد اتفقت على أن أهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبيائهم وضلوا ضلالا بعيدا، وكذلك أمم الوثنية التي كانت أبعد عهدا عن هداية رسلهم وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو أمى لم يكن يعلم من أحوال الأمم إلا شيئا يسيرا من شئون المجاورين لبلاد العرب خاصة»
يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال ، كما قال تعالى : ( ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ) [ الصافات : 71 ] ، وقال تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ يوسف : 103 ] ، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل "إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون" فإن الخرص هو الحزر ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمر وذلك كله عن قدر الله ومشيئته.
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ (116)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تطع هؤلاء العادلين بالله الأنداد، يا محمد، فيما دعوك إليه من أكل ما ذبحوا لآلهتهم, وأهلُّوا به لغير ربهم، وأشكالَهم من أهل الزيغ والضلال, فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله، ومحجة الحق والصواب، فيصدُّوك عن ذلك .
وإنما قال الله لنبيه: (وإن تطع أكثر من في الأرض)، من بني آدم, لأنهم كانوا حينئذ كفارًا ضلالا فقال له جل ثناؤه: لا تطعهم فيما دعوك إليه, فإنك إن تطعهم ضللت ضلالهم، وكنتَ مثلهم، لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطئوه . ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الذين نَهَى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه إليه في أنفسهم, فقال: (إن يتبعون إلا الظن)، فأخبر جل ثناؤه أنهم من أمرهم على ظن عند أنفسهم, وحسبان على صحة عزمٍ عليه، (25) وإن كان خطأ في الحقيقة =(وإن هم إلا يخرصون)، يقول: ما هم إلا متخرِّصون، يظنون ويوقعون حَزْرًا، لا يقينَ علمٍ. (26)
* * *
يقال منه: " خرَصَ يخرُصُ خَرْصًا وخروصًا "، (27)
أي كذب، و " تخرّص بظن "، و " تخرّص بكذب ", و " خرصتُ النخل أخرُصه ", و " خَرِصَتْ إبلك "، أصابها البردُ والجوع .
------------------
الهوامش :
(25) هكذا في المطبوعة و المخطوطة ، وأنا في شك من صوابه .
(26) انظر مجاز القرآن أبي عبيدة 1 : 206 .
(27) في المطبوعة : (( خرصا وخرصا )) ، وأثبت ما في المخطوطة ، ولم أجد (( خروصًا )) ، مصدرًا لهذا الفعل ، في شيء مما بين يدي من كتب اللغة ، ولكن ذكره أبو حيان في تفسيره أيضًا 4 : 205 .
التدبر :
وقفة
[116] دلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددًا، الأعظمون عند الله قدرًا وأجرًا.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ﴾ لا يكونُ الحقُّ دائمًا مع الكثرةِ بِالعدد، فقد انحرَف عَن الحق الكثيُر بسببِ اتِّباعهم لِلأكْثرية.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ وسبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة، ونفوس فاضلة، وتأمل في الصالح والضار، وتقديم الحق على الهوى، والرشد على الشهوة، ومحبة الخير للناس، وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ الاغترار بالكثرة يؤدي إلى العقل الجمعي ويفسر سياسة القطيع، والتي تقودك لمواكبة من حولك ولو كانوا على خطأ.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ كثرة الأتباع ليست دليلًا على صحة المنهج، وإلا فإبليس صاحب أكثر أتباع على وجه الأرض، ومن اغتر بكثرة أتباعه صرعوه، وتحكموا به وأهلكوه.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ أهل الحق أقل عددًا لكنهم أثقل وزنًا، وأهل الباطل كثرة، لكن لا وزن لهم عند الله.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ الأكثرية ليست دائمًا دليل على الصواب، والأقلية ليست دليلًا على الخطأ.
عمل
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ احذر تأثير الكثرة والانحراف مع التيار، فقد أخبر الله في كتابه أن طاعة الأكثرية كفيلة بإضلال سيد الأنبياء (مع استحالة ذلك في حق النبي المعصوم)، فكيف بمن دونه من الضعفاء؟!
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة التي تعلم الحق وتتبعه؛ إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق.
وقفة
[116] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ الاغترار بالكثرة وربط الحق بها خطأ انحرفت به أمم سابقة، لغة الأرقام تستعمل كثيرًا كما استعملها الجاهليون ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: 28]، طريق الحق واضح لا مجال للشك فية، تغليبك للظن لن يجعل منه حقًا!
وقفة
[116] أتباع الشياطين أكثر من أتباع المرسلين، واقرأ إن شئت: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ فلا تغرنك الكثرة.
وقفة
[116] من أعظم أسباب انحراف بعض الدعاة عن الطريق المستقيم: جعل كثرة الأتباع مقياس النجاح والفشل؛ تدبر: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾، فمن اغتر بالكثرة، واعتبرها مقياسه؛ أصبح تابعًا ومطيعًا لها، شاء أم أبى.
عمل
[116] الحرام حرام حتى لو فعله الجميع! لا تغتر فقط؟ تدبر: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ ، وتدبر: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103].
وقفة
[116] ستعرف قدر نعمة الهداية حق المعرفة حين تقرأ هذه النصوص بعيني قلبك: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103]، ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ ، ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: 13]، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: 21].
عمل
[116] اجعلوا الدين هو المقياس، فإن رأيتم الناس يمشون في طريق الحرام فلا تمشوا معهم، ولا تحتجوا بالأكثرية؛ فإن أكثر الناس غالبًا على ضلال، والله يقول: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾، ويقول: ﴿ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [يوسف: 103].
وقفة
[116] الكثرة ليست دليلًا على الحق ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.
وقفة
[116] الحق لا يرتبط بالكثرة, قال تعالى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.
عمل
[116] ﻻ يخيفنك كثرة من خالف طريق الحق، فإنهم قليلون بباطلهم، وإنك كثير بحقك، فقد قال الله لنبيه المعصوم ﷺ: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.
وقفة
[116] أتباع الشيطان أكثر من أتباع الأنبياء والمرسلين مجتمعين؛ واقرأ إن شئت: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ فلا تغتر بالكثرة !
وقفة
[116] الكثرة ليست دليل الصحة، فيُعرف الرجال بالحق، ولا يُعرف الحق بالرجال، تأمل: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.
وقفة
[116] لا يكتفي أهل الضلال بضلالهم، بل يدعون إليه: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.
وقفة
[116] ﴿ان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ طريق الحق واضح لا مجال للشك فية، تغليبك للظن لن يجعل منه حقًا.
الإعراب :
- ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ: ﴾
- الواو: استئنافية. إن: حرف شرط جازم. تطع:فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الياء تخفيفا وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أكثر: مفعول به منصوب بالفتحة.
- ﴿ مَنْ فِي الْأَرْضِ: ﴾
- من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة. في الأرض: جار ومجرور متعلق بصلة الموصول المحذوفة. والتقدير من كائن أو مستقر أو استقر في الأرض. وجملة «استقر في الأرض» صلة الموصول لا محل لها.
- ﴿ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: ﴾
- يضلّوا: فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه: حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو:ضمير متصل في محل رفع فاعل. والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. عن سبيل: جار ومجرور متعلق بيضلّون. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. وجملة «يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب.
- ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ: ﴾
- مخففة من «إِنْ» الثقيلة مهملة بمعنى «ما» نافية لا عمل لها.يتبعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل.
- ﴿ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ: ﴾
- إلّا: أداة استثناء والاستثناء هنا منقطع. الظن: مستثنى بإلّا منصوب بالفتحة. وإن: معطوفة بالواو على إن.
- ﴿ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ: ﴾
- هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إلّا: أداة حصر لا عمل لها. يخرصون: تعرب إعراب «يَتَّبِعُونَ» وجملة «إِلَّا يَخْرُصُونَ» في محل رفع خبر «هم» بتقدير: وما هم إلّا كاذبون. '
المتشابهات :
| الأنعام: 116 | ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ |
|---|
| يونس: 66 | ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ |
|---|
| الأنعام: 148 | ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [116] لما قبلها : وبعد أن أقام اللهُ عز وجل الأدلة على وحدانيته وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم؛ أتبع ذلك بنهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى جهالات أعدائه، فلا ينبغي أن يلتفت العاقلُ إلى كلمات الجهَّال، قال تعالى:
﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء
مدارسة الآية : [117] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن .. ﴾
التفسير :
والله تعالى أصدق قيلا، وأصدق حديثا، و{ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ} وأعلم بمن يهتدي. ويهدي. فيجب عليكم -أيها المؤمنون- أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم بمصالحكم، وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية، على أنه لا يستدل على الحق، بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون -عند الله- قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل، بالطرق الموصلة إليه.
وقوله- سبحانه- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ تقرير للآية السابقة، وتأكيد لما يفيده مضمونها، أى: إن ربك الذي لا تخفى عليه خافية هو أعلم منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن طريق الحق وهو أعلم منك ومن سائر الخلق- أيضا- بالمهتدين السالكين صراطه المستقيم، فعليك- أيها العاقل- أن تكون من فريق المهتدين لتسعد كما سعدوا واحذر أن تركن إلى فريق الضالين، فتشقى كما شقوا.
وبذلك تكون هذه الآيات الكريمة قد قررت أن الله وحده هو الحكم العدل، وأن كتابه هو المهيمن على الكتب السابقة، وأن أهل الكتاب يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، وأنه- سبحانه- قد تكفل بحفظ كتابه من التغيير والتبديل، وأن الطبيعة الغالبة في البشر هي اتباع الظنون والأهواء، لأن طلب الحق متعب، والكثيرون لا يصبرون على مشقة البحث والتمحيص، والقليلون هم الذين يتبعون اليقين في أحكامهم، والله وحده هو الذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده.
وبعد أن أقام- سبحانه- الأدلة على وحدانيته وكمال قدرته. وسعة علمه ورد على الشبهات التي أثارها المشركون حول الدعوة الإسلامية بما يخرس ألسنتهم. وأثبت- سبحانه- أنه هو الحكم الحق، وأن كتابه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه، وأن أكثر أهل الأرض يتبعون الظن في أحكامهم. بعد كل ذلك انتقل القرآن إلى الكلام في مسألة كثر فيها الجدل بين المسلمين والمشركين، وهي مسألة الذبائح ما ذكر عليه اسم الله منها وما لم يذكر فقال- تعالى-:
( هو أعلم من يضل عن سبيله ) فييسره لذلك ( وهو أعلم بالمهتدين ) فييسرهم لذلك ، وكل ميسر لما خلق له .
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ربك الذي نهاك أن تطيع هؤلاء العادلين بالله الأوثانَ, لئلا يُضِلوك عن سبيله, هو أعلم منك ومن جميع خلقه أيُّ خلقه يَضلّ عن سبيله بزخرف القول الذي يوحِي الشياطين بعضُهم إلى بعض, فيصدُّوا عن طاعته واتباع ما أمر به =(وهو أعلم بالمهتدين)، يقول: وهو أعلم أيضًا منك ومنهم بمن كان على استقامة وسدادٍ, لا يخفى عليه منهم أحد . يقول: واتبع، يا محمد، ما أمرتك به, وانته عما نهيتك عنه من طاعة مَنْ نهيتك عن طاعته, فإني أعلم بالهادي والمضلِّ من خلقي، منك .
* * *
واختلف أهل العربية في موضع: " مَن " في قوله: (إن ربك هو أعلم من يضل) .
فقال بعض نحويي البصرة: موضعه خفض بنيّة " الباء ". قال: ومعنى الكلام: إن ربك هو أعلم بمن يضِلُّ . (28)
* * *
وقال بعض نحويي الكوفة: موضعه رفع, لأنه بمعنى " أيّ"، والرافع له " يضلّ" . (29)
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أنه رفع بـ" يضل "، وهو في معنى " أيّ". وغير معلوم في كلام العرب اسم مخفوض بغير خافض، فيكون هذا له نظيرا.
* * *
وقد زعم بعضهم أن قوله: (أعلم)، في هذا الموضع بمعنى " يعلم ", واستشهد لقيله ببيت حاتم الطائي:
فَحَــالَفَتْ طَيّـئٌ مِـنْ دُونِنَـا حِلِفًـا
وَاللــهُ أَعْلَـمُ مـا كُنَّـا لَهُـمْ خُـذْلا (30)
وبقول الخنساء:
القَــــوْمُ أَعْلَـــمُ أَنَّ جَفْنَتَـــهُ
تَعْــدُو غَــدَاةَ الــرِّيحِ أَوْ تَسـري (31)
وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل، وإن كان جائزًا في كلام العرب, فليس قولُ الله تعالى ذكره: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله)، منه. وذلك أنه عطف عليه بقوله: (وهو أعلم بالمهتدين)، فأبان بدخول " الباء " في" المهتدين " أن " أعلم " ليس بمعنى " يعلم ", لأن ذلك إذ كان بمعنى " يفعل "، لم يوصل بالباء, كما لا يقال: " هو يعلم بزيد ", بمعنى: يعلم زيدًا .
------------------
الهوامش :
(28) انظر ما سلف 11 : 560 ، تعليق : 1 ، وأن قائله هو الأخفش .
(29) انظر تفصيل ذلك في معاني القرآن للفراء 1 : 352 ، وهذا قول الفراء .
(30) البيت ليس في ديوان حاتم ، وهو في تفسير القرطبي 7 : 72 ، عن هذا الموضع من تفسير أبي جعفر : وقوله : (( حلف )) هو بكسر الحاء واللام ، ألحق اللام كسرة الحاء لضرورة الشعر . ولو قال (( حلفا )) ( بفتح وكسر اللام ) وهو مصدر (( حلف يحلف )) مثل (( الحلف )) ( بكسر فسكون ) ، لكان صوابًا ، لأن (( الحلف )) الذي هو العهد ، إنما سمى (( حلفًا )) بمصدر (( حلف )) بمعنى أقسم ، لأن العهد يوثق باليمين والقسم .
(31) ديوانها : 104 ، في رثاء أخيها صخر ، وبعده :
فَــإِذَا أَضَــاءَ وَجَــاشَ مِرْجَلُـهُ
فَلَنِعْـــمَ رَبُّ النَّـــارِ والقِـــدْرِ
وقولها : (( تغدو )) ، أي تغدو على قومه وضيوفه . و (( غداة الريح )) ، أي غدوة في زمن الشتاء ، في زمان القحط وقلة الألبان ، (( و تسرى )) . يعني في الليل . وقولها : (( أضاء )) ، أي أوقد ناره لتوضع عليها القدور ، ويراها الضيفان .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[117] مقصد الآية إظهار شدة اعتناء الله بالمهتدين، وإحاطة علمه بضلال الضالين.
وقفة
[117] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ علم الله بهدايتك هو حسبك، ويغنيك إن ساء ظن الخلق بك.
الإعراب :
- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ: ﴾
- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ربك: اسمها منصوب للتعظيم بالفتحة. والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
- ﴿ أَعْلَمُ: ﴾
- خبر «هُوَ» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن «أفعل» التفضيل. والجملة الاسمية «هُوَ أَعْلَمُ» في محل رفع خبر «إِنَّ» ويجوز أن تكون «هُوَ» ضمير فصل لا محل له و «أَعْلَمُ» خبر «أن».
- ﴿ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ: ﴾
- من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به بفعل محذوف أي يعلم ويجوز أن يكون في محل جر بباء مقدرة. يضل: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «يَضِلُّ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.عن سبيله: جار ومجرور متعلق بيضل. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه.
- ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ: ﴾
- معطوفة بالواو على «هُوَ أَعْلَمُ» الأولى وتعرب إعرابها. بالمهتدين: جار ومجرور متعلق بأعلم وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. '
المتشابهات :
| الأنعام: 117 | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ |
|---|
| الأنعام: 119 | ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ |
|---|
| النحل: 125 | ﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ |
|---|
| النجم: 30 | ﴿ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ |
|---|
| القلم: 7 | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
لم يذكر المصنف هنا شيء
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [117] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو أطاع أكثر أهل الأرض لأضلُّوه؛ أخبره هنا أنه أعلم العالِمين بالضال والمهتدي؛ ففوض أمرهم إلى خالقهم، فقال تعالى:
﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾
القراءات :
يضل:
وقرئ:
بضم الياء، والفاعل ضمير «من» ، ومفعوله محذوف، وهى قراءة الحسن، وأحمد بن أبى شريح.
مدارسة الآية : [118] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر
﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ .. ﴾
التفسير :
تفسير الآيتين 118 و119:يأمر تعالى عباده المؤمنين، بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين، فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام، وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال، ابتداعا من عند أنفسهم، وإضلالا من شياطينهم، فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية، في هذه العادة الذميمة، المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه، أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم، وبينه، ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة، توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال، خوفا من الوقوع في الحرام، ودلت الآية الكريمة، على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها، فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك، فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه، قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى:{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى أن قال:{ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ثم حذر عن كثير من الناس، فقال:{ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ} أي:بمجرد ما تهوى أنفسهم{ بِغَيْرِ عِلْمٍ} ولا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامتُهم -كما وصفهم الله لعباده- أن دعوتهم غير مبنية على برهان، ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة، وآرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين، بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى، ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه.
روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال: أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله- فأنزل الله- فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. إلى قوله وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ .
وذكر الواحدي أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الله قتلها. قالوا. فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر أو الكلاب حلال وما قتله الله حرام فأنزل الله- تعالى- قوله: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الآية: .
والخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين الذين ضايقهم جدال المشركين لهم في شأن الذبائح.
والمعنى كلوا أيها المؤمنون مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه واتركوا ما ذكر عليه اسم غيره كالأوثان أو ما ذبح على النصب، أو ما ذكر اسم مع اسمه- تعالى- أو ما مات حتف أنفه، ولا تضرنكم مخالفتكم للمشركين في ذلك فإنهم ما يتبعون في عقائدهم ومآكلهم وأعمالهم إلا تقاليد الجاهلية وأوهامها التي لا ترتكز على شيء من الحق.
والفاء في قوله: فَكُلُوا يرى الزمخشري أنها جواب لشرط مقدر والتقدير: إن كنتم محقين في الإيمان فكلوا، ويرى غيره أنها معطوفة على محذوف والتقدير «كونوا على الهدى فكلوا» .
وقوله: إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ أى: إن كنتم بآياته التي من جملتها الآيات الواردة في هذا الشأن مؤمنين، فإن الإيمان بها يقتضى استباحة ما أحله سبحانه واجتناب ما حرمه.
هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه ، ومفهومه : أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه ، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات ، وأكل ما ذبح على النصب وغيرها . ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه
القول في تأويل قوله : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبآياته: " فكلوا "، أيها المؤمنون، مما ذكّيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحلّ به الذبيحة لكم, وذلك ما ذبحه المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق, أو ذبحه مَنْ دان بتوحيدي من أهل الكتاب, دون ما ذبحه أهل الأوثان ومَنْ لا كتاب له من المجوس =(إن كنتم بآياته مؤمنين)، يقول: إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه، بإحلال ما أحللت لكم، وتحريم ما حرمت عليكم من المطاعم والمآكل، مصدّقين, ودَعوا عنكم زخرف ما توحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكم، وتلبيس دينكم عليكم غرورًا .
* * *
وكان عطاء يقول في ذلك ما:-
13790- حدثنا به محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال، قلت لعطاء قوله: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)، قال: يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح. وكل شيء يدلّ على ذكره يأمر به .
المعاني :
لم يذكر المصنف هنا شيء
التدبر :
وقفة
[118] في هذه الآية أمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم.
وقفة
[118] تعرف على أحكام الذبائح الجائزة والمحرمة من خلال قراءة كتاب في ذلك، أو استماع درس ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾.
وقفة
[118] ﴿إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: إن كنتم بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإن الإيمان بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها.
الإعراب :
- ﴿ فَكُلُوا: ﴾
- الفاء: استئنافية. كلوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
- ﴿ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴾
- مما: مكونة من «من» حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن. ذكر: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. اسم: نائب فاعل مرفوع بالضمة. الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. عليه: أي على ذبحه وهو جار ومجرور متعلق بذكر. والجار والمجرور «مِمَّا» متعلق بكلوا. ومفعول «كلوا» محذوف لان «من» التبعيضية دالة عليه. وجملة «ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ: ﴾
- إن: حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء:ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور.
- ﴿ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ: ﴾
- جار ومجرور متعلق بمؤمنين. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة. مؤمنين: خبر «كان» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه بتقدير: إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. '
المتشابهات :
| الأنعام: 118 | ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ |
|---|
| الأنعام: 119 | ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ |
|---|
أسباب النزول :
- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج الترمذي وأبو داود والنَّسَائِي عن ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال أتى ناسٌ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل اللهفَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) إلى قولهوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ). وفي لفظ لابن ماجه عن ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله - عَزَّ وَجَلَّ -وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ). * دِرَاسَةُ السَّبَبِ:هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور.وقبل أن أنقل كلام المفسرين في نزول الآية الكريمة يحسن أن أبين أن اللفظ الآخر لحديث ابن عبَّاسٍ، والذي رواه ابن ماجه لا يخالف اللفظ الأول الذي جاء فيه: أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ أي كيف نأكل المذكاة التي قتلناها بأيدينا ولا نأكل الميتة التي قتلها الله ولم تذكَّ؟أما اللفظ الثاني فقالوا فيه: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، أي ما ذكيتم وذكرتم عليه اسم الله فلا تأكلوا أنتم الذين قتلتموه، وقولهم: وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، أي الميتة لأن الله هو الذي قتلها، وهذا يوافق اللفظ الأول تماماً. أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ وإليك كلام بعض المفسرين في نزول الآية الكريمة: قال ابن العربيمطلق سبب الآية الميتة، وهي التي قالوا هم فيها: ولا نأكل مما قتل الله، فقال الله لهم: لا تأكلوا منها فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها) اهـ. وقال القرطبيخاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها) اهـ. وقال السعديويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قولهحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ولعلها سبب نزول الآية لقولهوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ) بغير علم فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة، وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا: - معاندة لِلَّهِ ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان - أتأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك الميتة) اهـ.وقال ابن عاشوروالوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفًا من أن المشركين قالوا للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وللمسلمين لما حرم الله أكل الميتةأنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله) يعنون الميتة فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء فأنزل اللهوَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).أي: فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المُموّه بأن الميتة أولى بالأكل مما قتله الذابح بيده، فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى، بأن المذكى ذكر اسم الله عليه والميتة لا يذكر اسم الله عليها وهو فارق مؤثر) اهـ. * النتيجة: أن سبب نزول الآيات هو الحديث المذكور لأن سياقه يوافق سياق الآيات ولاحتجاج المفسرين به من السلف والخلف، ولأن إسناده حسن مع تصريحه بالنزول والعلم عند الله تعالى.'
- المصدر لباب النقول
الترابط والتناسب :
مُناسبة الآية [118] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل لرسولِه صلى الله عليه وسلم أنَّ أكثرَ أهلِ الأَرْضِ يُضِلُّونَ مَن أطاعَهم لأنَّهم ضالُّونَ خَرَّاصون، وأنه تعالى هو العليم بالضالين والمهتدين؛ أمر رسوله وأتباعه بمخالفة أولئك الضالين من قومهم ومن غيرهم في مسألة الذبائح وفي غيرها، قال تعالى:
﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾
القراءات :
لم يذكر المصنف هنا شيء


